المَذهَبُ الأشْعَريُّ أو مَذهَبُ الأشاعِرةِ: هو فِرْقةٌ تُنسَبُ إلى الشَّيْخِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ البَصْريِّ المُتَوفَّى في بَغْدادَ سَنَةَ (324هـ)، ظَهَرَ هذا المَذهَبُ في القَرْنِ الرَّابِعِ الهِجْريِّ، ثُمَّ تَطوَّرَ فيما بَعْدُ بواسِطةِ كَثيرٍ مِن أئِمَّةِ المَذهَبِ الأشْعَريِّ؛ كأبي الحَسَنِ الباهِلِيِّ، ومُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ يَعْقوبَ بنِ مُجاهِدٍ الطَّائيِّ، وأبي الحَسَنِ الطَّبَرِيِّ، والقاضي أبي بَكْرِ بنِ الباقِلَّانيِّ، والأسْتاذِ ابنِ فورَكٍ، والأسْتاذِ أبي إسْحاقَ الأسْفَرايِينيِّ، وأبي القاسِمِ القُشَيْريِّ، وأبي المَعالي الجُوَيْنيِّ، وأبي حامِدٍ الغَزاليِّ، والفَخْرِ الرَّازيِّ، وأبي الحَسَنِ الآمِدِيِّ، والإيجيِّ، حتَّى صارَ المَذهَبُ الأشْعَريُّ فِرْقةً كَلامِيَّةً، فَلْسَفيَّةً، مُرْجِئةً، جَبْريَّةً! وصارَ المَذهَبُ الأشْعَريُّ مِن أَشهَرِ المَذاهِبِ العَقَديَّةِ في العالَمِ الإسْلاميِّ، وصارَ يَنْتَسِبُ إليه كَثيرٌ مِن المُسلِمينَ؛ لظَنِّهم أنَّه مَذهَبُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ، وأنَّه المَذهَبُ الحَقُّ الواجِبُ الاتِّباعِ في العَقائِدِ دونَ ما سِواه مِن المَذاهِبِ! معَ أنَّ هذا المَذهَبَ لم يكُنْ مَعْروفًا عنْدَ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ وأتْباعِهم، ولا يُعرَفُ عن أحَدٍ مِن أئِمَّةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ القَوْلُ بِهذا المَذهَبِ الَّذي حَدَثَ بَعْدَ القَرْنِ الثَّالِثِ الهِجْريِّ، وسيَأتي النَّقْلُ مِن كُتُبِ الأشاعِرةِ أنْفُسِهم لبَيانِ تَطوُّرِ المَذهَبِ الأشْعَريِّ على يَدِ أعْلامِه، حتَّى دَخَلَ مُتَأخِّروهم في مَتاهاتٍ كَلامِيَّةٍ وفَلْسَفيَّةٍ تُخالِفُ العَقيدةَ الصَّحيحةَ السَّمْحةَ الَّتي كانَ عليها النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصْحابُه رَضِيَ اللهُ عنهم، ومَن اتَّبَعَهم بإحْسانٍ
.
انظر أيضا:
الفَصْلُ الثَّاني: التَّعْريفُ بأبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ.
الفَصْلُ الثَّالِثُ: أبرَزُ عُلَماءِ فِرقةِ الأشاعرَةِ وكُتُبِها.
الفَصْلُ الرَّابِعُ: تَفاوُتُ تَأثُّرِ أعْلامِ الأشاعِرةِ بالجَهْميَّةِ .
الفصلُ الخامسُ: علاقةُ الأشاعِرةِ بالتَّصوُّفِ.
الفَصْلُ الثَّاني: التَّعْريفُ بأبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ
هو أبو الحَسَنِ، علِيُّ بنُ إسْماعيلَ بنِ إسْحاقَ بنِ سالِمِ بنِ إسْماعيلَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ موسى بنِ بِلالِ بنِ أبي بُرْدةَ بنِ أبي موسى الأشْعَريِّ، مِن ذُرِّيَّةِ الصَّحابيِّ الجَليلِ أبي موسى الأشْعَريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، والأشْعَريُّ نِسْبةٌ إلى قَبيلةٍ يَمنيَّةٍ تَنْتَسِبُ إلى أَشعَرَ، مِن وَلَدِ كَهْلانَ بنِ سَبَأِ بنِ يَشجُبَ بنِ يَعرُبَ بنِ قَحْطانَ
.
وُلِدَ أبو الحَسَنِ الأشْعَريِّ في البَصْرةِ سَنَةَ 260هـ، وسَمِعَ الحَديثَ مِن الحافِظِ زَكَريَّا بنِ يَحْيى السَّاجيِّ البَصْريِّ (ت 307 هـ)، وأخَذَ عنه مَذهَبَ أهْلِ السُّنَّةِ، ولازَمَ أبا علِيٍّ الجُبَّائيَّ البَصْريَّ (ت 303 هـ)، شَيْخَ المُعْتَزِلةِ، وأخَذَ عنه مَذهَبَ الاعْتِزالِ، وكانَ الأشْعَريُّ يَنوبُ عنه في بعضِ مَجالِسِه، ولمَّا بَرَعَ في مَعْرِفةِ الاعْتِزالِ تَبَرَّأَ مِنه عَلَنًا، وأَكثَرَ مِن التَّأليفِ في الرَّدِّ على المُعْتَزِلةِ وغَيْرِهم مِن أهْلِ البِدَعِ .
قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ لمَّا رَجَعَ عن مَذهَبِ المُعْتَزِلةِ سَلَكَ طَريقةَ ابنِ كُلَّابٍ، ومالَ إلى أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ، وانْتَسَبَ إلى الإمامِ أَحْمَدَ، كما قد ذَكَرَ ذلك في كُتُبُه كلِّها، كـالإبانةِ، والمُوجَزِ، والمَقالاتِ، وغَيْرِها، وكانَ مُخْتلِطًا بأهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ كاخْتِلاطِ المُتكلِّمِ بهم...، وكانَ القُدَماءُ مِن أصْحابِ أَحْمَدَ؛ كـأبي بَكْرٍ عَبْدِ العَزيزِ، وأبي الحَسَنِ التَّميميِّ، وأمْثالِهما، يَذكُرونَه في كُتُبِهم على طَريقِ ذِكْرِ المُوافِقِ للسُّنَّةِ في الجُمْلةِ، ويَذكُرونَ ما ذَكَرَه مِن تَناقُضِ المُعْتَزِلةِ...، والأشْعَريُّ وأئِمَّةُ أصْحابِه؛ كـأبي الحَسَنِ الطَّبَرِيِّ، وأبي عَبْدِ اللهِ بنِ مُجاهِدٍ، والباهِلِيِّ، والقاضي أبي بَكْرٍ، مُتَّفِقونَ على إثْباتِ الصِّفاتِ الخَبَريَّةِ الَّتي ذُكِرَتْ في القُرْآنِ؛ كالاسْتِواءِ، والوَجْهِ، واليَدِ، وإبْطالِ تَأويلِها، وليس له في ذلك قَوْلانِ أصْلًا، ولم يَذكُرْ أحَدٌ عن الأشْعَريِّ في ذلك قَوْلَينِ أصْلًا، بلْ جَميعُ مَن يَحْكي المَقالاتِ مِن أتْباعِه وغَيْرِهم يَذكُرُ أنَّ ذلك قَوْلُه، ولكنْ لأتْباعِه في ذلك قَوْلانِ) .
وقال ابنُ تيميَّةَ أيضًا: (كانت خِبرتُه بالكلامِ خِبرةً مُفصَّلةً، وخِبرتُه بالسُّنَّةِ خِبرةً مُجمَلةً؛ فلذلك وافَق المُعتَزِلةَ في بعضِ أصولِهم التي التزموا لأجْلِها خِلافَ السُّنَّةِ، واعتقد أنَّه يمكِنُه الجمعُ بَينَ تلك الأصولِ وبين الانتِصارِ للسُّنَّةِ، كما فعل في مسألةِ الرُّؤيةِ والكلامِ والصِّفاتِ الخَبَريَّةِ، وغيرِ ذلك، والمُخالِفونَ له من أهلِ السُّنَّةِ والحديثِ ومن المُعتَزِلةِ والفلاسفةِ يقولونَ: إنَّه متناقِضٌ، وإنَّ ما وافق فيه المُعتَزِلةَ يُناقِضُ ما وافَق فيه أهلَ السُّنَّةِ، بل جُمهورُ المُخالِفينَ للأشعريِّ من المُثبتةِ والنُّفاةِ يقولونَ: إنَّ ما قاله في مسألةِ الرُّؤيةِ والكلامِ معلومُ الفسادِ بضرورةِ العَقلِ؛ ولهذا يقولُ أتباعُه: إنَّه لم يوافِقْنا أحَدٌ من الطَّوائِفِ على قَولِنا في مسألةِ الرُّؤيةِ والكلامِ، فلمَّا كان في كلامِه شَوبٌ من هذا وشَوبٌ من هذا، صار يقولُ من يقولُ: إنَّ فيه نوعًا من التجَهُّمِ، وأمَّا من قال: إنَّ قَولَه قَولُ جَهمٍ، فقد قال الباطِلَ، ومن قال: إنَّه ليس فيه شيءٌ من قولِ جَهمٍ، فقد قال الباطِلَ، واللهُ يحِبُّ الكلامَ بعِلمٍ وعَدلٍ، وإعطاءَ كُلِّ ذي حقٍّ حقَّه، وتنزيلَ النَّاسِ منازِلَهم) .
وقدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ في المَراحِلِ الَّتي مَرَّ بِها أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ كما سيَأتي بَيانُه، ومِن أَحسَنِ تَصانيفِه المُوافِقةِ لأهْلِ السُّنَّةِ في الجُمْلةِ: كِتابُ (الإبانة عن أصولِ الدِّيانة)، وكِتابُ (مَقالات الإسْلاميِّينَ واخْتِلاف المُصَلِّينَ)، و(رِسالة إلى أهْلِ الثَّغْرِ).
قالَ الذَّهَبيُّ: (لأبي الحَسَنِ ذَكاءٌ مُفرِطٌ، وتَبَحُّرٌ في العِلمِ، وله أشْياءُ حَسَنةٌ، وتَصانيفُ جَمَّةٌ تَقْضي له بسَعةِ العِلمِ...، قالَ أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ في كِتابِ (العُمَد في الرُّؤْيةِ) له: صَنَّفْتُ (الفُصول في الرَّدِّ على المُلْحِدينَ) وهو اثْنا عَشَرَ كِتابًا، وكِتابَ (المُوجَزِ)، وكِتابَ (خَلْق الأعْمالِ)، وكِتابَ (الصِّفات)، وهو كَبيرٌ، تَكَلَّمْنا فيه على أصْنافِ المُعْتَزِلةِ والجَهْميَّةِ، وكِتابَ (الرُّؤْية بالأبْصارِ)، وكِتابَ (الخاصِّ والعامِّ)، وكِتابَ (الرَّدِّ على المُجَسِّمةِ)، وكِتابَ (إيْضاحِ البُرْهانِ)، وكِتابَ (اللُّمَع في الرَّدِّ على أهْلِ البِدَع)، وكِتابَ (الشَّرْح والتَّفْصيل)، وكِتابَ (النَّقْض على الجُبَّائيِّ)، وكِتابَ (النَّقْض على البَلْخيِّ)، وكِتابَ (جُمَل مَقالاتِ المُلْحِدينَ)، وكِتابًا في الصِّفاتِ هو أَكبَرُ كُتُبِنا، نَقَضْنا فيه ما كُنَّا ألَّفْناه قَديمًا فيها على تَصْحيحِ مَذهَبِ المُعْتَزِلةِ، لم يُؤَلَّفْ لهم كِتابٌ مِثلُه، ثُمَّ أبانَ اللهُ لنا الحَقَّ فرَجَعْنا، وكِتابًا في (الرَّدِّ على ابنِ الرَّاوَنْديِّ)، وكِتابَ (القامِعِ في الرَّدِّ على الخالِديِّ)، وكِتابَ (أدَب الجَدَلِ)، وكِتابَ (جَواب الخُراسانيَّةِ)، وكِتابَ (جَواب السِّيرافِيِّينَ)، و(جَواب الجُرْجانِيِّينَ)، وكِتابَ (المَسائِل المَنْثورة البَغْداديَّة)، وكِتابَ (الفُنون في الرَّدِّ على المُلْحِدينَ)، وكِتابَ (النَّوادِر في دَقائِقِ الكَلامِ)، وكِتابَ (تَفْسير القُرْآنِ)، وسَمَّى كُتُبًا كَثيرةً سِوى ذلك) .
وقالَ الذَّهَبيُّ: (رَأيْتُ لأبي الحَسَنِ أرْبَعةَ تَواليفَ في الأُصولِ يَذكُرُ فيها قَواعِدَ مَذهَبِ السَّلَفِ في الصِّفاتِ، وقالَ فيها: تُمَرُّ كما جاءَتْ، ثُمَّ قالَ: وبذلك أَقولُ، وبه أَدينُ، ولا تُؤَوَّلُ) .
وقدْ تُوفِّيَ أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ في بَغْدادَ سَنَةَ 324هـ .
وقدِ اتَّفَقَ المُؤَرِّخونَ والباحِثونَ على أنَّه كانَ في أوَّلِ أمْرِه مُعْتزِليًّا، واسْتَمَرَّ على ذلك سِنينَ كَثيرةً، ثُمَّ رَجَعَ عن بِدْعةِ الاعْتِزالِ وعُمُرُه نَحْوُ أرْبَعينَ سَنَةً ، ورَدَّ على المُعْتَزِلةِ، وبَيَّنَ بُطْلانَ عَقائِدِهم الَّتي خالَفوا فيها الحَقَّ، وكانَ أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ في هذه المَرْحلةِ على طَريقةِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعيدِ بنِ كُلَّابٍ البَصْريِّ المُتَوفَّى سَنَةَ (243هـ)، الَّذي كانَ يُخالِفُ المُعْتَزِلةَ، ويُوافِقُ أهْلَ السُّنَّةِ في كَثيرٍ مِن المَسائِلِ الاعْتِقاديَّةِ. وطَريقةُ ابنِ كُلَّابٍ أَقرَبُ إلى السُّنَّةِ مِن طَريقةِ المُعْتَزِلةِ، فكانَ أبو الحَسَنِ على هذه الطَّريقةِ.
قالَ المَقْريزيُّ في تَرْجمةِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ: (صارَ مِن أئِمَّةِ المُعْتَزِلةِ، ثُمَّ رَجَعَ عن القَوْلِ بخَلْقِ القُرْآنِ وغَيْرِه مِن آراءِ المُعْتَزِلةِ، وصَعِدَ يَوْمَ الجُمُعةِ بجامِعِ البَصْرةِ كُرْسيًّا، ونادى بأَعْلى صَوْتِه: مَن عَرَفَني فقدْ عَرَفَني، ومَن لم يَعرِفْني فأنا أُعَرِّفُه بنَفْسي، أنا فُلانُ بنُ فُلانٍ، كُنْتُ أَقولُ بخَلْقِ القُرْآنِ، وأنَّ اللهَ لا يُرى بالأبْصارِ، وأنَّ أفْعالَ الشَّرِّ أنا أَفعَلُها، وأنا تائِبٌ مُقلِعٌ، مُعْتقِدٌ الرَّدَّ على المُعْتَزِلةِ، مُبَيِّنٌ لفَضائِحِهم ومَعايبِهم. وأخَذَ مِن حينِئذٍ في الرَّدِّ عليهم، وسَلَكَ بعضَ طَريقِ أبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَعيدِ بنِ كُلَّابٍ القَطَّانِ، وبَنى على قَواعِدِه) .
وذَكَرَ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ عَبْدَ اللهِ بنَ سَعيدِ بنِ كُلَّابٍ وقالَ: (وعلى طَريقتِه مَشى الأشْعَريُّ في كِتابِ الإبانةِ) . وفي هذا الكَلامِ نَظَرٌ، فالمُطَّلِعُ في كِتابِ الإبانةِ يَجِدُ أنَّه أَقرَبُ لمَنهَجِ السَّلَفِ مِن مَنهَجِ ابنِ كُلَّابٍ -كما سيَأتي- ثُمَّ الأشْعَريُّ نفْسُه صَرَّحَ أنَّه على مَنهَجِ ابنِ حَنْبَلٍ، فكيف نَترُكُ كَلامَه ونَقولُ: ألَّفَ كِتابَ الإبانةِ على طَريقةِ ابنِ كُلَّابٍ، وهو آخِرُ كُتُبِه؟!
وحُجَّةُ القائِلينَ بِهذا أنَّه لا يوجَدُ نَصٌّ واضِحٌ لأبي الحَسَنِ يُبيِّنُ فيه بَراءتَه مِن طَريقةِ ابنِ كُلَّابٍ كما تَبَرَّأَ مِن طَريقةِ المُعْتَزِلةِ، وهذه حُجَّةٌ داحِضةٌ، فلا يَلزَمُه أن يَذكُرَ ابنَ كُلَّابٍ بقَدْحٍ حتَّى يُنسَبَ لمَذهَبِ السَّلَفِ، ويَكْفيه انْتِسابُه للإمامِ أَحْمَدَ، وأنَّه يَقولُ بقَوْلِه؛ فقدْ قالَ في كِتابِه الإبانةِ : (فإن قالَ لنا قائِلٌ: قد أنْكَرْتُم قَوْلَ المُعْتَزِلةِ والقَدَريَّةِ والجَهْميَّةِ والحَروريَّةِ والرَّافِضةِ والمُرْجِئةِ، فعَرِّفونا قَوْلَكم الَّذي به تقَوْلونَ، وديانتَكم الَّتي بها تَدينونَ. قيلَ له: قَوْلُنا الَّذي نَقولُ به وديانتُنا الَّتي نَدينُ بها، التَّمَسُّكُ بكِتابِ اللهِ رَبِّنا عَزَّ وجَلَّ، وبسُنَّةِ نَبيِّنا مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وما رُوِيَ عن السَّادةِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ وأئِمَّةِ الحَديثِ، ونحن بذلك مُعْتَصِمونَ، وبما كانَ يَقولُ به أبو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ -نَضَّرَ اللهُ وَجْهَه ورَفَعَ دَرَجتَه وأَجزَلَ مَثوبتَه -قائِلونَ، ولِما خالَفَ قَوْلَه مُخالِفونَ؛ لأنَّه الإمامُ الفاضِلُ، والرَّئيسُ الكامِلُ، الَّذي أبانَ اللهُ به الحَقَّ، ودَفَعَ به الضَّلالَ، وأَوضَحَ به المِنْهاجَ، وقَمَعَ به بِدَعَ المُبْتَدِعينَ، وزَيْعَ الزَّائِغينَ، وشَكَّ الشَّاكِّينَ، فرَحْمةُ اللهِ عليه مِن إمامٍ مُقدَّمٍ، وجَليلٍ مُعظَّمٍ، وكَبيرٍ مُفهِمٍ) .
وهذا النَّصُّ ظاهِرٌ جِدًّا في رُجوعِه إلى مَذهَبِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وإلى ما كانَ عليه الإمامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ.
ومَن يُطالِعْ كِتابَ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ المُسمَّى (الإبانة عن أُصولِ الدِّيانة) بعِلمٍ وإنْصافٍ يَتَبيَّنْ له أنَّه سارَ فيه على مَذهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ، معَ وُجودِ عِباراتٍ مُجْمَلةٍ وأخْطاءٍ لا تُخرِجُه عن مَذهَبِ السَّلَفِ. وقدْ صَرَّحَ عَدَدٌ مِن العُلَماءِ برُجوعِه هذا، وانْتِسابِه للإمامِ أَحْمَدَ ومَذهَبِ السَّلَفِ .
قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (هذا الكِتابُ هو مِن أَشهَرِ تَآليفِ الأشْعَريِّ وآخِرِها؛ ولِهذا اعْتَمَدَه الحافِظُ أبو بَكْرٍ السَّمْعانيُّ في كِتابِ الاعْتِقادِ له، وحَكى عنه في مَواضِعَ مِنه، ولم يَذكُرْ مِن تَآليفِه سِواه، وكذلك الحافِظُ أبو القاسِمِ بنُ عَساكِرَ في كِتابِه الَّذي صَنَّفَه وسَمَّاه: «تَبْيينَ كَذِبِ المُفْتري فيما يُنسَبُ إلى الشَّيْخِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ»... صَنَّفَه ببَغْدادَ في آخِرِ عُمُرِه، لمَّا زادَ اسْتِبْصارُه في السُّنَّةِ، ولَعلَّه لم يُفصِحْ في بعضِ الكُتُبِ القَديمةِ بما أَفصَحَ به فيه وفي أمْثالِه، وإن كانَ لم يَنْفِ فيها ما ذَكَرَه هنا في الكُتُبِ المُتَأخِّرةِ، ففَرَّقَ بَيْنَ عَدَمِ القَوْلِ وبَيْنَ القَوْلِ وبَيْنَ القَوْلِ بالعَدَمِ) .
وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ أيضًا: (الأشْعَريَّةُ الَّذين يَنْفونَ الصِّفاتِ الخَبَريَّةَ، وأمَّا مَن قالَ مِنهم بكِتابِ الإبانةِ الَّذي صَنَّفَه الأشْعَريُّ في آخِرِ عُمُرِه، ولم يُظهِرْ مَقالةً تُناقِضُ ذلك؛ فهذا يُعَدُّ مِن أهْلِ السُّنَّةِ) .
وقالَ أيضًا: (أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ لمَّا رَجَعَ عن مَذهَبِ المُعْتَزِلةِ سَلَكَ طَريقةَ ابنِ كُلَّابٍ، ومالَ إلى أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ، وانْتَسَبَ إلى الإمامِ أَحْمَدَ، كما قد ذَكَرَ ذلك في كُتُبِه كلِّها؛ كـالإبانةِ، والمُوجَزِ، والمَقالاتِ، وغَيْرِها، وكانَ مُخْتلِطًا بأهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ كاخْتِلاطِ المُتَكلِّمِ بهم، بمَنزِلةِ ابنِ عَقيلٍ عنْدَ مُتَأخِّريهم، لكنَّ الأشْعَريَّ وأئِمَّةَ أصْحابِه أَتبَعُ لأُصولِ الإمامِ أَحْمَدَ وأمْثالِه مِن أئِمَّةِ السُّنَّةِ مِن مِثلِ ابنِ عَقيلٍ في كَثيرٍ مِن أحْوالِه، ومِمَّن اتَّبَعَ ابنَ عَقيلٍ كـأبي الفَرَجِ ابنِ الجَوْزيِّ في كَثيرٍ مِن كُتُبِه، وكانَ القُدَماءُ مِن أصْحابِ أَحْمَدَ؛ كـأبي بَكْرٍ عَبْدِ العَزيزِ، وأبي الحَسَنِ التَّميميِّ، وأمْثالِهما، يَذكُرونَه في كُتُبِهم على طَريقِ ذِكْرِ المُوافِقِ للسُّنَّةِ في الجُمْلةِ) .
وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ أيضًا: (كانَ الأشْعَريُّ أَقرَبَ إلى مَذهَبِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ وأهْلِ السُّنَّةِ مِن كَثيرٍ مِن المُتَأخِّرينَ المُنْتسِبينَ إلى أَحْمَدَ الَّذين مالوا إلى بعضِ كَلامِ المُعْتَزِلةِ؛ كابنِ عَقيلٍ، وصَدَقةَ بنِ الحُسَينِ، وابنِ الجَوْزيِّ، وأمْثالِهم) .
ونَقَلَ ابنُ القَيِّمِ كَلامَ ابنِ تَيْمِيَّةَ في انْتِسابِه لمَذهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ مُؤَيِّدًا له .
وقالَ الذَّهَبيُّ: (كانَ مُعْتزِليًّا ثُمَّ تابَ، ووافَقَ أصْحابَ الحَديثِ في أشْياءَ يُخالِفونَ فيها المُعْتَزِلةَ، ثُمَّ وافَقَ أصْحابَ الحَديثِ في أَكثَرِ ما يَقولونَه...، فله ثَلاثةُ أحْوالٍ: حالٌ كانَ مُعْتزِليًّا، وحالٌ كانَ سُنِّيًّا في بعضٍ دونَ البعضِ، وحالٌ كانَ في غالِبِ الأُصولِ سُنِّيًّا، وهو الَّذي عَلِمْناه مِن حالِه، فرَحِمَه اللهُ وغَفَرَ له ولسائِرِ المُسلِمينَ) .
وقالَ ابنُ كَثيرٍ: (ذَكَروا للشَّيْخِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ رَحِمَه اللهُ ثَلاثةَ أحْوالٍ، أوَّلُها: حالُ الاعْتِزالِ الَّتي رَجَعَ عنها لا مَحالةَ، والحالُ الثَّاني: إثْباتُ الصِّفاتِ العَقْلِيَّةِ السَّبْعةِ، وهي: الحَياةُ، والعِلمُ، والقُدْرةُ، والإرادةُ، والسَّمْعُ، والبَصَرُ، والكَلامُ، وتَأويلُ الخَبَريَّةِ؛ كالوَجْهِ، واليَدَينِ، والقَدَمِ، والسَّاقِ، ونَحْوِ ذلك، والحالُ الثَّالِثةُ: إثْباتُ ذلك كلِّه مِن غَيْرِ تَكْييفٍ ولا تَشْبيهٍ، جَرْيًا على مِنْوالِ السَّلَفِ، وهي طَريقتُه في (الإبانة) الَّتي صَنَّفَها آخِرًا، وشَرَحَه القاضي الباقِلَّانيُّ، ونَقَلَها أبو القاسِمِ ابنُ عَساكِرَ، وهي الَّتي مالَ إليها الباقِلَّانيُّ، وإمامُ الحَرَمينِ، وغَيْرُهما مِن أئِمَّةِ الأصْحابِ المُتَقدِّمينَ في أواخِرِ أقْوالِهم، واللهُ أَعلَمُ) .
وقالَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّاب: (كِتابُ الإبانةِ مِن أَشهَرِ تَصانيفِ أبي الحَسَنِ...، صَرَّحَ بأنَّ عَقيدتَه في آياتِ الصِّفاتِ وأحاديثِها اعْتِقادُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ، مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ وأئِمَّةِ الدَّينِ، ولم يَحْكِ تَأويلَ الاسْتِواءِ بالاسْتيلاءِ، واليَدِ بمَعْنى النِّعْمةِ، والعَيْنِ بمَعْنى العِلمِ، إلَّا عن المُعْتَزِلةِ والجَهْميَّةِ، وصَرَّحَ أنَّه خِلافُ قَوْلِه؛ لأنَّه خِلافُ قَوْلِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ. ثُمَّ تَجِدُ المُنْتَسِبينَ إلى عَقيدةِ الأشْعَريِّ قد صَرَّحوا في عَقائِدِهم ومُصَنَّفاتِهم مِن التَّفاسيرِ وشُروحِ الحَديثِ بالتَّأويلِ الَّذي أَنكَرَه إمامُهم، وبَيَّنَ أنَّه قَوْلُ المُعْتَزِلةِ والجَهْميَّةِ، ويَنسُبونَ هذا الاعْتِقادَ إلى الأشْعَريِّ، وهو قد أَنكَرَه ورَدَّه وأَخبَرَ أنَّه على غَيْرِ عَقيدةِ السَّلَفِ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ والأئِمَّةِ بَعْدَهم، وأنَّه على عَقيدةِ الإمامِ أَحْمَدَ!) .
وقالَ ابنُ بازٍ: (ليس عُلَماءُ الأشاعِرةِ مِن أتْباعِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ؛ لأنَّه رَجَعَ عن تَأويلِ الصِّفاتِ، وقالَ بمَذهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ في إثْباتِ الأسْماءِ والصِّفاتِ وإمْرارِها كما جاءَتْ مِن غَيْرِ تَحْريفٍ ولا تَعْطيلٍ ولا تَكْييفٍ ولا تَمْثيلٍ، كما أَوضَحَ ذلك في كِتابَيْه الإبانةِ والمَقالاتِ، فعُلِمَ ممَّا ذَكَرْنا أنَّ مَنْ أوَّلَ الصِّفاتِ مِن المُنْتَسِبينَ للأشْعَريِّ فليس على مَذهَبِه الجَديدِ، بلْ هو على مَذهَبِه القَديمِ، ومَعْلومٌ أنَّ مَذهَبَ العالِمِ هو ما ماتَ عليه مُعْتقِدًا له لا ما قالَه سابِقًا ثُمَّ رَجَعَ عنه؛ فيَجِبُ التَّنَبُّهُ لذلك) .
وقالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إنَّ إحدى الطَّائِفتَينِ فقط هُمْ أهْلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ؛ فإمَّا أن تكونَ طائِفةَ السَّلَفِ أهْلِ التَّحْقيقِ، وإمَّا أن تكونَ طائِفةَ الخَلَفِ أهْلِ التَّأويلِ، ولا يُمكِنُ أحْدًا أن يَقولَ: إنَّ أهْلَ السُّنَّةِ والجَماعةِ طائِفةُ الخَلَفِ دونَ طائِفةِ السَّلَفِ؛ لأنَّ طائِفةَ السَّلَفِ تَعْني المُهاجِرينَ والأنْصارَ، والَّذين اتَّبَعوهم بإحْسانٍ مِن سَلَفِ الأُمَّةِ وأئِمَّتِها، ومِنهم أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ رَحِمَه اللهُ في مَذهَبِه الَّذي اسْتَقَرَّ عليه أخيرًا في كِتابِه الإبانةِ، وبَيَّنَ أنَّه قائِلٌ بما قالَ به الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَه اللهُ تَعالى) .
وقالَ ابنُ عُثَيْمينَ أيضًا: (أبو الحَسَنِ كانَ له مَراحِلُ ثَلاثٌ في العَقيدةِ:
المَرْحلةُ الأُولى: مَرْحلةُ الاعْتِزالِ: اعْتَنَقَ مَذهَبَ المُعْتَزِلةِ أرْبَعينَ عامًا يُقرِّرُه ويُناظِرُ عليه، ثُمَّ رَجَعَ عنه، وصَرَّحَ بتَضْليلِ المُعْتَزِلةِ، وبالَغَ في الرَّدِّ عليهم.
المَرْحلةُ الثَّانيةُ: مَرْحلةٌ بَيْنَ الاعْتِزالِ المَحْضِ والسُّنَّةِ المَحْضةِ، سَلَكَ فيها طَريقَ أبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعيدِ بنِ كُلَّابٍ. قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ «ص: 471» مِن المُجلَّدِ السَّادِسَ عَشَرَ مِن مَجْموعِ الفَتاوى لابنِ قاسِمٍ: والأشْعَريُّ وأمْثالُه بَرْزَخٌ بَيْنَ السَّلَفِ والجَهْميَّةِ، أخَذوا مِن هؤلاء كَلامًا صَحيحًا، ومِن هؤلاء أُصولًا عَقْليَّةً ظَنُّوها صَحيحةً وهي فاسِدةٌ. اهـ.
المَرْحلة الثَّالِثةُ: مَرْحلةُ اعْتِناقِ مَذهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ مُقْتدِيًا بالإمامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحِمَه اللهُ، كما قَرَّرَه في كِتابِه الإبانةِ عن أُصولِ الدِّيانةِ، وهو مِن آخِرِ كُتُبِه أو آخِرُها) .
وقالَ أيضًا: (الأشْعَريُّ أبو الحَسَنِ رَحِمَه اللهُ كانَ في آخِرِ عُمُرِه على مَذهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ، وهو إثْباتُ ما أَثبَتَه اللهُ تَعالى لنفْسِه في كِتابِه، أو على لِسانِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن غَيْرِ تَحْريفٍ ولا تَعْطيلٍ، ولا تَكْييفٍ ولا تَمْثيلٍ. ومَذهَبُ الإنْسانِ ما قالَه أخيرًا إذا صَرَّحَ بحَصْرِ قَوْلِه فيه، كما هي الحالُ في أبي الحَسَنِ كما يُعلَمُ مِن كَلامِه في الإبانةِ) .
وعلى كلِّ حالٍ سَواءٌ تَبَرَّأَ أبو الحَسَنِ مِن طَريقةِ ابنِ كُلَّابٍ، أو بَقِيَ عليها، وسواءٌ ثَبَتَ اتِّباعُ أبي الحَسَنِ مَذهَبَ السَّلَفِ أو لم يَثبُتْ، فالعُلَماءُ يَحكُمونَ على أيِّ قَوْلٍ بالصِّحَّةِ والفَسادِ بحَسَبِ مُوافِقتِه لأدِلَّةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، فإذا وافَقَ أبو الحَسَنِ الكِتابَ والسُّنَّةَ في المَسائِلِ الَّتي تَكلَّمَ فيها، واتَّبَعَ فيها السَّلَفَ الصَّالِحَ فقدْ أصابَ، وإذا خالَفَ الأدِلَّةَ فقدْ أَخطَأَ، وكلُّ أحَدٍ يُؤخَذُ مِن قَوْلِه ويُرَدُّ إلَّا نَبيَّنا مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
ومِن المُؤسِفِ أنَّ مُعظَمَ الأشاعِرةِ المُتَأخِّرينَ يُخالِفونَ أبا الحَسَنِ الأشْعَريَّ فيما أَثبَتَه مِن الصِّفاتِ الإلَهيَّةِ في كِتابِ (الإبانة)، وهو كِتابٌ ثابِتٌ عنه بلا شَكٍّ عنْدَ أهْلِ العِلمِ المُنْصِفينَ ، وإن حاوَلَ بعضُ الأشاعِرةِ المُتَأخِّرينَ التَّشْكيكَ في ثُبوتِه أو ادِّعاءَ دُخولِ الزِّيادةِ فيه بلا بُرْهانٍ .
ولأبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ أيضا كِتابُ (مَقالات الإسْلاميِّينَ واخْتِلاف المُصَلِّينَ) و(رسالة إلى أهْلِ الثَّغْرِ ببابِ الأبْوابِ) ، فيهما ما يُوافِقُ كِتابَ (الإبانة) مِن إثْباتِ الصِّفاتِ .
وقدِ ادَّعى بعضُ الأشاعِرةِ المُتَأخِّرينَ أنَّ ما في كُتُبِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ مِن إثْباتِ الصِّفاتِ هو مِن بابِ التَّفْويضِ لمَعانيها، وزَعَموا أنَّ تَفْويضَ مَعاني الصِّفاتِ هو مَذهَبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وأنَّ أبا الحَسَنِ مُوافِقٌ للسَّلَفِ في تَفْويضِ مَعاني الصِّفاتِ ، وهذه دَعْوى لا تَصِحُّ؛ فلا يوجَدُ نَصٌّ صَريحٌ لأبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ بِذلك، وظاهِرُ كَلامِه في كِتابِه الإبانةِ إثْباتُ الصِّفاتِ على مَنهَجِ السَّلَفِ مِن غَيْرِ تَفْويضٍ للمَعاني، خاصَّةً أنَّه صَرَّحَ بأنَّه رَجَعَ لمَذهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ، وأَحْمَدُ ليس مُفَوِّضًا، وعلى التَّسْليمِ للأشاعرةِ بِذلك فإنَّ أبا الحَسَنِ في كِتابِه الإبانةِ تَرَكَ تَأويلَ صِفاتِ اللهِ سُبْحانَه، فليت أتْباعَه المُنْتَسِبينَ إليه يَقْتَدونَ به في تَرْكِ تَأويلِ الصِّفاتِ، قالَ الذَّهَبيُّ: (رَأيْتُ لأبي الحَسَنِ أرْبَعةَ تَواليفَ في الأُصولِ، يَذكُرُ فيها قَواعِدَ مَذهَبِ السَّلَفِ في الصِّفاتِ، وقالَ فيها: تُمَرُّ كما جاءَتْ، ثُمَّ قالَ: وبِذلك أَقولُ، وبه أَدينُ، ولا تُؤَوَّلُ) .
الفَصْلُ الأوَّلُ: التَّعْريفُ بالمَذهَبِ الأشْعَريِّ
المَذهَبُ الأشْعَريُّ أو مَذهَبُ الأشاعِرةِ: هو فِرْقةٌ تُنسَبُ إلى الشَّيْخِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ البَصْريِّ المُتَوفَّى في بَغْدادَ سَنَةَ (324هـ)، ظَهَرَ هذا المَذهَبُ في القَرْنِ الرَّابِعِ الهِجْريِّ، ثُمَّ تَطوَّرَ فيما بَعْدُ بواسِطةِ كَثيرٍ مِن أئِمَّةِ المَذهَبِ الأشْعَريِّ؛ كأبي الحَسَنِ الباهِلِيِّ، ومُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ يَعْقوبَ بنِ مُجاهِدٍ الطَّائيِّ، وأبي الحَسَنِ الطَّبَرِيِّ، والقاضي أبي بَكْرِ بنِ الباقِلَّانيِّ، والأسْتاذِ ابنِ فورَكٍ، والأسْتاذِ أبي إسْحاقَ الأسْفَرايِينيِّ، وأبي القاسِمِ القُشَيْريِّ، وأبي المَعالي الجُوَيْنيِّ، وأبي حامِدٍ الغَزاليِّ، والفَخْرِ الرَّازيِّ، وأبي الحَسَنِ الآمِدِيِّ، والإيجيِّ، حتَّى صارَ المَذهَبُ الأشْعَريُّ فِرْقةً كَلامِيَّةً، فَلْسَفيَّةً، مُرْجِئةً، جَبْريَّةً! وصارَ المَذهَبُ الأشْعَريُّ مِن أَشهَرِ المَذاهِبِ العَقَديَّةِ في العالَمِ الإسْلاميِّ، وصارَ يَنْتَسِبُ إليه كَثيرٌ مِن المُسلِمينَ؛ لظَنِّهم أنَّه مَذهَبُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ، وأنَّه المَذهَبُ الحَقُّ الواجِبُ الاتِّباعِ في العَقائِدِ دونَ ما سِواه مِن المَذاهِبِ! معَ أنَّ هذا المَذهَبَ لم يكُنْ مَعْروفًا عنْدَ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ وأتْباعِهم، ولا يُعرَفُ عن أحَدٍ مِن أئِمَّةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ القَوْلُ بِهذا المَذهَبِ الَّذي حَدَثَ بَعْدَ القَرْنِ الثَّالِثِ الهِجْريِّ، وسيَأتي النَّقْلُ مِن كُتُبِ الأشاعِرةِ أنْفُسِهم لبَيانِ تَطوُّرِ المَذهَبِ الأشْعَريِّ على يَدِ أعْلامِه، حتَّى دَخَلَ مُتَأخِّروهم في مَتاهاتٍ كَلامِيَّةٍ وفَلْسَفيَّةٍ تُخالِفُ العَقيدةَ الصَّحيحةَ السَّمْحةَ الَّتي كانَ عليها النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصْحابُه رَضِيَ اللهُ عنهم، ومَن اتَّبَعَهم بإحْسانٍ
.
الفَصْلُ الثَّاني: التَّعْريفُ بأبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ
هو أبو الحَسَنِ، علِيُّ بنُ إسْماعيلَ بنِ إسْحاقَ بنِ سالِمِ بنِ إسْماعيلَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ موسى بنِ بِلالِ بنِ أبي بُرْدةَ بنِ أبي موسى الأشْعَريِّ، مِن ذُرِّيَّةِ الصَّحابيِّ الجَليلِ أبي موسى الأشْعَريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، والأشْعَريُّ نِسْبةٌ إلى قَبيلةٍ يَمنيَّةٍ تَنْتَسِبُ إلى أَشعَرَ، مِن وَلَدِ كَهْلانَ بنِ سَبَأِ بنِ يَشجُبَ بنِ يَعرُبَ بنِ قَحْطانَ
.
وُلِدَ أبو الحَسَنِ الأشْعَريِّ في البَصْرةِ سَنَةَ 260هـ، وسَمِعَ الحَديثَ مِن الحافِظِ زَكَريَّا بنِ يَحْيى السَّاجيِّ البَصْريِّ (ت 307 هـ)، وأخَذَ عنه مَذهَبَ أهْلِ السُّنَّةِ، ولازَمَ أبا علِيٍّ الجُبَّائيَّ البَصْريَّ (ت 303 هـ)، شَيْخَ المُعْتَزِلةِ، وأخَذَ عنه مَذهَبَ الاعْتِزالِ، وكانَ الأشْعَريُّ يَنوبُ عنه في بعضِ مَجالِسِه، ولمَّا بَرَعَ في مَعْرِفةِ الاعْتِزالِ تَبَرَّأَ مِنه عَلَنًا، وأَكثَرَ مِن التَّأليفِ في الرَّدِّ على المُعْتَزِلةِ وغَيْرِهم مِن أهْلِ البِدَعِ .
قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ لمَّا رَجَعَ عن مَذهَبِ المُعْتَزِلةِ سَلَكَ طَريقةَ ابنِ كُلَّابٍ، ومالَ إلى أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ، وانْتَسَبَ إلى الإمامِ أَحْمَدَ، كما قد ذَكَرَ ذلك في كُتُبُه كلِّها، كـالإبانةِ، والمُوجَزِ، والمَقالاتِ، وغَيْرِها، وكانَ مُخْتلِطًا بأهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ كاخْتِلاطِ المُتكلِّمِ بهم...، وكانَ القُدَماءُ مِن أصْحابِ أَحْمَدَ؛ كـأبي بَكْرٍ عَبْدِ العَزيزِ، وأبي الحَسَنِ التَّميميِّ، وأمْثالِهما، يَذكُرونَه في كُتُبِهم على طَريقِ ذِكْرِ المُوافِقِ للسُّنَّةِ في الجُمْلةِ، ويَذكُرونَ ما ذَكَرَه مِن تَناقُضِ المُعْتَزِلةِ...، والأشْعَريُّ وأئِمَّةُ أصْحابِه؛ كـأبي الحَسَنِ الطَّبَرِيِّ، وأبي عَبْدِ اللهِ بنِ مُجاهِدٍ، والباهِلِيِّ، والقاضي أبي بَكْرٍ، مُتَّفِقونَ على إثْباتِ الصِّفاتِ الخَبَريَّةِ الَّتي ذُكِرَتْ في القُرْآنِ؛ كالاسْتِواءِ، والوَجْهِ، واليَدِ، وإبْطالِ تَأويلِها، وليس له في ذلك قَوْلانِ أصْلًا، ولم يَذكُرْ أحَدٌ عن الأشْعَريِّ في ذلك قَوْلَينِ أصْلًا، بلْ جَميعُ مَن يَحْكي المَقالاتِ مِن أتْباعِه وغَيْرِهم يَذكُرُ أنَّ ذلك قَوْلُه، ولكنْ لأتْباعِه في ذلك قَوْلانِ) .
وقال ابنُ تيميَّةَ أيضًا: (كانت خِبرتُه بالكلامِ خِبرةً مُفصَّلةً، وخِبرتُه بالسُّنَّةِ خِبرةً مُجمَلةً؛ فلذلك وافَق المُعتَزِلةَ في بعضِ أصولِهم التي التزموا لأجْلِها خِلافَ السُّنَّةِ، واعتقد أنَّه يمكِنُه الجمعُ بَينَ تلك الأصولِ وبين الانتِصارِ للسُّنَّةِ، كما فعل في مسألةِ الرُّؤيةِ والكلامِ والصِّفاتِ الخَبَريَّةِ، وغيرِ ذلك، والمُخالِفونَ له من أهلِ السُّنَّةِ والحديثِ ومن المُعتَزِلةِ والفلاسفةِ يقولونَ: إنَّه متناقِضٌ، وإنَّ ما وافق فيه المُعتَزِلةَ يُناقِضُ ما وافَق فيه أهلَ السُّنَّةِ، بل جُمهورُ المُخالِفينَ للأشعريِّ من المُثبتةِ والنُّفاةِ يقولونَ: إنَّ ما قاله في مسألةِ الرُّؤيةِ والكلامِ معلومُ الفسادِ بضرورةِ العَقلِ؛ ولهذا يقولُ أتباعُه: إنَّه لم يوافِقْنا أحَدٌ من الطَّوائِفِ على قَولِنا في مسألةِ الرُّؤيةِ والكلامِ، فلمَّا كان في كلامِه شَوبٌ من هذا وشَوبٌ من هذا، صار يقولُ من يقولُ: إنَّ فيه نوعًا من التجَهُّمِ، وأمَّا من قال: إنَّ قَولَه قَولُ جَهمٍ، فقد قال الباطِلَ، ومن قال: إنَّه ليس فيه شيءٌ من قولِ جَهمٍ، فقد قال الباطِلَ، واللهُ يحِبُّ الكلامَ بعِلمٍ وعَدلٍ، وإعطاءَ كُلِّ ذي حقٍّ حقَّه، وتنزيلَ النَّاسِ منازِلَهم) .
وقدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ في المَراحِلِ الَّتي مَرَّ بِها أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ كما سيَأتي بَيانُه، ومِن أَحسَنِ تَصانيفِه المُوافِقةِ لأهْلِ السُّنَّةِ في الجُمْلةِ: كِتابُ (الإبانة عن أصولِ الدِّيانة)، وكِتابُ (مَقالات الإسْلاميِّينَ واخْتِلاف المُصَلِّينَ)، و(رِسالة إلى أهْلِ الثَّغْرِ).
قالَ الذَّهَبيُّ: (لأبي الحَسَنِ ذَكاءٌ مُفرِطٌ، وتَبَحُّرٌ في العِلمِ، وله أشْياءُ حَسَنةٌ، وتَصانيفُ جَمَّةٌ تَقْضي له بسَعةِ العِلمِ...، قالَ أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ في كِتابِ (العُمَد في الرُّؤْيةِ) له: صَنَّفْتُ (الفُصول في الرَّدِّ على المُلْحِدينَ) وهو اثْنا عَشَرَ كِتابًا، وكِتابَ (المُوجَزِ)، وكِتابَ (خَلْق الأعْمالِ)، وكِتابَ (الصِّفات)، وهو كَبيرٌ، تَكَلَّمْنا فيه على أصْنافِ المُعْتَزِلةِ والجَهْميَّةِ، وكِتابَ (الرُّؤْية بالأبْصارِ)، وكِتابَ (الخاصِّ والعامِّ)، وكِتابَ (الرَّدِّ على المُجَسِّمةِ)، وكِتابَ (إيْضاحِ البُرْهانِ)، وكِتابَ (اللُّمَع في الرَّدِّ على أهْلِ البِدَع)، وكِتابَ (الشَّرْح والتَّفْصيل)، وكِتابَ (النَّقْض على الجُبَّائيِّ)، وكِتابَ (النَّقْض على البَلْخيِّ)، وكِتابَ (جُمَل مَقالاتِ المُلْحِدينَ)، وكِتابًا في الصِّفاتِ هو أَكبَرُ كُتُبِنا، نَقَضْنا فيه ما كُنَّا ألَّفْناه قَديمًا فيها على تَصْحيحِ مَذهَبِ المُعْتَزِلةِ، لم يُؤَلَّفْ لهم كِتابٌ مِثلُه، ثُمَّ أبانَ اللهُ لنا الحَقَّ فرَجَعْنا، وكِتابًا في (الرَّدِّ على ابنِ الرَّاوَنْديِّ)، وكِتابَ (القامِعِ في الرَّدِّ على الخالِديِّ)، وكِتابَ (أدَب الجَدَلِ)، وكِتابَ (جَواب الخُراسانيَّةِ)، وكِتابَ (جَواب السِّيرافِيِّينَ)، و(جَواب الجُرْجانِيِّينَ)، وكِتابَ (المَسائِل المَنْثورة البَغْداديَّة)، وكِتابَ (الفُنون في الرَّدِّ على المُلْحِدينَ)، وكِتابَ (النَّوادِر في دَقائِقِ الكَلامِ)، وكِتابَ (تَفْسير القُرْآنِ)، وسَمَّى كُتُبًا كَثيرةً سِوى ذلك) .
وقالَ الذَّهَبيُّ: (رَأيْتُ لأبي الحَسَنِ أرْبَعةَ تَواليفَ في الأُصولِ يَذكُرُ فيها قَواعِدَ مَذهَبِ السَّلَفِ في الصِّفاتِ، وقالَ فيها: تُمَرُّ كما جاءَتْ، ثُمَّ قالَ: وبذلك أَقولُ، وبه أَدينُ، ولا تُؤَوَّلُ) .
وقدْ تُوفِّيَ أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ في بَغْدادَ سَنَةَ 324هـ .
وقدِ اتَّفَقَ المُؤَرِّخونَ والباحِثونَ على أنَّه كانَ في أوَّلِ أمْرِه مُعْتزِليًّا، واسْتَمَرَّ على ذلك سِنينَ كَثيرةً، ثُمَّ رَجَعَ عن بِدْعةِ الاعْتِزالِ وعُمُرُه نَحْوُ أرْبَعينَ سَنَةً ، ورَدَّ على المُعْتَزِلةِ، وبَيَّنَ بُطْلانَ عَقائِدِهم الَّتي خالَفوا فيها الحَقَّ، وكانَ أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ في هذه المَرْحلةِ على طَريقةِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعيدِ بنِ كُلَّابٍ البَصْريِّ المُتَوفَّى سَنَةَ (243هـ)، الَّذي كانَ يُخالِفُ المُعْتَزِلةَ، ويُوافِقُ أهْلَ السُّنَّةِ في كَثيرٍ مِن المَسائِلِ الاعْتِقاديَّةِ. وطَريقةُ ابنِ كُلَّابٍ أَقرَبُ إلى السُّنَّةِ مِن طَريقةِ المُعْتَزِلةِ، فكانَ أبو الحَسَنِ على هذه الطَّريقةِ.
قالَ المَقْريزيُّ في تَرْجمةِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ: (صارَ مِن أئِمَّةِ المُعْتَزِلةِ، ثُمَّ رَجَعَ عن القَوْلِ بخَلْقِ القُرْآنِ وغَيْرِه مِن آراءِ المُعْتَزِلةِ، وصَعِدَ يَوْمَ الجُمُعةِ بجامِعِ البَصْرةِ كُرْسيًّا، ونادى بأَعْلى صَوْتِه: مَن عَرَفَني فقدْ عَرَفَني، ومَن لم يَعرِفْني فأنا أُعَرِّفُه بنَفْسي، أنا فُلانُ بنُ فُلانٍ، كُنْتُ أَقولُ بخَلْقِ القُرْآنِ، وأنَّ اللهَ لا يُرى بالأبْصارِ، وأنَّ أفْعالَ الشَّرِّ أنا أَفعَلُها، وأنا تائِبٌ مُقلِعٌ، مُعْتقِدٌ الرَّدَّ على المُعْتَزِلةِ، مُبَيِّنٌ لفَضائِحِهم ومَعايبِهم. وأخَذَ مِن حينِئذٍ في الرَّدِّ عليهم، وسَلَكَ بعضَ طَريقِ أبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَعيدِ بنِ كُلَّابٍ القَطَّانِ، وبَنى على قَواعِدِه) .
وذَكَرَ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ عَبْدَ اللهِ بنَ سَعيدِ بنِ كُلَّابٍ وقالَ: (وعلى طَريقتِه مَشى الأشْعَريُّ في كِتابِ الإبانةِ) . وفي هذا الكَلامِ نَظَرٌ، فالمُطَّلِعُ في كِتابِ الإبانةِ يَجِدُ أنَّه أَقرَبُ لمَنهَجِ السَّلَفِ مِن مَنهَجِ ابنِ كُلَّابٍ -كما سيَأتي- ثُمَّ الأشْعَريُّ نفْسُه صَرَّحَ أنَّه على مَنهَجِ ابنِ حَنْبَلٍ، فكيف نَترُكُ كَلامَه ونَقولُ: ألَّفَ كِتابَ الإبانةِ على طَريقةِ ابنِ كُلَّابٍ، وهو آخِرُ كُتُبِه؟!
وحُجَّةُ القائِلينَ بِهذا أنَّه لا يوجَدُ نَصٌّ واضِحٌ لأبي الحَسَنِ يُبيِّنُ فيه بَراءتَه مِن طَريقةِ ابنِ كُلَّابٍ كما تَبَرَّأَ مِن طَريقةِ المُعْتَزِلةِ، وهذه حُجَّةٌ داحِضةٌ، فلا يَلزَمُه أن يَذكُرَ ابنَ كُلَّابٍ بقَدْحٍ حتَّى يُنسَبَ لمَذهَبِ السَّلَفِ، ويَكْفيه انْتِسابُه للإمامِ أَحْمَدَ، وأنَّه يَقولُ بقَوْلِه؛ فقدْ قالَ في كِتابِه الإبانةِ : (فإن قالَ لنا قائِلٌ: قد أنْكَرْتُم قَوْلَ المُعْتَزِلةِ والقَدَريَّةِ والجَهْميَّةِ والحَروريَّةِ والرَّافِضةِ والمُرْجِئةِ، فعَرِّفونا قَوْلَكم الَّذي به تقَوْلونَ، وديانتَكم الَّتي بها تَدينونَ. قيلَ له: قَوْلُنا الَّذي نَقولُ به وديانتُنا الَّتي نَدينُ بها، التَّمَسُّكُ بكِتابِ اللهِ رَبِّنا عَزَّ وجَلَّ، وبسُنَّةِ نَبيِّنا مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وما رُوِيَ عن السَّادةِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ وأئِمَّةِ الحَديثِ، ونحن بذلك مُعْتَصِمونَ، وبما كانَ يَقولُ به أبو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ -نَضَّرَ اللهُ وَجْهَه ورَفَعَ دَرَجتَه وأَجزَلَ مَثوبتَه -قائِلونَ، ولِما خالَفَ قَوْلَه مُخالِفونَ؛ لأنَّه الإمامُ الفاضِلُ، والرَّئيسُ الكامِلُ، الَّذي أبانَ اللهُ به الحَقَّ، ودَفَعَ به الضَّلالَ، وأَوضَحَ به المِنْهاجَ، وقَمَعَ به بِدَعَ المُبْتَدِعينَ، وزَيْعَ الزَّائِغينَ، وشَكَّ الشَّاكِّينَ، فرَحْمةُ اللهِ عليه مِن إمامٍ مُقدَّمٍ، وجَليلٍ مُعظَّمٍ، وكَبيرٍ مُفهِمٍ) .
وهذا النَّصُّ ظاهِرٌ جِدًّا في رُجوعِه إلى مَذهَبِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وإلى ما كانَ عليه الإمامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ.
ومَن يُطالِعْ كِتابَ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ المُسمَّى (الإبانة عن أُصولِ الدِّيانة) بعِلمٍ وإنْصافٍ يَتَبيَّنْ له أنَّه سارَ فيه على مَذهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ، معَ وُجودِ عِباراتٍ مُجْمَلةٍ وأخْطاءٍ لا تُخرِجُه عن مَذهَبِ السَّلَفِ. وقدْ صَرَّحَ عَدَدٌ مِن العُلَماءِ برُجوعِه هذا، وانْتِسابِه للإمامِ أَحْمَدَ ومَذهَبِ السَّلَفِ .
قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (هذا الكِتابُ هو مِن أَشهَرِ تَآليفِ الأشْعَريِّ وآخِرِها؛ ولِهذا اعْتَمَدَه الحافِظُ أبو بَكْرٍ السَّمْعانيُّ في كِتابِ الاعْتِقادِ له، وحَكى عنه في مَواضِعَ مِنه، ولم يَذكُرْ مِن تَآليفِه سِواه، وكذلك الحافِظُ أبو القاسِمِ بنُ عَساكِرَ في كِتابِه الَّذي صَنَّفَه وسَمَّاه: «تَبْيينَ كَذِبِ المُفْتري فيما يُنسَبُ إلى الشَّيْخِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ»... صَنَّفَه ببَغْدادَ في آخِرِ عُمُرِه، لمَّا زادَ اسْتِبْصارُه في السُّنَّةِ، ولَعلَّه لم يُفصِحْ في بعضِ الكُتُبِ القَديمةِ بما أَفصَحَ به فيه وفي أمْثالِه، وإن كانَ لم يَنْفِ فيها ما ذَكَرَه هنا في الكُتُبِ المُتَأخِّرةِ، ففَرَّقَ بَيْنَ عَدَمِ القَوْلِ وبَيْنَ القَوْلِ وبَيْنَ القَوْلِ بالعَدَمِ) .
وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ أيضًا: (الأشْعَريَّةُ الَّذين يَنْفونَ الصِّفاتِ الخَبَريَّةَ، وأمَّا مَن قالَ مِنهم بكِتابِ الإبانةِ الَّذي صَنَّفَه الأشْعَريُّ في آخِرِ عُمُرِه، ولم يُظهِرْ مَقالةً تُناقِضُ ذلك؛ فهذا يُعَدُّ مِن أهْلِ السُّنَّةِ) .
وقالَ أيضًا: (أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ لمَّا رَجَعَ عن مَذهَبِ المُعْتَزِلةِ سَلَكَ طَريقةَ ابنِ كُلَّابٍ، ومالَ إلى أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ، وانْتَسَبَ إلى الإمامِ أَحْمَدَ، كما قد ذَكَرَ ذلك في كُتُبِه كلِّها؛ كـالإبانةِ، والمُوجَزِ، والمَقالاتِ، وغَيْرِها، وكانَ مُخْتلِطًا بأهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ كاخْتِلاطِ المُتَكلِّمِ بهم، بمَنزِلةِ ابنِ عَقيلٍ عنْدَ مُتَأخِّريهم، لكنَّ الأشْعَريَّ وأئِمَّةَ أصْحابِه أَتبَعُ لأُصولِ الإمامِ أَحْمَدَ وأمْثالِه مِن أئِمَّةِ السُّنَّةِ مِن مِثلِ ابنِ عَقيلٍ في كَثيرٍ مِن أحْوالِه، ومِمَّن اتَّبَعَ ابنَ عَقيلٍ كـأبي الفَرَجِ ابنِ الجَوْزيِّ في كَثيرٍ مِن كُتُبِه، وكانَ القُدَماءُ مِن أصْحابِ أَحْمَدَ؛ كـأبي بَكْرٍ عَبْدِ العَزيزِ، وأبي الحَسَنِ التَّميميِّ، وأمْثالِهما، يَذكُرونَه في كُتُبِهم على طَريقِ ذِكْرِ المُوافِقِ للسُّنَّةِ في الجُمْلةِ) .
وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ أيضًا: (كانَ الأشْعَريُّ أَقرَبَ إلى مَذهَبِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ وأهْلِ السُّنَّةِ مِن كَثيرٍ مِن المُتَأخِّرينَ المُنْتسِبينَ إلى أَحْمَدَ الَّذين مالوا إلى بعضِ كَلامِ المُعْتَزِلةِ؛ كابنِ عَقيلٍ، وصَدَقةَ بنِ الحُسَينِ، وابنِ الجَوْزيِّ، وأمْثالِهم) .
ونَقَلَ ابنُ القَيِّمِ كَلامَ ابنِ تَيْمِيَّةَ في انْتِسابِه لمَذهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ مُؤَيِّدًا له .
وقالَ الذَّهَبيُّ: (كانَ مُعْتزِليًّا ثُمَّ تابَ، ووافَقَ أصْحابَ الحَديثِ في أشْياءَ يُخالِفونَ فيها المُعْتَزِلةَ، ثُمَّ وافَقَ أصْحابَ الحَديثِ في أَكثَرِ ما يَقولونَه...، فله ثَلاثةُ أحْوالٍ: حالٌ كانَ مُعْتزِليًّا، وحالٌ كانَ سُنِّيًّا في بعضٍ دونَ البعضِ، وحالٌ كانَ في غالِبِ الأُصولِ سُنِّيًّا، وهو الَّذي عَلِمْناه مِن حالِه، فرَحِمَه اللهُ وغَفَرَ له ولسائِرِ المُسلِمينَ) .
وقالَ ابنُ كَثيرٍ: (ذَكَروا للشَّيْخِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ رَحِمَه اللهُ ثَلاثةَ أحْوالٍ، أوَّلُها: حالُ الاعْتِزالِ الَّتي رَجَعَ عنها لا مَحالةَ، والحالُ الثَّاني: إثْباتُ الصِّفاتِ العَقْلِيَّةِ السَّبْعةِ، وهي: الحَياةُ، والعِلمُ، والقُدْرةُ، والإرادةُ، والسَّمْعُ، والبَصَرُ، والكَلامُ، وتَأويلُ الخَبَريَّةِ؛ كالوَجْهِ، واليَدَينِ، والقَدَمِ، والسَّاقِ، ونَحْوِ ذلك، والحالُ الثَّالِثةُ: إثْباتُ ذلك كلِّه مِن غَيْرِ تَكْييفٍ ولا تَشْبيهٍ، جَرْيًا على مِنْوالِ السَّلَفِ، وهي طَريقتُه في (الإبانة) الَّتي صَنَّفَها آخِرًا، وشَرَحَه القاضي الباقِلَّانيُّ، ونَقَلَها أبو القاسِمِ ابنُ عَساكِرَ، وهي الَّتي مالَ إليها الباقِلَّانيُّ، وإمامُ الحَرَمينِ، وغَيْرُهما مِن أئِمَّةِ الأصْحابِ المُتَقدِّمينَ في أواخِرِ أقْوالِهم، واللهُ أَعلَمُ) .
وقالَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّاب: (كِتابُ الإبانةِ مِن أَشهَرِ تَصانيفِ أبي الحَسَنِ...، صَرَّحَ بأنَّ عَقيدتَه في آياتِ الصِّفاتِ وأحاديثِها اعْتِقادُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ، مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ وأئِمَّةِ الدَّينِ، ولم يَحْكِ تَأويلَ الاسْتِواءِ بالاسْتيلاءِ، واليَدِ بمَعْنى النِّعْمةِ، والعَيْنِ بمَعْنى العِلمِ، إلَّا عن المُعْتَزِلةِ والجَهْميَّةِ، وصَرَّحَ أنَّه خِلافُ قَوْلِه؛ لأنَّه خِلافُ قَوْلِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ. ثُمَّ تَجِدُ المُنْتَسِبينَ إلى عَقيدةِ الأشْعَريِّ قد صَرَّحوا في عَقائِدِهم ومُصَنَّفاتِهم مِن التَّفاسيرِ وشُروحِ الحَديثِ بالتَّأويلِ الَّذي أَنكَرَه إمامُهم، وبَيَّنَ أنَّه قَوْلُ المُعْتَزِلةِ والجَهْميَّةِ، ويَنسُبونَ هذا الاعْتِقادَ إلى الأشْعَريِّ، وهو قد أَنكَرَه ورَدَّه وأَخبَرَ أنَّه على غَيْرِ عَقيدةِ السَّلَفِ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ والأئِمَّةِ بَعْدَهم، وأنَّه على عَقيدةِ الإمامِ أَحْمَدَ!) .
وقالَ ابنُ بازٍ: (ليس عُلَماءُ الأشاعِرةِ مِن أتْباعِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ؛ لأنَّه رَجَعَ عن تَأويلِ الصِّفاتِ، وقالَ بمَذهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ في إثْباتِ الأسْماءِ والصِّفاتِ وإمْرارِها كما جاءَتْ مِن غَيْرِ تَحْريفٍ ولا تَعْطيلٍ ولا تَكْييفٍ ولا تَمْثيلٍ، كما أَوضَحَ ذلك في كِتابَيْه الإبانةِ والمَقالاتِ، فعُلِمَ ممَّا ذَكَرْنا أنَّ مَنْ أوَّلَ الصِّفاتِ مِن المُنْتَسِبينَ للأشْعَريِّ فليس على مَذهَبِه الجَديدِ، بلْ هو على مَذهَبِه القَديمِ، ومَعْلومٌ أنَّ مَذهَبَ العالِمِ هو ما ماتَ عليه مُعْتقِدًا له لا ما قالَه سابِقًا ثُمَّ رَجَعَ عنه؛ فيَجِبُ التَّنَبُّهُ لذلك) .
وقالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إنَّ إحدى الطَّائِفتَينِ فقط هُمْ أهْلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ؛ فإمَّا أن تكونَ طائِفةَ السَّلَفِ أهْلِ التَّحْقيقِ، وإمَّا أن تكونَ طائِفةَ الخَلَفِ أهْلِ التَّأويلِ، ولا يُمكِنُ أحْدًا أن يَقولَ: إنَّ أهْلَ السُّنَّةِ والجَماعةِ طائِفةُ الخَلَفِ دونَ طائِفةِ السَّلَفِ؛ لأنَّ طائِفةَ السَّلَفِ تَعْني المُهاجِرينَ والأنْصارَ، والَّذين اتَّبَعوهم بإحْسانٍ مِن سَلَفِ الأُمَّةِ وأئِمَّتِها، ومِنهم أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ رَحِمَه اللهُ في مَذهَبِه الَّذي اسْتَقَرَّ عليه أخيرًا في كِتابِه الإبانةِ، وبَيَّنَ أنَّه قائِلٌ بما قالَ به الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَه اللهُ تَعالى) .
وقالَ ابنُ عُثَيْمينَ أيضًا: (أبو الحَسَنِ كانَ له مَراحِلُ ثَلاثٌ في العَقيدةِ:
المَرْحلةُ الأُولى: مَرْحلةُ الاعْتِزالِ: اعْتَنَقَ مَذهَبَ المُعْتَزِلةِ أرْبَعينَ عامًا يُقرِّرُه ويُناظِرُ عليه، ثُمَّ رَجَعَ عنه، وصَرَّحَ بتَضْليلِ المُعْتَزِلةِ، وبالَغَ في الرَّدِّ عليهم.
المَرْحلةُ الثَّانيةُ: مَرْحلةٌ بَيْنَ الاعْتِزالِ المَحْضِ والسُّنَّةِ المَحْضةِ، سَلَكَ فيها طَريقَ أبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعيدِ بنِ كُلَّابٍ. قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ «ص: 471» مِن المُجلَّدِ السَّادِسَ عَشَرَ مِن مَجْموعِ الفَتاوى لابنِ قاسِمٍ: والأشْعَريُّ وأمْثالُه بَرْزَخٌ بَيْنَ السَّلَفِ والجَهْميَّةِ، أخَذوا مِن هؤلاء كَلامًا صَحيحًا، ومِن هؤلاء أُصولًا عَقْليَّةً ظَنُّوها صَحيحةً وهي فاسِدةٌ. اهـ.
المَرْحلة الثَّالِثةُ: مَرْحلةُ اعْتِناقِ مَذهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ مُقْتدِيًا بالإمامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ رَحِمَه اللهُ، كما قَرَّرَه في كِتابِه الإبانةِ عن أُصولِ الدِّيانةِ، وهو مِن آخِرِ كُتُبِه أو آخِرُها) .
وقالَ أيضًا: (الأشْعَريُّ أبو الحَسَنِ رَحِمَه اللهُ كانَ في آخِرِ عُمُرِه على مَذهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ، وهو إثْباتُ ما أَثبَتَه اللهُ تَعالى لنفْسِه في كِتابِه، أو على لِسانِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن غَيْرِ تَحْريفٍ ولا تَعْطيلٍ، ولا تَكْييفٍ ولا تَمْثيلٍ. ومَذهَبُ الإنْسانِ ما قالَه أخيرًا إذا صَرَّحَ بحَصْرِ قَوْلِه فيه، كما هي الحالُ في أبي الحَسَنِ كما يُعلَمُ مِن كَلامِه في الإبانةِ) .
وعلى كلِّ حالٍ سَواءٌ تَبَرَّأَ أبو الحَسَنِ مِن طَريقةِ ابنِ كُلَّابٍ، أو بَقِيَ عليها، وسواءٌ ثَبَتَ اتِّباعُ أبي الحَسَنِ مَذهَبَ السَّلَفِ أو لم يَثبُتْ، فالعُلَماءُ يَحكُمونَ على أيِّ قَوْلٍ بالصِّحَّةِ والفَسادِ بحَسَبِ مُوافِقتِه لأدِلَّةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، فإذا وافَقَ أبو الحَسَنِ الكِتابَ والسُّنَّةَ في المَسائِلِ الَّتي تَكلَّمَ فيها، واتَّبَعَ فيها السَّلَفَ الصَّالِحَ فقدْ أصابَ، وإذا خالَفَ الأدِلَّةَ فقدْ أَخطَأَ، وكلُّ أحَدٍ يُؤخَذُ مِن قَوْلِه ويُرَدُّ إلَّا نَبيَّنا مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
ومِن المُؤسِفِ أنَّ مُعظَمَ الأشاعِرةِ المُتَأخِّرينَ يُخالِفونَ أبا الحَسَنِ الأشْعَريَّ فيما أَثبَتَه مِن الصِّفاتِ الإلَهيَّةِ في كِتابِ (الإبانة)، وهو كِتابٌ ثابِتٌ عنه بلا شَكٍّ عنْدَ أهْلِ العِلمِ المُنْصِفينَ ، وإن حاوَلَ بعضُ الأشاعِرةِ المُتَأخِّرينَ التَّشْكيكَ في ثُبوتِه أو ادِّعاءَ دُخولِ الزِّيادةِ فيه بلا بُرْهانٍ .
ولأبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ أيضا كِتابُ (مَقالات الإسْلاميِّينَ واخْتِلاف المُصَلِّينَ) و(رسالة إلى أهْلِ الثَّغْرِ ببابِ الأبْوابِ) ، فيهما ما يُوافِقُ كِتابَ (الإبانة) مِن إثْباتِ الصِّفاتِ .
وقدِ ادَّعى بعضُ الأشاعِرةِ المُتَأخِّرينَ أنَّ ما في كُتُبِ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ مِن إثْباتِ الصِّفاتِ هو مِن بابِ التَّفْويضِ لمَعانيها، وزَعَموا أنَّ تَفْويضَ مَعاني الصِّفاتِ هو مَذهَبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وأنَّ أبا الحَسَنِ مُوافِقٌ للسَّلَفِ في تَفْويضِ مَعاني الصِّفاتِ ، وهذه دَعْوى لا تَصِحُّ؛ فلا يوجَدُ نَصٌّ صَريحٌ لأبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ بِذلك، وظاهِرُ كَلامِه في كِتابِه الإبانةِ إثْباتُ الصِّفاتِ على مَنهَجِ السَّلَفِ مِن غَيْرِ تَفْويضٍ للمَعاني، خاصَّةً أنَّه صَرَّحَ بأنَّه رَجَعَ لمَذهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ، وأَحْمَدُ ليس مُفَوِّضًا، وعلى التَّسْليمِ للأشاعرةِ بِذلك فإنَّ أبا الحَسَنِ في كِتابِه الإبانةِ تَرَكَ تَأويلَ صِفاتِ اللهِ سُبْحانَه، فليت أتْباعَه المُنْتَسِبينَ إليه يَقْتَدونَ به في تَرْكِ تَأويلِ الصِّفاتِ، قالَ الذَّهَبيُّ: (رَأيْتُ لأبي الحَسَنِ أرْبَعةَ تَواليفَ في الأُصولِ، يَذكُرُ فيها قَواعِدَ مَذهَبِ السَّلَفِ في الصِّفاتِ، وقالَ فيها: تُمَرُّ كما جاءَتْ، ثُمَّ قالَ: وبِذلك أَقولُ، وبه أَدينُ، ولا تُؤَوَّلُ) .
الفَصْلُ الرَّابِعُ: تَفاوُتُ تَأثُّرِ أعْلامِ الأشاعِرةِ بالجَهْميَّةِ
تَقدَّمَ أنَّ أبا الحَسَنِ الأشْعَريِّ رَحِمَه اللهُ كانَ مُعْتَزلِيًّا ثُمَّ تابَ ورَجَعَ عن عَقيدةِ المُعْتَزِلةِ، ورَدَّ عليهم، واتَّبَعَ طَريقةَ ابنِ كُلَّابٍ الَّذي كانَ مِن أهْلِ السُّنَّةِ مِن حيثُ الجُمْلةُ، وإن كانَ مُتَأثِّرًا بأهْلِ الكَلامِ في بعضِ المَسائِلِ، وقدِ انْتَسَبَ أبو الحَسَنِ إلى السَّلَفِ، وصَرَّحَ باقْتِدائِه بأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ في كِتابِه (الإبانة عن أُصولِ الدِّيانة)، إلَّا أنَّه كانَ خَبيرًا بمَذاهِبِ المُعْتَزِلةِ والجَهْميَّةِ أَكثَرَ مِن خِبْرتِه بمَذهَبِ أئِمَّةِ السَّلَفِ، فبَقِيَ عنْدَه بَقايا مِن مَذهَبِ المُعْتَزِلةِ والجَهْميَّةِ، وهو أَقرَبُ إلى مَذهَبِ السَّلَفِ مِمَّن جاءَ بَعْدَه مِن أتْباعِه؛ فقدْ تَطوَّرَ مَذهَبُ الأشاعِرةِ بواسِطةِ أعْلامِه إلى ما يُخالِفُ مَذهَبَ أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ نفْسِه، معَ انْتِسابِهم إليه، فاقْتَرَبَ كَثيرٌ مِن أعْلامِ الأشاعِرةِ بَعْدَ أبي الحَسَنِ على دَرَجاتٍ مُتفاوِتةٍ مِن مَذهَبِ الجَهْميَّةِ والمُعْتَزِلةِ والفَلاسِفةِ
.
قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (ابنُ كُلَّابٍ قَوْلُه مَشوبٌ بقَوْلِ الجَهْميَّةِ، وهو مُرَكَّبٌ مِن قَوْلِ أهْلِ السُّنَّةِ وقَوْلِ الجَهْميَّةِ، وكذلك مَذهَبُ الأشْعَريِّ في الصِّفاتِ، وأمَّا في القَدَرِ والإيمانِ فقَوْلُه قَوْلُ جَهْمٍ، وأمَّا ما حَكاه عن أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ وقالَ: وبِكلِّ ما ذَكَرْنا مِن قَوْلِهم نَقولُ، وإليه نَذهَبُ، فهو أَقرَبُ ما ذَكَرَه، وبعضُه ذَكَرَه عنهم على وَجْهِه، وبعضُه تَصرَّفَ فيه وخَلَطَه بِما هو مِن أقْوالِ جَهْمٍ في الصِّفاتِ والقَدَرِ؛ إذ كانَ هو نفْسُه يَعْتقِدُ صِحَّةَ تلك الأُصولِ، وهو يُحِبُّ الانْتِصارَ لأهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ ومُوافَقتَهم، فأرادَ أن يَجمَعَ بَيْنَ ما رآه مِن رأيِ أولئك، وبَيْنَ ما نَقَلَه عن هؤلاء. ولِهذا يَقولُ فيه طائِفةٌ: إنَّه خَرَجَ مِن التَّصْريحِ إلى التَّمْويهِ، كما يَقولُه طائِفةٌ: إنَّهم الجَهْميَّةُ الإناثُ، وأولئك الجَهْميَّةُ الذُّكورُ...، والطَّائِفتانِ أهْلُ السُّنَّةِ والجَهْميَّةُ يَقولونَ: إنَّه تَناقَضَ، لكنَّ السُّنِّيَّ يَحمَدُ مُوافَقتَه لأهْلِ الحَديثِ، ويَذُمُّ مُوافَقتَه للجَهْميَّةِ، والجَهْمِيُّ يَذُمُّ مُوافَقتَه لأهْلِ الحَديثِ، ويَحمَدُ مُوافَقتَه للجَهْميَّةِ؛ ولِهذا كانَ مُتَأخِّرو أصْحابِه كأبي المَعالي ونَحْوِه أَظهَرَ تَجَهُّمًا وتَعْطيلًا مِن مُتَقَدِّميهم، وهي مَواضِعُ دَقيقةٌ يَغفِرُ اللهُ لمَن أَخطَأَ فيها بَعْدَ اجْتِهادِه، لكنَّ الصَّوابَ ما أَخبَرَ به الرَّسولُ، فلا يكونُ الحَقُّ في خِلافِ ذلك قَطُّ. واللهُ أَعلَمُ) .
وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ أيضًا: (الأشْعَريُّ ما كانَ يَنْتَسِبُ إلَّا إلى مَذهَبِ أهْلِ الحَديثِ وإمامِهم أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وقدْ ذَكَرَ أبو بَكْرٍ عَبْدُ العَزيزِ ما يَقْتَضي أنَّه عِنْدَه مِن مُتَكلِّمي أهْلِ الحَديثِ، لم يَجعَلْه مُبايِنًا لهم، وكانوا قَديمًا مُتَقارِبينَ إلَّا أنَّ فيهم مَن يُنكِرُ عليه ما قد يُنكِرونَه على مَن خَرَجَ مِنهم إلى شيءٍ مِن الكَلامِ؛ لِما في ذلك مِن البِدْعةِ، معَ أنَّه في أصْلِ مَقالتِه ليس على السُّنَّةِ المَحْضةِ، بل هو مُقصِّرٌ عنها تَقْصيرًا مَعْروفًا...، والأشْعَرِيَّةُ الأَغلَبُ عليهم أنَّهم مُرْجِئةٌ في بابِ الأسْماءِ والأحْكامِ، جَبْريَّةٌ في بابِ القَدَرِ، وأمَّا في الصِّفاتِ فليسوا جَهْميَّةً مَحْضةً، بل فيهم نَوْعٌ مِن التَّجَهُّمِ) .
وقالَ أيضًا: (الأشْعَريُّ وأمْثالُه بَرْزَخٌ بَيْنَ السَّلَفِ والجَهْميَّةِ، أخَذوا مِن هؤلاء كَلامًا صَحيحًا، ومِن هؤلاء أُصولًا عَقْلِيَّةً ظَنُّوها صَحيحةً وهي فاسِدةٌ؛ فمِن النَّاسِ مَن مالَ إليه مِن الجِهةِ السَّلَفيَّةِ، ومِن النَّاسِ مَن مالَ إليه مِن الجِهةِ البِدْعيَّةِ الجَهْميَّةِ كأبي المَعالي وأتْباعِه، ومِنهم مَن سَلَكَ مَسلَكَهم كأئِمَّةِ أصْحابِهم) .
وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ أيضًا عن أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ ومُتَقَدِّمي أصْحابِه: (مِن النَّاسِ مَن له خِبْرةٌ بالعَقْليَّاتِ المَأخوذةِ عن الجَهْميَّةِ وغَيْرِهم، وقدْ شارَكَهم في بعضِ أُصولِها، ورأى ما في قَوْلِهم مِن مُخالَفةِ الأمورِ المَشْهورةِ عنْدَ أهْلِ السُّنَّةِ، كمَسْألةِ القُرْآنِ والرُّؤْيةِ، فأرادَ هؤلاء أن يَجمَعوا بَيْنَ نَصْرِ ما اشْتَهَرَ عنْدَ أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ، وبَيْنَ مُوافَقةِ الجَهْمِيَّةِ في تلك الأُصولِ العَقْلِيَّةِ الَّتي ظَنَّها صَحيحةً، ولم يكُنْ لهم مِن الخِبْرةِ المُفَصَّلةِ بالقُرْآنِ ومَعانيه والحَديثِ وأقْوالِ الصَّحابةِ ما لِأئِمَّةِ السُّنَّةِ والحَديثِ، فذَهَبَ مَذهَبًا مُرَكَّبًا مِن هذا وهذا، وكِلا الطَّائِفتَينِ يَنسُبُه إلى التَّناقُضِ، وهذه طَريقةُ الأشْعَريِّ وأئِمَّةِ أتْباعِه، كالقاضي أبي بَكْرٍ، وأبي إسْحاقَ الأسْفَرايِينيِّ، وأمْثالِهما؛ ولِهذا تَجِدُ أَفضَلَ هؤلاء كالأشْعَريِّ يَذكُرُ مَذهَبَ أهْلِ السُّنَّةِ والحَديثِ على وَجْهِ الإجْمالِ، ويَحْكيه بحَسَبِ ما يَظُنُّه لازِمًا، ويَقولُ: إنَّه يَقولُ بكلِّ ما قالوه، وإذا ذَكَرَ مَقالاتِ أهْلِ الكَلامِ مِن المُعْتَزِلةِ وغَيْرِهم حَكاها حِكايةَ خَبيرٍ بِها، عالِمٍ بتَفْصيلِها، وهؤلاء كَلامُهم نافِعٌ في مَعْرِفةِ تَناقُضِ المُعْتَزِلةِ وغَيْرِهم، ومَعْرِفةِ فَسادِ أقْوالِهم، وأمَّا في مَعْرِفةِ ما جاءَ به الرَّسولُ، وما كانَ عليه الصَّحابةُ والتَّابِعونَ، فمَعْرفتُهم بِذلك قاصِرةٌ) .
وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (كَثيرٌ مِن مُتَأخِّري أصْحابِ الأشْعَريِّ خَرَجوا عن قَوْلِه إلى قَوْلِ المُعْتَزِلةِ أو الجَهْميَّةِ أو الفَلاسِفةِ) .
وقدْ ذَكَرَ ابنُ تَيْمِيَّةَ قَوْلَ العِزِّ بنِ عَبْدِ السَّلامِ: (العُلَماءُ أنْصارُ فُروعِ الدِّينِ، والأشْعَريَّةُ أنْصارُ أُصولِ الدِّينِ)، ثُمَّ قالَ مُعلِّقًا: (ما نَصَروه مِن أُصولِ الدِّينِ هو ما ذَكَرْناه مِن مُوافِقةِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ والحَديثِ، والرَّدِّ على مَن خالَفَ القُرْآنَ والسُّنَّةَ والحَديثَ؛ ولِهذا كانَ الشَّيْخُ أبو إسْحاقَ يَقولُ: إنَّما نَفَقَتِ الأشْعَريَّةُ عنْدَ النَّاسِ بانْتِسابِهم إلى الحَنابِلةِ، وهذا ظاهِرٌ عليه وعلى أئِمَّةِ أصْحابِه في كُتُبِهم ومُصَنَّفاتِهم قَبْلَ وُقوعِ الفِتْنةِ القُشَيْريَّةِ ببَغْدادَ؛ ولِهذا قالَ أبو القاسِمِ بنُ عَساكِرَ في مَناقِبِه: ما زالَتِ الحَنابِلةُ والأشاعِرةُ في قَديمِ الدَّهْرِ مُتَّفِقينَ غَيْرَ مُفْتَرِقينَ حتَّى حَدَثَتْ فِتْنةُ ابنِ القُشَيْريِّ، ثُمَّ بَعْدَ حُدوثِ الفِتْنةِ وقَبْلَها لا تَجِدُ مَن يَمدَحُ الأشْعَريَّ بمِدْحةٍ إلَّا إذا وافَقَ السُّنَّةَ والحَديثَ، ولا يَذُمُّه مَن يَذُمُّه إلَّا بمُخالَفةِ السُّنَّةِ والحَديثِ، وهذا إجْماعٌ مِن جَميعِ هذه الطَّوائِفِ على تَعْظيمِ السُّنَّةِ والحَديثِ، واتِّفاقُ شَهاداتِهم على أنَّ الحَقَّ في ذلك؛ ولِهذا تَجِدُ أَعظَمَهم مُوافَقةً لأئِمَّةِ السُّنَّةِ والحَديثِ أَعظَمَ عنْدَ جَميعِهم ممَّن هو دونَه، فالأشْعَريُّ نفْسُه لمَّا كانَ أَقرَبَ إلى قَوْلِ الإمامِ أَحْمَدَ ومَن قَبْلَه مِن أئِمَّةِ السُّنَّةِ كانَ عنْدَهم أَعظَمَ مِن أتْباعِه، والقاضي أبو بَكْرِ بنُ الباقِلَّانيِّ لمَّا كانَ أَقرَبَهم إلى ذلك كانَ أَعظَمَ عنْدَهم مِن غَيْرِه، وأمَّا مِثلُ الأسْتاذِ أبي المَعالي وأبي حامِدٍ ونَحْوِهما ممَّن خالَفوا أُصولَه في مَواضِعَ فلا تَجِدُهم يُعظَّمونَ إلَّا بِما وافَقوا فيه السُّنَّةَ والحَديثَ، وأَكثَرُ ذلك تَقَلَّدوه مِن مَذهَبِ الشَّافِعيِّ في الفِقْهِ المُوافِقِ للسُّنَّةِ والحَديثِ، وممَّا ذَكَروه في الأُصولِ ممَّا يُوافِقُ السُّنَّةَ والحَديثَ، وما رَدُّوه ممَّا يُخالِفُ السُّنَّةَ والحَديثَ، وبِهذا القَدْرِ يَنْتَحِلونَ السُّنَّةَ ويُنحِلونَها، وإلَّا لم يَصِحَّ ذلك) .
وقدْ تَقَدَّمَتْ بعضُ النُّقولِ مِن الكُتُبِ المُعْتمَدةِ عنْدَ الأشاعِرةِ المُتَأخِّرينَ، وفيها بَيانُ خَوْضِ الأشاعِرةِ في عِلمِ الكَلامِ المَذْمومِ، ومِن أَشهَرِ الأمْثلةِ الَّتي تُبَيِّنُ قُرْبَ مُتَأخِّري الأشاعِرةِ مِن الجَهْميَّةِ نَفْيُهم الصِّفاتِ الإلَهيَّةَ الخَبَريَّةَ كالاسْتِواءِ؛ فقدْ خالَفوا مَذهَبَ شَيْخِهم أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ رَحِمَه اللهُ، الَّذي أَثبَتَ صِفةَ الاسْتِواءِ وغَيْرَها مِن الصِّفاتِ الخَبَريَّةِ في كِتابِه (الإبانة) و(رِسالة إلى أهْلِ الثَّغْرِ)، ومعَ ذلك خالَفَه المُنْتَسِبونَ إليه، فأوَّلوا هذه الصِّفاتِ بما لا يَثبُتُ عن شَيْخِهم أبي الحَسَنِ، ولا عن أحَدٍ مِن السَّلَفِ الصَّالِحِ.
قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ في رَدِّه على الرَّازِيِّ الَّذي نَصَرَ قَوْلَ الجَهْميَّةِ بنَفْيِ صِفةِ الاسْتِواءِ للهِ على عَرْشِه: (إذا كانَ قَوْلُ ابنِ كُلَّابٍ والأشْعَريِّ وأئِمَّةِ أصْحابِه، وهو الَّذي ذَكَروا أنَّه اتَّفَقَ عليه سَلَفُ الأُمَّةِ وأهْلُ السُّنَّةِ؛ أنَّ اللهَ فَوْقَ العَرْشِ، وأنَّ له وَجْهًا ويَدَينِ، وتَقْريرُ ما وَرَدَ مِن النُّصوصِ الدَّالَّةِ على أنَّه فَوْقَ العَرْشِ، وأنَّ تَأويلَ اسْتَوى بمَعْنى اسْتَوْلى هو تَأويلُ المُبْطِلينَ- عُلِمَ أنَّ هذا الرَّازِيَّ ونَحْوَه هُمُ المُخالِفونَ لأئِمَّتِهم في ذلك، وأنَّ الَّذي نَصَرَه ليس هو قَوْلَ ابنِ كُلَّابٍ والأشْعَريِّ وأئِمَّةِ أصْحابِه، وإنَّما هو صَريحُ قَوْلِ الجَهْميَّةِ والمُعْتَزِلةِ ونَحْوِهم، وإن كانَ قد قالَه بعضُ مُتَأخِّري الأشْعَريَّةِ كأبي المَعالي ونَحْوِه) .
والنَّاظِرُ في كُتُبِ الأشاعِرةِ بعِلمٍ وإنْصافٍ يَجِدُ تَأثُّرَ الأشاعِرةِ بالجَهْميَّةِ واضِحًا، ويَجِدُ مُخالَفةَ مُتَأخِّري الأشاعِرةِ لقَوْلِ أئِمَّتِهم المُتَقَدِّمينَ كأبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ، وتَأمَّلْ هذا النَّقْلَ عن أبي المَعالي الجُوَيْنيِّ في تَأويلِه صِفةَ الاسْتِواءِ للهِ سُبْحانَه؛ إذْ قالَ: (لم يَمْتَنِعْ مِنَّا حَمْلُ الاسْتِواءِ على القَهْرِ والغَلَبةِ، وذلك شائِعٌ في اللُّغةِ؛ إذِ العَرَبُ تَقولُ: اسْتَوى فُلانٌ على المَمالِكِ: إذا احْتَوى على مَقاليدِ المُلْكِ، واسْتَعْلى على الرِّقابِ، وفائِدةُ تَخْصيصِ العَرْشِ بالذِّكْرِ أنَّه أَعظَمُ المَخْلوقاتِ في ظَنِّ البَريَّةِ، فنَصَّ تَعالى عليه تَنْبيهًا بذِكْرِه على ما دونَه) .
وقالَ أبو المَعالي: (ذَهَبَ بعضُ أئِمَّتِنا إلى أنَّ اليَدَينِ والعَيْنَينِ والوَجْهَ صِفاتٌ ثابِتةٌ للرَّبِّ تَعالى، والسَّبيلُ إلى إثْباتِها السَّمْعُ دونَ قَضيَّةِ العَقْلِ، والَّذي يَصِحُّ عنْدَنا حَمْلُ اليَدَينِ على القُدْرةِ، وحَمْلُ العَيْنَينِ على البَصَرِ، وحَمْلُ الوَجْهِ على الوُجودِ) .
فهذا الَّذي صَحَّحَه الجُوَيْنيُّ مُوافِقٌ لقَوْلِ الجَهْميَّةِ، وهو الَّذي اعْتَمَدَه الأشاعِرةُ المُتَأخِّرونَ، معَ مُخالَفتِه الصَّريحةِ لأئِمَّتِهم المُتَقَدِّمينَ الَّذين يُعَظِّمونَهم؛ فتَأمَّلْ هذه النُّقولَ عن أبي الحَسَنِ الأشْعَريِّ والباقِلَّانيِّ في إثْباتِ الصِّفاتِ وعَدَمِ تَأويلِها:
قالَ أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ: (أَخبَرَ تَعالى أنَّ له وَجْهًا وعَيْنًا ولا تُكَيَّفُ ولا تُحَدُّ... ونَفى الجَهْميَّةُ أن يكونَ للهِ تَعالى وَجْهٌ كما قالَ، وأَبطَلوا أن يكونَ له سَمْعٌ وبَصَرٌ وعَيْنٌ... فمَن سَألَنا فقالَ: أتَقولونَ: إنَّ للهِ سُبْحانَه وَجْهًا؟ قيلَ له: نَقولُ ذلك، خِلافًا لِما قالَه المُبْتَدِعونَ...، قد سُئِلْنا أتَقولونَ: إنَّ للهِ يَدَينِ؟ قيلَ: نَقولُ ذلك بلا كَيْفٍ، فثَبَتَتِ اليَدُ بِلا كَيْفٍ...، وليس يَجوزُ في لِسانِ العَربِ ولا في عادةِ أهْلِ الخِطابِ أن يَقولَ القائِلُ: عَمِلْتُ كَذا بيَدي، ويَعْني به النِّعْمةَ، وإذا كانَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ إنَّما خاطَبَ العَربَ بلُغتِها، وما يَجْري مَفْهومًا في كَلامِها ومَعْقولًا في خِطابِها، وكانَ لا يَجوزُ في خِطابِ أهْلِ اللِّسانِ أن يَقولَ القائِلُ: فَعَلْتُ بيَدي، ويَعْني النِّعْمةَ-بَطَلَ أن يكونَ مَعْنى قَوْلِه تَعالى: بِيَدَيَّ النِّعْمةَ) .
وقالَ الباقِلَّانيُّ: (بابٌ: في أنَّ للهِ وَجْهًا ويَدَينِ. فإن قالَ قائِلٌ: فما الحُجَّةُ في أنَّ للهِ عَزَّ وجَلَّ وَجْهًا ويَدَينِ؟ قيلَ له: قَوْلُه تَعالى: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [الرحمن: 27]، وقَوْلُه: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص: 75] ، فأَثبَتَ لنَفْسِه وَجْهًا ويَدَينِ، فإن قالوا: فما أَنكَرْتُم أن يكونَ المَعْنى في قَوْلِه: خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أنَّه خَلَقَه بقُدْرتِه أو بنِعْمتِه؛ لأنَّ اليَدَ في اللُّغةِ قد تكونُ بمَعْنى النِّعْمةِ، وبمَعْنى القُدْرةِ، كما يقالُ: لي عنْدَ فُلانٍ يَدٌ بَيْضاءُ يُرادُ به نِعْمةٌ؟ يُقالُ لهم: هذا باطِلٌ؛ لأنَّ قَوْلَه: بِيَدَيَّ يَقْتَضي إثْباتَ يَدَينِ هما صِفةٌ له، فلو كانَ المُرادُ بِهما القُدْرةَ لَوَجَبَ أن يكونَ له قُدْرتانِ، وأنتم فلا تَزعُمونَ أنَّ لِلباري سُبْحانَه قُدْرةً واحِدةً، فكيف يَجوزُ أن تُثْبِتوا له قُدْرَتينِ؟ وقد أَجمَعَ المُسلِمونَ مِن مُثْبِتي الصِّفاتِ والنَّافينَ لها على أنَّه لا يَجوزُ أن يكونَ له تَعالى قُدْرتانِ، فبَطَلَ ما قُلْتُم، وكذلك لا يَجوزُ أن يكونَ اللهُ تَعالى خَلَقَ آدَمَ بنِعْمتَينِ؛ لأنَّ نِعَمَ اللهِ تَعالى على آدَمَ وعلى غَيْرِه لا تُحْصى) .
وقدْ صَرَّحَ كَثيرٌ مِن مُتَأخِّري الأشاعِرةِ أنَّ مَذهَبَ السَّلَفِ أَسلَمُ، ومَذهَبَ الخَلَفِ أَحكَمُ وأَعلَمُ، وقدْ شَنَّعَ عليهم في هذا القَوْلِ كَثيرٌ مِن العُلَماءِ؛ قالَ المُلَّا عَلِي القاري: (كلَّما ابْتَدَعَ شَخْصٌ بِدْعةً اتَّسَعوا في جَوابِها، واضْطَرَبوا في بَيانِ خَطَئِها وصَوابِها؛ فالعِلمُ نُقْطةٌ كَثَّرَها الجاهِلونَ، ولِذلك صارَ كَلامُ الخَلَفِ كَثيرًا قَليلَ البَرَكةِ، بخِلافِ كَلامِ السَّلَفِ؛ فإنَّه قَليلٌ كَثيرُ البَرَكةِ والمَنْفَعةِ، فالفَضْلُ لِلمُتَقَدِّمينَ لا ما يَقولُه جَهَلةُ المُتَكَلِّمينَ: إنَّ طَريقةَ المُتَقَدِّمينَ أَسلَمُ، وطَريقتَنا أَحكَمُ وأَعلَمُ) .
وقدْ وَصَلَ الحالُ بالأشاعِرةِ المُتَأخِّرينَ إلى مُوافَقةِ الجَهْميَّةِ في إنْكارِهم أنَّ اللهَ في السَّماءِ مُسْتَوٍ على عَرْشِه، كما أَخبَرَ في كِتابِه، وخالَفوا أبا الحَسَنِ الَّذي يَنْتَسِبونَ إليه، وقالوا قَوْلَهم العَجيبَ الغَريبَ الَّذي لا يَعرِفُه أحَدٌ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ وأتْباعِهم: إنَّ اللهَ ليس بداخِلِ العالَمِ ولا خارِجِه، ولا فَوْقَ ولا تحتَ
الفصلُ الخامسُ: علاقةُ الأشاعِرةِ بالتَّصوُّفِ
علاقةُ الأشاعِرةِ بالتَّصوُّفِ علاقةٌ قديمةٌ؛ فقد ثبتَ أنَّ أشهَرَ الأشاعِرةِ القُدامى كان لهم صلةٌ بالتَّصوُّفِ، وقد ادَّعى بعضُ الأشاعِرةِ كالسُّبْكيِّ أنَّ أبا الحسنِ الأشعَريَّ (ت: 324 هـ) مُؤسِّسَ المَذهَبِ الأشعَريِّ التقى بالجُنَيدِ شيخِ الصُّوفيَّةِ (ت: 298 هـ)، وزعَم هؤلاء أنَّه أوَّلُ ارتباطٍ بَينَ الأشاعِرةِ والصُّوفيَّةِ، وهذا بعيدٌ، لا دليلَ عليه
.
ومِن أعلامِ الأشاعِرةِ الذين كان لهم صِلةٌ بالتَّصوُّفِ: أبو الحسينِ الشِّيرازيُّ بُنْدار (ت: 353 ه)، خادمُ أبي الحسنِ الأشعَريِّ، وسمَّاه الذَّهبيُّ شيخَ الصُّوفيَّةِ ، وكانت له صِلةٌ بأبي بكرٍ الشِّبْليِّ (ت: 334 هـ)، والشِّبْليُّ هذا مِن مشاهيرِ الصُّوفيَّةِ؛ قالَ عنه الذَّهبيُّ: (أبو بكرٍ الشِّبْليُّ، الصُّوفيُّ المشهورُ، صاحبُ الأحوالِ) .
وذَكرَ ترجمتَه السُّبْكيُّ في ((طبَقاتِ الشَّافعيَّةِ الكُبرى)) .
ومنهم أبو عبدِ اللهِ بنُ خَفيفٍ الشِّيرازيُّ (ت: 371 هـ)، وهو مِن تلاميذِ أبي الحسنِ الأشعَريِّ.
ذَكرَه ابنُ عساكرَ مِن الأشاعِرةِ، ووصَفه بالصُّوفيِّ ، وقال السُّبْكيُّ عن ابنِ خَفيفٍ: (روى عنه القاضي أبو بكرِ بنُ الباقِلَّانيِّ شيخُ الأشعَريَّةِ وطائِفةٌ، رحَل ابنُ خَفيفٍ إلى الشَّيخِ أبي الحسنِ الأشعَريِّ، وأخَذ عنه، وهو مِن أعيانِ تلامِذتِه) .
ومنهم: أبو منصورٍ عبدُ القاهرِ البَغداديُّ (ت: 429 هـ)، كان مِن شُيوخِه أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجيدٍ السُّلَميُّ، شيخُ الصُّوفيَّةِ بخُراسانَ، وأحدُ مشايخِ أبي عبدِ اللهِ الحاكِمِ في الحديثِ، وهو مِن أصحابِ الجُنيدِ شيخِ الصُّوفيَّةِ، وهو جَدُّ الصُّوفيِّ المشهورِ أبي عبدِ الرَّحمنِ السُّلَميِّ لأمِّه .
فالبَغداديُّ مِن أشهَرِ أعلامِ الأشاعِرةِ، وقد كان مُتأثِّرًا بالصُّوفيَّةِ، وعَدَّهم مِن أصنافِ أهلِ السُّنَّةِ؛ قال عبدُ القاهرِ البَغداديُّ في ذِكرِه لأصنافِ أهلِ السُّنَّةِ: (الصِّنفُ السَّادسُ منهم: الزُّهَّادُ الصُّوفيَّةُ، الذين أبصَروا فأقصَروا، واختَبروا فاعتَبروا، ورَضُوا بالمَقدورِ وقنِعوا بالمَيسورِ، وعلِموا أنَّ السَّمعَ والبصرَ والفؤادَ كُلُّ أولئك مَسؤولٌ عن الخيرِ والشَّرِّ، ومُحاسَبٌ على مَثاقيلِ الذَّرِّ، فأعَدُّوا خيرَ الاعتِدادِ ليوم المَعادِ، وجرى كلامُهم في طريقَيِ العِبارةِ والإشارةِ على سَمتِ أهلِ الحديثِ، دونَ مَن يشتري لهْوَ الحديثِ، لا يعملونَ الخيرَ رِياءً، ولا يتركونَه حياءً، دينُهم التَّوحيدُ ونَفيُ التَّشبيهِ، ومَذهَبُهم التَّفويضُ إلى اللهِ تعالى والتَّوكُّلُ عليه، والتَّسليمُ لأمرِه، والقناعةُ بما رُزِقوا، والإعراضُ عن الاعتِراضِ عليه) .
قال عنه ابنُ الصَّلاحِ: (رأيتُ له كتابًا في "معنى لفظتَيِ التصَوُّفِ والصُّوفيِّ"، جمَع فيه مِن أقوالِ الصُّوفيَّةِ زُهاءَ ألفِ قَولٍ مُرتَّبةٍ على حُروفِ المُعجَمِ.
ومِن قَولِه فيه:
التصَوُّفُ: مجانَبةُ الأجانبِ من كُلِّ جانبٍ.
التصَوُّفُ: غَيثٌ بلا عَيثٍ.
الصُّوفيُّ: هو الذي لا يطمَعُ فيمَن يطمَعُ.
الصُّوفيُّ: مَن لا يُبالي أن يكونَ مَلومًا إذا لم يكُنْ مُليمًا.
الصُّوفيُّ: مُفهمٌ مُلهَمٌ، عن دَعواه مُفحَمٌ).
ثمَّ قال: (الأستاذُ أبو منصورٍ هذا يخبِطُ كثيرًا في نُقولِه وما يحكيه خَبْطَ عَشواءَ، فما أدري مِن أينَ يُؤتى؟!) .
ومنهم أبو القاسمِ القُشَيريُّ (ت: 465 هـ) مِن شيوخِه أبو عليٍّ الدَّقَّاقُ الصُّوفيُّ المَشهورُ، والقُشَيريُّ أشهَرُ مَن أدخَلَ التَّصوُّفَ في المَذهَبِ الأشعَريِّ، وربَطَه به، وذلك حين ألَّف القُشَيريُّ رِسالتَه المَشهورةَ في التَّصوُّفِ وأحوالِه وتراجِمِ رِجالِه المَشهورينَ، فذَكرَ في هذه الرِّسالةِ أنَّ عقيدةَ أعلامِ التَّصوُّفِ هي عقيدةُ الأشاعِرةِ؛ فكانت رِسالتُه سببًا عظيمًا في دخولِ الأشاعِرةِ في التَّصوُّفِ، ودخولِ الصُّوفيَّةِ في المَذهَبِ الأشعَريِّ .
ومنهم: أبو حامدٍ الغَزاليُّ (ت: 505 هـ). قال عبدُ الغافِر الفارسيُّ عن الغَزاليِّ: (غلبَتِ الحالُ عليه بَعدَ تَبحُّرِه في العلومِ، واستطالتِه على الكُلِّ بكلامِه، والاستِعدادِ الذي خصَّه اللهُ به في تحصيلِ أنواعِ العلومِ، وتَمكُّنِه مِن البحثِ والنَّظرِ، حتَّى تَبرَّمَ مِن الاشتِغالِ بالعلومِ العَريَّةِ عن المُعامَلةِ، وتَفكَّرَ في العاقبةِ، وما يُجدي وما ينفعُ في الآخرةِ، فابتَدأَ بصُحبةِ الفارمذيِّ، وأخذَ مِنه استِفتاحَ الطَّريقةِ) .
وأبو حامدٍ إمامٌ مَشهورٌ مِن أئمَّةِ المَذهَبِ الأشعَريِّ، وإمامٌ مَشهورٌ مِن أئمَّةِ التَّصوُّفِ، وله كلامٌ كثيرٌ في العقائِدِ الأشعَريَّةِ، وفي التَّصوُّفِ، وأشهَرُ كُتبِه ((إحياءُ علومِ الدِّينِ)) دعا فيه إلى عقيدةِ الأشاعِرةِ، وإلى التَّصوُّفِ؛ فقدْ عقَدَ فيه كتابًا أسماه قواعدَ العقائِدِ ، قرَّر فيه عقائِدَ الأشاعِرةِ، فالغَزاليُّ وكتابُه الإحياءُ مِن أهمِّ الأسبابِ التي ربطَتْ بَينَ التَّصوُّفِ والمَذهَبِ الأشعَريِّ، فلا تكادُ تجدُ صوفيًّا ممَّن يعظِّمُ الغَزاليَّ ويعظِّمُ كتابَه إحياءَ علومِ الدِّينِ إلَّا وهو أشعَريُّ المَذهَبِ!
وهكذا امتَزجَ التَّصوُّفُ بالمَذهَبِ الأشعَريِّ، وارتَبطَ به ارتِباطًا قويًّا؛ فكثيرٌ ممَّن جاء بَعدَ أبي حامدٍ الغَزاليِّ مِن أعلامِ الأشاعِرةِ الدُّعاةِ إليه تَجِدُهم أيضًا مِن الدُّعاةِ إلى التَّصوُّفِ، فهُم معَ تَقريرِهم عقائِدَ الأشاعِرةِ يدْعونَ إلى التَّصوُّفِ .
ومنهم فخرُ الدِّينِ الرَّازيُّ (ت: 606 هـ)، فقال في قصَّةِ أصحابِ الكهفِ: (احتجَّ أصحابُنا الصُّوفيَّةُ بهذه الآيةِ على صحَّةِ القولِ بالكراماتِ، وهو استِدلالٌ ظاهرٌ) .
وقال عنه طاش كُبْرى زادَه: (وكان من أهلِ الدِّينِ والتَّصَوُّفِ، وله يدٌ فيه، وتفسيرُه يُنبئُ عن ذلك) .
وقال أيضًا: (اعلَمْ أنَّ الإمامَ كان من زُمرةِ الفُقهاءِ، ثمَّ التحق بالصُّوفيَّةِ، فصار من أهلِ المُشاهَدةِ، وصنَّف التَّفسيرَ بَعدَ ذلك. ومَن تأمَّل في مباحثِه، وتصفَّح لطائِفَه؛ يجِدْ في أثنائِه كَلِماتِ أهلِ التَّصوُّفِ من الأمورِ الذَّوقيَّةِ) .
ومنهم عزُّ الدِّينِ بنُ عبدِ السَّلامِ (ت: 660 هـ)، كانَ أشعرِيًّا مُتصوِّفًا.
قالَ السُّيوطيُّ في ترجمتِه: (له كراماتٌ كثيرةٌ، ولبِسَ خِرقةَ التَّصوُّفِ مِن الشِّهابِ السُّهْروَرديِّ) .
ومنهم تَقيُّ الدِّينِ السُّبْكيُّ (ت: 756 هـ)، قالَ تاجُ الدِّينِ السُّبْكيُّ في ترجمةِ والدِه تَقيِّ الدِّينِ السُّبْكيِّ: (صَحِبَ في التَّصوُّفِ الشَّيخَ تاجَ الدِّينِ بنَ عطاءِ اللهِ) .
ومنهم تاجُ الدِّينِ السُّبْكيُّ (ت: 771هـ)، وكان يُكثِرُ في كتابِه طبَقاتِ الشَّافعيَّةِ الكُبرى مِن الثَّناءِ على الصُّوفيَّةِ، وتعظيمِ أمرِهم .
وقال في كتابِه "مُعيدُ النِّعمِ": (وقد جرَّبْنا فلم نَجِدْ فقيهًا ينكِرُ على الصُّوفيَّةِ إلَّا ويهلِكُه اللهُ تعالى، وتكونُ عاقبتُه وخيمةً) .
وقال أيضًا: (إذا علِمْتَ أنَّ خاصَّةَ الخلْقِ هُم الصُّوفيَّةُ، فاعلمْ أنَّهم قد تشبَّهَ بهم أقوامٌ ليسوا منهم، فأوجَبَ تَشبُّهُ أولاء بهم سوءَ الظَّنِّ، ولعلَّ ذلك مِن اللهِ تعالى قصدًا لخفاءِ هذه الطَّائفةِ التي تُؤثِرُ الخمولَ على الظُّهورِ) .
ومنهم زكريَّا الأنصاريُّ (ت: 926 هـ)، وله شرحٌ على رسالةِ القُشَيريِّ، وذَكرَ في آخِرِ كتابِه "غايةُ الوصولِ" خاتمةً فيما يُذكَرُ مِن مبادئِ التَّصوُّفِ .
وقالَ السَّخاويُّ عن زكريَّا الأنصاريِّ: (قرأ التَّصوُّفَ عن أبي عبدِ اللهِ الغَمْريِّ، والشِّهابِ أحمدَ الإدْكاويِّ، ومُحمَّدٍ الفُوِّيِّ...، وهو أحدُ مَن عظَّمَ ابنَ عربيٍّ، واعتَقده، وسمَّاه ولِيًّا) .
ومنهم ابنُ حَجَرٍ الهَيْتميُّ (ت: 974 هـ)، قالَ ابنُ حَجَرٍ الهَيْتميُّ: (أورادُ الصُّوفيَّةِ التي يقرؤونَها بَعدَ الصَّلواتِ على حسَبِ عاداتِهم في سلوكِهم لها أصلٌ أصيلٌ...، وإذا ثبَت أنَّ لِما يعتادُه الصُّوفيَّةُ مِن اجتماعِهم على الأذكارِ والأورادِ بَعدَ الصُّبحِ وغَيرِه أصلًا صحيحًا مِن السُّنَّةِ، وهو ما ذَكرْناه، فلا اعتِراضَ عليهم في ذلك، ثمَّ إن كان هناك مَن يتأذَّى بجَهرِهم كمُصلٍّ أو نائمٍ نُدِب لهم الإسرارُ، وإلَّا رجَعوا لِما يأمرُهم به أستاذُهم الجامعُ بَينَ الشَّريعةِ والحقيقةِ، لِما مرَّ أنَّه كالطَّبيبِ، فلا يأمرُ إلَّا بما يرى فيه شفاءً لعِلَّةِ المريضِ...، والأخذُ عن مشايخَ مُتعدِّدينَ يختلفُ الحالُ فيه بَينَ مَن يريدُ التَّبرُّكَ وبَينَ مَن يريدُ التَّربيةَ والسُّلوكَ؛ فالأوَّلُ يأخذُ عمَّن شاء؛ إذ لا حجْرَ عليه، وأمَّا الثَّاني فيَتعيَّنُ عليه على مصطَلحِ القومِ السَّالِمينَ مِن المَحظورِ واللَّومِ -حشَرَنا اللهُ في زُمرتِهم- أن لا يَبتدِئَ إلَّا بمَن جذَبه إليه حالُه قهرًا عليه، بحيثُ اضمحلَّتْ نفسُه لباهرِ حالِ ذلك الشَّيخِ المُحقِّ، وتخلَّتْ له عن شَهواتِها وإرادتِها، فحينَئذٍ يتعيَّنُ عليه الاستِمساكُ بهَديِه والدُّخولُ تحتَ جميعِ أوامرِه ونواهيه ورسومِه؛ حتَّى يصيرَ كالميِّتِ بَينَ يدَيِ الغاسلِ، يُقلِّبُه كيف شاءَ) .
وقال ابنُ حَجَرٍ الهَيْتميُّ أيضًا: (ينبغي للإنسانِ حيثُ أمكَنه عدمُ الانتِقادِ على السَّادةِ الصُّوفيَّةِ، نفَعَنا اللهُ بمعارِفِهم، وأفاض علينا بواسطةِ محبَّتِنا لهم ما أفاض على خواصِّهم، ونظَمَنا في سِلكِ أتباعِهم، ومَنَّ علينا بسوابِغِ عوارفِهم- أن يُسلِّمَ لهم أحوالَهم ما وجدَ لهم مَحمَلًا صحيحًا يخرِجُهم عن ارتِكابِ المُحرَّمِ، وقد شاهَدْنا مَن بالَغ في الانتِقادِ عليهم، معَ نوعِ تعصُّبٍ، فابتلاه اللهُ بالانحِطاطِ عن مرتبتِه، وأزال عنه عوائِدَ لُطفِه وأسرارَ حَضرتِه، ثُمَّ أذاقه الهوانَ والذِّلَّةَ، ورَدَّه إلى أسفَلِ سافِلينَ، وابتلاه بكلِّ عِلَّةٍ ومِحنةٍ) .
ثُمَّ في القرونِ الأربعةِ الأخيرةِ انتَشر التَّصوُّفُ انتِشارًا غَيرَ مَسبوقٍ، لا سيَّما في عَهدِ الدَّولةِ العُثمانيَّةِ التي كانت ترعاه، وتَبنَّاه علماءُ الأشاعِرةِ والماتُريديَّةِ، ودعَوا إليه.
أمَّا في القرنَينِ الأخيرَينِ فقد التَحمَتِ الصُّوفيَّةُ معَ الأشعَريَّةِ في مدرسةٍ واحدةٍ، وتجمَّع الأشاعِرةُ في محاضِنِ الصُّوفيَّةِ، وانتَشر التَّصوُّفُ بَينَ علماءِ الأزهَرِ بمِصرَ، وعلماءِ الشَّامِ وحَضْرَموتَ، وعلماءِ المَغرِبِ وما جاوَرَها، وعلماءِ الهِندِ، وعلماءِ تُركيا والشِّيشانِ وطاجَكِستانَ وغيْرِها مِن البُلدانِ، فلا تكادُ تَجِدُ صوفيًّا إلَّا وهو أشعَريٌّ أو ماتُريديُّ المُعتقَدِ، وجميعُ مُؤسَّساتِ ومراكِزِ الصُّوفيَّةِ في العالَمِ تدرِّسُ العقيدةَ الأشعَريَّةَ، وآخِرُ ما جمَعهم معًا المُؤتمَرُ الذي أُقيمَ في جروزني عاصمةِ الشِّيشانِ عامَ 1437هـ، المُوافِق 2016 م، والمُسمَّى زورًا وبُهتانًا (مُؤتمَرَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ)، حضَره علماءُ الصُّوفيَّةِ مِن الأشاعِرةِ والماتُريديَّةِ، وبعضُ المَخدوعينَ والمُنتفِعينَ، وكانت أبرَزُ نتائجِه إصدارَ بيانٍ قرَّروا فيه أنَّ أهلَ السُّنَّةِ والجماعةِ هُم الأشاعِرةُ والماتُريديَّةُ، والمُفوِّضةُ مِن أهلِ الحديثِ، وأهلُ المَذاهبِ الأربعةِ في الفِقهِ، وأهلُ التَّصوُّفِ، وأخرجوا غَيرَ هؤلاء مِن مُسمَّى أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ!
وهنا مِثالٌ على مسألةِ اختَلَف فيها قولُ الأشاعرةِ المتصَوِّفةِ عن الحَقِّ الذي قال به أهلُ السُّنَّةِ فيها: وهي حَياةُ الأَنْبِياءِ عليهم السَّلامُ بَعْدَ مَوْتِهم فهيَ مَحْمولةٌ عنْدَ أهْلِ السُّنَّةِ على حَياةٍ بَرزخيَّةٍ كحَياةِ الشُّهَداءِ، وليسَتْ كحَياتِهم في الدُّنْيا قَبلَ مَوتِهم، ولكنَّ بعضَ الأشاعِرةِ والصُّوفيَّةِ يَحمِلونَها على أنَّها حَياةٌ كحَياتِهم في الدُّنْيا قَبْلَ مَوْتِهم، وجَوَّزوا لِذلك دُعاءَهم والاستِغاثةَ بِهم!
قال الحصْنيُّ مُنتقِدًا ابنَ تَيميَّةَ في نَفيِه حَياةَ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في قَبرِه، ومَنعِه مِن التَّوَسُّلِ به بَعدَ مَوتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: (مِن الأمورِ المُنتَقَدةِ عليه، وهو مِن أقبَحِ القَبائِحِ، وشَرِّ الأقوالِ وأخبَثِها- مَسْألةُ التَّفْرقةِ الَّتي أَحدَثَها غُلاةُ المُنافِقينَ مِن اليَهودِ، وعَصَوا أمرَ النَّبيِّ واستَمَرَّ عليها أتباعُهم الَّذين يُظهِرونَ الإسلامَ وقُلوبُهم مُنطَويةٌ على بُغضِ النَّبيِّ، ولم يَقدِروا أن يَتَوصَّلوا إلى الغَضِّ مِنه إلَّا بِذلك.
وقد ذَكَرَ المَسألةَ الأئِمَّةُ الأعلامُ، فأذكُرُ بعضَ كَلامِهم فيها، ثُمَّ أعودُ إلى ابنِ تَيميَّةَ مُستدِلًّا بأمورٍ سَمعيَّةٍ وغَيرِها تُفيدُ جَلالتَه وعَظامتَه وحَياتَه في قَبرِه، وبَقاءَ حرْمتِه على ما كان عليه في حَياتِه، ويَقطَعُ الواقِفُ عليها أو على بَعضِها بأنَّ القائِلينَ بالتَّفرقةِ مِن مُتَغالي أهلِ الزَّيغِ والزَّندَقةِ، وأنَّ ابنَ تَيميَّةَ الذي كانَ يوصَفُ بأنَّه بَحرٌ في العِلمِ لا يُستَغرَبُ فيه ما قاله بعضُ الأئِمَّةِ عنه مِن أنَّه زِنديقٌ مُطلَقٌ!...، ولنَرجِعْ إلى قَولِ بعضِ الأئِمَّةِ؛ فمنهم الإمامُ العَلَّامةُ شَيخُ شُيوخِ وَقتِه، أبو الحَسَنِ علِيٌّ القُونَويُّ، قالَ بَعدَ ذِكرِه أشياءَ لا أُطَوِّلُ بذِكرِها، وفيها دَلالةٌ على أنَّ التَّوَسُّلَ بالنَّبيِّ في الحاجاتِ بَعدَ وَفاتِه كالتَّوَسُّلِ به في حالِ حَياتِه، ثُمَّ قالَ: وهذا وأمثالُه يَرُدُّ على هؤلاء المُبتَدعةِ الَّذين نَبَغوا في زَمانِنا، ومَنَعوا التَّوَسُّلَ برَسولِ اللهِ...، ولا مُتَشَبَّثَ في الحَديثِ المَذكورِ؛ فإنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه إنَّما قَصَدَ أن يُقدِّمَ العَبَّاسَ ويُباشِرَ الدُّعاءَ بنفسِه، وهذا لا يُتَصوَّرُ حُصولُه مِن غَيرِ الحَيِّ، أي: الحَياةَ الدُّنيويَّةَ. وأمَّا التَّوَسُّلُ برَسولِ اللهِ فلا نُسَلِّمُ أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه تَرَكَه بَعدَ مَوتِه، وتَقديمُ العَبَّاسِ لِيَدعوَ للنَّاسِ لا يَنفي جَوازَ التَّوَسُّلِ به معَ ذلك) .
وقال سَلامةُ العَزَّاميُّ الصُّوفيُّ: (التَّوَسُّلُ والتَّشَفُّعُ والاستِغاثةُ بالنَّبيِّينَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، والصَّالِحينَ رَضيَ اللهُ عنهم بَعدَ وَفاتِهم، معَ اعتِقادِ أنَّهم مَفاتيحُ الرَّحمةِ وأسبابُ الخَيرِ، والفاتِحُ لها بهم هو اللهُ وَحدَه- ليس شِركًا ولا كُفرًا، ولا حَرامًا ولا مَكروهًا، بل هو سَبيلُ المُؤمِنينَ، وطَريقُ عِبادِ اللهِ المَرضيِّينَ!) .
كما أنَّ لبعضِ المُتَأخِّرينَ مِن الصُّوفيَّةِ الأشاعِرةِ أو المُتَأثِّرينَ بالأشاعِرةِ كُتُبًا تُناقِضُ تَوحيدَ الرُّبوبيَّةِ وتَوحيدَ الأُلوهيَّةِ، ومن ذلك كِتابُ: (إتحاف الأذكياء بجَوازِ التَّوَسُّلِ بالأنبِياءِ والأولياء) لعَبدِ اللهِ بنِ مُحمَّدٍ الغماريِّ، وكِتابُ (شَواهِد الحَقِّ في الاستِغاثةِ بسَيِّدِ الخَلْقِ) ليوسُفَ النَّبْهانيِّ. واللهُ المُسْتعانُ.
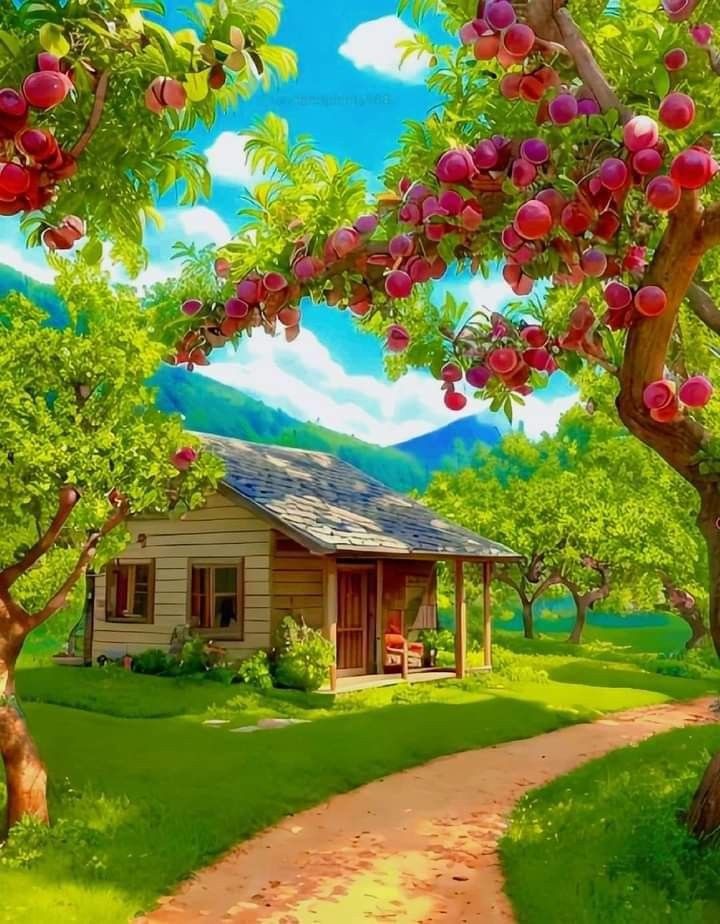
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق