قطر الولي على حديث الولي محمد بن علي الشوكاني
رحمه الله
اعتنى
به شــتــا
مـحـمـد
ديباجة التحقيق
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله، وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله، بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسر باله، الحي القيوم، الواحد الأحد، الفرد الصمد، المنفرد بالبقاء، وكل مخلوق ينتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله. وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده، ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه، ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها، الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله، فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجدها وقد تهيأ لموته وانقطع أوصاله، وإن أصر على الإعراض، ولم يتعرض لأسباب الرحمة، بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله، وصالح عدوه وقاطع سيده، فقد استحق الهلاك، ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك لعظيم رحمته وسعة إفضاله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا أحدًا فردًا صمدًا، جل عن الأشباه والأمثال، وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكال، لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [الرعد: 11].
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، القائم له بحقه، وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين، وإمامًا للمتقين، وحسرة على الكافرين، وحجة على العباد أجمعين، بعثه على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل. وافترض على العباد طاعته ومحبته، وتعظيمه وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. فشرح له صدره، ووضح له عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه، فلا يذكر إلا ذكر معه، كما في التشهد والخطب والتأذين.
فلم يزل ﷺ قائمًا بأمر الله لا يرجه عنه راد، مشمرًا في مرضاة الله لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجًا، ودخل الناس في دين الله أفواجًا أفواجًا، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، ثم استأثر الله به لينجز له ما وعده به في كتابه المبين، بعدما بلغ رسالته، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وأقام الدين، وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين. وقال: ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾([1]) [يوسف: 108].
أما بعد:
بين أيدينا أثرٌ مباركٌ من آثار النبوة، وريحانة أطيب من ريح الألوة، مشكاة مضيئة ودرة مصونة، قد حفت بالحجج البوالغ، ومُدت بالفوائد السوابغ، مصباحٌ منير ، إن حل نهاره فشمس لا تغيب، و إن حل ليله فقمرٌ لا ينطفأ.
هو حديثٌ نبوى ، كبير القدر، عظيم النفع، ما زالت عين فوائده تفور، مذ أن خرج من مشكاة النبوة، وما زال العلماء والعباد ينهلون من خيره، ويستسقون من نبعه، فطوبى لمن وعاه قلبه، وعملت به جوارحه، ودعا به على بصيرة وهدى، اللهم لا تحرمنا فضله ولا تمنعنا أجره.
إنه حديث الولي، الذي رواه «كنانة الأثر» أبو هريرة ﭬ حيث قال:
قال رسول الله ﷺ: «إن الله قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».
و قد استفاضت شروح هذا الحديث، وتعددت الحواشي عليه، فمنها ما هو من المطولات؛ كشروح «صحيح البخاري»، ومنها ما هو دون ذلك؛ كشروح «الأربعين» للإمام النووي $، وهي كثيرة جدًّا.
أما من خصه بمؤلف مستقل: فهم قليل؛ منهم الحافظ السيوطي في كتابه «القول الجلي»، وكتاب القطر هذا، ومن المعاصرين الشيخ علي الشحود في كتابه «الخلاصة في شرح حديث الولي».
والسفر الذي بين أيدينا قد بسط شرحه وحرر فوائده وأظهر غوامض مسائله: علامة اليمن وقاضيها الإمام محمد بن علي الشوكاني $، وجعل الجنة مثواه، وجعل ذلك في سفر سماه «قطر الولي على حديث الولي»، أطال في تحقيقه النفس، واستعرض عليه مسائلًا ظاهرها البعد عن مضمون الحديث، لكن له في ذلك بيان وحجة .
و قد استعنت بالله العلي القدير، بلا حول لي إلا بعزته، ولا عون إلا بتوفيقه وقدرته؛ فجمعت في هوامشه جملةً من زوائد الأئمة على شرحه؛ ومن تعليقات المحققين على تحقيقه، وكذلك ما تيسر من فوائد العلماء الربانيين، وتخريجات وتعليقات لبعض الحفاظ المحدثين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين.
ولم يخل كذلك من تزيلات على مسائل تعرض لها المصنف $، خاصة التي وقع فيها خلاف بين العلماء، والفضل لله وحده أولًا وآخرًا، ثم لهؤلاء الأعلام من المتقدمين والمتأخرين، وكذلك لمشايخنا حفظهم الله تعالى؛ الذين ربونا قبل أن يعلمونا، وأدبونا قبل أن يفهمونا، ولولا الأعذار لظلت ركابنا عند ركابهم، ننهل من علمهم، ونتأدب بسمتهم، فاللهم إنا نسألك لهم طول العمر، ودوام النفع للعالمين.
وها هو العبد الفقير يستعين الله تعالى على كل أمر فيه طاعته، يعم به فضله ورحمته، ويعوذ به تعالى من عثرة الأقدام، وذلل الأقلام، وإليه يلوذ من رياءٍ مهلك، وعُجبٍ محرق، وخَطْ حرفٍ لا يُراد به وجهه.
وقبل الشروع في تقديم نص الكتاب محققًا، أقدم بهذه المقدمة، والتي تتكون من قسمين:
1- قسم الدراسة. 2- قسم التحقيق.
ويتكون قسم الدراسة من:
* الفصل الأول: ترجمة المصنف:
- المبحث الأول: حياته الشخصية:
المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه.
المطلب الثاني: مولده ونشأته.
المطلب الثالث: أخلاقه وعبادته.
المطلب الرابع: وفاته.
- المبحث الثاني: حياته العلمية:
المطلب الأول: طلبه للعلم.
المطلب الثاني: مشايخه.
المطلب الثالث: عقيدته وطريقته.
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه.
- المبحث الثالث: حياته العملية:
المطلب الأول: أعماله.
المطلب الثاني: تلاميذه.
المطلب الثالث: مؤلفاته.
* الفصل الثاني: التعريف بالكتاب:
- المبحث الأول: توثيق الكتاب:
المطلب الأول: عنوان الكتاب.
المطلب الثاني: نسبته إلى المؤلف.
المطلب الثالث: تاريخ تأليف الكتاب.
- المبحث الثاني: أهمية الكتاب.
* الفصل الثالث: معنى الولاية:
- المبحث الأول: معنى الولاية لغةً.
- المبحث الثاني: مفهوم ولاية الله تعالى في الشرع.
- المبحث الثالث: الفرق بين مقام النبوة ومقام الولاية.
- المبحث الرابع: مقام النبوة أفضل من مقام الولاية.
- المبحث الخامس: ضابط التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
- المبحث السادس: كرامات الأولياء.
- المبحث السابع: الفرق بين الكرامة والمعجزة.
* الفصل الرابع: تخريج حديث الولي:
- المبحث الأول: من رواية أبي هريرة.
- المبحث الثاني: من رواية عائشة.
- المبحث الثالث: من رواية أبي أمامة.
- المبحث الرابع: من رواية علي بن أبي طالب.
- المبحث الخامس: من رواية ابن عباس.
- المبحث السادس: من رواية أنس بن مالك.
- المبحث السابع: من رواية حذيفة بن اليمان.
- المبحث الثامن: من رواية معاذ بن جبل.
- المبحث التاسع: من رواية ميمونة بنت الحارث.
- المبحث العاشر: من رواية وهب بن منبه.
ويتكون قسم التحقيق من:
الفصل الأول: منهج التحقيق.
الفصل الثاني: وصف النسخ الخطية.
الفصل الثالث: صور من النسخ الخطية.
وأسأل الله العلي القدير ألا أُحرم من نصيحة ناصح وإرشاد راشد كريم ،
و الحمد لله في الأولى والآخرة، وصل الله على نبيه وآله وصحبه وسلم.
وكتبه/ شتا محمد
المبحث الأول
حياته الشخصية
± المطلب الأول: اسمه ونسبه:
هو: شيخ الإسلام، القاضي، علامة القطر اليماني، محمد بن علي بن محمد ابن عبدالله، الشوكاني، ثم الصنعاني، اليماني.
± المطلب الثاني: مولده ونشأته:
ولد - حسبما وجد بخط والده - في وسط نهار يوم الاثنين، الثامن والعشرين من شهر القعدة، سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف، بمحل سلفه، وهو هجرة شوكان، وكان إذ ذاك قد انتقل والده إلى صنعاء واستوطنها، ولكنه خرج إلى وطنه القديم في أيام الخريف، فولد له صاحب الترجمة هنالك، ونشأ بصنعاء.
لو أمعنا النظر في نشأة العلامة الشوكاني، لوجدنا أنه نبغ وترعرع في بيت عريق في العلم والصلاح، فهو من أسرة عرفت بالنجابة، فمنها علماء، ودعاة، وأدباء، وللكثير من أبنائها أيادي طولى في الإصلاح والإفتاء والتدريس، ويأتي في مقدمتهم والده، الذي تولى قضاء صنعاء، وكان كبير رجال الإفتاء والتدريس فيها.
± المطلب الثالث: أخلاقه وعبادته:
قال الشوكاني $ عن نفسه: وكان منجمعًا عن بني الدنيا، لم يقف بباب أمير ولا قاض، ولا صحب أحدًا من أهل الدنيا، ولا خضع لمطلب من مطالبنا، بل كان مشتغلًا في جميع أوقاته بالعلم درسًا وتدريسًا، وإفتاء وتصنيفًا، عائشًا في كنف والده $، راغبًا في مجالسة أهل العلم والأدب وملاقاتهم والاستفادة منهم وإفادتهم، وربما قال الشعر إذا دعت لذلك حاجة؛ كجواب ما يكتبه إليه بعض الشعراء من سؤال أو مطارحة أدبية أو نحو ذلك، وقد جمع ما كتبه من الأشعار لنفسه وما كتب به إليه في نحو مجلد.
± المطلب الرابع: وفاته :
في شهر جمادى الآخرة، سنة خمسين ومائتين وألف للهجرة، توفي العلامة، محمد بن علي الشوكاني، قاضيًا بمدينة «صنعاء»، وصُلِّيَ عليه في الجامع الكبير، ثم دفن بمقبرة «خزيمة» المشهورة بها، وكان عمره عند موته ستة وسبعين عامًا، وستة أشهر، أمضاها في طلب العلم وتحصيله، ثم لما ارتوى منه، نشره بين تلاميذه، وفي أوساط مجتمعه، فرحمه الله رحمة واسعة.
المبحث الثاني
حياته العلمية
± المطلب الأول: طلبه للعلم:
فبعد أن حفظ الشوكاني القرآن، وجوَّده على جماعة من معلميه، ومشايخه في مدينة صنعاء، وهو في طفولته، وحفظ عددًا من المختصرات في الفقه واللغة وغيرهما، وحرص على مطالعة كتب التاريخ، ومجاميع الأدب - شرع في طلب العلم، حيث وجد بيئة علمية مناسبة، تعلمه العلوم المختلفة، فكان يختلف إلى حلقات كبار المشايخ، والعلماء في صنعاء، ولم يرحل إلى غيرها من المدن الأخرى طلبًا للعلم؛ وذلك لأعذارٍ لم تسمح له بالخروج منها أحد تلك الأعذار، عدم الإذن من الأبوين، كما ذكر ذلك.
وقد أشار الشوكاني $ إلى سبب آخر، ثناه عن الرحلة في طلب العلم، حيث قال في كتابه «فتح القدير» (2/474):
ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم، إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه، في الحضر من غير سفر.
وقد استنبط هذا السبب من مفهومه لقوله تعالى: ﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [التوبة: 122].
وقد طبَّق $ هذا الفهم لحيثيات الرحلة، وبعد تردده في القيام بها، أو الإحجام عنها، استقر رأيه على البقاء داخل اليمن.
وهكذا نجد أنه آثر ملازمة كبار العلماء، والمشايخ في مدينته، فبدأ بقراءة كتب الفقه على والده، ثم على علماء عصره البارزين، وكانت صنعاء إذ ذاك زاخرة بالعلماء والأدباء، الذين أثروا علمه وثقافته.
وقد ذكر الشوكاني أسماء أساتذته الذين لازمهم، وأنواع العلوم التي تلقَّاها عنهم، وقرأها عليهم في التفسير، والحديث، والفقه، واللغة، والأدب، والمنطق وغيرها.
يقول الشوكاني $ - بعد أن ذكر مشايخه والعلوم التي أخذها عنهم -:
هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترجمة، ومقروءاته، وله غير ذلك من المسموعات، والمقروءات ، وأما ما يجوز له روايته، بما معه من الإجازات فلا يدخل تحت الحصر .
وبذلك يتضح لنا أنه قد درس دراسة واسعة، واطَّلع اطلاعًا يندر أن يحيط به غيره، وقد أعانته الثقافة الواسعة والعميقة، وذكاؤه الخارق، إلى جانب إتقانه للحديث الشريف وعلومه ، على الاتجاه وجهة اجتهادية، وخلع ربقة التقليد، وهو دون الثلاثين، وكان قبل ذلك على المذهب الزيدي، وصار علمًا من أعلام الاجتهاد، ومن أكبر الدعاة إلى ترك التقليد، وأخذ الأحكام اجتهادًا من الكتاب والسنة.
وقد أحسَّ بوطأة الجمود، وجناية التقليد الذي ران على الأمة الإسلامية من بعد القرن الرابع الهجري، وأثر ذلك كله في زعزعة العقيدة الإسلامية في نفوس بعض الناس، واعتناق البدع والاعتقاد في الخرافات وشيوعها، وتحلل بعض الناس من التعاليم الدينية، وانكبابهم على الموبقات والمنكرات، مما جعله يشرع قلمه ولسانه في وجه الجمود والتقليد، فيعمل جاهدًا على محاولة تغيير هذه الأوضاع، وتطهير تلك العقائد.
فكتب عدة رسائل في ذلك، ضمَّنَها دعوته إلى عقيدة السلف، وتطهيرها وتنقيتها من مظاهر الشرك والبدع، ونبذ التقليد، ومن تلك الرسائل:
1- شرح الصدور في تحريم رفع القبور.
2- التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف.
3- الدر النَّضيد في إخلاص كلمة التوحيد.
4- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد.
وبالجملة؛ فإن الشوكاني يُعدُّ من أبرز العلماء المجدِّدين، والمجتهدين في العصر الحديث، وأحد كبار الأئمة الذين شاركوا في إيقاظ الأمة الإسلامية في هذا العصر.
± المطلب الثاني: مشايخه:
ذكرت فيما سبق أن الإمام الشوكاني $ نشأ في مدينة «صنعاء»، وتلقى على أيدي علمائها البارزين مختلف أنواع العلوم، وقد كانت إذ ذاك، مكتظة بالعشرات من جهابذ العلماء، وكانت المساجد تغص بالحلقات الدراسية المتنوعة، التي تُعقد في رحابها.
لقد حرص على ملازمة أولئك العلماء، وزاحم أقرانه من طلبة العلم على الحضور إلى الصفوف الأُوَل من تلك الحِلَق، لينهل من مناهلها العذبة، وليستقي من معينها الذي لا ينضب، فكان لذلك كله أثر في نضوج فكره، وتكوينه العلمي والثقافي.
ومن أبرز مشايخه الذين تلقى عنهم:
1- أحمد بن عامر، الحدائي، الصنعاني، ولد سنة (1127هـ)، قرأ عليه الشوكاني «الأزهار»، وشرحه، والفرائض، كان زاهدًا، متقللًا من الدنيا، مواظبًا على الطاعات، يغضب إذا بلغه ما يخالف الشرع، مات سنة (1197هـ).
2- أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر، القابلي الحرازي، ولد سنة (1158هـ)، قرأ عليه في الفقه والفرائض، ووصفه الشوكاني بأن له قدرة على حسن التعبير، وجودة التصوير، مع فصاحة لسان، ورجاحة عقل، وجمال صورة، مات سنة (1227هـ).
3- إسماعيل بن حسن بن أحمد الصنعاني، ولد سنة (1125هـ) تقريبًا، وقرأ عليه «مُلْحة الإعراب»، وشرحها، وكانت له مشاركة قوية في علم الصرف والمعاني، والبيان، والأصول. مات سنة (1206هـ).
4- الحسن بن إسماعيل بن الحسين المغربي، ولد سنة (1141هـ) تقريبًا، قرأ عليه «تنقيح الأنظار» في علوم الحديث، وبعض «صحيح مسلم»، وبعض شرحه للنووي، و«سنن أبي داود» وغير ذلك، وكان زاهدًا، ورعًا، عفيفًا، متواضعًا، مات سنة (1208هـ).
5- عبدالرحمن بن حسن الأكوع، ولد سنة (1135هـ)، قرأ عليه أحد كتب الحديث، وقال عنه الشوكاني: كان شيخ الفروع ومحققها، وكان يحضر درسه جماعة نحو الثلاثين والأربعين، مات سنة (1206هـ).
6- عبدالرحمن بن قاسم المداني، ولد سنة (1121هـ)، أخذ عنه في «شرح الأزهار»، وكان زاهدًا، حسن الأخلاق، عفيفًا، جميل المحاضرة، راغبًا في الفوائد العلمية، مات سنة (1211هـ).
7- عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر، ولد سنة (1135هـ)، قرأ عليه بعض «جمع الجوامع» وشرحه، وبعض «الصحاح»، وبعض «القاموس»، وبعض «منظومة الزين العراقي» في المصطلح، وغير ذلك، وقد بالغ الشوكاني في الثناء عليه، من مصنفاته: «شرح نزهة الطرف»، «فلك القاموس»، مات بصنعاء سنة (1257هـ).
8- عبدالله بن إسماعيل بن حسن النَّهمي، ولد بعد سنة (1150هـ)، قرأ عليه «شرح كافية ابن الحاجب»، و«قواعد الإعراب»، وشرحها للأزهري، وغير ذلك وتبادل معه الشعر، وكان بارعًا في علوم العربية، مات سنة (1228هـ).
9- عبدالله بن الحسن بن علي الصنعاني، ولد سنة (1165هـ)، قرأ عليه «شرح الجامي»، وكان نابغة في التفسير، والحديث والفقه وغير ذلك، مات سنة (1210هـ).
10- علي بن إبراهيم بن علي الصنعاني، ولد سنة (1145هـ)، سمع منه «صحيح البخاري» كاملًا، وأخذ عنه الطلبة في فنون متعددة، وله شعر جيد، مات سنة (1257هـ).
11- علي بن محمد الشوكاني، والده، كانت ولادة سنة (1130هـ)، بـ «هجرة شوكان» في اليمن، ثم ارتحل إلى «صنعاء»؛ لطلب العلم، فقرأ على جماعة من علمائها، حتى برع في علم الفقه، والفرائض، على مذهب الزيدية، ثم تولى القضاء بـ «صنعاء»، إضافة إلى الإفتاء والتدريس، واستمر بها إلى أن مات ليلة الاثنين (4/11/1211هـ)، وكان قد ترك القضاء قبل موته بسنتين.
12- علي بن هادي بن عرهب الصنعاني، ولد سنة (1164هـ)، قرأ عليه في «شرح التلخيص»، وفي حواشيه، كان بارعًا في النحو، والصَّرف، والأصول، والحديث، والتفسير، مات سنة (1236هـ).
13- القاسم بن يحيى الخولاني، ولد سنة (1126هـ)، قرأ عليه «الكافية» في النحو، وشرحها،، وحواشيها، و«الشافية» في الصرف، وشرحها، و«التهذيب» في المنطق، وشرحه، و«تلخيص المفتاح»، وشرحه، وغير ذلك، قال عنه: لم تر عيناي مثله في التواضع، وعدم التلفت إلى مناصب الدنيا، مع قلة ذات يده، وكثرة مكارمه، مات سنة (1209هـ).
14- هادي بن حسن القارني، ولد سنة (1164هـ)، قرأ عليه «شرح الجزرية»، وفي «المُلحة»، وشرحها، وسمع من الشوكاني «نيل الأوطار»، وبعض «صحيح البخاري»، فهو أستاذ الشوكاني، وتلميذه في آن واحد، وقد برع في علم القراءات، والفقه، مات سنة (1238هـ).
15- يحيى بن محمد بن علي الحوثي، ولد سنة (1160هـ)، قرأ عليه في الفرائض والوصايا، والمساحة وغيرها، مات سنة (1247هـ).
16- يوسف بن محمد بن علاء الدين، المزجاجي، ولد سنة (1145هـ) تقريبًا، قال الشوكاني: سمعت منه، وأجازني لفظًا بجميع ما يجوز له روايته، ثم كتب لي إجازة، مات سنة (1213هـ).
± المطلب الثالث: عقيدته وطريقته:
لقد كان الحق دائمًا ضالته، وحكى رحمه عن نفسه بأنه يتبع منهج السلف في العقيدة. و لكنه و إن كان جوادًا ماهرًا، فإنه لم يسلم من بعض الكبوات في بعض مسائل العقيدة ، تذكر في موضعها إن شاء الله.
ومن أحسن الكتب التي استفاضت في الكلام على منهج الشوكاني في مجمل حياته الدينية كتاب «منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» للدكتور عبدالله نومسوك .
قال عنه عصريُّه المؤرخ عبدالرحمن الأهدل:
«ولقد منحه الله تعالى من بحر فضل كرمه الواسع، ثلاثة أمور لا أعلم أنها في هذا الزمان الأخير جمعت لغيره:
الأول: سعة التبحر في العلوم على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها.
الثاني: سعة التلاميذ المحققين، والنبلاء المدققين، أولي الأفهام الخارقة، والفضائل الفائقة.
الثالث: سعة التأليفات المحررة، والرسائل والجوابات المحبَّرة، التي سَامَى في كثرتها الجهابذة الفحول، وبلغ من تنقيحها وتحقيقها كل غاية وسول».
% % %
المبحث الثالث
حياته العملية
± المطلب الأول: عمله في القضاء:
في شهر رجب سنة (1209هـ)، اختار والي اليمن - إذ ذاك - علي بن عباس ابن حسين (ت: 1224هـ) الإمام الشوكاني لشغل منصب قاضي اليمن، وكان عمره - إذ ذاك - ستًّا وثلاثين سنة. وقد ذكر الشوكاني كيفية تولِّيه القضاء، وَوَصَف ذلك بأنه ابتلاء، يقول:
لما كان شهر رجب سنة (1209هـ)، مات القاضي يحيى بن صالح الشجري السحولي، وبعد موته بأسبوع، لم أشعر إلا بطلاب من الخليفة، فذهبتُ إليه، فذكر لي أنه قد رجَّح قيامي مقام القاضي المذكور، فاعتذرت له بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم، فقال: القيام بالأمرين ممكن، وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلي في يومين فقط، فقلت: سيقع مني الاستخارة لله، والاستشارة لأهل الفضل، وما اختاره الله ففيه الخير، فلما فارقته، مازلت مترددًا نحو أسبوع، ولكنه وفد إليَّ غالبُ من ينتسب إلى العلم في مدينة «صنعاء»، وأجمعوا على أن الإجابة واجبة، وأنهم يخشون أن يدخل في هذا المنصب - الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية - من لا يوثق بدينه وعلمه، وأكثروا من هذا، وأرسلوا إليَّ الرسائل المطوَّلة، فقبلت مستعينًا بالله تعالى، ومتكلًا عليه.
لقد كان الشوكاني يعتقد أن الاشتغال بالقضاء سيحول بينه وبين ما كان يقوم به من التعليم، والتدريس، والتصنيف، ويرى أن عملًا كالقضاء يحتاج إلى خبرة بمجالس القضاء وأعمالهم، وهو لا يملك تلك الخبرة ابتداءً، ولكن استخارته لله ۵، ثم إلحاح جُلِّ ذوي العلم والرأي والمعرفة، قد دفع به إلى قبول ذلك العمل، الذي لو انصرف عنه أهل الدين والعلم، لأصبح في أيدي الجهلة والظلمة والمقلدين والمتعصبين.
ولم يقتصر عمله في القضاء، وفضِّ المنازعات بين الخصوم على يومين فقط كما حدَّد له الأمير عند عرض هذا المنصب عليه، بل شَغَل هذا العمل الجديد جل وقته.
يقول الشوكاني: ولم يقع التوقف على مباشرة الخصومات في اليومين فقط، بل انثال الناس من كل محل، فاستغرقتُ في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة، قد أفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم، أو لشيء من التحصيل، وتتميم ما قد كنت شرعت فيه، واشتغل الذهن شُغْلَةً كبيرة، وتكدّر الخاطر تكدرًا زائدًا، لاسيما وأنا لا أعرف الأمور الاصطلاحية في هذا الشأن، ولم أحضر عند قاض في خصومة ولا في غيرها، بل كنت لا أحضر في مجالس الخصومة عند والدي $ من أيام الصغر فما بعدها، ولكن شرح الله الصدر، وأعان على القيام بذلك الشأن.
± المطلب الثاني: تلاميذه:
قال الشوكاني عن نفسه: وأخذ عنه الطلبة، وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من تلك الكتب، وكثيرًا ما كان يقرأ على مشايخه، فإذا فرغ من كتاب قراءة أخذه عنه تلامذته، بل ربما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخه.
وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر درسًا، منها ما يأخذه عن مشايخه، ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة، حتى لم يبق عند أحد من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأه صاحب الترجمة، بل انفرد بمقروءات بالنسبة إلى كل واحد منهم على انفراده إلا شيخه العلامة عبدالقادر بن أحمد، فإنه مات ولم يكن قد استوفي ما عنده.
ثم إن صاحب الترجمة فرَّغ نفسه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على عشرة دروس في فنون متعددة، واجتمع منها في بعض الأوقات التفسير، والحديث، والأصول، والنحو، والصرف، والمعاني، والبيان، والمنطق، والفقه، والجدل، والعروض، وكان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل مدينة صنعاء، بل ومن وفد إليها، بل ترد عليه الفتاوى من الديار التهامية، وشيوخه إذ ذاك أحياء، وكادت الفتيا تدور عليه من عوام الناس وخواصهم، واستمر يفتي من نحو العشرين من عمره فما بعد ذلك، وكان لا يأخذ على الفتيا شيئًا تنزهًا، فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن، فأريد إنفاقه كذلك.
وأخذ عنه الطلبة كتبًا غير الكتب المتقدمة مما لا طريق له فيها إلا الإجازة، وهي كثيرة جدًّا، في فنون عدة، بل أخذوا عنه في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء منها؛ كعلم الحكمة التي منها علم الرياضي والطبيعي والإلهي، وكعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع.
ومن أبرز تلامذته الذين أخذوا عنه:
1- السيد محمد بن محمد «زبارة» الحسني اليمني الصنعاني: الذي ترجم للشوكاني في كتابه «نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر»، والذي ساهم في نشر بعض مؤلفات الشوكاني في مصر.
2- محمد بن أحمد السودي، لازم الشوكاني منذ ابتداء طلبه إلى انتهائه. وقال فيه الشوكاني:
|
أعز
المعالي أنت للدهر زينة |
|
وأنت
على رغم الحواسد ماجدُه |
3- محمد بن أحمد مشحم الصعدي الصنعاني: تولى القضاء في صنعاء وغيرها، وأثنى عليه الشوكاني كثيرًا.
4- السيد أحمد بن علي بن محسن بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم: واشتغل بطلب العلم بعد أن قارب الخمسين، ولازم الإمام الشوكاني نحو عشر سنين في الطلب.
5- السيد محمد بن محمد بن هاشم بن يحيى الشامي، ثم الصنعاني.
6- عبدالرحمن بن أحمد البهكلي الضمدي الصبياني: درس على الشوكاني وغيره، ولكنه اختص بالشوكاني اختصاصًا كاملًا، وكان من أولى تلاميذه له، ولي القضاء.
7- أحمد بن عبدالله الضمدي، ولد سنة (1174هـ)، نسبة إلى «ضمد»: أخذ عن الشوكاني وغيره، ولكن صلته به كانت أكثر.
8- علي بن أحمد هاجر الصنعاني.
9- عبدالله بن محسن الحيمي، ثم الصنعاني: درس على الشوكاني واستفاد منه في عدة فنون، ونقل كثيرًا من رسائله.
10- القاضي محمد بن حسن الشجني الذماري.
11- ابنه القاضي أحمد بن محمد الشوكاني، ولد في سنة (1229هـ): وكان له الاشتغال التام بمؤلفات والده، حتى حاز من العلم السهم الوافر، وانتفع به عدة من الأكابر، وتولى القضاء العام بمدينة صنعاء، وله مؤلفات مفيدة، وكان أكبر علماء اليمن بعد والده، توفي سنة (1281هـ).
هذا؛ وتلاميذ الشوكاني أكثر من أن يحصوا، وقد جمع أساتذته وتلاميذه في كتابه «الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام».
وهؤلاء هم تلاميذه المباشرون، أما غير المباشرين فما أكثرهم، ففي اليوم لا تزال مدرسته قائمة إلى اليوم على أقوى ما تكون، ورجالها يضيق عنهم نطاق الحصر، وكلهم على مبدأ الاجتهاد.
± المطلب الثالث: مؤلفاته:
خلّف المصنف $ وراءه تركة عظيمة من المطولات و المختصرات في غالب فروع العلم منها :
1- «شرح المنتقى»: كان تبييضه في أربع مجلدات كبار، أرشده إلى ذلك جماعة من شيوخه؛ كالسيد العلامة عبدالقادر بن أحمد، والعلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، وعرض عليهما بعضًا منه، وماتا قبل تمامه.
2- «حاشية شفاء الأوام» في مجلد.
3- «الدرر البهية» وشرحها «الدراري المضية» في مجلد.
4- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» في مجلد.
5- «الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام»: جعله كالمعجم لشيوخه وتلامذته، وقد ذكر أكابرهم.
6- «بغية الأريب من مغني اللبيب»: نظم ذكر فيه ما تمس الحاجة إليه وشرحها.
7- ونظم «كفاية المتحفظ» ولم يبيض، وكان نظمه لهاتين المنظومتين في أوائل أيام طلبه.
8- «المختصر البديع في الخلق الوسيع»: ذكر فيها خلق السموات والأرض والملائكة والجن والأنس، وسرد غالب ما ورد من الآيات والأحاديث، وتكلم عليها، فصار في مجلد لطيف، ولكنه لم يبيضه.
9- «المختصر الكافي من الجواب الشافي».
10- «طيب النشر في جواب المسائل العشر».
11- «عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد».
12- «الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية».
13- «رسالة في أحكام الاستجمار».
14- «رسالة في أحكام النفاس».
15- «رسالة في كون تطهير الثياب والبدن من شرائط الصلاة أم لا».
16- «رسالة في الكلام على وجوب الصلاة على النبي في الصلاة».
17- «رسالة في صلاة التحية».
18- «القول الصادق في إمامة الفاسق».
19- «رسالة في أسباب سجود السهو».
20- «تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع».
21- «الرسالة المكملة في أدلة البسملة».
22- «إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال».
23- «رسالة في وجوب الصوم على من لم يفطر إذا وقع الإشعار في دخول رمضان في النهار».
24- «رسالة في زيادة ثواب من باشر العبادة مع مشقة».
25- «رسالة في كون أجرة الحج من الثلث».
26- «رسالة في كون الخلع طلاقًا أو فسخًا».
27- «رسالة في حكم الطلاق ثلاثًا».
28- «رسالة في الطلاق البدعي».
29- «رسالة في نفقة المطلقة».
30- «رسالة في كون رضاع الكبير يقتضي التحريم لعذر وفيما يقتضي التحريم من الرضاع».
31- «رسالة في من حلف ليقضين دينه غدًا إن شاء الله».
32- «رسالة في بيع الشيء قبل قبضه».
33- «تنبيه ذوي الحجى في حكم بيع الرجا».
34- «شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل».
35- «رسالة في الهيئة لبعض الأولاد».
36- «رسالة في جواز إستناد الحاكم في حكمه إلى تقويم العدول».
37- «القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر».
38- «البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر».
39- «رسالة في الوصية بالثلث ضرارًا».
40- «رسالة في القيام للواصل لمجرد التعظيم».
41- «رسائل في أحكام لبس الحرير».
42- «رسالة في حكم المخابرة».
43- «إتحاف المهرة بالكلام على حديث لا عدوى ولا طيرة».
44- «رسالة في حكم بيع الماء».
45- «رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبواهم».
46- «رسائل على مسائل من السيد العلامة علي بن إسماعيل».
47- «رسالة في حكم طلاق المكره».
48- إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع».
49- «رسالة في حكم الجهر بالذكر».
50- «عقود الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان».
51- «رسالة على مسائل لبعض علماء الحجاز».
52- «رسالة في الكسوف هل لا يكون إلا في وقت معين على القطع أم ذلك يتخلف».
53- «زهر النسرين الفائح بفضائل العمرين».
54- «حل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال».
55- «الإبطال لدعوى الاختلال في حل الإشكال».
56- «تفويق النبال إلى إرسال المقال».
57- «رسالة في مسائل وقع الاختلاف فيها بين علماء كوكبان».
58- «رسالة في لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات».
59- «التشكيك على التفكيك لعقود التشكيك».
60- «إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي».
61- «رفع الجناح عن نافي المباح».
62- «البغية في مسئلة الرؤية».
63- «رسالة في حكم المولد».
64- «القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول».
65- «أمنية المتشوق في تحقيق حكم المنطق».
66- «إرشاد المستفيد إلى رفع كلام ابن دقيق العيد في الإطلاق والتقليد».
67- «الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد».
68- «البحث الملم بقوله تعالى إلا من ظلم».
69- «جواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل».
70- «وبل الغمامة في تفسير وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة».
71- «تحرير الدلائل فيما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والاحتفاظ والبعد والحائل».
72- «فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير».
73- «إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر».
74- «تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام
75- «رفع الخصام في الحكم بالعلم من الأحكام».
76- «الدر النضيد في إخلاص التوحيد».
77- «إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات».
78- «دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات».
79- «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح».
80- «الأبحاث الوضية في الكلام على حديث حب الدنيا رأس كل خطية».
81- «إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين».
82- «القول الجلي في لبس النساء الحلي».
83- «الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة».
84- «القول المفيد في حكم التقليد».
85- «الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم».
86- «إرشاد السائل إلى دلائل المسائل».
87- كشف الرين عن حديث ذي اليدين».
88- «هداية القاضي إلى نجوم الأراضي».
89- «إيضاح القول في إثبات العول».
90- «اللمعة في الاعتداد بركعة من الجمعة».
91- «أدب الطلب ومنتهى الأرب».
ثم قال $: وقد يعقب هذه المصنفات مصنفات كثيرة يطول تعدادها، وهو الآن يجمع تفسيرًا لكتاب الله، جامعًا بين الدارية والرواية «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير»، ويرجو الله أن يعين على تمامه بمنه وفضله، ثم منَّ الله - وله الحمد - بتمامه في أربعة مجلدات كبار.
وشرع في كتاب في أصول الفقه سماه «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»، وهو الآن في عمله، أعان الله على تمامه، ثم تم ذلك بحمد الله في مجلد.
وقد جمع من رسائله ثلاث مجلدات كبار، ثم لحق بعد ذلك قدر مجلد، وسمى الجميع «الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني»، وجميع ذلك رسائل مستقلة وأبحاث مطوله. وأما الفتاوى المختصرة فلا تنحصر أبدًا.
وهو الآن يشتغل بتصنيف الحاشية التى جعلها على الأزهار، وقد بلغ فيها إلى كتاب الجنايات، وسماها «السيل الجرار على حدائق الأزهار»، وهي مشتملة على تقرير ما دل عليه الدليل، ودفع ما خالفه، والتعرض لما ينبغي التعرض له، والاعتراض عليه من شرح الجلال وحاشيته، وهذا الكتاب إن أعان الله على تمامه، فسيعرف قدره من يعترف بالفضائل، وما وهب الله لعباده من الخير.
هذه ما أمكن خطوره بالبال حال تحرير هذه الترجمة، ولعل ما لم يذكر أكثر مما ذكر.
وقد كان جميع ما تقدم - من القراءة على شيوخه في تلك الفنون، وقراءة تلامذته لها عليه مع غيرها، وتصنيف بعض ما تقدم تحريره - قبل أن يبلغ صاحب الترجمة أربعين سنة، بل درس في شرحه للمنتقى قبل ذلك، وترك التقليد، واجتهد رأيه اجتهادًا مطلقًا غير مقيد، وهو قبل الثلاثين.
% % %
 |
|||
|
|||

المبحث الأول
توثيق الكتاب
± المطلب الأول: عنوان الكتاب:
جاء في النسخة الخطية الأصل، والتي بخط المؤلف: «وَلم يسْتَوْف شرَّاح الحَدِيث - رَحِمهم الله - مَا يسْتَحقّهُ هَذَا الحَدِيث من الشَّرْح؛ فَإِن ابْن حجر $ لم يشرحه فِي «فتح الْبَارِي»([2]) إِلَّا بِنَحْوِ ثَلَاث ورقات ، مَعَ أن شَرحه أكمل شروح البُخَارِيّ، وأكثرها تَحْقِيقًا، وأعمها نفعًا... وسميته «قطر الولي على حديث الولي».
± المطلب الثاني: نسبته إلى المؤلف:
لا شك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه الإمام الشوكاني، فقد وقفنا على نسخة خطية له بخط المؤلف، كما ذكر المؤلف في ثنايا كتابه هذا عدة من مصنفاته الأخرى، وذكره صاحب كتاب «مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» ضمن مؤلفات الإمام الشوكاني $.
± المطلب الثالث: تاريخ تأليف الكتاب:
جاء في آخر النسخة الخطية الأصل، والتي بخط المؤلف: «وَإلَى هُنَا انْتهى الشَّرْح للْحَدِيث الْقُدسِي، فِي نَهَار الِاثْنَيْنِ، لعله سَابِع شهر الْقعدَة، من شهور سنة (1239هـ)، بقلم مُؤَلفه مُحَمَّد بن عَليّ الشَّوْكَانِيّ غفر الله لَهما».
% % %
المبحث الثاني
أهمية الكتاب
إن أهمية الكتاب ترجع إجمالًا إلى فضل ما حواه و عظم ما تضمنه، وذلك أن حديث الولي كشف لنا فيه ربنا تعالى، على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم عن صفات فئة من المؤمنين، يوالي الله تعالى من والاهم، وينصر من نصرهم، ويحارب من حاربهم. يتقربون إليه بالواجبات قبل النوافل؛ لعلمهم أن أداء الفرائض أحب إليه من أداء النوافل، ثم كمّلوا متممات هذا المقام بفعل ما يحبه الله تعالى من أنواع القربات، حتى رقوا بذلك منزلة المحبة، التي لم يصل إليها إلا الأنبياء المرسلون، والملائكة المقربون، فسمع الله تعالى دعاءهم، وأجاب غوثهم، بل تردد سبحانه عن قبض نفس عبده الولي؛ لعلمه تعالى أنه يكره الموت، وهو يكره إساءت عبده، ولكن لابد له منه. فوالله إنه لميدانٌ حُق أن يتنافس فيه المتنافسون ويشمر له المشمرون.
ثم إنه بالنظر إليه من جهة أخرى: نجد أنه أوسع شرح لحديث الولي، مع أن الحديث كثر شُرّاحه، كما سبق بيانه. وقد تضمن الكتاب عدة مسائل في العقيدة، والأصول، والحديث، وإن كان بعضها لا يخلو من مقال، ويفتقر إلى تدقيق وتحقيق، إلا إنه يدل على سعة علم المصنف $.
% % %

 |
|||
|
|||

المبحث الأول
معنى الولاية لغةً
قال الجوهري في «الصحاح»([3]): « ولى»: الولي: القرب والدنو. يقال: تباعد بعد ولى. و«كل مما يليك»؛ أي: مما يقاربك. وقال:
|
هجرت غضوب وحبَّ من يتجنّب |
|
وعدت
عواد دون وليك تشعب
|
يقال منه: وليه يليه بالكسر فيهما، وهو شاذ. وأوليته الشئ فوليه. وكذلك ولي الوالي البلد، وولي الرجل البيع، ولاية فيهما. وأوليته معروفًا. ويقال في التعجب: ما أولاه للمعروف، وهو شاذ. وتقول: فلان وَلي ووُلي عليه، كما يقال: ساس وسيس عليه. وولاه الأمير عمل كذا، وولاه بيع الشيء. وتولى العمل؛ أي: تقلد. وتولى عنه؛ أي: أعرض. وولى هاربًا؛ أي: أدبر. وقوله تعالى: ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [البقرة: 148]؛ أي: مستقبلها بوجهه. والولى: المطر بعد الوسمي، سمي وليًّا؛ لأنه يلى الوسمي. وكذلك الولى بالتسكين على فعل وفعيل، والجمع أولية. يقال منه: وليت الأرض وليًّا.
ثم قال: والولي: ضد العدو. يقال منه: تولاه. والمولى: المعتِق، والمعتَق، وابن العم، والناصر، والجار. والولي: الصهر، وكل من ولي أمر واحد، فهو وليه. وقول الشاعر:
|
هم
المولى وإن جنفوا علينا |
|
وإنا
من لقائهم لزور |
قال أبو عبيدة: يعني الموالي؛ أي: بني العم. وهو كقوله تعالى: ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [غافر: 67].
وأما قول لبيد:
|
فغدت،
كلا الفرجين تحسب أنه |
|
مولى
المخافة خلفها وأمامها |
فيريد أنه أولى موضع أن تكون فيه الحرب. وقوله: فغدت، تم الكلام، كأنه قال: فغدت هذه البقرة، وقطع الكلام، ثم ابتدأ كأنه قال: تحسب أن كلا الفرجين مولى المخافة. والمولى: الحليف. وقال:
|
موالى
حلف لا موالى قرابة |
|
ولكن
قطينًا يسألون الأتاويا |
يقول: هم حلفاء، لا أبناء عم.
وقول الفرزدق:
|
فلو
كان عبد الله مولى هجوته |
|
ولكن
عبد الله مولى مواليا
|
لأن عبدالله بن أبي إسحاق مولى الحضرميين، وهم حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف، والحليف عند العرب مولى. وإنما قال مواليا فنصبه؛ لأنه رده إلى أصله للضرورة، وإنما لم ينون؛ لأنه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف.
والنسبة إلى المولى: مولوي، وإلى الولي من المطر: ولوي، كما قالوا علوي؛ لأنهم كرهوا الجمع بين أربع ياءات، فحذفوا الياء الأولى، وقلبوا الثانية واوًا. ويقال: بينهما ولاء بالفتح؛ أي: قرابة.
والولاء: ولاء المعتق. وفي الحديث: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته». والولاء: الموالون. يقال: هم ولاء فلان. والموالاة: ضد المعاداة. ويقال: والى بينهما ولاء؛ أي: تابع. وافعل هذه الأشياء على الولاء؛ أي: متتابعة. وتوالى عليه شهران؛ أي: تتابع. واستولى على الأمد؛ أي: بلغ الغاية. والولاية بالكسر: السلطان.
والوَلاية والوِلاية: النصرة. يقال: هم على ولاية؛ أي: مجتمعون في النصرة.
وقال سيبويه: الولاية بالفتح المصدر، والولاية بالكسر الاسم، مثل الإمارة والنقابة؛ لأنه اسم لما توليته وقمت به. فإذا أرادوا المصدر فتحوا. انتهى.
قال صاحب «تاج العروس»([4]): الولي في أسماء الله تعالى: هو الناصر، وقيل: المتولي لأمور العالم القائم بها. وأيضًا الوالي: وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها.
قال ابن الأثير: وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيه، لم ينطلق عليه اسم الْوَالِي([5]).
ابن سيده: ولي الشيء، وولي عليه، ولاية وولاية، وقيل: الولاية الخطة كالإمارة، والولاية :المصدرُ([6]).
* الفرق بين الولي والمولى:
قال العسكري في «الفروق»([7]): إن الولي يجري في الصفة على المعان والمعين، تقول: الله ولي المؤمنين؛ أي: معينهم، والمؤمن ولي الله؛ أي: المعان بنصر الله عز وجل، ويقال أيضًا: المؤمن ولي الله، والمراد: أنه ناصر لأوليائه ودينه، ويجوز أن يقال: الله ولي المؤمنين، بمعنى: أنه يلي حفظهم وكلاءتهم، كولي الطفل، المتولي شأنه، ويكون الولي على وجوه؛ منها: ولي المسلم الذي يلزمه القيام بحقه إذا احتاج إليه، ومنها: الولي الحليف المعاقد، ومنها: ولي المرأة القائم بأمرها، ومنها: ولي المقتول الذي هو أحق بالمطالبة بدمه.
وأصل الولي: جعل الثاني بعد الأول من غير فصل، من قولهم: هذا يلي ذلك وليًّا، وولاه الله؛ كأنه يلي أمره، ولم يكله إلى غيره، وولاه أمره وكله إليه، كأنه جعله بيده، وتولى أمر نفسه، قام به من غير وسيطة، وولى عنه خلاف والى إليه، ووالى بين رميتين، جعل إحداهما تلي الأخرى، والأولى هو الذي الحكمة إليه أدعى، ويجوز أن يقال: معنى الولي: أنه يحب الخير لوليه، كما أن معنى العدو أنه يريد الضرر لعدوه.
والمولى على وجوه: هو السيد، والمملوك، والحليف، وابن العم، والأولى بالشيء، والصاحب، ومنه قول الشاعر:
|
ولست
بمولى سوأة أدعى لها |
|
فإن
لسوآت الأمور مواليا |
أي: صاحب سوأة، وتقول: الله مولى المؤمنين؛ بمعنى: أنه معينهم، ولا يقال: إنهم مواليه؛ بمعنى أنهم معينوا أوليائه، كما تقول: إنهم أولياؤه بهذا المعنى. انتهى.
قَالَ ابْنُ الأَثير([8]): وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب، والمالك، والسيد، والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف، والعقيد، والصهر، والعبد، والمعتق، والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. وكل من ولي أمرًا أو قام به، فهو مولاه ووليه. وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والمعتق. والولاية بالكسر في الإمارة. والولاء المعتق، والموالاة من والى القوم. ومنه الحديث «من كنت مولاه فعلي مولاه»([9]).
قال أبو العباس: أي: من أحبني وتولاني، فليتوله. وقال ابن الأعرابي: الولي: التابع المحب. قال الشافعي ﭬ: يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله تعالى: ﴿ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾([10]). انتهى.
% % %
المبحث الثاني
مفهوم ولاية الله تعالى في الشرع
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي $: قوله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [يونس:62]، فبين أنه ولي المؤمنين، وأن المؤمنين أولياؤه. والولي: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به. فالإيمان سبب يوالي به المؤمنين ربهم بالطاعة، ويواليهم به الثواب والنصر والإعانة. وبين في مواضع أخر: أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كقوله: ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [المائدة:55]، وقوله: ﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [التوبة:71]، وبين في مواضع أخر: أن نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو قوله تعالى: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [الأحزاب:6].
وبين في مواضع أخر: أنه تعالى مولى المؤمنين دون الكافرين، وهو قوله تعالى: ﴿ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [محمد:11]، وهذه الولاية المختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق والإعانة، فلا تنافي أنه مولى الكافرين ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة، كقوله: ﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الأنعام:62].
وقال بعض العلماء: الضمير في قوله: ﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [الكهف:26]، راجع لأهل السموات والأرض المفهومين من قوله تعالى: ﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾. وقيل: الضمير في قوله: ﴿ﯮ ﯯ﴾ راجع لمعاصري النبي ﷺ من الكفار. ذكره القرطبي. وعلى كل حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم جل وعلا، وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة، وولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة. والعلم عند الله تعالى([11]). ا هـ.
و قد جمع الشيخ علي بن نايف الشحود في كتابه القيم «الخلاصة في شرح حديث الولي» فوائد جيدة في الباب وقريبة من المراد، فقال:
ذكر ابن القيم أن ولاية الله تعالى نوعان : عامة، وخاصة.
فأما الولاية العامة: فهي ولاية كل مؤمن، فمن كان مؤمنًا، لله تقيًّا، كان الله له وليًّا، وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقواه.
يدل على هذا قوله تعالى: ﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [آل عمران: 68]، وقوله سبحانه: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾([12]) [البقرة: 257].
قال ابن تيمية في هذا النوع من الولاية: فالظالم لنفسه من أهل الإيمان، معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول جميع أصحاب رسول الله ﷺ وأئمة الإسلام وأهل السنة([13]).
وأما الولاية الخاصة: فهي القيام لله بجميع حقوقه، وإيثاره على كل ما سواه في جميع الأحوال، حتى تصير مراضي الله ومحابه هي همه ومتعلق خواطره، يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه، وإن سخط الخلق([14]).
يقول الشوكاني في هذا النوع من الولاية: الولي في اللغة: القريب، والمراد بأولياء الله: خلص المؤمنين؛ لأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته([15]).
وقد تنوعت تعريفات العلماء لهذه الولاية، فقال الغنيمي الميداني: الأولياء جمع ولي، بوزن فعيل، بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، أو بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم.
قال ابن عبدالسلام: وكونه بمعنى فاعل أرجح؛ لأن الإنسان لا يمدح إلا على فعل نفسه، وقد مدحهم الله تعالى.
فعلى الأول: يكون الولي من تولى الله تعالى رعايته وحفظه، فلا يكله إلى نفسه، كما قال سبحانه: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [الأعراف: 196].
وعلى الثاني: يكون الولي من تولى عبادة الله وطاعته، فهو يأتي بها على التوالي، آناء الليل وأطراف النهار، ويجنح إلى هذا ما عرفه به السعد في «شرح العقائد» حيث قال: هو العارف بالله حسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك باللذات والشهوات([16]).
وكذا تعريف الهيتمي للأولياء بأنهم: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، بجمعهم بين العلم والعمل، وسلامتهم من الهفوات والزلل([17]).
ولا يخفي أن سلامتهم من الهفوات والزلل لا تعني العصمة، إذ لا عصمة إلا لنبي، ولكن - كما قال ابن عابدين -: على معنى أن الله يحفظ الولي من تماديه في الزلل والخطأ إن وقع فيهما، بأن يلهمه التوبة، فيتوب منهما، وإلا فهما لا يقدحان في ولايته([18]).
% % %
المبحث الثالث
الفرق بين مقام النبوة ومقام الولاية
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية $: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به؛ بخلاف الأولياء، فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به، ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به؛ بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودًا، وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهدًا معذورًا فيما قاله، له أجر على اجتهاده.
لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئًا، وكان من الخطإ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [التغابن: 16]، وهذا تفسير قوله تعالى ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [آل عمران: 102].
قال ابن مسعود وغيره: ﴿ﭩ ﭪ﴾؛ أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر؛ أي: بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، كما قال تعالى: ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [البقرة: 286]، وقال تعالى: ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [الأعراف: 42]، وقال تعالى: ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [الأنعام: 152].
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع، كقوله تعالى: ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [البقرة: 136]، وقال تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [البقرة: 1- 5]، وقال تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [البقرة: 177].
وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم؛ بل إما أن يكون كافرًا، وإما أن يكون مفرطًا في الجهل.
وهذا كثير في كلام المشايخ؛ كقول الشيخ أبي سليمان الداراني: إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين؛ الكتاب والسنة.
وقال أبو القاسم الجنيد $: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن، ويكتب الحديث، لا يصلح له أن يتكلم في علمنا، أو قال: لا يقتدى به.
وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولًا وفعلًا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولًا وفعلًا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم: ﴿ﭡ ﭢ ﭣ﴾([19]). ا هـ.
% % %
المبحث الرابع
مقام النبوة أفضل من مقام الولاية
إن مقام الولاية تبع لمقام النبوة، فلا يكون الولي وليًّا لله تعالى حتى يعتقد أن النبي أفضل منه ومن البشر أجمعين، ومن ظن غير ذلك فقد فتح على نفسه بابا من الزندقة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية $: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى، على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: ﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [النساء: 69]، وفي الحديث: « ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر»([20])، وأفضل الأمم أمة محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [آل عمران: 110]، وقال تعالى: ﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾([21]) [فاطر: 32].
قال القشيري: رتبة الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ للإجماع المنعقد على ذلك([22]).
وقد خرج علىنا من بعض غلاة المتصوفة من جوز أن يكون الولي أفضل من النبي، فسبحان مانح العقول وسالبها، كيف نعتقد أن يجعل الله تعالى النبي المصطفي، والمختار سببًا في هداية الناس، ثم نحكم على فئة من هؤلاء الناس يكون أفضل من هذا النبي. وقد اشتهرت هذه المقالة عن الحكيم الترمذي.
قال الذهبي $ في «السير»: قال أبو عبدالرحمن السلمي: أخرجوا الحكيم من ترمذ، وشهدوا عليه بالكفر، وذلك بسبب تصنيفه كتاب «ختم الولاية»، وكتاب «علل الشريعة»، وقالوا: إنه يقول: إن للأولياء خاتمًا كالأنبياء لهم خاتم، وإنه يفضل الولاية على النبوة، واحتج بحديث: «يغبطهم النبيون والشهداء»([23]).ا هـ.
وممن قال بهذه الزندقة البواح أيضًا: إبراهيم الدسوقي، ويزيد البسطامي، وابن عربي، وغيرهم([24]).
وقال
الشهرستاني في «الملل والنحل»: ادعت طائفة من الصوفية: أن في أولياء الله تعالى من
هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل، وقالوا: من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت
عنه الشرائع كلها؛ من الصلاة، والصيام، والزكاة، وغير ذلك، وحلت له المحرمات كلها؛
من الزنا، والخمر، وغير ذلك، واستباحوا بذلك
نساء غيرهم([25]).
فنعوذ بالله تعالى من ران يحيط بالقلوب، ومن سفه يخمر العقول.
% % %
المبحث الخامس
ضابط التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
قال شيخ الإسلام ابن تيمية $ في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص: 2): فصل: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، كما فرق الله ورسوله بينهما، فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [يونس:62، 63].
وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، عن أبي هريرة ﭬ عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة - أو فقد آذنته بالحرب - وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها - وفي رواية: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي - ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه». وهذا أصح حديث يروى في الأولياء.
فبين النبي ﷺ أنه من عادى وليًّا لله، فقد بارز الله في المحاربة. وفي حديث آخر: «وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب»؛ أي: آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره، وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب، وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع، كما في الترمذي وغيره، عن النبي ﷺ أنه قال: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله»، وفي حديث آخر رواه أبو داود وقال: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان». انتهى.
و قال $ في «مجموع الفتاوى» (11/214): «... بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء، أو مشى على الماء، لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله ﷺ، وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليًّا لله، فقد يكون عدوًا لله؛ فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار، والمشركين، وأهل الكتاب، والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم، وأفعالهم، وأحوالهم، التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان، والقرآن، وبحقائق الإيمان الباطنة، وشرائع الإسلام الظاهرة». انتهى.
وقال ابن القيم $ في «كتاب الروح» (ص: 359): «... ما يتلبس به العبد من قول وفعل وحال، فإن كان وفق ما يحبه الله ويرضاه في الأمور الباطنة التي في القلوب، وفي الأعمال الظاهرة التي على الجوارح، كان صاحبه من أولياء الله، وإن كان معرضًا في ذلك عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه و سلم، مخالفًا لهما إلى غيره، فهو من أولياء الشيطان.
ثم قال: فإن اشتبه عليك، فاكشفه في ثلاثة مواطن؛ في صلاته، ومحبته للسنة وأهلها أو نفرته عنهم، ودعوته إلى الله ورسوله، وتجريد التوحيد، والمتابعة وتحكيم السنة، فزنه بذلك، ولا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الماء، وطار في الهواء».
% % %
المبحث السادس
كرامات الأولياء
قال الشيخ علي الشحود في «الخلاصة»: الكرامات جمع كرامة، وهي في اللغة: الشرف، من الكرم: الذي يعني شرف الشيء في نفسه أو في خلق من الأخلاق، أو الإكرام: الذي هو إيصال نفع إلى الإنسان، لا يلحقه فيه غضاضة، أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئًا كريمًا؛ أي: شريفًا([26]).
أما في الاصطلاح الشرعي، فقد عرف ابن عابدين الكرامة بأنها: ظهور أمر خارق للعادة، على يد عبد ظاهر الصلاح، ملتزم لمتابعة نبي من الأنبياء، مقترنًا بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، غير مقارن لدعوى النبوة([27]).
فامتازت الكرامة بعدم الاقتران بدعوى النبوة عن المعجزة، وبكونها على يد ظاهر الصلاح، وهو الولي، عما يسمونه معونة، وهي الخارق الظاهر على أيدي عوام المؤمنين، تخلصًا لهم من المحن والمكاره، وبمقارنة صحيح الاعتقاد والعمل الصالح عن الاستدراج، وبمتابعة نبي قبله عن خوارق مدعي النبوة المؤكدة لكذبه المعروفة بالإهانة؛ كبصق مسيلمة في بئر عذبة الماء ليزداد ماؤها حلاوة، فصار ملحًا أجاجًا([28]).
وقد ذهب أهل السنة والجماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم - خلافًا للمعتزلة ومن وافقهم - إلى أن ظهور الكرامة على الأولياء جائز عقلًا؛ لأنها من جملة الممكنات، وأنها واقعة نقلًا مفيدًا لليقين من جهة مجيء القرآن بها، ووقوع التواتر عليها قرنًا بعد قرن، وجيلًا بعد جيل، وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز([29]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية $: وكرامات الأولياء حق باتفاق أهل الإسلام والسنة والجماعة، وقد دل عليها القرآن في غير موضع، والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم، ولكن كثيرًا ممن يدعيها أو تُدَّعى له يكون كذابًا أو ملبوسًا عليه([30]).
% % %
المبحث السابع
الفرق بين الكرامة والمعجزة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية $ في «النبوات» (1/40، 41): النبوة هي أصل المعجزة، والولاية هي أصل الكرامة، فلا تحصل المعجزة الخارقة للعادة - التي هي أصل الكرامة في الجنس - إلا مع النبوة الصادقة، كما أنّ الكرامة الخارقة للعادة لا تحصل للولي إلا بمتابعته لشرع نبيّه.
فالمعجزة إذن دليلٌ على النبوة الصادقة، والكرامة دليلٌ على صدق الشاهد بالنبوة الصادقة، وجامعهما: آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة، فهما من جنس واحدٍ.
ولكن لا يلزم من هذا أن تكون المعجزة والكرامة متساويتين في الحدّ والحقيقة؛ فآيات الله لا يُحاط بها علمًا، كما أنه - جلّ وعلا - لا يُحيطون به علمًا إلا بما شاء سبحانه وتعالى.
ومن آيات الله تعالى ما هي آيات كبرى، ومنها ما هي آيات صغرى، فالآيات الكبرى لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، وهي التي وجب على الناس الإيمان بمقتضاها، وهي التي يُطلق عليها اسم المعجزات. والآيات الصغرى لا تصل إلى درجة سابقتها، ولا تبلغ مبلغها في الحدّ ولا في الحقيقة، وهي التي يُطلق عليها اسم الكرامات.
ولما كانت الآيات الكبرى والصغرى من جنس واحد، وكان من خواصهما خرق العادة، كان من الواجب أن يكون خرق العادة فيهما مخالفٌ لسنن الطبيعة، وخواص المادة، وقانون الأسباب والمسبّبات، لا سيما في المعجزات التي هي الدلائل اليقينيّة على صدق الرسل؛ فإنّ رتبة الرسالة ذات شأن عظيم؛ إذ هي الواسطة بين الخالق والمخلوق، والعابد والمعبود، وعليها تترتب سعادة المصدّقين، وشقاوة المكذّبين في كلتا الدارين. انتهى.
وقد ضلّ الأشاعرة في هذه المسألة، فقالوا: إن كرامة الولي تساوي آية النبي، ولكن الفرق بينهما: أن الولي لا يدعي النبوة، والنبي يقول هو مرسل من عند الله جل وعلا.
قال الشيخ الشحود في «الخلاصة»:
أما وجوه التفرقة بين الكرامة والمعجزة، فهي:
أولًا: أن المعجزة تقترن بالتحدي، وهو طلب المعارضة والمقابلة، يقال: تحديت فلانًا، إذا باريته في فعل، ونازعته للغلبة، أما الكرامة فلا تقترن بذلك.
ولا شك أن كل ما وقع منه ﷺ بعد النبوة من معجزات؛ كنطق الحصى، وحنين الجذع، ونبع الماء من بين أصابعه ﷺ مقرون بالتحدي؛ لأن قرائن أقواله وأحواله ناطقة بدعواه النبوة، وتحديه للمخالفين، وإظهاره ما يقمعهم ويقطعهم، فكان كل ما ظهر منه ﷺ يسمى آيات ومعجزات؛ ولأن المراد من اقترانها بالتحدي الاقتران بالقوة أو الفعل([31]).
ثانيًا: أن الأنبياء مأمورون بإظهار معجزاتهم؛ لحاجة الناس إلى معرفة صدقهم واتباعهم، ولا يعرف النبي إلا بمعجز. أما الكرامة فلا يجب على الولي إظهارها، بل يستر كرامته ويسرها ويجتهد على إخفاء أمره([32]).
ثالثًا: أن دلالة المعجزة على النبوة قطعية، وأن النبي يعلم أنه نبي، بينما دلالة الكرامة على الولاية ظنية، ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت على يديه أنه ولي، ولا غيره يعلم ذلك، لاحتمال أن يكون ممكورًا به([33]).
قال القاضي أبو يعلى: والدلالة عليه أن العلم بأن الواحد منا ولي لله ۵ لا يصح إلا بعد العلم والقطع على أنه لا يموت إلا مؤمنًا، فإذا لم يعلم ذلك لم يمكنا أن نقطع على أنه ولي لله؛ لأن الولي من علم الله أنه لا يوافي إلا بالإيمان، ولما اتفق على أنه لا يمكننا أن نقطع عنه أنه لا يوافي إلا بالإيمان، علم أن الفعل الخارق للعادة لا يدل على ولايته([34]).
ويتفرع على ذلك: أن المعجزة تدل على عصمة صاحبها وعلى وجوب اتباعه، أما الكرامة فلا تدل على عصمة من ظهرت عليه، ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقول، ولا على ولايته؛ لجواز سلبها أو أن تكون استدراجًا له([35]).
رابعًا: أن الكرامة لا يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمها؛ كإحياء الموتى، وانفلاق البحر، وقلب العصا حية، وخروج الماء من بين الأصابع، وبذلك قال بعض الحنفية وبعض الشافعية.
وقال بعض المحققين من علماء المذهبين وغيرهم: كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، غير أن المعجزة تقترن بدعوى النبوة، والكرامة لا تقترن بذلك، بل إن الولي لو ادعى النبوة صار عدوًا لله، لا يستحق الكرامة، بل اللعنة والإهانة([36]).
% % %

|
||||
|
||||

المبحث الأول
من رواية أبي هريرة
وهو الذي اعتمده المصنف في كتابه، أخرجه البخاري (4/231)، وأبو نعيم في «الحلية» (1/4)، والبغوي في «شرح السنة» (1/142/2)، وابن حبان (347)، وأبو القاسم المهرواني في «الفوائد المنتخبة الصحاح» (2/3/1)، وابن الحمامي الصوفي في «منتخب من مسموعاته» (1/171)، وصححه ثلاثتهم، ورزق الله الحنبلي في «أحاديث من مسموعاته» (1/2-2/1)، ويوسف بن الحسن النابلسي في «الأحاديث الستة العراقية» (1/26)، والبيهقي في «الزهد» (2/83)، وفي «الأسماء والصفات» (ص: 491)، وفي «السنن الكبرى» (6188، 20769)، وفي «الأربعون الصغرى» (24)، وعبدالرزاق في «المصنف» (20301) مرسلًا عن الحسن البصري، وابن طاهر القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (4/1463)، وأبو يعلى الحنبلي في «طبقات الحنابلة» (2/250)، والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (9/316)، والمزي في «تهذيب الكمال» (26/97).
كلهم من طريق خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال: حدثني شريك ابن عبدالله بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ... فذكره.
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (1/641) في ترجمة خالد بن مخلد هذا - وهو القطواني - بعد أن ذكر اختلاف العلماء في توثيقه وتضعيفه، وساق له أحاديث تفرد بها هذا منها:
فهذا حديث غريب جدًّا، ولولا هيبة الجامع الصحيح لعددته في منكرات خالد ابن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا أخرجه من عدا البخاري، ولا أظنه في «مسند أحمد»، وقد اختلف في عطاء، فقيل: هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء ابن يسار. انتهى.
ونقل كلامه هذا مختصرًا الحافظ في «الفتح» (11/292، 293)، ثم قال: ليس هو في «مسند أحمد» جزمًا، وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضًا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص، وقدم وأخر، وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها، ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلًا. انتهى.
وانتقاد بعض المتأخرين لإسناد الحديث بحجة أن فيه راويين قد تُكلم فيهما، وهما: خالد بن مخلد، وشريك بن عبدالله ، هو ظلم واضح وتعد صريح، وسَقَطٌ من القول، ولو علموا طريقة الإمام البخاري ومذهبه لاستحيوا من أنفسهم، فكلامهم فيه لا يضره و لا يحط من منزلته، و لو كان هذا الحديث خارج الصحيح لبطلت حجتهم، ولذاب دليلهم، فكيف وهو في الصحيح؟!! وهاك بيانه من وجوه:
الوجه الأول : بطلان نقد الحديث بسبب خالد بن مخلد:
أولًا : يقول ابن حجر $ في «هدي الساري» (ص: 398) في رده لكلام من رد رواية خالد في الصحيح: أما التشيع، فقد قدمنا أنه إذا كان ثَبْتَ الأخذ والأداء لا يضر، لا سيما ولم يكن داعية إلى رأي، وأما المناكير: فقد تتبعها أبو أحمد ابن عدي من حديثه، وأوردها في «كامله»، وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة: «من عادى لي وليًّا...» الحديث، وروى له الباقون سوى أبي داود.
قلت: قد نقل ابن حجر عن ابن عدي أنه قال - بعد أن ساق له أحاديث، وهي عشرة حسب ما ذكر الذهَبِيّ - قال ابن عدي بعدها: لم أجد في حديثه أنكر مما ذكرته، ولعلها توهم منه، أو حملًا على حفظه. فتأمل هذا.
بالإضافة إلى قول ابن عدي أيضًا: هو من المكثرين، وهو عندي إن شاء الله لا بأس به. ينظر: «من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق أو صالح الحديث» للذهبي (ص: 121).
ثانيًا: أن إخراج البخاري لهذا الحديث نص منه على أنه ليس من مناكير خالد، و أنه موافق لشرطه في انتقاء ما صح سنده.
ثالثًا: أن العلماء أثنوا على رواية خالد عن سليمان بن بلال، فقد أثنى الغلابي على حديثه عن سليمان بن بلال.
قال ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» (2/775): ذكر الغلابي في «تاريخه»، قال: يؤخذ عنه مشيخة المدينة وسليمان بن بلال فقط. انتهى.
وأما قول أبي حاتم: «لا يحتج به»، فيقابله قول من وثق القطواني مطلقًا، مثل العجلي وصالح جزرة وابن حبان وعثمان بن أبي شيبة، وبعضهم عدله تعديلات منخفضة، وبعضهم ضعفه، وعلى كل حال، فحديثه عن سليمان بن بلال حالة خاصة.
الوجه الثاني: بطلان نقد الحديث بسبب شريك بن عبدالله:
قال الحافظ ابن حجر - في معرض الكلام على حديث شريك في الإسراء والمعراج -: قال أبو الفضل ابن طاهر: تعليل الحديث بتفرد شريك، ودعوى ابن حزم أن الآفة منه، شيء لم يسبق إليه، فإن شريكًا قبله أئمة الجرح والتعديل، ووثقوه، ورووا عنه، وأدخلوا حديثه في تصانيفهم، واحتجوا به.
وروى عبدالله بن أحمد الدورقي، وعثمان الدارمي، وعباس الدوري، عن يحيى بن معين: لا بأس به، وقال ابن عدي: مشهور، من أهل المدينة، حدث عنه مالك، وغيره من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به، إلا أن يروي عنه ضعيف.
قال ابن طاهر: وعلى تقدير تسليم تفرده... لا يقتضي طرح حديثه، فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث، ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور، ولو ترك حديث من وهم في تاريخ؛ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين([37]). قلت (ابن حجر): احتج به الجماعة([38]).
فتبين من خلال هذا صحة إسناد هذا الحديث وثقة رواته بما لا يجعل في النفس أدنى ريبة، وكفي هؤلاء الرواة شرفًا أن كانوا من رجال الشيخين (البخاري ومسلم).
من أجل ذلك: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهنا تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنًا، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرًا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقًا، أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح.
وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة؛ يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه.
قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد، وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف، يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما([39]).
والحديث قد جاء من عدة طرق أخرى غير طريق خالد وشريك، تشهد له، وإن كان هو غنيٌ بنفسه، قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص: 430): وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذ الإسناد مردود... ولكن للحديث طرقًا أخرى يدل مجموعها على أن له أصلًا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث شريف، قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أصح حديث روي في صفة الأولياء([40]).
وللدكتور سعد المرصفي رسالة قيمة تحت عنوان «دفاع عن الحديث القدسي: من عادي لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، في ضوء أصول التحديث... رواية ودراية، ورد الشبهات ودحض المفتريات»، ضمن سلسة قيمة للدفاع عن الحديث النبوي.
الوجه الثالث: ثناء العلماء في صحيح البخاري:
قال العلامة ابن باز $ كما في «مجموع فتاواه» (25/69): «... والذي عليه أهل العلم هو تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول والاحتجاج بها، كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر والحافظ ابن الصلاح وغيرهما، وإذا كان في بعض الرجال المخرج لهم في الصحيحين ضعفٌ، فإن صاحبي الصحيح قد انتقيا من أحاديثهم ما لا بأس به، مثل: إسماعيل بن أبي أويس، ومثل عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وجماعات فيهم ضعف، لكن صاحبي الصحيح انتقيا من أحاديثهم ما لا علة فيه؛ لأنَّ الرجل قد يكون عنده أحاديث كثيرة، فيكون غلط في بعضها أو رواها بعد الاختلاط إن كان ممن اختلط، فتنبه صاحبا الصحيحين لذلك، فلم يرويا عنه إلا ما صحَّ عندهما سلامته». انتهى.
وقال ولي الله الدهلوي $: أما الصحيحان، فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين([41]).
وقال العلامة أحمد بن محمد شاكر $: «الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث. على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه. وأما صحة الحديث في نفسه، فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين، وزعم الزاعمين، أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها، وانقدها على القواعد الدقيقة، التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم عن بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل».
وقال النووي $: «الصحيح أقسام؛ أعلاها: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما»([42]).
وقال الشوكاني $: «واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث؛ لأنهما التزما الصحة, وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول»([43]).
% % %
المبحث الثاني
الحديث من رواية عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وعن أبيها
الحديث روي عن أم المؤمنين من طريقين:
الأول: قال أبو القاسم الطبراني في «المعجم الأوسط» (9352): حدثنا هارون بن كامل، نا سعيد بن أبي مريم، ثنا إبراهيم بن سويد المدني، حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال:
«إن الله يقول: من أهان لي وليًّا، فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي عبد من عبادي بمثل أداء فرائضي، وإن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينيه التي يبصر بهما، وأذنيه التي يسمع بهما، ويده التي يبطش بها، ورجليه التي يمشي بهما، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن موته، وذلك أنه يكره الموت، وأنا أكره مساءته».
وجملة أقوال العلماء في رواية أم المؤمنين عائشة ڤ: أن رجال أسناده كلهم ثقات، لكنها معلولة بجهالة حال هارون بن كامل، وقالوا: ولولا جهالة حاله، لكان الحديث صحيحًا.
ولقد تتبعت مرويات هارون بن كامل في كتب الحديث؛ كالمعاجم الثلاثة للطبراني، وحلية الأولياء، و كتب أبي جعفر الطحاوي، وتاريخ ابن عساكر وغيرها، فجمعت أسماء من روى عنهم، ومن رووا عنه. والذين رووا عنه قيدت تراجمهم من «سير أعلام النبلاء»، فوجتهم كلهم ثقات، وأغلبهم محدثون حفاظ، وتتبعت كذلك كتب التراجم التي قد يذكر فيها هارون بن كامل، فلم أجد ذكره إلا في بعضها, ومن ترجم منهم له اقتصر على اسمه وتاريخ وفاته، وذكر بعض من روى عنهم ورووا عنه. وذكرت فصلًا مختصرًا من كلام الأئمة والعلماء - رحمة الله تعالى عليهم - في مسألة حكم رواية المستور أو مجهول الحال، الذي روى عنه جمع من الثقات، واختلافهم في ذلك، وجمعت ما رواه هارون بن كامل من حديثه، فوجتها قاربت السبعين، ولم أجد فيها ما ينكر عليه.
ولقد عقدت في ذلك بحثا مطولًا - حذفته من هنا اختصارًا - وكانت خلاصته: أن هارون ليس مجهول الحال، وعليه فالحديث من رواية أم المؤمنين صحيح، ولو افترض جهالته، فإنه قد روى عنه جمع من الثقات، ولم يثبت عنه رواية المناكير، وقد صحح جمع من المحققين والمحدثين حديث من هذه حاله.
أم الطريق الثاني، فسنده واهٍ جدًّا.
% % %
المبحث الثالث
من رواية أبي أمامة
أخرجه الطبراني (8/221، رقم 7880) قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا هشام بن عمار، ثنا صدقة بن خالد، ثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال:
«من أهان لي وليًّا فقد بارزني بالعداوة، ابن آدم لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك، ولا يزال عبدي يتحبب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأكون قلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به، وبصره الذي يبصر به، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته، وإذا استنصرني نصرته، وأحب عبادة عبدي إلي النصيحة».
قال الهيثمي (2/248): فيه علي بن يزيد، وهو ضعيف، وهو عند البيهقي في «الزهد» (696) من طريق ابن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عنه. وكذلك رواه السلمي في «الأربعين الصوفية» (9/1).
وهذا الإسناد يضعفه ابن حبان جدًّا، ويقول في مثله: إنه من وضع أحد هؤلاء الثلاثة الذين دون أبي أمامة، لكن أخرجه أبو نعيم في «الطب» (ق11/1- نسخة الشيخ السفرجلاني) من طريق عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، به نحوه.
وعثمان هذا، قال الحافظ في «التقريب»: ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1872): وسألت أبي عن حديث؛ رواه هشام - يعني: ابن عمار، عن صدقة بن خالد، قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ، أنه كان يقول: «إن الله تعالى يقول: من أهان لي وليًّا...»، فقال: هذا حديث منكر جدًّا.
% % %
المبحث الرابع
من رواية علي بن أبي طالب رضى الله عنه
ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (2/332)، ونسبه للإسماعيلي في «مسند علي»، وقال: إسناده ضعيف.
% % %
المبحث الخامس
من رواية ابن عباس رضى الله عنهما
أخرجه الطبراني في «الكبير» (12719) قال:
حدثنا عبيد بن كثير التمار، ثنا محمد بن الجنيد، ثنا عياض بن سعيد الثمالي، عن عيسى بن مسلم القرشي، عن عمرو بن عبدالله بن هند الجملي،
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد ناصبني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعلة كترددي عن موت المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، وربما سألني وليي المؤمن الغنى فأصرفه من الغنى إلى الفقر، ولو صرفته إلى الغنى لكان شرًّا له، وربما سألني وليي المؤمن الفقر فأصرفه إلى الغنى، ولو صرفته إلى الفقر لكان شرًّا له، إن الله ۵ قال: وعزتي وجلالي وعلوي وبهائي وجمالي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلا أثبت أجله عند بصره، وضمنت السماء والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر».
ورواه الإمام أحمد في «الزهد» مختصرًا (ص: 61)، وأبونعيم في «الحلية» (1/10) موقوفًا على ابن عباس في باب: أخبار موسى ڠ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، عن عبدالله بن أحمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا إبراهيم ابن عيينة، عن ورقاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس... به، وسندهما ضعيف، فقد ضعفه الحافظ كما تقدم، وبين علته الهيثمي، فقال (10/270): رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.
قال الألباني $: وإسناده أسوأ من ذلك، وفي متنه زيادة منكرة، وكذلك أوردته في «الضعيفة» (5396).
% % %
المبحث السادس
من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه
قال الطبراني في «الأوسط» (609): حدثنا أحمد، قال: حدثنا عمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي، قال: حدثنا صدقة بن عبدالله أبو معاوية، أخبرني عبدالكريم الجزري، عن أنس بن مالك، عن النبي ، صلى الله عليه و سلم عن جبريل، عن الله تعالى: «من أهان لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة». لم يرو هذا الحديث عن عبدالكريم إلا صدقة، تفرد به عمر. انتهى.
وحديث أنس ﭬ له طريقان:
الأول: طريق عمر بن سعيد أبي حفص الدمشقي، قال حدثنا صدقة بن عبدالله أبو معاوية، أخبرني عبدالكريم الجزري، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، عن جبريل، عن الله تعالى: «من أهان لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة». قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبدالكريم إلا صدقة، تفرد به عمر.
الثاني: طريق صدقة بن عبدالرحمن، عن هشام، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن الله تبارك وتعالى قال: «من أهان لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة، ما ترددت في شيء أنا فاعله مثل ترددي في قبض المؤمن، يكره الموت وأكره مماته ولا بد منه، وما تقرب إلي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي المؤمن يتقرب إلي بالتوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ومؤيدًا، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصح إيمانه إلا بالسقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصح إيمانه إلا بالصحة، ولو أسقمهم لأفسده ذلك».
رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء» (1)، وأبو نعيم في «الحلية» (8/318)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1456)، وابن الشجري في «أماليه» (1/416)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (27)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/95)، والقشيري في «الرسالة» (ص: 143).
قال الشيخ الألباني $ : وأما حديث أنس، فلم يعزه الهيثمي إلا للطبراني في «الأوسط» مختصرًا جدًّا بلفظ: «... من أهان لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة»، وقال: وفيه عمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي، وهو ضعيف.
وقد وجدته من طريق أخرى بأتم منه، ويرويه الحسن بن يحيى قال: حدثنا صدقة بن عبدالله، عن هشام الكناني، عن أنس، به، نحو حديث الترجمة، وزاد: «وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة، فأكفه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر...» الحديث.
أخرجه محمد بن سليمان الربعي في «جزء من حديثه» (ق216/2)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 121).
قلت: وإسناده ضعيف، مسلسل بالعلل، وهي:
الأولى: هشام الكناني لم أعرفه، وقد ذكره ابن حبان في كلامه الذي سبق نقله عنه بواسطة الحافظ ابن حجر، فالمفروض أن يورده ابن حبان في ثقات التابعين، ولكنه لم يفعل، وإنما ذكر فيهم هشام بن زيد بن أنس البصري، يروي عن أنس، وهو من رجال الشيخين، فلعله هو.
الثانية: صدقة بن عبدالله، وهو أبو معاوية السمين، ضعيف.
[قال الطالب]: قال السيوطي في «جامع الأحاديث»: وفيه صدقة بن عبدالله السمين، ضعفه أحمد والبخاري والبيهقي والدارقطني، وقال أبوحاتم: محله الصدق، وأنكر عليه القدر فقط.
الثالثة: الحسن بن يحيى، وهو الخشني، وهو صدوق كثير الغلط، كما في «التقريب». انتهى من «السلسلة الصحيحة» (1640).
% % %
المبحث السابع
من رواية حذيفة بن اليمان
قال أبو نعيم في «الحلية» (6/116): حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن رزيق، ثنا أبو اليمان، ثنا الأوزاعي، حدثني عبدة، حدثني زر بن حبيش، قال سمعت حذيفة يقول: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى أوحى إلي، يا أخا المرسلين، ويا أخا المنذرين، أنذر قومك أن لا يدخلوا بيتًا من بيوتي ولأحد عندهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائمًا بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها، فأكون سمعه الذي يسمع به، وأكون بصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة».
غريب من حديث الأوزاعي عن عبدة، ورواه علي بن معبد عن إسحاق بن أبي يحيى العكي عن الأوزاعي مثله. ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (65/44). قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (2/333): وهذا إسناد جيد، وهو غريب جدًّا.
وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (6308): ضعيف، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/116): حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن رزيق، ثنا أبو اليمان، ثنا الأوزاعي، حدثني عبدة، حدثني زر ابن حبيش قال: سمعت حذيفة يقول: قال رسول الله ﷺ...» فذكره. وقال: غريب من حديث الأوزاعي عن عبدة، ورواه علي بن معبد عن إسحاق بن أبي يحيى العكي عن الأوزاعي... به.
قلت (الألباني): وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات، مترجمون في «التهذيب»، إلا شيخ أبي نعيم سليمان بن أحمد، وهو الحافظ الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، وهو أشهر من أن يذكر، وإلا إسحاق بن إبراهيم بن زريق، فإني جهدت في أن أجد له ترجمة، فلم أوفق، ثم بدا لي شيء، وهو أن جده «زريق» محرف من «زبريق»، وأنه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء المصري، فإنه يعرف بـ «ابن زبريق»، وهو من هذه الطبقة، وقد مضى له حديث برقم (758) من رواية الطبراني بواسطة آخر له عنه: ثنا عمرو بن الحارث، فإذا كان هو هذا، فهو ضعيف جدًّا - كما بينت هناك - وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم كثيرًا، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب. ولعله قد خفي حاله على الحافظ ابن رجب الحنبلي، فقال في «جامع العلوم والحكم» (ص: 261) - بعد أن عزاه للطبراني -: وهذا إسناد جيد، وهو غريب جدًّا. ولم أجد من عزاه للطبراني، ولا هو في شيء من معجمه الثلاثة، فلعله في بعض كتبه الأخرى، مثل «مسند الشاميين»، فليراجع، فإن يدي لا تطوله الآن، وليس هو في المجلدين المطبوعين بتحقيق أخينا عبدالمجيد السلفي فرج الله عنه كربه. وأما إسحاق بن أبي يحيى العكي: فلم أعرفه.
% % %
المبحث الثامن
من رواية معاذ بن جبل
أخرجه ابن ماجه في «السنن» (398): حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبدالله ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن عيسى بن عبدالرحمن، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: أنه خرج يومًا إلى مسجد رسول الله ﷺ، فوجد معاذ ابن جبل قاعدًا عند قبر النبي ﷺ يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله ﷺ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن يسير الرياء شرك، وإن من عادى لله وليًّا فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة».
في «الزوائد»: في إسناده عبدالله بن لهيعة، وهو ضعيف. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (2041): هذا إسناد فيه عبدالله بن لهيعة، وهو ضعيف، رواه الحاكم من طريق عياش بن عباس عن عيسى به، وقال: لا علة له. وأبو نعيم في «الحلية» مختصرًا، وسنده ضعيف أيضًا، وحديث معاذ - مع ضعف إسناده - فهو شاهد مختصر ليس، فيه إلا قوله: «من عادى لله وليًّا فقد بارز الله بالمحاربة». وهو مخرج في «الضعيفة» (1850).
وحديث وهب بن منبه، أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/32) من طريق إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، حدثني وهب بن منبه، قال: إني لأجد في بعض كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: «ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبضِ روح المؤمن، يكره الموت، وأكره مساءته ولا بد له منه».
قلت: وإبراهيم هذا ضعيف، ولو صح عن وهب فلا يصلح للشهادة؛ لأنه صريح في كونه من الإسرائيليات التي أمرنا بأن لا نصدق بها، ولا نكذبها.
ونحوه ما روى أبو الفضل المقرئ الرازي في «أحاديث في ذم الكلام» (1/204) عن محمد بن كثير الصنعاني، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: «قال الله...» فذكر الحديث بنحوه معضلًا موقوفًا.
ولقد فات الحافظ $ حديث ميمونة مرفوعًا به بتمامه مثل حديث الطبراني عن عائشة. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (ق 334/1)، وأبو بكر الكلاباذي في «مفتاح المعاني» (1/13، رقم 15) عن يوسف بن خالد السمتيك، ثنا عمر بن إسحاق: أنه سمع عطاء بن يسار يحدث عنها.
لكن هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأن السمتي هذا قال فيه الحافظ: تركوه، وكذبه ابن معين. فلا يصلح للشهادة أصلًا. وقد قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه يوسف خالد السمتي، وهو كذاب.
% % %
المبحث التاسع
من رواية ميمونة بنت الحارث
رواه أبو يعلى في «مسنده» (7087) قال: حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يوسف بن خالد، عن عمر بن إسحاق، أنه سمع عطاء بن يسار يحدث، عن ميمونة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى : من آذى لي وليًّا فقد استحق محاربتي، وما تقرب إلي عبد بمثل أداء فرائضي، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت رجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، إن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موته، وذاك أنه يكرهه، وأنا أكره مساءته».
قال حسين سليم أسد (محقق مسند أبي يعلى): إسناده ضعيف جدًّا، وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (768) قال: وثنا العباس بن الوليد، ثنا يوسف بن خالد، عن محمد بن إسحاق، أنه سمع عطاء بن يسار يحدث، عن ميمونة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تبارك وتعالى: من آذى لي وليًّا فقد استحق محاربتي، وما تقرب إليِّ عبدي بمثل أداء فرائضي، وإنه ليتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت رجله التي بها يمشي، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، إن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موته، وذلك أنه يكرهه وأنا أكره مساءته».
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يوسف بن خالد السمتي البصري، قال فيه ابن معين: كذاب زنديق، لا يكتب حديثه. وقال أبوحاتم: أنكرت قول ابن معين: زنديق، حتى حمل إلي كتاب قد وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة، فعلمت أن ابن معين لا يتكلم إلا عن بصيرة وفهم، وهو ذاهب الحديث. وقال البخاري وأبو داود وابن معمر: كذاب. وقال ابن حبان: كان يضع الأحاديث على الأشياخ ويقرؤها عليهم، لا تحل الرواية عنه. قال الحافظ في «المطالب العالية» (575): يضعف. وقال الهيثمي في «المجمع» (17950): رواه أبو يعلى، وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب.
% % %
المبحث العاشر
من رواية وهب بن منبه
روي عن وهب بن منبه مقطوعًا، أخرجه أحمد في «الزهد»، وأبو نعيم في «الحلية»، وفيه تعقب على ابن حبان، حيث قال بعد إخراج حديث أبي هريرة: لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان - يعني: غير حديث الباب - وهما هشام الكناني، عن أنس، وعبدالواحد بن ميمون، عن عروة عن عائشة، وكلاهما لا يصح.
% % %
 |
|||
 |
|||

 |
|||
|
|||

اتبعت المنهج التالي في التحقيق:
1. نسخت الرسالة من النسخة (أ)، وجعلتها الأصل، وكتبتها حسب الرسم والإملاء الحديث.
2. ثم قابلت الرسالة على النسخة (ب)، والمطبوعة (ط)، وأثبت الفروق في الهامش.
3. قابلت النصوص التي نقلها المصنف من المصادر التي أخذ منها والتي وقفت عليها، و ما احتاج إلى تصويب صوبته.
4. ما كان خطأً في النسختين أثبته في الهامش، وتم تصحيح ما كان فيه من تصحيف، سواء كان ذلك في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية، وأثبت الصواب في المتن، ووضعته بين قوسين معكوفين هكذا [ ].
7. عزوت الآيات القرآنية إلى السور، وذكرت رقم الآية دبر كل آية.
8. خرَّجت الأحاديث الواردة من مصادر السنة النبوية، وذكرت الجزء والصفحة من الكتاب الذي ورد فيه الحديث، وذكرت أحكام العلماء والمحدثين من المتقدمين والمتأخرين، وأكثرت من نقل تحقيقات الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني $ تعالى، وما كان من هذه الأحاديث في الصحيحين لم أطل فيه الكلام، اللهم إن كانت فائدة أو زيادة من خارجهما.
9. ما احتاج المقام فيه للتعليق على كلام المصنفأ ذكرت أقوال العلماء فيه بما يقتضيه المقام والحاجة.
8. نقلت شروح الكلمات الغامضة من مصادره.
11. وضعت صورًا للنسخ الخطية.
12. وضعت فهارس موضوعية للكتاب.
% % %
 |
|||
|
|||

1- النسخة الأولى (أ):
نسخة بخط المؤلف، وتوجد بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء، في مجلد واحد مع «نثر الجوهر على حديث أبي ذر» تحت رقم (866 حديث)، وقد انتهى من كتابتها سنة (1239هـ)، وهي بحجم متوسط، وعدد صفحاتها (136 صفحة)، ومكتوبة بخط الرقعة الخالي من النقط في أكثر الأحوال.
وكتابتها تتسم بطابع التسرع، ففيها كثير من الشطب إلى جانب الخطأ في كثير من الآيات القرآنية، وتكرار بعض الكلمات أو نقصها، ونقض بعض الحروف، وتصحيف البعض، وعدم التبويب. وفي بعض الأحيان يكتب الإمام الشوكاني الضاد ظاءً حسب نطقهم، وكذلك قد يصل كلمتين من شأنهما أن يفصلا، مع وجود بعض الأخطاء النحوية القليلة.
وقد اعتبرت هذه النسخة الأصل، ورمزت لها بـ (أ).
2- النسخة الأخرى (ب):
نسخة بخط مجهول، كتبت سنة (1240هـ)، وموجودة بدار الكتب المصرية، تحت رقم (564 حديث)، بالمكتبة التيمورية، وكتبت عن النسخة (أ)، بخط رقعة واضح، منقوط إلا في القليل، وقد قرأها وأجازها بعد الكتابة تلميذ المؤلف محمد بن أحمد الشاطبي.
وهي في حجم متوسط، وعدد صفحاتها (224 صفحة)، وحالتها جيدة، لولا أن بها بعض الخروم، التي كادت أن تضيع معالم بعض الحروف.
وكاتبها يلتزم تسهيل الهمزة مثل الشوكاني، وقصر الممدود، وأخطاء (أ) تكاد تكون كلها فيها، وتزيد عليها (ب) في أن بها بعض حالات سقوط الكلمة أو الكلمتين، أو السطر بأكمله، أو الآية القرآنية كلها، إلى جانب بعض التصحيف من الناسخ، وهي تمتاز بإثبات بعض الكلمات التي يقتضيها المقام أو الأسلوب، والتي سقطت من المؤلف في (أ)، وكذلك بعض الحروف، أو إثبات بعض الحروف التي تتمشى مع الأسلوب، والتي يكون الشوكاني قد وضع في مقابلها حرفًا لا يتمشى مع السياق، أو لا يستقيم به الأسلوب. كما أن بهوامشها بعض تعليقات من القراء؛ لتوضيح كلمة، أو ذكر مناسبة. وقد نقل الناسخ هذه النسخة دون تبويب أيضًا على غرار الأصل. وقد رمزت لهذه النسخة بـ (ب).
% % %
 |
|||
|
|||

* النسخة الأولى (أ) *
ديباجة (أ)
الصفحة الأولى (أ)
 |
الصفحة الأخيرة (أ)
 |
* النسخة الأخرى (ب) *
ديباجة (ب)
 |
 الصفحة الأولى (ب)
الصفحة الأولى (ب) الصفحة الأخيرة (ب)
الصفحة الأخيرة (ب)
([1]) من مقدمة «إغاثة اللهفان» لابن القيم $.
([2]) «فتح الباري» (11/342- 347).
([3]) «الصحاح» (5/510).
([4]) «تاج العروس» (40/253).
([5]) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/510).
([6]) «المحكم والمحيط الأعظم» (10/457).
([7]) «الفروق اللغوية » (1/578).
([8]) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/510).
([9]) أخرجه ابن أبي شيبة (32132)، وأحمد (22995)، والحاكم (4578) من حديث ابن عباس، وأخرجه الترمذي (3713) من حديث أبي الطفيل، وقال: حسن صحيح، وله طرق كثيرة وشواهد عن عدة من الصحابة.
([10]) ينظر: «المحيط في اللغة» (10/279)، و«المخصص» (2/438)، و«تهذيب اللغة» (15/321)، و«غريب الحديث» لأبي عبيد بن سلّام (3/141)، و«معجم مقاييس اللغة» (6/141)، و«معجم مقاليد العلوم» (221).
([11]) «أضواء البيان» (3/257).
([12]) «بدائع الفوائد» (1063)، وانظر: حاشية المدابغي على «فتح المعين» لابن حجر الهيتمي (ص: 269)، و«شرح العقيدة الطحاوية» للغنيمي (ص: 103).
([13]) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: 588)، و«التحفة العراقية» في أعمال القلوب (ص: 15) وما بعدها، و«مجموع فتاوى ابن تيمية» (2 /345).
([14]) «بدائع الفوائد» (1073).
([15]) «فتح القدير» (4362).
([16]) «شرح العقيدة الطحاوية» للميداني (ص: 103)، وانظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (2/392)، والمحلي على «جمع الجوامع» وحاشية العطار عليه (2/481)، و«التعريفات» للجرجاني (ص: 132)، و«كشاف اصطلاحات الفنون» (2/1528)، و«فتح الباري» (11/342)، و«بستان العارفين» للنووي (ص: 171)، و«مجموعة رسائل ابن عابدين» (2/277)، وحاشية المدابغي على «فتح المعين» (ص: 269).
([17]) «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (ص: 301).
([18]) «مجموعة رسائل ابن عابدين» (2/277).
([19]) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (11/208- 223)، وينظر «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (2/301) .
([20]) أخرجه عبد بن حميد (508)، وابن أبي عاصم في «السنة» (1224)، وأبو نعيم في «الحلية» (4424)، وابن عساكر (30/210)، وابن أبي حاتم في «العلل» (2663).
([21]) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (11/221).
([22]) «بستان العارفين» (ص: 169).
([23]) «سير أعلام النبلاء» (13/441).
([24]) ينظر: «طبقات الشعراني» (2/16، 1/181).
([25]) «الملل والنحل» (5/226).
([26]) «معجم مقاييس اللغة» (5/172)، و«المفردات» للراغب (ص: 707).
([27]) المحلي على «جمع الجوامع» مع حاشية العطار (2/481)، و«شرح العقيدة الطحاوية» للغنيمي الميداني (ص: 139)، و«كشاف اصطلاحات الفنون» (2/975)، و«لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (2/392)، و«مجموعة رسائل ابن عابدين» (2/278)، و«التعريفات» للجرجاني (ص: 115).
([28]) «مجموعة رسائل ابن عابدين» (2/278).
([29]) «بستان العارفين» للنووي (ص: 141- 155)، و«المعتمد» لأبي يعلى (ص: 161)، و«الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (ص: 301)، و«شرح الطحاوية» للغنيمي (ص: 139)، و«لوامع الأنوار البهية» (4/239)، والمحلي على «جمع الجوامع» وحاشية العطار عليه (2/481).
([30]) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: 600).
([31]) «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (ص: 308).
([32]) «لوامع الأنوار البهية» (2/396)، و«بستان العارفين» للنووي (ص: 161- 165).
([33]) «الفتاوى الحديثية» للهيتمي (ص: 305)، و«بستان العارفين» للنووي (ص: 161).
([34]) «المعتمد» لأبي يعلي (ص: 165).
([35]) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: 600)، و«لوامع الأنوار البهية» (2/393).
([36]) «رد المحتار» (3/308)، و«مجموعة رسائل ابن عابدين» (2/279)، و«بستان العارفين» للنووي (ص: 156-162).
([37]) «فتح الباري» (13/349) .
([38]) «هدي الساري» (ص: 430).
([39]) «هدي الساري» ( ص 430) .
([40]) «مجموع الفتاوى» (18/129).
([41]) «حجة الله البالغة» (1/249).
([42]) «تدريب الراوي» (1/122، 123).
([43]) «نيل الأوطار» (1/22).
والصلاة والسلام على سيد الْمُرْسلين، وَآله الأكرمين، وَرَضي الله عَن صحابته الأفضلين.
وَبعد:
فَإِنَّهُ لما كَانَ حَدِيث «من عَادى لي وليًّا» قد اشْتَمَل على فَوَائِد كَثِيرَة النَّفْع، جليلة الْقدر، لمن فهمها حق فهمها، وتدبرها كَمَا يَنْبَغِي - أحْبَبْت أن أفرد هَذَا الحَدِيث الْجَلِيل بمؤلف مُسْتَقل، أنشر من فَوَائده مَا تبلغ إِلَيْهِ الطَّاقَة ويصل إِلَيْهِ الْفَهم، وَمَا أحقه بِأن يفرد( ) بالتأليف، فَإِنَّهُ قد اشْتَمَل على كَلِمَات كلهَا دُرَر، الْوَاحِدَة مِنْهَا تحتهَا من الْفَوَائِد مَا ستقف على الْبَعْض مِنْهُ.
وَكَيف لَا يكون كَذَلِك وَقد حَكَاهُ عَن الرب سُبْحَانَهُ من أُوتِيَ جَوَامِع الْكَلم، وَمن هُوَ أفْصح من نطق بالضاد( )، وَخير الْعَالم بأسره، وَأجل خلق الله، وَسيد ولد آدم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم( )؟.
وَلم يسْتَوْف شرَّاح الحَدِيث - رَحِمهم الله - مَا يسْتَحقّهُ هَذَا الحَدِيث من الشَّرْح؛ فَإِن ابْن حجر $ لم يشرحه فِي «فتح الْبَارِي»( ) إِلَّا بِنَحْوِ ثَلَاث ورق، مَعَ أن شَرحه أكمل شروح البُخَارِيّ، وأكثرها تَحْقِيقًا، وأعمها نفعًا.
وَلَا حَاجَة [لنا]( ) فِي الْكَلَام على رجال إِسْنَاده، فقد أجمع أهل هَذَا الشَّأْن أن أحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ أو أحدهمَا كلهَا من الْمَعْلُوم صدقه، المتلقى بِالْقبُولِ، الْمجمع على ثُبُوته، وَعند هَذِه الإجماعات تنْدَفع كل شُبْهَة، وَيَزُول كل تشكيك
.
وَقد دفع أكَابِر الْأئِمَّة من تعرض للْكَلَام على شَيْء مِمَّا فيهمَا وردوه أبلغ رد، وبينوا صِحَّته أكمل بَيَان، فَالْكَلَام على إِسْنَاده بعد هَذَا لَا يَأْتِي بفائدة يعْتد بهَا، فَكل رُوَاته قد جازوا القنطرة، وارتفع عَنْهُم القيل والقال، وصاروا أكبر من أن يتَكَلَّم فيهم بِكَلَام، أو يتناولهم طعن طَاعن، أو توهين موهن، وسميته:
«قطر الولي على حديث الولي»( )
وَهُوَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَلَفظه فِي البُخَارِيّ هَكَذَا: قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «إِن الله تبَارك وَتَعَالَى قَالَ: من عادى لي وليًّا، فقد آذنته بِالْحَرْبِ، وَمَا تقرب إليَّ عَبدِي بِشَيْء أحب إِلَيّ مِمَّا افترضت عَلَيْهِ، وَمَا يزَال( ) عَبدِي يتَقرَّب إليَّ بالنوافل حَتَّى أحببته، فَإِذا أحببته، كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ، وبصره الَّذِي يُبصر بِهِ، وَيَده الَّذِي يبطش بهَا، وَرجله الَّذِي يمشي بهَا، [وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه]( )، وَمَا ترددت عَن شَيْء أنا فَاعله ترددي عَن نفس الْمُؤمن يكره الْمَوْت، وأكره إساءته»( ). انْتهى.
* قَوْله: «إِن الله تبَارك وَتَعَالَى( ) قَالَ»: هَذَا من الْأحَادِيث الإلهية القدسية، وَهُوَ يحْتَمل أن يكون مِمَّا تَلقاهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم عَن ربه بِلَا وَاسِطَة، وَيحْتَمل أن يكون مِمَّا تَلقاهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم [عَن ربه]( ) بِوَاسِطَة الْملك.
قَالَ الْكرْمَانِي: يحْتَمل أن يكون من الْأحَادِيث القدسية، وَيحْتَمل أن يكون لبَيَان الْوَاقِع، وَالرَّاجِح الأول( ).
وَقد وَقع فِي بعض طرق هَذَا الحَدِيث أنه صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم حدث بِهِ، عَن جِبْرِيل، عَن الله ۵.
* قَوْله: «من عادى لي وليًّا»: قَالَ فِي «الصِّحَاح»( ): وَالْوَلِيّ ضد الْعَدو. انْتهى.
وَالْولَايَة ضد الْعَدَاوَة، وأصل الْولَايَة الْمحبَّة والتقرب كَمَا ذكره أهل اللُّغَة، وأصل الْعَدَاوَة البغض والبعد.
قَالَ ابْن حجر فِي «فتح الْبَارِي»( ): المُرَاد بولِي الله الْعَالم بِاللَّه تَعَالَى، المواظب( ) على طَاعَته، المخلص فِي عِبَادَته. انْتهى.
وَهَذَا التَّفْسِير للْوَلِيّ هُوَ الْمُنَاسب لِمَعْنى الْوَلِيّ الْمُضَاف إِلَى الرب سُبْحَانَهُ، وَيدل على ذَلِك مَا فِي الْآيَات القرآنية؛ كَقَوْلِه سُبْحَانَهُ( ): ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [يونس: 62-64]، وَكَقَوْلِه ۵: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [البقرة: 257]، وَكَقَوْلِه سُبْحَانَهُ: ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [المائدة: 54-56]، وَغير ذَلِك من الْآيَات. فأولياء الله هم خلص عباده، القائمون بطاعاته، المخلصون لَهُ.
وَأفضل أوْلِيَاء الله [سبحانه]( ) هم الْأنْبِيَاء، وَأفضل الْأنْبِيَاء هم المُرْسَلُونَ، وَأفضل الرُّسُل هم أولو الْعَزْم: نوح وَإِبْرَاهِيم ومُوسَى وَعِيسَى، وَمُحَمّد صلى الله عَلَيْهم وَسلم. وَأفضل أولي الْعَزْم نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْه وآله وَسلم( )، وَهُوَ الَّذِي أنزل الله سُبْحَانَهُ [وتعالى]( ) عَلَيْهِ: ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [آل عمران: 31]. فَجعل سُبْحَانَهُ صدق محبَّة الله ۵ متوقفة على اتِّبَاعه، وَجعل اتِّبَاعه سَبَب حُصُول الْمحبَّة من الله سُبْحَانَهُ.
وَقد ادَّعَت الْيَهُود وَالنَّصَارَى أنهم أبنَاء الله وأحباؤه [وأولياؤه]( ) ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [المائدة: 18].
بل ادعوا أنه لَا يدْخل الْجنَّة إِلَّا من كَانَ مِنْهُم ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [البقرة: 111، 112].
بل قد ادّعى ذَلِك مشركو الْعَرَب، كَمَا حكى الله سُبْحَانَهُ ذَلِك عَنْهُم بقوله: ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ إِلَى قَوْله: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾( ) [الأنفال: 30- 34]. وهم فِي الْحَقِيقَة أوْلِيَاء الشَّيْطَان، كَمَا قَالَ ۵: ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [النساء: 76]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﮝ( ) ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ( ) ﯙ ﯚ﴾ [النحل: 98- 100]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الكهف: 50]. [وَقَالَ سُبْحَانَهُ]( ): ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [النساء: 119].
وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [البقرة: 257]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [آل عمران: 175]، وَقَالَ: ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [الأعراف:27]، وَقَالَ: ﴿[ﯿ]( ) ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ[أ:4] ﰇ ﰈ﴾ [الأعراف: 30]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ِﮋ( ) ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [الأنعام: 121]. وَقَالَ الْخَلِيل [ﷺ]( ): ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [مريم: 45].
وَثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا أنه قَالَ: «إِن آل أبي فلَان لَيْسُوا لي بأولياء، إِنَّمَا وليِّي الله وَصَالح الْمُؤمنِينَ»( ). وَهُوَ كَقَوْل الله سُبْحَانَهُ: ﴿ِﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [التحريم: 4].
قَالَ الإِمَام تَقِيّ الدّين ابْن تَيْمِية $: (فصل): وأولياء الله على طبقتين: سَابِقُونَ مقربون، وأبرار أصْحَاب يَمِين مقتصدون. ذكرهم الله سُبْحَانَهُ فِي عدَّة مَوَاضِع من كِتَابه، فِي أول الْوَاقِعَة، وَآخِرهَا، وَفِي سُورَة الْإِنْسَان، والمطففين، وَفِي سُورَة فاطر، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ ذكر فِي الْوَاقِعَة، الْقِيَامَة الْكُبْرَى فِي أولهَا، وَذكر الْقِيَامَة الصُّغْرَى فِي آخرهَا، فَقَالَ فِي أولهَا: ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [الواقعة: 1- 14].
فَهَذَا تَقْسِيم النَّاس إِذا قَامَت الْقِيَامَة الْكُبْرَى الَّتِي يجمع الله فِيهَا الْأوَّلين والآخرين كَمَا وصف فِي كِتَابه فِي غير مَوضِع. ثمَّ قَالَ فِي آخر السُّورَة ﴿ﭭ﴾، أي: فَهَلا، ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [الواقعة:83- 96]، وَقَالَ فِي سُورَة الْإِنْسَان: ﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ [أ:5] ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [الإنسان: 3- 9] الْآيَات.
وَكَذَلِكَ فِي سُورَة المطففين فقال: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [المطفِّفين: 7- 28].
فَعَن ابْن عَبَّاس وَغَيره من السّلف قَالُوا: يمزج لأصْحَاب الْيمن مزجًا( )، وَيشْرب بهَا المقربون صرفًا. وَهُوَ كَمَا قَالُوا، فَإِنَّهُ قَال:َ ﴿ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [المطفِّفين: 28]، وَلم يقل: مِنْهَا؛ لِأنَّهُ ضمن قَوْله يشرب معنى يرْوى، فَإِن الشَّارِب قد يرْوى وَقد لَا يرْوى. فَإِذا قيل يشرب مِنْهَا لم يدل على الرِّي، وَإِذا قَالَ يشرب بهَا كَانَ الْمَعْنى يُرْوَون بهَا فَلَا يَحْتَاجُونَ مَعهَا إِلَى مَا هُوَ دونهَا. فَلهَذَا شَرِبُوهَا صرفًا، بِخِلَاف أصْحَاب الْيَمين، فَإِنَّهَا مزجت لَهُم مزجا. وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي سُورَة الْإِنْسَان: ﴿ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ [الإنسان: 5، 6]. فَعبَّاد الله هم المقربون المذكورون فِي تِلْكَ السُّورَة.
وَهَذَا لِأن الْجَزَاء من جنس الْعَمَل، فِي الْخَيْر وَالشَّر، كَمَا قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «من نفس عَن( ) مُؤمن كربَة من كرب الدُّنْيَا نفس الله عَنهُ كربَة من كرب يَوْم الْقِيَامَة، وَمن يسر على مُعسر يسر [الله]( ) عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَمن ستر مُسلمًا، ستره الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة. وَالله فِي عون العَبْد مَا كَانَ [العَبْد]( ) فِي عون أخِيه، وَمن سلك طَرِيقًا يلْتَمس فِيه( ) علمًا سهل الله لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجنَّة، وَمَا اجْتمع قوم فِي بَيت من بيُوت الله يَتلون كتاب الله، وَيَتَدَارَسُونَهُ( ) [بَينهم]( ) إِلَّا نزلت عَلَيْهِم السكينَة وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَة، وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَة، وَذكرهمْ الله [تَعَالَى]( ) فِيمَن عِنْده، وَمن بطأ بِهِ عمله، لم يسْرع بِهِ نسبه»( ). رَوَاهُ مُسلم فِي «صَحِيحه».
وَقَالَ: «الراحمون يرحمهم الرَّحْمَن، ارحموا من فِي الأرْض يَرْحَمكُمْ من فِي السَّمَاء»( ). قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث صَحِيح.
وَفِي «الصَّحِيح»: «يَقُول الله تَعَالَى: خلقت الرَّحِم، وشققت لَهَا اسْمًا من اسْمِي، فَمن وَصلهَا، وصلته، وَمن قطعهَا، قطعته»( ).
وَقَالَ: «من وصل صفًّا وَصله الله، وَمن قطعه قطعه الله»( ). وَمثل هَذَا كثير( ).
وَقد ذكر الله [تعالى]( ) أولياءه الْمُقْتَصِدِينَ؛ والسابقين، فِي سُورَة فاطر بقوله: ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [فاطر: 32- 35].
وَهَذِه الْأصْنَاف( ) الثَّلَاثَة هم أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم خَاصَّة كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [فاطر: 32] الْآيَة. وَأمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم هم الَّذين أورثوا الْكتاب بعد الْأُمَم الْمُتَقَدّمَة. وَلَيْسَ ذَلِك مُخْتَصًّا بحفاظ الْقُرْآن، بل كل من آمن بِالْقُرْآنِ فَهُوَ من هَؤُلَاءِ.
وقسمهم إِلَى ظَالِم لنَفسِهِ، ومقتصد، وسابق بالخيرات( )، بِخِلَاف الْآيَات الَّتِي فِي الْوَاقِعَة والمطففين، والانفطار وَالْإِنْسَان، فَإِنَّهُ دخل فِيهَا جَمِيع الْأُمَم الْمُتَقَدّمَة كافرهم ومؤمنهم.
وَهَذَا( ) التَّقْسِيم لأمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم. فالظالم لنَفسِهِ أصْحَاب الذُّنُوب المصرون عَلَيْهَا. والمقتصد الْمُؤَدِّي للفرائض المجتنب للمحارم، وَالسَّابِق بالخيرات، هُوَ الْمُؤَدِّي للفرائض والنوافل، المجتنب للمحرمات والمكروهات، كَمَا فِي تِلْكَ الْآيَات.
ثمَّ [قد]( ) ذكر [الله]( ) سُبْحَانَهُ المفاضلة بَين أوليائه الْمُؤمنِينَ، فَقَالَ: ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [الإسراء: 21].
بل بَين سُبْحَانَهُ التَّفَاضُل بَين أنبيائه فَقَالَ: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [البقرة: 253]. [أ:7]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [الإسراء: 55].
وَفِي «صَحِيح مُسلم»، عَن أبي هُرَيْرَة، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أنه قَالَ: «الْمُؤمن الْقوي خير وَأحب إِلَى الله [تعالى]( ) من الْمُؤمن الضَّعِيف، وَفِي كل خير، احرص على مَا ينفعك واستعن بِاللَّه وَلَا تعجز، وَإِن أصَابَك شَيْء فَلَا تقل لَو أنِّي فعلت كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِن قل قدر الله وَمَا شَاءَ فعل، فَإِن لَو تفتح عمل الشَّيْطَان»( ).
وَفِي «سنَن أبي دَاوُد»، عَن عَوْف بن مَالك أنه حَدثهمْ: أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم قضى بَين رجلَيْنِ، فَقَالَ الْمقْضِي عَلَيْهِ لما أدبر: حسبي الله وَنعم الْوَكِيل، فَقَالَ النَّبِي( ) صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «إِن الله يلوم على الْعَجز، وَلَكِن عَلَيْك بالكَيس، فَإِذا غلبك ( ) أمر، [فَقل] ( ): حسبي الله وَنعم الْوَكِيل»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا عَن أبي هُرَيْرَة وَعَمْرو بن الْعَاصِ، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم قَالَ: «إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أجْرَانِ، وَإِذا اجْتهد فَأخْطَأ فَلهُ أجر»( ). وروي من طرق خَارج الصَّحِيحَيْنِ: «أن للمصيب عشرَة أجور»( ).
وَقَالَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [الحديد: 10]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [النساء: 95، 96]. وَقَالَ: ﴿ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [التوبة: 19- 22]. وَقَالَ: ﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [الزُّمَر: 9]. وَقَالَ: ﴿ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾ [المجادلة: 11].
وَاعْلَم أن أوْلِيَاء الله غير الْأنْبِيَاء لَيْسُوا بمعصومين، بل يجوز عَلَيْهِم مَا يجوز على سَائِر عباد الله الْمُؤمنِينَ، لكِنهمْ قد صَارُوا فِي رُتْبَة رفيعة ومنزلة عليَّه، فقلَّ أن يَقع مِنْهُم مَا يُخَالف الصَّوَاب وينافي الْحق. فَإِذا وَقع ذَلِك فَلَا يخرجهم عَن كَونهم أوْلِيَاء الله ( ). كَمَا يجوز أن يُخطئ الْمُجْتَهد وَهُوَ مأجور على خطئه حَسْبَمَا تقدم أنه إِذا اجْتهد فَأصَاب فَلهُ أجْرَانِ، وَإِن اجْتهد فَأخْطَأ فَلهُ أجر.
وَقد تجَاوز الله سُبْحَانَهُ لهَذِهِ الْأمة عَن الْخَطَأ وَالنِّسْيَان، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [البقرة: 286].
وَقد ثَبت فِي «الصَّحِيح»: أن الله سُبْحَانَهُ قَالَ: بعد كل دَعْوَة من هَذِه الدَّعْوَات: قد فعلت( ).
وَحَدِيث «رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان...»( ). قد كثرت طرقه حَتَّى صَار من قسم الْحسن لغيره، كَمَا هُوَ مَعْرُوف عِنْد أهل هَذَا الْفَنّ.
وَلَا يجوز للْوَلِيّ أن يعْتَقد فِي كل مَا يَقع لَهُ من الْوَاقِعَات والمكاشفات أن ذَلِك كَرَامَة من الله سُبْحَانَهُ. فقد يكون من تلبيس الشَّيْطَان ومكره.
بل الْوَاجِب عَلَيْهِ أن يعرض أقْوَاله وأفعاله على الْكتاب وَالسّنة، فَإِن كَانَت مُوَافقَة لَهَا فَهِيَ حق وَصدق وكرامة من الله سُبْحَانَهُ. وَإِن كَانَت مُخَالفَة لشَيْء من ذَلِك، فَليعلم أنه مخدوع ممكور بِهِ قد طمع مِنْهُ الشَّيْطَان فَلبس عَلَيْهِ.
وَلَيْسَ لمنكر أن يُنكر على أوْلِيَاء الله مَا يَقع مِنْهُم من المكاشفات( ) الصادقة الْمُوَافقَة للْوَاقِع. فَهَذَا بَاب قد فَتحه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنه قَالَ: «قد كَانَ فِي الْأُمَم قبلكُمْ محدَّثون فَإِن يكن فِي أمتِي أحد مِنْهُم فعمر مِنْهُم»( ). وَفِي لفظ فِي الصَّحِيح: «إِن فِي هَذِه الْأمة محدَّثين، وَإِن مِنْهُم عمر». والمحدَّث: الصَّادِق الظَّن الْمُصِيب الفراسة. وَحَدِيث: «اتَّقوا فراسة الْمُؤمن فَإِنَّهُ يرى بِنور الله»( ). أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه.
وَقد كَانَ عمر ﭬ - مَعَ كَونه مشهودًا لَهُ بِأنَّهُ من الْمُحدثين بِالنَّصِّ [النَّبَوِيّ]( ) - يشاور الصَّحَابَة ويشاورونه، ويراجعهم ويراجعونه، ويحتج عَلَيْهِم [ويحتجون عليه] ( ) بِالْكتاب وَالسّنة، ويرجعون جَمِيعًا إِلَيْهِمَا، ويردون مَا اخْتلفُوا فِيهِ إِلَى مَا أمر الله [تعالى]( ) بِالرَّدِّ إِلَيْهِ من الرَّد إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَإِلَى رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، فالرد إِلَى الله هُوَ الرَّد إِلَى كِتَابه، وَالرَّدّ إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم بعد مَوته هُوَ الرَّد إِلَى مَا صَحَّ من سنته. [أ:9].
فَحق على الْوَلِيّ وَإِن بلغ فِي الْولَايَة إِلَى أعلَى مقَام وَأرْفَع مَكَان، أن يكون مقتديا بِالْكتاب وَالسّنة، وازنًا لأفعاله وأقواله بميزان هَذِه الشَّرِيعَة المطهرة، وَاقِفًا على الْحَد الَّذِي رسم فِيهَا، غير زائغ عَنْهَا فِي شَيْء من أُمُوره؛ فقد ثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فِي الصَّحِيح أنه قَالَ: «كل أمر لَيْسَ على أمرنَا فَهُوَ رد»( ).
وَإِذا ورد عَلَيْهِ وَارِد يُخَالف الشَّرِيعَة رده، واعتقد أنه من الشَّيْطَان، ويدافع ذَلِك بِحَسب استطاعته، وَبِمَا تبلغ إِلَيْهِ قدرته. قَالَ الله سُبْحَانَهُ ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [التغابن: 16]. وَقَالَ تَعَالَى ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [آل عمران: 102]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [البقرة: 286]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [الأعراف: 42]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الأنعام: 152]. وَمن خَالف هَذَا مِمَّن يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْوَلِيّ فَلَيْسَ من أوْلِيَاء الله ۵.
وَمَا أحسن مَا قَالَه أبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِي: إِنَّهَا لتقع فِي قلبِي النُّكْتَة من نكت الْقَوْم فَلَا ( ) أقبلها إِلَّا بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ الْكتاب وَالسّنة( ).
وَقَالَ الْجُنَيْدُ $: علمنَا هَذَا مُقَيّد بِالْكتاب وَالسّنة، فَمن لم يقْرَأ الْقُرْآن وَيكْتب الحَدِيث لَا يَصح لَهُ أن يتَكَلَّم فِي علمنَا( ).
وَقَالَ أبُو عُثْمَان( ) النَّيْسَابُورِي: من أمر على نَفسه الشَّرِيعَة قولًا وفعلًا نطق بالحكمة، وَمن أمر على نَفسه الْهوى قولًا وفعلًا نطق بالبدعة؛ لِأن الله تَعَالَى يَقُول: ﴿ﭡ ﭢ ﭣ﴾( ) [النور: 54].
وَقَالَ أبُو عَمْرو ابن نجيد: كل وجد لَا يشْهد لَهُ الْكتاب وَالسّنة فَهُوَ بَاطِل.
خوارق غير الأولياء
وَإِذا عرفت أنه لَابُد للْوَلِيّ من أن يكون مقتديًا فِي أقْوَاله وأفعاله بِالْكتاب وَالسّنة، وَأن ذَلِك هُوَ المعيار الَّذِي يعرف بِهِ الْحق من الْبَاطِل، فَمن ظهر مِنْهُ شَيْء مِمَّا يُخَالف هَذَا المعيار فَهُوَ رد عَلَيْهِ، وَلَا يجوز لأحد أن يعْتَقد فِيهِ أنه ولي الله، فَإِن أمْثَال هَذِه الْأُمُور تكون من أفعَال الشَّيَاطِين، كَمَا نشاهده فِي الَّذين لَهُم تَابع من الْجِنّ. فَإِنَّهُ قد يظْهر على يَده مَا يظنّ من لم يستحضر هَذَا المعيار أنه كَرَامَة. وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة مخاريق( ) شيطانية وتلبيسات إبليسية.
وَلِهَذَا ترَاهُ يظْهر من أهل الْبدع، [بل]( ) من أهل الْكفْر، وَمِمَّنْ يتْرك فَرَائض الله سُبْحَانَهُ ويتلوث( ) بمعاصيه؛ لِأن الشَّيْطَان أميل إِلَيْهِم للاشتراك بَينه وَبينهمْ فِي مُخَالفَة مَا شَرعه الله سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ.
وَقد يظْهر شَيْء مِمَّا يظنّ أنه كَرَامَة من أهل الرياضة( ) وَترك الاستكثار من الطَّعَام وَالشرَاب على تَرْتِيب مَعْلُوم، وقانون مَعْرُوف، حَتَّى يَنْتَهِي حَاله إِلَى أن لَا يَأْكُل إِلَّا فِي الأيَّام( ) ذَوَات الْعدَد، ويتناول بعد [مُضِيّ]( ) أيَّام شَيْئًا يَسِيرًا، فَيكون لَهُ بِسَبَب ذَلِك بعض صفاء من الكدورات البشرية، فيدرك مَا لَا يُدْرِكهُ غَيره، وَلَيْسَ هَذَا من الكرامات فِي شَيْء. وَلَو كَانَ من الكرامات الربانية، والتفضلات الرحمانية، لم يظْهر على أيدي أعدَاء الله، كَمَا يَقع كثيرًا من المرتاضين من كفرة الْهِنْد الَّذين يسمونهم الْآن «الجوكية»( ).
وَقد يظْهر شَيْء مِمَّا يظنّ أنه كَرَامَة على لِسَان بعض المجانين. وَسبب ذَلِك - كَمَا ذكره الْحُكَمَاء -: أنه قد ذهب عَنهُ مَا يصنعه الْفِكر من التَّفْصِيل وَالتَّدْبِير، اللَّذين يستمران للعقلاء، فَيكون لعقله إِدْرَاك لَا يكون للعقلاء، فَيَأْتِي فِي بعض الأحيان بمكاشفات صَحِيحَة، وَهُوَ مَعَ ذَلِك متلوث بِالنَّجَاسَةِ، مرتبك فِي القاذورات، قَاعد فِي الْمَزَابِل وَمَا يشابهها، فيظن من لَا حَقِيقَة عِنْده أنه من أوْلِيَاء الله، وَذَلِكَ ظن بَاطِل، وتخيل مختل، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة مَجْنُون، قد رفع الله عَنهُ قلم التَّكْلِيف، وَلم يكن وليًّا لله، وَلَا عدوًّا.
المكاشفات الصحيحة وأولياء المؤمنين:
وَقد تكون المكاشفة من رجل جعله الله سُبْحَانَهُ من الْمُحَدَّثين حَسْبَمَا سبق تَحْقِيق ذَلِك، وَهَذِه طَريقَة أثبتها الشَّرْع وَصَحَّ بهَا الدَّلِيل.
وَالْغَالِب أن ذَلِك لَا يكون إِلَّا من خُلَّص الْمُؤمنِينَ، كَمَا سبق فِي حَدِيث «اتَّقوا فراسة الْمُؤمن».
وَهَذَا التحَدِيث هُوَ شَيْء يوقعه الله [تعالى]( ) فِي روع من كتب لَهُ ذَلِك، فيلقيه إِلَى النَّاس، فَيكون مطابقًا للْوَاقِع، وَلَيْسَ من [باب]( ) الكهانة، وَلَا من بَاب النجامة والرمل، وَلَا من بَاب تلقين الشَّيْطَان، كَمَا كَانَ يَقع لعمر بن الْخطاب ﭬ.
وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الحَدِيث - الَّذِي نَحن بصدد شَرحه - أنه لَا يزَال العَبْد يتَقرَّب إِلَى الله سُبْحَانَهُ بالنوافل حَتَّى يُحِبهُ، فَإِذا أحبه، كَانَ سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ، وبصره الَّذِي يبصر بِهِ، وَيَده الَّتِي يبطش بهَا، وَرجله الَّتِي يمشي بهَا، وسنتكلم إِن شَاءَ الله [تعالى]( ) على مَعَاني هَذِه الْألْفَاظ النَّبَوِيَّة.
وَفِي الْقُرْآن الْكَرِيم من ذَلِك الْكثير الطّيب؛ كَقَوْلِه سُبْحَانَهُ: ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [النساء: 69] .
وللصحابة ﭫ النَّصِيب الوافر من طَاعَة الله سُبْحَانَهُ، وَمن التَّقَرُّب إِلَيْهِ بِمَا يُحِبهُ، وَلِهَذَا صَارُوا خير الْقُرُون، كَمَا ثَبت فِي الْأحَادِيث الصَّحِيحَة المروية من وُجُوه كَثِيرَة، وَثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فِي الصَّحِيح من طرق كَثِيرَة: أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم قَالَ: «لَا تسبوا أصْحَابِي فَوَالذي نَفسِي بِيَدِهِ لَو أنْفق أحدكُم مثل أُحد ذَهَبا مَا بلغ مُدَّ أحدهم وَلَا نصيفه»( ).
فَانْظُر إِلَى هَذِه المزية الْعَظِيمَة، والخصيصة الْكَبِيرَة الَّتِي لم تبلغ من غَيرهم إِنْفَاق مثل الْجَبَل الْكَبِير من الذَّهَب نصف المُدَّ الَّذِي يُنْفِقهُ الْوَاحِد مِنْهُم، فَرضِي الله [تعالى]( ) عَنْهُم وأرضاهم.
فهم أفضل أوْلِيَاء الله سُبْحَانَهُ وَأكْرمهمْ عَلَيْهِ، وَأعْلَاهُمْ منزلَة عِنْده، وهم الَّذين عمِلُوا بِكِتَاب الله تَعَالَى وَسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم.
فَمن جَاءَ بعدهمْ مِمَّن يُقَال لَهُ إِنَّه من الْأوْلِيَاء، لَا يكون وليًّا لله [تعالى]( ) إِلَّا إِذا اتبع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، واهتدى بهديه، واقتدى بِهِ فِي أقْوَاله وأفعاله.
صفات الولي :
وَاعْلَم أن من أعظم مَا يتَبَيَّن بِهِ من هُوَ من أوْلِيَاء الله سُبْحَانَهُ: أن يكون مجاب الدعْوَة، رَاضِيًا عَن الله ۵ فِي كل حَال، قَائِمًا بفرائض الله سُبْحَانَهُ، تَارِكًا لمناهيه، زاهدًا فِيمَا يتكالب [عَلَيْهِ]( ) النَّاس من طلب الْعُلُوّ فِي الدُّنْيَا، والحرص على رياستها، لَا يكون لنَفسِهِ شغل بملاذ الدُّنْيَا وَلَا بالتكاثر مِنْهَا، وَلَا بتحصيل أسبَاب الْغنى، وَكَثْرَة اكْتِسَاب الْأمْوَال وَالْعرُوض، إِذا وصل إِلَيْهِ الْقَلِيل صَبر، وَإِن وصل إِلَيْهِ الْكثير شكر، يَسْتَوِي عِنْده الْمَدْح والذم، والفقر والغنى، والظهور والخمول، غير معجب بِمَا منَّ الله بِهِ عَلَيْهِ من خِصَال الْولَايَة، إِذا زَاده الله رفْعَة، زَاد فِي نَفسه تواضعًا وخضوعًا، حسن الْأخْلَاق، كريم الصُّحْبَة، عَظِيم الْحلم، كثير الِاحْتِمَال.
وَبِالْجُمْلَةِ؛ فمعظم اشْتِغَاله بِمَا رغب الله [تعالى]( ) فِيهِ، وَندب عباده إِلَيْهِ. فَمن كملت لَهُ هَذِه الْخِصَال، واتصف بِهَذِهِ الصِّفَات، واتسم بِهَذِهِ السمات، فَهُوَ ولي الله الْأكْبَر، الَّذِي يَنْبَغِي لكل مُؤمن أن يُقَّرَ لَهُ بذلك، ويتبرك بِالنّظرِ إِلَيْهِ( )، والقرب مِنْهُ.
وَمن كَانَ فِيهِ بعض هَذِه الْخِصَال، واشتمل على شطر من هَذِه الصِّفَات( )، فَلهُ من الْولَايَة بِقدر مَا رزقه الله سُبْحَانَهُ مِنْهَا، ووهب لَهُ من محاسنها.
وَالْبَاب الْأعْظَم للدخول إِلَى سُوح( ) الْولَايَة هُوَ الْإِيمَان بِاللَّه كَمَا ندب إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم حَيْثُ قَالَ لما سُئِلَ عَن الْإِيمَان: «أن تؤمن بِاللَّه وَمَلَائِكَته وَكتبه وَرُسُله، وَالْقدر خَيره وشره»( ).
وأصعب هَذِه الْخِصَال: الْإِيمَان بِالْقدرِ، فَإِنَّهُ إِذا حصل لَهُ [ذَلِك]( ) على الْوَجْه الْمُعْتَبر، هَانَتْ عَلَيْهِ جَمِيع الْأُمُور( )، وَفرغ من شغل قلبه بِمَا نزل عَلَيْهِ من الْمَقَادِير خَيرهَا وشرها.
وَلَا يُنَافِي ذَلِك تعوذه [صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم]( ) من سوء الْقَضَاء. فقد ثَبت فِي «الصَّحِيح»: أن من الدَّعْوَات النَّبَوِيَّة قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من سوء الْقَضَاء، ودرك الشَّقَاء، وَجهد الْبلَاء، وشماتة الْأعْدَاء»( ). وَثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أنه كَانَ يَقُول فِي قنوت الْوتر: «وَقِنِي شَرَّ مَا قضيت»( ).
وأولياء الله سُبْحَانَهُ يتفاوتون فِي الْولَايَة بِقُوَّة مَا رزقهم الله سُبْحَانَهُ من الْإِيمَان، فَمن كَانَ أقوى إِيمَانًا كَانَ فِي بَاب الْولَايَة أعظم شَأْنًا، وأكبر قدرًا وَأعظم قربًا إِلَى الله [تعالى]( )، وكرامة لَدَيْهِ.
وَمن لَازِم الإيمانِ الْقوي العملُ السوي، والتحبُّبُ إِلَى الله بمحبته ۵ ومحبة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [آل عمران: 31].
وَكلما ازْدَادَ بَعْدَ التَّقَرُّب إِلَى الله بِفَرَائِضِهِ، وَاجْتنَاب مناهيه، بِفعل النَّوَافِل، والاستكثار من ذكره ۵ = زَاده الله [تعالى]( ) محبَّة، وَفتح لَهُ أبْوَاب الْخَيْر كُله، دِقِّهِ وَجِله، كَمَا سَيَأْتِي من الْكَلَام على شرح هَذَا الحَدِيث الَّذِي نَحن بصدد شَرحه وَبَيَان مَعَانِيه الشَّرِيفَة ونكاته اللطيفة .
فصل في جواز وقوع الكرامات( ):
وَمن وُهِب لَهُ هَذِه الموهوبات الجليلة، وتُفِضِّلَ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الصِّفَات الجميلة، فغَيْر بعيد، وَلَا مستنكر أن تظهر على يَده من الكرامات الَّتِي لَا تنَافِي الشَّرِيعَة والتصرفات فِي مخلوقات الله ۵( ) الوسيعة؛ لِأنَّهُ إِذا دَعَاهُ أجَابَهُ، وَإِذا سَألَهُ أعطَاهُ، وَلم يُصِب من جعل مَا يظْهر من كثير من الْأوْلِيَاء من قطع المسافات الْبَعِيدَة، والمكاشفات الْمُصِيبَة، وَالْأفْعَال الَّتِي تعجز عَنْهَا غَالب القوى البشرية، من الْأفْعَال الشيطانية والتصرفات الإبليسية.
فَإِن هَذَا غلط وَاضح؛ لِأن من كَانَ مجاب الدعْوَة لَا يمْتَنع عَلَيْهِ أن يسْأل الله سُبْحَانَهُ أن يوصله إِلَى أبعد الْأمْكِنَة الَّتِي لَا تقطع طريقها إِلَّا فِي شهور فِي لَحْظَة يسيرَة، وَهُوَ الْقَادِر الْقوي الَّذِي مَا شاءه كَانَ، وَمَا لم يشأه لم يكن، وَأي بُعد فِي أن يُجيب الله دَعْوَة من دَعَاهُ من أوليائه فِي مثل هَذَا الْمطلب وأشباهه.
وَفِي مثل هَذَا يُقَال مَا قَالَه الشَّاعِر:
وَالنَّاس ألف مِنْهُم كواحدٍ
وَوَاحِد كالألف إِن أمر عنى( )
وَقَال الآخر:
وَلم أر أمْثَال الرِّجَال تَفَاوتا
من النَّاس حَتَّى عُدَّ ألفٌ بِوَاحِد( )
بل هَذَا الَّذِي تفضل الله [تعالى]( ) عَلَيْهِ بِهَذِهِ التفضلات لَا يعْدِلُه( ) الْألف وَلَا الآلاف( ) مِمَّن لم ينل مَا نَالَ، وَلَا ظفر بِشَيْء من هَذِه الْخِصَال.
فمالك والتلدد حول نجد
وَقد غَصت تهَامَة بِالرِّجَالِ( )
وَمن نظر فِي مثل «الْحِلْية» لأبي نعيم( )، و«صفوة الصفوة» لِابْنِ الْجَوْزِيّ، عرف صِحَة مَا ذَكرْنَاهُ، وَمَا كَانَ عَطاء رَبك مَحْظُورًا( ).
وَكم للصحابة رَضِي الله [تعالى]( ) عَنْهُم من الكرامات الَّتِي يصعب حصرها، وسنشير إِلَى بَعْضهَا قَرِيبًا، وَلَو لم يكن مِنْهَا إِلَّا إِجَابَة دُعَاء كثير مِنْهُم.
وَقد عرفناك أن إِجَابَة الدُّعَاء هِيَ أكبر كَرَامَة، وَمن أكْرمه الله [تعالى]( ) بذلك دَعَا بِمَا يَشَاء كَيفَ يَشَاء من جليل الْأُمُور وحقيرها، وكبيرها وصغيرها.
وَفِي كتب الحَدِيث وَالسير من ذَلِك الْكثير الطّيب، وَكَذَلِكَ فِي أُمَم الْأنْبِيَاء السَّابِقين من أوْلِيَاء الله [سُبْحَانَهُ]( ) الصَّالِحين الْعدَد الجم حَسْبَمَا نقل إِلَيْنَا عَن نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، وحسبما تحكيه التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل، ونبوات أنْبيَاء بني إِسْرَائِيل [الَّتِي] ( ) من جُمْلَتهَا الزبُور.
وَالْحَاصِل؛ أن الله سُبْحَانَهُ يتفضل على عباده بِمَا يَشَاء، وَالْفضل بِيَدِهِ، من شَاءَ أعطَاهُ، وَمن شَاءَ مَنعه. وَلَيْسَ لنا أن ننكر إِلَّا مَا أنكرته الشَّرِيعَة المطهرة. فَمن جَاءَ بِمَا يُخَالِفهَا دفعناه ومنعناه.
وَأما مُجَرّد استبعاد أن يهب الله سُبْحَانَهُ لبَعض عباده أمرًا عَظِيمًا وَيُعْطِيه، مَا تتقاصر عَنهُ قوى غَيره من الْمنح الجليلة، والتفضلات الجزيلة، فَلَيْسَ مرادات المتصفين بالإنصاف.
وَكَثِيرًا مَا ترى الجبان إِذا حكيت لَهُ أفعَال الْأفْرَاد من أهل الشجَاعَة من مقارعة الْأبْطَال، وملابسة الْأهْوَال، ومنازلة الْعدَد الْكثير من الرِّجَال يستبعد عقله ذَلِك ويضيق ذهنه عَن تصَوره ويظنه بَاطِلًا، وَلَا سَبَب لذَلِك إِلَّا أن غريزته المجبولة على الْجُبْن الخالع تقصر عَن أقل قَلِيل من ذَلِك وتعجز عَن الملابسة لأحقر [حقير]( ) مِنْهُ.
وَهَكَذَا الْبَخِيل إِذا سمع مَا يحْكى عَن الأجواد من الْجُود بالموجود والسماحة بالكثير الَّذِي تشح نفوس من لم يهب الله لَهُ غريزة الْكَرم المحمودة بِعشر معشاره، ظن أن تِلْكَ الحكايات من كذب الوراقين، وَمن مَخْرَقَةِ المُمَخْرِقِين.
وَهَكَذَا من قل حَظه من المعارف العلمية، وَقصر فهمه عَن إِدْرَاك الْفُنُون المتنوعة استبعد عقله، ونبا فهمه عَن قبُول مَا منح الله [تعالى]( ) بِهِ أكَابِر عُلَمَاء هَذِه الْأمة، من التَّوَسُّع فِي المعارف، [أ:15] والاستكثار من الْعُلُوم الْمُخْتَلفَة، وفهمها كَمَا يَنْبَغِي، وحفظها حق الْحِفْظ، وَالتَّصَرُّف الْكَامِل فِي كل مَا يرد عَلَيْهِ مِنْهَا، فيورده موارده، ويصدره مصادره.
فاعرف هَذَا، وَاعْلَم أن مواهب الله ۵ لِعِبَادِهِ لَيست بِموضع لاستبعاد المستبعدين، وتشكيكات المشككين، فقد تفضل على بعض عباده بِالنُّبُوَّةِ، واصطفاه لرسالته، وَجعله وَاسِطَة بَينه وَبَين عباده.
وتفضل على بعض عباده بِالْملكِ، وَجعله فَوق جَمِيع رَعيته، وَاخْتَارَهُ على من سواهُ مِنْهُم. وهم الْعدَد الجم، والسواد الْأعْظَم، وَقد يكون غير شرِيف الأصْل، وَلَا رفيع المحتد( )، كَمَا أعْطى ملك مصر وَالشَّام والحرمين وَغَيرهَا الْمُلُوك الجراكسة، وهم عبيد يجلب الْوَاحِد مِنْهُم إِلَى سوق الرَّقِيق، وَبعد حِين يصير ملكًا كَبِيرًا، وسلطانًا جَلِيلًا( ).
وَهَكَذَا من ملك قبلهم من الأتراك المماليك؛ كبني قلاوون، وَأعْطى بني بويه - وهم أوْلَاد سماك - [غَالبَ]( ) الممالك الإسلامية، وجعلهم الْحَاكِمين على الْخُلَفَاء العباسية، وعَلى سَائِر الْعباد فِي أقطار الأرْض.
دع عَنْك التفضلات على هَذَا النَّوْع الإنساني المكرم بِالْعقلِ، وَانْظُر إِلَى مَا منَّ بِهِ على أنْوَاع من مخلوقاته، فَإِن الشجَاعَة الَّتِي جعلهَا فِي الْأسد لَا يقوم لَهَا من بني آدم الْعدَد الْكثير، وَتلك موهبة من الله سُبْحَانَهُ، وَهَكَذَا كثير من أنْوَاع الْحَيَوَان يخْتَص هَذَا بِالْقُوَّةِ الباهرة، وَهَذَا بالجسم الوافر، وَهَذَا بِحسن التَّرْكِيب، وَهَذَا بالطيران فِي الْهَوَاء، وَهَذَا بِالْمَشْيِ فِي قَعْر الْبَحْر، وَالتَّصَرُّف لما يحْتَاج إِلَيْهِ فِي أمواج المَاء.
وَكم يعد الْعَاد من تفضلات الْملك الْجواد جلَّت قدرته، فسبحانه مَا أعظم شَأْنه وأعز سُلْطَانه وأجلّ إحسانه.
وَهَذَا عَارض من القَوْل اقْتَضَاهُ تقريب مَا يتفضل الله بِهِ على خُلَّص عباده إِلَى الأذهان الجامدة، والطبائع الراكدة؛ حَتَّى تتزلزل عَن مَرْكَز الْإِنْكَار، وَرَبك يخلق مَا يَشَاء ويختار.
وَمن نظر إِلَى مَا وهبه الله سُبْحَانَهُ للصحابة رَضِي الله [تعالى]( ) عَنْهُم، لم يستبعد شَيْئًا مِمَّا وهبه الله ۵ لأوليائه [أ:16] ويصعب الْإِحَاطَة بِأكْثَرَ ذَلِك فضلًا عَن كُله.
صور من كرامات السلف رحمهم الله:
وَقد قدمنَا الْإِشَارَة إِلَى كراماتهم إِجْمَالًا، وَنَذْكُر الْآن بعض كراماتهم على التَّفْصِيل وَالتَّعْيِين.
فَمِنْهَا: أن أسيد بن حُضَير رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ كَانَ يقْرَأ سُورَة الْكَهْف، فَنزلت عَلَيْهِ السكينَة من السَّمَاء مثل الظُّلة، فِيهَا أمْثَال السرج، وَهِي الْمَلَائِكَة، وَأخْبر بذلك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، فَقَالَ [لَهُ]( ): «لَو اسْتمرَّ على تِلَاوَته لاستمرت تِلْكَ السكينَة واقفة عَلَيْهِ بَاقِيَة عِنْده» ( ).
وَكَانَت الْمَلَائِكَة تسلم على عمرَان بن حُصَيْن( ). وَكَانَ سلمَان الْفَارِسِي وَأبُو الدَّرْدَاء يأكلان فِي صَحْفَة، فسبَّحت أو سبَّح( ) مَا فِيهَا( ).
وَخرج عباد بْن بشر وَأسيد بن حضير من عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم]( ) فِي ظلمَة اللَّيْل، فأضاء لَهما أطْرَاف السَّوْط، فَلَمَّا افْتَرقَا افترق الضَّوْء مَعَهُمَا( ).
وَكَانَ الصّديق رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ يَأْكُل هُوَ وأضيافه من الْقَصعَة، فَلَا يَأْكُلُون لقْمَة إِلَّا رَبا مِن أسْفَلهَا أكثر مِنْهَا، فشبعوا وَهِي أكثر مِمَّا كَانَ فِيهَا قبل أن يَأْكُلُوا( ).
وخُبَيْب بن عدي رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ، لما أسره الْمُشْركُونَ، كَانَ يُؤْتَى بقطف من الْعِنَب فِي غير وقته( ). وعامر بن فهَيْرَة [رَضِي الله تعالى عَنهُ]( )، التمسوا جسده، فحمته الدبر، وَلم يقدروا على الْوُصُول إِلَيْهِ( ).
وَخرجت أم أيمن [رَضِي الله تعالى عَنها]( )، وَهِي صَائِمَة، وَلَيْسَ مَعهَا زَاد وَلَا مَاء، فعطشت حَتَّى كَادَت تتْلف، فَلَمَّا كَانَ وَقت الْفطر سَمِعت حسًّا على رَأسهَا، فَرَفَعته، فَإِذا هُوَ دلو برشاء أبيض مُعَلّق، فَشَرِبت مِنْهُ حَتَّى رويت وَمَا عطشت بعْدهَا( ).
وَأخْبر سفينة مولى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم الْأسدَ أنه مولى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فَمشى مَعَه الْأسد حَتَّى أوصله إِلَى مقْصده( ).
والبراء بن مَالك [ﭬ]( )، كَانَ إِذا أقسم على الله أبر قسمه( ).
وَكَانَ الْحَرْب إِذا اشْتَدَّ على الْمُسلمين فِي الْجِهَاد يَقُولُونَ: يَا برَاء، أقسم على رَبك، فَيَقُول: أقسم عَلَيْك يَا رب لما منحتنا أكتافهم، وجعلتني أول شَهِيد، فمنحوا أكتفاهم، وَقتل شَهِيدًا( ).
وحاصر خَالِد بن الْوَلِيد رَضِي الله [تعالى]( ) [عَنهُ]( ) حصنًا، فَقَالُوا: لَا نسلم حَتَّى تشرب السم فشربه، وَلم يضرّه( ).
وَأرْسل عمر بن الْخطاب رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ جَيْشًا مَعَ رجل يُسمى سَارِيَة، فَبَيْنَمَا عمر يخْطب، جعل [عمر]( ) يَصِيح على الْمِنْبَر: يَا سَارِيَة، الْجَبَل، يَا سَارِيَة، الْجَبَل، فَقدم رَسُول الْجَيْش، فَسَألَهُ عمر، فَقَالَ: يَا أمِير الْمُؤمنِينَ، لَقينَا عدونا فهزمونا، فَإِذا بصائحٍ يَقُول: يَا سَارِيَة، الْجَبَل، يَا سَارِيَة، الْجَبَل، فأسندنا ظُهُورنَا [أ:18] بِالْجَبَلِ فهزمناهم( ).
وَلما عُذِّبَت بعض الصحابيات ذهب بصرها، فَقَالَ الْمُشْركُونَ: مَا أصَاب بصرها إِلَّا اللات والعزى، فَقَالَت: كلا وَالله، فردَّ الله [تعالى]( ) عَلَيْهَا بصرها( ).
وَكَانَ سعد بن أبي وَقاص رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ مجاب الدعْوَة، مَا دَعَا قَطٍّ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ( ). وَكَذَلِكَ سعيد بن زيد ﭬ، دَعَا على الْمَرْأة لما كذبت عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِن كَانَت كَاذِبَة فأعم بصرها، واقتلها فِي أرْضهَا، فعميت وَوَقعت فِي حفيرة فِي أرْضهَا فَمَاتَتْ( ).
ودعا اللهَ الْعَلَاءُ بن الْحَضْرَمِيّ بِأن يسقوا ويتوضئوا، لما عدموا المَاء، وَلَا يبْقى بعدهمْ، فَأُجِيب. ودعا لما اعْتَرَضَهُمْ الْبَحْر، وَلم يقدروا على الْمُرُور، فَمروا بخيولهم على المَاء، مَا ابتلت سروج خيولهم( ). ودعا اللهَ بِأن لَا يرَوا جسده إِذا مَاتَ، فَلم يجدوه فِي اللَّحْد( ).
وَكَانَ للتابعين من الكرامات مَا هُوَ مَعْرُوف فِي كتب هَذَا الشَّأْن حَسْبَمَا قدمنَا الْإِشَارَة إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ من بعدهمْ.
وَقد كَانَ فِي التَّابِعين من ألْقي فِي النَّار، فَوجدَ قَائِمًا يُصَلِّي، وَهُوَ أبُو مُسلم الْخَولَانِيّ( ). وَلما قدم الْمَدِينَة جعله عمر بَينه وَبَين أبي بكر، وَقَالَ: الْحَمد لله الَّذِي لم يُمِتْنِي حَتَّى أرَانِي من أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم من فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بإبراهيم( ).
ودعا على امْرَأة أفسدت عَلَيْهِ زَوجته فعميت فتابت، فَدَعَا لَهَا فَرد الله عَلَيْهَا بصرها( ). وَمِنْهُم من وضع رجله على رَقَبَة الْأسد حَتَّى مرت الْقَافِلَة، وَهُوَ عَامر بْن عبد قيس( ).
وَمِنْهُم من مَاتَ فرسه فِي الْغَزْو، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تجْعَل لمخلوق علي منَّة، ودعا الله فأحياه، فَلَمَّا وصل [إِلَى بَيته]( )، قَالَ: يَا بني خُذ سرج الْفرس، فَإِنَّهُ عَارِية، فَأخذ سَرْجه، فَمَاتَ، وَهُوَ صلَة بن أشْيَم( ).
وَكَانَ سعيد بن الْمسيب لما خلى فِي الْمَسْجِد أيَّام الْحرَّة، سمع الْأذَان من قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم( ). وَكَانَ عمر بن عتبَة بن فرقد يُصَلِّي يَوْمًا فِي شدَّة الْحر، فأظلته غمامة( ).
وَكَانَ مطرف بن عبدالله الشخير إِذا دخل بَيته، سبحت مَعَه آنيته( ). وَلما مَاتَ الْأحْنَف بن قيس، وَقعت قلنسوة رجل فِي قَبره، فَأهوى ليأخذها، فَوجدَ الْقَبْر قد فسح فِيهِ مد الْبَصَر( ).
وأويس الْقَرنِي، وجدوا لما مَاتَ فِي ثِيَابه أكفانًا لم تكن مَعَه من قبل، ووجدوا لَهُ قبرًا محفورًا فِي صَخْرَة، فدفنوه فِيهِ، وكفنوه فِي تِلْكَ الأثواب( ).
وَكَانَ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ يُقيم الشَّهْر والشهرين لَا يَأْكُل شَيْئًا( ). وَخرج يمتار لأهله طَعَامًا، فَلم يقدر عَلَيْهِ ، فَأخذ من مَوضِع تُرَابًا أحْمَر، ثمَّ رَجَعَ إِلَى أهله، ففتحوها فَإِذا هِيَ حِنْطَة حَمْرَاء. وَكَانَ إِذا زرع مِنْهَا تخرج السنابل من أصْلهَا إِلَى فرعها حبًّا متراكبًا( ).
وَأصَاب عبدالْوَاحِد بن زيد الفالجُ، فَسَألَ ربه أن يُطلق أعضاءه وَقت الْوضُوء، فَكَانَ وَقت الْوضُوء تطلق لَهُ أعضاؤه، ثمَّ تعود بعده ،( ) وَغير ذَلِك كثير.
محل الكرامة :
وَالْحَاصِل؛ أن من كَانَ من الْمَعْدُودين( ) من الْأوْلِيَاء، إِن كَانَ من الْمُؤمنِينَ بِاللَّه وَمَلَائِكَته وَكتبه وَرُسُله، وَالْقدر خَيره وشره، مُقيمًا لما أوجب الله [تعالى]( ) عَلَيْهِ، تَارِكًا لما نَهَاهُ الله عَنهُ، مُستكثرًا من طاعاته، فَهُوَ من أوْلِيَاء الله سُبْحَانَهُ، وَمَا ظهر عَلَيْهِ من الكرامات الَّتِي لم تخَالف الشَّرْع، فَهِيَ موهبة من الله ۵، لَا يحل لمُسلم أن ينكرها.
وَمن كَانَ بعكس هَذِه الصِّفَات، فَلَيْسَ من أوْلِيَاء الله سُبْحَانَهُ، وَلَيْسَت ولَايَته رحمانية بل شيطانية، وكراماته من تلبيس الشَّيْطَان عَلَيْهِ وعَلى النَّاس.
وَلَيْسَ هَذَا بغريب وَلَا مستنكر، فكثير( ) من النَّاس من يكون مخدومًا بخادم من الْجِنّ أو بِأكْثَرَ، فيخدمونه فِي تَحْصِيل مَا يشتهيه، وَرُبمَا كَانَ محرمًا من الْمُحرمَات، وَقد قدمنَا أن المعيار الَّذِي لَا يزِيغ، وَالْمِيزَان الَّذِي لَا يجور، هُوَ ميزَان الْكتاب وَالسّنة.
فَمن كَانَ مُتَّبعًا لَهَما، مُعْتَمدًا عَلَيْهِمَا، فكراماته وَجَمِيع أحْوَاله رحمانية، وَمن لم يتَمَسَّك بهما، وَيقف عِنْد حدودهما، فأحواله شيطانية، فَلَا نطيل الْكَلَام فِي هَذَا الْمقَام، ولنعد إِلَى شرح الحَدِيث الَّذِي نَحن بصدد الْكَلَام عَلَيْهِ.
استشكال المعاداة من جانب الولى :
فَنَقُول: قَالَ ابْن حجر فِي «فتح الْبَارِي»( ): وَقد اسْتشْكل وجود أحد يعاديه يَعْنِي الْوَلِيّ، لِأن المعاداة، إِنَّمَا تقع من الْجَانِبَيْنِ، وَمن شَأْن الْوَلِيّ الْحلم والصفح عَمَّن يجهل عَلَيْهِ.
وَأجِيب: بِأن المعاداة لم تَنْحَصِر فِي الْخُصُومَة والمعاملة الدُّنْيَوِيَّة مثلًا، بل قد تقع عَن بغض ينشأ عَن التعصب، كالرافضيِّ فِي بغضه لأبي بكر، والمبتدع فِي بغضه للسني، فَتَقَع المعاداة من الْجَانِبَيْنِ. أما من جَانب الْوَلِيّ: فَللَّه تَعَالَى وَفِي الله، وَأما من جَانب الآخر فَلَمَّا تقدم. وَكَذَا الْفَاسِق المتجاهر يبغضه الْوَلِيّ، ويبغضه الآخر لإنكاره عَلَيْهِ وملازمته لنَهْيه عَن شهواته.
وَقد تطلق المعاداة، وَيُرَاد بهَا الْوُقُوع من أحد الْجَانِبَيْنِ بِالْفِعْلِ، وَمن الآخر بِالْقُوَّةِ. انْتهى .
وَأقُول: مَعْلُوم أن غَالب العداوات الدِّينِيَّة لَا تكون إِلَّا بَين المتبع والمبتدع وَالْمُؤمن وَالْفَاسِق، والصالح والطالح، والعالم وَالْجَاهِل، وأولياء الله سُبْحَانَهُ وأعدائه. وَمثل هَذَا من الوضوح بِحَيْثُ لَا يحْتَاج إِلَى سُؤال، وَلَا ينشأ عَنهُ إِشْكَال.
وَالْوَلِيّ لَا يكون وليًّا لله؛ حَتَّى يبغض أعدَاء الله ويعاديهم( )، وينكر عَلَيْهِم، فمعاداتهم وَالْإِنْكَار عَلَيْهِم هُوَ من تَمام ولَايَته، وَمِمَّا تترتب صِحَّتهَا عَلَيْهِ.
وأولياء الله سُبْحَانَهُ هم أحَق عباد الله بِالْقيامِ فِي هَذَا الْمقَام اقْتِدَاءً برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، فَإِنَّهُ كَانَ إِذا غضب لله احمرَّ وَجهه، وَعلا صَوته حَتَّى كَأنَّهُ مُنْذر جَيش، يَقُول: صبَّحكم مسَّاكم( )، وَهَكَذَا المعاداة من الْمُؤمن لِلْفَاسِقِ، وَمن الْفَاسِق لِلْمُؤمنِ.
فَإِن الْمُؤمن يعاديه لما أوجب الله عَلَيْهِ من عداوته، ولكراهته لما هُوَ عَلَيْهِ من الْوُقُوع فِي معاصي الله سُبْحَانَهُ، والانتهاك لمحارمه، وتعدي حُدُوده.
وَالْفَاسِق قد يعاديه لإنكاره عَلَيْهِ ولخوفه من قِيَامه عَلَيْهِ، وَقد يكون ذَلِك لما جرت بِهِ عَادَة الْفُسَّاق من الإزراء بِمن يكثر من طَاعَة الله والسخرية بهم، كَمَا يعرف ذَلِك من يعرف أحْوَالهم، فَإِنَّهُم يعدون مَا هم فِيهِ من اللّعب وَاللَّهْو، هُوَ الْعَيْش الصافي، والمنهج الَّذِي يختاره الْعُقَلَاء، ويعدون المشتغلين بِطَاعَة الله [تعالى]( ) من أهل الرِّيَاء والتلصص لاقتناص الْأمْوَال.
وَأما الْعَدَاوَة بَين الْعَالم وَالْجَاهِل( ) فَأمرهَا وَاضح، فالعالم يرغب عَنهُ ويعاديه لما هُوَ عَلَيْهِ من الْجَهْل للدّين، وَعدم الْقيام بِمَا يحْتَاج إِلَيْهِ من كَانَ من الْمُسلمين.
وَالْجَاهِل يعاديه لكَونه قد فَازَ بِتِلْكَ المزية الجليلة، والخصلة النبيلة الَّتِي هِيَ أشرف خِصَال الدّين( ):
فمنزلة السَّفِيه من الْفَقِيه
كمنزلة الْفَقِيه من السَّفِيه
فَهَذَا زاهد فِي حق هَذَا
وَهَذَا فِيهِ أزهد مِنْهُ فِيهِ( )
0
وَأما الْعَدَاوَة بَين المتبع والمبتدع فَأمرهَا أوضح من الشَّمْس، فَإِن المتبع يعادي المبتدع لبدعته، والمبتدع يعادي المتبع لاتباعه، وَكَونه على الصَّوَاب، والتمسك بالبدع يعمي بصائر أهلهَا، فيظن أن مَا هُوَ عَلَيْهِ من الضَّلَالَة هُوَ الْحق الَّذِي لَا شُبْهَة فِيهِ، وَأن المتبع للْكتاب وَالسّنة على ضَلَالَة.
وَقد تبلغ عداوات أهل الْبدع لغَيرهم من أهل الِاتِّبَاع فَوق عداوتهم للْيَهُود وَالنَّصَارَى، وَلَا شكّ أن أوْلِيَاء الله سُبْحَانَهُ لَهُم من منصب الْإِيمَان وَالْعلم والاتباع النصيب الأوفر.
فأعداؤهم يكثرون لِكَثْرَة مَا منحهم الله من الْخِصَال الشَّرِيفَة، ويحسدونهم زِيَادَة على مَا يحسدون أهل الْفَضَائِل لاجتماعها لديهم، مَعَ فوزهم بِالْقربِ من الله [تعالى]( ) بِمَا فتح الله عَلَيْهِم بِهِ( ) من طاعاته؛ فرائضها ونوافلها.
وهم أيْضًا يكْرهُونَ أعدَاء الله لوُجُود المقتضيات لديهم لكراهتهم؛ من الْإِيمَان وَالْعلم وَالْعَمَل الصَّالح، وتقوى الله سُبْحَانَهُ على الْوَجْه الأتم.
وَإِذا الْتبس عَلَيْك هَذَا، فَانْظُر فِي تَمْثِيل يقربهُ إِلَيْك، وَهُوَ أن من كَانَ لَهُ حَظّ من سُلْطَان كثر أعداؤه حسدًا لَهُ على تِلْكَ الْمنزلَة الدُّنْيَوِيَّة.
وَمن كَانَ رَأْسًا فِي الْعلم عَادَاهُ غَالب الْمُقَصِّرِينَ، لَا سِيمَا إِذا خَالف مَا يعتقدونه حَقًّا، وَجُمْهُور الْعَامَّة تبعًا لَهُم؛ لأنهم ينظرُونَ إِلَى كثرتهم، وَالْقِيَام بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من الْفَتَاوَى وَالْقَضَاء، مَعَ تلبيسهم عَلَيْهِم بعيوب مفتراة لذَلِك الْعَالم الَّذِي وصل إِلَى مَا لَا يعرفونه، وَبلغ إِلَى مَا يقصرون عَنهُ، أقل الْأحْوَال أن يلْقوا إِلَيْهِم بِأنَّهُ يُخَالف مَا هم عَلَيْهِ هم وآباؤهم، وَمَا مضى عَلَيْهِ سلفهم.
وَهَذِه؛ وَإِن كَانَت شكاة ظَاهر عَن ذَلِك الْعَالم عارها، لَكِنَّهَا تقع من قبُول الْعَامَّة لَهَا فِي أعلَى مَحل، وتثير من شرهم مَا لا يقادر قدره. وَهَذَا كَائِن فِي غَالب الْأزْمَان من غَالب نوع الْإِنْسَان.
قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي [الْإِيضَاح]( ): قَوْله: «عادى لي وليًّا»، أي: اتَّخذهُ عدوًّا، وَلَا أرى الْمَعْنى، إِلَّا أنه عَادَاهُ من أجل ولَايَته، وَهُوَ وإِن تضمن التحذير من إِيذَاء قُلُوب أوْلِيَاء الله تَعَالَى، فَلَيْسَ على إِطْلَاقه، بل يسْتَثْنى مِنْهُ مَا إِذا كَانَت الْحَال تَقْتَضِي نزاعًا بَين وليين فِي مخاصمة أو محاكمة، وَترجع إِلَى اسْتِخْرَاج حق، أو كشف غامض. فَإِنَّهُ جرى( ) بَين أبي بكر وَعمر مشاجرة( ) ، وَبَين الْعَبَّاس وعَلِيِّ( )، إِلَى غير ذَلِك من الوقائع.
وَتعقبه الْفَاكِهَانِيّ: بَأن معاداة الْوَلِيّ لَا تفهم إِلَّا إِذا كَانَ على طَرِيق الْحَسَد الَّذِي هُوَ تمني زَوَال ولَايَته، وَهُوَ بعيد جدًّا فِي حق الْوَلِيّ، فَتَأمّله. قَالَ ابْن حجر: وَالَّذِي قَدمته أولى أن يعْتَمد( ). انْتهى.
قلت: أما الْمُخَاصمَة [أ:21] فِي الْأمْوَال والدماء، فَهِيَ مُسْتَثْنَاة؛ سَوَاء كَانَت بَين وليين، أو بَين الْوَلِيّ وَغَيره، فَمن ادّعى عَلَيْهِ بِمَا يلْزمه التَّخَلُّص عَنهُ شرعًا، وَلم يكن ذَلِك لمُجَرّد التعنت، فَحق على ذَلِك الْوَلِيّ، أن يتَخَلَّص مِمَّا يجب عَلَيْهِ، وَلَا يحرج بِهِ صَدره، وَلَا يتَأذَّى بِهِ قلبه، فَإِن التأذي من التَّخَلُّص عَن الْحُقُوق الْوَاجِبَة لَيْسَ [من]( ) دأب الْأوْلِيَاء، ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النساء:65].
وتحكيم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم هُوَ تحكيم مَا جَاءَ بِهِ من الشَّرِيعَة المطهرة، وَهِي مَوْجُودَة فِي كتاب الله سُبْحَانَهُ، وَفِي سنة رَسُوله( ) صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، وهما باقيان إِلَى هَذِه الْغَايَة بَين أظهر الْمُسلمين، وَالْعُلَمَاء العارفون بِمَا فيهمَا، موجودون فِي كل أقطار الأرْض.
فَإِذا حكم حَاكم مِنْهُم على الْوَلِيّ بِمَا يجب عَلَيْهِ فِي كتاب الله سُبْحَانَهُ، وَفِي سنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، فالامتثال عَلَيْهِ أوجب من الِامْتِثَال على غَيره؛ لارْتِفَاع رتبته ومزيد [خصوصية]( )؛ بِكَوْنِهِ وليًّا لله سُبْحَانَهُ، فَإِذا حرج صَدره من ذَلِك وتأذى بِهِ، فَهُوَ قَادِح فِي ولَايَته، وَلَيْسَ على المخاصم لَهُ وَلَا على الْحَاكِم الَّذِي حكم عَلَيْهِ شَيْء من الْإِثْم.
معيار الولاية:
وَقد قدمنَا أن المعيار الَّذِي تعرف بِهِ صِحَة ولَايَته، هُوَ أن يكون عَاملًا بِكِتَاب الله سُبْحَانَهُ وبسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، مؤثرًا لَهما على كل شَيْء، مقدمًا لَهما فِي إصداره وإيراده، وَفِي كل شئونه، فَإِذا زاغ عَنْهُمَا زاغت عَنهُ الْولَايَة.
وَانْظُر مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ هَذِه الْآيَة الشَّرِيفَة مِمَّا هُوَ موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين، فَإِنَّهُ أولًا بَدَأ فِيهَا بالقسم الرباني، وَأقسم بِنَفسِهِ ۵ وتقدس، مُشَرفًا لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم بِإِضَافَة الربوبية إِلَيْهِ، جَازِمًا بِنَفي الْإِيمَان عَمَّن خَالف هَذَا الْقسم الرباني، فَقَالَ: ﴿ﯞ ﯟ﴾.
ثمَّ جعل لذَلِك غَايَة، هِيَ تحكيمه صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فِيمَا شجر بَين الْعباد. ثمَّ لم يكتف بذلك حَتَّى قَالَ: ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾.
فَلَا ينفع مُجَرّد التَّحْكِيم لكتاب الله سُبْحَانَهُ ولسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، حَتَّى لَا يكون فِي صدر الْمُحكم لَهما حرجًا من ذَلِك الْقَضَاء. ثمَّ لم يكتف بذلك، حَتَّى قَالَ: ﴿ﯭ﴾.
فَلَا ينفع مُجَرّد التَّحْكِيم لَهما مَعَ عدم الْحَرج من الحكم عَلَيْهِ بهما، حَتَّى يسلم مَا عَلَيْهِ مِمَّا أوجبه الْقَضَاء بهما( )، ثمَّ جَاءَ بالتأكيد [أ:22] لهَذَا التَّسْلِيم الْمُفِيد أنه أمر لَا مخلص عَنهُ، وَلَا خُرُوج مِنْهُ.
فَكيف يجد من كَانَ وليًّا لله سُبْحَانَهُ حرجًا فِي صَدره على خَصمه المطالب لَهُ بِحَق يحِق عَلَيْهِ التَّخَلُّص مِنْهُ، أو على حاكمه الَّذِي حكم بِهِ عَلَيْهِ؟ فَإِن هَذَا لَيْسَ بصنيع أهل الْإِيمَان بِاللَّه، فَكيف بأوليائه الَّذين ضمُّوا إِلَى الْإِيمَان مَا استحقوا بِهِ اسْم الْولَايَة الرحمانية، والمزية الربانية ( )؟!.
وَلَكِن هَذَا إِذا كَانَ الْخصم يعلم( ) أنه محق فِي طلبه، وَأن ذَلِك الْحق ثَابت لَهُ لَا محَالة، فَإِن القَاضِي إِنَّمَا يقْضِي لَهُ بِالظَّاهِرِ الشَّرْعِيّ( )، كَمَا ثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا أنه قَالَ: «إِنَّكُم تختصمون إليّ، وَلَعَلَّ بَعْضكُم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وَإِنَّمَا أقْضِي بِنَحْوِ مَا أسمع، فَمن قضيت لَهُ من حق أخِيه شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذهُ، فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار»( ).
فَهَذَا يَقُوله الصَّادِق المصدوق سيد ولد آدم، الْمَبْعُوث إِلَى جَمِيع الْعَالم، إنسهم وجنهم، وَقد أخبرنَا بِأنَّهُ( ) إِذا قضى بِشَيْء مِمَّا سَمعه، وَكَانَ الْبَاطِل بِخِلَافِهِ، لم يجز للمحكوم لَهُ أن يَأْخُذهُ، بل هُوَ قِطْعَة من النَّار، فَكيف بِمن هُوَ مَظَنَّة للخطأ، وَمحل للإصابة تَارَة ولغيرها أُخْرَى، وبمن لَا عصمَة لَهُ، وَلَا وَحي ينزل عَلَيْهِ؟
وَقد صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا أنه قَالَ: «إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب، فَلهُ أجْرَانِ، وَإِن اجْتهد فَأخْطَأ، فَلهُ أجر»( ).
فَكل حَاكم من حكام الْمُسلمين [يتَرَدَّد]( ) حكمه بَين الصَّوَاب وَالْخَطَأ، وَلكنه مأجور على كل حَال( )؛ لِأن ذَلِك فَرْضه الْوَاجِب عَلَيْهِ، وَلَا يحل للمحكوم لَهُ أن يسْتَحل مَال خَصمه بِمُجَرَّد الحكم، كَمَا قضى بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فِي أحْكَامه الشَّرِيفَة، فَكيف بِأحْكَام غَيره من حكام أمته؟
وَقد ثَبت فِي السّنَن وَغَيرهَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «إِن الْقُضَاة ثَلَاثَة؛ قاضيان فِي النَّار، وقاض فِي الْجنَّة، فَالَّذِي فِي الْجنَّة رجل علم بِالْحَقِّ( ) وَقضى بِهِ، والقاضيان اللَّذَان( ) هما فِي النَّار: رجل قضى للنَّاس بِجَهْل، فَهُوَ فِي النَّار، وَرجل علم الْحق وَقضى بِخِلَافِهِ، فَهُوَ فِي النَّار»( ).
وَبِهَذَا تعرف أن الْخصم المحاكم للْوَلِيّ، إِذا كَانَ يعلم أنه لَا حقَّ لَهُ عَلَيْهِ، وَأن دَعْوَاهُ بَاطِلَة، فَهُوَ دَاخل تَحت قَوْله: «من عادى لي وليًّا»؛ لِأن دَعْوَاهُ الْبَاطِلَة على الْوَلِيّ معاداة لَهُ ظَاهِرَة، فَاسْتحقَّ الْحَرْب الَّذِي توعده الله سُبْحَانَهُ بِهِ فِي هَذَا الحَدِيث. [أ:23].
وَأما القَاضِي إِذا قضى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ فِي ظَنّه [حق مُوَافق]( ) للْكتاب وَالسّنة، واجتهد فِي الْبَحْث والفحص، وَكَانَ أهلًا للْحكم، فَلَيْسَ ذَلِك مِنْهُ معاداة للْوَلِيّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ من تأذيه بِحكمِهِ شَيْء، فَهُوَ قد حكم بالشريعة المطهرة، وَاسْتحق أجْرَيْنِ أو أجرًا، وامتثل مَا أرشده( ) إِلَيْهِ الصَّادِق المصدوق صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم.
وَهَاهُنَا نُكْتَة يَنْبَغِي التنبه لَهَا من كل أحد من أهل الْعلم، وَهِي أن لفظ الشَّرِيعَة إِن أُرِيد بِهِ الْكتاب وَالسّنة، لم يكن لأحد من أوْلِيَاء الله تَعَالَى وَلَا من غَيرهم أن يخرج مِنْهُ، وَلَا يُخَالِفهُ بِوَجْه من الْوُجُوه، وَإِن أُرِيد بِهِ حكم الْحَاكِم، فقد يكون صَوَابًا، وَقد يكون خطأ، كَمَا بَينه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي الحَدِيث السَّابِق بِالْمَعْنَى الأول. [ولَيْسَ]( ) لأحد أن يخرج عَنهُ، وَمن خرج عَنهُ فَهُوَ كَافِر( ).
وَمن ظن أن لأحد من أوْلِيَاء الله سبحانه طَرِيقًا إِلَى الله تَعَالَى غير الْكتاب وَالسّنة، وَاتِّبَاع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، فَهُوَ كَاذِب. وَقد غلط كثير من النَّاس، فَجعلُوا الشَّرِيعَة شَامِلَة للقسمين( )، وَمَا أقبح هَذَا الْغَلَط، وَأشد عاقبته، وَأعظم خطره.
التفريق بين ما هو كونى وما هو دينى :
وكما وَقع الِاشْتِبَاه بَين هذَيْن الْقسمَيْنِ، وَقع الِاشْتِبَاه أيْضًا بَين شَيْئَيْنِ آخَرين، وَإِن كَانَا خَارِجين عَمَّا نَحن بصدده، وَهُوَ الْفرق بَين الْإِرَادَة الكونية، والإرادة الدِّينِيَّة، وَبَين الْأمر الكوني، وَالْأمر الديني، وَبَين الْإِذْن الكوني، وَالْإِذْن الديني، وَبَين الْقَضَاء الكوني وَالْقَضَاء الديني، والبعث الكوني، والبعث الديني، والإرسال الكوني، والإرسال الديني، والجعل الكوني، والجعل الديني، وَالتَّحْرِيم الكوني، وَالتَّحْرِيم الديني، وَبَين الْحَقِيقَة الكونية، والحقيقة الدِّينِيَّة.
وَالْفرق بَين هَذِه الْأُمُور وَاضح، وَإِن اشْتبهَ على طَائِفَة من أهل الْعلم فخبطوا وخلطوا.
وَبَيَان ذَلِك: أن الله سُبْحَانَهُ لَهُ الْخلق وَالْأمر، كَمَا قَالَ: ﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [الأعراف: 54].
فَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالق كل شَيْء وربه ومليكه، لَا خَالق غَيره، وَلَا رب سواهُ، مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لم يَشَأْ لم يكن. وكل مَا فِي الْوُجُود من حَرَكَة وَسُكُون بِقَضَائِهِ وَقدره ومشيئته وَقدرته وإرادته وخلقه، وَهُوَ سُبْحَانَهُ أمر بِطَاعَتِهِ وَطَاعَة رَسُوله، وَنهى عَن الشّرك بِاللَّه سُبْحَانَهُ.
فأعظم الطَّاعَات التَّوْحِيد لَهُ وَالْإِخْلَاص، وَأعظم الْمعاصِي الشّرك ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [النساء: 48]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [البقرة: 165].
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، أي الذَّنب أعظم؟ قَالَ: «أن تجْعَل لله ندًّا وَهُوَ خلقك»، قلت: ثمَّ أي؟ قَالَ: «أن تقتل ولدك خشيَة أن تطعمه مَعَك»، قلت: ثمَّ أي! قَالَ: «أن تَزني بحليلة جَارك». فَأنْزل الله [تعالى]( ) تَصْدِيق ذَلِك: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ [ﭵ]( ) ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الفرقان: 68- 70].
وَأمر الله سُبْحَانَهُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان، وإيتاء ذِي الْقُرْبَى، وَنهى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَالْبَغي، وَأخْبر أنه يحب الْمُتَّقِينَ والْمُحْسِنِينَ( )، وَيُحب التوابين وَيُحب المتطهرين، وَيُحب الَّذين يُقَاتلُون فِي سَبيله صفًّا كَأنَّهُمْ بُنيان مرصوص، وَهُوَ يكره مَا نهى عَنهُ، كَمَا قَالَ: ﴿ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾ [الإسراء: 38].
وَقد نهى عَن الشّرك وعقوق الْوَالِدين، وَأمر بإيتاء ذوي( ) الْحُقُوق، وَنهى عَن التبذير والتقتير، وَأن يَجْعَل يَده مغلولة إِلَى عُنُقه، وَأن لَا يبسطها كل الْبسط، وَنهى عَن قتل النَّفس بِغَيْر حق وَ[عَن]( ) قرْبَان مَال الْيَتِيم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أحسن إِلَى أن قَالَ: ﴿ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾ [الإسراء: 38]. وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يحب الْفساد وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر.
وَالْعَبْد مَأْمُور أن يَتُوب إِلَى الله سُبْحَانَهُ، وَقَالَ: ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [الزلزلة:7، 8]. وَقَالَ: ﴿ﭑ ﭒ( ) ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [آل عمران: 133- 135].
فَمَا خلقه الله سُبْحَانَهُ وَقدره وقضاه فَهُوَ يُريدهُ، وَإِن كَانَ لَا يَأْمر بِهِ وَلَا يُحِبهُ وَلَا يرضاه، وَلَا يثيب أصْحَابه، وَلَا يجعلهم من أوليائه.
وَمَا أمر بِهِ وشرعه وأحبه ورضيه وَأحب فَاعله وأثابهم وَأكْرمهمْ عَلَيْهِ، فَهُوَ الَّذِي يُحِبهُ ويرضاه، ويثيب فَاعله عَلَيْهِ( ).
فالإرادة الكونية، وَالْأمر الكوني: وَهِي مَشِيئَته لما خلقه من جَمِيع مخلوقاته إنسهم وجنهم، مسلمهم وكافرهم، حيوانهم وجمادهم، ضارهم ونافعهم.
والإرادة الدِّينِيَّة وَالْأمر الديني: هِيَ محبته المتناولة لجَمِيع مَا أمر بِهِ [أ:25] وَجعله شرعًا ودينًا، فَهَذِهِ مُخْتَصَّة بِالْإِيمَان وَالْعَمَل الصَّالح.
صور من الإرادة الكونية والإرادة الدينية:
فَمن الْإِرَادَة الأولى - أعنِي: الكونية -: قَول الله سُبْحَانَهُ: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [الأنعام: 125]. وَقَول نوح [عليه السلام]( ): ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [هود: 34]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [الرعد: 11].
وَمن الْإِرَادَة الدِّينِيَّة: قَوْله: ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [البقرة: 185]، وَقَوله تَعَالَى: ﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ( ) ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [المائدة: 6]. وَقَوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [النساء:26- 28]. وَقَوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [الأحزاب: 33].
وَمن الْأمر الكوني: قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿ﯥ ﯦ( ) ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النحل: 40]، وَقَوله: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [القمر: 50]، وَقَوله: ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [يونس: 24].
وَمن الْأمر الديني: قَوْله سُبْحَانَهُ: ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [النحل: 90]، وَقَوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [النساء: 58].
وَمن الْإِذْن الكوني: قَوْله تَعَالَى: ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [البقرة: 102]؛ أي: بمشيئته وَقدرته، وَإِلَّا فالسحر لَا يبيحه الله [تعالى]( ).
وَقَالَ تَعَالَى: فِي الْإِذْن الديني: ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [الأحزاب:45، 46]، وَقَالَ: ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [النساء: 64]، وَقَالَ: ﴿ﭟ( ) ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [الحشر: 5].
وَمن الْقَضَاء الكوني: قَوْله تَعَالَى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [فُصِّلَت: 12]، وَقَوله: ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [آل عمران: 47].
وَمن الْقَضَاء الديني: قَوْله سُبْحَانَهُ ﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الإسراء: 23]، أي: أمر، وَلَيْسَ المُرَاد قدَّر، فَإِنَّهُم قد عبدُوا غَيره، كَقَوْلِه: ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [يونس: 18]، وَقَول الْخَلِيل عَلَيْهِ السَّلَام: ﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [الشعراء:75- 77]، وَقَوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [الممتحنة: 4]، وَقَوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [الكافرون:1، 2] إِلَى آخر السُّورَة.
وَمن الْبَعْث الكوني: [أ:26] قَوْله سُبْحَانَهُ: ﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [الإسراء: 5].
وَمن الْبَعْث الديني: قَوْله سُبْحَانَهُ: ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ [ﭤ]( ) ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [الجمعة: 2].
وَقَوله ۵: ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [النحل: 36].
وَمن الْإِرْسَال الكوني: قَوْله تَعَالَى: ﴿[ ﮄ ﮅ]( ) ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [مريم: 83]، وَقَوله: ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [الفرقان: 48].
وَمن الْإِرْسَال الديني: قَوْله سُبْحَانَهُ ( ): ﴿[ﭛ ﭜ]( ) ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [الأحزاب: 45]، وقوله تَعَالَى: ﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [المزَّمل: 15].
وَمن الْجعل الكوني: قَوْله سُبْحَانَهُ: ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [القصص: 41].
وَمن الْجعل الديني: قَوْله سُبْحَانَهُ: ﴿ﮚ ﮛ[ﮜ]( ) ﮝ ﮞ﴾ [المائدة: 48]، وَقَوله تَعَالَى: ﴿ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [المائدة: 103].
وَمن التَّحْرِيم الكوني: قَوْله تَعَالَى: ﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [القصص: 12]، وَقَوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [المائدة: 26].
وَمن التَّحْرِيم الديني: قَوْله ۵: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [المائدة: 3]، وَقَوله ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [النساء: 23]، وَقَوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [الأنعام: 145]، وَقَوله تَعَالَى: ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ [ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ]( )﴾ [الأعراف: 33]. فَجَمِيع مَا تقدم يُقَال لما كَانَ كونيًا مِنْهُ حَقِيقَة كونية، وَلما كَانَ دينيًّا مِنْهُ حَقِيقَة دينية( ).
نفي القدر :
وَإِذا عرفت هَذَا؛ فَاعْلَم أن من ظن أن الْقدر حجَّة لأهل الْمعاصِي فقد غلط غَلطًا بَينًا، واقتدى بِأهْل الْكفْر الَّذين حكى الله [تعالى]( ) عَنْهُم، أنهم قَالُوا: ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [الأنعام: 148]، ثمَّ قَالَ: ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ( ) ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ( ) ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [الأنعام: 148، 149].
وَلَو كَانَ الْقدر حجَّة، لم يعذب الله سُبْحَانَهُ المكذبين للرسل؛ كقوم نوح وَعَاد وَثَمُود وَقوم فِرْعَوْن وَغَيرهم، وَلم يَأْمر بِإِقَامَة الْحُدُود على العصاة المرتكبين لَهَا، وَلَا يحْتَج أحد بِالْقدرِ إِلَّا إِذا كَانَ مُتبعًا لهواه بِغَيْر هدى من الله.
وَمن ظن ذَلِك فَعَلَيهِ أن لَا يذم كَافِرًا وَلَا عَاصِيًا، وَلَا يُعَاقِبهُ إِذا اعْتدى عَلَيْهِ، وَلَا يفرق بَين من يفعل الْخَيْر، وَمن يفعل الشَّرّ، وَهَذَا خلاف مَا تَقْتَضِيه عقول جَمِيع الْعُقَلَاء، وَمَا تَقْتَضِيه جَمِيع كتب الله [تعالى]( ) الْمنزلَة، وَمَا تَقْتَضِيه كَلِمَات أنْبيَاء الله عَلَيْهِم [الصلاة و]( ) السَّلَام.
فَلَا تمسك بعقل وَلَا شرع، وَقد قَالَ الله سُبْحَانَهُ [وتعالى]( ): [﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [الجاثية: 21]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ﮮ[أ:27] ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [المؤمنون:115]]( )، وَغير ذَلِك من الْآيَات القرآنية وَالْأحَادِيث الصَّحِيحَة.
وَمن ظن أن فِي مُحَاجَّة آدم ومُوسَى حجَّة للمحتجين بِالْقدرِ حَيْثُ قَالَ مُوسَى: أنْت أبُو الْبشر، خلقك الله بِيَدِهِ، وَنفخ فِيك من روحه، وأسجد لَك مَلَائكَته، أخرجتنا ونفسك من الْجنَّة، فَقَالَ لَهُ آدم: أنْت الَّذِي اصطفاك الله بِكَلَامِهِ، وَكتب لَك التَّوْرَاة بِيَدِهِ، فَلم تلومني على أمر قدره الله عَليّ قبل أن أخلق؟ قَالَ: فحج آدم مُوسَى . هَكَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا.
وَوجه الحَدِيث: أن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّمَا لَام أبَاهُ آدم عَلَيْهِ السَّلَام لأكله الشَّجَرَة الَّتِي كَانَت سَببًا لإخراجه وَذريته من الْجنَّة، وَلم يلمه على كَونه أذْنب ذَنبًا وَتَابَ مِنْهُ، فَإِن مُوسَى يعلم أن التائب من الذَّنب لَا يلام.
وَقد ثَبت فِي «الصَّحِيح» فِي الحَدِيث الْقُدسِي: أنه صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم قَالَ( ): «يَا عبَادي، إِنَّمَا هِيَ أعمالكُم، أحصيها لكم، ثمَّ أوفيكم إِيَّاهَا، فَمن وجد خيرًا، فليحمد الله سُبْحَانَهُ، وَمن وجد غير ذَلِك، فَلَا يَلُومن إِلَّا نَفسه».
الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأولياء بعد الأنبياء:
ولنرجع إِلَى شرح الحَدِيث الَّذِي نَحن بصدد شَرحه، فَنَقُول: اعْلَم أن الصَّحَابَة [ﭫ]( ) - لَا سِيمَا أكابرهم( ) - الجامعين بَين الْجِهَاد بَين يَدي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وَالْعلم بِمَا جَاءَ بِهِ، وأسعدهم الله سُبْحَانَهُ من مُشَاهدَة النُّبُوَّة وصحبة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء، وبذلهم أنفسهم وَأمْوَالهمْ فِي الْجِهَاد فِي سَبِيل الله سُبْحَانَهُ، حَتَّى صَارُوا خير الْقُرُون بالأحاديث الصَّحِيحَة. فهم خيرة الْخيرَة؛ لِأن هَذِه الْأمة هِيَ كَمَا أكْرمهم الله بِهِ بقوله: ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [آل عمران: 110]، وَكَانُوا الشُّهَدَاء على الْعباد كَمَا فِي الْقُرْآن الْعَظِيم، فهم خير الْعباد جَمِيعًا، وَخير الْأُمَم سابقهم ولاحقهم، وأولهم وَآخرهمْ. وَهَؤُلَاء الصَّحَابَة رَضِي الله [تعالى]( ) عَنْهُم، هم خير قرونهم، وَأفضل طوائفهم إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
فتقرر بِهَذَا؛ أن الصَّحَابَة رَضِي الله [تعالى]( ) عَنْهُم خير الْعَالم بأسره من أوله إِلَى آخِره، لَا يفضلهم أحد إِلَّا الْأنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة، وَلِهَذَا لم يعدل مثلُ أحد ذَهَبًا مُدَّ أحدهم وَلَا نصيفَه.
فَإِذا لم يَكُونُوا رَأس الْأوْلِيَاء، وصفوة الأتقياء، فَلَيْسَ لله أوْلِيَاء، وَلَا أتقياء، وَلَا بررة، وَلَا أصفياء. وَقد نطق الْقُرْآن الْكَرِيم( ) بِأن الله [سبحانه وتعالى]( ) قد رَضِي عَن أهل بيعَة الشَّجَرَة، وهم جُمْهُور الصَّحَابَة إِذْ ذَاك.
وَثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم ثبوتًا متواترًا: أن الله سُبْحَانَهُ اطلع على أهل بدر، فَقَالَ: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فقد غفرت لكم». وَشهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم لجَماعَة مِنْهُم بِأنَّهُم من أهل الْجنَّة.
فَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي هَذَا الحَدِيث: «من عادى لي وليًّا»، يصدق عَلَيْهِم صدقاً أوليًّا، ويتناولهم بفحوى الْخطاب.
بغض الرافضة لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم:
فَانْظُر - أرشدك الله - إِلَى مَا صَارَت الرافضة - أقمأهم الله - تَصنعهُ بهؤلاء الَّذين هم( ) رُءوس الْأوْلِيَاء، ورؤساء الأتقياء، وقدوة الْمُؤمنِينَ، وأسوة الْمُسلمين، وَخير عباد الله أجْمَعِينَ؛ [أ:28] من الطعْن واللعن والثلب والسب والشتم والثلم( )، وَانْظُر إِلَى أي مبلغ بلغ الشَّيْطَان الرَّجِيم بهؤلاء المغرورين المجترئين على هَذِه الْأعْرَاض المصونة المحترمة المكرمة؟
فيا لله الْعجب من هَذِه الْعُقُول الرقيقة، والأفهام الشنيعة، والأذهان المختلة، والإدراكات المعتلة، فَإِن هَذَا التلاعب الَّذِي تلاعب بهم الشَّيْطَان يفهمهُ أقصر النَّاس عقلًا، وأبعدهم فطانة، وأجمدهم فهمًا، وأقصرهم فِي الْعلم باعًا، وَأقلهمْ اطلاعًا.
فَإِن الشيطان - لَعنه الله - سَوَّلَ لَهُم، بِأن هَؤُلَاءِ الصَّحَابَة ﭫ، الَّذين لَهُم المزايا الَّتِي لَا يُحِيط بهَا حصر، وَلَا يحصيها حد وَلَا عد، أحقاء بِمَا يهتكون من أعراضهم الشَّرِيفَة، ويجحدون من مناقبهم المنيفة، حَتَّى كَأنَّهُمْ لم يَكُونُوا هم الَّذين أقَامُوا أعمدة الْإِسْلَام بسيوفهم، وشادوا قُصُور الدّين برماحهم ، واستباحوا الممالك الكسروية والقيصرية، وأطفأوا الْملَّة النَّصْرَانِيَّة والمجوسية، وَقَطعُوا حبائل الشّرك من الطوائف المشركة من الْعَرَب وَغَيرهم، وأوصلوا دين الْإِسْلَام إِلَى أطْرَاف الْمَعْمُور من شَرق الأرْض وغربها، ويمينها وشمالها، فاتسعت رقْعَة الْإِسْلَام، وطبقت الأرْض شرائع الْإِيمَان، وانقطعت علائق الْكفْر، وانقصمت حباله، وانفصمت أوصاله، ودان بدين الله سُبْحَانَهُ الْأسود والأحمر، والوثني والملي. فَهَل رَأيْت أو سَمِعت بأضعف من هَؤُلَاءِ تمييزًا، وَأكْثر مِنْهُم( ) جهلًا، وأزيف مِنْهُم رَأيًا؟!.
يا لله الْعجب، يعادون خير عباد الله وأنفعهم للدّين، الَّذِي بُعث بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، وهم لم يعاصروهم، وَلَا عاصروا من أدركهم، وَلَا أذنبوا إِلَيْهِم بذنب، وَلَا ظلموهم فِي مَال، وَلَا دم وَلَا عرض، بل قد صَارُوا تَحت أطباق الثرى، وَفِي رَحْمَة وَاسع الرَّحْمَة مُنْذُ مئين من السنين.
وَمَا أحسن مَا قَالَه بعض أُمَرَاء عصرنا، وَقد رام كثير من أهل الرَّفْض أن يفتنوه ويوقعوه فِي الرَّفْض: مَالِي ولقوم بيني وَبينهمْ زِيَادَة على اثْنَتَيْ عشرَة مائَة من السنين.
وَهَذَا الْقَائِل لم يكن من أهل الْعلم، بل هُوَ عبدٌ، صيَّره مَالِكه أمِيرًا، وهداه عقله إِلَى هَذِه الْحجَّة الْعَقْلِيَّة الَّتِي يعرفهَا بالفطرة كل من لَهُ نصيب من عقل، فَإِن عَدَاوَة من لم يظلم المعادي فِي مَال وَلَا دم وَلَا عرض، وَلَا كَانَ معاصرًا لَهُ حَتَّى ينافسه فِيمَا هُوَ فِيهِ، يعلم كل عَاقل أنه لَا يعود على الْفَاعِل بفائدة.
هَذَا على فرض أنه لَا يعود عَلَيْهِ بِضَرَر فِي الدّين، فَكيف وَهُوَ من أعظم الذُّنُوب الَّتِي لَا يُنجي فاعلها إِلَّا عَفْو الْغَرِيم الْمَجْنِي عَلَيْهِ بظلمه فِي عرضه؟.
انْظُر - عافاك الله - مَا ورد فِي غيبَة الْمُسلم من الْوَعيد الشَّديد، مَعَ أنَّهَا ذكر الْغَائِب بِمَا فِيهِ( )، كَمَا صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم فِي بَيَانهَا، لما سَألَهُ السَّائِل عَن ذَلِك، ثمَّ سَألَهُ عَن ذكره بِمَا لَيْسَ فِيهِ، جعل ذَلِك من الْبُهْتَان، كَمَا هُوَ ثَابت فِي «الصَّحِيح»، وَلم يرخص فِيهَا بِوَجْه من الْوُجُوه.
وَقد أوضحنا ذَلِك فِي الرسَالَة( ) الَّتِي دفعنَا بهَا مَا قَالَه النَّوَوِيّ وَغَيره، من جَوَاز الْغَيْبَة فِي سِتّ صور، وزيفنا مَا قَالُوهُ تزييفًا لَا يبْقى بعده شكّ وَلَا ريب، وَمن بقي فِي صَدره حرج وقف عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ دَوَاء لهَذَا الدَّاء الَّذِي هلك بِهِ كثير من عباد الله سُبْحَانَهُ( ).
فَإِذا كَانَ هَذَا حَرَامًا بَينًا وذنبًا عَظِيمًا فِي غيبَة فَرد من أفْرَاد الْمُسلمين الْأحْيَاء الْمَوْجُودين، فَكيف غيبَة الْأمْوَات، الَّتِي صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم النَّهْي عَنْهَا بقوله: «لَا تسبوا الْأمْوَات، فَإِنَّهُم قد أفضوا إِلَى مَا قدمُوا».
فكيف إِذا كَانَوا( ) هَؤُلَاءِ المسبوبين، الممزقة أعراضهم، المهتوكة حرماتهم، هم خير الخليقة، وَخير الْعَالم كَمَا قدمنَا تَحْقِيقه؟ فسبحان الصبور الْحَلِيم.
فيا هَذَا المتجرئ، على هَذِه الْكَبِيرَة، المتقحم على هَذِه الْعَظِيمَة، إِن كَانَ الْحَامِل لَك عَلَيْهَا والموقع لَك فِي وبالها هُوَ تأميلك الظفر بِأمْر دُنْيَوِيّ، وَعرض عَاجل، فَاعْلَم أنَّك لَا تنَال مِنْهُ طائلًا، وَلَا تفوز مِنْهُ بنقير وَلَا قطمير.
فقد جربنَا وجرب غَيرنا من أهل العصور الْمَاضِيَة، أن من طلب الدُّنْيَا بِهَذَا السَّبَب الَّذِي( ) فتح بَابه الشَّيْطَان الرَّجِيم، وشيوخ الْمَلَاحِدَة من الباطنية والقرامطة والإسماعيلية، تنكدت عَلَيْهِ أحْوَاله، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ معايشه، وعاندته مطَالبه، وَظهر عَلَيْهِ كآبة المنظر، وقَمَاءةٌ الْهَيْئَة ورثاثة الْحَال، حَتَّى يعرفهُ غَالب من رَآهُ أنه رَافِضِي، وَمَا علمنَا بِأن رَافِضِيًّا أفْلح فِي دِيَارنَا هَذِه قطّ. وَإِن كَانَ الْحَامِل لَك على ذَلِك الدّين، فقد كذبت على نَفسك، وَكَذبَك شَيْطَانك وَهُوَ كذوب.
فَإِن دين الله هُوَ كِتَابه وَسنة رَسُوله، فَانْظُر هَل ترى فيهمَا إِلَّا الْإِخْبَار [لنا]( ) بالرضى عَن الصَّحَابَة، [وَأنَّهُمْ]( ) أشداء على الْكفَّار، وَأن الله يغِيظ [بهم]( ) الْكفَّار، وَأنه لَا يلْحق بهم غَيرهم، وَلَا يماثلهم سواهُم؟
وهم الَّذين أنْفقُوا [من]( ) قبل الْفَتْح وقاتلوا، وأنفقوا بعده، كَمَا حَكَاهُ الْقُرْآن الْكَرِيم، وهم الَّذين جاهدوا فِي الله حق جهاده، وَجَاهدُوا بِأمْوَالِهِمْ وأنفسهم فِي سَبيله .
وهم الَّذين قَامُوا بفرائض الدّين، ونشروها فِي الْمُسلمين، وهم الَّذين وَردت لَهُم فِي السّنة المطهرة المناقب الْعَظِيمَة، والفضائل الجسيمة، عُمُومًا وخصوصًا.
وَمن شكّ فِي هَذَا نظر فِي دواوين الْإِسْلَام، وَفِيمَا يلْتَحق بهَا من المسندات والمستدركات والمعاجيم وَنَحْوهَا، فَإِنَّهُ سيجد هُنَالك مَا يشفي عِلَلَه، ويروي غَلَله، وَيَردهُ عَن غوايته، وَيفتح لَهُ أبْوَاب هدايته.
هَذَا إِذا كَانَ يعرف أن الشَّرِيعَة الإسلامية هِيَ الْكتاب وَالسّنة، وَأنه لَا شَرِيعَة بَين أظهرنَا من الله وَرَسُوله إِلَّا ذَلِك.
فَإِن كَانَ لَا يدري بِهَذَا، وَيَزْعُم أن لَهُ سلفًا فِي هَذِه الْمعْصِيَة الْعَظِيمَة والخصلة الذميمة، فقد غره الشَّيْطَان بمخذول مثله، ومفتون مثل فتنته، وَقد نزه الله ۵ عُلَمَاء الْإِسْلَام - سابقهم ولاحقهم، ومجتهدهم ومقلدهم - عَن الْوُقُوع فِي هَذِه البلية الحالقة للدّين، المخرجة لمرتكبها من سَبِيل الْمُؤمنِينَ إِلَى طَرِيق الْمُلْحِدِينَ.
حب أهل البيت وزراريهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
فَإِن زعم أنه قد قَالَ بِشَيْء من هَذَا الضلال الْمُبين قَائِل من أهل الْبَيْت المطهرين، فقد افترى عَلَيْهِم الْكَذِب الْبَين، وَالْبَاطِل الصُّراحَ. فَإِنَّهُم مجمعون - سابقهم ولاحقهم - على تَعْظِيم جَانب الصَّحَابَة الأكرمين، وَمن لم يعلم بذلك، فَلْينْظر فِي الرسَالَة الَّتِي ألفتها فِي الْأيَّام الْقَدِيمَة الَّتِي سميتها «إرشاد الغبي إِلَى مَذْهَب أهل الْبَيْت فِي صحب النَّبِي»( )، فَإِنِّي نقلت فِيهَا نَحْو أرْبَعَة عشر إِجْمَاعًا عَنْهُم من طرق مروية عَن أكابرهم، وَعَن المتابعين لَهُم، المتمسكين بمذهبهم.
فيا أيهَا الْمَغْرُور بِمن اقتديت، وعَلى من اهتديت، وَبِأيِّ حَبل تمسكت، وَفِي أي طَرِيق سلكت.
يالك الويل وَالثُّبُور، كَيفَ أذهبت دينك فِي أمر يُخَالف كتاب الله سُبْحَانَهُ، وَسنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، وَيُخَالف جَمِيع الْمُسلمين مُنْذُ قَامَ الدّين إِلَى هَذِه الْغَايَة، وَكَيف رضيت لنَفسك بِأن تكون خصمًا لله سُبْحَانَهُ ولكتابه وَلِرَسُولِهِ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، ولسنته ولصحابته وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين؟ أيْن يتاه بك، وَإِلَى أي هوة يرْمى بك، أما يخرج نَفسك من هَذِه الظُلُمَات المتراكمة إِلَى أنوار هَذَا الدّين الَّذِي جَاءَنَا ( ) بِهِ الصَّادِق المصدوق عَن رب الْعَالمين، وَأجْمع عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ أجْمَعُونَ، وَلم يُخَالف فِيهِ مُخَالف يعْتد بِهِ فِي إِجْمَاع الْمُسلمين، اللَّهُمَّ إِلَّا أن يكون رَافِضِيًّا خبيثًا، أو باطنيًّا ملحدًا، أو قَرْمَطِيًّا جَاحِدًا، أو زنديقيًّا معاندًا.
وَهَاهُنَا دقيقة نرشدك إِلَيْهَا، إِن بَقِي لَك طَرِيق إِلَى الرشاد، وَفهم ما ينقاد إِلَيْهِ الْعُقَلَاء.
منشأ الباطنية والروافض:
اعْلَم أن بقايا الْمَجُوس، وَطَوَائِف الشّرك والإلحاد، لما ظَهرت الشَّرِيعَة الإسلامية، وقهرتهم الدولة الإيمانية وَالْملَّة المحمدية، وَلم يَجدوا سَبِيلًا إِلَى دَفعهَا بِالسَّيْفِ وَلَا بِالسِّنَانِ، وَلَا بِالْحجَّةِ والبرهان، ستروا مَا هم فِيهِ من الْإِلْحَاد والزندقة بحيلة تقبلهَا الأذهان وتذعن لَهَا الْعُقُول.
فانتموا( ) إِلَى أهل الْبَيْت المطهرين، وأظهروا محبتهم وموالاتهم، كذبًا وافتراءً، وهم فِي الْبَاطِن أعظم أعدائهم، وأكبر الْمُخَالفين [لَهُم]( ). ثمَّ كذبُوا على أكابرهم، الجامعين بَين الْعلم وَالدّين، الْمَشْهُورين بالصلاح والرشد، فَقَالُوا: قَالَ الإِمَام فلَان كَذَا، وَقَالَ الإِمَام فلَان كَذَا، وجذبوا جمَاعَة من الْعَامَّة، الَّذين لَا يفهمون وَلَا يعْقلُونَ، فتدرجوا مَعَهم بدعوات مَعْرُوفَة، وسياسات شيطانية.
وَمَا زَالُوا ينقلونهم من رُتْبَة إِلَى رتبة، وَمن دَرَجَة إِلَى دَرَجَة، حَتَّى أخرجوهم إِلَى الْكفْر البَوَاح، والزندقة المحضة، والإلحاد الصُّرَاح.
فَعِنْدَ ذَلِك ظَهرت لَهُم دوَل: مِنْهَا دولة الْيمن، الَّتِي قَامَ بهَا عَليّ بْن الْفضل( ) الملحد، الْكَافِر كفرًا أقبح من كفر الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكين، ونعق بالإلحاد على مَنَابِر الْمُسلمين فِي غَالب الديار اليمنية، وصيرها كفرية إلحادية باطنية.
وَكَذَلِكَ مَنْصُور بن حسن( ) الْخَارِج مَعَه من عِنْد رَأس الملحدة مَيْمُون القداح( )، فَملك بعض الديار اليمنية، واستوطن الْحصن الْعَظِيم فِي مغارب الْيمن، وَهُوَ حصن مسور، وَنشر الدعْوَة الباطنية بِالسَّيْفِ، كَمَا نشرها عَليّ بْن الْفضل، وَلكنه كَانَ فِي إِظْهَار الْكفْر والإلحاد دون عَليّ بن الْفضل، ثمَّ بقيت بعده بقايا، يتناوبون هَذِه الدعْوَة الملعونة، يُقَال لَهُم الدعاة. وَمِنْهُم الْملك الْكَبِير عَليّ ابن مُحَمَّد الصُّليحي( ) [أ:32] الْقَائِم بِملك غَالب الديار اليمنية.
وَبقيت الدولة فيهم حينًا من الدَّهْر، وَلَكِن الله [تعالى]( ) حَافظ دينه، وناصر شَرِيعَته، فَإِنَّهُ كَانَ فِي جِهَات الْيمن الجبالية، دولة لأوْلَاد الإِمَام الْهَادِي يحيى بْن الْحُسَيْن رحمه الله [تعالى]( )، فصاولوهم، وجاولوهم، وقاتلوهم فِي معركة بعد معركة، وموطن بعد موطن، حَتَّى كفوهم عَن كثير من الْبِلَاد، وَبَقِي لِلْإِسْلَامِ رسم، وللدين اسْم. وَلَوْلَا أن الله [تعالى]( ) حفظ دينه بذلك، لَصَارَتْ الْيمن بأسرها قرمطية باطنية.
ثمَّ جَاءَت بعد حِين من الدَّهْر دولة الإِمَام الْأعْظَم صَلَاح الدّين مُحَمَّد بن عَليّ، وَولده الْمَنْصُور عَليّ بن صَلَاح، فقلقلتهم وزلزلتهم، وأخرجتهم من معاقلهم وشردتهم فِي أقطار الأرْض، وسفكت دِمَاءَهُمْ فِي كثير من المواطن. وَلم يبْق مِنْهُم بعد ذَلِك إِلَّا بقايا حقيرة قَليلَة ذليلة تَحت أذيال التَّقيَّة، وَفِي حجاب التستر والتَّظَهُّر بدين الْإِسْلَام إِلَى هَذِه الْغَايَة.
والرجاء فِي الله ۵، أن يستأصل بَقِيَّتهمْ، ويذهبهم بسيوف الْإِسْلَام وعزائم الْإِيمَان، [وَمَا ذَلِك على الله بعزيز]( ).
هَذَا مَا وَقع من هَذِه الدعْوَة الملعونة فِي الديار اليمنية، وَأما فِي غَيرهَا، فَأرْسل مَيْمُون القداح رجلًا أصله من الْيمن، يُقَال لَهُ: أبُو عبدالله الدَّاعِي( ) إِلَى بِلَاد الْمغرب، فَبَثَّ الدعْوَة هُنَالك، وتلقاها رجال من أهل الْمغرب من قَبيلَة كُتَامة وَغَيرهم من البربر، فظهرت هُنَالك دولة قَوِيَّة. وَلم يتم لَهُم ذَلِك إِلَّا بِإِدْخَال أنفسهم فِي النّسَب الشريف الْعلوِي الفاطمي.
ثمَّ طَالَتْ ذيول هَذِه الدولة المؤسسة على الْإِلْحَاد، واستولت على مصر، ثمَّ الشَّام، ثمَّ الْحَرَمَيْنِ، فِي كثير من الْأوْقَات، وغلبوا خلفاء بني الْعَبَّاس على كثير من بِلَادهمْ، حَتَّى أبادتهم الدولة الصلاحية [دولة]( ) صَلَاح الدّين بن أيُّوب( ).
فَكَانَ من أعجب الِاتِّفَاق، أن الْقَائِم بمصاولتهم ومحو دولتهم فِي الْيمن الإِمَام صَلَاح الدّين وَولده، والقائم بمحو دولتهم فِي مصر السُّلْطَان صَلَاح الدّين ابْن أيُّوب.
وَظَهَرت من هَذِه الدعْوَة الإلحادية دولة القرامطة؛ أبُو طَاهِر القرمطي( )، [وَأبُو سعيد القرمطي]( )( ) وَنَحْوهم، وَوَقع مِنْهُم فِي الْإِسْلَام وَأهله من سفك الدِّمَاء، وهتك الْحرم، وَقتل حجاج بَيت الله [أ:33] مرّة بعد مرّة، مَا هُوَ مَعْلُوم لمن يعرف علم التَّارِيخ، وأحوال الْعَالم.
وأفضى شرهم إِلَى دُخُول الْحرم الْمَكِّيّ، وَالْمَسْجِد الْحَرَام، وَقتلُوا الْحُجَّاج فِي الْمَسْجِد الْحَرَام حَتَّى ملأوه بالقتلى، وملأوا بِئْر زَمْزَم، وَصعد شيطانهم القرمطي على الْبَيْت الْحَرَام وَقَالَ:
وَلَو كَانَ هَذَا الْبَيْت لله رَبنَا
لصب علينا النَّار من فَوْقنَا صبا
لأنا حجَجنَا حجَّة جَاهِلِيَّة
محللة لم تبْق شرقًا وَلَا غربا
وَقَالَ مُخَاطبًا للحُجَّاج: يَا حمير، أنْتُم تَقولُونَ: من دخله كَانَ آمنًا، ثمَّ قلع الْحجر الْأسود وَحمله مَعَه إِلَى هَجَر، فَانْظُر مَا وصلت إِلَيْهِ هَذِه الدعْوَة الملعونة؟!.
ثمَّ أطفأ الله شرهم، وأخذتهم فِي آخر الْمدَّة جيوش التتر الخارجين على الْإِسْلَام، فَكَانَ فِي تِلْكَ المحنة منحة، أذهب الله بهَا هَذِه الطَّائِفَة الخبيثة. ثمَّ عَاد الْإِسْلَام كَمَا كَانَ، وَدخل فِي الْإِسْلَام مُلُوك التتر، وَكَانَت الْعَاقِبَة للدّين، وَدفع الله [تعالى]( ) عَن الْإِسْلَام جَمِيع المارقين مِنْهُ والخارجين عَلَيْهِ ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [آل عمران: 54]، ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ يُخَادِعُون( ) ﭾ ﭿ ﴾ [البقرة: 9].
وَإِنَّمَا قَصَصنَا عَلَيْك مَا قصصناه أيهَا الرافضي، المعادي لصحابة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم ولسنته، وَلدين الْإِسْلَام، لتعلم أنه لَا سلف لَك إِلَّا هَؤُلَاءِ القرامطة والباطنية والإسماعيلية، الَّذين بلغُوا فِي الْإِلْحَاد وَفِي كياد الْإِسْلَام مَا لم يبلغ إِلَيْهِ أحدٌ من طوائف الْكفْر.
فَإِن عرفت أنَّك على ضلال مُبين، وغرور عَظِيم، وَأن سلفك الَّذين اقتديت بهم، وتبعت أثَرهم، هم البالغون فِي الْكفْر إِلَى هَذِه المبالغ الَّتِي لم يطْمع فِيهَا الشَّيْطَان. فَرُبمَا تنتبه من هَذِه الرقدة، وتستيقظ من هَذِه الْغَفْلَة، وَترجع إِلَى الْإِسْلَام، وتمشي على هَدْيه القويم، وصراطه الْمُسْتَقيم.
فَإِن أبيت إِلَّا العناد، وَالْخُرُوج من طرق الرشاد إِلَى طرق الْإِلْحَاد، فعلى نَفسهَا براقش تجني( )، وَلَا يظلم رَبك أحدًا، ﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [الشعراء: 227]، واختر لنَفسك مَا يحلو.
افتراء الرافضة على السنة وبغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
وَاعْلَم أن لهَذِهِ الشنعة الرافضيّة، والبدعة الخبيثة ذيلًا هُوَ أشر( ) ذيل، وويلًا هُوَ أقبح ويل.
وَهُوَ أنهم لما علمُوا أن الْكتاب وَالسّنة يناديان [أ:34] عَلَيْهِم بالخسار والبوار بأعلى صَوت، عَادوا السّنة المطهرة، وقدحوا فيها وَفِي أهلهَا، بعد قدحهم فِي الصَّحَابَة رَضِي الله [تعالى]( ) عَنْهُم. وَجعلُوا المتمسك بهَا من أعدَاء أهل الْبَيْت وَمن الْمُخَالفين للشيعة لأهل الْبَيْت.
فأبطلوا السّنة المطهرة بأسرها، وتمسكوا فِي مقابلها، وتعوضوا عَنْهَا بأكاذيب مفتراة مُشْتَمِلَة على الْقدح المكذوب المتفرى فِي الصَّحَابَة وَفِي جَمِيع الحاملين للسّنة، المهتدين بهديها، العاملين بِمَا فِيهَا، الناشرين لَهَا فِي النَّاس، من التَّابِعين وتابعيهم إِلَى هَذِه الْغَايَة، ووسَمَوُهم بالنَّصب، والبغض لـ [أمير الْمُؤمنِينَ]( ) عَليّ ابن أبي طَالب رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ، ولأولاده.
فأبعد الله الرافضة وأقماهم، أيبغض عُلَمَاء السّنة المطهرة هَذَا الإِمَام، الَّذِي تعجز الألسن عَن حصر مناقبه، مَعَ علمهمْ بِمَا فِي كتب السّنة المطهرة، من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «لَا يحبك إِلَّا مُؤمن، وَلَا يبغضك إِلَّا مُنَافِق».
وَمَا ثَبت فِي السّنة من أنه يُحِبهُ الله سُبْحَانَهُ وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم( )؟ يَا لَهُم الويل الطَّوِيل، والخسار الْبَالِغ. أيوجد مُسلم من الْمُسلمين، وفرد من أفْرَاد الْمُؤمنِينَ بِهَذِهِ المثابة، وعَلى هَذِه العقيدة الخبيثة؟ سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم، وَلَكِن الْأمر كَمَا قلت:
قبيحٌ لَا يماثله قبيحٌ
لعمر أبِيك دينُ الرافضينا
أذاعوا فِي علي كل نكر
وأخفوا من فضائله اليقينا
وسبُّوا لَا رعوا أصْحَاب طه
وعادوا من عداهم أجمعينا
وَقَالُوا دينهم دين قويم
ألا لعن الْإِلَه الكاذبينا
وكما قلت:
تَشَيُّعُ الأقوام فِي عصرنا
منحصر فِي أربع من بدع
عَدَاوَة السّنة والثلب للأسلاف
وَالْجمع وَترك الجَمع
وكما قَالَ بعض المعاصرين لنا( ):
تَعَالَوْا إِلَيْنَا أخوة الرَّفْض إِن تكن
لكم شِرعةُ الْإِنْصَاف دينا كديننا
مَدْحنَا عليًّا فَوق مَا تمدحونه
وعاديتمُ أصحابَ أحْمد دوننَا
وقلتم بِأن الْحق مَا تصنعونه
ألا لعن الرَّحْمَن منا أضلّنا [أ:35]
ولاية الله تعالى والعلماء العاملون:
وَمن جملَة أوْلِيَاء الله سُبْحَانَهُ الداخلين تَحت قَوْله: «من عادى لي وليًّا» الْعلمَاء الْعَامِلُونَ. فهم كَمَا قَالَ بعض السّلف: إِن لم يَكُونُوا هم أوْلِيَاء الله [سُبْحَانَهُ]( ) فَمَا لله أوْلِيَاء.
فَإِذا فتح [الله]( ) عَلَيْهِم بالمعارف العلمية، ثمَّ منحهم الْعَمَل بهَا، ونشرها فِي النَّاس، وإرشاد الْعباد إِلَى مَا شَرعه الله لأمته، وَالْقِيَام بِالْأمر بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْي عَن الْمُنكر، فَهَذِهِ رُتْبَة عَظِيمَة، ومنزلة شريفة، وَلِهَذَا ورد أنهم وَرَثَة الْأنْبِيَاء( ).
وهم الَّذين قَالَ الله سُبْحَانَهُ فيهم: ﴿ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾ [المجادلة: 11].
فبيان الرّفْعَة لَهُم بِأنَّهَا دَرَجَات يدل أبْينَ دلَالَة، وينادي أرفع نِدَاء، بِأن مَنْزِلَتهمْ عِنْد الله [سُبْحَانَهُ]( ) منزلَة لَا تفضلها إِلَّا منَازِل الْأنْبِيَاء.
وهم الَّذين قرن الله سُبْحَانَهُ شَهَادَتهم بِشَهَادَتِهِ وَشَهَادَة مَلَائكَته، فَقَالَ: ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [آل عمران: 18].
وهم الَّذين قَالَ الله سُبْحَانَهُ فيهم: ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [فاطر: 28]، فحصر خَشيته الَّتِي هِيَ سَبَب الْفَوْز عِنْده عَلَيْهِم حَتَّى كَأنَّهُ لَا يخشاه غَيرهم.
وهم الَّذين أخذ الله [تعالى]( ) عَلَيْهِم الْمِيثَاق، أن يبينوا لِعِبَادِهِ مَا شَرعه لَهُم فَقَالَ: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [آل عمران: 187]، فهم أُمَنَاء الله سُبْحَانَهُ على شَرِيعَته.
وهم المترجمون لَهَا لِعِبَادِهِ المبينون لمراده، فَكَانُوا من هَذِه الْحَيْثِيَّة كالواسطة( ) بَين الرب سُبْحَانَهُ، وَبَين عباده لما اختصهم الله بِهِ من مِيرَاث النُّبُوَّة.
وَهَذِه منزلَة جليلة، ورتبة جميلَة لَا تعادلها( ) منزلَة، وَلَا تساويها مزية، فَحق على كل مُسلم أن يعْتَرف لَهُم بِأنَّهُم أوْلِيَاء الله سُبْحَانَهُ.
وَأنَّهُمْ المبلغون عَن الله وَعَن رَسُوله، وَأنَّهُمْ القائمون مقَام الرُّسُل فِي تَعْرِيف عباد الله بشرائع الله ۵، إِذا كَانُوا على الطَّرِيقَة السوية، والمنهج القويم، متقيدين بِقَيْد الْكتاب وَالسّنة، مقتدين بِالْهدي المحمدي، مُؤثِرِينَ لما فِي كتاب الله سُبْحَانَهُ، وَفِي سنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم على زائف الرَّأْي، وعاطل التَّقْلِيد.
فَهَؤُلَاءِ هم الْعلمَاء المستحقون للولاية الربانية، والمزية الرحمانية، فَمن عاداهم فقد اسْتحق مَا تضمنه هَذَا الحَدِيث من حَرْب الله ۵ لَهُ، وإنزال عُقُوبَته بِهِ؛ لِأنَّهُ عادى أوْلِيَاء الله، وَتعرض لغضب الله ۵.
وَمَعْلُوم أن الِانْتِفَاع بعلماء هَذِه الْأمة فَوق كل انْتِفَاع، وَالْخَيْر الْوَاصِل مِنْهُم إِلَى غَيرهم فَوق كل خير.
لماذا دخل العلماء فى زمرة أولياء الله تعالى؟
لأنهم يبينون مَا شَرعه الله سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ، ويرشدونهم إِلَى الْحق الَّذِي أمر الله سُبْحَانَهُ بِهِ، ويدفعونهم عَن الْبدع [أ:36] الَّتِي يَقع فِيهَا من جهل الْأحْكَام الشَّرْعِيَّة، ويصاولون أعدَاء الدّين الْمُلْحِدِينَ والمبتدعين، ويبينون للنَّاس أنهم على ضَلَالَة، وَأن تمسكهم بِتِلْكَ الْبدع إِمَّا عَن جهل أو عَن عناد، وَأنَّهُمْ( ) لَيْسَ بِأيْدِيهِم شَيْء من الدّين إِلَّا مُجَرّد تشكيكات يوقعون فِيهَا الْمُقَصِّرِينَ، ويجذبونهم إِلَى باطلهم.
وَمن أعظم فَوَائِد عُلَمَاء الدّين لدين الله ولعباد الله، أنهم يوضحون للنَّاس الْأحَادِيث الْمَوْضُوعَة المكذوبة على رَسُول الله [صلى الله عليه وآله وسلم]( )، كَمَا فعله طوائف من الملحدة والمبتدعة والزنادقة، ويرشدونهم إِلَى التَّمَسُّك بِمَا صَحَّ من السّنة.
وَكَذَلِكَ يوضحون للنَّاس مَا وَقع من أهل الزيغ والعناد من تَفْسِير كتاب الله [۵]( ) بأهويتهم وعَلى مَا يُطَابق مَا هم فِيهِ من الْبِدْعَة، وَذَلِكَ كثير جدًّا، يجده الباحث عَنهُ فِي تفاسير المبتدعة المحرفين لما أرَادَ الله سُبْحَانَهُ، وَلما فسره بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، وَمَا فسره بِهِ الصَّحَابَة والتابعون وَمن بعدهمْ من عُلَمَاء الدّين، وَمَا تَقْتَضِيه اللُّغَة الْعَرَبيَّة الَّتِي نزل بهَا الْقُرْآن الْكَرِيم.
فقد ضل كثير من الْعباد بتحريفات أهل الْأهْوَاء، وتلاعبهم بِالْكتاب الْعَزِيز، ورده إِلَى مَا قد دعوا إِلَيْهِ من الْبَاطِل الْمُبين( )، والزيغ الْوَاضِح. وَكَذَلِكَ ضل كثير من النَّاس بالأحاديث المكذوبة الَّتِي انتحلها المبطلون، وافتعلها المبتدعون.
وَكَذَلِكَ اغْترَّ كثير من الْمُقَصِّرِينَ بِعلم الرَّأْي، وآثروه على كتاب الله سُبْحَانَهُ، وعَلى سنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، وهما اللَّذَان( ) أمر الله سُبْحَانَهُ بِالرَّدِّ إِلَيْهِمَا عِنْد الِاخْتِلَاف. قَالَ الله ۵: ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾ [النساء: 59]، وَالرَّدّ إِلَى الله سُبْحَانَهُ، هُوَ الرَّد إِلَى كِتَابه، وَالرَّدّ إِلَى الرَّسُول هُوَ الرَّد إِلَى سنته بعد مَوته صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم بِلَا خلاف فِي ذَلِك.
بل قد ذهب جمع من الْعلمَاء إِلَى أن أولي الْأمر هم الْعلمَاء( )، وَمِنْهُم حَبْرُ الْأمة عبدالله بن عَبَّاس، وَجَابِر بن عبدالله، وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَأبُو الْعَالِيَة، وَعَطَاء ابن أبي رَبَاح، وَالضَّحَّاك، وَمُجاهد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْ أحْمد بْن حَنْبَل. وَقَالَ أبُو هُرَيْرَة، وَزيد بن أسلم، والسُّدِّي، ومُقاتل: هم الْأُمَرَاء( )، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ [أ:37] عَن أحْمد بن حَنْبَل، وروي أيْضًا عَن ابْن عَبَّاس أنهم الْأُمَرَاء( ).
فعلى القَوْل الأول فِيهِ الْأمر بِطَاعَة الْعلمَاء بعد طَاعَة الله وَرَسُوله، وعَلى القَوْل الثَّانِي، فمعلوم أن الْأُمَرَاء إِنَّمَا يطاعون إِذا أمروا بِمُقْتَضى الْعلم، فطاعتهم تبع لطاعة الْعلمَاء، فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم قد صَحَّ عَنهُ أنه قَالَ: «إِنَّمَا الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف»( )، وَالْمَعْرُوف إِنَّمَا يعرفهُ الْعلمَاء، وَصَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أنه قَالَ]( ): «لَا طَاعَة فِي مَعْصِيّة الله»( ). وَالْفرق بَين الطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة إِنَّمَا يعرفهُ الْعلمَاء، فطاعة الْأمراء لَا تجب إِلَّا إِذا أمروا بِمَا يبينه( ) لَهُم الْعلمَاء من أنه من الْمَعْرُوف غير الْمُنكر، وَمن الطَّاعَة غير الْمعْصِيَة.
قَالَ الشَّافِعِي $ فِيمَا صَحَّ عَنهُ: أجمع الْمُسلمُونَ على أن من استبانت لَهُ سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، لم يكن لَهُ أن يَدعهَا لقَوْل أحد من النَّاس( ).
قَالَ أبُو عمر ابن عبدالبَرِّ: أجمع النَّاس على أن المُقَلَّدَ لَيْسَ معدودًا من أهل الْعلم، فَإِن الْعلم معرفَة الْحق بدليله.
إجهاز الإمام الشوكاني على التقليد والمقلدين للمذاهب:
فقد تضمن هَذَانِ الإجماعان، إخْرَاج المتعصب الْمُقدم للرأي على كتاب الله، أو سنة رَسُوله، وَإخْرَاج الْمُقَلّد الْأعْمَى عَن زمرة الْعلمَاء.
وَقد قدم الْأئِمَّةُ الْأرْبَعَةُ الحَدِيثَ الضَّعِيف( ) على الرُّجُوع إلَى الرَّأْي، كَمَا روي عَن الإمَام أبي حنيفَة، أنه قدم حَدِيث القهقهة فِي الصَّلَاة( ) على مَحْض الْقيَاس، مَعَ أنه قد وَقع الْإجْمَاع من أئِمَّة الحَدِيث على ضعفه، وَقَدَّم حَدِيث الْوضُوء بنبيذ التَّمْر على الْقيَاس، وَجُمْهُور الْمُحدثين يضعفونه، وَقدم حَدِيث «أكثر الْحيض عشرَة أيَّام»( )، وَهُوَ ضَعِيف بِلَا خلاف بَين أهل الحَدِيث، وَقدم حَدِيث «لَا مهر دون عشرَة دَرَاهِم»( )، وَهُوَ ضَعِيف بِاتِّفَاق الْمُحدثين.
وَقدم الإمَام مَالك بن أنس الْمُرْسل، والمنقطع، والبلاغات، وَقَول الصَّحَابِيّ على الْقيَاس، وَقدم الشَّافِعِي حَدِيث تَحْرِيم صيد وَجِّ( ) على الْقيَاس مَعَ ضعفه.
وَقدم الإمَام أحْمد بن حَنْبَل، الضَّعِيف، والأثر الْمُرْسل، وَقَول الصَّحَابِيّ على الْقيَاس( ).
وَأما الصَّحَابَة - الَّذين هم خير الْقُرُون، والتابعون وتابعوهم( ) - فَكَانُوا لَا يفتون إلَّا بِمَا صَحَّ من النُّصُوص، وَقد يتورعون عَن الْفتيا مَعَ وجود النَّص، كَمَا هُوَ مَنْقُول عَن غالبهم فِي كتب الحَدِيث والتاريخ.
ويغني الْحَرِيص على دينه قَول الله سُبْحَانَهُ: ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الأعراف: 33].
فقرن التقول على الله بِمَا لم يقل بالفواحش، وَالْإثْم وَالْبَغي بِغَيْر الْحق، والشرك بِاللَّه، وَهَذَا زاجر( ) لمن نصب نَفسه للإفتاء أو الْقَضَاء، وَهُوَ غير عَالم بِكِتَاب الله وَسنة رَسُوله، تقشعر لَهُ الْجُلُود، وترجف مِنْهُ [أ:38] الأفئدة. وَهُوَ يَعُمُّ التَّقَوُّلَ على الله سُبْحَانَهُ بِلَا علم، سَوَاء كَانَ فِي أسْمَائِهِ، أو صِفَاته، أو أفعاله، أو فِي دينه وشرعه.
وَقَالَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [النحل: 116، 117]. فنهاهم الله سُبْحَانَهُ عَن الْكَذِب عَلَيْهِ فِي أحْكَامه، وَقَوْلهمْ لما لم يحرمه: هَذَا حرَام، وَلما لم يحله: هَذَا حَلَال. وَبَين لَهُم أنه لَا يجوز للْعَبد أن يَقُول هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام إلَّا إذا علم بِأن الله سُبْحَانَهُ أحله وَحرمه، وَإلَّا كَانَ متقولًا على الله بِمَا لم يقل.
وَمَعْلُوم أن الْمُسْتَدلّ بِمُجَرَّد مَحْض الرَّأْي لَا يعلم بِمَا أحله الله وَحرمه، فَإن زعم ذَلِك فَهُوَ كَاذِب على الله تَعَالَى، وعَلى نَفسه الَّتِي قادته إلَى هَذَا الافتراء، وأوقعته فِي هَذَا الذَّنب الْعَظِيم.
والمقلد يقر على نَفسه أنه لَا يعقل حجج الله وَلَا يفهم براهينه، وَلَا يدري بِمَا شَرعه الله لِعِبَادِهِ فِي كِتَابه، وعَلى لِسَان رَسُوله، بل هُوَ تَابع لرأي من قَلّدهُ، مقرّ على نَفسه بِأنَّهُ لَا يدري: هَل الرَّأْي الَّذِي قَلّدهُ فِيهِ من الْحق أو من الْبَاطِل؟( ).
وَمن الزواجر عَن التَّمَسُّك بمحض الرَّأْي، وبحت التَّقْلِيد، قَول الله سُبْحَانَهُ: ﴿ﮜ ﮝ( ) ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [يونس: 59].
وَقَالَ الإمَام الشَّافِعِي - فِيمَا رَوَاهُ عَنهُ الْخَطِيب فِي كتاب «الْفَقِيه والمتفقه»( ) لَهُ -: لَا يحل لأحد أن يُفْتِي فِي دين الله، إلَّا رجل عَارِف لكتاب( ) الله، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله، وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وَبعد ذَلِك يَكون بَصيرًا بِحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، وبالناسخ والمنسوخ [مِنْهُ]( )، وَيعرف من الحَدِيث مثل مَا عرف من الْقُرْآن، وَيكون بَصيرًا باللغة، بَصيرًا بالشعر، وَمَا يحْتَاج إلَيْهِ للْعلم وَالْقُرْآن، وَيسْتَعْمل هَذَا مَعَ الْإنْصَاف، وَيكون مشرفًا على اخْتِلَاف أهل الْأمْصَار، وَيكون لَهُ قريحة( ) بعد هَذَا، فَإذْ كَانَ هَكَذَا، فَلهُ أن يتَكَلَّم فِي الْحَلَال وَالْحرَام، وَإذا لم يكن هَكَذَا، فَلَيْسَ لَهُ [أن يُفتي] ( ). انْتهى.
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في مسائل الدين هو الطريقة العلمية:
وَالْحَاصِل: أن كل مَا لم يَأْتِ بِهِ الْكتاب وَالسّنة، فَهُوَ من هُوَ هوى الْأنْفس، كَمَا قَالَ [الله]( ) سُبْحَانَهُ: ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [القصص: 50].
فقسَّم سُبْحَانَهُ الْأمر إلَى قسمَيْنِ لَا ثَالِث لَهما: إمَّا الاستجابة لله [سبحانه]( ) وَلِلرَّسُولِ بِاتِّبَاع الْكتاب وَالسّنة، أو اتِّبَاع الْهوى.
فَكل مَا لم يكن فِي الْكتاب وَالسّنة فَهُوَ من الْهوى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ [أ:39] ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾ [ص: 26].
فقسم سُبْحَانَهُ الحكم بَين النَّاس إلَى أمريْن: إمَّا الحكم بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكتاب وَالسّنة، أو الْهوى، وَهُوَ مَا خالفهما.
وَقَالَ سُبْحَانَهُ لنَبيه صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [الجاثية: 18، 19]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ( )﴾[الأعراف: 3].
وَقد أجمع النَّاس - سابقهم ولاحقهم - أن الرَّد إلَى كتاب الله سُبْحَانَهُ، وَإلَى سنة رَسُوله [صلى الله عليه وآله وسلم]( )، هُوَ الْوَاجِب على جَمِيع الْمُسلمين، وَمن رد إلَى غَيرهمَا، فَهُوَ عَاصٍ لله وَرَسُوله، مُخَالف للْكتاب الْعَزِيز، وَالسّنة المطهرة( ).
وَلَا فرق بَين التَّنَازُع فِي الحقير وَالْكثير، فَإن قَوْله: ﴿ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ نكرَة فِي سِيَاق الشَّرْط، وَهِي( ) من صِيغ الْعُمُوم، فتشمل كل مَا يصدق [عَلَيْهِ]( ) الشَّيْء من الْأشْيَاء الشَّرْعِيَّة.
فَالْوَاجِب عِنْد التَّنَازُع فِيهِ رده إلَى مَا أمر الله [تعالى]( ) بِالرَّدِّ إلَيْهِ بقوله ﴿ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾، ثمَّ قَالَ: ﴿ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ [النساء: 59].
فَجعل هَذَا الرَّد من مُوجبَات الْإيمَان، وَعَدَمه من مُوجبَات عَدمه، فَإذا انْتَفَى الرَّد انْتَفَى الْإيمَان( ).
وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [الأحزاب: 36]، فَأخْبر سُبْحَانَهُ أنه مَا صَحَّ وَلَا استقام لأحد من الْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات أن يخْتَار غير مَا قضى بِهِ الله وَرَسُوله( ).
وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [الحُجُرات: 1] أي: لَا تقدمُوا بأقوالكم بَين يَدي قَول الله وَرَسُوله، [بل قُولُوا كَمَا يَقُول الله وَرَسُوله]( ).
وَمَعْلُوم أن فتيا الْمُفْتِي بِغَيْر الْكتاب وَالسّنة وَمَا يرجع إلَيْهِمَا [هِيَ]( ) فتيا بِالْجَهْل الَّذِي حذر مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، وأنذر بِهِ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من قَوْله: «إن الله لَا ينْزع الْعلم بعد إذْ أعطاكموه انتزاعًا، وَلَكِن يَنْزعهُ مَعَ قبض الْعلمَاء بعلمهم، فَيبقى نَاس جهال يستفتون، فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون»( ).
وَفِي حَدِيث عَوْف بن مَالك الْأشْجَعِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وآله وَسلم: «تفترق أمتِي على بضع وَسبعين فرقة، أعظمها فتْنَة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمُونَ مَا أحل الله، وَيحلونَ مَا حرم الله»( ).
قَالَ أبُو عَمْر ابن عبدالْبر: هَذَا هُوَ الْقيَاس على غير أصل، وَالْكَلَام فِي الدّين بالخرص والظنة. وَقد ثَبت عَن أكَابِر الصَّحَابَة الْخُلَفَاء الْأرْبَعَة وَغَيرهم ذمّ الرَّأْي ومقت الْعَامِل بِهِ، وَأنه لَيْسَ من الدّين فِي شَيْء.
وَقد استوفـى ذَلِك الْحَافِظ ابْن عبدالْبر فِي «كتاب الْعلم»، وَجمع مَا لم يجمعه غَيره( ).
والرأي إذا كَانَ فِي مُعَارضَة أدِلَّة الْكتاب وَالسّنة، أو كَانَ بالخرص وَالظَّن، مَعَ التَّقْصِير عَن معرفَة النُّصُوص، أو كَانَ متضمنًا تَعْطِيل أسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته، أو كَانَ مِمَّا أحدثت بِهِ الْبدع وغيرت بِهِ السّنَن، فَلَا خلاف بَين الْمُسلمين فِي أنه بَاطِل، وَأنه لَيْسَ من الدّين فِي شَيْء.
وَإذا كَانَ مَبْنِيًا على قِيَاس على دَلِيل فِي الْكتاب وَالسّنة، فَإن كَانَ بِتِلْكَ المسالك الَّتِي لَا ترجع إلَى شَيْء، إنَّمَا هِيَ مُجَرّد تَظنن وتخمين، فَهُوَ أيْضًا بَاطِل.
وَإن كَانَ مَعَ الْقطع بِنَفْي الْفَارِق( )، أو كَانَ ثُبُوت الْفَرْع بفحوى الْخطاب، أو كَانَت الْعلَّة منصوصة، فَهَذَا - وَإن أطلق عَلَيْهِ اسْم الْقيَاس - فَهُوَ دَاخل تَحت دلَالَة الأصْل، مشمول بِمَا دلّ عَلَيْهِ، مَأْخُوذ مِنْهُ( ). وتسميته قِيَاسًا إنَّمَا هُوَ مُجَرّد اصْطِلَاح، وَقد أوضحت الْكَلَام على هَذَا فِي كتابي الَّذِي سميته «إرشاد الفحول إلَى تَحْقِيق الْحق من علم الْأصُول».
تعريف التقليد وبيان حكمه عند الإمام الشوكاني( ):
وَإذا عرفت مَا ورد فِي ذمّ الرَّأْي وذم التقول على الله بِمَا لم يقل، فَاعْلَم أن التَّقْلِيد كَمَا قدمنَا، إنَّمَا هُوَ قبُول رَأْي الْغَيْر دون رِوَايَته( )، فالمقلد إنَّمَا يُقَال لَهُ مقلد فِي اصْطِلَاح أهل الْأصُول وَالْفُرُوع إذا وَقع مِنْهُ التَّقْلِيد للْعَالم فِي رَأْيه، وَأما إذا أخذ عَنهُ الرِّوَايَة عَن( ) الحكم فِي كتاب الله سُبْحَانَهُ، أو فِي سنة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، فَلَيْسَ هَذَا من التَّقْلِيد فِي شَيْء( ).
وَإذا كَانَ التَّقْلِيد هُوَ مَا ذَكرْنَاهُ، فَهُوَ مَذْمُوم من جِهَتَيْنِ:
الأولى: أنه عَمَلٌ بِعلم الرَّأْي، وَقد تقدم فِي ذمه وَعدم جَوَاز الْأخْذ بِهِ مَا تقدم.
الثَّانِيَة: أنه عمل بِالرَّأْيِ على جهل؛ لِأنَّهُ مقلد لصَاحب ذَلِك الرَّأْي، وَهُوَ لَا يدْرِي أكَانَ ذَلِك الرَّأْي من صَاحبه على صَوَاب أم على خطأ، بِاعْتِبَار علم الرَّأْي، فَإن لَهُ قوانين عِنْد أهله، من وافقها أصَاب الرَّأْي، وَمن أخطأها أخطَأ الرَّأْي، وَالْكل ظلمات بَعْضهَا فَوق بعض( ).
وَقد جَاءَت الْأدِلَّة القرآنية بذم تَقْلِيد الْآبَاء، فَقَالَ: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [البقرة: 170]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿[ﭑ]( ) ﭒ ﭓ [ﭔ ﭕ]( )ﭖ ﭗ( ) ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الزُّخرُف: 23، 24]، وَقَالَ ۵: ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ( ) ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [لقمان: 21] ( ).
وَفِي الْقُرْآن الْكَرِيم من هَذَا الْجِنْس آيَات كَثِيرَة، وَهِي وَإن كَانَ موردها فِي الْكفَّار، فَالْمُرَاد بهَا وبأمثالها ذمّ من أعرض عَمَّا أنزلهُ الله سُبْحَانَهُ، وَأخذ بقول سلفه، وَاللَّفْظ أوسع مِمَّا هُوَ سَبَب النُّزُول، وَالِاعْتِبَار بِهِ كَمَا تقرر فِي الْأصُول.
فَمن وَقع مِنْهُ الْإعْرَاض عَمَّا شَرعه الله [سبحانه]( )، وَقدم عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ سلفه فَهُوَ دَاخل تَحت عُمُوم هَذِه الْآيَات.
وَمِمَّا يدل على ذمّ التَّقْلِيد قَوْله سُبْحَانَهُ: ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [الإسراء:36]، والمقلد قد قفا مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ علم، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [الأعراف: 3]، والمقلد لَا يدْرِي بِمَا أنزل الله حَتَّى يتبعهُ، بل اتبع الرَّأْي، وَهُوَ غير مَا أنزل الله، وَاتبع من دونه من قَلّدهُ، فقد اتبع من دونه أوْلِيَاء.
والمقلد أيْضًا لَا علم لَهُ، فَإذا أخذ بِرَأْي من قَلّدهُ، كَانَ ذَلِك من التقول على الله بِمَا لم يقل، وَمن الرَّد إلَى غير الله وَرَسُوله، وَقد قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الأعراف: 33].
وَقَالَ: ﴿ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النساء: 59]، وَقد قدمنَا تَقْرِير معنى الْآيَتَيْنِ. وَمن ذَلِك قَوْله ۵: ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [الأحزاب: 67]( ).
قَالَ أبُو عَمْر ابن عبدالْبر [رحمه الله تعالى]( ): قد ذمّ الله تبَارك وَتَعَالَى التَّقْلِيد فِي كِتَابه فِي غير مَوضِع، فَقَالَ: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [التوبة: 31].
روي عَن حُذَيْفَة وَغَيره أنهم قَالُوا: لم يعبدوهم من دون الله، وَلَكنهُمْ أحلُّوا لَهُم وحرموا لَهُم فاتبعوهم.
وَقَالَ عدي بن حَاتِم: يَا رَسُول الله، إنَّا لم نتخذهم أرْبَابًا، قَالَ: «بلَى، ألَيْسَ يحلونَ لكم مَا حرم الله عَلَيْكُم فَتحِلُّونَهُ، ويحرمون عَلَيْكُم مَا أحل الله لكم فَتُحَرِّمُونَهُ؟» فَقلت: بلَى، قَالَ: «فَتلك عِبَادَتهم». أخرجه أحْمد وَالتِّرْمِذِيّ.
قَالَ: وَفِي هَؤُلَاءِ وَمثلهمْ قَالَ الله ۵: ﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [البقرة: 166، 167]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الأنبياء: 52، 53]( )، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [الأحزاب: 67]، وَمثل هَذَا فِي الْقُرْآن كثير من ذمّ التَّقْلِيد.
وَقد احْتج الْعلمَاء بِهَذِهِ الْآيَات على إبْطَال التَّقْلِيد، وَلم يمنعهُم كفر أولَئِكَ من الِاحْتِجَاج بهَا؛ لِأن التشبيه لم يَقع من جِهَة كفر أحدها( ) وإيمان الآخر، وَإنَّمَا وَقع التشبيه بَين المقلدين بِغَيْر حجَّة للمقلد، كَمَا لَو قلد رجلًا فَكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر فِي مَسْألَة فَأخْطَأ وَجههَا، كَانَ كل وَاحِد ملومًا على التَّقْلِيد بِغَيْر حجَّة؛ لِأن كل تَقْلِيد يشبه بعضه بَعْضًا، وَإن اخْتلفت الآثام فِيهِ.
وَقَالَ ۵: ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [التوبة: 115].
قَالَ: فَإذا بَطل التَّقْلِيد بِكُل مَا ذكرنَا، وَجب التَّسْلِيم لِلْأصُولِ الَّتِي يجب التَّسْلِيم لَهَا، وَهِي: الْكتاب وَالسّنة، [أ:42] وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُمَا بِدَلِيل جَامع( ).
قَالَ: قَالَ عَليّ: إيَّاكُمْ والاستنان بِالرِّجَالِ، فَإن الرجل يعْمل بِعَمَل أهل الْجنَّة، ثمَّ يَنْقَلِب لعلم الله فِيهِ، فَيعْمل بِعَمَل أهل النَّار، فَيَمُوت وَهُوَ من أهل النَّار، وَإن الرجل ليعْمَل بِعَمَل أهل النَّار، فينقلب لعلم الله فِيهِ، فَيعْمل بِعَمَل أهل الْجنَّة، فَيَمُوت وَهُوَ من أهل الْجنَّة.
قَالَ: وَقَالَ ابْن مَسْعُود: لَا يقلدن أحدكُم دينه رجلًا، إن آمن آمن، وَإن كفر كفر، فَإنَّهُ لَا أسْوَة فِي الشَّرّ( ).
قَالَ أبُو عَمْر ابن عبدالْبر: وَهَذَا كُله نفي للتقليد، وأبطال لَهُ لمن فهمه وَهدي لرشده( )( ).
قَالَ: قَالَ أهل الْعلم وَالنَّظَر: حد الْعلم التبين، وَإدْرَاك الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ، فَمن بَان لَهُ الشَّيْء فقد علمه، قَالُوا: والمقلد لَا علم [لَهُ]( )، لم يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِك.
قَالَ: يُقَال لمن قَالَ بالتقليد لم قلت بِهِ، وخالفت السّلف فِي ذَلِك؟ فَإنَّهُم لم يقلدوا؟ فَإن قَالَ: قلدت( )؛ لِأن كتاب الله تَعَالَى لَا علم لي بتأويله، وَسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم لم أحصها، وَالَّذِي قلدته قد علم ذَلِك، فقلدت من هُوَ أعلم مني. قيل لَهُ: أما الْعلمَاء إذا أجمعُوا على شَيْء من تَأْوِيل الْكتاب، وحكاية السّنة، أو اجْتمع رَأْيهمْ على شَيْء، فَهُوَ لَا شكّ فِيهِ، وَلَكِن قد اخْتلفُوا فِيمَا قلدت فِيهِ بَعضهم دون بعض، فَمَا حجتك فِي تَقْلِيد بَعضهم دون بعض؟ وَكلهمْ عَالم، وَلَعَلَّ الَّذِي رغبت عَن قَوْله أعلم من الَّذِي ذهبت إلَى مذْهبه. فَإن قَالَ: قلدته؛ لِأنِّي أعلم أنه صَوَاب، قيل لَهُ: علمت ذَلِك بِدَلِيل من كتاب أو سنة أو إجْمَاع؟ فَإن قَالَ: نعم، أبطل التقليد، وطولب بِمَا ادَّعَاهُ من الدَّلِيل، وَإن قَالَ: قلدته؛ لِأنَّهُ أعلم مني، قيل لَهُ: فقلد كل من هُوَ أعلم مِنْك( )، فَإنَّك تَجِد من ذَلِك خلقًا كثيرًا، وَلَا تخص من قلدته.
ثمَّ قَالَ أبُو عَمْر ابن عبدالْبر بعد كَلَام سَاقه: وَلَكِن من كَانَت هَذِه حَاله، هَل تجوز لَهُ الْفتيا فِي شرائع دين الله، فَيحمل غَيره على إبَاحَة الْفروج، وإراقة الدِّمَاء، واسترقاق الرّقاب، وَإزَالَة الْأمْلَاك، وتصييرها إلَى غير من كَانَت فِي يَدَيْهِ بقول لَا يعرف صِحَّته، وَلَا قَامَ لَهُ الدَّلِيل عَلَيْهِ، وَهُوَ مقرّ أن قَائِله يُخطئ ويصيب، وَأن مخالفه فِي ذَلِك رُبمَا كَانَ الْمُصِيب فِيمَا خَالفه فِيهِ، فَإن أجَاز الْفَتْوَى لمن جهل الأصْل وَالْمعْنَى لحفظه الْفُرُوع، لزمَه أن يُجِيزهُ للعامة، وَكفى بِهَذَا جهلًا وردًّا لِلْقُرْآنِ، قَالَ الله ۵: ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [الإسراء: 36]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [يونس: 68]، وَقد أجمع الْعلمَاء على أن مَا لم يُتَبين وَلم يُسْتيقن فَلَيْسَ بِعلم، وَإنَّمَا هُوَ ظن، وَالظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئًا.
ثمَّ قَالَ: وَلَا خلاف بَين عُلَمَاء الْأمْصَار فِي فَسَاد التَّقْلِيد، ثمَّ صرح بِأن الْمُقَلّد لَيْسَ من الْعلمَاء بِاتِّفَاق أهل الْعلم( ).
ذكر أقوال الأئمة في التقليد:
وَقد ذكرنَا فِي الرسَالَة الَّتِي سميناها «القَوْل الْمُفِيد فِي حكم التَّقْلِيد» [أ:43]، نهي الْأئِمَّة الْأرْبَعَة - أئِمَّة الْمذَاهب الْأرْبَعَة - عَن تقليدهم، فلنذكر هَاهُنَا طرفًا من ذَلِك.
قَالَ المُزَنِي فِي أول مُخْتَصره: اختصرت هَذَا من علم الشَّافِعِي، وَمن معنى قَوْله؛ لأقرأه على من أرَادَهُ، مَعَ إعْلَامه( ) نَهْيه عَن تَقْلِيده وتقليد غَيره؛ لينْظر فِيهِ لدينِهِ، ويحتاط لنَفسِهِ( ).
وَحكى ابْن الْقيم، عَن أحْمد بن حَنْبَل أنه قَالَ: لَا تقلدني، وَلَا تقلد مَالِكًا، وَلَا الثَّوْريّ، وَلَا الْأوْزَاعِيّ، وَخذ من حَيْثُ أخذُوا. قَالَ: وَمن قلَّة فقه الرجل أن يُقَلّد دينه الرِّجَال( ).
وَحكى بشر بْن الْوَلِيد، عَن أبي يُوسُف القَاضِي صَاحب أبي حنيفَة أنه قَالَ: لَا يحل لأحد أن يَقُول بمقالتنا حَتَّى يعلم من أيْن قُلْنَا( ). وَكَذَلِكَ قَالَ الإمَام أبُو حنيفَة.
وَقد صَحَّ عَن الشَّافِعِي أنه قَالَ: أجمع النَّاس على أن من استبانت لَهُ سنة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم لم يكن لَهُ أن يَدعهَا لقَوْل أحد. وتواتر عَنهُ أنه قَالَ: إذا صَحَّ الحَدِيث، فاضربوا بِقَوْلِي الْحَائِط( ).
وروى جَعْفَر الْفرْيَابِيّ، عَن مَالك أنه قَالَ: من ترك قَول عمر بن الْخطاب لقَوْل إبْرَاهِيم النَّخعِيّ أنه يُسْتَتَاب، فَقيل لَهُ: إنَّمَا هِيَ رِوَايَة عَن عمر، قَالَ مَالك: يُسْتَتَاب( ).
وَإذا كَانَ هَذَا قَوْله فِي ترك قَول عمر، فَمَا ترَاهُ يَقُول فِي ترك الْكتاب وَالسّنة؟ وَتَقْدِيم قَول عَالم من الْعلمَاء عَلَيْهِمَا؟.
وَالْحَاصِل؛ أن النَّقْل عَن السّلف الصَّالح من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ فِي الْمَنْع من الْعَمَل بِالرَّأْيِ، وَمن تَقْلِيد الرِّجَال فِي دين الله كثير جدًّا، لَا يَتَّسِع لَهُ هَذَا الْمُؤلف، وَيَكْفِي من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر بعض مَا قدمْنَاهُ من آيَات الْكتاب الْعَزِيز.
فَإن قَالَ الْمُقَلّد: قد دلّ على ذَلِك دَلِيل، قُلْنَا لَهُ: أنْت تشهد على نَفسك، وَيشْهد عَلَيْك غَيْرك بأنك لَا تعقل الْحجَّة، وَأنَّك إنَّمَا تَأْخُذ بِرَأْي غَيْرك دون رِوَايَته، فمالك وَالِاسْتِدْلَال، وَإقَامَة نَفسك مقَامًا تقر عَلَيْهَا بأنك لست من أهله، فَأنت كالمتشبع بِمَا لم يُعْط، وكلابس ثوبَيْ زور.
فَإن كنت تفهم حجج الله وتعقل براهينه، فَمَا بالك إذا أوردنا عَلَيْك الْحجَّة من الْكتاب أو السّنة فِي إبْطَال مَا أنْت عَلَيْهِ، رجعت إلَى الالتجاء بأذيال التَّقْلِيد، وَقلت: إنَّك لست مِمَّن يفهم الْحجَّة، وَلَا مِمَّن يُخَاطب بهَا، فَمَا بالك( ) تقدم فِي دين الله رجْلًا، وتؤخر أخْرَى؟.
اعْتمد على أيهمَا شِئْت حَتَّى نخاطبك خطاب من أقمت نَفسك فِي مقَامه. وَعند ذَلِك يسفر الصُّبْح لعينيك، وَتعلم أنَّك متمسك بحبلٍ غرور. ومصابٌ بخدعٍ زور.
وَمَعَ هَذَا فَمن صرت تقلده دون غَيره يَقُول لَك: لَا يجوز لَك أن تقلده، فَأنت قلدته شَاءَ أم أبى( )، ثمَّ أخبرنَا: مَا هُوَ الْحَامِل لَك على تَقْلِيد هَذَا الشَّخْص الْمعِين من جملَة عُلَمَاء الدّين، وَمِنْهُم عُلَمَاء الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ؟! فَإن قلت: لكَونه أعلم النَّاس، فَمَا يدْريك - أصلحك الله - بِالْعلمِ وبالأعلم( )، وَأنت تقر على نَفسك أنه لَا علم لَك؟ والمسلمون أجْمَعُونَ يَقُولُونَ: إنَّك لَا تعد من أهل الْعلم، وَلَا تدخل فِي عداد أهله( ).
وَأيْضًا عُلَمَاء الصَّحَابَة أعلم من صَاحبك، وَكَذَلِكَ عُلَمَاء التَّابِعين، فَكيف اخْتَرْت صَاحبك عَلَيْهِم؟ ثمَّ أخبرنَا: هَل وجد فِي أيَّام [أ:44] الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ مقلد لأحَدهم أو لجَماعَة مِنْهُم، بل لم تحدث بِدعَة التَّقْلِيد إلَّا فِي الْقرن الرَّابِع، وَلم يبْق إذْ ذَاك صَحَابِيّ وَلَا تَابِعِيّ( ).
ثمَّ هَذَا الَّذِي قلدته قد خَالفه غَيره من أهل الْعلم، وَقَالَ بِخِلَاف مَا يَقُول، فَأخْبرنَا بِمَ عرفت أن صَاحبك المحق دون الْمُخَالف [لَهُ]( )؟ فَإنَّك تقر على نَفسك بأنك لَا تعرف مَا هُوَ الْحق، وَلَا من المحق من أهل الْعلم، وَغَيْرك من المقلدين يعْتَقد مثل اعتقادك فِيمَن قَلّدهُ، فَمن المحق مِنْكُمَا؟ وَمن الْمُصِيب للحق من إماميكما؟.
إن قلتما( ): لَا نَدْرِي، فَمَا بالكما تقيمان أنفسكما مقَام المستدلين بحجج الله، وأنتما لَا تعرفانها وَلَا تعقلانها، بإقراركما على أنفسكما؟.
وَإن قلتما: قد عقلتما الْحجَّة على جَوَاز التَّقْلِيد، فقد فتح الله لَكمَا خوخة من هَذِه العماية، وَيسر لَكمَا طَرِيقًا إلَى الرشاد، فَأقْبَلَا إلَيْنَا نعرفكما مَا أنْتُمَا عَلَيْهِ من التَّمَسُّك بالتقليد فِي دين الله، وَالْعَمَل بِالرَّأْيِ الفايل الْمُخَالف للأدلة الشَّرْعِيَّة، فَإنَّهُ إن صَحَّ لَكمَا مَا زعمتماه لَا تخالفان فِي أن الْكتاب وَالسّنة مؤثران على ذَلِك الرَّأْي الَّذِي قلدتما غيركما فِيهِ. وَحِينَئِذٍ قد نجح الدَّوَاء وَقرب الْبُرْء من ذَلِك الْمَرَض الَّذِي أصابكما.
وَأيْضًا نقُول لهَذَا الْمُقَلّد الْمِسْكِين: نَحن نعلم، وَتعلم أنْت إن بَقِي لَك شَيْء من الْعقل، وَنصِيب من الْفَهم، أن عُلَمَاء الْمُسلمين من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ وَمن المعاصرين لمن قلدته وَمن بعدهمْ من أئِمَّة الْعلم أن التجويز فيهم من التَّرَدُّد فِيمَا جَاءُوا بِهِ واختاروه لأنْفُسِهِمْ، مثل التجويز مِنْك فِي إمامك، وَهَذَا شَيْء يعرفهُ عقلاء الْمُسلمين. فَمَا بالك عَمَدت إلَى وَاحِد مِنْهُم، فقلدته دينك فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ من الصَّوَاب وَالْخَطَأ؟.
إن قلت: لَا أدْرِي، فَنَقُول: لَا دَريت. نَحن نعرفك بِالْحَقِيقَةِ. أنْت ولدت فِي قطر قد قلد فِيهِ أهله عَالمًا من عُلَمَاء الْإسْلَام، فدنت بِمَا دانوا، وَقلت بِمَا قَالُوا، فَأنت من الَّذين يَقُولُونَ عِنْد سُؤال الْملكَيْنِ: سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ شَيْئًا فقلته، فَيُقَال لَك: لَا دَريت وَلَا تليت، وَكَانَ الْأحْسَن بك إن كنت ذَا عقل وَفهم، وَقد أخذت بأقوال( ) الإمَام الَّذِي قلدته، أن تضم إلَى ذَلِك قَوْله: إنَّه لَا يحل لأحد أن يقلده، فَمَا بالك تركت هَذَا من أقْوَاله؟!.
ثمَّ اعْلَم أنَّك مسئول يَوْم الْقِيَامَة عَن دين الله، هَذَا الَّذِي أنزل بِهِ كِتَابه الْعَزِيز، وَبعث بِهِ نبيه الْكَرِيم، فَانْظُر مَا أنْت قَائِل، وبماذا تجيب؟ إن قلت: أخذت بقول الْعَالم فلَان، فَهَذَا الْعَالم فلَان مَعَك فِي عرصات الْقِيَامَة مسئول كَمَا سُئِلت، متعبد بِمَا تعبدك الله بِهِ.
فَإذا قلت: قلدت فلَانًا وَأخذت بقوله، فعبدت الله سُبْحَانَهُ بِمَا أمرنِي بِهِ، وأفتيت بِمَا قَالَه، وقضيت بِمَا قَرَّرَهُ، فأبحت الْفروج، وسفكت الدِّمَاء، وَقطعت الْأمْوَال، فَإن قيل لَك: أفعلت هَذَا بِحَق أو بباطل، فَمَا أنْت قَائِل؟.
وَإن( ) قلت: فعلت ذَلِك بقول فلَان، فَلَا بُد أن يُقَال لَك [أ:45]: علمت أن قَوْله صَوَاب، مُوَافق لما شَرعه الله لِعِبَادِهِ فِي كِتَابه وَسنة رَسُوله، فَلَا بُد أن تَقول: لَا أدْرِي، فَلَا دَريت، وَلَا تليت.
ثمَّ إذا قيل لَك فِي عرصات الْقِيَامَة: أي دَلِيل دلك( ) على تَخْصِيص هَذَا الْعَالم بِالْعَمَلِ بِجَمِيعِ مَا قَالَه، وتأثيره على قَول غَيره، بل على الْكتاب وَالسّنة، هَل بعثته نَبيًّا لعبادي بعد مُحَمَّد بن عبدالله رَسُولي، أم أمرت عبَادي بِطَاعَتِهِ كَمَا أمرت عبَادي بِاتِّبَاع رَسُولي؟ فَانْظُر مَا أنْت قَائِل، فَإن هَذَا سُؤال لَا بُد أن تسْأل عَنهُ، فَإن الله سُبْحَانَهُ إنَّمَا بعث إلَى عباده رَسُولًا وَاحِدًا، وَأنزل إلَيْهِم كتابًا وَاحِدًا، وَجَمِيع الْأمة أولهَا وَآخِرهَا، سابقها ولاحقها، متعبدون بِمَا شَرعه لَهُم الله سُبْحَانَهُ فِي كِتَابه، وعَلى لِسَان رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم( ).
وَمن جملَة من هُوَ متعبد بِهَذِهِ الشَّرِيعَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، فَكيف بإمامك الَّذِي هُوَ وَاحِد من الْعَالم، وفرد من أفْرَاد الْبشر؟ ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [النور: 16].
ثمَّ انْظُر يَا مِسْكين فِي أمر آخر، وَهُوَ أنه قد انْقَضى قبل حُدُوث هَذِه الْمذَاهب خير الْقُرُون ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، وَمَعْلُوم لكل من لَهُ فهم أنهم كَانُوا على الْعَمَل بِالْكتاب وَالسّنة، وَكَانَ المقصرون مِنْهُم يسْألُون الْعلمَاء عَن الحكم الَّذِي يعرض لَهُم فِي عبَادَة أو مُعَاملَة، فيجيبون عَلَيْهِم بِمَا عِنْدهم من الْكتاب وَالسّنة، ويروون لَهُم مَا ورد فيهمَا فِي تِلْكَ الْمَسْألَة، وَأنت تقر بِأنَّهُم على هدى وَحقّ، فَانْظُر فِي حَال من خَالف مَا كَانُوا عَلَيْهِ من أهل التَّقْلِيد الْحَادِث، وَاجعَل نَفسك حَيْثُ شِئْت، واختر لَهَا مَا يحلو.
فَإن قلت: إمامي قد كَانَ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ، قُلْنَا لَك: فَهَل شَاركهُ فِي ذَلِك غَيره أم لَا؟ فَإن قلت: نعم، قُلْنَا لَك: فَمَا حملك على الْأخْذ بقول وَاحِد من أهل الْعلم دون غَيره، مَعَ نَهْيه لَك عَن تَقْلِيده؟!( ).
وَيُقَال لهَذَا الْمُقَلّد أيْضًا: إذا أخْبرك عَالم من عُلَمَاء الْإسْلَام بِأن مَا قلدت إمامك فِيهِ فِي الْمَسْألَة الْفُلَانِيَّة، خلاف مَا فِي كتاب الله أو خلاف مَا فِي سنة رَسُوله، أو خلاف مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة والتابعون، فَهَل أنْت تَارِك لذَلِك الرَّأْي الَّذِي أخذت بِهِ من رَأْي إمامك أم لَا؟.
إن قلت: نعم، فقد هديت ورشدت، وَلَا نطلب مِنْك غير هَذَا، فَانْظُر مَا عِنْد أكَابِر عُلَمَاء عصرك فِي تِلْكَ الْمَسْألَة الَّتِي قلدت إمامك فِيهَا، واسألهم عَن الدَّلِيل، وَعَما هُوَ الْحق المطابق للْكتاب وَالسّنة، واعمل على قَوْلهم، وعَلى مَا يرشدونك إلَيْهِ، وَلَا تسْأل إلَّا من اشْتهر بَين النَّاس بِمَعْرِفَة الْكتاب وَالسّنة.
وَإن قلت: لَا، فاعرف مَا أنْت عَلَيْهِ، وَمَا هُوَ الْأمر الَّذِي وَقعت [فِيهِ]( )، واعترف على نَفسك بِأن رَأْي إمامك أقدم من كتاب الله [۵]( )، وَمن سنة رَسُوله [صلى الله عليه وآله وسلم]( )، وَبعد ذَلِك انْظُر بعقلك: هَل أوجب الله عَلَيْك اتِّبَاع هَذَا الْعَالم، وَالْأخْذ بِجَمِيعِ مَا يَقُوله؟ وَأقل حَال أن تسْأل عُلَمَاء الدّين فِي هَذِه الْمَسْألَة بخصوصها، فَإنَّهُ ينفتح لَك عِنْد ذَلِك بَاب خير وَطَرِيق رشد.
فَإن أبيت، فَاعْلَم أنَّك قد جعلت إمامك نَاسِخًا للشريعة المحمدية رَافعًا لَهَا، وَلَيْسَ بعد هَذَا من الضلال شَيْء، وَأنت إن أنصفت اعْترفت بِهَذَا، وَلم تنكره، [فَإن أنكرته]( )، فَأخْبرنِي [أ:46]: مَتى آثرت دَلِيلًا من كتاب أو سنة على قَول إمامك، أو سَألت ( ) عُلَمَاء الْكتاب وَالسّنة عَن مَسْألَة مِمَّا أنْت عَلَيْهِ وَرجعت إلَى مَا أفتوك بِهِ، ورووه لَك؟.
فَإن قلت: أنْت لَا تعرف الْحجَّة وَلَا تعلقهَا، وَلَا تَدْرِي هَل الصَّوَاب بيد إمامك، أو بيد من خَالفه، قُلْنَا: فَأخْبرنَا، هَل أنْت على قصورك وجهلك لَا يسعك مَا وسع الْمُقَصِّرِينَ من الصَّحَابَة( ) وَالتَّابِعِينَ؟ فقد كَانَ فيهم من هُوَ كَذَلِك.
فَإن قلت: وَمَا كَانُوا يصنعونه إذا احتاجوا إلَى الْعَمَل فِي عبَادَة أو مُعَاملَة؟ قُلْنَا: كَانُوا يسْألُون المشتهرين بِالْعلمِ عَن الشَّرِيعَة فِي تِلْكَ الْمَسْألَة، ويستروونهم( ) النُّصُوص فيروونها لَهُم، فَكُن كَمَا كَانُوا، واعمل كَمَا عمِلُوا.
وَإن قلت: لَا يسعك مَا وسعهم، فَلَا وسع الله عَلَيْك، وستعلم سوء مغبة مَا أنْت فِيهِ، وخسار( ) عاقبته، وَلَا يظلم ربك أحدًا.
وَقد احْتج بعض مقصري المقلدة لجَوَاز التَّقْلِيد بِحَدِيث «أصْحَابِي كَالنُّجُوم، بِأيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ»( ).
وَهَذَا الحَدِيث لم يَصح عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، كَمَا هُوَ مَعْلُوم عِنْد أهل هَذَا الشَّأْن، فقد اتَّفقُوا [على]( ) أنه غير ثَابت، وَلَو سلمنَا ثُبُوته تنزلًا، فَمَعْنَاه ظَاهر وَاضح، وَهُوَ الِاقْتِدَاء بالصحابة فِي الْعَمَل بالشريعة الَّتِي تلقوها عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وأخذوها عَنهُ، فَمن اقْتدى بِوَاحِد مِنْهُم فِيمَا يرويهِ مِنْهَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فقد اهْتَدَى ورشد وَدخل إلَى الشَّرِيعَة من الْبَاب الَّذِي يدْخل إلَيْهَا مِنْهُ. وَلَيْسَ المُرَاد الِاقْتِدَاء بِهِ فِي رَأْيه، فَإنَّهُم ﭫ لَا رأي لَهُم يُخَالف مَا بَلغهُمْ من الشَّرِيعَة قطّ.
مذهب العالم عند فقد الدليل :
وَلَو كَانَ مثل هَذَا حجَّة فِي الِاقْتِدَاء بِمَا ينْقل عَنْهُم من الرَّأْي الرَّاجِع إلَى الْكتاب وَالسّنة بِقِيَاس صَحِيح أو نَحوه، لَكَانَ ذَلِك خَاصًّا بالصحابة؛ للمزية الَّتِي لَا يساويها غَيرهم( )، وَلَا يلْحق بهم سواهُم، مَعَ أنه قد وَقع الْإجْمَاع من عُلَمَاء الْإسْلَام جَمِيعًا أن رأي الْعَالم عِنْد فقد الدَّلِيل إنَّمَا هُوَ رخصَة لَهُ، لَا يحل لغيره الْعَمَل بِهِ( )، حَسْبَمَا قد بَيناهُ فِي مؤلفاتنا بأتم بَيَان، ونقلناه أصح نقل.
ثمَّ بعد اللتيا واللتي( )( ) نقُول لهَذَا الْمُسْتَدلّ بِهَذَا الحَدِيث الَّذِي لم يَصح: هَب أنه صَحِيح، فَهَل قلدت صحابيًّا أم غير صَحَابِيّ، وَعند ذَلِك يقف حِمَاره على القنطرة. وَمثل هَذَا لَو اسْتدلَّ مستدل مِنْهُم بِحَدِيث «عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين من بعدِي».
فَإن المُرَاد بِهِ الِاقْتِدَاء بهم فِي أقْوَالهم وأفعالهم، وَفِي عباداتهم، ومعاملاتهم، وهم لَا يوقعونها إلَّا على الْوَجْه الَّذِي أخَذُوهُ عن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وعرفوه من أفعاله وأقواله، وَقد كَانَ ذَلِك ديدنهم وهَجِيراهم، لَا يفارقونه قيد شبر، وَلَا يخالفونه أدنى مُخَالفَة.
فَهَذَا هُوَ المُرَاد بِالْحَدِيثِ على مَا فِيهِ من الْمقَال، فَإن فِي إسْنَاده مولى الرِّبعي( )، وَهُوَ مَجْهُول، والمفضل الضَّبِّيّ، وَلَيْسَ بِحجَّة( ).
ثمَّ بعد اللتيا واللتي( ) نقُول للمستدل بذلك، فَهَل قلدت أحد الْخُلَفَاء الرَّاشِدين أم قلدت غَيرهم؟ [أ:47].
وَهُوَ لَابُد أن يعْتَرف أنه قلد غَيرهم، وَأنه أبعد النَّاس عَن اتِّبَاع مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَأنه لَو جَاءَهُ من هديهم الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ مُجَلد ضخم يُخَالف أدنى مَسْألَة مِمَّا قلد فِيهَا إمَامه، لرمى بِهِ وَرَاء الْحَائِط، وَلم يلْتَفت إلَيْهِ، وَلَا عوَّل( ) عَلَيْهِ.
ثمَّ إذا صَحَّ هَذَا الحَدِيث، فَفِيهِ الْإرْشَاد إلَى سنته صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وَسنة خلفائه الرَّاشِدين، وَمَعْلُوم أن مَا كَانَ قد ثَبت من سنته لَا يُخَالِفهُ الْخُلَفَاء الراشدون، وَلَا غَيرهم من الصَّحَابَة.
بل هم عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُم سنة تخَالف مَا سَنَّه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قطّ، وَلَا سمع عَن وَاحِد مِنْهُم فِي جَمِيع عمره أنه خَالف سنة ثَابِتَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم.
منهج الاجتهاد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه:
وَإذا عرفت هَذَا، فقد قدمنَا من الْآيَات القرآنية، وَالْأحَادِيث( ) الصَّحِيحَة مَا هُوَ مَنْهَج الْحق، ومهيع الشَّرْع، وَهُوَ الْأمر الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وخلفاؤه الراشدون، وَبِه تقوم الْحجَّة على كل مُسلم، وَمن سنته صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم [الصَّحِيحَة]( ) الثَّابِتَة المتلقاة بِالْقبُولِ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «كل أمر لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد».
وكل عَاقل لَهُ أدنى تعلق بِعلم الشَّرِيعَة المطهرة، يعلم علمًا [يقينًا]( ) لَا شكّ فِيهِ وَلَا شُبْهَة، أن التَّقْلِيد لم يكن عَلَيْهِ أمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وَأنه حَادث بعد مُضِيّ عصره صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وعصر أصْحَابه، وعصر التَّابِعين لَهُم، فَهُوَ ردٌّ؛ [أي]( ) مَرْدُود، مَضْرُوب بِهِ وَجه صَاحبه( ).
فَإنَّا نعلم أن الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم هُوَ الْعَمَل بِكِتَاب الله سُبْحَانَهُ، ثمَّ بِمَا سَنَّه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وَبَينه للنَّاس عَن أمر الله، كَمَا قَالَ: ﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [النجم: 4]، وَقَالَ: ﴿ﮠ( ) ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [الحشر: 7]، وَقَالَ: ﴿ﭱ( ) ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [التغابن: 12]، وَقَالَ: ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [آل عمران: 31]، وَقَالَ ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [الأحزاب: 21]، وَقَالَ: ﴿ﰀ( ) ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النساء: 59] الْآيَة، وَقَالَ: ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ[ﯮ ﯯ]( ) ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [النور: 51]، وَقَالَ: ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النساء: 65]، وَقد تقدم الْكَلَام على بعض هَذِه الْآيَات الْكَرِيمَة.
وَمن سنته صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم الَّتِي قَالَ فِيهَا: «عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين»( )، وقَوْله( ) صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «كل بِدعَة ضَلَالَة». والتقليد بِدعَة لَا يُخَالف فِي ذَلِك مُخَالف، وَلَا يشك فِيهِ شَاك.
فِيا أيهَا الْمُقَلّد، انْزعْ عَن غوايتك، واخرج عَن ضلالتك، وخلِّص نَفسك من بدعتك، ودع عَنْك التَّعَلُّق بِمَا لَا يسمن وَلَا يُغني من جوع.
فَهَذَا الْحق لَيْسَ بِهِ خَفَاء
وَدعنِي من بُنَيَّاتِ الطَّرِيق( )
فَخير الْأمُور السالفات على الْهدى
وَشر الْأمُور المحدثات الْبَدَائِع( )
فَهَكَذَا نقُول فِي حَدِيث «اقتدوا باللذين( ) بعدِي أبُي بكر( ) وَعمر»( )، وَحَدِيث « رضيت لأمتي مَا رضي لَهَا ابْن أم عبد»، وَحَدِيث «إن أبَا عُبَيْدَة بن الْجراح( ) أمِين هَذِه الْأمة»( )، وَنَحْو ذَلِك من الْأحَادِيث.
فَالْمُرَاد الِاقْتِدَاء بِمن أمرنَا بالاقتداء بِهِ فِي أقْوَاله وأفعاله الْوَارِدَة على الشَّرِيعَة المطهرة، وَكَذَلِكَ الرضا بما رضيه( ) ابْن مَسْعُود من الْأفْعَال والأقوال الْوَارِدَة على مَا توجبه الشَّرِيعَة المطهرة. وَكَذَلِكَ كَون أبي عُبَيْدَة بن الْجراح أمِين هَذِه الْأمة، [هُوَ]( ) لما اختصه الله سُبْحَانَهُ بِهِ من عظم الْأمَانَة على الْأمُور، الَّتِي من أعظمها هَذَا الدّين القويم والشريعة الْمُبَارَكَة.
موقف عوام المسلمين من التقليد :
وَقد عرفت مَا قدمْنَاهُ؛ من أنا لَا نكلف الْمُقَلّد أن يعرف نُصُوص الشَّرِيعَة حَتَّى يَقُول: لَا أقدر على ذَلِك وَلَا أستطيعه، بل قُلْنَا لَهُ: دع [عنك]( ) هَذِه الْبِدْعَة الْحَادِثَة، وَكن كَمَا كَانَ المقصرون من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ( )، الَّذين اشتغلوا عَن حفظ الْعلم وَالْبُلُوغ إلَى غَايَته بِالْأعْمَالِ الصَّالِحَة، من جِهَاد أو عبَادَة، وَلَك بهم أسْوَة، وَفِيهِمْ لَك قدوة، فاسأل أهل الْعلم كَمَا أمرك الله بسؤالهم بقوله: ﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [النحل: 43]. واطلب مِنْهُم أن يرووا لَك مَا جَاءَت بِهِ الشَّرِيعَة فِي الْحَادِثَة الَّتِي احتجت إلَى السُّؤَال عَنْهَا من عبَادَة أو مُعَاملَة.
وكل عَالم يعلم - وَإن قلَّ علمه - أنه لم يكن فيهم أحد منتسبًا إلَى أحد من كبار الصَّحَابَة، الَّذين كَانُوا يروون للنَّاس الْعلم ويفتونهم بِهِ، كَمَا ينْسب بعد حُدُوث الْمذَاهب كل مقلد إلَى من قَلّدهُ، بل كَانَ السَّائِل مِنْهُم يسْأل من يلقاه من المشتهرين بِالْعلمِ مِنْهُم، على كَيفَ مَا يتَّفق لَهُ، وَيَأْخُذ( ) مَا يرويهِ لَهُ، ويفتيه بِهِ، وَقد قدمنَا الْإشَارَة إلَى هَذَا.
الاجتهاد ووجود النص:
وَيَنْبَغِي أن يعلم كل من لَهُ فهم؛ أن دين الله وَاحِد، وَأن مَا أحله فَهُوَ حَلَال لَا يتَغَيَّر عَن صفته، وَمَا حرمه فَهُوَ حرَام لَا يتَغَيَّر. وَإذا قَالَ قَائِل من أهل الْعلم - فِيمَا قد أحله بكتابه أو بِسنة رَسُوله -: أنه حرَام، فَهُوَ مُخطئ، مُخَالف لما شَرعه الله لِعِبَادِهِ، وَإذا قَالَ قَائِل من أهل الْعلم - فِيمَا قد حرمه الله سُبْحَانَهُ -: أنه حَلَال، فَهُوَ مُخطئ آثم، مُخَالف لما شَرعه الله لِعِبَادِهِ.
وَلَكِن هَذَا الْقَائِل الَّذِي قَالَ بِخِلَاف مَا تقرر فِي الشَّرِيعَة، إن كَانَ أهلًا للِاجْتِهَاد، وَقد بحث كُلية الْبَحْث، فَلم يجد، فَهُوَ مُخطئ مأجور، كَمَا فِي الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي قدمنَا ذكره، أن للمجتهد مَعَ الْإصَابَة أجْرَيْنِ، وللمجتهد مَعَ الْخَطَأ أجرًا، وَهُوَ حَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ، مُتلقًى بِالْقبُولِ. وَإن كَانَ غير أهل للِاجْتِهَاد، أو لم يبْحَث كمَا يجب عَلَيْهِ، فَهُوَ مجازف فِي دين الله، آثم بمخالفته لما شَرعه الله [سبحانه]( ) لِعِبَادِهِ.
فَمن قَالَ: إن كل مُجْتَهد مُصِيب، [إن أرَادَ أنه مُصِيب]( ) للحق، فقد غلط غَلطًا بَينًا، فَإنَّهُ جعل حكم الله سُبْحَانَهُ متناقضًا متخالفًا؛ لِأنَّهُ إذا قَالَ قَائِل: هَذَا حرَام، وَقَالَ آخر: هَذَا حَلَال، كَانَ حكم الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الْعين عِنْده أنَّهَا حَلَال حرَام، وَهَذَا بَاطِل من القَوْل، وزائف من الرَّأْي، وفاسد من النّظر، فَإنَّهُ مَعَ كَونه بَاطِلًا فِي نَفسه، يتنزه الله ۵ عَنهُ، هُوَ أيْضًا خلاف مَا عِنْد أهل الْعلم( ). [أ:49].
وَإن أرَادَ أنه مُصِيب، بِمَعْنى أنه يسْتَحق أجرًا على اجْتِهَاده، وَإن أخطَأ، فَهَذَا معنى صَحِيح، وَلكنه إطْلَاق لفظ يُخَالف مَا أطلقهُ عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم حَيْثُ قَالَ: «وَإن اجْتهد فَأخْطَأ فَلهُ أجر»، فَلَا يَنْبَغِي أن يُطلق لفظ الْمُصِيب عَلَيْهِ، وَإن كَانَ لمن أطلق هَذَا اللَّفْظ إرَادَة صَحِيحَة، بل يَنْبَغِي أن يُقَال كَمَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم من وَصفه بالْخَطَأ، مَعَ اسْتِحْقَاق الْأجر، أو يُقَال: إنَّه مُخطئ مأجور.
وكما أن هَذَا الْإطْلَاق لَا يحسن لما فِيهِ من شبه الرَّد على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وَإن كَانَ لَهُ إرَادَة صَحِيحَة، كَذَلِك لَا يجوز أن يُقَال فِي شَأْن هَذَا الْمُخطئ كَمَا يَقُوله بعض أهل الْأصُول: إنَّه مُخطئ آثم( )، فَإن هَذَا قَول بِالْجَهْلِ، وَمُخَالفَة لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فَإنَّهُ أثبت لَهُ الْأجر، وَهَذَا الْقَائِل أثبت لَهُ الْإثْم.
وَأما قَول من قَالَ من أهل الْأصُول: إنَّه مُخطئ، مُخَالف للأشبه( )عِنْد الله، فَهُوَ قَول صَوَاب؛ لِأنَّهُ مَعَ الْخَطَأ قد خَالف الْحق، إذا كَانَ يُرِيد بالأشبه مَا هُوَ الْحق عِنْد الله.
وَإن كَانَ يُرِيد غير هَذَا الْمَعْنى، كَأن يُرِيد بالأشبه الْأقْرَب، فَهُوَ كَلَام غير صَحِيح؛ لِأنَّهُ لَا قرب لخلاف الْحق حَتَّى يكون الْحق أقرب مِنْهُ. وعَلى كل حَال، فَالْأحْسَن أن يُقَال فِي مُخطئ الْحق مَا قَالَه رَسُول الله مُخطئ لَهُ أجر.
والبعيد كل الْبعد( ) عَن الْحق قَول من قَالَ: إن كل مُجْتَهد مُصِيب من الْإصَابَة، وَإن كل وَاحِد من الْعلمَاء قد أصَاب الْحق الَّذِي يُريدهُ الله سُبْحَانَهُ، فَإنَّهُم قد جعلُوا مُرَاد الله [۵]( ) أمرًا دائرًا بَين اجتهادات الْمُجْتَهدين إلَى يَوْم الْقِيَامَة، فَكل مُجْتَهد إذا اجْتهد، فَذَلِك الِاجْتِهَاد هُوَ مُرَاد الله من الْعباد، وَإن خَالف اجْتِهَاد غَيره، وناقضه كَمَا تقدم.
منهج المقلدين هو منهج السوفسطائيين:
وَمَا أشبه الْقَائِل بِهَذِهِ الْمقَالة بالفرقة الَّتِي يُقَال لَهَا الْفرْقَة السوفسطائية( )، فَإنَّهُم جَاءُوا بِمَا يُخَالف الْعقل، فَلم يعْتد بأقوالهم أحد من عُلَمَاء الْمَعْقُول؛ لِأنَّهَا بالجنون أشبه مِنْهَا بِالْعقلِ.
وهم ثلاث فرق: عِنْدِيَّة، وعِنَادية، والأدَرية.
فالعندية: إذا قيل لأحَدهم: أنْت مَوْجُود؟ قَالَ للقائل: عنْدك لَا عِنْدِي.
والعنادية: إذا قيل لأحَدهم: أنْت مَوْجُود؟ قَالَ: لَا، فَإذا قيل لَهُ: مَا هَذَا الشبح الَّذِي أرَاهُ، وَالْكَلَام الَّذِي أسمعهُ مِنْهُ، وَالْجرم الَّذِي ألمسه؟ قَالَ: لَا شَيْء، وَلَا وجود لي.
وَأما الأدرية: فَإذا قيل لأحَدهم: أنْت مَوْجُود؟ قَالَ: لَا أدْرِي.
وَقد صرح عُلَمَاء الْمَعْقُول أن هَؤُلَاءِ لَا يسْتَحقُّونَ جَوَابًا إلَّا الضَّرْب لَهُم حَتَّى يعترفوا؛ لأنهم لَا يقبلُونَ حجَّة، وَلَا يسمعُونَ برهانًا.
وَمن عَجِيب صنع المقلدة: أنهم يقبلُونَ مِمَّن ينتسب إلَى مَذْهَبهم التَّرْجِيح بَين الرِّوَايَتَيْنِ لإمامهم، وَإن كَانَ ذَلِك الْمرجع مُقَلدًا غير مُجْتَهد، وَلَا قريب من رُتْبَة الْمُجْتَهد.
وَلَو جَاءَ من هُوَ كإمامهم أو فَوق إمَامهمْ، وَأخْبرهمْ عَن الرَّاجِح من ذَيْنك الْقَوْلَيْنِ، لم يلتفتوا إلَيْهِ( )، وَلَا قبلوا قَوْله، وَلَو عضد ذَلِك بِالْآيَاتِ المحكمة، وَالْأحَادِيث المتواترة، بل يقبلُونَ من موافقيهم مُجَرّد التَّخْرِيج على مَذْهَب إمَامهمْ، وَالْقِيَاس على مَا ذهب إلَيْهِ، ويجعلونه دينًا، وَيحلونَ بِهِ ويحرمون.
فيا لله وللمسلمين، مَعَ علم كل عَاقل أن الرب وَاحِد، وَالنَّبِيّ وَاحِد، وَالْأمة وَاحِدَة، وَالْكتاب وَاحِد.
وَبِالْجُمْلَةِ؛ فَكل من يعقل لَا يخفى عَلَيْهِ أن هَذِه الْمذَاهب قد صَار كل وَاحِد مِنْهَا كالشريعة عِنْد أهله، يذودون عَنهُ كتاب الله وَسنة رَسُوله، ويجعلونه جِسْرًا يدْفَعُونَ بِهِ كل مَا يُخَالِفهُ كَائِنًا مَا كَانَ.
دعوتهم لسد باب الاجتهاد:
وَالْعجب أن هَؤُلَاءِ - مكاسير المقلدة - لم يقفوا حَيْثُ أوقفهم الله من الْقُصُور، وَعدم الْعلم النافع، فَقَامُوا على أهل الْعلم قومة جَاهِلِيَّة، وَقَالُوا: بَاب الِاجْتِهَاد قد انسد، وَطَرِيق الْكتاب وَالسّنة قد رُدِمَت( ).
وَهَذِه الْمقَالة من هَؤُلَاءِ الْجُهَّال تَتَضَمَّن نسخ الشَّرِيعَة وَذَهَاب رسمها، وَبَقَاء مُجَرّد اسمها، وَأنه لَا كتاب وَلَا سنة؛ لِأن الْعلمَاء العارفين بهما إذا لم يبْق لَهُم سَبِيل على الْبَيَان الَّذِي أمر الله سُبْحَانَهُ( ) عباده بِهِ بقوله: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [آل عمران: 187]، وَبِقَوْلِهِ: ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ إلَى قَوْله: ﴿ﮰ ﮱ ﯓ﴾ [البقرة: 159].
فقد انْقَطَعت أحْكَام الْكتاب وَالسّنة، وَارْتَفَعت من بَين الْعباد، وَلم يبْق إلَّا مُجَرّد تِلَاوَة الْقُرْآن، ودرس كتب السّنة، وَلَا سَبِيل إلَى التَّعَبُّد بِشَيْء مِمَّا فيهمَا.
وَمن زعم عِنْد هَؤُلَاءِ الجهلة أنه يقْضِي أو يُفْتِي بِمَا فيهمَا، أو يعْمل لنَفسِهِ بِشَيْء مِمَّا اشتملا عَلَيْهِ، فدعواه بَاطِلَة وَكَلَامه مَرْدُود. فَانْظُر إلَى هَذِه الفاقرة الْعُظْمَى، والداهية الدهياء( )، والجهالة الجهلاء، والبدعة العمياء الصماء، سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم.
وَإن زَعَمُوا أن هَذَا الصَّنِيع مِنْهُم لَيْسَ هُوَ بِمَعْنى مَا ذكرنَا من نسخ الْكتاب وَالسّنة، وَرفع التَّعَبُّد بهما، فَقل لَهُم: فَمَا بَقِي بعد قَوْلكُم هَذَا؟ فَإنَّكُم قد قُلْتُمْ: لَيْسَ للنَّاس إلَّا التَّقْلِيد، وَلَا سَبِيل لَهُم إلَى غَيره، وَأن الِاجْتِهَاد قد انسد بَابه وَبَطلَت دَعْوَى من يَدعِيهِ، وَامْتنع فضل الله على عباده، وانقطعت حجَّته!.
وَهَذَا مَعَ كَونه من الْإفْك الْبَين، قد اخْتلفت فِيهِ أنظار هَؤُلَاءِ المقلدة اخْتِلَافًا كثيرًا، فَقَالَت طَائِفَة مِنْهُم: لَيْسَ لأحد أن يجْتَهد بعد أبي حنيفَة، وَأبي يُوسُف، وَزفر بن الْهُذيْل، وَمُحَمّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ، وَالْحسن بن زِيَاد اللؤْلُؤِي، وَإلَى هَذَا ذهب غَالب المقلدة من الْحَنَفِيَّة.
وَقَالَ بكر بن الْعَلَاء الْقشيرِي الْمَالِكِي: لَيْسَ لأحد أن يجْتَهد بعد الْمِائَتَيْنِ من الْهِجْرَة. وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ لأحد أن يجْتَهد بعد الْأوْزَاعِيّ، وسُفْيَان الثَّوْريّ، ووكيع ابْن الْجراح، وَعبدالله بن الْمُبَارك. وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ لأحد أن يجْتَهد بعد الشَّافِعِي( ). وَقد ذكرنَا بعض هَذَا الْبَاطِل الْبَين والإفك الصَّرِيح فِي رسالتنا الَّتِي سميناها «القَوْل الْمُفِيد فِي حكم التَّقْلِيد»( ).
وَهَؤُلَاء - وَإن كَانُوا خَارِجين عَن زمرة الْعلمَاء بِالْإجْمَاع، حَسْبَمَا نَقَلْنَاهُ فِيمَا تقدم، وَلَيْسوا مِمَّا يسْتَحق الِاشْتِغَال بِمَا قَالَه، وَتَطْوِيل الْكَلَام فِي الرَّد عَلَيْهِ؛ لأنهم فِي عداد أهل الْجَهْل لَا يرتفعون عَن طبقتهم بِمُجَرَّد حفظهم لرأي من قلدوه، لكِنهمْ لما طبقت بدعتهم أقطار الأرْض، وصاروا هم السوَاد الْأعْظَم، وَكَانَ غَالب الْقُضَاة والمفتين مِنْهُم، وَكَذَلِكَ سَائِر أهل المناصب، فَإنَّهُم مشاركون لَهُم فِي الْجَهْل بِمَا شَرعه الله [تعالى]( ) لِعِبَادِهِ - صَارُوا أهل الشَّوْكَة والصولة، وَلَيْسَ للعامة بَصِيرَة يعْرفُونَ بهَا أهل الْعلم وَأهل الْجَهْل، ويميزون بَين مَنَازِلهمْ، وَغَايَة مَا عِنْدهم أنهم ينظرُونَ إلَى أهل المناصب وَإلَى المتجملين بالثياب الرفيعة، فَإن دققوا النّظر نظرُوا إلَى المدرسين فِي الْعلم، وهم عِنْد هَذَا النّظر يرَوْنَ شيخ علم الرَّأْي قد اجْتمع عَلَيْهِ الْجمع الجم من المقلدة، وَلَهُم صُرَاخ وعويل وجلبة، وَقد استغرقوا - هم وشيوخهم - الْمدَارِس والجوامع، وَلَا يرَوْنَ لشيوخ علم الْكتاب وَالسّنة أثرًا وَلَا خَبرًا، فَإن دَرَّسَ شيخ من شيوخهم فِي مدرسة أو جَامع، فَهُوَ فِي زَاوِيَة( ) من زواياه، يقْعد بَين يَدَيْهِ الرجل وَالرجلَانِ، وهم فِي سكينَة ووقار، لَا يلْتَفت إلَيْهِم ملتفت، وَلَا يتطلع لأمرهم متطلع، فَمَاذَا ترى الْعَاميّ عِنْد هَذَا النّظر، مَا ذَاك يخْطر بِبَالِهِ؟ ويغلب على ظَنّه؟ وَإلَى من يمِيل، وَلمن يحكم بِالْعلمِ؟ وعَلى من يلقي مقاليد مَا ينوبه من أمر دينه ودنياه؟ فلهذه النُّكْتَة احتجنا إلَى هَذَا الْكَلَام فِي هَذَا الْمُؤلف وَغَيره من مؤلفاتنا، وَإلَّا فهم أقل وأحقر من أن يشْتَغل بشأنهم، أو يعبأ بِمَا يصدر منهم من الْجَهْل المكشوف، الذي( ) لَا يكَاد يلتبس على من لَدَيْهِ أدنى علم وَأقل تَمْيِيز.
جهاد المصنف للمقلدين:
وَلَقَد كَانَ لي مَعَ هَؤُلَاءِ فِي أيَّام الِاشْتِغَال بالدرس والتدريس، وعنفوان الشَّبَاب، وحدة الحداثة، قلاقل وزلازل، جمعت فِيهَا رسائل، وَقلت فِيهَا قصائد.
فَمن جملَة مَا خاطبتهم بِهِ مَا قلته من قصيدة:
يَا ناقدًا لمقال لَيْسَ يفهمهُ
من لَيْسَ يفهم قل لي كَيفَ تنتقد
يَا صاعدًا فِي وعور ضَاقَ مَسْلَكُها
أيصعد الوعر من فِي السهل يرتعد؟
يَا مَاشِيًا فِي فلاة لَا أنيس بهَا
كَيفَ السَّبِيل إذا مَا اغتالك الْأسد؟
يَا خائض الْبَحْر لَا يدْرِي سباحته
ويلي عَلَيْك أتنجو إن علا الزَّبَدُ؟( )
وَمِنْهَا:
إنِّي بُليت بِأهْل الْجَهْل فِي زمن
قَامُوا بِهِ وَرِجَال الْعلم قد قعدوا
قوم يدق جليل القَوْل عِنْدهم
فمالهم طَاقَة فِي حل مَا يرد
وَغَايَة الْأمر عِنْد الْقَوْم أنهم
أعدى العداة لمن فِي علمه( ) سدد
إذا رَأوْا رجلًا قد نَالَ مرتبَة
فِي الْعلم دون الَّذِي يدرونه جَحَدُوا
أو مَال عَن زائف الْأقْوَال مَا تركُوا
بَابًا من الشَّرّ إلَّا نَحوه قصدُوا
أما الحَدِيث الَّذِي قد صَحَّ مخرجه
كالأمهات فَمَا فيهم لَهَا( ) ولد
تراهم إن رَأوْا من قَالَ حَدثنَا
قَالُوا لَهُ ناصِبِيِّ مَا له رشد
وَإن ترْضى على الْأصْحَاب بَينهم
قَالُوا لَهُ باغض للآل مُجْتَهد
يَا غارقين بشؤم الْجَتهْل فِي بدع
ونافرين عَن الْهدى القويم هُدُوا( )
مَا بِاجْتِهَاد فَتى فِي الْعلم منقصة
النَّقْص فِي الْجَهْل لَا حياكم الصَّمد( )
لَا تنكروا موردًا عذبًا لشاربه
إن كَانَ لَابُد من إنْكَاره فَردُّوا
وَإن أبَيْتُم فَيوم الْحَشْر موعدنا
فِي موقف الْمُصْطَفى وَالْحَاكِم الْأحَد( )
وَمِمَّا قلته فِي ذَلِك:
على عصر الشبيبة كل حِين
سَلام مَا تقهقهت الرعود
ويسقيه من السحب السَّوَارِي
ملث دَائِم التسكاب جود
زمَان خضت فِيهِ بِكُل فن
وسدت مَعَ الحداثة من يسود
وعدت على الَّذِي حصلت مِنْهُ
فجدت بِهِ وغيري لَا يجود
وعاداني على هَذَا أناس
وأظلم من يعاديك الحسود
رأوني لَا أدين بدين قوم
يرَوْنَ الْحق مَا قَالَ الجدود
ويطرحون قَول الطّهْر طه
وكل مِنْهُم عَنهُ شرود
فَقَالُوا قد أتَى فِينَا فلَان
بمعضلة وفاقرة تؤود [أ:53]
يَقُول الْحق قُرْآن وَقَول
لخير الرُّسُل لَا قَول ولود
فَقلت كَذَا أقُول وكل قَول
عدا هذَيْن تطرقه الردود
وَهَذَا مَهْيَعُ الْأعْلَام قبلي
وَكلهمْ لمورده وَرود
إذا جحد امْرُؤ فضلي ونبلي
فَقدمًا كَانَ فِي النَّاس الْجُحُود
وكل فَتى إذا مَا حَاز علمًا
وَكَانَ لَهُ بمدرجة صعُود
وراض جوامحًا من كل فن
وَصَارَ لكل شاردة يَقُود
رَمَاه القاصرون بِكُل عيب
وَقَامَ لحربه مِنْهُم جنود
فعادوا خائبين وكل كيد
لَهُم فعلى نُفُوسهم يعود
وراموا وضع رتبته فَكَانُوا( )
على الشّرف الرفيع هم الشّهُود
إذا مَا الله قدر نشر فضل
لإنْسَان يتاح لَهُ حسود
وَمن كثرت فضائله يعادى
وَيكثر فِي مناقبه الْجُحُود
وَيكثر فِي مناقبه الْجُحُود
إذا مَا غَابَ يلمزه أنَاس( )
وهم عِنْد الْحُضُور لَهُ سُجُود( )
وَلَيْسَ يضر نبح الْكَلْب بَدْرًا
وَلَيْسَ تخَاف من حمر أسود
وَمَا الشم الشوامخ عِنْد ريح
تمر على جوانبها تمود
وَلَا الْبَحْر الخضم يعاب يَوْمًا
إذا بَالَتْ بجانبه القرود( )
وَمِمَّا قلته من قصيدة طَوِيلَة:
لَا عيب لي غير أنِّي فِي دِيَاركُمْ
شمس وَلم يعرفوا مِنْهَا سوى الشهب
وَأنْتُم كخفافيش الظلام وَمَا
زَالَ الخفاش بِنور الشَّمْس فِي تَعب
موتوا إذا شِئْتُم قد طَار من كلمي
فِي نصْرَة الْحق مَا حررت فِي الْكتب
وأرتجي أن يُلَبِّي دَعْوَتِي نفرٌ
يسعون للدّين لَا يسعون للنشب
لَا يعدلُونَ بقول الله قَول فَتى
وَلَا بِسنة خير الرُّسُل رَأْي( ) غبي
لَا ينثنون عَن الْهدى القويم وَلَا
يصانعون لترغيب وَلَا رهب
أبث مَا بَينهم من مذهبي دررًا
حَجَبتهَا عَن ذَوي التَّقْلِيد والريب
يَا فرقة ضيعت أعلامها سفهًا
وصيرت رَأس أهل الْعلم كالذنب
مَا قَامَ رب عُلُوم فِي دِيَاركُمْ
إلَّا وجرعتموه أكؤس الكرب [أ:54]
من قَالَ: قَالَ رَسُول الله بَيْنكُم
غَدا بذا عنْدكُمْ من جملَة( ) النَّصَب
وَمِنْهَا:
عاديتم السّنة الغرا فَكَانَ بذا
دَعْوَى خصومكم مَوْصُولَة السَّبَب
كم ظن ذُو حمق فِي الضّر مَنْفَعَة
وظل( ) يَرْجُو نجاحًا من يَد العطب
سودتم جيل جهل بالعلوم وَذَا
رَأْي يجر بذيل الويل وَالْحَرب
وَالِاجْتِهَاد غَدا فِي كتب فقهكم
شَرط الإمَام فَإن يعدوه لم يجب
وَشرط حمال أعباء الْقَضَاء مَعَ
الْإفْتَاء فَلم تعرفوا مَا خطّ فِي الْكتب
وَمِنْهَا:
وإنني حزت أضْعَاف الَّذِي شرطُوا
قبل الثَّلَاثِينَ من عمري بِلَا كذب
ألم أضمخ أرجاء الْجَوَامِع بالتدريس
فِي كل فن معشر الطّلب
ألم أصنف فِي عصر الشبيبة مَا
يَغْدُو لَهُ مُحكم الْعرْفَان فِي طرب
لَو كَانَ مطلع شمس غير أرْضكُم
مَا حَال دون سناها عَارض السحب
وَلَا غَدَتْ لعشا الناظرين لَهَا
كَأنَّهَا طلعت فِي مظلم الْحجب( )
وَمِمَّا قلته من قصيدة طَوِيلَة:
وَمَا سد بَاب الْحق عَن طَالب الْهدى
وَلَكِن عين الأرمد الفدم سدت
رجال كأمثال الخفافيش ضوءها
يلوح لَدَى الظلماء وتعمى بِضَحْوَةٍ
وَهل ينقص الْحَسْنَاء فقدان رَغْبَة
إلَى حسنها مِمَّن أصِيب بعنة
وَهل حط قدر الْبَدْر عِنْد طلوعه
إذا مَا كلاب أنكرته فهرّت
وَمَا إن يضر الْبَحْر أن قَامَ أحمَق
على شطه يَرْمِي إلَيْهِ بصخرة
فخض فِي غمار الِاجْتِهَاد وعد عَن
رجال تسلت عَن سناء بفرية
وَمِنْهَا:
وَإن كنت شهمًا ناقدًا متبصرًا
فدع مَا بِهِ عين من الْعَمى قرت
فَمَا جَاءَنَا نقل بقصر وَلَا أتَى
بذلك حكم للعقول الصَّحِيحَة
وَمَا فاض من فضل الْإلَه على الأولى
مضوا فَهُوَ فياض عَلَيْك بحكمة
وَلَا تَكُ مطواعًا ذلولًا لرايض
تصير بِهَذَا مشبهًا للبهيمة [أ:55]
وَمَا قلته من الْأشْعَار الْجَارِيَة فِي هَذَا الْمِضْمَار، فَهُوَ كثير جدًّا، يحْتَاج إلَى مؤلف مُسْتَقل. وَقد حكيت بعض مَا وَقع لي مَعَ هَؤُلَاءِ المقلدة فِي الْكتاب الَّذِي سميته: «أدب الطّلب ومنتهى الأرب».
وكيدهم العتيد، وحسدهم الشَّديد، مُسْتَمر إلَى الْآن، وَالله نَاصِر دينه، وَرَافِع أعْلَام شَرِيعَته، وكابت من رام أهلهَا، أو رام الحاملين لَهَا بكيد ومكر، ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [فاطر: 43]، ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ يخادعون( ) ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [البقرة: 9]، ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [آل عمران: 54]، ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [يونس: 23]، ﴿ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [آل عمران:173، 174].
وَمَا أصدق هَذِه المواعيد الَّتِي وعد الله بهَا عباده، وَأبين حُصُولهَا، وَأظْهر وُقُوعهَا، وَهُوَ صَادِق الْوَعْد، فَللَّه( ) الْحَمد، [فَإنَّهُ]( ) مَا قَامَ قَائِم فِي مُعَارضَة المحقين إلَّا وكبه الله على منخره، وحاق بِهِ مكره، وَعَاد على نَفسه خداعه، وأحاط بِهِ بغيه.
وَكم قد رَأينَا من هَذَا وَسَمعنَا فِي عصرنا ومعنا وَفينَا، فَكَانَت الْعَاقِبَة لِلْمُتقين، كَمَا وعد بِهِ رب الْعَالمين، وَالْحَمْد لله.
خطر التّقليد والمقلدين:
وكما أن [قَول هَذِه]( ) المقلدة، الَّذين ردموا بَاب الِاجْتِهَاد، وسدوا طرقه، قد استلزم [فعلهم]( ) رفع الْكتاب وَالسّنة والتعبد بغَيْرهما، فَكَذَلِك استلزم رد مَا صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم من أنَّهَا «لَا تزَال طَائِفَة من هَذِه الْأمة على الْحق ظَاهِرين»( )، وَكَذَلِكَ استلزم رد مَا صَحَّ أنه لَا يزَال في هَذِه الْأمة قَائِم بِحجَّة الله، وَكَذَلِكَ استلزم رد مَا ورد، من أن الله سُبْحَانَهُ يبْعَث لهَذِهِ الْأمة فِي رَأس كل مائَة سنة من يجدد لَهَا دينهَا.
وجود الاجتهاد في المذاهب حجة على المقلدين:
وَمَعَ هَذَا؛ فَكل طَائِفَة من طوائف الْمذَاهب الَّذين كدر مشارب مذاهبهم وجود هَؤُلَاءِ المقلدة الَّذين لَا يعْقلُونَ حجَّة، وَلَا يعْرفُونَ برهانًا، وَلَا يفهمون من الْعلم إلَّا مُجَرّد صور، وقفُوا عَلَيْهَا فِي مختصرات المفرعين، قد جعل الله سُبْحَانَهُ فيهم من الْعلمَاء المبرزين العارفين بِالْكتاب وَالسّنة، وَبِمَا هُوَ كالمقدمة لَهما من الْعُلُوم الآلية وَغَيرهَا، عددًا جمًّا، كَمَا يعرف ذَلِك من يعرف أخْبَار النَّاس ويدري بأحوال الْعَالم، وَفِيهِمْ من كمل الله سُبْحَانَهُ لَهُم عُلُوم الِاجْتِهَاد وفوقها، وَلَكنهُمْ امتحنوا بهؤلاء الصم الْبكم من المعاصرين لَهُم من مقلدة الْمذهب، الَّذين اشْتَركُوا فِيهِ بِمُجَرَّد الانتماء إلَيْهِ، فغلبوهم على أنفسهم، وصانعوهم، [أ:56] وداروهم؛ لما يخشونه من معرتهم، ويتوقعونه من إغراء الْعَامَّة بهم( ).
فَمنهمْ من كتم اجْتِهَاد نَفسه، وَلم يسْتَطع أن ينْسب إلَى نَفسه الِاجْتِهَاد، وَلَا تَظَهَّر بِمَا يدين بِهِ ويعتقده من تَقْدِيم مَا يعرفهُ من الْأدِلَّة على مَا يُخَالِفهُ من الرَّأْي. وَمِنْهُم من تظهر بعض التُّظَهَّر، فلقي من متفقهة المقلدة من إغراء الْعَامَّة بِهِ( ) مَا هُوَ مَعْرُوف لمن نظر فِي التواريخ الْعَامَّة أو الْخَاصَّة( ) بِمذهب من الْمذَاهب، وَطَائِفَة من الطوائف.
وَمن كَانَ لَا يعرف التَّارِيخ، وَلَا ينشط إلَى الِاطِّلَاع على أخْبَار( ) الْعَالم، وَتَحْقِيق أحْوَال( ) الطوائف، فَلْينْظر إلَى مثل مؤلفات ابْن عبدالسَّلَام، وَابْن دَقِيق الْعِيد، وَابْن سَيِّد النَّاس، والذهبي، وزين الدّين الْعِرَاقِيّ، وَابْن حجر الْعَسْقَلَانِي، والسيوطي، وأمثالهم من الشَّافِعِيَّة. وَإلَى مثل مؤلفات ابْن قدامَة، وَمن فِي طبقته من المَقَادِسة، وَمن بعدهمْ، مثل تَقِيّ الدّين ابْن تَيْمِية، وتلميذه ابْن الْقيم، وأمثالهم من الْحَنَابِلَة. وَمثل ابْن عبدالبَرّ،ِ وَالْقَاضِي عِيَاض، وَابْن الْعَرَبِيّ، وأمثالهم من الْمَالِكِيَّة.
وَبِالْجُمْلَةِ؛ فَفِي كل مَذْهَب الْعدَد الْكثير، غالبهم يذم التَّقْلِيد وينكر على أهله، وَلَكنهُمْ - كَمَا عرفناك - لَا يُصَرح مِنْهُم بذلك تَصْرِيحًا إلَّا الْأقَل؛ لتِلْك الْعلَّة، وغالبهم يلوح به تَلْوِيحًا، ويعرض بِهِ تعريضًا.
الاجتهاد فى أهل اليمن :
وَأما قطرنا اليمني - بَارك الله فِيهِ - فغالب من توسع فِي الْعُلُوم، وَأدْركَ من نَفسه ملكة الِاجْتِهَاد، الرُّجُوع( ) إلَى الدَّلِيل، وَيَرْمِي بالتقليد وَرَاء الْحَائِط، ويلقي عَن عقنه قلادته.
عرفنَا هَذَا من شُيُوخنَا، وعرفوه من شيوخهم، وعرفه الأول عَن الأول، وعرفناه من أترابنا، والمرافقين لنا فِي الطّلب، بل غَالب الآخذين عَنَّا - وهم الْعدَد الجم - هم بِهَذِهِ الصّفة، وعَلى هَذِه الْخصْلَة المحمودة( ).
بل غَالب من كَانَ لَهُ إنصاف من الَّذين، لم يكثر اشتغالهم بِالْعلمِ فِي دِيَارنَا هَذِه، يصنع كَمَا كَانَ يصنع السّلف الصَّالح من الصَّحَابَة، وتابعيهم، وَمن بعدهمْ من عدم التقيد بالتقليد، والتعويل على سُؤال الْعلمَاء بِالْكتاب وَالسّنة عَن الدَّلِيل الرَّاجِح، فيعملون بِهِ ويقفون عِنْده، وَلَا يبالون بِمَا يُخَالِفهُ مِمَّا عَلَيْهِ المقلدة، وصاروا منتسبين إلَى السّنة المطهرة، غير منتمين إلَى مَذْهَب من الْمذَاهب، فَأصَابُوا - أصَاب الله بهم - وضاعف أجرهم، وَصرف عَنْهُم معرة المقلدة أتبَاع كل ناعق.
من جهل شيئا عاداه :
وَقد عرفناك أن هَؤُلَاءِ المقلدة ذموا مَا لم يعرفوه، وعابوا مَا لم يدروا بِهِ، وَهَذَا أمر يستقبحه كل عَاقل، ويزري بِصَاحِبِهِ كل فاهم، فَإن من تعرض للْكَلَام فِيمَا لَا يعرفهُ فَهُوَ جَاهِل من جِهَتَيْنِ:
الْجِهَة الأولى: كَونه لَا يعرف ذَلِك الشَّيْء.
الْجِهَة الثَّانِيَة: كَونه تكلم فِيمَا لَا يعرفهُ، كَمَا يَفْعَله أهل الْجَهْل الْمركب [أ:57] هَذَا على فرض أنه لم يتَعَرَّض للقدح فِيهِ، وَلَا أوقعته نَفسه الأمارة فِي الطعْن على المتمسكين بِهِ، فَإن فعل ذَلِك فقد أخطَأ من ثَلَاث جِهَات، هَذِه الثَّالِثَة.
وَمَا أحسن مَا قَالَه الشَّاعِر:
أتَانَا أن سهلًا ذمّ جهلًا
علومًا لَيْسَ يعرفهن سهل
علومًا لَو دراها مَا قَلأهَا
وَلَكِن الرضا بِالْجَهْلِ سهل( )
وَلَقَد صدق هَذَا الشَّاعِر، فَإن الْعلَّة الباعثة للجاهل على هَذَا الفضول هِيَ الرضا بِالْجَهْلِ، ويكفيه مَا رَضِي بِهِ لنَفسِهِ نقصًا وعيبًا، وغباوة ومهانة.
دور أهل الولاية نَحو المقلدين:
وواجب على كل من لَهُ ولَايَة يَأْمر فِيهَا بِمَعْرُوف أو ينْهَى عَن مُنكر: أن يَجْعَل نهي الْمُنكر الَّذِي عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ عنوان كل نهي يُنْهِي بِهِ عَن مُنكر، فَإنَّهُم فِي الْحَقِيقَة إنَّمَا يطعنون على كتاب الله [تعالى]( )، وَسنة رَسُوله [صلى الله عليه وآله وسلم]( )، بِأن مَا فيهمَا من الشَّرِيعَة قد صَار مَنْسُوخًا، ويطعنون على عُلَمَاء الدّين من السّلف الصَّالح، وَمن مَشى على هديهم القويم، ويدفعون بِالرَّأْيِ الَّذِي هُوَ ضد الشريعة( )، مَا شَرعه الله [تعالى]( ) لعباده، وهم بِهَذِهِ الْمنزلَة من الْجَهْل الْبَسِيط أو الْمركب.
فَهَل سَمِعت أذناك بمنكر مثل هَذَا الْمُنكر، وبلية فِي الدّين مثل هَذِه البلية، ورزية فِي الْملَّة الإسلامية مثل هَذِه الرزية؟ فَإن النّيل من عرض فَرد من( ) أفْرَاد الْمُسلمين مُنكر، لَا يُخَالف فِيهِ مُسلم، إذا كَانَ على طَرِيق الْغَيْبَة أو الْبُهْتَان( )، أو على طَرِيق الشتم مُوَاجهَة ومكافحة.
فَكيف بِمن جَاءَ بِمَا هُوَ [من]( ) أعظم الْبُهْتَان، وأقبح الشَّتيمة للشريعة المحمدية، وَالدّين الإسلامي، ولعلماء الْمُسلمين سابقهم ولاحقهم؟ فيا لله، وللمسلمين، يا لله وللمسلمين، يا لله وللمسلمين!.
فَإن هَؤُلَاءِ لما رَأوْا كثيرا من الْعلمَاء يداهنونهم ويدارونهم اتقاء لشرهم مَا زادهم ذَلِك إلَّا شرا، وَلَا أثر فيهم إلَّا تجرئا على مَا هم فِيهِ. وَلَو تكلم أهل الْعلم بِمَا يجب عَلَيْهِم من نصر الشَّرِيعَة والذب عَن أهلهَا بِمَا يجب عَلَيْهِم لكانوا أقل شرا وأحقر ضرًّا( ).
وَأقل حَال أن يعرفوهم بِأنَّهُم من أهل الْجَهْل الَّذين( ) لَا يسْتَحقُّونَ خطابًا وَلَا يستوجبون جَوَابا، فَإن فِي هَذَا كفا لبَعض مَا صَارُوا عَلَيْهِ من الظَّن بِأنْفسِهِم الْبَاطِل، والخيال المختل لما يرونه من سكُوت أهل الْعلم عَنْهُم وَالصَّبْر على مَا يسمعونه مِنْهُم، ويبلغهم عَنْهُم.
وَقد يتسبب عَن هَذِه الإهانة لَهُم( ) بالتجهيل والتضليل فَائِدَة ينْدَفع بهَا بِبَعْض تجرئهم على كتاب الله، وَسنة رَسُوله، وعلماء أمته، فَإن من النَّاس من يصلح بالهوان وَيفْسد بالإكرام، كَمَا هُوَ مَعْلُوم لكل من يعرف [أ:58] أحْوَال النَّاس وَاخْتِلَاف طبائعهم.
وَلَقَد أحسن الشَّاعِر حَيْثُ قَالَ:
أكْرم تميمًا بالهوان فَإنَّهُم
إن أكْرمُوا فسدوا على الْإكْرَام( )
وكما قَالَ الآخر:
أهن عامرًا تكرم عَلَيْهِ فَإنَّمَا
أخُو عَامر من مَسّه بهوان( )
وَيَنْبَغِي لمن سمع أحدهم يُفْتِي فِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم، وَينصب نَفسه لما لَيْسَ من شَأْنه، أن يَقُول لَهُ كَمَا قَالَ الشَّاعِر:
تَقولُونَ هَذَا عندنَا غير جَائِز
وَمن أنْتُم حَتَّى يكون لكم عِنْد؟!( )
وَإن سمع أحدًا مِنْهُم يتَكَلَّم فِي غير مَا يعلم، على تَقْدِير أن علمه بِطرف من الرَّأْي يعد علمًا كَمَا فِي اصْطِلَاح الْعَامَّة، وَإلَّا فَهُوَ لَيْسَ( ) بِعلم بِالْإجْمَاع، كَمَا قدمنَا نقل ذَلِك، فليتل عَلَيْهِ قَول الله سُبْحَانَهُ [﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [آل عمران: 66]، وليتل عَلَيْهِ قَوْله ۵]( ): ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [النحل: 116، 117]، وَقَوله ۵: ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الأعراف: 33]، وَقَوله تَعَالَى: ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [المائدة: 44]، ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [المائدة: 45]، ﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [المائدة: 47]، وَيَتْلُو عَلَيْهِ [هذه]( ) الْآيَات الَّتِي فِيهَا الحكم بِالْحَقِّ وبالعدل، وَبِمَا أرى الله رَسُوله.
تكريم الله سبحانَه للأولياء:
ولنرجع الْآن إلَى شرح الحَدِيث الَّذِي نَحن بصدد شَرحه.
قَالَ الْكرْمَانِي: إن قَوْله [«لي»]( ) فِي «من عادى لي وليًّا» هُوَ فِي الأصْل صفة لقَوْله «وليًّا»، لكنه لما تقدم عَلَيْهِ صَار حَالًا( ). انْتهى.
أقُول: وَلَا يخْتَلف الْمَعْنى بذلك؛ لِأن الْمَعْنى على الْوَصْف: «من عادى وليًّا» كَائِنا لي، وَهُوَ على الْحَال كَذَلِك، لَكِن التَّقَدُّم فِيهِ فَائِدَة جليلة، وَهِي الْإشْعَار باختصاص( ) الْوَلِيّ بِهِ لَا بِغَيْرِهِ، كَمَا هُوَ مَعْرُوف فِي كتب الْمعَانِي وَالْبَيَان، ثمَّ فِي نسبته الْوَلِيّ إلَى نَفسه تشريف لَهُ عَظِيم، وَرفع لشأنه بليغ( ).
قَالَ ابْن هُبَيْرَة: وَيُسْتَفَاد من هَذَا الحَدِيث تَقْدِيم الْإعْذَار على الْإنْذَار( ).
قلت: وَوَجهه؛ أنه لما قدم معاداة من هُوَ بِهَذِهِ الصّفة من الْولَايَة لله، فَكَأنَّهُ أعذر إلَى [كل سامع، أن من هَذَا شَأْنه لَا يَنْبَغِي أن يعادي، بل على]( ) كل من عرف أن هَذِه صفته( )، أن يواليه وَيُحِبهُ، فَإذا لم يفعل فقد أعذر الله إلَيْهِ، ونبهه على أن من عادى يسْتَحق الْعقُوبَة الْبَالِغَة على عداوته، فَقَالَ منذرًا لَهُ: «فقد آذنته بِالْحَرْبِ» على مَا صنع مَعَ ولِيِّ.
وَوَقع فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد أحْمد فِي «الزّهْد»، وَابْن أبي الدُّنْيَا، وَأبي نعيم فِي «الْحِلْية»، وَالْبَيْهَقِيّ فِي «الزّهْد» بِلَفْظ: «من أذلّ لي وليًّا»، وَفِي أخْرَى مِنْهُ «من آذَى»، وَفِي إسْنَاده عبدالْوَاحِد بن مَيْمُون عَن عُرْوَة، وَهُوَ مُنكر الحَدِيث، لَكِن أخرجه الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق يَعْقُوب بن مُجَاهِد( )، [عَن] عُرْوَة .
قَوْله: «فقد آذنته» بِالْمدِّ والفتح للمُعْجَمَة بعدها نون( )؛ أي: أعلمته.
قَالَ فِي «الصِّحَاح»( ): وآذنتك بالشيء أعلمتكه، والآذن الْحَاجِب، قَالَ الشَّاعِر:
تبدل بآذنك المرتضى
......................................
وَقد آذن وتأذَّنَ بِمَعْنى، كَمَا يُقَال: أيقَن وتيَقَّن، وَتقول: تأذَّن الْأمِير فِي النَّاس؛ أي: نَادَى فيهم، يكون فِي التَّهدُّد وَالنَّهْي؛ أي: تقدم وَأعلم، وَقَوله تَعَالَى: ﴿ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [الأعراف: 167]؛ أي: أعلم. انْتهى.
فَعرفت بِهَذَا أن فِي قَوْله «فقد آذنته» معنى التهديد لمن عادى الْوَلِيّ، وَالنَّهْي لَهُ عَن أن يقدم على معاداته؛ لِأنَّهُ قد تقدم( ) إلَيْهِ بِأن لَا يعاديه، وَأنه وليه وأعلمه بذلك. وَأما الْمَقْصُور فَيَجِيء بِمَعْنى علم، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [البقرة: 279]؛ أي: اعلموا، وَبِمَعْنى الِاسْتِمَاع. يُقَال: أذن لَهُ( )، إذا اسْتمع مِنْهُ( ).
قَالَ الشَّاعِر:
إن يسمعوا رِيبَة طاروا بهَا فَرحًا
عني وَمَا سمعُوا من صَالح دفنُوا
صمٌّ إذا سمعُوا خيرا ذُكِرْتُ( ) بِهِ
وَإن ذكرت بشرٍّ عِنْدهم أذِنُوا( )
وَمِنْه: «مَا أذن الله لشَيْء كَإذْنِهِ لنَبِيّ يتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»؛ أي: اسْتمع، وَالْأذَان الْإعْلَام، وَمِنْه الْأذَان للصَّلَاة.
* قَوْله: «بِالْحَرْبِ»، فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَني: «فقد أذَنْته بِحَرب»، وَفِي حَدِيث معَاذ عِنْد ابْن ماجه، وَأبي نعيم فِي «الْحِلْية» بِلَفْظ: «فقد بارز الله بالمحاربة»، وَفِي حَدِيث أبي أمَامَة عِنْد الطَّبَرَانِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي «الزّهْد» بِسَنَد ضَعِيف بِلَفْظ: «فقد بارزني بالمحاربة»، وَمثله لفظ حَدِيث أنس عِنْد أبي يعلى، وَالْبَزَّار، وَالطَّبَرَانِيّ، وَفِي سَنَده ضعف، وَفِي حَدِيث مَيْمُونَة بِلَفْظ: «فقد اسْتحلَّ محاربتي»( ). وَفِي رِوَايَة: [وهب]( ) بن مُنَبّه بِلَفْظ: «من أهان وليَّ الْمُؤمن فقد استقبلني بالمحاربة»( ).
قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح»( ): وَقد اسْتشْكل وُقُوع الْمُحَاربَة، وَهِي مفاعلة من الْجَانِبَيْنِ، مَعَ كَون الْمَخْلُوق فِي أسر الْخَالِق.
وَالْجَوَاب: أنه( ) من المخاطبة بِمَا يفهم، فَإن الْحَرْب تنشأ عَن الْعَدَاوَة، والعداوة تنشأ عَن الْمُخَالفَة. وَغَايَة الْحَرْب الْهَلَاك، وَالله ۵ لَا يغلبه غَالب. فَكَأن الْمَعْنى: فقد تعرض لإهلاكي إيَّاه فَأطلق الْحَرْب وَأرِيد لَازمه، أي أعمل بِهِ مَا يعْمل الْعَدو الْمُحَارب( ). انْتهى.
قلت: فقد جعل ذَلِك من الْكِنَايَة، وَهِي لفظ أرِيد بِهِ لَازم مَعْنَاهُ، مَعَ جَوَاز إرَادَته، كَمَا حَقَّقَهُ أهل علم الْبَيَان. وَيُمكن أن يُقَال: إن المفاعلة قد تطلق، وَلَا يُرَاد بهَا وُقُوعهَا من الْجِهَتَيْنِ، كَمَا فِي كثير من الاستعمالات الْعَرَبيَّة، فَيكون المُرَاد بالمحاربة هُنَا الْحَرْب من الله ۵، كَمَا يدل عَلَيْهِ لفظ «فقد آذنته بِالْحَرْبِ».
وَيُمكن أن يَجْعَل العَبْد - لما كَانَ معاندًا لله ۵ بعداوة أوليائه - بِمَنْزِلَة من أقَامَ نَفسه مقَام الْمُحَارب لله سُبْحَانَهُ، وَإن كَانَ فِي أسره وَتَحْت حكمه، بِاعْتِبَار الْحَقِيقَة، وَأنه أحْقَر [أ:60] وَأقل من أن يحارب ربه، لَكِنَّهَا خيلت لَهُ نَفسه الأمارة بالسوء هَذَا الخيال الْبَاطِل، فعادى من أمره الله بموالاته ومحبته، مَعَ علمه بِأن ذَلِك مِمَّا يسْخط الرب، وَيُوجب حُلُول الْعقُوبَة عَلَيْهِ، وإيقاعه فِي المهالك الَّتِي لَا ينجو مِنْهَا.
قَالَ الْفَاكِهَانِيّ: فِي هَذَا الحَدِيث تهديد شَدِيد؛ لِأن من حاربه الله [تَعَالَى]( ) أهلكه، وَهُوَ من الْمجَاز البليغ؛ لِأن من كره من( ) أحبه الله تَعَالَى خَالف الله سُبْحَانَهُ، وَمن خَالف الله ۵ عانده، وَمن عانده أهلكه، وَإذا ثَبت هَذَا فِي جَانب المعاداة، ثَبت فِي جَانب الْمُوَالَاة، فَمن والى أوْلِيَاء الله ۵ أكْرمه الله ۵( ). انْتهى.
قلت: لَا مُقْتَضى لهَذَا الْمجَاز بِهَذِهِ الوسائط والانتقالات، فَإن مُجَرّد وُقُوع الْحَرْب من الرب للْعَبد إهلاك لَهُ بأبلغ أنْوَاع الإهلاك، وانتقام مِنْهُ بأكمل أنْوَاع الانتقام، فَالْحَدِيث خَارج هَذَا الْمخْرج. وَمثله فِي وَعِيد أهل الرِّبَا: ﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾( ).
قَالَ الطوفي: لما كَانَ ولي الله سُبْحَانَهُ مِمَّن تولى الله سُبْحَانَهُ بِالطَّاعَةِ وَالتَّقوى، تولاه الله تَعَالَى بِالْحِفْظِ والنصرة، وَقد أجْرى الله تَعَالَى( ) الْعَادة بِأن عَدو الْعَدو صديق، وصديق الْعَدو عَدو، فعدو ولي الله تَعَالَى عَدو الله سُبْحَانَهُ، فَمن عَادَاهُ كَانَ كمن حاربه، وَمن حاربه فَكَأنَّمَا حَارب الله تبَارك وَتَعَالَى( ).
قلت: وَهَذَا هُوَ مثل كلامنا الْمُتَقَدّم فِي تَوْجِيه المفاعلة.
أداء الفرائض:
* قَوْله: «ومَا تقرب إلَيّ عَبدِي بِشَيْء أحب إلَى مِمَّا افترضت عَلَيْهِ»، لفظ التَّقَرُّب الْمَنْسُوب إلَى الله [تعالى]( ) من عَبده يُفِيد أنه وَقع ذَلِك على جِهَة الْإخْلَاص؛ لِأن مَنْ لم يخلص الْعِبَادَة لله سُبْحَانَهُ لَا يصدق عَلَيْهِ معنى التَّقَرُّب، وَهَكَذَا من فعل الْعِبَادَة المفترضة لخوف( ) الْعقُوبَة، فَإنَّهُ لم يكن متقربًا على الْوَجْه الأتم.
قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح»( ): وَيدخل تَحت هَذَا اللَّفْظ جَمِيع فَرَائض الْعين والكفاية، وَظَاهره الِاخْتِصَاص( ) بِمَا ابْتَدَأ الله تَعَالَى فريضته، وَفِي دُخُول مَا أوجبه الْمُكَلف على نَفسه نظر، للتَّقْيِيد بقول: «افترضت عَلَيْهِ» إلَّا إن أخذ من جِهَة الْمَعْنى [الأعم] ( ). انْتهى.
قلت: إن كَانَ مَا أوجبه العَبْد على نَفسه مِمَّا أوجب الله عَلَيْهِ الْوَفَاء بِهِ، فَهَذَا الْإيجَاب هُوَ من فَرَائض الله سُبْحَانَهُ، وَحكمه حكم مَا أوجبه الله ابْتِدَاء على عباده، بل هَل فَرد من أفرادها، لَا يحْتَاج إلَى أدراجه تَحت معنى أعم.
قَالَ( ): وَيُسْتَفَاد مِنْهُ: أن أدَاء الْفَرَائِض أحب الْأعْمَال إلَى الله تَعَالَى. انْتهى.
قلت: وَجه ذَلِك؛ أن النكرَة وَقعت فِي سِيَاق النَّفْي، فَعم كل مَا يصدق عَلَيْهِ معنى الشَّيْء، فَلَا يبْقى شَيْء من الْقُرَبِ [أ:61] إلَّا وَهُوَ دَاخل فِي هَذَا الْعُمُوم؛ لِأن كل قربَة كائنة مَا كَانَت يُقَال لَهَا شَيْء، سَوَاء كَانَت من الْأفْعَال، أو الْأقْوَال، أو مضمرات الْقُلُوب، أو الخواطر الْوَارِدَة على العَبْد، أو التروك للمعاصي، الَّتِي هِيَ ضد لفعلها( ).
قَالَ الطوفي: الْأمر بالفرائض جازم، وَيَقَع بِتَرْكِهَا المعاقبة، بِخِلَاف النَّفْل فِي الْأمريْنِ، وَإن اشْترك مَعَ الْفَرَائِض فِي تَحْصِيل الثَّوَاب، فَكَانَت الْفَرَائِض أكمل، فَلِذَا كَانَت أحب إلَى الله [سبحانه] ( ) وَأشد تقربًا.
فالفرض كالأصل والأسُّ، وَالنَّفْل كالفرع وَالْبناء، وَفِي الْإتْيَان بالفرائض على الْوَجْه الْمَأْمُور بِهِ امْتِثَال الْأمر، واحترامه، وتعظيمه؛ بالانقياد إلَيْهِ، وَإظْهَار عَظمَة الربوبية، وذل الْعُبُودِيَّة، فَكَانَ التَّقَرُّب بذلك أعظم الْعَمَل. وَالَّذِي يُؤَدِّي الْفَرْض قد يَفْعَله خوفًا من الْعقُوبَة، ومؤدي النَّفْل لَا يَفْعَله إلَّا إيثارًا للْخدمَة، فيجازى بالمحبة الَّتِي هِيَ غَايَة مَطْلُوب من يتَقرَّب بخدمته. انْتهى.
قلت: إذا كَانَ أدَاء الْفَرَائِض أعظم الْعَمَل لتِلْك الْعِلَل الَّتِي ذكرهَا( )؛ من امْتِثَال الْأمر واحترامه وتعظيمه، وَإظْهَار عَظمَة الربوبية وذل الْعُبُودِيَّة، كَانَ ثَوَابهَا أكثر، وَالْجَزَاء عَلَيْهَا أعظم، وَلَا يُخَالِفهُ مَا ذكره من أن العَبْد لَا يفعل النَّفْل إلَّا إيثارًا للْخدمَة، وَأنه يجازى بالمحبة، فَذَلِك سَببه وُقُوع التَّقَرُّب مِنْهُ بِمَا لم يُوجِبهُ الله [تعالى]( ) عَلَيْهِ، وَإن كَانَ الثَّوَاب عَلَيْهِ دون ثَوَاب الْفَرَائِض، وَسَيَأْتِي لهَذَا مزِيد تَحْقِيق عِنْد الْكَلَام على قَوْله «أحببته»( ).
من أداء الفرائض ترك المعاصي:
وَاعْلَم أن من أعظم فَرَائض الله سُبْحَانَهُ، ترك مَعَاصيه، الَّتِي هِيَ حُدُوده، الَّتِي من تعداها كَانَ عَلَيْهِ من الْعقُوبَة مَا ذكره الله سُبْحَانَهُ فِي كِتَابه الْعَزِيز.
وَلَا خلاف أن الله [سبحانه]( ) افْترض على الْعباد ترك كل مَعْصِيّة كائنة مَا كَانَت، فَكَانَ ترك الْمعاصِي من هَذِه الْحَيْثِيَّة دَاخِلًا تَحت عُمُوم قَوْله: «وَمَا تقرب إلَيّ عَبدِي بِشَيْء أحب إلَيّ مِمَّا افترضت عَلَيْهِ»، بل دُخُول فَرَائض التّرْك للمعاصي أولى من دُخُول فَرَائض الطَّاعَات، كَمَا يدل عَلَيْهِ حَدِيث «إذا أمرتكُم بِأمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَإذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَلَا تقربوه»( ) ( ).
إبطال الفرائض بالحيل:
وَاعْلَم أن من أعظم الْبدع الْحَادِثَة فِي الْإسْلَام، مَا فتح بَابه أهلُ الرَّأْي للعباد، من الْحِيَل الَّتِي زحلفوا( ) بهَا كثيرًا من فَرَائض الله سُبْحَانَهُ، فأخرجوها عَن كَونهَا فَرِيضَة، وَكَأن الله [تعالى]( ) لم يفرضها على عباده، وحللوا بهَا كثيرًا من معاصي الله، الَّتِي نهى عباده عَنْهَا، وتوعدهم على مقارفتها، والوقوع فِي شَيْء مِنْهَا.
وَمن تَأمل أكثر مَا ورد عَن الشَّارِع من اللَّعْن، وجد غالبه فِي المستحلين لما حرمه الله، والمسقطين لفرائضه بالحيل؛ كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ»( )، «لعن الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها»( )، «لعن الله الراشي والمرتشي»( )، «لعن الله آكل الرِّبَا ومؤكله وكاتبه وَشَاهده»( ) [أ:62]، و«لعن عاصر الْخمر ومعتصرها»( )، وَ«لعن الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة والواشمة والمستوشمة»( ).
ومسخ الله الَّذين استحلوا مَحَارمه بالحيل قردةُ وَخَنَازِيرَ، و ذمّ أهلَ الخداع وَالْمَكْر، وَأخْبر أن الْمُنَافِقين يخادعونه وَهُوَ يخادعهم، وَأخْبر عَنْهُم بمخالفة ظواهرهم لبواطنهم، وسرائرهم لعلانيتهم.
وَثَبت عَن ابْن عَبَّاس، أنه جَاءَهُ رجل، فَقَالَ: إن عمي طلق امْرَأته ثَلَاثًا، أيحلها لَهُ رجلٌ؟ فَقَالَ: من يُخَادع الله يخدعه( ). وَصَحَّ عَن ابْن عَبَّاس وَأنس، أنَّهُمَا سئلا عَن العينة؟ فَقَالَا: إن الله لَا يخدع( ).
وَقد عاقب الله المتحيلين على الْمَسَاكِين وَقت الْجذاذ( ) بإهلاك ثمارهم؛ حَتَّى أصبَحت كالصريم. وَصَحَّ أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم قَالَ: «البيعان بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إلَّا أن تكون صَفْقَة خِيَار، وَلَا يحل لَهُ أن يُفَارِقهُ خشيَة أن يستقيله»( ). وَصَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم النَّهْيُ لمن عَلَيْهِ الزَّكَاة أن يجمع بَين متفرق، أو يفرق بَين مُجْتَمع خشيَةَ الصَّدَقَة.
والأدلة فِي منع الْحِيَل( ) وإبطالها كَثِيرَة جدًّا، وَمُجَرَّد تَسْمِيَتهَا حيلة يُؤذن بدفعها وإبطالها، فَإن التحيل عل عُمُومه قَبِيح شرعًا وعقلًا، وَهَذَا المتحيل لإسْقَاط فرض من فَرَائض الله، أو تَحْلِيل مَا حرمه الله سُبْحَانَهُ، هُوَ ناصب لنَفسِهِ فِي مدافعة ما شرعه الله سبحانه لعباده، مريد لأن يجعل ما حرمه الله حلالًا، وَمَا أحله حَرَامًا، فَهُوَ من هَذِه الْحَيْثِيَّة معاند لله مخادع لِعِبَادِهِ، مندرج تَحت عُمُوم قَوْله سُبْحَانَهُ: ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ يخادعون( ) ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [البقرة: 9]. وَقَوله: ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [النساء: 142]. وَقَوله: ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [آل عمران: 54] .
وَمَعْلُوم لكل عَاقل؛ أن الشَّرِيعَة قد كملت وَانْقطع الْوَحْي بِمَوْتِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وَلم يبْق لأحد من عباد الله مجَالٌ فِي تشريع غير مَا شَرعه الله، وَلَا رفع شَيْء مِمَّا قد شَرعه الله سُبْحَانَهُ.
وكل الْعباد متعبدون بِهَذِهِ الشَّرِيعَة، لم يَجْعَل الله سُبْحَانَهُ لأحد مِنْهُم أن يحلل شَيْئًا مِمَّا حرم فِيهَا، وَلَا يحرم شَيْئًا مِمَّا أحل( ) فِيهَا.
فَمن جَاءَ إلَى عباد الله، وَقَالَ: قد لَقَّنَنِي الشَّيْطَان أن أحل لكم الْحَرَام الْفُلَانِيّ، أو أحرم عَلَيْكُم الْحَلَال الْفُلَانِيّ، أو أسقط عَنْكُم وَاجِب كَذَا، فَهَذَا مِمَّا يفهم كل عَاقل أنه أرَادَ تَبْدِيل الشَّرِيعَة المطهرة وَمُخَالفَة مَا فِيهَا.
فَحق على كل مُسلم أن يَأْخُذ على يَده، ويحول بَينه وَبَين مَا أرَادَ ارتكابه من الْمُخَالفَة لدين الْإسْلَام، والمعاندة لما قد ثَبت فِي كتاب الله أو فِي سنة رَسُوله، فَهَذَا بِمُجَرَّدِهِ يصك وَجه كل محتال، ويرغم أنف كل متجرئ على دين الله، بِإسْقَاط مَا هُوَ وَاجِب فِيهِ [أ:63] أو تَحْلِيل مَا هُوَ من محرماته.
الرد على من جوز الحيل المحرمة( ):
وَأما تمسك أهل الرَّأْي، المحتالين على الْإسْلَام وَأهله، بِمثل قَوْله( ) سُبْحَانَهُ لنَبيه أيُّوب ڠ: ﴿ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [ص: 44]، وَأنه سُبْحَانَهُ أذن لَهُ أن يتَحَلَّل من يَمِينه بِالضَّرْبِ بالضغث، وبمثل مَا أخبر الله سُبْحَانَهُ عَن نبيه يُوسُف ڠ أنه جعل صواعه فِي رَحل أخِيه؛ ليتوصل بذلك إلَى أخذه من إخْوَته، وَأخْبر سُبْحَانَهُ أنه فعل ذَلِك بِرِضَاهُ وإذنه، كَمَا قَالَ: ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [يوسف: 77]. وبمثل مَا صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، أنه اسْتعْمل رجلًا على خَيْبَر، فَجَاءَهُمْ بِتَمْر جنيب، فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «أكل تمر خَيْبَر هَكَذَا؟» قَالَ: إنَّا لنأخذ الصَّاع من هَذَا بالصاعين والصاعين بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: «لَا تفعل، بِعْ الْجَمِيع( ) بِالدَّرَاهِمِ، ثمَّ ابتع بِالدَّرَاهِمِ جنيبًا»( ).
و[قد]( ) لَقِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم طَائِفَة من الْمُشْركين، فِي نفر من أصْحَابه، فَقَالَ الْمُشْركُونَ: من أنْتُم؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من مَاء»، فَنظر بَعضهم إلَى بعض، وَقَالُوا: أحيَاء الْيمن كثير، فلعلهم مِنْهُم، وَانْصَرفُوا( ) .
وَجَاء رجل إلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فَقَالَ: احملني، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي إلَّا ولد الناقة»، فَقَالَ: مَا أصنع بِولد النَّاقة؟ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «وَهل تَلد الْإبِل إلَّا النوق؟»( ).
فيجاب عَنهُ: بِأن مَا ذَكرُوهُ من قصَّة أيُّوب خَارج عَمَّا نَحن بصدده، فَإن أيُّوب نذر أن يضْربهَا مائَة عصا، وَقد ضربهَا كَذَلِك بِمِائَة عصا. وَأيْضًا لَو سلم أنه نذر أن يضْربهَا مائَة عَصا مفرقة، أو مائَة ضَرْبَة مفرقة، فَذَلِك الَّذِي أذن الله لَهُ بِهِ تَخْفيف على الْمَرْأة، وَنسخ لما كَانَ قد أوجبه على نَفسه( )، على تَقْدِير أنه [كَانَ]( ) يجب فِي شَرِيعَته الْوَفَاء بِالنذرِ، وَأنه لما نذر أوجب الله ذَلِك عَلَيْهِ، ثمَّ خفف عَلَيْهِ وَنسخ مَا كَانَ قد أوجبه الله عَلَيْهِ بإيجابه على نَفسه. وَمَا الْمَانِع من أن يُوجب الله شَيْئًا ثمَّ ينسخه، وَلَيْسَ النزاع فِي مثل هَذَا، فَإن شريعتنا هَذِه فِيهَا النَّاسِخ والمنسوخ.
وَإنَّمَا النزاع فِي شَرِيعَة كملت، وَأخْبرنَا الله [سبحانه]( ) بكمالها، فَقَالَ: ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [المائدة: 3]، ثمَّ انْقَطع الْوَحْي بِمَوْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، ثمَّ جَاءَ جمَاعَة حوَّلوا الشَّرِيعَة وبدلوها( )، فحللوا حرامها، وأسقطوا فرائضها، بأكاذيب لم يَأْذَن الله بهَا، بل هِيَ ضد لشريعته وَدفع لَهَا وَرفع لأحكامها.
فَأيْنَ قصَّة أيُّوب( ) من صَنِيع هَؤُلَاءِ المحتالة على الله وعَلى رَسُوله وعَلى الشَّرِيعَة الإسلامية، وعَلى عباد الله الْمُسلمين؟ وَأي جَامع يجمع بَين هَذَا وَبَين قصَّة أيُّوب؟ ثمَّ هَذِه الْقِصَّة الأيوبية هِيَ من التَّحَلُّل من الأيمَان وَالْخُرُوج من المأثم [أ:64]، فَلَو فَرضنَا أن لَهَا دخلًا فِيمَا قصدوه، لَكَانَ ذَلِك خَاصًّا بِمَا فِيهِ خُرُوج من المأثم والتحلل من الأيمَان.
وَقد ثَبت فِي شرعنا: أن الْيَمين إذا كَانَ غَيرهَا خيرًا مِنْهَا، كَانَ الْحِنْث أولى من الْبر، كَمَا صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أنه قَالَ: «من حلف من شَيْء فَرَأى غَيره خيرًا مِنْهُ، فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يَمِينه»( )، وَصَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «وَالله لَا أحْلف على يَمِين، فَأرى غَيرهَا خيرًا مِنْهَا، إلَّا أتيت الَّذِي هُوَ خير وكفرت عَن يَمِيني»( ).
فقد ثَبت فِي شرعنا أن الْحَالِف على يَمِين غَيرهَا خير مِنْهَا يكفر عَن يَمِينه من غير حَاجَة إلَى ضرب فِي مثل صُورَة يَمِين أيُّوب، لَا مفرقًا وَلَا مجموعًا، وَقد ثَبت أن امْرَأة أيُّوب كَانَت ضَعِيفَة( )، لَا يحْتَمل ضعفها لوُقُوع مائَة ضَرْبَة مفرقة.
وَمثل هَذَا قد سوغت شريعتنا التَّخْفِيف فِيهِ خُرُوجًا من المأثم، وَلَا سِيمَا إذا صَحَّ مَا روي؛ أن مَرِيضًا أقرّ بِالزِّنَا، وَكَانَ ضَعِيفًا لَا يحْتَمل الْحَد الشَّرْعِيّ، فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم بِأن يضْرب بشمراخ من النّخل فِيهِ مائَة عثكول( ). فَهَذَا لَيْسَ بحيلة، بل شَرِيعَة ثَابِتَة. وَلَيْسَ النزاع إلَّا فِيمَا فعله المحتالون، من زحلفة أحْكَام الشَّرِيعَة بالأقوال الكاذبة المفتراة، لَا فِيمَا [قد]( ) ثَبت فِي الشَّرِيعَة.
وَبِهَذَا يَتَقَرَّر لَك أن استدلالهم بِقصَّة أيُّوب خَارج عَن مَحل النزاع، مَعَ أن هَذِه الْقِصَّة هِيَ أعظم مَا عولوا عَلَيْهِ وبنوا عَلَيْهِ القناطر الَّتِي لَيست من الشَّرِيعَة فِي قبيل وَلَا دبير، بل هِيَ ضد للشريعة وعناد لَهَا.
وَأما قصَّة يُوسُف؛ فَالْجَوَاب عَنْهَا وَاضح؛ لِأنَّهَا وَاقعَة وَقعت لنَبِيّ من أنْبيَاء الله سُبْحَانَهُ، صنعها الله سُبْحَانَهُ لَهُ لخير أرَادَ بِهِ لأهله. فَإن كَانَ مثل ذَلِك مَمْنُوعًا فِي شريعتنا( ) [فقد نسخ مَا كَانَ فِي تِلْكَ الشَّرِيعَة بِمَا كَانَ فِي شريعتنا]( )، وشريعتنا هِيَ الشَّرِيعَة الناسخة للشرائع، وَمَعْلُوم أنه لَا يُؤْخَذ مِمَّا كَانَ من الشَّرَائِع السَّابِقَة إلَّا مَا قَرّرته شريعتنا مِنْهَا، لَا مَا خالفته وأبطلته، فَمَا لنا وللتعلق بشريعة مَنْسُوخَة؟.
وَإن كَانَ مثل ذَلِك جَائِزًا فِي شريعتنا، فَلَيْسَ النزاع فِيمَا هُوَ جَائِز فِيهَا، بل النزاع فِي حيل المحتالين، ودلس المدلسين، المحللين لأحكام الشَّرِيعَة من عِنْد أنفسهم، المسقطين لفرائض الله سُبْحَانَهُ بآرائهم الفايلة( )، وتدليساتهم الْبَاطِلَة.
فى الشريعة ما يغني عن الحيل :
وَالْحَاصِل؛ أن كل مَا ثَبت فِي الشَّرِيعَة من تَخْفيف، أو خُرُوج من مأثم، فَنحْن نقُول، هُوَ شَرِيعَة بَيْضَاء نقية، فَمن زعم أنه حِيلَة( )، فقد افترى على الله وعَلى رَسُوله وعَلى كتاب الله( ) وعَلى سنة رَسُوله، الْكَذِب الصَّرَاح وَالْبَاطِل البَوَاح. فَأيْنَ هَذَا من صنع هَؤُلَاءِ المعاندين لله وَلِرَسُولِهِ، الْمُخَالفين للْكتاب وَالسّنة، الدافعين لما هُوَ ثَابت فِيهَا بعد كمالها وتمامها وَمَوْت نبيها وَانْقِطَاع الْوَحْي مِنْهَا؟.
يا لله الْعجب من هَؤُلَاءِ الَّذين تجرؤا أولًا: على عناد الشَّرِيعَة ومخالفتها، وَثَانِيًا: [على]( ) الِاسْتِدْلَال بِمَا شَرعه الله لِعِبَادِهِ، أو كَانَ فِي شَرِيعَة نَبِي من الْأنْبِيَاء قد رفعت شريعتنا حكمه ونسخته وأبطلته، وَهَكَذَا يُجَاب عَنْهُم فِي حَدِيث التَّمْر وَبيع الْجَمِيع( ) بِالدَّرَاهِمِ وَشِرَاء الجنيب بهَا، فَإن ذَلِك شَرِيعَة وَاضِحَة وَسنة قَائِمَة متضمنة لبيع الشَّيْء بِقِيمَتِه الَّتِي يَقع التَّرَاضِي عَلَيْهَا، فَكَانَ ذَلِك مِمَّا أذن الله سُبْحَانَهُ بِهِ بقوله تَعَالَى: ﴿ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [النساء: 29]، وَبقول رَسُوله( ) صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إلَّا بِطيبَة من نَفسه»( )، وَلَيْسَ مِمَّا نهى الله عَنهُ بقوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [النساء: 29]، وَبقول رَسُوله( ) صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «إن دماءكم وَأمْوَالكُمْ عَلَيْكُم حرَام»( ).
وَلَيْسَ النزاع إلَّا فِي صنع المحتالين الْمُخَالفين للشريعة، المزلزلين لأحكامها، المستبدلين بهَا غَيرهَا بعد كمالها، وَانْقِطَاع الْوَحْي مِنْهَا، وَمَوْت نبيها صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم.
فَأنْتم أيهَا المحتالون إذا عملتم بِهَذَا الحكم الثَّابِت فِي السّنة، فَلَيْسَ ذَلِك من الْعَمَل بالحيلة فِي شَيْء، بل من الْعَمَل بالشريعة الإسلامية، وَلَا نطلب مِنْكُم إلَّا الْعَمَل بهَا، والثبوت على مَا فِيهَا، وَترك تَحْلِيل حرامها وَإبْطَال فرائضها.
فاشدد يَديك على مَا ذَكرْنَاهُ هَاهُنَا من الْجَواب على المحتالين، فَإنَّك إن جاوبتهم بِهِ ألقمتهم حجرًا، وقطعتهم قطعًا، لَا يَجدونَ عَنهُ محيصًا.
وَقد أجَاب عَنْهُم أهل الْعلم بجوابات لم نرتضها، وَتَركنَا ذكر شَيْء مِنْهَا لاحتمالها للمعارضة والمناقضة، وَفتح بَاب الْمقَال للمحتالين( ).
المعاريض :
وَأما مَا ذَكرُوهُ من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، لمن سَألَهُمْ: من هم؟ فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «من مَاء»( )، وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «أحملك على ولد النَّاقة»، فَلَيْسَ فِي هَذَا من الْحِيلَة الْمُحرمَة شَيْء، بل هُوَ من بَاب المعاريض فِي الْكَلَام، وقد ثَبت الْإذْن بهَا( ) فِي هَذِه الشَّرِيعَة، كَمَا صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: أنه كَانَ إذا أرَادَ غَزْوَة يوري بغَيْرهَا( )، مَعَ كَون قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم «نَحن من مَاء» كَلَام صَحِيح صَادِق، فَإنَّهُ قصد صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم مَا ذكره الله سُبْحَانَهُ من قَوْله سُبْحَانَهُ: ﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [الفرقان: 54] وَنَحْوهَا من الْآيَات.
وَكَذَلِكَ قَوْله: «أحملك على ولد النَّاقة»( )، فَإن الْجمل هُوَ ولد النَّاقة، وَكَذَلِكَ مَا روي عنه صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم من قَوْله: «لَا تدخل الْجنَّةَ عَجُوزٌ»( )، وَكَذَلِكَ مَا روي عَن أبي بكر ﭬ فِي حَدِيث الْهِجْرَة، أنه كَانَ إذا سُئِلَ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: من هُوَ؟ قَالَ: هَذَا يهديني السَّبِيل( ).
فالمعاريض( )( ) بَاب آخر لَيست من التحيل فِي شَيْء، لَكِن هَؤُلَاءِ قد صَارُوا مثل الغريق بِكُل حَبل يلتوي.
فيا معشر المحتالين على الله، وعَلى كِتَابه، وعَلى رَسُوله، وعَلى سنته، وعَلى الْمُسلمين:
دعوا كل قَول عِنْد قَول مُحَمَّد
فَمَا آمن فِي دينه كمخاطر( )
فدع عَنْك بهتًا صِيحَ فِي حجراته
وهات حَدِيثًا مَا حَدِيث الرَّوَاحِل( )
يَقُولُونَ أقوالًا وَلَا يعرفونها
وَلَو قيل هاتوا حققوا لم يحققوا( )
من الحيل المستلزمة للكفر:
إذا عرفت هَذَا؛ فَاعْلَم أن من هَذِه الْحِيَل الشيطانية مَا يسْتَلْزم كفر فَاعله وَكفر من أفتاه، وَذَلِكَ كمن يُفْتِي الْمَرْأة بِأن ترتد عَن الْإسْلَام لأجل تبين من زَوجهَا.
وَكَمن يُفْتِي الْحَاج إذا خَافَ الْفَوْت، وخشي وجوب الْقَضَاء عَلَيْهِ من قَابل، أن يكفر بِاللَّه، ويرتد عَن الْإسْلَام، فَإذا عَاد إلَى الْإسْلَام، لم يلْزمه الْقَضَاء.
فاسمع واعجب من حِيلَة أوجبت كفر فاعلها، وَكفر من أفتاه بهَا، فَكَانَت ثَمَرَة هَذِه الْحِيلَة الملعونة هِيَ خُرُوج رجلَيْنِ مُسلمين من الْإسْلَام إلَى الكفر. فَهَل شَيْء من الشَّرّ( ) يعدل هَذَا الشَّرّ؟! وهل نوع من معاصي الله يعدل الْكفْر بِاللَّه، وَالْخُرُوج من( ) دين الْإسْلَام؟.
وَهَذَا الْمُفْتِي - وَإن كَانَ قد ظلم نَفسه ابْتِدَاءً، وَخرج من الْإسْلَام إلَى الْكفْر - فعلى نَفسهَا براقش تجني، وَلَكِن الشَّأْن فِي ظلمه لهَذِهِ المسكينة وَهَذَا الْمِسْكِين، اللَّذين استفتياه عَن الشَّرِيعَة الإسلامية، فأخرجهما مِنْهَا بادئ بَدْء.
وَمن جملَة الْحِيَل الملعونة: مَا قَالُوهُ فِي إسْقَاط الْقصاص الشَّرْعِيّ، أنه إذا جرح رجلًا، فخشي أن يَمُوت من الْجرْح، فَإن يدْفع إلَيْهِ دَوَاءً مسمومًا يَمُوت بِهِ، فَيسْقط عَنهُ الْقصاص. وَمِمَّا قَالُوهُ فِي إسْقَاط حد السّرقَة؛ أن السَّارِق يَقُول: هَذِه ملكي، وَهَذِه دَاري، وَهَذَا عَبدِي.
وَمن هَذِه الْحِيَل الملعونة: أنه إذا غصب شَيْئًا، فَادَّعَاهُ الْمَغْصُوب عَلَيْهِ، فَأنكرهُ، فَطلب تَحْلِيفه، قَالُوا: إنَّه يقر بِهِ لوَلَده الصَّغِير، فَيسْقط عَنهُ الْيَمين، ويفوز بالمغضوب. وَقَالُوا: إذا أرَادَ إخْرَاج زَوجته من الْمِيرَاث فِي مَرضه، أقرّ بِأنَّهُ قد طَلقهَا ثَلَاثًا. وَقَالُوا: إذا كَانَ فِي يَده نِصَاب، فَبَاعَهُ أو وهبه قبل الْحول، ثمَّ استرده، سَقَطت عَنهُ الزَّكَاة.
بل قَالُوا: إذا كَانَ عِنْده نِصَاب من الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَأرَادَ إسْقَاط زَكَاته فِي جَمِيع عمره، فَالْحِيلَةُ أن يَدْفَعهَا إلَى محتال مثله فِي آخر الْحول، وَيَأْخُذ مِنْهُ نَظِيره، فيستأنفا الْحول، ثمَّ إذا كَانَ آخر الْحول، فعلا كَذَلِك، فَلَا تجب عَلَيْهِمَا زَكَاة مَا عاشا.
وَهَكَذَا إذا كَانَ لَهُ عرُوض للتِّجَارَة، قَالُوا: يَنْوِي آخر الْحول أنَّهَا للْقنية، ثمَّ ينْقض هَذِه النِّيَّة بعد سَاعَة، فَلَا تجب عَلَيْهِ زَكَاة مَا عَاشَ. وَهَكَذَا قَالُوا: إذا أرَادَ أن يُجَامع فِي نَهَار رَمَضَان، يَبْتَدِئ بِالْأكْل وَالشرب، ثمَّ يُجَامع بعد ذَلِك، فَلَا يجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة.
بل قَالُوا: إنَّه إذا نوى قبل الْجِمَاع قطع الصَّوْم، لم تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة. وَهَكَذَا قَالُوا: إذا كَانَ لَهُ نِصَابٌ من السَّائِمَة، فَأرَادَ إسْقَاط زَكَاتهَا، فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِك أن يعلفها يَوْمًا وَاحِدًا، ثمَّ تعود إلَى السّوم.
وَكم نَعُدُّ من هَذِه الْحِيَل الطاغوتية لهَؤُلَاء الشَّيَاطِين، فَإنَّهَا - فِي الْغَالِب - فِي كل بَاب من أبْوَاب الشَّرِيعَة( ). [أ:67].
وَمن لم يعرف أنَّهَا حيل بَاطِلَة، معاندة للشريعة، لَا يجوز التَّعَلُّق بِشَيْء مِنْهَا، وَلَا يتَحَلَّل فاعلها مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ، فَهُوَ بَهِيمَة، لَيْسَ من هَذَا النَّوْع الإنساني، وَلَا يسْتَحق أن يُخَاطب خطاب الْعُقَلَاء، فضلًا عَن خطاب المتشرعين.
وَيجب على كل مُسلم أن يُعَاقب فَاعل هَذِه الْحِيَل( ) الملعونة بِمَا يَلِيق بِهِ من الْعقُوبَة؛ حَتَّى يرجع عَن فعله، ويلتزم بِمَا( ) يلْزمه شرعًا، وَيَتُوب إلَى الله سُبْحَانَهُ من الذَّنب الَّذِي أوقعه فِيهِ الْمُفْتِي لَهُ.
وَأما الْمُفْتِي لَهُ، فَيَنْبَغِي إغلاظ الْعقُوبَة لَهُ؛ حَتَّى يعْتَرف أولًا بِبُطْلَان مَا خيله لَهُ الشيطان، وأوقعه فِيهِ، من أن تِلْكَ الْحِيلَة المعاندة لدين الْإسْلَام لَيْسَ لَهَا وَجه صِحَة أو شَائِبَة [من]( ) قبُول، ثمَّ يَتُوب إلَى الله عن( ) أن يعود إلَى شَيْء من تِلْكَ الْفَتَاوَى الملعونة، فَإن فعل ذَلِك، وَإلَّا فَأقل الْأحْوَال تَطْوِيل حَبسه حَتَّى تصح تَوْبَته، وإشهاره فِي النَّاس بِأنَّهُ معاند للشريعة فِيمَا قد فعله، وتحذير النَّاس من قبُول مَا يدليهم بِهِ من الْغرُور، ويوقعهم فِيهِ من الْبَاطِل.
التّقرب لله بالنوافل:
* قَوْله: «وَمَا زَالَ عَبدِي يتَقرَّب إليَّ بالنوافل»، فِي رِوَايَة( ) الْكشميهني: «وَمَا يزَال» بِصِيغَة الْمُضَارع، وَوَقع فِي حَدِيث أبي أمَامَة: «يتحبب إليَّ» بدل «يتَقرَّب»، وَكَذَا حَدِيث مَيْمُونَة.
والتقرب( ) التفعل، وَهُوَ طلب الْقرب، والنوافل هِيَ مَا عدا الْفَرَائِض، الَّتِي افترضها الله سُبْحَانَهُ على عباده، من جَمِيع أجنَاس الطَّاعَات؛ من صَلَاة وَصِيَام وَحج وَصدقَة وأذكار، وكل مَا ندب الله سُبْحَانَهُ إلَيْهِ، وَرغب فِيهِ، من غير حتم وافتراض.
وتختلف النَّوَافِل باخْتلَاف ثَوَابهَا، فَمَا كَانَ ثَوَابه أكثر، كَانَ فعله أفضل، وتختلف أيْضًا باخْتلَاف مَا ورد فِي التَّرْغِيب فِيهَا، فبعضها قد يَقع التَّرْغِيب فِيهِ ترغيبًا مؤكدًا، وَقد يلازمه صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، مَعَ التَّرْغِيب للنَّاس فِي فعله :
وَمن نوافل الصَّلَاة المرغب فِيهَا، الْمُؤَكّد فِي استحبابها: رواتب( ) الْفَرَائِض، وَهِي كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عبدالله بن عمر، قَالَ: حفظت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة( ).
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ من حَدِيث عَائِشَة، وَأخرجه أحْمد، وَمُسلم، وَأبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ، لَكِن زادوا: «قبل الظّهْر أرْبعًا».
وَأخرج مُسلم، وَأهل السّنَن، من حَدِيث أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، قَالَ: «من صلى فِي يَوْم وَلَيْلَة اثْنَتَيْ عشرَة سَجْدَة سوى الْمَكْتُوبَة بني لَهُ بَيت فِي الْجنَّة»( ).
زَاد التِّرْمِذِيّ: «أرْبعًا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب»، وَزَاد النَّسَائِيّ: «رَكْعَتَيْنِ قبل الْعَصْر»، وَلم يذكر رَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء.
وَأخرج أحْمد وَأهل السّنَن، من حَدِيثها، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «من صلى أربع رَكْعَات قبل الظّهْر، وأربعًا بعْدهَا، حرمه الله على النَّار»( ).
وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ [أ:68]، وَلكنه من رِوَايَة مَكْحُول، عَن عَنْبَسَة بن أبي سُفْيَان( )، عَن أم حَبِيبَة، وَلم يسمع مَكْحُول من عَنْبَسَة، وَفِي إسْنَاد التِّرْمِذِيّ عبدالرَّحْمَن بن الْقَاسِم بن عبدالرَّحْمَن صَاحب أبي أمامة، وَقد اخْتلف فِيهِ، فَمنهمْ من يضعف رِوَايَته، وَمِنْهُم من يوثقه. وَوجه تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ لَهُ؛ أنه قد تَابع مَكْحُولًا الشعيثيُّ( )، وَهُوَ ثِقَة، وَقد صحّح هَذَا الحَدِيث أيْضًا ابْنُ حبَان.
وَأخرج أحْمد، وَأبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، عَن ابْن عمر: أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «رحم الله امرءًا صلى قبل الْعَصْر أرْبعًا»( ). حسنه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ ابْن حبَان، وَابْن خُزَيْمَة، وَفِي إسْنَاده مُحَمَّد بن مهْرَان( )، وَفِيه مقَال، وَقد وَثَّقَهُ ابْنُ حبَان، وَابْنُ عدي.
وَأخرج أحْمد، وَأبُو دَاوُد، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: مَا صلى رسول الله( ) صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم الْعشَاءَ قطّ فَدخل عَليّ إلَّا صلى أربع رَكْعَات أو سِتّ رَكْعَات( ). وَرِجَال إسْنَاده ثِقَات، وَمُقَاتِل بن بشير الْعجلِيّ قد وَثَّقَهُ ابْنُ حبَان، وَقد أخرجه النَّسَائِيّ.
وَأخرجه البُخَارِيّ وَأبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، من حَدِيث ابْن عَبَّاس، قَالَ: بت عِنْد خَالَتِي مَيْمُونَة... الحَدِيث، وَفِيه: فصلى( ) النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم الْعشَاءَ، ثمَّ جَاءَ إلَى منزله، فصلى أربع رَكْعَات( ).
وَقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: لم يكن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم على شَيْء من النَّوَافِل أشد تعاهدًا مِنْهُ على رَكْعَتي الْفجْر( ).
وَأخرج أحْمد، وَمُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ، من حَدِيثهَا، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَال( ): «رَكعَتَا الْفجْر خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»( ).
وَأخرج أحْمد وَأبُو دَاوُد، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة( )، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «لَا تدعوا رَكْعَتي الْفجْر، وَلَو طردتكم الْخَيل»( ).
وَفِي إسْنَاده عبدالرَّحْمَن بن إسْحَاق الْمدنِي، وَيُقَال: عباد بْن إسْحَاق. قَالَ أبُو حَاتِم الرَّازِيّ: لَا يحْتَج بِهِ، وَهُوَ حسن الحَدِيث، وَلَيْسَ بثبت وَلَا قوي. قلت: قد أخرج لَهُ مُسلم، وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيّ، وَوَثَّقَهُ يحيى بن معِين.
وَمن النَّوَافِل الْمُؤَكّدَة: صَلَاة اللَّيْل مَعَ الْوتر فِي آخرهَا، وَقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث ابْن عمر، قَالَ: قَامَ رجل، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، كَيفَ صَلَاة اللَّيْل؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإذا خفت الصُّبْح فأوتر بِوَاحِدَة»( ).
وَثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يُصَلِّي مَا بَين أن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء إلَى الْفجْر إحْدَى عشرَة رَكْعَة، يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَة( ).
وَثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيثهَا، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، يُوتر من ذَلِك بِخمْس، لَا يجلس فِي شَيْء مِنْهُنَّ إلَّا فِي آخِرهنَّ( ).
وَثَبت فِي الصَّحِيح، أنه كَانَ يُصَلِّي فِي اللَّيْل أرْبعًا، ثمَّ أرْبعًا، ثمَّ أرْبعًا، ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة. وَثَبت الْإتْيَان بِسبع وتسع( ).
وَمن النَّوَافِل الْمُؤَكّدَة: صَلَاة الضُّحَى، وَالْأحَادِيث فِي مشروعيتها متواترة حَسْبَمَا أوضحنا ذَلِك فِي شرحنا للمنتقى، وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ كَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: أوْصَانِي خليلي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم بِثَلَاث؛ صِيَام ثَلَاثَة أيَّام من كل شهر، وركعتي الضُّحَى، وَأن أوتر قبل أن أنَام( ).
وَفِيهِمَا من حَدِيث أم هَانِئ: أنه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم صلى على سُبحة الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات، يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ( ).
وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي أحدهمَا؛ كَحَدِيث أبي ذَر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «يصبح على كل سلامى صَدَقَة - إلَى أن قَالَ -: ويجزئ من ذَلِك رَكْعَتَيْنِ تركعهما من الضُّحَى»( ). أخرجه مُسلم وَغَيره.
وَأخرج مُسلم وَغَيره، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم [أ:69] يُصَلِّي الضُّحَى أربع وثمان رَكْعَات، وَيزِيد مَا شَاءَ( ). وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي غَيرهمَا، وَهُوَ أحَادِيث كَثِيرَة.
وَمن النَّوَافِل الْمُؤَكّدَة: صَلَاة تَحِيَّة الْمَسْجِد، وَالْأحَادِيث فِيهَا كَثِيرَة صَحِيحَة، وَمِنْهَا حَدِيث أبي قَتَادَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد، فَلَا يجلس حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»( ).
وَمن النَّوَافِل الْمُؤَكّدَة: الصَّلَاة عقب الْوضُوء، كَمَا فِي حَدِيث بِلَال، فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا؛ أنه قَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «حَدثنِي بأرجى عمل عملته فِي الْإسْلَام، فَإنِّي، سَمِعت دف نعليك بَين يَدي فِي الْجنَّة»، قَالَ: مَا عملت عملًا أرْجَى عِنْدِي، أنِّي لم أتطهر طهُورًا فِي سَاعَة من ليل أو نَهَار إلَّا صليت بذلك الطّهُور مَا كتب لي أن أصَلِّي( ).
وَمن النَّوَافِل الْمُؤَكّدَة: الصَّلَاة بَين الْأذَان وَالْإقَامَة؛ كَمَا فِي حَدِيث عبدالله بن مُغفل: «بَين كل أذانين صَلَاة، بَين كل أذانين صَلَاة»، ثمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَة: «لمن شَاءَ»( ). وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، وَالْمرَاد بالأذانين الْأذَان وَالْإقَامَة.
وَفِي لفظ من حَدِيثه مُتَّفق عَلَيْهِ، أنه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، قَالَ: «صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ»، ثمَّ قَالَ: «صلوا قبل الْمغرب رَكْعَتَيْنِ»، ثمَّ قَالَ عِنْد الثَّالِثَة: «لمن شَاءَ»( )؛ كَرَاهِيَة أن يتخذها النَّاس سنة؛ أي: وَاجِبَة.
وَفِي البُخَارِيّ وَغَيره، من حَدِيث أنس، قَالَ: كَانَ إذا أذن الْمُؤَذّن، قَامَ نَاس من أصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يبتدرون السَّوَارِي، حَتَّى يخرج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وهم كَذَلِك( ).
محبة الله والاستكثار النوافل:
وَالْحَاصِل؛ أن جَمِيع التَّقَرُّب إلَى الرب ۵ بنوافل الصَّلَاة فِي جَمِيع الْأوْقَات من أحسن الْعِبَادَات، إلَّا فِي الْأوْقَات المكروهات، فَمن استكثر مِنْهَا قرب إلَى الله [سبحانه]( ) بِقدر مَا فعل مِنْهَا، فَأحبهُ، وَلَيْسَ بعد الظفر بمحبة الله سُبْحَانَهُ( ) لعَبْدِهِ شَيْء.
من نوافل الصيام:
وَأما نوافل الصّيام الْمُؤَكّدَة فَهِيَ كَثِيرَة، وَمِنْهَا( ) صَوْم شهر الله الْمحرم، فَإنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم سُئِلَ: أي: الصّيام بعد رَمَضَان أفضل؟ فَقَالَ: «شهر الله الْمحرم»( )، كَمَا ثَبت فِي صَحِيح مُسلم، وَأحمد، وَأهل السّنَن، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَلَا يُعَارض هَذَا مَا أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: أي الصَّوْم أفضل بعد رَمَضَان؟ قَالَ: «شعْبَان»( )؛ لِأن فِي إسْنَاده صَدَقَة بن مُوسَى، وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ.
وَيُؤَيّد أفضَلِيَّة صَوْم الْمحرم، مَا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه، من حَدِيث عَليّ: أنه سمع رجلًا يسْأل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم وَهُوَ قَاعد، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أي شهر تَأْمُرنِي أن أصوم بعد شهر رَمَضَان؟ فَقَالَ: «إن كنت صَائِمًا بعد شهر رَمَضَان، فَصم الْمحرم، فَإنَّهُ شهر الله، فِيهِ يَوْم تَابَ فِيهِ على قوم، وَيَتُوب فِيهِ على قوم»( )؛ يَعْنِي: يَوْم عَاشُورَاء.
وَقد ثَبت من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَعَائِشَة، وَسَلَمَة بن الْأكْوَع، وَابْن مَسْعُود، فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، أنه كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَصُوم يَوْمَ عَاشُورَاء قبل أن يفْرض رَمَضَان، فَلَمَّا فرض رَمَضَان، قَالَ: «من شَاءَ صَامَهُ، وَمن شَاءَ ترك»( ).
وَثَبت فِي «صَحِيح مُسلم» وَغَيره: أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، قَالَ: «لَئِن بقيت إلَى قَابل، لأصومن التَّاسِع»( )، وَفِي لفظ لِأحْمَد: «صُومُوا يَوْم عَاشُورَاء، وخالفوا الْيَهُود، صُومُوا قبله يَوْمًا، وَبعده يَوْمًا»( ).
وَمن نوافل الصّيام الْمُؤَكّدَة: صِيَام سِتّ من شَوَّال، كَمَا فِي حَدِيث [أبي]( ) أيُّوب، عِنْد أحْمد، وَمُسلم، وَأهل السّنَن، عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم [أ:70] أنه قَالَ: «من صَامَ رَمَضَان، ثمَّ أتبعه سِتًّا من شَوَّال، فَذَلِك صِيَام الدَّهْر»( ).
وَأخرج أحْمد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، والدارمي، وَالْبَزَّار، من حَدِيث ثَوْبَان، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، أنه قَالَ: «من صَامَ رَمَضَان، وَسِتَّة أيَّام بعد الْفطر، كَانَ تَمام السّنة، من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أمْثَالهَا»( ). وَفِي الْبَاب أحَادِيث.
وَمن نوافل الصّيام الْمُؤَكّدَة: صَوْم عشر ذِي الْحجَّة، فقد ثَبت فِي الصَّحِيح، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، أنه قَالَ: «مَا من أيَّام الْعَمَل الصَّالح فِيهَا أحب إلَى الله ۵ من هَذِه الْأيَّام»؛ يَعْنِي أيَّام الْعشْر، قَالُوا: يَا رَسُول الله، وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله، إلَّا رجل خرج بِنَفسِهِ وَمَاله، ثمَّ لم يرجع من ذَلِك بشَيْء( )»( ).
وَمن الْعشْر يَوْم عَرَفَة، وَقد ثَبت فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره، من حَدِيث أبي قَتَادَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «صَوْم يَوْم عَرَفَة يكفِّر سنتَيْن - مَاضِيَة ومستقبلة - وَصَوْم يَوْم عَاشُورَاء يكفر سنة مَاضِيَة»( ).
وَمن نوافل الصّيام الْمُؤَكّدَة: صَوْم شعْبَان، كَمَا أخرج أحْمد وَأهل السّنَن، من حَدِيث أم سَلمَة: أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم لم يكن يَصُوم من السّنة شهرًا تَامًّا إلَّا شعْبَان، يصل بِهِ رَمَضَان( ). وَحسنه التِّرْمِذِيّ.
وَيَكْفِي فِي مَشْرُوعِيَّة مُطلق التَّنَفُّل بالصيام حَدِيث «الصَّوْم لي وَأنا أجزي بِهِ»( )، وَهُوَ حَدِيث صَحِيح.
من نوافل الحج:
وَأما نوافل الْحَج: فَيَكْفِي فِي ذَلِك حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: أي الْأعْمَال أفضل؟ قَالَ: «إيمَان بِاللَّه وبرسوله»، قَالَ: ثمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَاد فِي سَبِيل الله»، قَالَ: ثمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حج مبرور»( ). وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، وَقد احْتج بِهِ من فضل [نفل]( ) الْحَج على نفل الصَّدَقَة.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيثه أيْضًا: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، قَالَ: «الْعمرَة إلى العمرة كَفَّارَة لما بَينهمَا، وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إلَّا الْجنَّة»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيثه، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، يَقُول: «من حج فَلم يرْفث وَلم يفسق، رَجَعَ من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه»( ).
من نوافل الصدقة:
وَأما نوافل الصَّدَقَة: فقد ورد فِيهَا التَّرْغِيب الْعَظِيم، وَلَو لم يكن من ذَلِك إلَّا قَول الله ۵: ﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [سبأ: 39].
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «مَا من يَوْم يصبح الْعباد فِيهِ إلَّا وملكان ينزلان من السَّمَاء، فَيَقُول أحدهمَا: اللَّهُمَّ أعْط منفقًا خلفًا، وَيَقُول الآخر: اللَّهُمَّ أعْط ممسكًا تلفًا»( ).
وَفِي «صَحِيح مُسلم» وَغَيره، من حَدِيث أبي أمَامَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «يَا ابْن آدم، إنَّك إن تبذل الْفضل خير لَك، وَإن تمسكه شَرّ لَك، وَلَا تلام على كفاف، وابدأ بِمن تعول، وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة [أ:71]: أنه سمع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «مثل الْبَخِيل والمنفق، كَمثل رجلَيْنِ عَلَيْهِمَا جبتان من حَدِيد من ثديهما إلَى تراقيهما، فَأما الْمُنفق، فَلَا ينْفق إلَّا سبغت( ) عَلَيْهِ، ووفرت على جلده حَتَّى تخفي بنانه وَتَعْفُو أثَره، وَأما الْبَخِيل، فَلَا يُرِيد أن ينْفق شَيْئًا إلا لَزِمت كل حَلقَة مَكَانهَا، فَهُوَ يوسعها فَلَا تتسع»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ وَغَيره، من حَدِيث ابْن مَسْعُود، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «أيّكُم مَال وارثه أحب إلَيْهِ من مَاله؟» قَالُوا: يَا رَسُول الله، مَا منا أحد إلَّا مَاله أحب إلَيْهِ من مَال وَارثه، قَالَ: «فَإن مَاله مَا قدم، وَمَال وَارثه مَا أخر»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أسمَاء بنت أبي بكر، قَالَت: قَالَ لي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا توكي فيوكي الله عَلَيْك»( )، وَفِي رِوَايَة: «أنفقي أو انفحي أو انضحي( )، وَلَا تحصي فيحصي الله عَلَيْك، وَلَا توعي فيوعي الله عَلَيْك».
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث ابْن مَسْعُود، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، قَالَ: «لَا حَسَدَ إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رجل أتَاهُ الله مَالًا، فَسَلَّطَهُ على هَلَكته فِي الْحق، وَرجل أتَاهُ الله حِكْمَة، فَهُوَ يقْضِي بهَا وَيعلمهَا»( )، وَفِي رِوَايَة: «لَا حسد إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رجل أتَاهُ الله الْقُرْآن، فَهُوَ يقوم بِهِ آنَاء اللَّيْل وآناء النَّهَار، وَرجل آتَاهُ الله مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقهُ آنَاء اللَّيْل وآناء النَّهَار».
وَالْأحَادِيث فِي التَّرْغِيب فِي الصَّدَقَة وعظيم( ) أجرهَا كَثِيرَة جدًّا، وأفضلها صلَة الرَّحِم، كَمَا فِي البُخَارِيّ وَغَيره، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من سره أن يبسط لَهُ فِي رزقه، وَأن ينسأ لَهُ فِي أثَره، فَليصل رَحمَه»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «الرَّحِم معلقَة بالعرش، تَقول: من وصلني وَصله الله، وَمن قطعني قطعه الله»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث مَيْمُونَة، قَالَت: يَا رَسُول الله، أشعرت أنِّي أعتقت وليدتي، قَالَ: «وَفعلت؟»، قَالَت: نعم، قَالَ: «أما أنَّك لَو أعطيتهَا أخوالك كَانَ أعظم لأجرك»( ).
وَأخرج النَّسَائِيّ، من حَدِيث سلمَان بْن عَامر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة، وعَلى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ، صَدَقَة وصلَة»( ).
التقرب بالأذكار:
ترغيب الكتاب والسنة فيها:
وَأما نوافل الْأذْكَار: فقد ورد فِي التَّرْغِيب فِيهَا وعظيم( ) أجرهَا الْكتاب وَالسّنة.
أما الْكتاب: فَمن ذَلِك قَوْله ۵: ﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [العنكبوت: 45]؛ أي: أكبر مِمَّا سواهُ من الْأعْمَال الصَّالِحَة. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﯩ ﯪ﴾ [البقرة: 152]، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [الأنفال: 45]، وَقَالَ: ﴿ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾ [الرعد: 28]، وَقَالَ ۵: ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الأحزاب: 35].
وَفِي السّنة: الْكثير الطّيب؛ فَمن ذَلِك: حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «أنا عِنْد ظن عَبدِي بِي، وَأنا مَعَه إذا ذَكرنِي، فَإن ذَكرنِي فِي نَفسه، ذكرته فِي نَفسِي، وَإن ذَكرنِي فِي مَلأ، ذكرته فِي مَلأ خير مِنْهُ ، وَإن اقْترب إلَيّ شبْرًا، اقْتَرَبت مِنْهُ( ) ذِرَاعًا، وَإن اقْترب إلَي ذِرَاعًا، اقْتَرَبت إلَيْهِ باعًا، وَإن أتَانِي مشيًا، أتَيْته هرولة»( ). وَأخرجه البُخَارِيّ أيْضًا من حَدِيث أنس، ومسلم من حَدِيث أبي ذَر.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي مُوسَى: «الَّذِي يذكر ربه وَالَّذِي لَا يذكر مثل الْحَيّ وَالْمَيِّت»( ).
وَأخرج أحْمد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمَالك فِي «الْمُوَطَّأ»، وَابْن مَاجَه، وَالْحَاكِم فِي «الْمُسْتَدْرك»، وَالطَّبَرَانِيّ فِي «الْكَبِير»، من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «ألا أخْبركُم بِخَير أعمالكُم، وأزكاها عِنْد مليككم، وأرفعها فِي درجاتكم، وَخير لكم من إنْفَاق الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَخير لكم من أن تلقوا عَدوكُمْ، فتضربوا أعْنَاقهم، ويضربوا أعْنَاقكُم؟»، قَالُوا: بلَى، قَالَ: «ذكر الله»( ).
وصَحَّحهُ الْحَاكِم، وَقَالَ الهيثمي: إسْنَاده حسن. وَأخرجه أحْمد من حَدِيث معَاذ( )، قَالَ الْمُنْذِرِيّ: بِإسْنَاد جيد، إلَّا أن فِيهِ انْقِطَاعًا، وَقَالَ الهيثمي: رِجَاله رجال الصَّحِيح، إلَّا أن زِيَاد بن أبي زِيَاد مولى ابْن عَيَّاش( ) لم يدْرك معَاذًا.
وَأخرج مُسلم، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد مَعًا، عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، أنه قَالَ: «لَا يقْعد قوم يذكرُونَ الله تَعَالَى، إلَّا حفتهم الْمَلَائِكَة، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَة، وَنزلت عَلَيْهِم السكينَة، وَذكرهمْ الله سُبْحَانَهُ فِيمَن عِنْده»( ).
وَأخرجه غير مُسلم من حَدِيثهمَا، مِنْهُم أبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، وَأحمد فِي «الْمسند»، وَأبُو يعلى الْموصِلِي، وَابْن حبَان. وَأخرجه أيْضًا من حَدِيثهمَا ابْن أبي شيبَة، وَالتِّرْمِذِيّ فِي الدَّعْوَات، وَابْن شاهين فِي «الذّكر».
وَأخرج مُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، من حَدِيث مُعَاوِيَة: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم خرج على حَلقَة فِي الْمَسْجِد من أصْحَابه، فَقَالَ: «مَا أجلسكم؟»، قَالُوا: جلسنا نذْكر الله، نحمده على مَا هدَانَا لِلْإسْلَامِ، وَمنَّ بِهِ علينا، فَقَالَ: «آللَّهُ مَا أجلسكم إلَّا ذَلِك؟» قَالُوا: آللَّهُ مَا أجلسنا إلَّا ذَلِك، قَالَ: «أما إنِّي لم أستحلفكم تُهْمَة لكم، وَلكنه أتَانِي جِبْرِيل، فَأخْبرنِي أن الله ۵ يباهي بكم الْمَلَائِكَة»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَحسنه، من حَدِيث أنس، عن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «إذا مررتم برياض الْجنَّة فارتعوا»، قَالُوا: يَا رَسُول الله، وَمَا رياض الْجنَّة؟ قَالَ: «حلق الذّكر»( ).
وَأخرجه أيْضًا من حَدِيثه: أحْمد فِي «الْمسند»، وَالْبَيْهَقِيّ فِي «الشّعب». قَالَ الْمَنَاوِيّ: وَإسْنَاده وشواهده ترتقي إلَى الصِّحَّة. وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَفِي إسْنَاده رجل مَجْهُول.
وَالْأحَادِيث فِي فَضَائِل الذّكر كثيرة جدًّا، قد ذكرنَا مِنْهَا فِي شرحنا لـ «عدة الْحصن الْحصين» أحَادِيث كَثِيرَة، وَذكرنَا المفاضلة بَينهَا وَبَين سَائِر الْأعْمَال، فَليرْجع إلَيْهِ.
أعظم الأذكار أجرًا:
وَيَنْبَغِي أن نذْكر هَهُنَا مَا عظم أجره من الْأذْكَار؛ لينْتَفع بِهِ المطلع على هَذَا الشَّرْح.
فأفضل الذّكر مَا كَانَ فِي دُعَاء الرب ۵، فَإنَّهُ مَطْلُوب مِنْهُ سُبْحَانَهُ كَمَا قَالَ: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [غافر: 60]، وعقبه بقوله: ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ الْآيَة، فَجعل الدُّعَاء لَهُ فِي حوائج العَبْد عبَادَة، وَجعل تَارِك الدُّعَاء مستكبرًا عَن عِبَادَته.
فسبحان الله الْعَظِيم ذِي الْكَرم الْفَيَّاض، والجود المتتابع( )، جعل سُؤال عَبده لحوائجه، وَقَضَاء مآربه، عبَادَة لَهُ، وَطَلَبه مِنْهُ، وذمه على تَركه بأبلغ أنْوَاع الذَّم، فَجعله مستكبرًا على ربه. فشكرًا لَك يَا رب على هَذِه النِّعْمَة شكرًا يَلِيق بك، لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك، أنْت كَمَا أثنيت على نَفسك.
وَقَالَ ۵: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [النمل: 62]، وَقَالَ: ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [البقرة: 186]. [أ:73].
وَمِمَّا قلته من النّظم فِي شكره ۵ على نعمه الَّتِي هَذِه النِّعْمَة الْعُظْمَى فَرد من أفرادها:
لَو كَانَ لي كـــــل لِسَان لما
وفيت بالشــــــكر لبَعض النعم
فَكيف لَا أعجز عَن شـكرها
وَلَيْــــــسَ لي غير لِسَان وفم؟
هَذَا هُوَ الإفضال هَذَا الْعَطاء
الْفَيَّاض، هَذَا الْجُود هَذَا الْكَرم
وَأخرج ابْن أبي شيبَة فِي «مُصَنفه»، وَأهل السّنَن الْأرْبَع، [وَابْن حبَان]( )، من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير، قَالَ: قَالَ صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «الدُّعَاء هُوَ الْعِبَادَة»( )، ثمَّ تَلا الْآيَة: ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [غافر:60] الآية، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث أنس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «الدُّعَاء مخ الْعِبَادَة»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَابْن حبَان، من حَدِيث سلمَان، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «لَا يرد الْقَضَاء إلَّا الدُّعَاء، وَلَا يزِيد في الْعُمر إلَّا الْبر»( )، وَصَححهُ ابْن حبَان.
وَأخرجه أيْضًا الْحَاكِم وَصَححهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن غَرِيب، وَأخرجه أيْضًا الطَّبَرَانِيّ فِي «الْكَبِير»، والضياء فِي «المختارة».
وَأخرج ابْن أبي شيبَة، وَالطَّبَرَانِيّ فِي «الْكَبِير»، وَالْحَاكِم فِي «الْمُسْتَدْرك»، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، من حَدِيث ثَوْبَان؛ أنه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «لَا يرد الْقدر إلَّا الدُّعَاء، وَلَا يزِيد فِي الْعُمر إلَّا الْبر، وَإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يُصِيبهُ»( ).
وَأخرج الْحَاكِم فِي «الْمُسْتَدْرك»، وَالْبَزَّار، وَالطَّبَرَانِيّ فِي «الْأوْسَط»، والخطيب، من حَدِيث عَائِشَة، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا يغني حذر من قدر، وَالدُّعَاء ينفع مِمَّا نزل وَمِمَّا لم ينزل، وَإن الْبلَاء لينزل، فيتلقاه الدُّعَاء، فيعتلجان إلَى يَوْم الْقِيَامَة»( ).
قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح، وَتعقبه الذَّهَبِيّ فِي «التَّلْخِيص»؛ بِأن زَكَرِيَّا بن مَنْصُور - أحد رِجَاله - مجمع على ضعفه، وَقَالَ فِي «الْمِيزَان»: ضعفه ابْن معِين، ووهاه أبُو زرْعَة، وَقَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: حَدِيث لَا يَصح، وَقَالَ الهيثمي فِي «مجمع الزَّوَائِد»: رَوَاهُ أحْمد، وَأبُو يعلى بِنَحْوِهِ، وَالْبَزَّار، وَالطَّبَرَانِيّ فِي «الْأوْسَط»، وَرِجَال أحْمد، وَأبي يعلى، وَأحد إسنادي الْبَزَّار رِجَاله رجال الصَّحِيح، غير عَليّ بن أحْمد الرِّفَاعِي، وَهُوَ ثِقَة( ).
قلت: وَبِهَذَا يعرف أن الحَدِيث إذا لم يكن صَحِيحًا - كَمَا قَالَ الْحَاكِم - فَأقل أحْوَاله أن يكون حسنًا.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَابْن حبَان، من حَدِيث [عَائِشَة]( )، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَيْسَ شَيْء أكْرم على الله من الدُّعَاء»( ).
قَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن غَرِيب، وَأخرجه أيْضًا من حَدِيثهَا: أحْمد فِي «الْمسند»، وَالْبُخَارِيّ فِي «التَّارِيخ»، وَابْن مَاجَه، وَالْحَاكِم فِي «الْمُسْتَدْرك»، وَقَالَ: صَحِيح، وَأقرهُ الذَّهَبِيّ، وَقَالَ ابْن حبَان: حَدِيث صَحِيح.
قلت: وَإنَّمَا لم يُصَحِّحهُ التِّرْمِذِيّ؛ لِأن فِي إسْنَاده [عِنْده]( ) عمرَان الْقطَّان( )، ضعفه النَّسَائِيّ، وَأبُو دَاوُد، وَمَشاهُ أحْمد. قَالَ ابْن الْقطَّان: رُوَاته كلهم ثِقَات، إلَّا عمرَان، وَفِيه خلاف.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «من لم يسْأل الله يغْضب عَلَيْهِ»( ).
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة فِي «المُصَنّف» بِلَفْظ «من لم يدع الله يغْضب عَلَيْهِ»، وَأخرجه بِاللَّفْظِ الأول َالْحَاكِمُ، وَكَذَلِكَ أخرجه بِاللَّفْظِ الثَّانِي [الحاكم]( ) فِي «الْمُسْتَدْرك»، وَصَححهُ.
وَمَا أحسن قَول الشَّاعِر:
الله يغْضب إن تركت سُؤَاله
وَإذا سَألت بني آدم يغضب ( )
وَأخرج ابْن حبَان، وَالْحَاكِم، والضياء فِي «المختارة»، من حَدِيث أنس مَرْفُوعًا: «لَا تعجزوا فِي الدُّعَاء، فَإنَّهُ لن يهْلك مَعَ الدُّعَاء أحد»( ). وَصَححهُ ابْن حبَان، وَالْحَاكِم، والضياء، فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَة أئِمَّة صححوه.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَالْحَاكِم، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من سره أن يستجيب الله لَهُ عِنْد الشدائد وَالْكرب، فليكثر الدُّعَاء فِي الرخَاء»( ). وَصَححهُ الْحَاكِم، وَأقرهُ الذَّهَبِيّ، وَأخرجه الْحَاكِم أيْضًا من حَدِيث سلمَان، وَقَالَ: صَحِيح الْإسْنَاد( ).
وَأخرج الْحَاكِم، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «الدُّعَاء سلَاح الْمُؤمن، وعماد الدّين، وَنور السَّمَوَات وَالْأرْض»( ). قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإسْنَاد. وَأخرجه أبُو يعلى من حَدِيث عَليّ بِهَذَا اللَّفْظ.
وَأخرج أبُو يعلى أيْضًا من [حَدِيث]( ) جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «ألا أدلكم على مَا ينجيكم من عَدوكُمْ، ويدر [لكم]( ) أرزاقكم؟ تدعون الله سُبْحَانَهُ فِي ليلكم ونهاركم، فَإن الدُّعَاء سلَاح الْمُؤمن»( ).
وَأخرج أحْمد، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «مَا من مُسلم ينصب وَجهه لله فِي مَسْألَة، إلَّا أعطَاهُ إيَّاهَا؛ إمَّا أن يعجلها لَهُ، وَإمَّا أن يدخرها لَهُ»( ). قَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي «التَّرْغِيب والترهيب»: إسْنَاده لَا بَأْس بِهِ. وَأخرجه أيْضًا البُخَارِيّ فِي «الْأدَب الْمُفْرد»، وَالْحَاكِم.
وَأخرج أحْمد، وَالْبَزَّار، وَأبُو يعلى، وَالْحَاكِم، من حَدِيث أبي سعيد، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «مَا من مُسلم يَدْعُو بدعوة لَيْسَ فِيهَا إثْم وَلَا قطيعة رحم، إلَّا أعطَاهُ الله بهَا إحْدَى ثَلَاث: إمَّا أن يعجل لَهُ دَعوته، وَإمَّا أن يدخرها لَهُ فِي الْآخِرَة، وَإمَّا أن يصرف عَنهُ من السوء مثلهَا»( ).
قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإسْنَاد، وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ: أسانيده جَيِّدَة.
وَأخرج أبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَحسنه، [وابن ماجه]( )، وَابْن حبَان، وَصَححهُ، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ أيْضًا، من حَدِيث سلمَان، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن ربكُم حييّ كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إلَيْهِ يَدَيْهِ( )، أن يردهما صفرًا خائبتين»( ). وَأخرجه الْحَاكِم وَصَححهُ، من حَدِيث أنس.
الأذكار المؤقتة وفوائدها:
وَمن أكثر الْأذْكَار أجورًا وَأعْظَمهَا جَزَاء، الْأدْعِيَة الثَّابِتَة فِي الصَّباح والمساء، فَإن فِيهَا من النَّفْع وَالدَّفْع مَا هِيَ مُشْتَمِلَة عَلَيْهِ.
فعلى من أحب السَّلامَة من الْآفَات فِي الدُّنْيَا، والفوز بِالْخَيرِ الآجل والعاجل، أن يلازمها ويفعلها فِي كل صباح وَمَسَاء، فَإن عسر عَلَيْهِ الْإتْيَان بجميعها أتَى بِبَعْض مِنْهَا. وَقد ذكرهَا صَاحب «عدَّة الْحصن»( )، وَذكرنَا فِي الشَّرْح لَهَا تخريجها، وَبَيَان مَعَانِيهَا، وَمَا ورد فِي مَعْنَاهَا. وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي مُلَازمَة مَا يُقَال عِنْد النّوم، وَعند الاستيقاظ، فَإن ذَلِك هُوَ الترياق المجرب فِي دفع الْآفَات. وَهِي أيْضا مَذْكُورَة فِي الْعدة.
وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي للْإنْسَان أن يحافظ عِنْد خُرُوجه من بَيته على أن يَقُول: «أعوذ بِكَلِمَات الله التامات من شَرّ مَا خلق»، وَيَقُول: «بِسم الله الَّذِي لَا يضر مَعَ اسْمه شَيْء فِي الأرْض وَلَا فِي السَّمَاء وَهُوَ السَّمِيع الْعَلِيم»، وَآيَة الْكُرْسِيّ، فَإن ذَلِك حرز حريز من جَمِيع الشرور ؛ لما ورد فِي هذَيْن الذكرين بِهَذَا اللَّفْظ، وَمَا ورد فِي آيَة الْكُرْسِيّ.
وَكَذَلِكَ مُلَازمَة الاسْتِغْفَار، فَإنَّهُ المرهم الَّذِي يغسل كل ذَنْب، وَمن غفرت ذنُوبه فَازَ، وعَلى الصِّرَاط السوي جَازَ، وَقد وردت فِي ذَلِك أحَادِيث، ذكرهَا أئِمَّة الحَدِيث. وَقد ذكر صَاحب «عدَّة الْحصن» مِنْهَا نَصِيبًا وافرًا، وَذكرنَا فِي شرحنا لَهَا الكَلَام على كل حَدِيث مِنْهَا، وضممنا إلَيْهَا زِيَادَة على مَا فِيهَا.
أذكار التّوحيد:
وَمن أعظم مَا يلازمه العَبْد من أذكار الله سُبْحَانَهُ: هُوَ كلمة التَّوْحِيد. وَقد أخرج التِّرْمِذِيّ، وَأحمد بن حَنْبَل، من حَدِيث جَابر، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «أفضل الذّكر لَا إلَه إلَّا الله»( )، وَلَفظ أحْمد: «لَا إلَه إلَّا الله أفضل الذّكر وَهِي أفضل الْحَسَنَات»( ). وَأخرجه أيْضًا ابْن مَاجَه من حَدِيثه، بِلَفْظ: «أفضل الذّكر لَا إلَه إلَّا الله، وَأفضل الدُّعَاء الْحَمد [لله]( )».
وَكَذَا أخرجه النَّسَائِيّ، وَابْن حبَان، وَصَححهُ، وَالْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإسْنَاد، كلهم أخْرجُوهُ من طَرِيق طَلْحَة بن حِرَاش( )، عَن جَابر، وَطَلْحَة أنْصَارِي مدنِي صَدُوق. قَالَ الْأزْدِيّ: لَهُ مَا يُنكر. وَوَثَّقَهُ ابْن حبَان، وَأخرج لَهُ فِي «صَحِيحه».
وَأخرج أحْمد، من حَدِيث أبي ذَر، قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، أوصني؟ قَالَ: «إذا عملت( ) سَيِّئَة، فأتبعها حَسَنَة تمحوها»، قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله، أمن الْحَسَنَات لَا إلَه إلَّا الله؟ قَالَ: «هِيَ أفضل الْحَسَنَات»( ). قَالَ فِي «مجمع الزَّوَائِد»: رِجَاله ثِقَات، إلَّا أن سَمُرَة بن عَطِيَّة( ) حدث بِهِ عَن أشياخه، عن أبي ذَر، وَلم يسم أحدًا مِنْهُم.
وَأخرج مُسلم، من حَدِيث أبي ذَر، قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «مَا من عبد قَالَ لَا إلَه إلَّا الله، ثمَّ مَاتَ على ذَلِك، إلَّا دخل الْجنَّة»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، أنه [قَالَ]( ): يَا رَسُول الله، من أسعد النَّاس بشفاعتك يَوْم الْقِيَامَة؟ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لقد ظَنَنْت أن لَا يسألني عَن هَذَا الحَدِيث [أحد]( ) أول مِنْك؛ لما رَأيْت من حرصك على الحَدِيث، أسعد النَّاس بشفاعتي يَوْم الْقِيَامَة، من قَالَهَا خَالِصًا من قلبه»( ).
وَالْأحَادِيث الثَّابِتَة فِي كَون من قَالَ هَذِه الْكَلِمَة، وَكَانَت آخر قَوْله دخل الْجنَّة متواترة، فَالْحَمْد لله على ذَلِك.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي أيُّوب: أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «من قَالَ لَا إلَه إلَّا الله ، وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ على كل شَيْء قدير، عشر مَرَّات، كَانَ كمن أعتق أرْبَعَة من ولد إسْمَاعِيل»( ).
الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم :
وَمِمَّا يَنْبَغِي لطَالب الْخَيْر ملازمته، والاستكثار مِنْهُ، وَجعله فَاتِحَة لكل دُعَاء: الصَّلَاة وَالسَّلَام على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم. فقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث جمَاعَة؛ أن من صلى على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم صَلَاة وَاحِدَة، صلى الله عَلَيْهِ عشر صلوَات( ).
فَانْظُر إلَى هَذَا الْأمر الْعَظِيم، وَالْجَزَاء الْكَرِيم، يُصَلِّي العَبْد على الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم وَاحِدَة، فيصلى عَلَيْهِ خَالق الْعَالم، وَرب الْكل ۵، عشر مَرَّات؟ فَهَذَا ثَوَاب لَا يعادله ثَوَاب، وَجَزَاء لَا يُسَاوِيه جَزَاء، وَأجر لَا يماثله أجر.
فليستكثر مِنْهُ من شَاءَ الاستكثار من الْخَيْر، فَإن هَذَا العَبْد الحقير الَّذِي هُوَ أحد مخلوقات الرب سُبْحَانَهُ، يَقُول بِلِسَانِهِ هَذِه الصَّلَاة مرّة، فَيرد الله عَلَيْهِ عشر مَرَّات؟ فَهَل دَلِيل على الرِّضَا وَالْمَغْفِرَة [أ:76] والمحبة من الرب للْعَبد، أدل من هَذَا الدَّلِيل، وأوضح من هَذِه الْحجَّة. اللَّهُمَّ صلي وسلم على مُحَمَّد وعَلى آله مُحَمَّد عدد مَا صلى عَلَيْهِ المصلون مُنْذُ بعثته إلَى الْآن، وَعدد مَا سيصلي عَلَيْهِ المصلون من الْآن إلَى انْقِضَاء الْعَالم.
وَمَعَ هَذَا؛ فَمن أجور هَذِه الصَّلَاة على سيد ولد آدم صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، مَا ورد من أن أولى النَّاس بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أكْثَرهم صَلَاة عَلَيْهِ، وَمَا ورد من أن من صلى عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم حطت عَنهُ عشر خطيئات، وَرفعت لَهُ عشر دَرَجَات( )، وَغير ذَلِك مِمَّا تكْثر الْإحَاطَة بِهِ.
بل ورد أن من صلى عَلَيْهِ صَلَاة وَاحِدَة صلى الله عَلَيْهِ وَمَلَائِكَته سبعين صَلَاة( ). أخرج ذَلِك أحْمد فِي «الْمسند»، من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو. قَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي «التَّرْغِيب والترهيب»: بِإسْنَاد حسن، وَكَذَلِكَ حسنه الهيثمي، وَتَمَامه «فَلْيقل عبد من ذَلِك أو ليكْثر».
وَمن نظر بِعَين الْمعرفَة فِي هَذَا، وَفهم مَعْنَاهُ حق فهمه، طَار بأجنحة السرُور والحبور( )، إلَى أوكار الاستكثار من هَذَا الْخَيْر الْعَظِيم، وَالْأجْر الجسيم، وَالعطَاء الْجَلِيل، والجود الْجَمِيل، فشكرًا لَك يَا واهب الجزل، ومعطي الْفضل.
التسبيح وفوائده:
وَمِمَّا يَنْبَغِي لطَالب الْخَيْر ملازمته: التَّسْبِيح، وَالتَّكْبِير، والتوحيد، والتحميد، فقد ثَبت فِي صَحِيح مُسلم، من حَدِيث سَمُرَة بن جُنْدُب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «أحب الْكَلَام إلَى الله أربع: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْد لله، وَلَا إلَه إلَّا الله، وَالله أكبر، لَا يَضرك بأيهن بدأت»( ).
وَأخرجه من حَدِيثه أيْضًا: النَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «كلمتان خفيفتان على( ) اللِّسَان، ثقيلتان فِي الْمِيزَان، حبيبتان إلَى الرَّحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الله الْعَظِيم»( ).
وَورد أن الْأرْبَع الْكَلِمَات( ) الْمُتَقَدّمَة أفضل الْكَلَام بعد الْقُرْآن( )، كَمَا أخرجه أحْمد، بِإسْنَاد رِجَاله رجال الصَّحِيح.
الأدعية المأثورة :
وَيَنْبَغِي لطَالب الْخَيْر، وباغي الرشد، أن يلازم من الْأدْعِيَة النَّبَوِيَّة مَا تبلغ إلَيْهِ طاقته. وَأقل حَال أن يلازم الْكَلِمَات( ) الجامعة؛ مثل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «اللَّهُمَّ إنِّي أعوذ بك من زَوَال نعمتكم، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وَجَمِيع سخطك»( )، هَكَذَا ثَبت فِي صَحِيح مُسلم، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم، من حَدِيث ابْن عمر. وَأخرجه من حَدِيثه أيْضًا: أبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.
وَمثل حَدِيث أبي هُرَيْرَة عِنْد مُسلم قَالَ: كَانَ رَسُول الله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «اللَّهُمَّ أصلح لي ديني الَّذِي هُوَ عصمَة أمْرِي، وَأصْلح لي دنياي الَّتِي فِيهَا معاشي، وَأصْلح لي آخرتي الَّتِي إلَيْهَا معادي، وَاجعَل الْحَيَاة زِيَادَة لي فِي كل خير، وَاجعَل الْمَوْت رَاحَة لي من كل شَرّ»( ).
وَمثل حَدِيث أبي هُرَيْرَة أيْضًا، عِنْد الشَّيْخَيْنِ وَغَيرهمَا، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «تعوَّذوا بِاللَّه من جهد الْبلَاء، ودرك الشَّقَاء، وَسُوء الْقَضَاء، وشماتة الْأعْدَاء»( ).
وَمثل مَا أخرجه أحْمد فِي «مُسْنده» [أ:77]، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وصححاه، وَالطَّبَرَانِيّ فِي «الْكَبِير»، قَالَ فِي «مجمع الزَّوَائِد»: وَإسْنَاد أحْمد، وَأحد إسنادي الطَّبَرَانِيّ ثِقَات( ).
وَمثل حَدِيث أنس، فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، قَالَ: كَانَ أكثر دُعَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «اللَّهُمَّ رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة، وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة، وقنا عَذَاب النَّار»( ).
وَمثل سُؤال الله الْعَافِيَة( )، وَقد ورد( ) فِي ذَلِك أحَادِيث متواترة، كَمَا بَيناهُ فِي شرحنا لـ «عدة الْحصن الْحصين».
الأدعية عقب الوضوء والصلاة:
وَمِمَّا يَنْبَغِي لطَالب الْخَيْر ملازمة: الْأدْعِيَة الْوَارِدَة عقب الْوضُوء، وعقب الصَّلَوَات، وَهِي كَثِيرَة.
وَأقل الْأحْوَال أن يقْتَصر عقب الْوضُوء على مَا أخرجه مُسلم، وَأهل السّنَن، من حَدِيث عمر بن الْخطاب، عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «مَا مِنْكُم من أحد يتَوَضَّأ، ثمَّ يَقُول: أشهد أن لَا إلَه إلَّا الله، وَحده لَا شريك لَهُ، وَأشْهد أن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، إلَّا فتحت لَهُ أبْوَاب الْجنَّة الثَّمَانِية، يدْخل من أيهَا شَاءَ»( ).
وعقب الصَّلَاة؛ على مَا أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَغَيرهمَا، من حَدِيث الْمُغيرَة، أنه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم كَانَ يَقُول فِي دبر كل صَلَاة: «لَا إلَه إلَّا الله، وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد، وَهُوَ على كل شَيْء قدير، اللَّهُمَّ لَا مَانع لما أعْطَيْت، وَلَا معطي لما منعت، وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد»( )، ثَلَاث مَرَّات.
وعَلى مَا أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا: أن يكبر الله ويسبحه وَيَحْمَدهُ، حَتَّى يحصل من الْجَمِيع ثَلَاث وَثَلَاثُونَ( ). أو من كل وَاحِدَة من هَذِه الْكَلِمَات إحْدَى عشرَة، كَمَا فِي «صَحِيح مُسلم»( ). أو من كل [وَاحِدَة]( ) مِنْهَا عشر عشر، كَمَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ.
الأدعية عند الأذَان والإقامة ودخول المسجد:
وَيَقُول عِنْد الأذان كَمَا يَقُول الْمُؤَذّن، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي سعيد( ). وَبعد أن يَقُول الْمُؤَذّن: «حَيّ على الصَّلَاة»، «لَا حول وَلَا قُوَّة إلَّا بِاللَّه»، وَبعد أن يَقُول «حَيّ على الْفَلاح»، «لَا حول وَلَا قُوَّة إلَّا بِاللَّه»( )، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عمر بن الْخطاب.
وَيَقُول عِنْد سَماع النداء: «اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة، وَالصَّلَاة الْقَائِمَة، آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة والفضيلة، وابعثه مقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وعدته( )»( )، أخرجه البُخَارِيّ، من حَدِيث جَابر.
وَإذا دخل الْمَسْجِد يَقُول: «اللَّهُمَّ افْتَحْ لي أبْوَاب رحمتك»، وَإذا خرج مِنْهُ يَقُول: «اللَّهُمَّ إنِّي أسألك من فضلك»( )، كَمَا أخرجه مُسلم، وَأبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، من حَدِيث أبي حميد أو أبي أسيد.
الأدعية داخل الصلاة:
وأما الْأدْعِيَة دَاخل الصَّلَاة، فَهِيَ كَثِيرَة جدًّا، فِي كل ركن من أرْكَانهَا، فَيَأْتِي مِنْهَا بِمَا هُوَ صَحِيح عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم. وَله أن يَدْعُو بِمَا أحب، كَمَا فِي حَدِيث: «فليتخير( ) من الدُّعَاء أعجبه إلَيْهِ»( )، وَهُوَ وَإن كَانَ واردًا فِي التَّشَهُّد، فَلَا فرق بَينه وَبَين سَائِر أرْكَان الصَّلَاة( ).
الأدعية في الصيام والحج والجهاد والسفر وغيرها:
وَهَكَذَا ورد فِي الصّيام، وَالْحج، وَالْجهَاد، وَالسّفر، وَغَيرهَا، أدعية مروية فِي كتب الحَدِيث، يتَخَيَّر مِنْهَا أصَحهَا وأكثرها فَائِدَة، فَلَا نطول بذكرها، فَهِيَ مَعْرُوفَة فِي مواطنها. ولنرجع إلَى شرح الحَدِيث الَّذِي نَحن بصدد شَرحه.
الإيمان وقرب العبد من ربه:
قَالَ أبُو الْقَاسِم الْقشيرِي: قرب العَبْد من ربه يَقع أولًا بإيمانه، ثمَّ بإحسانه، وَقرب الرب تَعَالَى من عَبده بِمَا يَخُصُّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا من عرفانه، وَفِي الْآخِرَة من رضوانه ، وَفِيمَا بَين ذَلِك من وُجُوه لطفه وامتنانه.
وَلَا يتم قرب العَبْد من الْحق إلَّا ببعده( ) من الْخلق، قَالَ: وَقرب الرب بِالْعلمِ وَالْقُدْرَة عَام للنَّاس، وباللطف والنصرة خَاص بالخواص، وبالتأنيس خَاص بالأولياء. انْتهى مَا نَقله عَنهُ صَاحب الْفَتْح( ).
وَأقُول: يُشِير بقوله «قرب العَبْد من ربه يَقع أولًا بإيمانه، ثمَّ بإحسانه»، إلَى الحَدِيث الثَّابِت فِي الصَّحِيح، أنه سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم عَن الْإيمَان، فَقَالَ: «أن تؤمن بِاللَّه وَمَلَائِكَته وَكتبه وَرُسُله وَالْقدر خَيره وشره»، وَأنه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم سُئِلَ عَن الْإحْسَان، فَقَالَ: «أن تعبد الله كَأنَّك ترَاهُ، فَإن لم تكن ترَاهُ فَإنَّهُ يراك»( ).
فخصال الْإيمَان يَسْتَوِي فِي الْأرْبَع الأولى مِنْهَا غَالب الْمُسلمين. وَأما الْخَامِسَة( ) - وَهِي الْإيمَان بِالْقدرِ خَيره وشره - فَهِيَ الْخصْلَة الْعُظْمَى، الَّتِي( ) تَتَفَاوَت فِيهَا الْأقْدَام بِكَثِير من الدَّرَجَات، فَمن رسخ قدمه فِي هَذِه الْخصْلَة، ارْتَفَعت طبقته فِي الْإيمَان.
وَلَا يَسْتَطِيع الْإيمَان بهَا كَمَا يَنْبَغِي إلَّا خُلَّص الْمُؤمنِينَ، وأفراد عباد الله الصَّالِحين؛ لِأن من لَازم ذَلِك، أن يضيف إلَى قدر الله كل مَا يَنَالهُ من خير وَشر، غير متعرض للأسباب الَّتِي يتَعَلَّق بهَا كثير من النَّاس.
وَإذا مكنه الله من الْإيمَان بِهَذِهِ الْخصْلَة كَمَا يَنْبَغِي، وَعلم أنَّهَا من عِنْد الله سُبْحَانَهُ، بِقَدرِهِ السَّابِق لكل عبد من عباده، هَانَتْ عَلَيْهِ المصائب؛ لعلمه بِأن ذَلِك من عِنْد الله سُبْحَانَهُ، وَمَا كَانَ من عِنْد الله سُبْحَانَهُ، فالرضا بِهِ، وَالتَّسْلِيم لَهُ، شَأْن كل عَاقل؛ لِأنَّهُ خالقه وموجده من الْعَدَم، فَهُوَ حَقه وَملكه، يتَصَرَّف بِهِ كَيفَ يَشَاء، كَمَا يتَصَرَّف الْعباد فِي أملاكهم، من غير حرج عَلَيْهِم.
فَإن مَالك العَبْد أو الْأمة إذا أرَادَ أن يتَصَرَّف بهما، ويخرجهما عَن( ) ملكه، لم تنكر الْعُقُول ذَلِك، وَلَا تأباه الْعَادَات الْجَارِيَة بَين الْعباد. فَكيف تصرف الرب بمخلوقه( )، فَإنَّهُ الْمَالِك للْعَبد وسيده، وَلما فِي الْأرْضين وَالسَّمَوَات من الْعَالم، الَّذِي خلقه، وشق سَمعه وبصره، ورزقه، وَمنَّ عَلَيْهِ بِالنعَم الَّتِي لَا يقدر على شَيْء مِنْهَا إلَّا هُوَ، تعالت قدرته، وتقدس اسْمه.
الإيمان بالقدر:
وَمن فَوَائِد رسوخ الْإيمَان بِهَذِهِ الْخصْلَة، أنه يعلم أنه مَا وصل إلَيْهِ من الخير على أي صفة كَانَ، وبيد من اتّفق، فَهُوَ مِنْهُ تعالى ، فَيحصل لَهُ بذلك من الحبور وَالسُّرُور مَا لا يقادر قدره؛ لما لَهُ سُبْحَانَهُ من العظمة، الَّتِي تضيق أذهان الْعباد عَن تصورها، وتقصر عُقُولهمْ عَن إدْرَاك أدنى منازلها.
وَإذا كَانَ للعطية من ملك من مُلُوك الدُّنْيَا، مَا يتأثر لَهُ الْمُعْطَى، ويفرح بِهِ، وَيسر لأجله؛ لكَونه من أعظم بني آدم، لجعل الله سُبْحَانَهُ بِيَدِهِ الْحل وَالْعقد فِي طَائِفَة من عباده، فَكيف الْعَطاء الْوَاصِل من خَالق الْمُلُوك، ورازقهم، ومحييهم، ومميتهم.
وَمَا أحسن مَا قَالَه الْحَرْبِيّ( ) $: من لم يُؤمن بِالْقدرِ، لم يتهنَّ بعيشه( ).
وَهَذَا صَحِيح، فَمَا تعاظمت الْقُلُوب المصائب، وَضَاقَتْ بهَا الْأنْفس، وحرجت بالصُّدُور( )، إلَّا من ضعف الْإيمَان بِالْقدرِ. [أ:79] اللَّهُمَّ ارحمنا بِرَحْمَتك، فَإنَّا من الضعْف مَا أنْت أعلم بِهِ، وَمن عدم الصَّبْر على حوادث الزَّمَان مَا لا يخفى عَلَيْك، وَمن عدم الثَّبَات عِنْد المحن مَا لديك حَقِيقَته.
ولكنا نَسْألك الْعَافِيَة الَّتِي أرشدتنا إلَى سؤالها مِنْك، وَقد أرشدنا رَسُولك صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم إلَى أن نستعيذ بك من سوء الْقَضَاء، كَمَا ثَبت [لنا]( )، عَنهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، أنه كَانَ يَقُول: «اللَّهُمَّ إنِّي أعوذ بك من سوء الْقَضَاء، ودرك الشَّقَاء، وَجهد الْبلَاء( )، وشماتة الْأعْدَاء»( ). فَنَقُول: اللَّهُمَّ إنَّا نَعُوذ بك مِمَّا استعاذ مِنْهُ( ) رَسُولك صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فَإنَّهُ قد سَنِّ ذَلِك لأمته.
إذا عرفت هَذَا؛ فَاعْلَم أنه لَا مُنَافَاة بَين الْإيمَان بِالْقدرِ - خَيره وشره - وَبَين الِاسْتِعَاذَة من سوء الْقَضَاء.
فعلى العَبْد أن يجْهد نَفسه فِي الْإيمَان بِهَذِهِ الْخصْلَة، ويمرنها عَلَيْهَا، فَإنَّهَا إذا مُرِّنَت مَرَنَت. اللَّهُمَّ أعنا على هَذِه النُّفُوس، وَسَهل لنا الْخَيْر حَيْثُ كَانَ، وقو إيمَاننَا، فَإن الْخَيْر كل الْخَيْر فِي قُوَّة الْإيمَان، وَبِه تَتَفَاوَت الْمَرَاتِب.
وَمِمَّا يدل على جَوَاز الِاسْتِعَاذَة من سوء الْقَضَاء، مَا ثَبت من حَدِيث الْحسن السبط رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ، أنه علمه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم ذَلِك الدُّعَاء، بقوله فِي الْوتر، وفِيهِ( ): «وقني شَرّ مَا قضيت»( )، وَهُوَ حَدِيث صَحِيح، وَإن لم يكن فِي الصحيحين.
الإيمان والإحسان :
وَتَأمل بَيَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم لِمَعْنى الْإحْسَان، فَإنَّهُ يدل على أنه رُتْبَة عَلِيَّةٌ؛ لِأن من عَبَدَ اللهَ كَأنَّهُ يرَاهُ، قد بلغ إلَى أعلَى منَازِل الْخُشُوع، الَّذِي هُوَ روح الصَّلَاة، وَبِه يتَفَاوَت أجرهَا، كَمَا ثَبت فِي حَدِيث: «إن الرجل يُصَلِّي فَيكون لَهُ نصفهَا، ثلثهَا، ربعهَا»( ) الحَدِيث. فَإن ذَلِك التَّفَاوُت إنَّمَا هُوَ من جِهَة الْخُشُوع، وَحُضُور الْقلب، وَقطع النّظر عَمَّا سوى الله ۵.
فَهَذَا الَّذِي وصل إلَى هَذِه الرُّتْبَة، لَا يبلغهَا إلَّا بعد أن تحصل لَهُ خِصَال الْإيمَان على الْكَمَال بعد خِصَال الْإسْلَام( )، ثمَّ تحصل لَهُ هَذِه المزية الْعُظْمَى، وَلَا يكون ذَلِك إلَّا لأولياء الله تعالى، الراسخين فِي الْولَايَة، الْبَالِغين إلَى غَايَة مراتبها، وَلِهَذَا آذن( ) الله سُبْحَانَهُ من عاداهم بِالْحَرْبِ.
وَفِيه إشَارَة إلَى تفاوت مَرَاتِب الطَّاعَات بتفاوت الْأشْخَاص، وَأنه قد يَقع التَّفَاوُت بَين الرجلَيْن كَمَا بَين السَّمَاء وَالْأرْض، فكم بَين رجل يعبد الله وَهُوَ يفكر فِي أمر آخر، ويشتغل بِأمُور الدُّنْيَا، لَا يحصل لَهُ شَيْء من خشوع، وَلَا نصيب من حُضُور قلب، وَلَا طرف من المراقبة، وَبَين هَذَا الَّذِي رزقه الله سُبْحَانَهُ الْإحْسَان، وَشرح صَدره لعبادة الرَّحْمَن.
وَفِيه منزع قوي لما عَلَيْهِ أوْلِيَاء الله من تِلْكَ المزايا، الَّتِي لَا يشاركهم فِيهَا غَيرهم، وَلَا يلْحق( ) بهم فِيهَا سواهُم. وَمن أنكر مَا تفضل الله [تعالى]( ) بِهِ عَلَيْهِم من فَضله الَّذِي عَم، وَكَرمه الَّذِي جم، فَذَلِك لقصوره فِي علم الشَّرِيعَة المطهرة، مَعَ جَحده لما لَا يدْرِي، وإنكاره لما لَا يعرف. اللَّهُمَّ غفرًا.
الدعاء من أعظم القرب إلي الله :
وَأما قَول أبي الْقَاسِم الْقشيرِي فِي كَلَامه السَّابِق: «إن قرب الرب تَعَالَى من عَبده، بِمَا يَخُصُّهُ فِي الدُّنْيَا من عرفانه، وَفِي الْآخِرَة من رضوانه». فَأقُول: أعظم أنْوَاع قرب العَبْد من الرب مَا صرح بِهِ فِي الْكتاب الْعَزِيز بقوله سُبْحَانَهُ [وتعالى]( ): ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [البقرة: 186].
فقد جعل سُبْحَانَهُ عنوان هَذَا، الْقرب الَّذِي أخبرنَا بِهِ، مُفَسرًا لَهُ، ومبينًا لمعناه، أنه يجيب دَعْوَة من دَعَاهُ( ) من عباده، وَأكْرم بهَا خصْلَة، وَأعظم بهَا فَائِدَة، لَا يقادر قدرهَا [أ:80]، وَلَا تستطاع الْإحَاطَة بِمَا فِيهَا، من ارْتِفَاع طبقَة من يُجيب دَعَاهُ، ويلبي نداه. فشكرًا لَك يَا رَبنَا وحمدًا، لَا نحصي ثَنَاء عَلَيْك، أنْت كَمَا أثنيت على نَفسك.
الولاية ونفع الناس :
وَأما قَوْله: «وَلَا يتم قرب العَبْد من الْحق، إلَّا ببعده من الْخلق»، فَهَذَا إنَّمَا يكون فِيمَن لَا نفع فِيهِ للعباد. أما من كَانَ يَنْفَعهُمْ بِعِلْمِهِ، أو بموعظته، أو بجهاده، أو بإنكار الْمُنْكَرَات، أو بِالْقيامِ فيهم بِمَا أوجب الله [تعالى]( ) على مثله الْقيام بِهِ، فَهَذَا يكون قربه من الْخلق أقرب إلَى الْحق. وَهُوَ مقَام الْأنْبِيَاء، ومقام الْعلمَاء، الَّذين أخذ الله [تعالى]( ) عَلَيْهِم الْبَيَان للنَّاس.
فَلَيْسَتْ هَذِه الْقَضِيَّة - الَّتِي ذكرهَا أبُو الْقَاسِم - كُلية، كَمَا لَا يخفى على من يعرف شرائع الله سُبْحَانَهُ، وَمَا ندب عباده إلَيْهِ فِي كتبه الْمنزلَة، وعَلى ألسن رسله الْمُرْسلَة. وَقد جَاءَ فِي السّنة؛ أن الْمُؤمن الَّذِي يخالط النَّاس ويصبر على أذاهم، أحب إلَى الله [تعالى]( ) من الْمُؤمن الَّذِي لَا يخالطهم.
وَيُمكن حمل كَلَامه على الْبعد عَن الْخلق، بإقبال قلبه على الله سُبْحَانَهُ، وَعدم الِاعْتِدَاد بِمَا سواهُ، وَأنه وَإن خالطهم بظاهره( )، فَهُوَ مَعَ الله [تعالى]( ) بباطنه. وَهَذَا معنى حسن ،ورتبة عليَّة( ).
وَأما قَوْله: «وباللطف والنصرة خَاص بالخواص»، فَأقُول: قد أخبرنَا الله سُبْحَانَهُ فِي كِتَابه أنه لطيف بعباده، وَهَذَا الْمَعْنى عَام لكل من يصدق عَلَيْهِ أنه عبد لله، من غير فرق بَين عوامهم وخواصهم.
وَلَوْلَا مَا تفضل بِهِ على عباده، من جري ألطافه عَلَيْهِم، لم يهتدوا إلَى معاش، وَلَا معاد، وَلَا عمل دنيا، وَلَا عمل آخِرَة.
وَأما النُّصْرَة؛ فقد وعد سُبْحَانَهُ فِي كِتَابه بنصرة الْمُؤمنِينَ: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [الروم: 47]، وينصر حزبه، والمجاهدين فِي سَبيله.
فَمن كَانَ من الْمُؤمنِينَ أو من الْمُجَاهدين فِي سَبِيل الله، وَإن كَانَ فِي عمله تَخْلِيط، وَفِي طَاعَاته( ) قُصُور، فَهُوَ مِمَّن وعد الله سُبْحَانَهُ بنصرته.
حَتَّى أحببته:
قَوْله: «حَتَّى أحببته»، فِي رِوَايَة الْكشميهني( ): «حَتَّى أحبه». قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح»( ): ظَاهره؛ أن محبَّة الله تَعَالَى للْعَبد تقع بملازمة العَبْد التَّقَرُّب بالنوافل، وَقد اسْتشْكل بِمَا تقدم أولًا؛ أن الْفَرَائِض أحب الْعِبَادَات المتقرب بهَا إلَى الله تَعَالَى، فَكيف لَا تنْتج الْمحبَّة؟.
وَالْجَوَاب: أن المُرَاد من النَّوَافِل، مَا كَانَت حاوية للفرائض، مُشْتَمِلَة عَلَيْهَا، ومكملة لَهَا، وَيُؤَيِّدهُ أن فِي رِوَايَة أبي أمَامَة: «ابْن آدم، إنَّك لن تدْرك مَا عِنْدِي إلَّا بأدَاء مَا افترضت عَلَيْك». انْتهى.
وَأقُول: هَذَا الْإشْكَال مندفع( ) من أصله، فَإن العَبْد لما كَانَ مُعْتَقدًا لوُجُوب الْفَرَائِض عَلَيْهِ، وَأنه أمر حتم يُعَاقب على تَركهَا( )، كَانَ ذَلِك بِمُجَرَّدِهِ حَامِلًا لَهُ على الْمُحَافظَة عَلَيْهَا، وَالْقِيَام بهَا، فَهُوَ يَأْتِي بهَا بِالْإيجَابِ الشَّرْعِيّ والعزيمة الدِّينِيَّة.
وَأما النَّوَافِل: فَهُوَ يعلم أنه لَا عِقَاب عَلَيْهِ فِي تَركهَا، فَإذا فعلهَا، فَذَلِك لمُجَرّد التَّقَرُّب إلَى الرب، خَالِيًا عن حتم، عاطلًا عَن حزم، فَكَانَ فِي فعلهَا من هَذِه الْحَيْثِيَّة مَحْض الْمحبَّة للتقرب إلَى الله [تعالى]( ) بِمَا يحب من الْعَمَل، فجوزي على ذَلِك بمحبة الله [تعالى]( ) لَهُ، وَإن كَانَ أجر الْفَرْض أكثر، فَلَا يُنَافِي أن تكون المجازاة بِمَا كَانَ الْحَامِل عَلَيْهِ هُوَ محبَّة التَّقَرُّب إلَى الله، أن يحب الله فَاعله؛ لِأنَّهُ فعل مَا لم يُوجِبهُ الله عَلَيْهِ، وَلَا عزم عَلَيْهِ بِأن يَفْعَله. [أ:81].
وَمِثَال هَذَا فِي الْأحْوَال الْمُشَاهدَة فِي بني آدم، أن السَّيِّد إذا أمر عَبده بِأن يقْضِي لَهُ فِي كل يَوْم حَاجَة أو حوائج، وَكَذَلِكَ أمر من لَهُ من المماليك بِمثل ذَلِك، فَكَانَ أحدهم يقْضِي لَهُ تِلْكَ الحاجة أو الْحَوَائِج، ثمَّ يقْضِي لَهُ حوائج أخر، يعلم أن سَيّده يحب قضاءها، وتحسن لَدَيْهِ، وَالْآخرُونَ لَا يقضون لَهُ إلَّا تِلْكَ الْحَوَائِج الَّتِي أمرهم السَّيِّد بهَا. فمعلوم أن ذَلِك العَبْد الَّذِي صَار يَأْتِي لَهُ كل يَوْم بِمَا أمره بِهِ، وَبِغَيْرِهِ مِمَّا يُحِبهُ، يسْتَحق الْمحبَّة من السَّيِّد محبَّة زَائِدَة، على محبته( ) لكل وَاحِد مِنْهُم. فَالْمُرَاد من الحَدِيث هَذِه الْمحبَّة الزَّائِدَة، الْحَاصِلَة من فعله لما يُحِبهُ سَيّده من غير أمر مِنْهُ لَهُ، مَعَ قِيَامه بِمَا قَامَ بِهِ غَيره؛ من امْتِثَال أمر السَّيِّد، والتبرع بِالزِّيَادَةِ الَّتِي لم يَأْمُرهُ بهَا( ).
وَقَالَ الْفَاكِهَانِيّ: معنى الحَدِيث؛ أنه إذا أتَى بالفرائض، ودام على إتْيَان النَّوَافِل؛ من صَلَاة، وَصِيَام، وَغَيرهمَا، أفْضى بِهِ ذَلِك إلَى محبَّة الله تَعَالَى. انْتهى.
أقُول: المُرَاد فِي الحَدِيث، الْمحبَّة الْحَاصِلَة من النَّوَافِل خَاصَّة، لَا من مَجْمُوع الْفَرَائِض والنوافل. وَكَون فَاعل الْفَرَائِض محبوبًا، لَا يُنَافِي هَذِه الْمحبَّة الْخَاصَّة.
من جاء بالنوافل وترك الفرائض :
فَالْحَاصِل؛ أن الِاخْتِلَاف بَين المحبتين ظَاهر وَاضح؛ لاخْتِلَاف الْأسْبَاب، وَإن كَانَ سَبَبِيَّة أحد السببين مَشْرُوطَة بِفعل السَّبَب الآخر، فَإن من ترك الْفَرَائِض وَجَاء بالنوافل:
كتاركة بيضها بالفلا
وملبسة بيض أخْرَى جنَاحا( )
وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة: يُؤْخَذ من قَوْله «مَا تقرب...» إلَى آخِره، أن النَّافِلَة لَا تقدم على الْفَرِيضَة؛ لِأن النَّافِلَة إنَّمَا سميت نَافِلَة؛ لأنها تَأتي زَائِدَة على الْفَرِيضَة. فمن( ) لم يُؤَدِّ الْفَرِيضَة، لَا يحصل النَّافِلَة، وَمن أدّى الْفَرْض، ثمَّ زَاد عَلَيْهِ النَّفْل، وأدام [على]( ) ذلك، تحققت مِنْهُ إرَادَة التَّقَرُّب. انْتهى.
وَأقُول: أما قَوْله: إنه يُؤْخَذ من قَوْله «مَا تقرب...» إلَى آخِره، أن النَّافِلَة لَا تقدم على الْفَرِيضَة، فَلَيْسَ فِي مثل هَذَا خلاف؛ لِأن الْأمر بالفرائض حتم، فالإتيان بِمَا( ) هُوَ حتم، مقدم لَا يُنَازع فِي ذَلِك أحد، وَلَا يحْتَاج مثله إلَى التَّحْرِير وَالذكر. وَقد صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «إذا أقِيمَت الصَّلَاة، فَلَا صَلَاة إلَّا الْمَكْتُوبَة»( ).
ليست المداومة شرطًا في القرب:
وَأما قَوْله: وأدام [على]( ) ذَلِك، فَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيث مَا يدل على الإدامة( )، بل المُرَاد مُجَرّد وجود التَّقَرُّب بالنوافل وقتًا فوقتًا، وَتارَة فَتَارَة، فَإن من فعل هَكَذَا يصدق عَلَيْهِ أنه متقرب بالنوافل، وَإن لم يحافظ على ذَلِك، حَتَّى يصدق الدَّوَام على ذَلِك الَّذِي تقرب بِهِ، وَيصدق عَلَيْهِ أنه مديم للتقرب.
قَالَ ابْن حجر - بعد نَقله لكَلَام ابْن هُبَيْرَة الْمُتَقَدّم -: وَأيْضًا قد جرت الْعَادة، أن التَّقَرُّب يكون غَالِبًا بِغَيْر مَا وَجب على المتقرب؛ كالهدية، والتحفة، بِخِلَاف من يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ من خراج، أو يقْضِي مَا عَلَيْهِ من دين. انْتهى.
وَأقُول: لَا حَاجَة إلَى اسْتِخْرَاج هَذَا الْمَعْنى الْعرفِيّ للتقرب، فَإنَّهُ لَا يُفِيد شَيْئًا، مَعَ الْعلم بِأن معنى التَّقَرُّب فِي لِسَان الْعَرَب، وَفِي لِسَان الشَّرْع، يَشْمَل كل مَا يتَقرَّب بِهِ العَبْد من فَرِيضَة أو نَافِلَة، وَصدقه على الْفَرَائِض أقدم لكَون أمرهَا ألزم. وَأيْضًا؛ قد أغْنى عَن هَذَا الاستخراج لفظ النَّوَافِل، فَإنَّهَا فِي لِسَان الشَّرْع مَا زَاد على الْفَرَائِض( ).
قَالَ ابْن حجر: وَأيْضًا؛ فَإن من جملَة مَا شرعت لَهُ النَّوَافِل، جبر الْفَرَائِض، كَمَا صَحَّ فِي الحَدِيث الَّذِي أخرجه مُسلم «انْظُرُوا هَل لعبدي من تطوع، فتكمل بِهِ فريضته» الحَدِيث بِمَعْنَاهُ.
فَتبين أن المُرَاد من التَّقَرُّب بالنوافل، أن تقع مِمَّن أدّى الْفَرَائِض، لَا مِمَّن أخل بهَا، كَمَا قَالَ بعض الأكابر: من شغله الْفَرْض عَن النَّفْل، فَهُوَ مَعْذُور، وَمن شغله النَّفْل عَن الْفَرْض، فَهُوَ مغرور. انْتهى.
أقُول: لَا يخفى عَلَيْك، أن أصل الْإشْكَال عِنْد هَؤُلَاءِ الَّذين تكلمُوا [بِمثل]( ) هَذَا الْكَلَام، هُوَ وُرُود الْمحبَّة فِي جَانب التَّقَرُّب بالنوافل، وَقد بَينا وَجهه، وَأي مدْخل لذكر أن النَّوَافِل تجبر بهَا الْفَرَائِض، فَإن هَذَا إنَّمَا هُوَ إذا احْتِيجَ إلَى التَّرْجِيح بَين الْفَرَائِض والنوافل، فَإن الْفَرَائِض هِيَ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم «وَمَا تقرب إلَيّ عَبدِي( ) بِشَيْء أحب إلَيّ مِمَّا افترضت عَلَيْهِ»، فَإن هَذَا قد دلّ دلَالَة أوضح من شمس النَّهَار، أن التَّقَرُّب بالفرائض أحب إلَى الله [تعالى]( ) من كل شَيْء.
والنوافل لَيست بِهَذِهِ الْمنزلَة، فَإنَّهَا من جملَة مَا دخل تَحت النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي، لَكِن الرب [سبحانه]( ) جعل فعلهَا سَببًا لحبه لفاعلها من حَيْثُ أنه جَاءَ بِزِيَادَة على مَا أمره بِهِ، محبَّة للتقرب إلَى الله [تعالى]( ) بِمَا لم يُؤمر بِهِ. فَاسْتحقَّ محبَّة الله لَهُ، مَعَ كَون تأدية الْفَرَائِض أحب إلَى الله. لَكِن صَاحب هَذِه النَّافِلَة مَحْبُوب لَهُ لتِلْك النكتة الَّتِي قدمنَا ذكرهَا، والفرائض أحب مَا تقرب بِهِ إلَى الله [تعالى]( ).
ثمَّ لَا خلاف أن نوافل من هُوَ تَارِك للفرائض، لَيست بِمَنْزِلَة نَافِلَة من هُوَ مُقيم للفرائض، والمتنفل الَّذِي يُحِبهُ الله، هُوَ الَّذِي جَاءَ بِفَرِيضَتِهِ، ثمَّ تنفل مَا كتبه الله لَهُ. وَلِهَذَا سميت نَافِلَة؛ أي: زَائِدَة على مَا افترضه الله [تعالى]( ) على العَبْد.
فَمَا لنا وللتعرض للمفاضلة بَين الْفَرِيضَة والنافلة، فَإن هَذَا كَلَام خَارج عَن مَقْصُود الحَدِيث الْقُدسِي. وَكَيف يعتضد بِمَا نَقله عَن بعض الأكابر على هَذَا الْأمر الَّذِي هُوَ من الشَّرِيعَة بِمَنْزِلَة أوضح من شمس النَّهَار؟!.
محبة الله مشتملة على التقرب بالفرض والتقرب بالنفل:
وإيضاح الْمقَام بِأن يُقَال: إن التَّرْجِيح فرع التَّعَارُض، وَلَا تعَارض هُنَا ألْبَتَّة؛ لِأن كَون الْفَرَائِض أحب الْقرب إلَى الله [تعالى]( ) لَا يُنَافِي كَون المتقرب( ) بالنوافل يُحِبهُ الله، وَإنَّمَا يكون التَّعَارُض( ) فِي هَذَا الْمقَام لَو قَالَ: من جَاءَ بالفرائض، فَهُوَ أحب إلَى الله من كل أحد، وَمن تقرب بالنوافل فَهُوَ أحب إلَى الله من كل أحد؟.
وَأما مُجَرّد كَونه يحب أحدهمَا، فَإنَّهُ لَا يُنَافِي أن يحب الآخر، ثمَّ لَا تنافي بَين مَا ترَتّب عَلَيْهِمَا ، فَإن الَّذِي ترَتّب على التَّقَرُّب بتأدية الْفَرَائِض، هُوَ كَون هَذَا التَّقَرُّب أحب إلَى الله [تعالى]( ) من كل شَيْء من أعمال الْخَيْر، وَالَّذِي ترَتّب على التَّقَرُّب بالنوافل، هُوَ أن الله يحب فاعلها، وَكَونه يحب فاعلها، لَا يُنَافِي كَونه يحب غَيره.
وَكَون تأدية الْفَرَائِض أحب من غَيرهَا، لَا يُنَافِي أن تكون تأدية النَّوَافِل محبوبة، بل هُوَ الْمَعْنى الَّذِي يفِيدهُ أفعل التَّفْضِيل، فَإنَّهُ يدل على الِاشْتِرَاك فِي الأصْل، فالفرائض والنوافل محبوبة إلَى الله، وَلَكِن الْفَرَائِض أحب إلَيْهِ.
وَصَاحب النَّافِلَة يُحِبهُ الله، وَلَا يُنَافِيهِ أن يحب صَاحب الْفَرِيضَة، لَكِن صَاحب النَّافِلَة لما جَاءَ بِمَا جَاءَ بِهِ صَاحب الْفَرِيضَة، وَزَاد عَلَيْهِ بِمَا فعله من النَّافِلَة، ترَتّب على محبته مَا تضمنه الحَدِيث؛ من كَونه سُبْحَانَهُ سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ... إلَى آخر مَا فِي الحَدِيث.
وَمَعْلُوم أن صَاحب العملين أجره أكثر من صَاحب الْعَمَل، فاعرف هَذَا وَاشْدُدْ يدك( ) عَلَيْهِ، فَإنَّهُ قد وَقع من شرَّاح الحَدِيث فِي هَذَا الموطن خبط كثير.
* قَوْله: «فَإذا أحببته، كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ، وبصره الَّذِي يبصر بِهِ، وَيَده الذي( ) يبطش بهَا، وَرجله الَّذِي( ) يمشي بهَا». فِي حَدِيث عَائِشَة، فِي رِوَايَة عبدالْوَاحِد: «عينه الَّتِي يبصر بهَا»، وَفِي رِوَايَة يَعْقُوب: «عينيه الَّذِي يبصر بهما» بالتثنية، وَكَذَا قَالَ فِي الْأذن وَالْيَد وَالرجل، وَزَاد عبدالْوَاحِد فِي رِوَايَته: «وفؤاده الَّذِي يعقل بِهِ، وَلسَانه الَّذِي يتَكَلَّم بِهِ»، وَنَحْوه فِي حَدِيث أبي أمَامَة. وَفِي حَدِيث أنس «وَمن أحببته، كنت لَهُ سمعًا، وبصرًا، ويدًا، ومؤيدًا»، وَوَقع فِي رِوَايَة «فَبِي يسمع، وَبِي يبصر، وَبِي يبطش، وَبِي يمشي».
* قَوْله: «وَيَده الَّذِي يبطش بهَا، وَرجله الَّذِي يمشي بهَا»( )، هَكَذَا وَقع فِي الصَّحِيح، فِي بَاب التَّوَاضُع، بِلَفْظ «الَّذِي» فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَلَعَلَّه على تَأْوِيل الْيَد وَالرجل بِالْعَفو؛ لِأنَّهُمَا مؤنثتان، وَكَانَ على مُقْتَضى هَذَا التَّأْوِيل، أن يَقُول: الَّذِي يبطش بِهِ الَّذِي يمشي [بِهِ]( )، وَلكنه أنث وَذكر بالاعتبارين، وَالله أعلم.
* قَوْله: «يبطش»، قَالَ فِي «الصِّحَاح»( ): البطشة السطوة، وَالْأخْذ بالعنف، وَقد بَطش بِهِ يَبطِشُ ويَبْطُشُ بطشًا، وباطَشَهُ مباطشة.
استشكال كيف يكون الله سمع العبد وبصره.:
قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح»: وَقد اسْتشْكل كَيفَ يكون الْبَارِي جلّ وَعلا سمع العَبْد وبصره إلَى آخِره. وَالْجَوَاب من أوجه:
أحدهَا: أنه ورد على سَبِيل التَّمْثِيل، وَالْمعْنَى: كنت كسمعه وبصره فِي إيثاره أمْرِي، فَهُوَ يحب طَاعَتي، ويؤثر خدمتي، كَمَا يحب هَذِه الْجَوَارِح( ). انْتهى الْوَجْه الأول.
وَأقُول: هَذَا مَعَ كَونه إخراجًا للْكَلَام عَن الظَّاهِر الْبَين الْوَاضِح، فَهُوَ مَدْفُوع بالرواية الْمُتَقَدّمَة من رِوَايَات الصَّحِيح، وَهِي قَوْله: «فَبِي يسمع، وَبِي يبصر»( ) إلخ. ومدفوع أيْضًا بالرواية الْمُتَقَدّمَة، وَهِي قَوْله: «كنت لَهُ سمعًا، وبصرًا، ويدًا، ومؤيدًا»، [فَإن ذَلِك التَّأْوِيل لَا يَتَيَسَّر فِي مثل هَذِه الرِّوَايَة، لَا سِيمَا مَعَ قَوْله «ومؤيدًا] ( ).
قَالَ ابْن حجر: وثَانِيها: أن الْمَعْنى: أن كليته مَشْغُولَة بِي، فَلَا يصغي بسمعه إلَّا إلَى مَا يرضيني، وَلَا يرى ببصره إلَّا إلَى مَا أمرته بِهِ( ). انْتهى.
وَأقُول: هو( ) أقرب من الْوَجْه الأول، وَأقل تكلفًا، وَحَاصِله: أن هَذَا الْكَلَام خَارج مخرج التَّوْفِيق للْعَبد إلَى طاعات الله، وتسديده عَن الْوُقُوع فِي شَيْء من مَعَاصيه( ).
قَالَ ابْن حجر: ثَالِثهَا: [أن]( ) الْمَعْنى: أجعَل لَهُ مقاصده كَأنه ينالها بسمعه وبصره( )... إلخ. انْتهى.
وَأقُول: هَذَا الْوَجْه مغسول عَن الْفَائِدَة؛ إذ لَا معنى( ) لنيل مقاصده بسمعه وبصره، وَإن أمكن تَأْوِيله بِمَا كَانَ من الْمَقَاصِد الَّتِي لَا يقْصد بهَا إلَّا السماع لَهَا أو النّظر إلَيْهَا، وَمَا أقل ذَلِك. وَهُوَ إن [أ:84] استقام فِي الْيَد وَالرجل؛ لِأن الْيَد هِيَ آلَة الْأخْذ للشَّيْء، وَالرجل هِيَ آلَة الْمَشْي إلَيْهِ، لَكِن كَانَ يُغني عَن هَذَا كُله، كنت معينًا لَهُ على تَحْصِيل مطالبه، وتقريبها( ) مِنْهُ.
قَالَ: وَرَابِعهَا: كنت لَهُ فِي النُّصْرَة كسمعه، وبصره، وَيَده، وَرجله، على عدوه( ). انْتهى.
وَأقُول: الله أعلَى وَأجل من أن يكون فِي معاونة عَبده الضَّعِيف؛ كهذه الْجَوَارِح الضعيفة، فمعونته أكبر من كل كَبِير، وَأجل من كل جليل، وَإنَّمَا يصلح ذَلِك لَو كَانَ المُرَاد المساعدة والانقياد، فَإنَّهُ يُقَال مثل هَذَا على من كَانَ مساعدًا منقادًا كانقياد هَذِه الْجَوَارِح لصَاحِبهَا. وَمثل ذَلِك لَا يصلح فِي جَانب رب الْعَالم، وخالق الْكل. تَعَالَى وتقدس.
وَأيْضًا؛ لَا يصلح ذَلِك فِي بني آدم، إلَّا إذا كَانَ من قَالَ: فلَان هُوَ كسمعي وبصري عَزِيزًا عَلَيْهِ، وَكَانَ من قَالَ: هُوَ كيدي ورجلي قَاضِيًا حَوَائِجه( )، كَمَا يَفْعَله الْخَادِم الناصح.
قَالَ: خَامِسهَا: قَالَ الْفَاكِهَانِيّ - وَسَبقه إلَى مَعْنَاهُ ابْن هُبَيْرَة -: هُوَ فِيمَا ظهر لي [أنه]( ) على حذف مُضَاف، وَالتَّقْدِير كنت حَافظ سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ، فَلَا يسمع إلَّا مَا يحل سَمعه، وحافظ بَصَره... كذلك إلَى آخِره( ).
وَأقُول: مَا أبرد هَذَا التَّقْدِير، وَأقل جدواه، وعَلى كل حَال، فَهُوَ يؤول إلَى معنى الْوَجْه الثَّانِي.
قَالَ: سادسها: قَالَ الْفَاكِهَانِيّ: تحْتَمل معنى آخر أدق من الَّذِي قبله، وَهُوَ أن يكون معنى سَمعه مسموعه؛ لِأن الْمصدر قد جَاءَ بِمَعْنى الْمَفْعُول، مثل: فلَان أملي؛ أي: مأمولي. وَالْمعْنَى: أنه لَا يسمع إلَّا ذكري، وَلَا يلتذ إلَّا بِتِلَاوَة كتابي، وَلَا يأنس إلَّا بمناجاتي، وَلَا ينظر إلَّا فِي عجائب ملكوتي، وَلَا يمد يَده إلَّا فِيمَا فِيهِ( ) رضائي، وَرجله كَذَلِك، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ ابْن هُبَيْرَة أيْضًا. انْتهى.
وَأقُول: هَذَا الَّذِي زَعمه أدق معنى، هُوَ أبعد مَسَافَة مِمَّا قبله، وَكَون الله ۵ مسموع العَبْد ومبصره، على مَا فِيهِ من عوج، كَيفَ يَصح مثل هَذَا التَّأْوِيل فِي الْيَد وَالرجل، مَعَ أن تِلْكَ الرِّوَايَة الثَّابِتَة( ) فِي الصَّحِيح، وَهِي: «فَبِي يسمع، وَبِي يبصر» إلخ، تدفع هَذَا التَّأْوِيل، وترده على عقبه.
قَالَ الطوفي: اتّفق الْعلمَاء مِمَّن يعْتد بقوله، على أن هَذَا مجَاز وكناية عَنْ نصْرَة العَبْد، وتأييده، وإعانته؛ حَتَّى كَأنَّهُ سُبْحَانَهُ نزل نَفسه من عَبده منزلَة الْآلَات الَّتِي يَسْتَعِين بهَا، وَلِهَذَا وَقع فِي رِوَايَة: «فَبِي يسمع، وَبِي يبصر، [وَبِي]( ) يبطش، وَبِي يمشي».
والاتحادية زَعَمُوا أنه على حَقِيقَته، وَأن الْحق تَعَالَى عين العَبْد، وَاحْتَجُّوا بمجيء جِبْرِيل فِي صُورَة دحْيَة. قَالُوا: فَهُوَ روحاني، خلع صورته، وَظهر بمظهر الْبشر. قَالُوا: وَالله سُبْحَانَهُ أقدر على أن يظْهر فِي صُورَة الْوُجُود الْكُلِّي أو بعضه. تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ علوًا كَبِيرًا. انْتهى.
أقُول: هَذَا الَّذِي ذكره من التَّنْزِيل، لَا يَلِيق بجنابه سُبْحَانَهُ كَمَا قدمنَا، فالْمصير إلَى هَذَا الْمجَاز بِهَذَا الْوَجْه، هو كَمَا قَالَ الشَّاعِر:
فَكنت كالساعي إلَى مثعب
موائلًا من سبل الراعد( )
وَأما مَا حَكَاهُ عَن الاتحادية، فَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا يسْتَحق التَّعَرُّض لرده.
وَقَالَ الْخطابِيّ: هَذَا مِثَال، وَالْمعْنَى: توفيق الله تَعَالَى لعبده فِي الْأعْمَال الَّتِي يُبَاشِرهَا بِهَذِهِ الْأعْضَاء، وتيسر الْمحبَّة لَهُ فِيهَا؛ بِأن يحفظ جوارحه عَلَيْهِ، ويعصمه عَن مواقعة مَا يكرههُ الله تَعَالَى؛ من الإصغاء إلَى اللَّهْو بسمعه، وَمن النّظر إلَى مَا نهى عَنهُ تَعَالَى ببصره، وَمن الْبَطْش فِيمَا لَا يحل لَهُ بِيَدِهِ، وَمن السَّعْي إلَى الْبَاطِل بِرجلِهِ. وَإلَى هَذَا نحا الدَّاودِيّ، وَمثله الكلاباذي، وَعبر بقوله: أحفظه فَلَا يتَصَرَّف إلَّا فِي محابي؛ لِأنَّهُ إذا أحبه، كره لَهُ أن يتَصَرَّف فِيمَا يكرهه مِنْهُ. انْتهى.
وَأقُول: هَذَا يرجع إلَى الْوَجْه الثَّانِي.
قَالَ ابْن حجر: وسابعها: قَالَ الْخطابِيّ أيْضًا: وَقد يكون عبر بذلك عَن سرعَة إجَابَة الدُّعَاء، والنجح فِي الطّلب. وَذَلِكَ أن مساعي الْإنْسَان كلهَا إنَّمَا تكون بِهَذِهِ الْجَوَارِح الْمَذْكُورَة. وَقَالَ بَعضهم: وَهُوَ منتزع مِمَّا تقدم؛ لَا تتحرك لَهُ جارحة إلَّا فِي الله وَللَّه، فَهِيَ كلهَا تعْمل بِالْحَقِّ للحق( ). انْتهى.
وَأقُول: هَذَا الْوَجْه السَّابِع يرجع إلَى الْوَجْه الثَّانِي، كَمَا رَجَعَ إلَيْهِ قَول الْبَعْض. هَذَا؛ وَلَا يخفاك أن جعل «كنت سَمعه» بِمَعْنى: سامع دُعَائِهِ، مجيبه إلَى مَطْلُوبه، فِيهِ من الْبعد مَا لَا يخفى على من يفهم تصاريف الْكَلَام، ووجوه إفاداته.
إذا عرفت مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ هَذِه الْوُجُوه الَّتِي ذكرهَا ابْن حجر فِي «الْفَتْح»، وَعرفت مَا قُلْنَاهُ فِي كل وَجه مِنْهَا( )، فَاعْلَم أن الَّذِي يظْهر لي فِي معنى هَذَا الحَدِيث الْقُدسِي، أنه إمداد الرب سُبْحَانَهُ لهَذِهِ الْأعْضَاء بنوره، الَّذِي تلوح بِهِ طرائق الْهِدَايَة، وتنقشع عِنْده سحب الغواية. وَقد نطق الْقُرْآن الْعَظِيم( ) بِأن الله سُبْحَانَهُ هُوَ نور السَّمَوَات وَالْأرْض، وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم - لما سُئِلَ: هَل رأى ربه؟ قَالَ: «نُورٌ، أنِّى أرَاهُ»( )، وَهُوَ فِي الصَّحِيح.
وَثَبت أنه سُبْحَانَهُ محتجب بالأنوار، وَثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من دُعَائِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم إذا خرج إلَى الصَّلَاة: «اللَّهُمَّ اجْعَل فِي قلبِي نورًا، وَفِي بَصرِي نورًا، وَفِي سَمْعِي نورًا، وَعَن يَمِيني نورًا، وَخَلْفِي نورًا، وَفِي عصبي نورًا، وَفِي لحمي نورًا، وَفِي دمي نورًا، وَفِي شعري نورًا، وَفِي بشري نورًا»، وَزَاد مُسلم: «وَفِي لساني نورًا، وَاجعَل فِي نَفسِي نورًا، وَأعظم لي نورًا»( ).
وَأي مَانع [من]( ) أن يمد الله سُبْحَانَهُ عَبده من نوره، فَيصير صافيًا من كدورات الحيوانية الإنسانية، لاحقًا بالعالم الْعلوِي، سَامِعًا بِنور الله، مبصرًا بِنور الله، باطشًا بِنور الله، مَاشِيًا بِنور الله. وَمَا فِي هَذَا من منع أو من أمر لَا يجوز على الرب سُبْحَانَهُ، وَقد سَألَهُ رَسُوله( ) صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم وَطَلَبه من ربه( ).
وَوصف الله [سبحانه]( ) عباده بقوله: ﴿ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [التحريم: 8]، الآية، وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُخَالف موارد الشَّرِيعَة، وَلَا مَا يُنَافِي إدْرَاك عقول المتشرعين، العارفين بِالْكتاب وَالسّنة. [أ:86].
وَقد جعل الله سُبْحَانَهُ الْخُرُوج من ظلمات الْمعاصِي إلَى أنوار الطَّاعَات خُرُوجًا من الظُّلُمَات إلَى النُّور، وَورد فِي الْكتاب وَالسّنة من هَذَا الْجِنْس الْكثير الطّيب.
فَمَعْنَى الحَدِيث: كنت سَمعه بنوري الَّذِي أقذف فِيهِ، فَيسمع سَمَاعًا لَا كَمَا يسمعهُ أمْثَاله من بني آدم، وَكَذَلِكَ بَقِيَّة الْجَوَارِح.
وَانْظُر فِي هَذَا الدُّعَاء الَّذِي طلبه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم؛ أن يكون نور الله فِي سَمعه، وبصره، وَقَلبه، وعصبه، ولحمه، وَدَمه، وشعره، وبشره، وَلسَانه، وَنَفسه، بل سَألَ رَبَّه أن يمده بنوره خَلفَهَ وأمامه( )، فلولا أن لنُور الله سُبْحَانَهُ قُوَّة لجَمِيع الْأعْضَاء، مَا طلبه سيد ولد آدم وَخير الخليقة.
وَالْحَال؛ أن الله [تعالى]( ) قد جعله نورًا لِعِبَادِهِ، فَكيف لَا يكون ذَلِك مَطْلُوبًا لسَائِر الْعباد؛ لما ينشأ عَنهُ من النَّفْع الْعَظِيم؟
فَمن أمده الله سُبْحَانَهُ بنوره فِي جَمِيع بدنه، صَار لاحقًا بالعالم الْعلوِي، وَمن أمد عضوًا مِنْهُ بنوره، صَار ذَلِك الْعُضْو نورانيًّا.
فَإن كَانَ من الْحَواس، كَانَ لَهَا من الْإدْرَاك مَا لم يكن لغَيْرهَا من الْحَواس الَّتِي لم تمد بِنور الله تعالى. وَإن كَانَ الْإمْدَاد لعضو من الْأعْضَاء غير الْحَواس، صَار ذَلِك الْعُضْو قَوِيًّا فِي عمله الَّذِي يعْمل بِهِ مستنيرًا، إذا عمل بِهِ الْإنْسَان، كَانَ عمله صَالحًا مُوَافقًا لما هُوَ الصَّوَاب.
فاتضح لَك بِهَذَا معنى مَا فِي هَذَا الحَدِيث الْقُدسِي؛ أي: كنت - بِمَا ألقيت على سَمعه، وبصره، وَيَده، وَرجله، من نوري - سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ، وبصره الَّذِي يبصر بِهِ، وَيَده الَّتِي يبطش بهَا، وَرجله الَّتِي يمشي بهَا. ثمَّ أوضح هَذَا الْمَعْنى بقوله: «فَبِي يسمع، وَبِي يبصر، وَبِي يبطش، وَبِي يمشي»( ).
قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح»( ): وَأسْندَ الْبَيْهَقِيّ فِي «الزّهْد»، عَن أبي عُثْمَان [الْحِيرِي]( )، أحد أئِمَّة الطَّرِيق، قَالَ: مَعْنَاهُ: كنت أسْرع إلَى قَضَاء حَوَائِجه، من سَمعه فِي الإسماع، وعينه فِي النّظر، وَيَده فِي اللَّمْس، وَرجله فِي الْمَشْي( ).
وَحمله بعض متأخري الصُّوفِيَّة على مَا يذكرُونَهُ من مقَام الفناء والمحو، وَأنه الْغَايَة الَّتِي لَا شَيْء وَرَاءَهَا. وَهُوَ أن يكون قَائِمًا بِإقَامَة الله تَعَالَى، محبًا لمحبته لَهُ، نَاظرًا بنظره لَهُ، من غير أن تبقى مَعَه بَقِيَّة، تناط باسم، أو تقف على رسم، أو تتَعَلَّق بِأمْر، أو تُوصَف بِوَصْف. وَمعنى هَذَا الْكَلَام؛ أنه شهد إقَامَة الله تَعَالَى لَهُ حَتَّى قَامَ، ومحبته حَتَّى أحبه، وَنظره إلَى عَبده حَتَّى أقبل نَاظرًا إلَيْهِ بِقَلْبِه( ).
وَحمله بعض أهل الزيغ على [أ:87] مَا يَدعُونَهُ؛ من أن العَبْد إذا لَازم الْعِبَادَة الظَّاهِرَة والباطنة، حَتَّى تصفى من الكدورات، أنه يصير فِي معنى الْحق - تَعَالَى عَن ذَلِك علوًا كَبِيرًا - وَأنه يفنى عَن نَفسه جملَة، حَتَّى يشْهد أن الله تَعَالَى هُوَ الذاكر لنَفسِهِ، الموجد لنَفسِهِ، وَأن هَذِه الْأسْبَاب والرسوم تصير عدمًا صرفًا فِي شُهُوده، وأن يعْدم فِي الْخَارِج.
وعَلى الْأوْجه كلهَا، فَلَا تمسك فِيهِ للاتحاد، وَلَا لِلْقَائِلين بالوحدة الْمُطلقَة؛ لقَوْله فِي بَقِيَّة الحَدِيث: «لَئِن سَألَني...، وَلَئِن استعاذني...»، فَإنَّهُ كالتصريح فِي الرَّد عَلَيْهِم. انْتهى( ).
بطلان آراء الاتحادية والصوفية:
وَأقُول: أما مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، عَن أبي عُثْمَان، فَهُوَ كالوجه السَّابِع، الَّذِي حَكَاهُ ابْن حجر عَن الْخطابِيّ( ).
وَمَا ذكره عَن بعض أهل الزيغ، هُوَ مَا ذكره الْخطابِيّ( ) فِي كَلَامه السَّابِق عَن الاتحادية، إلَّا أن هَذَا لَا يكون الِاتِّحَاد [فِيهِ]( ) إلَّا بعد الفناء. وَذَاكَ هُوَ اتِّحَاد مُطلق من الأصْل، فَكَانَا من هَذِه الْحَيْثِيَّة قَولَانِ، وَيكون مَا حَكَاهُ عَن بعض متأخري الصُّوفِيَّة قولًا ثَالِثًا.
فَتكون الْوُجُوه الَّتِي وَجه بهَا قَوْله «كنت سَمعه...» إلى آخره( ) عشرَة، يَنْضَم إلَى ذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ واخترناه، فَتكون الْوُجُوه أحد عشر وَجهًا( ).
وَأما مَا ذكره من الرَّد على مَا حَكَاهُ عَن بعض أهل الزيغ من قَوْله: «لَئِن سَألَني...، وَلَئِن استعاذني...»، فَوجه الرَّد أنه يَقْتَضِي سَائِلًا ومسئولًا، ومستعيذًا ومستعاذًا بِهِ. وَلَعَلَّه رَحمَه الله لم يتَأمَّل هَذَا الحَدِيث كَمَا يَنْبَغِي، فَإنَّهُ لَو تَأمله لم يقْتَصر على مَا ذكره من السُّؤَال والاستعاذة، فَإن الحَدِيث كُله يرد عَلَيْهِم.
فَإن قَوْله: «من عادى لي وليًّا»، يرد عَلَيْهِم؛ لِأنَّهُ يَقْتَضِي وجود معاد، ومعادى، ومعادى لأجله. وَيَقْتَضِي وجود موالي وموالى، وَيَقْتَضِي وجود مُؤذِن ومُؤذَن، ومُحارِب ومُحارَب، ومُتقرِب ومُتقرَب إلَيْهِ، وَعبد ومعبود، ومحِب ومحَب، وَهَكَذَا إلَى آخر الحَدِيث( )، فَهُوَ جَمِيعه يرد على الاتحادية المتمسكين بِهِ من حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
فَإن قلت: لَعَلَّه( ) اقْتصر فِي الِاسْتِدْلَال على الرَّد عَلَيْهِم بذلك الْوَجْه الْمَأْخُوذ من ذَلِك اللَّفْظ؛ لكَونه أوضح مِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ الرَّد عَلَيْهِم فِي سَائِر ألْفَاظ الحَدِيث.
قلت: لَيْسَ ذَلِك الْوَجْه أوضح من غَيره، حَتَّى تكون لتأثيره على مَا عداهُ مزية، بل هِيَ كلهَا مستوية من هَذِه الْحَيْثِيَّة. بل الوضوح أظهر فِي قَوْله: «وَمَا ترددت عَن شَيْء أنا فَاعله، ترددي عَن نفس الْمُؤمن»، فَإنَّهُ يَقْتَضِي وجود مُتَرَدّد ومُتَرَدَّدٍ فِيهِ، وفاعل ومفعول، وَوُجُود نفس مُتَرَدّد فِيهَا، وَهِي نفس العَبْد الْمُؤمن، ومتردد وَهُوَ الْقَابِض( ) لَهَا، وكاره للْمَوْت وَهُوَ الْمُؤمن، وكاره لمساءته وَهُوَ الرب سُبْحَانَهُ.
وَالْحَاصِل؛ أن قَول الاتحادية يقْضِي عقل كل عَاقل بِبُطْلَانِهِ، وَلَا يحْتَاج إلَى نصب الْحجَّة مَعَهم.
وأصل الشُّبْهَة الدَّاخِلَة عَلَيْهِم مَنْ قُول الثنوية( )، فَإنَّهُم جعلُوا إلَهَيْنِ اثْنَيْنِ؛ إلَه الْخَيْر، وإله الشَّرّ. فإله الْخَيْر النُّور، وإله الشَّرّ الظلمَة، وجعلوهما أصل الموجودات كلهَا، فَإذا غلب النُّور صَار العَبْد نورانيًّا، وَإذا غلبت الظلمَة صَار العَبْد ظلمانيًّا. وغفلوا عَن كَون هَذَا الْمَذْهَب الكفري يرد عَلَيْهِم بادئ بَدْء، فَإن الظلمَة غير النُّور، وَالشَّيْء الَّذِي حلّا بِهِ غير هَذَا الْحَال.
نعم؛ قد يَقع الْغَلَط كثيرًا عِنْد إطْلَاق لفظ الْوحدَة مَعَ تعدد مَعَانِيهَا، فَإنَّهُ يُقَال وحدة شُهُود، ووحدة قصود، ووحدة وجود. فَالْأولى: مَعْنَاهَا أنه لَا يشْهد إلَّا الله، وَيقطع النّظر عَمَّا سواهُ( )، وَهَذِه وحدة محمودة. وَالثَّانية: مَعْنَاهَا: لَا يقْصد إلَّا الله، وَيقطع النّظر عَن قصد غَيره، وَهَذِه وحدة محمودة. وَأما الثَّالِثَة: فَهِيَ الَّتِي جَاءَت على خلاف الشَّرْع وَالْعقل( ).
نسْأل الله سُبْحَانَهُ أن يهدينا إلَى مَا يرضيه منا، من طَرِيق لَا يقْدَح فِيهَا شكّ، وَلَا تعترض فِيهَا شُبْهَة، وَلَا يكون للشَّيْطَان علينا سَبِيل.
تقديم السمع على البصر:
وَاعْلَم؛ أنه لم يكن لدي عِنْد تأليف هَذَا الشَّرْح شَيْء من الشُّرُوح إلَّا شرح الْفَتْح لِابْنِ حجر رَحمَه الله [تعالى]( )، وَلم يذكر فِيهِ وَجه تَقْدِيم قَوْله: «كنت سَمعه»، على مَا بعده، مَعَ أن الْآيَات الكونية والعبر الخلقية تتَعَلَّق بحاسة الْبَصَر أكثر من تعلقهَا بحاسة السّمع( ).
وَلَعَلَّ وَجه ذَلِك - وَالله أعلم - أن الْآيَات التنزيلية والعبر القولية، إنَّمَا تدْرك ابْتِدَاء بِالسَّمْعِ، ولا حظَ لِلْبَصَرِ فِيهَا، وَكَذَلِكَ سَائِر مَا شَرعه الله [سبحانه]( ) لِعِبَادِهِ؛ لِأنَّهَا إمَّا أقوال أو حِكَايَة أفعَال، وَهِي لَا تدْرك ابْتِدَاء إلَّا بِالسَّمْعِ، فَكَأن السّمع مُخْتَصًّا بِالْآيَاتِ التنزيلية، والعبر القولية، وَجَمِيع مَا جَاءَت بِهِ الشَّرِيعَة.
وَلَا شكّ أن مَا كَانَ بِهَذِهِ الْمنزلَة، وعَلى هَذِه الصّفة، من مشاعر الْإدْرَاك، أولى من غَيره مِنْهَا، وأحق بالتقديم، مَعَ أنه مشارك لِلْبَصَرِ فِي الْآيَات الكونية والعبر الخارجية بِوَجْه من الْوُجُوه؛ لِأنَّهُ يصف الواصف لمن يسمع وَلَا يبصر مَا يُشَاهِدهُ فِي الْخَارِج، فَيحصل لَهُ من الِاعْتِبَار والتفكر نصيب من ذَلِك، بِخِلَاف المبصر، الَّذِي لَا يسمع، فَإنَّهُ لَا يُمكنهُ إدْرَاك شَيْء من الْآيَات التنزيلية، وَلَا من العبر القولية، وَلَا من الشَّرِيعَة الْمَشْرُوعَة للعباد من الرب سُبْحَانَهُ، وَمن نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وَالله أعلم.
إجابة دعوة العبد:
* قَوْله: «وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني أعذته»، في رواية: «وَإن سَألَني لأعطينه»، بِاللَّامِ وَالنُّون فِي آخِره، وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة: «وَلَئِن استعاذني لأعيذنه»( ) ، وَزَاد فِي رِوَايَة عبدالْوَاحِد لفظ: «عَبدِي» بعد «سَألَني». وَفِي ضبط «استعاذني» وَجْهَان؛ الأول: بالنُّون بعد الذَّال الْمُعْجَمَة، وَالثَّانِي: بِالْبَاء الْمُوَحدَة. َفِي حَدِيث أبي أمَامَة: «وَإذا استنصرني نصرته»، وَفِي حَدِيث أنس: «وَإذا نصحني نصحت لَهُ».
وَفِي الحَدِيث دَلِيل على شُمُول النَّوَافِل للأقوال( ) وَالْأفْعَال، وَقد بَينا - فِيمَا تقدم - بعض مَا يدْخل تَحت لفظ النَّوَافِل، وَهِي كَثِيرَة جدًّا، يضبطها أن يُقَال: هِيَ كل مَا رغب الشَّرْع فِيهِ، أو وعد بالثواب عَلَيْهِ، من غير حتم.
وَظَاهر الصيغتين؛ أعنِي قَوْله: «وَإن سَألَني أعْطيته، وَإن استعاذني أعذته» الْعُمُوم، وَهُوَ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة - الَّتِي ذَكرنَاهَا – أظهر؛ لما فِيهَا من اللَّام الموطئة للقسم، فيجاب لَهُ كل مطلب، ويعاذ من كل مَا استعاذ مِنْهُ( ).
قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح»( ): وَقد اسْتشْكل؛ بِأن جمَاعَة من الْعباد والصلحاء دعوا، وبالغوا، وَلم يجابوا( ).
وَالْجَوَاب: أن الْإجَابَة تتنوع؛ فَتَارَة يَقع الْمَطْلُوب بِعَيْنِه على الْفَوْر، وَتارَة يَقع، وَلَكِن يتَأخَّر؛ لحكمة فِيهِ، وَتارَة قد تقع الْإجَابَة، وَلَكِن بِغَيْر الْمَطْلُوب، حَيْثُ لَا تكون فِي الْمَطْلُوب مصلحَة ناجزة، وَفِي الْوَاقِع مصلحَة ناجزة، أو أصلح مِنْهَا. انْتهى.
وَأقُول: كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أن يرْبط هَذَا التَّقْسِيم( ) بِالدَّلِيلِ، فَإنَّهُ لَا يقبل إلَّا بذلك. وَقد أخرج أحْمد بِإسْنَاد لَا بَأْس بِهِ، وَالْبُخَارِيّ فِي «الْأدَب الْمُفْرد»، وَالْحَاكِم، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «مَا من مُسلم ينصب وَجهه لله فِي مَسْألَة، إلَّا أعطَاهُ الله إيَّاهَا؛ إمَّا أن يعجلها لَهُ، وَإمَّا أن يدخرها [لَهُ] ( )»( ).
وَأخرج أحْمد، وَالْبَزَّار، وَأبُو يعلى، بأسانيد جَيِّدَة، [وَالْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإسْنَاد، من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ]( ): «مَا من مُسلم يَدْعُو بدعوة، لَيْسَ فِيهَا إثْم وَلَا قطيعة رحم، إلَّا أعطَاهُ الله بهَا إحْدَى ثَلَاث؛ إمَّا أن يعجل لَهُ دَعوته، وَإمَّا أن يدخرها لَهُ فِي الْآخِرَة، وَإمَّا أن يصرف عَنهُ من السوء مثلهَا»( ).
فقد تضمن [هذا]( ) الحَدِيث الأول صُورَتَيْنِ؛ إمَّا التَّعْجِيل، وَإمَّا التَّأْجِيل، وتضمن الحَدِيث الثَّانِي ثَلَاث صور؛ الصُّورَتَيْنِ المذكورتين فِي الحَدِيث الأول، والثالثة: أن يصرف عَنهُ من السوء مثلهَا.
وَورد أيْضًا مَا يدل على وُقُوع الْإجَابَة - وَلَا محَالة( ) - كَمَا فِي حَدِيث عَائِشَة، عِنْد الْحَاكِم، وَالْبَزَّار، وَالطَّبَرَانِيّ فِي «الْأوْسَط»، والخطيب، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «لَا حذر من قدر، وَالدُّعَاء ينفع مِمَّا نزل وَمِمَّا لم ينزل، وَإن الْبلَاء لينزل، فيتلقاه الدُّعَاء، فيعتلجان إلَى يَوْم الْقِيَامَة».
قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإسْنَاد. وَتعقبه الذَّهَبِيّ فِي «التَّلْخِيص»؛ بِأن زَكَرِيَّا بن مُوسَى أحد رِجَاله، وَهُوَ مجمع على ضعفه. وَقَالَ الهيثمي فِي «مجمع الزَّوَائِد»: رَوَاهُ أحْمد، وَأبُو يعلى بِنَحْوِهِ، وَالْبَزَّار، وَالطَّبَرَانِيّ فِي «الْأوْسَط»، وَرِجَال أحْمد، وَأبي يعلى، وَأحد إسنادي الْبَزَّار، رِجَاله رجال الصَّحِيح، غير عَليّ بن عَليّ الرِّفَاعِي، وَهُوَ ثِقَة. وَقد قدمنَا ذكر هَذَا الحَدِيث، وَذكر مَا قيل فِي إسْنَاده..
وَقد تضمن؛ أن الدُّعَاء ينفع مِمَّا نزل، وَمِمَّا لم ينزل. وَذَلِكَ يَشْمَل دفع كل الْبلَاء النَّازِل، وَأنه يعتلج - هُوَ وَالْبَلَاء - إلَى يَوْم الْقِيَامَة.
فَيمكن أن يجمع بَين هذا الحَدِيث، وَبَين حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَأبي سعيد؛ بِأن دفع الْبلَاء يحصل بِالدُّعَاءِ على كل حَال. وَأما إذا كَانَ الدُّعَاء فِي مَطْلُوب من المطالب الَّتِي لَيست بِدفع للبلَاء، فَيحْتَمل تِلْكَ الصُّور.
وَيُؤَيّد هَذَا الْجمع، مَا أخرجه ابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه»، والضياء فِي «المختارة»، [من حَدِيث أنس]( )، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «لَا تعجزوا فِي الدُّعَاء، فَإنَّهُ لن يهْلك مَعَ الدُّعَاء أحد»( ).
وَقد صَححهُ هَؤُلَاءِ الْأئِمَّة الثَّلَاثَة، فَلَا وَجه لتعقب الذَّهَبِيّ؛ بِأن فِي إسْنَاده عمر بن مُحَمَّد الْأسْلَمِيّ، وَأنه لَا يعرفهُ؛ لِأنَّهُ قد عرفه هَؤُلَاءِ الْأئِمَّة، وَلَو لم يعرفوه، لم يصححوا الحَدِيث. لكنه حكى الذَّهَبِيّ فِي «الْمِيزَان»( )، عَن أبي حَاتِم: أنه مَجْهُول، وَقَالَ ابْن حجر فِي «لِسَان الْمِيزَان»( ): أنه تساهل الْحَاكِم فِي تَصْحِيحه.
وَيُجَاب عَنهُ: بِأنَّهُ قد صَححهُ مَعَه ابْن حبَان والضياء، وهما مَا هما؟!( ) وَمَعْلُوم أنَّهُمَا لَا يصححان إلَّا حَدِيثًا قد عرفا إسْنَاده، وَمن علم حجَّة على من لم يعلم.
وَمِمَّا يدل على إجَابَة الدُّعَاء على الْعُمُوم، حَدِيث سلمَان عِنْد أبي دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن الله حييّ كريم، يستحي إذا رفع الرجل يَدَيْهِ إلَيْهِ، أن يردهما صفرًا خائبتين».
وَأخرج الْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإسْنَاد، من حَدِيث أنس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن الله حييّ كريم، يستحي من عَبده أن يرفع إلَيْهِ يَدَيْهِ، ثمَّ لَا يضع فيهمَا خيرًا»( ). وَيدل على إجَابَته على الْعُمُوم الْآيَاتِ الَّتِي قدمنَا ذكرهَا.
أثر النوافل في محبة الله لعبده:
قَالَ ابْن حجر: فِي الحَدِيث عظيم( ) قدر الصَّلَاة، فَإنَّهُ نَشأ عَنْهَا محبَّة الله تَعَالَى للْعَبد الَّذِي تقرب بهَا؛ وَذَلِكَ لِأن مَحل النجَاة الْقرْبَة، وَلَا وَاسِطَة فِيهَا بَين العَبْد وربه، وَلَا شَيْء أقرّ لعين العَبْد مِنْهَا، وَلِهَذَا جَاءَ فِي حَدِيث أنس الْمَرْفُوع: «وَجعلت قُرَّة عَيْني فِي الصَّلَاة». أخرجه النَّسَائِيّ وَغَيره، بِسَنَد صَحِيح.
وَمن كَانَت لَهُ قُرَّة عينه فِي شَيْء، فَإنَّهُ يود أن لَا يُفَارِقهُ، وَلَا يخرج مِنْهُ؛ لِأن فِيهِ نعيمه، وَبِه تطيب حَيَاته، وَلَا يحصل ذَلِك للعابد إلَّا بالمصابرة على النصب، فَإن السالك عرضة الْآفَات والفتور. انْتهى.
أقُول: خص فِي كَلَامه هَذَا من بَين النَّوَافِل نوافل الصَّلَاة، مَعَ أن نوافل الصّيام، وَالْحج، وَالصَّدَقَة، وَنَحْوهَا، ورد فِيهَا مَا ورد فِي التَّرْغِيب فِي نوافل الصَّلَاة، وَبَعضهَا ورد فِي نوافل مَا أجره أعظم من أجر نوافل الصَّلَاة، كَمَا فِي أحَادِيث التَّرْغِيب فِي ذَلِك، وَقد قدمنَا طرفًا مِنْهَا - وَلَا وَجه لذَلِك [أ:91]؛ فَإن الحَدِيث صرح بِعُمُوم النَّوَافِل، وَهِي تَشْمَل كل نَافِلَة، ونوافل كل نوع؛ مَا خرج عَن فَرَائِضه، مَعَ التَّرْغِيب فِي فعله.
فَإن قَالَ: إنَّه خص نوافل الصَّلَاة لما لَهَا من المزية، فَهَذِهِ المزية إنَّمَا ترْتَفع بارتفاع مَا وعد بِهِ عَلَيْهَا من الثَّوَاب. وَقد ذكرنَا أنه ورد فِي بعض نوافل غَيرهَا مَا هُوَ أكثر ثَوابًا من بَعْضهَا.
وَمَا ذكره من الِاسْتِدْلَال بِحَدِيث: «وَجعلت قُرَّة عَيْني فِي الصَّلَاة»( )، فَهُوَ غير مُنَاسِب؛ لِأن سِيَاق الْكَلَام فِي بَيَان عَظِيم( ) أجر نوافل الصَّلَاة للْمُصَلِّي، وَهَذَا إنَّمَا هُوَ شَيْء يحصل بِهِ التَّلَذُّذ لفاعل ذَلِك، وَلَيْسَ من الْجَزَاء الْمَوْعُود بِهِ.
لَكِن كَون الصَّلَاة جعلت قُرَّة عين رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فِيهَا مِمَّا يُحَرك( ) نشاط الراغبين فِي الْخَيْر إلَى الاستكثار مِنْهَا، وَأن تكون قُرَّة أعينهم فِي الصَّلَاة، كَمَا كَانَت قُرَّة عينه فِي الصَّلَاة. وَهَذِه الصَّلَاة الَّتِي كَانَت فِيهَا قُرَّة عين رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم تتَنَاوَل الْفَرَائِض والنوافل.
وَهَكَذَا، مِمَّا يرغب فِي الصَّلَاة، قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «يَا بِلَال، أرحْنَا بِالصَّلَاةِ»( )؛ أي: رُوحنَا بفعلها . وَذَلِكَ؛ وَإن كَانَ مورده صَلَاة الْفَرَائِض، لَكِن لنوافلها نصيب من هَذَا الرّوح.
قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح»( ): وَفِي حَدِيث حُذَيْفَة فِي الزِّيَادَة - يَعْنِي: حَدِيث الْبَاب - «وَيكون من أوليائي وأصفيائي، وَيكون جاري مَعَ النَّبِيين وَالصديقين وَالشُّهَدَاء فِي الْجنَّة»( ).
العصمة والقرب في الحديث:
وَقد تمسك بِهَذَا الحَدِيث بعض الجهلة، من أهل النَّحْل والرياضة، فَقَالُوا: الْقلب إذا كَانَ مَحْفُوظًا مَعَ الله تَعَالَى، كَانَت خواطره معصومة من( ) الْخَطَأ.
وَتعقب ذَلِك أهل التَّحْقِيق، من أهل الطَّرِيق، فَقَالُوا: لَا يلْتَفت إلَى شَيْء من ذَلِك، إلَّا إذا وَافق الْكتاب وَالسّنة، والعصمة إنَّمَا هِيَ للأنبياء، وَمن عداهم قد يُخطئ، فقد كَانَ عمر رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ رَأس الملهمين، وَمَعَ ذَلِك، فَكَانَ رُبمَا رأى الرَّأْي، فيخبره بعض الصَّحَابَة بِخِلَافِهِ، فَيرجع إلَيْهِ، وَيتْرك رَأْيه.
فَمن ظن أنه يَكْتَفِي بِمَا وَقع فِي خاطره، عَمَّا( ) جَاءَ بِهِ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فقد ارْتكب أعظم الْخَطَأ. وَأما من بَالغ مِنْهُم، فَقَالَ: حَدثنِي قلبِي، عَن رَبِّي( )، فَهُوَ أشد خطأ، فَإنَّهُ لَا يَأْمَن أن يكون قلبه إنَّمَا حَدثهُ عَن الشَّيْطَان، وَالله الْمُسْتَعَان. انْتهى.
متى نسلم بآراء أهل الولاية وخواطرهم:
أقُول: قد قدمنَا فِي أول هَذَا الشَّرْح، أن أهل الْولَايَة إذا لم تكن أعْمَالهم موزونة بميزان الْكتاب وَالسّنة، فَلَا اعْتِدَاد بهَا، وكررنا ذَلِك. وَمَعْلُوم أن أوْلِيَاء الله إذا لم يجْعَلُوا كَلَامه وَكَلَام رَسُوله قدوتهم، ويمشون على صراطها السوي، لم يَصح لَهُم هَذَا الانتساب إلَى الله تعالى .
وَكَيف يكون وليًّا لله( ) سُبْحَانَهُ من يعرض عَمَّا شَرعه لِعِبَادِهِ، ودعاهم إلَيْهِ، ويشتغل بزخارف الْأحْوَال، وخواطر السوء، ويؤثرها على كَلَام من هُوَ ولي لَهُ؟! فَإن هَذَا هُوَ بالعدو أشبه مِنْهُ بالولي.
وَلَيْسَ الْكَلَام فِيمَن كَانَ حَاله هَذَا الْحَال، بل الْكَلَام فِيمَن يستكثر من أنْوَاع الطَّاعَة الَّتِي رغب إلَيْهَا الشَّرْع، مُقَيّدًا لكل موارده ومصادره [أ:92] بِالشَّرْعِ، فَإن لهَذِهِ الطَّاعَات أثرًا عَظِيمًا فِي صَلَاح بَاطِنه، وَوُقُوع خواطره - فِي الْغَالِب - مُطَابقَة للصَّوَاب.
وَكَيف لَا يكون هَكَذَا، وَقد صَار محبوبًا لله، وَكَانَ سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ، وبصره الَّذِي يبصر بِهِ، وَيَده الذي( ) يطبش بهَا، وَرجله الذي( ) يمشي بهَا، فبه يسمع، وَبِه يبصر، وَبِه يبطش، وَبِه يمشي، كَمَا وَقع فِي هَذَا الحَدِيث الْقُدسِي.
وَأي رُتْبَة أعلَى من هَذِه، وَأي مزية أكبر مِنْهَا؟ والمحب فِي بني آدم يُؤثر محبوبه على نَفسه، ويقدمه عَلَيْهَا بأبلغ جهده، وَغَايَة طاقته، حَتَّى قَالَ بعض المحبين لمحبوبه شعرًا:
وَلَو قلت طأ فِي النَّار أعلم أنه
رضَا لَك أو مدنٍ لنا من وصالك
لقربت رجْلي نَحْوهَا ووطئتها
هدى مِنْك لي أو صلة من ضلالك
لَئِن سَاءَنِي أن نلتني بمساءة
لقد سرني أنِّي خطرت ببالك( )
وَقَالَ آخر:
وَلَقَد ذكرتك والرماح نواهل
مني وبيض الْهِنْد تقطر من دمي
فوددت تَقْبِيل الرماح لِأنَّهَا
لمعت كبارق ثغرك المتبسم( )
وَقَالَ آخر:
ذكرتك والخطى تخطر بَيْننَا
وَقد نهلت منا المثقفة السمر( )
فَإذا كَانَ هَذَا فِي الْحبّ البشري، الَّذِي هُوَ نوع من أنْوَاع مخلوقات الرب، الَّتِي لَا تدخل تَحت حصر، وَلَا تتطرق إلَيْهَا إحاطة، فَكيف لَا يصنع الله ۵ لمحبوبه؛ من تيسير( ) الْخَيْر، والحماية عَن الْجِنَايَة، وَحفظ الخواطر عَن الزيغ، مَا يصير بِهِ ملكي الْأفْعَال والأقوال، وَإن كَانَ بشري الْخلقَة، وَهُوَ الْقَادِر الْقوي، الَّذِي لَا يتعاظمه شَيْء.
وَمِمَّا يُشِير إلَى صدق غَالب خواطر أهل الْإيمَان، حَدِيث «اتَّقوا فراسة الْمُؤمن فَإنَّهُ يرى بِنور الله»، وَهُوَ حَدِيث حسن، كَمَا قدمنَا.
وَالْحَاصِل؛ أن الخواطر الكائنة من أهل الْولَايَة، إذا لم تخَالف الشَّرْع، فَيَنْبَغِي أن تكون مسلمة لَهُم؛ لكَوْنهم أحباء الله وأولياءه ، وَأهل طَاعَته وصفوة عباده.
وَلَيْسَ لمن كَانَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِم، كالبهيمة بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإنْسَان، أو كالإنسان بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَلَائِكَة، أن يُنكر عَلَيْهِم شَيْئا لَا يُخَالف الشَّرِيعَة، فَإن خَالف شَيْئًا مِنْهَا، فَهِيَ الجسر الَّذِي لَا يصل أحد إلَى مراضي الله [تعالى]( ) إلَّا بالمرور مِنْهُ، وَالْبَاب الَّذِي من دخل من غَيره، ضل وَزَل، وَقل وذل.
يَا سالكًا بَين الأسنة والقنا
إنِّي أشمّ عَلَيْك رَائِحَة الدَّم( )
وَلَا شكّ، وَلَا ريب؛ أن من جعل مَا امتن الله [تعالى]( ) به على عباده الصَّالِحين، المستكثرين [أ:93] من نوافل( ) الْعِبَادَات [فِي هَذَا الحَدِيث]( )، من الْمحبَّة لَهُم، وَمَا ترَتّب عَلَيْهَا، عصمَة كعصمة الْأنْبِيَاء - مُخطئ، مُخَالف للْإجْمَاع، فَإن الْعِصْمَة بِهَذَا الْمَعْنى خص الله سُبْحَانَهُ بهَا رسله وَمَلَائِكَته، وَلم يَجْعَلهَا لأحد من خلقه، فَإن هَذَا الْمقَام هُوَ مقَام النُّبُوَّة لَا مقَام الْولَايَة، وَلَا يُخَالف فِي ذَلِك إلَّا جَاهِل أو زائغ.
وَلَكِن الشَّأْن فِيمَا تستلزمه هَذِه الْمحبَّة من الرب سُبْحَانَهُ، وَمَا يتأثر عَن قَوْله «كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ، وبصره الَّذِي يبصر بِهِ، وَيَده الَّذِي( ) يبطش بهَا، وَرجله الَّذِي( ) يمشي بهَا»، فَإن هَذَا يدل أبلغ دلَالَة، ويفيد أعلَى مفَاد، أن من وَقع لَهُ ذَلِك من جناب رب الْعِزَّة، كَانَ مُثَبَّتًا أكمل تثبيت، وموفقًا أعظم توفيق، وَرَبك يخلق مَا يَشَاء ويختار، لَا مَانع لما أعْطى، وَلَا معطي لما منع.
وَأما مَا حَكَاهُ عَمَّن بَالغ مِنْهُم، فَقَالَ: حَدثنِي قلبِي عَن رَبِّي، فَلَيْسَ هَذَا من الخواطر، بل من الرِّوَايَة المكذوبة، وَالْكَلَام المفترى، إن كَانَ قَائِله كَامِل الْعقل، وَإلَّا؛ فغالب مَا تصدر مثل هَذِه الدَّعَاوَى العريضة عَن المصابين بعقولهم، المخالطين فِي إدراكهم، وَلَيْسَ على مَجْنُون حرج.
وَلَيْسَ أحباء الله سُبْحَانَهُ هم هَؤُلَاءِ، بل الْكَلَام فِي أحبائه، الَّذين( ) ذكرهم الله [تعالى]( ) فِي هَذَا الحَدِيث الْقُدسِي، ولسان حَالهم:
أهلًا بِمَا لم أكن أهلًا لموقعه
قَول المبشر بعد الْيَأْس بالفرج
لَك الْبشَارَة فاخلع مَا عَلَيْك فقد
ذكرت ثمَّ على مَا فِيك من عوج( )
الإحسان ومقاماته:
وَحكى ابْن حجر فِي «الْفَتْح»( )، عَن الطوفي، أنه قَالَ: هَذَا الحَدِيث أصل فِي السلوك إلَى الله تَعَالَى، والوصول إلَى مَعْرفَته ومحبته، وَطَرِيقَة أدَاء المفروضات الْبَاطِنَة؛ وَهِي الْإيمَان، وَالظَّاهِرَة؛ وَهِي الْإسْلَام، والمركب مِنْهُمَا؛ وَهُوَ الْإحْسَان، كَمَا تضمنه حَدِيث جِبْرِيل ڠ. وَالْإحْسَان يتَضَمَّن مقامات السالكين؛ من الزّهْد، وَالْإخْلَاص، والمراقبة، وَغَيرهَا. انْتهى.
أقُول: قد عرفناك - فِيمَا سلف - أن مِمَّا افترضه الله [تعالى]( ) على عباده، ترك الْمُحرمَات، فَتَركهَا فَرِيضَة من فَرَائض الله سُبْحَانَهُ. فَقَوله: أدَاء المفروضات الْبَاطِنَة؛ وَهِي الْإيمَان، وَالظَّاهِرَة؛ وَهِي الْإسْلَام، لَا يَشْمَل جَمِيع فَرَائض الله.
وَبَيَانه؛ أن الْإيمَان هُوَ كَمَا قَالَه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فِي جَوَاب من سَألَهُ عَن الْإيمَان: «أن تؤمن بِاللَّه وَمَلَائِكَته وَكتبه وَرُسُله وَالْقدر خَيره وشره»( )، فَلم يَشْمَل جَمِيع المفروضات الْبَاطِنَة، فَإن مِنْهَا أن لَا يتَعَلَّق بِشَيْء من الاعتقادات الْبَاطِلَة، وَلَا يحْسد، وَلَا يعجب، وَلَا يتكبر، وَلَا يشوب عمله رِيَاء، وَلَا نِيَّته عدم خلوص، وَلَا يستخف بِمَا أوجب الله عَلَيْهِ تَعْظِيمه، وَلَا يبطن غير مَا يظهره( )، حَتَّى يكون ذَا وَجْهَيْن، وَغير ذَلِك من الْأمُور القلبية، الَّتِي هِيَ عِنْد من يتفكر فِي الْأمُور ويتفهم الْحَقَائِق كَثِيرَة جدًّا، والتكليف( ) بهَا شَدِيد، والوعيد عَلَيْهَا عتيد، والحريص على دينه، إذا لم يجاهدها( ) كُلية المجاهدة، هلك من حَيْثُ لَا يشْعر، وَذهب عَلَيْهِ أجر أعماله الظَّاهِرَة وَهُوَ لَا يدْرِي..
فَترك هَذِه هُوَ من أعظم مَا افترضه الله [تعالى]( ) على عباده، وَهِي غير دَاخِلَة فِي خِصَال الْإيمَان، الَّتِي اشْتَمَل عَلَيْهَا الحَدِيث( )، فَإن الرجل قد يُؤمن بِاللَّه، وَمَلَائِكَته، وَكتبه، وَرُسُله، وَالْقدر؛ خَيره وشره، وَهُوَ مُشْتَمل على شَيْء من هَذِه الْمعاصِي الْبَاطِنَة.
وَبَيَان ذَلِك؛ أنَّك لَوكشفت مَا عِنْده فِي الْإيمَان بِاللَّه، لوجدته مُؤمنًا بِهِ، لَا يَعْتَرِيه فِي ذَلِك شكّ وَلَا شُبْهَة، وَكَذَلِكَ لَا يشك فِي الْمَلَائِكَة، وَفِي كتب الله، وَرُسُله، وَكَون الْأمر بيد الله تعالى، وَهُوَ الْقَابِض، الباسط، النافع، الضار. فَهَذِهِ يجدهَا( ) الْإنْسَان عِنْد كل أحد من الْمُسلمين. وَإذا كشفت عَن هَذِه الْأمُور الْبَاطِنَة، وجدت عباد الله مُخْتَلفين فِيهَا، لَا يَنْزِعهَا الله سُبْحَانَهُ إلَّا من قُلُوب خَاصَّة الْخَاصَّة( ).
وَمَا أحسن مَا روي عَن بعض كفار الْهِنْد الوثنية بعد إسْلَامه، أنه قَالَ: جاهدت نَفسِي فِي كسر الوثن الَّذِي كنت أعبده لَيْلَة فَغَلَبَتْهَا وكسرته، وَأنا فِي جِهَاد لَهَا نَحْو عشْرين سنة فِي كسر الْأصْنَام الْبَاطِنَة، فَلم أقدر عَلَيْهَا، وَلَا نفع جهادي لَهَا أبدًا.
وَمن فكر فِي هَذَا النَّوْع الإنساني، وجد غَالب مصائب دينه من الْمعاصِي الْبَاطِنَة، وَوجد الْمعاصِي الظَّاهِرَة - بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبَاطِنَة - أقل خطرًا وأيسر شرًا؛ لِأنَّهُ قد يمْنَع عَنْهَا الدّين، وَقد يمْنَع عَنْهَا الْحيَاء، وَحفظ الْمُرُوءَة. وَأما البلايا الْبَاطِنَة، فَهِيَ إذا لم يَزع حاملها وازع الدّين، لم يقْلع عَنْهَا؛ لِأنَّهَا أمُور لَا يطلع عَلَيْهَا النَّاس حَتَّى يستحي، ويحاشي، ويحافظ على مروءته.
طهارة الباطن مدخل الولاية الكبرى :
وَبِالْجُمْلَةِ؛ فَمن قدر على تصفية بَاطِنه من هَذِه الأدناس فقد دخل من بَاب الْولَايَة الْكُبْرَى، وَتمسك بأوثق أسبَابهَا، لِأنَّهُ قد خلص من أعظم موانعها، وَأشد القواطع عَنْهَا، وَصَارَ بَاطِنه قَابلا لأنوار التَّوْفِيق مستعدًا للظفر بالمنازل الْعَالِيَة والمزايا الجميلة الَّتِي هِيَ أس الْولَايَة الْعُظْمَى وأساس الْهِدَايَة الْكُبْرَى وركن الْإيمَان الْقوي، وعماد الْإخْلَاص السوي.
وَإذا تقرر لَك عدم اشْتِمَال خِصَال الْإيمَان( ) على جَمِيع الْأمُور الْبَاطِنَة، فَكَذَلِك( ) مَا ذكره من اشْتِمَال الْإسْلَام على الْفَرَائِض الظَّاهِرَة، فَإنَّهُ غير مُسلم؛ لِأن الْإسْلَام هُوَ الَّذِي ذكره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي جَوَاب سُؤال من سَألَهُ عَن الْإسْلَام، فقَالَ: «أن تقيم الصَّلَاة، وتؤتي الزَّكَاة، وتحج الْبَيْت، وتصوم رَمَضَان، وَتشهد أن لَا إلَه إلَّا الله»( )، فقد اقْتصر صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي بَيَان مَاهِيَّة الْإسْلَام على هَذِه الْخمس.
والفرائض الظَّاهِرَة كَثِيرَة جدًّا [أ:95]، يصعب حصرها، وتتعسر الْإحَاطَة بهَا، وناهيك أن رَأس الْفَرَائِض الظَّاهِرَة الْجِهَاد، وَلَيْسَ من جملَة الْخمس الَّتِي اشْتَمَل عَلَيْهَا حَدِيث الْإسْلَام، فَلَا نطيل بذكرها، فَإنَّهَا مَعْرُوفَة لكل ذِي علم وَفهم.
الطريق إلى طهارة الباطن:
وَيحسن أن نبين هَاهُنَا الزواجر عَن بعض الْمعاصِي الْبَاطِنَة؛ حَتَّى يكون ذَلِك بعد مَا قدمْنَاهُ من التحذير مِنْهَا، كالدواء لدائها العضال، وكالترياق لسمها الْقِتَال.
فَاعْلَم؛ أن عُمْدَة الْأعْمَال الَّتِي تترتب عَلَيْهَا صِحَّتهَا أو فَسَادهَا، هِيَ النِّيَّة وَالْإخْلَاص، وَلَا شكّ أنَّهُمَا من الْأمُور الْبَاطِنَة، فَمن لم تكن نِيَّته صَحِيحَة، لم يَصح عمله الَّذِي عمله، وَلَا أجره الْمُتَرَتب عَلَيْهِ، وَمن لم يخلص عمله لله سُبْحَانَهُ، فَهُوَ مَرْدُود عَلَيْهِ، مَضْرُوب بِهِ [فِي]( ) وَجهه. وَذَلِكَ كالعامل الَّذِي يشوب نِيَّته بالرياء، قَالَ الله تعالى: ﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ( )﴾ [البيِّنة: 5].
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عمر بن الْخطاب ﭬ، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «إنَّمَا الْأعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لكل امْرِئ مَا نوى فَمن كَانَت هجرته إلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إلَى الله وَرَسُوله، وَمن كَانَت هجرته إلَى دنيا يُصِيبهَا أو امْرَأة يَتَزَوَّجهَا فَهجرَته إلَى مَا هَاجر إلَيْهِ»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة [رضي الله عنها]( )، فِي قصَّة الْجَيْش الَّذِي يَغْزُو الْكَعْبَة، فيخسف بهم، قَالَت: قلت: يَا رَسُول الله، كَيفَ يخسف بأولهم وَآخرهمْ، وَفِيهِمْ أسواقهم، وَمن لَيْسَ مِنْهُم؟ قَالَ: «يخسف بأولهم وَآخرهمْ، ثمَّ يبعثون على قدر نياتهم»( ).
وَأخرج ابْن مَاجَه بِإسْنَاد حسن، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إنَّمَا يبْعَث النَّاس على نياتهم»( ). وَأخرجه أيْضًا من حَدِيث جَابر.
وَأخرج البُخَارِيّ وَغَيره، من حَدِيث أنس، قَالَ: رَجعْنَا من غَزْوَة تَبُوك مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فَقَالَ: «إن أقْوَامًا خلفنا بِالْمَدِينَةِ، مَا سلكنا شعبًا وَلَا وَاديًا، إلَّا وهم مَعنا، حَبسهم الْعذر»( ).
وَأخرج مُسلم، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن الله لَا ينظر إلَى أجسامكم، وَلَا إلَى صوركُمْ، وَلَكِن ينظر إلَى قُلُوبكُمْ»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث ابْن عَبَّاس، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من همَّ بحسنة فَلم يعملها، كتبهَا الله عِنْده حَسَنَة كَامِلَة، فَإن همَّ بهَا فعملها، كتبهَا الله عِنْده عشر حَسَنَات، إلَى سَبْعمِائة ضعف، إلَى أضْعَاف كَثِيرَة، وَمن هم بسيئة فَلم يعملها، كتبهَا الله عِنْده حَسَنَة كَامِلَة، وَإن هُوَ هم بهَا فعملها، كتبهَا الله عِنْده سَيِّئَة وَاحِدَة»( )، زَاد فِي رِوَايَة( ): «أو محاها، وَلَا يهْلك على الله إلَّا هَالك»، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِنَحْوِهِ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَمن ذَلِك حَدِيث الثَّلَاثَة الَّذين هم أول من تسعَّر بهم النَّار، وهم: الْعَالم؛ الَّذِي علم ليقال لَهُ عَالم، والمجاهد؛ الَّذِي جَاهد ليقال لَهُ جريء، وَالرجل الْغَنِيّ؛ الَّذِي تصدق ليقال لَهُ جواد( ). وَهُوَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، بِألْفَاظ.
وَأخرج أبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، بِإسْنَاد جيد، من حَدِيث أبي أمَامَة، قَالَ: جَاءَ رجل إلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فَقَالَ: أرَأيْت رجلًا غزا يلْتَمس الْأجر [أ:96] وَالذكر، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا شَيْء لَهُ»، فَأعَادَهَا ثَلَاث مَرَّات، يَقُول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا شَيْء لَهُ»، ثمَّ قَالَ: «إن الله لَا يقبل من العَبْد، إلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وابتغي بِهِ وَجهه»( ).
وَأخرج أحْمد، بِإسْنَاد جيد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَالطَّبَرَانِيّ، من حَدِيث أبي هِنْد الدَّارِيّ؛ أنه سمع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «من قَامَ مقَام رِيَاء وَسمعة، راءى الله بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وسَمّع»( ).
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي «الْكَبِير»، بأسانيد أحدهَا صَحِيح، والبيهقي، عَن عبدالله ابْن عَمْرو، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «من سمع النَّاس بِعِلْمِهِ، سمع الله بِهِ سامع خلقه، وصغره، وحقره»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث جُنْدُب بن عبدالله، قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من سمع سمع الله [بِهِ]( )، وَمن يرائي يرائي الله بِهِ»( ).
وَأخرج ابْن مَاجَه، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ فِي «كتاب الزّهْد»، من حَدِيث معَاذ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «الْيَسِير من الرِّيَاء شرك»( ) الحَدِيث. قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح، وَلَا عِلّة لَهُ.
وَأخرج أحْمد، بِإسْنَاد جيد، وَابْن أبي الدُّنْيَا، وَالْبَيْهَقِيّ فِي «الزّهْد»، عَن مَحْمُود بْن لبيد: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «إن أخوف مَا أخَاف عَلَيْكُم الشّرك الْأصْغَر»، قَالُوا: وَمَا الشّرك الْأصْغَر؟ قَالَ: «الرِّيَاء، يَقُول الله ۵ - إذا جزى النَّاس بأعمالهم -: اذْهَبُوا إلَى الَّذين كُنْتُم تراءون فِي الدُّنْيَا، فانظروا هَل تَجِدُونَ عِنْدهم جَزَاء؟»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، من حَدِيث أبي سعيد نَحوه. وَأخرج ابْن مَاجَه بِإسْنَاد رِجَاله ثِقَات، وَابْن خُزَيْمَة فِي «صَحِيحه»، وَالْبَيْهَقِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحوه أيْضًا.
وَالْأحَادِيث الْوَارِدَة فِي كَون الرِّيَاء مُبْطلًا للْعَمَل، مُوجبًا للإثم، كَثِيرَة جدًّا، وَارِدَة فِي أنْوَاع من الرِّيَاء؛ الرِّيَاء فِي الْعلم، والرياء فِي الْجِهَاد، والرياء فِي الصَّدَقَة، والرياء فِي أعمال الْخَيْر على الْعُمُوم، ومجموعها لَا يَفِي بِهِ إلا مُصَنف مُسْتَقل.
والرياء هُوَ أضرّ الْمعاصِي الْبَاطِنَة وأشرها، مَعَ كَونه لَا فَائِدَة فِيهِ إلَّا ذهَاب أجر الْعَمَل، والعقوبة على وُقُوعه فِي الطَّاعَة، فَلم يذهب بِهِ مُجَرّد الْعَمَل، بل لزم صَاحبه مَعَ ذهَاب عمله، الْإثْم الْبَالِغ. وَمن كَانَ ثَمَرَة ريائه هَذِه الثَّمَرَة، وَعجز عَن صرف نَفسه عَنهُ، فَهُوَ من ضعف الْعقل، وحمق الطَّبْع بمَكَان فَوق مَكَان الْمَشْهُورين بالحماقة.
وَمن الزّجر عَن الذُّنُوب الْبَاطِنَة، الْخَارِجَة عَن حَدِيث الْإيمَان، مَا أخرجه الشَّيْخَانِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالظَّن، فَإن الظَّن أكذب الحَدِيث، وَلَا تجسسوا، وَلَا تحسسوا، وَلَا تنافسوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تباغضوا، وَلَا تدابروا، كَمَا أمركُم، الْمُسلم أخُو الْمُسلم، لَا يَظْلمه، وَلَا يَخْذُلهُ، وَلَا يحقره، التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِير إلَى صَدره - بِحَسب امْرِئ من الشَّرّ أن يحقر أخَاهُ الْمُسلم، كل الْمُسلم على الْمُسلم حرَام؛ دَمه، وَعرضه، وَمَاله»( ).
وَهَذِه الْأمُور غالبها [أ:97] من الْمعاصِي الْبَاطِنَة، وناهيك أن التَّقْوَى - الَّتِي هِيَ طَرِيق النجَاة الْكُبْرَى - قد صرح صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم هَاهُنَا أنَّهَا من الْأمُور الْبَاطِنَة، فَإذا كَانَت النِّيَّة وَالْإخْلَاص وَالتَّقوى من الْأمُور الْبَاطِنَة، وَهِي عُمْدَة الِاعْتِدَاد بالأفعال والأقوال، فناهيك بذلك.
وَأخرج ابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «لَا يجْتَمع فِي جَوف عبد مُؤمن، غُبَار فِي سَبِيل الله، وفيح جَهَنَّم، وَلَا يجْتَمع فِي جَوف عبد، الْإيمَان والحسد»( ).
فقد أوضح فِي هَذَا الحَدِيث أن الْحَسَد مُغَاير للْإيمَان، فصح مَا ذَكرْنَاهُ من الِاعْتِرَاض على كَلَام الطوفي السَّابِق.
وَأخرج أبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَأخرجه ابْن مَاجَه، من حَدِيث أنس، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «إيَّاكُمْ والحسد، فَإن الْحَسَد يَأْكُل الْحَسَنَات، كَمَا تَأْكُل النَّار الْحَطب»( ).
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ، بِإسْنَاد رِجَاله ثِقَات، عَن ضَمرَة بن ثَعْلَبَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا يزَال النَّاس بِخَير، مَا لم يتحاسدوا»( ).
وَأخرج الْبَزَّار، وَالْبَيْهَقِيّ، بِإسْنَاد جيد، من حَدِيث الزبير: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «دب إلَيْكُم دَاء الْأمَم قبلكُمْ، الْحَسَد والبغضاء، والبغضاء هِيَ الحالقة، أما إنِّي لَا أقُول تحلق الشّعْر، وَلَكِن تحلق الدّين»( ).
وَأخرج ابْن مَاجَه، بِإسْنَاد صَحِيح، وَالْبَيْهَقِيّ: أنه سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم عَن أفضل النَّاس؟ فَقَالَ: «التقي النقي، لَا إثْم فِيهِ، وَلَا بغي، وَلَا غل، وَلَا حسد»( ). وَالْأحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب كَثِيرَة.
وَمِمَّا ورد فِي ذمّ الْكبر وَالْعجب: حَدِيث عِيَاض بن حمَار، الَّذِي أخرجه مُسلم، وَأبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن الله تَعَالَى أوحى إليّ أن تواضعوا، حَتَّى لَا يفخر أحد على أحد، وَلَا يَبْغِي أحد على أحد»( ).
وَأخرج مُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «مَا نقصت صَدَقَة من مَال، وَمَا زَاد( ) الله عبدًا بِعَفْو إلَّا عزًّا، وَمَا تواضع أحد لله إلَّا رَفعه»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم وَصَححهُ، من حَدِيث ثَوْبَان، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من مَاتَ، وَهُوَ بَرِيء من الْكبر، والغلول، والدَّين، دخل الْجنَّة»( ).
وَأخرج ابْن مَاجَه، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «من تواضع لله دَرَجَة، يرفعهُ دَرَجَة، حَتَّى يَجعله فِي أعلى عليين، وَمن تكبر على الله دَرَجَة، يَضَعهُ الله دَرَجَة، حَتَّى يَجعله فِي أسْفَل سافلين، وَلَو أن أحدكُم يعْمل فِي صَخْرَة صماء، لَيْسَ عَلَيْهَا بَاب وَلَا كوة؛ لخرج مَا غيبه للنَّاس، كَائِنًا ما كَانَ»( ).
وَأخرج أحْمد، وَالْبَزَّار، بِإسْنَاد رِجَاله رجال الصَّحِيح، وَالطَّبَرَانِيّ، عَن عمر بن الْخطاب [رضي الله عنه]( ) أنه قَالَ على الْمِنْبَر: أيهَا النَّاس، تواضعوا، فَإنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «من تواضع لله رَفعه الله»، وَقَالَ: انْتَعش نَعشك الله، فَهُوَ فِي أعين النَّاس عَظِيم، وَفِي نَفسه صَغِير، وَمن تكبر قصمه الله، وَقَالَ: «اخْسَأْ فَهُوَ فِي أعين النَّاس صَغِير، وَفِي نَفسه كَبِير»( )
وَأخرج مُسلم، من حَدِيث أبي سعيد، وَأبي هُرَيْرَة [رضي الله عنهما]( ) [أ:98]، قَالَا: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «يَقُول الله ۵: الْعِزّ إزَاره، والكبرياء رِدَاؤُهُ، فَمن( ) نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، عَذبته»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث حَارِثَة بن وهب، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «ألا أخْبركُم بِأهْل النَّار، كل عتل جَوَّاظٍ مستكبر»( ).
وَأخرج مُسلم، وَالنَّسَائِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله تَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة، وَلَا يزكيهم، وَلَا ينظر إلَيْهِم، وَلَهُم عَذَاب ألِيم؛ شيخ زانٍ، وَملك كَذَّاب، وعائل مستكبر»( ).
وَأخرج مُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ، من حَدِيث ابْن مَسْعُود، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «لَا يدْخل الْجنَّة من فِي قلبه مِثْقَال ذرة من كبر»، فَقَالَ رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثَوْبه حسنًا، وَنَعله حَسَنَة( )، قَالَ: «إن الله جميل يحب الْجمال، الْكبر بطر الْحق وغمط النَّاس»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ وَغَيره، من حَدِيث ابْن عمر: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «بَيْنَمَا رجل مِمَّن كَانَ قبلكُمْ، يجر إزَاره من الْخُيَلَاء، خسف بِهِ، فَهُوَ يتجلجل فِي الأرْض إلَى يَوْم الْقِيَامَة»( ). وَأخرج نَحوه البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَغَيرهما، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث ابْن عمر: أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «من جر ثَوْبه خُيَلَاء، لم ينظر الله إليه يَوْم الْقِيَامَة»، فَقَالَ أبُو بكر: يَا رَسُول الله، إن إزَارِي يسترخي، إلا أن أتعاهده؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إنَّك لست مِمَّن يَفْعَله خُيَلَاء»( ). وَالْخُيَلَاء عِنْد أهل اللُّغَة وَالشَّرْع: الْكبر وَالْعجب. وَالْأحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب كَثِيرة.
وَأخرج الشَّيْخَانِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «تَجِدُونَ النَّاس معادن، خيارهم فِي الْجَاهِلِيَّة، خيارهم فِي الْإسْلَام، إذا فقهوا، [وتجدون خيار الناس في هذا الشأن، أشدهم له كراهية]( )، وتجدون شَرّ النَّاس ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْه، وَهَؤُلَاء بِوَجْه»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ، من حَدِيث ابْن عمر: أن رجلًا قَالَ لَهُ: إنَّا ندخل على سلطاننا، فَنَقُول بِخِلَاف مَا نتكلم إذا خرجنَا من عِنْده، فَقَالَ: كُنَّا نعد هَذَا نفَاقًا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم( ).
وَأخرج أبُو دَاوُد، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، من حَدِيث عمار بن يَاسر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من كَانَ لَهُ وَجْهَان فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْم الْقِيَامَة لسانان من نَار»( ).
وَأخرجه ابْن أبي الدُّنْيَا، وَالطَّبَرَانِيّ، والأصبهاني، من حَدِيث أنس، وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ أيْضًا فِي «الْأوْسَط»، من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص، بِلَفْظ: «ذَوُو( ) الْوَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا، يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة، وَله وَجْهَان من نَار»( ).
وَمن الْأمُور الْبَاطِنَة الْخِيَانَة، وَقد وَردت الْأحَادِيث الصَّحِيحَة بِأنَّهَا من خِصَال النِّفَاق.
وَمن الْأمُور الْبَاطِنَة الْمحبَّة، والبغض، وَالْكَرَاهَة، وَقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «ثَلَاث مَنْ كُنَّ فِيهِ وجد بِهن حلاوة الْإيمَان؛ من كَانَ الله وَرَسُوله أحب إلَيْهِ [أ:99] مِمَّا سواهُمَا، وَمن أحب عبدًا، لَا يُحِبهُ إلَّا لله تَعَالَى، وَمن يكره أن يعود فِي الْكفْر بعد أن أنقذه الله مِنْهُ، كَمَا يكره أن يقذف فِي النَّار»، وَفِي رِوَايَة: «وَأن يحب فِي الله وَيبغض فِي الله»( ).
وَأخرج مُسلم، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن الله تَعَالَى يَقُول يَوْم الْقِيَامَة: [أيْن]( ) المتحابون لأجلي، الْيَوْم أظلهم فِي ظِلِّي، يَوْم لَا ظلّ إلا ظِلِّي»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة - فِي السَّبْعَة الَّذين يظلهم الله فِي ظله، يَوْم لَا ظلّ إلَّا ظله، وَمِنْهُم: «رجلَانِ تحابا فِي الله، اجْتمعَا عَلَيْهِ، وتفرقا عَلَيْهِ»( ).
وَأخرج مُسلم، من حَدِيثه - فِي الرجل الَّذِي أتَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وعرفه أنه زار أخًا لَهُ أحبه فِي الله تَعَالَى، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «إن الله قد أحبك، كَمَا أحْبَبْته فِيهِ»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي ذَر: أنه صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم قَالَ: «الْمَرْء مَعَ من أحب»( ).
وَالْأحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب كَثِيرَة جدًّا، وَمن ذَلِك مَا ورد فِي ذمّ حب الدُّنْيَا، ومدح حب الْآخِرَة، [وَهِي أحَادِيث كَثِيرَة] ( ).
وَمن الْأمُور الْبَاطِنَة الطَّيرَة، وَقد صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنَّهَا شرك( )، كَمَا فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن حبَان.
وَمن الْأمُور الباطنة التَّوْبَة، وَالْأحَادِيث الْوَارِدَة فِي التَّرْغِيب فِيهَا متواترة.
وَمِنْهَا الْأحَادِيث الْوَارِدَة فِي مدح الخشية من الله تعالى، وَمِنْهَا الْأحَادِيث الْوَارِدَة فِي ذمّ طول الأمل ومدح قصره، وَمِنْهَا الْأحَادِيث الْوَارِدَة فِي مدح الْخَوْف من الله تعالى، ومراقبته.
وَمِنْهَا الْأحَادِيث الْوَارِدَة فِي مدح حسن الظَّن بِاللَّه، وَلَو لم يكن مِنْهَا إلَّا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «قَالَ الله تعالى: أنا عِنْد ظن عَبدِي بِي»( )، وَحَدِيث جَابر، عِنْد مُسلم، وَغَيره: أنه سمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، قبل مَوته بِثَلَاثَة أيَّام يَقُول: «لَا يموتن أحدكُم، إلَّا وَهُوَ يحسن الظَّن بِاللَّه تعالى»( ).
وَمِنْهَا الصَّبْر، وَقد ورد مدحه، وَكَون الله مَعَ الصابرين، وَمَا لَهُم [في الآخرة]( ) من الْأجر الْعَظِيم، فِي الْكتاب وَالسّنة.
وَبِالْجُمْلَةِ؛ فاستيفاء الْفَرَائِض الْبَاطِنَة، والمحرمات الْبَاطِنَة، الَّتِي تَركهَا من الْفَرَائِض، يطول جدًّا، فلنقتصر على هَذَا الْمِقْدَار، وَبِه يتَبَيَّن أن مَا ذكره الطوفي من اشْتِمَال خِصَال الْإسْلَام على الْفَرَائِض الظَّاهِرَة، واشتمال خِصَال الْإيمَان الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث على الْفَرَائِض الْبَاطِنَة - غير صَحِيح.
ما يتركب منه الإحسان :
وَأما قَول الطوفي: والمركب مِنْهُمَا، وَهُوَ الْإحْسَان، كَمَا تضمنه حَدِيث جِبْرِيل... إلَخ، فَأقُول: وَجه تركبه مِنْهُمَا أنه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ فِي الْإحْسَان لما سَألَهُ السَّائِل عَنهُ: «أن تعبد الله كَأنَّك ترَاهُ، فَإن لم تكن ترَاهُ، فَإنَّهُ يراك»( )، فَأمره أن يعبد الله سُبْحَانَهُ على هَذِه الصّفة، وَهِي كَأنَّهُ يرَاهُ، فمجموع الْإحْسَان هُوَ الْعِبَادَة مَعَ الْحُضُور والمراقبة ومزيد الْخُشُوع فِيهَا.
وَلَكِن لَا يخفاك أن كَون الْإحْسَان يتركب من مَجْمُوع الْإسْلَام وَالْإيمَان مَبْنِيّ على أن الْعِبَادَة مَعَ هَذِه المراقبة تحصل لكل مُؤمن [أ:100] وَهُوَ مَمْنُوع. فَإن هَذِه رُتْبَة وَرَاء الْإيمَان بمسافات طَوِيلَة ودرجات كَثِيرَة؛ لِأن الْإيمَان يحصل للْعَبد بِمُجَرَّد إيمَانه بِاللَّه، وملائكته، وَكتبه، وَرُسُله، وَالْقدر خَيره وشره( ).
وَقد عرفناك أن هَذَا حَاصِل لغالب الْعباد، وَلَو كَانَ الْإحْسَان من مَجْمُوع الْإسْلَام وَالْإيمَان، لزم أن يحصل لكل مُسلم مُؤمن، وَأنه إذا لم يحصل لَهُ ذَلِك، وَلم يعبد الله كَأنَّهُ يرَاهُ، لم يحصل الْإيمَان، وَهَذَا بَاطِل من القَوْل، وتكليف بِمَا لَا يستطيعه من أهل الْإيمَان إلَّا من هُوَ الكبريت الْأحْمَر( )، والغراب الأبقع( )، وكل عَالم بِهَذِهِ الشَّرِيعَة الغراء لَا يخفى عَلَيْهِ مثل هَذَا. فالإحسان هُوَ موهبة يتفضل الله بهَا على خلص عباده، وَجلة صفوته، وأكابر أوليائه، وَأهل محبته.
فَالَّذِي يَنْبَغِي أن يُقَال: إن الْإحْسَان مَشْرُوط بِالْإسْلَامِ وَالْإيمَان، وَأنه لَا يتم إلَّا لمن حصل لَهُ هَذَانِ الْأمْرَانِ، وَهُوَ شَيْء ثَالِث، لَيْسَ هُوَ عين أحدهمَا، وَلَا مركب مِنْهُمَا، وَفرق بَين الشّطْر وَالشّرط، فَإن الشَّرْط خَارج عَن الْمَشْرُوط، وَإن استلزم عَدمه عَدمه، بِخِلَاف الشّطْر، فَإنَّهُ جزؤه الَّذِي تركب مِنْهُ مَعَ غَيره( ).
فالطوفي لما صرح بتركب الْإحْسَان من الْإسْلَام وَالْإيمَان، استلزم كَلَامه هَذَا أنَّهُمَا جزآن لَهُ، وليسا كَذَلِك، بل هما شَرْطَانِ لَهُ، من فقدهما أو أحدهمَا فقد الْإحْسَان، كَمَا هُوَ مَفْهُوم الشَّرْط. فَلَابُد من هَذَا، وَإلَّا استلزم كَلَامه الْبَاطِل، وَهُوَ أن كل من اجْتمع لَهُ الْإسْلَام وَالْإيمَان، يكون قد بلغ رُتْبَة الْإحْسَان، وَهَذَا غلط من القَوْل، وشطط من الرَّأْي، وعبء من التَّكْلِيف ثقيل، لَا ينوء بِهِ غَالب عباد الله الْمُؤمنِينَ.
والمراتب تَتَفَاوَت بتفاوت هَذِه المقامات، وَإن كَانَ بَينهَا فِي الْعُلُوّ مَا بَين السَّمَاء وَالْأرْض، وَأعظم محصلات هَذَا الْمقَام الإحساني، هُوَ الْخُشُوع، وَالْخَوْف، والخشية من الله تعالى، كَمَا قَالَ [تعالى]( ): ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [الرحمن: 46]، وَفِي الحَدِيث الْمُتَّفق عَلَيْهِ، فِي السَّبْعَة الَّذين يظلهم الله فِي ظله، وَمِنْهُم «رجل دَعَتْهُ امْرَأة ذَات منصب وجمال، فَقَالَ: إنِّي أخَاف الله».
وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث الثَّلَاثَة الَّذين انطبقت عَلَيْهِم الصَّخْرَة، فَقَالَ صَاحب الْمَرْأة الَّتِي دَعَتْهُ، فَتَركهَا( ): «اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أنِّي إنَّمَا فعلت ذَلِك رَجَاء رحمتك وخشية عذابك»( )، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا.
وَكَذَلِكَ حَدِيث الرجل، الَّذِي أمر أوْلَاده بإحراقه إذا مَاتَ، فَقَالَ لَهُ الله ۵: «لم فعلت هَذَا؟ قَالَ: من خشيتك يَا رب، وَأنت أعلم، فغفر الله لَهُ»( ). وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا.
وَأخرج ابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، عَن الله سُبْحَانَهُ، أنه قَالَ: «وَعِزَّتِي، لَا يجْتَمع على عبد خوفان وأمنان، إذا خافني فِي الدُّنْيَا، أمنته يَوْم الْقِيَامَة، وَإذا أمنني فِي الدُّنْيَا، أخفته يَوْم الْقِيَامَة»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَحسنه، وَالْبَيْهَقِيّ، من حَدِيث أنس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «قَالَ الله تعالى: أخرجُوا من النَّار من ذَكرنِي يَوْمًا أو خافني فِي مقَام»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «من خَافَ أدْلج، وَمن أدْلج بلغ الْمنزل، سلْعَة الله غَالِيَة، [ألا إن] ( ) سلْعَة الله الْجنَّة»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ وَغَيره، من حَدِيث أبي ذَر، أنه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «وَالله لَو تعلمُونَ( ) مَا أعلم، لضحكتم قَلِيلًا، ولبكيتم كثيرًا، وَمَا تلذذتم بِالنسَاء على الْفرش، ولخرجتم إلَى الصعدات تجأرون إلَى الله، وَالله لَوَدِدْت أنِّي شَجَرَة تعضد»( )، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، من حَدِيث أنس.
وَمن ذَلِك حَدِيث أنس، عَن التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه: أنه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم دخل على شَاب، وَهُوَ فِي الْمَوْت، فَقَالَ: «كَيفَ تجدك؟»، قَالَ: أرجو الله يَا رَسُول الله، وَإنِّي أخَاف ذُنُوبِي، فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قلب عبد مُؤمن فِي مثل هَذَا الموطن، إلَّا أعطَاهُ الله مَا يَرْجُو، وآمنه مِمَّا يخاف»( ). وَإسْنَاده حسن، وَفِي إسْنَاده جَعْفَر بن سُلَيْمَان الضبعِي، وَلكنه صَدُوق، أخرج لَهُ مُسلم، وَوَثَّقَهُ الْجُمْهُور، وَتكلم فِيهِ قوم؛ مِنْهُم: الدَّارَقُطْنِيّ.
وَأخرج أحْمد، وَالنَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث أبي ريحانة، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «حرمت النَّار على عين دَمَعَتْ أو بَكت من خشيَة الله»( ). وَأخرجه الْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث أنس.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإسْنَاد، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «لَا يلج النَّار رجل بَكَى من خشيَة الله، حَتَّى يعود اللَّبن فِي الضَّرع»( ). وَالْأحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب كَثِيرَة.
وَمن أعظم الْأسْبَاب الموصلة إلَى مقَام الْإحْسَان: الزّهْد فِي الدُّنْيَا، وَفِي ذَلِك ترغيبات [كَثِيرَة]( )؛ وَمِنْهَا: مَا أخرجه ابْن ماجه، من حَدِيث سهل بن سعد، قَالَ: جَاءَ رجل إلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، دلَّنِي على عمل إذا عملته، أحبَّنِي الله تَعَالَى، وأحبني النَّاس، قَالَ: «ازهد فِي الدُّنْيَا، يحبك الله، وازهد فِيمَا فِي أيدي النَّاس، يحبك النَّاس»( )، وَفِي إسْنَاده( ) خَالِد بن عَمْرو الْقرشِي الْأمَوِي السعيدي، وَفِيه مقَال.
وَأخرج مُسلم وَغَيره، من حَدِيث أبي سعيد: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم [قال]( ): «إن الدُّنْيَا خضرَة حلوة، وَإن الله تَعَالَى مستخلفكم فِيهَا، فَينْظر كَيفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الله، وَاتَّقوا النِّسَاء»( ).
وَأخرج مُسلم، عَن عبدالله بْن عَمْرو، سَألَهُ رجل، فَقَالَ لَهُ عبدالله: ألَك امْرَأة تأوي إلَيْهَا؟ قَالَ: نعم، قَالَ: ألَك مسكن تسكنه؟ قَالَ: نعم، قَالَ: فَأنت من الْأغْنِيَاء، قَالَ: فإن لي خَادِمًا؟ قَالَ: فَأنت من الْمُلُوك( ).
وَأخرج مُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه، من حَدِيث عبدالله بن عَمْرو: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «قد أفْلح من أسلم، ورزق كفافًا، وقنعه الله تَعَالَى بِمَا آتَاهُ»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «اللَّهُمَّ اجْعَل رِزْق آل مُحَمَّد قوتًا»، وَفِي رِوَايَة: «كفافًا»( ).
وَأخرج مُسلم، من حَدِيث المسْتَوْرَد، قَالَ: قَالَ: رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَة إلَّا كَمَا يَجْعَل أحدكُم إصبعه هَذِه فِي اليم - وَأشَارَ بالسبابة - فَلْينْظر بِمَا ترجع»( ).
وَأخرج أحْمد، بِإسْنَاد رُوَاته ثِقَات، وَالْبَزَّار، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ فِي «الزّهْد»، من حَدِيث أبي مُوسَى [رضي الله عنه]( ): أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «من أحب دُنْيَاهُ، أضرّ بآخرته، وَمن أحب آخرته، أضرّ بدنياه، فآثروا مَا يبْقى على مَا يفنى»( ).
وَأخرج الْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث أبي مَالك الْأشْعَرِيّ، قَالَ عِنْد مَوته: يَا معشر الْأشْعَرِيين، ليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب، إنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «حلوة الدُّنْيَا مرّة الْآخِرَة، وَمرَّة الدُّنْيَا حلوة الْآخِرَة»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، من حَدِيث كَعْب بن مَالك، قَالَ: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «مَا ذئبان جائعان، أرسلا فِي غنم، بأفسد لَهَا؛ من حرص الْمَرْء على المَال والشرف لدينِهِ»( ). وَأخرج الطَّبَرَانِيّ، وأبُو يعلى، بِإسْنَاد جيد، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، نَحوه. وَأخرج الْبَزَّار أيْضًا، بِإسْنَاد حسن، من حَدِيث ابْن عمر، نَحوه.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَمْرو بن عَوْف الْأنْصَارِيّ، قَالَ: لما قُدم عَلَيْهِ( ) بجزية الْبَحْرين، [قال]( ): «أبْشِرُوا وأملوا مَا يسركم، فوَاللَّه مَا الْفقر أخْشَى عَلَيْكُم، وَلَكِن أخْشَى أن تبسط الدُّنْيَا عَلَيْكُم، كَمَا بسطت على من كَانَ قبلكُمْ، فتنافسوها كَمَا تنافسوها، فتهلككم كَمَا أهلكتهم»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: جلس رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم على الْمِنْبَر، وَجَلَسْنَا حوله، فَقَالَ: «إن مِمَّا أخَاف عَلَيْكُم مَا( ) يفتح عَلَيْكُم من زهرَة الدُّنْيَا وَزينتهَا»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي ذَر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «يَا أبَا ذَر»، قلت: لبيْك يَا رَسُول الله، فَقَالَ( ): «مَا يسرني أن عِنْدِي مثل أحد هَذَا ذَهَبا يمْضِي عَلَيْهِ ثَالِثَة وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَار إلَّا شَيْء أرصده لدين إلَّا أن أقُول فِي عباد الله هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله وَمن خَلفه ثمَّ سَار»، فَقَالَ: «إن الْأكْثَرين( ) هم الأقلون يَوْم الْقِيَامَة، إلَّا من قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله وَمن خَلفه، وَقَلِيل ما هم»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، مَا شبع نَبِي الله( ) صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم ثَلَاثَة أيَّام تباعًا، من خبز حِنْطَة، حَتَّى فَارق الدُّنْيَا( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح، من حَدِيث ابْن عَبَّاس، قَالَ: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يبيت اللَّيَالِي المتتابعة وَأهله طاويًا، لَا يَجدونَ عشَاء، وَإنَّمَا كَانَ أكثر خبزهم الشّعير( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: مَا شبع آل مُحَمَّد من خبز الشّعير يَوْمَيْنِ مُتَتَابعين، حَتَّى قبض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم( ).
وَأخرج أحْمد، وَالطَّبَرَانِيّ، بِرِجَال ثِقَات، من حَدِيث أنس: أن فَاطِمَة رَضِي الله [تعالى]( ) عَنْهَا ناولت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم كسرة من خبز شعير، فَقَالَ: «هَذَا طَعَام أكله أبوك مُنْذُ ثَلَاثَة أيَّام»( ).
وَأخرج ابْن ماجه، بِإسْنَاد حسن، وَالْبَيْهَقِيّ، بِإسْنَاد صَحِيح، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: أتي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم بِطَعَام سخن، فَأكل، فَلَمَّا فرغ قَالَ: «الْحَمد لله، مَا دخل بَطْني طَعَام سخن مُنْذُ كَذَا( ) وَكَذَا»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حسن، من حَدِيث أبي أمامة قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «عرض عليَّ رَبِّي ۵ ليجعل لي بطحاء مَكَّة ذَهَبًا»، قلت: «لَا يَا رب، وَلَكِن أشْبع يَوْمًا، وأجوع يَوْمًا»، أو قَالَ: «ثَلَاثًا»، أو نَحْو هَذَا، «فَإذا جعت، تضرعت إلَيْك وذكرتك، وَإذا شبعت، شكرتك وحمدتك»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: خرج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم [من أيْدِينَا]( )، وَلم يشْبع من خبز الشّعير( ).
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ، بِإسْنَاد جيد، من حَدِيث كَعْب بن عجْرَة، قَالَ: أتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فرأيته متغيرًا، قَالَ: فَقلت: بِأبي أنْت، مَا لِي أرَاك متغيرًا؟ فَقَالَ: «مَا يدْخل جوفي، مَا يدْخل [جَوف]( ) ذَات كبد، مُنْذُ ثَلَاث»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ، من حَدِيث سهل بن سعد، قَالَ: مَا رأى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم النقي، من حِين ابتعثه الله تَعَالَى، حَتَّى قَبضه الله، فَقيل: هَل كَانَ لكم فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم مناخل؟ فَقَالَ: مَا رأى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم منخلًا، من حِين ابتعثه الله تَعَالَى، حَتَّى قَبضه الله، فَقيل: فَكيف كُنْتُم تَأْكُلُونَ الشّعير غير منخول؟ قَالَ: كُنَّا نطحنه وننفخه، فيطير مَا طَار، وَمَا بَقِي، ثريناه، فأكلناه( ).
وَأخرج البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة، أنَّهَا قَالَت: إن كُنَّا لنَنْظُر إلَى الْهلَال، ثمَّ الْهلَال، ثمَّ الْهلَال - ثَلَاثَة أهلة - فِي شَهْرَيْن، وَمَا أوقد فِي فِي أبْيَات النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم نَار. قَالَ عُرْوَة: يَا خَالَة، فَمَا كَانَ يعيشكم؟ قَالَت: الأسودان؛ التَّمْر، وَالْمَاء( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أنس: أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم عصب بَطْنه بعصابة من الْجُوع( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، من حَدِيث أنس، قَالَ: قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لقد أتَت عليَّ ثَلَاثُونَ، من بَين يَوْم وَلَيْلَة، وَمَا لِي( ) ولبلال طَعَام يَأْكُلهُ ذُو كبد، إلَّا شَيْء يواريه إبط بِلَال»( ).
وَأخرج ابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ، وَالطَّبَرَانِيّ، من حَدِيث عبدالله بن مَسْعُود، قَالَ: نَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم على حَصِير، فَقَامَ وَقد أثر فِي جنبه، قُلْنَا( ): يَا رَسُول الله، لَو اتخذنا لَك وطاء؟ فَقَالَ: «مَا لِي وللدنيا، مَا أنا فِي الدُّنْيَا إلَّا كراكب، استظل تَحت شَجَرَة، ثمَّ رَاح وَتركهَا»( ).
وَأخرجه أحْمد، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْبَيْهَقِيّ، من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَأخرج نَحوه ابْن ماجه، بِإسْنَاد صَحِيح، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث عمر بن الْخطاب، وَنَحْوه من حَدِيثه فِي «الصَّحِيح»، فِي قصَّة دُخُوله على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم لما آلى من نِسَائِهِ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: إنَّمَا كَانَ فرَاش رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم الَّذِي ينَام عَلَيْهِ أدمًا، حشوه لِيف( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي بردة بن أبي مُوسَى، قَالَ: أخرجت لنا عَائِشَة كسَاء ملبدًا، وإزارًا غليظًا، فَقَالَت: قبض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي هذَيْن( ). والملبد: المرقع.
وَأخرج البُخَارِيّ، من حَدِيث عَمْرو بن الْحَارِث، قَالَ: مَا ترك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم عِنْد مَوته درهمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عبدًا، وَلَا أمة، وَلَا شَيْئًا، إلَّا بغلته الْبَيْضَاء الَّتِي كَانَ يركبهَا، وسلاحه، وأرضًا جعلهَا لِابْنِ السَّبِيل( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: توفّي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وَدِرْعه مَرْهُونَة عِنْد يَهُودِيّ، فِي ثَلَاثِينَ صَاعًا من شعير( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص، قَالَ: إنِّي لأوّل الْعَرَب رمى بِسَهْم فِي سَبِيل الله، وَلَقَد كُنَّا نغزو مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، مَا لنا طَعَام إلَّا ورق الحُبْلة، وَهَذَا السَّمَر، حَتَّى إن كَانَ أحَدنَا ليضع كَمَا تضع الشَّاة، مَا له خلط( ). والحبلة( ) والسمر من شجر الْبَادِيَة.
وَأخرج مُسلم وَغَيره، من حَدِيث خَالِد بن عُمَيْر الْعَدوي، قَالَ: خَطَبنَا خَالِد ابن غزوان( )، وَفِي خطبَته: وَلَقَد رَأيْتنِي سَابِع سَبْعَة مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، مَا لنا طَعَام إلَّا ورق الشّجر، حَتَّى قرحت أشداقنا( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، من حَدِيث خباب بن الأرت: أنهم لم يَجدوا مَا يغطوا بهِ رَأس مُصعب بن عُمَيْر، لما قتل يَوْم أحد، إلَّا بردة، إذا غطوا بهَا رَأسه، خرجت رِجْلَاهُ، وَإذا غطوا بهَا رجلَيْهِ، خرج رَأسه، فَأمرهمْ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أن يغطوا بهَا رَأسه( ).
وَأخرج البُخَارِيّ وَغَيره، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: لقد رَأيْت سبعين من أهل الصّفة، مَا مِنْهُم رجل عَلَيْهِ رِدَاء، إمَّا إزَار أو كسَاء، قد ربطوا فِي أعْنَاقهم، مِنْهَا مَا يبلغ نصف السَّاقَيْن، وَمِنْهَا مَا يبلغ الْكَعْبَيْنِ، فيجمعه بِيَدِهِ؛ كَرَاهِيَة أن ترى عَوْرَته( ).
وَمن الْخِصَال الَّتِي يبلغ بهَا العَبْد مقَام الْإحْسَان: الرِّفْق، والأناة، والحلم، وَحسن الْخلق، وطلاقة الْوَجْه، وإفشاء السَّلَام.
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن الله رَفِيق يحب الرِّفْق فِي الْأمر كُله»( ).
وَأخرج مُسلم وَغَيره، عَنْهَا، قَالَت: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن الرِّفْق لَا يكون فِي شَيْء إلَّا زانه، وَلَا ينْزع من شَيْء إلَّا شانه»( ).
وَأخرج مُسلم وَغَيره، من حَدِيث جرير بن عبدالله، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من يحرم الرِّفْق، يحرم الْخَيْر»، زَاد أبُو دَاوُد: «كُله»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ، من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من أعْطي حَظه من الرِّفْق، فقد أعْطي حَظه من الْخَيْر، وَمن حرم حَظه من الرِّفْق، حرم حَظه من الْخَيْر»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ، وَمُسلم، وَغَيرهمَا، من حَدِيث أنس، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا، وبشروا وَلَا تنفرُوا»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إنَّمَا بعثتم ميسرين، وَلم تبعثوا معسرين»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: مَا خير رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم بَين أمريْن قطّ، إلَّا اخْتَار أيسرهما، مَا لم يكن إثْمًا( ).
وَأخرج مُسلم، من حَدِيث ابْن عَبَّاس [رضي الله عنه]( )، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم للأشج: «إن فِيك خَصْلَتَيْنِ يحبهما الله وَرَسُوله؛ الْحلم، والأناة»( ).
وَأخرج مُسلم، وَالتِّرْمِذِيّ، من حَدِيث النواس بن سمْعَان، قَالَ: سَألت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم عَن الْبر وَالْإثْم، فَقَالَ: «الْبر حسن الْخلق، وَالْإثْم مَا حاك فِي صدرك، وكرهت أن يطلع عَلَيْهِ النَّاس»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث ابْن عَمْرو، قَالَ: لم يكن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فَاحِشًا، ولا متفحشًا، وَكَانَ يَقُول: «إن من خياركم أحسنكم أخْلَاقًا»( ). وَالْأحَادِيث فِي الثَّنَاء على حسن الْخلق كَثِيرَة جدًّا.
وَأخرج مُسلم وَغَيره، من حَدِيث أبي ذَر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا تحقرن من الْمَعْرُوف شَيْئًا، وَلَو أن تلقى أخَاك بِوَجْه طلق»( ).
وَأخرج أحْمد، والتِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ، من حَدِيث جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «كل مَعْرُوف صَدَقَة، وَإن من الْمَعْرُوف أن تلقى أخَاك بِوَجْه طلق، وَأن تفرغ من دلوك فِي إنَاء أخِيك»( ). وصدره فِي الصَّحِيحَيْنِ، من حَدِيث حُذَيْفَة، وَجَابِر.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَحسنه، وَابْن حبَان، وَصَححهُ، من حَدِيث أبي ذَر [رضي الله عنه]( )، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «تبسمك فِي وَجه أخِيك [لَك]( ) صَدَقَة...» ( ) الحَدِيث. وَأخرجه الْبَزَّار، من حَدِيث ابْن عمر.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عدي بن حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «اتَّقوا النَّار وَلَو بشق تَمْرَة، فَمن لم يجد، فبكلمة طيبَة»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث ابْن عَمْرو: أن رجلًا سَألَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: أي الْإسْلَام خير؟ قَالَ: «تطعم الطَّعَام، وتقرئ السَّلَام على من عرفت، وَمن لم تعرف»( ).
وَأخرج مُسلم، وَأبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا تدْخلُوا الْجنَّة حَتَّى تؤمنوا، وَلَا تؤمنوا حَتَّى تحَابوا، ألا أدلكم على شَيْء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السَّلَام بَيْنكُم»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حسن صَحِيح، من حَدِيث عبدالله بن سَلام، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «يا أيها النَّاس، أفشوا السَّلَام، وأطعموا الطَّعَام، وصلوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نيام، تدْخلُوا الْجنَّة بِسَلام»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ، وَابْن حبَان، وَصَححهُ، من حَدِيث ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «اعبدوا الرَّحْمَن، وأفشوا السَّلَام، وأطعموا الطَّعَام، تدْخلُوا الْجنان»( ).
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث أبي شُرَيْح، أنه قَالَ: يَا رَسُول الله، أخْبرنِي بِشَيْء يُوجب لي الْجنَّة؟ قَالَ: «طيب الْكَلَام، وبذل السَّلَام، وإطعام الطَّعَام»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «حق الْمُسلم على الْمُسلم خمس...»( )، وَفِي رِوَايَة: «سِتّ»( )، وَمِنْهَا: «إذا لَقيته تسلم عَلَيْهِ».
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي «الْأوْسَط»، بِإسْنَاد جيد، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «أعجز النَّاس من عجز فِي الدُّعَاء، وأبخل النَّاس من بخل بِالسَّلَامِ»( ).
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي معاجمه الثَّلَاثَة، بِإسْنَاد جيد، من حَدِيث عبدالله بن مُغفل، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «أسرق النَّاس الَّذِي يسرق صلَاته»، قيل: يَا رَسُول الله، كَيفَ يسرق صلَاته؟ قَالَ: «لَا يتم ركوعها، وَلَا سجودها، وأبخل النَّاس من بخل بِالسَّلَامِ»( ).
وَأخرج أحْمد، وَالطَّبَرَانِيّ، وَالْبَزَّار، وإسناد أحْمد لَا بَأْس بِهِ، من حَدِيث جَابر، وَفِيه: أنه صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ للَّذي امْتنع من أن يَبِيعهُ عذقة بِالْجنَّةِ: «مَا رَأيْت أبخل مِنْك، إلَّا الَّذِي يبخل بِالسَّلَامِ»( ).
وَمن أعظم الْأسْبَاب الموصلة إلَى مقَام الْإحْسَان: المداومة على الْعَمَل الصَّالح، فقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة [رضي الله عنها]( )، أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم [قال]( ): «إن أحب الْأعْمَال إلَى الله أدومها وَإن قل»( ).
إجابة دعوة الولي :
ولنرجع إلَى شرح الحَدِيث الَّذِي نَحن بصدد شَرحه، فَنَقُول: إن قَوْله: «لَئِن سَألَني لأعطينه، وَلَئِن استعاذني لأعيذنه»، رُبمَا يُقَال: مَا الْفَائِدَة فِي توقف الْعَطِيَّة مِنْهُ ۵ على السُّؤَال، والإعاذ لَهُ على الِاسْتِعَاذَة، مَعَ أنه سُبْحَانَهُ الْمُعْطِي بِغَيْر حِسَاب، المتفضل على عباده بِكُل جميل، وغالب مَا يصل إلَى الْعباد، الَّذين لم تكن لَهُم مرتبَة الْولَايَة الْعُظْمَى، بل الَّذين هم دونهَا بمراحل، بل الَّذين خلطوا على أنفسهم، وَقصرُوا فِيمَا يجب عَلَيْهِم، هُوَ من تفضلاته الجمة، وتكرماته الفائضة، من غير تقدم سُؤال.
قلت: هَاهُنَا( ) نُكْتَة عَظِيمَة، وَفَائِدَة جليلة، وَهِي: أنهم إذا أعطوا بعد السُّؤَال، وأعيذوا بعد الِاسْتِعَاذَة، عرفُوا أن الله سُبْحَانَهُ قد أجَاب( ) لَهُم الدُّعَاء، وَتلك منقبة لَا تساويها منقبة، ورتبة تتقاصر عَنْهَا كل رُتْبَة، وَعند ذَلِك يحصل لَهُم من السرُور مَا لَا يقادر قدره، وَيَكُونُونَ عِنْد هَذِه الْإجَابَة أعظم سُرُورًا بهَا من الْعَطِيَّة، وَإن بلغت [أعظم]( ) مبلغ فِي الْكَثْرَة والنفاسة. وَعند ذَلِك يستكثرون من أعمال الْخَيْر، ويبالغون فِي تَحْصِيلهَا؛ لأنهم قد عرفُوا مَا لَهُم عِنْد رَبهم، حَيْثُ أجَاب دعاءهم، ولبى نداءهم.
وَأيْضًا: قد قدمنَا أن الدُّعَاء هُوَ الْعِبَادَة، بل هُوَ مخ الْعِبَادَة، فالإرشاد إلَيْهِ إرشاد إلَى عبَادَة جليلة، تترتب عَلَيْهَا فَائِدَة جميلَة، مَعَ مَا فِي ذَلِك من امْتِثَال الْأمر الرباني، حَيْثُ يَقُول: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [غافر: 60]، وَقَوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [البقرة: 186].
وَمَعَ مَا فِيهِ أيْضًا من خلوص خلص عباده من الاستكبار على رَبهم، الَّذِي ورد الْوَعيد عَلَيْهِ بقوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [غافر: 60]؛ أي: دعائي، كَمَا سبق بَيَانه.
فَكَانَت الْفَوَائِد ثَلَاثًا؛
الأولى: الظفر بالمرتبة الْعلية، من كَونهم من مُجَابِي( ) الدعْوَة.
الثَّانِيَة: مَا فِي ذَلِك من الْعِبَادَة لله تعالى بدعائه.
الثَّالِثَة: توقِّيهم( ) لما خُوطِبَ بِهِ غَيرهم من المستكبرين عَن الدُّعَاء( ).
وَمَعَ هَذَا؛ فَلَا شكّ أن بعض المسببات مربوطة بأسبابها، فَمن العطايا مَا لَا يحصل [للْعَبد]( ) إلَّا بِسَبَب الدُّعَاء. فالولي - وَإن كَانَ فِي أعلَى مَرَاتِب الْولَايَة - لَا ينَال مَا قَيده الله بِسَبَب، إلَّا بِفعل ذَلِك السَّبَب، فَكَانَ فِي الدُّعَاء من هَذِه الحثيثة فَائِدَة رَابِعَة؛ لِأن العَبْد لَا يَتَيَسَّر لَهُ أن يقطع بوصول مَطْلُوب من مطالبه إلَيْهِ، حَتَّى يتْرك الدُّعَاء لرَبه ۵ بِأن يوصله إلَيْهِ.
مقام المحبة:
قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح»( ): وَفِي الحَدِيث أيْضًا؛ أن من أتَى بِمَا وَجب عَلَيْهِ، وتقرب بالنوافل، لم يرد دعاؤه؛ لوُجُود هَذَا الْوَعْد الصَّادِق الْمُؤَكّد بالقسم، وَقد تقدم الْجَواب عَمَّا يتَخَلَّف. انْتهى.
أقُول: قد قدم ذكر استشكال مَا فِي الحَدِيث من الْوَعْد بالإجابة؛ بِأن جمَاعَة من الْعباد والصلحاء دعوا وبالغوا، وَلم يجابوا. ثمَّ ذكر ذَلِك الْجَواب الَّذِي قدمه، وَقدمنَا الِاسْتِدْلَال على مَا ذكره فِي الْجَواب، وَكَانَ الأولى لَهُ أن يقدم مَا ذكره هُنَا، على مَا ذكره هُنَاكَ، حَتَّى يكون ذَلِك الاستشكال، لما أفَادَهُ هَذَا الِاسْتِدْلَال الْمَذْكُور هُنَا.
وَأقُول: هَذَا الحَدِيث مورده هم أوْلِيَاء الله، الَّذين تقربُوا إلَيْهِ بِمَا يحب حَتَّى أحبهم، وَهُوَ مُقْتَضى لإجابتهم لَا محَالة. وَلَا يرد عَلَيْهِ مَا أوردهُ من عدم إجَابَة جمَاعَة من الْعباد والصلحاء، فَإن هَذَا مقَام هُوَ أعلَى من مقامهم، ومنزلة هِيَ أرفع من مَنْزِلَتهمْ.
وَلَا مُلَازمَة بَين مقَام الْعِبَادَة وَالصَّلَاح، وَبَين مقَام الْمحبَّة، فَإن الْعِبَادَة - وَإن كثرت وتنوعت - قد تقع مِنْهُ ۵ الْموقع الْمُقْتَضي لمحبته، وَقد لَا تقع؛ إمَّا لكَونهَا مشوبة بشائبة تكدر صفوها، وتمحق بركتها، مِمَّا لَا يتعمده الْعباد، بل يصدر؛ إمَّا على طَرِيق التَّقْصِير فِي علم الشَّرِيعَة، أو التَّقْصِير فِي الخلوص، الَّذِي يُوصل صَاحبه إلَى محبَّة الرب ۵.
وَلَا حرج على قَائِل أن يَقُول: إن من بلغ إلَى رُتْبَة الْمحبَّة، وَكَانَ الله سَمعه وبصره، أن يُجَاب لَهُ كل دُعَاء، وَيحصل بغيته( ) على حسب إرَادَته. وَأي مَانع يمْنَع من هَذَا؟! بل كل مَا يظنّ أنه مَانع لَيْسَ بمانع شَرْعِي وَلَا عَقْلِي، وَوُجُود بعض أهل الْعِبَادَة على الصّفة الَّتِي ذكرهَا، من كَونه دَعَا وَبَالغ، وَلم يجب، لَيْسَ ذَلِك إلَّا لمَانع يرجع إلَى نَفسه، وَلَا يكون الْمَانِع الرَّاجِع إلَى نَفسه مَانِعًا فِي حق من هُوَ أعلَى مِنْهُ رُتْبَة، وَأجل مِنْهُ مقَامًا، وأكبر مِنْهُ منزلَة( ).
وَإذا عرفت انْتِفَاء الْمَانِع الَّذِي يعْتد بِهِ فِي المانعية، فقد وجد هَاهُنَا الْمُقْتَضي الَّذِي هُوَ أوضح من شمس النَّهَار، وَهُوَ وعد من لَا يخلف الميعاد. وَإذا وجد الْمُقْتَضي، وانتفى الْمَانِع، حصل الْمَطْلُوب الَّذِي وجد مَا يَقْتَضِيهِ، إعمالًا لهَذَا الْمُقْتَضي الَّذِي ورد مؤكدًا بإقسام الرب سُبْحَانَهُ.
فَمَا أبعد مَا جَاءَ بِهِ المشككون فِي هَذَا الْأمر الَّذِي لَا يقبل التشكيك، لَا شرعًا، وَلَا عقلًا، بل وَلَا عَادَة. فَإن من اطلع على أحْوَال أوْلِيَاء الله سُبْحَانَهُ، وَعرف مَا ذكره المؤرخون فِي أخبارهم، وَمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ تراجمهم، وجد كل مَا توجهوا بِهِ إلَى رَبهم حَاصِلًا لَهُم، فِي كل مطلب من المطالب، كَائِنًا مَا كَانَ، والمحروم من حرم ذَلِك.
وَكَيف ترى ليلى بِعَين ترى بهَا
سواهَا وَمَا طهرتها بالمدامع
وتلتذ مِنْهَا بِالْحَدِيثِ وَقد جرى
حَدِيث سواهَا فِي خروت المسامع
أجلك يا ليلى عَن الْعين إنَّمَا
أرَاك بقلب خاشع لَك خاضع( )
أولَئِكَ قوم لما دعوا أجيبوا، وَلما أحبوا( ) أحِبُّوا، وَلما أخلصوا استُخلِصوا، صدقت مِنْهُم الضمائر، فصفت مِنْهُم السرائر، وصاروا صفوة الله فِي أرضه، فَفَاضَتْ عَلَيْهِم أنواره، وامتلأت قُلُوبهم من معارفه.
ألا إن وَادي الْجزع أضحى ترابه
من الْمس كافورًا وأعواده رندا
وَمَا ذَاك إلَّا أن هندًا عَشِيَّة
تمشت وَجَرت فِي جوانبه بردا( )
فَلَا تجهد نَفسك فِي كشف حقائقهم، وذوق دقائقهم، حَتَّى تتصل مِنْهُم بِسَبَب، وتتمسك من هديهم بِطرف، فلسان حَالهم ينشدك:
وَكم سَائل عَن سر ليلى رَددته
بعمياء من ليلى بِغَيْر يَقِين
يَقُولُونَ: خبرنَا فَأنت أمينها
وَمَا أنا إن خبرتهم بأمين( )
فهم الْقَوْم الَّذين لَا يشقى جليسهم، وَلَا يستوحش أنيسهم، قد نالوا مطالبهم بِرَفْع أكفهم إلَى خالقهم، لَا يَحْتَاجُونَ فِي حوائجهم إلَّا إلَيْهِ، وَلَا يعولون إلَّا عَلَيْهِ.
ونُبِّئْتُ ليلى أرْسلت بشفاعة
إلَيّ فَهَلا نفس ليلى شفيعها
أأكرم من ليلى عليّ فترتجى
بِهِ الْوَصْل أم كنت امْرءًا لَا أطيعها؟( )
وَقَول ابْن حجر فِي كَلَامه الَّذِي نَقَلْنَاهُ [هُنَا]( )، أنه قد تقدم الْجَواب عَمَّا يتَخَلَّف، هُوَ كَلَام لَا حَاصِل لَهُ؛ لِأن الاستشكال الَّذِي قدمه، هُوَ على مَا يَقتْضِيه الحَدِيث الْقُدسِي الَّذِي نَحن بصدد شَرحه، فَأجَاب عَن الْإشْكَال بِمَا ذكره سَابِقًا من قَوْله: وَالْجَوَاب: أن الْإجَابَة تتنوع؛ فَتَارَة قد يَقع الْمَطْلُوب بِعَيْنِه... إلَى آخر كَلَامه.
فَإن كَانَ هَذَا الْجَواب مِنْهُ، الَّذِي جعله متنوعًا، هُوَ عَمَّا أوردهُ من استشكال( ) مَا فِي هَذَا الحَدِيث، من قَوْله فِيهِ: «إن سَألَني لأعطينه، وَلَئِن استعاذني لأعيذنه»، فَكَلَامه هُنَا حَيْثُ قَالَ: إن من أتَى بِمَا وَجب عَلَيْهِ، وتقرب بالنوافل، لم يرد دعاؤه؛ لوُجُود هَذَا الْوَعْد الصَّادِق الْمُؤَكّد بالقسم، هُوَ كَلَام على ذَلِك اللَّفْظ الَّذِي أورد الْإشْكَال عَلَيْهِ، ومجموع كلاميه هما فِي شرح ذَلِك اللَّفْظ، فَمَا معنى قَوْله: إنَّه قد تقدم الْجَواب عَمَّا يتَخَلَّف؟
فَإن كَانَ التَّخَلُّف وَغير التَّخَلُّف بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَلِيّ، الَّذِي وعده الله بذلك الْوَعْد، فقد تنَاقض كَلَامه. وَإن كَانَ مُرَاده أنه قد يتَخَلَّف تَارَة، وَيَقَع الْمَطْلُوب بِعَيْنِه تَارَة، فَكَلَامه السَّابِق قد تضمن هَذَا، بل صرح بِهِ تَصْرِيحًا، لَا يبْقى بعده ريب، فَمَا معنى تَكْرِير الْكَلَام، بِمَا يُوهم أن دُعَاء الْوَلِيّ لَا يرد على كل حَال.
ملازمة المحب للدعاء :
ثمَّ قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح»( ): وَفِيه: أن العَبْد - وَلَو بلغ أعلَى الدَّرَجَات، حَتَّى يكون محبوبًا لله - لَا يَنْقَطِع عَن الطّلب من الله تَعَالَى؛ لما فِيهِ من الخضوع لَهُ، وَإظْهَار الْعُبُودِيَّة. انْتهى.
أقُول: إذا كَانَ أنْبيَاء الله صلوات الله تعالى وسلامه عليهم( )، لَا ينقطعون عَن الطّلب من الله [سبحانه]( )، والرجاء لَهُ، وَالْخَوْف مِنْهُ، حَتَّى قَالَ سيد ولد آدم صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم [أ:109] كَمَا صَحَّ عَنهُ: «وَالله مَا أدْرِي - وَأنا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]( ) - مَا يفعل بِي»( ). مَعَ أنه الَّذِي غفر الله لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأخّر.
وَيَقُول كَمَا صَحَّ عَنهُ، من شدَّة خَوفه من ربه [۵]( ): «لَو علمْتُم مَا أعلم، لضحكتم قَلِيلًا، ولبكيتم كثيرًا...»( ) الحَدِيث الَّذِي تقدم، حَتَّى قَالَ فِي آخِره: «وددت( ) أنِّي شَجَرَة تعضد»( ).
فَإذا كَانَ مقَام النُّبُوَّة، الَّذِي هُوَ أعلَى مقَام، وَأرْفَع رُتْبَة، وَلَيْسَ مقَام الْولَايَة بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ إلَّا كمقام التَّابِع من الْمَتْبُوع، وَالْخَادِم من المخدوم، فَكيف يحْتَاج أن يُقَال: إنَّه لَا يَنْقَطِع عَن الطّلب من الله تعالى، مَعَ انْتِفَاء الْعِصْمَة عَنهُ، وثبوتها لمن لم يَنْقَطِع عَن الطّلب من الله سُبْحَانَهُ.
بلَ كَانَ نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم مديمًا لدعاء ربه فِي جَمِيع أحْوَاله، مستمرًا على طلب حَوَائِجه الدُّنْيَوِيَّة والأخروية من خالقه، لَا يَعْتَرِيه ملل، وَلَا يتَعَلَّق بِهِ كلل، وَله من الْعِبَادَة - على اخْتِلَاف أنْوَاعهَا - مَا لَا يلْحقهُ بِهِ غَيره، وَلَا يطيقه سواهُ.
فَكيف يَنْقَطِع الْوَلِيّ عَن الطّلب، فَإنَّهُ إن فعل ذَلِك، كَانَ ممكورًا بِهِ، وَرجع عدوًا لله، بعد أن كَانَ وليًّا لَهُ، وبغيضًا لَهُ، بعد أن كَانَ حبيبًا لَهُ. اللَّهُمَّ أحسن عاقبتنا فِي الْأمُور كلهَا، وأجرنا من خزي الدُّنْيَا، وَعَذَاب الْآخِرَة.
وشأن كل عبد من عباد الله، إذا ازْدَادَ قربًا إلَى الله، وَصَارَ من المحبوبين لَهُ، أن يزْدَاد خضوعًا [لَهُ]( )، وتضرعًا إلَيْهِ، وتذللًا، وتمسكنًا، وَعبادَة. وَكلما ارْتَفع عِنْد ربه دَرَجَة، زَاد فِيمَا يُحِبهُ الله [مِنْهُ]( ) دَرَجَات، هَذَا شَأْن الْعُبُودِيَّة.
وَإذا كَانَ هَذَا هُوَ الْكَائِن فِيمَا بَين العَبْد وسيده فِي بني آدم، فَكيف لَا يكون فِيمَا بَين العَبْد وخالقه، ورازقه، ومحييه، ومميته.
ضلال المدعين لرفع التّكليف:
وَمَا أقبح مَا يحْكى عَن بعض المتلاعبين بِالدّينِ، المدعين للتصوف، أنهم يَزْعمُونَ أنهم قد وصلوا إلَى رَبهم، فَانْقَطَعت عَنْهُم التكاليف الشَّرْعِيَّة، وَخَرجُوا من جيل الْمُسلمين الْمُؤمنِينَ، وَسقط عَنْهُم مَا كلف الله بِهِ الْعباد فِي هَذِه الدَّار. فَإذا صَحَّ هَذَا، فَمَا يَقُوله أحد من أوْلِيَاء الرَّحْمَن، بل يَقُوله أوْلِيَاء الشَّيْطَان؛ لأنهم خَرجُوا إلَى حزبه، وصاروا من جملَة أتْبَاعه.
فالعجب لهَؤُلَاء المغرورين، فَإنَّهُم رفعوا أنفسهم عَن طبقَة الْأنْبِيَاء، وطبقة الْمَلَائِكَة، فَإن الْأنْبِيَاء حَالهم كَمَا عرفناك؛ من إدامة الْعِبَادَة لله [تعالى]( ) فِي كل حَال، والازدياد من التقربات المقربة( ) إلَى الله [سبحانه]( ) حَتَّى تَوَفَّاهُم الله تَعَالَى. وَكَذَلِكَ الْمَلَائِكَة، فَإنَّهُم كَمَا وَردت بذلك الْأدِلَّة، لَا ينفكون عَن الْعِبَادَة لله، وَصَارَت أذكاره سُبْحَانَهُ من التَّسْبِيح، والتكبير، والتهليل، هِيَ زادهم الَّذِي يعيشون بِهِ، وغذاؤهم الَّذِي يتغذون( ) بِهِ.
فحاشا لأولياء( ) الله سُبْحَانَهُ أن يَقع من أحقرهم فِي هَذِه الْمرتبَة الْعَظِيمَة، وأدناهم فِي هَذَا المنصب الْجَلِيل، هَذَا الزَّعْم الْبَاطِل، وَالدَّعْوَى الشيطانية، وَإنَّمَا ذَلِك الشَّيْطَان سوَّل لجَماعَة من أتْبَاعه، ومُطِيعِيه، واستزلهم، وأخرجهم من حزب الله [تعالى]( ) إلَى حزبه، وَمن طَاعَة الله [سبحانه]( ) إلَى طَاعَته، وَمن ولَايَة الله سُبْحَانَهُ( ) إلَى ولَايَته.
وَقد رَأينَا فِي تراجم جمَاعَة من أهل الله وأوليائه، أنهم سمعُوا خطابًا من فَوْقهم، وَرَأوا صُورَة تكلمهم، وَتقول: يَا عَبدِي، قد وصلت إلَيّ، وَقد أسقطت عَنْك التكاليف الشَّرْعِيَّة بأسرها، فَعِنْدَ أن يسمع مِنْهُم السَّامع [ذَلِك]( )، يَقُول: مَا أظُنك أيهَا الْمُتَكَلّم إلَّا شَيْطَانًا، فأعوذ بِاللَّه مِنْك، فَعِنْدَ ذَلِك تتلاشى تِلْكَ الصُّورَة، وَلَا يبْقى لَهَا أثر.
فقد بلغ كيد الشَّيْطَان إلَى هَذَا الكيد الْعَظِيم، وَلكنه لم ينْفق كَيده هَذَا على أوْلِيَاء الله سُبْحَانَهُ، فَردُّوهُ فِي نَحره، حَتَّى إنَّه قد يتطاير عِنْد ذَلِك التلاشي شررًا، كَمَا وَقع لكثير مِنْهُم.
فَهَذَا الَّذِي يزْعم أنه من أوْلِيَاء الله، قد كاده الشَّيْطَان بِهَذِهِ الْحِيلَة، واجتذبه إلى حزبه بِهَذَا الْمَكْر، فانخدع وَعَاد سَعْيه ضلالًا، وعبادته كفرًا، وَعَمله خسرًا، وَسبب ذَلِك مَا هُوَ فِيهِ من الْجَهْل بالشريعة المطهرة، وَلَوْلَا ذَلِك؛ لَكَانَ لَهُ من أنوار الدّين، وحجج الشَّرْع، مَا يرد عَنهُ كيد الشَّيْطَان الرَّجِيم، كَمَا رده أوْلِيَاء الله، فَعَاد خاسئًا وَهُوَ حسير.
وَقد عرفناك أن دَعْوَى الْولَايَة، إذا لم تكن مربوطة بِالشَّرْعِ، مُقَيّدَة بِالْكتاب وَالسّنة، ضل صَاحبهَا وَهُوَ لَا يدْرِي، ومكر بِهِ وَهُوَ لَا يشْعر، وَوَقع فِي مغاضب الله سُبْحَانَهُ، وَهُوَ يظنّ أنه فِي مراضيه.
وَمَا أحسن قَول الشَّاعِر:
فَسَاد كَبِير عَالم متهتك
وأفسد مِنْهُ جَاهِل متنسك
هما فتْنَة للْعَالمين كَبِيرَة
لمن بهما فِي دينه يتَمَسَّك( )
تردد الله سبحانه عن قبض نفس عبده صفة له تعالى على حقيقتها:
* قوله: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المُؤمن»، فِي حَدِيث عَائِشَة: «عَن مَوته».
التَّرَدُّد( ): التَّوَقُّف عَن الْجَزْم بِأحد الطَّرفَيْنِ، وَلأجل كَون هَذَا مَعْنَاهُ عِنْد أهل اللُّغَة، احْتَاجَ شرَّاح الحَدِيث إلَى تَأْوِيله بِوُجُوه.
قَالَ الْخطابِيّ: التَّرَدُّد فِي حق الله تَعَالَى غير جَائِز، والبداء عَلَيْهِ فِي الْأمُور غير سَائِغ، وَلَكِن لَهُ تأويلان( ).
أحدهَما( ): أن العَبْد قد يشرف على الْهَلَاك فِي أيَّام عمره من دَاء يُصِيبهُ، وفاقة تنزل بِهِ، فيدعو الله تَعَالَى، ويستغيثه، فيشفيه مِنْهَا، وَيدْفَع عَنهُ مكروهها، فَيكون ذَلِك من فعله، كتردد من يُرِيد أمرًا لم( ) يَبْدُو لَهُ، فيتركه، ويعرض عَنهُ، وَلَابُد لَهُ من لِقَائِه إذا بلغ الْكتاب أجله. وَلِأن الله تَعَالَى قد كتب الفناء على خلقه، واستأثر بِالْبَقَاءِ لنَفسِهِ. انْتهى الْوَجْه الأول( ).
أقُول: مَا أبرد هَذَا التَّأْوِيل وأسمجه، وَأقل فائدته( )، فَإن صُدُور الشِّفَاء من الله تعالى لذَلِك الَّذِي أصَابَهُ الدَّاء، فشفاه مِنْهُ، لَيْسَ من التَّرَدُّد فِي شَيْء، بل هُوَ أمر وَاحِد، وَجزم لَا تردد فِيهِ قطّ.
وَكَذَلِكَ إنْزَال الْمَرَض بِهِ جزم لَا تردد فِيهِ، فهما قَضَاء بعد قَضَاء، وقدَر بعد قدر، وَإن كَانَا باعْتِبَار( ) شخص وَاحِد، فهما مُخْتَلِفَانِ متغايران، لم يتحدا ذاتًا، وَلَا وقتًا، وَلَا زَمَانًا، وَلَا صفة، بل قضى الله على عَبده بِالْمرضِ، ثمَّ شفَاه مِنْهُ. فَأي مدْخل للتردد أو لما يشبه التَّرَدُّد، أو لما يَصح أن يُؤَل بِهِ التَّرَدُّد فِي مثل هَذَا.
وَقد ذكر أهل الْعلم أن التَّأْوِيل لما احتِيج إلَى تَأْوِيله، لَابُد أن يكون مَقْبُولًا على وَجه، وَله مدْخل على حَاله، وَإلَّا وَقع تَحْرِيف الْكَلِمَات الإلهية والنبوية، لمن شَاءَ، كَيفَ شَاءَ، وتلاعب بهما من شَاءَ، بِمَا شَاءَ.
قَالَ الْخطابِيّ: الثَّانِي( ): أن يكون مَعْنَاهُ: مَا رددت رُسُلِي فِي شَيْء أنا فَاعله، كترديدي إيَّاهُم فِي نفس الْمُؤمن، كَمَا روي فِي قصَّة مُوسَى ڠ، وَمَا كَانَ من لطمه عين ملك الْمَوْت، وَتردده إلَيْهِ مرّة بعد أخْرَى. قَالَ: وَحَقِيقَة الْمَعْنى على الْوَجْهَيْنِ عطف الله تَعَالَى على العَبْد، ولطفه بِهِ، وشفقته عَلَيْهِ. انْتهى.
أقُول: جعل التَّرَدُّد - الَّذِي مَعْنَاهُ التَّوَقُّف عَن الْجَزْم بِأحد الطَّرفَيْنِ - بِمَعْنى الترديد، الَّذِي هُوَ الرَّد مرّة بعد مرّة، وهما مُخْتَلِفَانِ مفهومًا وصدقًا. فحاصله: إخْرَاج التَّرَدُّد عَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ، إلَى معنى لَا يلاقيه، وَلَا يلابسه، بِوَجْه من الْوُجُوه، فَلَيْسَ هَذَا من التَّأْوِيل فِي شَيْء.
قَالَ فِي «الْفَتْح»( ) - بعد أن ذكر كَلَام الْخطابِيّ بِاللَّفْظِ الَّذِي حكيناه -: وَقَالَ الكلاباذي مَا حَاصله: إنه عبر عَن صفة الْفِعْل بِصفة الذَّات؛ أي: عَن الترديد بالتردد( )، وَجعل مُتَعَلق الترديد اخْتِلَاف أحْوَال العَبْد؛ من ضعف، ونَصَب، إلَى أن تنْتَقل محبته فِي الْحَيَاة، إلَى محبته فِي الْمَوْت، فَيقبض على ذَلِك.
قَالَ: وَقد يحدث الله تَعَالَى فِي قلب عَبده من الرَّغْبَة فِيمَا عِنْده، والشوق إلَيْهِ، والمحبة للقائه، مَا يشتاق مَعَه إلَى الْمَوْت، فضلًا عَن إزَالَة الْكَرَاهَة عنه، فَأخْبرهُ أنه يكره الْمَوْت، ويسوءه، فَيكْرَه الله تَعَالَى مساءته، فيزيل عَنهُ كَرَاهَة الْمَوْت، بِمَا يُورِدهُ عَلَيْهِ من الْأحْوَال، فيأتيه الْمَوْت، وَهُوَ لَهُ مُؤثر، وَإلَيْهِ مشتاق.
قَالَ: وَقد ورد تفَعَّل بِمَعْنى فَعَل، مثل: تَفَكَّر، وفَكَّرَ، وتَدَبَّر، ودَبَّرَ، وتهدد، وهدد. وَالله أعلم( ). انْتهى.
أقُول: كَلَامه هَذَا قد اشْتَمَل على أمريْن؛ أحدهمَا: هُوَ كالتفسير لما ذكره الْخطابِيّ، وَلكنه ربطه بغاية، هِيَ قَوْله: إلَى أن تنْتَقل محبته فِي الْحَيَاة، إلَى محبته فِي الْمَوْت، فَصَارَ كَلَامه بِهَذِهِ الْغَايَة أتم من كَلَام الْخطابِيّ، فَإنَّهُ إنَّمَا جعل حَاصِل الْوَجْهَيْنِ اللذين( ) ذكرهمَا، هُوَ عطف الله على العَبْد، ولطفه بِهِ، وشفقته عَلَيْهِ.
وَيُقَال للكلاباذي: غَايَة مَا جَاءَ بِهِ التَّأْوِيل الَّذِي ذكرته، أن التَّرَدُّد الَّذِي حَكَاهُ الله [تعالى]( ) عَن نَفسه، هُوَ انْتِقَال العَبْد من حَالَة إلَى حَالَة، فأخرجت التَّرَدُّد عَن مَعْنَاهُ، وأخرجت المتردد إلَى اخْتِلَاف أحْوَال المتردَد فِي شَيْء من الْأمُور الْمُتَعَلّقَة بِهِ، وَهَذَا إخْرَاج للمعنى إلَى معنى مُغَاير لَهُ بِكُل حَال، وعَلى كل وَجه.
وَيُقَال للخطابي: جعلت التَّرَدُّد فِي الْمَوْت عطف الله على الْعبد، ولطفه بِهِ، وشفقته عَلَيْهِ، وَهَذَا معنى لَا جَامع بَينه وَبَين التَّرَدُّد فِي موت العَبْد، فَإن لطف الله على عباده، وَعطفه عَلَيْهِم، وشفقته بهم، أمر مَقْطُوع بِهِ، لَا تردد فِيهِ مِنْهُ ۵.
وَأما مَا ذكره الكلاباذي، من قَوْله: وَقد يحدث الله [تعالى]( ) فِي قلب عَبده من الرَّغْبَة فِيمَا عِنْده، والشوق إلَيْهِ... إلخ، فَهُوَ تَكْرِير لقَوْله قبله: إلَى أن تنْتَقل محبته فِي الْحَيَاة، إلَى محبته فِي الْمَوْت، وَقد قدمنَا الْجَواب عَنهُ.
وَأما قَوْله: وَقد ورد تفعَّل بِمَعْنى فعل، مثل: تفكر، [وفكر]( )... إلخ، فَأقُول: هَذَا مُسلم فِيمَا لم يخرج مِنْهُ الْمَعْنى إلَى معنى آخر، فَإن فكر، وتفكر، لم يخرجَا عَن معنى حُصُول الفكرة للْعَبد فِي شَيْء متفكر فِيهِ، وَكَذَلِكَ دبَّر وتدبَّر، فَإنَّهُمَا راجعان إلَى معنى التَّدْبِير، وَكَذَلِكَ هدد وتهدد. وَأما التَّرَدُّد والترديد، فَلَا يرجعان إلَى معنى كَمَا بَينا، بل لكل وَاحِد مِنْهُمَا معنى مُسْتَقل يغاير معنى الآخر لمن تدبر وتفكر.
قَالَ فِي «الْفَتْح»( ): وَعَن بَعضهم: يحْتَمل أن يكون تركيب الْوَلِيّ يحْتَمل أن يعِيش خمسين سنة، وعمره الَّذِي كتب لَهُ سَبْعُونَ، فَإذا بلغَهَا، فَمَرض، دَعَا الله تَعَالَى بالعافية، فَيُجِيبهُ عشْرين أخْرَى مثلًا، فَعبر عَن قدر التَّرْكِيب، وَعَما انْتهى إلَيْهِ، بِحَسب الْأجَل الْمَكْتُوب، بالتردد. انْتهى.
أقُول: هَذَا التَّأْوِيل لم يَأْتِ بفائدة قطّ، فَإن الْعُمر - الَّذِي هُوَ السبعون - لَابُد أن يبلغهُ العَبْد على اعْتِقَاد هَذَا الْقَائِل، سَوَاء كَانَ التَّرْكِيب مُحْتملًا لذَلِك أم لَا، وَسَوَاء مرض عِنْد انْتِهَاء عمره إلَى خمسين أو لم يمرض، وَسَوَاء دَعَا الله بالعافية أو لم يدع، فَإنَّهُ لَابُد أن يبلغ السّبْعين، وَغَايَة مَا هُنَاكَ: أن الله [تعالى]( ) رَحمَه ولطف بِهِ، فشفاه من مَرضه الَّذِي عرض لَهُ، وَهُوَ فِي خمسين سنة. فَأي شَيْء هَذَا، وَمَا الْجَامِع بَينه وَبَين معنى التَّرَدُّد الْمَذْكُور فِي الحَدِيث.
قَالَ فِي «الْفَتْح»( ): وَعبر ابْن الْجَوْزِيّ( ) [عَن الثَّانِي]( )؛ بِأن التَّرَدُّد للْمَلَائكَة الَّذين يقبضون الرّوح، فأضاف الْحق ذَلِك لنَفسِهِ؛ لِأن ترددهم عَن أمره، قَالَ: وَهَذَا التَّرَدُّد ينشأ عَن إظْهَار الْكَرَاهَة، فَإن قيل: إذا أمر الْملك بِالْقَبْضِ، كَيفَ يَقع مِنْهُ التَّرَدُّد؟ فَالْجَوَاب: أنه مُتَرَدّد فِيمَا لم يُحدّ لَهُ فِيهِ الْوَقْت، كَأن يُقَال: لَا تقبض روحه إلَّا إذا رضي. انْتهى.
أقُول: انْظُر مَا فِي هَذَا الْكَلَام من الْخبط والخلط، فَإنَّهُ - أولًا( ) - جعل التَّرَدُّد للْمَلَائكَة، فَأخْرج الْكَلَام عَن مَعْنَاهُ إخراجًا لَا يبْقى للمعنى الْأصْلِيّ مَعَه أثر قطّ، وَكَأنَّهُ جعله من الْمجَاز الْعقلِيّ؛ كَقَوْلِهم: بنى الْأمِير الْمَدِينَة، وَهُوَ عَنهُ أجْنَبِي، فَإنَّهُ قد وَقع الْبناء فِي الْخَارِج، وَإنَّمَا نسب الْفِعْل إلَى الْأمير( ).
وَأما هَذَا؛ فَلم يكن للتردد الْوَاقِع من الْمَلَائِكَة فَائِدَة قطّ، وَلَا وجد فِي الْخَارِج لَها أثر. ثمَّ قَالَ: وَهَذَا التَّرَدُّد ينشأ عَن إظْهَار الْكَرَاهَة، فَيُقَال: إن كَانَ هَذَا الْإظْهَار من جِهَة الرب سُبْحَانَهُ، فَهُوَ يحْتَاج إلَى تَأْوِيل آخر، كَمَا احْتِيجَ التَّرَدُّد إلَى تَأْوِيل، فَإن الكرهة( ) لا تجوز عَلَيْهِ بِهَذَا الْمَعْنى.
ثمَّ لم يظْهر لهَذَا الْإظْهَار فَائِدَة، فَإن [ذَلِك]( ) العَبْد الَّذِي وَقع التَّرَدُّد فِي قبض روحه، لم يمت إلَّا بأجله المحتوم، من دون أن يتَقَدَّم عَنهُ سَاعَة، أو يتَأخَّر عَنهُ سَاعَة. ثمَّ انْظُر إلَى مَا أوردهُ على نَفسه من قَوْله: فَإن قيل: إذا أمر الْملك بِالْقَبْضِ، كَيفَ يَقع مِنْهُ التَّرَدُّد؟ وَهَذَا إيرَاد وَارِد، فَإنَّهُم لَا يعصون الله فِيمَا أمرهم، وَلَا يتراخون عَن إنجاز أمره سُبْحَانَهُ. ثمَّ انْظُر إلَى سُقُوط مَا أجَاب، من أن الْملك مُتَرَدّد فِيمَا لم يحد لَهُ فِيهِ الْوَقْت، وَكَيف يُؤمر الْملك بِفعل غير مَحْدُود، ثمَّ يُسَارع إلَى فعله؟!
وأما قَوْله: كَأن يُقَال لَهُ: لَا تقبض روحه إلَّا إذا رضي( )، فَهُوَ مَعَ كَونه يبطل التَّأْوِيل بالمرة، والكره لَيْسَ للْملك أن يفعل إلَّا مَا يرضى بِهِ العَبْد، من قبض روحه أو عَدمه؛ لِأنَّهُ قد علق ذَلِك بِرِضَاهُ، وَحِينَئِذٍ لَا ينجز الْفِعْل إلَّا عِنْد الرضا من العَبْد، والمفروض أنه يكره الْمَوْت، كَمَا نطق بِهِ هَذَا الحَدِيث الْقُدسِي. فَعِنْدَ أن يعرف الْملك أن العَبْد لَا يرض بِقَبض روحه، مَا بَقِي إلَّا الْإمْهَال لَهُ حَتَّى يرضى، وإن خَالف الْوَقْت الْمَحْدُود لمَوْته، وَحِينَئِذٍ ينفتح إشْكَال أكبر( ) من هَذَا الْإشْكَال الَّذِي هم بصدد تَأْوِيله.
قَالَ فِي «الْفَتْح»( ): ثمَّ ذكر ابْن الْجَوْزِيّ جَوَابا ثَانِيًا، وَهُوَ احْتِمَال أن يكون معنى التَّرَدُّد، اللطف بِهِ، كَأن الْملك يُؤَخر الْقَبْض، فَإنَّهُ إذا نظر إلَى قدر الْمُؤمن، وَعظم الْمَنْفَعَة بِهِ لأهل الدُّنْيَا، احترمه، فَلَا يبسط يَده إلَيْهِ، فَإذا ذكر أمر ربه تَعَالَى، لم يجد بدًّا من امتثاله. انْتهى.
أقُول( ): هَذَا اللطف الَّذِي بنى عَلَيْهِ هَذَا الْجَواب، لم يظْهر لَهُ أثر، وَلَا تبين لَهُ معنى، فَإن الْملك، وَإن تردد، فَهُوَ لَا محَالة سيقبض الرّوح فِي الْوَقْت الْمَحْدُود، وَوُقُوع ذَلِك الشَّيْء فِي نَفسه لم يجد لَهُ العَبْد فَائِدَة، وَلَا علم بِهِ، فضلًا عَن أن يصل إلَيْهِ مِنْهُ مَنْفَعَة.
فَهَذَا اللطف لَيْسَ بلطف أصلًا، وَإن( ) فَرضنَا أنه بِتِلْكَ الرأفة على العَبْد، لكَونه مِمَّن ينْتَفع الْعباد بِهِ، كَانَ بهَا تَأْخِير قبض روح العَبْد لَحْظَة، وَأن مُجَرّد ذَلِك [يعد]( ) لطفًا، فَإنَّهُ يرد عَلَيْهِ إشْكَال أعظم من الْإشْكَال الَّذِي هم بصدد تَأْوِيله، وَهُوَ أن الْأجَل المحتوم قد تَأخّر عَن وقته، بِسَبَب تراخي الْملك عَن إنْفَاذ ما أمر الله بِهِ، وحاشا الْملك أن يكون مِنْهُ هَذَا، وحاشا الْأمر الإلهي أن لَا ينجز حسب الْمَشِيئَة الربانية، فَمَا أحَق صَاحب هَذَا التَّأْوِيل بقول الشَّاعِر:
فَكنت كالساعي إلَى مثعب
موائلًا من سبل الراعد
قَالَ فِي «الْفَتْح»( ): وجوابًا رَابِعًا: وَهُوَ أن يكون خطابًا لنا بِمَا نعقل، والرب ۵ يتنزه( ) عَن حَقِيقَته( )، بل هُوَ من جنس قَوْله: «وَمن( ) أتَانِي يمشي، أتَيْته هرولة»( )، فَكَمَا أن أحَدنَا يُرِيد أن يضْرب وَلَده تأديبًا، فتمنعه الْمحبَّة، وتبعثه الشَّفَقَة، فيتردد بَينهمَا، وَلَو كَانَ غير الْوَالِد، كالمعلم، لم يتَرَدَّد، بل كَانَ لَا يُبَالِي، بل يُبَادر إلَى ضربه لتأديبه، فَأرِيد تفهيمنا بتحقيق الْمحبَّة للْوَلِيّ بِذكر التَّرَدُّد( ). انْتهى.
أقُول: هَذَا التَّأْوِيل هُوَ أحسن مِمَّا تقدم من تِلْكَ الْوُجُوه، فَإنَّهُم قد أولُوا مَا لا يجوز على الله سُبْحَانَهُ، من مثل التَّعَجُّب، والاستفهام، وَنَحْوهمَا، مِمَّا يرد هَذِه الْمَوَارِد، فإن( ) ذَلِك بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعباد المخاطبين، وَلَكِن هَذَا الْمقَام الَّذِي نَحن بصدده، هُوَ مقَام أوْلِيَاء الله، وأحبائه( )، وصفوته من خلقه، وخالصته من عباده.
وَفِيه التَّرْغِيب للعباد؛ بِأن يحرصوا على هَذِه الرُّتْبَة، وعَلى الْبلُوغ إلَيْهَا، بِمَا تبلغ إلَيْهِ طاقاتهم( )، وَتصل إلَيْهِ قدرتهم، وَلَا يألون جهدًا فِي تَحْصِيل أسبَابهَا الموصلة إلَيْهَا، من التَّقَرُّب إلَى الله سُبْحَانَهُ بِمَا يحب.
فَلَابُد أن يكون لذَلِك التَّرَدُّد فَائِدَة تعود على الْوَلِيّ، حَتَّى يكون ذَلِك سَببًا لتنشيط الْعباد إلَى بُلُوغ رتبته. وَأما إذا كَانَ يَمُوت بأجله المحتوم، فَهُوَ كَغَيْرِهِ من عباد الله، من غير فرق بَين سعيدهم، وشقيهم، وصالحهم، وطالحهم.
قَالَ فِي «الْفَتْح»( ): وجوَّز الْكرْمَانِي( ) احْتِمَالًا آخر، وَهُوَ أن المُرَاد: أنه يقبض روح الْمُؤمن بالتأني والتدريج، بِخِلَاف سَائِر الْأمْوَات، فَإنَّهَا تحصل بِمُجَرَّد قَول كن سَرِيعًا. انْتهى.
أقُول: هَذَا التأني والتدريج، إن كَانَ لَهُ تَأْثِير فِي تأخير الْأجَل، وَلَو يَسِيرًا، رَجَعَ الْإشْكَال بأعظم مِمَّا نَحن بصدده؛ لِأنَّهُ قد تَأخّر عَن وقته الْمَحْدُود، وأجله المحتوم. وَإن كَانَ لَا تَأْثِير لَهُ، فَلَا نفع فِيهِ للْعَبد أصلًا، بل قد يكون قبض روحه دفْعَة وَاحِدَة، من غير تراخ، وَلَا تدريج، أسهل عَلَيْهِ من قَبضه على خلاف ذَلِك.
فَإن قلت: إذا لم ترض( ) شَيْئًا من هَذِه التأويلات، فَأبِنْ لنا مَا لديك، حَتَّى نَنْظُر فِيهِ. قلت: ستعرف مَا لدي فِي ذَلِك إن شَاءَ الله [تعالى] ( )، لَكِن لَابُد هَاهُنَا من تَقْدِيم مُقَدّمَة يَتَّضِح بهَا الْكَلَام، ويتبين بهَا الصَّوَاب، فافهمها حق فهمها، وتدبرها حق تدبرها.
المحو والإثبات في المقادير عند المصنف( ):
اعْلَم؛ أن كثيرًا من أهل الْعلم لما نظرُوا فِي آيَات وَأحَادِيث، تدل على أن مَا قد سبق بِهِ الْقَضَاء لَا يتَحَوَّل، وَأنه لَيْسَ فِي هَذِه( ) الدَّار إلَّا مَا قد فرغ مِنْهُ من قَلِيل، وَكثير، وجليل، ودقيق، مُحَافظَة على مَا ورد مِمَّا يدل على ذَلِك، ووقوفًا عِنْد قَوَاعِد مقررة، قد تقررت عِنْد أهل الْكَلَام، حَتَّى قَالَ قَائِلهمْ: إنَّه لَو وَقع غير مَا قد سبق بِهِ الْقَلَم، وَفصل بِهِ الْقَضَاء، للَزِمَ لَازم بَاطِل، وَهُوَ انقلاب الْعلم جهلًا؛ لتخلف مَا قد حق بِهِ الْقَضَاء.
فقصروا أنظارهم على هَذَا الْإلْزَام، وغفلوا عَن لُزُوم مَا هُوَ أشد مِنْهُ، وَهُوَ أن الرب الْقَادِر الْقوي الْمُتَصَرف فِي عالمه بِمَا يَشَاء، وَكَيف يَشَاء، لم يبْق لَهُ تعالى إلَّا مَا قد سبق بِهِ قَضَاؤُهُ، وَلَا يتَمَكَّن من تَغْيِيره، وَلَا من نَقله، إلَى قَضَاء آخر. وَهَذَا تَقْصِير عَظِيم بالجناب الْعلي تعالى وَتَعَالَى وتقدس، وَهُوَ يسْتَلْزم إهمال كثير من الْأدِلَّة الشَّرْعِيَّة من الْكتاب وَالسّنة( ).
فَمِنْهَا: إهمال مَا أرشدنا إلَيْهِ سُبْحَانَهُ من التضرع إلَيْهِ، وَالدُّعَاء لَهُ؛ لِأنَّهُ لَيْسَ للداعي إلَّا مَا قد جف بِهِ الْقَلَم، دَعَا أو لم يدع( ). وَهَذِه مقَالَة تبطل بهَا فَائِدَة الدُّعَاء، الَّذِي أرشدنا سُبْحَانَهُ إلَيْهِ فِي كِتَابه الْعَزِيز. وَقَالَ: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [غافر: 60]، وَجعل ترك دُعَائِهِ من الاستكبار عَلَيْهِ، وتوعد عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ( ): ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ الآية، وَقَالَ: ﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [النساء: 32]، وَقَالَ: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ [ﯝ ﯞ]( )﴾ [النمل: 62]، وَقَالَ: ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [البقرة: 186].
فَأخْبرنَا سُبْحَانَهُ أنه يُجيب دَعْوَة من دَعَاهُ، بعد أن أمرنَا بِالدُّعَاءِ فِي آيَات كَثِيرَة، وَمِنْهَا هَذَا الحَدِيث الْقُدسِي الَّذِي نَحن بصدد شَرحه، فَإنَّهُ قَالَ فِيهِ: «لَئِن سَألَني لأعطينه، وَلَئِن استعاذني لأعيذنه»، وَهُوَ صَادِق، وَلَا يخلف الميعاد، كَمَا أخبرنَا بذلك فِي كِتَابه الْعَزِيز. وَقد أكد الْإجَابَة مِنْهُ للْعَبد فِي هَذَا الحَدِيث الْقُدسِي بالقسم على نَفسه تعالى. فَكيف يتخلف ذَلِك.
وَقد ورد، من التَّرْغِيب فِي الدُّعَاء مَا لَو جمع، لَكَانَ مؤلفًا مُسْتقِلًّا، فَمن ذَلِك مَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، وَمِنْهَا مَا هُوَ صَحِيح كَمَا ستقف عَلَيْهِ.
فَمن مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «قَالَ الله تعالى: أنا عِنْد ظن عَبدِي بِي، وَأنا مَعَه إذا دَعَاني»( ).
وَفِي الحَدِيث الْقُدسِي، الَّذِي أخرجه مُسلم وَغَيره، عَن أبي ذَر: «يَا عبَادي، لَو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم، وجنكم، قَامُوا فِي صَعِيد، فسألوني، فَأعْطيت كل إنْسَان مِنْهُم مَسْألته، مَا نقص ذَلِك مِمَّا عِنْدِي، إلَّا كَمَا ينقص الْمخيط إذا دخل الْبَحْر»( ).
وَأخرج أهل السّنَن، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «الدُّعَاء هُوَ الْعِبَادَة»( )، ثمَّ قَرَأ: ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [غافر: 60].
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة [رضي الله عنه]( ): أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «من سره أن يستجيب الله لَهُ عِنْد الشدائد، فليكثر من الدُّعَاء فِي الرخَاء»( ). وَأخرجه أيْضًا الْحَاكِم، من حَدِيث سلمَان، وَصَححهُ.
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَحسنه، من حَدِيث أنس، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «قَالَ الله: يَا ابْن آدم، إنَّك مَا دعوتني ورجوتني، غفرت لَك، على مَا كَانَ مِنْك، وَلَا أبَالِي»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَالْحَاكِم، وصححاه، من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «مَا على الأرْض مُسلم، يَدْعُو الله بدعوة، إلَّا آتَاهُ الله إيَّاهَا، أو صرف عَنهُ من السوء مثلهَا، مَا لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، فَقَالَ رجل من الْقَوْم: إذًا نكثر، قَالَ: «الله أكثر»( ).
وَأخرج أحْمد، بِإسْنَاد لَا بَأْس بِهِ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «مَا من مُسلم، ينصب وَجهه لله ۵ فِي مَسْألَة، إلَّا أعْطَاهَا إيَّاه؛ إمَّا أن يعجلها لَهُ، وَإمَّا أن يدخرها»( ).
وَأخرج أحْمد، وَالْبَزَّار، وَأبُو يعلى، بأسانيد جَيِّدَة، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «مَا من مُسلم، يَدْعُو بدعوة، لَيْسَ فِيهَا إثْم، وَلَا قطيعة رحم، إلَّا أعطَاهُ الله بهَا إحْدَى ثَلَاث؛ إمَّا أن يعجل لَهُ دَعوته، وَإمَّا أن يدخرها لَهُ فِي الْآخِرَة، وَإمَّا أن يصرف عَنهُ من السوء مثلهَا»، قَالُوا: إذًا نكثر، قَالَ: «الله أكثر»( ).
وَأخرج ابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، والضياء فِي «المختارة»، من حَدِيث أنس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا تعجزوا فِي الدُّعَاء، فَإنَّهُ لن يهْلك مَعَ الدُّعَاء أحد».
وَأخرج الْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «الدُّعَاء سلَاح الْمُؤمن، وعماد الدّين، وَنور السَّمَوَات وَالْأرْض»( ).
وَأخرجه أبُو يعلى، من حَدِيث عَليّ، وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من فتح لَهُ مِنْكُم بَاب الدُّعَاء، فتحت لَهُ أبْوَاب الرَّحْمَة، وَمَا سُئِلَ الله شَيْئًا أحب إلَيْهِ من أن يسْأل الْعَافِيَة، وَالدُّعَاء ينفع مِمَّا نزل، وَمِمَّا لم ينزل، فَعَلَيْكُم عباد الله بِالدُّعَاءِ»( ). وَفِي إسْنَاده عبدالرَّحْمَن بن أبي بكر الْمليكِي، وَفِيه مقَال.
وَأخرج أبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَحسنه، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث سلمَان [رضي الله عنه]( )، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إلَيْهِ يَدَيْهِ، أن يردهما صفرًا خائبتين».
وَأخرج الْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث أنس [رضي الله عنه]( )، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن الله رَحِيم كريم، يستحي من عَبده أن يرفع إلَيْهِ يَدَيْهِ، ثمَّ لَا يضع فيهمَا خيرًا».
وَأخرج أبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث عبدالله بن مَسْعُود [رضي الله عنه]( )، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من نزلت بِهِ فاقة، فأنزلها بِالنَّاسِ، لم تسد فاقته، وَمن نزلت بِهِ فاقة، فأنزلها بِاللَّه، فيوشك الله لَهُ برزق؛ عَاجل، أو آجل»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَابْن أبي الدُّنْيَا، من حَدِيث ابْن مَسْعُود [رضي الله عنه]( )، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «سلوا الله من فَضله، فَإن الله يحب أن يُسأل»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث أنس: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «الدُّعَاء مخ الْعِبَادَة»( ).
وَأخرج أبُو يعلى، من حَدِيث جَابر [رضي الله عنه]( )، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «ألا أدلكم على مَا ينجيكم من عَدوكُمْ، ويدر لكم أرزاقكم، تدعون الله فِي ليلكم ونهاركم، فَإن الدُّعَاء سلَاح الْمُؤمن»( ).
وَأخرج أبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَحسنه، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث عبدالله بن بُرَيْدَة: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم سمع رجلًا يَقُول: اللَّهُمَّ إنِّي أسألك، بِأنِّي أشهد أنَّك أنْت الله لَا إلَه إلَّا أنْت، الْأحَد الصَّمد، الَّذِي لم يلد، وَلم يُولد، وَلم يكن لَهُ كفؤًا( ) أحد، فَقَالَ: «لقد سَألت الله بِالِاسْمِ، الَّذِي إذا سُئِلَ بِهِ أعْطى، وَإذا دعي بِهِ أجَاب»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حسن، من حَدِيث معَاذ [رضي الله عنه]( )، قَالَ سمع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم رجلًا وَهُوَ يَقُول: يَا ذَا الْجلَال وَالْإكْرَام، فَقَالَ: «قد اسْتُجِيبَ لَك فسل»( ).
وَأخرج الْحَاكِم، من حَدِيث أبي أمَامَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن لله ملكًا موكلًا بقول: يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ، فَمن قَالَهَا ثَلَاث مَرَّات، قَالَ الْملك: إن أرْحم الرَّاحِمِينَ قد أقبل عَلَيْك، فسل»( ).
وَأخرج أحْمد، وَأبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث أنس قَالَ: مر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم بِأبي عَيَّاش زيد بن الصَّامِت الزرقي، وَهُوَ يُصَلِّي، وَهُوَ يَقُول: اللَّهُمَّ إنِّي أسألك بِأن لَك الْحَمد، لَا إلَه إلَّا أنْت، المنان، بديع السَّمَوَات وَالْأرْض، يَا ذَا الْجلَال وَالْإكْرَام، يَا حَيّ يَا قيوم، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لقد دَعَا الله باسمه الْأعْظَم، الَّذِي إذا دعي بِهِ أجَاب»( ).
وَمن ذَلِك؛ مَا ورد فِي إجَابَة دَعْوَة الْمَظْلُوم على ظالمه، وَالْأب على وَلَده، وَورد أيْضًا: أن جمَاعَة لَا يرد دعاؤهم، وَالْأحَادِيث بذلك صَحِيحَة ثَابِتَة.
وَالْأحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب كَثِيرَة، وفيهَا التَّرْغِيب فِي الدُّعَاء، ومحبة الله [تعالى]( ) لَهُ.
حَتَّى أخرج التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا: «من لم يسْأل الله، يغْضب عَلَيْهِ»، وَأخرج ابْن أبي شيبَة من حَدِيثه: «من لم يدْعُ الله غضب عَلَيْهِ»( ).
فَلَو لم يكن الدُّعَاء نَافِعًا لصَاحبه، وَأن لَيْسَ لَهُ إلَّا مَا قد كتب لَهُ، دَعَا أو لم يدع، لم يَقع الْوَعْد بالإجابة، وَإعْطَاء الْمَسْألَة، فِي هَذِه الْأحَادِيث وَنَحْوهَا، بل قد ثَبت أن الدُّعَاء يرد الْقَضَاء، كَمَا أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَحسنه، من حَدِيث سلمَان: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «لَا يرد الْقَضَاء إلا الدُّعَاء، وَلَا يزِيد فِي الْعُمر إلَّا الْبر».
وَأخرجه أيْضًا ابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ [أ:117]، وَأخرجه أيْضًا الطَّبَرَانِيّ فِي «الْكَبِير»، والضياء فِي «المختارة».
وَأخرج ابْن أبي شيبَة، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، وَالطَّبَرَانِيّ فِي «الْكَبِير»، من حَدِيث ثَوْبَان: «لَا يرد الْقدر إلَّا الدُّعَاء، وَلَا يزِيد فِي الْعُمر إلَّا الْبر، وَإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يُصِيبهُ»( ).
وَأخرج الْبَزَّار، وَالطَّبَرَانِيّ، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، وَالْبَزَّار، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا يُغني حذر من قدر، وَالدُّعَاء ينفع مِمَّا نزل، وَمِمَّا لم ينزل، وَأن الْبلَاء لينزل، فيتلقاه( ) الدُّعَاء، فيعتلجان إلَى يَوْم الْقِيَامَة»( ). فَهَذِهِ الْأحَادِيث، وَمَا ورد موردها، قد دلّت على أن الدُّعَاء يرد الْقَضَاء، فَمَا بَقِي بعد هَذَا؟( ).
وَمن الْأدِلَّة الَّتِي تدفع مَا قدمْنَاهُ، من قَول أولَئِكَ الْقَائِلين، مَا ورد من الِاسْتِعَاذَة من سوء الْقَضَاء، كَمَا ثَبت الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا: أنه كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «اللَّهُمَّ إنِّي أعوذ بك من سوء الْقَضَاء، ودرك الشَّقَاء، وَجهد الْبلَاء، وشماتة الْأعْدَاء»( )، وَقد قدمنَا هَذَا الحَدِيث.
فَلَو لم يكن للْعَبد إلَّا مَا قد سبق بِهِ الْقَضَاء، لم يستعذ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم من سوء الْقَضَاء. وَمن ذَلِك حَدِيث الدُّعَاء فِي الْوتر، وَفِيه: «وقني شَرّ مَا قضيت»، وَهُوَ حَدِيث صَحِيح، وَإن لم يكن فِي الصَّحِيحَيْنِ، حَسْبَمَا قدمنَا الْإشَارَة إلَيْهِ.
وَمن الْأدِلَّة الَّتِي ترد قَول أولَئِكَ الْقَائِلين، مَا ورد فِي صلَة الرَّحِم، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أنس: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «من أحب أن يبسط لَهُ فِي رزقه، وينسأ لَهُ فِي أثَره، فَليصل رَحمَه»( ).
قَوْله: «ينسأ»: بِضَم الْيَاء، وَتَشْديد السِّين الْمُهْملَة، مَهْمُوز؛ أي: يُؤَخر لَهُ فِي أجله. وَأخرجه البُخَارِيّ وَغَيره، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
وَأخرج الْبَزَّار، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه قَالَ: «مَكْتُوب فِي التوارة: من أحب أن يُزَاد فِي عمره، وَيُزَاد فِي رزقه، فَليصل رَحمَه»( ).
وَأخرج أحْمد، بِإسْنَاد رِجَاله ثِقَات، عَن عَائِشَة [ڤ]( ): أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «صلَة الرَّحِم وَحسن الْجوَار يعمرَانِ الديار وَيَزِيدَانِ فِي الْأعْمَار»( ). وَهُوَ من طَرِيق عبدالرَّحْمَن بن الْقَاسِم، وَلم يسمع من عَائِشَة. وَالْأحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب كَثِيرَة.
فَلَو لم يكن للْعَبد أن مَا قد سبق لَهُ، لم تحصل لَهُ الزِّيَادَة بصلَة رَحمَه، بل لَيْسَ لَهُ إلَّا مَا قد سبق بِهِ الْقَضَاء، وصل رَحمَه أو لم يصل، فَيكون مَا ورد فِي ذَلِك لَغوًا لَا عمل عَلَيْهِ، وَلَا صِحَة لَهُ.
وَمن الْأدِلَّة الَّتِي ترد قَول أولَئِكَ، مَا ورد من الْأمر بالتداوي، وَهِي أحَادِيث ثَابِتَة فِي الصَّحِيح، فلولا أن لذَلِك فَائِدَةـ كَانَ الْأمر بِهِ لَغوًا( ).
إذا عرفت مَا قدمْنَاهُ، فَاعْلَم أن الله سُبْحَانَهُ قَالَ فِي كِتَابه الْعَزِيز: ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [الرعد: 39]، وَظَاهر هَذِه الْآيَة الْعُمُوم الْمُسْتَفَاد من قَوْله ﴿ﯗ ﯘ﴾، فَمَا شَاءَ سُبْحَانَهُ مِمَّا [قد]( ) وَقع فِي الْقَضَاء، وَفِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ محاه، وَمَا شَاءَ أثْبته.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ مثل معنى هَذِه الْآيَة، قَوْله ۵: ﴿ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾ [فاطر: 11]، وَقَوله ۵: ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [الأنعام: 2].
وَقد أجَاب أولَئِكَ الْقَوْم - الَّذين قدمنَا ذكرهم - عَن الْآيَة الأولى بجوابات؛ مِنْهَا: أن المُرَاد: يمحو مَا يَشَاء من الشَّرَائِع والفرائض، فينسخه ويبدله، وَيثبت مَا يَشَاء، فَلَا ينسخه وَلَا يُبدلهُ، وَجُمْلَة النَّاسِخ والمنسوخ عِنْده فِي أم الْكتاب( ).
وَيُجَاب عَن ذَلِك: بِأنَّهُ تَخْصِيص لعُمُوم الْآيَة بِغَيْر مُخَصص، وَأيْضًا يُقَال لَهُم: إن الْقَلَم قد جرى بِمَا هُوَ كَائِن إلَى يَوْم الْقِيَامَة كَمَا فِي الْأحَادِيث الصَّحِيحَة، وَمن جملَة ذَلِك الشَّرَائِع والفرائض، فَهِيَ مثل الْعُمر، إذا جَازَ فِيهَا المحو وَالْإثْبَات، جَازَ فِي الْعُمر المحو وَالْإثْبَات. وكل مَا هُوَ جَوَاب لَهُم عَن هَذَا، فَهُوَ جَوَابنَا عَلَيْهِم.
وَمِنْهَا: أن المُرَاد بِالْآيَةِ محو مَا فِي ديوَان الْحفظَة، مِمَّا لَيْسَ بحسنة وَلَا سَيِّئَة؛ لأنهم مأمورون بكتب مَا ينْطق بِهِ الْإنْسَان( ).
وَيُجَاب عَنهُ بمثل الْجَواب الأول، وَيلْزم فِيهِ مثل اللَّازِم الأول، وَجَمِيع مَا ينْطق بِهِ بَنو آدم من غير فرق بَين أن يكون حَسَنَة أو سَيِّئَة، أو لَا حَسَنَة وَلَا سَيِّئَة، هُوَ فِي أم الْكتاب، و﴿ﭪ ﭫ( ) ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ( )﴾ [ق: 18]، ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [يس: 12]، ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [الأنعام: 38].
وَمِنْهَا: أن المُرَاد: أن الله يغْفر مَا يَشَاء من ذنُوب عباده، وَيتْرك مَا يَشَاء فَلَا يغفره( )، وَيُجَاب عَنهُ بِمثل الْجَواب السَّابِق.
وَمِنْهَا: أن المُرَاد: يمحو مَا يَشَاء من الْقُرُون، فَيَمْحُو قرنًا، وَيثبت قرنًا( )، كَقَوْلِه: ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [يس: 31]، وَقَوله: ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [المؤمنون: 31]، وَيُجَاب عَنهُ بِمثل مَا تقدم.
وَمِنْهَا: أن المُرَاد: الَّذِي يعْمل بِطَاعَة الله، ثمَّ يعمل بمعصيته، [فَيَمُوت]( ) على ضلاله، فَهَذَا الَّذِي يمحوه الله، وَالَّذِي يُثبتهُ؛ الرجل يعْمل بِمَعْصِيَة [الله]( )، ثمَّ يَتُوب، فيمحوه من ديوَان السَّيِّئَات، ويثبته فِي ديوَان الْحَسَنَات( )، وَيُجَاب عَنهُ بِمَا تقدم، وَيلْزم فِيهِ مَا يلْزم فِي الأول وَمَا بعده، بِلَا شكّ وَلَا شُبْهَة. وَأي فرق بَين محو السَّيئَة وَإثْبَات الْحَسَنَة، وَبَين محو أحد العمرين وَإثْبَات الآخر.
وَمِنْهَا: أن المُرَاد: يمحو مَا يَشَاء - يَعْنِي: الدُّنْيَا - وَيثبت الْآخِرَة( )، وَيُجَاب عَنهُ بِمَا تقدم.
وَإذا تقرر لَك هَذَا، عرفت أن الْآيَة عَامَّة، وَأن الْعُمر فَرد من أفرادها، وَيدل على هَذَا التَّعْمِيم مَا ثَبت عَن كثير من أكَابِر الصَّحَابَة، أنهم( ) كَانُوا يَقُولُونَ فِي دُعَائِهِمْ: اللَّهُمَّ إن كنت قد أثبتني فِي ديوَان الأشقياء، فانقلني إلَى ديوَان السُّعَدَاء( )، وَنَحْو هَذِه الْعبارَة من عباراتهم، وهم جُمْهُور، قد جمع بعض الْحَنَابِلَة فِيمَا ورد عَنْهُم من ذَلِك مجلدًا بسيطًا( ).
وَبِالْجُمْلَةِ؛ فَالْقَوْل بالتخصيص بِغَيْر مُخَصص هُوَ من التقول على الله بِمَا لم يقل؛ لِأن الَّذِي قَالَه هُوَ ذَلِك اللَّفْظ الْعَام، وَتلك الْآيَة الشاملة، فقصرها على بعض مدلولاتها بِغَيْر حجَّة نيرة، لَا شكّ أنه من التقول على الله بِمَا لم يقل، وَقد قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الأعراف: 33].
وَأجَابُوا عَن قَوْله تَعَالَى: ﴿ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾ [فاطر: 11]، بِأن المُرَاد بالمعمَّر الطَّوِيل الْعُمر، وَالْمرَاد بالمنقوص قصير الْعُمر.
وَيُجَاب عَن ذَلِك: بِأن الضَّمِير فِي قَوْله: ﴿ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾ يعود إلَى قَوْله ﴿ﰐ ﰑ﴾ لَا شكّ فِي ذَلِك، وَالْمعْنَى على هَذَا: وَمَا يعمر من معمر، وَلَا ينقص من عمر ذَلِك المعمر( ).
هَذَا معنى النّظم القرآني، الَّذِي لَا يحْتَمل غَيره، وَمَا عداهُ، فَهُوَ إرجاع للضمير إلَى غير مَا هُوَ الْمرجع، وَذَلِكَ لَا وجود لَهُ فِي النّظم.
وَأجَابُوا أيْضًا: بِأن معنى مَا يعمر من معمر، مَا يستقبله من عمره، وَمعنى وَلَا ينقص من عمره، مَا قد مضى( )، وَهَذَا تعسف، وتكلف، وتلاعب بِكِتَاب الله، وَتصرف فِيهِ بِمَا يُوَافق الْمَذْهَب، ويطابق الْهوى.
وَأجَابُوا أيْضًا: بِأن المُرَاد بالمعمر، من بلغ سنّ الْهَرم، وبالمنقوص من عمره هُوَ معمر آخر غير هَذَا الَّذِي بلغ سن الْهَرم؛ أي: ينقص من عمره عَن عمر الَّذِي بلغ سنّ الْهَرم( )، وَيُجَاب عَنهُ بِمثل مَا تقدم. وَقيل المعمر: من يبلغ عمره سِتِّينَ، والمنقوص من عمره من يَمُوت قبل السِّتين( )، وَيُجَاب عَنهُ بِمَا تقدم.
وَالْحَاصِل؛ أن مَا جَاءُوا بِهِ من الْأجْوِبَة يردهَا اللَّفْظ القرآني، ويدفعها النّظم الرباني، والصيغة عَامَّة بِمَا فِيهَا من النَّفْي الدَّال على الْعُمُوم المتوجه إلَى النكرَة المنفية الْمُؤَكّد نَفيهَا بِمن. وَكَذَلِكَ النَّفْي الآخر بِلَفْظ لَا، المتوجه إلَى نفي النَّقْص عن عمر ذَلِك المعمر، وَهَذَا ظَاهر لَا يخفى. ومحاولة تَخْصِيصه، أو إرجاع ضَمِيره إلَى غير من هو له، تعسف، وتلاعب بِكِتَاب الله، ورده بِلَا حجَّة نيرة إلَى مَا يُطَابق هوى الْأنْفس.
وَأجَابُوا عَن قَوْله تَعَالَى: ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾( ) [الأنعام: 2]، بِأن المُرَاد بالأجل الأول النّوم، وَالْأجَل الثَّانِي الْمَوْت، وَهَذَا من بدع التفاسير، وغرائب التَّأْوِيل، وَمعنى الْآيَة أوضح من أن يخفى.
وَأجَابُوا أيْضًا: بِأن الْأجَل الأول: مَا قد انْقَضى من عمر كل أحد، وَالثَّانِي: مَا بَقِي من عمر كل أحد. وَهَذَا كَالْأولِ، وَقيل: الأول أجل الْمَوْت، وَالثَّانِي: أجل الْحَيَاة فِي الْآخِرَة، وَهَذَا أشد تعسفًا مِمَّا قبله. وَقيل: الأول: مَا بَين خلق الْإنْسَان إلَى مَوته، وَالثَّانِي: مَا بَين مَوته إلَى بَعثه، وَهُوَ كَالَّذي قبله، وَالْكل مُخَالف لما يدل عَلَيْهِ النّظم القرآني.
وَإذا عرفت بطلَان مَا أجابوا بِهِ، تقرر لَك أن الثَّلَاث الْآيَات دَالَّة على مَا أردناه، فَإن المحو وَالْإثْبَات عامان، يدْخل تَحت عمومها الْعُمر، والرزق، والسعادة، والشقاوة، وَغير ذَلِك( ).
وَمعنى الْآيَة الثَّانِيَة: أنه لَا يطول عمر إنْسَان وَلَا يقصر، إلَّا وَهُوَ فِي كتاب؛ أي: اللَّوْح الْمَحْفُوظ، وَمعنى الْآيَة الثَّالِثَة: أن للْإنْسَان أجلين، يقْضِي الله سُبْحَانَهُ لَهُ بِمَا يَشَاء مِنْهُمَا؛ من زِيَادَة، أو نقص.
فَإن قلت: فعلام تحمل مثل قَوْله تَعَالَى: ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [الأعراف: 34]، وَقَوله [سُبْحَانَهُ]( ): ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [المنافقون: 11]، وَقَوله سُبْحَانَهُ ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [نوح: 4]، قلت: أفسرها بِمَا هِيَ مُشْتَمِلَة عَلَيْهِ، فَإنَّهُ قَالَ: فِي الْآيَة الأولى: فَإذا جَاءَ أجلهم، وَقَالَ فِي الثَّانِيَة: إذا جَاءَ أجلهَا، وَقَالَ فِي الثَّالِثَة: إن أجل الله إذا جَاءَ.
فَأقُول: إذا حضر الْأجَل، فَإنَّهُ لَا يتَقَدَّم، وَلَا يتَأخَّر، وَقبل حُضُوره يجوز أن يُؤَخِّرهُ الله بِالدُّعَاءِ، أو بصلَة الرَّحِم، أو بِفعل الْخَيْر، وَيجوز أن يقدمهُ لمن عمل شرًّا، وقطع مَا أمر الله بِهِ أن يُوصل، وانتهك محارم الله سُبْحَانَهُ( ).
فَإن قلت: فعلام تحمل نَحْو قَوْله تعالى: ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [الحديد: 22]، وَقَوله سُبْحَانَهُ: ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [التوبة: 51]، وَكَذَلِكَ سَائِر مَا ورد فِي هَذَا الْمَعْنى.
قلت: أجمع بَينهَا وَبَين مَا عارضها فِي الظَّاهِر، من قَوْله تعالى: ﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [الشورى: 30]، وَمَا ورد فِي مَعْنَاهَا، وَمن ذَلِك الحَدِيث الْقُدسِي الثَّابِت فِي «الصَّحِيح»، عَن الرب تعالى: «يَا عبَادي، إنَّمَا هِيَ أعمالكُم، أحصيها عَلَيْكُم، فَمن وجد خيرًا، فليحمد الله، وَمن وجد شرًّا، فَلَا يَلُومن إلَّا نَفسه»، بِحمْل الْآيَتَيْنِ الْأوليين( ) وَمَا ورد فِي مَعْنَاهُمَا، على عدم التَّسَبُّب من العَبْد بِأسْبَاب الْخَيْر؛ من الدُّعَاء، وصلَة الرَّحِم، وَسَائِر الْأفْعَال والأقوال الصَّالِحَة. وَحمل الْآيَة الآخرة، والْحَدِيث الْقُدسِي، وَمَا ورد فِي مَعْنَاهُمَا، على وُقُوع التَّسَبُّب من العَبْد بِأسْبَاب الْخَيْر الْمُوجبَة لحسن الْقَضَاء، واندفاع شَره، وعَلى وُقُوع التَّسَبُّب من العَبْد بِأسْبَاب الشَّرّ الْمُقْتَضِيَة لإصابة الْمَكْرُوه، ووقوعه على العَبْد.
وَهَكَذَا أجمع بَين الْأحَادِيث الْوَارِدَة بسبق الْقَضَاء، وَأنه قد فرغ من تَقْدِير الْأجَل والرزق، والسعادة والشقاوة، وَبَين الْأحَادِيث فِي طلب الدُّعَاء من العَبْد، وَأن الله [تعالى]( ) يُجيب دعاءه، وَيُعْطِيه مَا سَألَ أو مثله، وَأنه يغْضب إذا لم يسْأل، وَأن الدُّعَاء يرد الْقَضَاء، وَنَحْو ذَلِك مِمَّا قدمنَا؛ كصلة الرَّحِم، وأعمال الْخَيْر.
فأحمل أحَادِيث الْفَرَاغ من الْقَضَاء على عدم تسبب العَبْد بِأسْبَاب الْخَيْر، أو الشَّرّ، وأحمل الْأحَادِيث الآخرة على وُقُوع التَّسَبُّب من العَبْد بِأسْبَاب الْخَيْر، أو التَّسَبُّب بِأسْبَاب الشَّرّ.
وَأنت خَبِير بِأن هَذَا الْجمع لَابُد مِنْهُ؛ لِأن الَّذِي جَاءَنَا بالأدلة الدَّالَّة على أحد الْجَانِبَيْنِ، هُوَ الَّذِي جَاءَنَا بالأدلة الدَّالَّة على الْجَانِب الآخر، وَلَيْسَ فِي ذَلِك خلف لما وَقع فِي الْأزَل، وَلَا مُخَالفَة لما تقدم الْعلم بِهِ، بل هُوَ من تَقْيِيد المسببات بأسبابها، كَمَا قدر الشِّبَع والري بِالْأكْلِ وَالشرب، وَقدر الْوَلَد بِالْوَطْءِ، وَقدر حُصُول الزَّرْع بالبذر. فَهَل يَقُول عاقل( )، بِأن ربط هَذِه المسببات بأسبابها، يَقْتَضِي خلاف الْعلم السَّابِق، أو يُنَافِيهِ بِوَجْه من الْوُجُوه؟
فَلَو قَالَ قَائِل: أنا لَا آكل، وَلَا أشْرب، بل أنْتَظر الْقَضَاء، فَإن قدر الله لي ذَلِك كَانَ، وَإن لم يقدره لم يكن، أو قَالَ: أنا لَا أزرع، وَلَا أجامع زَوْجَتي، فَإن قدر الله لي الزَّرْع( ) وَالْولد حصلا، وَإن لم يقدرهما لم يحصلا.
ألَيْسَ هَذَا الْقَائِل قد خَالف مَا فِي كتب الله سُبْحَانَهُ، وَمَا جَاءَت بِهِ رسله، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم وَأصْحَابه، والتابعون، وتابعوهم، وَسَائِر عُلَمَاء الْأمة، وصلحائها، بل يكون هَذَا الْقَائِل قد خَالف مَا عَلَيْهِ هَذَا النَّوْع الإنساني من أبينَا آدم إلَى الْآن، بل قد خَالف مَا عَلَيْهِ جَمِيع أنْوَاع الْحَيَوَانَات فِي الْبر وَالْبَحْر؟.
فَكيف يُنكر وُصُول العَبْد إلَى الْخَيْر بدعائه، أو بِعَمَلِهِ الصَّالح، فَإن هَذَا من الْأسْبَاب الَّتِي ربط الله [تعالى]( ) مسبباتها بهَا، وَعلمهَا قبل أن تكون، فعلمه على كل تَقْدِير أزلي فِي المسببات والأسباب، وَلَا يشك من لَهُ اطلَاع على كتاب الله ۵، مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من تَرْتِيب، حُصُول المسببات على حُصُول أسبَابهَا، وَذَلِكَ كثير جدًّا.
وَمن ذَلِك قَوْله: ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [النساء: 31]، ﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [نوح: 10- 12]، و﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [إبراهيم: 7]، ﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [البقرة: 282]، ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [الصافات: 143، 144]. وَكم يعد الْعَاد من هَذَا الْجِنْس فِي الْكتاب الْعَزِيز، وَمَا ورد فِي مَعْنَاهُ من السّنة المطهرة.
فَهَل يُنكر هَؤُلَاءِ الغلاة مثل هَذَا، ويجعلونه [مُخَالفا]( ) لسبق الْعلم، مباينًا لأزليته، فإن قَالُوا: نعم، فقد أنْكَرُوا مَا فِي كتاب الله سُبْحَانَهُ، من فاتحته إلَى خاتمته، وَمَا فِي السّنة المطهرة، من أولهَا إلَى آخرهَا، بل أنْكَرُوا أحْكَام الدُّنْيَا وَالْآخِرَة جَمِيعهَا؛ لِأنَّهَا كلهَا مسببات مترتبة على أسبَابهَا، وجزاءات معلقَة بشروطها.
وَمن بلغ إلَى هَذَا الْحَد فِي الغباوة( )، وَعدم تعقل الْحجَّة، لم يسْتَحق المناظرة، وَلَا يَنْبَغِي الْكَلَام مَعَه فِي الْأمُور الدينية، بل يَنْبَغِي إلْزَامه بإهمال [أسبَاب]( ) مَا فِيهِ صَلَاح معاشه، وَأمر دُنْيَاهُ كُله؛ حَتَّى ينتعش من غفلته، وَيَسْتَيْقِظ من نومته، وَيرجع عَن ضلالته وجهالته، وَالْهِدَايَة بيد ذِي الْحول وَالْقُوَّة.
ثمَّ يُقَال لَهُم: أيّمَا فَائِدَة لأمره تعالى لِعِبَادِهِ بِالدُّعَاءِ، بقوله: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [غافر: 60]، ثمَّ عقب ذَلِك بقوله: ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾؛ أي: دعائي ﴿ﭨ ﭩ ﭪ﴾، وَقَوله تعالى : ﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [النساء: 32]، فَأي فَائِدَة لهذين( ) الْأمريْنِ مِنْهُ تعالى بِالدُّعَاءِ، ووعيده لمن تَركه، وَجعله مستكبرًا، وتمدحه سُبْحَانَهُ بقوله ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [النمل: 62]، وَبِقَوْلِهِ: ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [البقرة: 186].
فَإن قَالُوا: إن هَذَا الدُّعَاء الَّذِي أمرنَا الله ۵ بِهِ، وأرشدنا إلَيْهِ، وَجعل تَركه استكبارًا، وتوعد عَلَيْهِ بِدُخُول النَّار مَعَ الذل، وَأنكر عَلَيْهِم أن غَيره يُجيب الْمُضْطَر، إن ذَلِك كُله لَا فَائِدَة فِيهِ للْعَبد، وَأنه لَا ينَال إلَّا مَا قد سبق بِهِ الْقَضَاء، فعل الدُّعَاء، أو لم يفعل، فقد نسبوا إلَى الرب ۵ مَا لَا يجوز عَلَيْهِ، وَلَا تحل نسبته إلَيْهِ بِإجْمَاع الْمُسلمين، فَإنَّهُ ۵ لَا يَأْمر إلَّا بِمَا فِيهِ فَائِدَة للْعَبد؛ دنيوية، أو أخروية، إمَّا جلب نفع، أو دفع ضرّ.
هَذَا مَعْلُوم، لَا يشك فِيهِ إلَّا من لَا يعقل حجج الله [تعالى]( )، وَلَا يفهم كَلَامه، وَلَا يدْرِي بِخَير وَلَا شَرّ، وَلَا نفع وَلَا ضرّ، وَمن بلغ فِي الْجَهْل إلَى هَذِه الْغَايَة، فَهُوَ حقيق بِأن لَا يُخَاطب، وقمين بِأن لَا يناظر، فَإن هَذَا الْمِسْكِين، المتخبط فِي جَهله، المتقلب فِي ضَلَالَه، قد وَقع فِيمَا هُوَ أعظم خطرًا من هَذَا، وأكثر( ) ضَرَرًا مِنْهُ.
وَذَلِكَ بِأن يُقَال لَهُ: إذا كَانَ دُعَاء الْكفَّار إلَى الْإسْلَام، ومقاتلتهم على الْكفْر، وغزوهم إلَى عقر الديار، كَمَا فعله رسل الله، وَنزلت بِهِ كتبه، لَا يَأْتِي بفائدة، وَلَا يعود على القائمين بِهِ من الرُّسُل وأتباعهم، وَسَائِر الْمُجَاهدين بعائدة، وَأنه لَيْسَ هُنَاكَ إلَّا مَا قد سبق بِهِ الْقَضَاء، وجف بِهِ الْقَلَم، وَأنه لَابُد أن يدْخل فِي الْإسْلَام، ويهتدي إلَى الدّين، من علم الله فِي سَابق علمه، أنه يَقع مِنْهُ ذَلِك، سَوَاء قوتل أم لم يُقَاتل، وَسَوَاء دعي أم لم يدع، كَانَ هَذَا الْقِتَال والتكليف الشاق ضائعًا؛ لِأنَّهُ من تَحْصِيل الْحَاصِل، وتكوين مَا هُوَ كَائِن، فعلوا أو تركُوا، وَحِينَئِذٍ يكون الْأمر بذلك عَبَثًا، تَعَالَى الله عَن ذَلِك.
وَهَكَذَا مَا شَرعه الله [تعالى]( ) لِعِبَادِهِ من الشَّرَائِع على لِسَان أنبيائه، وَأنزل بِهِ كتبه، يُقَال فِيهِ مثل هَذَا، فَإنَّهُ إذا كَانَ مَا فِي سَابق علمه كَائِنًا لَا محَالة، سَوَاء أنزل كتبه، وَبعث رسله، أم لم ينزل، وَلَا بعث، كَانَ ذَلِك من تَحْصِيل الْحَاصِل، فَيكون عَبَثًا، تَعَالَى الله عَن ذَلِك.
ثمَّ يُقَال لَهُم: هَذِه الْأدْعِيَة الَّتِي علَّم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أمته فِي صلواتهم، وليلهم، ونهارهم، وسفرهم، وحضرهم، لَو رام الْعَالم جمعهَا متونًا لكَانَتْ فِي مُجَلد، وَقد كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أكثر النَّاس قيَامًا وتضرعًا إلَى ربه، حَتَّى كَانَ فِي تَارَة يرفع كفيه، حَتَّى يرى بَيَاض إبطَيْهِ، وَفِي تَارَة يرفعهما، حَتَّى يسْقط الرِّدَاء عَن مَنْكِبَيْه، ثمَّ أخبرنَا بِمَا للداعي لرَبه من الْجَزَاء الجزيل، وَالثَّوَاب الْجَلِيل، عُمُومًا وخصوصًا. هَل كَانَ لهَذَا فَائِدَة يتَبَيَّن أثَرهَا، أم لَا فَائِدَة، بل مَا خطّ فِي اللَّوْح، فَهُوَ كَائِن لَا محَالة، وَقع الدُّعَاء أم لم يَقع؟
فَيُقَال لَهُم: يَا نوكى( )، أنْتُم أعرف بِاللَّه سُبْحَانَهُ من رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، حَتَّى يكون مَا فعله، وَمَا علَّمه أمته، لَغوًا ضائعًا، لَا فَائِدَة فِيهِ وَلَا عَائِدَة، ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [النور: 16].
ثمَّ يُقَال لَهُم: لَو كَانَ الْقَضَاء السَّابِق حتمًا لَا يتَحَوَّل، فَأي فَائِدَة فِي استعاذته صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم من سوء الْقَضَاء( )، كَمَا صَحَّ ذَلِك عَنهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَصَحَّ عَنهُ أنه كَانَ يَقُول: «وقني شَرّ مَا قضيت».
فيا لله الْعجب من دعاوى عريضة، من قُلُوب مهيضة( )، وأفهام مَرِيضَة، يَا لكم الويل، أما تَدْرُونَ فِي أي بلية وَقَعْتُمْ، وعَلى أي جنب سَقَطْتُمْ، وَمن أي بَاب من الشَّرِيعَة خَرجْتُمْ؟! فَإنَّكُم لم تعملوا بشرع، وَلَا اهْتَدَيْتُمْ بعقل( ).
وَقد كَانَ لكم قدوة وأسوة برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، وبكتاب الله الْمنزل عَلَيْهِ، وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ أكَابِر الصَّحَابَة، فِي هَذِه الْمَسْألَة الذي نَحن بصددها؛ كعمر بن الْخطاب( )، وَعبدالله بن مَسْعُود، وَأبي وَائِل، وأمثالهم من أكَابِر الصَّحَابَة، الَّذين صَحَّ عَنْهُم؛ أنهم كَانُوا يسْألُون الله سُبْحَانَهُ أن يثبتهم فِي ديوَان السَّعَادَة، وَأن ينقلهم من ديوَان الشقاوة إن كَانُوا فِيهَا، إلَى ديوَان السَّعَادَة كَمَا قدمنَا.
وَللَّه در كَعْب الْأحْبَار، فَإنَّهُ قَالَ لما طعن عمر رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ: وَالله، لَو دَعَا عمر أن يُؤَخر الله أجله، لأخره، فَقيل لَهُ: إن الله ۵ يَقُول: ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [الأعراف: 34]، فَقَالَ: هَذَا إذا حضر الْأجَل، فَأما [ما]( ) قبل ذَلِك، فَيجوز أن يُزَاد وَينْقص، وَقَرَأ قَوْله تَعَالَى: ﴿ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾( ) [فاطر: 11].
وَكَلَامه هَذَا يرشد إلَى الْجمع الَّذِي جمعناه كَمَا عرفت، ولنقتصر على هَذَا الْمِقْدَار فِي تَقْرِير الْمُقدمَة الَّتِي قدمنَا، أنه يظْهر بهَا مَا سنذهب إلَيْهِ فِي ذَلِك الْمقَام، بعد أن تعقبنا جَمِيع تِلْكَ التأويلات الْمَذْكُورَة فِي التَّرَدُّد الَّذِي وَقع فِي الحَدِيث الْقُدسِي.
فَنَقُول الْآن: إن ذَلِك التَّرَدُّد، هُوَ كِنَايَة عَن محبَّة الله تعالى( ) لعَبْدِهِ الْمُؤمن، أن يَأْتِي بِسَبَب من الْأسْبَاب الْمُوجبَة لخلوصه من الْمَرَض الَّذِي وَقع فِيهِ، حَتَّى يطول بِهِ عمره، من دُعَاء، أو صلَة رحم، أو صَدَقَة، فَإن فعل، مد لَهُ فِي عمره بِمَا يَشَاء( )، وتقتضيه حكمته، وَإن لم يفعل حَتَّى جَاءَ أجله، وحضره الْمَوْت، مَاتَ بأجله الَّذِي قد قضي عَلَيْهِ، إذا لم يتسبب بِسَبَب يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الفسحة لَهُ فِي عمره، مَعَ أنه، وَإن فعل مَا يُوجب التَّأْخِير، والخلوص من الْأجَل الأول، فَهُوَ لَابُد لَهُ من الْمَوْت بعد انْقِضَاء تِلْكَ الْمدَّة الَّتِي وَهبهَا الله سُبْحَانَهُ لَهُ.
فَكَانَ هَذَا التَّرَدُّد مَعْنَاهُ: انْتِظَار( ) مَا يَأْتِي بِهِ العَبْد، مِمَّا يَقْتَضِي تَأْخِير الْأجَل، أو لَا يَأْتِي، فَيَمُوت بالأجل الأول، وَهَذَا معنى صَحِيح لَا يرد عَلَيْهِ إشْكَال، وَلَا يمْتَنع فِي حَقه سُبْحَانَهُ بِحَال، مَعَ أنه سُبْحَانَهُ يعلم أن العَبْد سيفعل ذَلِك السَّبَب، أو لَا يَفْعَله، لكنه لَا يَقع التَّنْجِيز لذَلِك الْمُسَبّب، إلَّا بِحُصُول السَّبَب الَّذِي ربطه ۵ بِهِ.
يكره الموت وأكره إساءته :
قَوْله: «يكره الْمَوْت، وأكره إساءته( )». قَالَ ابْن حجر: وَفِي حَدِيث عَائِشَة: أنه يكره الْمَوْت، وَأنا أكره مساءته، زَاد ابْن مخلد، عَن ابْن كَرَامَة، فِي آخِره: «وَلَابُد لَهُ مِنْهُ»، وَوَقعت هَذِه الزِّيَادَة أيْضًا فِي حَدِيث وهب. انْتهى.
فِيهِ فَائِدَة جليلة، هِيَ أن الْمُؤمن قد يكره الْمَوْت، وَلَا يخرج بذلك عَن رُتْبَة الْإيمَان الجليلة، وَلَا يُنَافِي ذَلِك أن شَأْن الْمُؤمن أن يحب لِقَاء الله سُبْحَانَهُ، كَمَا ورد فِي الْأحَادِيث الصَّحِيحَة؛ لوُقُوع الْبَيَان فِيهَا، بِأن محبَّة لِقَاء الله لَا تستلزم أن لَا يكره صَاحب هَذِه الْمحبَّة الْمَوْت، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من أحب لِقَاء الله، أحب الله لقاءه، وَمن كره لِقَاء الله كره الله لقاءه»، فَقلت: يَا نَبِي الله، أكراهية الْمَوْت، فكلنا يكره الْمَوْت؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِك، وَلَكِن الْمُؤمن إذا بشر برحمة الله، ورضوانه، وجنته، أحب لِقَاء الله، فَأحب الله لقاءه، وَإن الْكَافِر إذا بشر بِعَذَاب الله، وَسخطه، كره لِقَاء الله، وَكره الله لقاءه»( ).
وَأخرج أحْمد، بِرِجَال الصَّحِيح، وَالنَّسَائِيّ، بِإسْنَاد جيد، من حَدِيث أنس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من أحب لِقَاء الله أحب الله لقاءه، وَمن كره لِقَاء الله كره الله لقاءه»، قُلْنَا: يَا رَسُول الله، كلنا يكره الْمَوْت، قَالَ: «لَيْسَ ذَاك كَرَاهِيَة الْمَوْت، وَلَكِن الْمُؤمن إذا حُضر، جَاءَهُ البشير من الله، فَلَيْسَ شَيْء أحب إلَيْهِ من أن يكون قد لَقِي الله، فَأحب الله لقاءه، وَإن الْفَاجِر وَالْكَافِر، إذا حُضر، جَاءَهُ مَا هُوَ صائر إلَيْهِ من الشَّرّ، أو مَا يلقى من الشَّرّ، فكره لِقَاء الله، فكره الله لقاءه».
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «قَالَ الله: إذا أحب عَبدِي لقائي، أحْبَبْت لقاءه، وَإذا كره لقائي، كرهت لقاءه»( ).
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ، بِإسْنَاد جيد، من حَدِيث عبدالله بن عَمْرو، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «تحفة الْمُؤمن الْمَوْت»( ).
وَأخرج أحْمد، من رِوَايَة عبدالله بْن زَحر، من حَدِيث معَاذ [ﭬ]( )، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن شِئْتُم، أنبأتكم مَا أول مَا يَقُول الله تعالى للْمُؤْمِنين يَوْم الْقِيَامَة، وَمَا أول مَا يَقُولُونَ لَهُ»، قُلْنَا: نعم يَا رَسُول الله، قَالَ: إن الله تعالى يَقُول للْمُؤْمِنين: هَل أحْبَبْتُم لقائي، فَيَقُولُونَ: نعم يَا رَبنَا، فَيَقُول لَهُم: لم؟ فَيَقُولُونَ: رجونا عفوك، ومغفرتك، فَيَقُول: قد وَجَبت لكم مغفرتي»( ).
قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح»( ): وَأسْندَ الْبَيْهَقِيّ فِي «الزّهْد»( )، عَن الْجُنَيْد، سيد الطَّائِفَة، قَالَ: الْكَرَاهَة هُنَا لما يلقى الْمُؤمن من الْمَوْت، وصعوبته، وكربه، وَلَيْسَ الْمَعْنى أني أكره لَهُ الْمَوْت؛ لِأن الْمَوْت يُورِدهُ إلَى رَحْمَة الله ومغفرته. انْتهى.
أقُول: ظَاهر الْأحَادِيث الَّتِي قدمناها: أن الْكَرَاهَة لنَفس الْمَوْت، الَّذِي هُوَ انْتِقَال من هذه الدَّار إلَى الدَّار الْآخِرَة، من غير حَاجَة إلَى تَأْوِيل. وَلَا شكّ أن الْكَرَاهَة للْمَوْت قد تكون لاستصعاب مقدماته، وَقد تكون لما فِي الْمَوْت من مُفَارقَة الْأهْل، وَالْولد، وَالْأصْحَاب، والأتراب، وَقد تكون للخوف من أن يُفَارق الدُّنْيَا وَهُوَ غير رَاض من نَفسه بِأعْمَالِهِ الصَّالِحَة، أو لذنوب اقترفها لم يخلص التَّوْبَة عَنْهَا، أو لحقوق لله سُبْحَانَهُ، أو لِعِبَادِهِ، لم يتَخَلَّص عَنْهَا، فَلَيْسَتْ كَرَاهَة الْمَوْت مُخْتَصَّة بذلك الْوَجْه الَّذِي ذكره الْجُنَيْد رَحمَه الله.
قَالَ فِي «الْفَتْح»( ): وَعبر بَعضهم عَن هَذَا؛ بِأن الْمَوْت حتم مقضي، وَهُوَ مُفَارقَة الرّوح الْجَسَد، وَلَا يحصل غَالِبًا إلَّا بألم عظيم جدًّا، كَمَا جَاءَ عَن عَمْرو بن الْعَاصِ، أنه سُئِلَ وَهُوَ يَمُوت، فَقَالَ: كَأنِّي أتنفس من خرم إبرة، وَكَأن غُصْن شوك يجر بِهِ من قامتي إلَى هامتي( ). انْتهى.
قلت: هَذَا هُوَ مثل كَلَام الْجُنَيْد، وَالْجَوَاب عَنهُ جَوَاب عَن هَذَا، وقصة عَمْرو هَذِه مَشْهُورَة فِي كتب التَّارِيخ، قَالَ لَهُ رجل، وَهُوَ يجود بِنَفسِهِ: إنَّك كنت تَقول لنا: وددت أن يُخْبِرنِي رجل عَاقل، وهُوَ فِي سِيَاق الْمَوْت، كَيفَ يجد الْمَوْت؟، فَقَالَ لَهُ رجل: فأنْت ذَلِك الرجل الْعَاقِل، فَأخْبرنَا، فَقَالَ: كَأنِّي أتنفس... إلخ.
قَالَ فِي «الْفَتْح»( ): وَعَن كَعْب: أن عمر سَألَهُ عَن الْمَوْت، فوصفه بِنَحْوِ هَذَا، فَلَمَّا كَانَ الْمَوْت بِهَذَا الْوَصْف، وَالله سُبْحَانَهُ يكره أذَى الْمُؤمن، أطلق على ذَلِك الْكَرَاهَة. وَيحْتَمل أن تكون المساءة بِالنِّسْبَةِ إلَى طول الْحَيَاة؛ لِأنَّهَا تُؤدِّي إلَى أرذل الْعُمر، وتنكس الْخلق، وَالرَّدّ إلَى أسْفَل سافلين. انْتهى.
أقُول: معنى قَوْله «وأكره إساءته»: كَرَاهَة إساءته بِنَفس الْمَوْت، كَمَا يفِيدهُ قَوْله «يكره الْمَوْت»، فَإن قَوْله «وأكره إساءته» هُوَ مَعْطُوف عَلَيْهِ، فَالْمُرَاد: أكره إساءته بِمَا كرهه، وَتَخْصِيص التَّفْسِير بِوَجْه، مَعَ وضوح الْمَعْنى، لَا حَاجَة إلَيْهِ، فَإنَّهُ لَا يلْزم من ذَلِك شَيْء حَتَّى يُصَار إلَى التَّأْوِيل، وعَلى فرض وجود مُقْتَض للتأويل، فَهُوَ ذُو وُجُوه كَمَا بَينا، وَغير مَا تطابق عَلَيْهِ قَول الْجُنَيْد، وَكَعب، وَالْمُصَنّف أولى مِنْهُ.
قَالَ فِي «الْفَتْح»( ): وَجوز الْكرْمَانِي أن يكون المُرَاد: أنه يكره الْمَوْت، فَلَا أسْرع بِقَبض روحه، فَأكُون كالمتردد( ). انْتهى.
أقُول: هَذَا صَوَاب، إذْ لَا مُقْتَضى للتأويل كَمَا عرفناك.
قَالَ فِي «الْفَتْح»( ): وَقَالَ الشَّيْخ أبُو الْفضل( ): فِي هَذَا الحَدِيث، عظم قدر الْوَلِيّ؛ لكَونه خرج عَن تَدْبِيره( ) نَفسه، إلَى تَدْبِير ربه تَعَالَى، وَمن انتصاره لنَفسِهِ، إلَى انتصار الله لَهُ، وَعَن حوله وقوته؛ بِصدق توكله.
قَالَ: وَيُؤْخَذ مِنْهُ: أن لَا يحكم لإنْسَان آذَى وليًّا، ثمَّ لم يعاجل بمصيبة فِي نَفسه، أو مَاله، أو وَلَده، بِأنَّهُ يسلم من انتقام الله تَعَالَى لَهُ، فقد تكون مصيبته فِي غير ذَلِك، مِمَّا هُوَ أشد عَلَيْهِ؛ كالمصيبة فِي الدّين مثلًا.
قَالَ: وَيدخل فِي قَوْله: «افترضت عَلَيْهِ» الْفَرَائِض الظَّاهِرَة فعلًا؛ كَالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاة، وَغَيرهمَا من الْعِبَادَات، وتركًا؛ كَالزِّنَا، وَالْقَتْل، وَغَيرهمَا من الْمُحرمَات، والباطنة؛ كَالْعلمِ بِاللَّه تَعَالَى، وَالْحب لَهُ، والتوكل عَلَيْهِ، وَالْخَوْف مِنْهُ، وَغير ذَلِك. وَهُوَ يَنْقَسِم أيْضًا إلَى أفعَال، وتروك.
الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى :
قَالَ: وَفِيه دلَالَة على جَوَاز إطلَاع الْوَلِيّ على المغيبات، بإطلاع الله تَعَالَى إياه، وَلَا يمْنَع من ذَلِك ظَاهر قَوْله: ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [الجن: 26، 27]، فَإنَّهُ لَا يمْنَع دُخُول بعض أتْبَاعه مَعَه بالتبعية؛ لصدق قَوْلنَا: مَا دخل على الْملك الْيَوْم إلَّا الْوَزير، وَمن الْمَعْلُوم أنه دخل مَعَه بعض خدمه( ).
قلت: الْوَصْف الْمُسْتَثْنى للرسول هُنَا، إن كَانَ فِيمَا يتَعَلَّق بِخُصُوص كَونه رَسُولًا، فَلَا مُشَاركَة لأحد من أتْبَاعه فِيهِ إلَّا مِنْهُ، وَإلَّا فَيحْتَمل مَا قَالَ، وَالْعلم عِنْد الله ۵. انْتهى.
أقُول: أما قَوْله: فِي هَذَا الحَدِيث عظم قدر الْوَلِيّ، فَلَا شكّ فِي ذَلِك؛ لِأن الله سُبْحَانَهُ قد أحبه، وَكَانَ سَمعه، وبصره، وَيَده، وَرجله، ووعده بِأنَّهُ إذا سَألَهُ أعطَاهُ، وَإذا استعاذه أعَاذَهُ.
وَأما قَوْله: لكَونه( ) خرج من تَدْبيره... إلخ، فَإن أرَادَ بِهَذَا التَّعْلِيل، أن الْوَلِيّ فِي الْوَاقِع كَذَلِك، فَصَحِيح، وَإن أرَادَ أن فِي الحَدِيث الْقُدسِي دلَالَة على هَذِه الْعلَّة، فَلَا، فَإنَّهُ لم يذكر ذَلِك فِيهِ، إلَّا أن يُرِيد أن فِي قَوْله: «كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ» إلَى آخِره، مَا يدل على أنه بذلك قد صَار فِي تَدْبِير من صَار سَمعه وبصره... إلخ. وَهُوَ الرب سبحانه، وَلَكِن لَيْسَ هَذَا الْخُرُوج من فعل الْوَلِيّ، حَتَّى يكون [ذَلِك]( ) عِلّة لتعظيم قدره، فَإن ذَلِك من فعل الله سُبْحَانَهُ، فَهُوَ الَّذِي جازى الْوَلِيّ بالمحبة، وَكَانَ سَمعه، وبصره... إلخ، فذلك هو من جملَة مَا جوزي بِهِ الْوَلِيّ، فَلَا يَصح أن يكون عِلّة للمجازاة.
وَأما قَوْله: وَيُؤْخَذ مِنْهُ أن لَا يحكم لإنْسَان آذَى وليًّا... إلخ، فَلَعَلَّهُ يُرِيد أنه سُبْحَانَهُ لما آذن من يعادي الْوَلِيّ بِالْحَرْبِ، كَانَ ذَلِك وَاقعًا لَا محَالة؛ إمَّا معجلًا، أو مُؤَجّلًا، فِي النَّفس، أو فِي المَال، أو فِي الْوَلَد، فَإن كل ذَلِك يصدق عَلَيْهِ أنه من حَرْب الله لذَلِك المعادي للْوَلِيّ .
وَأما قَوْله: وَيدخل فِي قَوْله «افترضت عَلَيْهِ» الْفَرَائِض الظَّاهِرَة... إلخ، فقد أوضحنا هَذَا عِنْد كلامنا على قَوْله: «وَمَا تقرب إلَيّ عَبدِي بِمثل أدَاء مَا افترضت عَلَيْهِ»، بأوضح بَيَان، فارجع إلَيْهِ.
وَأما قَوْله: وَفِيه دلَالَة على جَوَاز إطلَاع الْوَلِيّ على المغيبات، بإطلاع الله تَعَالَى إيَّاه... إلخ، فَهُوَ مَأْخُوذ من قَوْله «كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ، وبصره الَّذِي يبصر بِهِ»... إلخ، فَإن من كَانَ الله سُبْحَانَهُ، سَمعه، وبصره، لَا مَانع من إطلَاعه على بعض أسرار الإلهية، وَلَا سِيمَا بعد بَيَان هَذَا بقوله: «فَبِي يسمع، وَبِي يبصر، وَبِي يبطش، وَبِي يمشي»، وَقد أطلنا الْكَلَام على هَذَا فِيمَا سبق، وبيناه أكمل بَيَان، وَذكرنَا مَا يُعَضِّدُ ذَلِك من الْأدِلَّة.
وَأما قَوْله: وَلَا يمْنَع من ذَلِك ظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [الجن: 26، 27]، فَإنَّهُ لَا يمْنَع دُخُول بعض أتْبَاعه مَعَه بالتبعية... إلخ، فَأقُول: هَذَا صَحِيح( )، فَإن الله سُبْحَانَهُ قد أطلع على مَا يَشَاء من غيبه من يرتضيه من رسله، كَمَا تفيده هَذِه الْآيَة، وَلم يمْنَع الرَّسُول من إظْهَار مَا أطلعه عَلَيْهِ على بعض خواصه من أتْبَاعه( ).
وَقد وَقع مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم ذَلِك فِي غير قَضِيَّة؛ كإطلاعه حُذَيْفَة على أهل النِّفَاق، ومعرفته بهم، وإطلاعه لَهُ أيْضًا على بعض الْأمُور الْمُسْتَقْبلَة، خُصُوصًا أمُور الْفِتَن الَّتِي حدثت بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فَإنَّهُ كَانَ بهَا خَبِيرًا، وَكَانَ يسْأل عَنْهَا، فيجيب، كسؤال عمر لَهُ، الثَّابِت فِي «الصَّحِيح»، وإخباره لَهُ بِأن بَينه وَبَينهَا بَابًا، فَقَالَ عمر لَهُ: أيكسر أم يفتح؟ فَقَالَ: بل يكسر، ففهم عمر ﭬ أنه الْبَاب، وَأنه يقتل( ). فَهَذَا وَأمْثَاله، هُوَ من عِنْد الله سُبْحَانَهُ.
وَمن ذَلِك: قَول عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ، كَمَا فِي «صَحِيح مُسلم» وَغَيره: وَالَّذِي فلق الْحبَّة، وبرأ النَّسمَة، إنَّه لعهد النَّبِي الْأمِّي، أن لَا يحبني إلَّا مُؤمن، وَلَا يبغضني إلَّا مُنَافِق( ).
وَمن ذَلِك: قَضِيَّة المُخْدَج الَّذِي قتل من الْخَوَارِج فِي يَوْم النهروان، وَأمرهمْ عَليّ [ﭬ]( ) أن يبحثوا عَنهُ، فَلم يجدوه، فَقَامَ، فَوَجَدَهُ، فَقَالَ لَهُ أبُو عَبِيدَةَ السَّلمَانِي: آللَّهُ إنَّه لعهد النَّبِي إلَيْك، قَالَ: نعم.
بل ثَبت فِي «الصَّحِيح»، أن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَامَ مقَامًا، فَمَا ترك شَيْئًا من الْأمُور الْمُسْتَقْبلَة حَتَّى أخْبرهُم بِهِ، حفظه من حفظه، ونسيه من نَسيَه. وَذكر كل قَائِد من قواد الْفِتَن، وَأخْبر جمَاعَة من الصَّحَابَة؛ كَأبي ذَر، وَأبي هُرَيْرَة، وَغَيرهمَا بِشَيْء من الْأمُور الْمُسْتَقْبلَة، كَمَا ذكره أهل الحَدِيث، وَالسير، والتاريخ.
وكما قَالَ [علي رضى الله عنه]( ) لعبدالله بن عَبَّاس، لما وصل إلَيْهِ بِابْنِهِ عَليّ ليبرك عَلَيْهِ: خُذ إلَيْك أبَا الْأمْلَاك، فَكَانَ أول من ملك من أوْلَاده السفاح؛ عبدالله بن مُحَمَّد بْن عَليّ بن عبدالله بن الْعَبَّاس( )، ثمَّ ملك بعده أخُوهُ الْمَنْصُور، ثمَّ أوْلَاده من خلفاء بني الْعَبَّاس، وَكَانَت لَهُم تِلْكَ الدولة الطَّوِيلَة.
بل كَانَ لَدَى أوْلَاد عَليّ بن أبي طَالب من الْأخْبَار الْمُتَعَلّقَة بالدول، مَا هُوَ مَعْرُوف، وَكَانَ الإمَام الباقر، وَالْإمَام الصَّادِق، يخبران خواصهم بِالْوَقْتِ الَّذِي تنْتَقل فِيهِ الدولة من بني أميَّة َى بني هَاشم، بل كَانَ عِنْد بني أميَّة من دولتهم أخْبَار منقولة فِي كتب التَّارِيخ، وَكَانَ الْعَارِف بهَا مسلمة بن عبدالْملك بن مَرْوَان.
وَمن أعجب مَا روي عَنهُ، أنهم اجْتَمعُوا فِي أيَّام دولتهم، فِي مَسْجِد من الْمَسَاجِد الْخَاصَّة بهم، فَصَارَ مسلمة بن عبدالْملك يُحَدِّثهُمْ بالأمور الَّتِي يكون بهَا زَوَال دولتهم، وبينا هُوَ يذكر لَهُم قيام أبي مُسلم، بِظُهُور الدولة الهاشمية بخراسان، صَادف فِي ذَلِك الْوَقْت دُخُول رجل غَرِيب عَلَيْهِم، ووقف يسمع الحَدِيث، ومسلمة يُحَدِّثهُمْ عَن الْجَيْش الَّذِي يقدم من خُرَاسَان، ويصل إلَى الْعرَاق، وَتظهر دولة [بني]( ) العباسية، فَسَماهُ باسمه، وَقَالَ: هُوَ رجل اسْمه قَحْطَبَةَ بْن شبيب، صفته كَذَا وكذا، ثمَّ وَقعت عينه على ذَلِك الْغَرِيب، فَقَالَ: كَأنَّهُ هَذَا، أو يشبه هَذَا، وَاسْتمرّ فِي حَدِيثه، حَتَّى قَالَ: ثمَّ يهْلك بعد وُصُوله هُوَ وجيشه إلَى الْعرَاق، فِي دجلة أو الْفُرَات، الشَّك مني.
وَكَانَ ذَلِك الرجل الْغَرِيب الدَّاخِل عَلَيْهِم، هُوَ قَحْطَبَةَ بن شبيب، فَلَمَّا سمع الحَدِيث، انْخَنَسَ من بَينهم، وَقصد خُرَاسَان، فكَانَ هُوَ الْأمِير الَّذِي أرْسلهُ أبُو مُسلم إلَى الْعرَاق، وطوى الممالك مَا بَين خُرَاسَان إلَى الْعرَاق، وَلما وصلوا إلَى النَّهر الَّذِي لَا يجاز مَعَه إلَى الْعرَاق إلَّا من القنطرة، أمر الْجَيْش أن يتوقفوا إلَى اللَّيْل، ويجوزوا القنطرة، ثمَّ جمع خَواص الْجَيْش وكبارهم، وَطلب مِنْهُم أنهم يعقدون الْإمَارَة بعده لِابْنِهِ حميد بن قَحْطَبَةَ، إذا عرض لَهُ الْمَوْت، فَفَعَلُوا، وَهُوَ قد ظن أنه يكون هَلَاكه بِالْقَتْلِ، فَدخل فِي غمار الْجَيْش كواحد مِنْهُم، وأخفى نَفسه، وَركب فرسًا من عُرض الأفراس، وَمَشى بهَا فِي الجسر، فازدحمت الْخَيل، حَتَّى رمت بِهِ إلَى النَّهر، فَهَلَك، وَكَانَ فِي تَدْبيره تدميره( ).
وَمن عجائب مَا ألْقي من هَذَا الْعلم على لِسَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أنه اجْتمع بَنو هَاشم؛ من آل عَليّ، وَآل الْعَبَّاس، فِي بعض الْأوْقَات، فِي أيَّام بني أميَّة، فَبَايعُوا مُحَمَّد بن عبدالله بن الْحسن بن الْحسن بن عَليّ بن أبي طَالب، وكان من جملة المبايعين له المنصور العباسي، ثاني خلفاء بني العباس، فَقَالَ جَعْفَر الصَّادِق لبَعض خواصه: إن هَذَا – يَعْنِي: الْمَنْصُور الْعَبَّاسي - هُوَ الَّذِي يكون خَليفَة، وسيكون قتل من بَايَعْنَاهُ الْآن؛ يَعْنِي: مُحَمَّد بن عبدالله الْمَذْكُور، وَهُوَ الملقب بِالنَّفسِ الزكية، على يَد جَيش الْمَنْصُور هَذَا، فَانْظُر إلَى هَذَا الْعجب العجيب.
وَمن ذَلِك: مَا أخبر بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، فِيمَا صَحَّ عَنهُ فِي «الصَّحِيح»؛ من خُرُوج التّرْك على بِلَاد الْإسْلَام، وَذكر مَا يصدر مِنْهُم؛ من أخذ الْبِلَاد الإسلامية، وَفتح مَدَائِن الْإسْلَام، ثمَّ وَصفهم بأوصاف؛ من جُمْلَتهَا: أن وُجُوههم كالمجان المطرقة، وَأن نعَالهمْ الشّعْر، وَنَحْو ذَلِك من الْأوْصَاف. فَخرج التّرْك الَّذين يُقَال لَهُم التتر، وفعلوا تِلْكَ الأفاعيل بِبِلَاد الْإسْلَام، حَتَّى كَادُوا يستولون عَلَيْهَا جَمِيعًا، وَلم يبْق إلَّا الْيَسِير مِنْهَا.
وَكم يعد الْعَاد من ذَلِك، فَإنَّهُ كثير جدًّا، وَكله مُسْتَفَاد من الجناب النَّبَوِيّ، وَمن الْغَيْب الَّذِي أطلع الله [تعالى]( ) رَسُوله عَلَيْهِ، فَأطلع عَلَيْهِ من ارْتَضَاهُ من أصْحَابه.
وَقد قدمنَا حَدِيث «إن فِي هَذِه الْأمة محدَّثين، وَإن مِنْهُم عمر»، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَهَذَا هُوَ نوع من أنْوَاع علم الْغَيْب( )، وَكَذَلِكَ ذكرنَا حَدِيث «اتَّقوا فراسة الْمُؤمن، فَإنَّهُ يرى بِنور الله»، وَهُوَ حَدِيث حسن( ) كَمَا بَينا فِيمَا سلف.
وَمن أغرب مَا نحكيه فِيمَا يتَعَلَّق بِهَذَا الحَدِيث: أن السري السَّقْطي شيخ الْجُنَيْد، أمره بِأن يخرج يتَكَلَّم على النَّاس، فَاعْتَذر مِنْهُ بِمَا فِي لِسَانه من العجمة، وبعدم صلاحيته لذَلِك، فعزم عَلَيْهِ أن يخرج صبح تِلْكَ اللَّيْلَة يتَكَلَّم على النَّاس فِي الْجَامِع، فَكَأنَّهُ نَادَى مُنَادي فِي النَّاس: بِأن الْجُنَيْد سيتكلم على النَّاس عقب صَلَاة الفجر فِي الْجَامِع، فَجَاءُوا إلَيْهِ أفْوَاجًا.
وَكَانَ هَذَا أول كَرَامَة للجنيد؛ لِأنَّهُ لم يطلع على مَا دَار بَينه وَبَين شَيْخه أحد، فَخرج، وَوجد الْجَامِع غاصًّا( ) بأهْله، فَلَمَّا قعد، وَأقْبلُوا إلَيْهِ بأجمعهم، فبرز رجل وَسَألَهُ عَن معنى حَدِيث: «اتَّقوا فراسة الْمُؤمن»، فَأطْرَقَ قَلِيلًا، ثمَّ قَالَ لَهُ: أسلم، فقد آن لَك أن تسلم، فَقَامَ وَجَثَا بَين يَدَيْهِ وَأسلم( )، وانكشف أن ذَلِك الرجل من النَّصَارَى، لما سمع أخْبَار النَّاس، بِأن الْجُنَيْد سيتكلم فِي ذَلِك الْمحل، فِي ذَلِك الْوَقْت، لَبِسَ لِبْسَ الْمُسلمين، وَدخل مَعَهم مختبرًا لِلْإسْلَامِ وَأهله، فَكَانَ فِي ذَلِك سعادته الأبدية.
وَبِهَذَا تعرف أنه لَا حَاجَة إلَى مَا قَالَه الشَّيْخ أبُو الْفضل فِي آخر كَلَامه، من قَوْله: لصدق قَوْلنَا: مَا دخل على الْملك إلَّا الْوَزير، وَمن الْمَعْلُوم أنه قد دخل مَعَه بعض خدمه؛ لِأن مثل هَذَا التمثيل لَا يُؤْكَل بِهِ الْكَتف، وَلَا ينفع فِي مقَام النزاع. وَمرَاده: أن بعض أتبَاع الرُّسُل، قد يدْخل مَعَه، كَمَا دخل أتبَاع الْوَزير مَعَه، فيطلعهم الله [تعالى]( ) على الْغَيْب، كَمَا أطلع عَلَيْهِ من ارتضى من رَسُول.
وَهَذَا إلْحَاق مَعَ فَارق أوضح من الشَّمْس، وَهُوَ كَونه رَسُولًا، وَكَون الله ارْتَضَاهُ، وَلَا يُوجد ذَلِك فِي غير رَسُول، وَلَيْسَ النزاع فِي دُخُول أتبَاع الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم فِي قَوْله: ﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [الجن: 27]، فمعلوم أنه لَا دُخُول لَهُم فِي ذَلِك، لَكِن النزاع فِي أن الرَّسُول: هَل لَهُ أن يطلع غَيره من أتْبَاعه على مَا أطلعه الله [تعالى]( ) عَلَيْهِ من علم الْغَيْب أم لَا؟ فَنحْن نقُول: لَا نسلم قَول من قَالَ: إنَّه لَا يجوز لَهُ، ونسند هَذَا الْمَنْع بِمَا قدمنَا ذكره، وبأمثاله مما لم نذكرهُ( ).
وَإذا تبرعنا بالاستدلال على جَوَاز إطلاعه لبَعض أتْبَاعه، على مَا أطلعه الله [سبحانه]( ) عَلَيْهِ من علم الْغَيْب، فَنَقُول: عُمُوم قَوْله: ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [المائدة: 67]، وَلِهَذَا يَقُول الله ۵: ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ( )﴾، وَتقول عَائِشَة [ڤ]( ): من زعم أن مُحَمَّدًا كتم شَيْئًا مِمَّا أوحاه الله إلَيْهِ، فقد أعظم على الله الْفِرْيَة. وَهُوَ فِي «الصَّحِيح».
وَلَو سلمنَا تَخْصِيص ذَلِك بِمَا يَحْتَاجهُ النَّاس من علم الشَّرِيعَة، وَهَذَا لَا يحتاجونه، لَكَانَ مَا قدمنَا ذكره من الْوَاقِعَات مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم، من إطلاع بعض أتْبَاعه على شَيْء من علم الْغَيْب، دَلِيلًا على أن ذَلِك جَائِز.
وَأما قَول ابْن حجر، مستدركًا على أبي الْفضل، بقوله: قلت: الْوَصْف الْمُسْتَثْنى للرسول هُنَا؛ إن كَانَ فِيمَا يتَعَلَّق بِخُصُوص كَونه رَسُولًا، فَلَا مُشَاركَة لأحد من أتْبَاعه فِيهِ إلَّا مِنْهُ، وَإلَّا فَيحْتَمل مَا قَالَ، وَالْعلم عِنْد الله. انْتهى.
فَأقُول: لَيْسَ المُرَاد إلَّا الشق الأول، فَإن قَالَ: ﴿ﯷ( ) ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾، فَلَو لم يكن ذَلِك الْوَصْف الْمُسْتَثْنى مُتَعَلقًا بِخُصُوص كَونه رَسُولًا، لكفى قَوْله: ﴿ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [الجن: 27]، بِدُونِ قَوْله: ﴿ﰀ ﰁ﴾، فَلَا يتم مَا قَالَه فِي الشق الثَّانِي من قَوْله، وَإلَّا فَيحْتَمل مَا قَالَ.
نعم؛ اقْتِصَار الشَّيْخ أبي( ) الْفضل على مُجَرّد ذَلِك الْمِثَال، وموافقة ابْن حجر لَهُ بقوله، وَإلَّا فَيحْتَمل مَا قَالَ [إن أرَادَا]( ) أن ذَلِك الْمِثَال، وَهَذَا الِاحْتِمَال فِي الْآيَة القرآنية، فقد عرفت اندفاع ذَلِك من الأصْل، وَلَكِن كَانَ يَنْبَغِي لَهما أن يحْتَجَّا لدُخُول بعض أوْلِيَاء الله، وصلحاء عباده، فِي الظفر بِشَيْء من الْغَيْب، الَّذِي اسْتَأْثر الله [تعالى]( ) بِعَمَلِهِ، بِمَا قدمنَا من قَوْله: «كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ، وبصره الَّذِي يبصر بِهِ»... إلخ( ).
وَلَو فَرضنَا أن دلَالَة هَذَا مَخْصُوصَة بقوله: ﴿ﯷ( ) ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ فَإن هَذَا النَّفْي وَالِاسْتِثْنَاء مشعران أتم إشْعَار باختصاص ذَلِك بِمن جمع بَين وصف كَونه مِمَّن ارْتَضَاهُ الله، وَوصف كَونه رَسُولًا، وَالْوَلِيّ، وَإن كَانَ مِمَّن ارْتَضَاهُ الله، فَإن وصف الْمحبَّة لَهُ يُفِيد كَونه مرتضى لله، لكنه لَيْسَ برَسُول.
نعم؛ مَا قدمنَا من حَدِيث الْمُحدثين، وَأن فِي هَذِه الْأمة مِنْهُم، وَأن مِنْهُم عمر رَضِي الله عَنه( )، يُفِيد أعظم إفَادَة، بِأن وصف كَونه من الْمُحدثين، طَرِيق إلَى تلقي شَيْء من علم الْغَيْب، ووصوله إلَيْهِم( )، والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ.
وَانْظُر إلَى قَول عمر رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ: يَا سَارِيَة الْجَبَل، مَعَ كَونه فِي الْمَدِينَة يخْطب فِي منبرها، وسارية وَمن مَعَه من الْمُسلمين فِي أقاصي بِلَاد الْعَجم، فأطلعه الله [تعالى]( ) على الْحَرْب الَّذِي هم فِيهِ، حَتَّى كَأنَّهُ مشَاهد لَهُم، وأسمعهم الله [سبحانه]( ) صَوته، فنفعهم بِهِ، وسلموا( ) من معرة الْكفَّار، مَعَ أن ذهنه فِي تِلْكَ الْحَالة كَانَ مَشْغُولًا بالخطابة، الَّتِي هِيَ محتاجة إلَى جمع الْفَهم عَلَيْهَا، وإفراغ الذِّهْن لَهَا، وَعدم الِاشْتِغَال بغَيْرهَا، لكَون ذَلِك فِي مجمع الصَّحَابَة رَضِي الله [تعالى]( ) عَنْهُم، وهم أهل الفصاحة التَّامَّة، والبلاغة الفائقة.
فَانْظُر إلَى مَا منح الله [تعالى]( ) هَذَا الرجل من الْمَوَاهِب الْعَظِيمَة من كل بَاب؛ جعله خَليفَة الْمُسلمين وإمامهم، ثمَّ فتح الله لَهُ أقطار الأرْض، وَكَانَت دولته مثلًا مَضْرُوبًا لكل دولة، جَامِعَة بَين كَمَال الحزم، والورع، وَالْعَمَل بالشريعة الْوَاضِحَة، ثمَّ جعل لَهُ من المهابة فِي الصُّدُور، مَا لا تبلغ إلَيْهِ المهابة لعادل، أو جَائِر، حَتَّى قَالَ النَّاس: إن درته أهيب فِي الصُّدُور من سيف الْحجَّاج، الَّذِي قتل من عباد الله ظلمًا وعدوانًا نَحْو مائَة وَعشْرين ألفًا.
وَكَانَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله [تعالى]( ) عنهما( ) يَقُول - إذا عوتب على قَول لم يقلهُ فِي أيَّام عمر، أو على فتيا لم يفت بهَا فِي زَمَانه -: كَانَ عمر مهيبًا، فهبته.
وَلَقَد صدق من قَالَ: إن سَعَادَة الْمُسلمين طويت فِي أكفان عمر؛ لِأن مُعظم الْفتُوح الإسلامية فِيهَا، ثمَّ حدث بعده مَا حدث؛ من الِاخْتِلَاف الْعَظِيم فِي آخر أيَّام الإمَام الْمَظْلُوم الشَّهِيد عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ، وَمَا زَالَت من بعد قَتله سيوف الْمُسلمين مُخْتَلفَة، من بَعضهم على بعض، إلَى هَذِه الْغَايَة.
وَأنت إذا كنت عَالما بأخبار النَّاس، عَارِفًا بِمَا اشْتَمَلت( ) عَلَيْهِ تواريخ أهل الْإسْلَام، لم تشك فِي هَذَا، وَلأجل هَذِه المزايا العمرية، قَالَ أمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ، لما رأى عمر فِي أكْفَانه: مَا أحب أن ألْقى الله بِعَمَل رجل من النَّاس، إلَّا بِعَمَل هَذَا. وَإنَّمَا يعرف الْفضل لأهل الْفضل ذووا الْفضل.
وَقد أخبرنَا الصَّادِق المصدوق، بِأن خلَافَة النُّبُوَّة بعده ثَلَاثُونَ عَامًا، فكملت( ) بخلافة الْحسن السبط رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ. وَهَذَا مِمَّا ألْقَاهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم إلَى أصْحَابه من علم الْغَيْب، فَلهُ مدْخل فِي الِاسْتِدْلَال بِهِ على مَا نَحن بصدده.
وَمن أخباره صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم لأصْحَابه ﭫ بِمَا هُوَ من علم الْغَيْب، مِمَّا يتَعَلَّق بِهَذَا الإمَام الْحسن السبط رَضِي الله [تعالى]( ) عَنهُ، قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إن ابْني هَذَا سيد، وسيصلح الله بِهِ بَين طائفتين من الْمُسلمين»( )، فَكَانَ ذَلِك كَمَا أخبر بِهِ الصَّادِق المصدوق.
وَبِالْجُمْلَةِ؛ فالأخبار المتلقاة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم من غيب الله [تعالى]( ) كَثِيرَة جدًّا، تشْتَمل عَلَيْهَا المؤلفات الْمُدَوَّنَة فِي معجزاته.
تواضع الولي لربه:
وَاعْلَم؛ أنه قد اسْتدلَّ البُخَارِيّ بِهَذَا الحَدِيث الَّذِي شرحناه على التَّوَاضُع؛ لذكره لَهُ فِي بَاب التَّوَاضُع، فَمن جملَة مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ، مَشْرُوعِيَّة التَّوَاضُع. وَقد قَالَ ابْن حجر فِي «الْفَتْح» عِنْد تَمام شَرحه لهَذَا الحَدِيث: تَنْبِيه: أشكل وَجه دُخُول هَذَا الحَدِيث فِي بَاب التَّوَاضُع، حَتَّى قَالَ الدَّاودِيّ: لَيْسَ هَذَا الحَدِيث من التَّوَاضُع فِي شَيْء، وَقَالَ بَعضهم: الْمُنَاسب إدْخَاله فِي الْبَاب الَّذِي قبله، وَهُوَ مجاهدة الْمَرْء نَفسه فِي طَاعَة الله تَعَالَى. وَالْجَوَاب عَن البُخَارِيّ من أوجه:
أحدهَا: أن التَّقَرُّب إلَى الله تَعَالَى بالنوافل لَا يكون إلَّا بغاية التَّوَاضُع لله تَعَالَى والتذلل لَهُ. ذكره الْكرْمَانِي( ).
وَثَانِيها: ذكره أيْضًا، فَقَالَ: قيل: التَّرْجَمَة مستفادة مِمَّا قَالَ: «كنت سَمعه»، وَمن التَّرَدُّد.
قلت: وَيخرج مِنْهُ جَوَاب ثَالِث، وَيظْهر لي رَابِع، وَهُوَ أنه يُسْتَفَاد من لَازم قَوْله «من عادى لي وليًّا»؛ لِأنَّهُ يَقْتَضِي الزّجر عَن معاداة الْأوْلِيَاء، المستلزم لموالاتهم، وموالاة جَمِيع الْأوْلِيَاء لَا تتأتى إلَّا بغاية التَّوَاضُع لله تَعَالَى، والتذلل لَهُ، إذْ مِنْهُم الْأشْعَث الأغبر، الَّذِي لَا يؤبه لَهُ( ).
وَقد ورد فِي الْحَث على التَّوَاضُع عدَّة أحَادِيث صَحِيحَة، لَكِن لَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا على شَرطه، فاستغنى عَنْهَا بحديثي الْبَاب.
مِنْهَا: حَدِيث عِيَاض بن حمَار، رَفعه: «إن الله تَعَالَى( ) أوحى إلَيّ أن تواضعوا؛ حَتَّى لَا يفخر أحد على أحد»( )، أخرجه مُسلم، وَأبُو دَاوُد وَغَيرهمَا.
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَفعه: «وَمَا تواضع أحد لله [تَعَالَى]( ) إلَّا رَفعه»( )، أخرجه مُسلم أيْضًا، وَالتِّرْمِذِيّ.
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد، رَفعه: «من تواضع لله تعالى، رَفعه الله تَعَالَى، حَتَّى يَجعله فِي أعلَى عليين...» ( )الحَدِيث، أخرجه ابْن مَاجَه، وَصَححهُ ابْن حبَان. انْتهى.
أقُول: كثيرًا مَا يَقع فِي أذهان كثير من الناظرين فِي البُخَارِيّ، عدم الْمُطَابقَة بَين بعض تراجم الْأبْوَاب، وَبَين مَا ذكره فِيهَا من الْأحَادِيث، فَإذا أعْطوا الْفَهم حَقه، وتدبروا كل التدبر، وجدوه قد عمد إلَى معنى دَقِيق، ومنزع لطيف من مُنَازع ذَلِك الحَدِيث، فَجعله دَلِيلًا على التَّرْجَمَة، وَإذا لم يجد على شَرطه شَيْئًا مِمَّا يصلح لذَلِك الْبَاب، جعل مُجَرّد تَرْجَمته، إشَارَة إلَى ذَلِك الْخَبَر الَّذِي لم يكن على شَرطه( ).
وَقد منح الله [تعالى]( ) هَذَا الرجل؛ من صدق الْفَهم، ونفوذ الذِّهْن، مَا لم يكن لغيره من أذكياء الْعَالم، هَذَا مَعَ مَا وهب لَهُ من حفظ السّنة المطهرة، والتمييز بَين صحيحها وسقيمها، وَاخْتِيَار مَا اخْتَارَهُ فِي كِتَابه، من أصح الصَّحِيح، حَتَّى سَمَّاهُ كثير من أئِمَّة هَذَا الشَّأْن، أمِير الْمُؤمنِينَ فِي الحَدِيث، وَجعل الله سُبْحَانَهُ كِتَابه هَذَا أرْفَعْ مجاميع كتب السّنة المطهرة، وأعلاها، وَأكْرمهَا عِنْد جميع الطوائف الإسلامية، وأجلها عِنْد كل أهل هَذِه الْملَّة، وصاروا فِي جَمِيع الديار إذا دهمهم عَدو، أو أصيبوا بجدب، يفزعون إلَى قِرَاءَته فِي الْمَسَاجِد، والتوسل إلَى الله [تعالى]( ) بالعكوف على قِرَاءَته؛ لما جربوه قرنًا بعد قرن، وعصرًا بعد عصر، من حُصُول النَّصْر، وَالظفر على الْأعْدَاء، بالتوسل بِهِ، واستجلاب غيث السَّمَاء، واستدفاع بذلك كل الشرور( )، وَصَارَ هَذَا لديهم من أعظم الْوَسَائِل إلَى الله سُبْحَانَهُ، وَهَذِه مزية عَظِيمَة، ومنقبة كَرِيمَة، وَلم يكن هَذَا لغير هَذَا الْكتاب، ولا يكون ذلك إلا بجاذب من جواذب الرب سبحانه إليه، لما اختص به الكتاب من حسن الانتقاء، وسلامة مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من قيل وَقَالَ. وَمن تعرض لشَيْء من ذَلِك، أرْغم الله أنفه، بِمَا يرد عَلَيْهِ أهل الإتقان، من الردود الَّتِي تدع اعتراضه هباء منثورًا، وهشيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاح.
وَقد كَانَ هَذَا الرجل فِي الْعِبَادَة على اخْتِلَاف أنْوَاعهَا، والزهد فِي الدُّنْيَا، بمنزلة علية، ورتبة رفيعة، وَتممّ الله لَهُ ذَلِك بِمَا امتحن بِهِ فِي آخر أيَّامه، من أعدَاء الْعلمَاء العاملين، والمتجرئين على عباد الله الصَّالِحين، حَتَّى مَاتَ كمدًا، رَحمَه الله، ووفر عِنْده جزاءه، فكوفئ فِي كِتَابه هَذَا بِهَذَا الْحَظ الْعَظِيم فِي الدُّنْيَا؛ ليتوفر له فِي الْأخْرَى بِمَا( ) يصل إلَيْهِ من الثَّوَاب الْحَاصِل من انْتِفَاع النَّاس بِهِ، فَإن الْعلم الَّذِي ينْتَفع بِهِ هُوَ إحْدَى الثَّلَاث الَّتِي يَدُوم للْمَيت ثَوَابهَا بعد انْقِطَاع كل شَيْء عَنهُ، كَمَا صَحَّ الحَدِيث بذلك، الَّذِي أخرجه مُسلم، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «إذا مَاتَ ابْن آدم، انْقَطع عمله، إلَّا من ثَلَاث: صَدَقَة جَارِيَة، أو علم ينْتَفع بِهِ، أو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ»( )، وَأخرجه ابْن مَاجَه، بِإسْنَاد صَحِيح، من حَدِيث أبي قَتَادَة، بِنَحْوِهِ. وَبِمَا ذكرنَا تعرف الْجَواب على مَا قَالَه الدَّاودِيّ إجْمَالًا.
وَأما مَا حَكَاهُ ابْن حجر عَن الْكرْمَانِي من الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين، فَيُقَال على الأول: إن كل الْعِبَادَات، وَسَائِر الصَّلَوَات؛ فرائضها، ونوافلها، هِيَ عبَادَة للرب، وَالْعَابِد متواضع للمعبود دَائِمًا، خُصُوصًا عِنْد الْعِبَادَة، فَمَا الْوَجْه لتقييد النَّوَافِل الْمَذْكُورَة فِي الْبَاب بِقَيْد التَّوَاضُع، مَعَ أن غَيرهَا مثلهَا؟
وَلِهَذَا ورد أن الصَّلَوَات الْفَرَائِض وَغَيرهَا، تَتَفَاوَت بتفاوت الْخُشُوع، حَتَّى تكون لبَعض الْعباد صَلَاة كَامِلَة، ولبعضهم نصف صَلَاة، ولبعضهم أقل من ذَلِك، كَمَا فِي الحَدِيث الْوَارِد فِي هَذَا الْمَعْنى.
والخشوع لَا يتم إلَّا بغاية الخضوع، فَهَذِهِ خَاصَّة للعبادات، خُصُوصًا الصَّلَوَات، شَامِلَة لَا مُخْتَصَّة بِنَوْع مِنْهَا، وَكلهَا إذا حصل الاستكثار من نوافلها، حصلت للْعَبد الْمحبَّة من الرب تعالى، فَيلْزم على هَذَا أن الْعِبَادَات كلهَا يسْتَدلّ بهَا على التَّوَاضُع فِي جَمِيع الْأحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي أنْوَاعهَا فِي البُخَارِيّ وَغَيره، بل مُجَرّد الْعُبُودِيَّة، إذا لم تكن على تواضع وخضوع، فَلَيْسَتْ عبودية( ) مُعْتَبرَة.
وَأما الْوَجْه الثَّانِي، فَمَا أبعده، فالرب سُبْحَانَهُ قد وصف نَفسه بِأنَّهُ المتكبر، وَأنه ذُو الْكِبْرِيَاء، وَأنه ذُو الْجلَال، فَمَا أسمج بِأن يُوصف بالتواضع مَعَ عَبده الحقير الذَّلِيل.
قَالَ فِي «الصِّحَاح»( ): التَّوَاضُع: التذلل، فَانْظُر؛ هَل يَصح إطْلَاق التَّوَاضُع، الَّذِي مَعْنَاهُ فِي هَذِه اللُّغَة الْعَرَبيَّة التذلل، على رب الْعَالم، وخالق الْكل، ورازقه، ومحييه، ومميته؟ سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم، تَعَالَى قدرك، وَجل اسمك، سُبْحَانَكَ مَا أعظم شَأْنك، سُبْحَانَكَ مَا أعز سلطانك.
وَأما قَول ابْن حجر: قلت: وَيخرج مِنْهُ جَوَاب ثَالِث، يُرِيد أنه يخرج من التَّرَدُّد، كَمَا خرج من قَوْله: «كنت سَمعه»، وَهَذَا الَّذِي استخرجه، مثل الْوَجْه الثَّانِي الَّذِي ذكره الْكرْمَانِي، وَكِلَاهُمَا فِي غَايَة السُّقُوط، وَنِهَايَة الْبطلَان.
أما قَول ابْن حجر: وَيظْهر لي وَجه رَابِع... إلَى آخر كَلَامه، فَلَمَّا قَيده بِأن يكون التَّوَاضُع لله سُبْحَانَهُ، لم يبْق للْوَلِيّ مِنْهُ شَيْء، وَلَا مُوجب لذَلِك، فَإن تواضع الْعباد مَعَ بَعضهم الْبَعْض، هُوَ الَّذِي ندب الله [تعالى]( ) إلَيْهِ، وَجَاءَت بِهِ الترغيبات الْكَثِيرَة. وَأما تواضع الْعباد مَعَ الرب سُبْحَانَهُ، فهم أحْقَر وَأقل من أن يتواضعوا لَهُ، وَإن كَانَ ذَلِك من لَوَازِم الْعُبُودِيَّة.
وَانْظُر فِي مِثَال هَذَا فِي الْأحْوَال، فَإنَّهُ يسمح أن يُقَال: تواضع الرجل لسلطانه ولوالديه؛ لِأن التَّوَاضُع هُوَ التذلل، بعد التَّلَبُّس بضده، كَمَا تدل عَلَيْهِ صِيغَة التفعل، مَعَ أن ابْن حجر ذكر فِي أول هَذَا الْبَاب مَا لَفظه: بَاب التَّوَاضُع، بِضَم الْمُعْجَمَة، مُشْتَقّ من الضعة، بِكَسْر أوله، وَهِي التذلل والهوان، وَالْمرَاد بالتواضع: إظْهَار التذلل لمن يُرَاد تَعْظِيمه، وَقيل: هُوَ تَعْظِيم من فَوْقه لفضله( ). انْتهى.
فَانْظُر؛ هَل يَصح إطْلَاقه على الرب تعالى على كلا الْمَعْنيين؟ فَلَعَلَّهُ سهى عَن أول الْبَاب( ).
وَأما تواضع الْعباد مَعَ بَعضهم الْبَعْض، فَهُوَ الممدوح المرغب فِيهِ، كَمَا ذكره فِي الحَدِيث الَّذِي اسْتدلَّ بِهِ فِي آخر الْبَحْث، «إن الله أوحى إلَيّ أن تواضعوا، حَتَّى لَا يفخر أحد على أحد»، فَإن المُرَاد تواضع الْعباد لبَعْضهم( ) الْبَعْض، حَتَّى لَا يفخر أحد على أحد.
وَأما حَدِيث: «من تواضع لله رَفعه [الله]( )»... إلخ، فَالْمُرَاد: تواضع لعباد الله لأجل الرب سُبْحَانَهُ [وتعالى]( )، امتثالًا لما أرشد إلَيْهِ رَسُوله، أو يكون المُرَاد بِهِ [التَّوَاضُع لكتابه، ولسنة رَسُوله، ولعلماء أمته، وَلَابُد من هَذَا، فَإن الله]( ) أعظم وَأجل من أن يتواضع لَهُ الْعباد، فَيكون معنى قَوْله: «من تواضع لله» من تواضع لأجل الله تعالى( )، وَمن هَذَا الْقَبِيل: من تصدق لله، من أحب لله، وَأبْغض لله، وَنَحْو ذَلِك كثير.
وَإذا عرفت هَذَا، كَانَ هَذَا الْوَجْه الَّذِي ذكره ابْن حجر، أحسن مَا يحمل عَلَيْهِ تَرْجَمَة البُخَارِيّ، لَكِن بِدُونِ ذَلِك التقييد، إلَّا أن يُرِيد هَذَا الْمَعْنى الَّذِي ذَكرْنَاهُ، فَيكون معنى قَوْله لَا يَتَأتَّى إلَّا بغاية التَّوَاضُع لله؛ أي: لأجله.
وَقد وَردت أحَادِيث فِي مَشْرُوعِيَّة التَّوَاضُع غير مَا ذكره المُصَنّف، مِنْهَا مَا هُوَ صَحِيح، وَمِنْهَا مَا هُوَ حسن.
وَورد فِي ذمّ التكبر، الَّذِي هُوَ مُقَابل التَّوَاضُع، أحَادِيث صَحِيحَة، مِنْهَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث حَارِثَة بن وهب، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم يَقُول: «ألا أخْبركُم بِأهْل النَّار؟ كل عتل جواظ( ) مستكبر»( ).
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد، وَأبي هُرَيْرَة، عِنْد مُسلم وَغَيره، قَالَا: يَقُول الله تعالى: «الْعِزّ إزَاره، والكبرياء رِدَاؤُهُ، فَمن نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهَا عَذبته»( ).
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد، عِنْد مُسلم، قَالَ: «احتجت الْجنَّة وَالنَّار، فَقَالَت النَّار: فيَّ الجبارون والمتكبرون، وَقَالَت الْجنَّة: فيَّ ضعفاء الْمُسلمين ومساكينهم»( ).
وَأخرج مُسلم وَغَيره، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله يَوْم الْقِيَامَة، وَلَا يزكيهم، وَلَا ينظر إلَيْهِم، وَلَهُم عَذَاب ألِيم؛ شيخ زَان، وَملك كَذَّاب، وعائل مستكبر»( ).
وَأخرجه الْبَزَّار، بِإسْنَاد حسن، من حَدِيث سلمَان، وَأخرج النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه، من حَدِيث ابْن عَمْرو، نَحوه.
وَأخرج مُسلم وَغَيره، من حَدِيث ابْن مَسْعُود، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «لَا يدْخل الْجنَّة من كَانَ فِي قلبه مِثْقَال ذرة من كبر»( ).
وَأخرج البُخَارِيّ وَغَيره، من حَدِيث ابْن عمر: أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «بَيْنَمَا رجل مِمَّن كَانَ قبلكُمْ، يجر إزَاره من الْخُيَلَاء، خسف بِهِ، فَهُوَ يتجلجل فِي الأرْض إلَى يَوْم الْقِيَامَة»( ).
وَأخرج نَحوه أحْمد، وَالْبَزَّار، بِرِجَال الصَّحِيح، من حَدِيث أبي سعيد، وَأخرج نَحوه الْبَزَّار، بِإسْنَاد رِجَاله ثِقَات، من حَدِيث جَابر.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم قَالَ: «بَيْنَمَا رجل يمشي فِي حلَّة، تعجبه نَفسه، مُرَجِّلٌ رَأسه، يختال فِي مشيته، إذْ خسف الله بِهِ، فَهُوَ يتجلجل فِي الأرْض إلَى يَوْم الْقِيَامَة»( ).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، من حَدِيث ابْن عمر، عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «لَا ينظر الله إلَى رجل جر ثَوْبه خُيَلَاء»( ).
وَأخرج التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه»، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ، من حَدِيث ثَوْبَان، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم: «من مَاتَ، وَهُوَ بَرِيء من الْكبر والغلول وَالدّين، دخل الْجنَّة»( ).
خاتمة الشرح:
وَإلَى
هُنَا انْتهى الشَّرْح للْحَدِيث الْقُدسِي فِي نَهَار الِاثْنَيْنِ لعله سَابِ
شهر الْقعدَة من شهور سنة 1239، بقلم مُؤَلفه مُحَمَّد بن عَليّ الشَّوْكَانِيّ
غفر الله لَهما( ).
- فهرس الموضوعات
- الــــمــــوضـــوع الصفحة
- ديباجة التحقيق
- قسم الدراسة
- الفصل الأول : ترجمة المصنف 15
- * المبحث الأول: حياته الشخصية
- - المطلب الأول: اسمه ونسبه
- - المطلب الثاني: مولده ونشأته
- - المطلب الثالث: أخلاقه وعبادته 15
- - المطلب الرابع: وفاته 16
- * المبحث الثاني: حياته العلمية 17
- - المطلب الأول: طلبه للعلم 17
- - المطلب الثاني: مشايخه 19
- - المطلب الثالث: عقيدته وطريقته 22
- * المبحث الثالث: حياته العملية 24
- - المطلب الأول: عمله في القضاء 24
- - المطلب الثاني: تلاميذه 25
- - المطلب الثالث: مؤلفاته 28
- الفصل الثانى: التعريف بالكتاب 35
- * المبحث الأول: توثيق الكتاب 35
- - المطلب الأول: عنوان الكتاب 35
- - المطلب الثاني: نسبته إلى المؤلف 35
- - المطلب الثالث: تاريخ تأليف الكتاب 36
- * المبحث الثاني: أهمية الكتاب 37
- الفصل الثالث : معنى الولاية 39
- * المبحث الأول: معنى الولاية لغة 39
- * المبحث الثاني: مفهوم ولاية الله تعالى في الشرع 45
- * المبحث الثالث: الفرق بين مقام النبوة ومقام الولاية 49
- * المبحث الرابع: مقام النبوة أفضل من مقام الولاية 52
- * المبحث الخامس: ضابط التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 55
- * المبحث السادس: كرامات الأولياء 58
- * المبحث السابع: الفرق بين الكرامة والمعجزة 60
- الفصل الرابع : تخريج حديث الولي 65
- * المبحث الأول: من رواية أبي هريرة 65
- * المبحث الثاني: من رواية أم المؤمنين عائشة 72
- * المبحث الثالث: من رواية أبي أمامة 74
- * المبحث الرابع: من رواية علي بن أبي طالب 76
- * المبحث الخامس: من رواية ابن عباس 77
- * المبحث السادس: من رواية أنس بن مالك 79
- * المبحث السابع: من رواية حذيفة بن اليمان 82
- * المبحث الثامن: من رواية معاذ بن جبل 84
- * المبحث التاسع: من رواية ميمونة بنت الحارث 86
- * المبحث العاشر: من رواية وهب بن منبه 88
- قسم التحقيق
- الفصل الأول: منهج التحقيق 91
- الفصل الثاني: وصف النسخ الخطية 95
- الفصل الثالث: صور من النسخ الخطية 95
- نص الكتاب محققًا
- الفصل الأول: من هو الولي؟
- 105
- خوارق غير الأولياء 128
- المكاشفات الصحيحة وأولياء المؤمنين 129
- صفات الولي 131
- فصل في جواز وقوع الكرامات 135
- صور من كرامات السلف 140
- محل الكرامة 151
- استشكال المعاداة من جانب الولي 152
- معيار الولاية 157
- التفريق بين ما هو كونى و ما هو دينى 162
- صور من الإرادة الكونية 165
- نفي القدر 169
- الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأولياء بعد الأنبياء 170
- بغض الرافضة لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 172
- حب أهل البيت وزراريهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 176
- منشأ الباطنية والروافض 178
- افتراء الرافضة على السنة وبغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 184
- ولاية الله تعالى والعلماء العاملون 186
- لماذا دخل العلماء فى زمرة أولياء الله تعالى؟
- 188
- إجهاز الإمام الشوكاني على التقليد والمقلدين للمذاهب 191
- الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في مسائل الدين هو الطريقة العلمية 196
- تعريف التقليد وبيان حكمه عند الإمام الشوكاني 201
- ذكر أقوال الأئمة في التقليد 209
- مذهب العالم عند فقد الدليل 218
- الاجتهاد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 221
- موقف عوام المسلمين من التقليد 224
- الاجتهاد ووجود النص 225
- منهج المقلدين هو منطق السوفسطائيين 227
- دعوتهم لسد باب الإجتهاد 229
- جهاد المصنف للمقلدين 231
- خطر التّقليد والمقلدين 237
- وجود الاجتهاد 238
- الإجتهاد فى أهل اليمن 239
- من جهل شيئا عاداه 240
- دور أولى الأمر نحو المقلدين 241
- تكريم الله سبحانه للأولياء 245
- الفصل الثاني: الطريق إلى ولاية الله 251
- من أداء الفرائض ترك المعاصي 255
- إبطال الفرائض بالحيل 256
- الرد على من جوز الحيل المحرمة 260
- فى الشريعة ما يغني عن الحيل 266
- المعاريض 268
- من الحيل المستلزمة للكفر 271
- التّقرب لله بالنوافل 274
- محبة الله والاستكثار من النوافل 283
- من نوافل الصيام 283
- من نوافل الحج 287
- من نوافل الصدقة 288
- التقرب بالأذكار 292
- أعظم الأذكار أجرًا 295
- أذكار المؤقته 304
- ذكر الله بكلمة التوحيد 305
- الإكثار من الصلاة على النبي 308
- ملازمة التسبيح 310
- الأدعية المأثورة 311
- الأدعية عقب الوضوء والصلاة 313
- الأدعية عند الأذَان والإقامة ودخول المسجد 314
- الأدعية داخل الصلاة 316
- الأدعية في الصيام والحج والجهاد والسفر وغيرها 316
- الإيمان وقرب العبد من ربه 316
- الإيمان بالقدر 318
- الإيمان والإحسان 320
- الدعاء من أعظم القرب إلى الله 321
- الولاية ونفع الناس 322
- حتى أحبه 324
- من جاء بالنوافل وترك الفرائض 327
- ليست المداومة شرطًا في القرب 328
- محبة الله مشتملة على المتقرب بالفرائض 331
- الفصل الثالث: أثر محبة الله في حياة الولي (هدايته وتوفيقه) 334
- أستشكال كيف يكون الله سمع العبد وبصره 337
- بطلان آراء الاتحادية والصوفية 349
- تقديم السمع على البصر 353
- إجابة دعوة الولي 354
- أثر النوافل في محبة الله لعبده 360
- هل الخواطر معصومة 362
- متى نسلم بآراء أهل الولاية وخواطرهم 363
- الإحسان ومقاماته 370
- طهارة الباطن مدخل الولاية الكبري 372
- الطريق إلى طهارة الباطن 373
- ما يتركب منه الإحسان 390
- إجابة دعوة الولي 417
- مقام المحبة 418
- ملازمة المحب للدعاء 422
- المراد بتردد الله سبحانه عن نفس المؤمن 427
- المحو والإثبات في المقادير 436
- يكره الموت وأكره إساءته 465
- الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى 469
- تواضع الولي لربه 483
- خاتمة الشرح
- فهرس الموضوعات
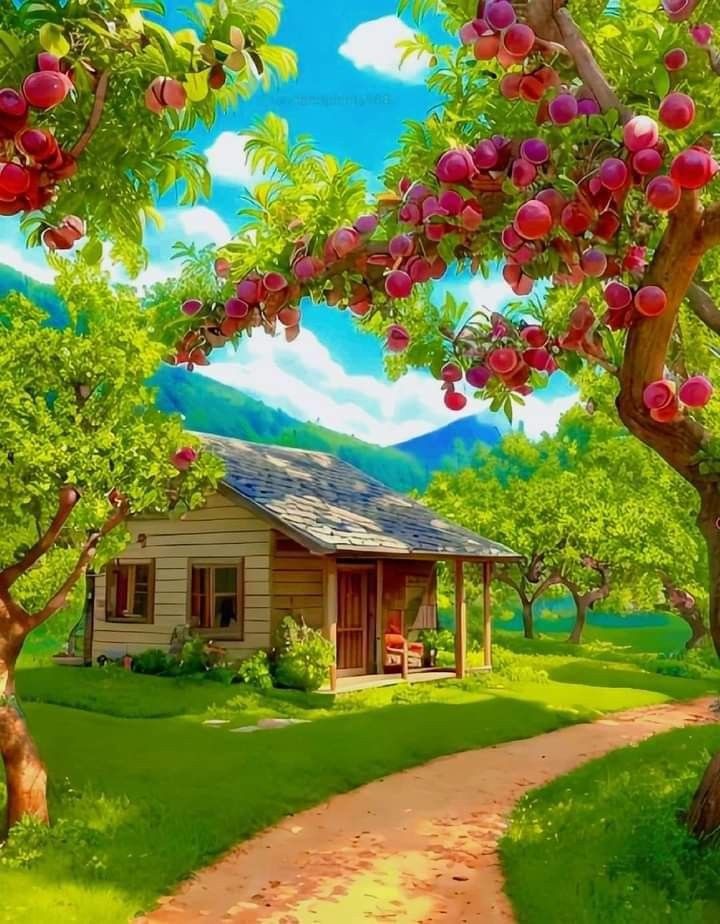
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق