لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب
لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني( ت:973 هـ)
دراسة وتحقيق
د.مها بنت عبدالعزيز العسكر/ د.نوال بنت سليمان الثنيان الأستاذتان المساعدتان في قسم اللغة العربية - كلية التربية للبنات بالرياض
ملخص البحث
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،،، وبعد .
نقدم بين يدي القارئ الكريم كتاباً من كتب التراث ، وهو متن من متون النحو والصرف ، يحمل اسم “ لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب ” لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني الصوفي المتوفى سنة ( 973 هـ ) .
وقد ألفه لعلماء عصره ومريديه من الصوفية بطريقة مختصرة ميسرة ليسهل الفهم والتطبيق منعاً للوقوع في اللحن في الكتاب والسنة .
وقد اشتمل البحث على مقدمة وقسمين رئيسين هما الدراسة والتحقيق .
وقد تم في الدراسة التعريف بالكتاب وبمؤلفه ، وقد عرف الشعراني بنفسه في كتابه “ لطائف المنن ” تعريفاً شاملاً جامعاً ، حيث عاش في عهد العثمانيين وهو العصر الذي انتشرت فيه كتب الشروح والمتون ، وذلك شرحاً لكتب المتقدمين واختصاراً لها ، وهو ابن عصره ، فقد حذا حذوهم في هذا النوع من التأليف الذي يفيد الناشئة كثيراً ، وقد سلكه من قبل عدد من العلماء ، كالزمخشري في مفصله ، وابن الحاجب في كافيته ، وابن هشام في شذوره ، وقد كثرت مؤلفاته بعد أن نضج علمه على أيدي شيوخه ، فأخذ ينشر علمه بالتعليم والتأليف .
أما كتابه هذا فهو مع صغر حجمه فقد جمع فيه مجموع ما في المطولات والشروح وأتى فيه بكل باب من أبواب النحو والصرف بطرف مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والحديث الشريف وبعض الشواهد الشعرية ، ثم ختمه بخاتمة جمع فيها خلاصة علم النحو .
والله نسأل أن ينفع به ويجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم سبحانه .
• • •
المقدمـة :
الحمـد لله والصـلاة والسـلام على رسـول الله محمد بن عبـد الله. وعلـى آلـه وصحبـه وسلــم... وبـعـد
فبعـون من الله وتوفيقه يسر لنا العثور على هذه المخطوطة المعنـونة بـ (لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب) لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني الصـوفــي ، (ت 973هـ) ، للوقوف على آثار السابقين ومكانتـهم العلميـة إذ يتبـين من العنوان الهدف الرئيسـي من تأليفه ، وهو منع الوقوع في اللحن في مصدري التشريع الإسـلامي وهمـا: القـرآن الكريــــم ، والسـنـة النبـويـة المطهــرة ، وهـو مختـصـر مـن مختصـرات النحـو ، جمـع فيهـا أبوابـه بصـورة ميسرة مختصرة مبتعداً فيه عن المطـولات والحواشـي التي انتشـرت في عصـره خاصـة وذلـك لتقريبهـا إلى علمـاء عصـره ليسهل فهمها وتطبيقها ، وقد قسـم الكتـاب إلى ستة أبواب وخاتمة كما جـاء في المقدمة.
وقد قدمنا للكتاب بدراسة لمؤلفـه ، إذ هو من علماء النحو المغمورين مع شهرته في عصـره.
ويأتي هذا البحث في مقدمة وقسمين رئيسين هما: الدراسة والتحقيق.
القسم الأول: الدراسة ، وقد اشتمل على فصليـن:
الفصـل الأول: (التعريف بصاحب الكتاب) وفيه مباحث ، هي:
اسمـه ونسبه ، مولده ونشـأته ، وتلاميـذه ، مؤلفاته ، وفاته.
الفصل الثاني: (التعريف بالكتـاب) وفيـه مباحـث ، هي:
نسبة الكتـاب ، منهج المؤلف في الكتاب ، وصف النسخة الخطيـة ، المنهج المتبع في التحقيـق.
القسم الثاني: النص المحقق والتعليق عليـه.
وعلى الرغم من كثرة ما حقق أو طبع من مؤلفات الشعراني في شتى العلوم إلا أنه لم يقـدم للمكتبة العربية كتاب في علم النحو سوى هذا الكتاب والذي نضعه بين يدي القارئ الكريم.
وقد نما إلى علمنا بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب أنه سبق وأن حُـقق قبل أربعة عشر عاماً من قبــل د. زيـان أحمـد الحـاج إبراهيـم ، ونشـر في مجـلـة معهـد المخطوطـات العـربيـة فـي الكويـت ـ المجلد30 ـ الجـزء الثاني ، في شهـر ذي القعــدة 1406هـ صفحــة: 501 ــ 574 ، ولم يتسن لنا الاطلاع عليه لندرة نسخ مجلة المعهـد ، وبعد السؤال عن النسخ التي اعتمدها المحقق المذكور كان الجواب أنه اعتمد نسختين غير النسختين المعتمدتيـن في تحقيقنـا هذا.
والله نسـأل أن ينفع به وعملنا فيه ويجعله خالصاً لوجهه الكريم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
الفصل الأول ( التعريف بصاحب الكتاب )
اسمه ونسبه :
عرف الشعرانـي بنفسه في كتابه لطائف المنن ، فقال :
" فإني بحمد الله تعالى عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن زوفا، ابن الشيخ موسى المكنى في بلاد البهنسا بأبي العمران ، جدي السادس ابن السلطان أحمد ابن السلطان سعيد ابن السلطان فاشين ابن السلطان محيـا ابن السلطان زوفا ابن السلطان ريان ابن السلطان محمـد بن موسى بن السيد محمـد بن الحنفية ابن الإمام علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه (1) ـ .
وقد افتخر الشعراني بنسبه ؛ إذ ذكر أن منّ النعم التي من الله تبارك وتعالى بها عليه شرف نسبه؛ لكونه من ذرية الإمام محمد بن الحنفية ، وأنه من أبناء ملوك الدرنى(2).
وهو الشيخ العالم الزاهد ، الفقيه المحدث ، المصري الشافعي الشاذلي الصوفي الأنصاري .
مولده ونشأته:
ولـد في قلقـشنـدة بمصـر في السابـع والعشرين من شهر رمضان المبـارك سنـة (898هـ)، ثم انتقل إلى ساقية أبي شعرة من قرى المنوفية ، وإليها نسبته ، فيقال : الشعراني ، والشعراوي(3) .
وفي أيامه انتقلت الديار المصرية من السلاطين المماليك إلى الدولة العثمانية (4) .
نشأ يتيم الأبوين ؛ إذ مات أبوه وهو طفل صغير ، ومع ذلك ظهرت عليه علامة النجابة ومخايل الرئاسة ، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن ثماني سنين ، وواظب على الصلوات الخمس في أوقاتها ، ثم حفظ متون الكتب ، كأبي شجاع في فقه الشافعية ، والآجرومية في النحو ، وقد درسهما على يد أخيه الشيخ عبد القادر الذي كفله بعد أبيه .
ثم انتقل إلى القاهرة سنة إحدى عشرة وتسعمائة ، وعمره إذا ذاك ثنتا عشرة سنة ، فأقام في جامع أبي العباس الغمري وحفظ عدة متون منها :
كتاب المنهاج للنووي ، ثم ألفية ابن مالك ، ثم التوضيح لابن هشام ، ثم جمع الجوامع ثم ألفية العراقي ، ثم تلخيص المفتاح ، ثم الشاطبية ثم قواعد ابن هشام ، وغير ذلك من المختصرات . وعرض ما حفظ على مشايخ عصره (5) .
ولبث في مسجد الغمري يُعَلـِّم ويتعلم سبعة عشر عاماً ، ثم انتقل إلى مدرسة أم خوند ، وفي تلك المدرسة بزغ نجمه وتألق (6) .
حبب إليـه علم الحديث فلزم الاشتغال به والأخذ عن أهله ، وقد سلك طريق التصوف وجاهد نفسه بعد تمكنه في العلوم العربية والشرعية (7).
شيوخه وتلاميذه:
أفاض الشعراني في ذكر شيوخه في كتبه ، وبين مدى إجلاله لهم خاصة في كتابه (الطبقات الكبرى) (8) ، وذكر بأنهم نحو خمسين شيخاً منهم (9):
الشيخ
أمين الدين ، الإمام والمحدث بجامع الغمري ، والشيخ الإمام العلامة شمس الدين
الدواخلي ، والشيخ شمس الدين السمانودي ، والشيخ الإمام العلامة شهاب الدين المسيري
والشيخ نور الدين المحلي ، والشيخ نور الدين الجارحي المدرس بجامع الغمري والشيخ
نور الدين السنهوري الضرير الإمام بجامع الأزهر ، والشيخ ملاعلي العجمي ، والشيخ
جمال الدين الصاني ، والشيخ عيسى الأخنائي ، والشيخ شمس الدين الديروطي ، والشيخ
شمس الدين الدمياطي الواعظ ، والشيخ شهاب الدين القسطلاني ، والشيخ صلاح الدين
القليوبي ، والشيخ العلامة نور الدين بن ناصر ، والشيخ نور الدين
الأشموني ، والشيخ سعد الدين الذهبي ، والشيخ برهان الدين القلقشندي ، والشيخ شهاب
الدين الحنبلبي ، والشيخ زكريا الأنصاري ، والشيخ شهاب الدين الرملي ، وجلال الدين
السيوطي ، وناصر الدين اللقاني ، وغيرهم كثير ، حيث قرأ عليهم عدة كتب في مختلف
العلوم والفنون .
أما مشايخ الصوفية الذين أخذ عنهم وصحبهم فهم :
علي المرصفي ، ومحمد الشناوي ، وعلي الخواص (10) وقد صرح في مقدمة كتابه بتبعيته لهذا المذهب بذكر اسم أحد أئمة الجماعة ـ ممن لم يعاصرهم ـ وهو أبو الحسن الشاذلي.
أما تلاميذه فهم كثر ولم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى واحــد منهم، وقد أنشأ مدرسة تبث تعاليمـه وعلـومه فتقاطر إليه الطلاب المريدون ، وكان يأتي إلى بابه الأمراء ، ويسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلاً ونهاراً (11) .
مؤلفاته:
خلف الشعراني آثاراً تزيد على خمسين كتاباً في موضوعات شتى ، وقد دلت كتبه على أنه اجتمع بكثير من العلماء والأولياء الصالحين (12) ، منها :
1. أسرار أركان الإسلام (في شريعة الإسلام ) :
مـوضـوعـه: الإســلام ، مبــادئ عـامة ، العبـادات في التصـوف ، وقد نشــر سنة1400هـ ـ 1980م بتحقيق: عبدالقادر أحمد عطا ، الذي نص في مقدمته أنه غير اسمه ليتطابق مع موضوعه تماماً ، ولأن العنــاوين الطويلة لا تناسب العصر ، وأن اسمه الأصلي (الفتح المبين في جملة من أسرار الدين ) (13) .
2. الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية :
موضوعه : التصوف وقد نشر في بيروت سنة 1408هـ ـ 1988م .
بتحقيق : طه عبد الباقي سرور ، والسيد محمد عيد الشافعي .
3. البحر المورود في المواثيق والعهود . وقد نشر سنة 1378هـ .
4. البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير .
موضوعه : الحديث والتخريج . وقد طبع بمصر سنة 1377هـ ـ 1860م .
وقد ذكر في هدية العارفين باسم : السراج المنير في غرائب أحاديث البشير النذير(14).
5. الطبقات الصغرى ، وقد نشر سنة 1390هـ ـ 1970م ، تحقيق : عبد القادر أحمد عطا .
6. الطبقات الكبرى المسمـاة بـ ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ) ، وبهامشه الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية .
موضوعه : التصوف ، تراجم مشاهير الأولياء من أبي بكر رضي الله عنه إلى أيامه ، في مجلدين كبيرين . وقد طبع بمصر مراراً ، كما طبع في بيروت .
7. الطبقات الوسطى . منها نسخة في الخزانة التيمورية .
8. الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة . تقـديم ، عبد الحميـد صالح حمدان وهو موسوعة في علوم القرآن ، والفقه وأصوله ، والدين ، والنحو ، والبلاغة ، والتصوف . منها نسخة في دار الكتب المصرية ، وفي برلين وغوطا .
9. كشف الغمة عن جميع الأمة .
في الفقه على المذاهب الأربعة ، نشر سنة 1332هـ .
10. لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق ، وهي (المنن الكبرى).
موضوعه : التصوف ، الأخلاق الإسلامية ، وقد ترجم فيه لنفسه وطبع بمصر غير مرة .
11. لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ، بهامشه كتاب : البحر المورود في المواثيق والعهود .
موضوعه : التصوف وقد طبع غير مرة .
12. المختار من الأنوار في صحبة الأخيار .
طبع سنة 1405هـ - 1985م . تحقيق : عبد الرحمن عميرة .
13. مختصر الألفية لابن مالك في النحو ولم تذكر المصادر عنه شيئاً.
14. مختصر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (تذكرة القرطبي) .
موضوعه : الموت ، الحياة الأخرى ، البرزخ ، القيامة ، وقد طبع بمصر مراراً .
15. مختصر تذكرة الإمام السويدي في الطب ، وبالهامش تذكرة شهاب الدين أحمد سلاقة القليوبي الشافعي ولم تذكر المصادر عنه شيئاً.
16. مختصر كتاب صفوة الصفوة ( لأبي الفرج بن الجوزي ) .
موضوعه : الصحابة والتابعون ، الإسلام ، تراجم . وقد طبع غير مرة .
17. مشارق الأنوار في بيان العهود المحمدية .
طبع في القاهرة سنة : 1287هـ ،وفي الأستانة أيضاً .
18. المقدمة النحوية في علم العربية ولم تذكر المصادر عنه شيئاً.
19. الميزان الكبرى :
موضوعه : الفقه الإسلامي ، مذاهب أصول الفقه ، وهو مدخل لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية . وقد طبع بمصر مراراً .
20. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ، وبهامشه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر للمؤلف نفسه .
موضوعه : التصوف ، وحدة الوجود ، وهو في عقائد الصوفية منه نسخة في مكاتب أوربا . وقد طبع بمصر مراراً وغيرها كثير (15).
وفاته:
توفى في القاهرة ، في جمادى الأولى سنة (973هـ) ، ودفن بجانب زاويته بين السورين . وقد قام بالزاوية بعده ولده الشيخ عبد الرحمن ثم توفى سنة إحدى عشرة بعد الألف(16) .
الفصل الثاني : (التعريف بالكتاب)
أولاً : نسبة الكتاب :
لم تنص كتب التراجم التي ترجمت للشعراني على اسم هذا الكتاب ضمن مؤلفاته ، وعلى الرغم من كثرة تآليفه في فنون شتى لم يذكر لـه من مؤلفات علم النحو سوى كتابين - سبق الإشارة إليهما في مؤلفاته - هما:
مختصر الألفية لابن مالك في النحو ، والمقدمة النحوية في علم العربية . ويبدو أن الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الثاني وليس الأول ، لأن ترتيب الكتاب ليس على ترتيب أبواب الألفية كما أن مادته العلمية ليست مادة الألفية ، إضافة إلى ما ذكره بعض الشراح على صفحة العنوان من أن هذا الكتاب مقدمة حيث قال : " اعلم أن ما على هذه النسخة من الحواشي كتبناه لمجـرد التنبيه من غيرتحرير ، وقد وقع التحرير بعد ذلك في شرح هذه المقدمة … "
وقد قال الشعراني في مقدمة كتابه:
" فهذا كتاب نفيس اقتبسته من نور كلام العرب الفصحاء … فأكرم به من كتاب جمع مع صغر حجمه مجموع ما في المطولات ، وأغنى من طالعه عن جميع المختصرات " والمطلع عليه يرى بحق أنه مقدمة نحوية مختصرة في علم العربية .
إلا أن هذه المقدمة النحوية لم ينص من ترجم له على عنوانــها ، وقد نص عليها الشعراني نفسه في مقدمة الكتاب إذ قال : " وسميته بلباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب " وقد ذكر العنوان نفسه على صفحة الغلاف ، إضافة إلى وجود عدة نسخ للكتاب تـنص على العنوان نفسه منسوباً إلى المؤلف نفسه. والله تعالى أعلم.
ثانياً : منهج المؤلف في الكتاب :
ألف المصنف هذا الكتاب في النحو وغرضه من تأليفه هذا ذكره في مقدمة الكتاب ، قال : "فهذا كتاب نفيس اقتبسته من نور كلام العرب الفصحاء في نحو يوم رجاء أن أكتب في حزب أنصار دين الله تعالى ، وليعرف به إخواننا المريدون لطريق الله عز وجل مواطن اللحن في كلام الله عز وجل وكلام رسوله r .. " .
من هذا النص يتبين لنا أن الغرض من التأليف هو تفادي الصوفيـة اللحن في كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام .
ومن أسباب تأليف هذا الكتاب أن يكون مرجعاً للفقراء من مريديه وأتباعه من المتصوفة دون أن يحوجهم للرجوع إلى كتب النحو الأخرى ، نص على ذلك المصنف في نهايـة خطبته فقال : " فأكرم به من كتاب جمع مع صغر حجمه مجموع ما في المطولات وأغنى من طالعه عن جميع المختصرات ".
وقد قسم المصنف كتابه إلى ستة أبواب وخاتمة ، والأبواب على النحو التالي :
الأول : في بيان الاسم ومباحثه .
الثاني : في المرفوعات وأنواعها الاثنى عشر .
الثالث : في المنصوبات وأنواعها الخمسة عشر .
الرابع : في المجرورات والمجزومات معاً .
الخامس : في بيان التوابع لما قبلها في الإعراب .
السادس : في بيان الأربعة أبواب الخارجة عن الإعراب .
وكانت الخاتمة في بيان زبدة علم النحو ، وأنه يدور على ثلاثة أقطاب : الفاعلية والمفعولية والإضافة .
وبالنسبة لمصادره لم يصرح المصنف بمصادره من المصنفات أو العلماء الذين يمكن الوصول إلى مصادره من خلال مؤلفاتهم .
كان الكتاب مختصراً من مختصرات النحو ، ومع ذلك كان نصيب الشواهد القرآنية في الكتاب كبيراً موازنة بغيرها من الشواهد ، يكتفي غالباً بذكر موضع الشاهد من الآية ، وقد يذكر الآية كاملة أحياناً .
وقد يعقب بذكر القراءة الواردة في الآية ، وذلك في ثلاثة مواضع فقط ، هي كالتالي:
- قوله تعالى: } وَقـَالوْا يَا مَال ِ( الزخرف - من الآية : 77 .
- قوله تعالى: } فـَبـِذلِكَ فـَلـْيـَفـْرَحُوا ( يونس - من الآية : 8
- قوله تعالى: } فـَهَبْ لِيْ مِنْ لـَدُنـْكَ وَلِيّـاً يَرِثـُنِيْ وَيَرِثُ ( مريـم- من الآيتيـن: 5،6
اكتفى المصنف بنسبة القراءة الأولى فقط إلى قارئها .
أما الأحاديث والآثار والأخبار التي استشهد بها المصنف فهي كالتالي :
- " كـَادَ الفـَقـْرُ أنْ يَكُوْنَ كُـفـْراً " .
- " زُرْ غِبّـاً تـَزْدَدَ حُبـّـاً "
- " إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَن " .
الأول منها: ضعف ، وقيل عنه: لا يصح عن رسول الله r .
والثاني: ليس فيه ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
والثالث: حديث ضعيف ، نسب إلى عمر - رضي الله عنه - موقوفاً ، وذكر مع الثاني من أمثال العرب.
وأما الشواهد الشعرية في الكتاب فكانت شاهدين فقط هما :
|
عَارٌ عَلـَيْكَ إذا فـَعَلـْتَ عَظِيـْـــــمُ |
- لا تـَنْهَ عَنْ خُلـُق ٍ وَتـَأتِيَ مِثـْلــَه |
|
|
- أنَا أبُوْ النَّجْم ِ وَشِعْـــِري شِعْــِري |
|
|
|
|
|
|
ومثل المصنف في موضعين بجزء من بيت شعر هو: خلِّ الطريق ، وهو مأخوذ من قول جرير:
|
وَابْرُزْ بـِبَرْزَة َ حَيْثُ اضْطـَرَّكَ القـَدَرُ |
خَلِّ الطـَّريْقَ لِمَنْ يَبْنِيْ المَنَارَ بـِهِ |
ثالثاً : وصف النسخ:
للكتاب عدة نسخ في أماكن مختلفة ، وقد اعتمدنا في التحقيق نسختين هما:
الأولى : نسخة مكتبة عارف حكمت .
عدد أوراقها : 30 لوحاً ، ومسطرتها : 15 سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر من 6 - 10 كلمات تقريباً .
أوراقها متسلسلة ، وخطها واضح ومقروء ، ضبطت بعض كلماتها ، وكتبت أرقام الأبواب والفصول والمباحث بلون أغمق وأكبر من المستعمل في كتابة المخطوط .
وهذه النسخة تميـزت بكونها موثقة ومصححة ، وعليها هوامش وحواش كثيرة جداً هي شروح للنص ، وقد ذكر في صفحة العنوان أن ما على هذه النسخة من الحواشي لمجرد التنبيه من غير تحرير .
نسخت - كما ورد في نهاية المخطوط - على يد الفقير أحمد بن علي العطيوي الشعراوي .
أما تاريخ النسخ فقد ورد في آخر لوح من المخطوط - ورقة 30 ب ما يلي :
" وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في يوم الثلاثاء المبارك سابع شهر جمادى الآخر سنة ست وثلاثين من الهجرة النبوية " .
وكان هناك تعليق في هامش هذا النص هو : " قف على خطأ هذا التاريخ " مما يدل على أن السنة المئوية قد سقطت من تاريخ النسخ المذكور .
ورمزنا لهذه النسخة بالرمز (أ) واتخذناها أصلاً ؛ للميزات التي ذكرت سابقاً .
الثانية
: نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود المصـورة من مكتبة سوهاج - مصر كان عدد أوراقها:
34 ورقة (غير مرقمة) ، عدد الأسطر : 23 سطراً ، كلماتها :
من 8-12 كلمة في السطر الواحد ، غير مضبوطة بالشكل . فيها سقط ، وهو النوع الثاني
عشر من الباب الثالث بكامله ؛ لذا أتت المنصوبات في هذه النسخة أربعة عشر نوعاً ،
وفي (أ) خمسة عشر نوعاً .
فيها بياض وعدم وضوح في عدد من الأسطر من اللوح الأول إلى الرابع ، خلت من الحواشي والشروح ، وعليها تصحيح .
الناسخ : هو محمد أبو علي الشافعي مذهباً ، وتاريخ النسخ في غرة ربيع الأول عام ثمان وسبعين ومائتين وألف من الهجرة ، وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (ب) .
المنهج المتبع في التحقيق :
تم إثبات النص محققاً كما أراده مؤلفه وتوخي المنهج العلمي للتحقيق ، وذلك باتباع الآتي:
* الوصول إلى النص الصحيح وتحريره وفق القواعد الإملائية والنحوية .
مقابلة النسختين المعتمدتين ، وإثبات الصواب منهما ، والتنبيه على أوجه الاختلاف بينهما مع الإشارة إلى مواضع السقط والزيادة في المتن أو الحاشية حسب ما يقتضيه السياق، وحصر مايقتضيه السياق من سقط بين قوسين معكوفين في المتن.
اتخاذ إحدى النسختين السابقتين أصلاً معتمداً في التحقيق ، وقد رمز لها بالرمز (أ) ورمز للأخرى بالرمز (ب) .
* العناية بتخريج الشواهد بأنواعها المختلفة ، شعرية ونثرية ، وضبطها .
* توثيق الآراء والأقوال بالرجوع إلى مصادرها الأصلية أو مظانها .
* مناقشة المسائل النحوية والصرفية والتعليق عليها .
* تفصيل ما أجمله المؤلف وإيضاح ما أبهمه استئناساً بالمصادر والمراجع .
النص المحقق
بسم الله الرحمن الرحيم ……. وبه الإعانة - قال سيدنا ومولانا وأستاذنا العارف بالله تعالى ، (والدال عليه) (17) مربي المريدين وقدوة السالكين وعمدة المحققين القطب الرباني والعالم الصمداني الشيخ عبد الوهاب ابن المرحوم الشيخ أحمد ابن المرحوم الشيخ علي الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه ، وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته وبركات علومه وأسراره في الدين والدنيا والآخرة ، آمين .
أحمد الله(18) رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، سيد الأولين والآخرين ، اللهم فصل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين ، وبعد :
|
|
|
فهذا كتاب نفيس اقتبسته من نور كلام العرب الفصحاء في نحو يوم ٍ رجاء أن أكتب في حزب أنصار دين الله تعالى وليعرف به أخواننا المريدون لطريق الله - عز وجل مواطن اللحن في كلام الله عز وجل وكلام رسوله r ليحكوا الكلام على صورة ما جاء من الوحي، إذ غالب الفقراء(19) في زماننا لا يعتـنون بإصلاح اللسان ويلحنون كثيراً في القرآن والأحاديث، وشرط الفقير أن يكون عالماً بجميع علوم الشريعة وتوابعها كما عليه جماعة سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي (20) رضي الله تعالى عنه ، وإنما صنعت هذا الكتاب للفقراء ولم أحوجهم إلى القراءة في كتب النحاة ، لأن من سلك على يد أحد من أهل الطريق لا ينبغي له أن يأخذ علماً من العلوم إلا على لسان شيخه ، فإن للفقهاء في ذلك مزيد ذوق يدركونه في نفوسهم(21) ولسان حال أهل الطريق يقول : من كان منا فلا يأخذ عن أحد إلا عنا .
وقد رتبت هذا الكتاب على ستة أبواب وخاتمة :
الباب الأول : في بيان الاسم ، ومباحثه .
|
|
|
الباب الثاني : في المرفوعات وأنواعها الاثني (22) عشر .
الباب الثالث : في المنصوبات وأنواعها الخمسة عشر .
الباب الرابع : في المجرورات والمجزومات(23) معاً .
الباب الخامس : في بيان التوابع لما قبلها في الإعراب .
الباب السادس : في بيان الأربعة أبواب الخارجة عن الإعراب .
الخاتمة : في بيان زبدة علم النحو ، وأنه كله يدور على ثلاثة أقطاب ، وهي(24) : الفاعلية والمفعولية والإضافة .
فأكرم به من كتاب جمع مع صغر حجمه مجموع ما في المطولات ، وأغنى من طالعه عن جميع المختصــرات وسميته : بـ(لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب) جعله الله تعالى خالصاً لوجهه الكريم ونفع به المسلمين آمين ولنشرع في أبواب الكتاب ، وأقول : وبالله التوفيق :
الباب الأول : في بيان الاسم ومباحثه :
|
|
|
اعلم يا أخي رحمك الله تعالى أن الاسم هو عبارة عن كل ما صح أن يخبر عنه بخبر(25)، نحو : زيد ، وعمرو ، وفرس وحجر ، ونحو ذلك .
ثم هو معرب ومبني ، فالمعرب ما تغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه ، كقولك: جاء زيدٌ ، ورأيت زيداً ، ومررت بزيدٍ .
فأما المبني فهو ما يستقر آخره على حالة واحدة ، ولا يتغير بتغير العوامل الداخله عليه ، كقولك : جاءني من ضربك ورأيت من ضربك ، ومررت بمن ضربك. وحركات الإعراب ثلاثة : رفع ونصب وجر(26) ، وكلها تدخل على الاسم المتمكن وأما الفعل فيدخله الرفع والنصب ولا يدخله الجر ، إلا أنهم وضعوا في الفعل المضارع مكان الجر الجزم ، وفيما لا ينصرف الفتح ، كما سيأتي. [وحركـات البناء ثلاثة ؛ ضم وفتح وكسر ] (27) ، كقولك(28): حيث ، وكيف ، وهؤلاء .
فصل في بيان حروف تنوب عن الحركات
(وهي على ثلاثة أضرب : الضرب الأول)(29) :في الأسماء الخمسة ، التي هي : أبوك ، وأخوك ، وحموك، وفوك، وذو مال(30)
|
|
|
ورفع هذه الأسماء يكون بالواو ، ونصبها يكون بالألف ، وجرها يكون(31) بالياء ، تقول جاءني أخوك ، ورأيت أخاك ومررت بأخيك .
الضرب الثاني : في التثنيه والجمع - وذلك أن رفع التثنيه بألف تقول : جاءني الزيدان ، ونصبها وجرها بالياء المفتوح ما قبلها ، نحو : رأيت الزيدَين ، ومررت بالزيدَين .
وأما الجمع فيكون رفعه بالواو ، نحو : جاءني المسلمون ، وأما نصبه وجره فيكون بالياء المكسور ما قبلها ، نحو : رأيت المسلمِين ، ومررت بالمسلمِين . وتكون نون التثنية مكسورة ، ونون الجمع مفتوحة ، لِيُفْرَق بينهما(32) .
وأما جمع المؤنث السالم ، نحو مسلمات ، وهندات ، فيرفع بالضمة ، تقول : جاءني مسلماتٌ ، كما تقول ، جاءني مسلمون ، وأما في النصب والجر فهو على لفظ واحد، تقول: رأيت مسلماتٍ ، ومررت بمسلماتٍ ، كما تقول : رأيت مسلمِين ومررت بمسلمِـين .
|
|
|
الضرب الثالث : الأفعال الخمسة ، وهي : تفعلان ، ويفعـلان ، وتفعلون ، ويفعلون ، وتفعلين ، وعلامة الرفع فيها ثبوت النون ، وأما في حالة النصب والجزم فتحذف النون ، كقولك: لم يفعلا ولن تفعلا ، ولم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، ولم تفعلي ولن تفعلي .
واعلم أن نون التثنية ونون الجمع يسقطان عند الإضافة ، تقول في التثنية : جاءني غلاماك ، ورأيت غلاميك ، ومررت بغلاميك ، وتقول في الجمع: جاءني صالحو قومك ، ورأيت صالحي قومك ، ومررت بصالحي قومك ، بسقوط النون.
فصل : في الاسم التام والناقص
فالتام : هو ما تم آخره من غير نقصان ، نحو : زيد وعمرو ، وخالد .
والناقص : ما نقص من آخره الحركة ، نحو : الحبلى ، والقاضي ، وهو ـ أعني الناقـص ـ على ثلاثة أنواع :
النوع الأول: أن يكون في آخره ألف مقصورة زائدة عنه ، نحو: حبلى ، وسكرى ، وصغرى ، وكبرى ، بغير تنوين؛ لأنها مما لا ينصرف فلا تنصرف.
ولا فرق بين أن تكون الألف فيه أصلية أو منقبلة ؛ إما عن الواو ، نحو : عصا ، وقفا ، وإما عن الياء ، نحو : رحى وهدى ، و[ حبلى] (33) ، ولكن لا يدخل هذا التنوين ؛ لأنه غير منصرف.
واعلم أن كلا هذين الضربين يكون على حالة واحدة في الرفع
|
|
|
والنصب والجر ، تقول: هذه حبلى وعصا ، ورأيت حبلى وعصا ، ومررت بحبلى وعصا ، فالمثل(34) معربات بحركات مقدرة في آخرها ، إلا أن الآخر على لفظ واحد ، قال الله تعالى: } يَـوْمَ لا يُغنِي مَـْولـَى عَنْ مَـْولَى شَيْـئاً { (35) ، الأول في موضع الرفع مرفوع ، والثاني في موضع الجر مجرور ولفظهما واحد .
النوع الثاني: أن يكون في آخره ياء قبلها كسرة ، كالقاضي والرازي ، فإنه يكــــون كالمنقوص في حال الرفع والجر ، بمعنى أنه مقدر في الرفع والجر ، ويكون منصوباً لفظاً في الحال تقول : جاء القاضي ، ومررت بالقاضي ، ورأيت القاضيَ ، بفتح الياء ، قال الله تعالى: } يَا قــَوْمَـنَا أجِـيـبُوا دَاعِيَ الله ِ {(36).
واعلم أنه إذا كانت الياء والواو مشددة أو قبلها ساكن أعرب ، تقول: هذا صبيٌّ وعدوٌّ ، ورأيت صبيّاً وعدوّاً ، ومررت بصبيٍّ وعدوٍّ . وتقول : هذا ظبْيٌ ودلْوٌ ، ورأيت ظبْياً ودلْواً ، ومررت بظبْي ٍودلْو ٍ.
|
|
|
النوع الثالث : أن يكون آخره ألفاً أو ياءً أو واواً ، وذلك خاص بالأفعال المستقبـــــلة(37)، نحو : يخشى ويرمي ويدعو ، فأما ( يخشى ) فهو على حالة واحدة في حالة الرفع والنصب ، نحو : هو يخشى ويرضى ، ولن يخشى ، ولن (38) يرضى ، وأما في حالة الجزم فتحذف الألف ، تقول : لم يخش ، ولم يرض ، وأما قولك : يرمي ، ويدعو فيكون ساكناً في الرفع ، نحو : هو يرمي ويدعو ، ومنصوباً في النصب : لن يرميَ ولن يدعوَ ، ومحذوفاً في الجزم نحو : لم يرم ِ، ولم يدعُ .
فصل في الاسم المنصرف وغير المنصرف
فأما الاسم المنصرف فهو ما تدخل عليه الحركات الثلاث مع التنوين ، وأما غير المنصرف فهو ما لا يدخله جر ولا تنوين(39) ، ويكون في موضع الجر مفتوحاً ، وموانع الصرف تسع ، نظمها الشاعر في قوله :
جَمْعٌ ونعْتٌ(40) وتَأنِيْثٌ ومَعْرفـَـة ٌ
وعُجْمَـة ٌ ثـمَّ عَـدْلٌ ثم تـركِيــبُ
والنونُ زائدة ٌمِن قبْـلِهَـا(41) ألِفٌ
وَوَزْنُ فِعْـلٍ، وهذا القولُ تقريبُ(42)
فكل اسم اجتمع(43) فيه سببان من هذه الأسباب التسعة - فهو غير
|
|
|
منصرف ، فإذا نقص منها سبب واحد عاد إلى الصرف .
وجميع ما لا ينصرف أحد عشر نوعاً ، وهي على قسمين :
قسم منها لا ينصرف في المعرفة ولا في النكرة ، وقسم منها لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة .
فأما ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، فكل ما كان على وزن (أفـْعَـل) صفة(44) ، نحو أحمر وأسود ، المانع من الصرف فيه الوصف ووزن الفعل.
وكل ما كان على وزن (فـَعْلان) ومؤنثه على ( فـَعْـلـَى ) (45) كعطشان وعطشى ، وسكران وسكرى المانع من الصرف فيه : الوصف وزيادة الألف والنون.
وكل ما كان صفة معدولة في النكرة ، نحو : مثنى ، وثلاث ، ورباع ، فإنها معدولة عن اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة(46) ، المانع من الصرف فيه العدل والصفة(47)، التي هي وصف للأجنحة في قوله تعالى: } أوْلِيْ أجْنِحَةٍ مَثـْنى وثـُلاثَ ورُباع { (48).
|
|
|
وكل ما كان في آخره ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة ، فالمقصورة ، نحو : حبلـى وسكرى ، والممدودة ، نحو : حمراء وصفراء ، المانع من الصرف فيهما : التأنيث والصفة(49).
وكل ما كان ثالثه ألفاً(50) ، وبعد الألف حرفان أو ثلاثة ، نحو : مساجد، ومصابيح ، المانع من الصرف فيه : تكرير الجمع مرتين(51) ، لأنه على صورة جمع الجمع ، مثل : مفاعل ، ومفاعيل ، ونظير ذلك أسْورَة وأسَاور(52) جمع سوار ، وكذلك عرب ثم أعاريب جمع الجمع ، لأن جمعها وجمع عرب أعاريب(53).
وأما ما لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة فهو: كل ما كان على وزن أحمد ويزيد ويشكر ، المانع من الصرف فيه المعرفة ووزن الفعل .
ومنه الاسم الأعجمي العلم ، نحو : إبراهيم واسماعيل وإسحاق ، المانع من الصرف فيه المعرفة(54)والعجمة.
ومنه ما في آخره ألف ونون نحو : سلمان وعثمان ومروان ، المانع من الصرف فيه : المعرفة والألف والنون الزائدتان .
|
|
|
ومنه ما كان مؤنثاً بالهاء كطلحة وحمزة (وفاطمة وعائشة - أو مؤنثاً بالمعنى كزينب)(55) وسعاد وسقر ، المانع من الصرف فيه : المعرفة والتأنيث .
ومنه ما كان معدولاً عن (فاعِـل) ، إلى (فـُعَـل) نحو : عُـمَر ، وزُفـَر(56) ، عدلا عن عامر وزافر ، المانع من الصرف فيه المعرفة والعدل .
ومنه كل اسمين جعلا اسماً واحداً ، نحو : حضرموت ، وبعلبك ، ومعديكرب ، المانع من الصرف فيه : المعرفة والتركيب .
فهذه الستة أقسام(57) لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة ؛ لأنها إذا نكرت نقص منها المعرفة فيبقى فيها سبب واحد فتعود إلى الأصل ، وهو الصرف ، فتقول : رُبَّ أحمدٍ ، ورُبَّ إبراهيـم ٍ وعمـر ٍ ومعديكربٍ وزفـرٍ.
|
|
|
واعلم أنه إذا وقع فيما لا ينصرف اسم على ثلاثة أحرف ساكن الوسط جاز فيه الصرف وتركه في المعرفة ، نحو : دعْد وهِنْد ، ونُوْح ، ولـُـوْط ، ومِصْـر(58) ، وأما في النكرة فليس فيه إلا الصرف .
قاعدتان: الأولى:جميع أسماء القبائل والأحياء والبلدان إذا قصدت به مؤنثاً - كقبيلة أو أرض أو بقعة لم ينصرف(59) وإن قصدت به مذكراً كان أو بلداً انصرف .
القاعدة الثانية : أن جميع ما لا ينصرف إذا أضيف أو أدخل فيه الألف واللام انصرف لغلبة الاسمية عليه(60) ، تقول : مررت بالأحمر ِ والحمراءِ والمساجدِ ، وتقول: مررت بعمـِركـُم وعثمانِنا .. إلى آخره .
فصل في المعرفة والنكرة
والمعرفة على خمسة أنواع(61) ، وما زاد عليها فهو نكرة ، نحو : فرس ورجل ، وثوب وأشباهها :
النوع الأول من المعرفة : الاسم العلم ، مثل : زيد وعمرو ، وكذلك نحو : أبي محمد ، وأبي زيد(62) .
النوع الثاني : ما دخله الألف واللام ، نحو قولك لآخر : جاءني الرجل ، يعني : الرجل الذي عهدناه .
والنوع الثالث : المبهم ، نحو : هذا ، وذاك ، وهؤلاء .
|
|
|
النوع الرابع : الضمير سواء كان متصلاً أو منفصلاً ، فالمنفصل نحو : أنا ، وأنت ، ونحن ، وهو ، وهم ، وأشباهها والمتصل ، نحو : ضربت ، وضربنا ، وضربك ، وأشباهها.
النوع الخامس : ما كان مضافاً إلى واحد من هذه ، نحو : غلام زيد ، وغلام الرجل، وغلامك ، وغلامه .. إلى آخره .
فصل في المذكر والمؤنث
قال العلماء : والمذكر أصل ، والمؤنث فرع ، وهو على ضربين : حقيقي وغير حقيقي.
فالمؤنث الحقيقي : ما كان خلقة ، كالمرأة والناقة ، وسائر ذوات الفروج .
والمؤنث غير الحقيقي أربعة أنواع :
النوع الأول : ما كان في آخره التاء المتحركة التي يوقف عليها هاء ، كالمعرفة والقدرة ، ونحوها .
النوع الثاني : ما كان فيه ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة ، نحو : البشرى ، والكبرى ، والحمراء ، والصفراء .
النوع الثالث : ما كان فيه تقدير التاء ، كالشمس والأرض ، والدار [ لأنك ] (63) تقول في تصغيرها: شُمَيْسة ، وأرَيْضة ودُوَيْرة(64) ، وهذا النوع سماعي لا قياسي (65).
النوع
|
|
|
الرابع : ما كان جمعاً ، وكل جمع مؤنث إلا ما جمع بالواو والنون ، نحو : المسلمون ، والزيدون ، فإنه مذكر فلا يجوز أن تقول : خرَجَتِ المسلمون ، - وأما بنون فيجوز ، لأن الواحد فيه لم يسلم .
فرع : كل ما كان في الجسد له ثان من الأعضاء فهو مؤنث ، مثل : اليد والرِّجل ، والكف ، والأذن ، والعين ، واليمين والشمال ، والفخذ ، والقدم والساق ، ونحوها ، إلا الحاجب والخد والجنب ، والهدب ، والجفـْن(66) .
وكل ما ليس له ثان من الأعضاء فهو مذكر(67) . كالرأس ، والعِـذار(68)، واللـُّحى ، والشعر ، والوجه ، والأنف اللسان ، والقـَفـَا ، ونحو ذلك .
قاعدة : المؤنث الحقيقي يؤنث فعله سواء تقدم أو تأخر ، تقول : خرجتِ المرأة ُ، والمرأة ُ خرجتْ ، وغير الحقيقي يجوز في فعله التذكير والتأنيث إذا تقدم ، نحو : طلعتِ الشمسُ ، وطلعَ الشمسُ(69) ، وإذا تأخر فعله فليس إلا التأنيث ، نحو : الشمس طلعت ، ولا يجوز الشمس طلع ، والله أعلم .
الباب الثاني : في المرفوعات
وأنواعها : اثنا عشر
النوع الأول : مرفوع ؛ لأنه فاعل
|
|
|
والفاعل : هو كل اسم أسند إليه الفعل قبله سـواء كان حقيقياً أو مجازياً(70) ، نحو: قام زيدٌ ، وسقط الحائطُ ، ومرض زيدٌ ، وتحركتِ الشجرةُ ، فأسندت الفعل إلى الحائط والشجرة مجازاً ، والمعنى : أسقط الله الحائط وحرك الشجرة ، وأمرض زيداً .
وأما قولهم : لم يركبْ زيدٌ ، ولم يخرجْ عمر ، فمرفوع أيضاً ، لإسناد نفي الفعل إليه .
واعلم أنه يجــوز تقديم المفعول على الفاعل إذا أمن اللبس ، كقولك : أكل الطعامَ زيدٌ ، وشربَ الماءَ عمروٌ ، وفي القرآن : } ولـَقـَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النـُّذرُ { (71).
فإن
خيف اللبس لم يكن الفاعل إلا المقدم ، نحو : ضرب موسى عيسى ، وشتم هذا هذا(72) ،
وإذا تقدم الفعل على الاسم فلا يجوز أن يثنى ولا أن يجمع ، قـال الله تعـالى :
} قـَالَ رَجُلان { (73)وقال
: } قـَدْ أفْـلـَحَ المُؤْمِنُونَ { (74)
، وأما إذا تأخر جاز أن يثنى ضميره ويجمع ، نحو : الزيدان قاما ، والزيدون قاموا .
وأما قوله تعالى : } وأسَرُّوا النَّجْوَى الـَّذِيْنَ ظـَلـَمُوا { (75) ففيـه تقديم وتأخير ، كأنه قال: الذين ظلموا أسروا النجوى(76) .
|
|
|
النوع الثاني : مرفوع لما لم يسم فاعله نحو قولك : ضُـِربَ زيدٌ ، وسِـيْقَ البعيرُ ، يريد أن ضارباً ضرب زيداً وسائقاً ساق البعير ، ولكنك لم تذكر اسمه .
واعلم أن الفعل على قسمين : لازم ومتعدٍّ(77) ، فاللازم : ما يلزم نفس الفاعل ولا يتعدى عنه إلى غيره ، نحو : قام وغضب ، وجاء ، وذهب ، فإذا لم تسمِّ الفاعل ضممت أول هـذه الأفعـال وكسرت ما قبل آخرها ، فتقول : ذُهِـــبَ بزيد } وجِـيْءَ يَوْمَـئِذٍ بـِجَهَـنـَّمَ { (78) ونحو ذلك .
وأما المتعدي : فمنه ما يتعدى إلى مفعول واحد ، نحو : ضرب زيدٌ عمراً ، فإذا لم يسم الفاعل قلت : ضُـِربَ عمروٌ وحذفت زيداً وأقمت عمراً مقامه.
ومنه ما يتعدى إلى مفعولين ، نحو: ظننت زيداً عالماً، وأعطيت زيداً درهماً، ونحو ذلك.
فإذا لم تسم الفاعل قـلت : ظُنَّ زيدٌ عالماً . وأعْطِيَ زيدٌ درهماً ، ومنه ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ، كقولك : أعْـلـَـمَ اللهُ زيداً عمراً أخاكَ ، فإذا لم تسم الفاعل قلت : أعْـلِمَ زيدٌ عمراً أخاكَ ، فأقمت المفعول الأول مقام الفاعل .
|
|
|
النوع الثالث : مرفوع بالابتداء نحو : زيد قائم ، فزيد رفع بالابتداء ، وقائم رفع بخبر الابتداء(79) ، والابتداء عامل معنوي لا لفظي .
واعلم أنه قد يحذف المبتدأ من الكلام نحو قولـه تعالى : } سُوْرَة ٌأنـْزَلْـناهَا {(80) (أي : هذه سورة أنزلناها)(81) وكذلك نحو ق ول يعقوب : } فـَصَبْرٌ جَمِيْلٌ { (82) أي : أمري صبر جميل (83).
النوع الرابع : مرفوع برجوع الهاء إليه نحو قولك : زيد ضربته ، وعمرو(84) أكرمته ، رفعت زيداً وعمراً برجوع الهاء (إليهما ، ولولا الهاء)(85) لكانا منصوبين(86) ، قال الله تعالى : }سُوْرَة ٌأنْـزَلْـناهَا {(87) . وقـال : } أم ِالسَّمَاءُ بَـنـــَاهَا {(88) فرفع ( السماء ) و ( سورة ) لرجوع الهاء إليهما .
النوع الخامس : مرفوع بـ (كان) وأخواتها وهي : كان ، وصار ، وأصبح ، وأمسى ، وظل ، وبات ، وما زال ، وما دام وما برح ، وما فتئ ، وما انفك ، وليس ، وما يتصرف منهـا ، نحـو : يكون ويصير ونحوهما(89)، فجميع هذه ترفع الأسماء وتنصب الأخبار ، تقول : كان زيد قائماً ، وصار زيد أميراً .. إلى آخره .
النوع السادس : مرفوع بـ ( ما ) النافية
|
|
|
كقولك: ما زيد قائماً ، فرفعت الاسم تشبيهاً بـ (ليس) على لغة أهل الحجـاز(90) ، قال الله تعالى: } مَا هَذا بَشـَرَاً { (91) وقال : } مَا هُنَّ أمَّهَاتِهـِـم { (92) .
قال شيخنا رحمه الله تعالى : فإن كان الكلام منقوضاً بـ (إلا ) نحو ما زيد إلا قائم رفعت الخبر(93) ، قال تعالـــى : } ومَا أمْرُ نـَا إلا وَاحِدَة ٌ{ (94).
النوع السابع : مرفوع بالحروف الرافعة وهي : هل ، وبل ، ولولا ، وإنما ، ولكنما ، وليتما ، ولعلما ، وأنما(95) ومتى وأيان ، وأين ، وكيف ، وحيـث ، وإذ ، وإذا فإن هذه الحروف والظروف كلها ترفع الأسماء والأخبار عند الكوفيين ، وأما عند البصريين فلا عمل ألبتـَّة ، وإنما يقع بعدها المبتدأ والخبر وهو الأصح(96) .
فأما (هل) فحرف استفهام ، تقول : هل زيد خارج ؟ جوابه : لا ، أو نعم .
وأما (بل) فحرف عطف ، تقول : ما جاءني زيدٌ بل عمروٌ.
وأما (لولا) فمعناه امتناع الشيء لوجود غيره ، تقـول : لولا زيد لهلك عمرو ، فهلاك عمرو(97) ممتنع لوجود زيد .
|
|
|
وأما إنما ، ولكنما ، وليتما ، ولعلما ، وأنما فحروف نواصب اتصلت بها (ما) فكفتها عن العمل ، والأسماء الواقعة بعدها إنما هي مرفوعة على الابتداء(98) .قال الله تعالى : }إنَّمَا الصَّدَقـَاتُ لِلفُـقـَرَاءِ والمَسَاكِيْن ِ{ (99) .
وأما (متى) فهي سؤال عن زمان ، لأن جوابها يقع بالزمان ، تقول : متى زيد خارج؟ جوابه : يوم الجمعة أو يوم السبت
وأما (أيان) فهي بمعنى ( متى ) أيضاً ، قال تعالى : } أيَّانَ يَوْمُ الدِّيْن { (100) .
وأما ( أين ) فسؤال عن المكان ، لأن جوابها يقع بالمكـان ، تقول : أيـن زيد جالس ؟ جوابه: في الدار أو في المسجد
وأما ( كيف ) فسؤال عن الحال ، لأن جوابها يقع بالحال ، تقول : كيف زيد؟ الجواب صحيح أو سقيم .
وأما (حيث ) فظرف مكان ، تقول : رأيته(101) حيث زيد يصلي .
وأما ( إذ ) و( إذا ) فظرفان للزمان ، لكن ( إذ ) للماضي ، و ( إذا ) للمستقبل ، قـال تـعالى : } وإذ ْجَعَلـْنـَا البَيْتَ مَثابَة ً لِلنَّاس ِ{ (102) ، وقـال تـعالى : } والليْـل ِ إذا يَغْـشَى {(103).
|
|
|
واعلـم أن ( إذا ) قـد تجعـل الماضي مستقبـلاً في المعنى ، نحو } إذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ {(104) والمعنى : إذا يجيء وكذلك ( إذ ) قد تجعل المستقبل ماضياً في المعنى ، كقوله تعالى : }إذْ يَقـُوْلُ المُنافِـقـُوْنَ { (105) ، والمعنى : إذ قـال والله أعلم(106) .
النوع الثامن : مرفوع بـ ( إن ) وأخواتها وهي : إنَّ ، ولكنَّ ، وليت ، ولعلَّ ، وكأنَّ ، وأنَّ ـ بفتح الهمزة ـ فهذه الحروف كلها تنصب الأسماء وترفع الأخبار ، تقول : إن زيداً قائم ، وليت زيداً خارج.. إلى آخرها(107).
وقال بعضهم : ليس (كأن) سادساً ، وإنما هو ( أنَّ ) دخلها كاف التشبيه(108) .
ولا يجوز تقديم خبر هذه الحروف على اسمها ، فلا يقال : إن قائم زيداً ، إلا إذا كان الخبر ظرفاً كقولك : إن في الدار زيداً(109) ، قال الله تعالى : } أنَّ الله َ بَريْءٌ مِنَ المُشْركِيْنَ ورَسُوْلُهُ }(110) والله أعلم .
النوع التاسع : مرفوع بـ ( نعم ) و ( بئس ) نحو : نعم الرجلُ زيدٌ ، ونعم سيدُ القوم زيدٌ ، وبئس صاحبُ الدار عمروٌ ويجوز: نعم رجلاً زيد [ وبـِئـْسَ غـُلامـاً عَمْـرو ] (111) تقديره ، نعم الرجل رجلاً زيد ، وبئس الغلام غلاماً عمرو(112) وقال تعالى: } كَبُرَتْ كـَلِمَة ً تـَخْرُجُ مِن أفـْوَاهِهـِمْ } (113).
|
|
|
النوع العاشر : مرفوع بحبذا وهي مركبة من كلمتين ؛ إحداهما : حَبَّ ، والأخرى ذا ، فجعلا كلمة واحدة ، تقـول : حبذا زيد ، وحبذا الرجل (114) ، وتقول : إذا كان نكرة : حبذا رجلاً زيدٌ .
النوع الحادي عشر : مرفوع بأفعال المقاربة وهي : عسى ، وكاد ، وكَرب ، وأوشك ، تقول : عسى زيد أن يخرج ، وقال تعـالى : }عَسَى اللهُ أنْ يَكُفَّ بَأسَ الذِيْنَ كَفَرُوا { (115) ، وقال : } تـَكَادُ السَّمَــوَاتُ يَتـَفـَطـَّــرْنَ{(116) ، وفي الحديث: " كَادَ الفـَقـْرُ أنْ يَكُوْنَ كُفْراً"(117) وكذا الحكم في كرَب وأوشك.
النوع الثاني عشر : مرفوع بالحكاية نحو قولك: زيد خرج ، وفي القرآن الكريم: } قالَ اللهُ عَلى مَا نـَقـُوْلُ وَكِيْـلٌ {(118)، وقد يضمر القـول في نحـو: } والمَلائِكــَة ُ يَـدْخُـلـُـوْنَ عَليْهـِمْ مِـنْ كُـلِّ بَـابٍ سَلامٌ عَليْـكُمْ {(119) أي : يقولون سلام عليكم والله أعلم .
الباب الثالث : في المنصوبات
وأنواعها خمسة عشر نوعاً(120) :
|
|
|
النوع الأول : منصوب ، لأنه مفعول به والمفعول به (121) كل اسم أوقعت عليه الفعل وذكرت فاعله ، نحو: ضربْتُ زيداً وشتمْتُ عمراً ، وأعطيتُ زيداً درهماً ، وكسوتُ عمراً جبة ً.
النوع الثاني : منصوب بأفعال الشك واليقين وهي سبعة : حسبت وظننت ، وخلت ، وعلمت ، ووجدت ، ورأيت ، وزعمت إذا كن بمعنى علمت ، وكلها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبها جميعاً ، تقول : ظننت زيداً أخاك ، وعلمت زيداً فاضلاً ونحو ذلك (122).
النوع الثالث : منصوب ، لأنه مفعول له وهو ما يقع الفعل لأجله وبسببه ، نحو قولك : جئتـُـكَ ابتغاءَ معروفِــك (أي بسبب ابتغاء معروفك)(123) ، وقال تعالى : } يَجْعَلـُوْنَ أصَابـِعَهُمْ فِي آذانِهـِمْ مِـنَ الصَّوَاعِق ِ حَـذرَ المَوْتِ { (124) أي لحذر الموت ، فتكون لام السبب مقدرة(125) في جميع ذلك .
النوع الرابع : منصوب ؛ لأنه مفعول معه كقولك : استوى الماءُ والخشبةَ ، وكنتُ وزيداً كالأخوين ، ونحو ذلك . وإنما هو مفعول معه؛ ؛ لأنك وضعت الواو مكان مع ، أي : استوى الماءُ معَ الخشبةِ .
|
|
|
النوع الخامس : منصوب ، لأنه مفعول مطلق وهو المصدر ، وإنما سمي مفعولاً مطلقاً ؛ لأنه هو المفعول الذي أحدثه الفاعل وأوجده بعينه بخلاف سائر المفعولات(126) . وإنما سمي مصدراً ؛ لأن الأفعال تصدر عنـه(127)، فشبه بمصدر الإبل وهو الماء الذي تصدر عنه الإبل وتذره(128) .
وحد المصدر: كل اسم دل على معنى في زمان مجهول ، تـقول: ضربت ضرباً ، وجلست جلسة ، ومن ذلك قولهم: أهلاً وسهلاً ومرحباً ، فإنها منصوبة بتقدير أفعال ليست من لفظ المصادر.
المعنى : أتيت(129) أهلاً لا عَزَباً (130) ، وأتيت مكاناً سهلاً لا حَزناً(131) ، وأتيت مرحباً لا مضيقاً ، ومنه أيضاً قولهم : لقيته عِياناً ، ولقيته فجأة ، وأخذته سماعاً .
النوع السادس : منصوب ، لأنه مفعول فيه :
|
|
|
وهو الظرف ، والظرف : الوعاء من الأزمنة والأمكنة ، فأما الأزمنة فنحو قولـه: قمت وقتاً من الأوقـات ، وسهـرت ليلة من الليـالي ، وفي الحـديث : " زُرْغِبـّـاً تـَزْدَدَ حُبّـاً "(132).
وأما الأمكــنة فالجهات الست وما في معناها ، والجهات : خلف وقدام وفوق وتحت ويمين وشمال وأمام ، وما في معناها(133) ، فكنحو ، وعند ، ووسط ، تقول: مررت نحو(134) زيد ، وقمت عندك ، وجلست وسط الدار ، ونحو ذلك .
النوع السابع : منصوب بالحال والحال صفة مذكورة تجيء بعد كلام تام معرفة ، كقولك جاء زيد راكباً ، أي في حال ركوبه ، ومنه هذا زيد قائماً ، أي: في حال قيامـه ، وفي القـرآن : } وَهَــذا بَعْـلِي شَيْـخاً }(135) ، ومن ذلك قوله تعالى : } وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّ قـاً } (136) ، وعلامة الحال أن يكون موضوعاً لجواب كيف ، فإذا قيل لك : كيف جاء زيد ؟ تقول: جاء راكباً ، ونحو ذلك.
النوع الثامن : منصوب بالتمييز
|
|
|
ولا يكون التمييز إلا بعد كلام مجهول مبهم ، تقول: امتلأ الإناء عسلاً ، وتصبب زيد عرقاً ، وقال تعالى : } وَضَاقَ بـِهـِمْ ذرْعــاً }(137) ، ومنه قولهم : هو أحسنُ الناس ِ وجهاً وأ}رفهم أباً ، قال الله تعــالى : } أنَا أكْـثــَرُ مِنْـكَ مَالاً ، وَأعَزُّ نَـفَراً }(138) ، ومنه قولهم: لله دره رجلاً ، ودلوي مملوءة عسلاً ، وقال تعالى : } مِلْءُ الأرْض ِ ذهَباً } (139)، ومنه قولهم: ما في السماء قـدرُ راحـةٍ سحاباً ، وعندي قـَـفِـيْـزَان(140) بُـراً وعندي منـوان(141) عسلاً ، وعندي(142) ذراعان قـَزّاً ، وعندي عشرون درهماً ، ومنه ثلاثة عشر رجلاً ، قال تعالــى :} أحَدَ عَشَرَ كَـوْكَباً } (143) } وَكَفـَى بـِاللهِ وَلِيّاً }(144) } وَكَفـَى بـِرَبِّـكَ هَادِياً وَنَصِــيْراً }(145) .
النوع التاسع : منصوب بالاستـثـناء ومعنى الاستثناء : إخراج الشيء مما دخل فيه ، تقول : جاء القومُ إلا زيداً وقال تعالى: }فـَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قـَلِيْـلاً }(146) ، وتقول: ما جاء أحد إلا زيداً ، وكذا الحكم في بقية أدوات الاستثناء ، نحو : سوى ، وسواء ، وخلا ، وعدا ، وحاشا ، وغير(147) ولكن يكون ما بعد هذه الأدوات مجروراً(148) بالإضافة ، تقول : جاءني القوم غير زيدٍ وسوى زيدٍ .. إلى آخره .
|
|
|
ويجوز نصب ما بعد خلا وعدا وحاشا ، ولا يجوز فيما بعد (غير) إلا علـى التفصيل المذكور فيها .
النوع العاشر : منصوب بالنداء : وحروف النداء خمسة ، هي : يا ، و أيا ، وهيا ، وأي ، والألف(149) ، وقد تحذف الهمزة تخفيفاً ، تقول ، يا رجلاً خذ بيدي . ويا طالعاً جبلاً ، ويا عبد الله(150) .
قال تعالى : } يَا أهْـلَ الكِتـَابِ } (151)وإذا كان المنادى مفرداً علماً أو نكرة مقصودة بني على الضم(152) وجوبا(153) نحو : يا زيد ويا رجل ، ولا تدخل ( يا ) على مافيه الألف واللام ، فلا يقال : يا الرحمن ، ولا يا الرجل .
ويرخم المنادى إذا كان مفرداً علماً زائداً على ثلاثـة أحـرف ، نحو قولك في حارث: يا حار ، وفي جعفر ، يا جعف كما قرأ(154) عبد الله بن مسعـود(155): } وَقـَالـُـوْا يَا مَـالِ}(156) يريدون (157): يا مالك ، ومنه قولهم (158) في طلـحة : يا طلحَ ـ بفتح الحاء على لغة من ينتظر ، وهي الفصحى ـ وفي فاطمة : يا فاطمَ(159) وفي منديل يا مندِ ، وفي مروان يا مروَ(160) ، والله أعلم.
النوع الحادي عشر : منصوب بـ (لا) نحو
|
|
|
لا غلامَ رجل قائم ، ها هنا في نفي الجنس ، ولا رجلَ في الدار ، ولا إلـهَ إلا الله.
وإذا فصلت بين (لا) وما تعمل فيه فليـــس إلا الرفع ، نحو : لا في الدار رجل ، ولا عندي غلام(161) ، قال تعـالى : }لا فِيْهَا غَوْلٌ }(162) والله أعلم.
النوع الثاني عشر(163) : منصوب بالإغراء والتحذير تقول في الإغراء : عليك زيداً ، على معنى احْـفـَظه، قال تعالى : } يَا أيُّهَا الـَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلـَيْـكُمْ أنْـفُسَكُمْ }(164) ، وحروف الإغراء : عليك ، ودونك(165) ، وأما التحذير ، فكقولك : الأسد الأسد ، 1 ـ خَـلِّ الطريق.............................................(166)
قال الله تعالى: }نَاقـَة َاللهِ وَسُـقـْـيَاهَا }(167) ، أي احذورا نـاقة الله ولا تمسـوها بسـوء ، وفي الحـديث: " إيَّـاكُمْ وَخَضْـرَاءَ الـدِّمَـن "(168).
النوع الثالث عشر : منصوب بفعل مضمر
|
|
|
نحو قولهم: امرأعمل لنفسـه ، تقديـره: رحم الله امرأ ، ومنه قولـه تعالى: } قـُـلْ بَلْ مِلـَّة إبْرَاهِيْمَ حَنِيْـفاً } (169) أي: اتبع ملـة إبراهيم ، وقال تعالى: } وَنُوْحاً إذ ْ نَادَى مِنْ قـَبْـلُ }(170) أي : واذكر نوحاً ، ومنه أيضاً قولهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر(171) ، (معناه: إن كان خيراً فجزاؤه خير)(172)- ومنه قولـه تعالى: }انْـتـَهُوْا خَيْراً لـَكُمْ }(173) ، تقديره: انتهوا يكون خيراً لكم(174) ، والعرب لفصاحتها تنصب الأسماء كثيراً بأفعال مضمرة(175) .
النوع الرابع عشر : منصوب بفعل التعجب نحو : ما أحسن زيداً ، ولا يكون لصيغة فعل التعجب مستقبل ولا مصدر ولا فاعل ولا يتصرف ، والله أعلم .
النوع الخامس عشر : منصوب بـ ( أن ) المخففة وأخواتها (176) نـحو: أرجو أن تعطيـني وأن تـخرج، ونحو } وَمَا كـَانَ اللهُ لِيـُضِيـْعَ إيْمَانَكـُمْ}(177) وتسمى هذه اللام لام الجحود ، لأنها لا تقع إلا بعد النفي ، ومنه قول الشاعر :
2ــ لا تـَنْهَ عَنْ خُلُق ٍ وَتـَأتِيَ مِثـْـلـَه [عَارٌ عَلـَيْـكَ إذا فـَعَلـْتَ عَظِيْمُ] (178)
|
|
|
(فقولـه (تأتي) منصوب بأن مقدرة ، أي: وأن تأتي مثله ، وقوله تعالى: } لـَيْسَ لكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتـُوْبَ عَلـَيْهـِم })(179) ، ومنه قولـه تعالى : } ولا تـَطـْغَوْا فِيْهِ فـَيَحِلَّ عَلـَيْـكُمْ غَضَبـِي } (180)وقولـه : } يَا لـَيْتـَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فـَأفـُوْزَ فـَوْزاً عَظِيْماً } (181) ، وقولـه تعالى } لا يُـقـْضَى عَلـَيْهـِمْ فـَيَمُوْتـُوْا} (182) فهذه وأمثالها كلها منصوبة بإضمار ( أن ) وعلامة صحة الجواب الفاء(183) والله أعلم .
الباب الرابع : في المجرورات والمجزومات معاً
أما المجرورات فأنواعها أربعة :
النوع الأول : مجرور بالحروف الجارة
وهي: من ، وإلى ، وعن ، وعلى ، وحـتى ، ومذ ، وفي ، ورب ، والباء ، والكاف ، واللام.
فأما (إلى) فأصلها لانتهاء الغاية ، تقول : خرجت من الكوفة إلى البصرة(184) ، وقد تقع بمعنى ( مع) (185) .
وأما ( عن ) فللتعدي والانحطاط ، تقول : رميت عن القوس(186) .
وأما (على ) فللاستعلاء ، تقول : جلس الأمير على السرير ، ووجب المال على زيد، وقد تقع بمعنى (مع) .
وأما (حتى) فلها ثلاث خصال؛ الغاية ، والعطف ، والابتداء ، تقول في الغاية: [أكلت السمكة حتى رأسِـــــــها ـ بالجـر](187) أكلت السمكة حتى رأسَها ـ بالفتح ـ ، وأكلت السمكة حتى رأسُـها ـ بالرفع ـ أي حتى رأسها مأكول فرأسها(188) مرفوع بالابتداء.
وأما (رُبَّ) فللتـقليـل ، نحو : رُبَّ رجلٍ لقيته(189) .
وأما (مِـن) فهي لابتداء الغاية ، نحو: خرجت من الدار ، وهي ضد ( إلى )(190).
|
|
|
وقد تقع بمعنى التبعيض كقولك: أخذت من المال أي: بعضه ، والفرق بين (من) و(عن) أن (عن) تدل على الانقطاع . بخلاف (من) ، تقول : رجعت [ عنه إليه ] (191) .
وأما (في ) فأصلها التوعية ، نحو : الدرهم في الكيس . وقد تقع بمعنى ( على ) كقوله تعالى }ولأ ُصَلـِّـبَـنَّـكُمْ فِي جُذوْع النَّخْـل ِ}(192) ؛ لأن الجذوع بمنزلة القبور(193) .
وأما (مذ) فأصله(194) (منذ) (195) وكلاهما يجر إذا وقعا بمعنى ابتداء الغاية ، كقولــك : ما رميت مذ يوم الجمعة ومـنذ(196) يوم الجمعة ، أي : من يوم الجمعة .
وأما (الكاف) فهي للتشبيه ، تقول : زيد كعمرو ، أي : مثل عمرو ، وقد تقع زائدة، كقوله تعالى : } لـَيْسَ كـَمِثـْـلِهِ شـَيْءٌ }(197) .
وأما (اللام) فأصلها التمليك والاستحقاق ، تقول : المال لزيد ، والحمد لله ، وقد تقع بمعنى (عند ) كقوله تعالى : } أقِـم ِالصَّلاة َ لِدُلـُوْكِ الشـَّمْس ِ}(198) أي عنده .
وأما (الباء) فأصلها للإلصاق(199) ، كقولك : كتبت بالقلم(200) ، ومررت بزيد(201) وقد تقع بمعنى (مع) كقوله تعـالى : } وقـَدْ دَخَلـُوْا بـِالكُفـْرِ وَهُمْ قـَدْ خَرَجُوْا بـِه }(202) .
وأما ( خلا ) و (عدا) و ( حاشا ) في الاستثناء فإن
|
|
|
منهم من جعلها حروفاً تجر ما بعدها كما مر في النواصب(203) .
النوع الثاني : مجرور بحروف القسم
وهي ثلاثة : الواو ، الباء ، والتاء .
فالباء ، كقولك (204): بالله لأفعلن كذا ، والواو كقولـه تعالى: } وَالعَصْرِ إنَّ الإنْسَانَ لـَفِيْ خُسْــرٍ} (205)والتاء كقوله تعالى: } وَتـَاللهِ لأكِيْدَنَّ أصْـنَامَكُم } (206) .
واعلم أنه يقال في القسم : ايمن(207) الله ، وايم(208) الله ، ولـَعَمْـرُالله ، كلها مرفوعة بالابتداء وخبرها محذوف التقدير: ايمن الله حلفي ، ولـَـعَمْرُ الله قسمي ، والعمر: البقاء ، ولكن يستعمل في القسم بفتح العين .
والحروف التي تصل القسم بالجواب الذي هو المقسم عليه ، خمسة : (إنَّ) المشددة المكسورة ، واللام المفتوحة ، و(ما) و (إنْ) الساكنة ، و (لا) .
|
|
|
قال الله تعالى : } والعَصْـرِ إنَّ الإنْسَانَ لـَفِيْ خُسْر }(209) ، وقال : } فـَوَرَبَّـكَ لـَنَسْألـَنَّهُم}(210)وقال تعــــالى : } وَالنَّجْـــِم إذا هَوَى مَا ضَـلَّ صَاحِبُـكُـمْ } (211) ، وقال تعـــــــالى: } تـَاللهِ إنْ كُنَّا لـَفِيْ ضَلالٍ مُبـِيْــــن ٍ}(212) ، وقال تعالى: } وَأقـْسَمُوْا بـِاللهِ جَهْدَ أيْمَانِهـِمْ ، لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوْتُ }(213).
ثم لا يخفى أن هذه الحروف قد تحذف تخفيفاً ، فيقال: والله قد جاءني زيد ، أي لقد جاءني ، وقال تعالى في جواب القسم: } والشَّمْس ِ وَضُحَاهَا... قـَدْ أفـْلـَحَ } (214) ، أي : لقد أفلح .
وقــد يـحذف الجـواب بالـكليـة كقولــه تـعالى : } ق~ . والقـُرْآن ِ المَجـِيْدِ بَلْ عَـجـِبُــوْا }(215) مـعنـاه : ق ، والقـرآن المجيـد لتبعثن ، وكـذلك : } ص~ والقـُرْآن ِ ذِيْ الذ ِّكْـر }(216) ، وكذلك : }والنـَّازِعَاتِ غَرْقاً}(217) ، والله أعلم .
النوع الثالث : مجرور بالإضافة إلى الظروف ، وكذلك الأسماء المخصوصة(218) بالجهات الست(219)
التي هي : أعلى ، وفوق ، وتحت ، وأسفل ، وقبل ، وقدام ، وأمام ، ومقابل ، وتلقاء ، وحذاء ، وإذا ، وجاه ، وتجاه وحيال ، وخلف ، وبعد ، ووراء ، ويمين، وشمال، وكالأسماء الأخر الشائعة في الحالات كلها ، كـ (عندي ، ولدى ، ولدن ومع ، وبين ، ووسط ، وطرف ، وشطر ، ونصف ، وبعض ، وكل ، ونحو ، وغير ، ودون ، وسواء ، ومثل ، ونظير ، وذو وذا ، وذات ، وذوات ) ونحو ذلك(220) .
|
|
|
تقول : فوق السرير زيد ، وتحت السرير عمرو ، وأمام الفرس أسد ، وعند زيد.. إلى آخره ، فقولك : فوق السرير زيد (فوق) ظرف ، و(السرير) مجرور بـ (فوق) ، و(زيد) مرفوع بالابتداء ، وخبره : فوق السرير ، مقدم عليه(221) ، وكذا القول في بقية الظروف والحروف الجارة .
النوع الرابع : مجرور بالإضافة إلى الأسماء المحضة
كقولك : دار زيد ، وغلام عمرو ، يُريد(222): الدار لزيد ، والغلام لعمرو ، وتسمَّى هذه الإضافة إضافة الكل .
وأما الإضافة بمعنى (من) ، فتسمى إضافة البعض ، كقولك : ثوب خزّ ، وخاتم فضة(223).
ومن هذا النوع الإضافة إلى الفاعل ، نحو قولك : الحسن الوجه ، والكريم الأب ، تريد حسنُُ وجهه ، وكريم أبوه .
ومنه أيضاً الإضافة إلى المفعول كقولك : الضاربا زيدٍ ، والراكبو الفرس ، تريد : الضاربانِ زيداً ، والراكبون الفرس قال تعالى : } والمُقِيْمِيْ الصَّلاةِ } (224).
|
|
|
فرع : لا يضاف الشيء إلى وصفه ، فلا يقال : زيدُُ القائم ، وعمروُُ الخارجِ ، وقد يضاف على قلـة(225) ، كقـوله : مسجــدُ الجامـعِ ، وقـال(226) تعـالى : } ذلِـكَ الدِّيْــنُ القـَيِّم ُ}(227) ، وقال تعالى:} عِلـْمَ اليَقِيْن ِ}(228) . والله أعلم
وأما المجزومات فنوعان :
الأول: مجزوم بحروف الجزم ، وهي خمس: لـَمْ ، لـَـمَّا ، ولا ، في النهي ، واللام في الأمر ، وإن في الشرط والجزاء .
تقول : لم يضرب زيد ، بمعنى ما ضرب ، وكذلك : لما يضرب ، وتقول : لا تفعل ، تنهى المخاطب عن ذلك الفعل ، وقال تعالى : } لا تـَقـُمْ فِيْـهِ أبَـداً }(229) ، وقــال تعـالى: } لا يَسْخَرْ قـَوْمٌ مِنْ قـَوْم ٍ }(230) ، وتقول في اللام المكسورة في الأمر للغائب : لينفق فلان، قال تعالى : } لِيُنْـفِقْ ذوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ }(231) .
ثـم
لا يخفى أنه إذا تقـدم هـذه اللام حرف عطف جاز تسكينها(232) ، قـال تعــالى :
} وَلـْيَتـَّق اللهَ
رَبَّهُ }(233) ، وتقول في الأمر المخاطب بغير اللام : اذهب واضرب لكن الصحيح أن
هذا مبني على الوقف وليس بمجزوم(234) .
|
|
|
وقد جاءت(235) الــلام في الأمـر للمخاطـب في قـولـه تعالى : } فـَبـِذلِكَ فـَلـْـتـَفـْرَحُوْا }(236) .
على قراءة ، من قرأها بالتاء الفوقية(237) .
وأما (إنْ) في الشرط والجزاء ، فنحو قوله تعالى: } إنْ تـَتـَقـُوْا اللهَ يَجْعَلْ لـَكُمْ فـُرْقـَاناً)(238)
أصلة ( تتقون ) ، حذفت النون للشرط ، وجزم ( يجعل ) بالجزاء ، وتقول : إن تكرمني أكرمك .
لا(239)يخفى أنه إذا كان الشرط والجزاء ماضيين جاز فيهما ترك الجزم ، نحو ، إن ضربتني ضربتك ، وإذا كان الجواب مستقبلاً والشرط ماضياً جاز فيه الجزم وتركه(240).
فرع:
وقد يقع الفعل المستقبل في الجواب موقع الصفة والحـال(241) ، كقولــه تعالى:
} أنـْزِلْ
عَلـَيْنـَا مَائِدَة ً مِنَ السَّمَاءِ تـَكُوْنُ لـَنـَا عِيْداً }(242) ،
فقولـه ( تكون ) صفة للمائدة(243) ، وكذلك نحو قولـه تعالى: } فـَهَبْ لِيْ مِنْ
لـَدُنـْكَ وَلِيّـاً يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ
.. }(244) فيرثني ويرث ، صفتان للولي على قراءة من رفعهما(245) .
النوع الثاني: مجزوم بالأسماء التي تتضمن معنى الشرط ، وهي تسعة ، مَنْ ، وَمَا ، وأي ، وأين ، ومتى ، وحيثما وإذما ، وأنـّى ، ومهما.
|
|
|
تـقول: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بـِهِ) (246) ، وقال تعالى: } مَا نـَـنـْسَخ مِنْ آيَةٍ أو نـُنـْسِهَا، نـَأتِ بـِخَيْر ٍ مِنــْهَا}(247) ، وتقول: أيكم يأتني أكرمه(248) ، وتقول: أين تذهب أذهب ، وتقول: متى تخرج أخرج ، وتقول: حيثما تكن أكن وإذ ما تكن أكن ، وأنـّى(249) تفعل أفعل ، ومهما تفعل أفعل.
فرع: إذا دخلت الفاء في جواب الشرط ارتفع الفعل المضارع بعده على إضمار مبتدأ ، تقول : من يأتني فأكرمه ، أي : فأنا أكرمه ، وقال تعالى : } وَمَنْ عَادَ فـَيَنْـتـَقِمُ اللهُ مِنْه}(250) . } وَمَنْ كـَفـَرَ فـَأمَتـِّعُهُ قـَلِيْلاً }(251) . أي : فأنا أمتعه ، والله أعلم(252) .
الباب الخامس : في التوابع
وأنواعها خمسة :
النوع الأول : تابع بالنعت .
وهو على خمسة أقسام :
الحلية ، والفعل ، والغريزة ، والنسب ، والوصف بأسماء الأجناس بـ (ذو) .
|
|
|
فالحلية كقولك : رجل طويل وأسود ونحوها : والفعل كقولك : رجل قائم ، وكاتب ، وخياط . والغريزة كقولك : رجل كريم وظريف ، وفطن ، ونحوها . والنسب كقولك : بصري ، هاشمي ، قرشي ، ونحوها . والوصف بأسماء الأجناس بـ (ذو) كقولك : جاءني رجل ذو مال ، ورأيت رجلاً ذا مال ، ومررت برجل ذي مال(253).
فهذه الصفات كلها تتبع الموصوف في إعرابه ، وتعريفه، وتنكيره ، وتأنيثه ، وتذكيـره ، وإفراده وتثنيته ، وجمعـه تقول : جاءني رجلٌ كريمٌ ، والرجلُ الكريمُ ، وامرأةٌ كريمةٌ ، ورجلان كريمان ، ورجال كرام .
فـرع : إذا تقدم صفة النكرة على الموصوف نصبتها على الحال ، نحو : جاءني ظريفاً رجل(254) .
النوع الثاني : تابع بالبدل وهو يجري مجرى الحال ، فيتبع إعراب ما قبله ، إلا أن البدل لا يكون إلا اسماً ، وعلامة البدل أنه يجوز إسقاط ما قبله وإقامة الثاني مقام الأول ، كما تقول : جاءني زيد أخوك، فيجوز أن تسقط زيداً ، فتقول : جاءني أخوك .
والبدل على أربعة أقسام :
بدل الكل ، وبدل البعض(255) ، وبدل الاشتمال ، وبدل الغلط . فأما بدل الكل من الكل فهو كقولك : جاءني زيد أخوك وقال تعالى : } اهْدِنـَا الصِّرَاط َ المُسْـتـَقِيْمَ صِرَاطَ الـَّذِيْـنَ }(256) .
|
|
|
وأما بدل البعض ، فقولك : ضربت زيداً رأسه ، وقال تعالى: } وللهِ عَلى النـَاس حِجُّ البَيْتِ مَـنِ اسْتـَطاعَ إلـَيْهِ سَبـِيْلاً }(257) ، فـ } مَن ِ اسْـتـَطاعَ } بدل من (النـَّاسِ)؛ لأن المستطيع بعض الناس لا كلهم .
وأما بدل الاشتمال ، وهو أن يكون معنى الكلام الأول مشــتملاً على الثاني ، كقولك: سلب زيد عقله ، وقال تعـالى : } قـُتِلَ أصْحَابُ الأخْدُوْدِ النـَّار ِ}(258) ، فالأخدود مشتمل على النار .
وأما بدل الغلط ، ولا يوجد ذلك في القرآن الكريم بل ولا في الشعر ، وإنما يقع في أثناء كلام الناس ، كقولك : مررت برجلٍ بحمار ٍ(259) ، كأنك تريد أن تقول : مررت برجلٍ وبحمار ٍ(259) ثم تذكرت فقلت : بحمار(259) ، ولا يصح في مثل هذا أن تقول بل حمار(260).
قاعدة : تبدل المعرفة من النكرة كقولـه تعالى : } وإنـَّكَ لـَتـَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْـتـَقِـيْمٍ صِـرَاطِ اللهِ}(261) وعكـسـه(262) ، كقـولـه تعالى: } لنـَسْـفـَـعاً بـِالنـَاصِـيَةِ نـَاصِيَةٍ }(263).
النوع الثالث : تابع بعطف البيان :
|
|
|
وهو أن تضع الاسم الذي ليس بحلية ولا فعل ولا نسب مكان الصفة ، كقولك: جاءني زيدٌ أخوك ، ورأيت أبا عبد الله محمداً ، ومررت بصاحبـِك زيدٍ ، فتبين الاسم الأول عن غيره بالاسم الثاني كما تبين بالصفة . والله أعلم .
النوع الرابع : تابع بالتأكيد
والتوكيد
أيضاً يجري مجرى الصفة في الإيضاح والإتباع ، وفائدته تخصيص المخبر
عنه ، كما إذا قلت جاءني زيد ، فربما توهم المخاطب أن أمر زيد جاءك دون نفسه ،
فإذا قلت: جاء زيدٌ نفسُه أو عينُـه خصصت المجيء بـ (زيد) .
وأسماء(264) التوكيد سبعة(265) وهي :
النفس ، والعين ، وكل ، وأجمعون ، وأبصعُون ، وأبتعون ، وأكتعون(266) .
تقول : جاءني زيدٌ نفسُه ، ورأيت الفرسَ عينـَه ، وقال تعالى : } فـَسَجَدَ المَلائِكـَة ُ كـُلـُّهُمْ أجْمَعُوْن}(267) وتقول : جاء القومُ كلـُّهم أبصعون .
والبَصْع : الجمع(268) .
|
|
|
وتقول : جاء القوم كلهم أبتعون ، مشتق من ( البتع ) الذي هو القوة والشدة ، ولا يستعمل أكتع(269) وأبصع وأبتع إلا بعد كل وأجمع(270) كما ذكرنا ، وتقول : جاءني النسوة كلـُّـهن ، جُمَعُ كـُتـَعُ بُصَعُ بُتـَعُ .
فـرع : وتـؤكـد التـثـنية بـ (كلا) وتكون مع غير المضمر بالألف أبداً على صورة [ واحدة ] (271) ، تقول : جاءني كلا الرجلين ، ومررت بكلا الرجلين ، ورأيت كلا الرجلين ، وأما مع المضمر فترفع بالألف ، وتنصب وتجر بالياء كسائر التثنية ، فتقول : جاءني كلاهما ، ورأيت كليهما ، ومررت بكليهما ، وفي المؤنث تقول: كلتا المرأتين بتاء زائدة.
فائدة: قد يؤكد الاسم بتكرير اللفظ ، كقولهم: هذا رجل رجل ، ومنه: الله أكـبر الله أكـبر ، وقال الشاعر:
3ــ أنـَا أبُوْ النـَّجْم وشِعْــِري شِعْــِري(272)
والله تعالى أعلم.
النوع الخامس : تابع بالعطف
وحروف العطف عشرة :
الواو ، والفاء ، وثـُمَّ(273) ، وأم ، وأو ، ولا ، وبلْ ، وحتى ، ولكن ، وإمَّا ( بكسر الهمزة ).
فأما (الواو) فهي للجمع والاشتراك ، ولا توجب الترتيب على الأصح ، تقول جاءني زيدٌ وعمروٌ ، ألا ترى أن (الواو) جمع بينهما في المجيء(274) .
|
|
|
وأما (الفاء) فتكون للترتيب والتعقيب ، تقول : جاءني زيدٌ فعمروٌ ، فهي تدل على أن عمرا جاء بعد زيد .
وأما (ثـُـمّ) فهي كالفاء إلا أنها أكثر مهلة ، تقول : جاءني زيدٌ ثمَّ عمروٌ.
وأما (لا) فمعناها إخراج الثاني مما دخل في الأول ، تقول : جاءني زيد لا عمرو ، ألا ترى أنك أخرجت عمراً بـ (لا) عن المجيء .
وأما (بلْ) فهي للإضراب عن الأول والإثبات للثاني ، تقول : ما جاءني زيد بل عمرو .
وأما (لكن) المخففة فمعناها الاستدراك(275) بعد النفي ، تقول : ما جاءني زيد لكن عمرو ، وإن شئت أدخلت الواو فيه قال الله تعالى : } مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبَا أحَدٍ مِنْ رِجَالِكـُمْ ولـَـكِـنْ رَسُوْلَ اللهِ { (276) ، [ فرسول الله ] (277) معطــوف على (أبا).
وأما (أو) فتكون تارة للشك ، وتارة للتخيير ، وتارة للإباحة ، تقول في الشك ، جاءني زيد أو عمرو ، وفي التخيير : كل السمك أو اشرب اللبن ، فليس لـه أن يجمع بينهما ، وتقول في الإباحة : كل اللحم أو الثريد ، فله الجمع بينهما .
|
|
|
وأما (أم) فهي عديلة الاستفهام عما وقع فيه الشك ، تقول : أزيد في الدار أم عمرو ، وقال تعالى : } أهُمْ خَيْرٌ أمْ قـَوْمُ تـُبَّعٍ }(278) وتقول في التسوية بين الشيئين : سواء عليه أقام أم قعد ، وقال تعالى : } سَوَاءٌ عَلـَيْهـِمْ أأنـَذرْتـَهُمْ أمْ لـَمْ تـُنـْذِرْهُـمْ }(279).
وأما ( إمَّا ) - بكسر الهمزة - فتجري مجرى (أو) في الشك وغيره ، إلا أنها تأتي قبل الاسمين فتؤذن بالشك في أول الكلام ، ولـذلك كررت(280) ، تقول : رأيت إما زيداً وإما عمراً ، قال(281) تعالى : } إمَّا شَاكِراً وإمَّا كـَفـُـْوراً }(282) بخلاف ( أمَّا ) ـ بفتح الهمزة ـ فإنها وإن كانت من حروف العطف فلابد لها من جواب لما فيها من معنى الشرط ، تقول : أمَّا زيدٌ فقائم ، وقال تعالى : } وأمَّا ثــَمُوْدُ فـُهَدَيْـنـَاهُمْ }(283) ، وإن كـررت فإنما هي لعطف كـلام على كلام(284) بالواو ، كقوله(285) تعالى : } فـَأمَّا اليَتِيْمَ فـَلا تـَقـْهَرْ وَأمَّا السَّائِلَ فـَلا تـَنـْهَرْ وَأمَّا بـِنِعْمَةِ رَبِّـكَ فـَحَدِّثْ }(286) .
|
|
|
وعاشر الحروف (حتى) ، وتكون ناصبـة ، تقـول : أكلتُ السمكـة َ حتى رأسَها - بالنصب ، وتكون لانتهاء الغاية وغير ذلك ذكرناه في مبحث الحروف من أصول الفقه(287) والله أعلم .
فرع : لا يعطـف اسم على اسم إلا إذا اتفقا في الفعل ، نحو: قام زيدٌ وعمروٌ ، فإن اختلفـا لـم يجـز العطف ، فلا يقال : ماتَ زيدٌ والشمسُ، إذ الشمس(288) لا توصف بالموت، وكــذلك لا يعـطـف الفـعـل على الفعـل ، إلا إذا اتـفـقـا ، فـلا يقـال : قـام ويقعـد وأمـا قـولـه تعالـى : } إنَّ الـَّذِيْـنَ كـَفـَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبـِـــيْل ِ اللهِ }(289) ، فالواو ليست للعطف وإنما هي واو الحال ، المعنى : إن الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدون عـن سبــيل الله (290).
|
|
|
قالوا: ولا يجوز عطف الفعل على الاسم ، وأما قولـه تعالى : } أوَ لـَمْ يَرَوْا إلـَى الطـَّيْر ِ فـَوْقـَهُمْ صَافـَّاتٍ وَيَقـْبـِضْنَ }(291) ، فتقديره : صافات وقابضات ؛ لأن الفعل المستقبل يضارع اسم الفاعل في المعنى؛ لاشتراكهما في الحال(292) . ولذلك سمي مضارعاً ، يعني مشابهاً ، فتقول : رأيت زيداً يصلي ورأيت زيداً مصلياً بمعنى واحد ، والله أعلم.
الباب السادس : في بيان الأربعة أبواب الخارجة عن الإعراب
وهي : باب العدد ، وباب الجمع ، وباب التصغير ، وباب النسب .
وقد ذكرناها في أربعة فصول :
الفصل الأول في بيان العدد :
أعلم أن للعدد أربع مراتب : آحاد ، وعشرات ، ومئات ، وألوف ، وما جاوزها فهو مكرر .
والآحاد: ما دون العشرة عندهم ، وعدد المذكر يكون بالهاء من الثلاثة إلى العشرة ، وعدد المؤنث يكون بغير الهاء من الثلاثة إلى العشرة ، فيقال: ثلاثة رجال(293)، وخمس نسوة ، وعشرة أبواب ، قال الله تعالى : } سَبْعَ لـَيَال ٍ وَثـَمَانِيَة َ أيَّام ٍحُسُوْماً }(294) .
وأما من [ الثلاثة إلى العشرة ] (295) ، فيضاف إلى جمع القلة ، نحو : أفـْعِلـَةٍ ، وأفـْعُـلٍ ، [ وأفـْعَالٍ ](296) ، ثم فِعْلـَةٍ.
|
|
|
فتزن جمع الجمع بهذا الميزان ، تقول : خمسة أكلب ، وثلاثة أجمال ، وسبعة أرغفة وعشرة صبية(297) .
واعلم أن الواحد والاثنين لا يضافان إلى المعدود ، ولكن يجعلان صفة له ، فتقول في المذكر : جاءني رجل واحد ورجلان اثنان ، وفي المؤنث : امرأة واحدة(298) ، وامرأتان اثنتان .
وأما [ ما فوق العشرة إلى تسعة عشر ] (299) فتجعل العددين اسماً واحداً وتبنيهما على الفتح في كل حال إلا(300) اثنى عشر رجلاً ، فإن اثنى تختلف(301) للزوم التثنيه له ، تقول: أحد عشر رجلاً ، وإذا عددت المذكر ألحقت الهاء بأول العدد وأسقطتها من الثاني ، فتقول: ثلاثة عشر رجلاً ، وخمسة عشر غلاماً ، وتسعة عشر ثوباً.
|
|
|
وإذا عـددت المؤنث أسقط الهاء من الأول وألحقها بالثاني على عكس المذكر ، فتقول: ثلاث عشرة امرأة ، وخمس عشرة جارية ، وتسع عشرة سنة ، فإذا بلغت العشرين استوى المذكر والمؤنث في العقود ، نحو : عشرون رجلاً وعشرون امرأة ، وكذلك ثلاثون وأربعون إلى المائة.
فرع: إذا جاوز العدد العشرة إلى المائة توحد المعدود ونصب على التمييز ، نحو }أحَدَ عَشَرَ كـَوْكـَباً}(302) وخمسون رجلاً ، وتسعون نعجة ، وأما قولـه تعالى: } اثـْـنَتـَي عَشْرَة َ أسْبَاطاً }(303) فبدل(304) من اثنتي عشرة أو عطف بيان فإذا بلغ العدد مائة أضيف إلى واحد ، فكان شائعاً في الجنس ، كقولك : مائة درهم ، وكذلك مائتا درهم وثلاثمائة إلى تسعمائة ، فلا يقال : ثلاثة مائة ، لأن المائة مؤنثة.
فإذا بلغ العدد الألف حكمت عليه حكم الواحد المذكر(305) ، فتقول: ثلاثة آلاف ، وأربعة آلاف ، إلى عشرة آلاف ، كما يقال : ثلاثمائة ، والله تعالى أعلم.
الفصل الثاني : في بيان الجمع
اعلم أن جميع الأسماء على ثلاثة أضرب :
أحدها: بزيادة الحروف مثل : رجل ورجال ، وحمْـل وأحْمَال ، ومسلم ومسلمين .
|
|
|
الثاني: بنقصان الحروف ، مثال(306) : كتاب وكـُتـُب ، وراكِب ورَكْب ، وصبور ، وصُبْرٍ ، ونـَخْلةٍ ونـَخْـلٍ وثمرةٍ وثمرٍ ، ونـَحْلةٍ ونـَحْـلٍ ، الفرق بين الواحد والجمع ثبوت تاء التأنيث وحذفها .
الثالث: بتغييـر الحركة ، نحو : جُوالـَِـق وجَوالِـق ، الواحد مضموم ، والجمع مفتوح(307).
واعلم أن كل جمع لم يسلم فيه بناء مفرد(308) واحده يسمى جمع التكسير ، نحو: رجل ورجال ، وبيت وأبيات .
فرع : أبنية الجموع القليلة على أربعة أقسام :
الأول : أفعُل(309) ، وهي جمع فعْل وفِعَال ، تقول : كـَلـْب وأكـْلـُب(310) ، وذِرَاع وأذْرُع .
القسم الثاني : أفـْعَال ، جمع فـَعَل ، وفـَعِل ، وفـَعُل(311) ، وفِعَل ، نحو: جمل وأجمال ، وفخذ وأفخاذ ، وعضد وأعضاد ، وعِنـَبٍ وأعْـنـَاب .
الثالث(312): أفـْعِلة ، وهي جمع فـَعَال ، وفـُعَال ، وفِعَال ، وفـَعِـيل ، تقول: متاع وأمتعة ، وغراب ، وأغربـة ومثال وأمثلة ، ورغيف وأرغفة .
الرابع: فِعْلة ، جمع فـُعَال ، وفعيل ، نحو(313): غُـلام وغِـلـْمَةٍ ، وصَبيٍّ ، وصِـبْيَة.
|
|
|
فهذه أبنية جموع القلة من الثلاثة إلى العشرة(314) ، تقول : رأيتُ ثلاثة َ أكلبٍ ، وأربعةَ أجمالٍ ، وخمسة أغربـةٍ وعشرةَ صبيةٍ.
وأما أبنية الجموع الكثيرة فهي ثمانية أقسام(315):
الأول: فـُعُول: وهو جمع فـَعْـل ، وفـَعَل ، [ وفـَعِل ](316) مثاله : قـَلـْب وقـُلـُوب ، وأسَد وأسُوْد ، ونـَمِر ونـُمُور.
الثاني : فِعَال : جمع فـَعَل ، وفـَعُل ، وفـَعْـل ، ونحو ذلك ، مثاله : جَمَل وجـِمَال ، وضَبُع وضِبَاع ، وبَحْر وبـِحَار
الثالث : فـُعُل ، جمع فـَعـِيْـل ، وفـَعـِيْلة ، وفـُعُـوْل ، ونحو : نـَذِير ونـُذُر ، وصَحِيْـفـَة وصُحُف ، ورَسُول ورُسُل .
الرابع : فـُِعَـل ـ بكسر الفاء وبضمها ـ نحو : نِعْمَة ونِعَم ، ومِحْنة ومِحَن ، وغُـرفـَة وغُـرَف ، وكُبْرى وكـُبَـر قال تعالى: } إنـَّهَا لإحْدَى الكـُبَر }(317).
الخامس : فـُعْـل ، جمع أحْمَرْ وحَمْرَاء ، وأصْـفـَرْ وصَفـْرَاء ، تقول في جمع ذلك: حُمْر وصُفـْر.
السادس: فـُِـعلان ـ بضم الفاء وبكسرها ـ جمع فـَعَـل نحو: حِلـْـفـَان وجـُِرْدَان(318) وغِلـْمَان وصِـبْـيَان.
|
|
|
السابع : ما يكون بالتاء ، تقول في شَجَرَة شَجَرَات ، وفي جمع جـِفـْـنـَة جَفـَنـَات ، وفي جمع رَوْضَة رَوْضَات وصَحْـفـَـة صَحفات ، وسُرَادُقـَات ، ورَمَضَانـَات وسُؤَالات وجَمَادَات ، وتقول أيضاً في جمع صحِـيفـة صحائف وفي جمع رسالة رسائل ، وفي جمع مِئـْـزَر مـآزر ، وفي جمع مِلـْحَفـَة مَلاحِف ، وفي جمع الضفـدع ضَفادع ، وفي جمع الخُـنْـفـُـس خنافس .
الثامن : فـَواعِل ، جمع فـَاعـِل ، تقول ، ناظر ونواظر ، وحاجر وحواجز .
خاتمة : في جموع الصفات :
الفاعل يجمع على الفاعِلين في الأغلب ، والفـُعَّال ، والفـَعَلة ، تقول: كافر ، وكافرون [ وكفار ] (319) وكفرة والله أعلم
الفصل الثالث : في بيان التصغير وأبنية(320) التصغير ثلاثة ، فعيل ، نحو ، فليس ، وفعيعل نحو : دريهم ، وفعيعيل نحو: دنينير .
وتصغير الأسماء على خمسة أنواع :
تصغير الثلاثي ، وتصغير الرباعي ، وتصغير الخماسي ، وتصغير المبهمات ، وتصغير جمع التكسير .
النوع الأول : تصغير الثلاثي ، نحو عَـبْد وعُبَيْد ، وقـَمَر وقـُمَيْر ، وفي فـَتى فـُتـَيّ ، وفي ظـَبي ظـُبَيّ ، وفي جَدِي جُدَيّ .
|
|
|
وإذا كان الاسم مؤنثاً على أكثر من ثلاثة أحرف لم تدخل الهاء في التصغير ، فلا يقال في عقرب : عُـقيربة ، وإنما يقال عُـقـَيرب(321) .
الثاني : تصغير الرباعي ، تقول في جعفر : جُعيفر ، وفي فِلفل فـُليفل .
الثالث : تصغير الخماسي نحو قولك في سفرجل: سُفـَيْرج بحذف الآخر ، وفي مصباح مُصيبيح ، وفي قنديل قـُنيديل وفي عصفور عُصيفير ، وفي سكين سُكـَيْـكين ، وفي سلطان سُلـَـيْـطين ، وفي حضرموت حُضَـيْرموت ، وفي بعلبك بُعيلـَبك ، ونحو ذلك(322).
الرابع : تصغير المبهمات ، تقول في ذا ، وهذا ، ذ َيَّا وهَذ َيَّا للمذكر . وللمؤنث: تـَيَّا وهَاتـَيَّا ، وفي التثنية هَذ َيَّان وهَاتـَيَّان ، وقس على ذلك(323) .
ولا تصغر المضمرات من الأسماء البتة ، نحو: أنت وهو ، وأمس ، وغدا ، والبارحة ، وعند ، وأين ، ومتى ، وكيف وأسماء أيام الأسبوع ، وشهور السنة لا يصغر شيء منها(324) . والله أعلم .
|
|
|
النـوع الخامـس: تصغيـر جمـوع التكسيـر نحـو: كـلاب ، وجـمال ، فتـقول: أجَيْمِـل وأكـَيْلِب (325) وتقــول في جمع: مساجد ، ومصابيح ، مُسَيْجدات ، ومُصَيْبحات(326) ، وفي تصغير(327) السنين والأرَضين: سُنـَيات وأرَيْضات(328). والله أعلم.
الفصل الرابع : في بيان النسب إذا نسبت شيئاً إلى شيء زدت في آخره ياء مثقلاً. والنسب على وجهين : مسموع ومقيس .
فالمسموع: نحو قولهم في النسبــة [ إلى ] (329) العالية علوي(330) ، (وإلىالشتاء شَـتوي(331) ، وإلى الزوج زوجاني)(332) ، وإلى الرب رباني، وإلى اللحية لحيانـي (333) ، وإلى الرازي رازيّ ، وإلى الطائي طائي(334) ، وإلى اليمن يماني بغير تشديد(335) .
وأما المقيس : فكقولهم في النسبة إلى زيد زيدي ، وإلى خالد خالدي ، وإلى أسد أسدي ، وفي النسبة إلى النمر نمري وإلى الشعر شعري ، وإلى ثعلب ثعلبي .
|
|
|
وتقول في النسبة إلى الرحا رحَوي ، وإلى القفا قفوي(336) ، وتقول في النسبة إلى نحو: حنيفة حَنَـفِي ، وإلى ربيعة رَبَعِي(337) ، وإلى جُهينة جُهَـني(338) ، وتقول في النسبة إلى عيسى عِيْسَوي ، وإلى موسى مُوْسَــوي - وإلى الدنيا دُنْيوي(339)، وتقول في النسبة إلى طلحة طلحي، وإلى الكوفة كوفي ، وإلى البصرة بصري ، وتقول في عماد الدين وفخر الدولة وتاج الملك ، عمادي وفخري وتاجي ، وتقول في النسبة إلى أبي بكر بكري ، وإلى الزبير زبيري(340) ، وإلى حضرموت حضرمي(341) ، والله أعلم.
• • •
خاتمة الكتاب :
وهي حاوية(342) لجميع ما في الكتاب ، لأنه كله يرجع إليها لمن حسن تأمله .
اعلم يا أخي أن كلام العرب كله يدور على ثلاثة أقطاب ، وهي : الفاعلية ، والمفعولية ، والإضافة ، ورتبة الفاعل (التقدم ، ورتبة المفعول التأخير ، والمضاف يكون بينهما ، واستحق الفاعل) (343) الضمة؛ لأنها أخت الواو وهي من الشفة والمضاف الكسرة؛ لأنها أخت الياء وهي من وسط الحلق(344) ، واستحق المفعول الفتحة لأنها أخت الألف وهي من أقصى الحلق(345) .
مثال كون المضاف واسطة : ضرب غلامُ زيدٍ جارية َ بكرٍ ، والله أعلم .
|
|
|
القطب الأول : الفاعلية : وكل مرفوع عائد إليها إما لكونه ، فاعلاً ، أو مشابهاً للفاعل(346) .
والفاعل هو: كل اسم اسند إليه الفعل نحو قولك: قام زيد ، وطاب الخبز ، ولم يقم عمرو ، ودخل في ذلك مفعول مالم يسم فاعله؛ لأنه أقيم مقام الفاعل ، ولذلك ارتفع(347) كما يرتفع الفاعل ، كقولك : ضُــِربَ عمرو(348) ، وسِـيْـقَ البعير ، ونحوهما.
ودخل في ذلك أيضاً المبتدأ؛ لأنه خبر عنه كالفاعل ، نحو: قـَامَ زيدٌ ، وخَرَجَ عمروٌ ، إلا أن خبر المبتدأ يكون بعده ، عكس الفاعل ، فتقول : زيدٌ قائمٌ ، وعمروٌ خارجٌ.
|
|
|
ودخل فيه أيضاً اسم (كان) وأخواتها ، نحو قولك : كان زيد قائماً ، يعني فيما مضى ، ( فأقمت (كان) مقام قولك فيما مضى ) (349) ، فأعملت عمل الأفعال ، فرفع المبتدأ بها ، ونصب الخبر ، فقيل : كانَ زيدٌ قائماً ، كما قيل : ضـرب زيـد عمـراً ؛ لأنها فعل مثل(350) (ضرب) وإن كانت تدل على الزمان دون المعنى ، و(ضـرب) يدل على المـعنى(351) والزمان معاً.
ودخل في ذلك أيضاً خبر (إن) وأخواتها نحو: إن زيداً قائم؛ لأن الاسم يشبه المفعول ، والخبر الفاعل ، وقال بعضهم غير ذلك(352) .
القطب الثاني : المفعولية : وكل منصوب عائد إليها إما لكونه مفعولاً أو مشابهاً للمفعول أو مشابهاً للمشابه للمفعول .
فأما المفعول فيكون على خمسة أقسام :
الأول: مفعول به ، وهو ما وقع به الفعل المسند إلى الفاعل ، نحو : ضربت زيداً.
الثاني: مفعول فيه ، ( وهو ما وقع الفعل فيه ) (353) ، ويسمى ظرفاً ، نحو: سرت اليوم ، وجلست عندك ، وهو منصوب بنـزع الخافض(354) .
الثالث: المفعول له، وهو ما وقع الفعل لأجله ولسببه ، نحو قـولك: جئتك ابتغاء الخير ، وهربت خوف الأسد .
الرابع: مفعول معه ، وهو ما اجتمع مع الفاعل على الفعل ، نحو قـولك: استوى الماء والخشبة.
|
|
|
الخامس: مفعول مطلق ، وهو المصدر ، وسمي مصدراً مطلقاً؛ لأنه هو المفعول الحقيقي الذي أحدثه الفاعل وأوجده بعينه ، كالماء الذي يصدر عنه الإبل .
ومن المنصوب العائد إلى المفعولية التعجب ، كقولك : ما أحسن زيداً ، ففي (أحسن) ضمير يعود إلى (ما) ، ومحل (ما) مرفوع بالابتداء.
|
|
|
ومنه
أيضاً المنادى ، نحو: يا عبد الله ، ويا رجلاً عاقلاً ، وهمـا منصوبان بفعل مضمر
يقوم مقامه(355) ، التقدير: أنادي عبدَالله ، وأدعو رجلاً عاقلا ، وما كان من
المنادى مفرد(356) ، فمبني على الضم ، نحو: يا زيدُ ، وبيانه أن حق المنادى أن
يكون ضميراً كالمخاطب ، فقولك: يازيدُ ، تقديره: ياك ، فلما وضع الاسم المتمكن
موضع الكاف بني على الضم نظير حروف الغاية ، نحو قولك: من قبل ومن بعد ، ومنه
أيضاً الإغراء والتحذير ، نحو قـولك للرجـل: الطـريـق الأســدَ(357) الأســدَ
، ومنـه قولـه تعالى :
} نـَاقـَة َاللهِ وَسُقـْـيـَاهَا }(358) ، تقدير ذلك: خَلِّ
الطريقَ(359) ، واحذر الأسدَ ، واحذروا ناقة َ الله وسقياها.
ومنه أيضاً المستثنى ، نحو : جاء القوم إلا زيداً ، ( أي : أستـثـني زيداً) (360) فهو ملحق بالتمييز ؛ لأنك أخرجته من القوم وصار بالاستثناء مميزاً عنهم .
وأما المشابه للمفعول ، فكخبر (كان) وأخواتها ، واسم (إن) وأخواتها ، كما مرّ .
ومنه التمييز كقولك : فلانة أحسن الناس وجهاً ، (فالوجه مشابه للمفعول) (361) ، وكذلك نحو : عشرون درهماً مشـابه(362) للضاربين زيداً ، ويقال للتمييز مفعول فيه .
ومنها أيضاً الحال ، نحو قولك : جئت راكباً ، مشابه للمفعـول فيه من أجل أن المختار في الظروف الفتح ، لكن لا يخفى أن الحال أضعف نصباً من المفعول ؛ لأن العامل فيها الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول به ، ويقال للحال مفعولاً عليه .
|
|
|
وأمــا المشابه للمشابه للمفعول ، فكقولك في نفي النكـرة : لا رجلَ في الدار ، العامل في (الرجل) (لا) وهي ملحقة بـ (أنَّ) ؛ لأنها نقيضتها ، وذلك لأن حرف (لا) يقتضي النفي ، وحرف (أنّ) يقتضي الإثبات ، فوجب أن تنصب الأسماء كما تنصبها ، وإنما بُني الاسم مع (لا) ؛ لأنه جواب كقول القائل: هل من رجل في الدار ، فتقول : لا من رجل في الدار ، فلما حذف (من) تضمـــن الكلام معنى الحرف ، والحروف كلها مبنية ، وقيل (الرجل) مع حرف (لا) مشبه بـ (خمسَة عشر) و (حضرَ موت ) ونحوها ، ولهذه العلة امتنع من التنوين ، وهذا القسم يعود إلى المفعول به فافهم(363) .
القطب الثالث : الإضافة : وكل مجرور عائد إليها ، والإضافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: إضافة اسم إلى اسم ، نحو: ذا زيد ، وغلام عمرو .
والثاني: إضافة ظرف إلى اسم ، نحو: عنـد ربِّك ، وتحت زيدٍ ، وفوق سطحٍ ، ويوم الجمعةِ .
والثالث: إضافة معنى إلى اسم ، وذلك لا يحصل إلا بحروف المعاني ، نحو : جئت من البصرة إلى الكوفـةِ ، وفي الدارِ زيد ، وعلى السطح ِ عمرو ، ومع زيدٍ سيف ؛ فـ(من) لابتداء الغاية ، و(إلى) انتهائها(364) ، و(في) للظرف ، و(على) للاستعلاء ، و(مع) للمصاحبة.
|
|
|
هذا قياس جميع أبواب النحو ، فامتحن بذلك ما شئت من أبواب النحو تجده راجعاً إلى هذه الخاتمة ، والله تعالى (365) أعلم .
وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله وسلم(366) على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، والحمد لله رب العالمين .
وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في يـوم الثلاثاء المبارك سابع شهر جمادى الآخر ، سنة ست وثلاثين من الهجرة النبوية(367) ، على يد الفقير ، أحمد بن علي العطيوي الشعرواي خرقة وتلميذاً ووطناً ، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة ، ولسائر المسلمين والمسلمات آمين ، اللهم آمين(368).
الهوامش والتعليقات
(1)لطائف المنن والأخلاق ، للشعراني: 1/32 .
(2)المصدر السابق : 1/5 ، 32 .
(3)انظر : معجم المؤلفين ، لعمر كحالة : 4/218 ، الأعلام للزركلي : 4/331 .
(4)انظر السابق .
(5)انظر : لطائف المنن : 1/32 - 33 .
(6)انظـر : مقـدمة محققي كتاب : الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصـوفية للشعراني:8 .
(7)انظر : شذرات الذهب ، للحنبلي : 8/372 - 373.
(8)انظر : الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار ، للشعراني : 1/114 .
(9)انظر : لطائف المنن : 1/33 .
(10)انظر : لطائف المنن : 1/34 - 35 ، 49 ، والكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة للغزي : 3/176 - 177 شذرات الذهب : 8/372 - 373 .
(11)انظر : شذرات الذهب : 8/374 .
(12)الكواكب السائرة : 3/177 .
(13)انظر : مقدمة كتاب : أسرار أركان الإسلام : 19 .
(14)هدية العارفين للبغدادي : 5/641 .
(15)انظر : شذرات الذهب : 8/373 ، هدية العارفين : 5/641 ، الأعلام : 4/331 .
(16)انظر : شذرات الذهب : 4/374 ، هدية العارفين : 5/641 .
(17)ما بين القوسين سقط من (ب) .
(18)في (أ) : الحمد لله ، وقد أثبت ما في (ب) للتوافق في العطف بين أحمد ، وأشهد .
(19)تكـرر رسمهـا في هـذا الموضع والمواضع التي تليه من (ب): الفقهاء ، وهو تحريف ، وما أثبته من (أ)، وهو المراد لأن مصطلح الفقراء يتداولـه المتصوفة كثيراً ، ولأنهم هم الذين لا يعتنون بإصلاح اللسـان .
(20)هو علي بن عبد الله … بن هرمز ، أبو الحسن الشاذلي المغربي ، وشاذلة قرية من أفريقية ، شيخ الطائفة الشاذلية من المتصوفة ، وصاحب الأوراد المسماة (حزب الشاذلي) ، له رسالة: الأمين ، والسر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيـــل ، ولابن تيمية رد على حزبه ، توفي في صحراء عيذاب في طريقه إلى الحج ، ودفن هناك في ذي القعدة سنة 656هـ.
انظر : الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار 20/4 ، والأعلام : 5/120 .
(21)النص من قوله : (كما عليه .. : في نفوسهم) غير واضح في (ب) .
(22)في (ب) : الاثنا .
(23)سقطت من (ب) .
(24)في (ب) : وهو
(25)حد الاسم عند جمهور النجاة : مادل على معنى في نفسه ، ولم يقترن بزمان .
وماذكره المصنف قريب من حد الأخفش الذي ذكره الزجاجي ، وهو علامة من علامات الاسم.
انظر الأصول في النحو : 1/36 ، 37 ، الإيضاح في علل النحو للزجاجي: 49 شرح المفصل: 1/22، شرح ابن عقيل: 1/15 ، 16 ، 21 ، الهمع : 1/7 ، 11.
(26)الرفع والنصب والجر أنواع الإعراب وألقابه ، وأضاف النحاة - عدا الكوفيين والمازني - الجزم ، وأما حركاته فهي الضمة والفتحة والكسرة ، وللجزم السكون .
انظر شرح الجمل لابن عصفور : 1/104 - 105 ، الهمع : 1/64 - 66 .
(27)ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق ، أضافها أحد الشراح في هامش الكتاب .
(28)يرى النحاة أن الضم والفتح والكسر بالنسبة للبناء ألقاب ؛ لأنها ألقاب الحركات في نفسها ، وأضافوا الوقف إذا خلى آخر الكلمة من الحركة .
(29)ما بين القوسين سقط من (ب) .
(30)أضاف النحاة اسماً سادساً هو : هنو ، يكنى به عما يستقبح ذكره أو يستعاب .
وأنكر الفراء مجيئه على الإتمام فيأتي على لغة القصر فقط ، يقال : هن بالحركات.
انظر: شرح المفصل : 1/51 ، وشرح ابن عقيل : 1/49 .
(31)سقطت من (ب) .
(32)حركت نون المثنى ، لالتقاء الساكنين خصت بالكسر لوجهين .
أحدهما أن الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك أحدهما بالكسر ، والآخر : للفرق بينهما وبين نون الجمع - المحرك بالفتح .
وهناك أقوال أخرى ، انظر شرح المفصل: 4/141 ، شرح الجمل: 1/150 ، وشرح التسهيل لابن مالك: 1/72 والأشباه والنظائر: 1/194.
(33)ما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها النص ، لأن الكلمات: عصا ، وقفا ، ورحى ، وهدى التنوين يدخل عليها لأنها منصرفة ، أما حبلى فغير منصرفة.
(34)في (ب) : فالأمثال .
(35)الدخان من الآية : 41 .
(36)الأحقاف ، من الآية : 31 .
(37)لأنها معربة .
(38)سقطت من (ب) .
(39)انظر الخلاف في حد الممنوع من الصرف في شرح المفصل : 1/58 ، الهمع : 1/76 .
(40)في ب : (وصف) .
(41)في (أ) و (ب) : (بعدها) ، والصحيح ما أثبت .
(42)ورد البيتان في أسرار العربية للأنباري : 307 وفي ألفية ابن مالك ، انظر شرح ابن عقيل : 2/321 .
(43)في ب: فكل ما يجتمع .
(44)بشرط ألا يقبل هذا الوزن التاء ، وأن تكون الوصفية أصلية لا عارضة .
انظر: شرح الجمل : 2/210 ، والهمع : 1/100 .
(45)اختلف النحاة في شرط ما جاء صفة في آخره ألف ونون زائدتان ، على ثلاثة آراء.
الأول: أن يكون مؤنثه على فعلى ، وهو ما ذهب إليه المصنف .
الثاني : ألا يكون مؤنثه على فعلانه .
الثالث : جمع بين الرأيين .
انظر ما ينصرف ومالا ينصرف: 46 ، أوضح المسالك : 4/118 ، الهمع : 1/96 حاشية الصبان 3/174.
(46)يريد
أن ألفاظ العدد المعدولة عن (فعال) و(مفعل) والمسموع منها من واحد إلى أربعة
باتفاق يقال
فيها : أحاد وموحد ـ وهو قليل ـ وثناء ومثنى ، وثلاث ومثلث ، ورباع ومربع . وأضاف بعضهم خماس ومخمس وعشار ومعشر .
واختلف فيما عدا ذلك بين السماع والقياس ، فذهب البصريون إلى أنه لا يقاس عليها وأجازه الكوفيون والزجاج وأجاز بعضهم القياس على (فعال) دون (مفعل) .
انظر الخلاف بالتفصيل في : ما ينصرف وما لا ينصرف : 59 ، وشرح الجمل : 2/219 ، أوضح المسالك : 4/122 الهمع : 1/83 .
(47)ومما منع من الصرف للعدل والوصف : أخر على وزن فعل ، جمع أخرى ـ مؤنث آخر ـ وذلك في حال تنكيره فقط ، أما في حال تعريفه فينصرف لذا لم يذكره المصنف لأنه في معرض الحديث عما لا ينصرف في النكرة والمعرفة .
انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: 54 ، شرح المفصل: 1/62 ، أوضح المسالك: 4/123.
(48)فاطر ، من الآية: 1 ، وقوله تعالى: (مثنى وثلاث وربـاع) زيادة من القرآن الكريم يقتضيها السياق ، لأنها موضع الشـاهد.
(49)ذهب المصنف إلى أن مانع الصرف مع ألفي التأنيث المقصورة أو الممدودة علتان ، وهذا مخالف لما ذهب إليه جمهور النحاة في أن العلة واحدة ، وهي: ما فيه ألف التأنيث مطلقاً ، مقصورة كانت أو ممدودة.
انظر ما ينصرف وما لا ينصرف : 6 37 ، شرح المفصل : 1/59 ، شـرح الجمل: 2/215 الهمع : 1/78 .
(50)في (أ) : (ألف) بالرفع ، والصحيح ما أثبت من (ب) .
(51)اتفق النحاة على أن إحدى العلتين الجمع ، واختلفوا في العلة الثانية على ثلاثة آراء:
الأول: خروجه عن صيغ الآحاد العربية ، وهو مذهب أبي علي ، ورجحه ابن مالك.
الثاني: تكرار الجمع ، اختاره ابن الحاجب ، وبه قال المصنف .
الثالث: جمع بين الرأيين السابقين ، وهو قول ابن يعيش .
انظر: شرح المفصل : 1/63 ، شرح الكافية : 1/54 ، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 850 ، حاشية الصـبان : 3/183 .
(52)في (أ) و (ب) : (أساوير) ، والصحيح ما أثبته ، انظر: اللسان (سور) ومصادر أخرى .
(53)ذكر اللغويون أن أعاريب جمع أعراب وعرب ، وعليه لعل الهاء في (جمعها) تعود على جمع مفرد أعاريب وهو (أعراب) .
انظر التهذيب (عرب) : 2/360 ، والصحاح ، واللسان : (عرب)
(54)في (ب) : (العلمية) .
(55)ما بين القوسين سقط من (ب) .
(56)من زفر الحمل : أي حمله ، والزُّفـْر : السيد الشجاع ، وبه سمي الرجل زُفـَر ، لقوته في حمل الأشياء ، اللسان (زفر).
(57)أضاف بعض النحويين إلى هذه الأقسام الستة قسماً سابعاً ، وهو : ما كان المانع من صرفه مع العلمية ألف الإلحاق المقصورة مختوماً بها ، نحو عَلـْقى ، وأرْطى علمين.
انظر: أوضح المسالك : 4/128 ، حاشية الصبان : 3/198 .
(58)حكم المصنف على كل ما جاء علماً ثلاثياً ساكن الوسط بحكم واحد وهو : جواز الصرف ومنعه مخالفاً بذلك جمهور النحاة فيما جاء علماً ثلاثياً ساكن الوسط أعجمياً إذ ذهبوا إلى صرفه .
قال سيبويه "وأما نوح وهود ولوط فتنصرف على كل حال لخفتها" الكتاب:3/35 ، 240 ، 241 وأما العلم الثلاثي الساكن الوسط المؤنث ، نحو : دَعْـد وهِـنـْد ففيه مذاهب:
- الأول : يجوز المنع والصرف ، قال أبو علي " فترك الصرف لاجتماع التأنيث والتعريف ، والصرف لأن الاسم على غاية الخفة فقاومت الخفة أحد السببين " الإيضاح العضدي : 307 ، هو رأي سيبويه والجمهور ، وقد جود سيبويه المنع ووافقه ابن جني وابن هشام والسيوطي....
- الثاني : يجب المنع ، وهو قول الزجاج ، قال : " أما ما قالوه من أنه لا ينصرف فحق صواب وأما إجازتهم صرفه .. وهذا خطأ " ما ينصرف وما لا ينصرف : 68 .
وانظر أوضح المسالك : 4/125 ، الهمع : 1/104 ، 108 ، حاشية الصبان : 3/191 .
(59)لاجتماع علتى التعريف والتأنيث .
(60)لأن الإضافة والألف واللام من خصائص الاسم فيبتعد بهما عن الأفعال .
(61)ذهب أكثر النحويين المتقدمين كسيبويه والزجاجي والفارسي وغيرهم إلى أن أقسام المعرفة خمسة ، وهي كما ذكرها المصنف ، ولكن النحويين أدخلوا الاسم الموصول تحت قسم المبهم ، أما المصنف فلم يشر للاسم الموصول في ذكره لأنواع المعارف ، وكأنه بذلك يتبع ابن بابشاذ الذي جعل المعارف خمسة ليس منها الاسم الموصول.
وقيل: المعارف ستة ، وقيل: سبعة على خلاف.
وقد أغفل المصنف المنادى ، لأن النكرة المقصودة تتعرف بالنداء ، فهي إذاً من أنواع المعارف.
انظر الكتاب : 2/5 ، الجمل : 178 ، الإيضاح العضدي : 289 ، شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ 1/170 ، شرح التسهيل : 1/115 ، 116 ، الهمع:1/190 .
(62)أعطى المصنف تقسيماً للعلم بحسب معناه ، وأضاف النحاة لهذا التقسيم : اللقب ، وهو ما أشعر بمدح أو ذم وللعلم تقسيمات كثيرة بثها النحاة في مؤلفاتهم.
انظر شرح ابن عقيل : 1/119 ، والهمع : 1/245
(63)ما بين المعكوفين زيادة من (ب) يقتضيها السياق .
(64)في (أ) : (شُـمَيْسَة ، أريضة ، دويرة) بدون واو.
(65)انظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري: 1/213 ، اللسان: (أرض) (شمس).
(66)والثدي ، والمنكِب ، والكُوع ، والشفر(حرف الجفن) ، والحِجَاج(العظم المشرف على غار العين) ، والمأق(طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع من العين)….وغير ذلك.
انظر المذكر والمؤنث 1/: 335 ـ 343 .
(67)هناك من الأعضاء ما ليس له ثان ، ومــع ذلك هو مؤنث ، نحو الكـَبـِد ، والكـَــِرش انظر: المذكر والمؤنث 1/: 348 ، 381 .
(68)العِذار : الشعر النابت على جانبي اللحية . اللسان (عذر) .
(69)انظر حالات جواز إلحاق التاء للفعل مع الفاعل المؤنث وغيره بالتفصيل في شرح ابن عقيل 1/477 ـ 483 .
(70)في حد الفاعل عند المؤلف أمران:
الأول: أنه اكتفى بالقول أنه الاسم المسند إليه الفعل دون ذكر المشتقات الأخرى ، لأن الفعل هو الأصل ، والمشتقات فرع عنه بدليل أنها عملت لمشابهتها له.
الثاني: أنه سار على مذهب البصرييـن في منع تقديم الفاعل على الفعل.
انظر: الكتاب: 1/33 ، وشرح المفصل: 1/74 ، وشرح الجمل: 1/157 ، الارتشاف: 179 ، الهمـع: 2/253.
(71)القمر ، الآية : 41 .
(72)يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف اللبس ، وذلك إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة يتبين أحدهما من الآخر ، هذا موضع من مواضع الوجوب مثل له المصنف .
وانظر المواضع الأخرى بالتفصيل في شرح ابن عقيل : 1/487 ـ 489 .
(73)المائدة من الآية : 23 .
(74)المؤمنون ، الآية : 1 .
(75)الأنبياء ، من الآية : 3 .
(76)أخذ المصنف بوجه الرفع لقوله ( الذين ) من الآية ، على أنه مبتدأ مؤخر ، والجملة قبله خبر مقدم ، وقد عزى هذا التوجيه للكسائي ، وفي رفعه وجوه أخرى ، وجاز فيه النصب والجر .
انظر هذه الوجوه بالتفصيل في : البيان : 2/158 ، شرح التسهيل : 2/116، البحر: 6/297 ، الدر المصــــون : 8/132
(77)في (أ) و (ب) : (متعدي) ، والصحيح ما أثبت .
(78)الفجر ، من الآية : 23 .
(79)في العبارة اضطراب ، وتوجيهه من أحد وجهين :
الأول
: لعلة اضطراب في النسخ ، وعبارة المصنف في الأصل : " وقائم رفع
بالابتداء"
وعليه يكون قد سار على مذهب الأخفش والزمخشري وابن يعيش في أن العامل في المبتدأ
والخبر الابتداء .
الثاني : أن المؤلف بعبارته لا يريد العامل في المبتدأ والخبر ، إنما مراده ، الموضع الإعرابي لـ (زيد) و (قائم) .
انظر : شرح المفصل : 1/85 ، الارتشاف : 2/28 ، الهمع : 2/8 .
(80)النور ، من الآية : 1 .
(81)ما بين القوسين سقط من (ب) .
(82)يوسف ، من الآية : 18 ومواضع أخرى .
(1) بهذين الشاهدين القرآنيين جمع المصنف بين حذف المبتدأ جوازاً ـ كما في الشاهد الأول ـ لوجود دليل يدل عليه وبين حذفه وجوباً ـ كما في الثاني ـ لكون الخبر مصدراً نائباً مناب الفعل
انظر هذه المواضع بالتفصيل في : شرح قطر الندى : 125 ، وشرح ابن عقيل : 1/255 .
(2) في (أ) : (وعمر) .
(3) ما بين القوسين سقط من (ب) .
(1)ذهب المصنف مذهب الكوفيين في أن المبتدأ مرفوع بالخبر ، أو بالراجع إليه من جملة الخبر ، وذهب البصريون إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء.
ويجوز في (زيد) من زيد ضربته...الرفع والنصب ، والمختار الرفع انظر الإنصاف: 1/ 49 .
انظر: الإنصاف:1/549 ، وشرح المفصل:2/32 ، شرح ابن عقيل:1/528 ، الهمع:5/157.
(1) النور ، من الآية : 1
(2) النازعات ، من الآية : 27 .
(3) في (أ) : ( ونحوها) .
(4) وهو رأي البصريين ، وذهب الكوفيون إلى إلغاء شبه (ما) بـ (ليس) .
انظر المسألة بالتفصيل في الإنصاف : 1/165 .
(5) يوسف ، من الآية : 31
(6) المجادلة ، من الآية : 2
(7) أجاز يونس والشلوبين النصب مع (إلا) مطلقاً .
وقد اقتصر المصنف على ذكر شرط واحد لإعمال (ما) عمل (ليس) ، واشترط النحاة لإعمالها هذا العمل أربعة شروط وبعضهم ستة .
انظر شرح المقدمة المحسبة لابن با بشاذ:2/324 ، ابن عقيل:1/303 ، الهمع:2/110.
(8) القمر ، من الآية : 50
(9) في (أ) : (لما) ، وفي (ب) : (أيما) ، ولعل ما أثبته هو المراد ، اعتماداً على ما سيرد لاحقاً .
(10) لم يرد خلاف بين النحاة ـ فيما بين يدي من مصادر ـ في إعمال هذه الحروف والظروف عدا (لولا) فقد اشتهر الخلاف في العامل في الاسم المرفوع بعدها ، فذهب البصريون إلى أنه مرفوع بالابتداء وذهب الكوفيون إلى أنه مرفوع بـــ (لولا) .
انظر الخلاف مفصلاً في الإنصاف : 1/70 .
(11) في (أ) : (عمر) .
(12) يبطل عمل (إن) وأخواتها بدخول (ما) عليها وتصبح حروف ابتداء عدا (ليت) فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال والإعمال أحسن .
انظر شرح المفصل: 8/54 ، 58 ، الجنى الداني : 380 ، والهمع : 2/189 .
(13) التوبة ، من الآية : 60 .
(14) الذاريات ، من الآية : 12 .
(15) في (ب): ( رأيت زيداً حيث ……) .
(16) البقرة ، من الآية : 125 .
(17) الليل ، الآية: 1.
(18) النصر ، من الآية: 1. قال المصنف: والمعنى: إذا جيء ، والصواب ما أثبت ، لأنه يريد الاستقبال.
(19) الأنفال ، من الآية : 49 .
(20) (إذا) للاستقبال لا تخرج عنه ، و(إذ) للمضي هو رأي الجمهور ، وذهب جماعة منهـم ابن مالك إلى أن (إذا) تخرج عن الاستقبال للمضي ، و(إذ) تخرج للاستقبال ، وكان رد الجمهور على حجج من أخرج (إذ) للاستقبال أنها من تنـزيل المستقبل الواجب الوقوع منـزلة ما وقع .
انظر : المغني : 129 ، 113 ، الهمع : 3/179 ، 172 .
(21) وافق المصنف البصريين في أن هذه الحروف عملت فيما بعدها الرفع والنصب لشبهها بالأفعال ، وقد فصل النحاة في وجوه هذا الشبه .
وذهب الكوفيون إلى أنها تعمل في الاسم النصب ولم تعمل في الخبر الرفع ، بل هو مرفوع على حاله .
انظر شرح المفصل : 1/102 ، شرح الجمل : 1/422 ، شرح التسهيل : 2/5 ، 8 .
(22) اختلف النحاة في (كأن) أبسيطة هي أم مركبة ؟ فذهب قلة من النحاة منهم أبو حيان ـ إلى أنها بسيطة لا تركيب فيها ، وقال بتركيبها أكثر النحويين ، منهم الخليل وسيبويه والأخفش وجمهور البصريين ، والفراء وغيرهم .
انظر: الكتاب : 2/171 ، شرح الكافية : 2/360 ، الجنى الداني : 581 ، المغني : 252 ، الهمع : 2/148 ، 151 152 .
(23) في (أ) : إن في الدار زيداً ذاهب ، وعليه يكون المتقدم معمول الخبر وليس الخبر .
(24) التوبة ، من الآية: 3.
(25) ما بين المعكوفين سقط من النسختيــن ، والعبارة مرادة بدليل وجودها في التقديـر.
(26) يقصد بالمرفوع في هذه الأمثلة : فاعل (نعم) ، و (بئس) إذا كان ظاهراً معرفاً بـ(أل) أو مضافاً إلى ما فيه (أل) أو كان ضميراً مستتراً .
انظر : الجمل 1/600 ، الهمع : 5/29 ، 33 .
(27) الكهف ، من الآية : 5 ، وهي شاهد على حذف المخصوص بالذم ، و(كلمة) منصوبة على التمييز مفسرة لهذا المحذوف ، والتقدير : كبرت الكلمة كلمة ..
انظر : البحر : 6/97 ، والدر المصون : 7/440 .
(28) وهو قول سيبويه .
انظر الكتاب : 2/180 ، شرح التسهيل : 3/23 ، اللسان (حبب) .
(29) النساء ، من الآية : 84 .
(30) مريم ، من الآية : 90 .
(31) جزء من حديث ، نصه كاملاً:(كادت النميمة أن تكون سحراً ، وكاد الفقرأن يكون كفراً). قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله r ).
وقال المباركفوري: ضعيف جـداً.
وقد أخرجه العُقيلي وابن الجوزي والشهاب القضاعي.
انظر الضعفاء للعُقيلي:4/206 ، والعلل المتناهية لابن الجوزي:2/805 ، مسند الشهاب القضاعي:1/342 ، وتحفة الأجوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري:7 /17 ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني:4/377.
(32) يوسف ، من الآية : 66 .
(33) الرعد ، من الآيتين : 23 ، 24 .
وانظر توجيه الآيتين في شرح الجمل : 2/464 ، الدر المصون : 7/44 .
(34) سقطت من (ب) .
(35) سقطت من (ب) .
(36) اقتصر المصنف هنا على أفعال القلوب التي تدل على اليقين وعلى الرجحان ، وهو ما مثل به عليها ، ولم يشر لأفعال التحويل مثل : صير ، وجعل ـ التي بمعنى صير ـ واتخذ .. وغيرها من الأفعال التي تنصب مفعولين .
(37) ما بين القوسين سقط من (ب) .
(38) البقرة ، من الآية : 19 .
(39) في (أ): (فتكون لام السبب مقدراً) ، وفي (ب): (فيكون لام السبب مقدرة) وما أثبته هو الصحيح .
(40)
قيل : سمي مفعولاً مطلقاً لدلالته على زمان مطلق بخلاف الفعل الذي يدل على زمان
معين
ومقيد ، وقيل : سمي كذلك لعدم تقييده بحرف كالمفعول به ، وله ، وفيه ، ومعه .
انظر : الأصول : 1/137 ، الإنصاف : 1/237 ، شرح الكافية : 2/192 ، الهمع : 3/94 .
(41) ذهب المصنف مذهب البصريين في أن المصدر أصل الاشتقاق ، وخالف الكوفيين الذين ذهبوا إلى أن الأصل الفعل .
انظر المسألة بالتفصيل في الإنصاف : 1/235 .
(42) في (أ) : (يصدر .. ويذره) .
(43) سقطت من (ب) .
(44) العَزَب : الذي لا أهل له ، اللسان (عزب) .
(45) الحَزْن : ما غلظ من الأرض وكان وعراً ، وهو ضد السهل ، اللسان (حزن) .
(46) قال ابن الجوزي عن هذا الحديث وأحاديث أخرى: (وهذه الأحاديث ليس فيها ما يثبت عن رسول الله r ).
وأخرجه الحارث، والبزار ، والطبراني ، والحاكم ، والشهاب القضاعي.
الغِبّ : الزيارة يوماً بعد يوم ، وقيل : بعد يومين ، وقيل : كل أسبوع ، اللسان (غبب) وهو مثل يضرب في تكرر الزيارة وكثرتها فتؤدي إلى البغضاء والخصام ، وأول من قـال به: معـاذ بن صِـْرم الخُـزاعي ، وهـو فارس خزاعة .
انظر العلل المتناهية:2/739ـ743 ، وانظر مسند الحارث للحارث بن أبي أسامة:2/863 ، مسند البزار:9/381 المعجم الكبير للطبراني:4/21 ، المستدرك على الصحيحين للحافـظ أبي عبد الله النيسابوري: 3/390 ، مسند الشهاب القضاعي: 1/366 ، وانظر المثل في مجمع الأمثال : 1/408 .
(47) في (أ) : ( وما في معناه ) .
(48) في (أ) : (خلف) ، وأثبتها (نحو) استناداً لما تقدم في النسختين .
(49) هود ، من الآية : 72 ، وقد سقطت الواو من النسختين .
(50) البقرة ، من الآية : 91 .
(51) هود ، من الآية : 77 .
(52) الكهف ، من الآية : 34 .
(53) آل عمران ، من الآية : 91 .
(54) مثنى ، مفرده قفيز ، وهو نوع من المكاييل ، اللسان (قفز) .
(55) مثنى ، مفرده ( منا) وهو نوع من الموازين ، اللسان (مني) .
(56) في (أ) : (عند) .
(57) يوسف ، من الآية : 4 .
(58) النساء ، من الآية : 45 .
(59) الفرقان ، من الآية : 31 .
(60) البقرة ، من الآية : 249 .
(61) أضاف النحاة أدوات أخر ، نحو : ليس ، ولا يكون ، وعند بعضهم : بيد ، ولا سيما.
انظر ذلك في شرح المفصل : 2/77 ، 78 ، 83 ـ 85 ، شرح الجمل : 2/248،249 الهمع: 3/282 ـ 291 .
(62) في (أ) (مجرور) بالرفع .
(63) هذا على رأي سيبويه وجمهور البصريين ، وحكى الكوفيون والأخفش : (آ) بالمد حرف من حروف النداء ، وحكى الكوفيون أيضاً (آي) بالمد والسكون ، وأجاز بعض النحويين أن ينادى بـ (وا) في غير المندوب .
انظر : الجنى : 249 ، 346 ، 398 ، المغني : 29 ، 482 ، الهمع : 3/36 .
(64) يريد أن المنادي يكون منصوباً إذا كان نكره غير مقصورة أو شبيهاً بالمضاف أو مضافاً على حسب تمثيله .
(65) آل عمران ، من الآية : 64 ومواضع أخرى .
(66) يريد: يبنى على ما يرفع به ، ففي حال الإفراد وجمع التكسير وجمع المؤنث يبنى على الضم ، والضم هو الأصل وغير الضم نائب عنه ، وفي التـثنية يبنى على الألف……. وهكذا.
(67) سقطت من (ب) .
(68) في (ب) : (قال) .
(69) عبد الله بن مسعود بن غافل ، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي ، أحد السابقين إلى الإسلام ، صحابي جليل عرض القرآن على النبي r ، كان إماماً في القرآن وترتيله وتحقيقه (ت:32هـ) .
انظر: الإصابة : 4/198 ، طبقات القراء : 1/458 .
(70) الزخرف ، من الآية : 77 .
قرأ الجمهور الآيـة : (يَا مَالِكُ) ، وقرأ علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن وثاب والأعمش: (يامال) على لغة من ينتظر الحرف، وقرأها أبو السرار الغنوي (يامالُ) بالبناء على الضم.
انظر: المحتسب : 2/257 ، الكشاف : 3/496 ، والبحر : 8/28 .
(71) في (أ) و(ب) : (يريدوا) والصواب ما أثبت .
(72) في (أ) و (ب) : (قوله) ، ولعل الصواب ما أثبت .
(73) في (أ) : ( يا فطم ) .
(74) يرخم العلم إذا كان زائداً على ثلاثة أحرف غير مختوم بتاء بحذف الحرف الأخير منه ، كما في مالك وحارث وجعفر ، وإذا كان مفرداً مختوماً بناء التأنيث فإنه يرخم بنفس الطريقة دون اشتراط في عدد الأحرف أو العلمية كما مثل المصنف : طلحة وفاطمة وغيرها .
ويرخم المنادى بحذف حرفين من آخره إذا كان ما قبل الأخير حرفاً ساكناً زائداً معتلاً وسبق بثلاثة أحرف فما فوقها نحو : منديل ومروان .
انظر شرح التسهيل : 3/421 ، أوضح المسالك : 4/581 .
(75) صرح المصنف لإعمال (لا) النافية للجنس عمل (إن) بشرط واحد ، وهو عدم وجود الفاصل بينها وبين اسمها ويفهم الشرطان الآخران ـ وهما الدلالة على نفي الجنس ، وكون معموليها نكرتين ـ من كلامه ومن أمثلته وشواهده وأضاف النحاة شروطاً أخرى لإعمالها نحو : عدم تكرارها .
انظر : الارتشاف : 2/164 .
(76) الصافات ، من الآية : 47 .
(77) سقط هذا النوع بكامله من النسخة (ب) ، فأتت المنصوبات في هذه النسخة أربعة عشر نوعاً فقط .
(78) المائدة من الآية : 105 ، والمعنى : احفظوا أو الزموا أنفسكم .
انظر الإملاء لأبي البقاء العكبري : 1/228 ، والدر المصون : 4/451 .
(79) تكررت ( دونك ) في (أ) .
اكتفى المصنف في التمثيل للإغراء بوجه واحد وهو : أسماء الأفعال ؛ عليك بمعنى الزم ، ودونك بمعنى خذ ، ولم يشر للإغراء بالتكرار أوالعطف ، نحو :أخاك أخاك ، وأخاك والإحسان إليه .
انظر : أوضح المسالك : 4/79 ، 85 ، شرح ابن عقيل : 2/301 ، 303 ، الهمع : 3/28 .
(80) هذا المثال مأخوذ من قول جرير :
خَلِّ الطـَّريْقَ لِمَنْ يَبْنِيْ المَنَارَ بـِهِ وَابْرُزْ بـِبَرْزَةَ حَيْثُ اضْطـَرَّكَ القـَدَرُ
ديوان جرير : 219 وانظر شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي : 1/223 ، الأمالي الشجرية : 2/97 ، شرح المفصل : 2/30 ، اللسان : (برز) .
(81) الشمس ، من الآية : 13 .
(82) نصه كاملاً: " إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَن . فقيل : وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَن ؟ قال :المَرْأة ُ الحَسْـنَاءُ فِيْ المَنْـبَتِ السُّوْءِ "
وهو ضعيف جداً ، قيل: كذ َّبه الإمام أحمد والنسائي وابن المديني وغيرهم. وأخرجه الشهاب.
ونسب إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ موقوفاً ، وذكر في كتب الأمثال ، انظر مسند الشهاب القضاعي:2/96 ، مجمع الأمثال: 1/64 ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني: 1/272 ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 1/69 .
وباستشهاد المصنف بهذا الحديث يكون قد مثل واستشهد لأسلوب التحذير بطرقه الثلاث وهي: إياك ، والتكرار ، والعطف
انظر : شرح المفصل : 2/25 ، الدر المصون : 11/24 ، أوضح المسالك : 4/76.
(83) البقرة ، من الآية : 135 .
(84) الأنبياء ، من الآية : 76 .
(85) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث واثلة بن الأسقع.... سمعت رسول الله r يقول: "إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر".
وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث جندب بن سفيان قال: قال رسول الله r : "ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر".
وورد في كتب النحو على أنه قول من أقوال العرب ، ونصه عند سيبويه: "الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر".
انظر: الكتاب: 1/ 258 ، المعجم الكبير: 2/171 ، المعجم الأوسط: 8/44 ، 56.
وقد ورد القول في نسخة ب: إن خيراً فجزاؤه خير.
(86) ما بين القوسين سقط من ب .
(87) النساء ، من الآية : 171 .
(88) في (ب) : ( أي يكون خيراً ) .
(89) للنحاة في توجيه آيتي البقرة والنساء السابقتي الذكر خلاف كبير :
ففي آية البقرة وافق المصنف الخليل وسيبويه والفراء والأخفش ومكي في أن النصب بفعل مضمر ، وقيل إضماره جوازاً قال الخليل : " وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر " الكتاب : 1/283 .
وأجاز آخرون أن يكون التقدير : بل نكون أهل ملة ، ورده بعضهم .
وفي آية النساء نجد للمصنف توجيهاً آخر يوافق فيه الكسائي وأبا عبيدة في نصب (خيراً) بإضمار (كان) .
ويذهب الخليل وسيبويه والزمخشري والسمين إلى نصبه على أنه مفعول به لفعل مضمر وجوباً ، وفي الآيتين توجيهات أخرى لا مجال لذكرها هنا .
انظر الكتاب: 1/257 ، 282 ، معاني القرآن للفراء: 1/72 ، 295 ، مجاز القرآن: 1/57، 143 ، معاني القــــرآن للأخفش : 1/150 ، مشكل إعراب القرآن : 1/73 ، 214 ، الكشاف: 1/314 ، 584 ، والدر المصون : 2/135 ، 4/164 .
(90) يريد بها ( أنْ ) المصدرية الناصبة للفعل المضارع وأخواتها : لن ، إذن ، كي .
و(أن) المخففة من ( أنَّ ) لا تنصب المضارع إلا إذا تلت (ظن) على الأرجح .
انظر أوضح المسالك : 4/157 ، الهمع : 4/89 .
(91) البقرة ، من الآية : 143 .
(92) الشطر الثاني من البيت لم يرد في (أ) .
وقد اختلف في نسبـة البيت ، نسبه جماعة لأبي الأسود الدؤلي ، وهو في ديوانه:165 ، ونسبـه سيبـويه في الكتـاب: 1/42 ، وابن يعيش في شـرح المفصل: 7/4 للأخطل ، وليس في ديوانه ، ونسبه السيرافي في شرح أبيات الكتاب: 2/188 لحسان بن ثابت ، وليس في ديوانه ، ونسبه النحاس في شرح أبيات سيبويه : 161 للأعشى ، وليس في ديوانه ، ونسبه الآمدي في المؤتلف والمختلف: 173، والمرزباني في معجم الشعراء : 410 للمتوكل الكناني الليثي ، وهو في الأبيات المنســوبة إليه في شعره : 81 ، 284 ، ونسب لسابق البربري : وهو في شعره: 121 ، ونسب في الخزانة 3/618 للطرماح ، وليس في ديوانه .
(93) آل عمران ، من الآية : 128 .
ما بين القوسين سقط من (ب) .
(94) طه ، من الآية : 81 .
والواو التي في بداية الآية سقطت من (أ) .
(95) النساء ، من الآية : 73 .
(96) فاطر ، من الآية : 36 .
(97) ذهب المصنف مذهب البصريين في أن المضارع منصوب بـ (أن) المضمرة وجوباً بعد لام الجحود ، وواو المعية وأو ، وفاء السببية ، وحتى ، إلا أن الأخير لم يشر له المصنف .
وذهب الكوفيون إلى أن المضارع منصوب بلام الجحود نفسها وحتى ، ومنصوب على الصرف بعد واو المعية . وعلى الخلاف بعد فاء السببية .
وفي
المسألة آراء أخرى ، انظر الخلاف مفصلاً في : الإنصاف : 2/555 ، 557 ، 575 ، 579 ،
593 ، 597 أوضح المسالك4/157 ، 170 ، 174 ، 177 ، 191 ، الهمع: 4/89 ،
108 ، 111 ، 116 ، 130 ، 136 .
(98) في ب : من البصرة إلى الكوفة .
(99) وذلك عند الكوفيين وجماعة من البصريين ، إذا ضممت شيئاً إلى شيء آخر مما لم يكن معه نحو قوله تعالى: "من أنصاري إلى الله" آل عمران 52. انظر: ارتشاف الضرب: 2/450 ، مغني اللبيب: 1/75.
قال الفراء في هذه الآية " المفسرون يقولون : من أنصاري مع الله ، وهو وجه حسن" معاني القرآن : 1/218 .
(100) وقد ذكر النحويون لـ (عن) في هذا المثال معنى آخر غير ما ذكر ، وهو الاستعانة ؛ لأنهم يقولون رميت بالقوس .الأزهية : 279 ، المغني : 1/147 ، 149 .
(101) زيادة يقتضيها السياق .
(102) في ب : ومأكول رأسها .
(103) أيد المصنف ما ذهب إليه أكثر النحاة من أنها لا تكون إلا للتقليل فقط ، وانظر الآراء الأخرى في: ارتشاف الضرب : 2/455 ، المغني: 1/134.
(104) انظر شرح المفصل لابن يعيش : 8/10 ، 14 ، 15 ، 41 ، 44 .
(105) سقط من أ ، زيادة يقتضيها السياق من (ب) .
(106) سورة طه ، من الآية (71) .
(107) تكون (في) بمعنى (على) عند الكوفيين ، أما البصريون فيقولون أن (في) على بابها ، لأنه إنما يصلب في عراضها لا عليها . معاني الحروف للرماني : 96 .
قال أبو حيان في هذه الآية : " لما كان الجذع مقراً للمصلوب واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف عدى الفعل بـ ( في ) التي للوعاء ، وقيل نقر فرعون الخشب وصلبهم في داخله ، فصار ظرفاً لهم حقيقة حتى يموتوا جوعاً وعطشاً " البحر المحيط: 6/261 . وقال ابن يعيش : " لما كان الصلب بمعنى الاستقرار والتمكن عدى بفي كما يعدى الاستقرار " . شرح المفصل : 8/21 ، وانظر : فتح القدير للشوكاني:3/376 .
(108) في ب : فأصلها .
(109) هذا مذهب الجمهور ، انظر: رصف المباني: 387 ، الجنى الداني: 304- 305 ، المغني: 1/336.
وذهب ابن ملكون إلى أن (مذ) أصل ؛ لأنه لا يتصرف في الحرف أو شبهه .
(110) ب : ومذ .
(111) سورة الشورى ، من الآية: 11 .
الكاف في هذه الآية زائدة عند أكثر العلماء ، لتوكيد نفي المثل ، انظر الآراء المختلفة في الكاف في: معاني الحروف للرماني: 48-49 ، سر صناعة الإعراب: 1/291 ، رصف المباني: 278 ، الجنى الداني: 87-90 ، المغني: 1/179.
(112) سورة الإسراء ، من الآية : 78 .
ذكر النحاة أن اللام في الآية الكريمة بمعنـــى (بعد) ، وأن اللام التــي بمعنى (عند) جاءت في نحو قولـه تعالى : " بل كذبوا بالحق لما جاءهم " ص (5) . انظر الأزهية : 289 ، الجنى الداني : 101 ، ارتشاف الضــرب : 2/434 المغني : 1/213
وفي تفسير القرطبي ما يشير إلى أنها بمعنى (عند) حيث قال : " ... فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده .. " الجامع لأحكام القرآن الكريم : 1/197 .
وقيل : اللام للسببية ؛ لأنها إنما تجب بزوال الشمس فيجب على المصلي إقامتها لأجل دلوك الشمس ، تفسير النهر الماد من البحر المحيط : 6/69 .
وجاء في فتح القدير : 3/250 " .. والمعنى : أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل .. " فتكون اللام بمعنى (من) .
(113) لهذا اقتصر عليه سيبويه. الكتاب: 4/217 ، وانظر: الجني الداني: 36 ، المغني: 1/101.
(114) الباء في هذا المثال للاستعانة ، وهي الداخلة على آلة الفعل .
انظر: ســر الصنـاعة:1/23 ، رصـف المبـانـي:221 ، الجنــى الدانــي:38 ، المغني:1/103.
(115) الإلصاق في هذا المثال مجازي ؛ إذ المراد : ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد .
انظر المصادر السابقة .
(116) سورة المائدة ، من الآية : 61 .
(117) لم يذكر المصنف من حروف الجر ما ذكره بعض النحاة وهي (كي) ، (متى) في لغة هذيــل ، و(لعل) في لغة عقيل ، و(لولا) في بعض استعمالاتها ، انظر: أوضح المسالك: 3/6-13 شرح ابن عـقيل : 2/3-9 وانظر : باب المنصوبات ـ النوع التاسع.
(118) ب: كـقـوله.
(119) سورة العصر ، الآيتان: 1- 2.
(120) سورة الأنبياء ، من الآية: 57 .
(121)
ذهب البصريون إلى أن (ايمن) اسم مفرد مشتق من اليمن والبركة ، وهمزته همزة وصل
مفتوحة ، وذهب الكوفيون إلى أنه جمع يمين وهمزته همزة قطع. الإنصاف: 1/44 ،
الأزهية:
20-21 ، شرح المفصل: 8/35- 36 ، رصف المباني:133 ، الجنى الداني: 133.
(122) تصرف العرب في (أيمن) بأنواع التخفيف لكثرة استعمالهم لها ، وهذه لغة من لغاتهم العشرين ، وهي حذف النون وفتح الهمزة أو كسرها . شرح المفصل : 8/36 ، ارتشاف الضرب : 2/481 ، الجنى الداني : 541 .
(123) سورة العصر الآيتان : 1-2 .
(124) سورة الحجر ، من الآية : 92 .
(125) سورة النجم ، الآية : 1 ومن الآية : 2 .
(126) سورة الشعراء الآية : 97 .
(127) سورة النحل ، من الآية : 38 .
(128) سورة الشمس ، الآية : 1 ، ومن الآية : 9 .
(129) سورة ق الآية : 1 ، ومن الآية : 2 .
(130) سورة ص الآية : 1 .
(131) سورة النازعات، الآية: 1. وقد اختلف النحويون في جواب القسم في هذه الآيات فمنهم من أظهره ومنهم من قدره بتقديرات مختلفة منها التقدير المذكور في المتن وهو (لتبعثن).
انظر: إعراب القرآن للنحاس: 4/219 ، 5/141 ، التبيان: 2/1096 ، 1173 ، 1269 ، الفريد: 4/149 ، 343 417 .
(132) ب : المخفوضة .
(133) انظر شرح المفصل : 2/126 - 127 .
(134) المصدر السابق : 2/128 - 129 .
(135) ب : مقدما .
(136) ب : وتريد .
(137) أضاف بعض النحاة نوعاً ثالثاً من أنواع الإضافة ، وهي أن تكون بمعنى (في) .
انظر شرح الكافية : 1/272 ، الهمع : 4/267 .
قال ابن مالك : " وقد أغفل النحويـون التي بمعنى (في) ، وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح .. " شرح التسهيل : 3/221 .
وقد ذكر ابن الحاجب في كافيته: 121 ، أن تقدير (في) أقل من اللام أو من .
وإنما كان جر المضاف إليه بهذه الأحرف المقدرة وليس بالمضاف كما ذكر بعض النحاة ، لأن كل واحـد من المضاف والمضاف إليه اسم ليس له أن يعمل في الآخر ، وحسن حذف هذه الأحرف لنيابة المضاف إليه عنها وصيرورته عوضاً عنها في اللفظ. شرح المفصل:2/117 ، الهمع: 4/265 . وهذا النوع من الإضافة يسمى الإضافة المعنوية أو المحضة وهي التي تفيد التعريف أو التخصيص .
انظر : الأصول : 2/5-6 ، الخصائص : 3/26 ، شرح المفصل : 2/118 .
(138) سورة ، الحج من الآية : 35 .
وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإضافة ، وتسمى إضافة لفظية أو غير محضة ، وهي التي تفيد التخفيف في اللفظ بحذف التنوين . انظر : الأصول : 2/6 ، شرح المفصل: 2/119 ، الهمع : 4/269 .
(139) أجاز المصنف هنا إضافة الصفة إلى الموصوف بقلة مؤيداً في ذلك مذهب الكوفيين وجماعة من النحاة الذين أجازوا هذه الإضافة من غير تأويل بشرط اختلاف اللفظين ، أما جمهور البصريين فقد ذهبوا إلى أن ما ورد عن العرب من ألفاظ ظاهرها من إضافة الموصوف إلى صفته فهي على تأويل أنها صفة لموصوف محذوف ؛ لأن الصفة والموصوف شيء واحد ، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز .
انظر : شرح المفصل : 3/10 ـ 11 ، ارتشاف الضرب : 2/506 ، الهمع : 4/276 .
وقد
سمى ابن مالك هذا النوع من الإضافة (شبيهة بالمحضة ) ، فالإضافة عنده على ثلاثة
أنواع .
انظر : شرح التسهيل : 3/225 ، 229 ، الهمع : 4/277 .
وقال أبو حيان : " ولا أعلم له سلفاً في ذلك " . ارتشاف الضرب : 2/505 .
كما ذهب أبو حيان إلى أن هذا النوع من الإضافة لا يتعدى السماع بل يحفظ ولا يقاس عليه . المصدر الســــابق : 2/506 ، وانظر : الهمع : 4/277 .
(140) ب : قال .
(141) سورة التوبة ، من الآية : 36 ، ومواضع أخرى ، في الأصل (وذلك) . والصواب ما أثبت كما جاء في المصحف وهنا لم يضف الموصوف إلى صفته .
(142) سورة التكاثر من الآية : 5 .
لم يذكر المصنف من أنواع الجر ، الجر بالتبعية والمجاورة .
وما ذكر ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته ، والتأويل فيها على غير ذلك ؛ إذ إن الصفة فيها لموصوف محذوف. انظر شرح المفصل : 3/10 .
(143) سورة التوبة ، الآية : 108 .
(144) سورة الحجرات من الآية : 11 .
(145) سورة الطلاق من الآية : 7 .
(146) وذلك بعد الواو والفاء باتفاق بين النحاة ، لشدة اتصالهما بما بعدهما لكونهما على حرف ، وبعد (ثم) على خلاف بينهم لانفصالها عما يليها . انظر : المقتضب : 2/133 ـ 134 ، شرح التسهيل : 4/58 ـ 59 ، الارتشاف 2/541 الهمع: 4/307 ـ 308 .
(147) سورة البقرة ، من الآيتين : 282 ، 283 .
(148) صحح مذهب البصريين القائل إن فعل الأمر للمواجه المعرى عن حرف المضارعة يكون مبنياً ، في حين ذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم . الإنصاف : 2/524 ، وانظر : شرح التسهيل : 4/61 .
(149) ب : جاء .
(150) سورة يونس ، من الآية : 58 .
(151) قرأ عثمان بن عفان وأبي وأنس والحسن ... بالتاء على الخطاب ، ورويت عن النبي r ، وهي لغة لبعض العرب .
وقرأ الحسن بكسر اللام من (لتفرحوا) ، وسكنها بقية القراء .
انظر : البحر المحيط : 5/172 ، النشر في القراءات العشر : 2/285 ، إتحــــاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : 252 .
(152) سورة الأنفال من الآية : 29 .
(153) ب : ولا .
(154) لعل المراد بقوله: (جاز فيهما ترك الجزم) ترك الجزم للفظهما لا محلهما بدليل عطف المضارع على محلهما بالجزم ، ومعلوم أن الشرط والجزاء إذا كانا ماضيين فلا جزم لهما لفظاً لأن الجزم مختص بالمضارع ، والضمير في قولـه: (جاز فيه) يعود على المستقبل ، لأنه هو الذي يجوز فيه الجزم وتركه لفظاً ، انظر: الكـتاب:3/66 ، 70- 71 ، المقتضب:2/68-70 ، شرح التسهيل: 4/77- 78 ، الارتشاف: 2/556 ، الهمع: 4/330.
(155) وذلك في جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض ، إذا لم يقصد الجواب والجزاء ، والرفع على ثلاثة أشياء ؛ الصفة ، والحال ، والقطع والاستئناف .
شرح المفصل : 7/50-51 .
(156) سورة المائدة : من الآية : 114 .
وقد
قرأها ابن مسعود (تكن) ، والأعمش (يكن) بالجزم علىجواب الطلب . معاني القرآن
1/325 ، مختصر شواذ ابن خالويه: 36 ،
الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني : 2/107.
(157) وذلك في حال الرفع .
(158) سورة مريم من الآيتين (5و6) .
قرأ أبو عمرو والكسائي من السبعة وغيرهما بجزم (يرثني ويرث) جواباً للطلب ، وعطف عليه (ويرث) ، والباقون بالرفع على الصفة وهو أقوى من الأولى ؛ لأنه سأل ولياً هذه صفته ، والجزم لا يحصل بهذا المعنى .
انظر السبعة لابن مجاهد : 407 ، إعراب القرآن للنحاس : 3/6 ، الكشف لمكي:2/84 ، التبيان للعكبري : 2/866 البحر المحيط : 6/174.
(159) ب: على قراءة رفعها .
(160) سورة النساء ، من الآية: 123.
(161) سورة البقرة ، من الآية: 106.
(162) أ : يأتيني أكرمه ، والصواب ما أثبت ، وفي ب: يأتني أكرمته.
(163) أ : وأيّا.
(164) سورة المائدة ، من الآية : 95 .
(165) سورة البقرة ، من الآية : 126 .
(166) ب : والله تعالى أعلم .
(167) انظر تفصيل هذه الأقسام الخمسة في : المقتضب : 1/26 ، المقتصد في شرح الإيضـاح: 2/901 ، الارتشاف : 2/579 ، التصريح : 2/110 .
(168) ب: رجلا .
(169) أجاز الأخفش والفارسي دخول (ال) على (كل) و(بعض) . الارتشاف : 2/515ـ516 وقد أدخلها بعض النحاة عليهما كالمبرد في المتقتضب : 1/31 ، 3/243 ، وابن درستويه . تاج العروس (بعض) . وقد استعمـلها الزجاجي في جمله : 23ـ24 ، فأدخل (ال) عليهما ثم اعتذر بأنه قالها مجازاً ، وعلى استعمال الجماعة لها مسامحة وهو في الحقيقة غير جائز . انظر : البسيط في شرح الجمل: 1/400-401 .
(170) سورة الفاتحة الآية : 6 ، ومن الآية : 7 .
(171) سورة آل عمران ، من الآية : 97 .
(172) سورة البروج ، الآية : 4 ومن الآية : 5 .
(173) أ : بجمال .
(174) ب : بحمار .
وبدل الغلط أثبته سيبويه والمبرد وغيرهما من النحاة . انظر : الكتاب : 1/439 ، 2/16 ، 341 ، 3/87 ، المقتضب : 4/297 ، المقتصد : 2/935 ، شرح المفصل : 3/66 ، الارتشاف : 2/625 ، التصريح : 2/158ـ159 ،الهمع 5/215
وأنكره قوم على الإطلاق . الهمع : 5/215 .
وجعله بعضهم من أقسام البدل المباين ، وليس قسماً برأسه. التصريح : 2/158-159.
(175) سورة الشورى من الآيتين 52 ، 53 .
(176) ذهب الكوفيون والبغداديون إلى اشتراط وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة ، أو تكون النكرة من لفظ الأول وتبعهم بعض النحاة ، كالسهيلي وابن أبي الربيع ، وأطلق الجمهور الجواز للسماع . شرح التسهيل : 3/331 ، الارتشاف : 2/620 ، الهمع : 5/218 .
(177) سورة العلق ، من الآيتين : 15-16 .
(178) ب : وأما .
(179) ب : فسبعة .
(180) انظر الكتاب: 1/377 ، 2/116 ، شرح التسهيل: 3/291 ، الارتشاف: 2/610 ، الهمع: 5/199.
(181) سورة الحجر الآية : 30 ، سورة ص الآية : 73 .
(182) البَصْع: الجمع ، ويقال : مضى بـِصْع من الليل ـ بالكسر ـ ، وأبْصع : كلمة يؤكد بها ، وبعضهم يقوله بالضاد المعجمة ، وليس بالعالي. اللسان (بصع) .
(183) أكتع: ردف لأجمع ، وقيل كأجمع ليس بردف ، وهو مأخوذ من قولهم : أتى عليه حول كتيع ، أي : تام اللسان : (كتع) .
(184) أجاز الكوفيون وابن كيسان تقديم (أكتع) عليهما ، واستعمالها وحدها دونهما ، وأجاز ابن كيسـان أيضاً أن تبدأ بأيهن شئت من هذه التوابع بعد (أجمع) .
انظر: شرح المفصل : 3/46 ، الارتشاف : 2/611 ، الهمع : 5/201 .
(185) زيادة يقتضيها السياق .
(186) البيت لأبي النجم العجلي في ديوانه: 99 .
انظر: الخصائص 3/337 ، المنصف : 1/10 ، التخمير : 1/274 ، شرح المفصل1/98 ، الهمع: 1/207.
(187) في (أ) و (ب): ثم ومـع. و(مع) ليست من حروف العطف ، وهي زائدة على الحروف العشرة التي ذكرها المصنف.
(188) وهو مذهب الجمهور ، انظر الكتاب:4/216 ، المقتضب:1/10 ، الأصول:2/55 ، وخالفهم في ذلك قطرب والربعي والفراء وثعلب وغلامه أبو عمر الزاهد ، وهشام وأبو جعفر الدينوري حيث قالوا بإفادتها للترتيب. انظر : الارتشاف : 2/633 ، الجنى الداني : 158-159 ، المغني : 2/354 ، الهمع : 5/224.
(189) في (أ) الاشتراك ، وقـد سقطت من ب .
(190) سورة الأحزاب ، الآية: 40.
(191) سقطـت مـن (أ) و (ب) ، وقـد اختـلف النحـويـون في دخـول الواو على (لكـنْ) .
انظر: نتائج الفكر للسهيلي: 257 ، الجنى الداني: 558 ، المغني: 1/293 ، الهمع: 5/263.
(192) سورة الدخان ، من الآية : 37 .
(193) سورة البقرة ، من الآية: 6 ، سورة يس من الآية: 10 ، وقد سقط موضع الشاهد (أم لم تنذرهم) من (أ).
(194) انظر: الأصول: 2/56 ، شرح المفصل : 8/101 .
(195) ب: وقال.
(196) سورة الإنسان ، من الآية: 3.
(197) سورة فصلت ، من الآية: 17.
(198) ب: الكلام.
(199) في أ ، ب: وكقوله ، والصواب ما أثبت بحذف الواو.
(200) سورة الضحى الآيتان: 10- 11.
(201) (حتى) حرف عطف عند البصريين ، أما الكوفيون فهي عندهم ليست بعاطفة ، ويعربون ما بعدها على إضمار عامل ، انظر الجنى الداني: 546 ، والباب الرابع من هذا الكـتاب.
(202) ب: والشمس .
(203) سورة الحج ، من الآية: 25.
(204) وقيل الواو عاطفة ، عطفت جملة على جملة ، وقيل هو عطف على المعنى ، والتقدير إن الكافرين والصادين عن المسجد الحرام. وقال الكوفيون: الواو زائدة ، و(يصدون) خبر (إن) ، وقيل: الخبر محذوف .
انظر : إعراب القرآن للنحاس : 3/92 ، المشكل لمكي : 2/489 ، التبيان : 2/938 ، البحر المحيط : 6/362 .
(205) سورة الملك ، من الآية : 19 .
قال أبو حيان : " ومثل هذا العطف ـ أي عطف الفعل على الاسم ـ فصيح ، وعكسه ـ عطف الاسم على الفعل ـ أيضاً جائز إلا عند السهيلي فإنه قبيح " . البحر المحيط : 8/302 .
وانظر: الارتشاف: 2/664 ـ 665، وانظر رأي السهيلي في كتابه: نتائج الفكر: 319ـ320.
(206) أ : رجلا ، والصواب ما أثبت .
(207) سورة الحاقة ، من الآية : 7 .
(208) في المخطوط من العشرة إلى الألف ، والصواب ما أثبت ؛ لأن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة هي التي تضاف إلى جمع القلة .
(209) انظر: الكتاب: 1/206 ، 3/557 ، المقتضب: 2/156 ـ 158 ، شرح المفصل: 6/19 ، 25.
(210) سقط هذا الوزن من (أ) و (ب) مع أنه قد ذُكِر مثال عليه عند التمثيل.
(211) ويجوز إضافته إلى بناء الكثير إن لم يكن له بناء قلة .
انظر المقتضب : 2/156 ، 160-161 ، شرح المفصل : 6/25 .
(212) سقطت من ب .
(213) في (أ) و (ب). وأمـا العشـرات فـمـــا فوقهــا إلى المـائة ، والصــواب مـا أثبــت ، انظر: الكتاب 1/206 ، المقـتضب : 2/161 .
(214) أ ، ب : إلى .
(215) أ : تخلف .
(216) سورة يوسف ، من الآية : 4 .
(217) سورة الأعراف ، من الآية : 160 .
والتقدير : اثنتي عشرة أمة أو فرقة أسباطاً ، فلا يكون (أسباطاً) تمييزاً ؛ لأنه جمع ، وتمييز ماعدا العشرة إنما يكون مفرداً ، وقد حذف التمييز لدلالة الحال عليه.
انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجــاج : 2/383 ، إعراب القرآن للنحاس : 2/156 ، التبيان : 1/599 ، الفريد : 2/373 .
(218) أ : بدل .
(219) انظر : المقتضب : 2/169 ، شرح المفصل : 6/20 .
(220) ب : مثل .
(221) انظر هذه الأضرب الثلاثة في : التكملة للفارسي : 398 . والجوالق والجوالق : وعاء من الأوعية ، أعجمي معرب ، والجمع جوالق وجواليق . انظر : المعرب ، 251 ، اللسان ( جلق ) .
(222) سقطت من (ب).
(223) ب: أ فعل وفعايل .
(224) أ ، ب : أكالب ، والصواب ما أثبت .
(225) سقط من ب .
(226) ب : القسم الثالث .
(227) ب : تقوم .
(228) لكل قسم من هذه الاقسام الأربعة أمثلة أخرى ، بعضهـا مطرد ، وبعضها الآخر حفــظ عــن العـرب. انظـر: التكمـلة: 399 ، شــرح الشافيـة ، 2/91 ، الارتشــــــاف:1/195 .
(229) حصر المصنف أبنية جموع الكثرة في ثمانية أقسام ، في حين ذكر العلماء أقساماً أخرى تزيد عن الثمانية ، كما ذكروا أيضاً أمثلة أخرى لكل بناء من الأبنية الثمانية غير ما ذكره المصنف . انظر المصادر السابقة .
(230) زيادة يقتضيها السياق.
(231) سورة المدثر ، الآية: 35 .
(232) ب : جدران .
(233) زيادة يقتضيها السياق .
وفي ب : كافر وكافرون وكافر وكفرة .
(234) أ ، ب : والبنية .
(235) لأن الحرف الرابع ينـزل عندهم منـزلة علم التأنيث لطول الاسم به . انظر : أسرار العربية للأنباري : 365 شرح المفصل : 5/128 .
(236) يصغر صدر المركب ؛ لأنه عندهم بمنزلة المضاف ، والآخر بمنزلة المضاف إليه ، إذ كانا شيئين . انظر الكتاب: 3/475 ، شرح الشافية للرضي : 1/273 .
(237) حق اسـم الإشارة ألا يصغر ، لغلبة شبه الحرف عليه ، ولأن أصله وهو (ذا) على حرفين ، إلا أنه لما تصرف تصرف الأسماء المتمكنة فوصف ووصف به وثني وجمع وأنث أجرى مجراها في التصغير ، وكذلك الأسماء الموصولة ؛ لأن مجراهما في الإبهام واحد .
ولما كان تصغيرهما على خلاف الأصل خولف بتصغيرهما تصغير الأسماء المتمكنة ، فلم تضم أوائلهما وزيد في الآخر ألف بدل الضمة ، بعد أن كملوا لفظ (ذا) ثلاثة أحرف بزيادة الياء على آخره ثم أدخلت ياء التصغير ثالثة بعد الألف ، وفتح ما قبلها فقلبت الألف ياء ، فاجتمع ثلاث ياءات وفيه ثقل فحذفوا الياء الأولى .
انظر : التكملة للفارسي : 505 ، شرح المفصل : 5/139 ، شرح الشافية : 1/284 .
(460)انظر : الكتاب : 3/478 ـ 481 .
ذهب الكوفيون والمازني والجرمي إلى جواز تصغير أيام الأسبوع وأسماء الشهور : شرح المفصل : 5 / 139، شرح الشافية : 1/293 .
(461)ب : أكيلب وأجيمل .
(462)جمع التكسير على ضربين ، جمع قلة وهو يصغر على لفظه .
وجمع كثرة ، وهو إما أن يكون له من لفظه جمع قلة فيرد إليه ويصغر على لفظه كتصغير كلاب يرد إلى أكلب ويصغر على أكيلب ، أو يرد جمع الكثرة إلى الواحد ، ويصغر ذلك الواحد ثم يجمع بالواو والنون إن كان لمـذكر عاقل كـ(رُجَيْلون) وبالألف والتاء إن كان لمؤنث ، أو لغير العاقل ، كـ (جُفـَيْنات) و (دُرَيْهمات).
وإن لم يكن لجمع الكثرة من لفظه جمع قلة فيرد إلى واحده ثم يصغر كالسابق .
أما جمع السلامة فيصغر على لفظه سواء كان للمذكر أم للمؤنث ، وكذلك أسماء الجموع تصغر على لفظها . وإنما لم يصغر جمع الكثرة على لفظه ؛ لأن المقصود من تصغير الجمع تقليل العدد ، وهو بناء يدل على الكثرة فلم يجز الجمع بينهما للتناقض والتضاد ، بخلاف أسماء الجموع وجمع السلامة فهـي مشتركة بين القلة والكثرة .
انظر: الكتاب: 3/490 ، التكملة: 502 ، شرح المفصل: 5/132 ، شرح الشافية: 1/266.
(327) ب : جمع .
(328)يصغران بهذه الصورة ، لأن الواو والنون فيهما عوض من اللام الذاهبة في السنة ، والتاء المقدرة في (أرض) ، فترجـــعان في التصغير فلا يبدل منهما ، ويجمعان على القياس ، وهو الجمع بالألف والتاء . انظر : الكتاب : 3/495 ، شرح الشافية : 1/271 .
(329)سقط من أ ، ب .
(330)كأنه منسوب إلى العلو ، والقياس: عالِيّ أو عالوَيّ ، شرح الشافية : 2/81 .
(331)وقياسه ( شتائي ) على لفظه ، الهمع : 6/173 .
وقيل إن (شتاء) جمع (شَـتـْوة) كـ (صِحَاف) جمع صَحْـفة ، والجمع في النسب يرد إلى واحده ، فعلى هذا يكون (شَـتـْويّ) على القياس . انظر : شرح المفصل : 6/12 ، شرح الشافية: 2/82 .
(332)ما بين القوسين سقط من ب .
(333) زادوا الألف والنون للمبالـغة للدلالة على عظمها . شرح المفصل : 6/12 ، شرح الشافية : 2/84 ، الهمع 6/174 .
(334) قال سيبويه : " ولا أراهم قالوا طائيّ إلا فراراً من طيْئي ، وكان القياس طيئي ، وتقديرها طيعيّ ، ولكنهم جعلوا الألف مكان الياء " الكتاب : 3/371 .
وذلك قصداً للتخفيف لكثرة استعمالهم إياه ، شرح الشافية : 2/32 .
(335) انظر : الكتاب : 3/337 ـ 338 .
(336) إذا كانت الألف ثالثة قلبت واواً مطلقاً عن الياء كان أصلها أو عن الواو . انظر: الكتاب : 3/342 ، التكملة : 242 .
(337) على وزن (فـَعِـيلة) ـ بفتح الفاء وكسر العين ـ ينسب إليها على (فـَعَـلي) ، بفتح العين وحذف الياء والتاء بشرط صحة العين وعدم تضعيفها . انظر : الكتاب : 3/339 ، شرح الشافية : 2/20 ، الهمع : 6/162.
(338) على وزن (فـُعَيلة) ـ بضم الفاء وفتح العين ـ ينسب إليها على (فـُـعَلي) بحذف الياء وتاء التأنيث كذلك بشرط عدم تضعيف العين فيها . انظر المصادر السابقة .
(339) ويجوز فيها أيضاً حذف الألف ، وزيادة الألف قبل الواو في حالة قلبها واواً ، نحو: دُنْييّ ، ودُنْيَويّ ، ودُنياوي وذلك لأن الألف وقعت رابعة في كلمة ثانيها حرف ساكن.
انظر: الكتاب: 3/353 ، التكملة: 242 ، شرح الشافية: 2/40 .
(340) انظر: الكتاب: 3/375 ، المقتضب: 3/141 ، التكملة: 254 ، شرح المفصل: 6/8 ، شرح الشافية: 2/75.
(341) جميع أقسام المركبات ينسب إلى صدرها نحو: حضريّ في (حضر موت ) و: بعليّ في (بعلبك). وقد يجوز أن يُشتق منهما اسم يكون فيه من حروف الاسمين ، نحو: حضرميّ ، وقد ينسب إلى المركب من غير حذف إذا خف اللفظ نحـو: بعلبكي .
انظر: الكتاب: 3/374 ، المقتضب: 3/143 ، شرح الشافية: 2/71 .
(342) ب: ترجع .
(343) ما بين القوسين سقط من ب .
(344) لأن الكسرة متوسطة بين الثقل والخفة جعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة . شرح التسهيل : 1/265 .
(345) انظر : أسرار العربية : 51 ، شرح التسهيل : 1/265 .
(346) اختلف في أصل المرفوعات ، فقيل المبتدأ والخبر هما الأصل وغيرهما من المرفوعات محمول عليهما ، ونسب إلى سيبويه وابن السراج ، وقيل الفاعل هو الأصل ونسب إلى الخليل ، وقيل كلاهما أصلان، ونسب إلى الأخفش وابن السراج واختاره الرضي.
انظر : شرح الكافية : 1/23 ، شرح المفصل : 1/73 ، الهمع : 2/3 .
(347) ب : رفع .
(348) ب : زيد .
(349) ما بين القوسين سقط من ب .
(350) ب : مثل فعل .
(351) ب : المضي .
(352) مذهب البصريين أن (إنّ) وأخواتها ترفع الخبر وتنصب الاسم ، لأنها قويت مشابهتها للفعل فعملت عمله ليكون المرفوع مشبها بالفاعل والمنصوب مشبهاً بالمفعول ، ومذهب الكوفيين أنها لا ترفع الخبر ، بل هو بـاق على رفعـه قبـل دخولهـا. الإنصــاف: 1/17 ، وانـظر الهمع : 2/155 .
لم يذكر المصنف جميع أنواع المرفوعات ، وقد سبق أن ذكرها في الباب الثاني في المرفوعات وأنواعها .
(353) ما بين القوسين سقط من ب .
(354) أي يكون منتصباً على تقدير (في). انظر: شرح المفصل: 2/41 ، الارتشاف: 2/22.
(355) وهو مذهب الجمهور ، انظر الآراء الأخرى في الهمع : 3/33 .
(356) ب: مفرداً .
(357) ب: والأسد .
(358) سورة الشمس ، من الآية: 13 .
(359) وهو جزء من بيت لجرير ، وقد سبق تخريجه .
(360) ما بين القوسين سقط من ب .
(361) ما بين القوسين سقط من ب .
(362) أ : مشابها .
(363) هذا على مذهب أكثر البصريين في أن حركة الاسم المفرد حركة بناء ، وذهب الكوفيون والجرمي والزجاج والسيرافي والرماني إلى انها فتحة إعراب ، وحذف التنوين منه تخفيفاً ، ولشبهه بالمركب . انظر أسرار العربية : 246 شرح المفصل:1/105 ـ 106 ، 2/101 ـ 104 ، شرح التسهـــيل : 2/58 ، الارتشاف : 2/164 ، مغني اللبيب : 1/238 ، الهمع : 2/199 .
(364) ب : لانتهائها .
(365) سقط من ب .
(366) سقط من ب .
(367) يوجد في حاشية المخطوط تعليق على تاريخ الفراغ من النسخة ، وهو (قف علىخطأ هذا التاريخ ) مما يدل على أن السنة المئوية قد سقطت من تاريخ النسخ .
(368) في ب …. تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد أفقر العباد وأحوجهـم إليه تعالى محمد أبو علي الشافعي مذهبا ، الشاذلي طريقة غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ، ومثل ذلك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم .
وكان الفراغ منه في غرة ربيع الأول سنة 1278من هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم.
المصادر والمراجع
(1) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ، للشيخ أحمد الدمياطي ، بيروت : دار الندوة الجديدة .
(2) ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيان ، تحقيق د. مصطفى أحمد النمـاس ، ط : القاهرة : مطبعة المدني ط 1 ، 1409هـ .
(3) الأزهية في علم الحروف ، للهروي، تحقيق: عبد المعين الملوحي ، دمشق : مطبوعات مجمع اللغة العربية 1413هـ / 1993م .
(4) أسرار أركان الإسلام ، للشعراني ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، دار التراث العربي ، ط1 : 1400هـ / 1980م
(5) أسرار العربية ، لأبـــي البركات الأنباري ، تحقيق : محمد بهجت البيطار ، دمشق : مطبعة الترقي ، 1377هـ 1957م.
(6) الأشباه والنظائر في النحو ، للسيوطي بيروت : ، ط دار الكتب العلميـة ، ط :1 ، 1405هـ .
(7) الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق وتعليق : الشيخ عادل عبد الموجود ، والشيخ علي معوض ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 1415هـ ، 1995م .
(8) الأصول في النحو لابن السراج ، تحقيق : د. عبد الحسين الفتلي ، بيروت: ط مؤسسة الرسالة ،ط: 1 ، 1405هـ
(9) إعراب القرآن ، للنحاس ، تحقيق : د. زهير غازي زاهد ، بيروت : عالم الكتب ، مكتبة النهضــة العربية 1405هـ ، 1985م .
(10) الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، ط: الثالثة .
(11) الأمالي الشجرية ، لابن الشجري ، تحقيق : د. محمود الطناحي ، القاهرة : مطبعة المدني ، ط:1 ، 1413هـ 1992م .
(12) إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء العكبري ، بيروت : دار مكتب الهلال .
(13) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، لأبي البركات الأنباري ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، ط دار إحياء التراث العربي وط : بيروت : دار الفكرالعربي .
(14) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لابن هشـام ، تحقيق : محمد محيي الـدين عبد الحميد، بيروت : طبعة دار الجيل ، ط: 5 1399هـ / 1979م . و:ط صيدا ، بيروت ، المكتبة العصرية .
(15) الإيضاح العضدي ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق د. حسن شاذلي فرهود ، ط دار العلوم ، ط : 2 ، 1408هـ.
(16) الإيضاح في علل النحو للزجاجي ، تحقيق د.مازن المبارك ، بيروت ، دار النفائس ، ط:4 ، 1402هـ:1982م.
(17) البحر المحيط ، لأبي حيان ، دار الفكر ، ط : 2 ، 1398هـ / 1978م ، : بيروت : دار الفكر ، 1403هـ 1983م .
(18) البسيـــط في شرح جمل الزجاجي ، لابن أبي الربيع ، تحقيق : د. عياد الثبيتي ، بيروت ط دار الغرب الإسلامي ط : 1 ، 1407هـ .
(19) البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري ، تحقيق د. طه عبد الحميد طه ، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1400هـ .
(20) تاج العروس من جواهر القاموس ، للزبيدي ، دار الفكر .
(21) التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، تحقيق: علي محمد البجاوي ، مصر ، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
(22) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. لمحمد بن عبدالرحمـن بن عبدالرحيم المباركفوري ، بيروت: دار الكتب العلمية.
(23) التخمير ( شرح المفصــل ) ، للخوارزمي ، تحقيق : د. عبد الرحمن العثيمين ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ط : 1 ، 1990م .
(24) التصريح بمضمون التوضيح ، للشيخ خالد الأزهري ، دار إحياء الكتب العربية.
(25) التكملة ، للفارسي ، تحقيق : د. كاظم بحر المرجان ، الجمهورية العراقية ، 1401هـ / 1981م.
(26) تهذيب اللغة ، للأزهري ، تحقيق جماعة من العلماء ، ط الدار المصرية للتأليف والترجمة .
(27) الجـامع لأحكـام القرآن ، للقرطـبي ، بيروت: دار الكتب العلمية ، 1413هـ /1993م .
(28) الجمل في النحو ، للزجاجي ، تحقيق د. علي توفيق الحمد ، بيروت ، ط مؤسسة الرسالة ط:1 ، 1404هـ .
وطبعة الأردن : دار الأمل ، ط : 2 ، 1405هـ / 1985م .
(29) الجني الداني في حروف المعاني ، تحقيق د. فخر الدين قباوة ، ومحمد نديم فاضل ، حلب : المكتبة العربية 1393هـ / 1976م .
وطبعة أخرى بتحقيق : طه محسن ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1396هـ / 1976م
(30) حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك ، ترتيب وضبط وتصحيح : مصطفى حسين أحمد، بيروت دار الفكر
(31) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد الكافية لعبد القادر البغدادي ، بيروت ، دار صادر ، ط : 1 .
(32) الخصائص ، لابن جني ، تحقيق : محمد علي النجار ، بيروت : دار الكتاب العربي.
(33) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحلبي . تحقيق : د. أحمد الخراط ، دمشق : ط دار القلـــم ط : 1 ، 1406هـ .
(34) ديوان الأخطل ، شرح: راجي الأسمر ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط: 1 ، 1413هـ / 1992م .
(35) ديوان أبي الأسود الدؤلي ، صنعه أبو سعيد السكري ، تحقيق محمد حسن آل ياسين ، بيروت ، دار الكتاب الجديد ط : 1 ، 1974م .
(36) ديوان أبي النجم العجلي ، صنعه وشرحه : علاء الدين أغا ، الرياض: النادي الأدبي، 1401هـ / 1981م .
(37) ديوان الأعشى ، بيروت ، دار صادر .
(38) ديوان جرير ، بيروت : دار صادر ، دار بيروت ، 1384هـ / 1964م .
(39) ديوان حسان بن ثابت ، بيروت ، دار صادر .
(40) ديوان الطرماح ، تحقيق د. عزة حسن ، بيروت ، دار الشرق العربي ، ط: 2 ، 1414هـ / 1994م .
(41) رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمالقي ، تحقيق : د. أحمد محمد الخراط ، دمشق : دار القلم ، ط : 2 1405هـ / 1985م .
(42) السبعة في القراءات ، لابن مجاهد ، تحقيق : د. شوقي ضيف ، القاهرة : دار المعارف ، ط: 2 ، 1980م .
(43) سر صناعة الإعراب ، لابن جني ، تحقيق : د. حسن هنداوي ، دمشق : دار القلم ، ط : 1 ، 1405هـ 1985م
(44) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، للألباني ، تخريج : محمد ناصر الدين الألباني ، بيروت: دمشق، طبعة المكتب الإسلامي ، ط : 5 ، 1405هـ / 1985م .
(45) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي ، بيروت : المكتب التجاري للطباعة والنشر .
(46) شرح أبيات سيبويه ، لابن السيرافي ، تحقيق : د. محمد علي سلطاني ، دمشق ، بيروت : ط دار المأمون للتراث 1979م .
(47) شرح التسهيل ، لابن مالك ، تحقيق د. عبد الرحمن السيد ، د. محمد بدوي المختون ، مصر : هجر ، ط:1 1410هـ / 1990م .
(48) شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير ) ، لابن عصفور ، تحقيق : د. صاحب أبو جناح ، العراق: مؤسسة دار الكتب
(49) شرح شافية ابن الحاجب ، للرضي ، تحقيق : محمد نور الحسن ، محمد الزقزاق ، محمد محيي الدين عبد الحميد بيروت : دار الكتب العلمية ، 1395هـ/1975م .
(50) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، مصر: مطبعة السعادة ، ط : 14 1384هـ / 1964م .
(51) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك ، تحقيق : عدنان الدورى ، بغداد ، مطبعة العاني ، 1397هـ 1977م .
(52) شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، مصر : مطبعة السعـــادة ط : 11 ، 1383هـ / 1963م .
(53) شــــرح الكـافيـــة فـي النـحــو للرضــي ، بـيــروت: دار الـكـتـــــــب العلميـة ط: 2، 1399هـ / 1979م .
(54) شرح المفصل ، لابن يعيش ، بيروت : عالم الكتب ، ط القاهرة : مكتبة المتنبي.
(55) شرح المقدمة المحسبة ، لابن بابشاذ ، تحقيق : خالد عبد الكريم ، الكويت: المطبعة العصرية ، ط:1 ، 1976م .
(56) الشعر (شرح الأبيات المشكلة الإعراب) ، للفارسي ، تحقيق : د. محمود محمد الطناحي ، القاهرة : مكتبة الخانجي ط: 1 ، 1408هـ / 1988م .
(57) شعر المتوكل الليثي ، د. يحيى الجبوري ، بغداد ، مكتبة الاندلس .
(58) الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، للجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، بيروت : دار العلم للملايين ط : 4 ، 1407هـ .
(59) الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العُقيلي. تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي ، بيروت: دار الكتب العلمية ، ط: 1 ، 1404هـ.
(60) الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار ، لعبد الوهاب الشعراني ، بيروت : دار الجيـــــل ط: 1 ، 1408هـ / 1988م .
(61) العلل المتناهيـة لعبد الرحمـن بن علي الجوزي. تحقيــــــق: خليل الميس ، بيروت: دار الكتب العلمية ط: 1، 1403هـ.
(62) غاية النهايـــة في طبقات القراء ، لابن الجزري ، عني بنشره ، ج . برجستراسر ، بيروت: دار الكتب العلمية ط : 2 ، 1400هـ .
(63) فتح القدير ، للشوكاني ، بيروت : دار إحياء التراث العربي .
(64) الفريد في إعراب القرآن المجيد ، للهمداني ، تحقيق : د. محمد حسن النمر ، قطر: دار الثقافة ، 1411هـ 1991م .
(65) الكافية في النحو ، لابن الحاجب ، تحقيق : د. طارق نجم عبد الله ، جدة : مكتبة دار الوفاء ، ط : 1 ، 1407هـ 1986م .
(66) الكتاب ، لسيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ، بيروت : عالم الكتب ، ط:3 ، 1403هـ / 1983م .
(67) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، للزمخشري ، ومعه حاشية الشريف علي الجرجاني .. بيروت : دار المعرفة .
(68) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني الجراحي ، بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ط : 3 ، 1351هـ .
(69) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة ، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعة البهية 1362هـ / 1943م .
(70) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، لمكي القيسي ، تحقيق:د.محيي الدين رمضان ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط : 2 ، 1401هـ/ 1981م.
(71) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، للغزي ، تحقيق : د. جبرائيل جبور ، بيروت: محمد أمين دمج وشركاه.
(72) لسان العرب ، لابن منظور ، بيروت : دار صادر .
(73) لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق (المنن الكبرى) ، للشعراني ، 1311هـ 1893م .
(74) ما ينصرف وما لاينصرف ، للزجاج ، تحقيق د. هدى قراعة ، القاهرة : مكتبة الخانجي ، ط:2 ، 1414هـ 1994م .
(75) مجاز القرآن لأبي عبيد ، تعليق محمد فؤاد سركين ، مؤسسة الرسالة ، ط: 2 1401هـ .
(76) مجمع الأمثال ، للميداني ، تعليق نعيم حسين زرزور ، بيروت : دار الكتب العلمية ط : 1 ، بيروت 1408هـ .
(77) المحتســــــــب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لابن جني، تحقيق: علي النجدي ناصف ود . عبـــد الحليم النجار ود . عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، القاهرة: ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، 1386هـ.
(78) مختــصر فـي شـواذ القـرآن من كتـاب البـديع ، لابـن خالويـه ، عنى بنشره: ج: برجستراسر القاهرة: مكتبة المتنبي.
(79) المذكر والمؤنث ، لأبي بكر بن الأنباري ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، مصر : وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث ، 1401هـ .
(80) المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري ، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، بيروت: دار الكتب العلمية.
(81) مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار ، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زبن الله ، مكتبة العلوم والحكم، بيروت: ط: 1 ، 1409هـ.
(82) مسند الحارث للحارث بن أبي أسامة ، تحقيق: د. حسين أحمد صالح البكري ، المدينة المنورة: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ، 1413هـ.
(83) مسند الشهاب محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي ، بيروت: مؤسسة الرسالة ، ط: 2 ، 1407هـ.
(84) مشكل إعراب القرآن ، لمكي القيسي ، تحقيق: ياسين السواسي ، دمشق: دار المأمون للتراث ، ط: 2.
(85) معاني الحروف ، للرماني ، تحقيق : د. عبـد الفتاح شلبي ، جدة : دار الشروق ، ط: 2، 1401هـ / 1981م
(86) معاني القرآن ، للفراء ، تحقيق: محمد علي النجار ، وأحمد يوسف نجــاتي ، بيروت: عالم الكتب ، 1980م .
و ط بيروت: عالم الكتب ، ط : 3 ، 1403هـ .
(87) معاني القرآن ، للأخفش ، تحقيق: د. فائز فارس ، ط : 2 ، 1401هـ .
(88) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، تحقيق : د. عبد الجليل عبده شلبي ، بيروت : عالم الكتب ، 1408هـ 1988م .
(89) المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد الحسيني القاهرة: دار الحرمين ، 1415هـ.
(90) المعجم الكبير للطبراني ، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي ، مكتبة العلوم والحكـم ، ط: 2 ، 1404هـ.
(91) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ، وضعه عدد من المستشرقين ، نشر :د. أ.ي ونسنك ، ليدن : مكتبة بريل 1936م .
(92) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، وضعه : محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت: دار الفكر .
(93) المعرَّب من الكلام الأعجمي ، للجواليقي ، تحقيق : د. ف . عبد الرحيم ، دمشق : دار القلم ، ط: 1، 1410هـ 1990م .
(94) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام ، تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ، بيروت: دار إحياء التراث العربي .
وطبعة أخرى بتحقيق د. مازن المبــــارك ، ومحمد علي حمد الله ، مراجعة : سعيد الأفغاني : بيروت ، دار الفكر ط : 5 ، 1979م .
(95) المقتصد في شرح الإيضاح ، للجرجاني ، تحقيق : د. كاظم بحر المرجان ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق : دار الرشيد ، 1982م .
(96) المقتضب ، للمبرد ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، بيروت : عالم الكتب.
(97) المنصف ، لابن جني ، تحقيق : إبراهيم مصطفى ، عبد الله أمين ، مصر : مصطفى البابي الحلبي ، 1373هـ 1954م .
(98) المؤتلف والمختلف للآمدي ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج : القاهرة ـ دار إحياء الكتب العربية 1381هـ 1961م .
(99) نتائج الفكر في النحو ، للسهيلي ، تحقيق : د. محمد إبراهيم البنا ، الرياض: دار الرياض .
(100) النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، بيروت : دار الكتب العلمية .
(101) هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، لإسماعيل البغدادي ، بيروت: ط مكتبة المثنى واستانبول: طبعة وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية ، 1955م.
(102) همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي ، تحقيق وشرح : عبـد السلام هارون ، د. عبد العال سالم مكرم : الكويت : دار البحوث العلمية ، 1394هـ / 1975م ، وط : بيروت : مؤسسة الرسالة 1413هـ / 1992م .
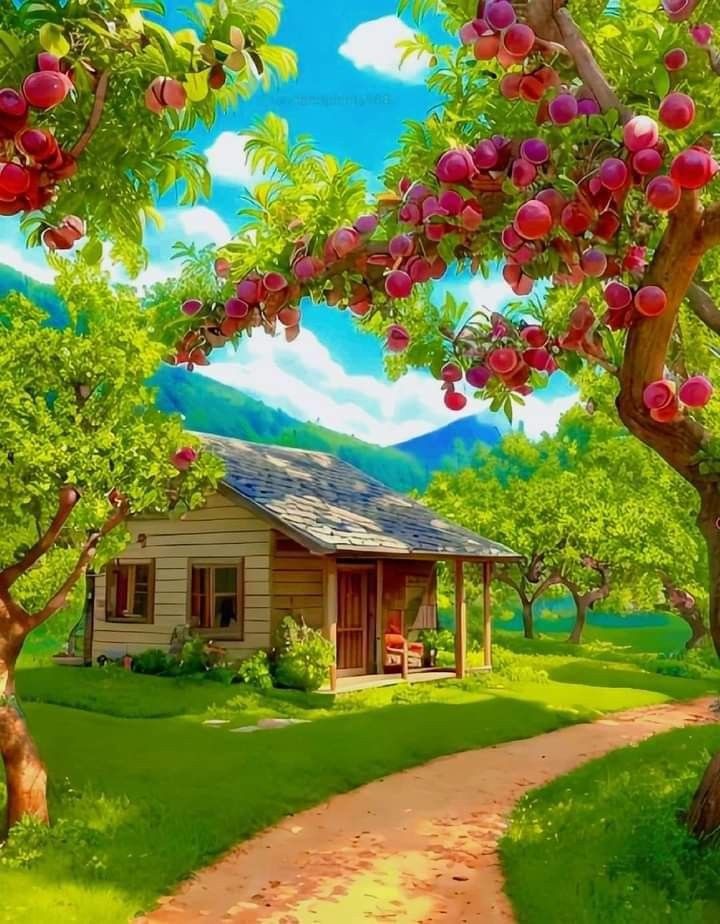
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق