شذا العرف فى فن الصرف
أحمد الحملاوي
نبذة عن الكتاب :
كتاب يبحث في علم هام من علوم اللغة العربية وهو علم التصريف، فإن من أهم خصائص اللغة العربية التي عدها العلماء لها ما تمتاز به من إتساع الأبنية، وكثرة الصيغ التي تستوعب المعاني الكثيرة لا سبيل للوصول إلى ذلك إلا علم التصريف ومن فاته فقد فاته الكثير من علوم اللغة . وهذا الكتاب هو أشهر ما كتب في هذا العلم
النصوص
الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( تعريف بمؤلف الكتاب )
تقديم
الحمد لله الذى علم القرآن، وخلق الإنسان، وعلمه البيان، وأصلى وأسلم على أفصح
الخلق لسانا، وأبلغهم بيانا، وعلى آله وصحبه الطيبين، ومن تبع هداهم إلى يوم
الدين.
وبعد، فإن من خصائص اللغة العربية التى عدها العلماء لها ما تمتاز به من اتساع
الأبنية، وكثرة الصيغ التى تستوعب المعانى التى يمكن أن تجيش بها نفس إنسان فى وقت
من الأوقات ولما كان التصريف هو سبيل الوصول إلى تلك الصيغ فقد قالوا: "أما
التصريف فإن من فاته علمه فاته المعظم". ويعلل ابن فارس لتلك المقولة بأمثلة
كثيرة تكشف عن فائدة التصريف فى التمييز بين المعانى التى تتحول بتصريف صيغها من
الضد إلى الضد. "يقال: القاسط للجائر، والمقسط للعادل، فتحول المعنى بالتصريف
من الجور إلى العدل...".
وثمة قصة وقعت لعمرو بن عبيد المعتزلى مع أبى عمرو بن العلاء تكشف عن التفات علماء
اللغة القدامى لخطورة أمر الصيغ، والخلط بين بعضها وعدم التفريق الدقيق بين
دلالاتها فقد أشارت المصادر إلى وفود أبى عثمان عمرو بن عبيد المعتزلى على أبى
عمرو بن العلاء يسأله قائلا: "يا أبا عمرو؛ أيخلف الله وعده؟ قال أبو عمرو:
لا. قال عمرو: أفرأيت من وعده الله على عمل عقابا، أيخلف الله وعده؟ فقال أبو
عمرو: من العجمة أتيت أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد ...".
فعمرو
بن عبيد هنا - إن صحت الرواية - قد أخطأ فى التفريق بين الصيغتين فالوعد مصدر
(وعد)، أما الوعيد فهو مصدر (أوعد) فالصيغة الأولى صيغة مصدر ثلاثى، والثانية صيغة
مصدر رباعى. والخلط بين الصيغتين ومصدريهما قد أدى إلى الانتقال من الضد إلى الضد،
وهذا المعنى الضدى هو ما يستفاد من المعنى الصيغى للكلمة، وفى اللغة نظائر كثيرة
تنقل الصيغة فيها الكلمة من الضد إلى الضد كما فى (قسط) و (أقسط) و (حنث) و
(تحنث)، و(أثم) و(تأثم) ...إلخ. مع اختلاف أنواع الصيغ الممثل بها. ويذكر السيوطى
كذلك كلاما عن أبى حيان يدلنا على مدى الدور الذى تلعبه تلك الصيغ فى التعبير عن
المعانى التى لا تكاد تتناهى والتى لولا الصيغ لضاقت اللغة عنها.
يقول أبو حيان: "وأنواع المعانى المتفاهمة لا تكاد تتناهى؛ فخصوا كل تركيب
بنوع منها؛ ليفيدو بالتراكيب والهيآت أنواعا كثيرة، ولو اقتصروا على تغاير المواد،
حتى لا يدلوا على معنى الإكرام والتعظيم إلا بما ليس فيه من حروف الإيلام والضرب؛
لمنافاتها لهما؛ لضاق الأمر جداً ولا حتاجوا إلى ألوف حروف لا يجدونها بل فرقوا
بين (معتِق) و (معتَق) بحركة واحدة حصل بها تمييز بين ضدين.
وهذا كله يدلنا على خطورة أمر الصياغة والتصريف إذ إن الخطأ فيها يحول المعنى من
الضد إلى الضد.
إن التصريف يثرى اللغة بما يتيحه لموادها من المعانى الوظيفية الكثيرة، التى تعبر
عن المعنى محمولا على هيئة اللفظ دون إرهاق المنشئ بالبحث عن مواد جديدة لأداء تلك
المعانى، ومن ثم فهى تحقق فى الوقت نفسه غاية عزيزة من أهم غايات البلاغة وهى
الإيجاز.
فإذا نظرنا على سبيل المثال، إلى قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ
فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ}.
نجد
أن لفظتى (صافات - ويقبضن) يمكن أن يعبر عن الحدث فيهما وهو أصل المعنى بأكثر من
طريقة، ولذا اختير التعبير باسم الفاعل فى اللفظة الثانية، وكان يمكن التعبير عنها
بغير اسم الفاعل كالفعل المضارع (يصفقن). وفى اللفظة الثانية كان يمكن التعبير
عنها بغير الفعل المضارع، كأن يعبر عنها باسم الفاعل كسابقتها مثلا. ولكن الآية قد
اختارت اسم الفاعل للتعبير عن الحدث فى اللفظة الأولى، واختارت الفعل المضارع
للتعبير عن الحدث فى اللفظة الثانية، وما ذلك إلا رعاية للمعنى الفنى الدقيق الذى
أرادت الآية أن ترمز إليه وتدل عليه.
قال الزمخشرى: "فإن قلت: لم قيل: (ويقبضن، ولم يقل: قابضات) (قلت): لأن الأصل
فى الطيران هو صف الأجنحة؛ لأن الطيران فى الهواء كالسباحة فى الماء والأصل فى
السباحة مد الأطراف وبسطها، وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك
فجئ بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات، ويكن منهن القبض تارة
بعد تارة كما يكون من السابح".
فكأن الآية قد رمزت بذلك - فضلا عن إثبات حدثى الصف والقبض - إلى أن الصف هو غالب
فعل الطير فى جو السماء وأن القبض يكون عارضا، وهذا المعنى وإن لم يكن مقصودا
بالأصالة من الكلام، فإن اختيار الآية لهاتين الصيغتين قد شمل هاتين الدلالتين دون
أن يزيد فى لفظ الكلام، بل عبر عن المعنى بهيئة اللفظ نفسه وليس بلفظ آخر، ولو
خولفت تلك الصياغة وأريد التعبير عن تلك المعانى، لقيل: "يصففن غالبا وأحيانا
قابضات"، وفيه من الركاكة والتطويل ما فيه، فضلا عن أن المعنى المراد إضافته
ليس مقصودا من الكلام بالأصالة، وإنما هو متمم لبيان القدرة وتمام الحكمة فكان
تضمينه فى هيئة الكلمة وبنيتها أولى من الإتيان بلفظ جديد يخصه.
والمقصد
هنا بيان قيمة الصياغة والتصريف فى التعبير عن المعانى الفنية الدقيقة فى أوجز
عبارة، عن طريق الإفادة من المعانى الوظيفية التى يمكن الحصول عليها من تصاريف
المادة الواحدة.
لذا كانت عناية اللغويين بهذا العلم الشريف الذى لا تقف قيمته عند صون اللسان عن
الخطأ فى المفردات، ومراعاة قانون اللغة فى الكتابة كما ذكروا، وإنما تتخطى ذلك
إلى تحقيق أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة، والإعانة على فهم الخطاب المعجز الذى لا
يتأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
ولما كان كتاب (شذا العرف) من خير ما صنف فى علم الصرف، لما يمتاز به من السهولة
والإيجاز وحسن العرض والتناول، فضلا عن تمكن مؤلفه فى علوم العربية وتقدمه فيها -
لا جرم - سعدت أبلغ سعادة، وشرفت أيَّما شرف، حينما عهد إلىّ بالاعتناء بهذا
الكتاب وشرحه وتحقيقه وفهرسته، وبذل الجُهد لإخراجه على الوجه اللائق به، فصادف
ذلك هوًى فى نفسى لخدمة هذا الكتاب الذى كان من أوّل ما تمرست به فى علم الصرف،
فجزى الله الجميع خير الجزاء، وأسأله سبحانه أن ينفع به عباده، وأن يجزل لنا فيه
المثوبة.
د / عبد الحميد هنداوى
المدرس بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة
التعريف بالشيخ الحملاوى
هو الأستاذ اللغوى الثقة الحافظ، الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوى نسبة إلى
"مُنْيَة حَمَل" من قرى "بُلْبَيْس" بمحافظة الشرقية. وهو
عربى الأرمة، ينمى إلى الدوحة العلوية الكريمة، كما صرح بذلك فى كثير من قصائده فى
ديوانه.
وقد ذكر على مبارك باشا فى كتابه الخطط التوفيقية (ج 9 ص 77) أنه ولد سنة "1273 هجرية - 1856م" وتربى فى حجر والده، وقرأ وتلقى كثيراً من العلوم الشرعية والأدبية عن أفاضل عصره، ثم دخل مدرسة دار العلوم، وتلقى الفنون المقررة بها. ونال الشيخ إجازة التدريس من دار العلوم سنة (1306هـ - 1888م) فعين مدرسًا بالمدارس الابتدائية بوزارة المعارف. وبعد مديدة أعلنت دار العلوم بحاجتها إلى مدرس للعلوم العربية، وعقدت لذلك امتحان مسابقة كان الشيخ من أوائل المبرزين فيه، فنقل إلى دار العلوم. وفى سنة 1897م ترك الأستاذ التدريس بالمدارس الحكومة، مؤثرًا الإشتغال بالمحاماة فى المحاكم الشرعية، وفى أثناء ذلك أقبل على التحضير لنيل شهادة العالمية من الأزهر فنال بغيته، وكان أول من جمع بين العالمية وإجازة التدريس فى دار العلوم وعلى إثر ذلك عهدت إليه الجامعة الأزهرية فى تدريس التاريخ والخطابة والرياضيات لطلابها وفى سنة 1902م أضيفت إليه مع ذلك نظارة مدرسة المرحوم عثمان باشا ماهر وهى مدرسة حديثة، كان يعلم بها القرآن والتجويد، ثم العلوم الدينية والعربية والعلوم الحديثة، على نحو ما يجرى فى بعض أقسام الأزهر التى نظمت حينئذ تنظيما حديثًا، وكان المنتهون منها يلحقون لإتمام دراساتهم بمدرسة القضاء الشرعى أو دار العلوم أو الأزهر. وقد قضى المترجم فى نظارة هذه المدرسة خمسا وعشرين سنة، انتفع به فيها طلاب كثيرون، كان يمدهم بمعارفه المتفننة الواسعة، ويتعهدهم بالتربية الإسلامية والتربية القومية ويزودهم بنصائحه وتجاربه الكثيرة، إلى أن علت سنه، فآثر الراحة، وترك العمل سنة 1928م. ثم أدركته الوفاة فى (22 من شهر ربيع الأول سنة 1351 هـ = 26 من يوليه سنة 1932م).
وقد
كسب الشيخ معارفه العلمية فى بيئتين: الأولى الأزهر، درس فيه علوم الدين؛ من تفسير
وحديث وعقائد وفقه على مذهب الشافعى، الذى خالط حبه شفاف قلبه وتمكن من نفسه ودرس
العلوم اللسانية: من نحو، وصرف، وعروض، وبلاغة، ووضع ...إلخ، على شيوخ عصره، وأحرز
من كل ذلك قسطا موفوراً، دل عليه تمكنه منها فى كتبه ودروسه، وإحرازه درجة
العالمية، بعد تركه خدمة الحكومة.
والبيئة الثانية: دار العلوم، التى أنشأها على مبارك باشا وزير المعارف المصرية،
لتخريج معلمين، يحسنون تعليم اللغة العربية والدين لتلاميذ المدارس الابتدائية
والثانوية. وكان طلابها حينئذ ينتخبون بامتحان مسابقة من صفوة الطلاب الأزهريين،
الذين أنهوا دراساتهم أو كادوا ينتهون منها، وكانوا يدرسون فيها العلوم الدينية
والعربية لزيادة التمكن. إلى جانب العلوم التى لم تكن فى الأزهر: من بيداجوجيا،
وأدب، ولغة، وكتابة، وخطابة، ورياضيات، وطبيعيات، وتاريخ، وجغرافيا، وخط، ورسم...
إلخ. وكانت عناية المدرسين بها تجمع بين المحاضرة والتطبيق العملى.
وكان بين أساتذتها نخبة من علماء الأزهر، أمثال الشيخ حسن المرصفى والشيخ حسن الطويل، والشيخ محمد عبده، والشيخ سليمان العبد، وأضرابهم من الفحول. وكان الجمع فى دار العلوم بين العلوم الإسلامية والعربية القديمة، وبين العلوم المدرسية الحديثة (كما كانوا يسمونها)، ثم بين المنهجين النظرى والتطبيقى خليقا أن يطبع خريجى دار العلوم وقتئذ بطابع وسط بين القديم المتمثل فى الدراسات الأزهرية، والحديث المتمثل فيما يُدَرَّس بالمدارس المصرية الحديثة والجامعات الأوربية. وقد جنت مدارس وزارة المعارف ثمرات هذه المدرسة القديمة الحديثة، التى وصلت ماضى الأمة العربية بحاضرها، فكانت من العوامل فى النهضة الأدبية والعلمية، التى ظهرت بواكيرها فى وادى النيل منذ بدء القرن التاسع عشر. لذلك أقبل كثير من أذكياء الطلاب الأزهريين على دار العلوم، ينهلون من ثقافتها المختلطة، وكان المؤلف من الرعيل الأول الذى استبق إليها، فنهل وعل من معارفها وآدابها. ونال إجازة التدريس منها سنة 1888م كما أشرنا إليه فى صدر هذه الكلمة.
كان
الشيخ رحمه الله ضليعًا فى علوم العربية: نحوها وصرفها ولغتها وعروضها وبلاغتها
وأدبها، وكان يروى من ذلك كله ويحفظ الشئ الكثير، مع حسن اعتناء بفهم ما يحفظ
وجودة نقد لما يروى، وبراعة استخراج للعبرة والفائدة. وكان النحو والصرف واللغة
والشعر الميدان المحبب إليه، يجول فيها فيتمتع ويتتبع أقوال الأوائل والأواخر، فلا
يكتفى ولا يشبع. ويظهر لى أنه كان معجبا بابن هشام الأنصارى من النحاة المصريين
(708 - 761هـ) وبما جمع شرحه لألفية ابن مالك الموسوم "بأوضح المسالك، إلى
ألفية ابن مالك". من مادة غزيرة. فحفظ مسائله، وجعله أساس دراساته النحوية
والصرفية وتحقيقاته اللغوية، التى كان ينثرها بين يدى تلاميذه فى دروسه ومحاضراته.
ومنه التقط أغلى دُرره التى ألف منها كتابه هذا: "شذا العرف فى فن
الصرف" مع ما أضاف إليها من شذرات أخرى، من مفصل الزمخشرى، ومن شافية ابن
الحاجب، وشرحها لرضى الدين الاستراباذىّ، وغيره من محققى الأعاجم المتأخرين، الذين
عنوا بالدراسات الصرفية، وأشبعوها تأليفا وتوضيحًا وتصنيفًا. وقد أسبغ الشيخ على
هذه المادة التى أحسن اختيارها من كتب العلماء، كثيراً من ذوقه وخبرته بأساليب
التعليم والتصنيف، فتصرف فيها توضيحا وتهذيبا، وتنسيقا وتبويبا، حتى جاء هذا
الكتاب محكم الطريقة، واضح الأسلوب، جامعا للعناصر الضرورية التى لا بد منها لدارسى
اللغة وفنونها ممثلا ما وصلت إليه الثقافة اللغوية فى مدارس البصرة والكوفة وبغداد
والفسطاط والأندلس. ثم ما انتهت إليه أخيرًا على يد ابن مالك وأبى حيان وتلاميذها
من رجال المدارس النحوية الأخيرة التى لا تزال آثارها قوية باقية.
وإجمال القول، أن كتاب "شذا العرف" من أنفع الكتب لطلاب الدراسات
الصرفية فى المدارس والمعاهد وبعض الكليات. وهذه الطبعة الحادية عشرة من طبعاته،
دليل على استمرار النفع به، وعلى قيمة ما أودع من مادة صحيحة مهذبة ملائمة لعقول
الطلاب.
مؤلفات
الشيخ وآثاره العلمية والأدبية:
1- شذا العرف، فى فن الصرف. (طبع أول مرة سنة 1312هـ = 1894م).
2- زهر الربيع، فى المعانى والبيان والبديع (طبع أول مرة سنة 1327هـ = 1909م)
بالمطبعة الأميرية.
3- مورد الصفا، فى سيرة المصطفى (طبع أول مرة سنة 1358هـ = 1939م) بمطبعة مصطفى
البابى الحلبى وأولاده بالقاهرة.
4- قواعد التأييد، فى عقائد التوحيد، رسالة صغيرة طبعت بمطبعة مصطفى البابى الحلبى
وأولاده بالقاهرة سنة (1372هـ = 1953).
5- ديوان شعره. تم طبع الجزء الأول منه فى أول يونية سنة 1957م، بمطبعة مصطفى
البابى الحلبى وأولاده بالقاهرة.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( خطبة الكتاب )
اللهمَّ إنا نحمدُك يا مصرِّف القلوب على مَزيد نعمك، ومترادِف جودك وكرمك،
غمرتَنَا بإحسانك، الذى مَصدرُه مجرَّد فضلك، وشملتنا بمُضاعَف نعَمِك وطَوْلك،
فسبحانَك تعالتْ صفاتك عن الشبيه والمثال، وتنزهت أفعالك عن النقص والإعلال؛ لا
رادَّ لماضى أمرك، ولا وُصول لقدْرِك حقَّ قدرك، ونستمطرك غيثَ صلواتك الهامِية،
وتسليماتك الباهرة الباهية، على نبيك إنسان عين الوجود، المشتقّ من ساطع نوره كلُّ
موجود، "محمد" المصطفى من خير العالمين نسبًا، وأرفعهم قَدْرًا، وأشرفهم
حسبًا، الذى صغَّر بصحيح عزمه جيشَ الجهالة، ومزّق بسالم حَزمه شمْلَ الضلالةِ،
وعلى آله مَظاهر الحِكَمِ، وصَحْبهِ مَصادرِ الهِممِ، الذين مَهَّدوا بلفيف جمعهم
المقرون بالسّداد، سبيلَ الهُدى ومعالمَ الرَّشادَ.
وبعدُ،
فما انتظم عِقدُ علمٍ إلاَّ والصَّرْفُ واسطتُه، ولا ارتفع مَنارُه، إلا وهو
قاعدته، إذ هو إحدى دعائم الأدب، وبه تُعرَف سَعة كلام العرب، وتنجلى فرائد مفردات
الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وهما الواسطة فى الوصول إلى السعادة الدينية
والدنيوية، وكان ممن تطلع لرشف أفاويقه وتَطلَّبَ جمع تفاريقه، طلبة مدرسة
"دار العلوم"، فإنهم أحدقوا بى من كل جانب، وكان المطلاب فيهم أكثر من
الطالب، فما وَسِعنى إلا أن أحفظ العلم ببذله، وألا أضنَّ به على أهله، فسرَّحت
نواظر البحث فى فِجاجِ الكواغد، وبعثتها فى طلب الشوارد، فاقتفت الأثرَ، حتى أتت
بالمبتدأ والخبر، ثم جعلتُ أميز الصحيح من العليل. وَأوْدِع ما أقتطفه من ثمار
الكثير فى السهل القليل، فجاء بحمد الله كتابًا تروق معانيه، وتطيب مَجانيه،
عباراته شافية، وشواهده كافية، فأمعن نظرك فيه، وقل: "ذلكْ فضل الله
يؤتيه"، وإن رأيت هفوة فقل طغى القلم، فإن ذلك من دواعى الكرم، وحاشاك أن تكون
ممن قيل فيهم:
*فإِنْ رَأَوْا هَفْوة طارُوا بها فَرَحاً * منّى وما علمِوا من صالح دَفَنُوا*
وقد سميته: "شذا العرف، فى فن الصرف".
واللهَ أسأل أن يُلبسه ثوبَ القَبول، وأن ينفع به، إنه أكرم مسئول.
وقد جعلته مرتبًا على مقدمة وثلاثة أبواب:
فالمقدمة: فيما لا بد منه فيه.
والباب الأول: فى الفعل. والثانى: فى الاسم. والثالث: فى أحكام تَعُمُّهما.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( مقدمة فى بيان
مبادئ علم الصرف )
الصَّرْفُ، ويُقال له: التصريفُ.
هو لغةً: التغييرُ، ومنه {تصريفُ الرياحِ}؛ أى تغييرها.
واصطلاحًا بالمعنى العَمَلىّ: تحويلُ الأَصلِ الواحدِ إلى أمثلةٍ مختلفةٍ، لِمعانٍ
مقصودة، لا تحصُل إلا بها، كاسمَىْ الفاعلِ والمفعولِ، واسمِ التفضيلِ، والتثنيةِ
والجمعِ، إلى غير ذلك.
وبالمعنى
العِلْمِىّ: علمٌ بأصول يُعْرَف بها أحوالُ أبنيةِ الكلمةِ، التى ليست بإعرابٍ ولا
بناءٍ.
وموضوعُه: الألفاظُ العربيةُ من حيثُ تلك الأحوالِ، كالصحَّة والإعلالِ، والأصالةِ
والزيادةِ، ونحوِها.
ويختصُّ بالأسماءِ المتمكنةِ، والأفعالِ المتصرّفة.
وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، وجمعها وتصغيرها، فصُورِىّ
لا حقيقىّ.
وواضعُه: مُعاذ بن مُسْلِم الهَرَّاء، بتشديد الراء، وقيل سيدنا علىّ كرَّم الله
وجهه.
ومسائلُه: قضاياهُ التى تُذكَر فيه صريحا أو ضِمنًا، نحو: كلُّ واو أو ياء تحرَّكت
وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا، ونحو: إذا اجتمعت الواو والياء وسُبقت إحداهما
بالسكون، قلبت الواو ياء، وأدغمت فى الياء، وهكذا.
وثمرته: صَوْنُ اللسانِ عن الخطأِ فى المفرداتِ، ومراعاةُ قانونِ اللغةِ فى
الكتابةِ.
واستمدادُه: من كلامِ الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلامِ العربِ.
وحكمُ الشارعِ فيه: الوجوبُ الكِفائىّ.
والأبنيةُ: جمعُ بناءٍ، وهى هيئةُ الكلمةِ الملحوظةِ، من حركةٍ وسكونٍ: وعددِ
حروفٍ، وترتيبٍ.
والكلمةُ: لفظٌ مفردٌ، وضعه الواضعُ ليدلَّ على معنىً، بحيث متى ذُكر ذلك اللفظ،
فُهمَ منه ذلك المعنى الموضوع هو له.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( تقسيم الكلمة )
تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف.
فالاسم: ما وُضِع ليدلَّ على معنى مستقلّ بالفهم ليس الزمن جزءًا منه، مثل رجل
وكتاب.
والفعل: ما وُضِع ليدل على معنى مستقل بالفهم، والزمن جزء منه، مثل كَتَبَ ويقرأ
واحفظ.
والحرف: ما وُضع ليدل على معنى غير مستقلّ بالفهم، مثل هَلْ وفى ولم، ولا دَخْلَ
له هنا كما مرّ.
ويختص الاسم بقَبول حرف الجرّ، وأل، وبلحوق التنوين له، وبالإضافة، وبالإسناد
إليه، وبالنداء، نحو:
الحمدُ للهِ مُنْشِى الخَلْقَ مِنْ عَدَمِ.
ونحو: {يَا إبْراهيمُ قَدْ صَدَّقْت الرُّوْيَا}.
ويختصُّ
الفعلُ بقبول قَدْ، والسين، وسوف، والنواصب، والجوازم، وبلحوق تاء الفاعل، وتاء
التأنيث الساكنة، ونون التوكيد، وياء المخاطبة له، نحو: {قدْ أفْلَحَ مَنْ
تَزكىَّ}. {سَنقْرئُك فَلا تَنْسَى}. {وَلَسَوْفَ يُعْطَيكَ رَبُّكَ فَترْضَى}.
{لَنْ تَنالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا ممَّا تُحبُّون}. {لَمْ يَلِدْ ولَمْ
يُولَدْ}. {رَبَّنَا وَسِعْت كُلَّ شَىْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً}. {قاَلَتْ إِنَّ
أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزيَكَ أجْرَ مَا سَقَيْت لَنَا}. {لَيُسْجَنَنَّ
وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرينَ}. {يأَيَّتُهَا النَّفْس المُطْمَئِنَّةُ ارْجِعى
إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مَرْضِيَّةً}.
ويختص الحرف بعدم قَبول شئ من خصائصِ الاسم والفعل.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الميزان الصرفى
)
1- لما كان أكثرُ كلماتِ اللغة العربية ثُلاثيًا، اعتبر علماءُ الصرفِ أنَّ أصولَ
الكلماتِ ثلاثةُ أحرف، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام، مصوَّرة بصورةِ
الموزون، فيقولون فى وزن قَمَر مَثَلاً: فَعَل، بالتحريك، وفى حِمْل: فِعْل بسكر
الفاء وسكون العين، وفى كَرُمَ: فَعُلَ، بفتح الفاء وضم العين، وَهلُمَّ جَرَّا،
ويُسَمُّون الحرف الأوَّل فاء الكلمة، والثانى عين الكلمة، والثالث لام الكلمة.
2- فإذا زادت الكلمة عن ثلاثة أحرف:
فإن كانت زيادتُها ناشئة من أصل وَضْعِ الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة، زدتَ فى
الميزان لامًا أَو لامين على أحرف "ف ع ل"، فتقول فى وزن دَحْرَجَ
مثلاً: فَعْلَلَ، وفى وزن جَحْمَرِش فَعْلَلِل.
وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة كَرَّرْتَ ما يقابله فى الميزان،
فتقول فى وزن قدَّم مَثلاً، بتشديد العين: فعَّلَ، وفى وزن جَلْبَبَ: فَعْلَلَ،
ويقال له: مُضعَّفُ العين أو اللام.
وإن
كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف "سألتمونيها" التى هى
حروف الزيادة، قابلتَ الأصول بالأصول، وعَبَّرْتَ عن الزائد بلفظه، فتقول فى وزن
قائم، مثَلاً: فاعِل، وفى وزن تقدَّم: تَفَعَّلَ، وفى وزن استخرج: استفْعَل، وفى
وزن مجتهد: مُفْتَعِل، وهكذا.
وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال، يُنْطَقُ بها نظرًا إلى الأصل، فيقال
مثلا فى وزن اضطراب: افتعل، لا افطعل، وقد أجازه الرضىّ.
3- وإن حصل حذف فى الموزون حُذِف ما يقابله فى الميزان، فتقول فى وزن قُلْ مثلاً:
فُلْ: وفى وزن قاضٍ: فاعٍ، وفى وزن عِدَة: عِلَة.
4- وإن حَصَل قلبٌ فى الموزون، حصل أيضا فى الميزان، فيقال مثلاً فى وزن جاه:
عَفَل، بتقديم العين على الفاء.
ويُعْرَفُ القلب بأمور خمسة:
الأول: الاشتقاق، كناءَ بالمد، فإن المصدر وهو النَّأى، دليل على أن
"ناء" الممدود مقلوب نأى، فيقال: ناء على وزن فَلَعَ، وكما فى جاه، فإن
ورُود وَجْه ووُجْهَة، دليل على أن جَاه مَقلوب وَجْه، فيقال: جاه على وزن عَفَل.
وكما فى قِسِىّ، فإِن ورود مفرده وهو قَوْس، دليل على أنه مقلوب قُوُوْس،
فَقُدِّمت اللام فى موضع العين، فصار قُسُوْوٌ على فُلُوع، فقلبت الواو الثانية
ياءً لوقوعها طَرَفا، والواو الأولى؛ لاجتماعها مع الياء وَسَبْق إحداهما بالسكون،
وكُسِرت السينُ لمناسبة الياء، وكسرت القافُ لعُسْر الانتقال من ضمٍّ إلى كسر...
وكما فى حادِى أيضا، فإن ورود وَحْدة دليلٌ على أنه مقلوب "واحد"، فوزن
"حادى": عالف.
الثانى: التصحيح مع وجود مُوجِب الإعلال، كما فى أيِسَ، فإِن تصحيحه مع وجود
الموجِب، وهو تحريك الياء وانفتاح ما قبلها، دليل على أنه مقلوب يَئِسَ، فيقال:
أيِسَ على وزن عَفِلَ ويُعْرَفُ القلبُ هنا أيضًا بأصله وهو اليَأس.
الثالث:
نُدْرَة الاستعمال، كآرام جمع رِئم، وهو الظَّبْى، فإِنّ نُدْرَتَه وكثرة آرام،
دليل على أنه مقلوب أرآم، ووزن أرآم: أفعال: فقدِّمت العينُ التى هى الهمزة
الثانية، فى موضع الفاء، وسُهِّلَتْ، فصارت آرام، فوزنه: أعْفال. وكذا آراء، فإِنه
على وزن أعفال، بدليل مفرده، وهو الرأى.
وقال بعضهم: إن علامة القلب هنا ورودُ الأصل، وهو رئم، ورأى.
الرابع: أن يترتَّب على عدم القلب وجود همزتين فى الطرف؛ وذلك فى كل اسم فاعل من
الفعل الأجوف المهموز اللام، كجاء وشاء، فإِن اسم الفاعل منه على وزن فاعل.
والقاعدة أنه متى أُعلَّ الفعل بقلب عينه ألفًا، أعِلَّ اسم الفاعل منه، بقلب عينه
همزة، فلو لم نقل بتقديم اللام فى موضع العين، لزم أن ننطِق باسم الفاعل من جاء:
جائئ، بهمزتين؛ ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين، بدون أن تقلب همزة، فتقول:
جائئٌ: بوزن فالع، ثم يُعَلّ إعلال قاض فيقال جاءٍ بوزن: فال.
الخامس: أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتض، كأشياء، فإننا لو لم نقل
بقلبها، لزم منع "أفعال" من الصرف بدون مقتض، وقد ورد مصروفًا. قال
تعالى: {إنْ هِىَ إلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها}، فنقول: أصل أشياءَ شَيْآء، على
وزن فعْلاءَ، قُدِّمَت الهمزة التى هى اللام، فى موضع الفاء، فصار أشياء على وزن
لَفْعَاءَ، فَمنعُهَا من الصرف نظرًا إلى الأصل، الذى هو فَعْلاء. ولا شك أن فعلاء
من موازين ألف التأنيث الممدودة، فهو ممنوع من الصرف لذلك، وهو المختار.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول -
فى الفعل ) ضمن العنوان ( التقسيم الأول )
التقسيم الأوَّل: إلى ماضٍ ومضارع وأمر.
ينقسم الفعل إلى ماض، ومضارع، وأمر.
فالماضى: ما دلّ على حدوث شئٍ قبل زمن التكلم، نحو: قام، وقعد، وأكل، وشرب.
وعلامته أن يقبل تاء الفاعل، نحو: قرأتُ، وتاءَ التأنيث الساكنة، نحو قَرَأتْ
هِنْد.
والمضارع:
ما دَّل على حدوث شئٍ فى زمن التكلّم أو بعده، نحو يقرأ ويكتب؛ فهو صالح للحال
والاستقبال. ويُعَيِّنُه للحال لام الابتداء، و "لا" و "ما"
النافيتان، نحو {إِنِّى لَيَحْزُنُنِى أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ}. {لاَ يُحِبُّ اللهُ
الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ}. {وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ
غَداً}.
ويعينه للاستقبال: السينُ، وَسَوْفَ، وَلَنْ، وَأَنْ، وَإِنْ، نحو: {سَيَقُولُ
السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاس مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتىِ كَانُوا
عَلَيْهَا}. {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}. {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ
حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}. {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم}. {إنْ
يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ}.
وعلامته: أن يصح وقوعه بعد "لم"، نحو: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولُدْ}.
ولا بد أن يكون مبدوءًا بحرف من حروف "أنيت"، وتسمى أحرف المضارعة.
فالهمزة: للمتكلم وحده، نحو أنا أقرأ. والنون: له مع غيره أو للمعظِّم نفسَه، نحو
نحن نقرأ. والياء: للغائب المذكر وجمع الغائبة، نحو محمد يقرأ والنسوة يقرأن.
والتاء: للمخاطب مطلقًا، ومفرد الغائبة ومثناها، نحو أنت تقرأ يا محمد، وأنتما
تقرآن، وأنتم تقرءون، وأنتِ يا هند تقرئين، وفاطمة تقرأ، والهندان تقرآن.
والأمر: ما يُطْلَبُ به حصول شئ بعد زمن التكلم، نحو اجتهدْ. وعلامته أن يقبل نون
التوكيد، وياء المخاطبة؛ مع دلالته على الطلب.
وأما ما يدلّ على معانى الأفعال ولا يقبل علاماتها، فيقال له اسمُ فِعل، وهو على
ثلاثة أقسام:
اسم فعل ماضى: نحو هيْهات وَشَتَّانَ، بمعنى بَعُدض وافترق.
اسم فعل مضارع: كَوَىْ وَأفٌ، بمعنى: أتعجب وأتضجَّر.
اسم فعل أمر: كصَهْ بمعنى: اسكتْ، وآمينَ بمعنى: استجبْ، وهو أكثرها وجودًا.
النصوص
الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول - فى
الفعل ) ضمن العنوان ( التقسيم الثاني للفعل )
ينقسم الفعل إلى صحيح، ومعتلّ.
فالصحيح: ما خلت أصوله من أحرف العلّة، وهى الألف، والواو، والياء، نحو: كَتَب
وجَلس.
ثم إنّ حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لَيِّنا، كثَوْب وسَيْف، فإن جانسه
ما قبله من الحركات يسمى مدّاً، كقال يقُول قِيلا؛ فعلى ذلك لا تنفك الألف عن
كونها حرف علة، ومدٍّ، ولين؛ لسكوِنها وفتح ما قبلها دائمًا، بخلاف أختيها.
والمعتلّ: ما كان أحد أصوله حرف عِلة، نحو: وجد، وقال، وسعى.
ولكل من الصحيح والمعتل أقسام:
أقسام الصحيح
ينقسم الصحيح إلى سالم، ومضعَّف، ومهموز.
فالسالم: ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة، والتضعيف، كضرب ونصر وقعد وجلس،
فإِذنْ يكون كل سالم صحيحًا. ولا عَكْس.
والمضعَّف: ويقال له الأصمّ لشدته، ينقسم إلى قسمين:
مضعّف الثلاثىّ ومزيده، ومضعف الرباعىّ. فمضعف الثلاثىّ ومزيده: ما كانت عينه
ولامه من جنس واحد، نحو فرّ، ومدّ، وامتدّ، واستمدّ، وهو محل نظر الصرفىّ. ومضعف
الرباعىّ: ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس،كزلزلَ،
وَعَسْعَسَ، وَقَلْقَلَ.
والمهموز: ما كان أحد أصوله همزة، نحو أخذ، وسأل، وقرأ.
أقسام المعتلّ
ينقسم المعتل إلى مثال، وأجوف، وناقص، ولفيف.
فالمثال: ما اعتلت فاؤه، نحو وَعَدَ وَيَسَر، وسُمِّى بذلك لأنه يماثل الصحيح فى
عدم إعلال ماضيه.
والأجوف: ما اعتلت عينه، نحو قال وباع. وسمى بذلك لخلوّ جوفه؛ أى وسطه من الحرف
الصحيح. ويسمى أيضًا ذا الثلاثة؛ لأنه عند إسناده لتاء الفاعل، يصير معها على
ثلاثة أحرفٍ، كقُلتُ وبعت، فى قال وباع.
والناقص:
ما اعتلّت لامه، نحو غزا ورمى. وسُمِّىَ بذلك لنقصانه، بحذف آخره فى بعض التصاريف،
كغَزَتْ وَرَمَت. ويسمى أيضًا ذا الأربعة؛ لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها
على أربعة أحرف، نحو غَزَرْتُ وَرَمَيْتُ.
واللفيف قسمان:
مَفْروق: وهو ما اعتلت فاؤه ولامه، نحو وفى ووقى. وسُمِّى بذلك لكون الحرف الصحيح
فارقًا بين حرفَىْ العلة.
ومَقْرون: وهو ما اعتلت عينُه ولامُه، نحو طَوَى وَرَوَى. وسُمِّى بذلك لاقتران
حرفَى العلة بعضهما ببعض.
وهذه التقاسيم التى جرت فى الفعل، تجرى أيضا فى الاسم، نحو شْمس، ووجه، وَيُمْن،
وقَوْل، وسيف، ودلو، وظَبْى، وَوَحْى، وَجَوّ، وَحَىّ، وَأمْر، وبئر، ونبأ،
وَجَدّ، وبلبل.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول -
فى الفعل ) ضمن العنوان ( التقسيم الثالث للفعل: بحسب التجرُّد والزيادة وتقسيم
كلّ )
ينقسم الفعل إلى: مجرَّد ومزيد.
فالمجرد: ما كانت جميع حروفه أصلية، لا يسقط حرف منها فى تصاريف الكلمة بغير
علَّة.
والمزيد: ما زِيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية.
والمجرد قسمان: ثُلاثىّ ورباعىّ.
والمزيد قسمان: مَزيد الثلاثىّ، ومزيد الرباعىّ.
[المجرد الثلاثى]
أما الثلاثىّ المجرد: فله باعتبار ماضيه فقط ثلاثة أبواب؛ لأنه دائمًا مفتوح
الفاء، وعينه إما أن تكون مفتوحة، أو مكسورة، أو مضمومة، نحو: نصَرَ وَضَرَبَ
وَفَتحَ، ونحو: كَرُم، ونحو: فَرِح وحَسِب.
وباعتبار الماضى مع المضارع له ستة أبواب؛ لأن عين المضارع إما مضمومة، أو مفتوحة،
أو مكسورة، وثلاثة فى ثلاثة بتسعة، يمتنع كسر العين فى الماضى مع ضمها فى المضارع،
ويمتنع ضم العين فى الماضى مع كسرها أو فتحها فى المضارع، فإذن تكون أبواب الثلاثى
ستة.
الباب الأول: فَعَل يَفْعُل
بفتح
العين فى الماضى وضمها فى المضارع، كَنَصَرَ يَنْصُر، وقَعَدَ يَقْعُدُ وَأَخَذَ
يَأْخُذُ، وَبَرَأَ يَبْرُؤ، وقال يقُول، وَغَزَ يَغْزُو، ومَرَّ يَمُرُّ.
الباب الثانى: فَعَل يَفْعِل
بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المضارع، كضَرَبَ يَضْرِب، وَجَلَسَ يَجْلِسُ، وَوَعَدَ
يعد، وباع يبيع، ورمَى يرمِى، ووَقى يقِى، وَطَوَى يطْوِى، وفرَّ يفِرُّ، وأتى
يأتى، وجاء يجئ، وأبَر النخل يأبِره، وَهَنَأ يَهْنِئ، وَأَوَى يَأوِى، وَوَأَى
يَئ، بمعنى وعد.
الباب الثالث: فَعَل يَفْعَل
بالفتح فيهما، كفتح يفتَح، وذهَب يذهَب، وَسعَى يسعَى، وَوَضَع يضَع، وَيفَع
يَيْفَعُ، وَوَهَل يَوْهَل، وَأَلَهَ يألَه، وَسأَل يَسأل، وَقَرَأ يَقْرَأ.
وكل ما كانت عينه مفتوحة فى الماضى والمضارع، فهو حَلْقى العين أو اللام وليس كل
ما كان حلقيًا كان مفتوحًا فيهما. وحروف الحلق ستة: الهمزة والهاء والحاء والخاء
والعين والغين.
وما جاء من هذا الباب بدون حرف حَلْقىّ فشاذّ، كأَبَى يأْبَى، وَهلَكَ يهْلَك، فى
إحدى لغتيه، أو مِن تداخل اللغات، كركَن يرْكَن، وَقَلَى يقْلَى: غير فصيح. وَبَقى
يبقَى: لغة طِّيئ، والأصل كسر العين فى الماضى، ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفًا، وهذا
قياس عندهم.
الباب الرابع: فَعِل يَفْعَل
بكسر العين فى الماضى، وفتحها فى المضارع، كفرِحَ يفرَح، وعلِم يَعلَم، وَوَجِل
يوْجَل، وَيَبِسَ يَيْبَس، وخاف يَخاف، وهاب يَهاب، وغَيِد يَغْيَد، وَعَوِر
يَعْوَر، ورَضِىَ يرضىَ، وَقَوِىَ يَقْوَى، وَوَجِىَ يوْجَى، وَعَضَّ يَعَضّ
وأمِنَ يأمَن، وَسَئِمَ يَسْأم، وصَدِئ يَصْدأ.
ويأتى
من هذا الباب الأفعال الدالّة على الفرح وتوابعه، والامتلاء وَالخُلْوّ، والألوان
والعيوب، والخلق الظاهرة، التى تذكر لتحلية الإنسان فى الغَزَل: كفرِح وطرِبَ،
وبَطِر وَأَشِر، وَغَضِب وَحزِن، وكشبع وَرَوِىَ وَسكِر، وكعطِش وظمِئ، وصَدِىَ
وَهَيِم، وكحَمِر وسَِودَ، وكَعوِرَ وَعَمِشَ وجَهِرَ، وكغَيِدَ وَهَيِفَ
وَلَمِىَ.
الباب الخامس: فَعُل يَفْعُلُ
بضم العين فيهما، كشَرُفَ يَشْرُفُ وحَسُنَ يَحْسُنُ، ووَسُمَ يَوْسُمُ، وَيمُنَ
يَيْمُنُ، وأَسُلَ يَأْسُلُ، ولَؤُمَ يَلْؤُمُ، وجَرُؤَ يَجْرُؤُ، وسَرُوَ
يَسْرُو.
ولم يرد من هذا الباب يائىَّ العين إلا لفظة هَيُؤَ: صار ذا هيئة. ولا يائىَّ
اللام وهو متصرف إلا نَهُوَ، من النُّهْية بمعنى العقل، ولا مُضَعَّفًا إلا
قليلاً، كشَرُرْت مُثَلَّثَ الراء، ولَبُبْت، بضم العين وكسرها، والمضارع تَلَبُّ
بفتح العين لا غير.
وهذا الباب للأوصاف الخِلْقية، وهى التى لها مُكْث.
ولك أن تحوِّل كل فعل ثلاثىّ إلى هذا الباب، للدلالة على أن معناه صار كالغريزة فى
صاحبه. وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجُّب، فتنسلخ عن الحدَث.
الباب السادس: فَعِل يَفْعِل
بالكسر فيها، كحسِب يحسِب، ونِعم ينعِم. وهو قليل فى الصحيح، كثير فى المعتلّ، كما
سيأتى:
تنبيهات
الأول: كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية، ولازمة، إلا أفعال الباب الخامس، فلا
تكون إلا لازمة. وأما "رَحُبَتْك الدارُ" فعلى التوسع، والأصل رَحُبَتْ
بك الدارُ، والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب، وهى فى الكثرة على ذلك
الترتيب.
الثانى: أن فَعَل المفتوح العين، إن كان أوَّله همزة أو واوًا، فالغالب أنه من باب
ضرب، كأسَر، يأسِر وأتَى، يأتِى ووعد يعِد، ووزَن يزِن. ومن غير الغالب: أخَذ وأكل
ووَهَل.
وإن كان مُضاعفاً فالغالب أنه من باب نصر، إن كان متعدّيا، كمَدّه يَمُدُّه، وصدّه
يصُدُّه.
ومن
باب ضرب، إن كان لازما، كخَفَّ يخِفُّ، وشذّ يشِذُّ، بالذال المعجمة.
الثالث: مما تقدم من الأمثلة تعلم:
1- أن المضاعَف: يجئ من ثلاثة أبواب: من باب نَصَر، وضَرَب، وفَرِحَ، نحو سرَّه
يسرُّه، وفرَّ يفِرُّ، وعضَّهُ يعَضُّه.
2- ومهموز الفاء: يجئ من خمسة أبواب: من باب نصر، وضرب، وفتح، وفرِح، وشَرُف، نحو:
أخذ يأخُذ، وأسَرَ يأسِر، وأَهَب يأهَبُ، وأمِنَ يأَمَن، وأسُل يأسُل.
3- ومهموز العين: يجئ من أربعة أبواب: من باب ضرب، وفتح، وفرح، وشَرُف، نحو: وأى
يَئى، وسأل يسأل، وسئِمَ يسأم، ولَؤُم يَلْؤُم.
4- ومهموز اللام: يجئ من خمسة أبواب: من باب نصر، وضرب، وفتح، وفرح، وشَرُف، نحو:
بَرَأَ يبرُؤ، وهَنَأ يهنئ، وقرَأ يقرَأ، وصدئ يَصْدَأ، وجرُؤ ويجرُؤ.
5- والمثال يجئ من خمسة أبواب: من باب ضرب، وفتح، وفرح، وشَرُف، وحسِب، نحو: وعَد
يعِد، ووَهِل يَوْهَل، وَوَجِل يَوْجَل، وَوَسُم يوسُم، وَوَرِث يرِث. وقد ورد من
باب نصر لفظة واحدة فى لغة عامرية وهى وَجَدَ يَجُد. قال جرير:
*لو شِئْتِ قد نَقَعَ الفؤادُ بشَرْبَةٍ * تَدَعُ الحوَائِمَ لا يَجِدْنَ غَلِيلا*
رُوِىَ بضم الجيم وكسرها. يقول لمحبوبته: لو شئت قد رَوِى الفؤادُ بشرية من ريقك،
تترك الحوَائِمَ، أى العِطاش، لا يَجِدن حرارة العطش.
6- والأجوف: يجئ من ثلاثة أبواب: من باب نَصَر، وضرب، وفرِح، نحو: قال يقول: وباع
يبيع، وخاف يخاف، وَغَيِد يَغْيَد، وعَوِرَ يَعوَر، إلا أن شرطه أن يكون فى الباب
الأول واويّا، وفى الثانى يائيًا، وفى الثالث مطلقًا، وجاء طال يطول فقط من باب
شرُف.
7- والناقص: يجئ من خمسة أبواب: من باب نصر، وضرب، وفتح، وفرح، وشرف. نحو: دعا،
ورمى، وسعَى، ورضىَ، وسرُوَ. ويشترط فى الناقص من الباب الأول والثانى، ما اشترط
فى الأجوف منهما.
8- واللفيف المفروق: يجئ من ثلاثة أبواب: من باب ضرب، وفرح، وحسب. نحو: وَفَى
يفِى، ووجِىَ يَوْجَى، وولِىَ يَلِى.
9-
واللفيف المقرون: يجئ من بابى ضرب، وفرح. نحو: روَى يرْوِى، وقوِىَ يقْوَى، ولم
يرد يائىّ العين واللام إلا فى كلمتين من باب فرح، هما عَيِىَ، وَحَيِىَ.
الرابع: الفعل الأجوف، إن كان بالألف فى الماضى، وبالواو فى المضارع، فهو من باب
نصر، كقال يقول، ما عدا طال يطول، فإِنه من باب شرُف. وإن كان بالألف فى الماضى
وبالياء فى المضارع، فهو من باب ضرب كباع يبيع. وإن كان بالألف أو بالياء أو
بالواو فيهما، فهو من باب فرح، كخاف يخاف، وغَيد يَغْيَد، وعور يَعوَر.
والناقص إن كان بالألف فى الماضى وبالواو فى المضارع، فهو من باب نصر، كدعا يدعو.
وإن كان بالألف فى الماضى وبالياء فى المضارع، فهو من باب ضرب، كرمى يرمى.
وإن كان بالألف فيهما، فهو من باب فتح، كسعَى يسعَى.
وإن كان بالواو فيهما، فهو من باب شَرُف كسَرُوَ ويسرُو.
وإن كان بالياء فيهما، فهو من باب حسِب، كولىِ يلِى.
وإن كان بالياء فى الماضى وبالأَلف فى المضارع، فهو من باب فرح، كرضِىَ يرضَى.
الخامس: لم يرد فى اللغة ما يجب كسر عينه فى الماضى والمضارع إلا ثلاثََة عَشَرَ
فعلاً، وهى: وثِقَ به، ووجِد عليه؛ أى حزِن، وورِث المال، وورِع عن الشبهات،
وورِك؛ أى اضطجع، وورِم الجُرح، ووَرِىَ المخ؛ أى اكتنز، ووَعِق عليه؛ أى عَجِل،
ووَفِق أمرَه؛ أى صادفه موافقًا، ووقِه له؛ أى سمع، ووكِم؛ أى اغتمَّ، وولِىَ الأمرَ،
ووَمِقَ؛ أى أحبّ.
وورَد أحد عشر فعلا، تُكْسَر عينها فى الماضى، ويجوز الكسر والفتح فى المضارع، وهى
بَئِس، بالباء الموحدة، وحسِب، وَوَبِق؛ أى هلك، وَوَحِمتِ الحُبْلَى، ووحِرَ
صدرُهُ، وَوَغِر؛ أَى اغتاظ فيهما، وولِغَ الكلب، وولِه، ووهِلَ اضطرب فيهما، ويَئِسَ
منه، ويبِسَ الغصن.
السادس:
كون الثلاثى على وزن معين من الأَوزان الستة المتقدمة سماعىّ، فلا يعتمد فى
معرفتها على قاعدة، غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط، ويجب فيه مراعاة
صورة الماضى والمضارع معًا، لمخالفة صورة المضارع للماضى الواحد كما رأيت، وفى
غيره تراعى صورة الماضى فقط؛ لأن لكل ماض مضارعًا لا تختلف صورته فيه.
السابع: ما بُنِى من الأفعال مطلقًا للدلالة على الغلبة فى المفاخرة، فقياس مضارعة
ضمُّ عينُه، كَسَابَقَنِى زيد ٌفسبقتُه، فأنا أسبقُهُ، ما لم يكن وَاوِىَّ الفاء،
أو يائىّ العين أو اللام، فقياس مضارعه كسر عينه، كواثبته فَوَثَبْتُه، فأنا
أثِبه، وبايعته فبِعته، فأنا أبيعه، وراميته فرمَيْته، فأنا أرمِيه.
أوزان الرباعىِّ المجرَّد وملحقاته
للرباعىّ المجرَّد وزن واحد، وهو فعلل، كدحرج يدحرج، وَدَرْبَخ يدربخ. ومنه أفعال
نحتتها العرب من مركبات، فتحفظ ولا يقاس عليها، كبسمَلَ: إذا قال: بسم الله، وحوقل
إذا قال: لا حول ولا قوة إِلا بالله، وطَلْبَق إذا قال: أطال الله بقاءك،
ودَمْعَزَ إذا قال: أدام الله عزك، وجَعْفَل إذا قال: جعلنى الله فداءك.
ومحلقاته سبعة:
الأول: فَعْلَلَ، كجلبَبَه؛ أى ألبسه الجلباب.
الثانى: فوْعل، كجوربه؛ أى ألبسه الجَوْرب.
الثالث: فعْوَل، كرَهْوَك فى مِشيته؛ أى أسرع.
الرابع: فَيْعَل، كَبَيْطرَ؛ أى أصلح الدواب.
الخامس: فعْيَلَ، كشَرْيَفَ الزرعَ. قطع شِريافه.
السادس: فعْلَى، كَسَلْقَى: إذا استلقى على ظهره.
السابع: فعنَلَ، كقلنسه: ألبسه القلنسوة.
والإلحاق: أن تزيد فى البناء زيادة، لتلحقه بآخرَ أكثر منه، فيتصرف تصرفه.
أوزان الثلاثىِّ المزيد فيه
الفعل الثلاثىّ المزيد فيه ثلاثة أقسام؛ ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان،
وما زيد فيه ثلاثة أحرف. فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة، بخلاف الاسم، فإنه
يبلغ بالزيادة سبعة؛ لِثقل الفعل، وخِفة الاسم، كما سيأتى.
فالذى
زيد فيه حرف واحد، يأتى على ثلاثة أوزان:
الأول: أَفْعَل، كأكرم وأولَى، وأعطى، وأقام، وآتى، وآمن، وأقرّ.
الثانى: فاعَلَ، كقاتل، وآخذ، ووالى.
الثالث: فَعَّلَ بالتضعيف، كفرَّح، وزكىَّ، وَوَلَّى، وَبرَّأ.
والذي زيد فيه حرفان يأتى على خمسة أوزان:
الأول: انفعَلَ، كانكسر، وانشقّ، وانقاد، وانمحى.
الثانى: افتعلَ، كاجتمع، واشتقّ، واختار، وادَّعَى، واتصل، واتقى، واصطبر، واضطرب.
الثالث: افْعَلَّ كاحمرَّ، واصفرَّ، واعورَّ. وهذا الوزْن يكون غالبًا فى الألوان
والعيوب، وندر فى غيرهما، نحو: ارْفَضّ عَرَقا، واخضلَّ الروضُ، ومنه ارْعَوَى.
الرابع: تفعَّلَ، كتعلَّم وتزكّى، ومنه اذّكر واطَّهَّر.
الخامس: تَفاعَلَ كتباعَدَ وتَشاوَرَ، ومنه تبارك وتعالى، وكذا اثَّاقل، وادَّارك.
والذى زيد فيه ثلاثة أحرف يأتى على أربعة أوزان:
الأول: استفعلَ، كاستخرج، واستقام.
الثانى: افْعَوعَلَ، كاغدودَنَ الشعر: إذا طال، واعشوشب المكان: إذا كثر عُشْبه.
الثالث: افْعَالّ كاحمارّ واشهابّ: قَوِيَت حُمرته وشُهْبته.
الرابع: افْعَوَّلَ كاجلوَّذ: إذا أسرع، واعلَوَّطَ: أى تعلق بعنق البعير فركبه.
أوزان الرباعىِّ المَزِيد فيه وملحقاته
ينقسم الرباعىّ المزيد فيه إلى قسمين: ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان،
فالذى زيد فيه حرف واحد ووزن واحد، وهو تفَعللَ كتدحرجَ.
والذى زيد فيه حرفان وزنان:
الأول: افعنلَلَ كاحرنجم.
الثانى: افعلَلَّ كاقشعرّ، واطمأنَّ.
والملحق بما زيد فيه حرف واحد يأتى على ستة أوزان:
الأول: تفعلَلَ، كتجَلببَ.
الثانى: تفعولَ، كترْهَوَك.
الثالث: تُفَيْعَل، كتشيطَنَ.
الرابع: تَفَوْعَل، كتجوْربَ.
الخامس: تَمَفْعَل، كتمسكنَ.
السادس: تَفَعْلَى، كتسلقى.
والملحق بما زيد فيه حرفان، وزنان:
الأول: افعنلَلَ، كاقعنسَسَ.
والثانى: افعنلَى، كاستلقى.
والفرق
بن وزْنَىِ احرنجمَ واقعنسَس، أن اقعنسَسَ إحدى لاميه زائدة للإلحاق، بخلاف
احرنجم، فإنهما فيه أصليتان.
تنبيهان:
الأول: ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام: ثُلاثىّ، ورُباعىَ،
وخُماسىّ، وسُداسى. وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسَّكَنات: سبعة وثلاثون
بابًا.
الثانى: لا يلزم فى كل مجرَّد أن يستعمل له مَزِيد، ولا فى كل مَزِيد أن يستعمل له
مُجَرَّد، ولا فيما استُعْمِل فيه بعضُ المَزيدات، أن يستعمل فيه البعضُ الرابع
الآخر، بل المَدار فى كل ذلك على السَّماع. ويُسْتثنى من ذلك الثلاثىّ اللازم،
فتطرد زيادة الهمزة فى أوله للتعدية، فيقال فى ذهب: أذهب، وفى خرج: أخرج.
فصل فى معانى صيغ الزوائد
1-أفْعَلَ
تأتى لعدَّة معان:
الأول: التَّعدية، وهى تصيير الفاعل بالهمزة مفعولاً، كأقمت زيداً، وأقعدته وأقرأته.
الأصل: قام زيد وقعد وقرأ، فلما دخلت عليه الهمزة صار زيد مُقاما مُقْعَداً
مُقْرَأ، فإذا كان الفعل لازمًا صار بها متعديًا لواحد، وإذا كان متعدياً لواحد
صار بها متعدياً لاثنين، وإذا كان متعديًا لاثنين، صار بها متعديًا لثلاثة. ولم
يُوجد فى اللغة ما هو متعدّ لاثنين، وصار بالهمزة متعديًا لثلاثة، إلاّ رَأى
وَعَلِم، كرأى وعلم زيدٌ بكراً قائمًا، تقول: أرَيْتُ أو أعلمتُ زيدًا بكرًا
قائمًا.
الثانى: صيرورة شئٍ ذا شئٍ: كألبنَ الرجلُ وأتمرَ وأفلسَ: صار ذا لبَن وتمْر
وفُلُوس.
الثالث: الدخول فى شئ: مكانًا كان أو زمانًا، كأشأم وأعرقَ وأصبحَ وأمسى، أى دخل
فى الشأم، والعراق، والصباح، والمساء.
الرابع: السَّلْب والإزالة: كأَقذيتُ عينَ فلان، وأعجمتُ الكتابَ: أى أزلتُ
القَذَى عن عينه، وأزلتُ عجْمة الكتاب بنقطه.
الخامس: مصادفة الشئ على صفة: كأحمدت زيدًا: وأكرمته، وأبخلته: أي صادفته محمودًا،
أو كريمًا أو بخيلاً.
السادس:
بالاستحقاق، كأحصَدَ الزرع، وأزْوَجَتْ هند؛ أى استحق الزرع الحَصاد، وهند
الزَّواج.
السابع: التعريض، كأرهنت المتاع وأبَعْتُهُ؛ أى عرّضته للرهن والبيع.
الثامن: أن يكون بمعنى استفعل، كأعظمته؛ أى استعظمته.
التاسع: أن يكون مطاوعًا لفعّل بالتشديد، نحو: فطَّرته فأفطر. وبشَّرْته فأبشر.
العاشر: التمكين، كأحفرته النهر؛ أى مكنته من حَفْره.
وربما جاء المهموز كاصله: كسَرَى وأسْرَى، أو أعنى عن أصله لعدم وروده، كأفلح: أى
فاز. وندر مجئ الفعل متعديًا بلا همزة، ولازمًا بها، كنَسَلْتُ ريش الطائر، وأنسلَ
الريشُ، وعرَضْتُ الشئ: أظهرته، وأعرض الشئُ: ظهر، وكَبَبْتُ زيدًا على وجهه،
وأكبَّ زيد على وجهه، وقَشَعَتِ الريحُ السحاب، وأقشعَ السحابُ، قال الشاعر:
*كما أَبْرَقَتْ قوْمًا عِطاشًا غَمامةٌ * فلما رأوْها أَقْشَعَتْ وَتجَلَّتِ*
2- فَاعَلَ
يكثر استعماله فى معنيين:
أحدهما: التشارُك بين اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاً، فيقابله
الآخر بمثله، وحينئذ فيُنْسَب للبادئ نسبة الفاعلية، وللمقابل نسبة المفعولية.
فإذا كان أصل الفعل لازمًا صار بهذه الصيغة متعديًا، نحو ماشيته والأصل: مَشَيت
ومشى.
وفى هذه الصيغة معنى المغالبة، ويُدَلُّ على غَلَبة أحدهما، بصيغة فَعَل من باب
نَصَر، ما لم يكن واوىّ الفاء، أو يائى العين أو اللام، فإِنه يُدَلّ على الغلبة
من باب ضَرَب كما تقدم، ومتى كان "فعَلَ" للدلالة على الغلبة كان
متعديًا، وإن كان أصله لازمًا، وكان من باب نصر أو ضرب على ما تقدم من أىّ باب
كان.
وثانيهما: المُوالاة، فيكون بمعنى أفعل المتعدّى، كـ"واليت" الصوم
وتابعته، بمعنى أوليتُ، وأتبعتُ بعضَه بعضًا.
وربما كان بمعنى فعَّلَ المضعف للتكثير، كضاعفت الشئ وضعَّفته.
وبمعنى فعَلَ، كدافع ودَفع، وسافر وسفَر.
وربما
كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته، كـ{يُخادعون الله}، جعلت معاملتهم لله بما
انطوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر، وإظهار الإسلام، ومجازاته لهم، مخادعة.
3- فَعَّلَ
يكثر استعمالها فى ثمانيةٍ معانٍ، تُشارك أفْعَلَ فى اثنين منها، وهما التعدية، كقوَّمتُ
زيدا وقعَّدته، والإزالة، كجَرَّبتُ البعيرَ وقشَّرْتُ الفاكهة، أى أزلت جَربه،
وأزلت قشره.
وتنفرد بستة:
أولها: التكثير فى الفعل، كجَوَّل، وطَوَّف: أكثر الجَولان والطَّوَفان، أو فى
المفعول، كـ{غلِّقَتِ الأبواب}، أو فى الفاعل، كمّوتَتِ الإِبلُ وبرَّكَتْ.
وثانيها: صيرورة شئ شبه شئٍ، كقوَّس زيدٌ، وحَجَّر الطين؛ أى صار شبه القوس فى
الانحناء والحجر فى الجمود.
وثالثها: نسبة الشئ إلى أصل الفعل، كفسَّقْت زيدًا، أو كفَّرْته: نسبته إلى الفسق،
أو الكفر.
ورابعها: التوجُّه إلى الشئ، كشرَّقْتُ، أو غرَّبت: توجهت إلى الشرق، أو الغرب.
وخامسها: اختصار حكاية الشئ، كهلُّل وسبَّح ولَبّى وأَمَّن: إذا قال لا إله إلا
الله، وسبحان الله، ولَبّيْك، وآمين.
وسادسها: قبول الشئ، كشفَّعت زيدًا: قبلت شفاعته.
وربما ورد بمعنى أصله، أو بمعنى تفعّل، كولىَّ وتوَلَّى وفكَّر وتفكَّر. وربما أغنى
عن أصله لعدم وروده، كعَيَّره إذا عابه، وعجّزت المرأة: بلغت السن العالية.
4-انْفَعَلَ
يأتى لمعنى واحد، وهو المطاوعة، ولهذا لا يكون إلا لازمًا، ولا يكون إلا فى
الأفعال العلاجية. ويأتى لمطاوعة الثلاثى كثيراً، كقطعته فانقطع، وكسرته فانكسر؛
ولمطاوعة غيره قليلا، كأطلقته فانطلق، وعدّلته - بالتضعيف - فانعدل، ولكونه مختصاً
بالعِلاجيات، لا يقال: علَّمته فانعلم، ولا فهّمته فانفهم.
والمطاوعة: هى قبول تأثير الغير.
5- افتعل
اشتهر فى ستة معانٍ:
أحدها: الاتخاذ، كاختتم زيد، واختدم: اتخذ له خاتمًا، وخادمًا.
وثانيهما: الاجتهاد والطلب، كاكتسب، واكتتب، أى اجتهد وطلب الكسب والكتابة.
وثالثها:
التشارك، كاختصم زيد وعمرو: اختلفا.
ورابعها: الإظهار، كاعتذر واعتظم، أى أظهر العُذر، والعَظَمة.
وخامسها: المبالغة فى معنى الفعل، كاقتدر وارتدّ، أى بالغ فى القدرة والرِّدة.
وسادسها: مطاوعة الثلاثىّ كثيرًا، كَعَدَلته فاعتدل، وَجَمعته فاجتمع.
وربما أتى مطاوعًا للمضعَّف ومهموز الثلاثى، كقرَّبته فاقترب، وأنصفته فانتصف. وقد
يجئ بمعنى أصله، لعدم وروده، كارتجل الخطبة، واشتمل الثوب.
6-افْعَلَّ
يأتى غالبًا المعنى واحد، وهو قوة اللون أو العيب، ولا يكون إلا لازمًا، كاحمرَّ
وابيضَّ واعورّ واعمشّ: قويت حمرته وبياضُه وعَوَرُه وعَمَشُه.
7-تَفَعّل
تأتى لخمسة معان:
أولها: مطاوعة فعَّل مضعف العين، كنبَّهته فتنبه، وكسَّرته فتكَسّر.
وثانيها: الاتخاذ، كتوسّد ثوبه: اتخذه وسادة.
وثالثها: التكلف، كتصبّر وتحلّم: تكلَّف الصبر والحلم.
ورابعها: التجنُّب، كتحرّج وتهجّد: تجنب الحَرَج والهُجود، أى النوم.
وخامسها: التدريج، كتجرّعت الماء، وتحفَّظت العلم؛ أى شربت الماء جرْعة بعد أخرى،
وحفظت العلم مسألة بعد أخرى. وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثىّ، لعدم وروده،
كتكلّمَ وَتصدَّى.
8- تَفَاعَلَ
اشتهرت فى أربعة معان:
أولها: التشريك بين اثنين فأكثر، فيكون كل منهما فاعلاً فى اللفظ مفعولاً فى
المعنى، بخلاف فاعَلَ المتقدم، ولذلك إذا كان فاعَلَ المتقدم متعديًا لاثنين، صار
بهذه الصيغة متعديًا لواحد، كجاذب زيد عَمرًا ثوبًا، وتجاذب زيد وعمرو ثوبًا. وإذا
كان متعديًا لواحد صار بها لازمًا، كخاصم زيد عمرا وتخاصم زيد وعمرو.
وثانيها: التظاهر بالفعل دون حقيقته، كتَنَاوَمَ وتغافل وتعامى؛ أى أظهر النوم
والغفلة والعمى، وهى منتفية عنه، وقال الشاعر:
*ليسَ الغَبِىُّ بسيِّدٍ فى قومِهِ * لكنّ سيِّدَ قَوْمِهِ المتغابى*
وقال الحريرى:
*ولما تَعامَى الدهرُ وهو أبو الوَرَى * عن الرُّشْدِ فى أنحائِهِ ومقاصدِهِ*
*تعامَيْتُ
حتى قِيلَ إنى أخو عَمَى * ولا غَرْوَ أن يَحْذُو الفتَى حَذْوُ وَالِده*
وثالثها: حصول الشئ تدريجًا، كتزايد النيلُ، وتواردت الإبل؛ أى حصلت الزيادة
والورود بالتدريج شيئًا فشيئًا.
ورابعها: مطاوعة فاعَلَ، كباعدته فتباعد.
9-اسْتَفْعَلَ
كثر استعمالها فى ستة معان:
أحدها: الطلب حقيقة كاستغفرت الله: أى طلبت مغفرته، أو مجازًا كاستخرجت الذهب من
المعدن، سُمِّيت الممارسة فى إخراجه، والاجتهاد فى الحصول عليه طلبًا، حيث لا يمكن
الطلب الحقيقى.
وثانيها: الصَّيْروة حقيقة، كاستحجر الطين، واستحصن المُهْرُ: أى صار حَجَرا
وَحِصانا، أو مجازًا كما فى المَثَل: "إن البُغاثَ بِأرْضِنا
يَسْتَنْسِرُ".
أى يصير كالنِّسر فى القوة. والبُغَاث: طائر ضعيف الطيران، ومعناه: إن الضعيف
بأرضنا يصير قويا، لاستعانته بنا.
وثالثها: اعتقاد صفة الشئ، كاستحسنتُ كذا واستصوبته، أى اعتقدت حسنه وصوابه.
ورابعها: اختصار حكاية الشئ كاسترجع، إذا قال: {إنا لله وإنا إليه راجعون}.
وخامسها: القوة، كاسْتُهتِرَ واستكبر: أى قوى هِتْرُه وكبره.
وسادسها: المصادفة، كاستكرمت زيدًا أو استبخلته: أى صادفته كريمًا أو بخيلاً.
وربما كان بمعنى أفعَلَ، كأجاب واستجاب، ولمطاوعته كأحكمته فاستحكم، وأقمته
فاستقام.
ثم إنّ باقى الصيغ تدل على قوة المعنى زيادةً عن أصله، فمثلاً اعشَوْشَب المكانُ
يدل على زيادة عُشْبه أكثر من عَشب، واخشوشَنَ يدلّ على قوة الخشونة أكثر من
خَشُن، واحمارّ يدل على قوة اللون، أكثر من حَمِر واحمرَّ، وهكذا.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول -
فى الفعل ) ضمن العنوان ( التقسيم الرابع للفعل: بحسب الجمود والتصرف )
ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف:
فالجامد:
ما لازم صورةً واحدة، وهو إما أن يكون ملازمًا للمضىّ كليس من أخوات كان، وكرب من
فعال المقاربة، وعَسَى وَحَرَىَ واخلولق من أفعال الرجاء، وأنشأ وطفِق، وأخذ وجعل
وعَلِق، من أفعال الشروع، ونِعْمَ وحَبَّذَا فى المدح، وبئس وساء فى الذم، وخلا
وعدا وحاشا فى الاستثناء، على خلاف فى بعضها، وإما أن يكون ملازمًا للأمرية، كهبْ
وتعلَّمْ، ولا ثالث لهما.
والمتصرف: مالا يُلازم صُورةً واحدة، وهو إما أن يكون تامَّ التصرف، وهو يأتى منه
الماضى والمضارع والأمر، كنصر ودحرَج، أو ناقصه وهو ما يأتى منه الماضى والمضارع
فقط، كزال يزَال، وبرِحَ يبْرَحُ، وفَتِئ يَفْتأ، وانفك ينفكُّ، وكاد يكاد، وأوشك
يُوشِك.
فصل فى تصريف الأفعال بعضها من بعض
كيفية تصريف المضارع من الماضى: أن يُزاد فى أوله أحد أحرف المضارعة، مضمومًا فى
الرُّباعىّ كيُدحرج، مفتوحًا فى غيره كيكتب وينطلق ويستغفر.
ثم إن كان الماضى ثلاثياً، سُكّنَتْ فاؤه، وحرِّكت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة،
حسبما يقتضيه نصُّ اللغة، كينصُر ويفتَح ويضرِب، كما تقدم، وإن كان غير ثلاثىّ،
بقى على حاله إن كان مبدوءًا زائدة، كيتشارك ويتعلم ويتدحرج، وإلا كُسر ما قبل
آخره، كيُعَظِّم ويقاتِل، وحذفت الهمزة الزائدة فى أوله إن كانت كيُكْرِم
ويَسْتَخرج.
وكيفية تصريف الأمر من المضارع: أن يُحذَف حرف المضارعة، كَعَظَّم وتشارَكْ
وتَعَلَّمْ، فإن كان أول الباقى ساكنًا زِيدَ فى أوله همزة، كانصُر وفتَحْ
واضرِبْ، وَأكرمْ وانطلِقْ وَاستغفِرْ.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول -
فى الفعل ) ضمن العنوان ( التقسيم الخامس للفعل: من حيث التعدى واللزوم )
ينقسم
الفعل إلى متعدٍّ، ويسمى مُتجاوِزًا، وإلى لازم ويسمى قاصِرًا. فالمتعدى عند
الإطلاق: ما يُجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، نحو حفظ محمد الدرس. وعلامته أن
تتصل به هاء تعود على غير المصدر، نحو زيد ضربه عمرو، وأن يصاغ منه اسم مفعول
تامّ؛ أى غير مقترن بحرف جَرّ أو ظرف، نحو: مضروب.
وهو على ثلاثة أقسام:
ما يتعدى إلى مفعول واحد: وهو كثير، نحو: حفظ محمد الدرس، وفهم المسألة.
وما يتعدى إِلى مفعولين: إِما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وهو ظنّ وأخواتها،
وإمَا لا، وهو أعطى وأخواتها.
وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: وهو باب أعلم وأرى.
واللازم: ما لم يجاوز الفاعل إِلى المفعول به، كقعد محمد، وخرج على.
وأسباب تعدى الفعل اللازم أصالةً ثمانيةٌ:
الأول: الهمزة كأكرم زيدٌ عمرا.
الثانى: التضعيف كفرَّحت زيدا.
الثالث: زيادة ألف المفاعلة، نحو: جالس زيد العلماء، وقد تقدمت.
الرابع: زيادة حرف الجرّ، نحو: ذهبت بِعَلىٍّ.
الخامس: زيادة الهمزة والسين والتاء، نحو: استخرج زيد المال.
السادس: التَّضْمين النحوى، وهو أن تُشْرَب كلمةٌ لازمة معنى كلمة متعدية، لتتعدى
تعديتها، نحو {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ
أَجَلَهُ} ضُمِّن تعزموا معنى تنْوُوا، فعُدِّىَ تعديته.
السابع: حذف حرف الجرّ توسعًا، كقوله:
*تُمرُّونَ الدِّيارَ ولم تَعُوجوا * كلامُكم عَلىَّ إِذَنْ حَرَامُ*
ويطِّرد حذفه مع أنَّ وَأنْ، نحو قوله تعالى: {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إلَه
إلاَّ هُو}، {أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ}.
الثامن: تحويل اللازم إلى باب نَصَرَ لقصد المغالبة، نحو: قاعَدته فقعدته فأنا
أقعُدُه، كما تقدم.
والحق
أن تعدية الفعل سماعية، فما سُمعَتْ تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره، وما لم
تسمع تعديته لا يجوز أن يُعَدَّى بهذه الأسباب. وبعضهم جعل زيادة الهمزة فى
الثلاثى اللازم لقصد تعديته قياسًا مطردًا، كما تقدم.
وأسباب لزوم الفعل المتعدِّى أصالةً خمسةٌ:
الأول: التّضمين، وهو أن تُشْرَبَ كلمةٌ متعدية معنى كلمة لازمة، لتصير مثلها،
كقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} ضُمِّن يخالف
معنى يَخْرُج، فصار لازمًا مثله.
الثانى: تحويل الفعل المتعدى إلى فَعُل بضم العين، لقصد التعجب والمبالغة، نحو:
ضَرُبَ زيدٌ؛ أى ما أضْرَبْه!
الثالث: صيرورته مطاوعًا، ككسرْتُه فانكسر، كما تقدم.
الرابع: ضعف العامل بتأخيره، كقوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ للِرُّؤيَا تَعْبُرونَ}.
الخامس: الضرورة، كقوله:
*تَبَلَتْ فُؤَادَكَ فى المَنَامِ خَرِيدَةٌ * تَسْقِى الَّضجيعَ بِبَارِدٍ
بَسَّامِ*
أى تَسْقِيهِ ريقًا باردًا.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول -
فى الفعل ) ضمن العنوان ( التقسيم السادس للفعل: من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول )
ينقسم
الفعل إلى مبنىّ للفاعل، ويُسمَّى معلومًا، وهو ما ذُكرَ معه فاعله، نحو: حفِظ
محمد الدرس. وإلى مبنىّ للمفعول، ويسمى مجهولاً، وهو ما حُذفَ فاعله وأنيب عنه
غيره، نحو: حُفِظ الدرس. وفى هذه الحالة يجب أن تغيَّر صورة الفعل عن أصلها، فإن
كان ماضيًا غير مبدوء بهمزة وصلٍ ولا تاء زائدة، وليست عينه ألفا، ضُمَّ أولُه
وكُسرَ ما قبل آخره ولو تقديرًا، نحو: ضُرِب علىّ، ورُدَّ المبيع. فإن كان مبدوءًا
بتاء زائدة، ضُمَّ الثانى مع الأولَّ، نحو: تُعُلِّمَ الحساب، وتقُوتِلَ مع زيد.
وإن كان مبدوءًا بهمزة وصل ضُمَّ الثالث مع الأول نحو: انطُلق بزيد، واسْتُخرج
المعدن. وإن كانت عينه ألفا قلبت ياء، وكُسر أوله، بإخلاص الكسر، أو إشمامه الضم،
كما فى قال وباع واختار وانقاد، تقول: بِيع الثوب، وقيل القول، واخْتِيرَ هذا،
وانْقِيد له. وبعضهم يُبْقى الضم، ويقلب الألف واوًا، كما فى قوله:
*لَيْتَ، وهل ينفعُ شيئًا لَيْتُ، * ليتَ شَبَاباً بُوعَ فاشترَيْتُ*
وقوله:
*حُوكَتْ عَلَى نِيرَيْنِ إِذْ تُحَاكُ * تَخْتَبِطُ الشَّوْكَ ولا تُشَاكُ*
رُوِيا بإخلاص الكسر، وبه مع إشمام الضم، وبالضم الخالص: وتُنْسب اللغة الأخيرة
لبنى فَقْعسٍ وَدُبَيْر، وادَّعى بعضهم امتناعها فى انفعل وافتعل. هذا إذا أَمِنَ
اللبس. فإِن لم يؤمَن، كُسِر أول الأجوف الواوىّ، إن كان مضارعه على يفُعل بضم
العين، كقول العبد: سِمت؛ أى سامنى المشترى، ولا تضمَّه لإيهامه أنه فاعل
السَّوْم، مع أن فاعله غيره، وضُمّ أول الأجوف اليائىّ، وكذا الواوىّ، إن كان
مضارعه على يفعَل، بفتح العين، نحو: بُعتُ: أى باعنى سيدى، ولا يُكْسَرُ، لإيهامه
أنه فاعل البيع، مع أن فاعله غيره، وكذا خُفْتُ بضم الخاء؛ أى أخافنى الغير.
وأوجب
الجمهور ضمَّ فاء الثلاثىّ المضعف، نحو: شُدَّ وَمُدَّ، والكوفيون أجازوا الكسر،
وهى لغة بنى ضَبَّة، وقد قُرِئَ {هذِهِ بِضَاعَتُنَا رِدَّت إلينا} {ولو رِدُّوا
لَعَادوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} بالكسر فيهما، وذلك بنقل حركة العَين إلى الفاء،
بعد توهم سلْب حركتها، وجوَّز ابن مالك والإشمامَ فى المضعف أيضًا حيث قال:
*(وَمَا لِبَاعَ قَد يُرَى لِنَحْوِ حَبّ)*
وإن كان مضارعًا ضُمَّ أوله، وفتح ما قبل آخره ولو تقديرًا، نحو: يُضْرَبُ عَلِىّ،
ويُرَدّ المبيع.
فإن كان ما قبل آخر المضارع مدًّا، كيَقول ويبيع، قُلب ألفا، كيُقال، ويُباع.
ولا يُبْنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين المختصين أو
المجرور الذى لم يلزم الجارُّ له طريقة واحدة، نحو: سِيرَ يومُ الجُمْعة، وَوُقِفَ
أمام الأمير، وجُلس جلوسٌ حسن، وفُرِح بقدوم محمد، بخلاف اللازم حالة واحدة، نحو:
عندَ، وإِذَا، وسُبْحَانَ، ومَعَاذَ.
تنبيه: ورد فى اللغة عدة أفعال على صورة المبنىّ للمجهول، منها: عُنِىَ فلان
بحاجتك؛ أى اهتمّ. وَزُهِىَ علينا؛ أى تكبَّرَ. وَفُلِجَ: أصابه الفالِج، وحُمَّ:
استحرَّ بدنه من الحُمَّى. وسُلَّ: أصابه السُّل. وجُنَّ عقله: استتر. وغُمّ
الهِلال: احتجب. وغُمَّ الخبرُ: استعجم. وأُغمِى عليه: غُشِىَ، والخبر: استعجم.
وشُدِهَ: دَهِشَ وتحيّر. وامتُقِع أو انتُقِع لَونُهُ: تغيّر.
وهذه الأفعال لا تنفك عن صورة المبنىّ للمجهول، ما دامت لازمة، والوصف منها على
مفعول، كما يُفهم من عباراتهم، وكأنهم لاحظوا فيها وفى نظائرها أن تنطبق صورة
الفعل على الوصف، فأتَوا به على فُعِل بالضم، وجعلوا المرفوع بعده فاعلا.
ووردت
أيضاً عَدّة أفعال مبنية للمفعول فى الاستعمال الفصيح، وللفاعل نادرًا أو شذوذًا،
وهذه مرفوعها يكون بحسب البنية، فمن ذلك بهِتَ الخصمُ وبَهُت، كفرح وكَرُم،
وَهُزِلَ وهَزَلَهُ المرض. ونُخِىَ ونَخَاه، من النَّخوة، وَزُكِمَ وَزَكَمَهُ
الله، وَوُعِكَ وَوَعَكَه، وَطُلَّ دَمُه وَطلَّه، وَرُهِصَت الدابة وَرَهصَها
الحَجَر، ونُتِجت الناقة ونَتجَها أهلُها.. إلى آخر ما جاء من ذلك، وعدَّه
اللغويون من باب عُنِىَ.
وعلاقة هذا المبحث باللغة أكثر منها بالصرف.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الأول -
فى الفعل ) ضمن العنوان ( التقسيم السابع للفعل: من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد )
ينقسم الفعل إلى مؤكَّد، وغير مؤكد.
فالمؤكَّد: ما لحقته نون التوكيد. ثقيلة كانت أو خفيفة، نحو: {لَيُسْجَنَنَّ
وَلَيَكُوننْ مِنَ الصَّاغِرِينَ}.
وغير المؤكد: ما لم تلحقه، نحو: يُسْجَنُ، ويكون.
فالماضى لا يؤكَّد مطلقًا، وأما قوله:
*دامَنَّ سَعْدُكِ لو رحمْتِ مُتَيَّما * لولاكِ لم يكُ للصَّبابة جَانِحا*
فضرورةٌ شاذة، سهَّلَها ما فى الفعل من معنى الطلَب، فعومل معاملة الأمر.
كما شذ توكيد الاسم فى قول رُؤْبة بن العجَّاج:
*(أقَائِلنّ أحْضِروا الشُّهُودَا)*
والأمر يجوز توكيده مطلقًا، نحو: اكْتُبَنَّ واجْتَهِدَنْ.
وأما المضارع فله ست حالات:
الأولى: أن يكون توكيده واجبًا. الثانية: أن يكون قريبًا من الواجب. الثالثة: أن
يكون كثيرًا. الرابعة: أن يكون قليلاً. الخامسة: أن يكون أقلّ. السادسة: أن يكون
ممتنعًا.
1- فيجب تأكيده إذا كان مُثْبَتًا، مستقبلاً، فى جواب قسمَ، غيرَ مفصول من لامه
بفاصل، نحو: {وَتَاللهِ لأكِيدَنَّ أصْنَامَكُمْ}. وحينئذٍ يجب توكيده باللام
والنون عند البصريين، وخُلُوُّه من أحدهما شاذ أو ضرورة.
2-
ويكون قريبًا من الواجب إذا كان شرطًا لإنِ المؤكَّدَة بما الزائدة، نحو:
{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً}، {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ}،
{فَإمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أحَداً فَقُولِى إنّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ
صَوْماً}.
وَمِن تَرْك توكيده قوله:
*يا صَاحِ إِمَّا تَجِدْنِى غيرَ ذى جِدَةٍ * فمَا التَّخَلِّى عَنِ الخلاّنِ مِنْ
شِيَمِى*
وهو قليل فى النثر، وقيل يختص بالضرورة.
3- ويكون كثيرًا إذا وقع بعد أداة طلب: أمْرٍ، أَوْ نَهْى، أَوْ دُعَاءٍ، أو
عَرْضٍ، أو تمنٍّ، أو استفهام، نحو: لَيَقومن زيد، وقوله تعالى:
{وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ}، وقول خِرْنِق
بنت هَفَّان:
*لا يَبْعَدَن قومى الَّذِينَ هُمُ * سُمُّ العُداةِ وآفَةُ الجُزُرِ*
وقول الشاعر:
*هلاَّ تمُنِّنْ بوَعْدٍ غيْرَ مُخْلِفَةٍ * كما عهِدْتُكِ فى أيَّامِ ذِى سَلَمِ*
وقوله:
*فَلَيْتَكِ يَوْمَ المُلْتَقَى ترَيِننَّى * لِكَىْ تْعلَمِى أنِّى امْرُؤٌ بِكَ
هَائِمُ*
وقوله:
*أفَبَعْدَ كِنْدَةَ تَمْدَحَنَّ قَبِيلاَ*
4- ويكون قليلا إذا كان بعد لا النافية، أو ما الزائدة، التى لم تُسْبق بإنِ
الشرطية، كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْكُم خَاصَّةً}. وإنما أُكِّد مع النافى، لأنه يشبه أداة النهى صورةً، وقوله:
*إذا ماتَ منهُمْ سيِّدٌ سَرَقَ ابْنُهُ * وَمِنْ عِضَةٍ ما يَنْبُتَنَّ
شَكِيرُها*
وكقول حاتم:
*قليلاً به ما يَحْمَدَنَّكَ وَارِثٌ * إَذا نَالَ مما كنْتَ تَجْمَعُ مَغْنَما*
وما زائدة فى الجميع، وشَمَل الواقعة بعد "رُبّ" كقول جَذِيمةَ الأبرش:
*رُبَّمَا أوْفَيْتُ فى عَلَمٍ * ترْفَعَنْ ثوْبى شَمالاتُ*
وبعضهم منعها بعدها، لمضىَّ الفعل بعد رُبَّ معنًى، وخصَّه بعضُهم بالضرورة.
5-
ويكون أقل إذا كان بعد "لَم" وبعد أداة جزاء غير "إمَّا"،
شرطاً كان المؤكد أو جزاء، كقوله فى وصف جَبَل:
*يَحْسَبُهُ الْجَاهل ما لَم يَعْلَما * شيخاً عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّما*
أى يعلمن،
وكقوله:
*مَنْ تَثْقَفَنْ منهم فليْس بآئبٍ * أبدا وقَتْلُ بنى قُتَيْبَةَ شَافى*
وقوله:
*ومَهْمَا تَشَأْ منه فزارةُ تمْنَعَا"*
أى تمنعَنْ.
6- ويكون ممتنعًا إذا انتفتْ شروطُ الواجب، ولم يكن مما سبق، بأن كان فى جواب قسم
منفىّ، ولو كان النافى مقدرًا، نحو: "تالله لا يذهبُ العُرْف بين الله
والناس"، ونحو قوله تعالى: {تَاللهِ تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُف} أى لا تفتأ. أو
كان حالاً: كقراءة ابن كثير: {لأقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}. وقول الشاعر:
*يمينًا لأبغِضُ كلَّ امرِئٍ * يزخرفُ قولاً ولا يفْعَلُ*
أو كان مفصولا من اللام، نحو: {وَلَئِن مُتُّمْ أوْ قُتِلْتُمْ لإلِى اللهِ
تُحْشَرُونَ}، ونحو: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}.
حُكْمُ آخِرِ الفعل المؤكَّد بنون التوكيد
إذا لحقت النون بالفعل: 1- فإن كان مسندًا إلى اسم ظاهر، أو إلى ضمير الواحد
المذكر، فُتِحَ آخره لمباشرة النون له، ولم يحذف منه شئ، سواء كان صحيحًا أو
معتلاً، نحو "لَيَنْصُرَنَّ زيد، وَلَيَقضِيَنَّ، وَلَيَغْزُوَنَّ،
وَلَيَسْعَيَنَّ" بردِّ لام الفعل إلى أصلها.
2- وإن كان مسندًا إلى ضمير الاثنين، لم يُحْذَفْ أيضًا من الفعل شئ، وحُذِفت نون
الرفع فقط، لتوالى الأمثال، وكُسِرَت نون التوكيد، تشبيهًا لها بنون الرفع، نحو
لَتَنْصُرَانِّ يا زيدان، وَلَتَقضِيانِّ، ولَتغزُوَانِّ، وَلَتَسْعَيانِّ.
3- وإن كان مسندًا إلى واو الجمع، فإن كان صحيحًا حذفت نون الرفع لتوالى الأمثال،
وواو الجمع لالتقاء الساكنين، نحو: لَتَنصُرنَّ يا قوم.
وإن
كان ناقصًا وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة، حذفت أيضًا لام الفعل زيادة على ما
تقدم، نحو: لَتَغْزُنّ وَلَتَقضُنَّ يا قوم، بضم ما قبل النون فى الأمثلة الثلاثة،
للدلالة على المحذوف، فإن كانت العين مفتوحة، حُذفت لام الفعل فقط، وبقى فتح ما
قبلها، وحرِّكت واو الجمع بالضمة، نحو: لَتَخْشَوُنَّ وَلَتَسْعَوُنَّ.
وسيأتى الكلام على ذلك فى الحذف لالتقاء الساكنين، إن شاء الله تعالى.
4- وإن كان مسندًا إلى ياء المخاطبة، حذفت الياء والنون، نحو: لتَنْصُرِنّ يا
دعدُ، ولتَغْزِنّ ولتَرْمِنَّ، بكسر ما قبل النون، إلا إذا كان الفعل ناقصًا،
وكانت عينه مفتوحة، فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر، مع فتح ما قبلها، نحو: لتَسْعَيِنَّ
ولتَخْشَيِنَّ يا دَعدُ.
5- وإن كان مسندًا إلى نون الإناث، زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد، وكسرت نون
التوكيد، لوقوعها بعد الألف، نحو: لتَنصُرْنانِّ يا نسوة ولتَسْعَيْنَانِّ،
ولتَغْزُونَانِّ، ولَترْمِينَانِّ.
والأمر مثل المضارع فى جميع ذلك، نحو: اضربَنّ يا زيد، واغزُوَنَّ وارْمِيَنَّ
واسْعَيَنّ. ونحو: اضْرِبانِّ يا زيدانِ واغزِوانِّ وارمِيانِّ واسعِيانِّ. ونحو:
اضرُبنَّ يا زيدون واغْزُنّ واقضُنّ، ونحو: اخْشَوُنَّ واسْعَوُنّ... إلخ.
* وتختص النون الخفيفة بأحكام أربعة:
الأول: أنها لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الإناث؛ لالتقاء الساكنين
على غير حَدِّه، فلا تقول اخْشَيْنانْ.
الثانى: أنها لا تقع بعد ألف الاثنين، فلا تقول: لا تضْرِبانْ يا زيدان، لما تقدم.
ونقل الفارسىّ عن يونس إجازته فيهما، ونظَّرَ له بقراءة نافع: {ومَحياىْ}، بسكون
الياء بعد الألف.
الثالث: أنها تُحذف إذا وليها ساكن، كقول الأضبط بن قُربع السَّعْدِىِّ:
*فَصِلْ حِبالَ البَعيدِ إِنْ وَصَلَ الْحَبْلَ * وأقصِ القَرِيبَ إِنْ قَطَعَهْ*
*ولا تُهِينَ الفقيرَ عَلَّكَ أَنْ * تَرْكَعَ يَوْمًا والدَّهْرُ قد رَفَعَه*
أى
لا تهينَنَّ
الرابع: أنها تُعْطَى فى الوقف حكم التنوين، فإِن وقعت بعد فتحة قلبت ألفًا، نحو:
{لنسْفَعًا}، و{ليكُونًا}، ونحو:
*وإِيّاكَ وَالميْتَاتِ لا تَقْرَبَنَّهَا * ولا تعبُدِ الشَّيْطانَ والله
فاعْبُدَا*
وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حُذِفت، ورُدَّ ما حذف فى الوصل لأجلها. تقول فى الوصل
اضرُبنَّ يا قوم، واضرِبنَّ يا هند، والأصل: اضْرِبُون واضْرِبِينْ، فإذا وقفتَ
عليها حذفت النون، لشبهها بالتنوين، فترجع الواو والياء؛ لزوال الساكنين، فتقول:
اضربوا، واضربى.
تتمة
فى حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها
1- حكم الصحيح السالم: أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به، نحو
كتبتُ، وكتَبُوا، وكتَبَتْ.
2- وحكم المهموز: كحكم السالم، إلا أن الأمر من أخَذَ وأَكلَ، تحذف همزته مطلقًا،
نحو خُذْ وكُلْ، ومن أمر وسأل فى الابتداء، نحو مُرُوا بالمعروف، وانْهَوْا عن
المنكر، ونحو {سَلْ بَنِى إسْرَائِيلَ}. ويجوز الحذف وعدمه إذا سُبقا بشئ، نحو قلت
له: مُرْ، أو اؤْمُرْ، وقلت له: سلْ، أو اسأل.
وكذا تحذف همزة رأى، أى عين الفعل من المضارع والأمر، كيرى ورَه، الأصل: يَرْأَى،
نُقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعدها، والأمر محمول
على المضارع.
وتحذف همزة أرَى، أى عينه أيضًا فى جميع تصاريفه، نحو أرَى وَيُرى وأرِه.
وإذا اجتمعت همزتان فى أول الكلمة وسكنت ثانيتهما، أبدلت مدا من جنس حركة ما
قبلها، كما سيأتى.
3- حكم المضعف الثلاثى ومزيده: يجب فى ماضيه الإدغام، نحو: مدّ واستمدّ، ومدُّوا
واستمدوا، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، فيجب الفك، نحو مَدَدْتُ، والنسوة
مَدَدْن، واستمددت، والنسوة استمددن.
ويجب
فى مضارعه الإدغام أيضًا، نحو يَرُدّ ويستردُّ، ويردُّون ويستردون، ما لم يكن
مجزومًا بالسكون، فيجوز الأمران، نحو: لم يَرُدّ ولم يَرْدُدْ، ولم يستردّ ولم
يسترددْ، وما لم تتصل به نون النسوة، فيجب الفك، نحو: يَردُدْن ويستردِدْن. بخلاف
ما إذا كان مجزومًا بغير السكون، فإِنه كغير المجزوم، تقول: لم يردُّوا، ولم
يستردّوا.
والأمر كالمضارع المجزوم فى جميع ذلك نحو رُدَّ يا زيدُ واردُدْ، واسترِدَّ واسترددْ،
واردُدْن واسترددْن يا نسوة، وردُّوا واستردُّوا.
4- حكم المثال: قد تقدم أنه إما يائىّ الفاء، أو واويُّها.
فاليائىّ: لا يُحذف منه فى المضارع شئ، إلا فى لفظين حكاهما سيبويه، وهما يَسرَ
البعيرُ يَسِرُ، كوعَدَ يَعِدُ، من اليَسْر كالضَّرْب: أى اللين والانقياد،
ويَئِسَ يَئِسُ فى لغة.
والواوىّ: تحذف فاؤه من المضارع، إذا كان على وزن "يفعِل" بكسر العين
وكذا من الأمر؛ لأنه فرعه، نحو وعَد يعِد عِدْ، وَوَزَنَ يَزِنُ زِنْ. وأما إذا
كان يائيًا كيَنَعَ يَيْنع، أو كان واويًا، وكان مضارعه على وزن يفعُل بضم العين،
نحو وَجُه يَوْجُه، أو على وزن يَفْعَل بفتحها نحو وجِل يَوْجَل، فلا يُحْذف منه
شئ. وسُمع: يا جَل ويَيْجَل. وشذَّ: يَدَع، ويَزَع، ويَذَر، ويَضع، وَيقَع،
ويَلَعُ، ويَلَغ، ويَهَب، بفتح عينها، وقيل لا شذوذ، إذ أصلها على وزن يفعِل بكسر
العين، وإنما فتحت لمناسبة حرف الحلق، وُحمِل يذَر على يَدَع.
أما الحذف فى يَطأ ويَسَعُ فشاذّ اتفاقًا، إذ ماضيهما مكسور العين، والقياس فى عين
مضارعه الفتح.
وأما مصدر نحو وَعَدَ وَوَزَنَ، فيجوز فيه الحذف وعدمه، فتقول: وعد يعد عِدَةً
وَوَعْدًا، وَوَزَن يزن زِنَة وَوَزنًا، وإذا حذفت الواو من المصدر عوَّضت عنها
تاء فى آخره، كما رأيت، وقد تحذف شذوذاً، كقوله:
*إِن الخليطَ أَجَدُّوا البَيْن فانجرَدُوا * وأخلفوك عِدَ الأمرِ الذى وَعَدُوا*
وشذ
حذفُ الفاء فى نحو رِقة: للفضة، وحِشَة بالمهملة للأرض الموحِشة، وجِهة للمكان
المتجَّهِ إليه، لانتفاء المصدرية عنها.
5- حكم الأجوف: إن أعِلَّت عينه، وتحركت لامه، ثبتت العين.
وإن سكنت بالجزم، نحو: لم يقل، أو بالبناء فى الأمر، نحو: قُلْ، أو لاتصاله بضمير
رفع متحرِّك فى الماضى، حُذفت عينه، وذلك فى الماضى، بعد تحويل فعَلَ بفتح العين
إلى فعُل بضمها إن كان أصل العين واوًا كقال، وإلى فعِل بالكسر إن كان أصلها ياء
كباع، وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما، لتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو
فى الأوَّل، وياء فى الثانى، تقول: قُلْتُ وَبِعْتُ، بالضم فى الأوَّل، والكسر فى
الثانى، بخلاف مضموم العين ومكسورها، كطال وخافَ، فلا تحويل فيهما، وإنما تنقل
حركة العين إلى الفاء، للدلالة على البِنية، تقول: طُلْتُ وَخِفْتُ، بالضم فى
الأوْل، والكسر فى الثانى.
هذا فى المجرَّد، والمزيدُ مثله فى حذف عينه إن سكنت لامه، وَأَعِلَّت عينه
بالقلب، كأقمت واستقمت، واخترت وانقدت. وإن لم تعلّ العين لم تحذف، كقاوَمْتُ،
وَقَوَّمْتُ.
6-حكم الناقص: إذا كان الفعل الناقص ماضيًا، وأسند لواو الجماعة، حذفَ منه حرف
العلة، وبقى فتحُ ما قبله إن كان المحذوف ألفًا، ويضم إن كان واواً أو ياء، فتقول
فى نحو سَعَى: سَعَوْا، وفى سَرُوَ وَرَضِىَ: سَرُوا وَرَضُوا.
وإذا أُسْنِد لغير الواو من الضمائر البارزة، لم يحذف حرف العلة، بل يبقى على
أصله، وتقلب الألف واواً أو ياء تبعًا لأصلها إِن كانت ثالثة، فتقول فى نحو
سَرُوَ: سَرُونَا. وفى رَضِىَ: رضِينا، وفى غزا ورمى: غَزَوْنا وَرَمَيْنا،
وَغَزَوَا وَرَميا. فإن زادت على ثلاثة قلبت ياء مطلقًا، نحو أعْطَيْتُ واستعطيت.
وإذا لحقت تاء التأنيث ما آخِره ألف حذفت مطلقًا، نحو رَمَتْ، وأعطت، واستعطت،
بخلاف ما آخره واو أو ياء، فلا يحذف منه شئ.
وأما
إذا كان مضارعًا، وأسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة، فيحذف حرف العلة، ويفتح ما
قبله إن كان المحذوف ألفًا، كما فى الماضى، ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة، أو
ياء المخاطبة، إن كان المحذوف واوًا أو ياء، فتقول فى نحو يسعَى: الرجال
يَسْعَوْنَ، وتَسْعَيْن يا هند، وفى نحو يغزُو ويرمى: الرجال يغزُون ويرمُون،
وتغزِين وترمين يا هند.
وإذا أسند لنون النسوة لم يحذف حرفُ العلة، بل يبقى على أصله، غير أن الألف تقلب
ياء، فتقول فى نحو يغزو ويرمى: النساء يغزُون ويرمِين، وفى نحو يسعَى: النساء
يسعَيْن.
وإذا أسند لألف الاثنين لم يحذَف منه شئ أيضًا، وتقلب الألف ياء، نحو الزيدان
يغزُوَان ويرميان وَيسعَيان.
والأمر كالمضارع المجزوم، فتقول: اغزُ، وارمِ، وَاسعَ، وَاغْزُوَا، وَارْمِيَا،
وَاسْعَيَا، وَاغْزُوا، وَارْمُوا، وَاسْعَواْ.
7- حكم اللفيف: إن كان مفروقًا، فحكم فائه مطلقًا حكم فاء المثال، وحكم لامه حكم
لام الناقص، كوقَى. تقول: وَقَى يَقِى قِهْ، وإن كان مقرونًا: فحكمه حكم الناقص،
كطوى يطوِى اطْوِ... إلى آخره.
تنبيه - يتصرف الماضى باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى ثلاثَةَ عَشَرَ وَجْهًا:
اثنان للمتكلم نحو: نَصَرْتُ، نصرنا.
وخمسة للمخاطب نحو: نصرتَ، نصرتِ، نصرتما، نصرتُم، نصرتُنَّ.
وستة للغائب نحو: نصرَ، نصرَا، نصرُوا. نصرَتْ، نصرَتَا، نصرْنَ.
وكذا المضارع، نحو أنصرُ، ننصُر. تنصُر يا زيد، تنصُران يا زيدان، أو يا هندان،
تنصُرون، تنصرين، تنصُرْنَ. ينصُر، ينصُران، ينصرُون، هند تنصرُ، الهندان تنصران،
النسوة يَنْصرن.
ومثله المبنى للمجهول.
ويتصرف الأمر إلى خمسة: انصُرْ، انصرَا، انصُرُوا، انْصُرى، انصُرْنَ.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثانى -
فى الكلام على الاسم ) ضمن العنوان ( التقسيم الأول للاسم من حيث التجرد والزيادة
)
ينقسم
الاسم إلى مجرَّد ومزيد، والمجرد إلى ثُلاثىّ، ورُباعىّ، وخماسىّ.
(1)- فأوزان الثلاثىّ المتفق عليها عشْرة:
1- فَعْل: بفتح فسكون، كسَهْم وسَهْل.
2- فَعَل: بفتحتين: كقَمَر وبَطَل.
3- فَعِل: بفتح فكسر، ككَتِف، وحَذِر.
4- فَعُل: بفتح فضم، كعَضُد وَيقُظ.
5- فِعْل: بكسر فسكون، كحِمْل ونِكْس.
6- فِعَل: بكسر ففتح، كَعِنَب وزِيمَ: أى متفرق.
7- فِعِل: بكسرتين: كإِبِل وبِلِز أى ضخمة، وهذا الوزن قليل، حتى ادَّعى سيبويه
أنه لم يرد منه إلا إِبل.
8- فُعْل: بضم فسكون، كقُفْل وحُلْو.
9- فُعَل: بضم ففتح، كصُرَد وحُطَم.
10- فُعُل: بضمتين، كعُنُق، وناقة سُرُح: أى سريعة.
وكانت القسمة العقلية تقتضى اثنى عشر وزنًا، لأَن حركات الفاء ثلاثة وهى الفتح
والضم والكسر، ويجرى ذلك فى العين أيضًا، ويزيد السكون، والثلاثة فى الأربعة باثنى
عشرة. يَقِلُّ "فُعِل" بضم فكسر، كدُئِل: اسم لدويْبة، أو اسم قَبيلة؛
لأن هذا الوزن قُصِد تخصيصه بالفعل المبنى للمجهول.
وأما "فِعُل" بكسر فضم، فغير موجود، وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم.
ويُجاب عن قراءة بعضهم: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحِبُك} بكسر فضم، بأنه مِن تداخل
اللغتين فى جزأىِ الكلمة، إذ يقال حُبُك بضمتين، وحِبِك بكسرتين، فالكسر فى الفاء
من الثانية، والضم فى العين من الأولى. وقيل كُسِرَت الحاء إتباعًا لكسرة تاء
"ذات".
ثم إن بعض هذه الأوزان قد يُخفَّف، فنحو كَتِف، يخفف بإسكان العين فقط أو به مع
كسر الفاء. وإذا كان ثانيه حرف حلق، خُفِّف أيضًا مع هذين بكسرتين فيكون فيه
أربَعُ لغات كفخذ. ومثل الاسم فى ذلك الفعل كشَهِد، ونحو عَضُد وإِبِل وعُنُق،
يخفَّف بإِسكان العين.
(2)- وأوزان الاسم الرباعى المجرّد المتفق عليها خمسة:
1- فَعْلَل: بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، كجَعفر.
2- وَفِعْلِل: بكسرهما وسكون ثانيه كزِبْرِج للزينة.
3-
وفُعْلُل: بضمهما وسكون ثانيه، كبُرْثُنٍ لِمَخْلب الأسد.
4- وفِعَلّ: بكسر ففتح مشدَّدة كقِمَطْر، لوعاء الكتب.
5- وفِعْلَل: بكسر فسكون ففتح كدِرْهَم.
وزاد الأخفش وزن "فُعْلَل" بضم فسكون ففتح، كَجُخْدَب: اسم للأسد.
وبعضهم يقول: إنه فرع جُخْدُب بالضم. والصحيح أنه أصل، ولكنه قليل.
(3)- وأوزان الخماسىِّ أربعة:
1- فَعَلَّل: بفتحات، مُشدد اللام الأولى، كسفرجل.
2- وفَعْلَلِلٌ: بفتح أوله وثالثه، وسكون ثانيه، وكسر رابعه، كَجَحْمَرِش للمرأة
العجوز.
3- وفِعْللَّ: بكسر فسكون ففتح، مشدد اللام الثانية كقِرْطعب: للشئ القليل.
4- وفُعَلِّل: بضم ففتح فتشديد اللام الأولى مكسورة كقُذَعْمِل، وهو الشئ القليل.
تنبيه - قد علمت مما تقدم أن الاسم المتمكن لا تقل حروفه الأصلية عن ثلاثة، إلا
إذا دخله الحذف، كـ: يد، ودم، وعدة، وسه، وأن أوزان المجرد منه عشرون، أو أحد
وعشرون، كما تقدم.
(4)- وأما المزيد فيه فأوزانه كثيرة، ولا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف، كما أن الفعل
لا يتجاوز بالزيادة ستة. فالاسم الثلاثى الأصول المزيد فيه نحو اشهيباب، مصدر
اشهابَّ.
والرباعى الأصول: المزيد فيه نحو احرنجام، مصدر احرنجمت الإبل إذا اجتمعت.
والخماسى الاصول: لا يزاد فيه إلاَّ حرف مَدٍّ قبل الآخر أو بعده نحو: عضرفوط،
مهمل الطرفين، بفتحتين بينهما سكون مضموم الفاء: اسم لدويبة بيضاء، وقبعثرى، بسكون
العين وفتح ما عداها: اسم للبعير الكثير الشعر.
وأما نحو خندريس اسم للخمر، فقيل إنه رباعى مزيد فيه، فوزنه فنعليل، والأوْلى
الحكم بأصالة النون، إذ قد ورد هذا الوزن فى نحو برقعيد: لبلد، ودردبيس: للداهية،
وسلسبيل: اسم للخمر، ولِعينٍ فى الجنة، قيل معرَّب، وقيل عربى منحوت من سلس سبيله،
كما فى "شفاء العليل".
وبالجملة
فأوزان المزيد فيه تبلغ ثلاث مئة وثمانية، على ما نقله سيبويه، وزاد بعضهم عليها
نحو الثمانين، مع ضعف فى بعضها وسيأتى إن شاء الله تعالى، فى باب الزيادة، قانونٌ
به يعرف الزائد من الأصلى.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثانى -
فى الكلام على الاسم ) ضمن العنوان ( التقسيم الثانى للاسم: من حيث الجمود
والاشتقاق )
ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق.
فالجامد: ما لم يؤخذ من غيره، ودلَّ عَلَى حَدَث، أو معنى من غير ملاحظة صفة،
كأسماء الأجناس المحسوسة، مثل رجُل وشجَر وبقَر. وأسماء الأجناس المعنوية، كنصْر
وفَهْم وقيام وقعود وضَوْء ونُور وزَمان.
والمشتق: ما أخِذَ من غيره، ودل على ذات، مع ملاحظة صفة، كعالِم وظريف. ومن أسماء
الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق، كفَهِم من الفهم، ونصرَ من النصر.
وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة، كأورقت الأشجار، وأسبعت الأرض: من
الوَرَق والسَّبُع، وكعقْرَبْتُ الصُّدْغ، وفَلْفَلَت الطعام، ونَرْجَسْتَ الدواء:
من العَقْرب، والنَّرجِس، والفُلْفُل، أى جعلت شعر الصدغ كالعقرب، وجعلت الفلفل فى
الطعام، والنرجس فى الدواء.
والاشتقاق: أخذ كلمة من أخرى، مع تناسب بينهما فى المعنى وتغيير فى اللفظ. وينقسم
إلى ثلاثة أقسام: صغير، وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفًا وترتيبًا، كعلم من
العلم، وفهم من الفهم. وكبير: وهو ما اتحدتا فيه حروفًا لا ترتيبًا، كجبذ من
الجَذْب. وأكبر: وهو ما اتحدتا فيه فى أكثر الحروف، مع تناسب فى الباقى كنَعَقَ من
النَّهْق، لتناسب العين فى المخرج.
وأهم الأَقسام عند الصرفىّ هو الصغير.
وأصل المشتقات عند البصريين: المصدر، لكونه بسيطًا، أى يَدُل على الحَدَث فقط،
بخلاف الفعل، فإنه يَدُلُّ عَلَى الحدث والزمن. وعند الكوفيين: الأصل الفعل، لأن
المصدر يجئ بعده فى التصريف، والذى عليه جميع الصَّرْفيين الأوّل.
ويُشتق
من المصدر عشرة أشياء: الماضى، والمضارع، والأمر، (وقد تقدمت) واسم الفاعل، واسم
المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسما الزمان والمكان، واسم الآلة.
ويلحق بها شيئان: المنسوبُ والمصغر. وكل يحتاج إلى البيان.
المَصْدَر
قد علمتَ أن أبنية الفعل ثُلاثية، ورُباعية، وخُماسية، وسُداسية؛ ولكل بناء منها
مصدر.
مصادر الثلاثىّ
[القياسى]
قد تقدم أن للماضى الثلاثىِّ ثلاثةَ أوزان: فَعَلَ بفتح العين، ويكون متعدِّيًا
كضربه، ولازمًا كقعد، وَفَعِلَ: بكسر العين، ويكون متعديًا أيضًا كفَهِم الدرس،
ولازمًا كرضِىَ، وَفَعُلَ: بضم العين، ولا يكون إلا لازمًا.
1 ، 2 - فأما فَعَل بالفتح، وَفَعِل بالكسر المتعدِّيان، فقياس مصدرهما: فَعْل،
بفتح فسكون، كضَرَب ضَرْبا، وَرَدَّ رَدًّا، وَفَهِمَ فَهْمًا، وَأَمِنَ أمْنا إلا
إن دل الأول على حِرفة، فقياسه فِعالة بكسر أوَّله، كالخِياطة والحِياكة.
3- وأما فَعِل بكسر العين القاصر، فمصدرُه القياسىّ: فَعَل بفتحتين، كفرِح فَرَحا
وَجَوِىَ جَوى، وَشَلَّ شَلَلا؛ إلا إن دل على حِرفة أو وِلاية. فقياسه: فِعالة،
بكسر الفاء، كوَلِىَ عليهم وِلاية. أو دلَّ على لون، فقياسه: فُعْلة، بضم فسكون
كَحَوِى حُوَّة، وَحَمِر حُمْرة، أو كان علاجًا ووصفُه على فاعل، فقياسه،
الفُعُول، بضم الفاء، كأزِف الوقت أزُوفًا، وقدم من السفر قُدُومًا، وصعِد فى
السُّلَّم والدَّرَج صُعُودًا.
4- وأما فعَلَ بالفتح اللازم فقياس مصدره: فُعول، بضم الفاء، كقعدَ قعودًا، وجلس
جلوسًا، ونهض نهوضًا، ما لم تعتلّ عينه، وإلا فيكون على فَعْل بفتح فسكون كَسَيْر،
أو فُعَال كقيام، أو فعالة كنياحة. وما لم يدلَّ على امتناعٍ، وإلا فقياس مصدره
فِعال بالكسر، كأبَى إباءً، ونَفَر نِفارًا، وجَمَحَ جِماحًا، وأبق إباقًا.
أو
على تقلُّب: فقياس مصدره: فعَلان، بفتحات، كجال جَوَلاَنا، وَغَلَى غَلَيانًا. أو
على داء: فقياسه فُعال بالضم كَمَشَى بطنُه مُشَاء. أو على سير فقياسه: فَعِيل،
كرحَلَ رحيلاً، وذَمَل ذَمِيلا. أو على صوت فقياسه: الفُعال بالضم، والفَعيل،
كصَرَخَ صُراخًا، وَعوَى الكلب عُواء، وصَهَل الفرس صَهيلاً، وَنَهَقَ الحمار
نَهِيقًا، وزَأر الأسد زَئيًرا.
أو على حرفة أو وِلاية: فقياس مصدره فِعالة بالكسر، كتَجَر تِجارة، وَعرَف على
القوم عِرَاقة: إذا تكلم عليهم، وسفَر بينهم سِفارة: إذا أصلح.
5- وأما فَعُل بضم العين فقياس مصدره: فعولة، كصعُب الشئ صُعوبة، وعذُب الماء
عذوبة، وفعالة بالفتح، كبلُغ بَلاغة، وفَصُحَ فَصَاحة، وصَرُح صرَاحة.
[السماعى]
وما جاء مخالفًا لما تقدَّم فليس بقياسى، وإنما هو سماعىّ، يُحفظ ولا يُقاس عليه.
فمن الأول: طَلَبَ طَلَبًا، ونَبَتَ نَبَاتًا، وكتَبَ كِتابًا، وحَرَس حِراسةً،
وحَسَب حُسْبانا، وشكر شكْرا، وَذكر ذِكْرا، وكَتَمَ كِتْمانا، وكَذِبَ كَذِبا،
وغَلَب غَلَبة، وَحَمى حِماية، وَغَفَرَ غُفْرانا، وعَصَى عِصيانا، وقَضَى قَضَاء،
وَهَدَى هِدَاية، وَرَأى رُؤية.
ومن الثانى: لَعِبَ لعِبا، ونَضِج نُضْجَا، وكرَهِ كَرَاهِية، وَسَمِن سِمنَا،
وَقَوىَ قُوَّة، وَقَبِل قَبُولا، وَرَحِم رَحْمَة.
ومن الثالث: كَرُم كرَما، وعَظُمَ عِظمَا، وَمَجُد مَجْدا، وَحَسُنَ حُسْنا،
وَحَلُمَ حِلْما، وَجَمُل جَمالا.
مصادر غير الثلاثى
لكل فعل غير ثلاثىّ مصدرٌ قياسىّ:
1-
فمصدر فعَّل بتشديد العين: التفعيل، كطهَّر تطهيرًا، ويسَّر تيسيرًا. هذا إذا كان
الفعل صحيح اللام. وأما إذا كان معتلَّها فيكون على وزن تفْعِلة بحذف ياء التفعيل،
وتعويضها بتاء فى الآخر، كزكىّ تزكِية، وربَّى تربية. وندر مجئ الصحيح على تفعلة،
كجرَّب تجربة، وذكَّر تذكِرة، وبصَّر تبصِرَة وفكَّر تفكرة، وكَمّل تكمِلة، وفرَّق
تَفْرِقة، وكرَّم تَكْرِمة. وقد يعامل مهموز اللام معاملة معتلها فى المصدر،
كَبَرَّأَ تبرئة، وَجَزَّأَ تجزئة، والقياس تبريئًا وتجزيئًا.
وزعم أبو زيد أن ورُود "تفْعِيل" فى كلام العرب مهموزًا أكثر من
"تَفْعِلة" فيه، وظاهر عبارة سيبويه يفيد الاقتصار على ما سُمع، حيث لم
يرد منه إلا نَبّأ تنبيئًا.
2- ومصدر أفْعَلَ: الإفعال كأكرم إكرامًا، وأحسن إحسانًا، هذا إذا كان صحيح العين،
أما إذا كان معتلّها، فتنقل حركتها إلى الفاء، وتقلب ألفا لتحركها بحسب الأصل،
وانفتاح ما قبلها بحسب الآن، ثم تحذف الأَلف الثانية لالتقاء الساكنين، كما سيأتى،
وتعوّض عنها التاء كأقام إقامَة، وأناب إنابة، وقد تحذف التاء إذا كان مضافًا، على
ما اختاره ابن مالك، نحو {وإقام الصلاة}. وبعضهم يحذفها مطلقًا. وقد يجئ على فعال،
بفتح الفاء، كأنبت نَباتًا، وأعطى عَطاء، ويُسَمونه حينئذ اسم مصدر.
3- وقياس مصدر ما أوله همزةُ وَصْلٍ قياسية كانطلق واقتدر، واصطفى واستغفر، أن
يُكْسَر ثالث حرف منه، ويزاد قبل آخره ألف، فيصير مصدرًا، كانطلاق واقتدار،
واصطفاء واستغفار، فخَرَج نحو اطَّاير واطَّيَّر، فمصدرهما التَّفاعُل التَّفعُّل،
لعدم قياسية الهمزة. وإن كان اسْتَفْعَلَ معتلَّ العين عُمِل فى مصدره ما عُمِل فى
مصدر "أفْعَلَ" معتل العين، كاستقام استقامة، واستعاذ استعاذة.
4-
وقياس مصدر ما بُدِئَ بتاء زائدة: أن يضم رابعه، نحو تَدَحْرَجَ تَدَحْرُجا،
وَتَشَيْطنَ تَشَيْطُنا، وَتَجَوْرَبَ تَجَوْربُا، لكن إذا كانت اللام ياءً كُسِر
الحرف المضموم، ليناسب الياء، كتوانَى توانِيًا، وتغالَى تغالِيًا.
5- وقياس مصدر فَعْلَل وما ألحق به: فَعْلَلَة، كدَحرج دَحْرجة وَزَلْزَل
زَلْزَلة، ووسْوَس وسوسة، وبيطَر بيطَرة، وفِعْلال بكسر الفاء، إن كان مضاعفًا،
نحو زَلْزَل زِلزالا، ووسوس وِسواسًا؛ وهو فى غير المضعف سَماعىّ كسَرْهَفَ
سِرْهافا، وإن فُتِحَ أول مصدر المضاعف، فالكثير أن يُراد به اسم الفاعل نحو قوله
تعالى: {مِنْ شَرِّ الوَسْوَاسِ} أى الموَسْوِس.
6- وقياس مصدر فاعَلَ: الفِعال بالكسر والمُفَاعلة، كقاتل قتالاً ومُقاتلة، وخاصم
خِصامًا ومُخاصمة. وما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه الفِعال، كياسَرَ
مُياسرة، ويامَنَ مُيامنة. هذا هو القياس.
وما جاء على غير ما ذكر فشاذّ نحو كَذَّا كِذّابا، والقياس تكذيباً.
وكقوله:
*باتَ يُنَزِّى دَلْوَهُ تَنْزِيَّا * كما تُنَزِّى شَهْلَةٌ صَبِيَّا*
والقياس: تَنْزية. وقولهم: تَحَمَّل تِحِمَّالا بكسر التاء والحاء وتشديد الميم،
والقياس تَحَمُّلا. وترامَى القوم رِمِّيّا، بكسر الراء والميم مشددة، وتشديد
الياء، وآخره مقصور. والقياس: ترَامِيا. وحَوْقل الرجل حِيقَالاً: ضعف عن الجماع،
والقياس حَوْقَلة، واقشعرّ جلده قُشَعْرِيرَة، بضم ففتح فسكون: أى أخذته الرِّعدة،
والقياس اقْشعرارًا.
فائدة - كلُّ ما جاء على زنة تفعال فهو بفتح التاء، إلا تِبْيان، وتِلْقاء،
والتِّنضال، من المناضلة، وقيل هو اسم، والمصدر بالفتح.
تنبيهات
الأول: يصاغ للدلالة على المَرة من الفعل الثلاثة مصدر على وزن
"فَعْلةَ" بفتح فسكون، كجلس جلْسَة، وأكل أكْلَة. وإذا كان بناء مصدره
الأصلى بالتاء، فيُدَلّ على المرة بالوصف، كَرَحِم رَحْمة واحدة.
ويُصاغ
منه للدلالة على الهيئة مصدر على وزن "فِعْلَة" بكسر فسكون، كجلس
جِلْسة، وفى الحديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة". وإذا كانت التاء فى
مصدره الأصلى دُلَّ على الهيئة بالوصف، كنَشَدَ الضالَّة نِشْدة عظيمة.
والمرة من غير الثلاثى، بزيادة التاء على مصدره كانطلاقة، وإن كانت التاء فى مصدره
دُلَّ عليها بالوصف، كإقامة واحدة. ولا يُبْنى من غير الثلاثى مصدر للهيئة، وشذ
خِمْرة ونِقْبة وعِمَّة، من اختمرت المرأة، وانتقبت، وتعمَّم الرجل.
الثانى: عندهم مصدر يقال له "المصدر الميمى"، لكونه مبدوءً بميم زائدة.
ويصاغ من الثلاثى على وزن مَفْعَل، بفتح الميم والعين وسكون الفاء، نحو: مَنْصَر
ومَضْرَب، ما لم يكن مثالاً صحيح اللام، تحذف فاؤه فى المضارع كوَعَد، فإنه يكون
على زنة مَفْعِل، بكسر العين، كموعِد وموضِع. وشذّ من الأول: المرجِع والمَصِير،
والمعرِفة، والمقدِرة، والقياس فيها الفَتْح. وقد وردت الثلاثة الأولى بالكسر،
والأخير مثلّثًا، فالشذوذ فى حالتى الكسر والضم.
ومن غير الثلاثى: يكون على زنة اسم المفعول، كمُكْرَم، ومُعَظَّم، ومُقام.
الثالث: يصاغ من اللفظ مصدر، يقال له المصدر الصناعى، وهو أن يُزاد على اللفظة يا
مشددة، وتاء التأنيث، كالحرية، والوطنية، والإنسانية، والهمَجِية، والمَدَنية.
اسم الفاعل:
هو ما اشْتُقَّ من مصدر المبنى للفاعل، لمن وقع منه الفعل، أو تعلق به.
وهو من الثلاثى على وزن فاعِل غالبًا، نحو ناصر، وضارب، وقابل، ومادّ، وواق،
وطاوٍ، وقائل، وبائع. فإن كان فعله أجوف مُعَلاَّ قلبت ألفه همزة، كما سيأتى فى
الإعلال.
ومن
غير الثلاثى على زِنَة مضارعه، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وكَسر ما قبل
الآخر، كمُدَحرِج وَمُنْطلِق وَمُستخرِج، وقد شذّ من ذلك ثلاثة ألفاظ، وهى: أسْهَب
فهو مُسْهَب، وأحصَنَ فهو مُحْصَن، وألفج بمعنى أفلس فهو ملْفَج، بفتح ما قبل
الآخر فيها. وقد جاء من أفعل على فاعِل، نحو أعشب المكان فهو عاشِب، وأورَس فهو
وارس، وأيفع الغلام فهو يافع، ولا يقال فيها مُفْعِل.
صيغ المبالغة:
وقد تُحَوَّل صيغة "فاعل" للدلالة على الكثرة والمبالغة فى الحَدَث، إلى
أوزان خمسة مشهورة، وتسمى صِيغ المبالغة، وهى: فَعَّال: بتشديد العين، كأكّال
وشرَّاب. ومِفعال: كمِنحار. وَفَعُول: كغَفُور. وَفَعِيل: كسميع. وفَعِل: بفتح
الفاء وكسر العين كحذِر.
وقد سُمِعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة، منها فِعِّيل: بكسر الفاء وتشديد العين
مكسورة كسِكِّير. ومِفْعِيل: بكسر فسكون كمِعْطير، وَفُعَلَة: بضم ففتح، كهُمَزَة
ولُمَزة. وفاعُول: كفاروق. وفُعال بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها، كطُوّال
وكُبار، بالتشديد أو التخفيف، وبهما قرئ قوله تعالى: {وَمَكَرُوا مَكراً
كُبَّارا}.
وقد يأتى "فاعل" مرادًا به اسم المفعول قليلاً، كقوله تعالى: {فى
عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} أى مَرْضية، وكقول الشاعر:
*دعِ المكارمَ لا ترحلْ لبغْيتها * واقعد فإنك أنت الطاعمُ الكاسى*
أى المطعوم المكسىّ. كما أنه قد يأتى مُرادًا به النسب، كما سيأتى.
وقد يأتى فعيل مرادًا به فاعِل، كقدير بمعنى قادر. وكذا فَعُول بفتح الفاء، كغفور
بمعنى غافر.
اسم المفعول
وهو ما اشْتُق من مصدر المبنى للمجهول، لمن وقع عليه الفعل.
وهو من الثلاثى على زنة "مَفْعُول" كمنصور، وموعود، ومَقُول، وَمَبِيع،
وَمَرْمِىّ، وَمَوْقِىِّ، وَمَطْوِىّ. أصل ما عدا الأولين مَقْوُوْل، وَمَبْيُوع،
ومَرْمُوى، ومَوْقوىّ، وَمَطْوُوى، كما سيأتى فى باب الإعلال.
وقد
يكون على وزن فَعيل كقَتيل وجريح، وقد يجئ مفعول مرادًا به المصدر، كقولهم: ليس
لفلان مَعْقُول، وما عنده مَعلوم: أى عَقْل وَعلِم.
وأما من غير الثلاثىّ، فيكون كاسم فاعله، لكن بفتح ما قبل الآخِر، نحو مُكْرَم،
وَمُعَظَّم، وَمُسْتَعان به.
وأما نحو مُخْتار وَمُعْتَدّ ومُنْصَبّ وَمُحَابّ وَمُتَحَابّ، فصالح لاسمَى
الفاعل والمفعول، بحسب التقدير.
ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر،
بالشروط المتقدمة فى المبنىّ للمجهول.
الصفة المشَبَّهةُ باسم الفاعل
هى لفظ مَصُوغ من مصدر اللازم، للدلالة على الثُّبوت.
ويغلب بناؤها من لازم باب فرح، ومن باب شرُف، ومن غير الغالب، نحو: سيّد ومَيِّت:
من ساد يسود ومات يموت، وَشيْخ: من شاخ يشيخ.
وأوزانها الغالبة فيها اثنا عشر وزنًا:
اثنان مختصان بباب فَرِح، وهما:
1- "أفْعَل" الذى مؤنثه "فعْلاء". كأحمرَ وحمراء.
2- و"فَعْلان" الذى مؤنثه "فَعْلىَ"، كعطشان وعطشى.
وأربعة مختصة بباب شَرُف، وهى:
1- "فَعَل" بفتحتين، كحسَن وبَطَل.
2- "وفُعُل" بضمتين كجُنُب، وهو قليل.
3- و"فُعَال" بالضم، كشُجاع وفُرات.
4- و"فَعَال" بالفتح والتخفيف، كرجل جَبَان، وامرأة حَصَان، وهى
العفيفة.
وستة مشتركة بين البابين:
1- "فعْل" بفتح فسكون، كسَبْطٍ وضَخْم. الأول: من سَبِط بالكسر والثانى:
من ضَخُم بالضم.
2- و"فِعْل" بكسر فسكون: كصِفْر ومِلْح، الأول: من صَفِر بالكسر،
والثانى: من مَلُح بالضم.
3- و"فُعْل" بضم فسكون، كحُرّ وصُلْب. الأوَّل: من حَرّ، أصله حَرِ
بالكسر، والثانى من صَلُب بالضم.
4- و"فَعِل" بفتح فكسر، كفَرِح ونَجِس. الأول: من فرِح بالكسر، والثانى:
من نَجُس بالضم.
5- و"فاعِل": كصاحب وطاهر. الأول: من صَحِب بالكسر، والثانى: من طهرُ
بالضم.
6-
و"فَعِيل" كبخيل وكريم. الأول: من بَخِل بالكسر، والثانى: من كَرُم
بالضم. وربما اشترك "فاعِل" و "فَعِيل" فى بناء واحد، كماجد
ومجيد، ونابه ونبيه.
وقد جاءت على غير ذلك، كشَكُس بفتح فضم، لسيِّئ الخلُق.
ويطرِّد قياسُها من غير الثلاثى على زنة اسم الفاعل إذ أريد به الثبوت كمعتدِل
القامة، ومنطَلِق اللسان، كما أنها قد تُحَوَّل فى الثلاثى إلى زنة
"فاعِل" إذا أريد بها التجدُّد والحدوث: نحو زيد شاجِعٌ أمسِ، وشارِف
غدًا، وحاسِن وجههُ، لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة مثلاً.
تنبيهان:
الأول: بالتأمل فى الصفات الواردة من باب فرِح، يُعلَمْ أن لها ثلاثة أحوال
باعتبار نسبتها لموصوفها: فمنها ما يحصُل ويُسْرع زواله، كالفرَح والطرَب. ومنها
ما هو موضوع على البقاء والثُّبوت، وهو دائر بين الألوان، والعيُوب، والحِلَى،
كالْحُمرة، والسُّمرة، والْحُمق، والعَمَى، والغَيَد، والهَيَف. ومنها ما هو فى
أمور تحصل وتزول، لكنها بطيئة الزوال، كالرِّى والعَطَش، والجوع والشِّبَع.
الثانى: قد ظهر لك مما تقدم أن "فعِيلا" يأتى مصدرًا، وبمعنى فاعِل،
وبمعنى مفعول، وصفة مشبهة. ويأتى أيضًا بمعنى مُفاعِل، بضم الميم وكسر العين،
كجليس وسَمير، بمعنى مُجالس ومُسامر، وبمعنى مُفْعَل بضم الميم وفتح العين، كحَكيم
بمعنى مُحْكم، وبمعنى مُفْعِل، بضم الميم وكسر العين، كبديع بمعنى مُبْدِع، فإذا
كان فعيل بمعنى فاعِل أو مُفاعِل، أو صفة مشبهة، لحقته تاء التأنيث فى المؤنث، نحو
رَحيمة، وشريفة، وجليسة، ونديمة، وإن كان بمعنى مفعول، استوى فيه المذكر والمؤنث
إن تبع موصوفه: كرجل جَرِيح وامرأة جريح، وربما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف،
نحو صفة ذميمة، وخَصْلة حميدة.
وسيأتى ذلك فى باب التأنيث إن شاء الله تعالى.
اسم التفضيل
1- هو الاسم المَصُوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا فى صفة، وزاد أحدهما
على الآخر فى تلك الصفة.
2-
وقياسه: أن يأتى على "أفْعَل" كزيد أكرم من عمرو، وهو أعظم منه. وخرج عن
ذلك ثلاثة ألفاظ، أتَتْ بغير همزة، وهى خَيْرٌ، وشَرٌ، وحَبّ، نحو خيرٌ منه، وشرٌّ
منه، وقولُه:
*(وحَبُّ شَىْءٍ إلى الإنسان ما مُنِعَا)*
وحذفت همزتين لكثرة الاستعمال، وقد ورد استعمالهُنَّ بالهمزة على الأصل كقوله:
*(بلالُ خيرُ النَّاسِ وابنُ الأخْيَرِ)*
وكقراءة بعضهم: {سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الأشَرُّ} بفتح الهمزة
والشين، وتشديد الراء، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "أحبُّ الأعمال إلى الله
أَدْوَمُها وإن قَلَّ". وقيل: حذفها ضرورة فى الأخير، وفى الأولين؛ لأنهما لا
فعل لهما، ففيهما شذوذان على ما سيأتى:
3- وله ثمانية شروط:
الأول: أن يكون له فِعْل، وشذ مما لا فعل له: كهو أَقْمَنُ بكذا؛ أى أحق به،
وألَصُّ من شِظاظ، بَنَوْه منْ قولهم: هو لِص أى سارق.
الثانى: أن يكون الفعل ثلاثيًا، وشذ: هذا الكلام أخْصَرُ من غيره، منِ
"اخْتُصِر" المبنى للمجهول، ففيه شذوذ آخر كما سيأتى، وسُمع "هو
أعطاهم للدراهم، وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره" وبعضهم جوَّز
بناءَه من أفعل مطلقًا، وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل.
الثالث: أن يكون الفعل متصرفًا، فخرج نحو: عَسَى وَلَيْسَ، فليس له أفعل تفضيل.
الرابع: أن يكون حَدَثُهُ قابلاً للتفاوت: فخرج نحو: مات وفَنِى، فليس له أفعل
تفضيل.
الخامس: أن يكون تامًّا، فخرجت الأفعال الناقصة؛ لأَنها لا تدل على الحدث.
السادس: ألاّ يكون مَنفيًّا، ولو كان النفى لازمًا. نحو: "ما عاج زيد
بالدواء" أى ما انتفع به، لئلا يلتبس المنفىّ بالمثبت.
والسابع: ألاّ يكون الوصف منه على أفْعَل الذى مؤنثه فَعْلاء، بأن يكون دالاًّ على
لون، أو عيب، أو حِلْية؛ لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. وأهل الكوفة
يصوغونه من الأفعال التى الوصف منها عَلَى أفْعَل مطلقًا، وعليه دَرَجَ المتنّبى
يخاطب الشيب، قال:
*أبْعَد
بَعِدْتَ بياضًا لا بياضَ لَهُ * لأنت أسودُ عَيْنِى مِنَ الظُّلَمِ*
وقال الرَضِىّ فى شرح الكافية: ينبغى المنع فى العيوب والألوان الظاهرة، بخلاف
الباطنة، فقد يُصاغ من مصدرِها، نحو فلان أبْلَهُ من فلان، وأَرْعَنُ وأحْمَقُ
منه.
والثامن: ألاّ يكون مبنيًا للمجهول ولو صورةً، لئلا يلتبس بالآتى من المبنى
للفاعل، وسُمع شذوذًا هو "أزْهَى مِنْ دِيك"، و"أشْغَلُ مِنْ ذَاتِ
النِّحْيَيْن" وكلامٌ أخْصَرُ من غيره، مِن زُهِىَ بمعنى تكبر، وشُغِل،
واخْتُصِرَ، بالبناء للمجهول فيهن، وقيل، إن الأول قد ورد فيه زَهَا يَزْهو،
فإِذنْ لا شُذُوذَ فيه.
4- ولاسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون مجرَّدًا من أل والإِضافة، وحينئذ يجب أن يكون مفردًا مُذكرًا،
وأن يُؤْتَى بعده بِمِنْ جارّةً للمفضَّل عليه، نحو قوله تعالى: {لَيُوسُف
وَأخُوهُ أحَبُّ إِلىَ أبِينَا مِنَّا}، وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آباؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُم وَأزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُمْ وَأمْوَالٌ
اقْتَرَفتُموهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ}.
وقد تُحذَف مِنْ وَمَدْخُولُها نحو: {وَالآخرَةُ خَيْرٌ وَأبْقَى} وقد جاء الحذف
والإثبات فى: {أَنَا أكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأعَزُّ نَفَراً}.
الثانية: أن يكون فيه ألْ، فيجب أن يكون مطابقًا لموصوفه، وَأَلاَّ يُؤْتَى معه
بِمِن، نحو محمد الأفضلُ، وفاطمة الفُضْلى، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون،
والهِنْدات الفُضْلَيات، أو الفُضَّلُ.
وأما الإتيان معه بمن مع اقترانه بأل فى قول الأعشى:
*وَلَسْتُ بالأكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى * وإِنما العزّةُ للكاثر*
فخُرِّج على زيادة "أل" أو أنَّ "مِنْ" متعلقة بأكثر نكرة
محذوفة، مُبْدَلاً من أكثر الموجودة.
الثالثة: أن يكون مضافاً.
فإن
كانت إضافته لنكرة، التُزم فيه الإفراد والتذكير، كما يُلْزمان المجرَّد،
لاستوائهما فى التنكير، ولزمت المطابقةُ فى المضاف إليه، نحو الزيدان أفضل رجلين،
والزيدون أفضلُ رِجال، وفاطمة أفضل امرأة. وأما قوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُوا
أوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} فعلى تقدير موصوف محذوف؛ أى أول فريق.
وإن كانت إضافته لمعرفة، جازت المطابقةُ وعدمُها، كقوله تعالى: {وَكَذلِكَ
جَعَلْنَا فى كُلِّ قَرْيَةٍ أكَابِرَ مُجْرِمِيهَا}، وقوله: {وَلَتَجِدَنَّهُم
أحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ} بالمطابقة فى الأول، وعدمها فى الثانى.
5- وله باعتبار المعنى ثلاث حالات أيضاً:
الأولى: ما تقدم شرحه، وهو الدلالة على أن شيئين اشتركا فى صفة، وزاد أحدهما على
الآخر فيها.
الثانية: أن يُرادَ به أن شيئًا زاد فى صفة نفسه، على شئ آخر فى صفته فلا يكون
بينهما وصف مشترك، كقولهم: العسلُ أحْلَى من الخَلّ، والصيفُ أحرُّ من الشتاء.
والمعنى: أن العسل زائد فى حلاوته على الخَلّ فى حُموضته، والصيف زائد فى حره، على
الشتاء فى برده.
الثالثة: أن يراد به ثبوت الوصف لمحلّه، من غير نظر إلى تفضيل، كقولهم:
"الناقصُ والأشَجُّ أعدلا بنى مَرْوان"؛ أى هما العادلان، ولا عدلَ فى
غيرهما، وفى هذه الحالة تجب المطابقة وعلى هذا يُخَرَّج قولُ أبى نُوَاس:
*كأنّ صُغْرَى وكُبْرَى من فَقاقِعها * حَصبْاءُ دُرٍّ عَلَى أرْضٍ من الذَّهَبَ*
أى صغيرة وكبيرة، وهذا كقول العَرُوضيَين: فاصلة صُغْرى وفاصلة كُبْرَى. وبذلك
يندفع القول بلحن أبى نواس فى هذا البيت، اللهمَّ إلا إذا عُلِم أن مراده التفضيل،
فيقال إذ ذاك بلحنه؛ لأنه كان يَلْزمه الإفراد والتذكير، لعدم التعريف، والإضافة
إلى معرفة.
[التعجب]
تنبيهان:
الأول: مِثْلُ اسمِ التفضيل فى شروطه فِعلُ التعجب، الذى هو انفعال النفس عند
شعورها بما خفى سببه.
وله
صيغتان: ما أفْعَله، وأفعِلْ به، نحو ما أحسَنَ الصدقَ! وأحسِنْ به! وهاتان
الصيغتان هما المبوّب لهما فى كُتُب العربية، وإن كانت صيغُه كثيرة، من ذلك قوله
تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأحْيَاكُمْ}! وقوله
عليه الصلاة والسلام: "سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجَسُ حَيَّا
ولا مَيِّتاً"! وقولهم: للهِ درُّهُ فارسا!.
وقوله: *يا جارَتَا ما أنْتِ جارَهْ!*
وأصل أحسِنْ بزيد! أحسَنَ زيدٌ؛ أى صار ذا حُسْن، ثم أريد التعجب من حسنه،
فَحُوِّلَ إلى صورة صيغة الأمر، وزيدت الباء فى الفاعل، لتحسين اللفظ.
وأما ما أفْعَلَه! فإن "ما": نكرة تامة، وَأفْعلَ: فعل ماض، بدليل لحاق
نون الوقاية فى نحو: ما أحوجنى إلى عفو الله.
الثانى: إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوف الشروط، فأت بصيغة مستوفية لها،
واجعل المصدر غير المستوفى تمييزاً لاسم التفضيل، ومعمولاً لفعل التعجب، نحو فلان
أشدُّ استخراجا للفوائد، وما أشدَّ استخراجه، وَأَشْدِدْ باستخراجه.
اسما الزمان والمكان
1- هما اسمان مَصُوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه.
2- وهما من الثلاثىِّ على وزن: "مَفْعَل" بفتح الميم والعين، وسكون ما
بينهما، إن كان المضارع مضمومَ العين، أو مفتوحَها، أو معتلَّ اللام مطلقا،
كمَنْصَر، ومَذْهَب، ومَرْمَى، وَمَوْقَى، وَمَسْعَى، ومَقام، وَمَخَاف،
وَمَرْضَى.
وعلى "مَفْعِل" بكسر العين، إن كانت عين مضارعه مكسورة، أو كان مثالاً
مطلقاً فى غير معتل اللام، كمجلِس، ومَبِيع، ومَوْعِد، ومَيْسِر، وَمَوْجِل. وقيل
إن صحت الواو فى المضارع، كَوَجِلَ يَوْجَل، فهو من القياس الأوَّل.
ومن غير الثلاثىّ: على زنة اسم مفعوله، كمُكْرَم ومُستخْرَج ومُسْتَعان.
ومن
هذا يُعْلَمْ أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميمىّ واحدة فى غير الثلاثىّ، وكذا
فى بعض أوزان الثلاثى، والتمييز بينهما بالقرائن، فإن لم توجد قرينة، فهو صالح
للزمان، والمكان، والمصدر.
3- وكثيراً ما يُصاغ من الاسم الجامد اسم مكان على وزن "مَفْعَلة"، بفتح
فسكون ففتح، للدلالة على كثرة ذلك الشئ فى ذلك المكان، كمأسَدَة، وَمَسْبَعة،
ومَبْطَخَة، ومَقْثَأة: من الأسد، والسبُع، والبطِّيخ، والقِثّاء.
4- وقد سُمِعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح، كالمسجِد: للمكان الذى بُنى للعبادة
وإن لم يُسْجَد فيه، والمَطْلِع، والمَسْكِن، والمَنْسِك، والمَنْبِت، والمَرْفِق،
والمَسْقِط، والمَفْرِق، والمَحْشِر، والمَجْزِر، والمَظِنَّة، والمَشْرِق،
وَالمَغْرِب. وسمع الفتح فى بعضها، قالوا: مَسْكَن، وَمَنْسَك، وَمَفْرَق،
وَمَطْلَع. وقد جاء من المفتوح العين: المَجْمِع بالكسر.
قالوا: الفتح فى كلِّها جائز وإن لم يُسْمع.
قال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين المرْصَفِىّ فى [الوسيلة]: هذا إذا لم يكن اسم
المكان مضبوطًا، وإلا صح الفتح، كقولك اسجُدْ مَسْجَد زيد تَعُدْ عليكَ برَكَتُه،
بفتح الجيم؛ أى فى الموضع الذى سجَد فيه. وقال سيبويه: وأما موضع السجود فالمسجَد،
بالفتح لا غير. (ا هـ). فكأنه أوجب الفتح فيه.
اسم الآلة
1- هو اسم مَصُوغٌ من مصدر ثلاثىّ، لِما وقع الفعل بواسطته.
2- وله ثلاثة أوزان: مِفْعال، ومِفْعل، ومِفْعَلة، بكسر الميم فيها، نحو مِفتاح،
ومِنشار، ومِقراض، ومِحْلَب، وَمِبْرَد، وَمِشْرَط، وَمِكْنَسة، وَمِقْرَعة،
وَمِصْفَاة، وقيل: إن الوَزْن الأخير فرع ما قبله.
وقد خرج عن القياس ألفاظ، منها مُسْعُط، وَمُنْخُل، وَمُنْصُل، وَمُدُقّ، وَمُدْهُن،
وَمُكْحُلَة، وَمُحْرُضَة، بضم الميم والعين فى الجميع.
وقد أتى جامدًا على أوزان شَتَّى، لا ضابط لها، كالفأس، والقَدُوم، والسِّكين
وَهَلُمَّ جَرَّا.
النصوص
الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثانى - فى
الكلام على الاسم ) ضمن العنوان ( التقسيم الثالث للاسم من حيث كونه مؤكدا أو غير
مؤكد )
1- ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث: فالمذكر كرجل، وكتاب، وكرسىّ. والمؤنث نوعان:
حقيقىّ، وهو ما دلَّ على ذات حِرِّ، كفاطمة وهند. ومجازىّ، وهو ما ليس كذلك،
كأذُن، ونار، وشمس. ويُستدل على تأنيثه: بضمير المؤنث أو إشارته، أو لحوق تاء
التأنيث فى الفعل، نحو: هذه الشمس رأيتها طلعتْ، أو ظهور التاء فى تصغيره كأذَينة،
أو حذفها من اسم عدده كثلاث آبار.
2- وينقسم المؤنث إلى:
لفظىّ: وهو ما وُضِع لمذكَّر وفيه علامة من علامات التأنيث، كطلحة وزَكريَّاء
والكُفُرَّى.
وإلى مَعْنَوِىّ، وهو ما كان علما لمؤنث وليس فيه علامة، كَمرْيم وهند وزينب.
وإلى لفظىّ ومعنوىّ: وهو ما كان علماً لمؤنث وفيه علامة، كفاطمةَ، وسَلْمَى،
وعاشُوراء، مُسَمَّى به مؤنث.
3- ولكون المذكر هو الأصل، لم يُحْتج فيه إلى علامة، بخلاف المؤنث، فله علامتان.
الأولى: التاء. وتكون ساكنة فى الفعل، نحو قامت هند، ومتحركة فيه، نحو هى تقوم،
وفى الاسم، نحو صائمة وظريفة.
وأصل وضع التاء فى الاسم: للفرق بين المذكر والمؤنث، فى الأوصاف المشتقة المشتركة
بينهما، فلا تدخل فى الوصف المختص بالنساء، كحائضٍ، وحائل، وفارِك، وثَيِّب،
ومُرْضِع، وعانِس. أما دخولها على الجامد المشترَكِ معناه بينهما، فسماعىّ، كرجل
ورَجُلة، وإنسان وإنسانة، وَفتَى وفتاة.
وَيُستثنى من دخولها فى الوصف المشترك خمسةُ ألفاظ، فلا تدخل فيها:
أحدها:
"فَعُول" بمعنى فاعل، كرجل صَبور وامرأة صَبور، ومنه {وَمَا كَانَتْ
أمُّك بَغِيَّا} أصله بَغويًا: اجتمعت الواو والياء، وَسُبقت إحداهما بالسكون،
فقلَبت الواو ياء، وأدغمتا، وقلبت الضمة كسرة. وما قيل من أنه لو كان على زنة
فَعُول لقيل: بَغُوّا كنَهُوّ، مردود بأن نَهُواً شاذّ، فى قولهم رجل نَهُوٌّ عن
المنكر. وأما قولهم امرأة ملولة، فالتاء فيه للمبالغة، إذ يقال أيضًا رجل مَلولة،
وأما عَدُوَّة فشاذّ، وسَوَّغه الحمل على صديقة. وإذا كان "فَعُول"
بمعنى مفعول، لحقته التاء، نحو جمل ركوب، وناقة ركوبة.
ثانيها: "فَعِيل" بمعنى مفعول إن تَبِع موصوفه، كرجل جَريح، وامرأة
جريح، فإن كان بمعنى فاعل، أوْ لم يَتْبَع موصوفه، لحقته، كامرأة رحيمة، ورأيت
قَتيلة.
ثالثها: "مِفعال" كمِهْذار، وشذَّ: ميقانة.
رابعها: "مِفْعِيل" كمِعْطِير، وشذ مِسْكينة. وقد سُمِع حذفها على
القياس.
خامسها: "مِفْعَل": كمِغْشَم.
وقد تُزاد التاء: لتمييز الواحد من جنسه، كلبِن ولَبِنَة، وتمرْ وَتمرْة، ونمْل
ونمْلة، فلا دليل فى الآية الكريمة على تأنيث النملة. ولعكسه فى كَمْءٍ وَكَمْأة.
وللمبالغة، كراوية. ولزيادتها كـ: علاَّمة. ولتعويض فاء الكلمة كعِدة، أوعينها
كإقامة، أو لامها كسَنَة، أو مَدَّة كَتزكية.
ولتعريب العَجَمِىّ، نحو: كَيْلَجَة فى كَيْلَج: اسم لِمكيال. وتزاد فى الجمع
عِوضاً عن ياء النسب فى مفرده، كأشاعثة وأزراقة، ولمجرد تكثير البِنية، كقرْيَةٍ
وَغرْفة، أو للإلحاق بمفرد، كصيارفة، للإلحاق بكراهية.
العلامة الثانية: الألف. وهى قسمان: مفردة، وهى المقصورة، كحُبْلَى وَبُشْرَى،
وغير مفردة، وهى التى قبلها ألف، فتقلب هى همزة، كحمراء وَعَذراء.
وللمقصورة أوزان، منها:
فُعَلَى: بضم ففتح، نحو أرَبَى: للدَّاهية، وأدَمَى: لموضع، وكذا شُعَبَى. قال
جرير:
*أَعَبْداً حَلَّ فى شُعَبَى غَرِيبًا * أَلُؤْمًا لا أبا لَكَ وَاغْتِرَابا*
وَفُعْلَى:
بضم فسكون، كبُهْمَى لنبت، وَحُبْلَى صفة، وبُشْرَى مصدرًا.
وَفَعَلَى: بفتحات، كبَرَدَى، اسم لنهر، قال حسان:
*يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البريصَ عليْهمُ * بَرَدَى يُصَفِّقُ بالرَّحيقِ
السَّلْسَلِ*
وَحَيَدَى: للحمار السريع فى مشيه، وبَشَكَى: للناقة السريعة.
وَفَعْلَى: بفتح فسكون كمَرْضَى جمعًا، وَنَجْوَى مصدرًا، وشَبْعَى صفةً.
وفُعَالَى: بالضم والتخفيف، كَحُبَارَى، لطائر، وسُكارَى: جمعًا، وَعُلادَى: صفة
للشديد من الإبل.
وفُعَّلى: بضم ففتح العين المشددة، كسُمَّهَى: للباطل.
وَفِعَلَّى: بكسر ففتح، فلام مشددة، كسِبَطْرَى: لمِشية فيها تبختُر.
وَفِعْلَى: بكسر فسكون نحو حِجْلى، جمع حَجَلة بفتحات: اسم لطائر، وظِرْبَى، جمع
ظَرِبان، بفتح فكسر: اسم لدُوَيْبَة مُنتنة الرائحة. ولم يوجد فى اللغة جمع على
هذا الوزن إلا هذان اللفظان وَذِكْرى مصدرًا. وهذا الوزن إن لم يكن جمعًا ولا
مصدرًا، فإن لم ينوّن فألفه للتأنيث، كقِسمة ضِيْزَى؛ أى جائزة، وإن نوِّن، فألفه
للإلحاق، نحو عِزْهى: لمن لا يلهو، وإن نُوِّن عند بعض ولم ينون عند آخرين، ففيه
وجهان، كذَفَزًى لِعَظمٍ خلف أذن البعير.
َفِعِّيلَىَ: بكسرتين، مشدد العين، نحو هِجِّيرَى: للهذيان، وحِثّيثَى: مصدر
حَثَّ.
وَفُعُلَّى: بضمتين مشدد اللام كحُذُرَّى: من الحَذَر، و(كُفُرَّى): اسم لوعاء
الطَّلْع.
وَفُعَّيلى: بضم ففتح العين مشددة كلُغَّيْزَى: للغز، وخُلَّيْطَى: للاختلاط.
وَفُعَّالى: بضم ففتح العين المشددة كخُبَّازَى وشُقَّارى: لنبتين، وحُضَّارى:
لطائر.
وللممدودة أوزان. منها:
فَعْلاء: بفتح فسكون كصحراء: اسمًا، ورَغْباء: مصدرًا، وطَرْفاء: جمعًا فى
المعْنى، وحَمرَاء: صفة لمؤنث أفْعَل، وَهطْلاء: صفة لغيره، كديمة هَطْلاء.
وأفْعِلاء: بفتح فسكون، مثلَّث العين، مخفَّف اللام، كأربِعاء لليوم المعروف.
وفُعْلُلاء:
بضمتين بينهما ساكن، كقُرْفُصاء: لهيئة مخصوصة فى القُعود.
وفاعُولاء: كتاسوعاء وعاشوراء: للتاسع والعاشر من المحرَّم.
وفاعِلاء: بكسر العين كقاصِعاء ونافقاء: لبابَىْ جُحْر اليربوع.
وفِعْلِياء: بكسرتين بينهما سكون، مخفَّف الياء: ككِبْرياء.
وَفُعَلاء: بفتح العين، وتثليث الفاء: كجنَفَاء بفتحات: لموضع، وسِيَرَاء، بكسر
ففتح: لثوبِ خزِّ مخطَّط، ونُقَساء، بضم ففتح.
وفُنْعُلاء: بضمتين بينهما سكون: كخُنفساء: للحيوان المعروف.
وفَعِيلاء: بفتح فكسر، كقَرِيثاء بالثاء المثلثة: لنوع من التمر.
ومَفْعولاء: كمَشْيوخاء: جمع شيخ.
ومما تقدم عُلِم أن هناك أوزانًا مشتركة بينهما، وهى: فَعْلى، بفتح فسكون،
كَسَكْرى وصَحْراء، وفُعَلى: بضم ففتح كَأرَبَى وحُنَفاء، وفَعَلى، بفتحاتٍ
كَجَمَزَى: لسرعة العدْو، وجَنَفَاء: لموضع، وَأَفْعَلَى: بفتح فسكون ففتح،
كَأجْفَلى: للدعوة العامة، وأرْبَعَاء: لليوم المعروف.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثانى -
فى الكلام على الاسم ) ضمن العنوان ( التقسيم الرابع لللاسم: من حيث كونه منقوصا،
أو مقصورا، أو ممدودا، او صحيحا )
1- ينقسم الاسم إلى منقوص، ومقصور، وممدود، وصحيح.
فالمنقوص: هو "الاسم المُعْرَب الذى آخره ياء لازمة مكسورٍ ما قبلها"،
كالداعِى والمنادى، فخرج بالاسم: الفعلُ كرَضِىَ، وبالمعرب: المبنىُّ كالذى،
وبالذى آخرُه ياءٌ: المقصورُ، وبلازمةٍ: الأسماءُ الخمسة فى حالة الجرِّ، وبمكسورٍ
ما قبلها: نحو ظّبْى ورَمْى، فإنه ملحق بالصحيح، لسكون ما قبل يائه.
والمقصور: هو "الاسم المُعْرَب الذى آخره ألف لازمة"، كالهُدَى
والمصطفَى، فخرج بالاسم: الفعل والحرف، كدَعَا وإلى، وبالمعرَب: المبنىّ، كأنا
وهذا وبما آخره ألفٌ: المنقوصُ، وبلازمِه: الأسماءُ الخمسة فى حالة النصب، والمثنى
فى حالة الرفع.
والممدود:
هو "الاسم المعرب الذى آخِرُهُ همزةٌ تلى ألفًا زائدة" كَصحراء وحمراء.
والصحيح: ما عدا ذلك، كرجل وكتاب.
2- وكل من المقصور والممدود: قياسىّ، وهو موضع نظر الصرفىّ، وسماعىّ، وهو موضع نظر
اللُّغَوِىّ، الذى يَسْردُ ألفاظ العرب، ويضع معانيها بإِزائها.
فالمقصور القياسىّ: هو كل اسم معتلّ اللام، له نظيرٌ من الصحيح، ملتَزَمٌ فتحُ ما
قبل آخره.
وذلك كمصدر الفعل المعتلّ اللام، الذى على وزن فعِلَ، بفتح فكسر، كالجَوَى
والهَوَى والعَمَى، فإنه نظيرُ الفَرَحِ والأشَرِ والطَّرَب. وكفِعَل بكسر ففتح،
فى جمع فِعْلة، بكسر فسكون. وفُعَل، بضم ففتح، فى جمع فُعْلة، بضم فسكون، نحو
فِرْية وفِرًى، ومِرْيَة ومِرًى، ومُدْيَة ومُدًى، وزُبْيَة وزُبًى؛ فإن نظيرهما
قِرَب بالكسر، وقُرَب بالضم، فى جمع قِرْبة بالكسر وقُرْبَة بالضم.
وكذا كل اسم مفعولٍ معتل اللام، زائد على الثلاثة، كمُعْطىً ومُسْتَدْعًى فإن
نظيره مُكْرَم ومستخْرَج.
وكذا أفعل صيغة تفضيل كالأقْصَى، أو لغيره كالأعمى، ونظيرهما من الصحيح الأبعدُ
والأعمش.
وكذا ما كان جمعا لفُعْلَى أنثى أفعل، كالدُّنيا والدُّنا. ونظيره الأخْرَى
والأخَر. وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالاً على الجمعية بالتجرد من التاء، على
وزن فَعَل بفتحتين، وعلى الوحدة بالتاء، كحَصاة وحصًى، ونظيره مَدْرَة ومَدَر.
وكذا المَفْعَل مدلولاً به على مصدر أو زمان أو مكان، نحو مَلْهًى ومَسْعًى،
ونظيرُه مَذْهَب ومَسْرَح.
والممدود القياسىّ: كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح الآخِر، مُلْتَزَمٌ فيه
زيادة ألف قبل آخره.
وذلك كمصدر ما أوَّلُهُ همزة وصل، نحو ارْعَوَى ارْعِواء، وابتغَى ابْتِغاء،
واستقصى استقصاء، فإن نظيرها من الصحيح: احمرَّ احمرارًا، واقتدر اقتدارًا،
واستخرج استخراجًا.
وكذا
مصْدَرُ كلِّ فعل معتلِّ اللام يوازن أفْعَلَ، كأعْطَى إعطاءً، وأملَى إملاء فإن
نظيره من الصحيح أكرم إكرامًا، وأحسن إحسانًا.
وكذا كل ما كان مفردًا لأفْعِلة، ككِساء وأكْسِية، ورِداء وأردية، فإن نظيره من
الصحيح حمارٌ وأحْمِرة، وسلاحٌ وأسلِحَة.
وكذا كل مصدر لفَعَل بفتحتين دالاً على صوت أو داء، كالرُّغاء: لصوت البعير،
وَالثُّغاء: لصوت الشاة، فإِن نظيره الصُّراخ، وكالمُشاء، فإن نظيره الزُّكام.
والسماعىّ منهما ما فقد ذلك النظير.
فمن المقصور سماعًا: الفتَى: واحد الفِتْيان، والْحِجا؛ أى العقل، والسَّنا؛ أى
الضَّوء، والثَّرَى؛ أى التراب.
ومن الممدود سماعا الثَّراء بالفتح: لكثرة المال، والْحِذاء بالكسر: للنعل،
والفُتاء بالضم: لحداثة السنّ، والسَّناء بفتح السين: للشرف.
وقد أجمعوا على جواز قصر الممدود للضرورة، كقوله:
*لا بدَّ من صَنْعَا وإِن طالَ السَّفَرْ*
واختلفوا فى مدّ المقصور؛ فمنعه البصريون، وأجازه الكوفيون، وحُجتهم قول الشاعر:
*سَيُغْنِينى الَّذِى أَغْنَاكَ عَنِّى * فلا فقْرٌ يَدُومُ وَلا غِنَاءُ*
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثانى -
فى الكلام على الاسم ) ضمن العنوان ( التقسيم الخامس لللاسم من حيث كونه مفردا، أو
مثنى، أو مجموعا )
ينقسم الاسم إلى مفرد، ومثنى، ومجموع.
فالمفرد: ما دل على واحدٍ، كرجل وامرأة وقلم وكتاب. أو هو ما ليس مُثَنًّى ولا
مجموعا، ولا ملحقًا بهما، ولا من الأسماء الخمسة المبينة فى النحو.
والمثنى: ما دل على اثنين مُطْلقا، بزيادة ألف ونون، أو ياء ونون، كرجلان
وامرأتان، وكتابان وقلمان، أو رجلين وامرأتين وكتابين وقلمْين، فليس منه كِلا،
وكِلْتا، واثنان، واثنتان، وزَوْج، وَشَفْع؛ لأن دلالتها على الاثنين ليست
بالزيادة.
وشرط الاسم الذى يراد تثنيته:
أن يكون مفردًا، فلا يُثنّى المجموع ولا المثنَّى، بأن يُقال رجلانان وزيدونان.
وأن
يكون معرَبا، وَأما اللذان وَهذان، فليسا بمُثَنَّيَيْن، وكذا مؤنثهما، وَإنما هما
على صُورة المثنى.
وأن يكونا متَّفِقين فى اللفظ والوزن والمعنى، فلا يقال العُمَران بضم ففتح فى أبى
بكر وعُمَر؛ لعدم الاتفاق فى اللفظ، ولا العَمْران، بفتح فسكون فى عَمْروٍ
وَعُمَر؛ لعدم الاتفاق فى الوزن، ولا العَينان فى الباصرة والجارية؛ لعدم الاتفاق
فى المعنى.
وأن يكون مُنَكَّرًا، فلا يُثنى العَلَم باقيًا على عَلَميته.
وأن يكون له مُمَاثل، فلا يُثَنَّى الشمس والقمر؛ لعدم المماثلة، وقولهم:
القَمَران للشمس والقمر تغليبٌ.
وألاّ يستغنى بتثنية غيره عنه، فلا يُثنى سَواء، للاستغناء عن تثنيته بتثنية سِىّ.
[الجمع]
3- والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مذكَّر سالم، ومؤنثٍ سالم، وجمع تكسير.
فجمع المذكر السالم: هو لفظ دل على أكثر مِن اثنين، بزيادة واو ونون، أو ياء ونون،
كالزيدون والصالحون، والزيدين والصالحين.
والمفرد الذى يُجْمع هذا الجمعَ: إما أن يكون جامدًا أو مشتقًا، ولكلٍ شروط:
فيُشترط فى الجامد: أن يكون عَلَما لمذكَّر عاقل، خاليًا من التاء، ومن التركيب،
فلا يقال فى رجل: رجلون لعدم العلمية، ولا فى زينب: زينبون؛ لعدم التذكير، ولا فى
"لاحق" (علَم لفرس): لاحقون؛ لعدم العقل، ولا فى طَلْحة: طَلْحتون؛
لوجود التاء، ولا فى سيبويه: سِيْبَوَيْهُون؛ لوجود التركيب.
ويشترط فى المشتق: أن يكون صفة لذكر عاقل، خالية من التاء، ليست على وزن أفعل الذى
مؤنثه فَعْلاء، ولا فَعْلان الذى مؤنثه فَعْلَى، ولا مما يستوى فيه المذكر
والمؤنث، فلا يقال فى مُرْضِع: مُرْضعون، لعدم التذكير، ولا فى نحو
"فارهٍ" صفة فَرَس: فارِهون؛ لعدم العقل.
ولا فى علاّمة: عَلاّمَتُون؛ لوجود التاء.
ولا فى نحو أحمر: أحمرون؛ لمجيئه على وزن أفعل الذى مؤنثه فعلاء، وشذ قولُ حكيم
الأعور بن عَياش الكَلْبىّ:
*فما
وُجِدَتْ نساءُ بنى تميم * حَلائلَ أَسْوَدِينَ وَأَحمرِينَا*
ولا فى نحو عَطْشانَ: عَطْشَانون؛ لكونه على فَعْلان الذى مؤنثه فَعْلَى.
ولا فى نحو عَدْل وصَبُور وجَرِيح: عَدْلون، وصَبُورون، وحَرِيحون؛ لاستواء المذكر
والمؤنث فيها.
وجمع المؤنث السالم: ما دل على أكثر مِن اثنين، بزيادة ألف وتاء على مفرده،
كفاطمات وزينبات.
وهذا الجمع يَنقاس:
فى جميع أعلام الإناث، كزينب وهند ومريم. وفى كل ما خُتم بالتاء مطلقا كفاطمة
وطلحة. ويستثنى من ذلك امرأة، وشاة، وقُلَة بالضم والتخفيف: اسم لُعْبة، وأمَة؛
لعدم ورودها.
وفى كل ما لحقته ألف التأنيث مطلقًا: مقصورة أو ممدودة، كسَلْمى وَحُبْلَى وصحراء
وحسناء. ويستثنى من ذلك فَعْلاء مؤنث أفْعَل، وفَعْلَى مؤنث فَعْلان، فلا يجمعان
هذا الجمع، كما لا يجمع مذكرهما جمع مذكر سالما، وفى مصغر غير العاقل كجُبيل
وَدُرَيْهم، وفى وصفه أيضًا، كشامخ صفة جَبَل، ومعدودٍ صفة يوم.
وفى كل خُماسىّ لم يُسْمع له جمع تكسير، كسُرَادِق وَحمّام وإصْطَبل.
وما سوى ذلك فمقصور على السماع، كسموات وسِجِلاّت وأمَّهَات.
كيفية التثنية
[الصحيح]: إذا كان الاسم الذى تريد تثنيته صحيحًا، أو منزلاً منزلة الصحيح، كرَجل
وامرأة، وظبى ودَلوْ، زِدتَ الألف والنون، أو الياء والنون، بدون عمل سواها فتقول:
رجلان، وامرأتان، ودلوان، وظَبْيان.
[المنقوص]: وإذا كان منقوصًا محذوف الياء كقاضٍ وداعٍ، رَددتَها فى التثنية،
فتقول: قاضيان وداعيان.
[المقصور]: وإذا كان مقصورًا، وتجاوزتْ ألفُه ثلاثةً، قلبتها ياءً كحُبْلَى
ومستدعَى، فتقول: حُبلَيان ومستدعَيَان. وشذَّ: قَهْقَران وَخوْزلان بالحذف، فى
تثنية قَهْقَرى وَخَوْزَلى.
وكذا
تُقْلب ألفه ياء إذا كانت ثالثة مبدلة منها، كفَتَيان وَرَحَيَان فى فَتًى ورحى،
فرارًا من التقاء الساكنين لو بقيت، وحذَرا من التباس المفرد بالمثَّنى حال إضافته
لياء المتكلم لو حُذفت. وشذَّ فى حِمًى حِمَوَان بالواو.
وكذا إذا كانت غير مبدلة وأميلتْ، كمتى علَمًا، فتقول فى تثنيته: مَتَيان.
وتقلب ألف المقصور واوًا إذا كانت مبدلة منها كعصًا وَقَفًا، فتقول: عَصَوان
وقفوان، وشذّ فى رِضا: رَضَيان بالياء، مع أنه واوىّ.
وكذا تقلب وَاوا إذا كانت غير مبدلة ولم تُمَلْ، كَلَدَى و"إذا" مسمًّى
بهما، فتقول: لَدَوَانِ وَإذَوَان.
[الممدود]: وإذا كان ممدودًا، فيجب إبقاء همزته إن كانت أصلية، كقرَّاءان
ووُضَّاءَان، فى تثنية قرَّاء ووُضَّاء، الأول الناسك، والثانى وضئ الوجه. ويجب
قلبهما واوا، إن كانت للتأنيث، كحمراوان وصحراوان، فى حمراء وصحراء. وقال
السيرافى: إذا كان قبل ألف التأنيث واو، وجب تصحيح الهمزة، لئلا يجتمع واوان ليس
بينهما إلا ألف، كعشواء، فتقول: عشواءان، والكوفيون يجيزون الوجهين فيها، وشذ
حَمْرايان بالياء، وخُنْفُسان وعاشوران وقُرْفُصان، بالحذف، فى تثنية خُنْفُساء
وعاشوراء، وقُرْفُصاء. وإذا كانت همزته بدلاً من أصل، جاز فيه التصحيح والقلب،
ولكن التصحيح أرجح، ككساء وَحياء أصلهما: كِساو وَحَيَاى، فتقول: كساوان
وَحَياوان، أو كساءان وَحَيَاءان.
وإذا كانت همزته للإلحاق، كعِلْباء وقُوْباء بالموحدة، زيدت الهمزة فيهما، للإلحاق
بقِرْطاس وقُرْناس، بضم فسكون، وهو أنف الجبل، ترجَّح القلب على التصحيح، فتقول:
علباوان وَقُوباوان، أو عِلباآن وقُوباآن. وقيل: التصحيح فيه أرجح.
كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالم
[الصحيح]: إذا كان الاسم المراد جمعه صحيحًا زيدت الواو والنون، أو الياء والنون
عليه بدون عمل سواها.
[المنقوص]:
وإذا كان منقوصًا حذفت ياؤه، وضُمَّ ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء، فتقول:
القاضُون والداعُون، أو القاضِين والداعِين، أصلهما القاضِيون والداعِيُون
والقاضِيينَ والداعِيين. وسيأتى سبب الحذف فى الْتقاء الساكنين.
[المقصور]: وإن كان الاسم مقصورًا حذفت ألفه، وأبقيت الفتحة للدلالة عليها، نحو:
{وأنتمُ الأعْلَوْنَ} {وَإنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ}، أصلهما:
الأعْلَوُوْنَ والمُصْطَفَوِين.
[الممدود]: وحكم الممدود فى الجمع، حكمه فى التثنية، فتقول فى وُضَّاء:
وُضَّاءُون، وفى حَمْراءَ عَلمًا لمذكر: حَمْراوُون، ويجوز الوجهان فى نحو:
عِلْباء وكِساء عَلَمين لمذكر.
ومما تقدم تعلم أن أولُو، وعالَمون، وَأرَضون، وسِنُون، وبَنُون، وثُبون، وعِزُون،
وأهْلُون، وعِشْرُون وبابه، ليست من جمع المذكر السالم، وإنما هى ملحقة به.
كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالما
إذا كان المفرد بلا تاء، كزينب ومَرْيَم، زدتَ عليه الألف والتاء، بدون عمل سواها،
فتقول: زَينبات ومَرْيَمات.
وإذا كان مقصورًا: عومل معاملته فى التثنية، فتقول: فَتَيَات، وحُبْلَيات،
ومُصْطَفَيات، ومتَيَات: فى فتىً، وحُبْلَى، ومصطفَى، ومَتَى "مسمَّى بها
مُؤنث"، وتقول: عَصَوات، وإذَاوَات، وإلَوَات، فى عصا وإذا وإلى "مسمَّى
بها مُونَّث".
وكذا إن كان ممدودًا أو منقوصًا، فتقول: صَحْرَاوات وَقُرَّاءات، وعِلْبَاوَات، أو
علباءات، وكساءات أو كساوات. وتقول فى قاض "مسمى به مؤنثٌ": قاضيات.
وإذا كان المفرد مختومًا بالتاء زائدة كانت كفاطمة وخديجة، أو عوضًا من أصل، كأخْت
وبنْت وعِدة، حُذِفت منه فى الجمع، فتقول: فاطمات، وخديجات، وبَنات، وأخَوَات،
وعِدَات.
ومتى
كان المفرد اسمًا ثلاثيًا، سالم العين ساكنها، مؤنثًا، سواءٌ ختم بتاء أو لا، جاز
فى عين جمعه المؤنث الفتحُ، والتسكينُ، وإتباع العين للفاء، إلا إن كانت الفاء
مفتوحة، فيتعين الإتباع، وأما قول بعض العُذْريين:
*وَحُمِّلْتُ زَفْرَاتِ الضُّحَى فأَطَقْتُهَا * وَمَا لِى بِزَفْرَاتِ الْعَشِىِّ
يَدَانِ*
بتسكين فاء زَفرات: فضرورة.
أو كانت لامُ مضمومِ الفاء ياءً كدُمْية، أو لامُ مكسورها واوًا كَذِروة، فيمتنع
الإتباع، فنحو دَعْد وَجَفْنة بفتح فائهما، يتعين فيه الفتح فى الجمع، ونحو جُمْل
وبُسْرة بالضم، وهِند وكِسْرة بالكسر، يجوز فيه الثلاث، ونحو دُمْية بالضم،
وذِرْوة بالكسر، يمتنع فيه الإتباع، وشذ جِرِوات، بكسر الراء.
أما الصفة كضخمة، أو الرباعىّ كزينب، أو معتل العين كجُور، أو مضعفها كجنة بتثليث
الجيم، أو متحركها كشجرة فلا تتغير فيها حالة العين فى الجمع.
جمع التكسير
هو ما دلَّ على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده، تغييرًا مقدرًا كفُلْك، بضم
فسكون، للمفرد والْجمع، فزنته فى المفرد كزنة قُفْل، وفى الجمع كزنة أسْد، وكهِجان
لنوع من الإبل، ففى المفرد ككتاب، وفى الجمع كرِجال. أو تغييرًا ظاهرًا، إما
بالشكل فقط، كأُسْد بضم فسكون، جمع أسدَ بفتحتين. وإما بالزيادة فقط، كصِنوان، فى
جمع صِنو بكسر فسكون فيهما. وإما بالنقص فقط، كتُخَم فى جمع تُخَمة بضم ففتح
فيهما. وإما بالشكل والزيادة كرِجال بالكسر، فى جمع رَجل بفتح فضم. وإما بالشكل
والنقص كَكُتب بضمتين. فى جمع كتاب بالكسر. وإما بالثلاثة، كغِلمان بكسر فسكون، فى
جمع غلام بالضم.
أما التغير بالنقص والزيادة دون الشكل، فتقضيه القسمة العقلية، ولكن لم يوجد له
مثال.
وهذا الجمع عامًّ فى العقلاء وغيرهم، ذكورًا كانوا أو إناثًا. وأبنيته سبعة
وعشرون، منها أربعة للقِلة، والباقى للكثرة.
والْجمعان
قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية، فالقلة: من ثلاثة إلى عشرة، والكثرة: من أحد عشر
إلى ما لا نهاية له. وقيل: إنهما متفقان مبدأ لا غاية، فالقلة: من ثلاثة إلى عشرة.
والكثرة: من ثلاثة إلى ما لا نهاية له.
وإنما تعتبر القلة فى نكرات الْجموع، أما معارفها بأل أو الإضافة فصالحة للقلة
والكثرة، باعتبار الجنس أو الاستغراق، وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعًا: بأن تضع
العرب أحد البناءين صالحًا للقلة والكثرة، ويستغنون به عن وضع الآخر، فيستعمَل
مكانه بالاشتراك المعنوىّ لا مجازًا، ويسمى ذلك بالنيابة وضعًا، كأرْجُل، بفتح
فسكون فضم، فى جمع رِجْل بكسر فسكون، وكرجال بكسر ففتح، فى جمع رَجُل بفتح فضم، إذ
لم يضعوا بناء كثرة للأوّل، ولا قِلّة للثانى، فإنْ وُضع بناءان للفظ واحد، كأفلس
وفلوس، فى جمع فَلْس بفتح فسكون، وأثْوُبُ وثياب، فى جمع ثوْب، فاستعمال أحدهما
مكان الآخر يكون مجازًا، كإطلاق أفْلس على أحَدَ عشر، وفُلُوس على ثلاثة، ويسمى
بالنيابة استعمالاً.
جموع القِلَّة
الأول: أفْعُل، بفتح فسكون فضم: ويطرَّد فى:
1- كل اسم ثلاثى صحيح الفاء والعين ولم يضاعَف، على وزن فَعْل، بفتح فسكون، ككلْب
وأكْلُب، وظَبْى وأظْبٍ، ودَلْو وأَدْلٍ. وما كان من هذا النوع واوىَّ اللام أو
يائيها، تكسر عينه فى الجمع، وتحذف لامه، كما سيأتى: فى الإعلال.
وشذ: أوْجُه، وأكُفّ، وأعْيُن.
وأثْوُب، وأسْيُف فى قوله:
*لكُل دَهَرٍ قد لَبِسْتُ أثْوُبا * حتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قناَعاً أشْهَبَا*
وقوله:
*كأنَّهُمْ أسْيُفٌ بِيضٌ يَمَانِيَةٌ * عضْبٌ مَضَارِبُها باقٍ بهَا الأثُرُ*
2- وفى اسم رباعىّ مؤنّث بلا علامة، قبل آخره مدّ، كذراع وأذرع، ويمين وأيمن، وشذ
أفْعُلٌ فى مكانٍ، وغُرابٍ، وشهابٍ، من المذكر.
الثانى: أفْعَال، بفتح فسكون.
ويكون
جمعًا لكل ما لم يَطرَّد فيه أفْعُلٌ السابق، كثوب وأثواب، وسيف وأسياف، وحِمْل
بكسر فسكون وأحمال، وصُلْب بضم فسكون وأصلاب، وباب وأبواب، وسبَب بفتحتين وأسباب،
وكَتِف بفتح فكسر وأكتاف، وعَضُد بفتح فضم وأعضاد، وجُنُب بضمتين وأجناب، ورُطَب
بضم ففتح وأرطاب، وإبِل بكسرتين وآبال، وضِلَع بكسرٍ ففتح وأضلاع، وشذ أفراخ فى
قول الحُطيئة:
*ماذا تقولُ لأفرَاخٍ بذى مَرَخٍ * زُغْبِ الحواصلِ لا ماءٌ ولا شجَرُ*
كما شذّ أحمال جمع حَمْل، بفتح فسكون، فى قوله تعالى: {وَأولاتُ الأحْمَالِ
أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
الثالث: أفْعِلَة، بفتح فسكون فكسر.
ويطرِّد فى كل اسم مذكرَّ رُباعىّ قبل آخره مدّ، كطعام وأطعمة، ورغيف وأرغفة،
وعمود وأعمدة، وَيُلْتزَم فى فِعَالٍ، بفتح أوله أو كسره، مضعَّف اللام أو معتلها،
كَبَتَاتٍ وأبِتَّة، وزِمام وأَزِمَّة، وقِباء وأقبية، وكِساء وأكِسية، ولا
يُجمعان على غيره إلا شذوذًا.
الرابع: فِعْلة، بكسر فسكون.
ولم يطرِّد فى شئ، بل سمع فى ألفاظ، منها شِيخة جمع شيخ، وثِيْرة جمع ثوْر، وفِتية
جمع فَتًى، وصِبْية جمع صَبِىّ وَصَبِيّة، وغِلْمة جمع غُلام، و ثِنْية جمع ثُنْىِ
بضم الأول أو كسره، وهو الثانى فى السيادة.
ولعدم اطراده قيل إنه اسم جمع لا جمع.
جموع الكثرة
الأول: فُعْل، بضم فسكون:
وينقاس فى أفْعَلَ ومُؤنّثِه فَعْلاء صِفتين، كحُمْر بضم فسكون، فى جمع أحمر
وحمراء.
ويكثر فى الشعر ضم عينه إن صحت هى ولامه ولم يضعَّف، نحو:
*وَأنْكَرَتْنِى ذَوَاتُ الأعْيُنِ النُّجُلِ*
بضم الجيم جمع نَجْلاء: أى واسعة، بخلاف نحو بيضٍ وَعُمْى وغُرّ فلا يُضَم لاعتلال
العين فى الأول، واللام فى الثانى، والتضعيف فى الثالث.
وكما
يكون جمعًا لأفْعَل الذى مؤنثه فَعْلاء، يكون جمعًا أيضًا لأفعل الذى لا مؤنث له
أصلاً، كأكْمَر لعظيم الكَمَرَة، وآدَر بالمد لعظيم الخُصية، وكذا لفَعلاء الذى لا
أفعل له كَرَتْقاء.
الثانى: فُعُل، بضمتين:
ويطَّرد فى وصف على فَعُول بمعنى فاعل، كغفور وغُفُر، وصَبور وصُبُر. وفى كل اسم
رُباعىّ قبل آخره مدّ، صحيح الآخِر، مذكرًا، كان أو مؤنثًا، كقَذَال بالفتح، وجمع
جِمَاع مؤخَّر الرأس، وقُذُل، وحِمار وَحُمُر، وكُرَاع بالضم وكُرُع، وقضيب
وقُضُب، وَعمود وعُمُد.
ويشترط فى مفرده أيضًا ألاّ يكون مضعَّفًا مَدّته ألف.
ثم إن كانت عين هذا الْجمع واوًا وجب تسكينُها، كَسُوْر وسُوْك جمعَىْ سِوار
وسِواك، وإلا جاز ضمها وتسكينها، نحو قُذُل بضمتين، وقُذْل بالسكون، وسُيُل
بضمتين، وسِيْل بكسر فسكون، جمع سَيال: اسم شجر له شوك، لكن إن سكنت الياء وجب كسر
ما قبلها، نظير بِيْض فى جمع أبيض.
الثالث: فُعَل بضم ففتح:
ويطرد فى اسم على فُعْلة بضم فسكون، وفى فُعْلى بضم فسكون أنثى أفعل، كغُرْفة ومُدْية
وحُجّة. وكصُغْرَى، وكُبْرَى، فتقول فيها: غُرَف، ومُدًى، وحُجَج، وصُغَر وكُبَر.
وشذَّ فى بُهْمة بضم فسكون، وصف للرجل الشجاع: بُهَم، كما شذ جمع رُؤْيا بضم
الأوَّل، ونَوْبة وقَرْية بفتح أوَّلهما، ولِحْيَة بكسره، وتُخَمة بضم ففتح، على
فُعَل، للمصدرية فى الأوَّل، وانتفاء ضم الفاء فى الثلاثة بعده، وفتح عين الأخير.
الرابع: فِعَل، بكسر ففتح:
ويطَّرد فى اسمٍ على فِعْلة بكسر فسكون، كحِجَّة وحِجج، وكِسْرة وكِسَر، وفِرْية،
وهى الكذب، وفِرًى. وسُمِع فى حِلية ولِحْيَة بكسر أوَّلهما: حُلىً وَلُحًى بضمه،
كما سمع فى فُعْلة بضم فسكون: فِعَل بكسر ففتح، كصُورة وصِوَر.
الخامس: فُعَلَة، بضم ففتح:
ويطَّرد فى وصفِ عاقلٍ على وزن فاعل معتل اللام، كقاضٍ وقضاة، وَرَامٍ ورُماة،
وغاز وغُزَاة.
السادس: فَعَلة، بفتحات:
ويطَّرد
فى وصف مذكر عاقل صحيح اللام ككاتب وكَتَبة، وساحر وسَحَرة، وبائع وباعة، وصائغ
وصاغَة، وبارٍّ وبَرَرة، وبعضهم يجعل هذه الصيغة أصل سابقتها، وإنما ضُمّت فاء
الأولى، للفرق بين صحيح اللام ومعتلها.
السابع: فَعْلَى، بفتح فسكون ففتح:
ويطَّرد فى وصفٍ دالٍّ على هلاك، أو توجُّع، أو تشتُّت، بزنة فَعِيل، نحو قتيل
وقَتْلَى، وجريح وجَرْحَى، وأسير وأسْرَى، ومريض ومَرْضَى.
أو زنة فَعِل بفتح فكسر، كزَمِن وزَمْنَى، أو زنة فاعل، كهالك وهَلْكَى، أو زنة
فَيْعِل بفتح فسكون فكسر، كميت ومَوْتَى، أو زنة أفعَل كأحمَقَ وَحَمْقى، أو زنة
فَعْلان، كعطشان وعَطْشَى.
الثامن: فِعَلَة، بكسر ففتح:
وهو كثير فى فُعْل بضم فسكون اسمًا صحيح اللام، كقُرْط وقِرَطة، ودُرْج ودِرَجة،
وكُوز وكِوَزة، ودُبّ ودِبَبة. وقلَّ فى اسم صحيح اللام على فَعْل بفتح فسكون:
كغَرْد (بالغين المعجمة لنوع من الكمأة) وغِرَدَة، أو بكسر فسكون: كقِرْد وقِرَدة.
التاسع: فُعَّل، بضم الأول، وتشديد الثانى مفتوحًا:
ويطَّرد فى وصف على وزن فاعل وفاعلة صحيحَىْ اللام، كراكع وراكعة، وصائم وصائمة،
تقول فى الجمع: رُكَّع وصُوَّم. وندر فى معتلها كغازٍ وغُزَّى، كما ندر فى فَعيلة
وفُعَلاء بضم ففتح، كخَريدة وخُرَّد، ونُفَسَاء ونفَّس.
العاشر: فُعَّال، بضم الأول، وفتح الثانى مشدَّدًا.
ويطَّرد كسابقه فى وصف على فاعل، فيقال: صائم وصوَّام، وقارئ وقرَّاء، وعاذل
وعُذَّال، وندر فى وصف على فاعلة، كصُدَّاد فى قول القُطامىّ:
*أبْصَارُهُنَّ إلى الشُّبَّانِ مائلةٌ * وقد أَراهُنَّ عنى غيْرَ صُدَّادِ*
كما ندر فى المعتل، كغازٍ وغُزَّاء، وسارٍ وسُرَّاء.
الحادى عشر: فِعَال، بكسر ففتح مخففا: ويطَّرد فى ثمانية أنواع:
الأول
والثانى: فَعْل وفَعْلة بفتح فسكون، اسمين أو وصفين، ليست عينهما ولا فاؤهما ياء،
مثل كلْب وكلْبة وكِلاب، وصعْب وصَعْبة وصِعاب، وتُبدل واوُ المفرد ياء فى الجمع،
كثَوْب وثِياب، وندر فيما عينه أو فاؤه الياء منهما، كضيْف وضِياف، ويَعْر ويِعار،
وهو الجَدْى يُرْبط فى زُبْية الأسد.
الثالث والرابع: فَعَل وفَعَلة، بفتحتين اسمين صحيحى اللام، ليست عينهما ولامهما
من جنس، نحو جَمَل وجِمال، ورَقَبة ورِقاب.
الخامس: فِعْل، بكسر فسكون اسمًا كقِدْح وَقِداح، وذِئْب وَذِئاب، ونِهْى، وهو
الغدير، ونِهاء.
السادس: فُعْل، بضم فسكون اسمًا غير واوىِّ العين، ولا يائىّ اللام، كرُمْح ورِماح
وجُبٍّ وجِباب.
السابع والثامن: فَعيل وفَعيلة، وَصْفىَ باب كَرُم، صحيحى اللام، كظريف وظريفة
وَظِراف. وتلزم هذه الصغية فيما عينه واو من هذا النوع، فلا يُجْمع على غيرها،
كطويل وطويلة وطِوال.
وشاعت أيضًا فى كل وصف على فَعْلان بفتح فسكون للمذكر، وفَعْلَى للمؤنث، وفُعلان
بضم فسكون له وفُعْلانة لها، كغَضْبان وغَضْبَى وغِضاب، وعطْشان وعطْشَى وعِطاش،
وكخُمْصان وخُمْصانة وخِماص.
الثانى عشر: فُعُول، وبضمتين:
ويطَّرد فى اسم على فَعِل، بفتح فكسر، ككَبِد وكُبُود، وَوَعِل ووُعُول، ونَمِر
ونُمور.
وفى فَعْل اسما ثلاثيًا ساكن العين، مثلث الفاء، نحو كَعْب وكعُوب، وَجُنْد
وَجُنُود، وضِرْس وَضُرُوس.
ويشترط أن لا تكون عين المفتوح أو المضموم واواً كحوض وحُوت، ولا لام المضموم ياء
كمُدْى. وشَذّ فى نُؤْى: وهى الحفرة تُجعل حول الخباء، لوقايته من السيل نِئِىّ،
ولا مضعفا كخُف. ويُحفظ فى فَعَل بفتحتين كأسَد وأسود، وذكَرَ وذُكور، وَشجَن، وهو
الحزن، وشُجون.
الثالث عشر: فِعْلان، بكسر فسكون:
ويَطَّرد
فى اسم على فُعالٍ بالضم، كغُراب وغِرْبان، وغُلاَم وغِلمان، أو فُعَل بضم ففتح
كصُرَد وصِرْدان. وبه يُسْتَغْنَى عن أفعال فى جمع هذا المفرد. أو فُعْل بضم الفاء
أو فتحها واوىّ العين الساكنة، كحُوت وَحِيتان، وكُوز وَكِيزان وتاج وَتِيجان،
ونار وَنِيران. وَقلّ فى نحو: غَزَالِ غِزلان، وفى خروف خِرْفان، وفى نِسْوة
نِسْوان.
الرابع عشر: فُعْلان بضم فسكون.
وَيكثر فى اسم على فَعْل بفتح فسكون، كظَهْر وَظهْران، وَبَطْن وَبُطْنان، أو على
فَعَل بفتحتين صحيح العين وَليست هى ولامه من جنس واحد، كذكَر وذُكْران، وَحَمل
بالمهملة، وهو ولد الضأن الصغير وحَمْلان، أو على فَعيل كقضيب وقُضْبان، وغَدِير
وغُدْران. وقَلَّ فى نحو: راكب رُكْبان، وفى أسْود سُودَان.
الخامس عشر: فُعَلاء، بضم ففتح ممدودًا.
ويطَّرد فى وصف مذكر عاقل، على زنة فعيل بمعنى فاعل، غير مضعَّف ولا معتل اللام،
ولا واوىّ العين، نحو كرِيم وكُرَماء، وبخيل وبُخلاء، وظريف وظُرَفاء. وشَذّ أسيرٌ
وأسَرَاء، وقَتِيلٌ وُقتَلاء؛ لأنهما بمعنى مفعول.
أو بمعنى مُفْعِل، بضم فسكون فكسر، كسميع بمعنى مُسْمِع، وأليم بمعنى مُؤْلم، تقول
فيهما: سُمعاء وألَماء، أو بمعنى مُفاعِل، كخُلطاء وَجُلَساء، فى خَلِيط بمعنى
مُخَالِط، وَجَلِيس بمعنى مجالِس: أو على زِنة فاعل دالاً على معنى كالغريزة،
كصالح وصُلَحاء، وجاهِل وجُهَلاء. وشَذَّ: شُجَعاء فى شُجاع، وجُبناء فى جَبَان،
وسُمَحاء فى سَمْح، وَخُلَفَاء فى خليفة؛ لأنها ليست على فَعِيل ولا فاعل.
السادس عشر: أفْعِلاء، بفتح فسكون فكسر:
ويَطَّرد فى مُفْرد سابقه الأول، وهو فعيل، لكِنْ بشرط أن يكون معتلَّ اللام أو
مضعفًا، كغنىّ وأغنياء، ونبىّ وأنبياء، وشديد وأشِدّاء، وعزيز وأعِزّاء، وهو لازم
فيهما. وشذ فى نَصِيب أنْصِباء، وفى صديق أصْدقاء، وفى هَيِّن أَهْوِناء؛ لأنها
ليست معتلة اللام ولا مضعفة.
السابع عشر: فَواعِل:
ويطَّرد
فى فاعِلةٍ اسمًا أو صِفة، كناصية ونواص، وكاذبة وكواذب، وفى اسم على فَوْعَل،
بفتح فسكون ففتح، أوْ فَوْعَلة بفتح الأول والثالث وسكون ما بينهما. أو فاعِل بفتح
العين أو كسرها، كجَوْهَر وجواهر، وصَوْمعة وصوامع، وخاتَم وخواتِم، وكاهِل
وكواهل. أو فاعِل بكسر العين وصفًا لمؤنث، كحائض وحوائض، وحامل وحوامل؛ أو لمذكر
غير عاقل كصاهلٍ وصواهل، وشاهقٍ وشواهق. وشذ فى فارسٍ: فوَارس، وفى ناكسٍ بمعنى
خاضع: نَوَاكس، وفى هالِكٍ: هَوَالك. ويطرد أيضًا فى فاعِلاءَ، بكسر العين والمدّ،
كقاصِعاءَ وَقَواصِع، ونافقاءَ ونَوَافق.
الثامن عشر: فَعَائل، بالفتح وكسر ما بعد الألف:
ويطرد فى رُباعىٍّ مؤنث، ثالثه مَدَّة، سواء كان تأنيثه بالتاء أو بالألف مطلقاً،
أو بالمعنى، كسحابة وسحائب، ورسالة ورسائل، وصحيفة وصحائف، وذُؤابة وذوائب،
وحَلوبة وحلائب، وشِمال بالكسر، وشَمال بالفتح: ريح تهب من جهة القطب الشمالىّ،
وشَمائل، وَعجُوز وعَجائز، وسعيد علم امرأة وسعائد، وحَبَاَئر، وجَلُولاء: قرية
بفارس، وجَلائل.
ويُشْتَرَط فى ذى التاء من هذه الأمثلة: الاسميةُ، إلاَّ فَعيلة، فيشترط فيها ألا
تكون بمعنى مفعولة، وشذ ذَبيحة وذبائح. وندر فى وَصِيد: وهو اسم للبيت أو فنائه:
وَصَائد، وفى جزُور: جزائر، وفى سماء، اسم للمطر: سمائى.
التاسع عشر: فَعَالِى، بفتح أوله وثانيه وكسر رابعه.
العشرون: فَعَالَى، بفتح أوله وثانيه ورابعه.
وهاتان الصيغتان تشتركان فى أشياء، وينفرد كل منهما فى أشياء.
فتشتركان فى فَعْلاء اسمًا كصَحْراء، أو صفة لا مذكر لها كعذراء، وفى ذى الألف
المقصورة للتأنيث كحبلَى، أو الإلحاق، كذِفْرًى بكسر الأول: اسم للعظم الشاخص خلْف
أذُن الناقة، وألفه للإلحاق بدرهم، وعَلْقًى بفتح الأول: اسم لنبت، فتقول فى جمعها
صحارٍ وصحارَى، وعَذارٍ وعَذَارَى، وَحَبَالٍ وَحَبَالَى، وذَفارٍ وَذَفارَى،
وعَلاقٍ وعَلاقَى.
وتنفرد
"الفَعالِى" بكسر اللام فى أشياء: منها فَعلاة بفتح فسكون، كمَوْماة:
اسم للفلاة الواسعة التى لا نبات بها، وفِعْلاة بالكسر كسِعْلاة، اسم لأخبث
الغِيلان، وفِعْلِية بكسرتين بينهما سكون مخفف الياء كهِبْرية، وهو ما يعلق بأصول
الشَّعَر كنخالة الدقيق، أو ما يتطاير من زَغَب القُطْن والريش؛ وفَعْلُوة بفتح
فسكون فضم كعَرقُوَة، اسم للخَشبَة المعترِضة فى فم الدلو، وما حذف أوّلُ زائديه
كحبنطًى: اسم لعظيم البطن، وقَلَنْسُوة لما يُلْبَس على الرأس، وبُلَهْنِيَة، بضم
ففتح فسكون فكسر: اسم لِسِعَة العيش، وحُبَارَى بضم الأول، تقول فى جمعها:
مَوَامٍ، وسَنعَالٍ، وهَبَارٍ، وَعَرَاقٍ، وَحَبَاطٍ، وَقَلاَسٍ، وَبَلاهٍ،
وَحَبارٍ.
وينفرد "الفَعَالَى" بفتح اللام فى وصف على فَعْلان، كعطشانَ وغضْبان،
أو على فَعْلَى بالفتح كعطْشَى وَغَضْبَى، تقول فى الجمع: عَطَاشَى وَغَضَابَى.
والراجح فيهما ضم الفاء كسُكارى.
ويحفظ المفتوح اللام فى نحو حَبِط بفتح فكسر وَحَبَاطَى، ويتيم ويَتَامَى وَأيِّم،
وهى الخالية من الزوج وأيَامَى، وطاهِر وطَهَارَى، فى قول امرئ القيس:
*ثيابُ بنى عَوْف طَهارَى نقِيَّةٌ*
وفى شاةٍ رئيسٍ: إذا أصيب رأسها، ورآسَى. ويُحفظ المضموم فى نحو قديم وقُدَامى،
وأسير وأسارَى.
الحادى والعشرون: فَعَالِىّ، بفتحتين وكسر اللام وتشديد الياء:
ويطرد
فى كل ثلاثى ساكن العين، زيد فى آخره ياء مشدَّدة، ليست متجدَّدة للنسب، ككُرسىِّ
وبُخْتىّ وَقُمْرِىّ، بالضم، أو لنسب تُنُوسِىَ كَمَهْرِىّ، تقول فى جمعها:
كراسِىّ، وَبَخاتِىّ، وقمَارِىّ، وَمَهَارِىّ. والفرق أن ياء النسب يدل اللفظ بعد
حذفها على معنى بخلاف ياء نحو كرسىّ، إذ يختل اللفظ بعد سقوطه ولا يكون له معنى،
وشذّ قَبَاطِىّ فى قُِبطىّ لأن ياءه للنسب، والقِبط: نصارَى مصر. ويُحْفَظ فى
إنسان، وَظربان بفتح فكسر، إذ قد سمع أناسىُّ وَظَرَابىُّ، وليسا جمعًا لإنسىٍّ
وَظِرْبىّ بل أصلهما: أناسينُ وضرابينُ، قلبت النون فيهما ياء، وأدغمت الياء فى الياء.
وَسُمِع فى عَذْراء وَصحْراء تقول فيهما: عذَارِىُّ وَصَحَارِىّ.
الثانى والعشرون: فَعَالِلُ:
ويطرد فى الرُّباعِىّ المجرَّد ومزيده، وكذا فى الْخماسىّ المجرّد ومزيده، فتقول
فى جعْفَر وبُرْثُن وَزبْرِج: جعافِر، وَبَرَاثِن، وزَبارِج. أما الخماسىّ فإن لم
يكن رابعه يشبه الزائد، حُذِف الخامس كسَفَرْجل، تقول فيه: سَفَارِج، وإن أشبه
الزائد فى اللفظ أو المخرَج فأنت بالخيار بين حذفه وحذف الخامس، فتقول فى نحو
خَدَرْنَق بوزن سفَرْجل، اسم للعنكبوت، وفى فرزدق بوزنه أيضًا: خَدَارِقُ أو
خَدَارِنُ، وفَرَازِقُ أو فرازدُ؛ إذ النون فى الأول من حروف الزيادة، والدال فى
الثانى تشبه التاء فى المخرج، وتقول فى مزيد الرُّباعِىّ نحو مُدَحْرِج: دَحارِج
بحذف الزائد، إلا إذا كان ما قبل الآخر لِينا فلا يُحْذَف، ثم إن كان اللين ياءً
صحّ، كقنديل وقناديل، وإن كان ألفا أو واوًا قلب ياء نحو سِرْداح، وهى الناقة
الشديدة، وعصفور، فتقول فيهما: سراديح وعصافير، وفى مزيد الخماسى: يحذف الخامس مع
الزائد، فتقول فى قِرْطَبُوس بكسر القاف: للناقة الشديدة، وبالفتح: للداهية،
وَقَبَعْثَرًى: قراطِب وقباعِث.
الثالث والعشرون: شِبْه فَعَالِل:
وهو ما ماثله عَدَدًا وهيئة، وإن خالفه زِنة، وذلك كمفاعِل، وفوَاعِل، وفياعِل، وأفاعِلة. ويطرّد فى مزيد الثلاثى غير ما تقدم من نحو أحمر، وسكران، وصائم، ورام، وباب كُبْرَى وَسَكْرَى، فإن لها جموعَ تكسير تقدمت ولا يُحْذَف الزائد إن كان واحدًا، كأفضلَ ومَسْجدٍ وَجَوْهَرٍ وَصَيْرَفٍ وَعَلْقى، بل يُحذَف ما زاد عليه، سواء كان واحدًا كما فى نحو منطلق، أو اثنين كما فى نحو مستخرج، ويُؤْثَر بالبقاء ما له مزِيَّة على الآخر، معنىً ولفظاً كالميم، فيقال: مَطالِق وَمَخارج، لا نَطَالق وسَخَارِج أو تَخَارِج، لفضْل الميم، بتصدّرها، ودلالتها على معنى يختص بالأسماء؛ لأنها تدلُّ على اسمَىْ الفاعل والمفعول، وكالهمزة والياء مصدَّرتين فى نحو ألنَدد وَيَلَنْدَد للشديد الخصومة؛ لأنهما فى موضعين يقعان فيه دالّين على معنى كأقوم ويقوم، فتقول فى جمعها: ألاَدُّ وَيَلاَدُّ، أو لفظًا فقط: كالتاء فى نحو استخراج، تقول فى جمعه: تَخَارِيج بإبقاء التاء؛ لأنها لا تُخْرِج الكلمة عن عدم النظير، بل لها نظير نحو تَبَاريح وتماثيل وتصاوير، بخلاف السين لو قلت سَخَاريج، إذ لا وجود لسفاعيل. وكالواو فى نحو حَيْزَبُون للعجوز، فإن بقاءها يغنى عن حذف غيرها، وهو الياء، فتقول فى جمعه: حَزَابِين، بقلب الواو ياءً كما فى عُصْفور، بخلاف ما لو حذفتها وأبقيت الياء، وقلت: حَيَازِبْن بسكون الموحدة قبل النون، فإن حذفها لا يغنى عن حذف غيرها، إذ لا يلى ألف التكسير ثلاث إلا وأوسطهن ساكن معتلّ. فيلجئك ذلك إلى حذف المثناة التحتية، حتى يحصل مفاعل، فتقول: حَزَابِن. فإن لم يكن لأحد الزائدَين مزية على الآخرَ. فأنت بالخيار فى حذف أيهما شئت، كنونَىْ: سَرَنْدَى: للسريع فى أموره والشديد. وعَلَنْدَى للغليظ وألفيهما. فتقول: سرانِد، وعلاند بحذف الألف، وسراد وعلادٍ بحذف النون. وكذا حَبَنْطَى لعظيم البطن. تقول فيه: حَبانِطٍ وَحَبَاطٍ، بقلب الألف ياءً، ثم
يُعَلّ
إعلال جَوَارٍ؛ لأن كلتا الزيادتين للإلحاق بسفرجل؛ فتكافأتا.
خاتمة تشتمل على عدة مسائل
الأولى: يجوز تعويض ياءً قبل الطَّرف مما حذف، سواء كان المحذوف أصلاً أو زائدًا.
فتقول فى سفَرْجَل وَمُنْطَلِق: سفاريج وَمَطاليق. وأجاز الكوفيون زيادتها فى
مماثل مَفَاعِل. وحذفها من مماثل مفاعيل، فتقول فى جَعافر: جعافير وفى عصافير:
عصافِر. ومن الأول: {وَلَوْ ألْقَى مَعَاذِيرَه} ومن الثانى: {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ
الْغَيْبِ}. وأما فَوَاعل فلا يقال فيه: فواعيل إلا شذوذًا كقول زهير بن أبى
سُلمى:
*سَوَابِيغُ بِيضٌ لا يُخَرِّقُهَا النَّبْلُ*
الثانية: كلّ ما جرى على الفعل: مِن اسَمىْ الفاعل والمفعول، وأوله ميم، فبابه
التصحيح ولا يُكَسَّر، لمشابهته الفعل لفظًا ومعنى، وجاءَ شذوذًا فى اسم مفعول
الثلاثى من نحو ملعون، وميمون، ومَشْئوم، ومكْسور، وَمَسلوخة: ملاعين، وميامين،
ومشائيم، ومكاسير، ومَسَاليخ. وجاء أيضًا فى مُفْعِل. بضم الميمْ وكسر العين من
المذكر، كمُوسِر وَمُفْطِر: مياسيرُ ومفاطِير، كما جاء فى مُفْعَل بفتح العين
كمنكَر: مناكِير.
وأما إذا كان مُفْعِل بكسر العين، مختصًا بالإناث، فإنه يُكَسَّر كمُرْضِع
وَمَرَاضِع.
الثالثة:
قد تدعُو الحاجة إلى جَمْع الجمع، كما تدعو إلى تثنيته، فكما يقال فى جماعتين من
الجمال أو البيوت جِمالان وبَيُوتان. تقول أيضًا فى جماعات منها: جمالات
وبَيُوتات. ومنه {كَأنَّهُ جِمالاَتٌ صُفْر} وإذا قصِد تكسير مُكسَّر نظر إلى ما
يشاكله من الآحاد، فكيسَّر بمثل تكسيره، كقولهم فى أعْبُد: أعابد، وفى أسلحة:
أسالح، وفى أقوال: أقاوِيل، شَبَّهوها بأسْود وأساودِ، وأجْرِدة وأجارد، وإعصار
وأعاصير، وقالوا فى مُصْران جمع مَصِير: مَصَارِينُ. وفى غِرْبان: غَرَابِينُ.
تشبيهًا بسلاطين وسَراحين. وما كان على زِنة مَفاعل أو مفاعيل، فإنه لا يُكَسَّر
لأنه لا نظير له فى الآحاد، حتى يُحْمَل عليه، ولكنه قد يُجْمَع تصحيحًا، كقولهم
فى نَوَاكِس وأيامِن: نواكِسُون وأيامنون، وفى خرائد وصواحِب: خَرَائِدَات
وَصَواحبات، ومنه "إنكُنَّ لأنتنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُف".
الرابعة: قد تلحق التاء صيغة منتهى الجموع: إما عِوّضًا عن الياء المحذوفة،
كقنادِلة فى قناديل، وإما للدلالة على أن الْجمع للمنسوب لا للمنسوب إليه،
كأشاعثَة وأزارقة ومَهالبة، فى جمع أشعثىّ وأزرقىّ ومُهَلَّبىّ، نسبة إلى أشعَث
وازرقَ وَمُهلَّبَ، وإما لإلحاق الجمع بالمفرد، كصيارفة وصياقلة، جمع صيْرَفٍ
وَصيْقَل، لإِلحاقهما بطواعية وكراهية، وبها يصير الجمع منصرفًا بعد أن كان
ممنوعًا من الصرف. وربما تلحق التاءُ بعضَ صيغ الجموع لتأكيد التأنيث اللاحق له
كحجارة وعُمومة وخُئولة.
الخامسة:
المركبات الإضافية التى جُعلت أعلامًا تُجمع أجزاؤها الأوَلُ كما تُثَّنى، فتقول:
عبْدَا الله وعبْدَان لله وعِباد الله، وَذَوو القَعْدة والحِجَّة، وأذْوَاء أو
ذوات. وما كان كابن عِرس وابن آوَى وابنِ لَبُون، يقال فى جمعه: بنات عِرس، وبنات
آوى، وبنات لَبُون. والمركبات المَزْجِية، والمركبات الإسنادية، والمثنى، والجمع،
إذا جعلت أعلامًا لا تُثَنَّى ولا تجمع، بل يُؤْتَى بذو مثناةً أو مجموعة، بحسب
الحاجة، فتقول: ذَوَا بَعْلَبَكَّ أو أذْواء سِيبَوَيْه وذوو سِيبَويَه وذَوو
زَيْدِين.
السادسة: مما تقدم علمتَ أن للجمع صيغًا مخصوصة، وقد يدُلُّ على معنى الجمعية
سواها، ويسمى اسم الجمع، أو اسم الجنس الجمعىّ.
والفرق بين الثلاثة، مع اشتراكها فى الدلالة على ما فوق الاثنين: أن اسم الجنس
الجمعىّ: هو ما يتميز عن واحده: إما بالياء فى الواحد، نحو رومىّ ورُوم، وتُرْكَىّ
وتُرْك، وزَنجىّ وزَنِج، وإما بالتاء فى الواحد غالبًا، ولم يلتزم تأنيثه نحو تمرة
وتمر، وكلمة وكلم، وشجرة وشجر، ويقل كونها فى غير الواحد. والمحفوظ منه جَبْأة
وكَمْأة: لجنس الجَبْءِ، والكَمْءِ. وبعضهم يجعل الواحد منها ذا التاء على القياس،
فإن التُزِمَ تأنيثه بأن عُومِل معاملة المؤنث فَجَمْع، كَتُخَم وتُهَم، فى تُخَمة
وتُهمَة، إذ تقول: هى أو هذه تُخَمٌ وَتُهَمٌ.
وأن اسم الَجمع ما لا واحد له من لفظه، وليس على وزن خاص بالْجموع أو غالب فيها،
كقوم ورهط، أوْ لهُ واحد لكنه مخالف لأوزان الْجمع، كركْب وصَحْب، جمع راكب وصاحب،
وكغَزِىّ. بوزن غَنِىّ: اسم جمع غازٍ، أوْ له واحد وهو موافق لها، لكنه مساوٍ
للواحد فى النسب إليه: نحو رِكاب، على وزن رِجال، اسم جمع ركوبة، تقول فى النسب
إليه: رِكابىّ، والجمع كما سيأتى لا يُنْسَبُ إليه على لفظه إلا إذا جرى مجرى
الأعلام، أو أُهْمِل واحده، وهذا ليس واحدًا منهما، فليس بجمع.
وأن
الْجمع ما عدا ذلك، سواء كان له واحد من لفظه كرجال، أو لم يكن، وهو على وزن خاص
بالْجموع، كأبابيل: لجماعات الطير، وعَباديد: للفِرَق من الناس والخيل، أو غالب فى
الْجمع كأعراب، فإنه جمع واحدُهُ مُقَدَّرٌ.
وسواء توافق المفرد والْجمع فى الهيئة، كفُلْك وإمام، {وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إمَاماً} أوْ لا، كأفراس جَمْع فَرَس.
وعندهم اسم جنس إفرادىّ، وهو ما يصدُق على القليل والكثير، كعسل ولبن وماء وتراب.
التصغير
وهو لغة: التقليل، واصطلاحا: تغيير مخصوص يأتى بيانه، وقد سبق أنه من الملحق
بالمشتقات؛ لأنه وصف فى المعنى.
وفوائده: تقليل ذات الشئ أو كميته، نحو: كليب ودريهمات. وتحقير شأنه، نحو: رُجَيل.
وتقريب زمانه أو مكانه، نحو: قُبَيل العصر، وبُعَيد المغرب، وفُوَيق الفَرْسخ،
وتُحَيْتَ البَرِيد. أو تقريب مَنزلته نحو صُدَيِّقى أو تعظيمه نحو قول أوْس بنِ حَجَر:
*فَوَيْقَ جُبَيْلٍ شامخِ الرَّأس لم تكُن * لِتبْلُغَهُ حتَّى تَكِلَّ
وَتَعْمَلاَ*
وزاد بعضهم التمليح نحو: بُنَية وحُبيب، فى بنت وحبيب، وكلها ترجع للتحقير
والتقليل.
وشرط المصغر:
1- أن يكون اسمًا، فلا يصغر الفعل ولا الحرف، وشذ قوله:
*يا ما أميْلِحَ غِزْلانَا شَدَنَّ لنَا * مِن هَؤْليَّاءِ بَيْنَ الضَّالِ
والسَّلَمِ*
2- وألاَّ يكون متوغلا فى شبه الحرف، فلا تصغر المضْمَرات ولا المُبْهمَات، ولا
مَنْ وكيْفَ ونحوهما، وتصغيرهم لبعض الموصولات وأسماء الإشارة شاذّ، كما سيأتى.
3- وأن يكون خاليًا من صيغ التصغير وشبهها فلا يصغّر نحو كُمَيت وَشُعَيب؛ لأنه
على صيغته، ولا نحو مُهَيْمِن وَمُسَيْطِر؛ لأنهما على صيغة تشبهه.
4- وأن يكون قابلا للتصغير، فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء الله تعالى وأنبيائه
وملائكته، وعظيم وجسيم، ولا جمع الكثرة، ولا كلّ وبعض، ولا أسماء الشهور والأسبوع
على رأى سيبويه.
وأبنيته
ثلاثة: فُعَيل، وفُعَيْعِل، وفُعَيْعِيل، كفُلَيْس، وَدُرَيْهم، وَدُنَيْنِير، وضع
هذه الأمثلة الخليل. وقال: عليها بُنِيت معاملة الناس.
والوزن بها اصطلاح خاص بهذا الباب، لأجل التقريب، وليس على الميزان الصرفىّ، ألا
ترى أن نحو أحَيْمِر وَمُكَيْرم وَسُفَيرج: وزنها الصرفى أفَيْعِل، وَمُفَيْعل،
وَفُعَيْلِل، وأما التصغير فهو فُعَيْعل فى الجميع.
والأصل فى تلك الأبنية "فُعَيْل" وهو خاص بالثلاثىّ، ولا بد من ضم
الأوّل ولو تقديرًا، وفتح ثانيه، واجتلاب ياء ثالثة ساكنة، تسمَّى ياء التصغير.
وَيُقْتَصر فى الثلاثى على تلك الأعمال الثلاثة، فليس نحو لُغَيْرىّ: للّعز،
وَزُمَّيل للجبان تصغيراً، لسكون ثانيهما، وكون الياء ليست ثالثة.
وإن كان المصغر متجاوزًا الثلاثة احتيج إلى زيادة عمل رابع، وهو كسر ما بعد ياء
التصغير، وهو بناء "فُعَيْعِل" كجعيفِر فى جعفر.
ثم إن كان بعد المكسور حرف لِين قبل الآخِر: فإن كان ياء بقى كقنديل، فتقول فيه
قُنَيْديِل، وإلاّ قلب إليها، كمصيبيح وعُصيفير. فى مصباح وعصفور، وهو بناء
"فُعَيْعِيل".
ويُتَوَصَّل إلى هذين البناءين بما تُوُصَّل به إلى بناء فَعالِل وفَعاليل فى
التكثير من الحذف وجوبًا، أو تخييرًا، فتقول فى سفرجَل وفَرزدق، ومستخرج، وألندد،
ويلندد، وحَيزبون: سُفَيْرِج، وفُريزِد أَوفُريزِق، ومُخَيْرِج، وألَيَّد،
وَيُلَيِّد، وحُزيبين. وفى سرندى، وعلندى، سُريْنِد وعُليْند، أو سُرَيْد
وَعُلَيْدٍ، مع إعلالهما إعلال قاضٍِ.
وكما جاز فى التكسير تعويضُ ياء قبل الآخِر مما حُذِف، يجوز هنا أيضًا، فتقول:
سُفِيرج وسفيريج، كما قلت فى التكسير: سَفَارِج وسفَاريج، ولا يمكن زيادتها فى
تكسيرِ وتصغيرِ نحو احرنجام مصدر احرنجم؛ لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف
فى المفرد.
وما
جاء فى بابى التصغير والتكسير مخالفاً لما سبق فشّاذٌ، مثاله فى التكسير جمعهم
مكانًا على أمكن، ورهْطًا وكُراعًا على أراهط وأكارع، وباطلا وحديثًا على أباطيل
وأحاديث، والقياس: أمْكِنة، وأرْهُط أو رُهُوط، وأكرعة، وبواطل، وأحدثة. ومثاله فى
التصغير تصغيرهم مَغْرِبا وعشاء على مُغَيْرِبان وعُشَيّان، وإنسانًا وَلَيْلَة،
على أنَيْسِيان ولُيَيْلِيَة، ورَجُلا على رُوَيْجل، وصِبْية وَغِلْمة وَبَنون على
أصَيْبِية، وأغيلمة، وَأبَيْنون، وعَشية على عُشَيْشية، والقياس: مُغَيْرب،
وعُشَىّ، وأُنَيْسين، ولُيَيْلة، وَرُجَيل، وصُبَية، وغُلَيْمة، وبَنُيُّون
وَعُشَيّة. وقيل إن هذه الألفاظ مما استغنى فيها بتكسيرٍ وتصغير مهمل، عن تكسيرٍ
وتصغيرٍ مستعمَل.
ويستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير، فيما تجاوز الثلاثة: ما قبل علامة التأنيث
كشجرة وحُبْلى، وما قبل المَدَّة الزائدة قبل ألف التأنيث كحمراء، وما قبل ألف
أفعال، كأجمال وأفراس، وما قبل ألف فَعْلان الذى لا يُجمع على فعالين، كسكران
وعثمان، فيجب فى هذه المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحه للخفة، ولبقاء
ألِفَىْ التأنيث وما يشبههما فى منع الصرف، وللمحافظة على الجمع، فتقول: شُجَيرة
وحُبَيلى، وحُمَيراء، وأجيمال، وأفيراس، وسُكيران، وعُثيمان؛ لأنهم لم يجمعوها على
فَعَالين كما جمعوا عليه سِرْحانا وسُلطانا، ولذا تقول فى تصغيرهما: سُرَيْحين
وسُلَيْطين، لعدم منع الصرف بزيادتهما، فلم يبالوا بتغييرهما تصغيرًا وتكسيرًا.
ويستثنى
من التوصل إلى بِنَاءَىْ فُعَيْعِل وفعَيْعِيل، بما يُتَوصَّل به إلى بناء مَفاعل
ومفاعيل، عِدَّةُ مسائل جاءت على خلاف ذلك، لكونها مختَتَمة بشئ مقدّر انفصاله،
والتصغير وارد على ما قبله. والمقدر الانفصال هو ما وقع بعد أربعة أحرف: من ألف
تأنيث ممدودة كقُرفُصاء، أو تائه كحَنْضلة، أو علامة نسَب كعَبْقَرِىّ، أو ألف
ونون زائدتين، كزعْفران وجُلْجُلان، أو علامتَى تثنية، كمسلِمَيْن ومُسلِمان، أو
علامتى جمع تصحيح المذكر والمؤنث، كجعفَرِين وجعفرون ومسلمات، أو عَجُزَىِ المضاف
والمَزْجىِّ، فهذه كلها يخالف تصغيرها تكسيرها، تقول فى التصغير: قُرَيْفِصاء،
وحُنَيظلة، وعُبَيقِرىّ، وزُعَيفران، وجُلَيجِلان ومُسَيْلمَين أو مُسَيْلمان،
وجُعَيْفِرينَ أو جُعَيفرون، ومُسَيْلِمات، وأُمَيْرِئ القيس وَبُعَيْلَبَكّ،
وتقول فى تكسيرها: قرافِص، وحناظل، وعباقر، وزَعافر، وجلاجل؛ إذ لا لبس فى حذف
زائدها تكسيرًا، بخلاف التصغير؛ للالتباس بتصغير المجرد منها. وإذا أتت ألف
التأنيث المقصورة رابعة، ثبتت فى التصغير، فتقول فى حُبْلى: حُبَيْلَى، وتُحذف
السادسة والسابعة كَلُغَيزَى: للغز، وبَرْدَرايا: لموضع، فتقول: لُغَيْغِيز
وبُرَيْدِر، وكذا الخامسة إن لم تُسبق بمدة كقَرْقَرى: لموضع: تقول فيها
قُرَيْقِر، وإن سُبِقت بمدة خُيّرْت بين حذفها وحذف ألف التأنيث، كحبارى: لطائر،
وقُريْثا لِتمر، فتقول: حُبَيّر أو حُبيْرى، وقُرَيِّث أو قُرَيْثَا.
واعلم أن التصغير يردّ الأشياء إلى أصولها:
فإِن
كان ثانى الاسم المصغر لينًا منقلبًا عن غيره، يُرَدّ إلى ما انقلب عنه. سواء كان
واوًا منقلبة ياء أو ألفا، نحو: قيمة ماء، تقول فيهما: قُوَيْمة ومُوَية؛ وإذ
أصلهما: قوْمة ومَوَه، بخلاف ثانى نحو: متَّعِدّ، فإنه غير لين، فيصغّر على
مُتَيْعد، وبخلاف ثانى "آدم" فإنه منقلب عن غير لين، فيقلب واوًا كالألف
الزائدة من نحو ضارب، والمجهولة من نحو صاب وعاج، فتقول فيها: أوَيْدِم، وضُوَيرب،
وصُوَيب وعُوَيْج. وأما تصغيرهم عيدًا على عُيَيْد، مع أنه من العَوْد فشاذّ،
دعاهم إليه خوف الالتباس بالعُود أحد الأعواد.
أو كان ياءً منقلبة واوًا أو ألفًا، كموقن وناب، تقول فيهما: مُيَيْقِن ونُييب، إذ
أصلهما مُيْقِن ونَيْب. أو كان همزة منقلبة ياء كذِيب، تقول فيه: ذؤيب. أو كان
أصله حرفًا صحيحًا غير همزة، نحو: دنينير فى دينار، إذ أصله دِنَّار، بتشديد
النون.
ويجرى هذا الحكم فى التكسير الذى يتغير فيه شكل الحرف الأول، كموازين وأبواب
وأنياب بخلاف نحو قِيَم ودِيَم.
وإن حذف بعض أصول الاسم، فإن بقى على ثلاثة كشاكٍ وقاض، لم يُرَدّ إليه شئ، بل
تقول: شُويْكٍ وقويضٍ، بكسر آخره منوَّنا، رفعًا وجرًا، وشُوَيْكيًا وقويضيًا
نصبًا، وإلا رُدّ، نحو "كُلْ وَخُذ وَعِدْ" بحذف الفاء فيها، وَمُذْ
وَقُلْ وَبِعْ بحذف العين أعلامًا، ونحو: يد ودم، بحذف لامهما، ونحو: قِه وفِه
وشِه، بحذف الفاء واللام، وَرَهْ بحذف العين أعلامًا أيضًا، فتقول فى تصغيرها:
أكَيل، وَأخَيذ، ووعَيد، بردّ الفاء، ومُنَيذ وَقُوَيل وَبُيَيع، برد العين،
ويُدَىّ وَدُمَىّ، برد اللام، وَوُقَىّ وَوُفَىّ وَوُشَىّ، برد الفاء واللام،
وَرُأىّ، برد العين واللام.
أما
العَلم الثُّنَائىُّ الوضع. فإن صح ثانيه كبَلْ وهلْ، ضُعِّف أو زيدت عليه ياء،
فيقال: بُليْل أو بُلَىّ، وهُلَيل أو هُلَىّ، وإلا وجب تضعيفه قبل التصغير، فيقال
فى لَوْ وما وكَى أعلامًا: لَوّ وكَىّ، بتشديد الأخير، وماء، بزيادة ألف للتضعيف
وقلب المزيدة همزة؛ إذ لا يمكن تضعيفها بغير ذلك، وتصغر تصغير دوٍّ وحىّ وماء،
فيقال: لُوىّ وكُيَىّ ومُوَىّ، كما يقال: دُوَىّ وَحُيَىّ وَمُوَيه، إلا أن هذا
لامه هاء، فرُدّ إليها.
وإن صغِّر الخالى من علامة التأنيث، الثلاثىّ أصلا وحالا، كدار وسن وأُذن وعين، أو
أصلاً: كيد، أو مآلا فقط كحُبْلَى وحمراء، إذا أريد تصغيرهما تصغير ترخيم كما
سيأتى، وكسماء مطلقًا، أى ترخيما وغيره، لحقته التاء إن أمن اللبس، فتقول:
دُوَيْرة، وسُنَينة، وعُيَيْنَة، وأذَيْنة، ويُدَية، وحُبَيلة، وحُميرة، وفى غير الترخيم
حُبَيلىَ وحُميراء كما سلف، وسُمَية، وأصله سُمَيَىُّ بثلاث ياءات، الأولى
للتصغير، والثانية بدل المدة، والثالثة بدل الهمزة المنقلبة عن الواو؛ لأنه من سما
يسمو، حُذفت منه الثالثة لتوالى الأمثال، ولو سَمَّيت به مذكرًا حذفت التاء،
فتقول: سُمىّ، لتذكير مسمَّاه، وأما نحو شجر وبقَر فلا يصغَّر بالتاء؛ لئلا يلتبس
بالمفرد، وذلك عند من أنَّثهما، وأما عند من ذكرَّهما فلا إشكال، وكذا نحو زينب
وسُعاد لتجاوزهما الثلاثة، فيقال فيهما: زُيَينب، وسُعيِّد بتشديد الياء.
وشذ حذف التاء فيما لا لبس فيه، كحرْب وذَوْد وَدِرْع ونَعْل ونحوها، مع ثلاثيتها،
واجتلابها فيما زاد على الثلاثة، كوُرَيِّئَة وأمَيِّمة، بياءين مدغمتين، الأولى
للتصغير، والثانية بدل المدة، وَقُدَيديمة، بياءين بينهما دال: الأولى للتصغير،
والثانية بدل المدة، تصغير وراء، وأمام، وقُدَّام.
[تصغير الترخيم]
واعلم
أن عندهم تصغيرًا يسمى تصغير الترخيم، ولا وزن له إلا فُعَيْل وَفُعَيْعِل؛ لأنه
عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزائد.
فيصغر الثلاثىّ الأصول على فعَيْل، مجرَّدًا من التاء، إن كان مسماه مذكرًا،
كحُمَيد فى جامد ومحمود ومحمد وأحمد وحمَّاد وحمدان وحَمُّودة، ولا التفات إلى
اللبس ثِقةً بالقرائن، وإلا فبالتاء كحُبَيلة وسويدة فى حبلى وسوداء، إلا الوصف
المختص بالنساء كحائض وطالق، فيقال فى تصغيرهما: حُيَيْض وطُلَيْق من غير تاء؛
لكونه فى الأصل وصف مذكر، أى شخص حائض أو طالق، فإن صغَّرتهما لغير ترخيم، قلت:
حُويِّض بشدّ الياء، وطُويلِق، بقلب ألفهما واوًا، لأنها ثانية زائدة.
وأما الرباعىّ: فيصغر على فُعَيْعِل كقُرَيْطِس وَعُصيفر فى قِرطاس وعُصفور، ويصغر
إبراهيم وإسماعيل ترخيما على بُرَيْه وسُمَيْع، ولغير ترخيم على بُرَيْهِيم
وسُمَيْعِيل، أو على أبَيْرَه وأسَيْمَع، على الخلاف فى أن الهمزة أو الميم واللام
أوْلى بالحذف. ولا يختص تصغير الترخيم بالأعلام، على الصحيح.
تنبيهان:
الأول: تقدم أنه لا يصغر جمع على مثال من أمثلة الكثرة، لمنافاة التصغير للكثرة،
وأجاز الكوفيون تصغير ماله نظير فى الآحاد كرُغْفان، فإنه نظير عثمان، فيقال فى
تصغيره: رُغَيفان. فمن أراد تصغير جمعٍ ردَّه إلى مفرده وصغَّره، ثم يجمعه جمع
مذكر إن كان لمذكر عاقل، وجمع مؤنث إن كان لمؤنث أو لغير عاقل، كقولك فى غلمان
وجوارٍ وَدَرَاهم: غُلَيّمون أو غُلَيِّمِين، وجُوَيْريات وَدُرَيهمات.
وأما اسم الجمع واسم الجنس الجمعى فيُصغران، لشبههما بالواحد.
الثانى: لا يُصغر إلا المتمكن كما سبق، ولا يصغر من غيره إلا أربعة:
1- أفعل فى التعجب.
2- والمزْجىّ ولو عدديا عند من بناه.
3- و "ذا" و "تا" ومثناهما وجمعهما.
4- والذى والتى كذلك.
وحكمها:
أن تصغير أفعل والمزجىّ كالمتكن فى هيئته، كما تقدم، بخلاف الإشارة والموصول،
فيترك أولهما على حاله: مِن فتحٍ، كذا والذى، أو ضمٍّ كأولَى، ويزاد فى آخِر غير
المثنى ألف، فتقول: ذيا وتيا، ومنه قول رؤْبة الراجز:
*أو تحلِفى بِرَبِّكِ الْعَلِىِّ * أنَّى أبُو ذَيَّالِك الصَّبِيِّ*
وذَيَّان وَتَيَّان وأولَيَّا، وَاللَّذَيَا وَاللَّتَيَا وَاللَّذَيان
واللَّتَيان واللَّذَيِّين مطلقًا، بفتح الياء المشددة أو كسرها، أو اللَّذَيُّون
فى حالة الرفع، بضم الياء أو فتحها، على الخلاف بين سيبويه والأخفش، وَاللَّتيات
جمع اللَّتيا، يغنى عن تصغير اللائى واللاتى عند سيبويه، وصغَّرهما الأخفش بقلب
الألف واوًا وحذف لامهما وهى الياء الأخيرة. وتقلب الهمزة ياء فى اللائى، فيقال:
اللَّويَا وَاللَّوَيْتا. وضم لام اللَّذيا واللتيا لغةٌ، كما فى التسهيل، خلافًا
للحرِيرىّ فى "دُرَّة الغواص". وإنما ساغ تصغير الإشارة والموصول؛ لأنهما
يوصفان ويوصف بهما، والتصغير وصف فى المعنى ولذا مُنِع عمل اسم الفاعل مصغرًا، كما
مُنع موصوفًا.
النَّسَب
وسماه سيبويه: الإضافة، وابن الحاجب: النّسبة بكسر النون وضمها، بمعنى الإِضافة؛
أى الإضافة المعكوسة، كالإِضافة الفارسية.
ويحدث به ثلاث تغييرات: لفظىّ، ومعنوىّ، وحُكْمِىّ.
فالأول: زيادة ياء مشددة فى آخر الاسم مكسور ما قبلها، لتدل على نسبته، إلى المجرد
منها، منقولاً إعرابه إليها، كمصرىّ، وشامىّ وعراقىّ.
والثانى: صيرورته اسمًا للمنسوب.
والثالث: معاملته معاملة الصفة المشبهة فى رفعه الظاهر والمضمر باطراد، كقولك: زيد
قرشىّ أبوه، وأمه مصريّة.
ويحذف لتلك الياء ستة أشياء فى الآخِر:
الأول:
الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف، سواء كانت زائدة ككرسىّ أو للنسب كشافعىّ،
كراهية اجتماع أربع ياءات. ويقدرَّ حينئذ أن المنسوب والمنسوب إليه مع الياء
المجددة للنسب، غيرُهما بدونها، ولهذا التقدير ثمرة تظهر فى نحو بَخاتِىّ وكراسىّ
إذا سُمِّى بهما مذكر، ثم نسب إليه، فإنه قبل النسب ممنوع من الصرف؛ لوجود صيغة
منتهى الجموع، نظرًا لما قبل التسمية، فإن الياء من بِنْية الكلمة، وبعد النسب
يصير مصروفًا لزوال صيغة الجمع بياء النسب. وإن سُمِّىَ به مؤنث، فيكون ممنوعًا من
الصرف، ولكن للعلمية والتأنيث المعنوىّ. والأفصح فى نحو مَرمىّ مما إحدى ياءيه
زائدة حذفهما، وبعضهم يحذف الأولى، ويقلب الثانية واوًا، لكن بعد قلبها ألفًا،
لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فتقول على الأول: مرمىّ، وعلى الثانى: مَرْمَوىّ.
ويتعين فى نحو حَىَّ وَطَىّ مما وقعتا فيه بعد حرف واحد فتحُ أولاهما، وردُّها إلى
الواو إن كانت الواو أصلها، وقلبُ الثانية واوًا كطَووىّ وَحَيَوىّ.
الثانى: تاء التأنيث، تقول فى النسبة إلى مكة: مكىّ، وقول العامة: خليفتِىّ فى
خليفة، وخَلْوَتِىّ فى خَلْوة لَحْن، والصواب خَلَفِىّ وخَلْوِىّ.
الثالث: الألف خامسة فصاعدًا مطلقًا، أو رابعة متحركًا ثانى كلمتها: فالأولى ألف
التأنيث كحُبارى: لطائر، أو الإلحاق: كحَبَرْكىَ مُلْحَق بسفرجل: للقُراد، أو
المنقلبة عن أصل كمصطفى من الصفوة، تقول فى النسبة إليها: حُبَارِىّ وَحَبَرْكِىّ
ومصطفىّ. والثانية: ألف التأنيث خاصةً كجمَزَى: للحمار السريع، تقول فى النسبة
إليه جَمَزِىّ.
فإن
سكن ثانى كلمتها جاز حذفها وقلبها واوًا سواء كانت للتأنيث كحُبْلى، أو للإلحاق
كعَلْقًى، اسم لنبت، فإنه ملحق بجعفر، أو منقلبة عن أصل كَملْهًى من اللهو، تقول
فيها: حُبْلِىّ أو حُبْلَوِىّ، وعَلْقِىّ أو عَلْقَوِىّ، ومَلْهِىّ أو مَلْهَوِىّ.
والقلب أحسن من الحذف، ويجوز زيادة ألف بين اللام والواو نحو: حُبْلاوِىّ.
الرابع: ياء المنقوص خامسة كالمعتدى، أو سادسة كالمستعْلِى، تقول فيهما:
المعتدِىُّ والمستعلِىّ. أما الرابعة كالقاضى فكألف نحو مَلْهًى، تقول: القاضِىّ
والقاضَوِى، والحذف أرجح. وأما الثالثة كالشجى والشذِى فيجب قلبها واوًا، كألف نحو
فَتى وعَصًى، تقول: شَجَوِىّ وَشّذَوِىّ، كما تقول فَتَوِىّ وعَصَوِىّ، ولا تقلب
الياء واوًا إلا بعد قلبها ألفًا، ويُتَوصَل لذلك بفتح ما قبلها، كما سبق فى
مَرْمِىّ.
وإذا نسَبْتَ إلى فَعِل، مكسور العين، مثلث الفاء، كنَمِر ودُئِل وَإبِل، فتَحْتَ
عينه فى النسب، تقول: نمرىّ، ودُؤَلِىّ وَإبَلىّ، وقال بعضهم: يجوز فى نحو إبل
إبقاء الكسرة إتباعاً.
الخامس والسادس: علامتا التثنية وجمع تصحيح المذكر عَلَمَيْن إذا أعربا بالحروف،
تقول: زَيْدىّ فى النسب إلى زيدانِ وزيدُونَ. وأما من أجرى المثنى عَلَمًا مجرى
سَلْمان فى المنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، فيقول: زَيْدَانى، ومن
أجرى المذكر مجرى غِسْلين، فى لزوم الياء والإعراب على النون منونة، يقول فيه: زَيْدِينِىّ،
ومن جعله كهارونَ فى المنع من الصرف للعلمية وشبه العُجمة مع لزوم الواو، أو
كعُرَبُون فى لزومها منونًا، أو كالماطرونَ: اسم قرية بالشام فى لزومها وتقدير
الإِعراب عليها، وفتح النون للحكاية، يقول فى الجميع: زَيْدُونِىّ.
أما
جمع المؤنث السالم، فنحو تَمرات جمعًا، ينسب إلى مفرده ساكن الميم، وعلمَا
مفتوحها، سواء حُكى أو مُنع، وذلك للفرق بين النسب إليه مفردًا وجمعًا، وأما نحو
ضَخْمات فألفه كألف حُبْلى بجامع الوصفية. ويجب الحذف فى ألف هذا الجمع خامسةً
فصاعدًا، سواء كان من الجموع القياسية كمسلمات، أو الشاذة كسُرادقات، تقول: فيها
مُسْلمِىّ وَسُرادِقىّ.
ويجب حذف ستة أخرى متصلة بالآخِر:
أحدها: الياء المكسورة المدغم فيها مثلها، فيقال فى نحو طيِّب وَهَيِّن: طَيْبىّ
وهينىّ، بخلاف المفتوحة كهبيَّخ للغلام الممتلئ، ما لم يكن بعد المكسورة ياء ساكنة
كمُهَيَّيم، تقول: هَبَيَّخِىّ ومُهَيَّيمِىّ، ومُهَيَّيمِىّ تصغيرها مِهْيَام،
مِفْعال من هام على وجهه: إذا ذهب من العشق، أو من هام إذا عطِش، أو مُهوِّم، اسم
فاعِل من هَوَّمَ الرجلُ: هز رأسه من النُّعاس، تحذف الواو الأولى، ثم توضع ياء
التصغير، فيصير مُهْيوم، فَيُعَلّ على مُهيم، إتباعًا لقاعدة اجتماع الواو والياء
وسبْقِ إحداهما بالسكون، فيشتبه حينئذ باسم الفاعل المكبر من هَيَّمه الحُبّ،
فإِذا نسب إلى المصغَّر زيدت ياء، لمنع الاشتباه، ومثله مصغر مُهيَّم المذكور،
وشذّ طائِىّ فى طَيّئ، إلا إذا قيل بحذف الياء الأولى، وقلب الثانية ألفًا.
ثانيها: ياء فَعِيلة بفتحٍ فكسر، صحيح العين غير مضعِّفها، كحنيفة وحنَفِىّ،
وصحيفة وصَحَفّى، بحذف التاء ثم الياء، ثم قلب كسرة العين فتحة، وشذ: سَلِيقىّ،
منسوبًا إلى سَلِيقة فى قوله:
*وَلَسْتُ بِنَحْوِىّ يَلُوكُ لِسانَهُ * وَلكِنْ سَلِيقىُّ أقُولُ فَأعْرِبُ*
كما شذ: عَمِيرىّ وسَلِيمِىّ، فى عَمِيرة كلْب، وسَلِيمة الأزد، نطقوا بالأول،
للتنبيه على الأصل المرفوض، وبالأخيرين له، وللتفرقة بين عَمِيرة غير كلْب،
وسَلِيمة غير الأزد.
أما معتل العين كطويلة، أو مضعَّفها كجليلة، فلا تحذف ياؤهما، تقول فيهما: طَوِيلىّ،
وجَلِيلىّ.
ثالثها:
ياء فُعَيْلة بضم الفاء، وفتح العين، غير مضعفتها، كجُهَيْنة وَقُرَيْظة، تقول فى
النسبة إليهما: جُهَنِىّ وَقُرَظَىّ بحذف التاء، ثم الياء، وعُيَنِىّ وَقُوَمِىّ،
فى عُيَيْنة وقُوَيمة كذلك، مع بقاء ضم الفاء؛ إذ لا يترتب عليها إعلال العين.
وشذَّ: رُدَيْنِى فى رُدَيْنة، ولا يجوز الحذف فى نحو قُلَيلة؛ لأن العين مضعَّفة.
رابعها: واو فَعُولة، بفتح الفاء، صحيحة العين، غيرَ مضعفتها، كشَنُوءَة؛ تقول فيه
على مذهب سيبويه والجمهور: شَنَئِىّ، بحذف التاء، ثم الواو، ثم قلب الضمة فتحة.
ومَن قال: شَنَوِىّ بالواو، قال فيها: شَنُوَّة، بشد الواو. وذهب الأخفش إلى حذف
التاء فقط، وغيرُهُ إلى حذف الواو مع التاء فقط. وأما نحو قَوُولة وَمَلُولة، فلا
حذْف فيهما غير التاء؛ للاعتلال فى الأول، والتضعيف فى الثانى.
خامسها: يا فَعِيل، بفتحٍ فكسر، يائىّ اللام أو واويها، كغَنِىّ وعَلِىّ، تحذف
الياء الأولى، ثم تقلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الياء الثانية ألفًا، ثم تقلب الألف
واوًا، فتقول: غَنَوِىُّ وَعَلَوِىّ.
سادسها: ياء فُعَيل، بضم ففتح، المعتلّ اللام كقُصَىّ. تحذف الياء الأولى، ثم تقلب
الثانية ألفًا، ثم تقلب الألف واوًا، فتقول: قُصَوِىّ، فإن صحت لام فعِيل وفُعَيل،
كعَقيل وعُقَيل، ولم يحذف منهما شئ، وشذَّ فى ثَقيف، وقُرَيش، وهُذَيل: ثَقَفىّ،
وقُرَشِىّ، وهُذَلِىّ.
وحكم همزة الممدود هنا كحكمها فى التثنية، فتسلم إن كانت أصلا، كقُرَّائِىّ فى
قُرَّاء، ومنهم من يقلبها واوًا، والأجود التصحيح. وتقلب واوًا إن كانت للتأنيث
كحَمْرَاوِىّ وصَحْرَاوِىّ، فى حمراء وصحراء، وشذّ قلبها نونا فى صَنْعانىّ
وبَهْرانِىُّ، نسبة إلى صَنْعاء اليمن وَبَهْرَاء اسم قَبيلة من قُضاعة، وبعض
العرب يقول: صَنْعاوِىّ وَبَهْرَاوىّ على الأصل.
ويُخيّرُ
فيها إن كانت للإلحاق كعلباء، أو بدلاً من أصل ككساء، فتقول: عِلْبائى أو
عِلْباوىّ، وكسائىّ أو كساوىّ.
وَيُنْسَب إلى صدر العَلمَ المركَّب إسناديًّا، كبَرَقِىّ، وتأبَّطِىّ: فى بَرَقَ
نحره، وتأبَّطَ شَرًّا. أو مَزْجِيا كبَعْلِىّ وَمَعْدِىّ فى بعْلَبَكّ وَمَعْدِ
يكَرِبَ. وهذا هو القياس فيه مطلقًا، سواء كان صحيح الصدر أو معتله. وبعضهم يعامل
المعتلَّ معاملة المنقوص، فيقول فى مَعْدِ يكرب: مَعْدَوِىّ. وقيل يُنْسَبُ إلى
عجُزه، فتقول: بَكِّىّ وَكَرَبِىّ. وقيل: إليهما مُزالا تركيبهما، فتقول: بَعْلِىّ
بَكِّىّ، وَمَعْدِىّ كَرَبِىّ؛ وعليه قولُه:
*تَزَوَّجْتُها رَامِيَّة هُرْمُزيَّةً * بِفَضْلَة مَا أَعْطَى الأمِيرُ مِنَ
الرِّزْقِ*
فى النسبة إلى "رامَ هُرْمُزَ" وقيل إلى المركب غير مزال تكريبه، تقول
بعْلَبكِّىّ ومَعْدِيكَربىّ. وقيل: يُنْسَبُ إلى "فَعْلَلٍ" مُنْتَحَتَا
منهما، تقول بَعْلَبِىّ ومَعْدكِىّ، كما تقول: حضْرَمِىّ فى حَضْرَمَوْت.
ومثل الإِسنادى أيضًا الإضافىّ كامرئ القيس، تقول فيه امْرِئى أو مَرَئىّ، والثانى
أفصح عند سيبويه، وعليه قول ذى الرُّمَّة يهجو امرأ القيس:
*إذا المَرَئِىُّ شَبَّ له بَنَاتٌ * عقَدْنَ برأسِهِ إِبَةً وَعَارَا*
وقول ذى الرُّمة:
*يعُدُّ النَّاسِبُون إِلَى تمِيمٍ * بُيُوتَ المجدِ أرْبَعَةً كِبَارَا*
*ويخرُجُ منهُمُ المَرَئىُّ لَغْواً * كما ألغَيْتَ فى الدِّيَةِ الْحُوَارَا*
ويُسْتثنى من المركب الإضافىّ ما كان كُنية، كأبى بكر وأم كلثوم، أو معرّفًا صدرُه
بعجزه، كابن عمر وابن الزُّبير، فإنك تَنْسُب إلى عَجُزه، فتقول: بكْرِىّ
وكُلْثُومِىّ وَعُمَرِىّ.
وألحق بهما ما خِيف فيه لَبْس، كقولهم فى عبد مَناف: مَنَافِىّ، وعبد الأشهل:
أشْهَلِىّ، دفعًا للَّبس.
وشذّ
فيه: "فَعْلَلٌ" السابق، كتَيْمَلِىّ وعَبْدَرِىّ، ومَرْقَسِىّ،
وعَبْقَسِىّ، وعبْشَمِىّ: فى تيم اللاَّت، وعبد الدار، وامرئ القيس ابن جحْر
الكِنْدِىّ، وعبد القيس، وعبد شَمْس. ومن الأخير قول بعد يغُوث الحارثىّ:
*وَتَضْحَكُ مِنِّى شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّة * كأَن لَمّ تَرَى قَبْلِى أسيراً
يَمانِيَا*
وَإذا نُسِبَ إلى ما حُذِفَتْ لامه، فإن جُبر فى التثنية وجمعِ التصحيح بردّها،
كأبٍ وَأخٍ وَعِضةٍ وَسَنَةٍ، تقول فيها: أبَوَانِ وَأخَوَانِ وعِضَوات
وَسَنَوَاتِ، أو عِضَهات وسَنَهات، وجب ردُّ المحذوف فى النسب، فتقول: أبَوِىّ
وأخَوِىّ وعِضَوِىّ وسَنَوِىّ، أو عِضَهِىّ وسَنَهِىّ. وإن لم يُجبَر فيهما جاز
الأمران فى النسب، نحو غَدٍ وَشَفَةٍٍ، تقول فيهما: غَدِىّ وشَفِىّ، أو غَدَوِىّ
وشَفَوِى إلا إن كانت عينه معتلة فيجب جَبْره، كَذَوَوِىّ فى ذِى وذَات، بمعنى
صاحب وصاحبة، وشَاهِىّ أو شَوْهِىِّ، بسكون الواو فى شاة، أصلها: شَوْهة. ويجوز
الأمران فى يدٍ ودمٍ عند من لا يَرُدّ لامَهما فى التثنية، ووجب الردُّ عند من
يردها، فتقول على الأول: يَدِىٌّ أو يَدَوِىّ، ودَمِىّ أو دمَوِىّ، وعلى الثانى:
يَدَوِىّ وَدَمَوِىّ لا غير.
وإذا نُسِب إلى ما حُذِفت لامه، وعُوِّض عنها تاء تأنيث لا تنقلب هاء فى الوقف،
حذَفت تاؤه، فتقول: بَنَوِىّ وأخَوِىّ فى بِنْت وَأخْت، ويونس يقول: بِنْتِىّ
وَأُخْتِىّ، ببقاء التاء، محتجًّا بأن التاء لغير التأنيث؛ لأن ما قبلها ساكن
صحيح، ولا يُسَكن ما قبل تاء التأنيث إلا إن كان معتلا كفتاة، وبأن تاءها لا
تُبْدل هاء فى الوقف. وكل ذلك مردود بصيغة الجمع، إذ تقول فيهما: بَنَات وأخَوَات،
بزيادة ألف وتاء، وحذف التاء الأصلية.
ولا
تُرَدُّ الفاء لما صحت لامه، كعِدَة وصِفَة، تقول فيهما: عِدِىّ وصِفّى، وتُردُّ
لمعتلها كشِيَة، تقول فيه: وَشَوِىّ، بكسر الواو، وفتح الشين، أو وِشْيِىِّ،
بكسرتين بينهما شين ساكنة.
وإذا نُسِب إلى محذوف العين، وهو قليل فى كلامهم، فإن صحت لامه ولم يكن مضعَّفًا،
لم يجبَر بردِّ المحذوف، كسَه وَمُذْ، مسمًّى بهما، فتقول منهما: سَهِىّ ومُذِىّ،
لا: سَتَهِىّ ومُنْذِىّ. وإن كان مضعفًا كرُبَ بحذف الباء الأولى، مخفف رُبَّ إذا
سمى به، فإنه يجبر برد المحذوف، فيقال: رُبَّىّ. ومثل المضعَّف فى وجوب الرد:
معتلُّ اللام كالْمُرِى، اسم فاعل أرَى، وكيَرَى مضارع رَأى مسمًّى بهما، فتقول
فيهما: الْمُرْئى، واليَرْئىّ، بفتح الياء، وسكون أو فتح الراء، على الخلاف بين
سيبويه والأخفش، من إبقاء حركة فاء الكلمة بعد الرد، أو عدم إبقائها.
وإذا نَسَبْت إلى الثَّنائى وضعًا، ضَعَّفت ثانيه إن كان معتلا، فتقول فى لَوْ
وكىْ مُسمًّى بهما: لَوُّ وكَىُّ بالتشديد، وتقول فى لا عَلَما: "لاء"
بالمدّ، وفى النسب إليها: لَوِّىُّ وكَيْوِىّ، ولائىُّ أو لاوِىّ، كما تقول فى
النسب إلى الدوِّ وهو الفلاة، والحىّ، والكساء: دوِّىّ وحَيَوِىّ وكِسائىّ أو
كِساوِىّ، وأنت فى الصحيح بالخيار، نحو: كم، فتقول: كَمِىّ بالتخفيف، أو كَمِّى
بالتضعيف.
وينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إن كانت اسم جمع، كقومىّ ورهطىّ: فى
قوم ورهط، أو اسم جنس كشَجَرىّ فى شجر، أو جمع تكسير لا واحد له، كأبابيلىّ فى
أبابيل، أو علَمًا كَبَساتينىّ، نِسبة إلى البساتين، عَلَم على قرية من ضواحى مصر،
أو جاريا مجرى العلم كأنصارىّ، أو يتغير المعنى إذا نُسب لمفرده كأعرابىّ.
خاتمة
قد يُسْتغنى عن ياء النسب غالبًا بصوغ "فاعِلٍ" مقصودًا به صاحب كذا،
كطاعم، وكاسٍ، ولابن، وتامرٍ. ومنه قول الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر:
*دعِ
المكارِمَ لا تَرْحَل لبُغيتها * واقْعُدْ فإنَّكَ أنْتَ الطَّاعِمُ الكاسِى*
أى ذُو طعام وكُسْوة.
وقوله:
*وَغَررْتَنى وَزَعَمْتَ * أنكَ لابنٌ فى الصيف تَامِرْ*
أى ذُو لبن وتمر.
أو بصوغ "فعَّال" بفتح الفاء وتشديد العين، مقصودًا به الْحِرَفُ،
كنَجَّار وعطَّار وبَزَّاز؛ أى محترف بالنِّجارة والعِطارة والبزارةِ، أو بصوغ
"فَعِل" بفتح فكسر، كطَعِم وَلَبِن؛ أى صاحب طعامٍ ولبن. ومنه قوله:
*لَسْتُ بِلَيْلِىّ ولكنّى نَهِرْ * لا أدْلجُ اللَّيْلَ وَلكِنْ أبْتَكِرْ*
وتصاغ نادرًا على وزن "مِفْعال" كمِعطار؛ أى ذى عِطر،
"وَمِفْعِيل" كفرس مِحْضير؛ أى ذى حُضْر، بضم فسكون، وهو الجرى.
وما خرج عما تقدَّم فى النسب فشاذّ، كقولهم: رَقَبانِىّ وشَعْرَانِىّ وفَوْقانىّ
وتحتانىَ، بزيادة الألف والنون: لعظيم الرَّقبة، والشعْر، ولِفَوق، وتحت،
ومَرْوَزِىّ فى مَرْو، بزيادة الزاى، وَأمَوِىّ بفتح الهمزة فى أمَيَّة بضمها،
وَدُهْرِىّ بالضم: للشيخ الكبير فى الدهر بالفتح، وبَدَوِىّ، بحذف الألف، فى
البادية، وَجَلُولِىّ وحَرورِىّ، بحذف الألف والهمزة، فى جَلُولاء، قرية بفارس،
وحَرُوراء قرية بالكوفة.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثالث -
فى أحكام تعم الاسم والفعل ) ضمن العنوان ( فصل: فى حروف الزيادة، ومواضعها،
وأدلتها )
اعلم أن الزيادة فى الكلمة عن الفاء والعين واللام: إمَّا أن تكون لإفادة معنى،
كفرَّح بالتشديد من فرح، وإمَّا لإلحاق كلمةٍ بأخرى، كإلحاق قُرْدُد (اسم جبل)
بجعفر، وجَلْبَبَ بِدَحْرَجَ.
ثم هى نوعان:
أحدهما: ما يكون بتكرير حرف أصلى لإلحاق أو غيره، وذلك إما أن يكوت بتكرير عين مع
الاتصال، نحو قَطَّع، أو مع الانفصال بزائد، نحو: عَقَنْقَل، بمهملة وقافين بينهما
ساكن مفتوح ما عداه: للكثيب العظيم من الرمل.
أو
بتكرير لام كذلك، نحو جلْبَبَ وجِلْباب، أو بتكرير فاء وعين مع مباينة اللام لهما،
نحو مَرْمَرِيس، بفتح فسكون ففتح فكسر: للداهية، وهو قليل. أو بتكرير عين ولام مع
مباينة الفاء، نحو صَمَحْمَح بوزن سفَرْجَل: للشديد الغليظ. وأما مكرر الفاء وحدها
كقَرقَف وسُندس، أو العين المفصولة بأصل، كحَدْرد بزنة جعفر اسم رجل، أو العين
والفاء فى رُباعىّ كسِمْسِم فأصلىّ، فلو تكرر فى الكلمة حرفان وقبلهما حرف أصلىٌ
كصَمَحْمَحٍ وَسَمَعْمَعٍ: لصغير الرأس، حُكم بزيادة الضعفين الأخرين (لكون الكلمة
استوفت بما قبلهما أقلَّ الأصول).
ثانيهما: ما لا يكون بتكرير حرف أصلىّ، وهذا لا يكون إلا من الحروف العشرة،
المجموعة فى قولك: "سألتمونيها". وقد جمعها ابن مالك فى بيت واحد أربع
مرَّات، فقال:
*هَنَاءٌ وَتَسْلِيمٌ، تَلاَ يَوْمَ أنْسِهِ * نِهَايَةُ مَسْئُولٍ، أمَانٌ
وَتَسْهِيلُ*
وقد تكون الزيادة واحدة، وثنْتين، وثلاثا، وأربعا.
ومواضعها أربعة؛ لأنها إما قبل الفاء، أو بين الفاء والعين، أو بين العين واللام،
أو بعد اللام، ولا يخلو إذا كانت متعددةً من أن تقع متفرقة أو مجتمعة.
فالواحدة قبل الفاء نحو: أصبع وأكرم.
وبين الفاء والعين، نحو: كاهل، وضارب.
وبين العين واللام نحو: غَزال.
وبعد اللام كحُبْلَى.
والزيادتان المتفرّقتان بينهما الفاء، نحو: أجادل.
وبينهما العين: كعاقول.
وبينهما اللام: نحو قُصَيْرَى؛ أى الضلَع القصيرة.
وبينهما الفاء والعين: نحو إعصار.
وبينهما العين واللام: نحو: خَيْزَلَى، وهى مِشية فيها تثاقل.
وبينهما الفاء والعين واللام، نحو: أجْفَلَى للدعوة العامة.
والمجتمعتان قبل الفاء: نحو: منطلق.
وبين الفاء والعين، نحو: جواهر.
وبين العين واللام، نحو: خُطّاف.
وبعد اللام نحو: عِلباء.
والثلاث المتفرقات، نحو: تماثيل.
والمجتمعة قبل الفاء، نحو: مستخرج.
وبين العين واللام، نحو: سَلاليم.
وبعد اللام نحو: عنفوان.
واجتماع
ثنتين وانفراد واحدة، نحو: أفْعُوَان.
والأربع المتفرقات، نحو: احميرار، مصدر احمارَّ، ولا توجد الأربع مجتمعة.
وأدلة الزيادة تسعة:
الأول: سقوط بعض الكلمة من أصلها، كألف ضارب، وألف وتاء تَضَارَبَ من الضرب، فما
عدا الضاد والراء والباء: حُكْمه الزيادة.
الثانى: سقوط بعض الكلمة من فرع، كنُونَىْ سُنبْل وحَنْظل، من أسبل الزرع،
وَحَظِلت الإبل؛ أى خرج سُنْبُل الزرع، وتأذت الإبِل من أكل الحنظل، فنونهما
زائدة؛ لسقوطها من الفرعين.
الثالث: لزوم خروج الكلمة عن أوزان نوعها لو حكمنا بأصالة حروفها، كنونى نَرْجِس،
بفتح فسكون فكسر، وهُنْدَلِع بضم فسكون ففتح فكسْر: لبقلة، وتاءى تَنْضُب، بفتح
فسكون فضم: اسم شجر، وتَنْفُل بفتح فسكون فضم: لولد الثعلب؛ لانتفاء هذه الأوزان
فى الرُّباعىّ المجرَّد.
الرابع: التكلم بالكلمة رباعية مرة وثلاثية أخرى مَثَلا، كأيْطل (بفتحتين بينهما
ساكن)، وإطْل (بكسر فسكون أو بكسرتين): للخاصرة.
الخامس: لزوم عدم النظير فى نظير الكلمة التى اعتبرتها أصلاً، كتُتْفُل بضمتين
بينهما ساكن، فإنه وإن لم يترتب عليه عدم النظير لوجود فُعْلُل كبُرْثُن، لكن
يترتب ذلك فى نظير تلك الكلمة، وهى تَتْفُل المفتوحة التاء فى اللغة الأخرى، إذ لا
وجود "لفَعْلُل" بفتح فضم بينهما سكون، فثبوتُ زيادة التاء فى لغة الفتح
لعدم النظير، دليلٌ على زيادتها فى لغة الضم، والأصل الاتحاد.
السادس: كون الحرف دالاً على معنى، كأحرف المضارعة وألفِ اسم الفاعل.
السابع:
كونه مع عدم الاشتقاق فى موضع يلزم فيه زيادته مع الاشتقاق، كالنون ثالثة ساكنة
غير مدغمة، بعدها حرفان، كوَرَنْتَل (بفتحات، بينهما نون ساكنة): للداهية،
وشَرَنْبَث (بزنته): للغليظ الكفين والرجلين، وعَصَنْصَر (بفتح المهملات وسكون
النون): اسم جبل؛ لأنها فى موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا زائدة، كجَحَنفل (بزنته
أيضًا) وهو الغليظ الشفة، من الجَحْفَلة، وهى لذى الحافر كالشفة للإنسان.
الثامن: وقوعه منها فى موضع تغلب زيادته فيه مع المشتق، كهمزة أرْنب وأفكَل،
بفتحتين بينهما ساكن: للرِّعْدة، لزيادتها فى هذا الموضع مع المشتق، كأَحمر.
التاسع: وجوده فى موضع لا يقع فيه إلا زائدًا، كنونات حِنْطَأوٍ، بكسر فسكون ففتح
فسكون: لعظيم البطن، وكنْتأو (بزنته)، لعظيم اللحية، وَسِنْدَأو وَقِنْدَأو بزنة
ما تقدم: لخفيفها.
وزاد بعضهم عاشرًا - وهو الدخول فى أوسع البابين، عند لزوم الخروج عن النظير
فيهما، نحو كَنَهْبُل، (بفتحتين فسكون فضم): شجر عظيم، (وقد تفتح باؤه)، فزنته
بتقدير أصالة النون: "فَعَلُّل"، وبتقدير زيادتها "فَنَعْلُل"
وكلاهما مفقود، غير أن أبنية المزيد أكثر، فيصار إليه.
[حروف الزيادة]
[الألف]
ويحكم بزيادة الألف: متى صاحبت أكثر من أصلين، كضارب وعماد، وحبلى.
[الواو]
ويحكم بزيادة الواو: متى صحبت أكثر من أصلين ولم تتصدر، ولم تكن كلمتها من باب
سمسم، كمحمود وبويع، بخلاف نحو: سوط، و "وَرَنْتَل" و
"وعوعة".
[الياء]
ويحكم بزيادة الياء: متى صحبت أكثر من أصلين، ولم تتصدر سابقةً أكثَر من ثلاثة
أصول، ولم تكن كلمتها من باب سمسم، كيضرب فعلا، ويرمع اسمًا، بخلاف نحو: بيت،
ويؤيؤ لطائر، ويستعور بزنة فعللول، كعضرفوط: اسم لدويبة.
[الميم]
ويحكم
بزيادة الميم: متى سبقت أكثَر من أصلين، ولم تلزم فى الاشتقاق، كمحمود، ومسجد،
ومنطلق، ومفتاح بخلاف نحو: مَهْدِ وَمِرْعِز (بكسرتين بينهما سكون): اسم لما لان
من الصوف، فَإنّهم قالوا: ثوب ممرعز فأثبتوها فى الاشتقاق، واستدلوا بذلك على
أصالتها، خلافًا لسيبويه القائل بزيادتها.
[الهمزة]
ويحكم بزيادة الهمزة: مصدَّرةً متى صحبت أكثر من أصلين، ومتأخرةً بشرط أن تُسبق
بألف مسبوقة بأكثر من أصلين كأحفظ فعلاً، وأفضل اسمًا مشتقًا، وإصبع اسمًا جامدًا،
وأفلُس جمعًا، وكحمراء وصحراء.
[النون]
ويحكم بزيادة النون: متطرفةَ إن كانت مسبوقة بألف مسبوقة بأكثر من أصلين، كسكران
وغضبان، ومتوسطة بين أربعة أحرف إن كانت ساكنة غير مضعفة كغضنفر وقرنفل، أو كانت
من باب الانفعال كانطلق ومنطلق، أو بدأتْ المضارعَ.
[التاء والسين]
ويحكم بزيادة التاء: فى باب التفعُّل كالتدحرج، والتفاعل كالتعاون، والافتعال
كالاقتراب، والاستفعال كالاستغراب والاستغفار، وهو الموضع الذى يحكم فيه بزيادة
السين. أو كانت التاء فى التفعيل أو التفعلل، أو كانت للتأنيث كقائمة، أو بدأت
المضارعَ.
وتزاد التاء سَمَاعًا فى نحو ملكوت وجبروت ورَهَبُوت وعنكبوت.
وتزاد السينَ سماعًا فى قُدمُوس بزنة عصفور للإلحاق به.
[الهاء واللام]
وزيادة الهاء واللام قليلة: ومثَّلوا للهاء بقولهم أهراق فى أراق، وبأمهات فى جمع
أم. ومَن مثَّل لها بهاء السكت رُدَّ عليه بكونها كلمة مستقلة. ومثَّلوا للأَّم
بطيسل وزيدل وعبدل، والأصل طيس وهو الكثير، وزيد وعبد، ومن مثَّل لها بلام ذلك
وتلك، رُدَّ عليه بردّ هاء السكت.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثالث -
فى أحكام تعم الاسم والفعل ) ضمن العنوان ( فصل: فى همزة الوصل )
همزة الوصل: هل التى يُتوصل بها إلى النطق بالساكن، وتسقط عند وصل الكلمة بما
قبلها.
ولا
تكون فى حرف غير ألْ، ومثلها أمْ فى لغة حِمْيَر، ولا فى فعل مُضارع مطلقًا، ولا
فى ماضى ثلاثى كأمَر وأخذ، أو رُباعىّ كأكرم وأعطى، بل فى الخماسىّ كانطلق واقتدر،
والسُّداسىّ كاستخرج واحرنجم، وأمرهما، وأمر الثلاثىّ الساكنُ ثانى مضارعه لفظًا
كاضرب، بخلاف نحو: هَبْ وعِدْ وقُلْ. ولا فى اسمٍ إلا فى مصادر الخماسىّ
والسداسىّ، كانطلاق واستخراج.
وفى عشرة أسماء مسموعة، وهى: اسْمٌ واسْتٌ، وابنٌ، وابنُم، وابنة، وامْرُؤٌ،
وامرَأة، واثْنان، واثْنتان، وايْمُنُ المختصة بالقسم، وما عدا ذلك فهمزته همزة
قطع.
ويجب فتحُ همزة الوصل فى أل، وضمُّها فى نحو انطُلِق واستُخْرِج مبنيين للمجهول،
وأمر الثلاثى المضموم العين أصالة، كادخُلْ واكتُب. بخلاف امْشُوا واقْضُوا مما
جُعِلت كسرة عينه ضمة لمناسبة الواو، فتكسر الهمزة بخلاف عكسه، مما جعلت ضمة العين
فيه كسرة لمناسبة الياء، كاغزِى، فيترجح الضم على الكسر، كما يترجح الفتح على
الكسر فى ايْمُن وايم، والكسر على الضم فى اسم، ويجوزان مع الإشمام فى نحو اختار
وانقاد مبنيين للمجهول.
ويجب الكسر فيما بقى من الأسماء العشرة، والمصادر، والأفعال.
وتُحذف لفظًا لا خطّاًّ إن سُبقت بكلام، ولفظًا وخطًّا فى "ابن" مسبوق
بعلَم وبعده علَم، بشرط كونه صفةً للأول، والثانى أبًا له، ما لم يقع أول السطر،
وفى {بسم الله الرحمن الرحيم}، قال بعض الشعراء مشيرًا إلى ذلك.
*أفى الحق أن يُعطى ثلاثون شاعرًا * ويُحْرَمُ ما دُون الرضا شاعرٌ مِثْلى*
*كما سامحوا عَمْراً بواو مَزيدة * وضُويق "باسم الله" فى ألفِ الوصلِ*
وإن وقعت بعد همزة استفهام، فإِن كانت مكسورة حذفت نحو: {أتخذناهم سخريا}،
{أستغفرت لهم}، أبنك هذا؟ أسمك على؟ بخلاف ما إذا كانت مفتوحة فإنها تبدل ألفًا.
وقد تُسَهَّل نحو: {آلله أذن لكم؟}.
كما
تحذف همزة "أل" خطًّا ولفظًا إذا دخلت عليها اللام الحرفية، سواء كانت
للجر، أو لام القسم والتوكيد، أو الاستغاثة، أو للتعجب نحو قوله تعالى: {للفقراء
والمساكين}، {وإنه للحق من ربك}، وللآخرة خير لك من الأولى}.
وكقول الشاعر:
*يا للرجال عليكم حملتى حسبت*
ونحو: يا للماء والعشب. ولا تحقق مطلقا إلا فى الضرورة، كقوله:
*ألا لا أرى إثنين أحسن شيمةً * على حدثان الدهر منى ومن جملِ*
الإعلال والإبدال
الإعلال: هو تغيير حرف العلة للتخفيف، بقلبه، أو إسكانه، أو حذفه، فأنواعه ثلاثة:
القلب، والإسكان، والحذف.
وأما الإبدال: فهو جَعْلُ مطلق حرف مكان آخر. فخرج باإِطلاق الإعلال بالقلب؛
لاختصاصه بحروف العلة؛ فكل إعلال يقال له: إبدال ولا عكس؛ إذ يجتمعان فى نحو: قال
ورمى، وينفرد الإبدال فى نحو اصْطَبَر وادَّكر. وخرج بالمكان العوض، فقد يكون فى
غير مكان المعوض منه. كتاءَى عِدَة واستقامة، وهمزتى ابن واسم. وقال الأشمونى: قد
يُطْلق الإبدال على ما يعُم القلب، إلا أن الإبدال إزالة، والقلب إحالة، والإحالة
لا تكون إلا بين الأشياء المتماثلة، ومن ثَمَّ اختص بحروف العلة والهمزة؛ لأنها
تقاربها بكثرة التغيير.
واعلم أن الحروف التى تبدل من غيرها ثلاثة أقسام:
1- ما يُبدل إبدالاً شائعًا للإدغام، وهو جميع الحروف إلا الألف.
2- وما يبدل إبدالاً نادراً، وهو ستة أحرف: الحاء، والخاء، والعين المهملة،
والقاف، والضاد، والذال المعجمتانِ، كقولهم فى وُكْنة، وهى بيت القَطَا فى الجبل:
وُقْنة، وفى أغْنّ: أخَنّ، وفى رُبَع: رُبح، وفى خَطَر: غَطَر، وفى جَلْد: جَضْد،
وفى تلعثمَ: تلَعْذَم.
وما يُبدل إبدالاً شائعًا لغير إدغام، وهو اثنان وعشرون حرفًا يجمعها قولك
"لجد صرف شكس أمن طى ثوب عزته". والضرورىّ منها فى التصريف تسعة أحرف،
يجمعها قولك: "هَدَأْتُ مُوطِيا".
وما
عداها فإبداله غير ضرورىّ فيه، كقولهم فى أصَيْلان: تصغير أصْلان بالضم، على ما
ذهب إليه الكوفيون، جمع أصيل، أو هو تصغير أصيل، وهو الوقت بعد العصر: أصَيْلال،
وفى اضطجع إذا نام: الْطَجع، وفى نحو علىّ (عَلَمًا) فى الوقف أو ما جرى مجراه:
علِجّ بإِبدال النون لامًا فى الأول، والضاد لامًا فى الثانى، والياء جيمًا فى
الثالث.
قال النابغة:
*وَقَفْتُ فِيها أصَيْلاَلاً أسَائِلُهَا * أعْيَتْ جَوَابًا وَمَا بالرَّبْع مِنْ
أحَدِ*
وقال منظور بن حَبَّة الأسدى فى ذئب:
*لَمَّا رَأى أن لادَعَهْ وَلا شِبَعْ * مَالَ إلىَ أرْطَاةِ حقْفٍ فَالْطَجَعْ*
وقال آخر:
*خالِى عُوَيْفٌ وَأبو عَلِجّ * المُطْعِمانِ اللَّحْمَ بِالعَشِجّ*
يريد أبا علىّ والعشىّ، وتسمّى هذه اللغة عَجْعَجَة قُضاعة. واشترط بعضهم فيها أن
تكون الجيم مسبوقة بعين، كما فى البيت، وبعضهم يُطْلِق، مستدلاً بقول بعض أهل
اليمن:
*لا هُمّ إن كنت قبلتَ حِجَّتِجْ*
*فلا يزالُ شاحِجٌ يأتِيكَ بِجْ*
*أقْمَرُ نَهَّاتٌ يُنَزَّى وَفْرَتِجْ*
(أ) الإعلال فى الهمزة
1- تقلب الياء والواو همزة وجوباً فى أربعة مواضع:
الأول: أن تتطرفا بعد ألف زائدة كسماء وبناء، أصلهما سَماوٌ وبِناىٌ، بخلاف نحو:
قال، وباع، وإداوة، وهى المطْهرة، وهداية؛ لعدم التطرف، ونحو دَلْو وَظَبْى؛ لعدم
تقدم الألف، ونحو آية ورايةٍ؛ لعدم زيادتها.
وتشاركهما فى ذلك الألف، فإنها إذا تطرفت بعد ألف زائدة أبدلت همزة، كحمراءَ، إذ
أصلها حَمْرَى كسَكرَى، زيدت ألف قبل الآخر للمدّ، كألف كتاب، فقلبت الأخيرة همزة.
الثانى: أن تقعا عينًا لاسم فاعلِ فِعْلٍ أعِلَّتا فيه، نحو قائل وبائع، أصلهما
قاوِل وبايع، بخلاف نحو عَيِنَ فهو عايِنَ، وعَوِرَ فهو عاوِر؛ لأن العين لما
صحَّت فى الفعل، خوف الإلباس بعان وعار، صحت فى اسم الفاعل تبعًا للفعل.
الثالث:
أن تقعا بعد ألف "مَفَاعل" وشِبِهه، وقد كانتا مَدتين زائدتين فى
المفرد، كعجوز وعجائز، وصحيفة وصحائف، بخلاف نحو قَسْور، وهو الأسد، وقساوِر؛ لأن
الواو ليست بمدة، ومَعِيشة ومعايِش؛ لأن المدة فى المفرد أصلية، وشذّ فى مُصيبة
مصائب، وفى مَنارة منائر بالقلب، مع أصالة المدة فى المفرد، وسهَّله شَبَه
الأصلىِّ بالزائد.
وتشاركهما فى ذلك الحكم الألْفُ، كرِسالَة ورسائل، وقلاَدة وقلائد.
الرابع: أن تقعا ثانيتى لينين بينهما ألف "مفَاعِل"، سواء كان اللِّينان
ياءين، كنيائف جمع نيِّف، وهو الزائد على العِقد، أو واوين، كأوائل جمع أوّل، أو
مختلفين، كسيائد جمع سيِّد، أصله سيود، وأما قول جَنْدَل بن المُثَنّى
الطُّهَوِىّ:
*وكَحَّل العينين بِالعَوَاوِرِ*
من غير قلب؛ فلأن أصله بالعواوير كطواويس، وقد تقدم جواز حذف ياء
"مفاعيل"، ولذا صُحِّح.
وتختص الواو بقلبها همزة إذا تصدرت قبل واوٍ متحركة مطلقًا، أو ساكنة متأصلةِ
الواوية، نحو أواصل وأواق، جمعَىْ واصلة وواقية.
ومنه قول مُهَلْهِل:
*ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلىَّ وقَالَتْ * يَا عَدِيًّا لقَدْ وَقَتْكَ الأوَاقِى*
ونحو الأولى أثنى الأوّل، وكذا جمعها: وهو الأَوَلُ.
بخلاف نحو هَوَوِىّ ونَوَوِىّ، فى النسبة إلى هَوىّ وَنَوىّ، لعدم التصدر،
وَوُوْفِىَ وَوُوْعِدَ مجهولين؛ لعدم تأصل الثانية.
وتبدل الهمزة من الواو جوازًا فى موضعين:
أحدهما: إذا كانت مضمومة ضمًا لازمًا غير مشددة، كوُجوه وأجوُه، ووُقوت وأقوت: فى
جمع وجه ووقت، وأدْوُرْ وأدْؤُر، وأنْوُر وأنْؤُر: جمعى دار ونار، وقَئُول وصئول:
مبالغة فى قائل وصائل، فخرجت ضمة الإعراب، نحو هذا دلُو، وضمةُ التقاء الساكنين،
نحو {وَلاَ تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُم}، وخرج بـ "غير مشدَّدةٍ". نحو
التعوُّذ والتجوُّل.
ثانيهما: إذا كانت مكسورة فى أول الكلمة، كإشاح وإفادة وإسادة، فى وِشاح، ووِفادة
ووِسادة.
وتبدل
الهمزة من الياء جوازًا إذا كانت الياء بعد ألف، وقبل ياء مشدَّدة، كغائىّ ورائىّ:
فى النسبة لغاية وراية.
وجاءت الهمزة بدلاً من الهاء فى ماء، بدليل تصغيره على مويه، وجمعه على أمواه.
(ب) فصل فى عكس ما تقدم
وهو قلب الهمزة ياء أو واوًا، ولا يكون ذلك إلا فى بابين:
أحدهما: باب الجمع الذى على زنة "مفَاعِل"، إذا وقعت الهمزة بعد ألف،
وكانت تلك الهمزة عارضة فيه، وكانت لامه همزة أو واوًا أو ياء. فخرج باشتراط عروض
الهمزة المرَائِى: فى جمع مِرْآة؛ فإن الهمزة موجودة فى المفرد، وبالأخير سلامةُ
اللام، فى نحو صحائف وعجائز ورسائل، فلا تغير الهمزة فيما ذُكِر. والذى استوفى
الشروط يجب فيه عملان: قلب كسر الهمزة فتحة، ثم قلب الهمزة ياء فى ثلاثة مواضع،
وواوًا فى موضع واحد. فالتى تقلب ياء يشترط فيها أن تكون لام الواحد همزة، أو ياء
أصلية، أو واوًا منقلبة ياء، والتى تقلب واوًا يشترط فيها أن تكون لام الواحد
واوًا ظاهرة فى اللفظ، سالمة من القلب ياء.
فهذه أربعة مواضع تحتاج إلى أربعة أمثلة:
1- مثال ما لامه همزة: خطايا جمع خطيئة، أصلها خَطَايئ، بياء مكسورة هى ياء
المفرد، وهمزة بعدها هى لامه. ثم أبدلت الياء المسكورة همزة، على حد ما تقدم فى
صحائف، فصار خَطَائئ بهمزتين، ثم الهمزة الثانية ياء؛ لأن الهمزة المتطرفة إثر
همزة تقلب ياء مطلقًا، فبعد المكسورة أولى، ثم قلبت كسرة الهمزة الأولى فتحة
للتخفيف، كما فى المدارَى والعذارَى، ثم قلبت الياء ألفًا، لتحركها وانفتاح ما قبلها،
فصار خَطاءًا بألفين بينهما همزة، والهمزة تشبه الألف، فاجتمع شبه ثلاث ألفات،
وذلك مستكرَه، فأبدلت الهمزة ياء، فصار خطايا، بعد خمسة أعمال.
2-
ومثال ما لامه ياء أصلية: قضايا جمع قضية، أصلها قضايى بياءين أبدلت الياء الأولى
همزة، على ما تقدم فى نحو صحائف، فصار قضائِىُ، قلبت كسرة الهمزة فتحة، ثم الياء
ألفا، فصار قضاءًا، ثم قلبت الهمزة المتوسطة ياء، لما تقدّم، فصار قضايا، بعد
أربعة أعمال.
3- ومثال ما لامه واوٌ قلبت ياء فى المفرد: مَطِيَّة، إذ أصلها مَطِيْوَة من
المَطا، وهو الظهر، أو من المَطْو وهو المدّ، اجتمعت الواو والياء وسُبقت إحداهما
بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمتا، كما فى سيِّد وميِّت، وجمعها مطايا، وأصلها:
مَطايِوُ، قلبت الواو ياء، لتطرُّفها إثر كسرة، فصار مَطايِىُ، ثم قلبت الياء
الأولى همزة كما تقدّم، ثم أبدلت الكسرة فتحة، فصار مَطَاءَىُ، ثم الياء ألفا، ثم
الهمزة المتوسطة ياء، فصار مطايا بعد خمسة أعمال.
4- ومثال ما لامه واو ظاهرة سلمت فى المفرد: هِرَاوَة، وهى العصا، وجمعها
هَرَاوَى، أصلها هَرَائِوُ. وذلك أن ألف المفرد قلبت فى الجمع همزة، كما فى رسالة
ورسائل، فصار هرائوُ، ثم أبدلت الواو ياء، لتطرُّفها إثر كسرة، فصار هَرَائىُ ثم
فتحت كسرة الهمزة، فصار هَرَاءَىُ، ثم قلبت الياء ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها،
فصار هراءَا، بهمزة بين ألفين، ثم قلبت الهمزة واوًا، ليتشاكل الجمع مع المفرد،
فصار هَرَاوَى بعد خمسة أعمال.
وشذ من هذا الباب قوله:
*"حَتّى أزِيرُوا المَنَائِيا"*
والقياس المنايا، و "اللهم اغْفِر لى خَطَائئى" والقياس خطاياى،
وهَدَاوَى جمع هَدية، والقياس هدايا.
ثانيهما: باب الهمزتين الملتقيين فى كلمة واحدة، والتى تُعَلّ هى الثانية؛ لأن
الثقل لا يحصل إلا بها، فلا تخلو الهمزتان: إما أن تكون الأولى متحركة والثانية
ساكنة، أو بالعكس، أو تكونا متحركتين.
فإن
كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة، أبدلت الثانية من جنس حركة الأولى، نحو آمنت
أومِنُ إيمانًا، والأصل: أأمَنْت أؤْمِن إئمَانا، وشذّ قراءة بعضهم
"إئْلافِهِم" بتحقيق الهمزة الثانية.
وإن كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة، ولا تكونان إلا فى موضع العين أو اللام،
فإِن كانتا فى موضع العين، أدْغمت الأولى فى الثانية، نحو سَآل مبالغة فى السؤال،
ولآل ورآس، فى النسب لبائع اللُّؤلؤ والرُّءوس.
وإن كانتا فى موضع اللام، أبْدِلت الثانية ياء مطلقًا، فتقول فى مثال
"قِمَطْر" مِن قرأ: قِرَأى، وفى مثال: سَفَرجَل منه: قَرَأيَأ.
وإن كانتا متحركتين، فإن كانتا فى الطّرَف أو كانت الثانية مكسورة أبدلت ياء
مطلقًا. وإن لم تكن طَرفًا وكانت مضمومة: أبدلت واوًا مطلقا، وإن كانت مفتوحة، فإن
انفتح ما قبلها أو انضم أبدلت واوًا، وإن انكسر أبدلت ياء.
ويجوز فى: نحو رَأس ولُؤْم وبِئْر، إبقاؤها وقلبها من جنس حركة ما قبلها وفى نحو:
وضوء ومجئ، يجوز إبقاؤها وقلبها من جنس ما قبلها مغ الإدغام.
2- الإعلال فى حروف العلة
(أ) قلب الألف والواو ياء
تقلب الألف ياء فى مسألتين:
الأولى: أن ينكسِر ما قبلها، كما فى تكسير وتصغير نحو: مصباح ومفتاح، تقول فيهما:
مصابيح ومفاتيح، وَمُصَيْبيح ومُفَيتيح.
الثانية: أن تقع تالية لياء التصغير، كقولك فى غلام: غُلَيِّم.
وتقلب الواو ياء فى عشرة مواضع:
أحدها: أن تقع بعد كسرة فى الطرف، كرَضِىَ وَقَوِىَ، وَعُفِىَ مبنيًا للمجهول.
والغازِى والداعِى؛ أو قبل تاء التأنيث كشَجِية وَأكْسِيَة وغازِية وعُرَيْقِيَة:
تصغير عَرْقُوَة؛ وشذَّ سَوَاسِوَة: جمع سواء. أو قبل الألف والنون الزائدتين،
كقولك فى مثال قَطِران، بفتح فكسر، من الغزو: غَزِيان.
ثانيهما:
أن تقع عينًا لمصدر فعلٍ أعِلَّت فيه، وقبلها كسرة، وبعدها ألف كصِيام وقيام
وانقِياد واعتِياد، فخرج نحو سِوار وسِواك، بكسر أولهما؛ لانتفاء المصدرية،
وَلِواذ وجِوار؛ لعدم إعلال عين الفعل فى لاوَذَ وجاوَرَ، وحال حِوَلاً، وعاد
المريضَ عِوَدَا، لعدم الألف فيها، وراح رَوَاحاً لعدم الكسر، وقلَّ الإعلال فيما
عَدِم الألف، كقراءة بعضهم: {جَعَلَ الله الكَعْبَةَ البيْتَ الحَرَامَ قِيمًا
لِلنَّاس}. وشذّ التصحيح مع استيفاء الشروط فى قولهم: نَارَت الظِّبية تَنُور
نِوَاراً، بكسر النون، أى نفرت، وشار الدابةَ شِوارًا بالكسر: راضها، ولا ثالث
لهما.
ثالثها: أن تكون عينًا لجمع صحيح اللام، وقبلها كسرة، وهى فى مفرده إما معتلَّة،
كدار ودِيار، وحِيلة وحِيَل، ودِيمة ودِيَم، وقِيمة وقِيَم، وشذّ حِوَج بالواو فى
حاجة.
وإما شبيهة بالمعَلَّة، وهى الساكنة، بشرط أن يليها فى الجمع ألف، كسوط وسِياط،
وحَوْض وحِياض، وروض ورِياض. فإن عُدِمَت الألف صحت الواو، نحو كُوز وكِوَزة، وشذ
ثِيرة جمع ثَوْر. وكذا إن تحركت فى مفرده، كطَوِيل وطوال، وشذ الإعلال فى قول
أنَيْفِ بن زَبَّانَ النَّبْهَانّى الطَّائى:
*تَبَيَّنْ لِى أنَّ القُمَاءَةَ ذلَّةٌ * وَأنَّ أعِزَّاء الرِّجَال طِيَالُها*
وتسْلم الواو أيضا إن أعِلَّت لامُ المفرد، كجمع رَيَّان وجَوّ، فيقال فيهما:
رِوَاء وجِوَاء، بكسر الفاء وتصحيح العين، لئلا يتوالى فى الجمع إعلالان: قَلْبُ
العين ياء، وقلبُ اللام همزة.
رابعها: أن تقع طَرَفا، ورابعة فصاعدًا بعد فتح، نحو أعْطَيْتُ وزكَّيْتُ،
وَمُعْطَيان ومُزكَّيان، بصيغة اسم المَفعول، حملوا الماضى المزيد على مضارعه،
واسم المفعول على اسم الفاعل.
خامسها:
أن تقع متوسطة إثر كَسْرة، وهى ساكنة مفردة، كميزان، ومِيقات، فخرَج نحو صِوان،
وهو وِعاء الشئ، وسِوَار، لتحرك الواو فيها، ونحو اجْلِوَّاذ، وهو إسراع الإبل فى
السير، واعْلِوَّاط وهو التعلق بعنق البعير بقصد الركوب؛ لأن الواو فيهما مكررة لا
مفردة.
سادسها: أن تكون الواو لامًا لِفُعْلَى "بضم فسكون" وصفا، نحو الدُّنيا
والعُلْيا. وقول الحجازيين القُصْوَى شاذ قياسًا، فصيحٌ استعمالاً، نُبِّه به على
أن الأصل الواو، كما: اسْتَحْوَذَ والقَوَد، إذ القياس الإعلال، ولكنه نُبِّه به
على الأصل، وبنو تميم يقولون: القُصْيَا على القياس. فإن كانت "فُعْلَى"
اسمًا لم تُغَيَّر كحُزْوَى: لموضع.
سابعها: أن تجتمع هى [أى: الواو] والياء فى كلمة، والسابق منهما متأصل ذاتا
وسكونا، نحو سيِّد ومَيِّت، وطىَّ وَلَىُّ، مَصدَرَى طويت ولويت، فخرج نحو يدعو
ياسر، ويرمى واقد، لكون كل منهما فى كلمة، ونحو طويل وغيور، لتحرك السابق، ونحو
ديوان، إذ أصله دِوَّان "بشد الواو" وبُويع، إذ أصل الواو ألف فاعَلَ،
ونحو قَوْىَ "بفتح فسكون" فخفف قَوِىَ "بالكسر" للتخفيف. وشذّ
التصحيح مع استيفاء الشروط كَضَيْونٍ للسِّنَّور الذكر، ويوم أيْوَمُ: حصلت فيه
شدَّة، وعَوَى الكلب عَوْية، ورجاء بن حَيْوَة.
ثامنها: أن تكون الواو لام "مَفْعُول" الذى ماضيه على "فَعِل"
بكسر العين، نحو مَرْضِىّ ومَقْوِىّ عليه، فإِن كانت عينُ الفعل مفتوحة صحت الواو،
كمدعوّ ومغزوّ. وشذ الإعلال فى قول عبدِ يغوثَ الحارثىّ من الجاهليين:
*وقد عَلِمَتْ عِرْسِى مُلَيْكَةُ أننى * أنَا اللَّيْثُ مَعْدِيًا عَلَىَّ
وعادِيا*
تاسعها:
أن تكون لام "فُعُول" بضم الفاء جمعا، كعِصِىّ وَدِلِىّ وَقِفىّ، ويقل
فيه التصحيح؛ نحو أبُوٍّ وأخُوٍّ: جمعى: أب وأخ، ونُجُوّ: جمع نَجو، وهو السحاب
الذى هَراق ماءه، وأما المفرد فالأكثر فيه التصحيح، كعُلُوّ وعُتُوّ، ويقلّ فيه
الإعلال، نحو عَتَا الشيخ عِتِيًّا: إذا كَبر، وقسا قلبه قِسِيًّا.
عاشرها: أن تكون عينًا "لفُعَّل" بضم الفاء وتشديد العين، جمعًا صحيح
اللام، غير مفصولة منها، كصُيَّمَ وزُيَّم، والأكثر تصحيحه، كصُوَّم ونُوَّم. ويجب
تصحيحه إن أعلت اللام، لئلا يتوالى إعلالان، كشُوَّى وغُوّى؛ جمعى شاوٍ وغاوٍ، أو
فصلت من العين، نحو صُوَّام ونُوَّام، وشذ قول ذى الرُّمّة:
*ألاَ طَرقَتْنَا مَيَّةُ ابْنَةُ مُنْذِر * فما أرَّقَ النُّيَّامَ إلا كَلامُها*
(ب) قلب الألف والياء واوًا
1- وتقلب الألف واوًا: إذا انضم ما قبلها كبُويِع وضُورِب وضُوَيْرِب.
2- وتقلب الياء واوًا: إن كانت الياء ساكنة مفردة مضمومًا ما قبلها فى غير جمع،
كمُوقِنٍ وَمُوسِر، ويَوُقِنُ وَيُوسِر. فخرج بساكنة نحو: هُيَام، وبمفردة نحو:
حُيّض جمع حائض، وبـ "مضمومًا ما قبلها": ما إذا كان مفتوحًا أو مكسورًا
أو ساكنا، وبغير جمع: ما إذا كانت فيه كبيض وهِيم، جمعى أبيض وبيضاء، وأهيم
وهيماء. ويجب فى هذه الحالة قلب الضمَّة كسرة.
وكذا تقلب الياء واوًا إذا انضم ما قبلها، وكانت لام "فَعُلَ" بفتح فضم
كنَهُوَ الرجل وَقَضُوَ، أو كان ما هى فيه مختومًا بتاء بنيت الكلمة عليها، كأن
تَصُوغ من الرمْى مثل مقْدُرة، فإنك تقول: مَرْمُوَة. أو كانت هى لام اسم ختم بألف
ونون مزيدتين، كأن تصوغ من الرْمى أيضًا مثل سَبُعَان، بفتح فضم: اسم موضع، فإنك
تقول: رَمُوان.
وكذا
تقلب واوًا إن كانت لامًا "لفَعْلَى، بفتح الفاء" اسمًا لا صفة،
كَتَقْوَى وَشَرْوَى، وهوَ المثل، وَفَتْوى. وشذّ التصحيح فى سَعْيا: لمكان،
وَرَيَّا: للرائحة، وكذا إن كانت الياء عينًا "لفُعْلَى، بضم الفاء"
اسمًا كطُوبى، أو صفة جارية مجرى الأسماء، وكانت مؤنث أفعل، كطُوبى وكُوسَى
وَخُوْرَى، مؤنثات: أطْيَبَ وَأكْيَسَ وَأخيْرَ، فإن كانت "فُعْلَى" صفة
محضة، وجب تصحيح الياء، وقلب الضمة كسرة، ولم يسمع منه إلا {قِسْمَة ضِيزَى} أى
جائزة، ومِشْيَة حِيْكَى؛ أى يتحرَّك فيها المَنْكِبان. وقال بعضهم: إن كانت
"فُعْلَى" وصفا: فإن سلمت الضمة قلبت الياء واوًا، وإن قلبت كسرة بقيت
الياء، فتقول: الطُّوبَى وَالطِّيبَى، والضُّوقَى والضِّيقى، والكوسَى والكِيْسَى.
(ج) قلب الواو والياء ألفًا
تقلب الواو والياء ألفا بعشرة شروط:
الأول: أن يتحركا.
الثانى: أن تكون الحركة أصلية.
الثالث: أن يكون ما قبلها مفتوحًا.
الرابع: أن تكون الفتحة متصلة فى كلمتيهما.
الخامس: أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين، وألاّ يقع بعدهما ألف ولا ياء مشددة
إن كانتا لامين، فخرج بالأول القول والبيع لسكونهما، وبالثانى جَيَل وتَوَم
"بفتح أولهما وثانيهما" مخففى جَيْأل وتَوءَم "بفتح فسكون ففتح
فيهما" الأول اسم للضَّبُع، والثانى للود يولد معه آخر. وبالثالث العِوَض
والحِيَل والسُّوَر، "بالكسر فى الأوَّلَيْن والضم فى الثالث"، وبالرابع
ضربَ واقَد، وكتبَ يَاسر، وبالخامس بَيَان وطَوِيل وخَوَرْنَق: اسم قصر بالعراق؛
لسكون ما بعدهما، وَرَمَيَا وغَزَوَا وَفَتَيان وعَصَران؛ لوجود الألف، وعَلَوِىّ
وفَتَوِىّ؛ لوجود ياء النسب المشدَّدة.
السادس: "ألاّ تكونا عينًا لِفَعِلَ بكسر العين" الذى الوصف منه على
أفعل، كهَيِف فهو أهْيَف، وعَوِر فهو أعْوَر. وأما إذا كان الوصف منه على غير
أفعل، فإنه يُعَلّ، كخاف وهاب.
السابع:
ألاّ تكونا عينًا لمصدر هذا الفعل، كالهَيف وهو ضُمور البطن، والعَوَر، وهو فقد
إحدى العينين.
الثامن: ألاّ تكون الواو عينًا لافتعل الدال على التشارك فى الفعل، كاجْتَورُوا
وَاشْتَوَروا، بمعنى تجاوروا وتشاوروا، فإن لم يدل على التشارك وجب إعلاله،
كاخْتَان بمعنى خان، واختار بمعنى خار. وأما الياء فلا يشترط فيها عدم الدلالة على
ذلك، ولذلك أعِلَّتْ فى استافوا: بمعنى تسايفوا؛ أى تضاربوا بالسيوف، لقربها من
الألف فى المخرج.
التاسع: ألاّ تكون إحداهما متلوَّة بحرف يستحق هذا الإِعلان. فإن كانت كذلك
صَحَّتِ الأولى وأعلّت الثانية، نحو الحَيَا والهوَى، وربما عكسوا بتصحيح الثانية
وإعلال الأولى، كآية أصلها أيَيَة كقَصَبة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت
ألفًا فصار آية. وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله:
*وَإِنْ لَحَرْفَيْنِ ذا الإعلاَلُ اسْتُحِقّْ * صُحِّح أوَّلٌ وَعَكْسٌ قد
يَحِقّ*
العاشر: ألاّ تكونا عينين لما آخره زيادة مختصة بالأسماء، كالألف والنون، وألف
التأنيث، نحو الجَوَلان والهَيَمَان مصدرىْ جَالَ وهَامَ، والصَّوَرَى اسم محل،
والحَيَدَى: وصف للحمار الحائد عن ظله.
*وشذّ الإعلال فى: ماهان وداران، والأصل: مَوَهان وَدَورَان، بفتحات فيهما.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثالث -
فى أحكام تعم الاسم والفعل ) ضمن العنوان ( فصل: فى فاء الافتعال وتائه )
1- إذا كانت فاء الافتعال واوًا أصلية، أبْدِلت تاء، وأدْغمت فى تاء الافتعال،
وكذا ما تَصَرَّف منه، نحو اتَّعَد وَاتَّصل واتَّسَر، من الوعد والوصل واليُسر،
وإن كانت الياء أو الواو بدلاً من همزة، فلا يجوز إبدالها تاء، وإدغامها فى تاء
الافتعال، فى نحو إيتَزَر؛ لأن الياء ليست أصلية، ونحو أوتمن من الأمن؛ لأن الواو
ليست أصلية. وشذ فى "افتعل" من الأكل اتَّكَلَ.
2-
وإذا كانت فاؤه صادًا، أو ضادًا، أو طاء، أو ظاء، وتسمى أحرف الإطباق، وجب إبدال
تائه طاء فى جميع التصاريف، فتقول فى "افتعل" من الصبر: اصطبر، ولا يجوز
فى الفصيح الإدغام، ومن الضرب: اضطرب، بلا إدغام أيضا، وجاء قليلا اصَّلح واضَّرب،
بقلب الثانى إلى الأوَّل، ثم الإدغام، وتقول من الطُّهر "بالطاء
المهملة": اطَّهَّر، وفى هذه الحالة يجب الإِدغام لاجتماع المثلين، وسكون
أوَّلهما. ومن الظلم (بالمعجمة) اظْطُلم، بمعجمة فمُهْمَلة. ويجوز لك فيه ثلاثة
أوجه: إظهار كل منهما على الأصل، وإبدال الظاء معجمة طاء مهملة مع الإدغام، فتقول:
اطَّلم بالمهملة. وإبدال الطاء المهملة ظاء والإدغام أيضًا، فتقول: اظَّلم. وقد
رُوِى قول زُهَيْر يمدح هَرِمَ بن سِنان:
*هُوَ الجَوَادُ الَّذِى يُعْطِيكَ نَائِلَهُ * عفْوًا، ويُظْلَمُ أحيَانًا
فَيَظَّلِمُ*
فَيَطَّلِمُ بتشديد المهملة، وَيَظّلِمُ بتشديد المعجمة، ويَظْطَلِم بالإظهار.
3- وإذا كانت فاؤه دالاً، أو ذالاً أو زايًا، أبْدِلت تاؤه دالاً مُهملة، فتقول فى
"افْتَعلَ" من دان: ادّان بالإبدال والإدغام، لوجود المثلين وسكون
أوَّلهما، ومن زَجَر ازْدَجَر، بلا إدغام، ومن ذكر اذْدكَر.
ولك فى هذا المثال ثلاثة الأوجه المتقدمة فى اظطلم، فتقول اذْدكَر وَادَّكر
وَاذَّكر. وَقُرِئ شاذاً {فهل من مُدَّكِر} بالذال المعجمة والإدغام.
وسمع إبدال تاء الافتعال صادًا مع الإدغام، وعليه قراءة {وهُمْ يَخِصِّمُون} أى
يَخْتَصِمُون.
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثالث -
فى أحكام تعم الاسم والفعل ) ضمن العنوان ( فصل: فى إبدال الميم من الواو، والنون
)
1-
تُبْدَل الميم من الواو وجوبًا فى "فم"، إذا لم يضف إلى ظاهر أو مضمر؛
ودليل ذلك تكسيره على أفواه، والتكسير يَرُدُّ الأشياء إلى أصولها، وربما بَقِىَ
الإبدال مع الإضافة، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لَخُلُوف فم الصائمِ أطيب
عندَ اللهِ من ريحِ المسك" وقول رُؤْبة:
*يُصْبحُ ظمآنَ وفى البَحْرِ فَمُه*
2- ومن النون، بشرط سكونها ووقوعها قبل باء من كلمتها أو من غيرها، نحو قوله
تعالى: {إذ انْبَعَثَ أشْقَاهَا} وقوله: {مَن بَعثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا}؟.
وأبدلت الميم من النون شذوذًا فى قول رُؤْبة:
*يا هَالَ ذات المنطِقِ التَّمْتَامِ * وكفك المخضَّبِ البَنَامِ*
أصله البنان.
وجاء العكس كقولهم: أسْوَدُ قَاتِنٌ: أى قاتم، بإبدال الميم نونا.
الإعلال بالنقل
تُنْقَلُ حركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله، مع بقاء المعتل إن جانس الحركة،
كيقُولُ ويَبيع، أصلها يَقْوُل كَيَنْصُر، ويَبْيِع كيضْرِب، وإلا قَلِبَ حرفاً
يجانسها، كيَخاف ويُخيف، أصلهما يَخْوف كيعْلم، ويُخْوِف كيُكْرم.
ويمتنع النقل إن كان الساكن معتلاً، كبايع، وَعَوَّق، وبَيّنَ، بالتشديد فيهما،
كما يمتنع أيضًا إن كان فعلَ تعجب، نحو ما أبيَنَه وأقوَمه، أو كان مضعَّفًا، نحو:
ابْيَضّ واسْوَدّ، أو معتل اللام نحو: أحْوَى وأهوى.
وينحصر الإعلال بالنقل فى أربعة مواضع:
الأول: الفعل المعتل عينًا كما مُثِّل.
الثانى:
الاسم المشبه للفعل المضارع وزنًا فقط، بشرط أن يكون فيه زيادة يمتاز بها عن
الفعل، كالميم فى مَفْعَل، أو زيادة لا يمتاز بها، فالأول كمَقام ومَعاش، أصلهما:
مَقْوَم وَمَعْيَش على زنة مَذْهب، فنقلوا وقلبوا. وأما مَدْيَنَ وَمَرْيَم
فشاذَّان، والقياس: مَدَان وَمَرَام. وعند المبرد لا شذوذ؛ لأبه يَشْترط فى
مَفْعَل أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال. والثانى: كأن تَبْنى من البيع أو
القول اسمًا على زنة "تِحْلِئِ"، بكسرتين بينهما ساكن، وآخره همزة: اسم
للقشر الذى على الأديم، مما يلى منبِت الشعر، فإنك تقول: تِبيِع وتِقِيل، بكسرتين
متواليتين، بعدهما ياء فيهما، فإن أشبهه فى الوزن والزيادة نحو أبيض وأسود، خالفه
فيهما نحو مِخْيَط، وجب التصحيح.
الثالث: المصدر الموازن للإفعال والاستفعال، نحو إقوام واستقوام. ويجب حذف إحدى
الألفين بعد القلب؛ لالتقاء الساكنين، وهل المحذوف الأولى أو الثانية؟ خِلاف،
والصحيح أنها الثانية، لقربها من الآخِر، ويؤتى بالتاء عوضًا عنها، فيقال: إقامة،
استقامة، وقد تُحْذَف كأجاب إجابًا، وخصوصًا عند الإضافة، نحو: {وإقامِ الصَّلاة}،
ويقتصر فيه على ما سُمِع. وورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما، نحو أعوَل إعوالا،
واستحوذ استِحْواذا، وهو إذن سماعىّ أيضًا.
الرابع: صيغة "مفْعُول" كمقُول ومَبِيع، بحذف أحد المدَّين فيهما، مع
قلب الضمة كسرة فى الثانى، لئلا تنقلب الياء واوًا، فيلتبس الواوى باليائىّ وبنو
تميم تصحح اليائىّ، فيقولون مَبْيوع ومَدْيون ومَخْيُوط، وعليه قول العبَّاس ابن
مِرْداس السُلَمِىّ:
*قد كان قَوْمُكَ يَحْسِبُونَكَ سَيِّدًا * وَإِخَالُ أنَّك سَيِّدٌ مَغْيُونُ*
وعلى ذلك لغة عامة المصريين، فى قولهم: فلان مَدْيُون لفلان.
وربما صَحَّح بعض العرب شيئًا من ذوات الواو، فقد سُمِع: ثوب مَصْوُون، وفرس
مَقْوُود، وقول مَقْوُول، ورمِسْك مَدْوُوف؛ أى مبلول.
الإعلال بالحذف
الحذف
قسمان: قياسىّ: وهو ما كان لعلة تصريفية سوى التخفيف؛ كالاستثقال والتقاء
الساكنين.
غيرُ قياسىّ: وهو ما ليس لها، ويقال له الحذف اعتباطًا.
فالقياسىّ يدخل فى ثلاث مسائل:
الأولى: تتعلق بالحرف الزائد فى الفعل.
والثانية: تتعلق بفاء الفعل المثال ومصدره.
والثالثة: تتعلق بعين الفعل الثلاثى، الذى عينه ولامه من جنس واحد، عند إسناده
لضمير الرفع المتحرك.
المسألة الأولى: إذا كان الماضى على وزن "أفْعَلَ" فإِنه يجب حذف الهمزة
من مضارعه ووصْفَيْه، ما لم تُبدل، كراهة اجتماع الهمزتين فى المبدوء بهمزة
المتكلم، وحُمِل غيره عليه، نحو أكرَمَ ويُكْرِم ونُكْرِم وتُكْرِم ومُكْرِم
ومُكْرَم؛ وشذّ قولُه:
*"فإنَّهُ أهْلٌ لأِنْ يُؤكْرَمَا*
فلو أبْدلت همزة "أفْعَلَ" هاءً، كَهرَاقَ فى أراق، أو عينًا كعَنْهَلَ
الإبلَ: لغة فى أنْهَلَهَا، أى سقاها نَهَلا، لم تحذف، وتفتح الهاء والعين فى
جميعِ تصاريفهما.
وأما المسألةُ الثانية: فقد تقدمت فى حكم المثال، فارجع إليها إن شئت.
والمسألة الثالثة: متى كان الفعل الماضى ثلاثيًا مكسور العين، وكانت هى ولامه من
جنس واحد، جاز لك فيه عند إسناده للضمير المتحرّك ثلاثة أوجه؛ الإتمام، وحذف العين
منقولة حركتها للفاء، وغير منقولة، كظَلِلْت بالإتمام، وظِلْتُ بحذف اللام الأولى،
ونقل حركتها لما قبلها، وظَلْت، محذوف اللام بدون نقل، فإن زاد على ثلاثة تعين
الإتمام، نحو أقررت، وشذّ أحَسْتُ فى أحْسَسْتُ، كما يتعين الإتمام لو كان ثلاثيًا
مفتوح العين، نحو حَلَلْتُ، وشذ: هَمْتُ فى هَمَمْتُ.
وأما
إن كان الفعل المكسور العين مضارعًا أو أمرًا اتصل بنون نسوة. فيجوز فيه الوجان
الأوّلان فقط، نحو يَقْرِرْنَ وَيَقِرْنَ، واقْرِرْنَ وَقِرْنَ، لأنه لما اجتمع
مثلان وأوّلهما مكسور، حسُن الحذف كالماضى، قال تعالى: {وَقِرْنَ في بُيُوتِكُنَّ}
فإِن كان أولُ المثلين مفتوحًا كما فى لغة قرِرت أقَرُّ بالكسر فى الماضى، والفتح
فى المضارع، قلّ النقل، كقراءة نافع وعاصم {وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ}.
وأما القسم الثانى من القياسىّ، وهو الحذف لالتقاء الساكنين، فسيأتى له باب مستقل
إن شاء الله.
وأما غير القياسىّ فكحذف الياء من نحو يدٍ ودمٍ، أصلهما يَدَىٌ وَدَمَىٌ، والواو
من نحو اسم وابن وشَفَة، أصلها: سِمْوٌ وَبَنَوٌ وشَفَوٌ، والهاء من نحو است، أصله
سَتَةٌ، والتاء من نحو اسْطَاع، أصله استطاع فى أحد وجهين.
الإدغام
بسكون الدال وشدّها. والأولى عبارة الكُوفيين، والثانية عبارة البصريين، وبها
عَبَّر سيبويه. وهو لغةً: الإدخال.
واصطلاحًا: الإتيان بحرفين ساكن فمتحّرك، من مَخْرج واحد بلا فصل بينهما، بحيث
يرتفع اللسان وينحطُّ بهما دفعة واحدة، وهو باب واسع؛ لدخوله فى جميع الحروف، ما
عدا الألف اللينة، ولوقوعه فى المتماثلين والمتقاربين، فى كلمة وفى كلمتين.
وينقسم إلى ممتنع، وواجب، وجائز.
1- فمن الممتنع ما إذا تحرك أولُ المثلين وسكن الثانى، نحو ظَلِلْت، أو عُكِس وكان
الأول هاء سكت، نحو {مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ}؛ لأن الوقف
مَنْوِىّ، وقد أدغمها ورْش على ضعف، أو كان مَدّة فى الآخر، كيدعو واقد، ويُعْطى
ياسر، لفوات الغرض المقصود وهو المد، أو كان همزة مفصولة من فاء الكلمة، كلم
يقْرَأ أحد. والحقَّ أن الإدغام هنا ردئ، أو تحركا وفات الإدغام غرض الإلحاق،
كقَرْدَدٍ وَجَلْبَبَ، أو خِيْفَ اللبس بزنة أخرى، نحو دُرَر كما سيأتى:
2-
ويجب إذا سَكَن أولُ المثلين وتحرَك الثانى، ولم يكن الأول مدًّا ولا همزة مفصولة
من الفاء كما تقدم، نحو جدّ وحظّ وَسآل ورَآس، بزنة فَعّال، وكذا إذا تحركا معًا
بأحد عشر شرطًا.
أحدها: أن يكونا فى كلمة كمدّ ومَلّ وحَبّ، أصلها مَدَدَ بالفتح، ومَلِلَ بالكسر،
وحَبُب بالضم، وأما إذا كانا فى كلمتين، فيكون الإدغام جائزاً، نحو: {جعل لَكم}.
ثانيها: ألا يتصدَّر أحدهما كدَدَن وهو اللهو.
ثالثها: ألا يتَّصل بمدغم كَجُسَّسٍ جمع جاسّ.
رابعها: ألاّ يكونا فى وزن مُلْحَق بغيره كقَردَد: لجبل، فإنه ملحق بجعفر،
وجَلْبَبَ فإنه ملحق بدحرجَ، واقعنسَسَ فإنه ملحق باحرنجم.
خامسها وسادسها وسابعها وثامنها: ألاّ يكونا فى اسم على وزن "فَعَلٍ"
بفتحتين كطَلَل: وهى ما بقى من آثار الديار، أو "فُعُلٍ" بضمتين كذُلُل
جمع ذَلول: ضد الصعْب، أو "فِعَلٍ" بكسر ففتح كَلِمَم جمع لِمَّة: وهى
الشعر المجاوز شحمة الأذن، أو "فُعَل" بضم ففتح كدُرَر جمع دُرة: وهى
اللؤلؤة. فإن تصدر أو اتصل بمدغم، أو كان الوزن ملحقًا، أو كان فى اسم على زنة:
فَعَل، أو فِعَل، أو فُعُل، أو فُعَل، امتنع الإدغام.
الشرط التاسع: ألا تكون حركة إحداهما عارِضة، كاخْصُص أبِى واكفْفِ الشر.
العاشر: ألاّ يكونا ياءين لاَزَما تحريك ثانيهما، كحيِىَ وَعَيِىَ.
الحادى عشر: ألاّ يكونا تاءين فى "افتعل" كاستتر، واقتتل.
3- وفى الصور الثلاث الأخيرة يجوز الإدغام والفك.
كما يجوز أيضًا فى ثلاثٍ أخَر:
إحداها:
أولَى التاءين الزائدتين فى أول المضارع، نحو تَتَجَلّى وتتعلم. وإذا أدغمتَ جئت
بهمزة وصل فى الأول، للتمكن من النطق، خلافًا لابن هشام فى توضيحه، حيثُ رَدّ على
ابن مالك وابنه بعدم وجود همزة وصل فى أول المضارع ولكنهما حُجَّة فى اللغة
العربية، تقول فى إدغام نحو اسْتَتر واقتتل: سَتّر وقَتَّل ويُسَتِّر سِتّارا،
بنقل حركة التاء الأولى للفاء، وإسقاط همزة الوصل، وهو خماسىّ، بخلاف نحو سَتّر
بالتضعيف كفعَّل، فمصدره التفعيل، وتقول فى نحو تَتَجَلَّى، وتَتَعَلم: اتَّجَلى،
وَاتَّعَلّم.
وإذا أرادت التخفيف فى الابتداء، حذَفْتَ إحدى التاءين وهى الثانية، قال تعالى:
{نَاراً تَلَظَّى}، {ولَقَدْ كُنْتُم تَمَنّوْنَ المَوْتَ}.
وقد تُحْذَفُ النون الثانية من المضارع أيضًا، وعليه قراءة عاصم {وكَذالِكَ نُجِّى
المُؤْمِنِين} أصله نُنَجِّى بفتح الثانى.
ثانيتها وثالثتها: الفعل المضارع المجزوم بالسكون، والأمر المبنىّ عليه، نحو {مَنْ
يَرْتَدِد مِنكُمْ عَنْ دِينِه} يُقْرَأ بالفك، وهو لغة الحجازيين، والإدغام، وهو
لغة التيميين، ونحو قوله تعالى: {وَاغْضُضْ مِن صَوتِكَ}، وقول جَرير يهجو الراعىَ
النُّميرىَّ الشاعر:
*فَغُضّ الطرْفَ إنكَ مِنْ نُمَيْرٍ * فَلاَ كَعْبًا بَلغْتَ وَلا كِلاَبَا*
وقد
تقدّم ذلك فى حكم المضعّف. والتزموا فك "أفْعَل" فى التعجب، نحو أحْبِبْ
بزيد، وَأشْدِدْ بِبَيَاضِ وَجه المُتقِين، وَإدغامَ هلُمَّ لثقلها بالتركيب، ولذا
التزموا فى آخرها الفتحَ، ولم يجيزوا فيها ما أجازوه فى نحو رُدَّ وَشُدّ، من الضم
للاتباع، والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، فهما مُستثنيان من فعل الأمر،
واستثناؤهما منه فى الأول بحسب الصورة؛ لأنه فى الحقيقة ماض، وفى الثانى على لغة
تميم؛ لأنه عندهم فعلُ أمْرٍ غيرُ متصرِّف تلحقه الضمائر، بخلاف الحجازيين، فإنه
عندهم اسمُ فِعْلِ أمر لا يلحقه شئ، وبلغتهم جاء التنزيل. قال تعالى: {هَلُمَّ
إلَيْنَا}، {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُم}.
تنبيه
إذا ولِىَ المدغَمَ حرف مدّ، وجب تحريكه بما يناسبه، نحو رَدُّوا وَرُدِّى
وَرُدَّا؛ وإذا وليه هاء غائبة وجب فتحه، لخفاء الهاء، فكأن الألفَ وَلِيَتْه،
ويجب الضم إذا وليه هاء غائب، خلافًا لثعلب. وأما إذا وليه ساكن أو لم يله شئ
فيثلث آخره فى المضارع المجزوم والأمر، إذا كان مضمومَىْ الفاء، نحو رُدَّ القوم.
ولم يَغُضَّ الطّرف. فإذا كانا مفتوحى الفاء أو مكسوريها نحو عَضَّ وَفَرَّ، ففيه
وجهان فقط: الفتح والكسر، على خلاف فى بعض ذلك بين البصريين والكوُفيين.
وإذا اتصل المدغَم بضمير رفع متحرِّك وجب فك الإدغام، نحو {نَحْنُ خَلَقْناهُم
وَشَدَدْنَا أسْرَهُمْ}. وقد يُفَكُّ شذوذاً فى غير ذلك، نحو ألِلَ السِّقاء؛ أى
تغيَّرت رائحته، وفى الضرورة، نحو قول أبى النجم العِجْلِىّ:
*"الحمدُ لِلَّهِ الْعَلىِّ الأجْلَلِ*
النصوص الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( الباب الثالث -
فى أحكام تعم الاسم والفعل ) ضمن العنوان ( فصل: فى إدغام المتقاربين )
1-
حيث إنّ التقاربَ ينقسم إلى تقارب فى المَخْرج، وتقارب فى الصفة، لزم أن نُبين
أوّلاً مَخارج الحروف وصفاتها، ليكون الطالب على بصيرة، فنقول: مخارج الحروف أربعة
عَشَرَ تقريبًا:
1- أقصى الحلق: للألف، والهمزة، والهاء.
2- ووسَطُه: للحاء، والعين المهملتين.
3- وأدناه: للخاء والغين المعجمتين.
4- وأقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك: للقاف والكاف.
5- ووسطه مع ما فوقه من الحَنَك: للجيم والشين.
6- وإحدى حافتيه مع ما يليه من الأضراس: للضاد.
7- وما دون طرَفه إلى منتهاه مع ما فوقه من الحَنَك: للام، فمَخرَج اللام قريب من
الضاد، وهى أوسع الحروف مخرجًا.
8- وللراء من اللسان وما فوقه ما يليهما، فهى أخرج من اللام.
9- وللنُّون ما يليه من الخَيْشُوم، وهو أقصى الأنف.
10- وللطاء والدال المهملتين والتاء المثناة طرفُه، مع أصول الثنايا العليا، وهى
الأسنان المتقدمة، ثِنْتان من أعلى، وثنتان من أسفل.
11- وطرفه مع الثنايا للصاد، والزاى، والسين.
12- وطرفه مع طرف الثنايا: للظاء، والذال، والثاء المثلثة.
13- وباطن الشفة السُّفْلى مع طرف الثنايا العليا: للفاء.
14- وما بين الشفتين: للباء، والميم، والواو.
وصفاتها: جَهْر، وهَمْس، ورَخاوة، وشدة، وتوسُّط بينهما، وإطباق، وانفتاح،
واستعلاء، واستِفال، وذَلاقة، وإصمات، وصَفِيِر، ولين.
1- فالمجهور: ما ينحصر جَرْى النَّفَس مع تحركه لقوَّته، وقوَّة الاعتماد عليه فى
مَخْرجه، فلا يخرج إلا بصوت قَوِىّ، يمنع النَّفَس من الجرى معه.
2- والمهموس: بخلافه، وحروفه مجموعة فى قوله: "فَحَثّهُ شخصٌ سكَتَ".
وما عداها فهو المجهور.
3- والشديد: ما ينحصر جَرْى الصوت عند إسكانه. وأحرفه: "أجدُكَ
قَطَّبْتَ".
ومن هذه الأحرف خمسة تسمى أحرف القَلْقَلة، إذا كانت ساكنة، وهى: "قُطْبُ
جُدْ".
4- والرَّخو: ضدّه. الذى بينهما ما لا يتمّ له الانحصار ولا الجرى، وأحرفه:
"لم يروِعنا".
5-
والمطبَق: ما ينطبق معه اللسان على الحنك، فينحصر الصوت بين اللسان وما يحاذيه من
الحَنَك. وأحرفه: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء.
6- والمنفتح: بخلافه.
7- والمستعلِى: ما يرتفع به اللسان إلى الحَنَك. وأحرفه أحرف الإطباق، والخاء
والغين المعجمتان، والقاف.
8- والمُسْتَفِلُ: ما عداها.
9- والذَّلاقة: الفصاحة والخِفة فى الكلام. وحروفها: "مُرْ بِنَفل".
ولخفة أحرفها لا يخلو رُباعىّ أو خُماسىّ لثقلهما من أحدها إلا نادراً، كالعسجد،
وهو الذهب، والزَّهْزَقة، بزايين مفتوحتين، بينهما هاء ساكنة، وهى شدة الضَّحِك.
10- والمُصْمَتة: ما عداها.
11- وأحرف الصَّفِير: الزاى، والسين، والصاد.
12- وأحرف اللين: الألف، والواو، والياء.
والقياس فى إدغام ما يدغم من تلك الحروف: قَلْب الأول إلى الثانى، لا العكس، إلا
إذا دعا الحال لذلك، نحو ادَّكَرَ وَاذَّكَر.
2- ولإدغام الحروف المتقاربة فى بعضها ثلاثة أحكام: الوُجوب، والامتناع، والجواز.
فالوجوب فى لام التعريف مع أحد الحروف الشمسية، وهى: التاء، والثاء، والدال، إلى
الظاء، واللام، والنون.
وفى اللام الساكنة غيرَها مع الراء، نحو {بَل رَّفَعَهُ اللهُ}.
وفى النون الساكنة مع ستة: أربعة فيها بِغنّة، وهى أحرف "ينمو"، واثنان
بلا غُنَّة، وهما اللام والراء. وتقلب ميما الباء كما تقدّم، وتظهر مع حروف الحلق،
وتختفى مع الباقى، فلها خمس حالات:
والامتناع فى إدغام أحرف "ضَوِىَ مِشْفَر" فيما يقاربها؛ لأن استطالة
الضاد، ولين الياء والواو، وغُنّة الميم، وتَفَشِّى الشين والفاء، وتكرار الراء،
تزول مع الإدغام، وإدغام نحو سيِّد ومَهْدِىّ لا يَرِد؛ لأن الإعلال جعلهما مثلين.
والجواز
فيما عدا ذلك، نحو إدغام النون المتحركة فى حرف من حروف "يرملون". ونحو
التاء والثاء والدال والذال والطاء والظاء بعضها فى بعض، أو فى الزاى والسين
والصاد، كأن تقول: سكَت ثَّابِت أو دارم أو ذاكر أو طالب أو ظافر أو زيد أو سالم
أو صابر، أو تقول: لبث تَّاجر أو دارم... إلخ، أو تقول: حقد تاجر أو دارم.
التقاء الساكنين
1- إذا التقى ساكنان فى كلمة أو كلمتين، وجب التخلص منهما: إما بحذف أولهما، أو
تحريكه، ما لم يكن على حَدِّه، كما سيأتى:
فيجب إن كانا فى كلمة حذف الأوّل لفظًا وخطًّا إذا كان مدة، سواء كان الثانى جزءًا
من الكلمة أو كالجزء منها، نحو قُلْ وبِع وَخف، ونحو: أنتم تغزُون وتقضُون،
ولَتَرْمُنَّ ولتَغْزُنَّ يا رجال. وأنتِ ترمِين وتغْزِينَ، ولتَرْمِنَّ
وَلَتَغزِن يا هند، ويُحذف لفظًا لا خطًّا إن كانا فى كلمتين؛ وكان الأوّل مدة
أيضًا، نحو يغزو الجيش، ويرمى الرجل، و "ركْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ
الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"، و {أطِيعُوا اللَّه وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأولِي
الأمْرِ مِنْكُمْ}.
ويجب تحريكه إن لم يكن مدة إلا فى موضعين:
أحدهما: نون التوكيد الخفيفة، فإنها تُحذف إذا وليها ساكن كما تقدم.
ثانيهما: تنوين العلَم الموصوفِ بابنٍ مضافٍ إلى علَم، نحو: محمدُ بن عبد الله
والتحريك إمّا بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، وهو الأكثر، وإما بالضم
وجوبًا عند بعضهم فى موضعين:
الأول: أمر المضَعَّف المتصل به هاء الغائب، ومضارعُه المجزوم، نحو رُدُّهُ ولم
يَرُدُّه، والكوفيون يجيزون فيه الفتح والكسر أيضًا، كما تقدم فى الإدغام.
الثانى: ميم جماعة الذكور المتصلة بالضمير المضموم، نحو {كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ} و {لَهُمُ الْبُشْرَى} ويترجح الضم على الكسر فى واو الجماعة المفتوح
ما قبلها، نحو: اخْشَوُا الله، {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُم} لخفة الضمة
على الواو، بخلاف الكسرة.
ويجوز
الضم والكسر على السواء: فى ميم الجماعة المتصلة بالضمير المكسور، نحو بِهِمُ
اليوم، وفيما ضمُّ التالى لثانيهما أصلىّ، وإن كسر للمناسبة، نحو: قالتُ اخْرُج،
وقالتُ اغزِى، و{أنُ اقْتُلُو?اْ أنْفُسَكُم أوُِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُم}.
وأما الفتحُ وجوبًا: وذلك فى تاء التأنيث إذا وليها ألف الاثنين، نحو قالتا، وفى
نون مِن الجارة إذا دخلت على ما فيه أل، نحو مِنَ الله، ومِنَ الكتاب، بخلافها مع
غير أل، فالكسر أكثر، نحو مِنَ ابْنِك، وفى أمر المضعف المضموم العين، ومضارعه
المجزوم مع ضمير الغائبة، نحو رُدَّها ولم يرُدّها. وأجاز الكوفيون فيه الضم
والكسر أيضًا، كما تقدم فى الإدغام.
ويترجح الفتح على الكسر فى نحو {ال?م? * اللَّهُ}. ويجوز الفتح والكسر على السواء
فى مضموم العين من أمر المضعف ومضارعه سوى ما مر.
2- ويغتفر التقاء الساكنين فى ثلاثة مواضع:
الأول: إذا كان أول الساكنين حرف لين، وثانيهما مدغما فى مثله، وهما فى كلمة
واحدة، نحو {وَلاَ الضَّالّين} ومادّة، ودابّة، وخُوَيصَّة. وتُمُوْدَّ الحبل.
الثانى: ما قُصِد سرده من الكلمات، نحو جِيْمْ مِيْمْ، قافْ، وَواوْ، وهكذا.
الثالث: ما وُقف عليه من الكلمات، نحو قالْ، وزيْدْ، وثْوبْ، وبكْرْ، وَعمْرْو،
إلا أن ما قبل آخره حرف صحيح، يكون التقاء الساكنين فيه ظاهريا فقط، وفى الحقيقة
أن الصحيح محرك بكسرة مختلسة جدًا. وأما ما قبل آخره حرف لين، فالتقاء الساكنين
فيه حقيقىّ، لإمكانه وإن ثقُلَ. وأخف اللين فى الوقف: الألف، ثم الواو والياء
مدّين، ثم اللَّينان بلا مدّ، كثَوْب وبَيْت.
الإمالة
وتسمى الكسر، والبطح، والإضجاع
هى لغةً: مصدر أمَلْتُ الشئَ إمالة: عَدَلْت به إلى غير الجهة التى هو فيها.
واصطلاحًا: أن تذهب بالفتحة إلى جهة الياء، إن كان بعدها ألف كالفتى، وإلى جهة
الكسرة إن لم يكن ذلك، كنعمِة وبسحِر.
وأصحابها:
بنو تميم، وأسَد، وقَيْس، وعامة نجد، ولا يُميل الحجازيون إلا قليلاً.
ولها أسباب وموانع.
فأسبابها سبعة:
أحدها: كون الألف مبدلة من ياء متطرفة حقيقةً: كالفَتى، واشتَرَى؛ أو تقديرًا:
كفتاة؛ لتقدير انفصال تاء التأنيث، لا نحو باب؛ لعدم التطرف.
ثانيها: كون الياء تخلُفها فى بعض التصاريف، كألف مَلْهًى: وَأرْطَى، وَحُبْلَى
وَغَزَا وَتَلاَ وَسَجَى، لقولهم فى تثنيتها: ملْهَيان، وَأرْطَيَان،
وَحُبْلَيَان، وفى بناء الباقى للمجهول: غُزِىَ، وَتُلِىَ، وَسُجِىَ.
ثالثها: كون الألف مبدلة من عين فِعْل يئول عند إسناده للتاء إلى لفظ فِلْت
بالكسر، كباعَ وكالَ وهابَ وكادَ وماتَ، إذ تقول: بِعْتُ، وكِلْتُ، وهِبْتُ،
وكِدْتُ، وِمِتُّ، على لغة من كسر الميم، بخلاف نحو: طالَ.
رابعها: وقوع الألف قبل الياء، كبايَعْته وسايَرْته.
خامسها: وقوعها بعد ياء متصلة أو منفصلة بحرف أو حرفين أحدهما الهاء، نحو عِيان
وشَيْبان، ودخلْت بيْتها.
سادسها: وقوع الألف قبل كسرة مباشرة كسالِم، أو بعدها منفصلةً منها بحرف ككِتاب،
أو بحرفين كلاهما متحرِّك، وثانيهما هاء، وأولهما غير مضموم، كيريد أن يضرِبَها،
دون: هو يضربُها، أو أوَّلاهما ساكن: كشِمْلال، أو بهذين وبالهاء: كدرْهَماك.
سابعها: إرادة التناسب بين كلمتين أميلت إحداهما لسبب متقدِّم، كإمالة
{وَالضُّحَى}، فى قراءة أبى عمرو، لمناسبة: "سَجَى" و
"قَلَىَ"؛ لأن ألف الضُّحَى لا تمال، إذ هى منقلبة عن واو.
ويمنعها شيئان:
أحدهما: الراء بشرط كونها غير مكسورة، وأن تكون متصلة بالألف قبلها كراشد، أو
بعدها نحو هذا الجِْدار، وبنيت الجِْدَار، وبعضهم جعل المؤخَّرة المفصولة بحرف
ككافر، كالمتصلة. وألا يُجاور الألفَ راءٌ أخرى، فإن جاورتها أخرى لم تمنع الأولى،
نحو: {إنَّ الأبْرَارَ}.
ثانيهما:
حروف الاستعلاء السبعة، وهى: الخاء، والغين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء،
والقاف متقدمة أو متأخرة. ويشترط فى المتقدم منها ألاَّ يكون مكسورًا. فخرج نحو
طِلاَب وغِلاَب وَخِيام. وأن يكون متصلاً بالألف، أو منفصلاً عنها بحرف واحد،
كصالح، وضامن، وطالب، وظالم، وغالب، وخالد، وقاسم، وكغنائم. وألاَّ يكون ساكنًا
بعد كسرة، فخرج نحو مِصباح وإصلاح ومِطواع. وألا يكون هناك راء مكسورة مجاورة،
فخرج نحو {وَعَلَى أبْصَارِهِمْ} و {إذْ هُما فِي الْغَارِ}.
ويشترط فى المتأخر الاتصال أو الانفصال بحرف أو حرفين كساخِر وخاطِب، وكنافِخ
وناعِق، وكمواثيق ومناشيط.
تنبيهات
الأول: شرط الامالة التى يكفّها المانع ألاّ يكون سببها كسرة مقدَّرة كخاف، فإن
ألفه منقلبة عن واو مكسورة، ولا ألفًا منقلبةً عن ياء كطاب، فسبب إمالة الأول
الكسرة المقدرة. والثانى الياء التى انقلبت ألفًا، لأن السبب المقَّدر هنا أقوى من
السبب الظاهر؛ لأن الظاهر إما متقدِّم على الألف، كالكسرة فى كتاب، والياء فى
بيان، أو متأخر عنها نحو: غانم وبايع، والذى فى نفس الألف أقوى من الاثنين، ولذلك
أُمِيلَ نحو طابَ وخافَ، مع تقدُّم حرف الاستعلاء، وحاق وزاغ مع تأخره.
الثانى: سبب الإمالة لا يؤثر إلا إذا كان مع الممال فى كلمة؛ لأن عدم الإمالة هو
الأَصل، فيصار إليه بأدنى شئ، فلا يمال نحو "لزيد مال"؛ لوجود الألف فى
كلمة، والكسرة فى كلمة.
وأما المانع فيؤثر مطلقًا؛ لأنه لا يصار إلى الإمالة التى هى غير الأصل إلا بسبب
قوىّ، فلا تُمال ألف كتاب، من نحو "كتاب قاسم"؛ لوجود حرف الاستعلاء،
وإن كان منفصلاً.
الثالث: تمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة:
أحدها:
الألف وقد تقدَّمت. وشرطها ألا تكون الفتحة فى حرف، ولا فى اسم يشبه، إذ فى
الإمالة نوع تصرف، والحرف وشبهه برئ منه، فلا تمال فتحة إلاَّ، ولا علَى، ولا إلى،
مع السبب المقتضى فى كلّ، وهو الكسرة فى الأول، والرجوع إلى الياء فى الثانى،
وكلاهما فى الثالث. واستثْنَوْا من ذلك ضميرى "ها" و "تا" فقد
أمالوهما عند سبق الكسرة أو الياء؛ لكثرة استعمالها.
ثانيها: الراء، بشرط كونها مكسورة، وكون الفتحة فى غير ياء، وكونهما متصلتين، نحو
"من الكبر"، أو منفصلتين بساكن غير ياء، نحو "مِنْ عمرو"،
بخلاف نحو: أعوذ بالله مِنَ الغِيَر، ومن قبح السِّيَر، ومن غيرك.
ثالثها: هاء التأنيث فى الوقف خاصة، كرحمة ونعمة، شبهوا هاء التأنيث بألفها؛
لاتفاقهما فى المخرج والمعنى والزيادة والتطرف والاختصاص بالأسماء، وأمال الكسائى
قبل هاء السكت نحو {كتابيَه}، ومنعها بعضهم، وهو الأصحّ.
مسائل للتمرين
التمرين: مصدر مرَّنه على كذا، مأخوذ من قولهم: مَرَنَ على الشئ مُرونًا
وَمَرَانة: إذا اعتاده واستمر عليه، وهو هنا بمعنى تعويد الطالب تطبيق المسائل على
القواعد الصرفية التى علمها.
وكثيرًا ما يقولون: المطلوب أن تَبْنِىَ من كذا لفظًا بزنة كذا، فيجب أن نبحث
أوّلاً عن معنى هذه العبارة، حتى يعملَ سامعها بمقتضاها، فنقول:
إنهم قد اختلفوا فى ذلك على أقوال: أصحها هو أن المعنى: صُغ من لفظ ضرب مثلاً ما
هو بزنة جعفر، بمعنى أن تعمل فى هذه الزنة الفرعية ما يقتضيه القياس، من القلب أو
الحذف أو الإدغام مثلاً، إن كان فى هذه الزنة الفرعية أسباب تقتضيها.
فإذا
كان فى الأصل حرف زائد مثلاً، فلا خلاف فى أن يُزاد مثله فى الفرع إلا إذا كان
الحرف الزائد عوضًا عن حرف فى الأَصل، كما فى نحو اسم، فإن همزة الوصل فيه عِوَض
عن أصل، هو لام الكلمة أو فاؤها، ففيه خلاف، وإذا حصل قلب فى الأصل، فلا خلاف فى
حصوله فى الفرع، فإِذا أردنا أن نبنى من الضرب مثالاً بزنة أيِسَ قلنا رَضِبَ.
وإن وُجِدَ فى الفرع ما يقتضى عدم الإدغام مثلا، عُمِل به، كما إذا لزم عليه لبس
أو ثقَل، لرفض العرب ذلك فى كلامهم، وإن كلامهم، وإن وُجد فى الأَصل سبب إعلال
لحرف لم يوجد فى الفرع، فلا خلاف فى أنه لا يقلَب فى الفرع، فيقال على وزن أوائل
من القتل: أقَاتِل.
تنبيه
يجوز عند سيبويه أن يصاغ على وزن ثبت فى كلام العرب وإن لم ينطقوا به الفرع
المطلوب، فيصح أن يصاغ من ضرب على زنة شَرَنْبَث، فيقال: ضرنبب مع أنهم لم ينطقوا
به. ولا محذور فيما قاله سيبويه؛ إذ الغرض التمرين فقط، ولا يقال: إنه يلزم إثبات
صيغ لم تنطق بها العرب فى كلامهم. وأما نحو جالينوس وميكائيل فلا يصاغ على زنتهما؛
لعدم ثوبتهما فى كلامهم.
تطبيق
1- إذا أردت أن تصوغ من باع وقال على وزن عنسل بمهملتين مفتوحتين، بينهما نون
ساكنة: للناقة السريعة، قلتَ فيه "بَنْيَع وَقَنْوَل" بلا إدغام، مع أن
هنا حرفين متقاربين؛ لأنه يشترط فى إدغام المتقاربين ألاّ يحصل لبس، ووجه اللبس
هنا أنك لو أدغمت لقلت: قَوَّل وَبَيَّع، فيلتبسان بمضعَّفى. قال وباع.
2-
وإذا أردت أن تصوغ من قال وباع بوزن "قِنْفَخْر بكسر فسكون ففتح فسكون: للرجل
العظيم الجثة" قلت: قِنْوَلّ وبِنْيَعّ بلا إدغام، مع أن هنا حرفين متقاربين،
هما النون والواو، والنون والياء، حذرًا من أن يلتبس بنحو عِلْكَدّ، ومعناه البعير
الغليظ، فلا يُدْرَى: أهو مثله، أو مثل قِنْفَخْرٍ وأدغم؟ ولا يجوز أن تصوغ من نحو
كَسَرَ وَجَعَل على وزن جَحَنْفَل، فلا تقول كسَنْرَر ولاَ جَعَنْلَل، فإنك إن لم
تدغم حصل الثقل، وإن أدغمتَ التبس بنحو سفَرجَل، فيظن أنه خماسىّ الأصول.
3- وإذا قيل كيف تَبنى من نحو ضرَّب مضعَّف العين على زنة مُحَوِىّ، بضم ففتح فكسر
فياء مشددة، قلت: مُضَرِّبِىّ لا مُضَرَبِىّ. وذلك أن لفظ مُحَوِىّ اسم فاعل منسوب
إليه، من قولهم حَيِّى بثلاث ياءات، أدغمت الأولى فى الثانية، فأصل مُحَوِىّ قبل
النسب مُحيِّى بثلاث ياءات، على وزن مُطرِّز، فللنسب إليه يلزم حذف الياء الأخيرة،
كما تحذف من نحو المشترى، ثم حذف إحدى الياءين الباقيتين، وقلب الأخرى واوًا، وفتح
ما قبلها، فيصير بعد النسب مُحَوِيّاً، وحيث أن هذه الأسباب الموجبة للتغيير فى
الأصل لم توجد فى الفرع، الذى هو مُضَرِّبِىّ نُطقَ به على حاله؛ أى على زنة
مُحَوِىّ لو لم يحصل فيه تغيير.
4- وإذا قيل: صُغ من "آءة" اسم شجرة أو ثمرة، على زنُة مُسْطار: اسم
للخمر، قلت: مُسْتآة لا مُسْآة؛ لأنه لا يحذف من الفرع إلا ما اقتضاه فى نفسه، لا
بالنظر إلى أصله، إذ أصلهُ مُسْتَطَار، من "ط ى ر"، ولو قدّر أنه من
"س ط ر" لقيل مُؤْواء.
5-
وإذا قيل كيف نَبْنِى من "وَأيْت" بزنة كوكب، حال كون المصوغ مخففًا
مجموعًا جمع سلامة، مضافًا إلى ياء المتكلم؟ قلت فيه "أوِىَّ" بفتح
فكسر، فياء مشددة مفتوحة. وذلك أنك أوَّلا تبنى من وأى بزنة كوكب فتقول:
"وَوْأى" ثم يعلّ إعلال فتًى، فيقال وَوْأىً. فإذا خففتَ همزته بنقل
حركتها إلى ما قبلها، قلت فيه: "ووًى" بزنة فتًى، ثم تقلب الواو الأولى
همزة، فيصير أوًى، وجوَّز بعضهم عدم القلب. فإذا جمعته جمع سلامة، قلت فيه:
أوَوْنَ كفَتَوْنَ. فإِذا أضفته إلى ياء المتكلم قلت: أوَوْىَ، ثم تقلب الواو
الثانية ياء، وتدغم فى الياء، وتكسِر الواو الأولى لمناسبة الياء، فيصير أوِىَّ.
6- وإذا قيل: كيف تبنى من "وأيت" بزنة أبْلُم، وهو خوص المُقْل؟ قلت
فيه: "أوْءٍ" بضم أوله، وذلك لأن أصله أوْؤىٌ، ثم أعِلّ إعلال قاض، فصار
أوْءٍ.
7- وإذا قيل صُغ من "أوَيْتَ" بزنة أبْلُم؟ قلت فيه: "أوٍّ"
أصله: "أؤوُىٌ" قلبت الهمزة الثانية واوًا، وأدغم المثلان. ثم أعِلّ
إعلال قاض فصار أوٍّ.
8- وإذا قيل كيف تبنى من "وأيْتُ" بزنة إِوَزَّة؟ قلت:
"إيئاة" بهمزة فياء فهمزة. وذلك لأن أصل إوزة: إوْزَزَة، فحينئذ يكون
أصل إيئَاة: إوْ أيَة، بهمزة مكسورة، فواو ساكنة، فهمزة مفتوحة، فياء مفتوحة. قلبت
واوه ياء؛ لوقوعها إثر كسرة، فصار إيْأيَة، ثم قلبت الياء الثانية ألفًا لتحركها
وانفتاح ما قبلها، فصار إيئَاة كسِعلاة.
9- وإذا بنيت من "أوَيت" مثل إوزّة قلت: "إيّاة" بهمزة مكسورة
فياء مشددة. وذلك لأن أصله إثْوَيَة. أما الهمزة الأولى فهى زائدة، وأما الثانية
فهى فاء الكلمة، وأما الواو فهى عينها، ولوقوع الهمزة الثانية إثر كسرة تقلب ياء،
ثم يقال: اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداها بالسكون، قلبت الواو ياء وأدغمتا.
وحينئذ اجتمعت ثلاث ياءات، قلبت الأخيرة ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار
إيَّاة.
10-
وإذا قيل: كيف تَبْنى من قال وباع بزنة "عَنْكبوت"؟ قلت: بَيْعَعُوت
وقَوْلَلوت، لا بنْيَعُوت وقَنْوَلُوت؛ لأن الصحيح أن النون لا تزاد ثانية ساكنة
إلا بضَعْف.
11- وإذا قيل كيف تبنى من "بِعْتُ" على زنة اطمأن؟ قلت:
"ابْيَعَعّ" بإدغام العين الثانية فى الثالثة، بعد نقل حركتها إلى العين
الأولى.
12- وإذا قيل كيف تبنى من قال على زنة "اغْدوْدَن" مبنيا للمعلوم؟ قلت:
"اقُوْوَّلَ" بإدغام الواو الثانية فى الثالثة وجوبًا.
13- وإذا قيل: كيف تبنى من قال وباع بزنة "اغْدوْدَن" مبنيا للمجهول؟ قلت:
"اقْوُووِل وابْيُويِع" بلا إدغام وجوبًا؛ لأن الواو الثانية فى
اقْوُوْوِل، والواو فى ابيويِع حرفا مدّ زائدان، فلا إدغام فيهما.
14- وإذا قيل: كيف تبنى من "قَوِىَ" بزنة "بيقور"، وهو اسم
جمع البقرة؟ قلت فيه: "قَيُّوُّ" بياء مشدَّدة مضمومة، فواو مشددة.
والأصل: "قَيْوُوْرٌ" قلبت الواو الأولى ياء لاجتماعها مع الياء، وسبق
إحداهما بالسكون، وأدغمتا، ثم أدغمت الواو الثانية فى الثالثة، ولم تقلبا ياءين مع
وقوعهما طرَفا؛ لأن لذلك مواضع قد تقدم ذكرها، وليس هذا منها. ولم تنقل حركة العين
التى هى الواو الأولى إلى ما قبلها، كما فى مَبْيوع، لأن العين لا تعلُّ إذاكانت
هى واللام حَرفَىْ علة، سواء أعِلَّت اللام كما فى "قَوِىَ" أو لم تعلّ
كما فى هَوِىَ.
وعلى هذا القياس يكون التمرين.
الوقف
1- هو قطع النطق عند آخر الكلمة، ويقابله الابتداء الذى هو عمل. فالوقف استراحة عن
ذلك العمل. ويتفرّع عن قصد الاستراحة فى الوقف ثلاثة مقاصد: فيكون، لتمام الغرض من
الكلام، ولتمام النظم فى الشعر، ولتمام السجع فى النثر.
وهو
إما اختيارىّ (بالياء المثناة من تحت): أى قُصِد لذاته، أو اضطرارىّ عند قطع
النَّفَس. أو اختبارىّ (بالموحدة)، أى قُصِد لاختبار شخص هل يحسن الوقف على نحو
بِمَ و "ألا يا سجدوا" و {أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين} أولا؟
والأول: إما استثباتى، وهو ما وقع فى الاستثبات، والسؤال المقصود به تعيين مبهم،
نحو مَنُو، وأيُّونْ؟ لمن قال: جاءنى رجل أو قوم. وإما إنكارىّ لزيادة مدة الإنكار
فيه، وهو الواقع فى سؤال مقصود به إنكار خبر، أو كون الأمر على خلاف ما ذُكِر.
وحينئذ فإِن كانت الكلمة منونة كسر التنوين، وتعينت الياء مدة، نحو أزَيدُنِيه بضم
الدال، وأزيدَنِيه بفتحها، وأزيدِنِيه بكسرها، وكسر النون فى الجميع، لمن قال: جاء
زيدٌ، أو رأيتُ زيدًا، أو مررت بزيد. وإن لم تكن منونة أتى بالمدّ من جنس حركة آخر
الكلمة، نحو أعُمَرُوه وأعَمرُوه وأعمرَاه، وأحَذَامِيه، لمن قال جاء عُمَرُ،
ورأيتُ عُمَر، ومررت بحَذَامِ.
وإما تذكُّرِىّ، وهو المقصود به تذكر باقى اللفظ، فيؤتى فى آخر الكلمة بَمّدة
مجانسة لحركة آخرها، كقالا، ويقولوُا، وفى الدَّارِى.
وإما ترنمىُّ كالوقف فى قول جرير:
*أقّلى اللّوْمَ عاذِلَ والعتابَنْ*
وإما غير ذلك وهو المقصود هنا.
2- والتغييرات الشائعة فى الوقف سبعة أنواع، نظمها بعضهم فقال:
*نَقْل وَحَذْفٌ وَإسْكانٌ وَيَتْبَعُهَا التـ * ـضعيف وَالرَّوْمُ وَالإشْمَامُ
وَالْبَدَلُ*
فيُبدّل تنوين الاسم بعد فتحه ألفا، كرأيتُ زيدًا، وفَتى، ونحو ويْهَا وَإيْهَا
بكسر الهمزة، وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة ألفًا، وَيُّرَدُّ ما حُذِفَ لأجلها
فى الوقف كما تقدّم، وشبَّهُوا "إذنْ" بالمنوَّن، فأبدلوا نونها ألفا فى
الوقف مطلقًا، وبعضهم يقف عليها بالنون مطلقًا، لشبهها بأنْ ولنْ، وبعضهم يقف
عليها بالألف إن ألْغِيت، وبالنون إن أعْمِلت.
ويُوقَف
بعد غير الفتحة بحذف التنوين، وإسكان الآخر، كهذا زيدْ، ومررت بزيدْ، ومطلقا عند
ربيعة. وأما الأزد فتقلبه واوًا بعد الضم، وياء بعد الكسر، فيقولون: جاء زيدُو،
ومررت بزيدِى. وإن وقف على هاء الضمير حذفت صلته، أى مَدَّته، بعد غير الفتح، نحو
به وله، إلا فى الضرورة كقول رُؤبة:
*وَمَهْمَهٍ مُغْبَرَّةٍ أرْجَاوُهُ * كأنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ*
بخلاف نحو: بِهَا ومنْها، فتبقى الصلة، وقد تحذف على قلة، كقوله: "وبالكرامة
ذات أكرمكم الله يَهْ".
أراد: بِها، فحذف الألف، وسكَّن الهاءَ، بعد نقل حركتها إلى ما قبلها.
وَإِذا وُقف على المنقوص ثبتت ياؤه إذا كان محذوف الفاء، كما إذا سَميت بمضارع
نحو: وَفَى: تقول: هذا يَفى، أو كان محذوف العين، كما إذا سميت باسم الفاعل مِن:
رأى، فإنك تقول هذا مُرِى؛ إذ لو حذفت اللام منهما لكان إِجحافًا، وكان إذا كان
منصوبًا منوَّنا نحو: {رَبَّنَا إنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً}، أو غير منوّن
مقرونًا بأل، نحو {كَلاَّ إذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ} فإن كان غير منصوب جاز
الإثبات والحذف، ولكن يترجح فى المنوّن الحذف، نحو هذا قاض، ومررت بقاض، وقرأ ابن
كثير: {وَمَا لَهُمْ مِنْ دونِهِ مِن وَالِى} وفى غير المنوّن يترجَّح الإثبات،
كهذا القاضِى، ومررت بالمنادِى، وقرأ الجمهور: {الكَبِيرُ المُتَعَالُ}.
ويوقف على هاء التأنيث بالسكون، نحو فاطمة، وعلى غيرها من المتحرك بالسكون فقط، أو
مع الرَّوم، وهو إخفاء الصوت بالحركة، والإشارة إليها ولو فتحة، بصوت خفىّ، ومنعه
الفَرَّاءُ فيها، أو الإشمام، وهو ضَمُّ الشَفَتين، والإشارة بهما إلى الحركة بدون
صوت، ويختص بالمضموم، ولا يُدركه إلا البصير؛ أو التضعيف، نحو هذا خالدّ، وهو
يضربّ، بتشديد الحرف الأخير، وهى لغة سَعْدية.
وشرط
الوقف بالتضعيف ألاّ يكون الموقوف عليه همزة كرِشاء، ولا ياء كالراعى, ولا واواً
كيغزو، ولا ألفًا كيخشى، ولا واقعًا إثر سكون كزيد وبكر، أو مع نقل حركة الحرف
الموقوف عليه إلى ما قبله، كقراءة بعضهم: {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}، بكسر الباء،
وسكون الراء، بشرط أن يكون ما قبل الآخر ساكنا غير متعذر، ولا مستثقل تحريكه،
وألاّ تكون الحركة فتحة، وألا يؤدَّىَ النقل إلى عدم النظير. فخرج نحو جعفر، لتحرك
ما قبله، ونحو إنسان ويشدّ، لأن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة، ويقولٌ ويبيعُ،
لاستثقال الضمة إثر كسرة أو ضمة، ونحو هذا عِلْم؛ لأنه لا يوجد فِعُل بكسر فضم فى
العربية. والشرطان الأخيران مختصان بغير المهموز، فيجوز النقل فى نحو {يُخْرجُ
الخَبَء} وإِن كانت الحركة فتحة، وفى نحو: هذه رِدُءْ، وإن أدى إلى عدم النظير؛ لأنهم
يغتفرون فى الهمزة مالا يغتفرون فى غيرها.
ويوقف على ياء التأنيث بدون تغيير إن كانت فى حرف: كَثُمَّتْ وَرُبَّتْ، أو فى
فعل: كقامت، أو اسم وقبلها ساكان صحيح: كأخْتْ وبِنْتْ. وجاز إبقاؤها على حالها
وقلبها هاء، إن كان قبلها حركة كَثَمَرَةْ وَشَجَرَةْ، أو ساكن معتلّ، كصلاةْ
ومسلماتْ، ويترجح إبقاؤها فى الجمع وما سمى به منه، تحقيقًا أو تقديرًا، وفى اسمه
كمسلمات وَأذْرِعاتْ وهيْهَآتْ، فإنها فى التقدير جمع هَيْهَيَةٍ كقَلْقَلَة،
سمَّى بها الفعل، ونحو أولاتْ. ومن الوقف بالإبدال قولهم: كيف الإخوةُ والأخواهْ،
وقولهم: "دَفْنُ البناهْ، من المكْرُماهْ" وقُرِئَ {هَيْهَاهْ}
هَيْهَاهْ. ومن الوقف بتركه وقف بعضهم بالتاء فى قوله تعالى: {إِنَّ شَجَرَتْ}
وقولِه:
*كانَت نُفوس القومِ عنْدَ الغَلْصَمَتْ * وكادتِ الْحُرَّةُ أنْ تُدْعى أمَت*
وَيُوقف
بهاء السكت جَوازًا على الفعل المعلّ لاماً بحذف آخره، نحو لم يَغْزُهْ ولم
تَرْمِهْ، ولم يَخْشَهْ. وتجب الهاء إن بقى على حرف واحد، نحو قِهْ، وعِهْ، وقال
بعضهم: وكذا إذا بقى على حرفين أحدهما زائد، نحو لم يَقِهْ، ولم يعِهْ. ورُدَّ
بلَمْ أكْ، ومَنْ تَقْ، بدون هاء عند إرادة الوقف. ويترجح الوقف بها على ما
الاستفهامية المجرورة بالحرف، نحو لِمَهْ، وَعَمَّهْ. ويجب إن جرَّتْ باسم، نحو:
مَجِئَ مَه. وعلى كلٍّ فيجب حذف ألفها فى الجر مطلقًا. وأما قولُ حسان رضى الله
عنه:
*عَلَى ما قامَ يَشْتُمُنِى لَئِيمٌ * كخِنْزِيرٍ تمَرّغَ فى تُرَابِ*
بإثبات الألف، فضرورة.
وقال الشاطبىّ: حذف الألف ليس بلازم، فيما جرت باسم، فيجوز مَجِئ: بِمَا جِئْتَ؟
ولكن الأجود الحذف.
وكذا يُوقَفُ بها على كلّ كلمة مبنية على حركة بناء لازمًا، وليست فعلاً ماضياً،
نحو هُوَ وهِىَ وياء المتكلم عند من فتحهن فى الوصل، وكيفَ، وثَمّ، ولحاقها لهذا
النوع جائز مستحسن. فلا تلحَق اسم "لا" ولا المنادىِ المضموم، ولا ما
قُطِع لفظه عن الإضافة، كقبلُ وبعدُ؛ ولا العددَ المركَّبَ كخمسةَ عشر، لشبه
حركاتها بحركات الإعراب، لعُروضها عند المقتضى، وزوالها عند عدمه، فيقال فى الوقف
على هُوَ: هُوَهْ، قال حسان:
*إذَا مَا تَرَعْرَعَ فِينَا الْغُلامُ * فَما إنْ يُقَالُ لَهُ مَنْ هُوَهْ*
وفى هِىَ: هِيَهْ؛ ومنه قوله تعالى: {وَمَا أدْرَاكَ مَاهِيَهْ} وفى كيفَ وثُمَّ:
كيفَه، وثمَّهْ. وفى غلامىَ وكتابىَ: غلاميَهْ، وكتابيَهْ. قال تعالى: {فَأمَّا
مَنْ أوتىَ كِتَابهُ بِيَمِيِنِه فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ}. والله
أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد النبىَّ الأمىّ وعلى آله وصحبه وسلم.
قال المؤلف حفظه الله:
وكان الفراغ من تبييضه يوم الاثنين، لعشر خلت من شوّال عامَ أحَدَ عشَرَ بعد
ثلثمائة وألفٍ هجرية (1311 هـ)، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية.
النصوص
الواردة في ( شذا العرف في فن الصرف / أحمد ) ضمن الموضوع ( تفاريظ الكتاب )
قرَّظ هذا الكتاب الاطلاع عليه بعض العلماء الأفاضل، فأحببنا إثبات تقاريظهم،
اعترافا بفضلهم، وشكرا لعملهم.
1
قال حضرة الأستاذ الجليل، والشاعر النائر النبيل، رئيس التصحيح بالمطبعة الأميرية
سابقا، المرحوم الشيخ طه قَطَرِيّة، مقرّظا ومؤرّخا عام طبعه الأول:
*العِلْمُ أَحسَنُ ما بهِ ظَفِرتْ يَدُ * عظُمَتْ عَلَىَّ به لأُستاذى يَدُ*
*رُوحِى فِداً لمعلِّمٍ تحيا به رُوحِى وَيَحْسُنُ مَصْدَرِىَ وَالمَوْرِدُ*
*وَيَطُبُّنى من داءِ جهلِى بالَّذِى * يَعْيَا بصنعتِهِ الطبيبُ الأَوْحَدُ*
*العلمُ بيْتٌ والمعلمٌ سُلَّمٌ * من أَيْنَ تَرْقَى البيْتَ لوْلاَ المِصْعَدُ*
*فاعْرِفْ له حَقّاً فأَنت به عَرَفْـ * تَ الحَقَّ إِذْ غُصْنُ الشَّبِيبَةِ
أَمْلَد*
*والعلم إن أَنصفْتَ لا تعْدِلْ به * عَرَضاً من الدنيا يَزُولَ وَيَنْفَدُ*
*وَاعْمذِرْ بَنِى الدُّنْيَا فإِنَّ زُيُوفَهَا * جادتْ بِأَعْيُنِهِمْ وَزَافَ
الجَيِّدُ*
*لا تَطْلُبِ الشَّهَوَاتِ تَقْلِيداً لَهُمْ * فَمِنَ البَهَائِمِ ما تَرَاهُ
يُقَلِّدُ*
*يا جامِعاً لِلْمَالِ يُدْنَى سَيِّداً * من غير بَذْلٍ أَيْنَ مِنْكَ
السُّودَدُ*
*المجدُ مَوْقوفٌ عَلَى كَفٍ نَدٍ * مَنْ كَانَ يَجْمُدُ كَفُّهُ لا بَمْجُدُ*
*فانهَضْ إِلَى كَسْبِ العلومِ مُنَزِّها * للنَّفْس عَنْ خُلُقٍ يَشِينُ
وَيَفْسُدُ*
*فإِذَا فَعَلْتَ فأَنْتَ شَهْمٌ. سيِّدٌ * تسعَى لخدمته المُلُوكُ وَتَجْفِدُ*
*نمَّتْ بهِ أَوْصَافُهُ الغُرَّا كما * نَمَّ "الشَّذَا فينا بفضلك
"أَحْمَدُ"*
*هذا لكتاب غنيمة الصَّرْقِىّ من * زَمَن به "دار العلوم" تُشَيَّدُ*
*لم أَلْقَ أطْيَبَ من "شَذَا العَرف" الذى * أهْدَى إلينا ذا الهمامُ
الأمجدُ*
*يا قومُ دونَكُمُ الشَّذَا فَتَمَسَّكُوا * بمدادهِ وبهِ إلى الصَّرْف اهْتَدُوا*
*وبه
افْرِقُوا بين الصَّحيح وما بدا * فيه اعتلال وهو منه مُجَرَّدُ*
*وبه ثقوا، وله اسمعوا قولا، وعُوا * وإذا قضى أمْراً فلا تتَرَدَّدُوا*
*فمباحِث التصريف قد أضْحَت به * كالشَّمْس ضاحيةً عليها فاشْهَدُوا*
*لا تَعْجَبُوا للصَّرْفِ مُجتمعا به * شَمْلاً فأصل الجمع هذا المفردُ*
*فارغَبْ إِليه وقف عَلَى أبوابِهِ * تَصْدُرْ أخى عنها وأنت مُزَوّدُ*
*وكأننى بفتًى تعرَّضَ سائلاً * من ذا الذى تُثْنى عليه وتحْمَدُ*
*بالله خبّرْنى، فقلت مؤرخا: * مَنْ فاحَ طيبُ شَذَاهُ أحمَدُ أحمَدُ*
سنة 1312هـ 90 89 21 100 53 53
2
وقال التقىّ النفىّ، الورع الذكىّ، مَحْتِد الكمال الأستاذ الفاضل الشيخ على
غَزَال، المدرس بالأزهر المعمور، رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحْدَه، والصلاة والسلام على من لا نبىَّ بعده، وعلى آله وأصحابه، وجميع
أحبابه.
وبعدُ: فقد اطلعت على الكتاب الموسوم "بشذا العرف، فى فن الصرف"، الذى
ألفه العالم الفاضل، والهمام الكامل، الشيخ أحمد الحملاوىّ، فوجدته كتابا بديعا،
لكثرة فوائده، وتحرير مقاصده، مع سهولة عباراته، ولطف إشاراته، وقد احتوى على
مهمات هذا الفن، مع تحرير حَسَن مُتْقَن، فجزَى الله مؤلفه أحسن الجزاء، ونفع
بالمؤلّف والتأليف، إنه سميع للدعاء آمين.
وصلى الله على سيدنا محمد النبىِّ الأمىّ، وعلى آله وصحبه وسلم.
3
وقال العلامة الفاضل، العالم العامل، مَظْهَر المجد، الأستاذ الشيخ سليمان العبْد،
المدرس بالأزهر المعمور، ومدرسة دار العلوم الخديوية سابقا، رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم.
نحمدُك
يا مصدَر الأسماء والأفعال، سبُحانك صَحَّحْتَ إيماننا، وخلّصته من شوائب
الاعتلال، ونُثْنِى عليك، صَرَفْتَ قلوبنا إلى التحلِّى بحِلية المعارف، وأسبغت
علينا ظِلَّ إنعامك الوارف، ونُصَلِّى ونسلِّم على سيد العرب والعجم، أفصحِ من نطق
بالضاد من حروف المُعْجَم، سيدنا ومولانا محمد، المشهور فى المصحف الأولى بأحمد،
والداعى إلى الصراط المستقيم والمنهج الأَحمد، وعلى آله وصحبه ما تحلى جيد الزمان
العاطل، بوجود العلماء الأَفاضل.
وبعد، فإِنه لما زالت عن قلبى الغُصَص، ونالت بُغْيتى أجلَّ الفُرَص، بمطالعة
الكتابة المسمى "شذا العرف، فى فن الصرف"، فوجدته سِفرا كالعَروس تشتاق
إليه جميع النفوس، ويُخْجِل قُسَّ الفصاحة بفصاحته، ويرينا نهج البلاغة ببلاغته،
فصرت أستخرج من بحاره الدُّرَرَ، وأشكر فضل جامعه، حيث انتقى فيه أحسن الغُرَر،
فما زال يُبْدى من بُرْج سعود قِرطاسه بدورا وشموسا، ويدير علينا من خمر لذة
معانيه كُئوسا، فاز من كان جليسا له، فإنه لم يُرَ فى فنه مجموعا عادلَه، فلذلك
أرَّخته، ولحسنه قَرَّظْته، فقلت:
*كتابٌ كبدر التِّمّ حُسنا فإنه * يضئ بأنوارٍ عُجَابٍ غَرَائِبِ*
*فَفَاقَ سِوَاهُ فى المحاسِنِ والبَهَا * وسُرَّت به الطلاَّبُ من كلِّ جانِبِ*
وَقَلّدَ جيدَ الدهرِ جامعُه به * قلائِدَ فَخْرٍ من أجلِّ المنَاقِبِ*
*ومن طِيبِ مَبْنَاهُ أقولُ مؤرِّخا * شذا العرفِ نبراسٌ بديعُ المطالِبِ*
سنة 1894 1382 313 86 133
فلله درّ مؤلفه الذى رُفِعَتْ له بين العلماء الأعْلام، وسجَدت له طوعا الأقلام،
العالم العامل، واللوذعىّ الكامل، الذى هو فى الشعر والنثر، وأعمال القلم، أشهر من
نار على عَلَم، من هو لكل فضل وكمالٍ راوِى، حضرة الشيح أحمد الحملاوِى، حفظه
الله.
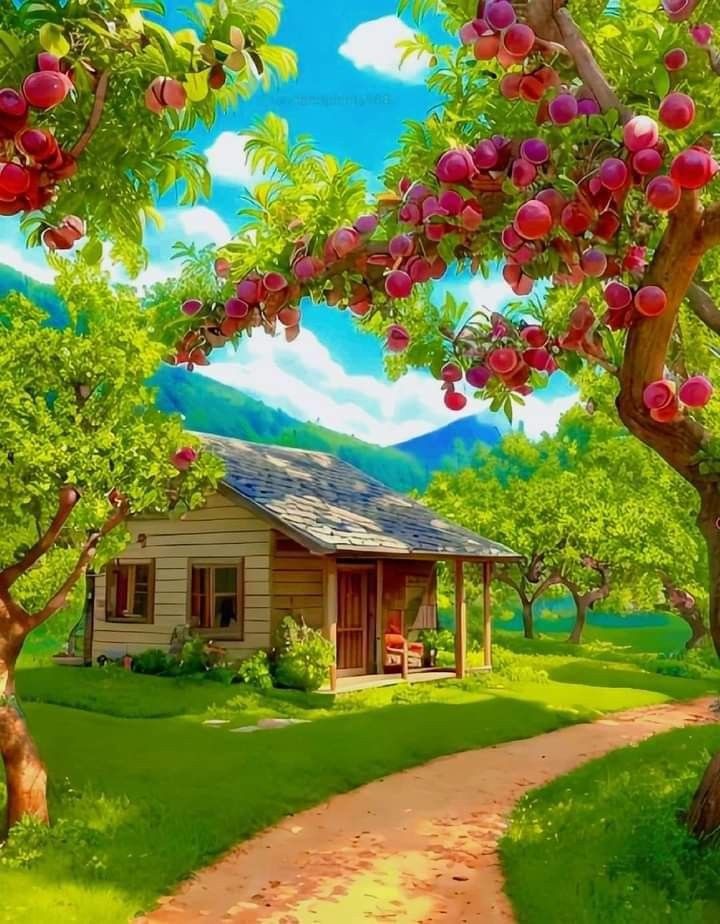
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق