الخصائص
موضوع: الأدب والبلاغة
نبذة: كتابٌ عُمْدَةٌ في أصول اللغة وفقهها، وفي النحو، والصرف. بدأ ببابٍ في مناقشة إلهامية اللغة واصطلاحيتها، وعَرَضَ لقضايا من أصول اللغة: كالقياس، والاستحسان، والعلل... والحقيقة والمجاز، والتقديم والتأخير، والأصول والفروع، واخْتُتِمَ بحديث عن أغلاط العرب، وسقطات العلماء.
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
المقدمة
باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح
باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية
باب القول على الاطراد والشذوذ
باب في تقاود السماع وتقارع الانتزاع
باب في مقاييس العربية
باب جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه
باب في تعارض السماع والقياس
باب في الاستحسان
باب في تخصيص العلل
باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المجوزة
باب في تعارض العلل
باب في أن العلة
باب في العلة وعلة العلة
باب في إدراج العلة واختصارها
باب في دور الاعتلال هذا موضع طريف.
باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة
باب في الاحتجاج بقول المخالف
باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة
باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط
باب في عدم النظير
باب في إسقاط الدليل
باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين
باب في الدور والوقوف منه على أول رتبة
باب في الحمل على أحسن الأقبحين
باب في حمل الشيء على الشيء من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم
باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني
باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها
باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديراً وحكماً لا زماناً ووقتاً
باب في فرق بين البدل والعوض
باب في الاستغناء بالشيء عن الشيء
باب في عكس التقدير
باب في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى
باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به
باب من غلبة الفروع على الأصول
باب في إصلاح اللفظ
باب في تلاقي اللغة
باب في هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو لا
باب في الاعتراض
باب في التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين
باب في تدريج اللغة
باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب
باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا
باب في تركب اللغات
باب فيما يرد عن العربي مخالفاً لما عليه الجمهور
باب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في القياس
الجزء الأول المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد العدل القديم، وصلى الله على صفوته محمد وآله المنتخبين.
وعليه وعليهم السلام أجمعين.
هذا - أطال الله بقاء مولانا السيد المنصور المؤيد بهاء الدولة وضياء الملة وغياث الأمة وأدام ملكه ونصره وسلطانه ومجده وتأييده وسموه وكبت شانئه وعدوه - كتاب لم أزل على فارط الحال وتقادم الوقت ملاحظاً له عاكف الفكر عليه منجذب الرأي والروية إليه واداً أن أجد مهملاً أصله به أو خللاً أرتقه بعمله والوقت يزداد بنواديه ضيقاً ولا ينهج لي إلى الابتداء طريقاً.
هذا مع إعظامي له وإعصامي بالأسباب المنتاطة به واعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنف في علم العرب وأذهبه في طريق القياس والنظر وأعوده عليه بالحيطة والصون وآخذه له من حصة التوقير والأون وأجمعه للأدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة: من خصائص الحكمة ونيطت به من علائق الإتقان والصنعة فكانت مسافر وجوهه ومحاسر أذرعه وسوقه تصف لي ما اشتملت عليه مشاعره وتحي إلي بما خيطت عليه أقرابه وشواكله وتريني أن تعريد كل من الفريقين: البصريين والكوفيين عنه وتحاميهم طريق الإلمام به والخوض في أدنى أوشاله
وخلجه فضلاً عن اقتحام غماره ولججه إنما كان لامتناع جانبه الفصل بين الكلام والقول هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول ولنقدم أمام القول على فرق بينهما طرفاً من ذكر أحوال تصاريفهما واشتقاقهما مع تقلب حروفهما فإن هذا موضع يتجاوز قدر الاشتقاق ويعلوه إلى ما فوقه.
وستراه فتجده طريقاً غريباً ومسلكاً من هذه اللغة الشريفة عجيباً.
فأقول: إن معنى " ق و ل " أين وجدت وكيف وقعت من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره عنه إنما هو للخفوف والحركة.
وجهات تراكيبها الست مستعملة كلها لم يهمل شيء منها.
وهي: " ق و ل " " ق ل و " " و ق ل " " و ل ق " " ل ق و " " ل و ق ".
الأصل الأول " ق و ل " وهو القول.
وذلك أن الفم واللسان يخفان له ويقلقان ويمذلان به.
وهو بضد السكوت الذي هو داعية إلى السكون ألا ترى أن الابتداء لما كان أخذاً في القول لم يكن الحرف المبدوء به إلا متحركاً ولما كان الانتهاء أخذاً في السكوت لم يكن الحرف الموقوف عليه إلا ساكناً.
الأصل الثاني " ق ل و " منه القلو: حمار الوحش وذلك لخفته وإسراعه قال العجاج: ومنه قولهم " قلوت البسر والسويق فهما مقلوان " وذلك لأن الشيء إذا قلى جف وخف وكان أسرع إلى الحركة وألطف ومنه قولهم " اقلوليت يا رجل " قال: قد عجبت مني ومن يعيليا لما رأتني خلقاً مقلوليا أي خفيفاً للكبر وطائشاً وقال: وسرب كعين الرمل عوج إلى الصبا رواعف بالجادي حور المدامع سمعن غناء بعد ما نمن نومة من الليل فاقلولين فوق المضاجع أي خففن لذكره وقلقن فزال عنهن نومهن واستثقالهن على الأرض.
وبهذا يعلم أن لام اقلوليت واو لا ياء.
فأما لام اذلوليت فمشكوك فيها.
ومن هذا الأصل أيضاً قوله: أقب كمقلاء الوليد خميص فهو مفعال من قلوت بالقلة ومذكرها القال قال الزاجر: وأنا في الضراب قيلان القلة فكأن القال مقلوب قلوت وياء القيلان مقلوبة عن واو وهي لام قلوت ومثال الكلمة فلعان.
ونحوها عندي في القلب قولهم " باز " ومثاله فلع واللام منه واو لقولهم في تكسيره: ثلاثة أبواز ومثالها أفلاع.
ويدل على صحة ما ذهبنا إليه: من قلب هذه الكلمة قولهم فيها " البازي " وقالوا في تكسيرها " بزاة " و " بواز " أنشدنا أبو علي لذي الرمة: كأن على أنيابها كل سدفة صياح البوازي من صريف اللوائك وقال جرير: إذا اجتمعوا علي فحل عنهم وعن باز يصك حباريات فهذا فاعل لاطراد الإمالة في ألفه وهي في فاعل أكثر منها في نحو مال وباب.
وحدثنا أبو علي سنة إحدى وأربعين قال: قال أبو سعيد الحسن بن الحسين " باز " وثلاثة " أبواز " فإن كثرت فهي " البيزان " فهذا فلع وثلاثة أفلاع وهي الفلعان.
ويدل على أن تركيب هذه الكلمة من " ب ز و " أن الفعل منها عليه تصرف وهو قولهم " بزا يبزو " إذا غلب وعلا ومنه البازي - وهو في الأصل اسم الفاعل ثم استعمل استعمال الأسماء كصاحب ووالد - وبزاة وبواز يؤكد ذلك وعليه بقية الباب من أبزى وبزواء وقوله: فتبازت فتبازخت لها والبزا لأن ذلك كله شدة ومقاولة فاعرفه.
فمقلاء من قلوت وذلك أن القال - وهو المقلاء - هو العصا التي يضرب بها القلة وهي الثالث " و ق ل " منه الوقل للوعل وذلك لحركته وقالوا: توقل في الجبل: إذا صعد فيه وذلك لا يكون إلا مع الحركة والاعتمال.
قال ابن مقبل: عوداً أحم القرا إزمولة وقلا يأتي تراث أبيه يتبع القذفا الرابع " و ل ق " قالوا: ولق يلق: إذا أسرع.
قال: جاءت به عنس من الشام تلق أي تخف وتسرع.
وقرىء " إذ تلقونه بألسنتكم " أي تخفون وتسرعون.
وعلى هذا فقد يمكن أن يكون الأولق فوعلاً من هذا اللفظ وأن يكون أيضاً أفعل منه.
فإذا كان أفعل فأمره ظاهر وإن سميت به لم تصرفه معرفة وإن كان فوعلاً فأصله وولق فلما التقت الواوان في أول الكلمة أبدلت الأولى همزة لاستثقالها أولاً كقولك في تحقير واصل: أويصل.
ولو سميت بأولق على هذا لصرفته.
والذي حملته الجماعة عليه أنه فوعل من تألق البرق إذا خفق وذلك لأن الخفوق مما يصحبه الانزعاج والاضطراب.
على أن أبا إسحاق قد كان يجيز فيه أن يكون أفعل من ولق يلق.
والوجه فيه ما عليه الكافة: من كونه فوعلاً من " أ ل ق " وهو قولهم " ألق الرجل فهو مألوق " ألا ترى إلى إنشاد أبي زيد فيه: وقد قالوا منه: ناقة مسعورة أي مجنونة وقيل في قول الله سبحانه " إن المجرمين في ضلال وسعر ": إن السعر هو الجنون وشاهد هذا القول قول القطامي: يتبعن سامية العينين تحسبها مسعورة أو ترى ما لا ترى الإبل الخامس " ل و ق " جاء في الحديث " لا آكل من الطعام إلا ما لوق لي " أي ما خدم وأعملت اليد في تحريكه وتلبيقه حتى يطمئن وتتضام جهاته.
ومنه اللوقة للزبدة وذلك لخفتها وإسراع حركتها وأنها ليست لها مسكة الجبن وثقل المصل ونحوهما.
وتوهم قوم أن الألوقة - لما كانت هي اللوقة في المعنى وتقاربت حروفهما - من لفظها وذلك باطل لأنه لو كانت من هذا اللفظ لوجب تصحيح عينها إذ كانت الزيادة في أولها من زيادة الفعل والمثال مثاله فكان يجب على هذا أن تكون ألوقة كما قالوا في أثوب وأسوق وأعين وأنيب بالصحة ليفرق بذلك بين الاسم والفعل وهذا واضح.
وإنما الألوقة فعولة من تألق البرق إذا لمع وبرق واضطرب وذلك لبريق الزبدة واضطرابها.
السادس " ل ق و " منه اللقوة للعقاب قيل لها ذلك لخفتها وسرعة طيرانها قال: كأني بفتخاء الجناحين لقوة دفوف من العقبان طأطأت شملال ومنه اللقوة في الوجه.
والتقاؤهما أن الوجه اضطرب شكله فكأنه خفة فيه وطيش منه وكانت لقوة لاقت قبيسا واللقوة: الناقة السريعة اللقاح وذلك أنها أسرعت إلى ماء الفحل فقبلته ولم تنب عنه نبو العاقر.
فهذه الطرائق التي نحن فيها حزنة المذاهب والتورد لها وعر المسلك ولا يجب مع هذا أن تستنكر ولا تستبعد فقد كان أبو علي رحمه الله يراها ويأخذ بها ألا تراه غلب كون لام أثفية - فيمن جعلها أفعولة - واواً على كونها باء - وإن كانوا قد قالوا " جاء يثفوه ويثفيه " - بقولهم " جاء يثفه " قال: فيثفه لا يكون إلا من الواو ولم يحفل بالحرف الشاذ من هذا وهو قولهم " يئس " مثل يعس لقلته.
فلما وجد فاء وثف واواً قوي عنده في أثفية كون لامها واواً فتأنس للام بموضع الفاء على بعد بينهما.
وشاهدته غير مرة إذا أشكل عليه الحرف: الفاء أو العين أو اللام استعان على علمه ومعرفته بتقليب أصول المثال الذي ذلك الحرف فيه.
فهذا أغرب مأخذاً مما تقتضيه صناعة الاشتقاق لأن ذلك إنما يلتزم فيه شرج واحد من تتالي الحروف من غير تقليب لها ولا تحريف.
وقد كان الناس: أبو بكر رحمه الله وغيره من تلك الطبقة استسرفوا أبا إسحاق رحمه الله فيما تجشمه من قوة حشده وضمه شعاع ما انتشر من المثل المتباينة إلى أصله.
فأما أن يتكلف تقليب الأصل ووضع كل واحد من أحنائه موضع صاحبه فشيء لم يعرض له ولا تضمن عهدته.
وقد قال أبو بكر: " من عرف أنس ومن جهل استوحش " وإذا قام الشاهد والدليل وضح المنهج والسبيل.
وبعد فقد ترى ما قدمنا في هذا أنفاً وفيه كاف من غيره على أن هذا وإن لم يطرد وينقد في كل أصل فالعذر على كل حال فيه أبين منه في الأصل الواحد من غير تقليب لشيء من حروفه فإذا جاز أن يخرج بعض الأصل الواحد من أن تنظمه قضية الاشتقاق له كان فيما تقلبت أصوله: فاؤه وعينه ولامه أسهل والمعذرة فيه أوضح.
وعلى أنك إن أنعمت النظر ولاطفته وتركت الضجر وتحاميته لم تكد تعدم قرب بعض من بعض وإذا تأملت ذاك وجدته بإذن الله.
وأما " ك ل م " فهذه أيضاً حالها وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة.
والمستعمل منها أصول خمسة وهي: " ك ل م " " ك م ل " " ل ك م " " م ك ل " " م ل ك " وأهملت منه " ل م ك " فلم تأت في ثبت.
فمن ذلك الأصل الأول " ك ل م " منه الكلم للجرح.
وذلك للشدة التي فيه وقالوا في قول الله سبحانه: " دابة من الأرض تكلمهم " قولين: أحدهما من الكَلام والآخر من الكِلام أي تجرحهم وتأكلهم وقالوا: الكُلام: ما غلظ من الأرض وذلك لشدته وقوته وقالوا: رجل كليم أي مجروح وجريح قال: عليها الشيخ كالأسد الكليم ويجوز الكليم بالجر والرفع فالرفع على قولك: عليها الشيخ الكليم كالأسد والجر على قولك: عليها الشيخ كالأسد الكليم إذا جرح فحمي أنَفاً وغضب فلا يقوم له شيء كما قال: كأن محرباً من أسد ترج ينازلهم لنابيه قبيب ومنه الكلام وذلك أنه سبب لكل شر وشدة في أكثر الأمر ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كفي مئونة لقلقه وقبقبه وذبذبه دخل الجنة ) فاللقلق: اللسان والقبقب: البطن والذبذب: الفرج.
ومنه قول أبي بكر - رضي الله عنه - في لسانه: " هذا أوردني الموارد ".
وقال: وجرح اللسان كجرح اليد وقال طرفة: فإن القوافي يتلجن موالجا تضايق عنها أن تولجها الإبر حتى اتقوني وهم مني على حذر والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر وجاء به الطائي الصغير فقال: عتاب بأطراف القوافي كأنه طعان بأطراف القنا المتكسر وهو باب واسع.
فلما كان الكلام أكثره إلى الشر اشتق له من هذا الموضع.
فهذا أصل.
الثاني " ك م ل " من ذلك كمَل الشيء وكمُل وكمِل فهو كامل وكميل.
وعليه بقية تصرفه.
والتقاؤهما أن الشيء إذا تم وكمل كان حينئذ أقوى وأشد منه إذا كان ناقصاً غير كامل.
الثالث " ل ك م " منه اللكم إذا وجأت الرجل ونحوه ولا شك في شدة ما هذه سبيله أنشد الأصمعي: كأن صوت جرعها تساجل هاتيك هاتا حتنى تكايل لدم العجى تلكمها الجنادل وقال: وخفان لكامان للقلع الكبد الرابع " م ك ل " منه بئر مكول إذا قل ماؤها قال القطامي: والتقاؤهما أن البئر موضوعة الأمر على جمتها بالماء فإذا قل ماؤها كره موردها وجفا جانبها.
وتلك شدة ظاهرة.
الخامس " م ل ك " من ذلك ملكت العجين إذا أنعمت عجنه فاشتد وقوي.
ومنه ملك الإنسان ألا تراهم يقولون: قد اشتملت عليه يدي وذلك قوة وقدرة من المالك على ملكه ومنه الملك لما يعطى صاحبه من القوة والغلبة وأملكت الجارية لأن يد بعلها تقتدر عليها.
فكذلك بقية الباب كله.
فهذه أحكام هذين الأصلين على تصرفهما وتقلب حروفهما.
فهذا أمر قدمناه أمام القول على الفرق بين الكلام والقول ليرى منه غور هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة ويعجب من وسيع مذاهبها وبديع ما أمد به واضعها ومبتدئها.
وهذا أوان القول على الفصل.
أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه.
وهو الذي يسميه النحويين الجمل نحو زيد أخوك وقام محمد وضرب سعيد وفي الدار أبوك وصه ومه ورويد وحاء وعاء في الأصوات وحس ولب وأف وأوه فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام.
وأما القول فأصله أنه كل لفظ مذل به اللسان تاماً كان أو ناقصاً.
فالتام هو المفيد أعني الجملة وما كان في معناها من نحو صهٍ وإيهٍ.
والناقص ما كان بضد ذلك نحو زيد ومحمد وإن وكان أخوك إذا كانت الزمانية لا الحدثية.
فكل كلام قول وليس كل قول كلاماً.
هذا أصله.
ثم يتسع فيه فيوضع القول على الاعتقادات والآراء وذلك نحو قولك: فلان يقول بقول أبي حنيفة ويذهب إلى قول مالك ونحو ذلك أي يعتقد ما كانا يريانه ويقولان به لا أنه يحكي لفظهما عينه من غير تغيير لشيء من حروفه ألا ترى أنك لو سألت رجلاً عن علة رفع زيد من نحو قولنا: زيد قام أخوه فقال لك: ارتفع بالابتداء لقلت: هذا قول البصريين.
ولو قال: ارتفع بما يعود عليه من ذكره لقلت: هذا قول الكوفيين أي هذا رأي هؤلاء وهذا اعتقاد هؤلاء.
ولا تقول: كلام البصريين ولا كلام الكوفيين إلا أن تضع الكلام موضع القول متجوزاً بذلك.
وكذلك لو قلت: ارتفع لأن عليه عائداً من بعده أو ارتفع لأن عائداً عاد عليه أو لعود ما عاد من ذكره أو لأن ذكره أعيد عليه أو لأن ذكراً له عاد من بعده أو نحو ذلك لقلت في جميعه: هذا قول الكوفيين ولم تحفل باختلاف ألفاظه لأنك إنما تريد اعتقادهم لا نفس حروفهم.
وكذلك يقول القائل: لأبي الحسن في هذه المسئلة قول حسن أو قول قبيح وهو كذا غير أني لا أضبط كلامه بعينه.
ومن أدل الدليل على الفرق بين الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا: القرآن كلام الله ولا يقال: القرآن قول الله وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه.
فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتاً تامة مفيدة وعدل به عن القول الذي قد يكون أصواتاً غير مفيدة وآراء معتقدة.
قال سيبويه: " واعلم أن " قلت " في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى بها وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاماً لا قولاً ".
ففرق بين الكلام والقول كما ترى.
نعم وأخرج الكلام هنا مخرج ما قد استقر في النفوس وزالت عنه عوارض الشكوك.
ثم قال في التمثيل: " نحو قلت زيد منطلق ألا ترى أنه يحسن أن تقول: زيد منطلق " فتمثيله بهذا يعلم منه أن الكلام عنده ما كان من الألفاظ قائماً برأسه مستقلاً بمعناه وأن القول عنده بخلاف ذلك إذ لو كانت حال القول عنده حال الكلام لما قدم الفصل بينهما ولما أراك فيه أن الكلام هو الجمل المستقلة بأنفسها الغانية عن غيرها وأن القول لا يستحق هذه الصفة من حيث كانت الكلمة الواحدة قولاً وإن لم تكن كلاماً ومن حيث كان الاعتقاد والرأي قولاً وإن لم يكن كلاماً.
فعلى هذا يكون قولنا قام زيد كلاماً فإن قلت شارطاً: إن قام زيد فزدت عليه " إن " رجع بالزيادة إلى النقصان فصار قولاً لا كلاماً ألا تراه ناقصاً ومنتظراً للتمام بجواب الشرط.
وكذلك لو قلت في حكاية القسم: حلفت بالله أي كان قسمي هذا لكان كلاماً لكونه مستقلاً ولو أردت به صريح القسم لكان قولاً من حيث كان ناقصاً لاحتياجه إلى جوابه.
فهذا ونحوه من البيان ما تراه.
فأما تجوزهم في تسميتهم الاعتقادات والآراء قولاً فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول أو بما يقوم مقام القول: من شاهد الحال فلما كانت لا تظهر إلا بالقول سميت قولاً إذ كانت سبباً له وكان القول دليلاً عليها كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان ملابساً له.
ومثله في الملابسة قول الله سبحانه " ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت " ومعناه - والله أعلم - أسباب الموت إذ لو جاءه الموت نفسه لمات به لا محالة.
ومنه تسمية المزادة الراوية والنجو نفسه الغائط وهو كثير.
فإن قيل: فكيف عبروا عن الاعتقادات والآراء بالقول ولم يعبروا عنها بالكلام ولو سووا بينهما أو قلبوا الاستعمال كان ماذا فالجواب أنهم إنما فعلوا ذلك من حيث كان القول بالاعتقاد أشبه منه بالكلام وذلك أن الاعتقاد لا يفهم إلا بغيره وهو العبارة عنه كما أن القول قد لا يتم معناه إلا بغيره ألا ترى أنك إذا قلت: قام وأخليته من ضمير فإنه لا يتم معناه الذي وضع الكلام عليه وله لأنه إنما وضع على أن يفاد معناه مقترناً بما يسند إليه من الفاعل وقام هذه نفسها قول وهي ناقصة محتاجة إلى الفاعل كاحتياج الاعتقاد إلى العبارة عنه.
فلما اشتبها من هنا عبر عن أحدهما بصاحبه.
وليس كذلك الكلام لأنه وضع على الاستقلال والاستغناء عما سواه.
والقول قد يكون من الفقر إلى غيره على ما قدمناه فكان إلى الاعتقاد المحتاج إلى البيان أقرب وبأن يعبر به عنه أليق.
فاعرف ذلك.
فإن قيل: ولم وضع الكلام على ما كان مستقلاً بنفسه البتة والقول على ما قد يستقل بنفسه وقد يحتاج إلى غيره ألاشتقاق قضى بذلك أم لغيره من سماع متلقى بالقبول والاتباع قيل: لا بل لاشتقاق قضى بذلك دون مجرد السماع.
وذلك أنا قد قدمنا في أول القول من هذا الفصل أن الكلام إنما هو من الكَلم والكَلام والكُلوم وهي الجراح لما يدعو إليه ولما يجنيه في أكثر الأمر على المتكلمة وأنشدنا في ذلك قوله: وجرح اللسان كجرح اليد ومنه قوله: قوارص تأتيني ويحتقرونها وقد يملأ القطر الإناء فيفعم ونحو ذلك من الأبيات التي جئنا بها هناك وغيرها مما يطول به الكتاب وإنما ينقم من القول ويحقر ما ينثى ويؤثر وذلك ما كان منه تاماً غير ناقص ومفهوماً غير مستبهم وهذه صورة الجمل وهو ما كان من الألفاظ قائماً برأسه غير محتاج إلى متمم له فلهذا سموا ما كان من الألفاظ تاماً مفيداً كلاماً لأنه في غالب الأمر وأكثر الحال مضر بصاحبه وكالجارح له.
فهو إذاً من الكلوم التي هي الجروح.
وأما القول فليس في أصل اشتقاقه ما هذه سبيله ألا ترى أنا قد عقدنا تصرف " ق و ل " وما كان أيضاً من تقاليبها الستة فأرينا أن جميعها إنما هو للإسراع والخفة فلذلك سموا كل ما مذل به اللسان من الأصوات قولاً ناقصاً كان ذلك أو تاماً.
وهذا واضح مع أدنى تأمل.
واعلم أنه قد يوقع كل واحد من الكلام والقول موقع صاحبه وإن كان أصلهما قبل ما ذكرته ألا ترى إلى رؤبة كيف قال: لو أنني أوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل يريد قول الله عز وجل " قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم " وعلى هذا اتسع فيهما جميعاً اتساعاً واحداً فقال أبو النجم: قالت له الطير تقدم راشداً إنك لا ترجع إلا حامداً وقال الآخر: وقالت له العينان: سمعاً وطاعة وأبدت كمثل الدر لما يثقب امتلأ الحوض وقال: قطني وقال الآخر: بينما نحن مرتعون بفلج قالت الدلح الرواء: إنيه إنيه: صوت رزمة السحاب وحنين الرعد وأنشدوا: قد قالت الأنساع للبطن الحق فهذا كله اتساع في القول.
ومما جاء منه في الكلام قول الآخر: فصبحت والطير لم تكلم جابية طمت بسيل مفعم وكأن الأصل في هذا الاتساع إنما هو محمول على القول ألا ترى إلى قلة الكلام هنا وكثرة القول وسبب ذلك وعلته عندي ما قدمناه من سعة مذاهب القول وضيق مذاهب الكلام.
وإذا جاز أن نسمي الرأي والاعتقاد قولاً وإن لم يكن صوتاً كانت تسمية ما هو أصوات قولاً أجدر بالجواز.
ألا ترى أن الطير لها هدير والحوض له غطيط والأنساع لها أطيط والسحاب له دوي.
فأما قوله: وقالت له العينان سمعاً وطاعة فإنه وإن لم يكن منهما صوت فإن الحال آذنت بأن لو كان لهما جارحة نطق لقالتا: سمعاً وطاعة.
وقد حرر هذا الموضع وأوضحه لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان - لو علم الكلام - مكلمي وامتثله شاعرنا آخراً فقال: فلو قدر السنان على لسان لقال لك السنان كما أقول وقال أيضاً: لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا ولا تستنكر ذكر هذا الرجل - وإن كان مولداً - في أثناء ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه ولطف متسربه فإن المعاني يتناهبها المولدون كما يتناهبها المتقدمون.
وقد كان أبو العباس - وهو الكثير التعقب لجلة الناس - احتج بشيء من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابه في الاشتقاق لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه فأنشد فيه له: لو رأينا التوكيد خطة عجز ما شفعنا الأذان بالتثويب وإياك والحنبلية بحتاً فإنها خلق ذميم ومطعم على علاته وخيم.
وقال سيبويه: " هذا باب علم ما الكلم من العربية " فاختار الكلم على الكلام وذلك أن الكلام اسم من كلم بمنزلة السلام من سلم وهما بمعنى التكليم والتسليم وهما المصدران الجاريان على كلم وسلم قال الله سبحانه {وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} وقال - عز اسمه -: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فلما كان الكلام مصدراً يصلح لما يصلح له الجنس ولا يختص بالعدد دون غيره عدل عنه إلى الكلم الذي هو جمع كلمة بمنزلة سلمة وسلم ونبقة ونبق وثفنة وثفن.
وذلك أنه أراد تفسير ثلاثة أشياء مخصوصة وهي الاسم والفعل والحرف فجاء بما يخص الجمع وهو الكلم وترك ما لا يخص الجمع وهو الكلام فكان ذلك أليق بمعناه وأوفق لمراده.
فأما قول مزاحم العقيلي: لظل رهيناً خاشع الطرف حطه تخلب جدوى والكلام الطرائف فوصفه بالجمع فإنما ذلك وصف على المعنى كما حكى أبو الحسن عنهم من قولهم: " ذهب به الدينار الحمر والدرهم البيض " وكما قال: تراها الضبع أعظمهن رأسا فأعاد الضمير على معنى الجنسية لا على لفظ الواحد لما كانت الضبع هنا جنساً.
وبنو تميم يقولون: كِلمة وكِلَم ككِسرة وكِسَر.
فإن قلت: قدمت في أول كلامك أن الكلام واقع على الجمل دون الآحاد وأعطيت ههنا أنه اسم الجنس لأن المصدر كذلك حاله والمصدر يتناول الجنس وآحاده تناولاً واحداً.
فقد أراك انصرفت عما عقدته على نفسك: من كون الكلام مختصاً بالجمل المركبة وأنه لا يقع على الآحاد المجردة وأن ذلك إنما هو القول لأنه فيما زعمت يصلح للآحاد والمفردات وللجمل المركبات.
قيل: ما قدمناه صحيح وهذا الاعتراض ساقط عنه وذلك أنا نقول: لا محالة أن الكلام مختص بالجمل ونقول مع هذا: إنه جنس أي جنس للجمل كما أن الإنسان من قول الله سبحانه {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} جنس للناس فكذلك الكلام جنس للجمل فإذا قال: قام محمد فهو كلام وإذا قال: قام محمد وأخوك جعفر فهو أيضاً كلام كما كان لما وقع على الجملة الواحدة كلاماً وإذا قال: قام محمد وأخوك جعفر وفي الدار سعيد فهو أيضاً كلام كما كان لما وقع على الجملتين كلاماً.
وهذا طريق المصدر لما كان جنساً لفعله ألا ترى أنه إذا قام قومة واحدة فقد كان منه قيام وإذا قام قومتين فقد كان منه قيام وإذا قام مائة قومة فقد كان منه قيام.
فالكلام إذاً إنما هو جنس للجمل التوام: مفردها ومثناها ومجموعها كما أن القيام جنس للقومات: مفردها ومثناها ومجموعها.
فنظير القومة الواحدة من القيام الجملة الواحدة من الكلام.
وهذا جلي.
ومما يؤنسك بأن الكلام إنما هو للجمل التوام دون الآحاد أن العرب لما أرادت الواحد من ذلك خصته باسم له لا يقع إلا على الواحد وهو قولهم: " كلِمة " وهي حجازية و " كِلمة " وهي تميمية.
ويزيدك في بيان ذلك قول كثير: ومعلوم أن الكلمة الواحدة لا تشجو ولا تحزن ولا تتملك قلب السامع إنما ذلك فيما طال من الكلام وأمتع سامعيه بعذوبة مستمعه ورقة حواشيه وقد قال سيبويه: " هذا باب أقل ما يكون عليه الكلم " فذكر هنالك حرف العطف وفاءه وهمزة الاستفهام ولام الابتداء وغير ذلك مما هو على حرف واحد وسمى كل واحد من ذلك كلمة.
فليت شعري: كيف يستعذب قول القائل وإنما نطق بحرف واحد! لا بل كيف يمكنه أن يجرد للنطق حرفاً واحداً ألا تراه أن لو كان ساكناً لزمه أن يدخل عليه مكن أوله همزة الوصل ليجد سبيلاً إلى النطق به نحو " اِب اِص اِق " وكذلك إن كان متحركاً فأراد الابتداء به والوقوف عليه قال في النطق بالباء من بكر: بَه وفي الصاد من صلة: صِه وفي القاف من قدرة: قُه فقد علمت بذلك أن لاسبيل إلى النطق بالحرف الواحد مجرداً من غيره ساكناً كان أو متحركاً.
فالكلام إذاً من بيت كثير إنما يعني به المفيد من هذه الألفاظ القائم برأسه المتجاوز لما لا يفيد ولا يقوم برأسه من جنسه ألا ترى إلى قول الآخر: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح فقوله بأطراف الأحاديث يعلم منه أنه لا يكون إلا جملاً كثيرة فضلاً عن الجملة الواحدة فإن كأن لها في الأرض نسياً نقصه على أمها وإن تخاطبك تبلت أي تقطع كلامها ولا تكثره كما قال ذو الرمة: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر فقوله: رخيم الحواشي: أي مختصر الأطراف وهذا ضد الهذر والإكثار وذاهب في التخفيف والإختصار قيل: فقد قال أيضاً: ولا نزر وأيضاً فلسنا ندفع أن الخفر يقل معه الكلام ويحذف فيه أحناء المقال إلا أنه على حال لا يكون ما يجري منه وإن قل ونزر أقل من الجمل التي هي قواعد الحديث الذي يشوق موقعه ويروق مستمعه.
وقد أكثرت الشعراء في هذا الموضع حتى صار الدال عليه كالدال على المشاهد غير المشكوك فيه ألا ترى إلى قوله: وحديثها كالغيث يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا! فأصاخ يرجو أن يكون حياً ويقول من فرح: هيا ربا! - يعني حنين السحاب وسجره وهذا لا يكون عن نبرة واحدة ولا رزمة مختلسة إنما يكون مع البدء فيه والرجع وتثنى الحنين على صفحات السمع - وقول ابن الرومي: وحديثها السحر الحلال لو انه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز فذكر أنها تطيل تارة وتوجز أخرى والإطالة والإيجاز جميعاً إنما هما في كل كلام مفيد مستقل بنفسه ولو بلغ بها الإيجاز غايته لم يكن له بد من أن يعطيك تمامه وفائدته مع أنه لا بد فيه من تركيب الجملة فإن نقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان ولا استعذاب ألا ترى إلى قوله: قنا لها قفي لنا قالت قاف وأن هذا القدر من النطق لا يعذب ولا يجفو ولا يرق ولا ينبو وأنه إنما يكون استحسان القول واستقباحه فيما يحتمل ذينك ويؤديهما إلى السمع وهو أقل ما يكون جملة مركبة.
وكذلك قول الآخر - فيما حكاه سيبويه -: " ألا تا " فيقول مجيبه: " بلى فا ".
فهذا ونحوه مما يقل لفظه فلا يحمل حسناً ولا قبحاً ولا طيباً.
ولا خبثاً.
لكن قول الآخر " مالك بن أسماء ": أذكر من جارتي ومجلسها طرائفاً من حديثها الحسن ومن حديث يزيدني مقة ما لحديث الموموق من ثمن أدل شيء على أن هناك إطالة وتماماً وإن كان بغير حشو ولا خطل ألا ترى إلى قوله: " طرائفاً من حديثها الحسن " فذا لا يكون مع الحرف الواحد ولا الكلمة الواحدة بل لا يكون مع الجملة الواحدة دون أن يتردد الكلام وتتكرر فيه الجمل فيبين ما ضمنه من العذوبة وما في أعطافه وحوراء المدامع من معد كأن حديثها ثمر الجنان ومعلوم أن من حرف واحد بل كلمة واحدة بل جملة واحدة لا يجنى ثمر جنة واحدة فضلاً عن جنان كثيرة.
وأيضاً فكما أن المرأة قد توصف بالحياء والخفر فكذلك أيضاً قد توصف بتغزلها ودماثة حديثها ألا ترى إلى قول الله سبحانه: {عُرُبًا أَتْرَابًا لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ} وأن العروب في التفسير هي المتحببة إلى زوجها المظهرة له ذلك بذلك فسره أبو عبيدة.
وهذا لا يكون مع الصمت وحذف أطراف القول بل إنما يكون مع الفكاهة والمداعبة وعليه بيت الشماخ: ولو أني أشاء كننت جسمي إلى بيضاء بهكنة شموع قيل فيه: الشماعة هي المزح والمداعبة.
وهذا باب طويل جداً وإنما أفضى بنا إليه ذرو من القول أحببنا استيفاءه تأنساً به وليكون هذا الكتاب ذاهباً في جهات النظر إذ ليس غرضنا فيه الرفع والنصب والجر والجزم لأن هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب المصنفة فيه منه.
وإنما هذا الكتاب مبني على إثارة معادن المعاني وتقرير حال الأوضاع والمبادي وكيف سرت أحكامها في الأحناء والحواشي.
فقد ثبت بما شرحناه وأوضحناه أن الكلام إنما هو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برءوسها المستغنية عن غيرها وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تركيبها.
وثبت أن القول عندها أوسع من الكلام تصرفاً وأنه قد يقع على الجزء الواحد وعلى الجملة وعلى ما هو اعتقاد ورأي لا لفظ وجرس.
وقد علمت بذلك تعسف المتكلمين في هذا الموضع وضيق القول فيه عليهم حتى لم يكادوا يفصلون بينهما.
والعجب ذهابهم عن نص سيبويه فيه وفصله بين الكلام والقول.
ولكل قوم سنة وإمامها اللغة وما هي باب القول على اللغة وما هي أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.
هذا حدها.
وأما اختلافها فلما سنذكره في باب القول عليها: أمواضعة هي أم إلهام.
وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإنها فعلة من لغوت.
أي تكلمت وأصلها لغوة ككرة وقلة وثبة كلها لاماتها واوات لقولهم.
كروت بالكرة وقلوت بالقلة ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب يثوب.
وقد دللت على ذلك وغيره من نحوه في كتابي في " سر الصناعة ".
وقالوا فيها: لغات ولغون ككرات وكرون وقيل منها لغى يلغى إذا هذى ومصدره اللغا قال: ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم وكذلك اللغو قال الله سبحانه وتعالى {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} أي بالباطل وفي الحديث: (من قال في الجمعة: صه فقد لغا) أي تكلم.
وفي هذا كاف.
النحو باب القول على النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم وإن شد بعضهم عنها رد به إليها.
وهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحواً كقولك: قصدت قصداً ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم كما أن الفقه في الأصل مصدر فقهت الشيء أي عرفته ثم خص به علم الشريعة من التحليل والتحريم وكما أن بيت الله خص به الكعبة وإن كانت البيوت كلها لله.
وله نظائر في قصر ما كان شائعاً في جنسه على أحد أنواعه.
وقد استعملته العرب ظرفاً وأصله المصدر.
أنشد أبو الحسن: ترمي الأماعيز بمجمرات بأرجل روح مجنبات يحدو بها كل فتى هيهات وهن نحو البيت عامدات الإعراب باب القول على الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه وشكر سعيداً أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول ولو كان الكلام شرجاً واحداً لاستبهم أحدهما من صاحبه.
فإن قلت: فقد تقول ضرب يحيى بشرى فلا تجد هناك إعراباً فاصلاً وكذلك نحوه قيل: إذا اتفق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله ألزم الكلام من تقديم الفاعل وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان الإعراب.
فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير نحو أكل يحيى كمثرى: لك أن تقدم وأن تؤخر كيف شئت وكذلك ضربت هذا هذه وكلم هذه هذا وكذلك إن وضح الغرض بالتثينة أو الجمع جاز لك التصرف نحو قولك أكرم اليحييان البشريين وضرب البشريين اليحيون وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس فقلت: كلم هذا هذا فلم يجبه لجعلت الفاعل والمفعول أيهما شئت لأن في الحال بياناً لما تعني.
وكذلك قولك ولدت هذه هذه من حيث كانت حال الأم من البنت معروفة غير منكورة.
وكذلك إن ألحقت الكلام ضرباً من الإتباع جاز لك التصرف لما تعقب من البيان نحو ضرب يحيى نفسه بشرى أو كلم بشرى العاقل معلى أو كلم هذا وزيداً يحيى.
ومن أجاز قام وزيد عمرو لم يجز ذلك في نحو " كلم هذا وزيد يحيى " وهو يريد كلم هذا يحيى وزيد كما يجيز " ضرب زيداً وعمرو جعفر ".
فهذا طرف من القول أدى إليه ذكر الإعراب.
وأما لفظه فإنه مصدر أعربت عن الشيء إذا أوضحت عنه وفلان معرب عما في نفسه أي مبين له وموضح عنه ومنه عربت الفرس تعريباً إذا بزغته وذلك أن تنسف أسفل حافره ومعناه أنه قد بان بذلك ما كان خفياً من أمره لظهوره إلى مرآة العين بعد ما كان مستوراً وبذلك تعرف حاله: أصلب هو أم رخو و أصحيح هو أم سقيم وغير ذلك.
وأصل هذا كله قولهم " العرب " وذلك لما يعزى إليها من الفصاحة والإعراب والبيان.
ومنه قوله في الحديث " الثيب تعرب عن نفسها " والمعرب: صاحب الخيل العراب وعليه قول الشاعر: يصهل في مثل جوف الطوى صهيلاً يبين للمعرب أي إذا سمع صاحب الخيل العراب صوته علم أنه عربي.
ومنه عندي عروبة والعروبة للجمعة وذلك أن يوم الجمعة أظهر أمراً من بقية أيام الأسبوع لما فيه من التأهب لها والتوجه إليها وقوة بوائم رهطاً للعروبة صيماً ولما كانت معاني المسمين مختلفة كان الإعراب الدال عليها مختلفاً أيضاً وكأنه من قولهم: عربت معدته أي فسدت كأنها استحالت من حال إلى حال كاستحالة الإعراب من صورة إلى صورة.
وفي هذا كاف بإذن الله.
البناء باب القول على البناء وهو لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً: من السكون أو الحركة لا لشيء أحدث ذلك من العوامل.
وكأنهم إنما سموه بناء لأنه لما لزم ضرباً واحداً فلم يتغير تغير الإعراب سمي بناء من حيث كان البناء لازماً موضعه لا يزول من مكان إلى غيره وليس كذلك سائر الآلآت المنقولة المبتذلة كالخيمة والمظلة والفسطاط والسرادق ونحو ذلك.
وعلى أنه قد أوقع على هذا الضرب من المستعملات المزالة من مكان إلى مكان لفظ البناء تشبيهاً لذلك - من حيث كان مسكوناً وحاجزاً ومظلاً - بالبناء من الآجر والطين والجص ألا ترى إلى قول أبي مارد الشيباني: لو وصل الغيث أبنين امرأ كانت له قبة سحق بجاد أي لو اتصل الغيث لأكلأت الأرض وأعشبت فركب الناس خيلهم للغارات فأبدلت الخيل الغني الذي كان له قبة من قبته سحق بجاد فبناه بيتاً له بعد ما كان يبني لنفسه قبة.
فنسب ذلك البناء إلى الخيل لما كانت هي الحاملة للغزاة الذين أغاروا على الملوك فأبدلوهم من قبابهم ونظير معنى هذا البيت ما أخبرنا به أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى من قول الشاعر: قد كنت تأمنني والجدب دونكم فكيف أنت إذا رقش الجراد نزا ومثله أيضاً ما رويناه عنه عنه أيضاً من قول الآخر: قوم إذا اخضرت نعالهم يتناهقون تناهق الحمر قالوا في تفسيره: إن النعال جمع نعل وهي الحرة أي إذا اخضرت الأرض بطروا وأشروا فنزا بعضهم على بعض.
وبنحو من هذا فسر أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ) أي إذا ابتلت الحرار.
ومن هذا اللفظ والمعنى ما حكاه أبو زيد من قولهم: " المعزى تبهى ولا تبنى ".
ف " تبهى " تفعل من البهو أي تتقافز على البيوت من الصوف فتخرقها فتتسع الفواصل من الشعر فيتباعد ما بينها حتى يكون في سعة البهو.
" ولا تبنى " أي لا ثلة لها وهي الصوف فهي لا يجز منها الصوف ثم ينسجونه ثم يبنون منه بيتاً.
هكذا فسره أبو زيد.
قال: ويقال أبنيت الرجل بيتاً إذا أعطيته ما يبني منه بيتاً.
ومن هذا قولهم: قد بنى فلان بأهله وذلك أن الرجل كان إذا أراد الدخول بأهله بنى بيتاً من أدم أو قبة أو نحو ذلك من غير الحجر والمدر ثم دخل بها فيه فقيل لكل داخل بأهله: هو بان بأهله وقد بنى بأهله.
وابتنى بالمرأة هو افتعل من هذا اللفظ وأصل المعنى منه.
فهذا كله على التشبيه لبيوت الأعراب ببيوت ذوي الأمصار.
ونحو من هذه الاستعارة في هذه الصناعة استعارتهم ذلك في الشرف والمجد قال لبيد: فبنى لنا بيتاً رفيعاً سمكه فسما إليه كهلها وغلامها وقال غيره: بنى البناة لنا مجداً ومأثرة لا كالبناء من الآجر والطين وقال الآخر: لسنا وإن كرمت أوائلنا يوماً على الأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا ومن الضرب الأول قول المولد: وبيت قد بنينا فا رد كالكوكب الفرد بنيناه على أعم دة من قضب الذهب وهذا واسع غير أن الأصل فيه ما قدمناه.
باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح
هذا موضع محوج إلى فضل تأمل غير أن أكثر أهل النظرعلى أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف.
إلا أن أبا علي رحمه الله قال لي يوماً: هي من عند الله واحتج بقوله سبحانه: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا} وهذا لا يتناول موضع الخلاف.
وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله: أقدر آدم على أن واضع عليها وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة.
فإذا كان ذلك محتملاً غير مستنكر سقط الاستدلال به.
وقد كان أبو علي رحمه الله أيضاً قال به في بعض كلامه.
وهذا أيضاً رأي أبي الحسن على أنه لم يمنع قول من قال: إنها تواضع منه.
على أنه قد فسر هذا بأن قيل: إن الله سبحانه علم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات: العربية والفارسية والسريانية والعبرية والرومية وغير ذلك من سائر اللغات فكان آدم وولده يتكلمون بها ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات فغلبت عليه واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم بها.
وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه باعتقاده والانطواء على القول به.
فإن قيل: فاللغة فيها أسماء وأفعال وحروف وليس يجوز أن يكلم المعلم من ذلك الأسماء دون غيرها: مما ليس بأسماء فكيف خص الأسماء وحدها قيل: اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى القبل الثلاثة ولا بد لكل كلام مفيد من الاسم وقد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرف والفعل فلما كانت الأسماء من القوة والأولية في النفس والرتبة على ما لا خفاء به جاز أن يكتفى بها مما هو تال لها ومحمول في الحاجة إليه عليها.
وهذا كقول المخزومي: الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبد أي فإذا كان الله يعلمه فلا أبالي بغيره سبحانه أذكرته واستشهدته أم لم أذكره ولم أستشهده.
ولا يريد بذلك أن هذا أمر خفي فلا يعلمه إلا الله وحده بل إنما يحيل فيه على أمر واضح وحال مشهورة حينئذ متعالمة.
وكذلك قول الآخر: الله يعلم أنا في تلفتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صور وليس بمدع أن هذا باب مستور ولا حديث غير مشهور حتى إنه لا يعرفه أحد إلا الله وحده وإنما العادة في أمثاله عموم معرفة الناس به لفشوه فيهم وكثرة جريانه على ألسنتهم.
فإن قيل: فقد جاء عنهم في كتمان الحب وطيه وستره والبجح بذلك والادعاء له ما لا خفاء قيل: هذا وإن جاء عنهم فإن إظهاره أنسب عندهم وأعذب على مستمعهم ألا ترى أن فيه إيذاناً من صاحبه بعجزه عنه وعن ستر مثله ولو أمكنه إخفاؤه والتحامل به لكان مطيقاً له مقتدراً عليه وليس في هذا من التغزل ما في الاعتراف بالبعل به وخور الطبيعة عن الاستقلال بمثله ألا ترى إلى قول عمر بن أبي ربيعة: فقلت لها: ما بي من ترقب ولكن سري ليس يحمله مثلي وكذلك قول الأعشى: وهل تطيق وداعاً أيها الرجل وكذلك قول الآخر: ودعته بدموعي يوم فارقني ولم أطق جزعاً للبين مد يدي وأمر في هذا أظهر وشواهده أسير وأكثر.
ثم لنعد فلنقل في الاعتلال لمن قال بأن اللغة لا تكون وحياً.
وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة قالوا: وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظاً إذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز من غيره وليغنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله.
بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إدناؤه كالفاني وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد كيف يكون ذلك لو جاز وغير هذا مما هو جار في الاستحالة والبعد مجراه فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم فأومئوا إليه وقالوا: إنسان إنسان إنسان فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا: يد عين رأس قدم أو نحو ذلك.
فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معنيها وهلم جرا فيما سوى هذا من الأسماء والأفعال والحروف.
ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها فتقول: الذي اسمه إنسان فليجعل مكانه مرد والذي اسمه رأس فليجعل مكانه سر وعلى هذا بقية الكلام.
وكذلك لو بدئت اللغة الفارسية فوقعت المواضعة عليها لجاز أن تنقل ويولد منها لغات كثيرة: من الرومية والزنجية وغيرهما.
وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصناع لآلات صنائعهم من الأسماء: كالنجار والصائغ والحائك والبناء وكذلك الملاح.
قالوا: ولكن لا بد لأولها من أن يكون متواضعاً بالمشاهدة والإيماء.
قالوا: والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن يواضع أحداً من عباده على شيء إذ قد ثبت أن المواضعة لا بد معها من إيماء وإشارة بالجارحة نحو المومأ إليه والمشار نحوه والقديم سبحانه لا جارحة له فيصح الإيماء والإشارة بها منه فبطل عنهم أن تصح المواضعة على اللغة منه تقست أسماؤه قالوا: ولكن يجوز أن ينقل الله اللغة التي قد وقع التواضع بين عباده عليها بأن يقول: الذي كنتم تعبرون عنه بكذا عبروا عنه بكذا والذي كنتم تسمونه كذا ينبغي أن تسموه كذا وجواز هذا منه - سبحانه - كجوازه من عباده.
ومن هذا الذي في الأصوات ما يتعاطاه الناس الآن من مخالفة الأشكال في حروف المعجم كالصورة التي توضع للمعميات والتراجم وعلى ذلك أيضاً اختلفت أقلام ذوي اللغات كما اختلفت أنفس الأصوات المرتبة على مذاهبهم في المواضعات.
وهذا قول من الظهور على ما تراه.
إلا أنني سألت يوماً بعض أهله فقلت: ما تنكر أن تصح المواضعة من الله تعالى وإن لم يكن ذا جارحة بأن يحدث في جسم من الأجسام خشبة أو غيرها إقبالاً على شخص من الأشخاص وتحريكاً لها نحوه ويسمع في نفس تحريك الخشبة نحو ذلك الشخص صوتاً يضعه اسماً له ويعيد حركة تلك الخشبة نحو ذلك الشخص دفعات مع أنه - عز اسمه - قادر على أن يقنع في تعريفه ذلك بالمرة الواحدة فتقوم الخشبة في هذا الإيماء وهذه الإشارة مقام جارحة ابن آدم في الإشارة بها في المواضعة وكما أن الإنسان أيضاً قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير بخشبة نحو المراد المتواضع عليه فيقيمها في ذلك مقام يده لو أراد الإيماء بها نحوه فلم يجب عن هذا بأكثر من الاعتراف بوجوبه ولم يخرج من جهته شيء أصلاً فأحكيه عنه وهو عندي وعلى ما تراه الآن لازم لمن قال بامتناع مواضعة القديم تعالى لغة مرتجلة غير ناقلة لساناً إلى لسان.
فاعرف ذلك.
وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك.
ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد.
وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل.
واعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي مختلفة جهات التغول على فكري.
وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما يملك علي جانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر.
فمن ذلك ما نبه عليه أصحابنا رحمهم الله ومنه ما حذوته على أمثلتهم فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وآماده صحة ما وفقوا لتقديمه منه.
ولطف ما أسعدوا به وفرق لهم عنه.
وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند الله عز وجل فقوى في نفسي اعتقاد كونها توفيقاً من الله سبحانه وأنها وحي.
ثم أقول في ضد هذا: كما وقع لأصحابنا ولنا وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا - وإن بعد مداه عنا - من كان ألطف منا أذهاناً وأسرع خواطر وأجرأ جناناً.
فأقف بين تين الخلتين حسيراً وأكاثرهما فأنكفيء مكثوراً.
وإن خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به وبالله التوفيق.
باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية
اعلم أن علل النحويين - وأعني بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفافهم المستضعفين - أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين.
وذلك أنهم إنما يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس وليس كذلك حديث علل الفقه.
وذلك أنها إنما هي أعلام وأمارات لوقوع الأحكام ووجوه الحكمة فيها خفية عنا غير بادية الصفحة لنا ألا ترى أن ترتيب مناسك الحج وفرائض الطهور والصلاة والطلاق وغير ذلك إنما يرجع في وجوبه إلى ورود الأمر بعمله ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة خمساً دون غيرها من العدد ولا يعلم أيضاً حال الحكمة والمصلحة في عدد الركعات ولا في اختلاف ما فيها من التسبيح والتلاوات إلى غير ذلك مما يطول ذكره ولا تحلى النفس بمعرفة السبب الذي كان له ومن أجله وليس كذلك علل النحويين.
وسأذكر طرفاً من ذلك لتصح الحال به.
قال أبو إسحاق في رفع الفاعل ونصب المفعول: إنما فعل ذلك للفرق بينهما ثم سأل نفسه فقال: فإن قيل: فهلا عكست الحال فكانت فرقاً أيضاً قيل: الذي فعلوه أحزم وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد وقد يكون له مفعولات كثيرة فرفع الفاعل لقلته ونصب المفعول لكثرته وذلك ليقل في كلامهم ما يسثقلون ويكثر في كلامهم ما يستخفون.
فجرى ذلك في وجوبه ووضوح أمره مجرىشكر المنعم وذم المسيء في انطواء الأنفس عليه وزوال اختلافها فيه ومجرى وجوب طاعة القديم سبحانه لما يعقبه من إنعامه وغفرانه.
ومن ذلك قولهم: إن ياء نحو ميزان وميعاد انقلبت عن واو ساكنة لثقل الواو الساكنة بعد الكسرة.
وهذا أمر لا لبس في معرفته ولا شك في قوة الكلفة في النطق به.
وكذلك قلب الياء في موسر وموقن واواً لسكونها وانضمام ما قبلها.
ولا توقف في ثقل الياء الساكنة بعد الضمة لأن حالها في ذلك حال الواو الساكنة بعد الكسرة وهذا - كما تراه - أمر يدعو الحس إليه ويحدو طلب الاستخفاف عليه.
وإذا كانت الحال المأخوذ بها المصير بالقياس إليها حسية طبيعية فناهيك بها ولا معدل بك عنها.
ومن ذلك قولهم في سيد وميت وطويت طياً وشويت شياً: إن الواو قلبت ياء لوقوع الياء الساكنة قبلها في سيد وميت ووقوع الواو الساكنة قبل الياء في شيا وطيا.
فهذا أمر هذه سبيله أيضاً ألا ترى إلى ثقل اللفظ بسيود وميوت وطويا وشويا وأن سيدا وميتا وطيا وشيا أخف على ألسنتهم من اجتماع الياء والواو مع سكون الأول منهما.
فإن قلت: فقد جاء عنهم نحو حيوة وضيون وعوى الكلب عوية فسنقول في هذا ونظائره في فإن قلت: فقد نجد أيضاً في علل الفقه ما يضح أمره وتعرف علته نحو رجم الزاني إذا كان محصناً وحده إذا كان غير محصن وذلك لتحصين الفروج وارتفاع الشك في الأولاد والنسل.
وزيد في حد المحصن على غيره لتعاظم جرمه وجريرته على نفسه.
وكذلك إفادة القاتل بمن قتله لحقن الدماء وكذلك إيجاب الله الحج على مستطيعه لما في ذلك من تكليف المشقة ليستحق عليها المثوبة وليكون أيضاً دربة للناس على الطاعة وليشتهر به أيضاً حال الإسلام ويدل به على ثباتها واستمرار العمل بها فيكون أرسخ له وأدعى إلى ضم نشر الدين وفثء كيد المشركين.
وكذلك نظائر هذا كثيرة جداً.
فقد ترى إلى معرفة أسبابه كمعرفة أسباب ما اشتملت عليه علل الإعراب فلم جعلت علل الفقه أخفض رتبة من علل النحو قيل له: ما كانت هذه حاله من علل الفقه فأمر لم يستفد من طريق الفقه ولا يخص حديث الفرض والشرع بل هو قائم في النفوس قبل ورود الشريعة به ألا ترى أن الجاهلية الجهلاء كانت تحصن فروج مفارشها وإذا شك الرجل منهم في بعض ولده لم يلحقه به خلقاً قادت إليه الأنفة والطبيعة ولم يقتضه نص ولا شريعة.
وكذلك قول الله تعالى {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} قد كان هذا من أظهر شيء معهم وأكثره في استعمالهم أعني حفظهم للجار ومدافعتهم عن الذمار فكأن الشريعة إنما وردت فيما هذه حاله بما كان معلوماً معمولاً به حتى إنها لو لم ترد بإيجابه لما أخل ذلك بحاله لاستمرار الكافة على فعاله.
فما هذه صورته من عللهم جار مجرى علل النحويين.
ولكن ليت شعري من أين يعلم وجه المصلحة في جعل الفجر ركعتين والظهر والعصر أربعاً أربعاً والمغرب ثلاثاً والعشاء الآخرة أربعاً ومن أين يعلم علة ترتيب الأذان على ما هو عليه وكيف تعرف علة تنزيل مناسك الحج على صورتها ومطرد العمل بها ونحو هذا كثير جداً.
ولست تجد شيئاً مما علل به القوم وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله والحس منطو على الاعتراف به ألا ترى أن عوارض ما يوجد في هذه اللغة شيء سبق وقت الشرع وفزع إلى التحاكم فيه إلى بديهة الطبع فجميع علل النحو إذاً مواطئة للطباع وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا الانقياد.
فهذا فرق.
سؤال قوي: فإن قلت: فقد نجد في اللغة أشياء كثيرة غير محصاة ولا محصلة لا نعرف لها سبباً ولا نجد إلى الإحاطة بعللها مذهباً.
فمن ذلك إهمال ما أهمل وليس في القياس ما يدعو إلى إهماله وهذا أوسع من أن يحوج إلى ذكر طرف منه ومنه الاقتصار في بعض الأصول على بعض المثل ولا نعلم قياسا يدعو إلى تركه نحو امتناعهم أن يأتوا في الرباعي بمثال فَعلُل أو فُعلِل أو فَعَل أو فِعِل أو فُعُل ونحو ذلك.
وكذلك اقتصارهم في الخماسي على الأمثلة الأربعة دون غيرها مما تجوزه القسمة.
ومنه أن عدلوا فُعَلا عن فاعل في أحرف محفوظة.
وهي ثعل وزحل وغدر وعمر وزفر وجشم وقثم وما يقل تعداده.
ولم يعدلوا في نحو مالك وحاتم وخالد وغير ذلك فيقولوا: مُلك ولا حُتم ولا خُلد.
ولسنا نعرف سبباً أوجب هذا العدل في هذه الأسماء التي أريناكها دون غيرها فإن كنت تعرفه فهاته.
فإن قلت: إن العدل ضرب من التصرف وفيه إخراج للأصل عن بابه إلى الفرع وما كانت هذه حاله أقنع منه البعض ولم يجب أن يشيع في الكل.
قيل: فهبنا سلمنا ذلك لك تسليم نظر فمن لك بالإجابة عن قولنا: فهلا جاء هذا العدل في حاتم ومالك وخالد وصالح ونحوها دون ثاعل وزاحل وغادر وعامر وزافر وجاشم وقاثم ألك ههنا نفق فتسلكه أو مرتفق فتتوركه وهل غير أن تخلد إلى حيرة الإجبال وتخمد نار الفكر حالاً على حال! ولهذا ألف نظير بل ألوف كثيرة ندع الإطالة بأيسر اليسير منها.
وبعد فقد صح ووضح أن الشريعة إنما جاءت من عند الله تعالى ومعلوم أنه سبحانه لا يفعل شيئاً إلا ووجه المصلحة والحكمة قائم فيه وإن خفيت عنا أغراضه ومعانيه وليست كذلك حال هذه اللغة ألا ترى إلى قوة تنازع أهل الشريعة فيها وكثرة الخلاف في مباديها ولا تقطع فيها بيقين ولا من الواضع لها ولا كيف وجه الحكمة في كثير مما أريناه آنفاً من حالها وما هذه سبيله لا يبلغ شأو ما عرف الآمر به - سبحانه وجل جلاله - وشهدت النفوس واطردت المقاييس على أنه أحكم الحاكمين سبحانه.
انقضى السؤال.
قيل: لعمري إن هذه أسئلة تلزم من نصب نفسه لما نصبنا أنفسنا من هذا الموقف له.
وههنا أيضاً من السؤالات أضعاف أضعافه غير أنه لا ينبغي أن يعطى فيها باليد.
بل يجب أن ينعم الفكر فيها ويكاس في الإجابة عنها.
فأول ذلك أنا لسنا ندعي أن علل أهل العربية في سمت العلل الكلامية البتة بل ندعي أنها أقرب إليها من العلل الفقهية وإذا حكمنا بديهة العقل وترافعنا إلى الطبيعة والحس فقد وفينا الصنعة حقها وربأنا بها أفرع مشارفها.
وقد قال سيبويه: وليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً.
وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك فتستضيء به وتستمد التنبه على الأسباب المطلوبات منه.
ونحن نجيب عما مضى ونورد معه وفي أثنائه ما يستعان به ويفزع فيما يدخل من الشبه إليه بمشيئة الله وتوفيقه.
أما إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة فأكثره متروك للاسثتقال وبقيته ملحقة به ومقفاة على إثره.
فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه نحو سص وطس وظث وثظ وضش وشض وهذا حديث واضح لنفور الحس عنه والمشقة على النفس لتكلفه.
وكذلك نحو قج وجق وكق وقك وكج وجك.
وكذلك حروف الحلق: هي من الائتلاف أبعد لتقارب مخارجها عن معظم الحروف أعني حروف الفم.
فإن جمع بين اثنين منها قدم الأقوى على الأضعف نحو أهل وأحد وأخ وعهد وعهر وكذلك متى تقارب الحرفان لم يجمع بينهما إلا بتقديم الأقوى منهما نحو أرل ووتد ووطد.
يدل على أن الراء أقوى من اللام أن القطع عليها أقوى من القطع على اللام.
وكأن ضعف اللام إنما أتاها لما تشربه من الغنة عند الوقوف عليها ولذلك لا تكاد تعتاص اللام وقد ترى إلى كثرة اللثغة في الراء في الكلام وكذلك الطاء والتاء هما أقوى من الدال وذاك لأن جرس الصوت بالتاء والطاء عند الوقوف عليهما أقوى منه وأظهر عند الوقوف على الدال.
وأنا أرى أنهم إنما يقدمون الأقوى من المتقاربين من قبل أن جمع المتقاربين يثقل على النفس فلما اعتزموا النطق بهما قدموا أقواهما لأمرين: أحدهما أن رتبة الأقوى أبدا أسبق وأعلى والآخر أنهم إنما يقدمون الأثقل ويؤخرون الأخف من قبل أن المتكلم في أول نطقه أقوى نفساً وأظهر نشاطاً فقدم أثقل الحرفين وهو على أجمل الحالين كما رفعوا المبتدأ لتقدمه فأعربوه بأثقل الحركات وهي الضمة وكما رفعوا الفاعل لتقدمه ونصبوا المفعول لتأخره فإن هذا أحد ما يحتج به في المبتدأ والفاعل.
فهذا واضح كما تراه.
وأما ما رفض أن يستعمل وليس فيه إلا ما استعمل من أصله فعنه السؤال وبه الاشتغال.
وإن أنصفت نفسك فيما يرد عليك فيه حليت به وأنقت له وإن تحاميت الإنصاف وسلكت سبيل الانحراف فذاك إليك ولكن جنايته عليك.
" جواب قوي ": اعلم أن الجواب عن هذا الباب تابع لما قبله وكالمحمول على حكمه.
وذلك أن الأصول ثلاثة: ثلاثي ورباعي وخماسي.
فأكثرها استعمالاً وأعدلها تركيباً الثلاثي.
وذلك لأنه حرف يبتدأ به وحرف يحشى به وحرف يوقف عليه.
وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه حسب لو كان كذلك لكان الثنائي أكثر منه لأنه أقل حروفاً وليس الأمر كذلك ألا ترى أن جميع ما جاء من ذوات الحرفين جزء لا قدر له فيما جاء من ذوات الثلاثة نحو من وفي وعن وهل وقد وبل وكم ومن وإذ وصه ومه.
ولو شئت لأثبت جميع ذلك في هذه الورقة.
والثلاثي عارياً من الزيادة وملتبساً بها مما يبعد تداركه وتتعب الإحاطة به.
فإذا ثبت ذلك عرفت منه وبه أن ذوات الثلاثة لم تتمكن في الاستعمال لقلة عددها حسب ألا ترى إلى قلة الثنائي وأقل منه ما جاء على حرف واحد كحرف العطف وفائه وهمزة الاستفهام ولام الابتداء والجر والأمر وكاف رأيتك وهاء رأيته.
وجميع ذلك دون باب كم وعن وصه.
فتمكن الثلاثي إنما هو لقلة حروفه لعمري ولشيء آخر وهو حجز الحشو الذي هو عينه بين فائه ولامه وذلك لتباينهما ولتعادي حاليهما ألا ترى أن المبتدأ لا يكون إلا متحركاً وأن الموقوف عليه لا يكون إلا ساكناً فلما تنافرت حالاهما وسطوا العين حاجزاً بينهما لئلا يفجئوا الحس بضد ما كان آخذاً فيه ومنصباً إليه.
فإن قلت: فإن ذلك الحرف الفاصل لما ذكرت بين الأول والآخر - وهو العين - لا يخلو أن يكون ساكناً أو متحركاً.
فإن كان ساكناً فقد فصلت عن حركة الفاء إلى سكونه وهذا هو الذي قدمت ذكر الكراهة له وإن كان متحركاً فقد فصلت عن حركته إلى سكون اللام الموقوف عليها وتلك حال ما قبله في انتفاض حال الأول بما يليه من بعده.
فالجواب أن عين الثلاثي إذا كانت متحركة والفاء قبلها كذلك فتوالت الحركتان حدث هناك لتواليهما ضرب من الملال لهما فاستروح حينئذ إلى السكون فصار ما في الثنائي من سرعة الانتفاض معيفاً مأبياً في الثلاثي خفيفاً مرضياً وأيضاً فإن المتحرك حشوا ليس كالمتحرك أولاً أولا ترى إلى صحة جواز تخفيف الهمزة حشواً وامتناع جواز تخفيفها أولاً وإذا اختلفت أحوال الحروف حسن التأليف وأما إن كانت عين الثلاثي ساكنة فحديثها غير هذا.
وذلك أن العين إذا كانت ساكنة فليس سكونها كسكون اللام.
وسأوضح لك حقيقة ذلك لتعجب من لطف غموضه.
وذلك أن الحرف الساكن ليست حاله إذا أدرجته إلى ما بعده كحاله لو وقفت عليه.
وذلك لأن من الحروف حروفاً إذا وقفت عليها لحقها صويت ما من بعدها فإذا أدرجتها إلى ما بعدها ضعف ذلك الصويت وتضاءل للحس نحو قولك اِح اِص اِث اِف اِخ اِك.
فإذا قلت: يحرد ويصبر ويسلم ويثرد ويفتح ويخرج خفى ذلك الصويت وقل وخف ما كان له من الجرس عند الوقوف عليه.
وقد تقدم سيبويه في هذا المعنى بما هو معلوم واضح.
وسبب ذلك عندي أنك إذا وقفت عليه ولم تتطاول إلى النطق بحرف آخر من بعده تلبثت عليه ولم تسرع الانتقال عنه فقدرت بتلك اللبثة على إتباع ذلك الصوت إياه.
فأما إذا تأهبت للنطق بما بعده وتهيأت له ونشمت فيه فقد حال ذلك بينك وبين الوقفة التي يتمكن فيها من إشباع ذلك الصويت فيستهلك إدراجك إياه طرفاً من الصوت الذي كان الوقف يقره عليه ويسوغك إمدادك إياه به.
ونحو من هذا ما يحكى أن رجلاً من العرب بايع أن يشرب علبة لبن ولا يتنحنح فلما شرب بعضه كده الأمر فقال: كبش أملح.
فقيل له: ما هذا تنحنحت.
فقال: من تنحنح فلا أفلح.
فنطق بالحاءات كلها سواكن غير متحركة ليكون ما يتبعها من ذلك الصويت عوناً له على ما كده وتكاءده.
فإذا ثبت بذلك أن الحرف الساكن حاله في إدراجه مخالفة لحاله في الوقوف عليه ضارع ذلك الساكن المحشو به المتحرك لما ذكرناه من إدراجه لأن أصل الإدراج للمتحرك إذ كانت الحركة سبباً له وعوناً عليه ألا ترى أن حركته تنتقصه ما يتبعه من ذلك الصويت نحو قولك صبر وسلم.
فحركة الحرف تسلبه الصوت الذي يسعفه الوقف به كما أن تأهبك للنطق بما بعده يستهلك بعضه.
فأقوى أحوال ذلك الصويت عندك أن تقف عليه فتقول: اص.
فإن أنت أدرجته انتقصته بعضه فقلت: اصبر فإن أنت حركته اخترمت الصوت البتة وذلك قولك صبر.
فحركة ذلك الحرف تسلبه ذلك الصوت البتة والوقوف عليه يمكنه فيه وإدراج الساكن يبقي عليه بعضه.
فعلمت بذلك مفارقة حال الساكن المحشو به لحال أول الحرف وآخره فصار الساكن المتوسط لما ذكرنا كأنه لا ساكن ولا متحرك وتلك حال تخالف حالي ما قبله وما بعده وهو الغرض الذي أريد منه وجيء به من أجله لأنه لا يبلغ حركة ما قبله فيجفو تتابع المتحركين ولا سكون ما بعده فيفجأ بسكونه المتحرك الذي قبله فينقض عليه جهته وسمته.
فتلك إذاً ثلاث أحوال متعادية لثلاثة أحرف متتالية فكما يحسن تألف الحروف المتفاوتة كذلك يحسن تتابع الأحوال المتغايرة على اعتدال وقرب لا على إيغال في البعد.
لذلك كان مثال فعل أعدل الأبنية حتى كثر وشاع وانتشر.
وذلك أن فتحة الفاء وسكون العين وإسكان اللام أحوال مع اختلافها متقاربة ألا ترى إلى مضارعة الفتحة للسكون في أشياء.
منها أن كل واحد منهما يهرب إليه مما هو أثقل منه نحو قولك في جمع فُعلة وفِعلة: فعلات بضم العين نحو غرفات وفعلات بكسرها نحو كسرات ثم يسثقل توالي الضمتين والكسرتين فيهرب عنهما تارة إلى الفتح فتقول: غرَفات وكسَرات وأخرى إلى السكون فتقول: غُرفات وكِسرات.
أفلا تراهم كيف سووا بين الفتحة والسكون في العدول عن الضمة والكسرة إليهما.
ومنها أنهم يقولون في تكسير ما كان من فعل ساكن العين وهي واو على فعال بقلب الواو ياء نحو: حوض وحياض وثوب وثياب.
فإذا كانت واو واحده متحركة صحت في هذا المثال من التكسير نحو: طويل وطوال.
فإذا كانت العين من الواحد مفتوحة اعتلت في هذا المثال كاعتلال الساكن نحو: جواد وجياد.
فجرت واو جواد مجرى واو ثوب.
فقد ترى إلى مضارعة الساكن للمفتوح.
وإذا كان الساكن من حيث أرينا كالمفتوح كان بالمسكن أشبه.
فلذلك كان مثال فعل أخف وأكثر من غيره لأنه إذا كان مع تقارب أحواله مختلفها كان أمثل من التقارب بغير خلاف أو الاتفاق البتة والاشتباه.
ومما يدلك على أن الساكن إذا أدرج ليست له حال الموقوف عليه أنك قد تجمع في الوقف بين الساكنين نحو: بكر وعمرو فلو كانت حال سكون كاف بكر كحال سكون رائه لما جاز أن تجمع بينهما من حيث كان الوقف للسكون على الكاف كحاله لو لم يكن بعده شيء.
فكان يلزمك حينئذ أن تبتديء بالراء ساكنة والابتداء بالساكن ليس في هذه اللغة العربية.
لا بل دل ذلك على أن كاف بكر لم تتمكن في السكون تمكن ما يوقف عليه ولا يتطاول إلى ما وراءه.
ويزيد في بيان ذلك أنك تقول في الوقف النفس فتجد السين أتم صوتاً من الفاء فإن قلبت فقلت: النسف وجدت الفاء أتم صوتاً وليس هنا أمر يصرف هذا إليه ولا يجوز حمله عليه إلا زيادة الصوت عند الوقوف على الحرف البتة.
وهذا برهان ملحق بالهندسي في الوضوح والبيان.
فقد وضح إذاً بما أوردناه وجه خفة الثلاثي من الكلام وإذا كان كذلك فذوات الأربعة مستثقلة غير متمكنة تمكن الثلاثي لأنه إذا كان الثلاثي أخف وأمكن من الثنائي - على قلة حروفه - فلا محالة أنه أخف وأمكن من الرباعي لكثرة حروفه.
ثم لا شك فيما بعد في ثقل الخماسي وقوة الكلفة به.
فإذا كان كذلك ثقل عليهم مع تناهيه وطوله أن يستعملوا في الأصل الواحد جميع ما ينقسم إليه به جهات تركيبه.
ذلك أن الثلاثي يتركب منه ستة أصول نحو: جعل جلع عجل علج لجع لعج.
والرباعي يتركب منه أربعة وعشرون أصلاً وذلك أنك تضرب الأربعة في التراكيب التي خرجت عن الثلاثي وهي ستة فيكون ذلك أربعة وعشرين تركيباً المستعمل منها قليل وهي: عقرب وبرقع وعرقب وعبقر وإن جاء منه غير هذه الأحرف فعسى أن يكون ذلك والباقي كله مهمل.
وإذا كان الرباعي مع قربه من الثلاثي إنما استعمل منه الأقل النزر فما ظنك بالخماسي على طوله وتقاصر الفعل الذي هو مئنة من التصريف والتنقل عنه.
فلذلك قل الخماسي أصلاً.
نعم ثم لا تجد أصلاً مما ركب منه قد تصرف فيه بتغيير نظمه ونضده كما تصرف في باب عقرب وبِرقِع وبُرقُع ألا ترى أنك لا تجد شيئاً من نحو سفرجل قالوا فيه سرفجل ولا نحو ذلك مع أن تقليبه يبلغ به مائة وعشرين أصلاً ثم لم يستعمل من جميع ذلك إلا سفرجل وحده.
فأما قول بعضهم زبردج فقلب لحق الكلمة ضرورة في بعض الشعر ولا يقاس.
فدل ذلك على استكراههم ذوات الخمسة لإفراط طولها فأوجبت الحال الإقلال منها وقبض اللسان عن النطق بها إلا فيما قل ونزر ولما كانت ذوات الأربعة تليها وتتجاوز أعدل الأصول - وهو الثلاثي - إليها مسها بقرباها منها قلة التصرف فيها غير أنها في ذلك أحسن حالاً من ذوات الخمسة لأنها أدنى إلى الثلاثة منها.
فكان التصرف فيها دون تصرف الثلاثي وفوق تصرف الخماسي.
ثم إنهم لما أمسوا الرباعي طرفاً صالحاً من إهمال أصوله وإعدام حال التمكن في تصرفه تخطوا بذلك إلى إهمال بعض الثلاثي لا من أجل إجفاء تركبه بتقاربه نحو سص وصس ولكن من قبل أنهم حذوه على الرباعي كما حذوا الرباعي على الخماسي ألا ترى أن لجع لم يترك استعماله لثقله من حيث كانت اللام أخت الراء والنون وقد قالوا نجع فيه ورجع عنه واللام أخت الحرفين وقد أهملت في باب اللجع فدل على أن ذلك ليس للاستثقال وثبت أنه لما ذكرناه من إخلالهم ببعض أصول الثلاثي لئلا يخلو هذا الأصل من ضرب من الإجماد له مع شياعه واطراده في الأصلين اللذين فوقه كما أنهم لم يخلو ذوات الخمسة من بعض التصرف فيها وذلك ما استعملوه من تحقيرها وتكسيرها وترخيمها نحو قولك في تحقير سفرجل: سفيرج وفي تكسيره: سفارج وفي ترخيمه - علما - يا سفرج أقبل وكما أنهم لما أعربوا المضارع لشبهه باسم الفاعل تخطوا ذاك أيضاً إلى أن شبهوا الماضي بالمضارع فبنوه على الحركة لتكون له مزية على ما لا نسبة بينه وبين المضارع أعني مثال أمر المواجه.
فاسم الفاعل في هذه القضية كالخماسي والمضارع كالرباعي والماضي كالثلاثي.
وكذلك أيضاً الحرف في استحقاقه البناء كالخماسي في استكرارهم إياه والمضمر في إلحاقهم إياه ببنائه كالرباعي في إقلالهم تصرفه والمنادي المفرد المعرفة في إلحاقه في البناء بالمضمر كالثلاثي في منع بعضه التصرف وإهماله البتة ولهذا التنزيل نظائر كثيرة.
فأما قوله: مال إلى أرطاة حقف فالطجع فإنه ليس بأصل إنما أبدلت الضاد من اضطجع لاماً فاعرفه.
فقد عرفت إذاً أن ما أهمل من الثلاثي لغير قبح التأليف نحو ضث وثض وثذ وذث إنما هو لأن محله من الرباعي محل الرباعي من الخماسي فأتاه ذلك القدر من الجمود من حيث ذكرنا كما أتى الخماسي ما فيه من التصرف في التكسير والتحقير والترخيم من حيث كان محله من الرباعي محل الرباعي من الثلاثي.
وهذا عادة للعرب مألوفة وسنة مسلوكة: إذا أعطوا شيئاً من شيء حكماً ما قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكماً من أحكام صاحبه عمارة لبينهما وتتميماً للشبه الجامع لهما.
وعليه باب ما لا ينصرف ألا تراهم لما شبهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوه كذلك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه.
وإذ قد ثبت ما أردناه: من أن الثلاثي في الإهمال محمول على حكم الرباعي فيه لقربه من الخماسي بقي علينا أن نورد العلة التي لها استعمل بعض الأصول من الثلاثي والرباعي والخماسي دون بعض وقد كانت الحال في الجميع متساوية.
والجواب عنه ما أذكره.
اعلم أن واضع اللغة لما أراد صوغها وترتيب أحوالها هجم بفكره على جميعها ورأى بعين تصوره وجوه جملها وتفاصيلها وعلم أنه لا بد من رفض ما شنع تألفه منها نحو هع وقج وكق فنفاه عن نفسه ولم يمرره بشيء من لفظه وعلم أيضاً أن ما طال وأمل بكثرة حروفه لا يمكن فيه من التصرف ما أمكن في أعدل الأصول وأخفها وهو الثلاثي.
وذلك أن التصرف في الأصل وإن دعا إليه قياس - وهو الاتساع به في الأسماء والأفعال والحروف - فإن هناك من وجه آخر ناهياً عنه وموحشاً منه وهو أن في نقل الأصل إلى أصل آخر نحو صبر وبصر وصرب وربص صورة الإعلال نحو قولهم " ما أطيبه وأيطبه " " واضمحل وامضحل " " وقسي وأينق " وقوله: مروان مروان أخو اليوم اليمى وهذا كله إعلال لهذه الكلم وما جرى مجراها.
فلما كان انتقالهم من أصل إلى أصل نحو صبر وبصر مشابهاً للإعلال من حيث ذكرنا كان من هذا الوجه كالعاذر لهم في الامتناع من استيفاء جميع ما تحتمله قسمة التركيب في الأصول.
فلما كان الأمر كذلك واقتضت الصورة رفض البعض واستعمال البعض وكانت الأصول ومواد الكلم معرضة لهم وعارضة أنفسها على تخيرهم جرت لذلك عندهم مجرى مال ملقى بين يدي صاحبه وقد أجمع إنفاق بعضه دون بعضه فميز رديئه وزائفه فنفاه البتة كما نفوا عنهم تركيب ما قبح تأليفه ثم ضرب بيده إلى ما أطف له من عرض جيدة فتناوله للحاجة إليه وترك البعض لأنه لم يرد استيعاب جميع ما بين يديه منه لما قدمنا ذكره وهو يرى أنه لو أخذ ما ترك مكان أخذ ما أخذ لأغنى عن صاحبه ولأدى في الحاجة إليه تأديته ألا ترى أنهم لو استعملوا لجع مكان نجع لقام مقامه وأغنى مغناه.
ثم لا أدفع أيضاً أن تكون في بعض ذلك أغراض لهم عدلوا إليه لها ومن أجلها فإن كثيراً من هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها ألا تراهم قالوا قضم في اليابس وخضم في الرطب ذلك لقوة القاف وضعف الخاء فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى والصوت الأضعف للقعل الأضعف.
وكذلك قالوا: صر الجندب فكرروا الراء لما هناك من استطالة صوته وقالوا: صرصر البازي فقطعوه لما هناك من تقطيع صوته وسموا الغراب غاق حكاية لصوته والبط بطاً حكاية لأصواتها وقالوا " قط الشيء " إذا قطعه عرضاً " وقده " إذا قطعه طولاً وذلك لأن منقطع الطاء أقصر مدة من منقطع الدال.
وكذلك قالوا " مد الحبل " " ومت إليه بقرابة " فجعلوا الدال - لأنها مهجورة - لما فيه علاج وجعلوا التاء - لأنها مهموسة - لما لا علاج فيه وقالوا: الخذأ - بالهمزة - في ضعف النفس والخذا - غير مهموز - في استرخاء الأذن يقال: أذن خذواء وآذان خذو ومعلوم أن الواو لا تبلغ قوة الهمزة.
فجعلوا الواو - لضعفها - للعيب في الأذن والهمزة - لقوتها - للعيب في النفس من حيث كان عيب النفس أفحش من عيب الأذن.
وسنستقصي هذا الموضع - فإنه عظيم شريف - في باب نفرده به.
نعم وقد يمكن أن تكون أسباب التسمية تخفى علينا لبعدها في الزمان عنا ألا ترى إلى قول سيبويه: " أو لعل الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر " يعني أن يكون الأول الحاضر شاهد الحال فعرف السبب الذي له ومن أجله ما وقعت عليه التسمية والآخر - لبعده عن الحال - لم يعرف السبب للتسمية ألا ترى إلى قولهم للإنسان إذا رفع صوته: قد رفع عقيرته فلو ذهبت تشتق هذا بأن تجمع بين معنى الصوت وبين معنى " ع ق ر " لبعد عنك وتعسفت.
وأصله أن رجلاً قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها الأخرى ثم صرخ بأرفع صوته فقال الناس: رفع عقيرته.
وهذا مما ألزمه أبو بكر أبا إسحاق فقبله منه ولم يردده.
والكلام هنا أطول من هذا لكن هذا مقاده فأعلق يدك بما ذكرناه: من أن سبب إهمال ما أهمل إنما هو لضرب من ضروب الاستخفاف لكن كيف ومن أين فقد تراه على ما أوضحناه.
فهذا الجواب عن إهمالهم ما أهملوه من محتمل القسمة لوجوه التراكيب فاعرفه ولا تستطله فإن هذا الكتاب ليس مبنياً على حديث وجوه الإعراب وإنما هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام وكيف بديء وإلام نحي.
وهو كتاب يتساهم ذوو النظر: من المتكلمين والفقهاء والمتفلسفين والنحاة والكتاب والمتأدبين التأمل له والبحث عن مستودعه فقد وجب أن يخاطب كل إنسان منهم بما يعتاده ويأنس به ليكون له سهم منه وحصة فيه! وأما ما أورده السائل في أول هذا السؤال الذي نحن منه على سمت الجواب من علة امتناعهم من تحميل الأصل الذي استعلموا بعض مثله ورفضهم بعضاً نحو امتناعهم أن يأتوا في الرباعي بمثال فَعلُل وفَعلِل وفُعلَل - في غير قول أبي الحسن - فجوابه نحو من الذي قدمناه: من تحاميهم فيه الاستثقال وذلك أنهم كما حموا أنفسهم من استيعاب جميع ما تحتمله قسمة تراكيب الأصول من حيث قدمنا وأرينا كذلك أيضاً توقفوا عن استيفاء جميع تراكيب الأصول من حيث كان انتقالك في الأصل الواحد رباعياً كان أو خماسياً من مثال إلى مثال في النقص والاختلال كانتقالك في المادة الواحدة من تركيب إلى تركيب أعني به حال التقديم والتأخير لكن الثلاثي جاء فيه لخفته جميع ما تحتمله القسمة وهي الاثنا عشر مثالاً إلا مثالاً واحداً فإنه رفض أيضاً لما نحن عليه من حديث الاستثقال وهو فِعُل وذلك لخروجهم فيه من كسر إلى ضم.
وكذلك ما امتنعوا من بنائه في الرباعي - وهو فِعلُل - هو لاستكراههم الخروج من كسر إلى ضم وإن كان بينهما حاجز لأنه ساكن فضعف لسكونه عن الاعتداد به حاجزاً على أن بعضهم حكى زئبر وضئبل وخرفع وحكيت عن بعض البصريين " إصبع " وهذه ألفاظ شاذة لا تعقد باباً ولا يتخذ مثلها قياساً.
وحكى بعض الكوفيين ما رأيته مذست وهذا أسهل - وإن كان لا حاجز بين الكسر والضم - من حيث كانت الضمة غير لازمة لأن الوقف يستهلكها ولأنها أيضاً من الشذوذ بحيث لا يعقد عليها باب.
فإن قلت: فما بالهم كثر عنهم باب فُعُل نحو عنق وطنب وقل عنهم باب فِعِل نحو إبل وإطل مع أن الضمة أثقل من الكسرة فالجواب عنه من موضعين: أحدهما أن سيبويه قال: " واعلم أنه قد يقل الشيء في كلامهم وغيره أثقل منه كل ذلك لئلا يكثر في كلامهم ما يستثقلون " فهذا قول والآخر أن الضمة وإن كانت أثقل من الكسرة فإنها أقوى منها وقد يحتمل للقوة ما لا يحتمل للضعف ألا ترى إلى احتمال الهمزة مع ثقلها للحركات وعجز الألف عن احتمالهن وإن كانت خفيفة لضعفها وقوة الهمزة.
وإنما ضعفت الكسرة عن الضمة لقرب الياء من الألف وبعد الواو عنها.
ومن حديث الاستثقال والاستخفاف أنك لا تجد في الثنائي - على قلة حروفه - ما أوله مضموم إلا القليل وإنما عامته على الفتح نحو هل وبل وقد وأن وعن وكم ومن وفي المعتل أو ولو وكي وأي أو على الكسر نحو إن ومن وإذ.
وفي المعتل إي وفي وهي.
ولا يعرف الضم في هذا النحو إلا قليلاً قالوا: هو وأما هم فمحذوفة من همو كما أن مذ محذوفة من منذ.
وأما هو من نحو قولك: رأيتهو وكلمتهو فليس شيئاً لأن هذه ضمة مشبعة في الوصل ألا تراها يستهلكها الوقف وواو هو في الضمير المنفصل ثابتة في الوقف والوصل.
فأما قوله: فبيناه يشري رحله قال قائل: لمن جمل رِخو الملاط نجيب فللضرورة والتشبيه للضمير المنفصل بالضمير المتصل في عصاه وقناه.
فإن قلت: فقد قال: أعني على برق أريك وميضهو فوقف بالواو وليست اللفظة قافية وقد قدمت أن هذه المدة مستهلكة في حال الوقف قيل: هذه اللفظة وإن لم تكن قافية فيكون البيت بها مقفى أو مصرعاً فإن العرب قد تقف على العروض نحواً من وقوفها على الضرب أعني مخالفة ذلك لوقف الكلام المنثور غير الموزون ألا ترى إلى قوله أيضاً: فأضحى يسح الماء حول كتيفتن فوقف بالتنوين خلافاً على الوقف في غير الشعر.
فإن قلت: فأقصى حال قومه " كتيفتن " - إذ ليست قافية - أن تجري مجرى القافية في الوقف عليها وأنت ترى الرواة أكثرهم على إطلاق هذه القصيدة ونحوها بحرف اللين للوصل نحو قوله: ومنزلي وحوملي وشمألي ومحملي فقوله " كتيفتن " ليس على وقف الكلام ولا وقف القافية قيل: الأمر على ما ذكرت من خلافه له غير أن هذا أيضاً أمر يخص المنظوم دون المنثور لاستمرار ذلك عنهم ألا ترى إلى قوله: أني اهتديت لتسليم على دِمنن بالغمز غيرهن الأعصر الأولو وقوله: كأن حدوج المالكية غُدوتن خلايا سفين بالنواصف من دَدي وقوله: وقوله: فوالله لا أنسى قتيلاً رزئتهو بجانب قوسي ما مشيت على الأرضي وفيها: ولم أدر من ألقى عليه رداءهو على أنه قد سل عن ماجد محضي وأمثاله كثير.
كل ذلك الوقوف على عروضه مخالف للوقوف على ضربه ومخالف أيضاً لوقوف الكلام غير الشعر.
ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الموضع في علم القوافي.
وقد كان يجب أن يذكر ولا يهمل.
" رجع " وكذلك جميع ما جاء من الكلم على حرف واحد: عامته على الفتح إلا الأقل وذلك نحو همزة الاستفهام وواو العطف وفائه ولام الابتداء وكاف التشبيه وغير ذلك.
وقليل منه مكسور كباء الإضافة ولامها ولام الأمر ولو عرى ذلك من المعنى الذي اضطره إلى الكسر لما كان مفتوحاً ولا نجد في الحروف المنفردة ذوات المعاني ما جاء مضموماً هرباً من ثقل الضمة.
فأما نحو قولك: اقتل ادخل استقصي عليه فأمره غير معتد إذ كانت هذه الهمزة إنما يتبلغ بها في حال الابتداء ثم يسقطها الإدراج الذي عليه مدار الكلام ومتصرفه.
فإن قلت: ومن أين يعلم أن العرب قد راعت هذا الأمر واستشفته وعنيت بأحواله وتتبعته حتى تحامت هذه المواضع التحامي الذي نسبته إليها وزعمته مراداً لها وما أنكرت أن يكون القوم أجفى طباعاً وأيبس طيناً من أن يصلوا من النظر إلى هذا القدر اللطيف الدقيق الذي لا يصح لذي الرقة والدقة منا أن يتصوره إلا بعد أن توضح له أنحاؤه بل أن تشرح له أعضاؤه قيل له: هيهات! ما أبعدك عن تصور أحوالهم وبعد أغراضهم ولطف أسرارهم حتى كأنك لم ترهم وقد ضايقوا أنفسهم وخففوا عن ألسنتهم بأن اختلسوا الحركات اختلاساً وأخفوها فلم يمكنوها في أماكن كثيرة ولم يشبعوها ألا ترى إلى قراءة أبي عمرو {مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ} مختلساً لا محققاً وكذلك قوله عز وجل: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى} مخفي لا مستوفي وكذلك قوله عز وجل: {فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ} مختلساً غير ممكن كسر الهمزة حتى دعا ذلك من لطف عليه تحصيل اللفظ إلى أن ادعى أن أبا عمرو كان يسكن الهمزة والذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لاحذفها البتة وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكناً.
ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة لكن أتوا من ضعف دراية.
وأبلغ من هذا في المعنى ما رواه من قول الراجز: متى أنام لا يؤرقني الكرى ليلاً ولا أسمع أجراس المطى بإشمام القاف من يؤرقني ومعلوم أن هذا الإشمام إنما هو للعين لا للأذن وليست هناك حركة البتة ولو كانت فيه حركة لكسرت الوزن ألا ترى أن الوزن من الرجز ولو اعتدت القاف متحركة لصار من الكامل.
فإذا قنعوا من الحركة بأن يومئوا إليها بالآلة التي من عاداتها أن تستعمل في النطق بها من غير أن يخرجوا إلى حس السمع شيئاً من الحركة مشبعة ولا مختلسة أعني إعمالهم الشفتين للإشمام في المرفوع بغير صوت يسمع هناك لم يبق وراء ذلك شيء يستدل به على عنايتهم بهذا الأمر ألا ترى إلى مصارفتهم أنفسهم في الحركة على قلتها ولطفها حتى يخرجوها تارة مختلسة غير مشبعة وأخرى مشمة للعين لا للأذن.
ومما أسكنوا فيه الحرف إسكاناً صريحاً ما أنشده من قوله: رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر بسكون النون البتة من " هنك ".
وأنشدنا أبو علي رحمه الله لجرير: سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ونهر تيرى فلا تعرفكم العرب بسكون فاء تعرفكم أنشدنا هذا بالموصل سنة إحدى وأربعين وقد سئل عن قول الشاعر: فلما تبين غب أمري وأمره وولت بأعجاز الأمور صدور وقال الراعي: وعلى هذا حملوا بيت لبيد: تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها وبيت الكتاب: فاليوم أشرب غير مستحقب إثماً من الله ولا واغل وعليه ما أنشده من قوله: إذا اعوججن قلت صاحب قوم واعتراض أبي العباس في هذا الموضع ي هذا الموضع إنما هو رد للرواية وتحكم على السماع بالشهوة مجردة من النصفة ونفسه ظلم لا من جعله خصمه.
وهذا واضح.
ومنه إسكانهم نحو رسل وعجز وعضد وظرف وكرم وعلم وكتف وكبد وعصر.
واستمرار ذلك في المضموم والمكسور دون المفتوح أدل دليل - بفصلهم بين الفتحة وأختيها - على ذوقهم الحركات واستثقالهم بعضها واستخفافهم الآخر.
فهل هذا ونحو إلا لإنعامهم النظر في هذا القدر اليسير المحتقر من الأصوات فكيف بما فوقه من الحروف التوام بل الكلمة من جملة الكلام.
وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد القرميسيني عن أبي بكر محمد بن هارون الروياني عن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني في كتابه الكبير في القراءات قال: قرأ علي أعرابي بالحرم: " طيبى لهم وحسن مآب " فقلت: طوبى فقال: طيبى فأعدت فقلت: طوبى فقال: طيبى فلما طال علي قلت: طوطو قال: طي طي.
أفلا ترى إلى هذا الأعرابي وأنت تعتقده جافياً كراً لا دمثاً ولا طيعاً كيف نبا طبعه عن ثقل الواو إلى الياء فلم يؤثر فيه التلقين ولا ثنى طبعه عن التماس الخفة هز ولا تمرين وما ظنك به إذا خلي مع سومه وتساند إلى سليقيته ونجره.
وسألت يوماً أبا عبد الله محمد بن العساف العقيلي الجوثي التميمي - تميم جوثة - فقلت له: كيف تقول: ضربت أخوك فقال أقول: ضربت أخاك.
فأدرته على الرفع فأبى وقال: لا أقول: أخوك أبداً.
قلت: فكيف تقول ضربني أخوك فرفع.
فقلت: ألست زعمت أنك لا تقول: أخوك أبداً فقال: أيش هذا! اختلفت جهتا الكلام.
فهل هذا إلا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام وإعطائهم إياه في كل موضع حقه وحصته من الإعراب عن ميزة وعلى بصيرة وأنه ليس استرسالاً ولا ترجيماً.
ولو كان كما توهمه هذا السائل لكثر اختلافه وانتشرت جهاته ولم تنقد مقاييسه.
وهذا موضع نفرد له باباً بإذن الله تعالى فيما بعد.
وإنما أزيد في إيضاح هذه الفصول من هذا الكتاب لأنه موضع الغرض: فيه تقرير الأصول وإحكام معاقدها والتنبيه على شرف هذه اللغة وسداد مصادرها ومواردها وبه وبأمثاله تخرج أضغانها وتبعج أحضانها ولا سيما هذا السمت الذي نحن عليه ومرزون إليه فاعرفه فإن أحداً لم يتكلف الكلام على علة إهمال ما أهمل واستعمال ما استعمل.
وجماع أمر القول فيه والاستعانة على إصابة غروره ومطاويه لزومك محجة القول بالاستثقال والاستخفاف ولكن كيف وعلام ومن أين فإنه باب يحتاج منك إلى تأن وفضل بيان وتأت.
وقد دققت لك بابه بل خرقت بك حجابه.
ولا تستطل كلامي في هذا الفصل أو ترين أن المقنع فيه كان دون هذا القدر فإنك إذا راجعته وأنعمت تأمله علمت أنه منبهة للحس مشجعة للنفس.
وأما السؤال عن علة عدل عامر وجاشم وثاعل وتلك الأسماء المحفوظة إلى فُعل: عمر وجشم وثعل وزحل وغدر دون أن يكون هذا العدل في مالك وحاتم وخالد نحو ذلك فقد تقدم الجواب عنه فيما فرط: أنهم لم يخصوا ما هذه سبيله بالحكم دون غيره إلا لاعتراضهم طرفاً مما أطف لهم من جملة لغتهم كما عن وعلى ما اتجه لا لأمر خص هذا دون غيره مما هذه سبيله وعلى هذه الطريقة ينبغي أن يكون العمل فيما يرد عليك من السؤال عما هذه حاله ولكن لا ينبغي أن تخلد إليها إلا بعد السبر والتأمل والإنعام والتصفح فإن وجدت غدراً مقطوعاً به صرت إليه واعتمدته وإن تعذر ذلك جنحت إلى طريق الاستخفاف والاستثقال فإنك لا تعدم هناك مذهباً تسلكه ومأماً تتورده.
فقد أريتك في ذلك أشياء: أحدها استثقالهم الحركة التي هي أقل من الحرف حتى أفضوا في ذلك إلى أن أضعفوها واختلسوها ثم تجاوزوا ذلك إلى أن انتهكوا حرمتها فحذفوها ثم ميلوا بين الحركات فأنحو على الضمة والكسرة لثقلهما وأجموا الفتحة في غالب الأمر لخفتها فهل هذا إلا لقوة نظرهم ولطف استشفافهم وتصفحهم.
أنشدنا مرة أبو عبد الله الشجري شعراً لنفسه فيه بنو عوف فقال له بعض الحاضرين: أتقول: بنو عوف أم بني عوف شكاً من السائل في بني وبنو فلم يفهم الشجري ما أراده وكان في ثنايا السائل فضل فرق فأشبع الصويت الذي يتبع الفاء في الوقف فقال الشجري مستنكراً لذلك: لا أقوى في الكلام على هذا النفخ.
وسألت غلاماً من آل المهيا فصيحاً عن لفظة من كلامه لا يحضرني الآن ذكرها فقلت: أكذا أم كذا فقال: " كذا بالنصب لأنه أخف " فجنح إلى الخفة وعجبت من هذا مع ذكره النصب بهذا اللفظ.
وأظنه استعمل هذه اللفظة لأنها مذكورة عندهم في الإنشاد الذي يقال له النصب مما يتغنى به الركبان.
وسنذكر فيما بعد باباً نفصل فيه بين ما يجوز السؤال عنه مما لا يجوز ذلك فيه بإذن الله.
ومما يدلك على لطف القوم ورقتهم مع تبذلهم وبذاذة ظواهرهم مدحهم بالسباطة والرشاقة فتى قد السيف لا متآزف ولا رهل لباته وبآدله وقول جميل في خبر له: وقد رابني من جعفر أن جعفراً يبث هوى ليلى ويشكو هوى جمل فلو كنت عذري الصبابة لم تكن بطيناً وأنساك الهوى كثرة الأكل وقول عمر: قليلاً على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر وإلى الأبيات المحفوظة في ذلك وهي قوله: ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل وأظن هذا الموضع لو جمع لجاء مجلداً عظيماً.
وحدثني أبو الحسن علي بن عمرو عقيب منصرفه من مصر هارباً متعسفاً قال: أذم لنا غلام - أحسبه قال من طيء - من بادية الشام وكان نجيباً متيقظاً يكنى أبا الحسين ويخاطب بالأمير فبعدنا عن الماء في بعض الوقت فأضر ذلك بنا قال فقال لنا ذلك الغلام: على رسلكم فإني أشم رائحة الماء.
فأوقفنا بحيث كنا وأجرى فرسه فتشرف ههنا مستشفاً ثم عدل عن ذلك الموضع إلى آخر مستروحاً للماء ففعل ذلك دفعات ثم غاب عنا شيئاً وعاد إلينا فقال: النجاة والغنيمة سيروا على اسم الله تعالى فسرنا معه قدراً من الأرض صالحاً فأشرف بنا على بئر فاستقينا وأروينا.
ويكفي من ذلك ما حكاه من قول بعضهم لصاحبه: ألا تا فيقول الآخر مجيباً له: بلى فا وقول الآخر: قلنا لها قفي لنا قالت قاف ثم تجاوزوا ذلك إلى أن قالوا: " رب إشارة أبلغ من عبارة " نعم وقد يحذفون بعض الكلم استخفافاً حذفاً يخل بالبقية ويعرض لها الشبه ألا ترى إلى قول علقمة: كأن إبريقهم ظبي على شرف مفدم بسبا الكتان ملثوم أراد: بسبائب.
وقول لبيد: درس المنا بمتالع فأبان أراد المنازل.
وقول الآخر: حين ألقت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل يريد عبد الأشهل من الأنصار وقول أبي داود: يذرين جندل حائر لجنوبها فكأنما تذكى سنابكها الحبا أي تصيب بالحصى في جريها جنوبها وأراد الحباحب وقال الأخطل: قالوا: يريد منازلها ويجوز أن يكون مناها قصدها.
ودع هذا كله ألم تسمع إلى ما جاءوا به من الأسماء المستفهم بها والأسماء المشروط بها كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الأبعاد والطول فمن ذلك قولك: كم مالك ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك: أعشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون أم مائة أم ألف فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبداً لأنه غير متناه فلما قلت: " كم " أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها ولا المستدركة.
وكذلك أين بيتك قد أغنتك " أين " عن ذكر الأماكن كلها.
وكذلك من عندك قد أغناك هذا عن ذكر الناس كلهم.
وكذلك متى تقوم قد غنيت بذلك عن ذكر الأزمنة على بعدها.
وعلى هذا بقية الأسماء من نحو: كيف وأي وأيان وأنى.
وكذلك الشرط في قولك: من يقم أقم معه فقد كفاك ذلك من ذكر جميع الناس ولولا هو لاحتجت أن تقول: إن يقم زيد أو عمرو أو جعفر أو قاسم ونحو ذلك ثم تقف حسيراً مبهوراً ولما تجد إلى غرضك سبيلاً.
وكذلك بقية أسماء العموم في غير الإيجاب: نحو أحد وديار وكتيع وأرم وبقية الباب.
فإذا قلت: هل عندك أحد أغناك ذلك عن أن تقول: هل عندك زيد أو عمرو أو جعفر أو سعيد أو صالح فتطيل ثم تقصر إقصار المعترف الكليل وهذا وغيره أظهر أمراً وأبدى صفحة وعنواناً.
فجميع ما مضى وما نحن بسبيله مما أحضرناه أو نبهنا عليه فتركناه شاهد بإيثار القوم قوة إيجازهم وحذف فضول كلامهم.
هذا مع أنهم في بعض الأحوال قد يمكنون ويحتاطون وينحطون في الشق الذي يؤمون وذلك في التوكيد نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون وقد قال جرير: تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا فزاد الزاد في آخر البيت توكيداً لا غير.
وقيل لأبي عمرو: أكانت العرب تطيل فقال: نعم لتبلغ.
قيل: أفكانت توجز قال: نعم ليحفظ عنها.
واعلم أن العرب - مع ما ذكرنا - إلى الإيجاز أميل وعن الإكثار أبعد.
ألا ترى أنها في حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها ودالة على أنها إنما تجشمتها لما عناها هناك وأهمها فجعلوا ما في ذلك على العلم بقوة الكلفة فيه دليلاً على إحكام الأمر فيما هم عليه.
ووجه ما ذكرناه من ملالتها الإطالة - مع مجيئها بها للضرورة الداعية إليها - أنهم لما أكدوا فقالوا: أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون لم يعيدوا أجمعون البتة فيكرروها فيقولوا: أجمعون أجمعون أجمعون أجمعون فعدلوا عن إعادة جميع الحروف إلى البعض تحامياً - فإن قيل: فلم اقتصروا على إعادة العين وحدها دون سائر حروف الكلمة قيل: لأنها أقوى في السجعة من الحرفين اللذين قبلها وذلك أنها لام فهي قافية لأنها آخر حروف الأصل فجيء بها لأنها مقطع الأصول والعمل في المبالغة والتكرير إنما هو على المقطع لا على المبدأ ولا المحشى.
ألا ترى أن العناية في الشعر إنما هي بالقوافي لأنها المقاطع وفي السجع كمثل ذلك.
نعم وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أولها والعناية بها أمس والحشد عليها أوفى وأهم.
وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه.
ألا تعلم كيف استجاوزا الجمع بين الياء والواو ردفين نحو: سعيد وعمود.
وكيف استكرهوا اجتماعهما وصلين نحو قوله: " الغراب الأسودو " مع قوله أو " مغتدى " وقوله في " غدى " وبقية قوافيها وعلة جواز اختلاف الردف وقبح اختلاف الوصل هو حديث التقدم والتأخر لا غير.
وقد أحكمنا هذا الموضع في كتابنا المعرب - وهو تفسير قوافي أبي الحسن - بما أغنى عن إعادته هنا.
فلذلك جاءوا لما كرهوا إعادة جميع حروف أجمعين بقافيتها وهي العين لأنها أشهر حروفها إذ كانت مقطعاً لها.
فأما الواو والنون فزائدتان لا يعتدان لحذفهما في أجمع وجمع وأيضاً فلأن الواو قد تترك فيه إلى الياء نحو أجمعون وأجمعين.
وأيضاً لثبات النون فإن قلت: إن هذه النون إنما تحذف مع الإضافة وهذه الأسماء التوابع نحو " أجمعين وبابه " مما لم تسمع إضافته فالنون فيها ثابتة على كل حال فهلا اقتصر عليها وقفيت الكلم كلها بها.
قيل: إنها وإن لم يضف هذا الضرب من الأسماء فإن إضافة هذا القبيل من الكلم في غير هذا الموضع مطردة منقادة نحو: مسلموك وضاربو زيد وشاتمو جعفر فلما كان الأكثر فيما جمع بالواو والنون إنما هو جواز إضافته حمل الأقل في ذلك عليه وألحق في الحكم به.
فأما قولهم: أخذ المال بأجمعه فليس أجمع هذا هو أجمع من قولهم: جاء الجيش أجمع وأكلت الرغيف أجمع من قبل أن أجمع هذا الذي يؤكد به لا يتنكر هو ولا ما يتبعه أبداً نحو أكتع وجميع هذا الباب وإذا لم يجز تنكيره كان من الإضافة أبعد إذ لا سبيل إلى إضافة اسم إلا بعد تنكيره وتصوره كذلك.
ولهذا لم يأت عنهم شيء من إضافة أسماء الإشارة ولا الأسماء المضمرة إذ ليس فيها ما ينكر.
ويؤكد ذلك عندك أنهم قد قالوا في هذا المعنى: جاء القوم بأجمعهم بضم الميم فكما أن هذه غير تلك لا محالة فكذلك المفتوحة الميم هي غير تلك.
وهذا واضح.
وينبغي أن تكون " أجمع " هذه المضمومة العين جمعاً مكسراً لا واحداً مفرداً من حيث كان هذا المثال مما يخص التكسير دون الإفراد وإذا كان كذلك فيجب أن يعرف خبر واحده ما هو.
فأقرب ذلك إليه أن يكون جمع " جمع " من قول الله سبحانه {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ}.
ويجوز عندي أيضاً أن يكون جمع أجمع على حذف الزيادة وعليه حمل أبو عبيدة قول الله تعالى {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ} أنه جمع أشد على حذف الزيادة.
قال: وربما استكرهوا على حذف هذه الزيادة في الواحد وأنشد بيت عنترة: عهدي به شد النهار
أي أشد النهار ويعني أعلاه وأمتعه وذهب سيبويه في أشد هذه إلى أنها جمع شدة كنعمة وأنعم.
وذهب أبو عثمان فيما رويناه عن أحمد بن يحيى عنه إلى أنه جمع لا واحد له.
ثم لنعد فنقول: إنهم إذا كانوا في حال إكثارهم وتوكيدهم مستوحشين منه مصانعين عنه علم أنهم إلى الإيجاز أميل وبه أعنى وفيه أرغب ألا ترى إلى ما في القرآن وفصيح الكلام: من كثرة الحذوف كحذف المضاف وحذف الموصوف والاكتفاء بالقليل من الكثير كالواحد من الجماعة وكالتلويح من التصريح.
فهذا ونحوه - مما يطول إيراده وشرحه - مما يزيل الشك عنك في رغبتهم فيما خف وأوجز عما طال وأمل وأنهم متى اضطروا إلى الإطالة لداعي حاجة أبانوا عن ثقلها عليهم واعتدوا بما كلفوه من ذلك أنفسهم وجعلوه كالمنبهة على فرط عنايتهم وتمكن الموضع عندهم وأنه ليس كغيره مما ليست له حرمته ولا النفس معنية به.
نعم ولو لم يكن في الإطالة في بعض الأحوال إلا الخروج إليها عما قد ألف ومل من الإيجاز لكان مقنعاً.
ألا ترى إلى كثرة غلبة الياء على الواو في عام الحال ثم مع هذا فقد ملوا ذلك إلى أن قلبوا الياء واواً قلباً ساذجاً أو كالساذج لا لشيء أكثر من الانتقال من حال إلى حال فإن المحبوب إذا كثر مل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يا أبا هريرة زر غباً تزدد حباً ) والطريق في هذا بحمد الله واضحة مهيع.
وذلك الموضع الذي قلبت فيه الياء واواً على ما ذكرنا لام فعلى إذا كانت اسماً من نحو: الفتوى والرعوى والثنوى والبقوى والتقوى والشروى والعوى " لهذا النجم ".
وعلى ذلك أو قريب منه قالوا: عوى الكلب عوة.
وقالوا: الفتوة وهي من الياء وكذلك الندوة.
وقالوا: هذا أمر ممضو عليه وهي المضواء وإنما هي من مضيت لا غير.
وقد جاء عنهم: رجل مهوب وبر مكول ورجل مسور به.
فقياس هذا كله على قول الخليل أن يكون مما قلبت فيه الياء واواً لأنه يعتقد أن المحذوف من هذا ونحوه إنما هو واو مفعول لا عينه وأنسه بذلك قولهم: قد هوب وسور به وكول.
واعلم أنا - مع ما شرحنا وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل النحو على علل الفقه وإلحاقها بعلل الكلام - لا ندعي أنها تبلغ قدر علل المتكلمين ولا عليها براهين المهندسين غير أنا نقول: إن علل النحويين على ضربين: أحدهما واجب لا بد منه لأن النفس لا تطيق في معناه غيره.
والآخر ما يمكن تحمله إلا أنه على تجشم واستكراه له.
الأول - وهو ما لا بد للطبع منه -: قلب الألف واواً للضمة قبلها وياء للكسرة قبلها.
أما الواو فنحو قولك في سائر: سويئر وفي ضارب: ضويرب.
وأما الياء فنحو قولك في نحو تحقير قرطاس وتكسيره: قريطيس وقراطيس.
فهذا ونحوه مما لا بد منه من نقبل أنه ليس في القوة ولا احتمال الطبيعة وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة.
فقلب الألف على هذا الحد علته الكسرة والضمة قبلها.
فهذه علة برهانية ولا لبس فيها ولا توقف للنفس عنها.
وليس كذلك قلب واو عصفور ونحوه ياء إذا انكسر ما قبلها نحو: عصيفير وعصافير ألا ترى أنه قد يمكنك تحمل المشقة في تصحيح هذه الواو بعد الكسرة وذلك بأن تقول عصيفور وعصافور.
وكذلك نحو: موسر وموقن وميزان وميعاد لو أكرهت نفسك على تصحيح أصلها لأطاعتك عليه وأمكنتك منه وذلك قولك: موزان وموعاد وميسر وميقن.
وكذلك ريح وقيل قد كنت قادراً أن تقول: قول وروح لكن مجيء الألف بعد الضمة أو الكسرة أو السكون محال ومنها لا يكون.
ومن المستحيل جمعك بين الألفين المدتين نحو ما صار إليه قلب لام كساء ونحوه قبل إبدال الألف همزة وهو خطا كساا أو قضاا فهذا تتوهمه تقديراً ولا تلفظ به البتة.
قال أبو إسحاق يوماً لخصم نازعه في جواز اجتماع الألفين المدتين - ومد الرجل الألف في نحو هذا وأطال - فقال له أبو إسحاق: لو مددتها إلى العصر ما كانت إلا ألفاً واحدة.
وعلة امتناع ذلك عندي أنه قد ثبت أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً فلو التقت ألفان مدتان لانتقضت القضية في ذلك ألا ترى أن الألف الأولى قبل الثانية ساكنة وإذا كان ما قبل الثانية ساكناً كان ذلك نقضاً في الشرط لا محالة.
فأما قول أبي العباس في إنشاد سيبويه: دار لسعدى إذه من هواكا إنه خرج من باب الخطأ إلى باب الإحالة لأن الحرف الواحد لا يكون ساكناً متحركاً في حال فخطأ عندنا.
وذلك أن الذي قال: " إذه من هواك " هو الذي يقول في الوصل: هي قامت فيسكن الياء وهي لغة معروفة فإذا حذفها في الوصل اضطراراً واحتاج إلى الوقف ردها حينئذ فقال: هي فصار الحرف المبدوء به غير الموقوف عليه فلم يجب من هذا أن يكون ساكناً متحركاً في حال وإنما كان قوله " إذه " على لغة من أسكن الياء لا لغة من حركها من قبل أن الحذف ضرب من الإعلال والإعلال إلى السواكن لضعفها أسبق منه إلى المتحركات لقوتها.
وعلى هذا قبح قوله: لأنه موضع يتحرك فيه الحرف في نحو قولك: لم يكن الحق.
وعلة جواز هذا البيت ونحوه مما حذف فيه ما يقوى بالحركة هي أن هذه الحركة إنما هي لالتقاء الساكنين وأحداث التقائهما ملغاة غير معتدة فكأن النون ساكنة وإن كانت لو أقرت لحركت فإن لم تقل بهذا لزمك أن تمتنع من إجماع العرب الحجازيين على قولهم: اردد الباب واصبب الماء واسلل السيف.
وأن تحتج في دفع ذلك بأن تقول: لا أجمع بين مثلين متحركين.
وهذا واضح.
ومن طريف حديث اجتماع السواكن شيء وإن كان في لغة العجم فإن طريق الحس موضع تتلاقى عليه طباع البشر ويتحاكم إليه الأسود والأحمر وذلك قولهم: " آرد " للدقيق و " ماست " للبن فيجمعون بين ثلاثة سواكن.
إلا أنني لم أر ذلك إلا فيما كان ساكنه الأول ألفاً وذلك أن الألف لما قاربت بضعفها وخفائها الحركة صارت " ماست " كأنها مست.
فإن قلت: فأجز على هذا الجمع بين الألفين المدتين واعتقد أن الأولى منهما كالفتحة قبل الثانية.
قيل: هذا فاسد وذلك أن الألف قبل السين في " ماست " إذا أنت استوفيتها أدتك إلى شيء آخر غيرها مخالف لها وتلك حال الحركة قبل الحرف: أن يكون بينهما فرق ما ولو تجشمت نحو ذلك في جمعك في اللفظ بين ألفين مدتين نحو كساا وحمراا لكان مضافاً إلى اجتماع ساكنين أنك خرجت من الألف إلى ألف مثلها وعلى سمتها والحركة لا بد لها أن تكون مخالفة للحرف بعدها هذا مع انتقاص القضية في سكون ما قبل الألف الثانية.
ورأيت مع هذا أبا علي - رحمه الله - كغير المستوحش من الابتداء بالساكن في كلام العجم.
ولعمري إنه لم يصرح بإجازته لكنه لم يتشدد فيه تشدده في إفساد إجازة ابتداء العرب بالساكن.
قال: وذلك أن العرب قد امتنعت من الابتداء بما يقارب حال الساكن وإن كان في الحقيقة متحركاً يعني همزة بين بين.
قال: فإذا كان بعض المتحرك لمضارعته الساكن لا يمكن الابتداء به فما الظن بالساكن نفسه! قال: وإنما خفى حال هذا في اللغة العجمية لما فيها من الزمزمة يريد أنها لما كثر ذلك فيها ضعفت حركاتها وخفيت.
وأما أنا فأسمعهم كثيراً إذا أرادوا المفتاح قالوا: " كليد " فإن لم تبلغ الكاف أن تكون ساكنة فإن حركتها جد مضعفة حتى إنها ليخفى حالها علي فلا أدري أفتحة هي أم كسرة وقد تأملت ذلك طويلاً فلم أحل منه بطائل.
وحدثني أبو علي رحمه الله قال: دخلت " هيتا " وأنا أريد الانحدار منها إلى بغداد فسمعت أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها قبل فعجبت منها وأقمنا هناك أياماً إلى أن صلح الطريق للمسير فإذا أنني قد تكلمت مع القوم بها وأظنه قال لي: إنني لما بعدت عنهم أنسيتها.
ومما نحن بسبيله مذهب يونس في إلحاقه النون الخفيفة للتوكيد في التثنية وجماعة النساء وجمعه بين ساكنين في الوصل نحو قوله: اضربان زيداً واضربنان عمراً وليس ذلك - وإن كان في الإدراج - بالممتنع في الحس وإن كان غيره أسوغ فيه منه من قبل أن الألف إذا أشبع مدها صار ذلك كالحركة فيها ألا ترى إلى اطراد نحو: شابة ودابة وادهامت والضالين.
فإن قلت: فإن الحرف لما كان مدغماً خفى فنبا اللسان عنه وعن الآخر بعده نبوة واحدة فجريا لذلك مجرى الحرف الواحد وليست كذلك نون اضربان زيداً وأكرمنان جعفراً قيل: فالنون الساكنة أيضاً حرف خفي فجرت لذلك نحواً من الحرف المدغم وقد قرأ نافع {مَحْيَايَ وَمَمَاتِي} بسكون الياء من " محياي " وذلك لما نحن عليه من حديث الخفاء والياء المتحركة إذا وقعت بعد الألف احتيج لها إلى فضل اعتماد وإبانة وذلك قول الله تعالى {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} ولذلك يحض المبتدئون والمتلقنون على إبانة هذه الياء لوقوعها بعد الألف فإذا كانت من الخفاء على ما ذكرنا وهي متحركة ازدادت خفاء بالسكون نحو محياي فأشبهت حينئذ الحرف المدغم.
ونحو من ذلك ما يحكى عنهم من قولهم: " التقت حلقتا البطان " بإثبات الألف ساكنة في اللفظ قبل اللام وكأن ذلك إنما جاز ههنا لمضارعة اللام النون ألا ترى أن في مقطع اللام غنة كالنون وهي أيضاً تقرب من الياء حتى يجعلها بعضهم في اللفظ ياء فحملت اللام في هذا على النون كما حملت أيضاً عليها في لعلي ألا تراهم كيف كرهوا النون من لعلني مع اللام كما كرهوا النون في إنني وعلى ذلك قالوا: هذا بلوسفر وبلىسفر فأبدلوا الواو ياء لضعف حجز اللام كما أبدلوها " في قنية " ياء لضعف حجز النون وكأن " قنية " - وهي عندنا من " قنوت " - و " بلياً " أشبه من عذى وصبيان لأنه لا غنة في الذال والباء.
ومثل " بلى " قولهم: فلان من علية الناس وناقة عليان.
فأما إبدال يونس هذه النون في الوقف ألفاً وجمعه بين ألفين في اضرباا واضربناا فهو الضعيف المستكره الذي أباه أبو إسحاق وقال فيه ما قال.
ومن الأمر الطبيعي الذي لا بد منه ولا وعى عنه أن يلتقي الحرفان الصحيحان فيسكن الأول منهما في الإدراج فلا يكون حينئذ بد من الادغام متصلين كانا أو منفصلين.
فالمتصلان نحو قولك: شد وصب وحل فالادغام واجب لا محالة ولا يوجدك اللفظ به بداً منه.
والمنفصلان نحو قولك: خذ ذاك ودع عامرا.
فإن قلت: فقد أقدر أن أقول: شدد وحلل فلا أدغم قيل: متى تجشمت ذلك وقفت على الحرف الأول وقفة ما وكلامنا إنما هو على الوصل.
فأما قراءة عاصم: " وقيل من راق " ببيان النون من " من " فمعيب في الإعراب معيف في الأسماع وذلك أن النون الساكنة لا توقف في وجوب ادغامها في الراء نحو: من رأيت ومن رآك فإن كان ارتكب ذلك ووقف على النون صحيحة غير مدغمة لينبه به على انفصال المبتدأ من خبره فغير مرضي أيضاً ألا ترى إلى قول عدي: من رأيت المنون عرين أم من ذا عليه من أن يضام خفير بإدغام نون " من " في راء رأيت ويكفي من هذا إجماع الجماعة على ادغام " من راق " وغيره مما تلك سبيله.
وعاصم في هذا مناقض لمن قرأ: " فإذا هيتلقف " بإدغام تاء تلقف.
وهذا عندي يدل على شدة اتصال المبتدأ بخبره فإذا صارا معاً ههنا كالجزء الواحد فجرى " هيت " في اللفظ مجرى خدب وهجف ولولا أن الأمر كذلك للزمك أن تقدر الابتداء بالساكن أعني تاء المضارعة من " تتلقف ".
فاعرف ذلك.
وأما المعتلان فإن كانا مدين منفصلين فالبيان لا غير نحو: في يده وذو وفرة وإن كانا متصلين ادغما نحو: مرضية ومدعوة فإن كان الأول غير لازم فك في المتصل أيضاً نحو قوله: بان الخليط ولو طووعت ما بانا وقول العجاج: وفاحم دووى حتى اعلنكسا ألا ترى أن الأصل داويت وطاوعت فالحرف الأول إذاً ليس لازماً.
فإن كانا بعد الفتحة ادغما لا غير متصلين ومنفصلين وذلك نحو: قو وجو وحي وعي ومصطفو واقد وغلامي ياسر وهذا ظاهر.
فهذا ونحوه طريق ما لا بد منه وما لا يجري مجرى التحيز إليه والتخير له.
وما منه بد هو الأكثر وعليه اعتماد القول وفيه يطول السؤال والخوض وقد تقدم صدر منه ونحن نغترق في آتي الأبواب جميعه ولا قوة إلا بالله فأما إن استوفينا في الباب الواحد كل ما يتصل به - على تزاحم هذا الشأن وتقاود بعضه مع بعض - اضطرت الحال إلى إعادة كثير منه وتكريره في الأبواب المضاهية لبابه وسترى ذلك مشروحاً بحسب ما يعين الله عليه وينهض به.
باب القول على الاطراد والشذوذ
أصل مواضع " ط ر د " في كلامهم التتابع والاستمرار.
من ذلك طردت الطريدة إذ اتبعتها واستمرت بين يديك ومنه مطاردة الفرسان بعضهم بعضاً ألا ترى أن هناك كراً وفراً فكل يطرد صاحبه.
ومنه المطرد: رمح قصير يطرد به الوحش واطرد الجدول إذا تتابع ماؤه بالريح.
أنشدني بعض أصحابنا لأعرابي: مالك لا تذكر أو تزور بيضاء بين حاجبيها نور تمشي كما يطرد الغدير ومنه بيت الأنصاري: أتعرف رسماً كاطراد المذاهب أي كتتابع المذاهب وهي جمع مذهب وعليه قول الآخر: سيكفيك الإله ومسنمات كجندل لبن تطرد الصلالا أي تتابع إلى الأرضين الممطورة لتشرب منها فهي تسرع وتستمر إليها.
وعليه بقية الباب.
يتركن شذان الحصى جوافلا أي ما تطاير وتهافت منه.
وشذ الشيء يشِذ ويشُذ شذوذاً وشذاً وأشذذته أنا وشذذته أيضاً أشذه بالضم لا غير وأباها الأصمعي وقال: لا أعرف إلا شاذاً أي متفرقاً.
وجمع شاذ شذاذ قال: كبعض من مر من الشذاذ هذا أصل هذين الأصلين في اللغة.
ثم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سمته وطريقه في غيرهما فجعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطرداً وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذاً حملاً لهذين الموضعين على أحكام غيرهما.
ثم اعلم من بعد هذا أن الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب: مطرد في القياس والاستعمال جميعاً وهذا هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوبة وذلك نحو: قام زيد وضربت عمراً ومررت بسعيد.
ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال.
وذلك نحو الماضي من: يدر ويدع.
وكذلك قولهم " مكان مبقل " هذا هو القياس والأكثر في السماع باقل والأول مسموع أيضاً قال أبو داود لابنه أعاشني بعدك واد مبقل آكل من حوذانه وأنسل وقد حكى أيضاً أبو زيد في كتاب حيلة ومحالة: مكان مبقل.
ومما يقوى في القياس يضعف في الاستعمال مفعول عسى اسماً صريحاً نحو قولك: عسى زيد قائماً أو قياماً هذا هو القياس غير أن السماع ورد بحظره والاقتصار على ترك استعمال الاسم ههنا وذلك قولهم: عسى زيد أن يقوم و {فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ}.
وقد جاء عنهم شيء من الأول أنشدنا أبو علي: أكثرت في العذل ملحاً دائماً لا تعذلا إني عسيت صائما ومنه المثل السائر: " عسى الغويرأ بؤساً ".
والثالث المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس نحو قولهم: أخوص الرمث واستصوبت الأمر.
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال: يقال استصوبت الشيء ولا يقال: استصبت الشيء.
ومنه استحوذ وأغيلت المرأة واستنوق الجمل واستتيست الشاة وقول زهير: هنالك إن يسخولوا المال يخولوا ومنه اسفيل الجمل قال أبو النجم: والرابع الشاذ في القياس والاستعمال جميعاً.
وهو كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو: ثوب مصوون ومسك مدووف.
وحكى البغداديون: فرس مقوود ورجل معوود من مرضه.
وكل ذلك شاذ في القياس والاستعمال.
فلا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره إليه.
ولا يحسن أيضاً استعماله فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية.
واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه لكنه لا يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره.
ألا ترى أنك إذا سمعت: استحوذ واستصوب أديتهما بحالهما ولم تتجاوز ما ورد به السمع فيهما إلى غيرهما.
ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم ولا في استساغ: استسوغ ولا في استباع: استبيع ولا في أعاد: أعود لو لم تسمع شيئاً من ذلك قياساً على قولهم: أخوص الرمث.
فإن كان الشيء شاذاً في السماع مطرداً في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله.
من ذلك امتناعك من: وذر وودع لأنهم لم يقولوهما ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما نحو: وزن ووعد لو لم تسمعهما.
فأما قول أبي الأسود: ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه فشاذ.
وكذلك قراءة بعضهم { ما وَدَعك ربك وما قلى }.
فأما قولهم: ودع الشيء يدع - إذا وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف فمعنى " لم يدع " - بكسر الدال - أي لم يتدع ولم يثبت والجملة بعد " زمان " في موضع جر لكونها صفة له والعائد منها إليه محذوف للعلم بموضعه وتقديره: لم يدع فيه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلف فيرتفع " مسحت " بفعله و " مجلف " عطف عليه وهذا أمر ظاهر ليس فيه من الاعتذار والاعتلال ما في الرواية الأخرى.
ويحكى عن معاوية أنه قال: خير المجالس ما سافر فيه البصر واتدع فيه البدن.
ومن ذلك استعمالك " أن " بعد كاد نحو: كاد زيد أن يقوم هو قليل شاذ في الاستعمال وإن لم يكن قبيحاً ولا مأبياً في القياس.
ومن ذلك قول العرب: أقائم أخواك أم قاعدان هذا كلامها.
قال أبو عثمان: والقياس يوجب أن تقول: أقائم أخواك أم قاعد هما إلا أن العرب لا تقوله إلا قاعدان فتصل الضمير والقياس يوجب فصله ليعادل الجملة الأولى.
باب في تقاود السماع وتقارع الانتزاع
هذا الموضع كأنه أصل الخلاف الشاجر بين النحويين.
وسنفرد له باباً.
غير أنا نقدم ها هنا ما كان لائقاً به ومقدمة للقول من بعده.
وذلك على أضرب: فمنها أن يكثر الشيء فيسئل عن علته كرفع الفاعل ونصب المفعول فيذهب قوم إلى شيء ويذهب آخرون إلى غيره.
فقد وجب إذاً تأمل القولين واعتماد أقواهما ورفض صاحبه.
فإن تساويا في القوة لم ينكرا اعتقادهما جميعاً فقد يكون الحكم الواحد معلولاً بعلتين.
وسنفرد لذلك باباً.
وعلى هذا معظم قوانين العربية.
وأمره واضح فلا حاجة بنا إلى الإطالة فيه.
ومنها أن يسمع الشيء فيستدل به من وجه على تصحيح شيء أو إفساد غيره ويستدل به من وجه آخر على شيء غير الأول.
وذلك كقولك: ضربتك وأكرمته ونحو ذلك مما يتصل فيه الضمير المنصوب بالضمير قبله المرفوع.
فهذا موضع يمكن أن يستدل اتصال الفعل بفاعله.
ووجه الدلالة منه على ذلك أنهم قد أجمعوا على أن الكاف في نحو ضربتك من الضمير المتصل كما أن الكاف في نحو ضربك زيد كذلك ونحن نرى الكاف في ضربتك لم تباشر نفس الفعل كما باشرته في نحو ضربك زيد وإنما باشرت الفاعل الذي هو التاء فلولا أن الفاعل قد مزج بالفعل وصيغ معه حتى صار جزءاً من جملته لما كانت الكاف من الضمير المتصل ولاعتدت لذلك منفصلة لا متصلة.
لكنهم أجروا التاء التي هي ضمير الفاعل في نحو ضربتك - وإن لم تكن من نفس حروف الفعل - مجرى نون التوكيد التي يبنى الفعل عليها ويضم إليها في نحو لأضربنك.
فكما أن الكاف في نحو هذا معتدة من الضمير المتصل وإن لم تل نفس الفعل كذلك الكاف في نحو ضربتك ضمير متصل وإن لم تل نفس الفعل.
فهذا وجه الاستدلال بهذه المسألة ونحوها على شدة اتصال الفعل بفاعله وتصحيح القول بذلك.
وأما وجه إفساده شيئاً آخر فمن قبل أن فيه رداً على من قال: إن المفعول إنما نصبه الفاعل وحده لا الفعل وحده ولا الفعل والفاعل جميعاً.
وطريق الاستدلال بذلك أنا قد علمنا أنهم إنما يعنون بقولهم: الضمير المتصل: أنه متصل بالعامل فيه لا محالة ألا تراهم يقولون: إن الهاء في نحو مررت به ونزلت عليه ضمير متصل أي متصل بما عمل فيه وهو الجار وليس لك أن تقول: إنه متصل بالفعل لأن الباء كأنها جزء من الفعل من حيث كانت معاقبة لأحد أجزائه المصوغة فيه وهي همزة أفعل وذلك نحو أنزلته ونزلت به وأدخلته ودخلت به وأخرجته وخرجت به لأمرين: أحدهما أنك إن اعتددت الباء لما ذكرت كأنها بعض الفعل فإن هنا دليلاً آخر يدل على أنها كبعض الاسم ألا ترى أنك تحكم عليها وعلى ما جرته بأنهما جميعاً في موضع نصب بالفعل حتى إنك لتجيز العطف عليهما جميعاً بالنصب نحو قولك: مررت بك وزيداً ونزلت عليه وجعفراً فإذا كان هنا أمران أحدهما على حكم والآخر على ضده وتعارضا هذا التعارض ترافعا أحكامهما وثبت أن الكاف في نحو مررت بك متصلة بنفس الباء لأنها هي العاملة فيها.
وكذلك الهاء في نحو إنه أخوك وكأنه صاحبك وكأنه جعفر: هي ضمير متصل أي متصل بالعامل فيه وهذا واضح.
والآخر إطباق النحويين على أن يقولوا في نحو هذا: إن الضمير قد خرج عن الفعل وانفصل من الفعل وهذا تصريح منهم بأنه متصل أي متصل بالباء العاملة فيه فلو كانت التاء في ضربتك هي العاملة في الكاف لفسد ذلك من قبل أن أصل عمل النصب إنما هو للفعل وغيره من النواصب مشبه في ذلك بالفعل والضمير بالإجماع أبعد شيء عن الفعل من حيث كان الفعل موغلاً في التنكير والاسم المضمر متناه في التعريف.
بل إذا لم يعمل الضمير في الظرف ولا في الحال - وهما مما تعمل فيه المعاني - كان الضمير من نصب المفعول به أبعد وفي التقصير عن الوصول إليه أفعد.
وأيضاً فإنك تقول: زيد ضرب عمراً والفاعل مضمر في نفسك لا موجود وأما الاستدلال بنحو ضربتك على شيء غير الموضعين المتقدمين فأن يقول قائل: إن الكاف في نحو ضربتك منصوبة بالفعل والفاعل جميعاً ويقول: إنه متصل بهما كاتصاله بالعامل فيه في نحو إنك قائم ونظيره.
وهذا أيضاً وإن كان قد ذهب إليه هشام فإنه عندنا فاسد من أوجه: أحدها أنه قد صح ووضح أن الفعل والفاعل قد تنزلا باثني عشر دليلاً منزلة الجزء الواحد فالعمل إذاً إنما هو للفعل وحده واتصل به الفاعل فصار جزءاً منه كما صارت النون في نحو لتضربن زيداً كالجزء منه حتى خلط بها وبنى معها.
ومنها أن الفعل والفاعل إنما هو معنى والمعاني لا تعمل في المفعول به إنما تعمل في الظروف.
ومن ذلك أن تستدل بقول ضيغم الأسدي: إذا هو لم يخفني في ابن عمي وإن لم ألقه الرجل الظلوم على جواز ارتفاع الاسم بعد إذا الزمانية بالابتداء ألا ترى أن " هو " من قوله " إذا هو لم يخفني " ضمير الشأن والحديث وأنه مرفوع لا محالة.
فلا يخلو رفعه من أن يكون بالابتداء كما قلنا أو بفعل مضمر.
فيفسد أن يكون مرفوعاً بفعل مضمر لأن ذلك المضمر لا دليل عليه ولا تفسير له وما كانت هذه سبيله لم يجز إضماره.
فإن قلت: فلم لا يكون قوله " لم يخفني في ابن عمي الرجل الظلوم " تفسيراً للفعل الرافع ل " هو " كقولك: إذا زيد لم يلقني غلامه فعلت كذا فترفع زيداً بفعل مضمر يكون ما بعده تفسيراً له.
قيل: هذا فاسد من موضعين: أحدهما أنا لم نر هذا الضمير على سريطة التفسير عاملاً فيه فعل محتاج إلى تفسير.
فإذا أدى هذا القول إلى ما لا نظير له وجب رفضه واطراح الذهاب إليه.
والآخر أن قولك " لم يخفني الرجل الظلوم " إنما هو تفسير ل " هو " من حيث كان ضمير الشأن والقصة لا بد له أن تفسره الجملة نحو قول الله عز وجل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقولنا {اللَّهُ أَحَدٌ} تفسير ل " هو ".
وكذلك قوله تعالى: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ} فقولك: {لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ} تفسير ل " ها " من قولك: فإنها من حيث كانت ضمير القصة.
فكذلك قوله: " لم يخفني الرجل الظلوم " إنما هذه الجملة تفسير ل " هو ".
فإذا ثبت أن هذه الجملة إنما هي تفسير لنفس الاسم المضمر بقي ذلك الفعل المضمر لا دليل عليه وإذا لم يقم عليه دليل بطل إضماره لما في ذلك من تكليف علم الغيب.
وليس كذلك " إذا زيد قام أكرمتك " ونحوه من قبل أن زيداً تام غير محتاج إلى تفسير.
فإذا لم يكن محتاجاً إليه صارت الجملة بعده تفسيراً للفعل الرافع له لا له نفسه.
فإذا ثبت بما أوردناه ما أردناه علمت وتحققت أن " هو " من قوله " إذا هو لم يخفني الرجل الظلوم " مرفوع بالابتداء لا بفعل مضمر.
وفي هذا البيت تقوية لمذهب أبي الحسن في إجازته الرفع بعد إذا الزمانية بالابتداء في نحو قوله تعالى {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} و {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}.
ومعنا ما يشهد لقوله هذا: شيء غير هذا غير أنه ليس ذلك غرضنا هنا إنما الغرض إعلامنا أن في البيت دلالة على صحة مذهب أبي الحسن هذا.
فهذا وجه صحيح يمكن أن يستنبط من بيت ضيغم الذي أنشدناه.
وفيه دليل آخر على جواز خلق الجملة الجارية خبراً عن المبتدأ من ضمير يعود إليه منها ألا ترى أن قوله " لم يخفني الرجل الظلوم " ليس فيه عائد على هو وكيف يكون الأمر إلا هكذا ألا تعلم أن هذا المضمر على شريطة التفسير لا يوصف ولا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه ولا يعود عائد ذكر عليه وذلك لضعفه من حيث كان مفتقراً إلى تفسيره.
وعلى هذا ونحوه عامة ما يرد عليك من هذا الضرب ألا ترى أن قول الله عز وجل {اللَّهُ أَحَدٌ} لاضمير فيه يعود على " هو " من قبله.
واعلم أن اللفظ قد يرد شيء منه فيجوز جوازاً صحيحاً أن يستدل به على أمر ما وأن يستدل به على ضده البتة.
وذلك نحو مررت بزيد ورغبت في عمرو وعجبت من محمد وغير ذلك من الأفعال الواصلة بحروف الجر.
فأحد ما يدل عليه هذا الضرب من القول أن الجار معتد من جملة الفعل الواصل به ألا ترى أن الباء في نحو مررت بزيد معاقبة الهمزة لنقل في نحو أمررت زيداً وكذلك قولك أخرجته وخرجت به وأنزلته ونزلت به.
فكما أن همزة أفعل مصوغة فيه كائنة من جملته فكذلك ما عاقبها من حروف الجر ينبغي أن يعتد أيضاً من جملة الفعل لمعاقبته ما هو من جملته.
فهذا وجه.
والآخر أن يدل ذلك على أن حرف الجر جار مجرى بعض ما جره ألا ترى أنك تحكم لموضع الجار والمجرور بالنصب فيعطف عليه فينصب لذلك فنقول: مررت بزيد وعمراً وكذلك أيضاً لا يفصل بين الجار والمجرور لكونهما في كثير من المواضع بمنزلة الجزء الواحد.
أفلا تراك كيف تقدر اللفظ الواحد تقديرين مختلفين وكل واحد منهما مقبول في القياس متلقى بالبشر والإيناس.
ومن ذلك قول الآخر: زمان علي غراب غداف فطيره الشيب عني فطارا فهذا موضع يمكن أن يذهب ذاهب فيه إلى سقوط حكم ما تعلق به الظرف من الفعل ويمكن أيضاً أن يستدل به على ثباته وبقاء حكمه.
وذلك أن الظرف الذي هو " علي " متعلق بمحذوف وتقديره غداة ثبت علي أو استقر علي غراب ثم حذف الفعل وأقيم الظرف مقامه.
وقوله فطيره - كما ترى - معطوف.
فأما من أثبت به حكم الفعل المحذوف فله أن يقول: إن طيره معطوف على ثبت أو استقر وجواز العطف عليه أدل دليل على اعتداده وبقاء حكمه وأن العقد عليه والمعاملة في هذا ونحوه إنما هي معه ألا ترى أن العطف نظير التثنية ومحال أن يثنى الشيء فيصير مع صاحبه شيئين إلا وحالهما في الثبات والاعتداد واحدة.
فهذا وجه جواز الاستدلال به على بقاء حكم ما تعلق به الظرف وأنه ليس أصلاً متروكاً ولا شرعاً منسوخاً.
وأما جواز اعتقاد سقوط حكم ما تعلق به الظرف من هذا البيت فلأنه قد عطف قوله " فطيره " على قوله " علي " وإذا جاز عطف الفعل على الظرف قوي حكم الظرف في قيامه مقام الفعل المتعلق هو به وإسقاطه حكمه وتوليه من العمل ما كان الفعل يتولاه وتناوله به ما كان متناولاً له.
فهذان وجهان من الاستدلال بالشيء الواحد على الحكمين الضدين وإن كان وجه الدلالة به على قوة حكم الظرف وضعف حكم الفعل في هذا وما يجري مجراه هو الصواب عندنا وعليه اعتمادنا وعقدنا.
وليس هذا موضع الانتصار لما نعتقده فيه وإنما الغرض منه أن نرى وجه ابتداء تفرع القول وكيف يأخذ بصاحبه ومن أين يقتاد الناظر فيه إلى أنحائه ومصارفه.
ونظير هذا البيت في حديث الظرف والفعل من طريق العطف قول الله عز اسمه {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ} أفلا تراه كيف عطف الظرف الذي هو {لَهُ مِن قُوَّةٍ} على قوله " تبلى " وهو فعل فالآية نظيرة البيت في العطف وإن اختلفا في تقدم الظرف تارة وتأخره أخرى.
وهذا أمر فيه انتشار وامتداد وإنما أفرض منه ومما يجري مجراه ما يستدل به ويجعل عياراً على غيره.
والأمر أوسع شقة وأظهر كلفة ومشقة ولكن إن طبنت له ورفقت به أولاك جانبه وأمطاك كاهله وغاربه وإن خبطته وتورطته كدك مهله وأوعرت بك سبله فرفقاً وتأملاً.
باب في مقاييس العربية
وهي ضربان: أحدهما معنوي والآخر لفظي.
وهذان الضربان وإن عما وفشوا في هذه اللغة فإن أقواهما وأوسعهما هو القياس المعنوي ألا ترى أن الأسباب المانعة من الصرف تسعة: واحد منها لفظي وهو شبه الفعل لفظاً نحو أحمد ويرمع وتنضب وإثمد وأبلم وبقم وإستبرق والثمانية الباقية كلها معنوية كالتعريف والوصف والعدل والتأنيث وغير ذلك.
فهذا دليل.
ومثله اعتبارك باب الفاعل والمفعول به بأن تقول: رفعت هذا لأنه فاعل ونصبت هذا لأنه مفعول.
فهذا اعتبار معنوي لا لفظي.
ولأجله ما كانت العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى أنها معنوية ألا تراك إذا قلت: ضرب سعيد جعفراً فإن " ضرب " لم تعمل في الحقيقة شيئاً وهل تحصل من قولك ضرب إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فعل فهذا هو الصوت والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوباً إليه الفعل.
وإنما قال النحويون: عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض العمل يأتي مسبباً عن لفظ يصحبه كمررت بزيد وليت عمراً قائم وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره.
وإنما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ.
وهذا واضح.
واعلم أن القياس اللفظي إذا تأملته عارياً من اشتمال المعنى عليه ألا ترى أنك إذا سئلت عن " إن " من قوله: ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيراً لا يزال يزيد فإنك قائل: دخلت على " ما " - وإن كانت " ما " ههنا مصدرية - لشبهها لفظاً بما النافية التي تؤكد بإن من قوله: ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم تخالج الأمر إن الأمر مشترك وشبه اللفظ بينهما يصير " ما " المصدرية إلى أنها كأنها " ما " التي معناها النفي أفلا ترى أنك لو لم تجذب إحداهما إلى أنها كأنها بمعنى الأخرى لم يجز لك إلحاق " إن " بها.
فالمعنى إذاً أشيع وأسير حكماً من اللفظ لأنك في اللفظي متصور لحال المعنوي ولست في المعنوي بمحتاج إلى تصور حكم اللفظي.
فاعرف ذلك.
واعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن وأنه منها على أقوى بال ألا ترى أنهم لما أعربوا بالحروف في التثنية والجمع الذي على حده فأعطوا الرفع في التثنية الألف والرفع في الجمع الواو والجر فيهما الياء وبقي النصب لا حرف له فيماز به جذبوه إلى الجر فحملوه عليه دون الرفع لتلك الأسباب المعروفة هناك فلا حاجة بنا هنا إلى الإطالة بذكرها ففعلوا ذلك ضرورة ثم لما صاروا إلى جمع التأنيث حملوا النصب أيضاً على الجر فقالوا ضربت الهندات " كما قالوا مررت بالهندات " ولا ضرورة هنا لأنهم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا التاء فيقولوا: رأيت الهندات فلم يفعلوا ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة التي عارضت في المذكر عنه فدل دخولهم تحت هذا - مع أن الحال لا تضطر إليه - على إيثارهم واستحبابهم حمل الفرع على الأصل وإن عرى من ضرورة الأصل.
وهذا جلي كما ترى.
ومن ذلك حملهم حروف المضارعة بعضها على حكم بعض في نحو حذفهم الهمزة في نكرم وتكرم ويكرم لحذفهم إياها في أكرم لما كان يكون هناك من الاستثقال لاجتماع الهمزتين في نحو أؤكرم وإن عريت بقية حروف المضارعة - لو لم تحذف - من اجتماع همزتين وحذفهم أيضاً الفاء من نحو وعد وورد في يعد ويرد لما كان يلزم - لو لم تحذف - من وقوع الواوين ياء وكسرة ثم حملوا على ذلك ما لو لم يحذفوه بين ياء وكسرة نحو أعد وتعد ونعد لا فإذا جاز أن يحمل حروف المضارعة بعضها على بعض - ومراتبها متساوية وليس بعضها أصلاً لبعض - كان حمل المؤنث على المذكر لأن المذكر أسبق رتبة من المؤنث أولى وأجدر.
ومن ذلك مراعاتهم في الجمع حال الواحد لأنه أسبق من الجمع ألا تراهم لما أعلت الواو في الواحد أعلوها أيضاً في الجمع في نحو قيمة وقيم وديمة وديم لما صحت في الواحد صححوها في الجمع فقالوا: زوج وزوجة وثور وثورة.
فأما ثيرة ففي إعلال واوه ثلاثة أقوال: أما صاحب الكتاب فحمله على الشذوذ وأما العباس فذكر أنهم أعلوه ليفصلوا بذلك بين الثور من الحيوان وبين الثور وهو القطعة من الأقط لأنهم لا يقولون فيه إلا ثِوَرة بالتصحيح لا غير.
وأما أبو بكر فذهب في إعلال ثيَرة إلى أن ذلك لأنها منقوصة من ثيارة فتركوا الإعلال في العين أمارة لما نووه من الألف كما جعلوا تصحيح نحو اجتوروا واعتونوا دليلاً على أنه في معنى ما لابد من صحته وهو تجاوروا وتعاونوا.
وقد قالوا أيضاً: ثيرة قال: صدر النهار يراعي ثيرةً رتعا وهذا لا نكير له في وجوبه لسكونه عينه.
نعم وقد دعاهم إيثارهم لتشبيه الأشياء بعضها ببعض أن حملوا الأصل على الفرع ألا تراهم يعلون المصدر لإعلال فعله ويصححونه لصحته.
وذلك نحو قولك: قمت قياماً وقاومت قواماً.
فإذا حملوا الأصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل فهل بقي في وضوح الدلالة على إيثارهم تشبيه الأشياء المتقاربة بعضها ببعض شبهة! وعلى ذلك أيضاً عوضوا في المصدر ما حذفوه في الفعل فقالوا: أكرم يكرم فلما حذفوا الهمزة في المضارع أثبتوها في المصدر فقالوا: الإكرام فدل هذا على أن هذه المثل كلها جارية مجرى المثال الواحد ألا تراهم لما حذفوا ياء فرازين عوضوا منها الهاء في نفس المثال فقالوا فرازنة.
وكذلك لما حذفوا فاء عدة عوضوا منها نفسها التاء.
وكذلك أينق في أحد قولي سيبويه فيها: لما حذفوا عينها عوضوا منها الياء في نفس المثال.
فدل هذا وغيره مما يطول تعداده على أن المثال والمصدر واسم الفاعل كل واحد منها يجري عندهم وفي محصول اعتدادهم مجرى الصورة الواحدة حتى إنه إذا لزم في بعضها شيء لعلة ما أوجبوه في الآخر وإن عرى في الظاهر من تلك العلة فأما في الحقيقة فكأنها فيه نفسه ألا ترى أنه إذا صح أن جميع هذه الأشياء على اختلاف أحوالها تجري عندهم مجرى المثال الواحد فإذا وجب في شيء منها حكم فإنه لذلك كأنه أمر لا يخصه من بقية الباب بل هو جار في الجميع مجرى واحداً لما قدمنا ذكره من الحال آنفاً.
واعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب نحو قولك في قوله: كيف تبني من ضرب مثل جعفر: ضربب هذا من كلام العرب ولو بنيت مثله ضيرب أو ضورب أو ضروب أو نحو ذلك لم يعتقد من كلام العرب لأنه قياس على الأقل استعمالاً والأضعف قياساً.
وسنفرد لهذا الفصل باباً فإن فيه نظراً صالحاً.
باب جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه
هذا باب ظاهره - إلى أن تعرف صورته - ظاهر التناقض إلا أنه مع تأمله صحيح.
وذلك أن يقل الشيء وهو قياس ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس.
الأول قولهم في النسب إلى شنوءة: شنئي فلك - من بعد - أن تقول في الإضافة إلى قتوبة: قتبي وإلى ركوبة: ركبي وإلى حلوبة: حلبي قياساً على شنئي.
وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعيلة لمشابهتها إياها من عدة أوجه: أحدها أن كل واحدة من فعولة وفعيلة ثلاثي ثم إن ثالث كل واحدة منهما حرف لين يجري مجرى صاحبه ألا ترى إلى اجتماع الواو والياء ردفين وامتناع ذلك في الألف وإلى جواز حركة كل واحدة من الياء والواو مع امتناع ذلك في الألف إلى غير ذلك.
ومنها أن في كل واحدة من فعولة وفعيلة تاء التأنيث.
ومنها اصطحاب فعول وفعيل على الموضع الواحد نحو أثيم وأثوم ورحيم ورحوم ومشي ومشو ونهي عن الشيء ونهو.
فلما استمرت حال فعيلة وفعولة هذا الاستمرار جرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة فكما قال أبو الحسن: فإن قلت: إنما جاء هذا في حرف واحد - يعني شنوءة - قال: فإنه جميع ما جاء.
وما ألطف هذا من القول من أبي الحسن! وتفسيره أن الذي جاء في فعولة هو هذا الحرف والقياس قابله ولم يأت فيه شيء ينقضه.
فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء وكان أيضاً صحيحاً في القياس مقبولاً فلا غرو ولا ملام.
وأما ما هو أكثر من باب شنئي ولا يجوز القياس عليه لأنه لم يكن هو على قياس فقولهم في ثقيف: ثقفي وفي قريش: قرشي وفي سليم: سلمي فهذا وإن كان أكثر من شنئي فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس.
فلا يجيز على هذا في سعيد سعدي ولا في كريم كرمي.
فقد برد في اليد من هذا الموضع قانون يحمل عليه ويرد غيره إليه.
وإنما أذكر من هذا ونحوه رسوماً لتقتدى وأفرض منه آثاراً لتقتفى ولو التزمت الاستكثار منه لطال الكتاب به وأمل قارئه.
واعلم أن من قال في حلوبة: حلبي قياساً على قولك في حنيفة: حنفي فإنه لا يجيز في النسب إلى حرورة حرري ولا في صرورة صرري ولا في قوولة قولي.
وذلك أن فعولة في هذا محمولة على فعيلة وأنت لا تقول في الإضافة إلى فعيلة إذا كانت مضعفة أو معتلة العين إلا بالتصحيح نحو قولهم في شديد: شديدي وفي طويلة: طويلي استثقالاً لقولك: شددي وطولي.
فإذا كانت فعولة محمولة على فعيلة وفعيلة لا تقول فيها مع التضعيف واعتلال العين إلا بالإتمام فما كان محمولاً عليها أولى بأن يصح ولا يعل.
ومن قال في شنوءة: شنئي فأعل فإنه لا يقول في نحو جرادة وسعادة إلا بالإتمام: جرادي وسعادي.
وذلك لبعد الألف عن الياء " و " لما فيها من الخفة.
ولو جاز أن يقول في نحو جرادة: جردي لم يجز ذلك في نحو حمامة وعجاجة: حممي ولا عججي استكراهاً للتضعيف إلا أن يأنس بإظهار تضعيف فعل ولا في نحو سيابة وحوالة: سيبي ولا حولي استكراهاً لحركة المعتل في هذا الموضع.
وعلة ذلك ثابتة في التصريف فغنينا عن ذكرها الآن.
باب في تعارض السماع والقياس
إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في غيره وذلك نحو قول الله تعالى: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ} فهذا ليس بقياس لكنه لا بد من قبوله لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم.
ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره ألا تراك لا تقول في استقام: استقوم ولا في استباع: استبيع.
فأما قولهم " استنوق الجمل " و " استتيست الشاة " و " استفيل الجمل " فكأنه أسهل من استحوذ وذلك أن استحوذ قد تقدمه الثلاثي معتلاً نحو قوله: يحوذهن وله حوذي كما يحوذ الفئة الكمي - يروى بالذال والزاي: يحوذهن و يحوزهن -.
فلما كان استحوذ خارجاً عن معتل: أعني حاذ يحوذ وجب إعلاله إلحاقاً في الإعلال به.
وكذلك باب أقام وأطال واستعاذ واستزاد مما يسكن ما قبل عينه في الأصل ألا ترى أن أصل أقام أقوم وأصل استعاذ استعوذ فلو أخلينا وهذا اللفظ لاقتضت الصورة تصحيح العين لسكون ما قبلها غير أنه لما كان منقولاً ومخرجاً من معتل - هو قام وعاذ - أجرى أيضاً في الإعلال عليه.
وليس كذلك " استنوق الجمل " و " استتيست الشاة " لأن هذا ليس منه فعل معتل ألا تراك لا تقول: ناق ولا تاس إنما الناقة والتيس اسمان لجوهر لم يصرف منهما فعل معتل.
فكان خروجهما على الصحة أمثل منه في باب استقام واستعاذ.
وكذلك استفيل.
ومع هذا أيضاً فإن استنوق واستتيس شاذ ألا تراك لو تكلفت أن تأتي باستفعل من الطود لما قلت: استطود ولا من الحوت استحوت ولا من الخوط استخوط ولكان القياس أن تقول: استطاد واستحات واستخاط.
والعلة في وجوب إعلاله وإعلال استنوق واستفيل واستتيست أنا قد أحطنا علماً بأن الفعل إنما يشق من الحدث لا من الجوهر ألا ترى إلى قوله " وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء " فإذا كان كذلك وجب أن يكون استنوق مشتقاً من المصدر.
وكان قياس مصدره أن يكون معتلاً فيقال: استناقة كاستعانة واستشارة.
وذلك أنه وإن لم يكن تحته ثلاثي معتل كقام وباع فيلزم إجراؤه في الإعلال عليه فإن باب الفعل إذا كانت عينه أحد الحرفين أن يجيء معتلاً إلا ما يستثنى من ذلك نحو طاول وبايع وحول وعور واجتوروا واعتونوا لتلك العلل المذكورة هناك.
وليس باب أفعل ولا استفعل منه.
فلما كان الباب في الفعل ما ذكرناه من وجوب إعلاله وجب أيضاً أن يجيء استنوق ونحوه بالإعلال لاطراد ذلك في الفعل كما أن الاسم إذا كان على فاعل كالكاهل والغارب إلا أن عينه حرف علة لم يأت عنهم إلا مهموزاً وإن لم يجر على فعل ألا تراهم همزوا الحائش وهو اسم لا صفة ولا هو جار على فعل فأعلوا عينه وهي في الأصل واو من الحوش.
فإن قلت: فلعله جار على حاش جريان قائم على قام قيل: لم نرهم أجروه صفة ولا أعملوه عمل الفعل وإنما الحائش: البستان بمنزلة الصور وبمنزلة الحديقة.
فإن قلت: فإن فيه معنى الفعل لأنه يحوش ما فيه من النخل وغيره وهذا يؤكد كونه في الأصل صفة وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء كصاحب ووالد قيل: ما فيه من معنى الفعلية لا يوجب كونه صفة ألا ترى إلى قولهم: الكاهل والغارب وهما وإن كان فيهما معنى الاكتهال والغروب فإنهما اسمان.
ولا يستنكر أن يكون في الأسماء غير الجارية على الأفعال معاني الأفعال.
من ذلك قولهم: مفتاح ومنسج ومسعط ومنديل ودار ونحو ذلك تجد في كل واحد منها معنى الفعل وإن لم تكن جارية عليه.
فمفتاح من الفتح ومنسج من النسج ومسعط من الإسعاط ومنديل من الندل وهو التناول على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلاً زريق المال ندل الثعالب وكذلك دار: من دار يدور لكثرة حركة الناس فيها وكذلك كثير من هذه المشتقات تجد فيها معاني الأفعال وإن لم تكن جارية عليها.
فكذلك الحائش جاء مهموزاً وإن لم يكن اسم فاعل لا لشيء غير مجيئه على ما يلزم اعتلال عينه نحو قائم وبائع وصائم.
فاعرف ذلك.
وهو رأي أبي علي رحمه الله وعنه أخذته لفظاً ومراجعة وبحثاً.
ومثله سواء الحائط: هو اسم بمنزلة الركن والسقف وإن كان فيه معنى الحوط.
ومثله أيضاً العائر للرمد هو اسم مصدر بمنزلة الفالج والباطل والباغز وليس اسم فاعل ولا جارياً على معتل وهو كما تراه معتل.
فإن قلت: فما تقول في استعان وقد أعل وليس تحته معتل ألا تراك لا تقول: عان يعون كقام يقوم قيل: هو وإن لم ينطق بثلاثيه فإنه في حكم المنطوق به وعليه جاء أعان يعين.
وقد شاع الإعلال في هذا الأصل ألا تراهم قالوا: المعونة - فأعلوها كالمثوبة والمعوضة - والإعانة والاستعانة.
فأما المعاونة فكالمعاودة: صحت لوقوع الألف قبلها.
فلما اطرد الإعلال في جميع ذلك دل أن ثلاثيه وإن لم يكن مستعملاً فإنه في حكم ذلك.
وليس هذا بأبعد من اعتقاد موضع " أن " لنصب الأفعال في تلك الأجوبة وهي الأمر والنهي وبقية ذلك وإن لم تستعمل قط.
فإذا جاز اعتقاد ذلك وطرد المسائل عليه لدلالة الحال على ثبوته في النفس كان إعلال نحو أعان واستعان ومعين ومستعين والإعانة والاستعانة - لاعتقاد كون الثلاثي من ذلك في حكم الملفوظ به - أحرى وأولى.
وأيضاً فقد نطقوا من ثلاثية بالعون وهو مصدر وإذا ثبت أمر المصدر الذي هو الأصل لم يتخالج شك في الفعل الذي هو الفرع قال لي أبو علي بالشام: إذا صحت الصفة فالفعل في الكف.
وإذا كان هذا حكم الصفة كان في المصدر أجدر لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة ألا ترى أن في الصفة " ما ليس بمشتق " نحو قولك: مررت بإبل مائة ومررت برجل أبي عشرة أبوه ومررت بقاع عرفج كله ومررت بصحيفة طين خاتمها ومررت بحية ذراع طولها وليس هذا مما يشاب به المصدر وإنما هو ذلك الحدث الصافي كالضرب والقتل والأكل والشرب.
فإن قلت: ألا تعلم أن في الناقة معنى الفعل.
وذلك أنها من التنوق في الشيء وتحسينه قال ذو الرمة:
تنوقت به حضرميات الأكف الحوائك والتقاؤهما أن الناقة عندهم مما يتحسن به ويزدان بملكه وبالإبل يتباهون وعليها يحملون ويتحملون ولذلك قالوا لمذكرها: الجمل لأنه فَعَل من الجمال كما أن الناقة فعلة من التنوق.
وعلى هذا قالوا: قد كثر عليه المشاء والفشاء والوشاء إذا تناسل عليه المال.
فالوشاء فَعَال من الوشي كأن المال عندهم زينة وجمال لهم كما يلبس من الوشي للتحسن به.
وعلى ذلك قالوا: ما بالدار دبيج فهو فِعيل من لفظ الديباج ومعناه.
وذلك أن الناس هم الذين يشون الأرض وبهم تحسن وعلى أيديهم وبعمارتهم تجمل.
وعليه قالوا: إنسان لأنه فعلان من الأنس.
فقد ترى إلى توافي هذه الأشياء وتباين شعاعها وكونها عائدة إلى موضع واحد لأن التنوق والجمال والأنس والوشي والديباج مما يؤثر ويستحسن - وكنت عرضت هذا الموضع على أبي علي رحمه الله فرضيه وأحسن تقبله - فكذلك يكون استنوق من باب استحوذ من حاذ يحوذ من حيث كان في الناقة معنى الفعل من التنوق دون أن يكون بعيداً عنه كما رمت أنت في أول الفصل.
انقضى السؤال.
فالجواب أن استنوق أبعد عن الفعل من استحوذ على ما قدمنا.
فأما ما في الناقة من معنى الفعلية والتنوق فليس بأكثر مما في الحجر من معنى الاستحجار والصلابة فكما أن استحجر الطين واستنسر البغاث من لفظ الحجر والنسر فكذلك استنوق من لفظ الناقة والجميع ناء عن الفعل وما فيه من معنى الفعلية إنما هو كما في مفتاح ومدق ومنديل ونحو ذلك منه.
ومما ورد شاذاً عن القياس ومطرداً في الاستعمال قولهم: الحوكة والخونة.
فهذا من الشذوذ عن القياس على ما ترى وهو في الاستعمال منقاد غير متأب ولا تقول على هذا في جمع قائم: قومة ولا في صائم: صومة ولو جاء على فعلة ما كان إلا معلا.
وقد قالوا على القياس: خانة.
ولا تكاد تجد شيئاً من تصحيح نحو مثل هذا في الياء: لم يأت عنهم في نحو بائع وسائر بيعة ولا سيرة.
وإنما شذ من هذا مما عينه واو لا ياء نحو الحوكة والخونة والخول والدول.
وعلته عندي قرب الألف من الياء وبعدها عن الواو فإذا صحت نحو الحوكة كان أسهل من تصحيح نحو البيعة.
وذلك أن الألف لما قربت من الياء أسرع انقلاب الياء إليها فكان ذلك أسوغ من انقلاب الواو إليها لبعد الواو عنها ألا ترى إلى كثرة قلب الياء ألفاً استحساناً لا وجوباً نحو قولهم في طيء: طائي وفي الحيرة: حاري وقولهم في حيحيت وعيعيت وهيهيت: حاحيت وعاعيت وهاهيت.
وقلما ترى في الواو مثل هذا.
فإذا كان بين الألف والياء هذه الوصل والقرب كان تصحيح نحو بيعة وسيرة أشق عليهم من تصحيح نحو الحوكة والخونة لبعد الواو من الألف وبقدر بعدها عنها ما يقل انقلابها إليها.
ولأجل هذا الذي ذكرناه عندي ما كثر عنهم نحو اجتوروا واعتونوا واهتوشوا.
ولم يأت عنهم من هذا التصحيح شيء في الياء ألا تراهم لا يقولون: ابتيعوا ولا استيروا ولا نحو ذلك وإن كان في معنى تبايعوا وتسايروا.
وعلى أنه قد جاء حرف واحد من الياء في هذا فلم يأت إلا معلاً وهو قولهم: استافوا في معنى تسايفوا ولم يقولوا استيفوا لما ذكرناه من جفاء ترك قلب الياء ألفاً في هذا الموضع الذي قد قويت فيه داعية القلب.
وقد ذكرنا هذا في " كتابنا في شعر هذيل " بمقتضى الحال فيه.
وإن شذ الشيء في الاستعمال وقوى في القياس كان استعمال ما كثر استعماله أولى وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله.
من ذلك اللغة التميمية في " ما " هي أقوى قياساً وإن كانت الحجازية أسير استعمالاً.
وإنما كانت التميمية أقوى قياساً من حيث كانت عندهم ك " هل " في دخولها على الكلام مباشرة كل واحد من صدري الجملتين: الفعل والمبتدأ كما أن " هل " كذلك.
إلا أنك إذا استعملت أنت شيئاً من ذلك فالوجه أن تحمله على ما كثر استعماله وهو اللغة الحجازية ألا ترى أن القرآن بها نزل.
وأيضاً فمتى رابك في الحجازية ريب من تقديم خبر أو نقض النفي فزعت إذ ذاك إلى التميمية فكأنك من الحجازية على حرد وإن كثرت في النظم والنثر.
ويدلك على أن الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة غيرها أقوى في القياس عنده منها ما حدثنا به أبو علي رحمه الله قال: عن أبي بكر عن أبي العباس أن عمارة كان يقرأ {ولا الليل سابق النهار} بالنصب قال أبو العباس: فقلت له: ما أردت فقال: أردت {سابقٌ النهار} قال فقلت له فهلا قلته فقال: لو قلته لكان أوزن.
فقوله: أوزن أي أقوى وأمكن في النفس.
أفلا تراه كيف جنح إلى لغة وغيرها أقوى في نفسه منها.
ولهذا موضع نذكره فيه.
واعلم أنك إذا أداك القياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه.
فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخير: تستعمل أيهما شئت.
فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا عليه البتة وأعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعر مولد أو لساجع أو لضرورة لأنه على قياس كلامهم.
بذلك وصى أبو الحسن.
وإذا فشا الشيء في الاستعمال وقوى في القياس فذلك ما لا غاية وراءه نحو منقاد اللغة من النصب بحروف النصب والجر بحروف الجر والجزم بحروف الجزم وغير ذلك مما هو فاش في الاستعمال قوي في القياس.
وأما ضعف الشيء في القياس وقلته في الاستعمال فمرذول مطرح غير أنه قد يجيء منه اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس قالوا أراد: " اضربن عنك " فحذف نون التوكيد وهذا من الشذوذ في الاستعمال على ما تراه ومن الضعف في القياس على ما أذكره لك.
وذلك أن الغرض في التوكيد إنما هو التحقيق والتسديد وهذا مما يليق به الإطناب والإسهاب وينتفي عنه الإيجاز والاختصار.
ففي حذف هذه النون نقض الغرض.
فجرى وجوب استقباح هذا في القياس مجرى امتناعهم من ادغام الملحق نحو مهدد وقردد وجلبب وشملل وسهلل وقفعدد في تسليمه وترك التعرض لما اجتمع فيه من توالي المثلين متحركين ليبلغ المثال الغرض المطلوب في حركاته وسكونه ولو ادغمت لنقضت الغرض الذي اعتزمت.
ومثل امنتاعهم من نقض الغرض امتناع أبي الحسن من توكيد الضمير المحذوف المنصوب في نحو الذي ضربت زيد ألا ترى أنه منع أن تقول: الذي ضربت نفسه زيد على أن " نفسه " توكيد للهاء المحذوفة من الصلة.
ومما ضعف في القياس والاستعمال جميعاً بيت الكتاب: له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير فقوله: " كأنه " - بحذف الواو وتبقية الضمة - ضعيف في القياس قليل في الاستعمال.
ووجه ضعف قياسه أنه ليس على حد الوصل ولا على حد الوقف.
وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه كما تمكنت في قوله في أول البيت " لهو زجل " والوقف يجب أن تحذف الواو والضمة فيه جميعاً وتسكن الهاء فيقال: " كأنه " فضم الهاء بغير واو منزلة بين منزلتي الوصل والوقف.
وهذا موضع ضيق ومقام زلخ لا يتقيك بإيناس ولا ترسو فيه قدم قياس.
وقال أبو إسحاق في نحو هذا: إنه أجرى الوصل مجرى الوقف وليس الأمر كذلك لما أريتك من أنه لا على حد الوصل ولا على حد الوقف.
لكن ما أجري من نحو هذا في الوصل على حد الوقف قول الآخر: فظلت لدى البيت العتيق أخيله ومطواي مشتاقان له أرقان على أن أبا الحسن حكى أن سكون الهاء في هذا النحو لغة لأزد السراة.
ومثل هذا البيت ما رويناه عن قطرب من قول الشاعر: وأشرب الماء ما بي نحوه عطش إلا لأن عيونه سيل واديها ورويناه أيضاً عن غيره: إن لنا لكنة مبقة مفنة متيحة معنة سمعنة نظرنة فقوله " تره " مما أجرى في الوصل مجراه في الوقف أراد: إلا تر ثم بين الحركة في الوقف بالهاء فقال " تره " ثم وصل ما كان وقف عليه.
فأما قوله: أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا: الجن قلت: عموا ظلاما ويروي: .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
منون قالوا سراة الجن قلت عموا ظلاما فمن رواه هكذا فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف.
فإن قلت: فإنه في الوقف إنما يكون " منون " ساكن النون وأنت في البيت قد حركته فهذا إذاً ليس على نية الوقف ولا على نية الوصل فالجواب أنه لما أجراه في الوصل على حده في الوقف فأثبت الواو والنون التقيا ساكنين فاضطر حينئذ إلى أن حرك النون لإقامة الوزن.
فهذه الحركة إذاً إنما هي حركة مستحدثة لم تكن في الوقف وإنما اضطر إليها الوصل: وأما من رواه " منون أنتم " فأمره مشكل.
وذلك أنه شبه من بأي فقال: " منون أنتم " على قوله: أيون أنتم وكما حمل ههنا أحدهما على الآخر كذلك جمع بينهما في أن جرد من الاستفهام كل منهما ألا ترى إلى حكاية يونس عنهم: ضرب من منا كقولك: ضرب رجل رجلاً.
فنظير هذا في وأسماء ما أسماء ليلة أدلجت إلي وأصحابي بأي وأينما فجعل " أي " اسماً للجهة فلما اجتمع فيها التعريف والتأنيث منعها الصرف.
وأما قوله: " وأينما " ففيه نظر.
وذلك أنه جرده أيضاً من الاستفهام كما جرد أي فإذا هو فعل ذلك احتمل هنا من بعد أمرين: أحدهما أن يكون جعل " أين " علماً أيضاً للبقعة فمنعها الصرف للتعريف والتأنيث كأي فتكون الفتحة في آخر " أين " على هذا فتحة الجر وإعراباً مثلها في مررت بأحمد.
فتكون " ما " على هذا زائدة و " أين " وحدها هي الاسم كما كانت " أي " وحدها هي الاسم.
والآخر أن يكون ركب " أين " مع " ما " فلما فعل ذلك فتح الأول منهما كفتحة الياء من حيهل لما ضم حي إلى هل فالفتحة في النون على هذا حادثة للتركيب وليست بالتي كانت في أين وهي استفهام لأن حركة التركيب خلفتها ونابت عنها.
وإذا كانت فتحة التركيب تؤثر في حركة الإعراب فتزيلها إليها نحو قولك: هذه خمسة معرب ثم تقول في التركيب: هذه خمسة عشر فتخلف فتحة التركيب ضمة الإعراب على قوة حركة الإعراب كان إبدال حركة البناء من حركة البناء أحرى بالجواز وأقرب في القياس.
وإن شئت قلت: إن فتحة النون في قوله: " بأي وأينما " هي الفتحة التي كانت في أين وهي استفهام من قبل تجريدها أقرها بحالها بعد التركيب على ما كانت عليه ولم يحدث خالفاً لها من فتحة التركيب واستدللت على ذلك بقولهم: قمت إذ قمت فالذال كما ترى ساكنة ثم لما ضم إليها " ما " وركبها معها أقرها على سكونها فقال: إذ ما أتيت على الرسول فقل له فكما لا يشك في أن هذا السكون في " إذ ما " هو السكون في ذال إذ فكذلك ينبغي أن تكون فتحة النون من " أينما " هي فتحة النون من " أين " وهي استفهام.
والعلة في جواز بقاء الحال بعد التركيب على ما كانت عليه قبله عندي هي أن ما يحدثه التركيب من الحركة ليس بأقوى مما يحدثه العامل فيها ونحن نرى العامل غير مؤثر في المبني نحو " من أين أقبلت " و " إلى أين تذهب " فإذا كان حرف الجر على قوته لا يؤثر في حركة البناء فحدث التركيب - على تقصيره عن حدث الجار - أحرى بألا يؤثر في حركة البناء.
فاعرف ذلك فرقاً وقس عليه تصب إن شاء الله.
وفي ألف " ما " من " أينما " - على هذا القول - تقدير حركة إعراب: فتحة في موضع الجر لأنه لا ينصرف.
وإن شئت كان تقديره " منون " كالقول الأول ثم قال: " أنتم " أي أنتم المقصودون بهذا الاستثبات كقوله: إذا أراد: أنت الهالك.
وما يرد في هذه اللغة مما يضعف في القياس ويقل في الاستعمال كثير جداً وإن تقصيت بعضه طال ولكن أضع لك منه ومن غيره من أغراض كلامهم ما تستدل به وتستغني ببعضه من كله بإذن الله وطَوله.
باب في الاستحسان
وجماعه أن علته ضعيفة غير مستحكمة إلا أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف.
من ذلك تركك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة نحو قولهم: الفتوى والبقوى والتقوى والشروى ونحو ذلك ألا ترى أنهم قلبوا الياء هنا واواً من غير استحكام علة أكثر من أنهم أرادوا الفرق بين الاسم والصفة.
وهذه ليست علة معتدة ألا تعلم كيف يشارك الاسم الصفة في أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها.
من ذلك قولهم في تكسير حسن: حِسان فهذا كجبل وجبال وقالوا: فرس وَرد وخيل وُرد فهذا كسَقف وسُقف.
وقالوا: رجل غفور وقوم غُفُر وفخور وفخر فهذا كعمود وعمد.
وقالوا: جمل بازل وإبل بوازل وشغل شاغل وأشغال شواغل فهذا كغارب وغوارب وكاهل وكواهل.
ولسنا ندفع أن يكونوا قد فصلوا بين الاسم والصفة في أشياء غير هذه إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علة وليس بجار مجرى رفع الفاعل ونصب المفعول ألا ترى أنه لو كان الفرق بينهما واجباً لجاء في جميع الباب كما أن رفع الفاعل ونصب المفعول منقاد في جميع الباب.
حتى لحقنا بهم تعدى فوارسنا كأننا رعن قف يرفع الآلا فرفع المفعول ونصب الفاعل قيل لو لم يحتمل هذا البيت إلا ما ذكرته لقد كان على سمت من القياس ومطرب متورد بين الناس ألا ترى أنه على كل حال قد فرق فيه بين الفاعل والمفعول وإن اختلفت جهتا الفرق.
كيف ووجهه في أن يكون الفاعل فيه مرفوعاً والمفعول منصوباً قائم صحيح مقول به.
وذلك أن رعن هذا القف لما رفعه الآل فرئي فيه ظهر به الآل إلى مرآة العين ظهوراً لولا هذا الرعن لم يبن للعين فيه بيانه إذا كان فيه ألا تعلم أن الآل إذا برق للبصر رافعاً شخصاً كان أبدى للناظر إليه منه لو لم يلاق شخصاً يزهاه فيزداد بالصورة التي حملها سفوراً وفي مسرح الطرف تجلياً وظهوراً.
فإن قلت: فقد قال الأعشى: إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفعا فجعل الآل هو الفاعل والشخص هو المفعول قيل ليس في هذا أكثر من أن هذا جائز وليس فيه دليل على أن غيره غير جائز ألا ترى أنك إذا قلت ما جاءني غير زيد فإنما في هذا دليل على أن الذي هو غيره لم يأتك فأما زيد نفسه فلم تعرض للإخبار بإثبات مجيء له أو نفيه عنه فقد يجوز أن يكون قد جاء وأن يكون أيضاً لم يجيء.
فإن قلت: فهل تجد لبيت الجعدي على تفسيرك الذي حكيته ورأيته نظيراً قيل: لا ينكر وجود ذلك مع الاستقراء واعمل فيما بعد على أن لا نظير له ألا تعلم أن القياس إذا أجاز شيئاً وسمع ذلك الشيء عينه فقد ثبت قدمه وأخذ من الصحة والقوة مأخذه ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير لأن إيجاد النظير وإن كان مأنوساً به فليس في واجب النظر إيجاده ألا ترى أن قولهم: في شنوءة شنَئي لما قبله القياس لم يقدح فيه عدم نظيره نعم ولم يرض له أبو الحسن بهذا القدر من القوة حتى جعله أصلاً يرد إليه ويحمل غيره عليه.
وسنورد فيما بعد باباً لما يسوغه القياس وإن لم يرد به السماع بإذن الله وحوله.
ومن ذلك - أعني الاستحسان - أيضاً قول الشاعر: أريت إن جئت به أملودا مرجلاً ويلبس البرودا أقائلن أحضروا الشهودا فألحق نون التوكيد اسم الفاعل تشبيهاً له بالفعل المضارع.
فهذا إذاً استحسان لا عن قوة علة ولا عن استمرار عادة ألا تراك لا تقول: أقائمن يا زيدون ولا أمنطلقن يا رجال إنما تقوله بحيث سمعته وتعتذر له وتنسبه إلى أنه استحسان منهم على ضعف منه واحتمال بالشبهة له.
ومن الاستحسان قولهم: ِصبية وقِنية وعِذىُ وبِلىُسفر وناقة عليان ودبة مهيار.
فهذا كله استحسان لا عن استحكام علة.
وذلك أنهم لم يعتدوا الساكن حائلاً بين الكسرة والواو لضعفه وكله من الواو.
وذلك أن " قنية " من قنوت ولم يثبت أصحابنا قنيت وإن كان البغداديون قد حكوها و " صبية " من صبوت و " علية " من علوت و " عذى " من قولهم أرضون عذوات و " بلى " سفر من قولهم في معناه: بِلوٌ أيضاً ومنه البلوى وإن لم يكن فيها دليل إلا أن الواو مطردة في هذا الأصل قال: فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو وهو راجع إلى معنى بلوسفر وقالوا: فلان مبلو بمحنة وغير ذلك والأمر فيه واضح وناقة " عليان " من علوت أيضاً كما قيل لها: ناقة سناد أي أعلاها متساند إلى أسفلها ومنه سندنا إلى الجبل أي علونا وقال الأصمعي قيل لأعرابي: ما الناقة القرواح فقال: التي كأنها تمشي على أرماح ودبة " مهيار " من قولهم هار يهور وتهور الليل على أن أبا الحسن قد حكى فيه هار يهير وجعل الياء فيه لغة وعلى قياس قول الخليل في طاح يطيح وتاه يتيه لا يكون في يهير دليل لأنه قد يمكن أن يكون: فَعِل يَفعِل مثلهما.
وكله لا يقاس ألا تراك لا تقول في جرو: جِرى ولا في عِدوة الوادي: عِدية ولا نحو ذلك.
ولا يجوز في قياس قول من قال عليان ومهيار أن تقول في قرواح ودرواس: قرياح ودرياس وذلك لئلا يلتبس مثال فعوال بفعيال فيصير قرياح ودرياس كسرياح وكرياس.
وإنما يجوز هذا فيما كانت واوه أصلية لا زائدة وذلك أن الأصلي يحفظ نفسه بظهوره في تصرف أصله ألا تراك إذا قلت: علية ثم قلت: علوت وعلو وعلوة وعلاوة ويعلو ونحو ذلك دلك وجود الواو في تصرف هذا الأصل على أنها هي الأصلية وأن الياء في علية بدل منها وأن الكسرة هي التي عذرت بعض العذر في قلبها وليس كذلك الزائد ألا تراه لا يستمر في تصرف الأصل استمرار الأصلي فإذا عرض له عارض من بدل أو حذف لم يبق هناك في أكثر الأمر ما يدل عليه وما يشهد به ألا تراك لو حقرت قرياحاً بعد أن أبدلت واوه ياء على حذف زوائده لقلت: قريح فلم تجد للواو أثراً يدلك على أن ياء قرياح بدل من الواو كما دلك علوت وعلو ورجل معلو بالحجة ونحو ذلك على أن ياء " علية " بدل من الواو.
فإن قلت: فقد قالوا في قرواح: قرياح أيضاً سمعاً جميعاً فإن هذا ليس على إبدال الياء من الواو لا بل كل واحد منها مثال برأسه مقصود قصده.
فقرواح كقرواش وجلواخ وقرياح ككرياس وسرياح ألا ترى أن أحداً لا يقول: كرواس ولا سرواح ولا يقول أحد أيضاً في شرواط وهلواع: شرياط ولا هلياع.
وهذا أحد ما يدلك على ضعف القلب فيما هذه صورته لأن القلب للكسرة مع الحاجز لو كان قوياً في القياس لجاء في الزائد مجيئه في الأصلي كأشياء كثيرة من ذلك.
ومثل امتناعهم من قلب الواو في نحو هذا ياء من حيث كانت زائدة فلا عصمة لها ولا تلزم لزوم الأصلي فيعرف بذلك أصلها أن ترى الواو الزائدة مضمومة ضماً لازماً ثم لا ترى العرب أبدلتها همزة كما أبدلت الواو الأصلية نحو أُجوه وأُقٍتت.
وذلك نحو الترهوك والتدهور والتسهوك: لا يقلب أحد هذه الواو - وإن انضمت ضماً لازماً - همزة من قبل أنها زائدة فلو قلبت فقيل: الترهؤك لم يؤمن أن يظن أنها همزة أصلية غير مبدلة من واو.
فإن قلت: ما تنكر أن يكون تركهم قلب هذه الواو همزة مخافة أن تقع الهمزة بعد الهاء وهما حلقيان وشديدا التجاور قيل يفسد هذا أن هذين الحرفين قد تجاورا والهاء مقدمة على الهمزة نحو قولهم: هأهأت في الدعاء.
فإن قلت: هذا إنما جاء في التكرير والتكرير قد يجوز فيه ما لولاه لم يجز ألا ترى أن الواو لا توجد منفردة في ذوات الأربعة إلا في ذلك الحرف وحده وهو " ورنتل " ثم إنها قد جاءت مع التكرير مجيئاً متعالماً نحو وحوح ووزوز ووكواك ووزاوزة وقوقيت وضوضيت وزوزيت وموماة ودوداة وشوشاة قيل: قد جاء امتناعهم من همز نظير هذه الواوات بحيث لا هاء.
ألا تراهم قالوا: زحولته فتزحول تزحولاً وليس أحد يقول تزحؤلاً.
وقد جمعوا بينهما متقدمة الحاء على الهمزة: نحو قولهم في الدعاء: حؤ حؤ.
فإن قيل: فهذا أيضاً إنما جاء في الأصوات المكررة كما جاء في الأول أيضاً في الأصوات المكررة نحو هؤ هؤ وقد ثبت أن التكرير محتمل فيه ما لا يكون في غيره.
قيل هذه مطاولة نحن فتحنا لك بابها وشرعنا منهجها ثم إنها مع ذلك لا تصحبك ولا تستمر بك ألا تراهم قد قالوا في " عنونت الكتاب ": إنه يجوز أن يكون فعولت من عن يعن ومطاوعه تعنون ومصدره التعنون وهذه الواو لا يجوز همزها لما قدمنا ذكره وأيضاً فقد قالوا في علونته: يجوز أن يكون فعولت من العلانية وحاله في ذلك حال عنونته على ما مضى.
وقد قالوا أيضاً: سرولته تسرولاً ولم يهمزوا هذه الواو لما ذكرنا.
فإن قيل: فلو همزوا فقالوا: التسرؤل لما خافوا لبساً لقولهم مع زوال الضمة عنها: تسرول وسرولته ومسرول كما أنهم لما قالوا: وقت وأوقات وموقت ووقًته أعلمهم ذلك أن همزة " أُقتت " إنما هي بدل من واو.
فقد ترى الأصل والزائد جميعاً متساويين متساوقين في دلالة الحال بما يصحب كل واحد منهما من تصريفه وتحريفه وفي هذا نقض لما رمت به الفصل بين الزائد والأصل.
قيل كيف تصرفت الحال فالأصل أحفظ لنفسه وأدل عليها من الزائد ألا ترى أنك لو حقرت تسرولاً - وقد همزته - تحقير الترخيم لقلت " سريل " فحذفت الزائد ولم يبق معك دليل عليه ولو حقرت نحو " أقتت " - وقد نقلتها إلى التسمية فصارت " أقتة " - تحقير الترخيم لقلت: وقيته وظهرت الواو التي هي فاء.
فإن قلت: فقد تجيز ههنا أيضاً " أقيتة " قيل الهمز ههنا جائز لا واجب وحذف الزوائد من " تسرؤل " في تحقير الترخيم واجب لا جائز.
فإن قلت: وكذلك همز الواو في " تسرؤل " إنما يكون جائزاً أيضاً لا واجباً قيل همز الواو حشواً أثبت قدماً من همزها مبتدأة أعني في بقائها وإن زالت الضمة عنها ألا ترى إلى قوله في تحقير قائم: قويئم وثبات الهمزة وإن زالت الألف الموجبة لها فجرت لذلك مجرى الهمزة الأصلية في نحو سائل وثائر من سأل وثأر - كذا قال - فلذلك اجتنبوا أن يهمزوا واو " تسرول " لئلا تثبت قدم الهمزة فيرى أنها ليست بدلاً وليس كذلك همزة " أقتت " ألا ترى تراها متى زالت الضمة عنها عادت واواً نحو موقت ومويقت.
فإن قلت: فهلا أجازوا همز واو " تسرول " وأمنوا اللبس وإن قالوا في تحقير ترخيمه " سريل " من حيث كان وسط الكلمة ليس بموضع لزيادة الهمزة إنما هو موضع زيادة الواو نحو جدول وخِروع وعجوز وعمود.
فإذا رأوا الهمزة موجودة في " تسرؤل " محذوفة من " سريل " علموا - بما فيها مكن الضمة - أنها بدل من واو زائدة فكان ذلك يكون أمناً من اللبس قيل: قد زادوا الهمزة وسطاً في أحرف صالحة.
وهي شمأل وشأمل وجرائض وحطائط بطائط ونِئذلان وتأبل وخأتم وعألم وتأبلت القدر والرئبال.
فلما جاء ذلك كرهوا أن يقربوا باب لبس.
فإن قلت: فإن همزة تأبل وخأتم والعألم إنما هي بدل من الألف قيل: هي وإن كانت بدلاً فإنها بدل من الزائد والبدل من الزائد زائد وليس البدل من الأصل بأصل.
فقد ترى أن حال البدل من الزائد أذهب به في حكم ما هو بدل منه من الأصل في ذلك.
فاعرف هذا.
ومن الاستحسان قولهم: رجل غديان وعشيان وقياسه: غدوان وعشوان لأنهما من غدوت وعشوت أنشدنا أبو علي: بات ابن أسماء يعشوه ويصبحه من هجمة كأشاء النخل درار ومثله أيضاً دامت السماء تديم ديماً وهو من الواو لاجتماع العرب طراً على " الدوام " و " هو أدوم من كذا ".
ومن ذلك ما يخرج تنبيهاً على أصل بابه نحو استحوذ وأغيلت المرأة وصددت فأطولت الصدود.
فإنه أهل لأن يؤكرما ونظائره كثيرة غير أن ذلك يخرج ليعلم به أن أصل استقام استقوم وأصل مقامة مقومة وأصل يحسن يؤحسن.
ولا يقاس هذا ولا ما قبله لأنه لم تستحكم علته وإنما خرج تنبيهاً وتصرفاً واتساعاً.
باب في تخصيص العلل
اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومتصرف أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل.
وذلك أنها وإن تقدمت علل الفقه فإنها أو أكثرها إنما تجري مجرى التخفيف والفرق ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكناً - وإن كان على غير قياس - ومستثقلاً ألا تراك لو تكلفت تصحيح فاء ميزان وميعاد لقدرت على ذلك فقلت: مِوزان وموعاد.
وكذلك لو آثرت تصحيح فاء موسر وموقن لقدرت على ذلك فقلت: ميسر وميقن.
وكذلك لو نصبت الفاعل ورفعت المفعول أو ألغيت العوامل: من الجوار والنواصب والجوازم لكنت مقتدراً على النطق بذلك وإن نفى القياس تلك الحال.
وليست كذلك علل المتكلمين لأنها لا قدرة على غيرها ألا ترى أن اجتماع السواد والبياض في محل واحد ممتنع لا مستكره وكون الجسم متحركاً ساكناً في حال واحدة فاسد.
لا طريق إلى ظهوره ولا إلى تصوره.
وكذلك ما كان من هذا القبيل.
فقد ثبت بذلك تأخر علل النحويين عن علل المتكلمين وإن تقدمت علل المتفقهين.
أحدهما ما لا بد منه فهو لاحق بعلل المتكلمين وهو قلب الألف واواً لانضمام ما قبلها وياء لانكسار ما قبلها نحو ضورب وقراطيس وقد تقدم ذكره.
ومن ذلك امتناع الابتداء بالساكن وقد تقدم ما فيه.
ثم يبقى النظر فيما بعد فنقول: إن هذه العلل التي يجوز تخصيصها كصحة الواو إذا اجتمعت مع الياء وسبقت الأولى منهما بالسكون نحو حيوة وعوى الكلب عوية ونحو صحة الواو والياء في نحو غزوا ورميا والنزوان والغليان وصحة الواو في نحو اجتوروا واعتونوا واهتوشوا إنما اضطر القائل بتخصيص العلة فيها وفي أشباهها لأنه لم يحتط في وصف العلة ولو قدم الاحتياط فيها لأمن الاعتذار بتخصيصها.
وذلك أنه إذا عقد هذا الموضع قال في علة قلب الواو والياء ألفاً: إن الواو والياء متى تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين نحو قام وباع وغزا ورمى وباب وعاب وعصا ورحى فإذا أدخل عليه فقيل له: قد صحتا في نحو غزوا ورميا وغزوان وصميان وصحت الواو خاصة في نحو اعتونوا واهتوشوا أخذ يتطلب ويتعذر فيقول: إنما صحتا في نحو رميا وغزوا مخافة أن تقلبا ألفين فتحذف إحداهما فيصير اللفظ بهما: غزا ورمى فتلتبس التثنية بالواحد.
وكذلك لو قلبوهما ألفين في نحو نفيان ونزوان لحذفت إحداهما فصار اللفظ بهما نفان ونزان فالتبس فعلان مما لامه حرف علة بفعال مما لامه نون.
وكذلك يقولون: صحت الواو في نحو اعتونوا واهتوشوا لأنهما في معنى ما لا بد من صحته أعني تعاونوا وتهاوشوا.
وكذلك يقولون: صحتا في نحو عور وصيد لأنهما في معنى اعور واصيد وكذلك يقولون في نحو بيت الكتاب: وما مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمه حي أبوه يقاربه إنما جاز ما فيه من الفصل " بين ما لايحسن " فصله لضرورة الشعر.
وكذلك ما جاء من قصر الممدود ومد المقصور وتذكير المؤنث وتأنيث المذكر ومن وضع الكلام في غير موضعه يحتجون في ذلك وغيره بضرورة الشعر ويجنحون إليها مرسلة غير متحجرة وكذلك ما عدا هذا: يسوون بينه ولا يحتاطون فيه فيحرسوا أوائل التعليل له.
وهذا هو الذي نتق عليهم هذا الموضع حتى اضطرهم إلى القول بتخصيص العلل وأصارهم إلى حيز التعذر والتمحل.
وسأضع في ذلك رسماً يقتاس فينتفع به بإذن الله ومشيئته.
وذلك أن نقول في علة قلب الواو والياء ألفاً: إنهما متى تحركتا حركة لازمة وانفتح ما قبلهما وعرى الموضع من اللبس أو أن يكون في معنى ما لا بد من صحة الواو والياء فيه أو أن يخرج على الصحة منبهة على أصل بابه فإنهما يقلبان ألفاً.
ألا ترى أنك إذا احتطت في وصف العلة بما ذكرناه سقط عنك الاعتراض عليك بصحة الواو والياء في حوبة وجيل إذ كانت الحركة فيهما وكذلك يسقط عنك الإلزام لك بصحة الواو والياء في نحو قوله تعالى {لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ} وفي قولك في تفسير قوله عز وجل {وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ}: معناه: أي امشوا.
فتصح الياء والواو متحركتين مفتوحاً ما قبلهما من حيث كانت الحركة فيهما لالتقاء الساكنين فلم يعتد لذلك.
وكذلك يسقط عنك الاعتراض بصحة الواو والياء في عور وصيد بأنهما في معنى ما لا بد فيه من صحة الواو والياء وهما اعور واصيد.
وكذلك صحت في نحو اعتونوا وازدوجوا لما كان في معنى ما لا بد فيه من صحتها وهو تعاونوا وتزاوجوا.
وكذلك صحتا في كروان وصميان مخافة أن يصيرا من مثال فعلان واللام معتلة إلى فعال واللام صحيحة وكذلك صحتا في رجل سميته بكروان وصميان ثم رخمته ترخيم قولك يا حار فقلت: يا كرو ويا صمى لأنك لو قلبتهما فيه فقلت: يا كرا ويا صما لالتبس فعلان بفعل ولأن الألف والنون فيهما مقدرتان أيضاً فصحتا كما صحتا وهما موجودتان.
وكذلك صحت أيضاً الواو والياء في قوله عز اسمه {وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ} وقوله تعالى {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ} وقوله تعالى {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا} من حيث كانت الحركة عارضة لالتقاء الساكنين غير لازمة.
وكذلك صحتا في القود والحوكة والغيب تنبيهاً على أصل باب ودار وعاب.
أفلا ترى إلى احتياطك في العلة كيف أسقط عنك هذه الالتزامات كلها ولو لم تقدم الأخذ بالحزم لاضطررت إلى تخصيص العلة وأن تقول: هذا من أمره.
وهذا من حاله.
والعذر في كذا وكذا.
وفي كذا وكذا.
وأنت إذا قدمت ذلك الاحتياط لم يتوجه عليك سؤال لأنه متى قال لك: فقد صحت الياء والواو في جيل وحوبة قلت: هذا سؤال يسقطه ما تقدم إذ كانت الحركة عارضة لا لازمة ولو لم تحتط بما قدمت لأجاءتك الحال إلى تمحل الاعتذار.
وهذا عينه موجود في العلل الكلامية ألا ترى أنك تقول في إفساد اجتماع الحركة والسكون على المحل الواحد: لو اجتمعا لوجب أن يكون المحل الواحد ساكناً متحركاً في حال واحدة ولولا قولك: في حال واحدة لفسدت العلة ألا ترى أن المحل الواحد قد يكون ساكناً متحركاً في حالين اثنين.
فقد علمت بهذا وغيره مما هو جار مجراه قوة الحاجة إلى الاحتياط في تخصيص العلة.
فإن قلت: فأنت إذا حصل عليك هذا الموضع لم تلجأ في قلب الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما ألفين إلا إلى الهرب من اجتماع الأشباه وهي حرف العلة والحركتان اللتان اكتنفتاه وقد علم مضارعة الحركات لحروف اللين وهذا أمر موجود في قام وخاف وهاب كوجوده في حوِل وعوِر وصيِد وعيِن ألا ترى أن أصل خاف وهاب: خوِف وهيِب فهما في الأصل كحول وصيد وقد تجشمت في حول وصيد من الصحة ما تحاميته في خوف وهيب.
فأما احتياطك بزعمك في العلة بقولك: إذا عرى الموضع من اللبس وقولك: إذا كان في معنى ما لا بد من صحته وقولك: وكانت الحركة غير لازمة فلم نرك أوردته إلا لتستثنى به ما يورده الخصم عليك: مما صح من الياء والواو وهو متحرك وقبله فتحة.
وكأنك إنما جئت إلى هذه الشواذ التي تضطرك إلى القول بتخصيص العلل فحشوت بها حديث علتك لاغير وإلا فالذي أوجب القلب في خاف وهاب من استثقال حرفي اللين متحركين مفتوحاً ما قبلهما موجود البتة في حول وصيد وإذا كان الأمر كذلك دل على انتقاض العلة وفسادها.
قيل: لعمري إن صورة حول وصيد لفظاً هي صورة خوف وهيب إلا أن هناك من بعد هذا فرقاً وإن صغر في نفسك وقل في تصورك وحسك فإنه معنى عند العرب مكين في أنفسها متقدم في إيجابه التأثير الظاهر عندها.
وهو ما أوردناه وشرطناه: من كون الحركة غير لازمة وكون الكلمة في معنى ما لا بد من صحة حرف لينه ومن تخوفهم التباسه بغيره فإن العرب - فيما أخذناه عنها وعرفناه من تصرف مذاهبها - عنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظها.
وسنفرد لهذا باباً نتقصاه فيه بمعونة الله.
أولا تعلم عاجلاً إلى أن تصير إلى ذلك الباب آجلاً أن سبب إصلاحها ألفاظها وطردها إياها على المثل والأحذية التي قننتها لها وقصرتها عليها إنما هو لتحصين المعنى وتشريفه والإبانة عنه وتصويره ألا ترى أن استمرار رفع الفاعل ونصب المفعول إنما هو للفرق بين الفاعل والمفعول وهذا الفرق أمر معنوي أصلح اللفظ له وقيد مقادة الأوفق من أجله.
فقد علم بهذا أن زينة الألفاظ وحليتها لم يقصد بها إلا تحصين المعاني وحياطتها.
فالمعنى إذاً هو المكرم المخدوم واللفظ هو المبتذل الخادم.
وبعد فإذا جرت العادة في معلولها واستتبت على منهجها وأمها قوى حكمها واحتمى جانبها ولم يسع أحداً أن يعرض لها إلا بإخراجه شيئاً إن قدر على إخراجه منها.
فأما أن يفصلها ويقول: بعضها هكذا وبعضها هكذا فمردود عليه ومرذول عند أهل النظر فيما جاء به.
وذلك أن مجموع ما يورده المعتل بها هو حدها ووصفها فإذا انقادت وأثرت وجرت في معلولاتها فاستمرت لم يبق على بادئها وناصب نفسه للمراماة عنها بقية فيطالب بها ولا قصمة سواك فيفك يد ذمته عنها.
فإن قلت: فقد قال الهذلي: استاف فقد كنت قلت في هذه اللفظة في كتابي في ديوان هذيل: إنه إنما أعلت هذه العين هناك ولم تصح كما صحت عين اجتوروا واعتونوا من حيث كان ترك قلب الياء ألفاً أثقل عليهم من ترك قلب الواو ألفاً لبعد ما بين الألف والواو وقربها من الياء وكلما تدانى الحرفان أسرع انقلاب أحدهما إلى صاحبه وانجذابه نحوه وإذا تباعدا كانا بالصحة والظهور قمناً.
وهذا - لعمري - جواب جرى هناك على مألوف العرف في تخصيص العلة.
فأما هذا الموضع فمظنة من استمرار المحجة واحتماء العلة.
وذلك أن يقال: إن استاف هنا لا يراد به تسايفوا أي تضاربوا بالسيوف فتلزم صحته كصحة عين تسايفوا كما لزمت صحة اجتوروا لما كان في معنى ما لا بد من صحة عينه وهو تجاوروا بل تكون استافوا هنا: تناولوا سيوفهم وجردوها.
ثم يعلم أنهم تضاربوا مما دل عليه قولهم: استافوا فكأنه من باب الاكتفاء بالسبب عن المسبب كقوله: ذر الآكلين الماء ظلماً فما أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء يريد قوماً كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلونه فاكتفى بكر الماء الذي هو سبب المأكول من ذكر المأكول.
فأما تفسير أهل اللغة أن استاف القوم في معنى تسايفوا فتفسير على المعنى كعادتهم في أمثال ذلك ألا تراهم قالوا في قول الله عز وجل {مِن مَّاء دَافِقٍ}: إنه بمعنى مدفوق فهذا - لعمري - معناه غير أن طريق الصنعة فيه أنه ذو دفق كما حكاه الأصمعي عنهم من قولهم: ناقة ضارب إذا ضربت وتفسيره أنها ذات ضرب أي ضربت.
وكذلك قوله تعالى {لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ} أي لا ذا عصمة وذو العصمة يكون مفعولاً كما يكون فاعلاً فمن هنا قيل: إن معناه: لا معصوم.
وكذلك قوله: لقد عيل الأيتام طعنة ناشره أناشر لا زالت يمينك آشره أي ذات أشر والأشر: الحز والقطع وذو الشيء قد يكون مفعولاً كما يكون فاعلاً وعلى ذلك عامة باب طاهر وطالق وحائض وطامث ألا ترى أن معناه: ذات طهر وذات طلاق وذات حيض وذات طمث.
فهذه ألفاظ ليست جارية على الفعل لأنها لو جرت عليه للزم إلحاقها تاء التأنيث كما لحقت نفس الفعل.
وعلى هذا قول الله تعالى {فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} أي ذات رضا فمن هنا صارت بمعنى مرضية.
ولو جاءت مذكرة لكانت كضارب وبازل كباب حائض وطاهر إذ الجميع غير جار على الفعل لكن قوله تعالى {رَّاضِيَةٍ} كقوله لا زالت يمينك آشرة.
وينبغي أن يعلم أن هذه التاء في " راضية " و " آشرة " ليست التاء التي يخرج بها اسم الفاعل على التأنيث لتأنيث الفعل من لفظه لأنها لو كانت تلك لفسد القول ألا ترى أنه لا يقال: ضربت الناقة ولا رضيت العيشة.
وإذا لم تكن إياها وجب أن تكون التي للمبالغة كفروقة وصرورة وداهية وراوية مما لحقته التاء للمبالغة والغاية.
وحسن ذلك أيضاً شيء آخر.
وهو جريانها صفة على مؤنث وهي بلفظ الجاري على الفعل فزاد ذلك فيما ذكرناه ألا ترى إلى همز حائض وإن لم يجر على الفعل إنما سببه أنه شابه في اللفظ ما اطرد همزه من الجاري على الفعل نحو قائم وصائم وأشباه ذلك.
ويدلك على أن عين حائض همزة وليست ياء خالصة - كما لعله يظنه كذلك ظان - قولهم: امرأة زائر من زيارة النساء وهذا واضح ألا ترى أنه لو كانت العين صحيحة لوجب ظهورها واواً وأن يقال: زاور.
وعليه قالوا: الحائش والعائر للرمد وإن لم يجريا على الفعل لما جاءا مجيء ما يجب همزه وإعلاله في غالب الأمر.
نعم وإذا كانوا قد أنثوا المصدر لما جرى وصفاً على المؤنث نحو امرأة عدلة وفرس طوعة القياد وقول أمية: والحية الحتفة الرقشاء أخرجها من جحرها آمنات الله والكلم وإذا جاز دخول التاء على المصادر وليست على صورة اسم الفاعل ولا هي الفاعل في الحقيقة وإنما استهوى لذلك جريها وصفاً على المؤنث كان باب " عيشة راضية " و " يد آشرة " أحرى بجواز ذلك فيه وجريه عليه.
فإن قلت: فقد قالوا في يوجل: ياجل وفي ييأس: ياءس وفي طيئي طائي وقالوا: حاحيت وعاعيت وهاهيت فقلبوا الياء والواو هنا ألفين وهما ساكنتان وفي هذا نقض لقولك ألا تراك إنما جعلت علة قلب الواو والياء ألفين تلك الأسباب التي أحدها كونهما متحركتين وأنت تجدهما ساكنتين ومع ذلك فقد تراهما منقلبتين.
قيل: ليس هذا نقضاً ولا يراه أهل النظر قدحاً.
وذلك أن الحكم الواحد قد يكون معلولاً بعلتين ثنتين في وقت واحد تارة وفي وقتين اثنين.
وسنذكر ذلك في باب المعلول بعلتين.
فإن قلت: فما شرطك واحتياطك في باب قلب الواو ياء إذا اجتمعت مع الياء في نحو سيد وهين وجيد وشويت شياً ولويت يده لياً وقد تراهم قالوا: حيوة وضيون وقالوا عوى الكلب عوية وقالوا في تحقير أسود وجدول: جديول وأسيود وأجازوا قياس ذلك فيما كان مثله: مما واوه عين متحركة أو زائدة قبل الطرف فالذي نقول في هذا ونحوه: أن الياء والواو متى اجتمعتا وسبقت الأولى بالسكون منهما ولم تكن الكلمة علماً ولا مراداً بصحة واوها التنبيه على أصول أمثالها ولا كانت تحقيراً محمولاً على تكسير فإن الواو منه تقلب ياء.
فإذا فعلت هذا واحتطت للعلة به أسقطت تلك الإلزامات عنك ألا ترى أن " حيوة " علم والأعلام تأتي مخالفة للأجناس في كثير من الأحكام وأن " ضيون " إنما صح لأنه خرج على الصحة تنبيهاً على أن أصل سيد وميت: سيود وميوت.
وكذلك " عوية " خرجت سالمة ليعلم بذلك أن أصل لية لوية وأن أصل طية طوية وليعلم أن هذا الضرب من التركيب وإن قل في الاستعمال فإنه مراد على كل حال.
وكذلك أجازوا تصحيح نحو أسيود وجديول إرادة للتنبيه على أن التحقير والتكسير في هذا النحو من المثل من قبيل واحد.
فإن قلت: فقد قالوا في العلم أسيد فأعلوا كما أعلوا في الجنس نحو قوله: أسيد ذو خريطة نهارا من المتلقطي قرد القمام فعن ذلك أجوبة.
منها أن القلب الذي في أسيد قد كان سبق إليه وهو جنس كقولك: غليم أسيد ثم نقل إلى العملية بعد أن أسرع فيه القلب فبقي بحاله لا أن القلب إنما وجب فيه بعد العلمية وقد كان قبلها - وهو جنس نكرة - صحيحاً.
ويؤنس بهذا أيضاً أن الإعلال في هذا النحو هو الاختيار في الأجناس.
فلما سبق القلب الذي هو أقوى وأقيس القولين سمي به معلاً فبقي بعد النقل على صورته.
ومثل ذلك ما نقوله في " عيينة " أنه إنما سمي به مصغراً فبقي بعد بحاله قبل ولو كان إنما حقر بعد أن سمي به لوجب ترك إلحاق علامة التأنيث به كما أنك لو سميت رجلاً هنداً ثم حقرت قلت: هنيد: ولو سميته بها محقرة قبل التسمية لوجب أن تقر التاء بحالها فتقول: هذا هنيدة مقبلاً.
هذا مذهب الكتاب وإن كان يونس يقول بضده.
ومنها أنا لسنا نقول: إن كل علم فلا بد من صحة واوه إذا اجتمعت مع الياء ساكنة أولاهما فيلزمنا ما رمت إلزامنا وإنما قلنا: إذا اجتمعت الياء والواو وسبقت الأولى منهما بالسكون ولم يكن الاسم علماً ولا على تلك الأوصاف التي ذكرنا فإن الواو تقلب ياء وتدغم الياء في الياء.
فهذه علة من علل قلب الواو ياء.
فأما ألا تعتل الواو إذا اجتمعت مع الياء ساكنة أولاهما إلا من هذا الوجه فلم نقل به.
وكيف يمكن أن نقول به وقد قدمنا أن الحكم الواحد قد يكون معلولاً بعلتين وأكثر من ذلك وتضمنا أن نفرد لهذا الفصل باباً! فإن قلت: ألسنا إذا رافعناك في صحة " حيوة " إنما نفزع إلى أن نقول: إنما صحت لكونهما علماً والأعلام تأتي كثيراً أحكامها تخالف أحكام الأجناس وأنت تروم في اعتلالك هذا الثاني أن تسوي بين أحكامهما وتطرد على سمت واحد كلاً منهما.
قيل: الجواب الأول قد استمر ولم تعرض له ولا سوغتك الحال الطعن فيه وإنما هذا الاعتراض على الجواب الثاني.
والخطب فيه أيسر.
وذلك أن لنا مذهباً سنوضحه في باب يلي هذا وهو حديث الفرق بين علة الجواز وعلة الوجوب.
ومن ذلك أن يقال لك: ما علة قلب واو سوط وثوب إذا كسرت فقلت: ثياب وسياط.
وهذا حكم لا بد في تعليله من جمع خمسة أغراض فإن نقصت واحداً فسد الجواب وتوجه عليه الإلزام.
والخمسة: أن ثياباً وسياطاً وحياضاً وبابه جمع والجمع أثقل من الواحد وأن عين واحده ضعيفة بالسكون وقد يراعى في الجمع حكم الوحد وأن قبل عينه كسرة وهي مجلبة في كثير من الأمر لقلب الواو ياء وأن بعدها ألفاً والألف شبيهة بالياء وأن لام سوط وثوب صحيحة.
فتلك خمسة أوصاف لا غنى بك عن واحد منها.
ألا ترى إلى صحة خوان وبوان وصوان لما كان مفرداً لا جمعاً.
فهذا باب.
ثم ألا ترى إلى صحة واو زوجة وعودة وهي جمع واحد ساكن العين وهو زوج وعود ولامه أيضاً صحيحه وقبلها في الجمع كسرة.
ولكن بقي من مجموع العلة أنه لا ألف بعد عينه كألف حياض ورياض.
وهذا باب أيضاً.
ثم ألا ترى إلى صحة طوال وقوام وهما جمعان وقبل عينهما كسرة وبعدهما ألف ولاماهما صحيحتان.
لكن بقي من مجموع العلة أن عينه في الواحد متحركة وهي في طويل وقويم.
وهذا أيضاً باب.
ثم ألا ترى إلى صحة طواء ورواء جمع طيان وريان فيه الجمعية وأن عين واحده ساكنة بل معتلة وقبل عينه كسرة وبعدها ألف.
لكن بقي عليك أن لامه معتلة فكرهوا إعلال عينه وهذا الموضع مما يسترسل فيه المعتل لاعتلاله فلعله أن يذكر من الأوصاف الخمسة التي ذكرناها وصفين " أو أكثره " ثلاثة ويغفل الباقي فيدخل عليه الدخل منه فيرى أن ذلك نقض للعلة ويفزع إلى ما يفزع إليه من لا عصمة له ولا مسكة عنده.
ولعمري إنه كسر لعلته هو لاعتلالها في نفسها.
فأما مع إحكام علة الحكم فإن هذا ونحوه ساقط عنه.
ومن ذلك ما يعتقده في علة الادغام.
وهو أن يقال: إن الحرفين المثلين إذا كانا لازمين متحركين حركة لازمة ولم يكن هناك إلحاق ولا كانت الكلمة مخالفة لمثال فعِل وفعُل أو كانت فعَل فعلاً ولا خرجت منبهة على بقية بابها فإن الأول منها يسكن ويدغم في الثاني.
وذلك نحو شد وشلت يده وحبذا زيد وما كان عارياً مما استثنيناه ألا ترى أن شد وإن كان فعَل فإنه فِعل وليس كطلل وشرر وجدد فيظهر.
وكذلك شلت يده: فَعِلَت.
وحبذا زيد أصله حبب ككرم وقضو الرجل.
ومثله شر الرجل من الشر: هو فعل لقولهم: شررت يا رجل وعليه جاء رجل شرير كرديء.
وعلى ذلك قالوا أجد في الأمر وأسر الحديث واستعد لخلوة مما شرطناه.
فلو عارضك معارض بقولهم: اصبب الماء وامدد الحبل لقلت: ليست الحركتان لازمتين لأن الثانية لالتقاء الساكنين.
وكذلك إن ألزمك ظهور نحو جلبب وشملل: وقعدد ورمدد قلت: وكذلك إن أدخل على قولك هما يضربانني ويكرمانني ويدخلاننا قلت: سبب ظهوره أن الحرفين ليسا لازمين ألا ترى أن الثاني من الحرفين ليس ملازماً لقولك: هما يضربان زيداً ويكرمانك ونحو ذلك.
وكذلك إن ألزمك ظهور نحو جُدَد وقِدَد وسُرُر قلت: هذا مخالف لمثال فَعُل وفَعِل.
فإن ألزمك نحو قول قعنب: مهلاً أعاذل قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ضننوا وقول العجاج: تشكو الوجى من أظلل وأظلل وقول الآخر: وإن رأيت الحجج الرواددا قواصراً بالعمر أو مواددا قلت: هذا ظهر على أصله منبهة على بقية بابه فتعلم به أن أصل الأصم أصمم وأصل صب صبِب وأصل الدواب والشواب الدوابب والشوابب على ما نقوله في نحو استصوب وبابه: إنما خرج على أصله إيذاناً بأصول ما كان مثله.
فإن قيل: فكيف اختصت هذه الألفاظ ونحوها بإخراجها على أصولها دون غيرها قيل: رجع الكلام بنا وبك إلى ما كنا فرغنا منه معك في باب استعمال بعض الأصول وإهمال بعضها فارجع إليه تره إن شاء الله.
وهذا الذي قدمناه آنفاً هو الذي عناه أبو بكر رحمه الله بقوله: قد تكون علة الشيء الواحد أشياء كثيرة فمتى عدم بعضها لم تكن علة.
قال: ويكون أيضاً عكس هذا وهو أن تكون علة واحدة لأشياء كثيرة.
أما الأول فإنه ما نحن بصدده من اجتماع أشياء تكون كلها علة وأماالثاني فمعظمه الجنوح إلى المستخف والعدول عن المستثقل.
وهو أصل الأصول في هذا الحديث وقد مضى صدر منه.
وسترى بإذن الله بقيته.
واعلم أن هذه المواضع التي ضممتها وعقدت العلة على مجموعها قد أرادها أصحابنا وعنوها وإن لم يكونوا جاءوا بها مقدمة محروسة فإنهم لها أرادوا وإياها نووا ألا ترى أنهم إذا استرسلوا في وصف العلة وتحديدها قالوا: إن علة شد ومد ونحو ذلك في الادغام إنما هي اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد.
فإذا قيل لهم: فقد قالوا: قعدد وجلبب واسحنك قالوا: هذا ملحق فلذلك ظهر.
وإذا ألزموا نحو اردد الباب واصبب الماء قالوا: الحركة الثانية عارضة لالتقاء الساكنين وليست بلازمة.
وإذا أدخل عليهم نحو جدد وقدد وخلل قالوا: هذا مخالف لبناء الفعل.
وإذا عورضوا بنحو طلل ومدد فقيل لهم: هذا على وزن الفعل قالوا: هو كذلك إلا أن الفتحة خفيفة والاسم أخف من الفعل فظهر التضعيف في الاسم لخفته ولم يظهر في الفعل - نحو قص ونص - لثقله.
وإذا قيل لهم: قالوا هما يضربانني وهم يحاجوننا قالوا: المثل الثاني ليس بلازم.
وإذا أوجب عليهم نحو قوله " وإن ضننوا " ولححت عينه وضبب البلد وألل السقاء قالوا: خرج هذا شاذاً ليدل على أن أصل قرت عينه قررت وأن أصل حل الحبل ونحوه حلل.
فهذا الذي يرجعون إليه فيما بعد متفرقاً قدمناه نحن مجتمعاً.
وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه مستوفاة محررة.
وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور.
الآن قد أريتك بما مثلته لك من الاحتياط في وضع العلة كيف حاله والطريق إلى استعمال مثله فيما عدا ما أوردته وأن تستشف ذلك الموضع فتنظر إلى آخر ما يلزمك إياه الخصم فتدخل الاستظهار بذكره في أضعاف ما تنصبه من علته لتسقط عنك فيما بعد الأسولة والإلزامات التي يروم مراسلك الاعتراض بها عليك والإفساد لما قررته من عقد علتك.
ولا سبيل إلى ذكر جميع ذلك لطوله ومخافة الإملال ببعضه.
وإنما تراد المثل ليكفي قليلها من كثير غيرها ولا قوة إلا بالله.
باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المجوزة
اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها كنصب الفضلة أو ما شابه في اللفظ الفضلة ورفع المبتدأ والخبر والفاعل وجر المضاف إليه وغير ذلك.
فعلل هذه الداعية إليها موجبة لها غير مقتصر بها على تجويزها وعلى هذا مقاد كلام العرب.
وضرب آخر يسمى علة وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب.
من ذلك الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة هي علة الجواز لا علة الوجوب ألا ترى أنه ليس في الدنيا أمر يوجب الإمالة لا بد منها وأن كل ممال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه.
فهذه إذاً علة الجواز لا علة الوجوب.
ومن ذلك أن يقال لك: ما علة قلب واو " أقتت " همزة فتقول: علة ذلك أن الواو انضمت ضماً لازماً.
وأنت مع هذا تجيز ظهورها واواً غير مبدلة فتقول: وقتت.
فهذه علة الجواز إذاً لا علة الوجوب.
وهذا وإن كان في ظاهر ما تراه فإنه معنى صحيح وذلك أن الجواز معنى تعقله النفس كما أن الوجوب كذلك فكما أن هنا علة للوجوب فكذلك هنا علة للجواز.
هذا ومن علل الجواز أن تقع النكرة بعد المعرفة التي يتم الكلام بها وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى فتكون حينئذ مخيراً في جعلك تلك النكرة - إن شئت - حالاً و - إن شئت - بدلاً فتقول على هذا: مررت بزيد رجل صالح على البدل وإن شئت قلت: مررت بزيد رجلاً صالحاً على الحال.
أفلا ترى كيف كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علة لجواز كل واحد من الأمرين لاعلة لوجوبه.
وكذلك كل ما جاز لك فيه من المسائل الجوابان والثلاثة وأكثر من ذلك على هذا الحد فوقوعه عليه علة لجواز ما جاز منه لا علة لوجوبه.
فلا تستنكر هذا الموضع.
فإن قلت: فهل تجيز أن يحل السواد محلاً ما فيكون ذلك علة لجواز اسوداده لا لوجوبه قيل: هذا في هذا ونحوه لا يجوز بل لا بد من اسوداده البتة وكذلك البياض والحركة والسكون ونحو ذلك متى حل شيء منها في محل لم يكن له بد من وجود حكمه فيه ووجوبه البتة له لأن هناك أمراً لا بد من ظهور أثره.
وإذا تأملت ما قدمناه رأيته عائداً إلى هذا الموضع غير مخالف له ولا بعيد عنه وذلك أن وقوع النكرة تلية المعرفة - على ما شرحناه من تلك الصفة - سبب لجواز الحكمين اللذين جازا فيه فصار مجموع الأمرين في وجوب جوازهما كالمعنى المفرد الذي استبد به ما أريتناه: من تمسك بكل واحد من السواد والبياض والحركة والسكون.
فقد زالت عنك إذاً شناعة هذا الظاهر وآلت بك الحال إلى صحة معنى ما قدمته: من كون الشيء علة للجواز لا للوجوب.
فاعرف ذلك وقسه فإنه باب واسع.
باب في تعارض العلل
الكلام في هذا المعنى من موضعين: أحدهما الحكم الواحد تتجاذب كونه العلتان أو أكثر منهما.
والآخر الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان.
الأول منهما كرفع المبتدأ فإننا نحن نعتل لرفعه بالابتداء على ما قد بيناه وأوضحناه من شرحه وتلخيص معناه.
والكوفيون يرفعونه إما بالجزء الثاني الذي هو مرافعه عندهم وإما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه.
وكذلك رفع الخبر ورفع الفاعل ورفع ما أقيم مقامه ورفع خبر إن وأخواتها.
وكذلك نصب ما انتصب وجر ما انجر وجززم ما انجزم مما يتجاذب الخلاف في علله.
فكل واحد من هذه الأشياء له حكم واحد تتنازعه العلل على ما هو مشروح من حاله في أماكنه.
وإنما غرضنا أن نرى هنا جملة لا أن نشرحه ولا أن نتكلم على تقوية ما قوي منه وإضعاف ما ضعف منه.
الثاني منهما الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان وذلك كإعمال أهل الحجاز ما النافية للحال وترك بني تميم إعمالها وإجرائهم إياها مجرى " هل " ونحوها مما لا يعمل فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخول ليس عليهما ونافية للحال نفيها إياها أجروها في الرفع والنصب مجراها إذا اجتمع فيها الشبهان بها.
وكأن بني تميم لما رأوها حرفاً داخلاً بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها ومباشرة لكل واحد من جزأيها كقولك: ما زيد أخوك وما قام زيد أجروها مجرى " هل " ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفي دخول " هل " عليها للاستفهام ولذلك كانت عند سيبويه لغة التميميين أقوى قياساً من لغة الحجازيين.
ومن ذلك " ليتما " ألا ترى أن بعضهم يركبهما جميعاً فيسلب بذلك " ليت " عملها وبعضهم يلغي " ما " عنها فيقر عملها عليها: فمن ضم " ما " إلى " ليت " وكفها بها عن عملها ألحقها بأخواتها: من " كأن " و " لعل " و " لكن " وقال أيضاً: لا تكون " ليت " في وجوب العمل بها أقوى من الفعل " و " قد نراه إذا كف ب " ما " زال عنه عمله وذلك كقولهم: قلما يقوم زيد ف " ما " دخلت على " قل " كافة لها عن عملها ومثله كَثُر ما وطالما فكما دخلت " ما " على الفعل نفسه فكفته عن عمله وهيأته لغير ما كان قبلها متقاضياً له كذلك تكون ما كافة ل " ليت " عن عملها ومصيرة لها إلى جواز وقوع الجملتين جميعاً بعدها ومن ألغى " ما " عنها وأقر عملها جعلها كحرف الجر في إلغاء " ما " معه نحو قول الله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ} وقوله: {عَمَّا قَلِيلٍ} و {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ} ونحو ذلك وفصل بينها وبين " كأن " و " لعل " بأنها أشبه بالفعل منهما ألا تراها مفردة وهما مركبتان لأن الكاف زائدة واللام زائدة.
هذا طريق اختلاف العلل لاختلاف الأحكام في الشيء الواحد فأما أيها أقوى وبأيها يجب أن يؤخذ فشيء آخر ليس هذا موضعه ولا وضع هذا الكتاب له.
ومن ذلك اختلاف أهل الحجاز وبني تميم في هلم.
فأهل الحجاز يجرونها مجرى صه ومه ورويداً ونحو ذلك مما سمي به الفعل وألزم طريقاً واحداً.
وبنو تميم يلحقونها علم التثينة والتأنيث والجمع ويراعون أصل ما كانت عليه لم.
وعلى هذا مساق جميع ما اختلفت العرب فيه.
فالخلاف إذاً بين العلماء أعم منه بين العرب.
وذلك أن العلماء اختلفوا في الاعتلال لما اتفقت العرب عليه كما اختلفوا أيضاً فيما اختفلت العرب فيه وكل ذهب مذهباً وإن كان بعضه قوياً وبعضه ضعيفاً.
باب في أن العلة
إذا لم تتعد لم تصح من ذلك قولهم من اعتل لبناء نحو كم ومن وما وإذ ونحو ذلك بأن هذه الأسماء لما كانت على حرفين شابهت بذلك ما جاء من الحروف على حرفين نحو هل وبل وقد.
قال: فلما شابهت الحرف من هذا الموضع وجب بناؤها كما أن الحروف مبنية.
وهذه علة غير متعدية وذلك أنه كان يجب على هذا أن يبنى ما كان من الأسماء أيضاً على حرفين نحو يد وأخ وأب ودم وفم وحِر وهَن ونحو ذلك.
فإن قيل: هذه الأسماء لها أصل في الثلاثة وإنما حذف منها حرف فهو لذلك معتد فالجواب أن هذه زيادة في وصف العلة لم تأت بها في أول اعتلالك.
وهبنا سامحناك بذلك قد كان يجب على هذا أن يبني باب يد وأخ وأب ونحو ذلك لأنه لما حذف فنقص شابه الحرف وإن كان أصله الثلاثة ألا ترى أن المنادى المفرد المعرفة قد كان أصله أن يعرب فلما دخله شبه الحرف لوقوعه موقع المضمر بني ولم يمنع من بنائه جريه معرباً قبل حال البناء.
وهذا شبه معنوي كما ترى مؤثر داع إلى البناء والشبه اللفظي أقوى من الشبه المعنوي فقد كان يجب على هذا أن يبني ما جاء من الأسماء على حرفين وله أصل في الثلاثة وألا يمنع من بنائه كونه في الأصل ثلاثياً كما لم يمنع من بناء زيد في النداء كونه في الأصل معرباً بل إذا كانت صورة إعراب زيد قبل ندائه معلومة مشاهدة ثم لم يمنع ذاك من بنائه كان أن يبنى باب يد ودم وهن لنقصه ولأنه لم يأت تاماً على أصله إلا في أماكن شاذة أجدر.
وعلى أن منها ما لم يأت على أصله البتة وهو معرب.
وهو حر وسه وفم.
فأما قوله: يا حبذا عينا سليمى والفما وقول الآخر: هما نفثا في فِيَ من فمويهما فإنه على كل حال لم يأت على أصله وإن كان قد زيد فيه ما ليس منه.
فإن قلت: فقد ظهرت اللام في تكسير ذلك نحو أفواه وأستاه وأحراح قيل: قد ظهر أيضاً الإعراب في زيد نفسه لا في جمعه ولم يمنع ذلك من بنائه.
وكذلك القول في تحقيره وتصريفه نحو فويه وأسته وحرح.
ومن ذلك قول أبي إسحاق في التنوين اللاحق في مثال الجمع الأكبر نحو جوار وغواش: إنه عوض من ضمة الياء وهذه علة غير جارية ألا ترى أنها لو كانت متعدية لوجب أن تعوض من فإن قيل: الأفعال لا يدخلها التنوين ففي هذا جوابان: أحدهما أن يقال له: علتك ألزمتك إياه فلا تلم إلا نفسك والآخر أن يقال له: إن الأفعال إنما يمتنع منا التنوين اللاحق للصرف فأما التنوين غير ذاك فلا مانع له ألا ترى إلى تنوينهم الأفعال في القوافي لما لم يكن ذلك الذي هو علم للصرف كقول العجاج: من طلل كالأتحمي أنهجَن وقول جرير: وقولي إن أصبت: لقد أصابن ومع هذا فهل التنوين إلا نون وقد ألحقوا الفعل النونين: الخفيفة والثقيلة.
وههنا إفساد لقول أبي إسحاق آخر وهو أن يقال له: إن هذه الأسماء قد عاقبت ياءاتها ضماتها ألا تراها لا تجتمع معها فلما عاقبتها جرت لذلك مجراها فكما أنك لا تعوض من الشيء وهو موجود فكذلك أيضاً يجب ألا تعوض منه وهناك ما يعاقبه ويجري مجراه.
غير أن الغرض في هذا الكتاب إنما هو الإلزام الأول لأن به ما يصح تصور العلة وأنها غير متعدية.
ومن ذلك قول الفراء في نحو لغة وثُبة ورئة ومئة: إن كان من ذلك المحذوف منه الواو فإنه يأتي مضموم الأول نحو لغة وبرة وثبة وكرة وقلة وما كان من الياء فإنه يأتي مكسور الأول نحو مئة ورئة.
وهذا يفسده قولهم: سنة فيمن قال: سنوات وهي من الواو كما ترى وليست مضمومة الأول.
وكذلك قولهم: عِضة محذوفها الواو لقولهم فيها: عضوات قال: هذا طريق يأزم المآزما وعضوات تقطع اللهازما وقالوا أيضاً: ضَعَة وهي من الواو مفتوحة الأول ألا تراه قال: متخذاً من ضَعَوات تَولَجا فهذا وجه فساد العلل إذا كانت واقفة غير متعدية.
وهو كثير فطالب فيه بواجبه وتأمل ما يرد عليك من أمثاله.
باب في العلة وعلة العلة
ذكر أبو بكر في أول أصوله هذا ومثل منه برفع الفاعل.
قال: فإذا سئلنا عن علة رفعه قلنا: ارتفع بفعله فإذا قيل: ولم صار الفاعل مرفوعاً فهذا سؤال عن علة العلة.
وهذا موضع ينبغي أن تعلم منه أن هذا الذي سماه علة العلة إنما هو تجوز في اللفظ فأما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة ألا ترى أنه إذا قيل له: فلم ارتفع الفاعل قال: لإسناد الفعل إليه ولو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا قام زيد: إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه فكان مغنياً عن قوله: إنما ارتفع بفعله حتى تسأله فيما بعد عن العلة التي ارتفع لها الفاعل.
وهذا هو الذي أراده المجيب بقوله: ارتفع بفعله أي بإسناد الفعل إليه.
نعم ولو شاء لماطله فقال له: ولم صار المسند إليه الفعل مرفوعاً فكان جوابه أن يقول: إن صاحب الحديث أقوى الأسماء والضمة أقوى الحركات فجعل الأقوى للأقوى.
وكان يجب على ما رتبه أبو بكر أن تكون هنا علة وعلة العلة وعلة علة العلة.
وأيضاً فقد كان له أن يتجاوز هذا الموضع إلى ما وراءه فيقول: وهلا عكسوا الأمر فأعطوا الاسم الأقوى الحركة الضعيفة لئلا يجمعوا بين ثقيلين.
فإن تكلف متكلف جواباً عن هذا تصاعدت عدة العلل وأدى ذاك إلى هجنة القول وضعفة القائل به وكذلك لو قال لك قائل في قولك: قام القوم إلا زيداً: لم نصبت زيداً لقلت: لأنه مستثنى وله من بعد أن يقول: ولم نصبت المستثنى فيكون من جوابه لأنه فضلة ولو شئت أجبت مبتدئاً بهذا فقلت: إنما نصبت زيداً في قولك: قام القوم إلا زيداً لأنه فضلة.
والباب واحد والمسائل كثيرة.
فتأمل وقس.
فقد ثبت بذلك أن هذا موضع تسمح " فيه أبو بكر " أو لم ينعم تأمله.
ومن بعد فالعلة الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة ألا ترى أن السواد الذي هو علة لتسويد ما يحله إنما صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلاً جعله على هذه القضية.
وفي هذا بيان.
فقد ثبت إذاً أن قوله: علة العلة إنما غرضه فيه أنه تتميم وشرح لهذه العلة المقدمة عليه.
وإنما ذكرناه في جملة هذه الأبواب لأن أبا بكر - رحمه الله - ذكره فأحببنا أن نذكر ما عندنا فيه.
وبالله التوفيق.
حكم المعلول بعلتين
باب في حكم المعلول بعلتين
وهو على ضربين: أحدهما ما لا نظر فيه والآخر محتاج إلى النظر.
الأول منهما نحو قولك: هذه عشري وهؤلاء مسلمي.
فقياس هذا على قولك: عشروك ومسلموك أن يكون أصله عشروي ومسلموي فقلبت الواو ياء لأمرين كل واحد منهما موجب للقلب غير محتاج إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه: أحدهما اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون والآخر أن ياء المتكلم أبداً تكسر الحرف الذي قبلها إذا كان صحيحاً نحو هذا غلامي ورأيت صاحبي وقد ثبت فيما قبل أن نظير الكسر في الصحيح الياء في هذه الأسماء نحو مررت بزيد ومررت بالزيدين ونظرت إلى العشرين.
فقد وجب إذاً ألا يقال: هذه عشروي بالواو كما لا يقال: هذا غلامي بضم الميم.
فهذه علة غير الأولى في وجوب قلب الواو ياء في عشروي وصالحوي ونحو ذلك وأن يقال عشري بالياء البتة كما يقال هذا غلامي بكسر الميم البتة.
ويدل على وجوب قلب هذه الواو إلى الياء في هذا الموضع من هذا الوجه ولهذه العلة لا للطريق الأول - من استكراههم إظهار الواو ساكنة قبل الياء - أنهم لم يقولوا: رأيت فاي وإنما يقولون: رأيت في.
هذا مع أن هذه الياء لا ينكر أن تأتي بعد الألف نحو رحاي وعصاي لخفة الألف فدل امتناعهم من إيقاع الألف قبل هذه الياء على أنه ليس طريقه طريق الاستخفاف والاستثقال وإنما هو لاعتزامهم ترك الألف والواو قبلها كتركهم الفتحة والضمة قبل الياء في الصحيح نحو غلامي وداري.
فإن قيل: فأصل هذا إنما هو لاستثقالهم الياء بعد الضمة لو قالوا: هذا غلامي قيل: لو كان لهذا الموضع البتة لفتحوا ما قبلها لأن الفتحة على كل حال أخف قبل الياء من الكسرة فقالوا: رأيت غلامَى.
فإن قيل: لما تركوا الضمة هنا وهي علم للرفع أتبعوها الفتحة ليكون العمل من موضع واحد كما أنهم لما استكرهوا الواو بعد الياء نحو يعد حذفوها أيضاً بعد الهمزة والنون والتاء في نحو أعد ونعد وتعد قيل: يفسد هذا من أوجه.
وذلك أن حروف المضارعة تجري مجرى الحرف الواحد من حيث كانت كلها متساوية في جعلها الفعل صالحاً لزمانين: الحال والاستقبال فإذا وجب في أحدها شيء أتبعوه سائرها وليس كذلك علم الإعراب: ألا ترى أن موضوع الإعراب على مخالفة بعضه بعضاً من حيث كان إنما جيء به دالاً على اختلاف المعاني.
فإن قلت: فحروف المضارعة أيضاً موضوعة على اختلاف معانيها لأن الهمزة للمتكلم والنون للمتكلم إذا كان معه غيره وكذلك بقيتها قيل: أجل إلا أنها كلها مع ذلك مجتمعة على معنى واحد وهو جعلها الفعل صالحاً للزمانين على ما مضى.
فإن قلت: فالإعراب أيضاً كله مجتمع على جريانه على حرفه قيل: هذا عمل لفظي والمعاني أشرف من الألفاظ.
وأيضاً فتركهم إظهار الألف قبل هذه الياء مع ما يعتقد من خفة الألف حتى إنه لم يسمع منهم نحو فاى ولا أباى ولا أخاى وإنما المسموع عنهم رأيت أبي وأخي وحكى سيبويه كَسَرت فِيَ أدل دليل على أنهم لم يراعوا حديث الاستخفاف والاستثقال حسب وأنه أمر غيرهما.
وهو اعتزامهم ألا تجيء هذه الياء إلا بعد كسرة أو ياء أو ألف لا تكون علماً للنصب: نحو هذه عصاي وهذا مصلاي.
وعلى أن بعضهم راعى هذا الموضع أيضاً فقلب هذه الألف ياء فقال: عصي ورحي ويا بشري " هذا غلام " وقال أبو داود: فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم وأستدرج نويا وروينا أيضاً عن قطرب: يطوف بي عكب في معد ويطعن بالصملة في قفيا وهو كثير.
ومن قال هذا لم يقل في هذان غلاماي: " غلامَي " بقلب الألف ياء لئلا يذهب علم الرفع.
ومن المعلول بعلتين قولهم: سيُ وريُ.
وأصله سوي وروي فانقلبت الواو ياء - إن شئت - لأنها ساكنة غير مدغمة وبعد كسرة و - إن شئت - لأنها ساكنة قبل الياء.
فهاتان علتان إحداهما كعلة قلب ميزان والأخرى كعلة طيا وليا مصدري طويت ولويت وكل واحدة منهما مؤثرة.
فهذا ونحوه أحد ضربي الحكم المعلول بعلتين الذي لا نظر فيه.
والآخر منهما ما فيه النظر وهو باب ما لا ينصرف.
وذلك أن علة امتناعه من الصرف إنما هي لاجتماع شبهين فيه من أشباه الفعل.
فأما السبب الواحد فيقل عن أن يتم علة بنفسه حتى ينضم إليه الشبه الآخر من الفعل.
فإن قيل: فإذا كان في الاسم شبه واحد من أشباه الفعل أله فيه تأثير أم لا فإن كان له فيه تأثير فماذا التأثير وهل صرف زيد إلا كصرف كلب وكعب وإن لم يكن للسبب الواحد إذا حل الاسم تأثير فيه فما باله إذا انضم إليه سبب آخر أثرا فيه فمعناه الصرف وهلا إذا كان السبب الواحد لا تأثير له فيه لم يؤثر فيه الآخر كما لم يؤثر فيه الأول وما الفرق بين الأول فالجواب أن السبب الواحد وإن لم يقو حكمه إلى أن يمنع الصرف فإنه لا بد في حال انفراده من تأثير فيما حله وذلك التأثير الذي نوميء إليه وندعي حصوله هو تصويره الاسم الذي حله على صورة ما إذا انضم إليه سبب آخر اعتونا معاً على منع الصرف ألا ترى أن الأول لو لم تجعله على هذه الصفة التي قدمنا ذكرها لكان مجيء الثاني مضموماً إليه لايؤثر أيضاً كما لم يؤثر الأول ثم كذلك إلى أن تفنى أسباب منع الصرف فتجتمع كلها فيه وهو مع ذلك منصرف.
لا بل دل تأثير الثاني على أن الأول قد كان شكل الاسم على صورة إذا انضم إليه سبب آخر انضم إليها مثلها وكان من مجموع الصورتين ما يوجب ترك الصرف.
فإن قلت: ما تقول في اسم أعجمي علم في بابه مذكر متجاوز للثلاثة نحو يوسف وإبراهيم ونحن نعلم أنه الآن غير مصروف لاجتماع التعريف والعجمة عليه فلو سميت به من بعد مؤثناً ألست قد جمعت فيه بعد ما كان عليه - من التعريف والعجمة - التأنيث فليت شعري أبالأسباب الثلاثة منعته الصرف أم باثنتين منها فإن كان بالثلاثة كلها فما الذي زاد فيه التأنيث الطاريء عليه فإن كان لم يزد فيه شيئاً فقد رأيت أحد أشباه الفعل غير مؤثر وليس هذا من قولك.
وإن كان أثر فيه التأنيث الطاريء عليه شيئاً فعرفنا ما ذلك المعنى.
فالجواب هو أنه جعله على صورة ما إذا حذف منه سبب من أسباب الفعل بقي بعد ذلك غير مصروف أيضاً ألا تراك لو حذفت من يوسف اسم امرأةٍ التأنيث فأعدته إلى التذكير لأقررته أيضاً على ما كان عليه من ترك الصرف وليس كذلك امرأة سميتها بجعفر ومالك ألا تراك لو نزعت عن الاسم تأنيثه لصرفته لأنك لم تبق فيه بعد إلا شبهاً واحداً من أشباه الفعل.
فقد صار إذاً المعنى الثالث مؤثراً أثراً ما كما كان السبب الواحد مؤثراً أثراً ما على ما قدمنا ذكره فاعرف ذلك.
وأيضاً فإن " يوسف " اسم امرأة أثقل منه اسم رجل كما أن " عقرب " اسم امرأة أثقل من " هند " ألا تراك تجيز صرفها ولا تجيز صرف " عقرب " علماً.
فهذا إذاً معنى حصل ليوسف عند تسمية المؤنث به وهو معنى زائد بالشبه الثالث.
فأما قول من قال: إن الاسم الذي اجتمع فيه سببان من أسباب منع الصرف فمنعه إذا انضم إلى ذلك ثالث امتنع من الإعراب أصلاً ففاسد عندنا من أوجه: أحدها أن سبب البناء في الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرف وترك الصرف إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير.
وأما تمثيله ذلك بمنع إعراب حذام وقطام وبقوله فيه: إنه لما كان معدولاً عن حاذمة وقاطمة وقد كانتا معرفتين لا ينصرفان وليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب البتة فلاحق في الفساد بما قبله لأنه منه وعليه حذاه.
وذلك أن علة منع هذه الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراك ونزال ثم شبهت حذام وقطام ورقاش بالمثال والتعريف والتأنيث بباب دراك ونزال على " ما بيناه " هناك.
فأما أنه لأنه ليس بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب أصلاً فلا.
ومما يفسد قول من قال: إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإن اجتماع الثلاثة فيه ترفع عنه الإعراب أنا نجد في كلامهم من الأسماء ما يجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف وهو مع ذلك معرب غير مبني.
وذلك كامرأة سميتها " بأذربيجان " فهذا اسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع: وهو التعريف والتأنيث والعجمة والتركيب والألف والنون وكذلك إن عنيت " بأذربيجان " البلدة والمدينة لأن البلد فيه الأسباب الخمسة وهو مع ذلك معرب كما ترى.
فإذا كانت الأسباب الخمسة لا ترفع الإعراب فالثلاثة أحجى بألا ترفعه وهذا بيان.
ولتحامي الإطالة ما أحذف أطرافاً من القول على أن فيما يخرج إلى الظاهر كافياً بإذن الله.
باب في إدراج العلة واختصارها
هذا موضع يستمر " النحويون عليه " فيفتق عليهم ما يتعبون بتداركه والتعذر منه.
وذلك كسائل سأل عن قولهم: آسيت الرجل فأنا أواسيه وآخيته فأنا أواخيه فقال: وما أصله فقلت: أؤاسيه وأؤاخيه - وكذلك نقول - فيقول لك: فما علته في التغيير فنقول: اجتمعت الهمزتان فقلبت الثانية واواً لانضمام ما قبلها.
وفي ذلك شيئان: أحدهما أنك لم تستوف ذكر الأصل والآخر أنك لم تتقص شرح العلة.
أما إخلالك بذكر حقيقية الأصل فلأن أصله " أؤاسوك " لأنه أفاعلك من الأسوة فقلبت الواو ياء لوقوعها طرفاً بعد الكسرة وكذلك أؤاخيك أصله " أؤاخوك " لأنه من الأخوة فانقلبت اللام لما ذكرنا كما تنقلب في نحو أعطِى واستقصِى.
وأما تقصي علة تغيير الهمزة بقلبها واواً فالقول فيه أنه اجتمع في كلمة واحدة همزتان غير عينين " الأولى منهما مضمومة والثانية مفتوحة " و " هي " حشو غير طرف فاستثقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها - وهي الضمة - واواً.
ولا بد من ذكر جميع ذلك وإلا أخللت ألا ترى أنك قد تجمع في الكلمة الواحدة بين همزتين فتكونان عينين فلا تغير ذلك وذلك نحو سآل ورآس وكبنائك من سألت نحو تبع فتقول: " سؤل " فتصحان لأنهما عينان ألا ترى أن لو بنيت من قرأت مثل " جرشع " لقلت " قرء " وأصله قرؤؤ فقلبت الثانية ياء وإن كانت قبلها همزة مضمومة وكانتا في كلمة واحدة لما كانت الثانية منهما طرفاً لا حشواً.
وكذلك أيضاً ذكرك كونهما في كلمة واحدة ألا ترى أن من العرب من يحقق الهمزتين إذا كانتا من كلمتين نحو قول الله تعالى {السُّفَهَاء أَلا} فإذا كانتا في كلمة واحدة فكلهم يقلب نحو جاء وشاء ونحو خطايا وزوايا في قول الكافة غير الخليل.
فأما ما يحكى عن بعضهم من تحقيقهما في الكلمة الواحدة نحو أئمة وخطائيء " مثل خطاعع " وجائيء فشاذ لا يجوز أن يعقد عليه باب.
ولو اقتصرت في تعليل التغيير في " أؤاسيك " ونحوه على أن تقول: اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة فقلبت الثانية واواً لوجب عليك أن تقلب الهمزة الثانية في نحو سأآل ورأآس واواً وأن تقلب همزة أأدم وأأمن واواً وأن تقلب الهمزة الثانية في خطائيء واواً.
ونحو ذلك كثير لا يحصى وإنما أذكر من كل نبذاً لئلا يطول الكتاب جداً.
باب في دور الاعتلال هذا موضع طريف.
ذهب محمد بن يزيد في وجوب إسكان اللام في نحو ضربن وضربت إلى أنه لحركة ما بعده من الضمير: يعني مع الحركتين قبل.
وذهب أيضاً في حركة الضمير من نحو هذا أنها إنما وجبت لسكون ما قبله.
فتارة اعتل لهذا بهذا ثم دار تارة أخرى فاعتل لهذا بهذا.
وفي ظاهر ذلك اعتراف بأن كل واحد منهما ليست له حال مستحقة تخصه في نفسه وإنما استقر على ما استقر عليه لأمر راجع إلى صاحبه.
ومثله ما أجازه سيبويه في جر " الوجه " من قولك: هذا الحسن الوجه.
وذلك أنه أجاز فيه الجر من وجهين: أحدهما طريق الإضافة الظاهرة والآخر تشبيهه بالضارب الرجل.
" وقد أحطنا علماً بأن الجر إنما جاز في الضارب الرجل " ونحوه مما كان الثاني منهما منصوباً لتشبيههم إياه بالحسن الوجه أفلا ترى كيف صار كل واحد من الموضعين علة لصاحبه في الحكم الواحد الجاري عليهما جميعاً.
وهذا من طريف أمر هذه اللغة وشدة تداخلها وتزاحم الألفاظ والأغراض على جهاتها.
والعذر أن الجر لما فشا واتسع في نحو الضارب الرجل والشاتم الغلام والقاتل البطل صار - لتمكنه فيه وشياعه في استعماله - كأنه أصل في بابه وإن كان إنما سرى إليه لتشبيهه بالحسن الوجه.
فلما كان كذلك قوي في بابه حتى صار لقوته قياساً وسماعاً كأنه أصل للحر في " هذا الحسن الوجه " وسنأتي على بقية هذا الموضع في باب نفرده له بإذن الله.
لكن ما أجازه أبو العباس وذهب إليه في باب ضربن وضربت من تسكين اللام لحركة الضمير وتحريك الضمير لسكون اللام شنيع الظاهر والعذر فيه أضعف منه في مسئلة الكتاب ألا ترى أن الشيء لا يكون علة نفسه وإذا لم يكن كذلك كان من أن يكون علة علته أبعد وليس كذلك قول سيبويه وذلك أن الفروع إذا تمكنت " قويت قوة تسوغ " حمل الأصول عليها.
وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم.
باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة
اعلم أن هذا الموضع هو الذي يتعسف بأكثر من ترى.
وذلك أنه لا يعرف أغراض القوم فيرى لذلك أن ما أوردوه من العلة ضعيف واه ساقط غير متعال.
وهذا كقولهم: يقول النحويون إن الفاعل رفع والمفعول به نصب وقد ترى الأمر بضد ذلك ألا ترانا نقول: ضرب زيد فنرفعه وإن كان مفعولاً به ونقول: إن زيداً قام فننصبه وإن كان فاعلاً ونقول: عجبت من قيام زيد فنجره وإن كان فاعلاً ونقول أيضاً: قد قال الله عز وجل {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ} فرفع " حيث " وإن كان بعد حرف الخفض.
ومثله عندهم في الشناعة قوله - عز وجل - {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} وما يجري هذا المجرى.
ومثل هذا يتعب مع هذه الطائفة لا سيما إذا كان السائل عنه من يلزم الصبر عليه.
ولو بدأ الأمر بإحكام الأصل لسقط عنه هذا الهوس وذا اللغو ألا ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلاً في المعنى وأن الفاعل عندهم إنما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم وأن الفعل الواجب وغير الواجب في ذلك سواء لسقط صداع هذا المضعوف السؤال.
وكذلك القول على المفعول أنه إنما ينصب إذا أسند الفعل إلى الفاعل فجاء هو فضلة وكذلك لو عرف أن الضمة في نحو حيث وقبل وبعد ليست إعراباً وإنما هي بناء.
وإنما ذكرت هذا الظاهر الواضح ليقع الاحتياط في المشكل الغامض.
وكذلك ما يحكى عن الجاحظ من أنه قال: قال النحويون: إن أفعل الذي مؤنثه فُعلى لا يجتمع فيه الألف واللام ومن وإنما هو بمن أو بالألف واللام نحو قولك: الأفضل وأفضل منك والأحسن وأحسن من جعفر ثم قال: وقد قال الأعشى: فلست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر ورحم الله أبا عثمان أما إنه لو علم أن " من " في هذا البيت ليست التي تصحب أفعل للمبالغة نحو أحسن منك وأكرم منك لضرب عن هذا القول إلى غيره مما يعلو فيه قوله ويعنو لسداده وصحته خصمه.
وذلك أن " من " في بيت الأعشى إنما هي كالتي في قولنا: أنت من الناس حر وهذا الفرس من الخيل كريم.
فكأنه قال: لست من بينهم بالكثير الحصى ولست الاعتلال بالأفعال باب في الاعتلال لهم بأفعالهم ظاهر هذا الحديث طريف ومحصوله صحيح وذلك إذا كان الأول المردود إليه الثاني جارياً على " صحة علة ".
من ذلك أن يقول قائل: إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه لما أفسد معنى كان ترك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجى ألا ترى أنهم يقولون: الذي في الدار زيد وأصله الذي استقر أو ثبت في الدار زيد ولو أظهروا هذا الفعل هنا لما أحال معنى ولا أزال غرضاً فكيف بهم في ترك إظهاره في النداء ألا ترى أنه لو تجشم إظهاره فقيل: أدعو زيداً وأنادي زيداً لاستحال أمر النداء فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذب والنداء مما لا يصح فيه تصديق ولا تكذيب.
ومن الاعتلال بأفعالهم أن تقول: إذا كان اسم الفاعل - على قوة تحمله للضمير - متى جرى على غير من هو له - صفة أو صلة أو حالاً أو خبراً - لم يحتمل الضمير كما يحتمله الفعل فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل نحو قولك: زيد هند شديد عليها هو إذا أجريت " شديداً " خبراً عن " هند " وكذلك قولك: أخواك زيد حسن في عينه هما والزيدون هند ظريف في نفسها هم وما ظنك أيضاً بالشفة المشبهة " بالصفة المشبهة " باسم الفاعل نحو قولك: أخوك جاريتك أكرم عليها من عمرو هو وغلاماك أبوك أحسن عنده من جعفر هما والحجر الحية أشد عليها من العصا هو.
ومن قال: مررت برجل أبي عشرة أبوه قال: أخواك جاريتهما أبو عشرة عندها هما فأظهرت الضمير.
وكان ذلك أحسن من رفعه الظاهر لأن هذا الضمير وإن كان منفصلاً ومشبهاً للظاهر بانفصاله فإنه على كل حال ضمير.
وإنما وحدت فقلت: أبو عشرة عندها هما ولم تثنه فتقول: أبوا عشرة من قبل أنه قد رفع ضميراً منفصلاً مشابهاً للظاهر فجرى مجرى قولك: مررت برجل أبي عشرة أبواه.
فلما رفع الظاهر وما يجري مجرى الظاهر شبهه بالفعل فوحد البتة.
ومن قال: مررت برجل قائمين أخواه فأجراه مجرى قاما أخواه فإنه يقول: مررت برجل أبوي عشرة أبواه.
والتثنية في " أبوي عشرة " من وجه تقوى ومن آخر تضعف.
أما وجه القوة فلأنها بعيدة عن اسم الفاعل الجاري مجرى الفعل فالتثنية فيه - لأنه اسم - حسنة وأما وجه الضعف فلأنه على كل حال قد أعمل في الظاهر ولم يعمل إلا لشبهه بالفعل وإذا كان كذلك وجب له أن يقوى شبه الفعل ليقوم العذر بذلك في إعماله عمله ألا ترى أنهم لما شبهوا الفعل باسم الفاعل فأعربوه كنفوا هذا المعنى بينهما وأيدوه بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه.
وهذا في معناه واضح سديد كما تراه.
وأمثال هذا في الاحتجاج لهم بأفعالهم كثيرة وإنما أضع من كل شيء رسماً ما ليحتذى.
فأما الإطالة والاستيعاب فلا.
باب في الاحتجاج بقول المخالف
اعلم أن هذا - على ما في ظاهره - صحيح ومستقيم.
وذلك أن ينبغ من أصحابه نابغ فينشيء خلافاً ما على أهل مذهبه فإذا سمع خصمه به وأجلب عليه قال: هذا لا يقول به أحد من الفريقين فيخرجه مخرج التقبيح له والتشنيع عليه.
وذلك كإنكار أبي العباس جواز تقديم خبر ليس عليها فأحد ما يحتج به عليه أن يقال له: إجازة هذا مذهب سيبويه وأبي الحسن وكافة أصحابنا والكوفيون أيضاً معنا.
فإذا كانت إجازة ذلك مذهباً للكافة من البلدين وجب عليك - يا أبا العباس - أن تنفر عن خلافه وتستوحش منه ولا تأنس بأول خاطر يبدو لك فيه.
ولعمري إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم إلا أن فيه تشنيعاً عليه وإهابة به إلى تركه وإضافة لعذره في استمراره عليه وتهالكه فيه من غير إحكامه وإنعام الفحص عنه.
وإنما لم يكن فيه قطع لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو بنص أو ينتهك حرمة شرع.
فقس على ما ترى فإنني إنما أضع من كل شيء مثالاً موجزاً.
باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة
اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص.
والمقيس على النصوص فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه.
وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ( أمتي لا تجتمع على ضلالة ) وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة.
فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره.
إلا أننا - مع هذا الذي رأيناه وسوغناه مرتكبة - لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثها وتقدم نظرها وتتالت أواخر على أوائل وأعجازاً على كلاكل والقوم الذين لا نشك في أن الله - سبحانه وتقدست أسماؤه - قد هداهم لهذا العلم الكريم وأراهم وجه الحكمة في الترجيب له والتعظيم وجعله ببركاتهم وعلى أيدي طاعاتهم خادماً للكتاب المنزل وكلام نبيه المرسل وعوناً على فهمهما ومعرفة ما أمر به أو نهي عنه الثقلان منهما إلا بعد أن يناهضه إتقاناً ويثابته عرفاناً ولا يخلد إلى سانح خاطره ولا إلى نزوة من نزوات تفكره.
فإذا هو حذا على هذا المثال وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال أمضى الرأي فيما يريه الله منه غير معاز به ولا غاض من السلف - رحمهم الله - في شيء منه.
فإنه إذا فعل ذلك سدد رأيه.
وشيع خاطره وكان بالصواب مئنة ومن التوفيق مظنة وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: ما على الناس شيء أضر من قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئاً.
وقال أبو عثمان المازني: " وإذا قال العالم قولاً متقدماً فللمتعلم الاقتداء به والانتصار له والاحتجاج لخلافه إن وجد إلى ذلك سبيلاً " وقال الطائي الكبير: يقول من تطرق أسماعه كم ترك الأول للآخر! فمما جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بديء هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت ما رأيته أنا في قولهم: هذا جحر ضب خرب.
فهذا يتناوله آخر عن أول وتال عن ماض على أنه غلط من العرب لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه وأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه ولا يجوز رد غيره إليه.
وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفاً على ألف موضع.
وذلك أنه على حذف المضاف لا غير.
فإذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن والشعر ساغ وسلس وشاع وقبل.
وتلخيص هذا أن أصله: هذا جحر ضب خربٍ جحره فيجري " خرب " وصفاً على " ضب " وإن كان في الحقيقة للجحر.
كما تقول مررت برجل قائم أبوه فتجري " قائماً وصفاً على " رجل " وإن كان القيام للأب لا للرجل لما ضمن من ذكره.
والأمر في هذا أظهر من أن يؤتى بمثال له أو شاهد عليه.
فلما كان أصله كذلك حذف الجحر المضاف إلى الهاء وأقيمت الهاء مقامه فارتفعت لأن المضاف المحذوف كان مرفوعاً فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس " خرب " فجرى وصفاً على ضب - وإن كان الخراب للجحر لا للضب - على تقدير حذف المضاف على ما أرينا.
وقلت آية تخلو من حذف المضاف نعم وربما كان في الآية الواحدة من ذلك عدة مواضع.
وعلى نحو من هذا حمل أبو علي رحمه الله: كبير أناس في بجاد مزمل ولم يحمله على الغلط قال: لأنه أراد: مزمل فيه ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول.
فإذا أمكن ما قلنا ولم يكن أكثر من حذف المضاف الذي قد شاع واطرد كان حمله عليه أولى من حمله على الغلط الذي لا يحمل غيره عليه ولا يقاس به.
أو مذهب جدد على ألواحه الناطق المبروز والمختوم أي المبروز به ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول.
وعليه قول الآخر: إلى غير موثوق من الأرض تذهب أي موثوق به ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول.
باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط
قد يفعل أصحابنا ذلك إذا كانت الزيادة مثبتة لحال المزيد عليه.
وذلك كقولك في همز " أوائل ": أصله " أواول " فلما اكتنفت الألف واوان وقربت الثانية منهما من الطرف ولم يؤثر إخراج ذلك على الأصل تنبيهاً على غيره من المغيرات في معناه ولا هناك ياء قبل الطرف منوية مقدرة وكانت الكلمة جمعاً ثقل ذلك فأبدلت الواو همزة فصار أوائل.
فجميع ما أوردته محتاج إليه إلا ما استظهرت به من قولك: وكانت الكلمة جمعاً فإنك لو لم تذكره لم يخلل ذلك بالعلة ألا ترى أنك لو بنيت من قلت وبعت واحداً على فواعل كعوارض أو أفاعل " من أول أو يوم أو ويح " كأباتر لهمزت كما تهمز في الجمع.
فذكرك الجمع في أثناء الحديث إنما زدت الحال به أنساً من حيث كان الجمع في غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء في نحو حقي ودلي فذكرته هنا تأكيداً لا وجوباً.
وذكراك أنهم لم يؤثروا في هذا إخراج الحرف على أصله دلالة على أصل ما غير من غيره في نحوه لئلا يدخل عليك أن يقال لك: قد قال الراجز: تسمع من شدانها عواولا وذكرت أيضاً قولك: ولم يكن هناك ياء قبل الطرف مقدرة لئلا يلزمك قوله: وكحل العينين بالعواور ألا ترى أن أصله عواوير من حيث كان جمع عوار.
والاستظهار في هذين الموضعين أعني حديث عواول وعواور أسهل احتمالاً من دخولك تحت الإفساد عليك بهما واعتذارك من بعد بما قدمته في صدر العلة.
فإذا كان لا بد من إيراده فيما بعد إذا لم تحتط بذكره فيما قبل كان الرأي تقديم ذكره والاستراحة من التعقب عليك به.
فهذا ضرب.
ولو استظهرت بذكر ما لا يؤثر في الحكم لكان ذلك منك خطلاً ولغواً من القول ألا ترى أنك لو سئلت عن رفع طلحة من قولك: جاءني طلحة فقلت: ارتفع لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث أو لأنه علم لم يكن ذكرك التأنيث والعلمية إلا كقولك: ولأنه مفتوح الطاء أو لأنه ساكن عين الفعل ونحو ذلك مما لا يؤثر في الحال.
فاعرف بذلك موضع ما يمكن الاحتياط به للحكم مما فإن قيل: هلا كان ذكرك أنت أيضاً هنا الفعل لا وجه له ألا ترى أنه إنما ارتفع بإسناد غيره إليه فاعلاً كان أو مبتدأ.
والعلة في رفع الفاعل هي العلة في رفع المبتدأ وإن اختلفا من جهة التقديم والتأخير قلنا: لا لسنا نقول هكذا مجرداً وإنما نقول في رفع المبتدأ: إنه إنما وجب ذلك له من حيث كان مسنداً إليه عارياً من العوامل اللفظية قبله فيه وليس كذلك الفاعل لأنه وإن كان مسنداً إليه فإن قبله عاملاً لفظياً قد عمل فيه وهو الفعل وليس كذلك قولنا: زيد قام لأن هذا لم يرتفع لإسناد الفعل إليه حسب دون أن انضم إلى ذلك تعريه من العوامل اللفظية من قبله.
فلهذا قلنا: ارتفع الفاعل بإسناد الفعل إليه ولم نحتج فيما بعد إلى شيء نذكره كما احتجنا إلى ذلك في باب المبتدأ ألا تراك تقول: إن زيداً قام فتنصبه - وإن كان الفعل مسنداً إليه - لما لم يعر من العامل اللفظي الناصبه.
فقد وضح بذلك فرق ما بين حالي المبتدأ والفاعل في وصف تعليل ارتفاعهما وأنهما وإن اشتركا في كون كل واحد منهما مسنداً إليه فإن هناك فرقاً من حيث أرينا.
ومن ذلك قولك في جواب من سألك عن علة انتصاب زيد من قولك: ضربت زيداً: إنه إنما انتصب لأنه فضلة ومفعول به فالجواب قد استقل بقولك: لأنه فضلة وقولك من بعد: " ومفعول به " تأنيس وتأييد لا ضرورة بك إليه ألا ترى أنك تقول في نصب " نفس " من قولك: طبت به نفساً: إنما انتصب لأنه فضلة وإن كانت النفس هنا فاعلة في المعنى.
فقد علمت بذلك أن قولك: ومفعول به زيادة على العلة تطوعت بها.
غير أنه في ذكرك كونه مفعولاً معنى ما وإن كان صغيراً.
وذلك أنه قد ثبت وشاع في الكلام أن الفاعل رفع والمفعول به نصب وكأنك أنست بذلك شيئاً.
وأيضاً فإن فيه ضرباً من الشرح.
وذلك أن كون الشيء فضلة لا يدل على أنه لا بد من أن يكون مفعولاً به ألا ترى أن الفضلات كثيرة كالمفعول به والظرف والمفعول له والمفعول معه والمصدر والحال والتمييز والاستثناء.
فلما قلت: ومفعول به ميزت أي الفضلات هو.
فاعرف ذلك وقسه.
باب في عدم النظير
أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير.
وذلك مذهب الكتاب فإنه حكى فيما جاء على فِعِلٍ " إبلا " وحدها ولم يمنع الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه.
فأما إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير ألا ترى إلى عِزويت لما لم يقم الدليل على أن واوه وتاءه أصلان احتجت إلى التعلل بالنظير فمنعت من أن يكون فِعويلا لما لم تجد له نظيراً وحملته على فِعليت لوجود النظير وهو عفريت ونفريت.
وكذلك قال أبو عثمان في الرد على من ادعى أن السين وسوف ترفعان الأفعال المضارعة: لم نر عاملاً في الفعل تدخل عليه اللام وقد قال سبحانه {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ}.
فجعل عدم النظير رداً على من أنكر قوله.
وأما إن لم يقم الدليل ولم يوجد النظير فإنك تحكم مع عدم النظير.
وذلك كقولك في الهمزة والنون من أندلس: إنهما زائدتان وإن وزن الكلمة بهما " أنفعُل " وإن كان مثالاً لا نظير له.
وذلك أن النون لا محالة زائدة لأنه ليس في ذوات الخمسة شيء على " فعلَلُل " فتكون النون فيه أصلاً لوقوعها موقع العين وإذا ثبت أن النون زائدة فقد برد في يدك ثلاثة أحرف أصول وهي الدال واللام والسين وفي أول الكلمة همزة ومتى وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة ولا تكون النون أصلاً والهمزة زائدة لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزوائد من أوائلها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو مدحرج وبابه.
فقد وجب إذاً أن الهمزة والنون زائدتان وأن الكلمة بهما على أنفعل وإن كان هذا مثالاً لا نظير له.
فإن ضام الدليل النظير فلا مذهب بك عن ذلك وهذا كنون عنتر.
فالدليل يقضي بكونها أصلاً لأنها مقابلة لعين جعفر والمثال أيضاً معك وهو " فعلَل " وكذلك القول على بابه.
فاعرف ذلك وقس.
باب في إسقاط الدليل
وذلك كقول أبي عثمان: لا تكون الصفة غير مفيدة فلذلك قلت: مررت برجل أفعل.
فصرف أفعل هذه لما لم تكن الصفة مفيدة.
وإسقاط هذا أن يقال له: قد جاءت الصفة غير مفيدة.
وذلك كقولك في جواب من قال رأيت زيداً: آلمنيّ يا فتى فالمنيّ صفة وغير مفيدة.
ومن ذلك قول البغداديين: إن الاسم يرتفع بما يعود عليه من ذكره نحو زيد مررت به وأخوك أكرمته.
فارتفاعه عندهم إنما هو لأن عائداً عاد عليه فارتفع بذلك العائد.
وإسقاط هذا الدليل أن يقال لهم: فنحن نقول: زيد هل ضربته وأخوك متى كلمته ومعلوم أن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله فكما اعتبر أبو عثمان أن كل صفة فينبغي أن تكون مفيدة فأوجد أن من الصفات ما لا يفيد وكان ذلك كسراً لقوله كذلك قول هؤلاء: إن كل عائد على اسم عار من العوامل يرفعه يفسده وجود عائد على اسم عار من العوامل وهو غير رافع له فهذا طريق هذا.
باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين
وذلك عندنا على أوجه: احدها أن يكون أحدهما مرسلاً والآخر معللاً.
فإذا اتفق ذلك كان المذهب الأخذ بالمعلل ووجب مع ذلك أن يتأول المرسل.
وذلك كقول صاحب الكتاب - في غير موضع - في التاء من " بنت وأخت ": إنها للتأنيث وقال أيضاً مع ذلك في باب ما ينصرف وما لا ينصرف: إنها ليست للتأنيث.
واعتل لهذا القول بأن ما قبلها ساكن وتاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها ساكناً إلا أن يكون ألفاً كقناة وفتاة وحصاة والباقي كله مفتوح كرطبة وعنبة وعلامة ونسابة.
قال: ولو سميت رجلاً ببنت وأخت لصرفته.
وهذا واضح.
فإذا ثبت هذا القول الثاني بما ذكرناه وكانت التاء فيه إنما هي عنده على ما قاله بمنزلة تاء " عفريت " و " ملكوت " وجب أن يحمل قوله فيها: إنها للتأنيث على المجاز وأن يتأول ولا يحمل القولان على التضاد.
ووجه الجمع بين القولين أن هذه التاء وإن لم تكن عنده للتأنيث فإنها لما لم توجد في الكلمة إلا في حال التأنيث استجاز أن يقول فيها: إنها للتأنيث ألا ترى أنك إذا ذكرت قلت " ابن " فزالت التاء كما تزول التاء من قولك: ابنة.
فلما ساوقت تاء بنت تاء ابنة وكانت تاء ابنة للتأنيث قال في تاء بنت ما قال في تاء ابنة.
وهذا من أقرب ما يتسمح به في هذه الصناعة ألا ترى أنه قال في عدة مواضع في نحو " حمراء " و " أصدقاء " و " عشراء " وبابها: إن الألفين للتأنيث وإنما صاحبة التأنيث منهما الأخيرة التي قلبت همزة لا الأولى وإنما الأولى زيادة لحقت قبل الثانية التي هي كألف " سكرى " و " عطشى " فلما التقت الألفان وتحركت الثانية قلبت همزة.
ويدل على أن الثانية للتأنيث وأن الأولى ليست له أنك لو اعتزمت إزالة العلامة للتأنيث في هذا الضرب من الأسماء غيرت الثانية وحدها ولم تعرض للأولى.
وذلك قولهم " حمراوان " و " عشراوات " و " صحراوي ".
وهذا واضح.
قال أبو علي رحمه الله: ليس بنت من ابن كصعبة من صعب إنما تأنيث ابن على لفظه ابنة.
والأمر على ما ذكر.
فإن قلت: فهل في بنت وأخت علم تأنيث أو لا قيل: بل فيهما علم تأنيث.
فإن قيل: وما ذلك العلم قيل: الصيغة " فيهما علامة تأنيثهما " وذلك أن أصل هذين الاسمين عندنا فعل: بنو وأخو بدلالة تكسيرهم إياهما على أفعال في قولهم: أبناء وآخاء.
قال بشر بن المهلب: فلما عدلاعن فَعل إلى فِعل وفُعل وأبدلت لاماهما تاء فصارتا بنتا وأختا كان هذا العمل وهذه الصيغة علماً لتأنيثهما ألا تراك إذا فارقت هذا الموضع من التأنيث رفضت هذه الصيغة البتة فقلت في الإضافة إليهما: بنوي وأخوي كما أنك إذا أضفت إلى ما فيه علامة تأنيث أزلتها البتة نحو حمراوي وطلحي وحبلوي.
فأما قول يونس: بنتي وأختي فمردود عند سيبويه.
وليس هذا الموضع موضوعاً للحكم بينهما وإن كان لقول يونس أصول تجتذبه وتسوغه.
وكذلك إن قلت: إذا كان سيبويه لا يجمع بين ياءي الإضافة وبين صيغة بنت وأخت من حيث كانت الصيغة علماً لتأنيثهما فلم صرفهما علمين لمذكر وقد أثبت فيهما علامة تأنيث بفكها ونقضها مع ما لا يجامع علامة التأنيث: من ياءي الإضافة في بنوي وأخوي فإذا أثبت في الاسمين بها علامة للتأنيث فهلا منع الاسمين الصرف بها مع التعريف كما تمنع الصرف باجتماع التأنيث إلى التعريف في نحو طلحة وحمزة وبابهما فإن هذا أيضاً مما قد أجبنا عنه في موضع آخر.
وكذلك القول في تاء ثنتان وتاء ذيت وكيت وكلتى: التاء في جميع ذلك بدل من حرف علة كتاء بنت وأخت وليست للتأنيث.
إنما التاء في ذية وكية واثنتان وابنتان للتأنيث.
فإن قلت: فمن أين لنا في علامات التأنيث ما يكون معنى لا لفظاً قيل: إذا قام الدليل لم يلزم النظير.
وأيضاً فإن التاء في هذا وإن لم تكن للتأنيث فإنها بدل خص التأنيث والبدل وإن كان كالأصل لأنه بدل منه فإن له أيضاً شبهاً بالزائد من موضع آخر وهو كونه غير أصل كما أن الزائد غير أصل ألا ترى إلى ما حكاه عن أبي الخطاب من قول بعضهم في راية: راءة بالهمز كيف شبه ألف راية - وإن كانت بدلاً من العين - بالألف الزائدة فهمز اللام بعدها كما يهمزها بعد الزائدة في نحو سقاء وقضاء.
وأما قول أبي عمر: إن التاء في كلتى زائدة وإن مثال الكلمة بها " فِعتل " فمردود عند أصحابنا لما قد ذكر في معناه من قولهم: إن التاء لا تزاد حشواً إلا في " افتعل " وما تصرف منه " و " لغير ذلك غير أني قد وجدت لهذا القول نحواً ونظيراً.
وذلك فيما حكاه الأصمعي من قولهم للرجل القواد: الكلتبان وقال مع ذلك: هو من الكَلَب وهو القيادة.
فقد ترى التاء على هذا زائدة حشواً ووزنه فعتلان.
ففي هذا شيئان: أحدهما التسديد من قول أبي عمر والآخر إثبات مثال فائت للكتاب.
وأمثل ما يصرف إليه ذلك أن يكون الكلب ثلاثياً والكلتبان رباعياً كزرم وازرأم وضفد واضفأد وكزغَّب الفرخ وازلَغب ونحو ذلك من الأصلين الثلاثي والرباعي المتداخلين.
وهذا غور عرض فقلنا فيه ولنعد.
ومن ذلك أن يرد اللفظان عن العالم متضادين على غير هذا الوجه.
وهو أن يحكم في شيء بحكم ما ثم يحكم فيه نفسه بضده غير أنه لم يعلل أحد القولين.
فينبغي حينئذ أن ينظر إلى الأليق بالمذهب والأجرى على قوانينه فيجعل هو المراد المعتزم منهما ويتأول الآخر إن أمكن.
وذلك كقوله: حتى الناصبة للفعل وقد تكرر من قوله أنها حرف من حروف الجر وهذا ناف لكونها ناصبة له من حيث كانت عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال فضلاً عن أن تعمل فيها.
وقد استقر من قوله في غير مكان ذكر عدة الحروف الناصبة للفعل وليست فيها حتى.
فعلم بذلك وبنصه عليه في غير هذا الموضع أن " أن " مضمرة عنده بعد حتى كما تضمر مع اللام الجارة في نحو قوله سبحانه {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ} ونحو ذلك.
فالمذهب إذاً هو هذا.
ووجه القول في الجمع بين القولين بالتأويل أن الفعل لما انتصب بعد حتى ولم تظهر هناك " أن " وصارت حتى عوضاً منها ونائبة عنها نسب النصب إلى " حتى " وإن كان في الحقيقة ل " أن ".
ومثله معنى لا إعراباً قول الله سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فظاهر هذا تناف بين الحالتين لأنه أثبت في أحد القولين ما نفاه قبله: وهو قوله ما رميت إذ رميت.
ووجه الجمع بينهما أنه لما كان الله أقدره على الرمي ومكنه منه وسدده له وأمره به فأطاعه في فعله نسب الرمي إلى الله وإن كان مكتسباً للنبي صلى الله عليه وسلم مشاهداً منه.
ومثله معنىً قولهم: أذن ولم يؤذن وصلى ولم يصل ليس أن الثاني ناف للأول لكنه لما لم يعتقد الأول مجزئاً لم يثبته صلاة ولا أذاناً.
وكلام العرب لمن عرفه وتدرب بطريقها فيه جار مجرى السحر لطفاً وإن جسا عنه أكثر من ترى وجفا.
ومن ذلك أن يرد اللفظان عن العالم متضادين غير أنه قد نص في أحدهما على الرجوع عن القول الآخر فيعلم بذلك أن رأيه مستقر على ما أثبته ولم ينفه وأن القول الآخر مطرح من رأيه.
فإن تعارض القولان مرسلين غير مبان أحدهما من صاحبه بقاطع يحكم عليه به بحث عن تاريخهما فعلم أن الثاني هو ما اعتزمه وأن قوله به انصراف منه عن القول الأول إذ لم يوجد في أحدهما ما يماز به عن صاحبه.
فإن استبهم الأمر فلم يعرف التاريخ وجب سبر المذهبين وإنعام الفحص عن حال القولين.
فإن كان أحدهما أقوى من صاحبه وجب إحسان الظن بذلك العالم وأن ينسب إليه أن الأقوى منهما هو قوله الثاني الذي به يقول وله يعتقد وأن الأضعف منهما هو الأول منهما الذي تركه إلى الثاني.
فإن تساوى القولان في القوة وجب أن يعتقد فيهما أنهما رأيان له فإن الدواعي إلى تساوي القولان في القوة وجب أن يعتقد فيهما أنهما رأيان له فإن الدواعي إلى تساويهما فيهما عند الباحث عنهما هي الدواعي التي دعت القائل بهما إلى أن اعتقد كلاً منهما.
هذا بمقتضى العرف وعلى إحسان الظن فأما القطع البات فعند الله علمه.
وعليه طريق الشافعي في قوله بالقولين فصاعداً.
وقد كان أبو الحسن ركاباً لهذا الثبج آخذاً به غير محتشم منه وأكثر كلامه في عامة كتبه عليه.
" وكنت إذا ألزمت عند أبي علي - رحمه الله - قولاً لأبي الحسن شيئاً لا بد للنظر من إلزامه إياه يقول لي: مذاهب أبي الحسن كثيرة ".
ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أبو العباس تتبع به كلام سيبويه وسماه مسائل الغلط.
فحدثني أبو علي عن أبي بكر أن أبا العباس كان يعتذر منه ويقول: هذا شيء كنا رأيناه في أيام الحداثة فأما الآن فلا.
وحدثنا أبو علي قال: كان أبو يوسف إذا أفتى بشيء أو أمل شيئاً فقيل له: قد قلت في موضع كذا غير هذا يقول: هذا يعرفه من يعرفه أي إذا أنعم النظر في القولين وجدا مذهباً واحداً.
وكان أبو علي - رحمه الله - يقول في هيهات: أنا أفتي مرة بكونها اسماً سمي به الفعل كصه ومه وأفتى مرة أخرى بكونها ظرفاً على قدر ما يحضرني في الحال.
وقال مرة أخرى: إنها وإن كانت ظرفاً فغير ممتنع أن تكون مع ذلك اسماً سمي به الفعل كعندك ودونك.
وكان إذا سمع شيئاً من كلام أبي الحسن يخالف قوله يقول: عكر الشيخ.
وهذا ونحوه من خلاج الخاطر وتعادي المناظر هو الذي دعا اقواماً إلى أن قالوا بتكافؤ الأدلة واحتملوا أثقال الصغار والذلة.
وحدثني أبو علي: قال: قلت لأبي عبد الله البصري: أنا أعجب من هذا الخاطر في حضوره تارة ومغيبه اخرى.
وهذا يدل على أنه من عند الله.
فقال: نعم هو من عند الله إلا أنه لا بد من تقديم النظر ألا ترى أن حامداً البقال لا يخطر له.
ومن طريف حديث هذا الخاطر أنني كنت منذ زمان طويل رأيت رأياً جمعت فيه بين معنى آية ومعنى قول الشاعر: وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر ولم أثبت حينئذ شرح حال الجمع بينهما ثقة بحضوره متى استحضرته ثم إني الآن - وقد مضى له سنون - أعان الخاطر وأستثمده وأفانيه وأتودده على أن يسمح لي بما كان أرانيه من الجمع بين معنى الآية والبيت وهو معتاص متأب وضنين به غير معط.
وكنت وأنا أنسخ التذكرة لأبي علي إذا مر بي شيء قد كنت رأيت طرفاً منه أو ألممت به فيما قبل أقول له: قد كنت شارفت هذا الموضع وتلوح لي بعضه ولم أنته إلى آخره وأراك أنت قد جئت به واستوفيته وتمكنت فيه فيبتسم - رحمه الله - له ويتطلق إليه سروراً وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن علي الرازي - رحمه الله - وقد أفضنا في ذكر أبي علي ونبل قدره ونباوة محله: أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع أصحابنا فأصغى أبو بكر إليه ولم يتبشع هذا القول عليه.
وإنما تبسطت في هذا الحديث ليكون باعثاً على إرهاف الفكر واستحضار الخاطر والتطاول إلى ما أوفى نهده وأوعر سمته وبالله سبحانه الثقة.
باب في الدور والوقوف منه على أول رتبة
هذا موضع كان أبو حنيفة - رحمه الله - يراه ويأخذ به.
وذلك أن تؤدي الصنعة إلى حكم ما مثله مما يقتضي التغيير فإن أنت غيرت صرت أيضاً إلى مراجعة مثل ما منه هربت.
فإذا حصلت على هذا وجب أن تقيم على أول رتبة ولا تتكلف عناء ولا مشقة.
وأنشدنا أبو علي - رحمه الله - غير دفعة بيتاً مبني معناه على هذا وهو: رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا وذلك كأن تبني من قويت مثل رسالة فتقول على التذكير: قواءة وعلى التأنيث: قواوة ثم تكسرها على حد قول الشاعر: موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطينا يحلبون الأتاويا - جمع إتاوة - فيلزمك أن تقول حينئذ: قواوٍ فتجمع بين واوين مكتنفتي ألف التكسير ولا حاجز بين الأخيرة منهما وبين الطرف.
ووجه ذلك أن الذي قال " الأتاويا " إنما أراد جمع إتاوة وكان قياسه أن يقول: أتاوى كقوله في علاوة وهراوة: علاوى وهراوى غير أن هذا الشاعر سلك طريقاً أخرى غير هذه.
وذلك أنه لما كسر إتاوة حدث في مثال التكسير همزة بعد ألفه بدلاً من ألف فعالة كهمزة رسائل وكنائن فصار التقدير به إلى أتاء ثم تبدل من كسرة الهمزة فتحة لأنها عارضة في الجمع واللام معتلة كباب مطايا وعطايا فتصير حينئذ إلى أتاءى ثم تبدل من الياء ألفاً فتصير إلى أتاءا ثم تبدل من الهمزة واواً لظهورها لاماً في الواحد فتقول: أتاوى كعلاوى.
وكذا تقول العرب في تكسير إتاوة: أتاوى.
غير أن هذا الشاعر لو فعل ذلك لأفسد قافيته فاحتاج إلى قرار الكسرة بحالها لتصح بعدها الياء التي هي روي القافية كما معها من القوافي التي هي " الروابيا " و " الأدانيا " ونحو ذلك فلم يستجز أن يقر الهمزة العارضة في الجمع بحالها إذ كانت العادة في هذه الهمزة أن تعل وتغير إذا كانت اللام معتلة فرأى إبدال همزة أتاء واواً ليزول لفظ الهمزة التي من عادتها في هذا الموضع أن تعل ولا تصح لما ذكرنا فصار " الأتاويا ".
وكذلك قياس فعالة من القوة إذا كسرت أن تصير بها الصنعة إلى قواء ثم تبدل من الهمزة الواو كما فعل من قال " الأتاويا " فيصير اللفظ إلى قواو.
فإن أنت استوحشت من اكتناف الواوين لألف التكسير على هذا الحد وقلت: أهمز كما همزت في أوائل لزمك أن تقول: قواء ثم يلزمك ثانياً أن تبدل من هذه الهمزة الواو على ما مضى من حديث " الأتاويا " فتعاود أيضاً قواو ثم لا تزال بك قوانين الصنعة إلى أن تبدل من الهمزة الواو ثم من الواو الهمزة ثم كذلك ثم كذلك إلى ما لا غاية.
فإن أدت الصنعة إلى هذا ونحوه وجبت الإقامة على أول رتبة منه وألا تتجاوز إلى أمر ترد بعد إليها ولا توجد سبيلاً ولا منصرفاً عنها.
فإن قلت: إن بين المسألتين فرقاً.
وذلك أن الذي قال " الأتاويا " إنما دخل تحت هذه الكلفة والتزم ما فيها من المشقة وهي ضرورة واحدة وأنت إذا قلت في تكسير مثال فعالة من القوة: قواو قد التزمت ضرورتين: إحداهما إبدالك الهمزة الحادثة في هذا المثال واواً على ضرورة " الأتاويا " والأخرى كنفك الألف بالواوين مجاوراً آخرهما الطرف فتانك ضرورتان وإنما هي في " الأتاويا " واحدة.
وهذا فرق يقود إلى اعتذار وترك.
قيل: هذا ساقط وذلك أن نفس السؤال قد كان ضمن ما يلغي هذا الاعتراض ألا ترى أنه كان: كيف يكسر مثال فعالة من القوة على قول من قال " الأتاويا " والذي قال ذلك كان قد أبدل من الهمزة العارضة في الجمع واواً فكذلك فأبدلها أنت أيضاً في مسألتك.
فأما كون ما قبل الألف واواً أو غير ذلك من الحروف فلم يتضمن السؤال ذكراً له ولا عيجاً به فلا يغني إذاً ذكره ولا الاعتراض على ما مضى بحديثه أفلا ترى أن هذا الشاعر لو كان يسمح نفساً بأن يقر هذه الهمزة العارضة في أتاء مكسورة بحالها كما أقرها الآخر في قوله: وكان أبو علي ينشدنا: .
.
.
فوق ست سمائيا لقال " الأتائيا " كقوله " سمائيا ".
فقد علمت بذلك شدة نفوره عن إقرار الهمزة العارضة في هذا الجمع مكسورة.
وإنما اشتد ذلك عليه ونبا عنه لأمر ليس موجوداً في واحد " سمائيا " الذي هو سماء.
وذلك أن في إتاوة واواً ظاهرة فكما أبدل غيره منها الواو مفتوحة في قوله " الأتاوى " كالعلاوى والهراوى تنبيهاً على كون الواو ظاهرة في واحدة - أعني إتاوة - كوجودها في هراوة وعلاوة كذلك أبدل منها الواو في أتاو وإن كانت مكسورة شحاً على الدلالة على حال الواحد وليس كذلك قوله: .
.
.
فوق سبع سمائيا ألا ترى أن لام واحدة ليست واواً في اللفظ فتراعى في تكسيره كما روعيت في تكسير هراوة وعلاوة.
فهذا فرق - كم تراه - واضح.
نعم وقد يلتزم الشاعر لإصلاح البيت ما تتجمع فيه أشياء مستكرهة لا شيئان اثنان: وذلك أكثر من أن يحاط به.
فإذا كان كذلك لزم ما رمناه وصح به ما قدمناه.
فهذا طريق ما يجيء عليه فقس ما يرد عليك به.
باب في الحمل على أحسن الأقبحين
اعلم أن هذا موضع من مواضع الضرورة المميلة.
وذلك أن تحضرك الحال ضرورتين لا بد من ارتكاب إحداهما فينبغي حينئذ أن تتحمل الأمر على أقربهما وأقلهما فحشاً.
وذلك كواو " ورنتل " أنت فيها بين ضرورتين: إحداهما أن تدعي كونها اصلاً في ذوات الأربعة غير مكررة والواو لا توج في ذوات الأربعة إلا مع التكرير نحو الوصوصة والوحوحة وضوضيت وقوقيت.
والآخر أن تجعلها زائدة أولاً والواو لا تزاد أولاً.
فإذا كان كذلك كان أن تجعلها أصلاً أولى من أن تجعلها زائدة وذلك أن الواو قد تكون أصلاً في ذوات الأربعة على وجه من الوجوه أعني في حال التضعيف.
فأما أن تزاد أولاً فإن هذا أمر لم يوجد على حال.
فإذا كان كذلك رفضته ولم تحمل الكلمة عليه.
ومثل ذلك قولك: فيها قائماً رجل.
لما كنت بين أن ترفع قائماً فتقدم الصفة على الموصوف - وهذا لا يكون - وبين أن تنصب الحال من النكرة - وهذا على قلته جائز - حملت المسئلة على الحال فنصبت.
وكذلك ما قام إلا زيداً أحد عدلت إلى النصب لأنك إن رفعت لم تجد قبله ما تبدله منه وإن نصبت دخلت تحت تقديم المستثنى على ما استثني منه.
وهذا وإن كان ليس في قوة تأخيره عنه فقد جاء على كل حال.
فاعرف ذلك أصلاً في العربية تحمل عليه غيره.
باب في حمل الشيء على الشيء من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم
اعلم أن هذا باب طريقه الشبه اللفظي وذلك كقولنا في الإضافة إلى ما فيه التأنيث بالواو وذلك نحو حمراوي وصفراوي وعشراوي.
وإنما قلبت الهمزة فيه ولم تقر بحالها لئلا تقع علامة التأنيث حشواً.
فمضى هذا على هذا لا يختلف.
ثم إنهم قالوا في الإضافة إلى عِلباء: علباوي وإلى حِرباء: حرباوي فأبدلوا هذه الهمزة وإن لم تكن للتأنيث لكنها لما شابهت همزة حمراء وبابها بالزيادة حملوا عليها همزة علباء.
ونحن نعلم أن همزة حمراء لم تقلب في حمراوي لكونها زائدة فتشبه بها همزة علباء من حيث كانت زائدة مثلها لكن لما اتفقتا في الزيادة حملت همزة علباء على همزة حمراء.
ثم إنهم تجاوزوا هذا إلى أن قالوا في كساء وقضاء: كساوي وقضاوي فأبدلوا الهمزة واواً حملاً لها على همزة علباء من حيث كانت همزة كساء وقضاء مبدلة من حرف ليس للتأنيث فهذه علة غير الأولى ألا تراك لم تبدل همزة علباء واواً في علباوي لأنها ليست للتأنيث فتحمل عليها همزة كساء وقضاء من حيث كانتا لغير التأنيث.
ثم إنهم قالوا من بعد في قراء: قراوي فشبهوا همزة قراء بهمزة كساء من حيث كانتا أصلاً غير زائدة كما أن همزة كساء غير زائدة.
وأنت لم تكن أبدلت همزة كساء في كساوي من حيث كانت غير زائدة لكن هذه أشباه لفظية يحمل أحدها على ما قبله تشبثاً به وتصوراً له.
وإليه وإلى نحوه أومأ سيبويه بقوله: وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً.
وعلى ذلك قالوا: صحراوات فأبدلوا الهمزة واواً لئلا يجمعوا بين علمي تأنيث ثم حملوا التثنية عليه من حيث كان هذا الجمع على طريق التثنية ثم قالوا: علباوان حملاً بالزيادة على حمراوان ثم قالوا: كساوان تشبيهاً له بعلباوان ثم قالوا: قُرّاوان حملاً له على كساوان على ما تقدم.
وسبب هذه الحمول والإضافات والإلحاقات كثرة هذه اللغة وسعتها وغلبة حاجة أهلها إلى التصرف فيها والتركح في أثنائها لما يلابسونه ويكثرون استعماله من الكلام المنثور والشعر الموزون والخطب والسجوع ولقوة إحساسهم في كل شيء شيئاً وتخيلهم ما لا يكاد يشعر به من لم يألف مذاهبهم.
وعلى هذا ما منع الصرف من الأسماء للشبه اللفظي نحو أحمر وأصفر وأصرم وأحمد وتألب وتنضب علمين لما في ذلك من شبه لفظ الفعل فحذفوا التنوين من الاسم لمشابهته ما لا حصة له في التنوين وهو الفعل.
والشبه اللفظي كثير.
وهذا كاف.
باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني
اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية وأكرمها وأعلاها وأنزهها.
وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يؤنقك ويذهب في الاستحسان له كل مذهب بك.
وذلك أن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدراً في نفوسها.
فأول ذلك عنايتها بألفاظها.
فإنها لما كانت عنوان معانيها وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها ورتبوها وبالغوا في تحبيرها وتحسينها ليكون ذلك أوقع لها في السمع وأذهب بها في الدلالة على القصد ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعا لذ لسامعه فحفظه فإذا هو حفظه كان جديراً باستعماله ولو لم يكن مسجوعاً لم تأنس النفس به ولا أنقت لمستمعه وإذا كان كذلك لم تحفظه وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له وجيء به من أجله.
وقال لنا أبو علي يوماً: قال لنا أبو بكر: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه.
وكذلك الشعر: النفس له أحفظ وإليه أسرع ألا ترى أن الشاعر قد يكون راعياً جلفاً أو عبداً عسيفاً تنبو صورته وتمج جملته فيقول ما يقوله من الشعر فلأجل قبوله وما يورده عليه من طلاوته وعذوبة مستمعه ما يصير قوله حكماً يرجع إليه ويقتاس به ألا ترى إلى قول العبد الأسود: إن كنت عبداً فنفسي حرة كرماً أو أسود اللون إني أبيض الخلق وقول نصيب: سودت فلم أملك سوادي وتحته قميص من القوهي بيض بنائقه وقول الآخر: إني وإن كنت صغيراً سني وكان في العين نبوٌ عني فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فن حتى يزيل عني التظني فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها وحموا حواشيها وهذبوها وصقلوا غروبها وأرهفوها فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتنويه بها وتشريف منها.
ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته وتقديسه وإنما المبغي بذلك منه الاحتياط للموعى عليه وجواره بما يعطر بشره ولا يعر جوهره كما قد نجد من المعاني الفاخرة السامية ما يهجنه ويغض منه كدرة لفظه وسوء العبارة عنه.
فإن قلت: فإنا نجد من ألفاظهم ما قد نمقوه وزخرفوه ووشوه ودبجوه ولسنا نجد مع ذلك تحته معنى شريفاً بل لا نجد قصداً ولا مقارباً ألا ترى إلى قوله: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح فقد ترى إلى علو هذا اللفظ ومائه وصقاله وتلامح أنحائه ومعناه مع هذا ما تحسه وتراه: إنما هو: لما فرغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين وتحدثنا على ظهور الإبل.
ولهذا نظائر كثيرة شريفة الألفاظ رفيعتها مشروفة المعاني خفيضتها.
قيل: هذا الموضع قد سبق إلى التعلق به من لم ينعم النظر فيه ولا رأى ما أراه القوم منه وإنما ذلك لجفاء طبع الناظر وخفاء غرض الناطق.
وذلك أن في قوله " كل حاجة " ما يفيد منه أهل النسيب والرقة وذوو الأهواء والمقة ما لا يفيده غيرهم ولا يشاركهم فيه من ليس منهم ألا ترى أن من حوائج منى أشياء كثيرة غير ما الظاهر عليه والمعتاد فيه سواها لأن منها التلاقي ومنها التشاكي ومنها التخلي إلى غير ذلك مما هو تال له ومعقود الكون به.
وكأنه صانع عن هذا الموضع الذي أومأ إليه وعقد غرضه عليه بقوله في آخر البيت: ومسح بالأركان من هو ماسح أي إنما كانت حوائجنا التي قضيناها وآرابنا التي أنضيناها من هذا النحو الذي هو مسح الأركان وما هو لاحق به وجار في القربة من الله مجراه أي لم يتعد هذا القدر المذكور إلى ما يحتمله أول البيت من التعريض الجاري مجرى التصريح.
وأما البيت الثاني فإن فيه: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وفي هذا ما أذكره لتراه فتعجب ممن عجب منه ووضع من معناه.
وذلك أنه لو قال: أخذنا في أحاديثنا ونحو ذلك لكان فيه معنى يكبره أهل النسيب وتعنو له ميعة الماضي الصليب.
وذلك أنهم قد شاع عنهم واتسع في محاوراتهم علو قدر الحديث بين الأليفين والفكاهة بجمع شمل المتواصلين ألا ترى إلى قول الهذلي: وإن حديثاً منك لو تعلمينه جنى النخل في ألبان عوذ مطافل وحديثها كالغيث يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا فأصاخ يرجو أن يكون حياً ويقول من فرح هيا ربا وقال الآخر: وحدثتني يا سعد عنها فزدتني جنوناً فزدني من حديثك يا سعد وقال المولد: وحديثها السحر الحلال لو انه لم يجن قتل المسلم المتحرز الأبيات الثلاثة.
فإذا كان قدر الحديث - مرسلاً - عندهم هذا على ما ترى فكيف به إذا قيده بقوله " بأطراف الأحاديث ".
وذلك أن قوله " أطراف الأحاديث " وحياً خفياً ورمزاً حلواً ألا ترى أنه يريد بأطرافها ما يتعاطاه المحبون ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح وذلك أحلى وأدمث وأغزل وأنسب من أن يكون مشافهة وكشفاً ومصارحة وجهراً وإذا كان كذلك فمعنى هذين البيتين أعلى عندهم وأشد تقدماً في نفوسهم من لفظهما وإن عذب موقعه وأنق له مستمعه.
نعم وفي قوله: فكأن العرب إنما تحلى ألفاظها وتدبجها وتشيها وتزخرفها عناية بالمعاني التي وراءها وتوصلا بها إلى إدراك مطالبها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن من الشعر لحكماً وإن من البيان لسحراً ).
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد هذا في ألفاظ هؤلاء القوم التي جعلت مصايد وأشراكاً للقلوب وسبباً وسلماً إلى تحصيل المطلوب عرف بذلك أن الألفاظ خدم للمعاني والمخدوم - لا شك - أشرف من الخادم.
والأخبار في التلطف بعذوبة الألفاظ إلى قضاء الحوائج أكثر من أن يؤتى عليها أو يتجشم للحال نعت لها ألا ترى إلى قول بعضهم وقد سأل آخر حاجة فقال المسئول: إن علي يميناً ألا أفعل هذا.
فقال له السائل: إن كنت - أيدك الله - لم تحلف يميناً قط على أمر فرأيت غيره خيراً منه فكفرت عنها له وأمضيته فما أحب أن أحنثك وإن كان ذلك قد كان منك فلا تجعلني أدون الرجلين عندك.
فقال له: سحرتني وقضى حاجته.
وندع هذا ونحوه لوضوحه ولنأخذ لما كنا عليه فنقول: مما يدل عىل اهتمام العرب بمعانيها وتقدمها في أنفسها على ألفاظها أنهم قالوا في شمللت وصعررت وبيطرت وحوقلت ودهورت وسلقيت وجعبيت: إنها ملحقة بباب دحرجت.
وذلك أنهم وجدوها على سمتها: عدد حروف وموافقة بالحركة والسكون فكانت هذه صناعة لفظية ليس فيها أكثر من إلحاقها ببنائها واتساع العرب بها في محاوراتها وطرق كلامها.
والدليل على أن فعللت وفعيلت وفوعلت وفعليت ملحقة بباب دحرجت مجيء مصادرها على مثل مصادر باب دحرجت.
وذلك قولهم: الشمللة والبيطرة والحوقلة والدهورة والسلقاة والجعباة.
فهذا ونحوه كالدحرجة والهملجة والقوقاة والزوزاة.
فلما جاءت مصادرها الرباعية والمصادر أصول للأفعال حكم بإلحاقها بها ولذلك استمرت في تصريفها استمرار ذوات الأربعة.
فقولك: بيطر يبيطر بيطرة كدحرج يدحرج دحرجة ومبيطر كمدحرج.
وكذلك شملل يشملل شمللة وهو مشملل.
فظهور تضعيفه على هذا الوجه أوضح دليل على إرادة إلحاقه.
ثم إنهم قالوا: قاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة وأكرم يكرم إكراماً وقطع يقطع تقطيعاً فجاءوا بأفعل وفاعل وفعل غير ملحقة بدحرج وإن كانت على سمته وبوزنه كما كانت فعلل وفيعل وفوعل وفعول وفعلى على سمته ووزنه ملحقة.
والدليل على أن فاعل وأفعل وفعل غير ملحقة بدحرج وبابه امتناع مصادرها أن تأتي على مثال الفعللة ألا تراهم لا يقولون: ضارب ضاربة ولا أكرم أكرمة ولا قطع قطعة فلما امتنع فيها هذا - وهو العبرة في صحة الإلحاق - علم أنها ليست ملحقة بباب دحرج.
فإذا قيل: فقد تجيء مصادرها من غير هذا الوجه على مثال مصادر ذوات الأربعة ألا تراهم يقولون: قاتل قيتالاً وأكرم إكراماً {وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا} فهذا بوزن الدحراج والسرهاف والزلزال والقلقال قال: سرهفته ما شئت من سرهاف قيل: الاعتبار بالإلحاق بها ليس إلا من جهة الفعللة دون الفعلال وبه كان يعتبر سيبويه.
ويدل على صحة ذلك أن مثال الفعللة لا زيادة فيه فهو بفعلل أشبه من مثال الفعلال والاعتبار بأصول أشبه منه وأوكد منه بالفروع.
فإن قلت: ففي الفعللة الهاء زائدة قيل: الهاء في غالب أمرها وأكثر أحوالها غير معتدة من حيث كانت في تقدير المنفصلة.
فإن قيل: فقد صح إذاً أن فاعل وأفعل وفعّل - وإن كانت بوزن دحرج - غير ملحقة به فلم لم تلحق به قيل: العلة في ذلك أن كل واحد من هذه المثل جاء بمعنى.
فأفعل للنقل وجعل الفاعل مفعولاً نحو دخل وأدخلته وخرج وأخرجته.
ويكون أيضاً للبلوغ نحو أحصد الزرع وأركب المهر وأقطف الزرع ولغير ذلك من المعاني.
وأما فاعل فلكونه من اثنين فصاعداً نحو ضارب زيد عمراً وشاتم جعفر بشراً.
وأما فعّل فللتكثير نحو غلّق الأبواب وقطّع الحبال وكسّر الجرار.
فلما كانت هذه الزوائد في هذه المثل إنما جيء بها للمعاني خشوا إن هم جعلوها ملحقة بذوات الأربعة أن يقدر أن غرضهم فيها إنما هو إلحاق اللفظ باللفظ نحو شملل وجهور وبيطر فتنكبوا إلحاقها بها صوناً للمعنى وذباً عنه أن يستهلك ويسقط حكمه فأخلوا بالإلحاق لما كان صناعة لفظية ووقروا المعنى ورجبوه لشرفه عندهم وتقدمه في أنفسهم.
فرأوا الإخلال باللفظ في جنب الإخلال بالمعنى يسيراً سهلاً وحجماً محتقراً.
وهذا الشمس إنارة مع أدنى تأمل.
ومن ذلك أيضاً أنهم لا يلحقون الكلمة من أولها إلا أن يكون مع الحرف الأول غيره ألا ترى أن " مَفعلاً " لما كانت زيادته في أوله لم يكن ملحقاً بها نحو: مَضرب ومَقتل.
وكذلك " مِفعل " نحو: مِقطع ومِنسج وإن كان مَفعل بوزن جعفر ومِفعل بوزن هِجرع.
يدل على أنهما ليسا ملحقين بهما ما نشاهده من ادغامهما نحو مسد ومرد ومتل ومشل.
ولو كانا ملحقين لكانا حري أن يخرجا على أصولهما كما خرج شملل وصعرر على أصله.
فأما محبب فعلم خرج شاذاً كتهلل ومكوزة ونحو ذلك مما احتمل لعلميته.
وسبب امتناع مَفعل ومِفعل أن يكونا ملحقين - وإن كانا على وزن جعفر وهِجرع - أن الحرف الزائد في أولهما وهو لمعنى وذلك أن مَفعلاً يأتي للمصادر نحو ذهب مذهباً ودخل مدخلاً وخرج مخرجاً.
ومِفعلاً يأتي للآلات والمستعملات نحو مِطرق ومِروح ومِخصف ومئزر.
فلما كانت الميمان ذواتى معنى خشوا إن هم ألحقوا بهما أن يتوهم أن الغرض فيهما إنما هو الإلحاق حسب فيستهلك المعنى المقصود بهما فتحاموا الإلحاق بهما ليكون ذلك موفراً على المعنى لهما.
ويدلك على تمكن المعنى في أنفسهم وتقدمه للفظ عندهم تقديمهم لحرف المعنى في أول الكلمة وذلك لقوة العناية به فقدموا دليله ليكون ذلك أمارة لتمكنه عندهم.
وعلى ذلك تقدمت حروف المضارعة في أول الفعل إذ كن دلائل على الفاعلين: من هم وما هم وكم عدتهم نحو أفعل ونفعل وتفعل ويفعل وحكموا بضد " هذا لِلّفظ " ألا ترى إلى ما قاله أبو عثمان في الإلحاق: إن أقيَسه أن يكون بتكرير اللام فقال: باب شمللت وصعررت أقيس من باب حوقلت وبيطرت وجهورت.
أفلا ترى إلى حروف المعاني: كيف بابها التقدم وإلى حروف الإلحاق والصناعة: كيف بابها التأخر.
فلو لم يعرف سبق المعنى عندهم وعلوه في تصورهم إلا بتقديم دليله وتأخر دليل نقيضه لكان مغنياً من غيره كافياً.
وعلى هذا حشوا بحروف المعاني فحصنوها بكونها حشواً وأمنوا عليها ما لا يؤمن على الأطراف المعرضة للحذف والإجحاف.
وذلك كألف التكسير وياء التصغير نحو دارهم ودريهم وقماطر وقميطر.
فجرت في ذلك - لكونها حشواً - مجرى عين الفعل المحصنة في غالب الأمر المرفوعة عن
حال الطرفين من الحذف ألا ترى إلى كثرة باب عدة وزنة وناس والله في أظهر قولي سيبويه وما حكاه أبو زيد من قولهم لاب لك وويلِمّهِ ويا با المغيرة وكثرة باب يد ودم وأخ وأب وغَد وهَن وحِر واست وباب ثُبة وقُلة وعِزَة وقلة باب مُذ وسَه: إنما هما هذان الحرفان بلا خلاف.
وأما ثُبة ولِثة فعلى الخلاف.
فهذا يدلك على ضنهم بحروف المعاني وشحهم عليها: حتى قدموها عناية بها أو وسطوها تحصيناً لها.
فإن قلت: فقد نجد حرف المعنى آخراً كما نجده أولاً ووسطاً.
وذلك تاء التأنيث وألف التثنية وواو الجمع على حده والألف والتاء في المؤنث وألفا التأنيث في حمراء وبابها وسكرى وبابها وياء الإضافة كهني فما ذلك قيل: ليس شيء مما تأخرت فيه علامة معناه إلا لعاذر مقنع.
وذلك أن تاء التأنيث إنما جاءت في طلحة وبابها آخراً من قبل أنهم أرادوا أن يعرفونا تأنيث ما هو وما مذكره فجاءوا بصورة المذكر كاملة مصححة ثم ألحقوها تاء التأنيث ليعلموا حال صورة التذكير وأنه قد استحال بما لحقه إلى التأنيث فجمعوا بين الأمرين ودلوا على الغرضين.
ولو جاءوا بعلم التأنيث حشواً لانكسر المثال ولم يعلم تأنيث أي شيء هو.
فإن قلت: فإن ألف التكسير وياء التحقير قد تكسران مثال الواحد والمكبر وتخترمان صورتيهما لأنهما حشو لا آخر.
وذلك قولك دفاتر ودفيتر وكذلك كليب وحجير ونحو ذلك قيل: أما التحقير فإنه أحفظ للصورة من التكسير ألا تراك تقول في تحقير حبلى: حبيلى وفي صحراء: صحيراء فتقر ألف التأنيث بحالها فإذا كسرت قلت: حبالى وصحارى وأصل حبالى حبال كدعاو وتكسير دعوى فتغير علم التأنيث.
وإنما كان الأمر كذلك من حيث كان تحقير الاسم لا يخرجه عن رتبته الأولى - أعني الإفراد - فأقر بعض لفظه لذلك وأما التكسير فيبعده عن الواحد الذي هو الأصل فيحتمل التغيير لا سيما مع اختلاف معاني الجمع فوجب اختلاف اللفظ.
وأما ألف التأنيث المقصورة والممدودة فمحمولتان على تاء التأنيث وكذلك علم التثنية والجمع على حده لاحق بالهاء أيضاً.
وكذلك ياء النسب.
وإذا كان الزائد غير ذي المعنى قد قوي سببه حتى لحق بالأصول عندهم فما ظنك بالزائد ذي المعنى وذلك قولهم في اشتقاق الفعل من قلنسوة تارة: تقلنس وأخرى: تقلسى فأقروا النون وإن كانت زائدة وأقروا أيضاً الواو حتى قلبوها ياء في تقلسيت.
وكذلك قالوا: قَرنُوة فلما اشتقوا الفعل منها قالوا قرنيت السقاء فأثبتوا الواو كما أثبتوا بقية حروف الأصل: من القاف والراء والنون ثم قلبوها ياء في قرنيت.
هذا مع أن الواو في قرنوة زائدة للتكثير والصيغة لا للإلحاق ولا للمعنى وكذلك الواو في قلنسوة للزيادة غير الإلحاق وغير المعنى.
وقالوا في نحوه: تعفرت الرجل إذا صار عفريتاً فهذا تفعلت وعليه جاء تمسكن وتمدرع وتمنطق وتمندل ومخرق وكان يسمى محمداً ثم تمسلم أي صار يسمى مسلماً و " مرحبك الله ومسهلك " فتحملوا ما فيه تبقية الزائد مع الأصل في حال الاشتقاق كل ذلك توفية للمعنى وحراسة له ودلالة عليه.
ألا تراهم إذ قالوا: تدرع وتسكن وإن كانت أقوى اللغتين عند أصحابنا فقد عرضوا أنفسهم لئلا يعرف غرضهم: أمن الدرع والسكون أم من المدرعة والمسكنة وكذلك بقية الباب.
ففي هذا شيئان: أحدهما حرمة الزائد في الكلمة عندهم حتى أقروه إقرار الأصول.
والآخر ما يوجبه ويقضى به: من ضعف تحقير الترخيم وتكسيره عندهم لما يقضى به ويفضي بك إليه: من حذف الزوائد على معرفتك بحرمتها عندهم.
فإن قلت: فإذا كان الزائد إذا وقع أولاً للإلحاق فكيف ألحقوا بالهمزة في ألَندد وألَنجج والياء في يلَندد ويلَنجج والدليل على الإلحاق ظهور التضعيف قيل: قد قلنا قبل: إنهم لا يلحقون الزائد من أول الكلمة إلا أن يكون معه زائد آخر فلذلك جاز الإلحاق بالهمزة والياء في ألندد ويلندد لما انضم إلى الهمزة والياء والنون.
وكذلك ما جاء عنهم من إنقحل - في قول صاحب الكتاب - ينبغي أن تكون الهمزة في أوله للإلحاق - بما اقترن بها من النون - بباب جِردَحل.
ومثله ما رويناه عنهم من قولهم: رجل إنزَهوٌ وامرأة إنزَهوة ورجال إنزهوون ونساء إنزهوات إذا كان ذا زهو فهذا إذاً إنفعل.
ولم يحك سيبويه من هذا الوزن إلا إنقحلا وحده وأنشد الأصمعي - رحمه الله -: لما رأتني خَلَقاً إنقَحلا ويجوز عندي في إنزهوٍ غير هذا وهو أن تكون همزته بدلاً من عين فيكون أصله عِنزَهو: فِنعلو من العزهاة وهو الذي لا يقرب النساء.
والتقاؤهما أن فيه انقباضاً وإعراضاً وذلك طرف من أطراف الزهو قال: إذا كنت عزهاة عن اللهو والصبا فكن حجراً من يابس الصخر جلمدا وإذا حملته على هذا لحق بباب أوسع من إنقحل وهو باب قِندأو وسِندأو وحِنطأو وكِنتأو.
فإن قيل: ولم لما كان مع الحرف الزائد إذا وقع أولاً زائد ثان غيره صارا جميعاً للإلحاق وإذا انفرد الأول لم يكن له قيل: لما كنا عليه من غلبة المعاني للألفاظ على ما تقدم.
وذلك أن أصل الزيادة في أول الكلمة إنما هو للفعل.
وتلك حروف المضارعة في أفعلُ ونفعلُ وتفعلُ ويفعلُ وكل واحد من أدلة المضارعة إنما هو حرف واحد فلما انضم إليه حرف آخر فارق بذلك طريقه في باب الدلالة على المعنى فلم ينكر أن يصار به حينئذ إلى صنعة اللفظ وهي الإلحاق.
ويدلك على تمكن الزيادة إذا وقعت أولاً في الدلالة على المعنى تركهم صرف أحمد وأرمل وأزمل وتنضب ونرجس معرفة لأن هذه الزوائد في أوائل الأسماء وقعت موقع ما هو أقعد منها في ذلك الموضع وهي حروف المضارعة.
فضارع أحمد أركب وتنضب تقتل ونرجس نضرب فحمل زوائد الأسماء في هذا على أحكام زوائد الأفعال دلالة على أن الزيادة في أوئل الكلم إنما بابها الفعل.
فإن قلت: فقد نجدها للمعنى ومعها زائد آخر غيرها وذلك نحو ينطلق وأنطلق وأحرنجم ويخرنطم ويقعنسس.
قيل: المزيد للمضارعة هو حرفها وحده فأما النون فمصوغة في حشو الكلمة في الماضي نحو احرنجم ولم تجتمع مع حرف المضارعة في وقت واحد كما التقت الهمزة والياء مع النون في ألنجج ويلندد في وقت واحد.
فإن قلت: فقد تقول: رجل ألد ثم تلحق النون فيما بعد فتقول: ألندد فقد رأيت الهمزة والنون غير مصطحبتين.
قيل: هاتان حالان متعاديتان وذلك أن ألد ليس من صيغة ألندد في وأما ألندد فهمزته مرتجلة مع النون في حال واحدة ولا يمكنك أن تدعي أن احرنجم لما صرت إلى مضارعه فككت يده عما كان فيها من الزوائد ثم ارتجلت له زوائد غيرها ألا ترى أن المضارع مبناه على أن ينتظم جميع حروف الماضي من أصل أو زائد كبيطر ويبيطر وحوقل ويحوقل وجهور ويجهور وسلقى ويسلقي وقطع ويقطع وتكسر ويتكسر وضارب ويضارب.
فأما أكرم يكرم فلولا ما كره من التقاء الهمزتين في أؤكرم لو جيء به على أصله للزم أن يؤتى بزيادته فيه كما جيء بالزيادة في نحو يتدحرج وينطلق.
وأما همزة انطلق فإنما حذفت في ينطلق للاستغناء عنها بل قد كانت في حال ثباتها في حكم الساقط أصلاً فهذا واضح.
ولأجل ما قلناه: من أن الحرف المفرد في أول الكلمة لا يكون للإلحاق ما حمل أصحابنا تهلل على أن ظهور تضعيفه إنما جاز لأنه عَلَم والأعلام تغير كثيراً.
ومثله عندهم محبب لما ذكرناه.
وسألت يوماً أبا علي - رحمه الله - عن تجفاف: أتاؤه للإلحاق بباب قرطاس فقال: نعم واحتج في ذلك بما انضاف إليها من زيادة الألف معها.
فعلى هذا يجوز أن يكون ما جاء عنهم من باب أُملود وأُظفور ملحقاً بباب عُسلوج ودُملوج وأن يكون إطريح وإسليح ملحقاً بباب شِنظيز وخنزير.
ويبعد هذا عندي لأنه يلزم منه أن يكون باب إعصار وإسنام ملحقاً بباب حِدبار وهِلقام وباب إفعال لا يكون ملحقاً ألا ترى أنه في الأصل للمصدر نحو إكرام وإحسان وإجمال وإنعام وهذا مصدر فعل غير ملحق فيجب أن يكون المصدر في ذلك على سمت فعله غير مخالف له.
وكأن هذا ونحوه إنما لا يجوز أن يكون ملحقاً من قبل أن ما زيد على الزيادة الأولى في أوله إنما هو حرف لين وحرف اللين لا يكون للإلحاق إنما جيء به لمعنى وهو امتداد الصوت به وهذا حديث غير حديث الإلحاق ألا ترى انك إنما تقابل بالملحق الأصل وباب المد إنما هو الزيادة أبداً فالأمران على ما ترى في البعد غايتان.
فإن قلت على هذا: فما تقول في باب إزمَول وإدرَون أملحق هو أم غير ملحق وفيه - كما ترى - مع الهمزة الزائدة الواو زائدة قيل: لا بل هو ملحق بباب جردحل وحنزقر.
وذلك أن الواو التي فيه ليست مداً لأنها مفتوح ما قبلها فشابهت الأصول بذلك فألحقت بها.
فإن قلت: فقد قال في طومار: إنه ملحق بقسطاس والواو كما ترى بعد الضمة أفلا تراه كيف ألحق بها مضموماً ما قبلها.
قيل: الأمر كذلك وذلك أن موضع المد إنما هو قبيل الطرف مجاوراً له كألف عماد وياء سعيد وواو عمود.
فأما واو طومار وياء ديماس فيمن قال دياميس فليستا للمد لأنهما لم تجاورا الطرف.
وعلى ذلك قال في طومار: إنه ملحق لما فلو بنيت على هذا من " سألت " مثل طومار وديماس لقلت: سوءال وسيئال.
فإن خففت الهمزة ألقيت حركتها على الحرفين قبلها ولم تحتشم ذلك فقلت: سوال وسيال ولم تجرهما مجرى واو مقروءة وياء خطيئة في إبدالك الهمزة بعدهما إلى لفظهما وادغامك إياهما فيها في نحو مقروة وخطية.
فلذلك لم يقل في تخفيف سوءال وسيئال: سُوّال ولا سِيّال.
فاعرفه.
فإن قيل: ولم لم يتمكن حال المد إلا أن يجاور الطرف قيل: إنما جيء بالمد في هذه المواضع لنعمته وللين الصوت به.
وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقف ومكان الاستراحة والأون فقدموا أمام الحرف الموقوف عليه ما يؤذن بسكونه وما يخفض من غلواء الناطق واستمراره على سنن جريه وتتابع نطقه.
ولذلك كثرت حروف المد قبل حرف الرويّ - كالتأسيس والردف - ليكون ذلك مؤذناً بالوقوف ومؤدياً إلى الراحة والسكون.
وكلما جاور حرف المد الروي كان آنس به وأشد إنعاماً لمستمعه.
نعم وقد نجد حرف اللين في القافية عوضاً عن حرف متحرك أوزنة حرف متحرك حذف من آخر البيت في أتم أبيات ذلك البحر كثالث الطويل وثاني البسيط والكامل.
فلذلك كان موضع حرف اللين إنما هو لما جاور الطرف.
فأما ألف فاعل وفاعال وفاعول ونحو ذلك فإنها وإن كانت راسخة في اللين وعريقة في المد فليس ذلك لاعتزامهم المد بها بل المد فيها - أين وقعت - شيء يرجع إليها في ذوقها وحسن النطق بها ألا تراها دخولها في " فاعل " لتجعل الفعل من اثنين فصاعداً نحو ضارب وشاتم فهذا معنى غير معنى المد وحديث غير حديثه.
وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي في شرح تصريف أبي عثمان وغيره من كتبي وما خرج من كلامي.
فإن قلت: فإذا كان الأمر كذا فهلا زيدت المدات في أواخر الكلم للمد فإن ذلك أنأى لهن وأشد تمادياً بهن قيل: يفسد ذاك من حيث كان مؤدياً إلى نقض الغرض وذلك أنهن لو تطرفن لتسلط الحذف عليهن فكان يكون ما أرادوه من زيادة الصوت بهن داعياً إلى استهلاكه بحذفهن ألا ترى أن ما جاء في آخره الياء والواو قد حفظن عليه وارتبطن له بما زيد عليهن من التاء من بعدهن وذلك كعفرية وحدرية وعفارية وقراسية وعلانية ورفاهية وبُلهنية وسُحفنية وكذلك عرقوة وترقوة وقلنسوة وقمحدوة.
فأما رباع وثمان وشناح فإنما احتمل ذلك فيه للفرق بين المذكر والمؤنث في رباعية وثمانية وشناحية.
وأيضاً فلو زادوا الواو طرفاً لوجب قلبها ياء ألا تراها لما حذفت التاء عنها في الجمع قلبوها ياء قال: أهل الرياط البيض والقلنسي وقال المجنون: وبيض القلنسي من رجال أطاول حتى تقُضّي عرقي الدُلي وأيضاً فلو زيدت هذه الحروف طرفاً للمد بها لانتقض الغرض من موضع آخر.
وذلك أن الوقف على حرف اللين ينقصه ويستهلك بعض مده ولذلك احتاجوا لهن إلى الهاء في الوقف ليبين بها حرف المد.
وذلك قولك: وازيداه وواغلامهموا وواغلام غلامهيه.
وهذا شيء اعترض فقلنا فيه ولنعد.
فإن قيل زيادة على مضى: إذا كان موضع زيادة الفعل أوله بما قدمته وبدلالة اجتماع ثلاث زوائد فيه نحو استفعل وباب زيادة الاسم آخراً بدلالة اجتماع ثلاث زوائد فيه نحو عِنظيان وخِنذيان وخُنزوان وعُنفوان فما بالهم جعلوا الميم - وهي من زوائد الأسماء - مخصوصاً بها أول المثال نحو مفعل ومفعول ومِفعال ومُفعِل وذلك الباب على طوله.
قيل: لما جاءت لمعنى ضارعت بذلك حروف المضارعة فقدمت وجعل ذلك عوضاً من غلبة زيادة الفعل على أول الجزء كما جعل قلب الياء واواً في التقوى والبقوى عوضاً من كثرة دخول الواو على الياء.
وعلى الجملة فالاسم أحمل للزيادة في آخره من الفعل وذلك لقوة الاسم وخفته فاحتمل سحب الزيادة من آخره.
والفعل - لضعفه وثقله - لا يتحامل بما يتحامل به الاسم من ذلك لقوته.
ويدلك على ثقل الزيادة في آخر الكلمة أنك لا تجد في ذوات الخمسة ما زيد فيه من آخره إلا الألف لخفتها وذلك قبعثرى وضبغطرى وإنما ذلك لطول ذوات الخمسة فلا ينتهي إلى آخرها إلا وقد ملت لطولها.
فلم يجمعوا على آخرها تماديه وتحميله الزيادة عليه.
فإنما زيادتها في حشوها نحو عضرفوط وقرطبوس ويستعور وصهصليق وجعفليق وعندليب وحنبريت.
وذلك أنهم لما أرادوا ألا يخلوا ذوات الخمسة من الزيادة كما لم يخلوا منها الأصلين اللذين قبلها حشوا بالزيادة تقديماً لها كراهية أن ينتهي إلى آخر الكلمة على طولها ثم يتجشموا حينئذ زيادة هناك فيثقل أمرها ويتشنع عليهم تحملها.
فقد رأيت - بما أوردناه - غلبة المعنى للفظ وكون اللفظ خادماً له مشيداً به وأنه إنما جيء به له ومن أجله.
وأما غير هذه الطريق: من الحمل على المعنى وترك اللفظ - كتذكير المؤنث وتأنيث المذكر وإضمار الفاعل لدلالة المعنى عليه وإضمار المصدر لدلالة الفعل عليه وحذف الحروف والأجزاء التوام والجمل وغير ذلك حملاً عليه وتصوراً له وغير ذلك مما يطول ذكره ويمل أيسره - فأمر مستقر ومذهب غير مستنكر.
باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها
اعلم أن هذا موضع في تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة وللنفس به مسكة وعصمة لأن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب: من أنها أرادت كذا لكذا وفعلت كذا لكذا.
وهو أحزم لها وأجمل بها وأدل على الحكمة المنسوبة إليها من أن تكون تكلفت ما تكلفته: من استمرارها على وتيرة واحدة وتقريها منهجاً واحداً تراعيه وتلاحظه وتتحمل لذلك مشاقه وكلفه وتعتذر من تقصير إن جرى وقتاً منها في شيء منه.
وليس يجوز أن يكون ذلك كله في كل لغة لهم وعند كل قوم منهم حتى لا يختلف ولا ينتقض ولا يتهاجر على كثرتهم وسعة بلادهم وطول عهد زمان هذه اللغة لهم وتصرفها على ألسنتهم اتفاقاً وقع حتى لم يختلف فيه اثنان ولا تنازعه فريقان إلا وهم له مريدون وبسياقه على أوضاعهم فيه معنيون ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل ونصب المفعول والجر بحروف الجر والنصب بحروفه والجزم بحروفه وغير ذلك من حديث التثنية والجمع والإضافة والنسب والتحقير وما يطول شرحه فهل يحسن بذي لب أن يعتقد أن هذا كله اتفاق وقع وتوارد اتجه!.
فإن قلت " فما تنكر " أن يكون ذلك شيئاً طبعوا عليه وأجيئوا إليه من غير اعتقاد منهم لعلله ولا لقصد من القصود التي تنسبها إليهم في قوانينه وأغراضه بل لأن آخراً منهم حذا على ما نهج الأول فقال به وقام الأول للثاني في كونه إماماً له فيه مقام من هدى الأول إليه وبعثه عليه ملكاً كان أو خاطراً قيل: لن يخلو ذلك أن يكون خبراً روسلوا به أو تيقظاً نبهوا على وجه الحكمة فيه.
فإن كان وحياً أو ما يجري مجراه فهو أنبه له وأذهب في شرف الحال به لأن الله سبحانه إنما هداهم لذلك ووقفهم عليه لأن في طباعهم قبولاً له وانطواء على صحة الوضع فيه لأنهم مع ما قدمناه من ذكر كونهم عليه في أول الكتاب من لطف الحس وصفائه ونصاعة جوهر الفكر ونقائه لم يؤتوا هذه اللغة الشريفة المنقادة الكريمة إلا ونفوسهم قابلة لها محسة لقوة الصنعة فيها معترفة بقدر النعمة عليهم بما وهب لهم منها ألا ترى إلى قول أبي مهدية: يقولون لي: شنبِذ ولست مشنبِذا طوال الليالي ما أقام ثبير ولا تاركاً لحني لأحسن لحنهم ولو دار صرف الدهر حيث يدور وحدثني المتنبي شاعرنا - وما عرفته إلا صادقاً - قال: كنت عند منصرفي من مصر في جماعة من العرب وأحدهم يتحدث.
فذكر في كلامه فلاة واسعة فقال: يحير فيها الطرف قال: وآخر منهم يلقنه سراً من الجماعة بينه وبينه فيقول له: يحار يحار.
أفلا ترى إلى هداية بعضهم لبعض وتنبيهه إياه على الصواب.
وقال عمار الكلبي - وقد عيب عليه بيت من شعره فامتعض لذلك -: ماذا لقينا من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا إن قلت قافية بكراً يكون بها بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا قالوا لحنت وهذا ليس منتصباً وذاك خفض وهذا ليس يرتفع وحرضوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فطال الضرب والوجع كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم على إعرابهم طبعوا ما كل قولي مشروحاً لكم فخذوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا لأن أرضي أرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع والخبر المشهور في هذا للنابغة وقد عيب عليه قوله في الدالية المجرورة: فلما لم يفهمه أتى بمغنية فغنته: من آل مية رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغير مزود ومدت الوصل وأشبعته ثم قالت: وبذاك خبرنا الغراب الأسود ومطلت واو الوصل فلما أحسه عرفه واعتذر منه وغيره - فيما يقال - إلى قوله: وبذاك تنعاب الغراب الأسود وقال دخلت يثرب وفي شعري صنعة ثم خرجت منها وأنا أشعر العرب.
كذا الرواية.
وأما أبو الحسن فكان يرى ويعتقد أن العرب لا تستنكر الإقواء.
ويقول: قلت قصيدة إلا وفيها الإقواء.
ويعتل لذلك بأن يقول: إن كل بيت منها شعر قائم برأسه.
وهذا الاعتلال منه يضعف ويقبح التضمين في الشعر.
وأنشدنا أبو عبد الله الشجري يوماً لنفسه شعراً مرفوعاً وهو قوله: نظرت بسنجار كنظرة ذي هوى رأى وطناً فانهل بالماء غالبه لأونس من أبناء سعد ظعائنا يزن الذي من نحوهن مناسبه يقول فيها يصف البعير: فقلت: يا أبا عبد الله: أتقول " دوينة حاجبه " مع قولك " مناسبه " و " أشانبه "! فلم يفهم ما أردت فقال: فكيف أصنع أليس ههنا تضع الجرير على القِرمة على الجِرفة وأمأ إلى أنفه فقلت: صدقت غير أنك قلت " أشانبه " و " غالبه " فلم يفهم وأعاد اعتذاره الأول.
فلما طال هذا قلت له: أيحسن أن يقول الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاوٍ يُمَل منه الثواء ومطلت الصوت ومكنته ثم يقول مع ذلك: ملك المنذر بن ماء السمائي فأحس حينئذ وقال: أهذا! أين هذا من ذاك! إن هذا طويل وذاك قصير.
فاستروح إلى قصر الحركة في " حاجبه " وأنها أقل من الحرف في " أسماء " و " السماء ".
وسألته يوماً فقلت له: كيف تجمع " دكاناً " فقال: دكاكين قلت: فسرحاناً قال: سراحين قلت: فقرطاناً قال: قراطين قلت: فعثمان قال: عثمانون.
فقلت له: هلا قلت أيضاً عثامين قال: أيش عثامين! أرأيت إنساناً يتكلم بما ليس من لغته والله لا أقولها أبداً.
والمروي عنهم في شغفهم بلغتهم وتعظيمهم لها واعتقادهم أجمل الجميل فيها أكثر من أن يورد أو فإن قلت: فإن العجم أيضاً بلغتهم مشغوفون ولها مؤثرون ولأن يدخلها شيء من العربي كارهون ألا ترى أنهم إذا أورد الشاعر منهم شعراً فيه ألفاظ من العربي عيب به وطعن لأجل ذلك عليه.
فقد تساوت حال اللغتين في ذلك.
فأية فضيلة للعربية على العجمية قيل: لو أحست العجم بلطف صناعة العرب في هذه اللغة وما فيها من الغموض والرقة والدقة لاعتذرت من اعترافها بلغتها فضلاً عن التقديم لها والتنويه منها.
فإن قيل: لا بل لو عرفت العرب مذاهب العجم في حسن لغتها وسداد تصرفها وعذوبة طرائقها لم تبء بلغتها ولا رفعت من رءوسها باستحسانها وتقديمها.
قيل: قد اعتبرنا ما تقوله فوجدنا الأمر فيه بضده.
وذلك أنا نسأل علماء العربية مما أصله عجمي وقد تدرب بلغته قبل استعرابه عن حال اللغتين فلا يجمع بينهما بل لا يكاد يقبل السؤال عن ذلك لبعده في نفسه وتقدم لطف العربية في رأيه وحسه.
سألت غير مرة أبا علي - رضي الله عنه - عن ذلك فكان جوابه عنه نحواً مما حكيته.
فإن قلت: ما تنكر أن يكون ذلك لأنه كان عالماً بالعربية ولم يكن عالماً باللغة العجمية ولعله لو كان عالماً بها لأجاب بغير ما أجاب به.
قيل: نحن قد قطعنا بيقين وأنت إنما عارضت بشك ولعل هذا ليس قطعاً كقطعنا ولا يقيناً كيقيننا.
وأيضاً فإن العجم العلماء بلغة العرب وإن لم يكونوا علماء بلغة العجم فإن قواهم في العربية تؤيد معرفتهم بالعجمية وتؤنسهم بها وتزيد في تنبيههم على أحوالها لاشتراك العلوم اللغوية واشتباكها وتراميها إلى الغاية الجامعة لمعانيها.
ولم نر أحداً من أشياخنا فيها - كأبي حاتم وبندار وأبي علي وفلان وفلان - يسوون بينهما ولا يقربون بين حاليهما.
وكأن هذا موضع ليس للخلاف فيه مجال لوضوحه عند الكافة.
وإنما أوردنا منه هذا القدر احتياطاً به واستظهاراً على مورد له عسى أن يورده.
فإن قلت: زعمت أن العرب تجتمع على لغتها فلا تختلف فيها وقد نراها ظاهرة الخلاف ألا ترى إلى الخلاف في " ما " الحجازية والتميمية وإلى الحكاية في الاستفهام عن الأعلام في الحجازية وترك ذلك في التميمية إلى غير ذلك قيل: هذا القدر من الخلاف لقلته ونزارته محتقر غير محتفل به ولا معيج عليه وإنما هو في شيء من الفروع يسير.
فأما الأصول وما عليه العامة والجمهور فلا خلاف فيه ولا مذهب للطاعن به.
وأيضاً فإن أهل كل واحدة من اللغتين عدد كثير وخلق " من الله " عظيم وكل واحد منهم محافظ على لغته لا يخالف شيئاً منها ولا يوجد عنده تعاد فيها.
فهل ذلك إلا لأنهم يحتاطون ويقتاسون ولا يفرطون ولا يخلطون.
ومع هذا فليس شيء مما يختلفون فيه - على قلته وخفته - إلا له من القياس وجه يؤخذ به.
ولو كانت هذه اللغة حشواً مكيلاً وحثواً مهيلاً لكثر خلافها وتعادت أوصافها: فجاء عنهم جر الفاعل ورفع المضاف إليه والمفعول به والجزم بحروف النصب والنصب بحروف الجزم بل جاء عنهم الكلام سدى غير محصل وغفلاً من الإعراب ولاستغنى بإرساله وإهماله عن إقامة إعرابه والكلف الظاهرة بالمحاماة على طرد أحكامه.
هذا كله وما أكني عنه من مثله - تحامياً للإطالة به - إن كانت هذه اللغة شيئاً خوطبوا به وأخذوا باستعماله.
وإن كانت شيئاً اصطلحوا عليه وترافدوا بخواطرهم ومواد حكمهم على عمله وترتيبه وقسمة أنحائه وتقديمهم أصوله وإتباعهم إياها فروعه - وكذا ينبغي أن يعتقد ذلك منهم لما نذكره آنفاً - فهو مفخر لهم ومعلم من معالم السداد دل على فضيلتهم.
والذي يدل على أنهم قد أحسوا ما أحسسنا وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته وقصده شيئان: أحدهما حاضر معنا والآخر غائب عنا إلا أنه مع أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا.
فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من احوال العرب ووجوهها وتضطر إلى معرفته من أغراضها وقصودها: من استخفافها شيئاً أو استثقاله وتقبله أو إنكاره والأنس به أو الاستيحاش منه والرضا به أو التعجب من قائله وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود بل الحالفة على ما في النفوس ألا ترى إلى قوله: تقول - وصكت وجهها بيمينها - أبعلي هذا بالرحى المتقاعس! فلو قال حاكياً عنها: أبعلي هذا بالرحى المتقاعس - من غير أن يذكر صك الوجه - لأعلمنا بذلك أنها كانت متعجبة منكرة لكنه لما حكى الحال فقال: " وصكت وجهها " علم بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لها.
هذا مع أنك سامع لحكاية الحال غير مشاهد لها ولو شاهدتها لكنت بها أعرف ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين وقد قيل " ليس المخبر كالمعاين " ولو لم ينقل إلينا هذا الشاعر حال هذه المرأة بقوله: وصكت وجهها لم نعرف به حقيقة تعاظم الأمر لها.
وليست كل حكاية تروى لنا ولا كل خبر ينقل إلينا يشفع به شرح الأحوال التابعة له المقترنة - كانت - به.
نعم ولو نقلت إلينا لم نفد بسماعها ما كنا نفيده لو حضرناها.
وكذلك قول الآخر: قلنا لها قفي لنا قالت قاف لو نقل إلينا هذا الشاعر شيئاً آخر من جملة الحال فقال مع قوله " قالت قاف ": " وأمسكت بزمام بعيرها " أو " وعاجته علينا " لكان أبين لما كانوا عليه وأدل على أنها أرادت: وقفت أو توقفت دون أن يظن أنها أرادت: قفي لنا! أي يقول لي: قفي لنا! متعجبة منه.
وهو إذا شاهدها وقد وقفت علم أن قولها قاف إجابة له لا رد لقوله وتعجب منه في قوله " قفي لنا ".
وبعد فالحمالون والحماميون والساسة والوقادون ومن يليهم ويعتد منهم يستوضحون من مشاهدة الأحوال ما لا يحصله أبو عمرو من شعر الفرزدق إذا أخبر به عنه ولم يحضره ينشده.
أولا تعلم أن الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطب به صاحبه وينعم تصويره له في نفسه استعطفه ليقبل عليه فيقول له: يا فلان أين أنت أرني وجهك أقبل علي أحدثك أما أنت حاضر يا هناه.
فإذا أقبل عليه وأصغى إليه اندفع يحدثه أو يأمره أو ينهاه أو نحو ذلك.
فلو كان استماع الأذن مغنياً عن مقابلة العين مجزئاً عنه لما تكلف القائل ولا كلف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه.
وعلى ذلك قال: العين تبدي الذي في نفس صاحبها من العداوة أو ود إذا كانا وقال الهذلي: رفوني وقالوا: يا خويلد لا ترع فقلت - وأنكرت الوجوه -: هم هم أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه وجعلها دليلاً على ما في النفوس.
وعلى ذلك قالوا: " رب إشارة أبلغ من عبارة " وحكاية الكتاب من هذا الحديث وهي قوله: " ألا تا " و " بلى فا ".
وقال لي بعض مشايخنا رحمه الله: أنا لا أحسن أن أكلم إنساناً في الظلمة.
ولهذا الموضع نفسه ما توقف أبو بكر عن كثير مما أسرع إليه أبو إسحاق من ارتكاب طريق الاشتقاق واحتج أبو بكر عليه بأنه لا يؤمن أن تكون هذه الألفاظ المنقولة إلينا قد كانت لها أسباب لم نشاهدها ولم ندر ما حديثها ومثل له بقولهم " فرع عقيرته " إذا رفع صوته.
قال له أبو بكر: فلو ذهبنا نشتق لقولهم " ع ق ر " من معنى الصوت لبعد الأمر جداً وإنما هو أن رجلاً قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم نادى وصرخ بأعلى صوته فقال الناس: رفع عقيرته أي رجله المعقورة.
قال أبو بكر: فقال أبو إسحاق: لست أدفع هذا.
ولذلك قال سيبويه في نحو من هذا: أو لأن الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر يعني ما نحن عليه من مشاهدة الأحوال والأوائل.
فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويونس وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه وأبو الحسن وأبو زيد وخلف الأحمر والأصمعي ومن في الطبقة والوقت من علماء البلدين وجوه العرب فيما تتعاطاه من كلامها وتقصد له من أغراضها ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤديه الحكايات ولا تضبطه الروايات فتضطر إلى قصود العرب وغوامض ما في أنفسها حتى لو حلف منهم حالف على غرض دلته عليه إشارة لا عبارة لكان عند نفسه وعند جميع من يحضر حاله صادقاً فيه غير متهم الرأي والنحيزة والعقل.
فهذا حديث ما غاب عنا فلم ينقل إلينا وكأنه حاضر معنا مناج لنا.
وأما ما روي لنا فكثير.
منه ما حكى الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلاً من اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها.
فقلت له: أتقول جاءته كتابي! قال: نعم أليس بصحيفة.
أفتراك تريد من أبي عمرو وطبقته وقد نظروا وتدربوا وقاسوا وتصرفوا أن يسمعوا أعرابياً جافياً غفلاً يعلل هذا الموضع بهذه العلة ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكره فلا " يهتاجواهم " لمثله ولا يسلكوا فيه طريقته فيقولوا: فعلوا كذا لكذا وصنعوا كذا لكذا وقد شرع لهم العربي ذلك ووقفهم على سمته وأمه.
وحدثنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس أنه قال: سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} فقلت له ما تريد قال: أردت: سابقٌ النهار.
فقلت له: فهلا قلته فقال: لو قلته لكان أوزن.
ففي هذه الحكاية لنا ثلاثة أغراض مستنبطة منها: أحدها تصحيح قولنا: إن أصل كذا كذا والآخر قولنا: إنها فعلت كذا لكذا ألا تراه إنما طلب الخفة يدل عليه قوله: لكان أوزن: أي أثقل في النفس وأقوى من قولهم: هذا درهم وازن: أي ثقيل له وزن.
والثالث أنها قد تنطق بالشيء غيره في أنفسها أقوى منه لإيثارها التخفيف.
وقال سيبويه حدثنا من نثق به أن بعض العرب قيل له أما بمكان كذا وكذا وجذ فقال: بلى وِجاذاً أي أعرف بها وِجاذاً وقال أيضاً: وسمعنا بعضهم يدعو على غنم رجل فقال: اللهم ضبعاً وذئباً فقلنا: له ما أردت فقال: أردت: اللهم اجمع فيها ضبعاً وذئباً كلهم يفسر ما ينوي.
فهذا تصريح منهم بما ندعيه عليهم وننسبه إليهم.
وسألت الشجري يوماً فقلت: يا أبا عبد الله كيف تقول ضربت أخاك فقال: كذاك.
فقلت: أفتقول: ضربت أخوك فقال: لا أقول: أخوك أبداً.
قلت: فكيف تقول ضربني أخوك فقال: كذاك.
فقلت: ألست زعمت أنك لا تقول: أخوك أبداً فقال أيش ذا! اختلفت جهتا الكلام.
فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن: صار المفعول فاعلاً وإن لم يكن بهذا اللفظ البتة فإنه هو لا محالة.
ومن ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوماً من العرب أتوه فقال لهم: من أنتم فقالوا: نحن بنو غيان فقال: بل أنتم بنو رشدان.
فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة: إن الألف والنون زائدتان وإن كان - عليه السلام - لم يتفوه بذلك غير أن اشتقاقه إياه من الغي بمنزلة قولنا نحن: إن الألف والنون فيه زائدتان.
وهذا واضح.
وكذلك قولهم: إنما سميت هانئاً لتهنأ قد عرفنا منه أنهم كأنهم قد قالوا: إن الألف في هانيء زائدة وكذلك قولهم: فجاء يدرم من تحتها - أي يقارب خطاه لثقل الخريطة بما فيها فسمي دارماً - قد أفادنا اعتقادهم
زيادة الحمل على الظاهر
باب في الحمل على الظاهر
وإن أمكن أن يكون المراد غيره اعلم أن المذهب هو هذا الذي ذكرناه والعمل عليه والوصية به.
فإذا شاهدت ظاهراً يكون مثله أصلاً أمضيت الحكم على ما شاهدته من حاله وإن أمكن أن تكون الحال في باطنه بخلافه ألا ترى أن سيبويه حمل سيداً على أنه مما عينه ياء فقال في تحقيره: سييد كديك ودييك وفيل وفييل.
وذلك أن عين الفعل لا ينكر أن تكون ياء وقد وجدت في سيد ياء فهي في ظاهر أمرها إلى أن يرد ما يستنزل عن بادي حالها.
فإن قلت: فإنا لا نعرف في الكلام تركيب " س ي د " فهلا لما لم يجد ذلك حمل الكلمة على ما في الكلام مثله وهو ما عينه من هذا اللفظ واو وهو السواد والسودد ونحو ذلك قيل: هذا يدلك على قوة الظاهر عندهم وأنه إذا كان مما تحتمله القسمة وتنتظمه القضية حكم به وصار أصلاً على بابه.
وليس يلزم إذا قاد الظاهر إلى إثبات حكم تقبله الأصول ولا تستنكره ألا يحكم به حتى يوجد له نظير.
وذلك أن النظير - لعمري - مما يؤنس به فأما ألا تثبت الأحكام إلا به فلا ألا ترى أنه قد أثبت في الكلام فعُلت تفعَل وهو كدت تكاد وإن لم يوجدنا غيره وأثبت بإنقحل باب " إنفعل " وإن لم يحك هو غيره وأثبت بسخاخين " فُعاعِيلا " وإن لم يأت بغيره.
فإن قلت: فإن " سيداً " مما يمكن أن يكون من باب ريح وديمة فهلا توقف عن الحكم بكون عينه ياء لأنه لا يأمن أن تكون واواً قيل: هذا الذي تقوله إنما تدعي فيه ألا يؤمن أن يكون من الواو وأما الظاهر فهو ما تراه.
ولسنا ندع حاضراً له وجه من القياس لغائب مجوز ليس عليه دليل.
فإن قيل: كثرة عين الفعل واواً تقود إلى الحكم بذاك قيل: إنما يحكم بذاك مع عدم الظاهر فأما والظاهر معك فلا معدل عنه بك.
لكن - لعمري - إن لم يكن معك ظاهراً احتجت إلى التعديل والحكم بالأليق والحمل على الأكثر.
وذلك إذا كانت العين ألفاً مجهولة فحينئذ ما تحتاج إلى تعديل الأمر فتحمل على الأكثر.
فلذلك قال في ألف " آءة ": إنها بدل من واو.
وكذلك ينبغي أن تكون ألف " الراء " لضرب من النبت وكذلك ألف " الصاب " لضرب من الشجر.
فأما ألا يجيء من ذلك اللفظ نظير فتعلل بغير نافع ولا مجد ألا ترى أنك تجد من الأصول ما لم يتجاوز به موضع واحد كثيراً.
من ذلك في الثلاثي حوشب وكوكب ودودري وأبنبم.
فهذه ونحوها لا تفارق موضعاً واحداً ومع ذلك فالزوائد فيها لا تفارقها.
وعلى نحو مما جئنا به في " سيد " حمل سيبويه عيَّناً فأثبت به " فيعلاً " مما عينه ياء وقد كان يمكن أن يكون " فوعلاً " و " فعولاً " من لفظ العين ومعناها ولو حكم بأحد هذين المثالين لحمل على مألوف غير منكور " ألا ترى أن فوعلاً وفعولاً " لا مانع لكل واحد منهما أن يكون في المعتل كما يكون في الصحيح وأما " فيعل " - بفتح العين - مما عينه معتلة فعزيز ثم لم يمنعه عزه ذلك أن حكم به على " عين " وعدل عن أن يحمله على أحد المثالين اللذين كل واحد منهما لا مانع له من كونه في المعتل العين كونه في الصحيحها.
وهذا أيضاً مما يبصرك بقوة الأخذ بالظاهر عندهم وأنه مكين القدم راسيها في أنفسهم.
وكذلك يوجب القياس فيما جاء من الممدود لا يعرف له تصرف ولا مانع من الحكم بجعل همزته أصلاً فينبغي حينئذ أن يعتقد فيها أنها أصلية.
وكذلك همزة " قساء " فالقياس يقتضي اعتقاد كونها أصلاً اللهم إلا أن يكون " قساء " هو " قسى " في قوله: بجو من قسىً ذفر الخزامى تداعى الجِربياء به الحنينا فإن كان كذلك وجب أن يحكم بكون همزة " قساء " أنها بدل من حرف العلة الذي أبدلت منه ألف " قسى ".
وأن يكون ياء أولى من أن يكون واواً لما ذكرناه في كتابنا في شرح المقصور والممدود ليعقوب بن السكيت.
فإن قلت: فلعل " قسى " هذا مبدل من " قساء " والهمزة فيه هي الأصل.
قيل: هذا حمل على الشذوذ لأن إبدال الهمز شاذ والأول أقوى لأن إبدال حرف العلة همزة إذا وقع طرفاً بعد ألف زائدة هو الباب.
وذكر محمد بن الحسن " أروى " في باب " أرو " فقلت لأبي علي: من أين له أن اللام واو وما يؤمنه أن تكون ياء فتكون من باب التقوى والرعوى فجنح إلى ما نحن عليه: من الأخذ بالظاهر وهو القول.
فاعرف بما ذكرته قوة اعتقاد العرب في الحمل على الظاهر ما لم يمنع منه مانع.
وأما حيوة والحيوان فيمنع من حمله على الظاهر أنا لا نعرف في الكلام ما عينه ياء ولامه واو فلا بد أن تكون الواو بدلاً من ياء لضرب من الاتساع مع استثقال التضعيف في الياء ولمعنى العلمية في حيوة.
وإذا كانوا قد كرهوا تضعيف الياء مع الفصل حتى دعاهم ذلك إلى التغيير في حاحيت وهاهيت وعاعيت كان إبدال اللام في الحيوان - ليختلف الحرفان - أولى وأحجى.
فإن قلت: فهلا حملت الحيوان على ظاهره وإن لم يكن له نظير كما حملت سيداً على ظاهره وإن لم تعرف تركيب " س ي د " قيل: ما عينه ياء كثر وما عينه ياء ولامه واو مفقود أصلاً من الكلام.
فلهذا أثبتنا سيداً ونفينا " ظاهر أمر " الحيوان.
وكذلك القول في نون عنتر وعنبر: ينبغي أن تكون أصلاً وإن كان قد جاء عنهم نحو عنبس وعنسل لأن أذنيك أخرجهما الاشتقاق.
وأما عنتر وعنبر وخَنشَلت وحِنزَقر وحِنبَتر ونحو ذلك فلا اشتقاق يحكم له بكون شيء منه زائداً فلا بد من القضية بكونه كله أصلاً.
فاعرف ذلك واكتف به بإذن الله تعالى.
باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديراً وحكماً لا زماناً ووقتاً
هذا الموضع كثير الإيهام لأكثر من يسمعه لا حقيقة تحته. وذلك كقولنا: الأصل في قام قوم وفي باع بيع وفي طال طول وفي خاف ونام وهاب: خوف ونوم وهيب وفي شد شدد وفي استقام استقوم وفي يستعين يستعون وفي يستعد يستعدد.
فهذا يوهم أن هذه الألفاظ وما كان نحوها - مما يدعي أن له أصلاً يخالف ظاهر لفظه - قد كان مرة يقال حتى إنهم كانوا يقولون في موضع قام زيد: قوَم زيد وكذلك نوِم جعفر وطَوُلَ محمد وشدَد أخوك يده واستعدد الأمير لعدوه وليس الأمر كذلك بل بضده.
وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه.
وإنما معنى قولنا: إنه كان أصله كذا: أنه لو جاء مجيء الصحيح ولم يعلل لوجب أن يكون مجيئه " على ما ذكرنا ".
فأما أن يكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر.
ويدل على أن ذلك عند العرب معتقد - كما أنه عندنا مراد معتقد - إخراجها بعض ذلك مع صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم هذا يدلك على أن أصل أقام أقوم وهو الذي نوميء نحن إليه ونتخيله فرب حرف يخرج هكذا منبهة على أصل بابه ولعله إنما أخرج على أصله فتُجشم ذلك فيه لما يعقب من الدلالة على أولية أحوال أمثاله.
وكذلك قوله: أني أجود لأقوام وإن ضننوا فأنت تعلم بهذا أن أصل شلت يده شلِلَت: أي لو جاء مجيء الصحيح لوجب فيه إظهار تضعيفه.
وقد قال الفرزدق: ولو رضيت يداي بها وضنت لكان علي في القدر الخيار فأصل ضنت إذاً ضنِنَت بدلالة قوله: ضننوا.
وكذلك قوله: تراه - وقد فات الرماة - كأنه أمام الكلاب مُصغِيُ الخد أصلم تعلم منه أن أصل قولك: هذا معطي زيد: معطيُ زيد.
ومن أدل الدليل على أن هذه الأشياء التي ندعي أنها أصول مرفوضة لا يعتقد أنها قد كانت مرة مستعملة ثم صارت من بعد مهملة ما تعرضه الصنعة فيها من تقدير ما لا يطوع النطق به لتعذره.
وذلك كقولنا في شرح حال الممدود غير المهموز الأصل نحو سماء وقضاء.
ألا ترى أن الأصل سماوٌ وقضايٌ فلما وقعت الواو والياء طرفاً بعد ألف زائدة قلبتا ألفين فصار التقدير بهما إلى سماا وقضاا فلما التقت الألفان تحركت الثانية منهما فانقلبت همزة فصار ذلك إلى سماء وقضاء.
أفلا تعلم أن أحد ما قدرته - وهو التقاء الألفين - لا قدرة لأحد على النطق به.
وكذلك ما نتصوره وننبه عليه أبداً من تقدير مفعول مما عينه أحد حرفي العلة وذلك نحو مبيع ومكيل ومقول ومصوغ ألا تعلم أن الأصل مبيوع ومكيول ومقوول ومصووغ فنقلت الضمة من العين إلى الفاء فسكنت وواو مفعول بعدها ساكنة فحذفت إحداهما - على الخلاف فيهما - لالتقاء الساكنين.
فهذا جمع لهما تقديراً وحكماً.
فأما أن يمكن النطق بهما على حال فلا.
واعلم مع هذا أن بعض ما ندعي أصليته من هذا الفن قد ينطق به على ما ندعيه من حاله - وهو أقوى الأدلة على صحة ما نعتقده من تصور الأحوال الأول - وذلك اللغتان تختلف فيهما القبيلتان كالحجازية والتميمية ألا ترى أنا نقول في الأمر من المضاعف في التميمية - نحو شُدّ وضَنّ وفِرّ واستَعِدّ واصطبّ يا رجل واطمئنّ يا غلام -: إن الأصل اشدُد واضنَن وافرِر واستعدِد واصطبِب واطمأنِن ومع هذا فهكذا لغة أهل الحجاز وهي اللغة الفصحى القدمى.
ويؤكد ذلك قول الله سبحانه: {فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ} أصله استطاعوا فحذفت التاء لكثرة الاستعمال ولقرب التاء من الطاء وهذا الأصل مستعمل ألا ترى أن عقيبه قوله تعالى {وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا}.
وفيه لغة أخرى وهي: استعت بحذف الطاء كحذف التاء ولغة ثالثة: أسطعت بقطع الهمزة مفتوحة ولغة رابعة: أستعت مقطوعة الهمزة مفتوحة أيضاً.
فتلك خمس لغات: استطعت واسطعت واستعت وأسطعت وأستعت.
وروينا بيت الجران: وفيك إذا لاقيتنا عجرفية مراراً فما نستيع من يتعجرف بضم حرف المضارعة وبالتاء.
ومن ذلك اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين نحو مبيع ومخيط ورجل مدين من الدين.
فهذا كله مغير.
وأصله مبيوع ومديون ومخيوط فغير على ما مضى.
ومع ذلك فبنو تميم - على ما حكاه أبو عثمان عن الأصمعي - يتمون مفعولاً من الياء فيقولون: مخيوط ومكيول قد كان قومك يزعمونك سيداً وإخال أنك سيد معيون وأنشد أبو عمرو بن العلاء: وكأنها تفاحة مطيوبة وقال علقمة بن عبدة: يوم رذاذٍ عليه الدجن مغيوم ويروي: يومٌ رذاذٌ.
وربما تخطوا الياء في هذه إلى الواو وأخرجوا مفعولاً منها على أصله وإن كان - أثقل منه من - الياء.
وذلك قول بعضهم: ثوب مصوون وفرس مقوود ورجل معوود من مرضه.
وأنشدوا فيه: والمسك في عنبره مدووف ولهذا نظائر كثيرة إلا أن هذا سمتها وطريقها.
فقد ثبت بذلك أن هذه الأصول المومأ إليها على أضرب: منها ما لا يمكن النطق به أصلاً نحو ما اجتمع فيه ساكنان كسماء ومبيع ومصوغ ونحو ذلك.
ومنها ما يمكن النطق به غير أن فيه من الاستثقال ما دعا إلى رفضه واطراحه إلا أن يشذ الشيء القليل منه فيخرج على أصله منبهة ودليلاً على أولية حاله كقولهم: لححت عينه وألِل السقاء إذا تغيرت ريحه وكقوله: لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطَّلب ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الياء في نحو موسر وموقن والواو في نحو ميزان وميعاد وامتناعهم من إخراج افتعل وما تصرف منه إذا كانت فاؤه صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء أو دالاً أو ذالاً أو زاياً على أصله وامتناعهم من تصحيح الياء والواو إذا وقعتا طرفين بعد ألف زائدة وامتناعهم من جمع الهمزتين في كلمة واحدة ملتقيتين غير عينين.
فكل هذا وغيره مما يكثر تعداده يمتنع منه استكراهاً للكلفة فيه وإن كان النطق به ممكناً غير متعذر.
وحدثنا أبو علي رحمه الله فيما حكاه - أظنه - عن خلف الأحمر: قال: يقال التقطت النوى واشتقطته واضتقطته.
فصحح تاء افتعل وفاؤه ضاد ونظائره - مما يمكن النطق به إلا أنه رفض استثقالاً له - كثيرة.
قال أبو الفتح: ينبغي أن تكون الضاد في اضتقطت بدلاً من شين اشتقطت فلذلك ظهرت كما تصح التاء مع الشين.
ونظيره قوله: مال إلى أرطاة حقف فالطجع ومنها ما يمكن النطق به إلا أنه لم يستعمل لا لثقله لكن لغير ذلك: من التعويض منه أو لأن الصنعة أدت إلى رفضه.
وذلك نحو " أن " مع الفعل إذا كان جواباً للأمر والنهي وتلك الأماكن السبعة نحو اذهب فيذهب معك {لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ} وذلك أنهم عوضوا من " أن " الناصبة حرف العطف وكذلك قولهم: لا يسعني شيء ويعجز عنك وقوله: .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
إنما نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا صارت أو - والواو - فيه عوضاً من " أن " وكذلك الواو التي تحذف " معها رب " في أكثر الأمر نحو قوله: وقاتم الأعماق خاوي المخترق غير أن الحر لرب لا للواو كما أن النصب في الفعل إنما هو لأن المضمرة لا للفاء ولا للواو ولا " لأو ".
ومن ذلك ما حذف من الأفعال وأنيب عنه غيره مصدراً كان أو غيره نحو ضرباً زيداً وشتماً عمراً.
وكذلك دونك زيداً وعندك جعفراً ونحو ذلك: من الأسماء المسمى بها الفعل.
فالعمل الآن إنما هو لهذه الظواهر المقامات مقام الفعل الناصب.
ومن ذلك ما أقيم من الأحوال المشاهدة مقام الأفعال الناصبة نحو قولك إذا رأيت قادماً: خير مقدم أي قدمت خير مقدم.
فنابت الحال المشاهدة مناب الفعل الناصب.
وكذلك قولك للرجل يهوي بالسيف ليضرب به: عمراً وللرامي للهدف إذا أرسل النزع فسمعت صوتاً القرطاس والله: أي اضرب عمراً وأصاب القرطاس.
فهذا ونحوه لم يرفض ناصبه لثقله بل لأن ما ناب عنه جار عندهم مجراه ومؤد تأديته.
وقد ذكرنا في كتابنا الموسوم " بالتعاقب " من هذا النحو ما فيه كاف بإذن الله تعالى.
باب في فرق بين البدل والعوض
جماع ما في هذا أن البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه.
وإنما يقع البدل في موضع المبدل منه والعوض لا يلزم فيه ذلك ألا تراك تقول في الألف من قام: إنها بدل من الواو التي هي عين الفعل ولا تقول فيها: إنها عوض منها وكذلك يقال في واو جُوَن وياء مِيَر: إنها بدل للتخفيف من همزة جؤن ومئر ولا تقول: إنها عوض منها.
وكذلك تقول في لام غاز وداع: إنها بدل من الواو ولا تقول: إنها عوض منها.
وتقول في العوض: إن التاء في عدة وزنة عوض من فاء الفعل ولا تقول: إنها بدل من منها.
فإن قلت: ذاك فما أقله! وهو تجوز في العبارة.
وسنذكر لم ذلك.
وتقول في ميم " اللهم ": إنها عوض من " يا " في أوله ولا تقول: بدل.
وتقول في تاء زنادقة: إنها عوض من ياء زناديق ولا تقول: بدل.
وتقول في ياء " أينق ": إنها عوض من عين " أنوق " فيمن جعلها أيفل ومن جعلها عيناً مقدمة مغيرة إلى الياء جعلها بدلاً من الواو.
فالبدل أعم تصرفاً من العوض.
فكل عوض بدل وليس كل بدل عوضاً.
وينبغي أن تعلم أن العوض من لفظ " عَوضُ " - وهو الدهر - ومعناه قال الأعشى: والتقؤهما أن الدهر إنما هو مرور الليل والنهار وتصرم أجزائهما فكلما مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون عوضاً منه.
فالوقت الكائن الثاني غير الوقت الماضي الأول.
فلهذا كان العوض أشد مخالفة للمعوض منه من البدل.
وقد ذكرت في موضع من كلامي مفرد اشتقاق أسماء الدهر والزمان وتقصيته هناك.
وأتيت أيضاً في كتابي الموسوم ب " التعاقب " على كثير من هذا الباب ونهجت الطريق إلى ما أذكره بما نبهت به عليه.
باب في الاستغناء بالشيء عن الشيء
قال سيبويه: واعلم أن العرب قد تستغني بالشيء عن الشيء حتى يصير المستغنى عنه مسقطاً من كلامهم البتة.
فمن ذلك استغناؤهم بترك عن " ودع " و " وذر ".
فأما قراءة بعضهم " ما ودَعك ربك وما قلى " وقول أبي الأسود " حتى وَدَعه " فلغة شاذة وقد تقدم القول عليها.
ومن ذلك استغناؤهم بلمحة عن ملمحة وعليها كسرت ملامح وبشبه عن مشبه وعليه جاء مشابه وبليلة عن ليلاة وعليها جاءت ليال وعلى أن ابن الأعرابي قد أنشد: في كل يوم ما وكل ليلاه حتى يقول كل راء إذ راه يا ويحه من جمل ما أشقاه! وهذا شاذ لم يسمع إلا من هذه الجهة.
وكذلك استغنوا بذكر عن مذكار أو مذكير وعليه جاء مذاكير.
وكذلك استغنوا ب " أينق " عن أن يأتوا به والعين في موضعها فألزموه القلب أو الإبدال فلم يقولوا " أنوق " إلا في شيء شاذ حكاه الفراء.
وكذلك استغنوا بقسي عن قووس فلم يأت إلا مقلوباً.
ومن ذلك استغناؤهم بجمع القلة عن جمع الكثرة نحو قولهم أرجل لم يأتوا فيه بجمع الكثرة.
وكذلك شسوع: لم يأتوا فيه بجمع القلة.
وكذلك أيام: لم يستعملوا فيه جمع الكثرة.
فأما جيران فقد أتوا فيه بمثال القلة أنشد الأصمعي: مذمة الأجوار والحقوق وذكره أيضاً ابن الأعرابي فيما أحسب.
فأما دراهم ودنانير ونحو ذلك - من الرباعي وما ألحق به - فلا سبيل فيه إلى جمع القلة.
وكذلك اليد التي هي العضو قالوا فيها أيد البتة.
فأما أياد فتكسير أيد لا تكسير يد وعلى أن " أياد " أكثر ما تستعمل في النعم لا في الأعضاء.
وقد جاءت أيضاً فيها أنشد أبو الخطاب: ساءها ما تأملت في أيادي نا وإشناقُها إلى الأعناق وأنشد أبو زيد: أما واحداً فكفاك مثلي فمن ليد تطاوحها الأيادي ومن أبيات المعاني في ذلك قوله: ومستامة تستام وهي رخيصة تباع بساحات الأيادي وتمسح " مستامة " يعني أرضاً تسوم فيها الإبل من السير لا من السوم الذي هو البيع و " تباع " أي تمد فيها الإبل أبواعها وأيديها و " تمسح " من المسح وهو القطع من قول الله تبارك وتعالى " فطفق مسحاً بالسوق والأعناق " وقال العجاج: وخطرت فيه الأيادي وخطر رايٌ إذا أورده الطعن صدر وقال الراجز: كأنه بالصحصحان الأنجل قطنٌ سخامٌ بأيادي غُزَّل ومن ذلك استغناؤهم بقولهم: ما أجود جوابه عن " هو أفعل منك " من الجواب.
فأما قولهم: ما أشد سواده وبياضه وعوره وحوله فما لا بد منه.
ومنه أيضاً استغناؤهم باشتد وافتقر عن قولهم: فقر وشد.
وعليه جاء فقير.
فأما شد فحكاها أبو زيد في المصادر ولم يحكها سيبويه.
ومن ذلك استغناؤهم عن الأصل مجرداً من الزيادة بما استعمل منه حاملاً للزيادة وهو صدر صالح من اللغة.
وذلك قولهم " حوشب " هذا لم يستعمل منه " حشب " عارية من الواو الزائدة ومثله " كوكب " ألا ترى أنك لا تعرف في الكلام " حشب " عارياً من الزيادة ولا " ككب " ومنه قولهم " دَودَرَّي " لأنا لا نعرف " ددر " ومثله كثير في ذوات الأربعة.
وهو في الخمسة أكثر منه في الأربعة.
فمن الأربعة فلنقس وصرنفح وسميدع وعميثل وسرومط وجحجبي وقسقبّ وقسحبّ وهرشفّ ومن ذوات الخمسة جعفليق وحنبريت ودردبيس وعضرفوط وقرطبوس وقرعبلانة وفنجليس.
فأما عرطليل - وهو رباعي - فقد استعمل بغير زيادة قال أبو النجم: في سرطم هادٍ وعنقٍ عرطل وكذلك خنشليل ألا ترى إلى قولهم: خنشلت المرأة والفرس إذا أسنت وكذلك عنتريس ألا ترى أنه من العترسة وهي الشدة.
فأما قِنفَخر فإن النون فيه زائدة.
وقد حذفت - لعمري - في قولهم: امرأة قفاخرية إذا كانت فائقة في معناها غير أنك وإن كنت قد حذفت النون فإنك قد صرت إلى زيادة أخرى خلفتها وشغلت الأصل شغلها وهي الألف وياء الإضافة.
فأما تاء التأنيث فغير معتدة.
وأما حيزبون فرباعي لزمته زيادة الواو.
فإن قلت: فهلا جعلته ثلاثياً من لفظ الحزب قيل يفسد هذا أن النون في موضع زاي عيضموز فيجب لذلك أن تكون أصلاً كجيم " خيسفوج " وأما " عريقصان " فتناوبته زيادتان وهما الياء في عريقصان والنون في " عرنقصان " كلاهما يقال بالنون والياء.
فأما " عِزويت " فمن لفظ " عزوت " لأنه " فِعليت " والواو لام.
وأما " قنديل " فكذلك أيضاً ألا ترى إلى قول العجلي: رُكب في ضخم الذفاري قندل وأما عَلَندى فتناهبته الزوائد.
وذلك أنهم قد قالوا فيه: عِلوَدٌ وعُلادى وعُلَندًى وعَلَندًى ألا ولزوم الزيادة لما لزمته من الأصول يضعف تحقير الترخيم لأن فيه حذفاً للزوائد.
وبإزاء ذلك ما حذف من الأصول كلام يد ودم وأب وأخ وعين سهٍ ومذ وفاء عدة وزنة وناس والله في أقوى قولي سيبويه.
فإذا جاز حذف الأصول فيما أرينا وغيره كان حذف الزوائد التي ليست لها حرمة الأصول أحجى وأحرى.
وأجاز أبو الحسن أظننت زيداً عمراً عاقلاً ونحو ذلك وامتنع منه أبو عثمان وقال: استغنت العرب عن ذلك بقولهم: جعلته يظنه عاقلاً.
ومن ذلك استغناؤهم بواحد عن اثنٍ وباثنين عن واحدين وبستة عن ثلاثتين وبعشرة عن خمستين وبعشرين عن عشرتين ونحو ذلك.
باب في عكس التقدير
هذا موضع من العربية غريب.
وذلك أن تعتقد في أمر من الأمور حكماً ما وقتاماً ثم تحور في ذلك الشيء عينه في وقت آخر فتعتقد فيه حكماً آخر.
من ذلك الحكاية عن أبي عبيدة.
وهو قوله: ما رأيت أطرف من أمر النحويين يقولون: إن علامة التأنيث لا تدخل على علامة التأنيث وهم يقولون " علقاة " وقد قال العجاج: فكر في علقي وفي مكور يريد أبو عبيدة أنه قال " في علقي " فلم يصرف التأنيث ثم قالوا مع هذا " علقاة " أي فألحقوا تاء التأنيث ألفه.
قال أبو عثمان: كان أبو عبيدة أجفى من أن يعرف هذا.
وذلك أن من قال " علقاة " فالألف عنده للإلحاق بباب جعفر كألف " أرطى " فإذا نزع الهاء أحال اعتقاده الأول عما كان عليه وجعل الألف للتأنيث فيما بعد فيجعلها للإلحاق مع تاء التأنيث وللتأنيث إذا فقد التاء.
ولهذا نظائر.
هي قولهم: بُهمي وبُهماة وشكاعى وشكاعاة وباقلى وباقلاة ونقاوى ونقاواة وسمانى وسماناة.
ومثل ذلك من الممدود قولهم: طرفاء وطرفاءة وقصباء وقصباءة وحلفاء وحلفاءة وباقلاء وباقلاءة.
فمن قال: " طرفاء " فالهمزة عنده للتأنيث ومن قال: " طرفاءة " فالتاء عنده للتأنيث وأما الهمزة على قوله فزيادة لغير التأنيث.
وأقوى القولين فيها عندي أن تكون همزة مرتجلة غير منقلبة لأنها إذا كانت منقلبة في هذا المثال فإنها عن ألف التأنيث لا غير نحو صحراء وصلفاء وخبراء والحرشاء.
وقد يجوز أن تكون منقلبة عن حرف لغير الإلحاق فتكون - في الانقلاب لا في الإلحاق - كألف علباء وحرباء.
وهذا مما يؤكد عندك حال الهاء ألا ترى أنها إذا لحقت اعتقدت فيما قبلها حكماً ما فإن لم تلحق حار الحكم إلى غيره.
ونحو منه قولهم: الصفنة والصفن والرضاع والرضاعة وهو صفو الشيء وصفوته وله نظائر قد ذكرت ومنه البرك والبركة للصدر.
ومن ذلك قولنا: كان يقوم زيد ونحن نعتقد رفع " زيد " ب " كان " ويكون " يقوم " خبراً مقدماً عليه.
فإن قيل: ألا تعلم أن " كان " إنما تدخل على الكلام الذي كان قبلها مبتدأ وخبراً وأنت إذا قلت: يقوم زيد فإنما الكلام من فعل وفاعل فكيف ذلك فالجواب أنه لا يمتنع أن يعتقد مع " كان " في قولنا: كان يقوم زيد أن زيداً مرتفع ب " كان " وأن " يقوم " مقدم عن موضعه فإذا حذفت " كان " زال الاتساع وتأخر الخبر الذي هو " يقوم " فصار بعد " زيد " كما أن ألف " علقاة " للإلحاق فإذا حذفت الهاء استحال التقدير فصارت للتأنيث حتى قال: على ذا تأوله أبو عثمان ولم يحمله على أنهما لغتان.
وأظنه إنما ذهب إلى ذلك لما رآه قد كثرت نظائره نحو سمانى وسماناة وشكاعى وشكاعاة وبهمى وبهماة.
فألف " بهمى " للتأنيث وألف " بهماة " زيادة لغير الإلحاق كألف قبعثرى وضبغطرى.
ويجوز أن تكون للإلحاق بجخدب على قياس قول أبي الحسن الأخفش إلا أنه إلحاق اختص مع التأنيث ألا ترى أن أحداً لا ينون " بهمى " فعلى ذلك يكون الحكم على قولنا: كان يقوم زيد ونحن نعتقد أن زيداً مرفوع بكان.
ومن ذلك ما نعتقده في همزاء حمراء وصفراء ونحوهما أنهما للتأنيث فإن ركبت الاسم مع آخر قبله حرت عن ذلك الاستشعار والتقدير فيها واعتقدت غيره.
وذلك أن تركب مع " حمراء " اسماً قبلها فتجعلهما جميعاً كاسم واحد فتصرف " حمراء " حينئذ.
وذلك قولك: هذا دار حمراء ورأيت دار حمراء ومررت بدار حمراء وكذلك هذا كلبصفراء ورأيت كلبصفراء ومررت بكلبصفراء - فلا تصرف الاسم للتعريف والتركيب كحضرموت.
فإن نكرت صرفت فقلت: رب كلبصفراءٍ مررت به - وكلبصفراء آخر.
فتصرف في النكرة وتعتقد في هذه الهمزة مع التركيب أنها لغير التأنيث وقد كانت قبل التركيب له.
ونحو من ذلك ما نعتقده في الألفات إذا كن في الحروف والأصوات أنها غير منقلبة وذلك نحو ألف لا وما وألف قاف وكاف ودال وأخواتها وألف على وإلى ولدى وإذا فإن نقلتها فجعلتها أسماء أو اشتققت منها فعلاً استحال ذلك التقدير واعتقدت فيها ما تعتقده في المنقلب.
وذلك قولك: مويت إذا كتبت " ما " ولويت إذا كتبت " لا " وكوفت كافاً حسنة ودولت دالاً جيدة وزويت زاياً قوية.
ولو سميت رجلاً ب " على " أو " إلى " أو " لدى " أو " ألا " أو " إذا " لقلت في التثنية: عَلَوان وإلَوان ولَدَوان وأَلَوان وإذَوَان فاعتقدت في هذه الألفات مع التسمية بها وعند الاشتقاق منها الانقلاب وقد كانت قبل ذلك عندك غير منقلبة.
وأغرب من ذلك قولك: بأبي أنت!.
فالباء في أول الاسم حرف جر بمنزلة اللام في قولك: لله أنت! فإذا اشتققت منه فعلاً اشتقاقاً صوتياً استحال ذلك التقدير فقلت: بأبأت به بئباء وقد أكثرت من البأبأة.
فالباء الآن في لفظ الأصل وإن كنا قد أحطنا علماً بأنها فيما اشتقت منه زائدة للجر.
ومثال البِئباء على هذا الفعلال كالزلزال والقلقال والبأبأة الفعللة كالقلقلة والزلزلة وعلى هذا اشتقوا منهما " البئب " فصار فعلاً من باب سلس وقلق قال: يا بأبي أنت ويا فوق البئب! فالبئب الآن بمنزلة الضلع والعنب والقمع والقرب.
ومن ذلك قولهم: القرنوة للنبت وقالوا: قرنيت السقاء إذا دبغته بالقرنوة فالياء في قرنيت الآن للإلحاق بمنزلة ياء سلقيت وجعبيت وإنما هي بدل من واو " قرنوة " التي هي لغير الإلحاق.
وسألني أبو علي - رحمه الله - عن ألف " يا " من قوله - فيما أنشده أبو زيد -: فخيرٌ نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا فقال: أمنقلبة هي قلت: لا لأنها في حرف أعني " يا " فقال: بل هي منقلبة.
فاستدللته على ذلك فاعتصم بأنها قد خلطت باللام بعدها ووقف عليها فصارت كأنها جزء منها فصارت " يال " بمنزلة قال والألف في موضع العين وهي مجهولة فينبغي أن يحكم عليها بالانقلاب عن الواو.
هذا جمل ما قاله ولله هو وعليه رحمته فما كان أقوى قياسه وأشد بهذا العلم اللطيف الشريف أنسه.
فكأنه إنما كان مخلوقاً له.
وكيف كان لا يكون كذلك وقد أقام على هذه الطريقة مع جلة أصحابها وأعيان شيوخها سبعين سنة زائحة علله ساقطة عنه كلفه وجعله همه وسدمه لا يعتاقه عنه ولد ولا يعارضه فيه متجر ولا يسوم به مطلباً ولا يخدم به رئيساً إلا بأخرة وقد حط من أثقاله وألقى عصا ترحاله! ثم إني - ولا أقول إلا حقاً - لأعجب من نفسي في وقتي هذا كيف تطوع لي بمسئلة أم كيف تطمح بي إلى انتزاع علة! مع ما الحال عليه من علق الوقت وأشجانه وتذاؤبه وخلج أشطانه ولولا معازة الخاطر واعتناقه ومساورة الفكر واكتداده لكنت عن هذا الشأن بمعزل وبأمر سواه على شغل.
وقال لي مرة رحمه الله بهذه الانتقالات: كما جاز إذا سميت ب " ضرب " أن تخرجه من البناء إلى الإعراب كذلك يجوز أيضاً أن تخرجه من جنس إلى جنس إذا أنت نقلته من موضعه إلى غيره.
ومن طريف ما ألقاه - رضي الله تعالى عنه - علي أنه سألني يوماً عن قولهم هات لا هاتيت فقال " ما هاتيت " فقلت: فاعلت فهات من هاتيت كعاط من عاطيت فقال: أشيء آخر فلم يحضر إذ ذاك فقال أنا أرى فيه غير هذا.
فسألته عنه فقال: يكون فعليت قلت: ممه قال: من الهوتة وهي المنخفض من الأرض - قال: وكذلك " هيت " لهذا البلد لأنه منخفض من الأرض - فأصله هوتيت ثم أبدلت الواو التي هي عين فعليت وإن كانت ساكنة كما أبدلت في ياجل وياحل فصار هاتيت وهذا لطيف حسن.
على أن صاحب العين قد قال: إن الهاء فيه بدل من همزة كهرقت ونحوه.
والذي يجمع بين هاتيت وبين الهوتة حتى دعا ذلك أبا علي إلى ما قال به أن الأرض المنخفضة تجذب إلى نفسها بانخفاضها.
وكذلك قولك: هات إنما هو استدعاء منك للشيء واجتذابه إليك.
وكذلك صاحب العين إنما حمله على اعتقاد بدل الهاء من الهمزة أنه أخذه من أتيت الشيء والإتيان ضرب من الانجذاب إلى الشيء.
والذي ذهب إليه أبو علي في " هاتيت " غريب لطيف.
ومما يستحيل فيه التقدير لانتقاله من صورة إلى أخرى قولهم " هلممت " إذا قلت: هلم.
فهلممت الآن كصعررت وشمللت وأصله قبل غير هذا إنما هو أول " ها " للتنبيه لحقت مثال الأمر للمواجه توكيداً.
وأصلها ها لُمَّ فكثر استعمالها وخلطت " ها " ب " لم " توكيداً للمعنى لشدة الاتصال فحذفت الألف لذلك ولأن لام " لم " في الأصل ساكنة ألا ترى أن تقديرها أول " المم " وكذلك يقولها أهل الحجاز ثم زال هذا كله بقولهم " هلممت " فصارت كأنها فعللت من لفظ " الهلمام " وتنوسيت حال التركيب.
وكأن الذي صرفهما جميعاً عن ظاهر حاله حتى دعا أبا علي إلى أن جعله من " الهوتة " وغيره من لفظ أتيت عدم تركيب ظاهره ألا ترى أنه ليس في كلامهم تركيب " ه ت و " ولا " ه ت ي " فنزلا جميعاً عن بادي أمره إلى لفظ غيره.
فهذه طريق اختلاف التقدير وهي واسعة غير أني قد نبهت عليها فأمض الرأي والصنعة فيما يأتي منها.
ومن لفظ " الهوتة " ومعناها قولهم مضى هيتاء من الليل وهو فعلاء منه ألا تراهم قالوا: قد تهور الليل ولو كسرت " هيتاء " لقلت " هواتي " وقريب من لفظه ومعناه قول الله سبحانه {هَيْتَ لَكَ} إنما معناه هلم لك وهذا اجتذاب واستدعاء له قال: أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا
باب في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى
هذا الموضع كثيراً ما يستهوي من يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة.
وذلك كقولهم في تفسير قولنا " أهلَكَ والليلَ " معناه الحق أهلك قبل الليل فربما دعا ذاك من لا دربة له إلى أن يقول " أهلك والليل " فيجره وإنما تقديره الحق أهلك وسابق الليل.
وكذلك قولنا زيد قام: ربما ظن بعضهم أن زيداً هنا فاعل في الصنعة كما أنه فاعل في المعنى.
وكذلك تفسير معنى قولنا: سرني قيام هذا وقعود ذاك بأنه سرني أن قام هذا وأن قعد ذاك ربما اعتقد في هذا وذاك أنهما في موضع رفع لأنهما فاعلان في المعنى.
ولا تستصغر هذا الموضع فإن العرب أيضاً قد مرت به وشمت روائحه وراعته.
وذلك أن الأصمعي أنشد في جملة أراجيزه شعراً من مشطور السريع طويلاً ممدوداً مقيداً التزم الشاعر فيه أن جعل قوافيه كلها في موضع جر إلا بيتاً واحداً من الشعر: يستمسكون من حذار الإلقاء بتلعات كجذوع الصيصاء رِدِي رِدِي وِردَ قطاة صماء كدرية أعجبها برد الماء كأنها وقد رآها الرؤاء والذي سوغه ذاك - على ما التزمه في جميع القوافي - ما كنا على سمته من القول.
وذلك أنه لما كان معناه: كأنها في وقت رؤية الرؤاء تصور معنى الجر من هذا الموضع فجاز أن يخلط هذا البيت بسائر الأبيات وكأنه لذلك لم يخالف.
ونظير هذا عندي قول طرفة: في جفان تعتري نادينا وسديف حين هاج الصِنَّبِر يريد الصِنَّبر فاحتاج للقافية إلى تحريك الباء فتطرق إلى ذلك بنقل حركة الإعراب إليها تشبيهاً بباب قولهم: هذا بكر ومررت ببكر وكان يجب على هذا أن يضم الباء فيقول: الصَنَّبُر لأن الراء مضمومة إلا أنه تصور معنى إضافة الظرف إلى الفعل فصار إلى أنه كأنه قال: حين هيج الصنبر فلما احتاج إلى حركة الباء تصور معنى الجر فكسر الباء وكأنه قد نقل الكسرة عن الراء إليها.
ولولا ما أوردته في هذا لكان الضم مكان الكسر.
وهذا أقرب مأخذاً من أن تقول: إنه حرّف القافية للضرورة كما حرفها الآخر في قوله: هل عرفت الدار أم أنكرتها بين تبراك فشسَّى عبقُر وما دمية من دمى ميسنا ن معجبة نظراً واتصافا أراد - فيما قيل - ميسان فزاد النون ضرورة فهذا - لعمري - تحريف بتعجرف عار من الصنعة.
والذي ذهبت أنا إليه هناك في " الصنبِر " ليس عارياً من الصنعة.
فإن قلت: فإن الإضافة في قوله " حين هاج الصنبر " إنما هي إلى الفعل لا إلى الفاعل فكيف حرفت غير المضاف إليه قيل الفعل مع الفاعل كالجزء الواحد وأقوى الجزأين منهما هو الفاعل فكأن الإضافة إنما هي إليه لا إلى الفعل فلذلك جاز أن يتصور فيه معنى الجر.
فإن قيل: فأنت إذا أضفت المصدر إلى الفاعل جررته في اللفظ واعتقدت مع هذا أنه في المعنى مرفوع فإذا كان في اللفظ أيضاً مرفوعاً فكيف يسوغ لك بعد حصوله في موضعه من استحقاقه الرفع لفظاً ومعنى أن تحور به فتتوهمه مجروراً قيل هذا الذي أردناه وتصورناه هو مؤكد للمعنى الأول لأنك كما تصورت في المجرور معنى الرفع كذلك تممت حال الشبه بينهما فتصورت في المرفوع معنى الجر.
ألا ترى أن سيبويه لما شبه الضارب الرجل بالحسن الوجه وتمثل ذلك في نفسه ورسا في تصوره زاد في تمكين هذه الحال له وتثبيتها عليه بأن عاد فشبه الحسن الوجه بالضارب الرجل في الجر كل ذلك تفعله العرب وتعتقده العلماء في الأمرين ليقوى تشابههما وتعمر ذات بينهما ولا يكونا على حرد وتناظر غير مجد فاعرف هذا من ومن ذلك قولهم في قول العرب: كل رجل وصنعته وأنت وشأنك: معناه أنت مع شأنك وكل رجل مع صنعته فهذا يوهم من أمم أن الثاني خبر عن الأول كما أنه إذا قال أنت مع شأنك فإن قوله " مع شأنك " خبر عن أنت.
وليس الأمر كذلك بل لعمري إن المعنى عليه غير أن تقدير الأعراب على غيره.
وإنما " شأنك " معطوف على " أنت " والخبر محذوف للحمل على المعنى فكأنه قال: كل رجل وصنعته مقرونان وأنت وشأنك مصطحبان.
وعليه جاء العطف بالنصب مع أن قال: أغار على معزاي لم يدر أنني وصفراء منها عبلة الصفوات ومن ذلك قولهم أنت ظالم إن فعلت ألا تراهم يقولون في معناه: إن فعلت فأنت ظالم فهذا ربما أوهم أن " أنت ظالم " جواب مقدم ومعاذ الله أن يقدم جواب الشرط عليه وإنما قوله " أنت ظالم " دال على الجواب وساد مسده فأما أن يكون هو الجواب فلا.
ومن ذلك قولهم في عليك زيداً: إن معناه خذ زيداً وهو - لعمري - كذلك إلا أن " زيداً " الآن إنما هو منصوب بنفس " عليك " من حيث كان اسماً لفعل متعد لا أنه منصوب ب " خذ ".
ألا ترى إلى فرق ما بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منه ولا تسترسل إليه فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه وإن كان تقدير الإعراب مخالفاً لتفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه وصححت طريق تقدير الإعراب حتى لا يشذ شيء منها عليك وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه ألا تراك تفسر نحو قولهم: ضربت زيداً سوطاً أن معناه ضربت زيداً ضربة بسوط.
وهو - لا شك - كذلك ولكن طريق إعرابه أنه على حذف المضاف أي ضربته ضربة سوط ثم حذفت الضربة على عبرة حذف المضاف.
ولو ذهبت تتأول ضربته سوطاً على أن تقدير إعرابه: ضربة بسوط كما أن معناه كذلك للزمك أن تقدر أنك حذفت الباء كما تحذف حرف الجر في نحو قوله: أمرتك الخير وأستغفر الله ذنباً فتحتاج إلى اعتذار من حذف حرف الجر وقد غنيت عن ذلك كله بقولك: إنه على حذف المضاف أي ضربة سوط ومعناه ضربة بسوط فهذا - لعمري - معناه فأما طريق إعرابه وتقديره فحذف المضاف.
باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به
إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه من ذلك أن ترى رجلاً قد سدد سهماً نحو الغرض ثم أرسله فتسمع صوتاً فتقول: القرطاس والله أي أصاب القرطاس.
ف " أصاب " الآن في حكم الملفوظ به البتة وإن لم يوجد في اللفظ غير أن دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ به.
وكذلك قولهم لرجل مهو بسيف في يده: زيداً أي اضرب زيداً.
فصارت شهادة الحال بالفعل بدلاً من اللفظ به.
وكذلك قولك للقادم من سفر: خير مقدم أي قدمت خير مقدم وقولك: قد مررت برجل إن زيداً وإن عمراً أي إن كان زيداً وإن كان عمراً وقولك للقادم من حجه: مبرور مأجور أي أنت مبرور مأجور ومبروراً مأجوراً أي قدمت مبروراً مأجوراً وكذلك قوله: رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الغداة من جلله أي رب رسم دار.
وكان رؤبة إذا قيل له كيف أصبحت يقول: خير عافاك الله - أي بخير - يحذف الباء لدلالة الحال عليها بجري العادة والعرف بها.
وكذلك قولهم: الذي ضربت زيد تريد الهاء وتحذفها لأن في الموضع دليلاً عليها.
وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة وهي قوله سبحانه " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامِ " ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس بل الأمر فيها دون ذلك وأقرب وأخف وألطف وذلك أن لحمزة أن يقول لأبي العباس: إنني لم أحمل " الأرحام " على العطف على المجرور المضمر بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت: " وبالأرحام " ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها كما حذفت لتقدم ذكرها في نحو قولك: بمن تمرر أمرر وعلى من تنزل أنزل ولم تقل: أمرر به ولا أنزل عليه لكن حذفت الحرفين لتقدم ذكرهما.
وإذا جاز للفرزدق أن يحذف حرف الجر لدلالة ما قبله عليه " مع مخالفته له في الحكم " في قوله: وإني من قوم بهم يتقى العدا ورأب الثأى والجانب المتخوف أراد: وبهم رأب الثأى فحذف الباء في هذا الموضع لتقدمها في قوله: بهم يتقى العدا وإن كانت حالاهما مختلفتين.
ألا ترى أن الباء في قوله " بهم يتقى العدا " منصوبة الموضع لتعلقها بالفعل الظاهر الذي هو يتقى كقولك: بالسيف يضرب زيد والباء في قوله: " وبهم رأب الثأى " مرفوعة الموضع عند قوم وعلى كل حال فهي متعلقة بمحذوف ورافعه الرأب - ونظائر هذا كثيرة - كان حذف الباء من قوله " والأرحام " لمشابهتها الباء في " به " موضعاً وحكماً أجدر وقد أجازوا تباً له وويل على تقدير وويل له فحذفوها وإن كانت اللام في " تباً له " لا ضمير فيها وهي متعلقة بنفس " تباً " مثلها في هلم لك وكانت اللام في " ويل له " خبراً ومتعلقة بمحذوف وفيها ضمير فهذا عروض بيت الفرزدق.
فإن قلت: فإذا كان المحذوف للدلالة عليه عندك بمنزلة الظاهر فهل تجيز توكيد الهاء المحذوفة في نحو قولك: الذي ضربت زيد فتقول: الذي ضربت نفسه زيد كما تقول: الذي ضربته نفسه زيد قيل: هذا عندنا غير جائز وليس ذلك لأن المحذوف هنا ليس بمنزلة المثبت بل لأمر آخر وهو أن الحذف هنا إنما الغرض به التخفيف لطول الاسم فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض.
وذلك أن التوكيد والإسهاب ضد التخفيف والإيجاز فلما كان الأمر كذلك تدافع الحكمان فلم يجز أن يجتمعا كما لا يجوز ادغام الملحق لما فيه من نقض الغرض.
وكذلك قولهم لمن سدد سهماً ثم أرسله نحو الغرض فسمعت صوتاً فقلت: القرطاس والله أي أصاب القرطاس: لا يجوز توكيد الفعل الذي نصب " القرطاس ".
لو قلت: إصابةً القرطاس فجعلت " إصابة " مصدراً للفعل الناصب للقرطاس لم يجز من قبل أن الفعل هنا قد حذفته العرب وجعلت الحال المشاهدة دالة عليه ونائبة عنه فلو أكدته لنقضت الغرض لأن في توكيده تثبيتاً للفظه المختزل ورجوعاً عن المعتزم من حذفه واطراحه والاكتفاء بغيره منه.
وكذلك قولك للمهوي بالسيف في يده: زيداً أي اضرب زيداً لم يجز أن تؤكد ذلك الفعل الناصب لزيد ألا تراك لا تقول: ضرباً زيداً وأنت تجعل " ضرباً " توكيداً لاضرب المقدرة من قبل أن تلك اللفظة قد أنيبت عنها الحال الدالة عليها وحذفت هي اختصاراً فلو أكدتها لنقضت القضية التي كنت حكمت بها لها لكن لك أن تقول: ضرباً زيداً لا على أن تجعل ضرباً توكيداً للفعل الناصب لزيد بل على أن تبدله منه فتقيمه مقامه فتنصب به زيداً فأما على التوكيد به لفعله وأن يكون زيد منصوباً بالفعل الذي هذا توكيد له فلا.
فهذه الأشياء لولا ما عرض من صناعة اللفظ - أعني الاقتصار على شيء دون شيء - لكان توكيدها جائزاً حسناً لكن " عارض ما منع " فلذلك لم يجز لا لأن المحذوف ليس في تقدير الملفوظ به.
ومما يؤكد لك أن المحذوف للدلالة عليه بمنزلة الملفوظ به إنشادهم قول الشاعر: قاتلي القوم يا خزاع ولا يأخذكم من قتالهم فشل فتمام الوزن أن يقال: فقاتلي القوم فلولا أن المحذوف إذا دل الدليل عليه بمنزلة المثبت لكان هذا كسراً لا زخافاً.
وهذا من أقوى وأعلى ما يحتج به لأن المحذوف للدلالة عليه بمنزلة الملفوظ به البتة فاعرفه واشدد يدك به.
وعلى الجملة فكل ما حذف تخفيفاً فلا يجوز توكيده لتدافع حاليه به من حيث التوكيد للإسهاب والإطناب والحذف للاختصار والإيجاز.
فاعرف ذلك مذهباً للعرب.
ومما يدلك على صحة ذلك قول العرب - فيما رويناه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى -: " راكب الناقة طليحان " كذا رويناه هكذا وهو يحتمل عندي وجهين: أحدهما ما نحن عليه من الحذف فكأنه قال: راكب الناقة والناقة طليحان فحذف المعطوف لأمرين: أحدهما تقدم ذكر الناقة والشيء إذا تقدم ذكره دل على ما هو مثله.
ومثله من حذف المعطوف قول الله عز وجل {فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً} أي فضرب فانفجرت.
فحذف " فضرب " لأنه معطوف على قوله: " فقلنا ".
وكذلك قول التغلبي: إذا ما الماء خالطها سخينا أي شربنا فسخينا.
فكذلك قوله: راكب الناقة طليحان أي راكب الناقة والناقة طليحان.
فإن قلت: فهلا كان التقدير على حذف المعطوف عليه أي الناقة وراكب الناقة طليحان قيل يبعد ذلك من وجهين: أحدهما أن الحذف اتساع والاتساع بابه آخر الكلام وأوسطه لا صدره وأوله ألا ترى أن من اتسع بزيادة " كان " حشواً أو آخراً لا يجيز زيادتها أولاً وأن من اتسع بزيادة " ما " حشواً وغير أول لم يستجز زيادتها أولاً إلا في شاذ من القول نحو قوله: وقد ما هاجني فازددت شوقاً بكاء حمامتين تجاوبان فيمن رواه " وقدما " بزيادة " ما " على أنه يريد: وقد هاجني لا فيمن رواه فقال: " وقدماً هاجني " أي وقديماً هاجني.
والآخر أنه لو كان تقديره: الناقة وراكب الناقة طليحان لكان قد حذف حرف العطف وبقي المعطوف به وهذا شاذ إنما حكى منه أبو عثمان عن أبي زيد: أكلت لحماً سمكاً تمراً وأنشد أبو الحسن: كيف أصبحت كيف أمسيت مما يزرع الود في فؤاد الكريم وأنشد ابن الأعرابي: وكيف لا أبكي على علاتي صبائحي غبائقي قيلاتي وهذا كله شاذ ولعله جميع ما جاء منه.
وأما على القول الآخر فإنه - لعمري - قد حذف حرف العطف مع المعطوف به وهذا ما لا بد منه ألا ترى أنه إذا حذف المعطوف لم يجز أن قد وعدتني أم عمرو أن تا تدهن رأسي وتفليني وا وتمسح القنفاء حتى تنتا فإنما جاز هذا لضرورة الشعر ولأنه أيضاً قد أعاد الحرف في أول البيت الثاني فجاز تعليق الأول بعد أن دعمه بحرف الإطلاق وأعاده فعرف ما أراد بالأول فجرى مجرى قوله: عجل لنا هذا وألحقنا بذا ال الشحم إنا قد مللناه بجل فكما علق حرف التعريف مدعوماً بألف الوصل وأعاده فيما بعد فكذلك علق حرف العطف مدعوماً بحرف الإطلاق وأعاده فيما بعد.
فإن قلت: فألف قوله " وا " ملفوظ بها وألف الوصل في قوله " بذا ال " غير ملفوظ بها قيل: لو ابتدأت اللام لم يكن من الهمزة بد.
فإن قلت: أفيجوز على هذا " قام زيد وه وعمرو " فتجري هاء بيان الحركة ألف الإطلاق فإنه أضعف القياسين.
وذلك أن ألف الإطلاق أشبه بما صيغ في الكلمة من هاء بيان الحركة ألا ترى إلى ما جاء من قوله: ولاعب بالعشي بني بنينه كفعل الهر يحترش العظايا فأبعده الإله ولا يؤبى ولا يسقى من المرض الشفايا - وقرأته على أبي علي: ولا يشفى - ألا ترى أن أبا عثمان قال: شبه ألف الإطلاق بتاء التأنيث أي فصحح اللام لها كما يصححها للهاء وليست كذلك هاء بيان الحركة لأنها لم تقو قوة تاء التأنيث أولا ترى أن ياء الإطلاق في قوله: .
كله لم أصنعي قد نابت عن الضمير العائد حتى كأنه قال: لم أصنعه فلذلك كان " وا " من قوله " وتفليني وا " كأنه لاتصاله بالألف غير معلق.
فإذا كان في اللفظ كأنه غير معلق وعاد من بعد معطوفاً به لم يكن هناك كبير مكروه فيعتذر منه.
فإن قلت: فإن هاء بيان الحركة قد عاقبت لام الفعل نحو ارمه واغزه واخشه فهذا يقويها فإنه موضع لا يجوز أن يسوى به بينها وبين ألف الإطلاق.
والوجه الآخر الذي لأجله حسن حذف المعطوف أن الخبر جاء بلفظ التثنية فكان ذلك دليلاً على أن المخبر عنه اثنان.
فدل الخبر على حال المخبر عنه.
إذ كان الثاني هو الأول.
فهذا أحد وجهي ما تحتمله الحكاية.
والآخر أن يكون الكلام محمولاً على حذف المضاف أي راكب الناقة أحد طليحين كما يحتمل ذلك قوله سبحانه {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} أي من أحدهما وقد ذهب فيه إليه فيما حكاه أبو الحسن.
فالوجه الأول وهو ما كنا عليه: من أن المحذوف من اللفظ إذا دلت الدلالة عليه كان بمنزلة الملفوظ به ألا ترى أن الخبر لما جاء مثنى دل على أن المخبر عنه مثنى نقض المراتب إذا
عرض عارض
باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض
من ذلك امتناعهم من تقديم الفاعل في نحو ضرب غلامه زيداً. فهذا لم يمتنع من حيث كان الفاعل ليس رتبته التقديم وإنما امتنع لقرينة انضمت إليه وهي إضافة الفاعل إلى ضمير المفعول وفساد تقدم المضمر على مظهره لفظاً ومعنى.
فلهذا وجب إذا أردت تصحيح المسئلة أن تؤخر الفاعل فتقول: ضرب زيداً غلامه وعليه قول الله سبحانه: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} وأجمعوا على أن ليس بجائز ضرب غلامه زيداً لتقدم المضمر على مظهره لفظاً ومعنى.
وقالوا في قول النابغة: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل إن الهاء عائدة على مذكور متقدم كل ذلك لئلا يتقدم ضمير المفعول عليه مضافاً " إلى الفاعل " فيكون مقدماً عليه لفظاً ومعنى.
وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء في قوله: جزى ربه عني عدي بن حاتم عائدة على عدي خلافاً على الجماعة.
فإن قيل: ألا تعلم أن الفاعل رتبته التقدم والمفعول رتبته التأخر فقد وقع كل منهما الموقع الذي هو أولى به فليس لك أن تعتقد في الفاعل وقد وقع مقدماً أن موضعه التأخير وإنما المأخوذ به في ذلك أن يعتقد في الفاعل إذا وقع مؤخراً أن موضعه التقديم فإذا وقع مقدماً فقد أخذ مأخذه ورست به قدمه.
وإذا كان كذلك فقد وقع المضمر قبل مظهره لفظاً ومعنى.
وهذا ما لا يجوزه القياس.
قيل: الأمر وإن كان ظاهره ما تقوله فإن هنا طريقاً آخر يسوغك غيره وذلك أن المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل حتى دعا ذاك أبا علي إلى أن قال: إن تقدم المفعول على الفاعل قسم أيضاً قائم برأسه وإن كان تقديم الفاعل أكثر وقد جاء به الاستعمال مجيئاً واسعاً نحو قول الله عز وجل {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} وقول ذي الرمة: أستحدث الركب من أشياعهم خبراً أم عاود القلب من أطرابه طرب وقول معقر بن حمار البارقي: أجد الركب بعد غد خفوف وأمست من لبانتك الألوف وقول دُرنى بنت عبعبة: وقول لبيد: فمدافع الريان عُرِّيَ رسمها خلقاً كما ضمن الوُحِيَّ سِلامها ومن أبيات الكتاب: اعتاد قلبك من سلمى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطلل فقدم المفعول في المصراعين جميعاً وللبيد أيضاً: رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها وله أيضاً: لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها وقال الله عز وجل: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} وقال الآخر: أبعدك الله من قلب نصحت له في حب جمل ويأبى غير عصياني وقال المرقش الأكبر: لم يشج قلبي مِلحوادث إل لا صاحبي المتروك في تغلم وفيها: في باذخات من عماية أو يرفعه دون السماء خيم والأمر في كثرة تقديم المفعول على الفاعل في القرآن وفصيح الكلام متعالم غير مستنكر فلما كثر وشاع تقديم المفعول على الفاعل كان الموضع له حتى إنه إذا أخر فموضعه التقديم فعلى ذلك كأنه قال: جزى عديَّ بن حاتم ربُّه ثم قدم الفاعل على أنه قد قدره مقدماً عليه مفعوله فجاز ذلك ولا تستنكر هذا الذي صورته لك ولا يجف عليك فإنه مما تقبله هذه اللغة ولا تعافه ولا تتبشعه ألا ترى أن سيبويه أجاز في جر الوجه من قولك: هذا الحسن الوجهِ أن يكون من موضعين: أحدهما بإضافة الحسن إليه والآخر تشبيه له بالضارب الرجل هذا مع أنا قد أحطنا علماً بأن الجر في الرجل من قولك: هذا الضارب الرجل إنما جاءه وأتاه من جهة تشبيههم إياه بالحسن الوجه لكن لما اطرد الجر في نحو هذا الضارب الرجل والشاتم الغلام صار كأنه أصل في بابه حتى دع ذاك سيبويه إلى أن عاد " فشبه الحسن الوجه " بالضارب الرجل - من الجهة التي إنما صحت للضارب الرجل تشبيهاً بالحسن الوجه - وهذا يدلك على تمكن الفروع عندهم حتى إن أصولها التي أعطتها حكماً من أحكامها قد حارت فاستعادت من فروعها ما كانت هي أدته إليها وجعلته عطية منها لها فكذلك أيضاً يصير تقديم المفعول لما استمر وكثر كأنه هو الأصل وتأخير الفاعل كأنه أيضاً هو الأصل.
فإن قلت إن هذا ليس مرفوعاً إلى العرب ولا محكياً عنها أنها رأته مذهباً وإنما هو شيء رآه سيبويه واعتقده قولاً ولسنا نقلد سيبويه ولا غيره في هذه العلة ولا غيرها فإن الجواب عن هذا حاضر عتيد والخطب فيه أيسر وسنذكره في باب يلي هذا بإذن الله.
ويؤكد أن الهاء في " ربه " لعدي بن حاتم من جهة المعنى عادة العرب في الدعاء ألا تراك لا تكاد تقول: جزى رب زيد عمراً وإنما يقال: جزاك ربك خيراً أو شراً.
وذلك أوفق لأنه إذا كان مجازيه ربه كان أقدر على جزائه وأملأ به.
ولذلك جرى العرف بذلك فاعرفه.
ومما نقضت مرتبته المفعول في الاستفهام والشرط فإنهما يجيئان مقدمين على الفعلين الناصبين لهما وإن كانت رتبة المعمول أن يكون بعد العامل فيه.
وذلك قوله سبحانه وتعالى {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} ف " أي منقلب " منصوب على المصدر ب " ينقلبون " لا ب " سيعلم " وكذلك قوله تعالى " أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي " وقال {أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} فهذا ونحوه لم يلزم تقديمه من حيث كان مفعولاً.
وكيف يكون ذلك وقد قال عز اسمه {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا} وقال تعالى {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ} وقال {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} وقال {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وهو ملء الدنيا كثرة وسعة لكن إنما وجب تقديمه لقرينة انضمت إلى ذلك وهي وجوب تقدم الأسماء المستفهم بها والأسماء المشروط بها.
فهذا من النقض العارض.
ومن ذلك وجوب تأخير المبتدأ إذا كان نكرة وكان الخبر عنه ظرفاً نحو قولهم: عندك مال وعليك دين وتحتك بساطان ومعك ألفان.
فهذه الأسماء كلها مرفوعة بالابتداء ومواضعها التقديم على الظروف قبلها التي هي أخبار عنها إلا أن مانعاً منع من ذلك حتى لا تقدمها عليها ألا ترى أنك لو قلت: غلام لك أو بساطان تحتك ونحو ذلك لم يحسن لا لأن المبتدأ ليس موضعه التقديم لكن لأمر حدث وهو كون المبتدأ هنا نكرة ألا تراه لو كان معرفة لاستمر وتوجه تقديمه فتقول: البساطان تحتك والغلام لك.
أفلا ترى أن ذلك إنما فسد تقديمه لما ذكرناه: من قبح تقديم المبتدأ نكرة في الواجب ولكن لو أزلت الكلام إلى غير الواجب لجاز تقديم النكرة كقولك: هل غلام عندك وما بساط تحتك فجنيت الفائدة من حيث كنت قد أفدت بنفيك عنه كون البساط تحته واستفهامك عن الغلام: أهو عنده أم لا إذ كان هذا معنى جلياً مفهوماً.
ولو أخبرت عن النكرة في الإيجاب مقدمة فقلت: رجل عندك كنت قد أخبرت عن منكور لا يعرف وإنما ينبغي أن تقدم المعرفة ثم تخبر عنها بخبر يستفاد منه معنى منكور نحو زيد عندك ومحمد منطلق وهذا واضح.
فإن قلت: فلم وجب مع هذا تأخير النكرة في الإخبار عنها بالواجب قيل لما قبح ابتداؤها نكرة لما ذكرناه رأوا تأخيرها وإيقاعها في موقع الخبر الذي بابه أن يكون نكرة فكان ذلك إصلاحاً للفظ كما أخروا اللام لام الابتداء مع " إن " في قولهم: إن زيداً لقائم لإصلاح اللفظ.
وسترى ذلك في بابه بعون الله وقدرته.
فاعلم إذاً أنه لا تنقض مرتبة إلا لأمر حادث فتأمله وابحث عنه.
باب من غلبة الفروع على الأصول
هذا فصل من فصول العربية طريف تجده في معاني العرب كما تجده في معاني الإعراب.
ولا تكاد تجد شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة.
فمما جاء فيه ذلك للعرب قول ذي الرمة: ورمل كأوراك العذارى قطعته إذا ألبسته المظلمات الحنادس أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً.
وذلك أن العادة والعرف في نحو هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء ألا ترى إلى قوله: ليلى قضيب تحته كثيب وفي القلاد رَشَأٌ ربيب وإلى قول ذي الرمة أيضاً - وهو من أبيات الكتاب -: ترى خلفها نصفاً قناة قويمة ونصفاً نقاً يرتج أو يتمرمر وإلى قول الآخر: خلقت غير خلقة النسوان إن قمت فالأعلى قضيب بان وإلى قوله: كدِعص النقا يمشي الوليدان فوقه بما احتسبا من لين مس وتسهال وما أحسن ما ساق الصنعة فيه الطائي الكبير: كم أحرزت قضب الهندي مصلتةً تهتز من قضب تهتز في كثب ولله البحتري فما أعذب وأظرف وأدمث قوله: أين الغزال المستعير من التقا كفلاً ومن نور الأقاحي مبسما فقلب ذو الرمة العادة والعرف في هذا فشبه كثبان الأنقاء بأعجاز النساء.
وهذا كأنه يخرج مخرج المبالغة أي قد ثبت هذا الموضع وهذا المعنى لأعجاز النساء وصار كأنه الأصل فيه حتى شبه به كثبان الأنقاء.
ومثله للطائي الصغير: في طلعة البدر شيء من ملاحتها وللقضيب نصيب من تثنيها وآخر من جاء به شاعرنا فقال: نحن ركب مِلجِنِّ في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال فجعل كونهم جناً أصلاً وجعل كونهم ناساً فرعاً وجعل كون مطاياه طيراً أصلاً وكونها جمالاً فرعاً فشبه الحقيقة بالمجاز في المعنى الذي منه أفاد المجاز من الحقيقة ما أفاد.
وعلى نحو جمالية تغتلي بالردف إذا كذب الآثمات الهجيرا وقال الراعي: على جمالية كالفحل هملاج وهو كثير.
فلما شاع ذلك واطرد صار كأنه أصل في بابه حتى عادوا فشبهوا الجمل بالناقة في ذلك فقال: وقربوا كل جُمالي عَضِه قريبةٍ ندوتُه من مَحمَضِه فهذا من حملهم الأصل على الفرع فيما كان الفرع أفاده من الأصل ونظائره في هذه اللغة كثيرة.
وهذا المعنى عينه قد استعمله النحويون في صناعتهم فشبهوا الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل ألا ترى أن سيبويه أجاز في قولك: هذا الحسن الوجه أن يكون الجر في الوجه من موضعين أحدهما الإضافة والآخر تشبيهه بالضارب الرجل الذي إنما جاز فيه الجر تشبيهاً له بالحسن الوجه على ما تقدم في الباب قبل هذا.
فإن قيل: وما الذي سوغ سيبويه هذا وليس مما يرويه عن العرب رواية وإنما هو شيء رآه واعتقده لنفسه وعلل به قيل يدل على صحة ما رآه من هذا وذهب إليه ما عرفه وعرفناه معه: من أن العرب إذا شبهت شيئاً بشيء مكنت ذلك الشبه لهما وعمرت به الحال بينهما ألا تراهم لما شبهوا الفعل المضارع بالاسم فأعربوه تمموا ذلك المعنى بينهما بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه.
وكذلك لما شبهوا الوقف بالوصل في نحو قولهم " عليه السلام والرحمت " وقوله: بل جوزتيهاء كظهر الحجفت وقوله: آلله نجاك بكفي مَسلمت من بعدما وبعدما وبعدمت صارت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحرة أن تدعى أمت كذلك شبهوا أيضاً الوصل بالوقف في قولهم: ثلاثهَ اربعه يريد ثلاثه أربعه ثم تخفف الهمزة فتقول: ثلاثهَ اربَعَه وفي قولهم: " سبسبَّا وكلكلاّ ".
وكما أجروا غير اللازم مجرى اللازم في قولهم: " لَحمر ورُيا " وقولهم: وَهْوَ الله وَهْيَ التي فعلتْ وقوله: فقمت للطيف مرتاعاً وأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلم وقولهم ها الله ذا أجروه مجرى دابة وقوله: ومن يتق فإن الله معه ورزق الله مؤتابٌ وغادي أجرى " تق ف " مجرى علم حتى صار " تقف " كعلم كذلك أيضاً أجروا اللازم مجرى غير اللازم في قول الله سبحانه {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى} فأجرى النصب مجرى الرفع الذي لا تلزم فيه الحركة ومجرى الجزم الذي لا يلزم فيه الحرف أصلاً وكما حمل النصب على الجر في التثنية والجمع الذي على حد التثينة كذلك حمل الجر على النصب فيما لا ينصرف وكما شبهت الياء بالألف في قوله: كأن أيديهن بالقاع القَرِق وقوله: يا دار هند عفت إلا أثافيها كذلك حملت الألف على الياء في قوله - فيما أنشد أبو زيد -: إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضّاها ولا تملَّق وكما وضع الضمير المنفصل موضع المتصل في قوله: إليك حتى بلغت إياكا ومنه قول أمية: بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير فما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار وكما قلبت الواو ياء استحساناً لا عن قوة علة في نحو غديان وعشيان وأبيض لياح كذلك أيضاً قلبت الياء واواً في نحو الفتوى والرعوى والتقوى والبقوى والثنوى والشروى - وقد ذكر ذلك - وقولهم عوى الكلب عوة.
وكما أتبعوا الثاني الأول في نحو شد وفر وعض ومنذ كذلك أتبعوا الأول الثاني في نحو: اقتل اخرج ادخل وأشباه هذا كثير فلما رأى سيبويه العرب إذا شبهت شيئاً بشيء فحملته على حكمه عادت أيضاً فحملت الآخر على حكم صاحبه تثبيتاً لهما وتتميماً لمعنى الشبه بينهما حكم أيضاً لجر الوجه من قوله " هذا الحسن الوجه " أن يكون محمولاً على جر الرجل في قولهم " هذا الضارب الرجل " كما أجازوا أيضاً النصب في قولهم " هذا الحسن الوجهَ " حملاً له منهم على " هذا الضارب الرجل " ونظيره قولهم: يا أميمة ألا تراهم حذفوا الهاء فقالوا: أميم فلما أعادوا الهاء أقروا الفتحة بحالها اعتياداً للفتحة في الميم وإن كان الحذف فرعاً.
وكذلك قولهم " اجتمعت أهل اليمامة " أصله " اجتمع أهل اليمامة " ثم حذف المضاف فأنث الفعل فصار " اجتمعت اليمامة " ثم أعيد المحذوف فأقر التأنيث الذي هو الفرع بحاله فقيل اجتمعت أهل اليمامة " نعم " وأيد ذلك ما قدمنا ذكره: من عكسهم التشبيه وجعلهم فيه الأصول محمولة على ولما كان النحويون بالعرب لاحقين وعلى سمتهم آخذين وبألفاظهم متحلين ولمعانيهم وقصودهم آمين جاز لصاحب هذا العلم الذي جمع شعاعه وشرع أوضاعه ورسم أشكاله ووسم أغفاله وخلج أشطانه وبعج أحضانه وزم شوارده وأفاء فوارده أن يرى فيه نحواً مما رأوا ويحذوه على أمثلتهم التي حذوا وأن يعتقد في هذا الموضع نحواً مما اعتقدوا في أمثاله لا سيما والقياس إليه مصغ وله قابل وعنه غير متثاقل.
فاعرف إذاً ما نحن عليه للعرب مذهباً ولمن شرح لغاتها مضطرباً وأن سيبويه لاحق بهم وغير بعيد فيه عنهم.
ولذلك عندنا لم يتعقب هذا الموضع عليه أحد من أصحابه ولا غيرهم ولا أضافوه إلى ما نعوه عليه وإن كان بحمد الله ساقطاً عنه وحرىً بالاعتذار هم منه.
وأجاز سيبويه أيضاً نحو هذا وهو قوله " زيداً إذا يأتيني أضرب " فنصبه ب " أضرب " ونوى تقديمه حتى كأنه قال " زيداً أضرب إذا يأتيني " ألا ترى إلى نيته بما يكون جواباً ل " إذا " - وقد وقع في موقعه - أن يكون التقدير فيه تقديمه عن موضعه.
ومن غلبة الفروع للأصول إعرابهم في الآحاد بالحركات نحو زيدٌ وزيداً وزيدٍ وهو يقوم وإذا تجووزت رتبة الآحاد أعربوا بالحروف نحو الزيدان والزيدين والزيدون والعمرين وهما يقومان وهم ينطلقون.
فأما ما جاء في الواحد من ذلك نحو أخوك وأباك وهنيك فإن أبا بكر ذهب فيه إلى أن العرب قدمت منه هذا القدر توطئة لما أجمعوه من الإعراب في التثنية والجمع بالحروف.
وهذا أيضاً نحو آخر من حمل الأصل على الفرع ألا تراهم أعربوا بعض الآحاد بالحروف حملاً لهم على ذلك في التثنية والجمع.
فأما قولهم " أنت تفعلين " فإنهم إنما أعربوه بالحرف وإن كان في رتبة الآحاد - وهي الأول - من حيث كان قد صار بالتأنيث إلى حكم الفرعية ومعلوم أن الحرف أقوى من الحركة فقد ترى إلى علم إعراب الواحد أضعف لفظاً من إعراب ما فوقه فصار - لذلك - الأقوى كأنه الأصل والأضعف كأنه الفرع.
ومن ذلك حذفهم الأصل لشبهه عندهم بالفرع ألا تراهم لما حذفوا الحركات - ونحن نعلم أنها زوائد في نحو لم يذهب ولم ينطلق - تجاوزوا ذلك إلى أن حذفوا للجزم أيضاً الحروف الأصول فقالوا: لم يخش ولم ير ولم يغز.
ومن ذلك أيضاً أنهم حذفوا ألف مغزىً ومدعىً في الإضافة فأجازوا مغزِيّ ومرمِيّ ومَدعِيّ فحملوا الألف هنا - وهي لام - على الألف الزائدة في نحو حبلىّ وسكرىّ.
ومن ذلك حذفهم ياء تحية وإن كانت أصلاً حملاً لها على ياء شقية وإن كانت زائدة فلذلك قالوا تحويّ كما قالوا سقويّ وغنويّ في شقية وغنية.
وحذفوا أيضاً النون الأصلية في قوله: ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل كأنهما ملآن لم يتغيرا وقوله: أبلغ أبا دختنوس مألكةً غير الذي قد يقال مِلكذب كما حذفوا الزائدة في قوله: وحاتم الطائي وهاب المئى وقوله: ولا ذاكراً الله إلا قليلا ومن ذلك حملهم التثنية - وهي أقرب إلى الواحد - على الجمع وهو أنأى عنه ألا تراهم قلبوا همزة التأنيث فيها فقالوا: حمراوان وأربعاوان كما قلبوها فيه واواً فقالوا: حمراوات علماً وصحراوات وأربعاوات.
ومن ذلك حملهم الاسم - وهو الأصل - على الفعل - وهو الفرع - في باب ما لا ينصرف " نعم " وتجاوزوا بالاسم رتبة الفعل إلى أن شبهوه بما ورءاه - وهو الحرف - فبنوه نحو أمس وأين وكيف وكم وإذا.
وعلى ذلك ذهب بعضهم في ترك تصرف " ليس " إلى أنها ألحقت ب " ما " فيه كما ألحقت " ما " بها في العمل في اللغة الحجازية.
وكذلك قال أيضاً في " عسى ": إنها منعت التصرف لحملهم إياها على لعل.
فهذا ونحوه يدلك على قوة تداخل هذه اللغة وتلامحها واتصال أجزائها وتلاحقها وتناسب أوضاعها وأنها لم تقتعث اقتعاثاً ولا هيلت هيلاً وأن واضعها عني بها وأحسن جوارها وأمد بالإصابة والأصالة فيها.
باب في إصلاح اللفظ
اعلم أنه لما كانت الألفاظ للمعاني أزمة وعليها أدلة وإليها موصلة وعلى المراد منها محصلة عنيت العرب بها فأولتها صدراً صالحاً من تثقيفها وإصلاحها.
فمن ذلك قولهم: أما زيد فمنطلق ألا ترى أن تحرير هذا القول إذا صرحت بلفظ الشرط فيه صرت إلى أنك كأنك قلت: مهما يكن من شيء فزيد منطلق قتجد الفاء في جواب الشرط في صدر الجزأين مقدمة عليهما.
وأنت في قولك: أما زيد فمنطلق إنما تجد الفاء واسطة بين الجزأين ولا تقول: أما فزيد منطلق كما تقول فيما هو في معناه: مهما يكن من شيء فزيد منطلق.
وإنما فعل ذلك لإصلاح اللفظ.
ووجه إصلاحه أن هذه الفاء وإن كانت جواباً ولم تكن عاطفة فإنها على مذهب لفظ العاطفة وبصورتها فلو قالوا: أما فزيد منطلق كما يقولون: مهما يكن من شيء فزيد منطلق لوقعت الفاء الجارية مجرى فاء العطف بعدها اسم وليس قبلها اسم إنما قبلها في اللفظ حرف وهو أما.
فتنكبوا ذلك لما ذكرنا ووسطوها بين الحرفين ليكون قبلها اسم وبعدها آخر فتأتي على صورة العاطفة فقالوا: أما زيد فمنطلق كما تأتي عاطفة بين الاسمين في نحو قام زيد فعمرو.
وهذا تفسير أبي علي رحمه الله تعالى.
وهو الصواب.
ومثله امتناعهم أن يقولوا: انتظرتك وطلوع الشمس أي مع طلوع الشمس فينصبوه على أنه مفعول معه كما ينصبون نحو قمت وزيداً أي مع زيد.
قال أبو الحسن: وإنما ذلك لأن الواو التي بمعنى مع لا تستعمل إلا في الموضع الذي لو استعملت فيه عاطفة لجاز.
ولو قلت: انتظرتك وطلوع الشمس أي و " انتظرتك طلوع الشمس " لم يجز.
أفلا ترى إلى إجرائهم الواو غير العاطفة في هذا مجرى العاطفة فكذلك أيضاً تجري الفاء غير العاطفة في نحو أما زيد فمنطلق مجرى العاطفة فلا يؤتى بعدها بما لا شبيه له في جواز العطف عليه قبلها.
ومن ذلك قولهم في جمع تمرة وبسرة ونحو ذلك: تمرات وبسرات فكرهوا إقرار التاء تناكراً لاجتماع علامتي تأنيث في لفظ اسم واحد فحذفت وهي في النية - مرادة البتة - لا لشيء إلا لإصلاح اللفظ لأنها في المعنى مقدرة منوية لا غير ألا تراك إذا قلت " تمرات " لم يعترض شك في أن الواحدة منها تمرة وهذا واضح.
" والعناية " إذاً في الحذف إنما هي بإصلاح اللفظ إذ المعنى ناطق بالتاء مقتض لها حاكم بموضعها.
ومن ذلك قولهم: إن زيداً لقائم فهذه لام الابتداء وموضعها أول الجملة وصدرها لا آخرها وعجزها فتقديرها أول: لَئنّ زيداً منطلق فلما كره تلاقي حرفين لمعنى واحد - وهو التوكيد - أخرت اللام إلى الخبر فصار إن زيداً لمنطلق.
فإن قيل: هلا أخرت " إن " وقدمت اللام قيل: لفساد ذلك من أوجه: أحدها أن اللام لو تقدمت وتأخرت " إن " لم يجز أن تنصب " إن " اسمها الذي من عادتها نصبه من قبل أن لام الابتداء إذا لقيت الاسم المبتدأ قوت سببه وحمت من العوامل جانبه فكان يلزمك أن ترفعه فتقول: لَزيدٌ إنَّ قائم ولم يكن إلى نصب " زيد " - وفيه لام الابتداء - سبيل.
ومنها أنك لو تكلفت نصب زيد - وقد أخرت عنه " إن " - لأعملت " إن " فيما قبلها وإن لا تعمل أبداً إلا فيما بعدها.
ومنها أن " إن " عاملة واللام غير عاملة والمبتدأ لا يكون إلا اسماً وخبره قد يكون جملة وفعلاً وظرفاً وحرفاً فجعلت اللام فيه لأنها غير عاملة ومنعت منه " إن " لأنها لا تعمل في الفعل ولا في الجملة كلها النصب إنما تعمله في أحد جزأيها ولا تعمل أيضاً في الظرف ولا في حرف الجر.
ويدل على أن موضع اللام في خبر " إن " أول الجملة قبل " إن " أن العرب لما جفا عليها اجتماع هذين الحرفين قبلوا الهمزة هاء ليزول لفظ " إن " فيزول أيضاً ما كان مستكرهاً من ذلك فقالوا " لهِنّك قائم " أي لئنك قائم.
وعليه قوله - فيما رويناه عن محمد بن سلمة عن أبي العباس -: فإن قلت: فما تصنع بقول الآخر: ثمانين حولاً لا أرى منك راحة لهنك في الدنيا لباقية العمر وما هاتان اللامان قيل: أما الأولى فلام الابتداء على ما تقدم.
وأما الثانية في قوله: " لباقية العمر " فزائدة كزيادتها في قراءة سعيد بن جبير {إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ} ونحوه ما رويناه عن قطرب من قول الشاعر: ألم تكن حلفت بالله العلي أن مطاياك لمن خير المطي بفتح أن في الآية وفي البيت.
وروينا عن أحمد بن يحيى - وأنشدناه أبو علي رحمه الله تعالى -: مروا عجالاً وقالوا: كيف صاحبكم! قال الذي سألوا: أمسى لمجهودا فزاد اللام.
وكذلك اللام عندنا في لعل زائدة ألا ترى أن العرب قد تحذفها قال: عل صروف الدهر أو دولاتها يدلننا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها وكذلك ما أنشده ابن الأعرابي من قول الراجز: ثمت يغدو لكأن لم يشعر رخو الإزار زمح التبختر لهنك في الدنيا لباقية العمر زائدة.
فإن قلت: فلم لا تكون الأولى هي الزائدة والأخرى غير زائدة قيل: يفسد ذلك من جهتين: إحداهما أنها قد ثبتت في قوله " لهنك من برق علي كريم " هي لام الابتداء لا زائدة فكذلك ينبغي أن تكون في هذا الموضع أيضاً هي لام الابتداء.
والأخرى أنك لو جعلت الأولى هي الزائدة لكنت قد قدمت الحرف الزائد والحروف إنما تزاد لضرب من ضروب الاتساع فإذا كانت للاتساع كان آخر الكلام أولى بها من أوله ألا تراك لا تزيد " كان " مبتدأة وإنما تزيدها حشواً أو آخراً وقد تقدم ذكر ذلك.
فأما قول من قال: إن قولهم " لهنك " إن أصله " لله إنك " فقد تقدم ذكرنا ذلك مع ما عليه فيه في موضع آخر وعلى أن أبا علي قد كان قواه بأَخَرةٍ وفيه تعسف.
ومن إصلاح اللفظ قولهم: كأن زيداً عمرو.
اعلم أن أصل هذا الكلام: زيد كعمرو ثم أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه " إن " فقالوا: إن زيداً كعمرو ثم إنهم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية به وإعلاماً أن عقد الكلام عليه فلما تقدمت الكاف وهي جارّة لم يجز أن تباشر " إن " لأنها ينقطع عنها ما قبلها من العوامل فوجب لذلك فتحها فقالوا: كأن ومن ذلك أيضاً قولهم: لك مال وعليك دين فالمال والدين هنا مبتدآن وما قبلهما خبر عنهما إلا أنك لو رمت تقديمهما إلى المكان المقدر لهما لم يجز لقبح الابتداء بالنكرة في الواجب فلما جفا ذلك في اللفظ أخروا المبتدأ وقدموا الخبر وكان ذلك سهلاً عليهم ومصلحاً لما فسد عندهم.
وإنما كان تأخره مستحسناً من قبل أنه لما تأخر وقع موقع الخبر ومن شرط الخبر أن يكون نكرة فلذلك صلح به اللفظ وإن كنا قد أحطنا علماً بأنه في المعنى مبتدأ.
فأما من رفع الاسم في نحو هذا بالظرفية فقد كفي مئونة هذا الاعتذار لأنه ليس مبتدأ عنده.
فإن قلت: فقد حكى عن العرب " أمتٌ في حجر لا فيك " وقولهم: " شرٌ أهرَّ ذا ناب " وقولهم: {سَلَامٌ عَلَيْكَ} قال الله سبحانه وتعالى: {سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي} وقال: {وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} ونحو ذلك.
والمبتدأ في جميع هذا نكرة مقدمة.
قيل: أما قوله سلام عليك وويل له وأمت في حجر لا فيك فإنه جاز لأنه ليس في المعنى خبراً إنما هو دعاء ومسألة أي ليسلم الله عليك وليلزمه الويل وليكن الأمت في الحجارة لا فيك.
والأمت: الانخفاض والارتفاع والاختلاف قال الله عز وجل: {لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا} أي اختلافاً.
ومعناه: أبقاك الله بعد فناء الحجارة وهي مما توصف بالخلود والبقاء ألا تراه كيف قال: وقال: بقاء الوحي في الصم الصلاب وأما قولهم " شر أهر ذا ناب " فإنما جاز الابتداء فيه بالنكرة من حيث كان الكلام عائداً إلى معنى النفي أي ما أهر ذا ناب إلا شر وإنما كان المعنى هذا لأن الخبرية عليه أقوى ألا ترى أنك لو قلت: أهر ذا ناب شر لكنت على طرف من الإخبار غير مؤكد فإذا قلت: ما أهر ذا ناب إلا شر كان ذلك أوكد ألا ترى أن قولك: ما قام إلا زيد أوكد من قولك: قام زيد.
وإنما احتيج إلى التوكيد في هذا الموضع من حيث كان أمراً عانياً مهماً.
وذلك أن قائل هذا القول سمع هرير كلب فأضاف منه وأشفق لاستماعه أن يكون لطارق شر فقال: شر أهر ذا ناب أي ما أهر ذا ناب إلا شر تعظيماً عند نفسه أو عند مستمعه.
وليس هذا في نفسه كأن يطرق بابه ضيف أو يلم به مسترشد.
" فلما عناه وأهمه وكد الإخبار عنه " وأخرج القول مخرج الإغلاظ به والتأهيب لما دعا إليه.
ومن ذلك امتناعهم من الإلحاق بالألف إلا أن تقع آخراً نحو أرطىً ومعزىً وحبنطىً وسرندىً وزبعرىً وصلخدىً وذلك أنها إذا وقعت طرفاً وقعت موقع حرف متحرك فدل ذلك على قوتها عندهم وإذا وقعت حشواً وقعت موقع الساكن فضعفت لذلك فلم تقو فيعلم بذلك إلحاقها بما هي على سمت متحركه ألا ترى أنك لو ألحقت بها ثانية فقلت: خاتم ملحق بجعفر لكانت مقابلة لعينه وهي ساكنة فاحتاطوا للفظ بأن قابلوا بالألف فيه الحرف المتحرك ليكون أقوى لها وأدل على شدة تمكنها وليعلم بتنوينها أيضاً وكون ما هي في على وزن أصل من الأصول له أنها للإلحاق به.
وليست كذلك ألف قبعثرى وضبغطرى لأنها وإن كانت طرفاً ومنونة فإن المثال الذي فيه لا مصعد للأصول إليه فيلحق هذا به لأنه لا أصل لها سداسياً فإنما ألف قبعثرى قسم من الألفات الزوائد في أواخر الكلم ثالث لا للتأنيث ولا للإلحاق.
فاعرف ذلك.
ومن ذلك أنهم لما أجمعوا الزيادة في آخر بنات الخمسة - كما زادوا في آخر بنات الأربعة - خصوا بالزيادة فيه الألف استخفافاً لها ورغبة فيها هناك دون أختيها: الياء والواو.
وذلك أن بنات الخمسة لطولها لا ينتهي إلى آخرها إلا وقد ملت فلما تحملوا الزيادة في آخرها طلبوا أخف الثلاث - وهي الألف - فخصوها بها وجعلوا الواو والياء حشواً في نحو عضرفوط وجعفليق لأنهم لو جاءوا بهما طرفاً وسداسيين مع ثقلهما لظهرت الكلفة في تجشمهما وكدت في احتمال النطق بهما كل ذلك لإصلاح اللفظ.
ومن ذلك باب الادغام في المتقارب نحو ود في وتد ومن الناس " ميقول " في " من يقول " ومنه ومن ذلك تسكينهم لام الفعل إذا اتصل بها علم الضمير المرفوع نحو ضربت وضربن وضربنا.
وذلك أنهم أجروا الفاعل هنا مجرى جزء من الفعل فكره اجتماع الحركات " الذي لا يوجد " في الواحد.
فأسكنوا اللام إصلاحاً للفظ فقالوا: ضربت ودخلنا وخرجتم.
نعم وقد كان يجتمع فيه أيضاً خمس متحركات نحو: خرجتما فالإسكان إذاً أشد وجوباً.
وطريق إصلاح اللفظ كثير واسع فتفطن له.
ومن ذلك أنهم لما أرادوا أن يصفوا المعرفة بالجملة كما وصفوا بها النكرة " ولم " يجز أن يجروها عليها لكونها نكرة أصلحوا اللفظ بإدخال " الذي " لتباشر بلفظ حرف التعريف المعرفة فقالوا: مررت بزيد الذي قام أخوه ونحوه.
باب في تلاقي اللغة
هذا موضع لم أسمع فيه لأحد شيئاً إلا لأبي علي رحمه الله.
وذلك أنه كان يقول في باب أجمع وجمعاء وما يتبع ذلك من أكتع وكتعاء وبقيته: إن هذا اتفاق وتوارد وقع في اللغة على غير ما كان في وزنه منها.
قال: لأن باب أفعل وفعلاء إنما هو للصفات وجميعها تجيء على هذا الوضع نكرات نحو أحمر وحمراء وأصفر وصفراء وأسود وسوداء وأبلق وبلقاء وأخرق وخرقاء.
هذا كله صفات نكرات فأما أجمع وجمعاء فاسمان معرفتان وليسا بصفتين فإنما ذلك اتفاق وقع بين هذه الكلم المؤكد بها.
قال: ومثله ليلة طلقة وليال طوالق قال: فليس طوالق تكسير طلقة لأن فعلة لا تكسر على فواعل وإنما طوالق جمع طالقة وقعت موقع جمع طلقة.
وهذا الذي قاله وجه صحيح.
وأبين منه عندي وأوضح قولهم في العلم: سلمان وسلمى فليس سلمان إذاً من سلمى كسكران من سكرى.
ألا ترى أن فعلان الذي يقاوده فعلى إنما بابه الصفة كغضبان وغضبى وعطشان وعطشى وخزيان وخزيا وصديان وصديا وليس سلمان ولا سلمى بصفتين ولا نكرتين وإنما سلمان من سلمى كقحطان من ليلى غير أنهما كانا من لفظ واحد فتلاقيا في عرض اللغة من غير قصد لجمعهما ولا إيثار لتقاودهما.
ألا تراك لا تقول: هذا رجل سلمان ولا امرأة سلمى كما تقول: هذا سكران وهذه سكرى وهذا غضبان وهذه غضبى.
وكذلك لو جاء في العلم " ليلان " لكان ليلان من ليلى كسلمان من سلمى.
وكذلك لو وجد في العلم " قحطى " لكان من قحطان كسلمى من سلمان.
وأقرب إلى ذلك من سلمان وسلمى قولهم في العلم: عدوان والعدوى مصدر أعداه الجرب ونحوه.
ومن ذلك قولهم: " أسعد " لبطن من العرب ليس هذا من سعدى كالأكبر من الكبرى والأصغر من الصغرى.
وذلك أن هذا إنما هو تقاود الصفة وأنت لا تقول: مررت بالمرأة السعدى ولا بالرجل الأسعد.
فينبغي - على هذا - أن يكون أسعد من سعدى كأسلم من بشرى.
وذهب بعضهم إلى أن أسعد تذكير سعدى ولو كان كذلك لكان حرىً أن يجيء به سماع ولم نسمعهم قط وصفوا بسعدى وإنما هذا تلاق وقع بين هذين الحرفين المتفقي اللفظ كما يقع هذان المثالان في المختلفية نحو أسلم وبشرى.
وكذلك أيهم ويهماء ليسا كأدهم ودهماء لأمرين: أحدهما أن الأيهم الجمل الهائج " أو السيل " واليهماء الفلاة فهما مختلفان.
والآخر أن أيهم لو كان مذكر يهماء لوجب أن يأتي فيهما " يهم " كدهم ولم نسمع ذلك فعلمت بذلك أن هذا تلاق بين اللغة وأن أيهم لا مؤنث له ويهماء لا مذكر لها.
ومن التلاقي قولهم في العلم: أسلم وسلمى.
وليس هذا كالأكبر والكبرى لأنه ليس وصفاً.
فتأمل أمثاله في اللغة.
ومثله شتان وشتى إنما هما كسرعان وسكرى.
وإنما وضعت من هذا الحديث رسماً لتتنبه على ما يجيء من مثله فتعلم به أنه توارد وتلاق وقع في أثناء هذه اللغة عن غير قصد له ولا مراسلة بين بعضه وبعض.
وليس من هذا الباب سعد وسعدة من قبل أن هاتين صفتان مسوقتان على منهاج واستمرار.
فسعد من سعدة كجلد من جلدة وندب من ندبة.
ألا تراك تقول: هذا يوم سعد وهذه ليلة سعدة كما تقول: هذا شعر جعد وهذه جمة جعدة.
فاعرف ذلك إلى ما يليه وقسه بما قررته عليه بإذن الله تعالى.
باب في هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أو لا
سألت أبا علي رحمه الله عن هذا فقال: كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم.
فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا وما حظرته عليهم حظرته علينا.
وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتنا وما كان من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندنا.
وما بين ذلك بين ذلك.
فإن قيل: هلا لم يجز لنا متابعتهم على الضرورة من حيث كان القوم لا يترسلون في عمل أشعارهم ترسل المولدين ولا يتأنون فيه ولا يتلومون على حوكه وعمله وإنما كان أكثره ارتجالاً قصيداً كان أو رجزاً أو رملاً.
فضرورتهم إذاً أقوى من ضرورة المحدثين.
فعلى هذا ينبغي أن يكون عذرهم فيه أوسع وعذر المولدين أضيق.
قيل: يسقط هذا من أوجه: أحدها أنه ليس جميع الشعر القديم مرتجلاً بل قد كان يعرض لهم فيه من الصبر عليه والملاطفة له والتلوم على رياضته وإحكام صنعته نحو من مما يعرض لكثير من المولدين.
ألا ترى إلى ما يروى عن زهير: من أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين فكانت تسمى حوليات زهير لأنه كان يحوك القصيدة في سنة.
والحكاية في ذلك عن ابن أبي حفصة أنه قال: كنت أعمل القصيدة في أربعة أشهر وأحككها في أربعة أشهر وأعرضها في أربعة أشهر ثم أخرج بها إلى الناس.
فقيل له: فهذا هو الحولي المنقح.
وكذلك الحكاية عن ذي الرمة: أنه قال: لما قال: بيضاء في نعج صفراء في برج أجبل حولاً لا يدري ما يقول إلى أن مرت به صينية فضية قد أشربت ذهباً فقال: كأنها فضة قد مسها ذهب وقد وردت أيضاً بذلك أشعارهم قال ذو الرمة: أجنبه المساند والمحالا ألا تراه كيف اعترف بتأنيه فيه وصنعته إياه.
وقال عدي بن الرقاع العاملي: وقصيدة قد بت أجمع بينها حتى أقوم ميلها وسنادها نظر المثقف في كعوب قناته حتى يقيم ثقافه منآدها وقال سويد بن كراع: وإنما يبيت عليها لخلوه بها ومراجعته النظر فيها.
وقال: أعددت للحرب التي أعنى بها قوافياً لم أعي باجتلابها حتى إذا أذللت من صعابها واستوسقت لي صحت في أعقابها فهذا - كما ترى - مزاولة ومطالبة واغتصاب لها ومعاناة كلفة بها.
ومن ذلك الحكاية عن الكميت وقد افتتح قصيدته التي أولها: ألا حييت عنا يا مدينا ثم أقام برهة لا يدري بماذا يعجز على هذا الصدر إلى أن دخل حماماً وسمع إنساناً دخله فسلم على آخر فيه فأنكر ذلك عليه فانتصر بعض الحاضرين له فقال: وهل بأس بقول المسلّمين فاهتبلها الكميت فقال: وهل بأس بقول مسلّمينا ومثل هذا أشعارهم الدالة على الاهتمام بها والتعب في إحكامها كثير معروف.
فهذا وجه.
وثان: أن من المحدثين أيضاً من يسرع العمل ولا يعتاقه بطء ولا يستوقف فكره ولا يتعتع خاطره.
فمن ذلك ما حدثني به من شاهد المتنبي وقد حضر عند أبي علي الأوارجي وقد وصف له طرداً كان فيه وأراده على وصفه فأخذ الكاغد والدواة واستند إلى جانب المجلس ومنزل ليس لنا بمنزل وهي طويلة مشهورة في شعره.
وحضرت أنا مجلساً لبعض الرؤساء ليلة وقد جرى ذكر السرعة وتقدم البديهة وهنالك حدث من غير شعراء بغداد فتكفل أن يعمل في ليلته تلك مائتي بيت في ثلاث قصائد على أوزان اخترناها عليه ومعان حددناها له فلما كان الغد في آخر النهار أنشدنا القصائد الثلاث على الشرط والاقتراح وقد صنعها وظاهر إحكامها وأكثر من البديع المستحسن فيها.
وثالث: كثرة ما ورد في أشعار المحدثين من الضرورات كقصر الممدود وصرف ما لا ينصرف وتذكير المؤنث ونحوه.
وقد حضر ذلك وشاهده جلة أصحابنا من أبي عمرو إلى آخر وقت والشعراء من بشار إلى فلان وفلان ولم نر أحداً من هؤلاء العلماء أنكر على أحد من المولدين ما ورد في شعره من هذه الضرورات التي ذكرناها وما كان نحوها فدل ذلك على رضاهم به وترك تناكرهم إياه.
فإن قلت: فقد عيب بعضهم كأبي نواس وغيره في أحرف أخذت عليهم قيل: هذا كما عيب الفرزدق وغيره في أشياء استنكرها أصحابنا.
فإذا جاز عيب أرباب اللغة وفصحاء شعرائنا كان مثل ذلك في أشعار المولدين أحرى بالجواز.
فإذا كانوا قد عابوا بعض ما جاء به القدماء في غير الشعر بل في حال السعة وموقف الدعة كان يرد من المولدين في الشعر - وهو موقف فسحة وعذر - أولى بجواز مثله.
فمن ذلك استنكارهم همز مصائب وقالوا: منارة ومنائر ومزادة ومزائد فهمزوا ذلك في الشعر وغيره وعليه قال الطرماح: مزائد خرقاء اليدين مسيفة يخب بها مستخلف غير آئن وإنما الصواب مزاود ومصاوب ومناور قال: يصاحب الشيطان من يصاحبه فهو أذيٌ جمةٌ مصاوبه ومن ذلك قولهم في غير الضرورة: ضبب البلد: كثرة ضبابه.
وألل السقاء: تغيرت ريحه.
ولححت عينه: التصقت ومششت الدابة.
وقالوا: إن الفكاهة مقودة إلى الأذى.
وقرأ بعضهم {لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّه خَيْرٌ} وقالوا: كثرة الشراب مبولة وكثرة الأكل منومة وهذا شيء مطيبة للنفس وهذا طريق مهيع إلى غير ذلك مما جاء في السعة ومع غير الضرورة.
وإنما صوابه: لحت عينه وضب البلد وألَّ السقاء ومشَّت الدابة ومقادة إلى الأذى ومثابة ومبالة ومنامة ومطابة ومهاع.
فإذا جاز هذا للعرب عن غير حصر ولا ضرورة قول كان استعمال الضرورة في الشعر فأما ما يأتي عن العرب لحناً فلا نعذر في مثله مولداً.
فمن ذلك بيت الكتاب: وما مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمه حي أبوه يقاربه ومراده فيه معروف وهو فيه غير معذور.
ومثله في الفصل قول الآخر - فيما أنشده ابن الأعرابي -: فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفراً رسومها قلما أراد: فأصبحت بعد بهجتها قفراً كأن قلماً خط رسومها فأوقع من الفصل والتقديم والتأخير ما تراه.
وأنشدنا أيضاً: فقد والشك بين لي عناءٌ بوشك فراقهم صرد يصيح أراد: فقد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم والشك عناء.
فقد ترى إلى ما فيه من الفصول التي لا وجه لها ولا لشيء منها.
وأغرب من ذلك وأفحش وأذهب في القبح قول الآخر: لها مقلتا حوراء طل خميلة من الوحش ما تنفك ترعى عرارها أراد: لها مقلتا حوراء من الوحش ما تنفك ترعى خميلة طل عرارها.
فمثل هذا لا نجيزه للعربي أصلاً فضلاً عن أن نتخذه للمولدين رسماً.
وأما قول الآخر: معاوى لم ترع الأمانة فارعها وكن حافظاً لله والدين شاكر فحسن جميل وذلك أن " شاكر " هذه قبيلة وتقديره: معاوى لم ترع الأمانة شاكر فارعها أنت وكن حافظاً لله والدين.
فأكثر ما في هذا الاعتراض بين الفعل والفاعل والاعتراض للتسديد قد جاء بين الفعل والفاعل وبين المبتدأ والخبر وبين الموصول والصلة وغير ذلك مجيئاً كثيراً في القرآن وفصيح الكلام.
ومثله من الاعتراض بين الفعل والفاعل قوله: وقد أدركتني - والحوادث جمة - أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل والاعتراض في ههذ اللغة كثير حسن.
ونحن نفرد له باباً يلي هذا الباب.
بإذن الله سبحانه وتعالى.
ومن طريف الضرورات وغريبها ووحشيها وعجيبها ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: هل تعرف الدار ببيدا إنه دار لخود قد تعفت إنَّه فانهلت العينان تسفحنه مثل الجمان جال في سلكنَّه وهذه الأبيات قد شرحها أبو علي رحمه الله في البغداديات فلا وجه لإعادة ذلك هنا.
فإذا آثرت معرفة ما فيها فالتمسه منها.
وكذلك ما أنشده أيضاً أبو زيد للزفيان السعدي: يا إبلي ما ذامه فتأبَيَه ماء رواء ونصيٌ حولَيَه هذا بأفواهك حتى تأبَيَه حتى تروحي أصلاً تباريه تباري العانة فوق الزازيه هكذا روينا عن أبي زيد وأما الكوفيون فرووه على خلاف هذا يقولون: فتأبَيْه ونصي حولَيْه وحتى تأبَيْه وفوق الزازيْه.
فينشدونه من السريع لا من الرجز كما أنشده أبو زيد.
وقد ذكرت هذه الأبيات بما يجب فيها في كتابي " في النوادر الممتعة " ومقداره ألف ورقة.
وفيه من كلتا الروايتين صنعة طريفة.
وأخبرنا محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى - أحسبه عن ابن الأعرابي - يقول الشاعر: وما كنت أخشى الدهر إحلاس مسلم من الناس ذنباً جاءه وهو مسلما وقال في تفسيره معناه: ما كنت أخشى الدهر إحلاس مسلم مسلماً ذنباً جاءه وهو ولو وكد الضمير في جاء فقال: جاءه هو وهو لكان أحسن.
وغير التوكيد أيضاً جائز.
وأبيات الإعراب كثيرة وليس على ذكرها وضعنا هذا الباب.
ولكن اعلم أن البيت إذا تجاذبه أمران: زيغ الإعراب وقبح الزحاف فإن الجفاة الفصحاء لا يحفلون بقبح الزحاف إذا أدى إلى صحة الإعراب.
كذلك قال أبو عثمان وهو كما ذكر.
وإذا كان الأمر كذلك فلو قال في قوله: ألم يأتيك والأنباء تنمي " ألم يأتك والأنباء تنمي " لكان أقوى قياساً على ما رتبه أبو عثمان ألا ترى أن الجزء كان يصير منقوصا لأنه يرجع إلى مفاعيل: ألم يأت مفاعيل.
وكذلك بيت الأخطل: كلمع أيدي مثاكيل مسلبة يندبن ضرس بنات الدهر والخطب أقوى القياسين على ما مضى أن ينشد " مثاكيل " غير مصروف لأنه يصير الجزء فيه من مستفعلن إلى مفتعلن وهو مطوي والذي روى " مثاكيل " بالصرف.
وكذلك بقية هذا.
فإن كان ترك زيغ الإعراب يكسر البيت كسراً لا يزاحفه زحافاً فإنه لا بد من ضعف زيغ الإعراب واحتمال ضرورته وذلك كقوله: سماء الإله فوق سبع سمائيا فهذا لا بد من التزام ضرورته لأنه لو قال: سمايا لصار من الضرب الثاني إلى الثالث وإنما مبنى هذا الشعر على الضرب الثاني لا الثالث.
وليس كذلك قوله: لأنه لو قال: معار لما كسر الوزن لأنه يصير من مفاعلتن إلى مفاعيلن وهو العصب.
لكن مما لا بد من التزام ضرورته مخافة كسر وزنه قول الآخر: خريع دوادي في ملعب تأزر طوراً وترخي الإزارا فهذا لا بد من تصحيح معتله ألا ترى أنه لو أعل اللام وحذفها فقال دواد لكسر البيت البتة.
فاعرف إذاً حال ضعف الإعراب الذي لا بد من التزامه مخافة كسر البيت من الزحاف الذي يرتكبه الجفاة الفصحاء إذا أمنوا كسر البيت ويدعه من حافظ على صحة الوزن من غير زحاف وهو كثير.
فإن أمنت كسر البيت اجتنبت ضعف الإعراب وإن أشفقت من كسرة ألبتة دخلت تحت كسر الإعراب.
باب في الاعتراض
اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جاء في القرآن وفصيح الشعر ومنثور الكلام.
وهو جار عند العرب مجرى التأكيد فلذلك لا يشنع عليهم ولا يستنكر عندهم أن يعترض به بين الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغيره إلا شاذاً أو متأولاً.
قال الله سبحانه وتعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} فهذا فيه اعتراضان: أحدهما قوله {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} لأنه اعترض به بين القسم الذي هو قوله {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} وبين جوابه الذي هو قوله {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} وفي نفس هذا الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف الذي هو " قسم " وبين صفته التي هي " عظيم " وهو قوله " لو تعلمون ".
فذانك اعتراضان كما ترى.
ولو جاء الكلام غير معترض فيه لوجب أن يكون: فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم وإنه لقسم {لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ}.
ومن ذلك قول امريء القيس: ألا هل أتاها - والحوادث جمةٌ - بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا ألا هل أتاها والحوادث كالحصى وأنشدنا أبو علي: وقد أدركتني - والحوادث جمة - أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل فهذا كله اعتراض بين الفعل وفاعله.
وأنشدنا أيضاً: ذاك الذي - وأبيك - تعرف مالك والحق يدفع ترهات الباطل فقوله: " وأبيك " اعتراض بين الموصول والصلة.
وروينا لعبيد الله بن الحر: تعلم ولو كاتمته الناس أنني عليك - ولم أظلم - بذلك عاتب فقوله: " ولو كاتمته الناس " اعتراض بين الفعل ومفعوله وقوله: " ولم أظلم بذلك " اعتراض بين اسم أن وخبرها.
ومن ذلك قول أبي النجم - أنشدناه -: وبدلت - والدهر ذو تبدل - هيفاً دبوراً بالصبا والشمأل فقوله: " والدهر ذو تبدل " اعتراض بين المفعول الأول والثاني.
ومن الاعتراض قوله: ألم يأتك - والأنباء تنمي - بما لاقت لبون بني زياد فقوله: " والأنباء تنمي " اعتراض بين الفعل وفاعله.
وهذا أحسن مأخذاً في الشعر من أن يكون في " يأتيك " ضمير من متقدم مذكور.
فأما ما أنشده أبو علي من قول الشاعر: أتنسى - لا هداك الله - ليلى وعهد شبابها الحسن الجميل! كأن - وقد أتى حول جديد - أثافيها حمامات مثول فإنه لا اعتراض فيه.
وذلك أن الاعتراض لا موضع له من الإعراب ولا يعمل فيه شيء من الكلام المعترض به بين بعضه وبعض على ما تقدم.
فأما قوله: " وقد أتى حول جديد " فذو موضع من الإعراب وموضعه النصب بما في " كأن " من معنى التشبيه ألا ترى أن معناه: أشبهت وقد أتى حول جديد حمامات مثولاً أو أشبهها وقد مضى حول جديد بحمامات مثول أي أشبهها في هذا الوقت وعلى هذه الحال بكذا.
وأنشدنا: أراني - ولا كفران لله أية لنفسي - لقد طالبت غير منيل ففي هذا اعتراضان: أحدهما - " ولا كفران لله ".
والآخر - قوله: " أية " أي أوَيت لنفسي أيَّة معناه رحمتها ورققت لها.
فقوله: أويت لها لا موضع له من الإعراب.
وسألنا الشجري أبا عبد الله يوماً عن فرس كانت له فقال: هي بالبادية.
قلنا لم قال: إنها وجية فأنا آوي لها أي أرحمها وأرق لها.
وكذلك قول الآخر: أراني ولا كفران لله إنما أواخي من الأقوام كل بخيل ومن الاعتراض قولهم: زيد - ولا أقول إلا حقاً - كريم.
وعلى ذلك مسئلة الكتاب: إنه - المسكين - أحمق ألا ترى أن تقديره: إنه أحمق وقوله " المسكين " أي هو المسكين وذلك اعتراض بين اسم إن وخبرها.
ومن ذلك مسئلته: " لا أخا - فاعلم - لك ".
فقوله: " فاعلم " اعتراض بين المضاف والمضاف إليه كذا الظاهر.
وأجاز أبو علي رحمه الله أن يكون " لك " خبراً ويكون " أخا " اسماً مقصوراً تاماً غير مضاف كقولك: لا عصا لك.
ويدل على صحة هذا القول أنهم قد كسروه على أفعال وفاؤه مفتوحة فهو إذاً فعل وذلك قولهم: أخ وآخاء فيما حكاه يونس.
وقال بعض آل المهلب: وجدتم بنيكم دوننا إذ نسبتم وأي بني الآخاء تنبو مناسبه! فغير منكر أن يخرج واحدها أصله كما خرج واحد الآباء على أصله وذلك قولهم: هذا أباً ورأيت أباً ومررت بأباً.
وروينا عن محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال: يقال هذا أبوك وهذا أباك وهذا أبُك فمن قال: هذا أبوك أو أباك فتثنيته أبوان ومن قال هذا أبك فتثنيته أبان وأبوان.
وأنشد: سوى أبك الأدنى وإن محمداً على كل عال يابن عم محمد وأنشد أبو علي عن أبي الحسن: تقول ابنتي لما رأتني شاحباً كأنك فينا يا أبات غريب قال: فهذا تأنيث أبا وإذا كان كذلك جاز جوازاً حسناً أن يكون قولهم: لا أبا لك " أبا " منه اسم مقصور كما كان ذلك في " أخالك " ويحسنه أنك إذا حملت الكلام عليه جعلت له خبراً ولم يكن في الكلام فصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر غير أنه يؤنس بمعنى إرادة الإضافة قول الفرزدق: ظلمت ولكن لا يدى لك بالظلم فلهذا جوزناها جميعاً.
وروينا لمعن بن أوس: وفيهن - والأيام يعثرن بالفتى - نوادب لا يمللنه ونوائح ففصل بقوله: " والأيام يعثرن بالفتى " بين المبتدأ وخبره.
وأنشدنا: وسألته عن بيت كثير: وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلت فأجاز أن يكون قوله: " وتهيامي بعزة " جملة من مبتدأ وخبر اعترض بها بين اسم إن وخبرها الذي هو قوله: لكالمرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلت فقلت له: أيجوز أن يكون " وتهيامي " بعزة قسماً فأجاز ذلك ولم يدفعه.
وقال الله عز وجل: " هذا فليذوقوه حميم وغساق ".
فقوله تعالى: " فليذوقوه " اعتراض بين المبتدأ وخبره.
وقال رؤبة: إني وأسطار سطرن سطرا لقائل يا نصر نصرٌ نصرا فاعترض بالقسم بين اسم إن وخبرها.
والاعتراض في شعر العرب ومنثورها كثير وحسن ودال على فصاحة المتكلم وقوة نفسه وامتداد نفسه وقد رأيته في أشعار المحدثين وهو في شعر إبراهيم بن المهدي أكثر منه في شعر غيره من المولدين.
باب في التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين
هذا في كلام العرب كثير فاش والقياس له قابل مسوغ.
فمن ذلك قولهم: مررت بزيد وما كان نحوه مما يلحق من حروف الجر معونة لتعدي الفعل.
فمن وجه يعتقد في الباء أنها بعض الفعل من حيث كانت معدية وموصلة له.
كما أن همزة النقل في " أفعلت " وتكرير العين في " فعلت " يأتيان لنقل الفعل وتعديته نحو قام وأقمته وقومته وسار وأسرته وسيرته.
فلما كان حرف الجر الموصل للفعل معاقباً لأحد شيئين كل واحد منهما مصوغ في نفس المثال جرى مجراهما في كونه جزءاً من الفعل أو كالجزء منه.
فهذا وجه اعتداده كبعض الفعل.
وأما وجه اعتداده كجزء من الاسم فمن حيث كان مع ما جره في موضع نصب وهذا يقضي له بكونه جزءاً مما بعده أو كالجزء منه ألا تراك تعطف على مجموعهما بالنصب كما تعطف على الجزء الواحد في نحو قولك: ضربت زيداً وعمراً وذلك قولك: مررت بزيد وعمراً ورغبت فيك وجعفراً ونظرت إليك وسعيداً أفلا ترى إلى حرف الجر الموصل للفعل كيف ووجه جوازه من قبل القياس أنك إنما تستنكر اجتماع تقديرين مختلفين لمعنيين متفقين وذلك كأن تروم أن تدل على قوة اتصال حرف الجر بالفعل فتعتده تارة كالبعض له والأخرى كالبعض للاسم.
فهذا ما لا يجوز مثله لأنه لا يكون كونه كبعض الاسم دليلاً على شدة امتزاجه بالفعل لكن لما اختلف المعنيان جاز أن يختلف التقديران فاعرف ذلك فإنه مما يقبله القياس ولا يدفعه.
ومثل ذلك قولهم: " لا أبا لك " فههنا تقديران مختلفان لمعنيين مختلفين.
وذلك أن ثبات الألف في " أبا " من " لا أبا لك " دليل الإضافة فهذا وجه.
ووجه آخر أن ثبات اللام وعمل " لا " في هذا الاسم يوجب التنكير والفصل.
فثبات الألف دليل الإضافة والتعريف ووجود اللام دليل الفصل والتنكير.
وليس هذا في الفساد والاستحالة بمنزلة فساد تحقير مثال الكثرة الذي جاء فساده من قبل تدافع حاليه.
وذلك أن وجود ياء التحقير يقتضي كونه دليلاً على القلة وكونه مثالاً موضوعاً للكثرة دليل على الكثرة وهذا يجب منه أن يكون الشيء الواحد في الوقت الواحد قليلاً كثيراً.
وهذا ما لا يجوز لأحد اعتقاده.
وليس كذلك تقديرك الباء في نحو: مررت بزيد تارة كبعض الاسم وأخرى كبعض الفعل من قبل أن هذه إنما هي صناعة لفظية يسوغ معها تنقل الحال وتغيرها فأما المعاني فأمر ضيق ومذهب مستصعب ألا تراك إذا سئلت عن زيد من قولنا: قام زيد سميته فاعلاً وإن سئلت عن زيد من قولنا: زيد قام سميته مبتدأ لا فاعلاً وإن كان فاعلاً في المعنى.
وذلك أنك سلكت طريق صنعة اللفظ فاختلفت السمة فأما المعنى فواحد.
فقد ترى إلى سعة طريق اللفظ وضيق طريق المعنى.
فإن قلت: فأنت إذا قلت في " لا أبا لك " إن الألف تؤذن بالإضافة والتعريف واللام تؤذن بالفصل والتنكير فقد جمعت على الشيء الواحد في الوقت الواحد معنيين ضدين وهما التعريف والتنكير وهذان - كما ترى - متدافعان.
قيل: الفرق بين الموضعين واضح وذلك أن قولهم: " لا أبا لك " كلام جرى مجرى المثل وذلك أنك إذا قلت هذا فإنك لا تنفي في الحقيقة أباه وإنما تخرجه مخرج الدعاء أي أنت عندي ممن يستحق أن يدعى عليه بفقد أبيه.
كذا فسره أبو علي وكذلك هو لمتأمله ألاترى أنه قد أنشد توكيداً لما رآه من هذا المعنى فيه قوله: وتترك أخرى فردة لا أخا لها ولم يقل: لا أخت لها ولكن لما جرى هذا الكلام على أفواههم " لا أبا لك " " ولا أخا لك " قيل مع المؤنث على حد ما يكون عليه مع المذكر فجرى هذا نحواً من قولهم لكل أحد من ذكر وأنثى واثنين وجماعة " الصيف ضيعت اللبن " على التأنيث لأنه كذا جرى أوله وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولهم " لا أبا لك " إنما فيه تعادي ظاهره " واجتماع " صورتي الفصل والوصل والتعريف والتنكير لفظاً لا معنى.
وإذا آل الأمر إلى ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه من تنافر قضيتي اللفظ في نحو: مررت بزيد وإذا أردت بذلك أن تدل على شدة اتصال حرف الجر بالفعل وحده دون الاسم ونحن إنما عقدنا فساد الأمر وصلاحه على المعنى كأن يكون الشيء الواحد في الوقت الواحد قليلاً كثيراً.
وهذا ما لايدعيه مدع ولا يرضاه - مذهباً لنفسه - راض.
ويؤكد عندك خروج هذا الكلام مخرج المثل كثرته في الشعر وأنه يقال لمن له أب ولمن ليس له أب.
فهذا الكلام دعاء في المعنى لا محالة وإن كان في اللفظ خبراً.
ولو كان دعاء مصرحاً وأمراً معنياً لما جاز أن يقال لمن لا أب له لأنه إذا كان لا أب له لم يجز أن يدعى عليه بما هو فيه لا محالة ألا ترى أنك لا تقول للأعمى: أعماه الله ولا للفقير: أفقره الله وهذا ظاهر باد.
وقد مر به الطائي الكبير فقال: نعمة الله فيك لا أسال الل ه إليها نعمى سوى أن تدوما ولو اني فعلت كنت كمن يس أله وهو قائم أن يقوما فكما لا تقول لمن لا أب له: أفقدك الله أباك كذلك يعلم أن قولهم لمن لا أب له: " لا أبا لك " لا حقيقة لمعناه مطابقة للفظه وإنما هي خارجة مخرج المثل على ما فسره أبو علي.
قال عنترة: فاقني حياءك لا أبا لك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتل وقال: ألق الصحيفة لا أبا لك إنه يخشى عليك من الحباء النقرس وقال: أبالموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني أراد: لا أبا لك فحذف اللام من جاري عرف الكلام.
وقال جرير: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوأة عمر وهذا أقوى دليل على كون هذا القول مثلاً لا حقيقة ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون للتيم كلها أب واحد ولكن معناه: كلكم أهل للدعاء عليه والإغلاظ له.
وقال الحطيئة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا فإن قلت: فقد أثبت الحطيئة في هذا البيت ما نفيته أنت في البيت الذي قبله وذلك أنه قال " لأبيكم " فجعل للجماعة أباً واحداً وأنت قلت هناك: إنه لا يكون لجماعة تيم أب واحد فالجواب عن هذا من موضعين: أحدهما ما قدمناه من أنه لا يريد حقيقة الأب وإنما غرضه الدعاء مرسلاً ففحش بذكر الأب على ما مضى.
والآخر أنه قد يجوز أن يكون أراد بقوله " لأبيكم " الجمع أي لا أبا لآبائكم.
يريد الدعاء على آبائهم من حيث ذكرها فجاء به جمعاً مصححاً على قولك: أب وأبون وأبين قال: فلما تبيَّنَّ أصواتنا بكين وفدَّيننا بالأبينا وعليه قول الآخر - أنشدناه -: فمن يك سائلاً عني فإني بمكة مولدي وبها ربيت وقد شنئت بها الآباء قبلي فما شنئت أبي ولا شنيت أي ما شنئت آبائي.
فهذا شيء عرض ولنعد.
ومن ذلك قولهم: مختار ومعتاد ونحو ذلك فهذا يحمل تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين.
وذلك أنه إن كان اسم الفاعل فأصله مختير ومعتوِد كمقتطع بكسر العين.
وإن كان مفعولاً فأصله مختيَر ومعتوَد كمقتطَع.
ف " مختار " من قولك: أنت مختار للثياب أي مستجيد لها أصله مختير.
ومختار من قولك: هذا ثوب مختار أصله مختير.
فهذان تقديران مختلفان لمعنيين.
وإنما كان يكون هذا منكراً لو كان تقدير فتح العين وكسرها لمعنى واحد فأما وهما لمعنيين فسائغ حسن.
وكذلك ما كان من المضعف في هذا الشرج من الكلام نحو قولك: هذا رجل معتد للمجد ونحوه فهذا هو اسم الفاعل وأصله معتدد بكسر العين وهذا رجل معتد أي منظور إليه فهذا مفتعل بفتح العين وأصله معتدد كقولك: هذا معنىً معنىٌ معتبر أي ليس بصغير متحقر.
وكذلك هذا جوز معتد فهذا أيضاً اسم المفعول وأصله معتدد كمقتسم ومقتطع.
ونظائر هذا وما قبله كثيرة فاشية.
ومن ذلك قولهم: كساء وقضاء ونحوه أعللت اللام لأنك لم تعتد بالألف حاجزاً لسكونها وقلبتها أيضاً لسكونها وسكون الألف قبلها فاعتددتها من وجه ولم تعتددها من آخر.
ومن ذلك أيضاً قولهم: أيهم تضرب يقم زيد.
ف " أيهم " من حيث كانت جازمة ل " تضرب " يجب أن تكون مقدمة عليها ومن حيث كانت منصوبة ب " تضرب " يجب أن تكون في الرتبة مؤخرة عنها فلم يمتنع أن يقع هذان التقديران على اختلافهما من حيث كان هذا إنما هو عمل صناعي لفظي.
لو كان التعادي والتخالف في المعنى لفسد " ولم " يجز.
وأيضاً فإن حقيقة الجزم إنما هو لحرف الجزاء المقدر المراد لا ل " أي " " فإذا " كان كذلك كان الأمر أقرب مأخذاً وألين ملمساً.
باب في تدريج اللغة
وذلك أن يشبه شيء شيئاً من موضع فيمضى حكمه على حكم الأول ثم يرقى منه إلى غيره.
فمن ذلك قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين " ولو " جالسهما جميعاً لكان مصيباً مطيعاً لا مخالفاً وإن كانت " أو " إنما هي في أصل وضعها لأحد الشيئين.
وإنما جاز ذلك في هذا الموضع لا لشيء رجع إلى نفس " أو " بل لقرينة انضمت من جهة المعنى إلى " أو ".
وذلك لإنه قد عرف أنه إنما رغب في مجالسة الحسن لما لمجالسه في ذلك من الحظ وهذه الحال موجودة في مجالسة ابن سيرين أيضاً وكأنه قال: جالس هذا الضرب من الناس.
وعلى ذلك جرى النهي في هذا الطرز من القول في قول الله سبحانه {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} وكأنه - والله أعلم - قال: لا تطع هذا الضرب من الناس.
ثم إنه لما رأى " أو " في هذا الموضع قد جرت مجرى الواو تدرج من ذلك إلى غيره فأجراها مجرى الواو في موضع عار من هذه القرينة التي سوغته استعمال " أو " في معنى الواو ألا تراه كيف قال: وسواء وسيان لا يستعمل إلا بالواو.
وعليه قول الآخر: فسيَّان حرب أو تبوءوا بمثله وقد يقبل الضيم الذليل المسير أي فسيَّان حرب وبواؤكم بمثله كما أن معنى الأول: فكان سيان ألا يسرحوا نعما وأن يسرحوه بها.
وهذا واضح.
ومن ذلك قولهم: صبية وصبيان قلبت الواو من صبوان وصبوة في التقدير - لأنه من صبوت - لانكسار الصاد قبلها وضعف الباء أن تعتد حاجزاً لسكونها.
وقد ذكرنا ذلك.
فلما ألف هذا واستمر تدرجوا منه إلى أن أقروا قلب الواو ياء بحاله وإن زالت الكسرة وذلك قولهم أيضاً: صبيان وصبية " وقد " كان يجب - لما زالت الكسرة - أن تعود الياء واواً إلى أصلها لكنهم أقروا الياء بحالها لاعتيادهم إياها حتى صارت كأنها كانت أصلاً.
وحسن ذلك لهم شيء آخر وهو أن القلب في صبية وصبيان إنما كان استحساناً وإيثاراً لا عن وجوب علة ولا قوة قياس فلما لم تتمكن علة القلب ورأوا اللفظ بياء قوي عندهم إقرار الياء بحالها لأن السبب الأول إلى قلبها لم يكن قوياً ولا مما يعتاد في مثله أن يكون مؤثراً.
ومن ذلك قولهم في الاستثبات عمن قال ضربت رجلاً: منا ومررت برجل مني وعندي رجل: منو فلما شاع هذا ونحوه عنهم تدرجوا منه إلى أن قالوا: ضرب منٌ منا كقولك: ومن ذلك قولهم: أبيض لياح وهو من الواو لأنه ببياضه ما يلوح للناظر.
فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وليس ذلك عن قوة علة إنما هو للجنوح إلى خفة الياء مع أدنى سبب وهو التطرق إليها بالكسرة طلباً للاستخفاف لا عن وجوب قياس ألا ترى أن هذا الضرب من الأسماء التي ليست جمعاً كرباض وحياض ولا مصدراً جارياً على فعل معتل كقيام وصيام إنما يأتي مصححاً نحو: خوان وصوان غير أنهم لميلهم عن الواو إلى الياء ما أقنعوا أنفسهم في لياح في قلبهم إياه إلى الياء بتلك الكسرة قبلها وإن كانت ليس مما يؤثر حقيقة التأثير مثلها ولأنهم شبهوه لفظاً إما بالمصدر كحيال وصيال وإما بالجمع كسوط وسياط ونوط ونياط.
نعم وقد فعلوا مثل هذا سواء في موضع آخر.
وذلك قول بعضهم في صوان: صيان وفي صوار: صيار فلما ساغ ذلك من حيث أرينا أو كاد تدرجوا منه إلى أن فتحوا فاء لياح ثم أقروا الياء بحالها وإن كانت الكسرة قبلها قد زايلتها وذلك قولهم فيه: لياح.
وشجعه على ذلك شيئاً أن قلب الواو ياء في لياح لم يكن عن قوة ولا استحكام علة وإنما هو لإيثار الأخف على الأثقل فاستمر على ذلك وتدرج منه إلى أن أقر الياء بحالها مع الفتح إذ كان قلبها مع الكسر أيضاً ليس بحقيقة موجب.
قال: وكما أن القلب مع الكسر لم يكن عن صحة عمل وإنما هو لتخفيف مؤثر فكذلك أقلب أيضاً مع الفتح وإن لم يكن موجباً غير أن الكسر هنا على ضعفه أدعى إلى القلب من الفتح فلذلك جعلنا ذاك تدرجاً عنه إليه ولم نسو بينهما فيه.
فاعرف ذلك.
وقريب من ذلك قول الشاعر: ولقد رأيتك بالقوادم مرة وعلي من سدف العشي رياح قياسه رواح لأنه فعال من راح يروح لكنه لما كثر قلب هذه الواو في تصريف هذه الكلمة ياء - نحو ريح ورياح ومريح ومستريح - وكانت الياء أيضاً عليهم أخف وإليهم أحب تدرجوا من ذلك إلى أن قلبوها في رياح وإن زالت الكسرة التي كانت قلبتها في تلك الأماكن.
ومن ذلك قلبهم الذال دالاً في " ادكر " وما تصرف منه نحو يدكر ومدكر وادكار وغير ذلك: تدرجوا من هذا إلى غيره بأن قلبوها دالاً في غير بناء افتعل فقال ابن مقبل: من بعض ما يعتري قلبي من الدكر ومن ذلك قولهم: الطنة - بالطاء - في الظنة وذلك في اعتيادهم اطن ومطن واطنان كما جاءت الدكر على الأكثر.
ومن ذلك حذفهم الفاء - على القياس - من ضغة وقحة كما حذفت من عدة وزنة ثم إنهم عدلوا بها عن فِعلة إلى فَعلة فأقروا الحذف بحاله وإن زالت الكسرة التي كانت موجبة له فقالوا: الضعة والقحة فتدرجوا بالضعة والقحة إلى الضعة والقحة وهي عندنا فعلة كقصعة وجفنة " لا أن " فتحت لأجل الحرف الحلقي فيما ذهب إليه محمد بن يزيد.
ومن ذلك قولهم: بأيهم تمرر أمرر فقدموا حرف الجر على الشرط فأعملوه فيه وإن كان الشرط لا يعمل فيه ما قبله لكنهم لما لم يجدوا طريقاً إلى تعليق حرف الجر استجازوا إعماله في الشرط.
فلما ساغ لهم ذلك تدرجوا منه إلى أن أضافوا إليه الاسم فقالوا: غلام من تضرب أضربه وجارية من تلق ألقها.
فالاسم في هذا إنما جاز عمله في الشرط من حيث كان محمولاً في ذلك على حرف الجر.
وجميع هذا حكمه في الاستفهام حكمه في الشرط من حيث كان الاستفهام له صدر الكلام كما أن الشرط كذلك.
فعلى هذه جاز بأيهم تمر وغلام من تضرب فأما قولهم: أتذكر إذ من يأتنا نأته فلا يجوز إلا في ضرورة الشعر وإنما يجوز على تقدير حذف المبتدأ أي أتذكر إذ الناس من يأتنا نأته فلما باشر المضاف غير المضاف إليه في اللفظ أشبه الفصل بين المضاف والمضاف إليه فلذلك أجازوه في الضرورة.
فإن قيل: فما الذي يمنع من إضافته إلى الشرط وهو ضرب من الخبر قيل: لأن الشرط له صدر الكلام فلو أضفت إليه لعلقته بما قبله وتانك حالتان متدافعتان.
فأما بأيهم تمرر أمرر ونحوه فإن حرف الجر متعلق بالفعل بعد الاسم والظرف في قولك: أتذكر إذ من يأتنا نأته متعلق بقولك أتذكر وإذا خرج ما يتعلق به حرف الجر من حيز الاستفهام لم يعمل في الاسم المستفهم به ولا المشروط به.
ومن التدريج في اللغة أن يكتسي المضاف من المضاف إليه كثيراً من أحكامه: من التعريف والتنكير والاستفهام والشياع وغيره ألا ترى أن ما لا يستعمل من الأسماء في الواجب إذا أضيف إليه شيء منها صار في ذلك إلى حكمه.
وذلك قولك: ما قرعت حلقة باب دار أحد قط فسرى ما في " أحد " من العموم والشياع إلى " الحلقة ".
ولو قلت: قرعت حلقة باب دار أحد أو نحو ذلك لم يجز.
ومن التدريج في اللغة: إجراؤهم الهمزة المنقلبة عن حرفي العلة عينا مجرى الهمزة الأصلية.
وذلك نحو قولهم في تحقير قائم وبائع: قويئم وبويئع فألحقوا الهمزة المنقلبة بالهمزة الأصلية في سائل وثائر من سأل وثأر إذا قلت: سويئل وثويئر.
وليست كذلك اللام إذا انقلبت همزة عن أحد الحرفين نحو كساء وقضاء ألا تراك تقول في التحقير: كسيٌ وقضيّ فترد حرف العلة وتحذفه لاجتماع الياءات.
وليست كذلك الهمزة الأصلية ألا تراك تقول في تحقير سلاء وخلاء بإقرار الهمزة لكونها أصلية وذلك سُليِّء وخُليِّء.
وتقول أيضاً في تكسير كساء وقضاء بترك الهمزة البتة وذلك قولك: أكسية وأقضية.
وتقول في سلاء وخلاء: أسلئة وأخلئة فاعرف ذلك.
لكنك لو بنيت من قائم وبائع شيئاً مرتجلاً أعدت الحرفين البتة.
وذلك كأن تبني منهما مثل جعفر فتقول: قومم وبيعع.
ولم تقل: قأمم ولا بأعع لأنك إنما تبني من أصل المثال لا من حروفه المغيرة ألا تراك لو بنيت من قيل وديمة مثال " فعل " لقلت: دوم وقول لا غير.
فإن قلت: ولم لم تقرر الهمزة في قائم وبائع فيما تبنيه منهما كما أقررتها في تحقيرهما قيل: البناء من الشيء أن تعمد لأصوله فتصوغ منها زوائده فلا تحفل بها.
وليس كذلك التحقير.
وذلك أن صورة المحقر معك ومعنى التكبير والتحقير في أن كل واحد منهما واحد واحد وإنما بينهما أن أحدهما كبير والآخر صغير فأما الإفراد والتوحيد فيهما كليهما فلا نظر فيه.
قال أبو علي - رحمه الله - في ضحة الواو في نحو أسيود وجديول: مما أعان على ذلك وسوغه أنه في معنى جدول صغير فكما تصح الواو في جدول صغير فكذلك أنس بصحة الواو في جديول.
وليس كذلك الجمع لأنه رتبة غير رتبة الآحاد فهو شيء آخر فلذلك سقطت في الجمع حرمة الواحد ألا تراك تقول في تكسير قائم: قوام وقوم فتطرح الهمزة وتراجع لفظ وسألت مرة أبا علي - رحمه الله - عن رد سيبويه كثيراً من أحكام التحقير إلى أحكام التكسير وحمله إياها عليها ألا تراه قال تقول: سريحين لقولك: سراحين ولا تقول: عثيمين لأنك لا تقول: عثامين ونحو ذلك.
فقال: إنما حمل التحقير في هذا على التكسير من حيث كان التكسير بعيداً عن رتبة الآحاد.
فاعتد ما يعرض فيه لاعتداده بمعناه والمحقر هو المكبر والتحقير فيه جار مجرى الصفة فكأن لم يحدث بالتحقير أمر يحمل عليه غيره كما حدث بالتكسير حكم يحمل عليه الإفراد: هذا معقد معناه وما أحسنه وأعلاه! ومن التدريج قولهم: هذا حضرُموت بالإضافة على منهاج اقتران الاسمين أحدهما بصاحبه.
ثم تدرجوا من هذا إلى التركيب فقالوا: هذا حضرَموت.
ثم تدرجوا من هذا إلى أن صاغوهما جميعاً صياغة المفرد فقالوا: هذا حضرَمُوت فجرى لذلك مجرى عضرفوط ويستعور.
ومن التدريج في اللغة قولهم: ديمة وديم واستمرار القلب في العين للكسرة قبلها ثم تجاوزوا ذلك لما كثر وشاع إلى أن قالوا: ديمت السماء ودومت فأما دومت فعلى القياس وأما ديمت فلاستمرار القلب في ديمة وديم.
أنشد أبو زيد: هو الجواد ابن الجواد ابن سبل إن دوموا جاد وإن جادوا وبل ورواه أيضاً " ديموا " بالياء.
نعم ثم قالوا: دامت السماء تديم فظاهر هذا أنه أجري مجرى باع يبيع وإن كان من الواو.
فإن قلت: فلعله فعل يفعل من الواو كما ذهب الخليل في طاح يطيح وتاه يتيه قيل: حمله على الإبدال أقوى ألا ترى أنه قد حكي في مصدره ديماً فهذا مجتذب إلى الياء مدرج إليها مأخوذ به نحوها.
فإن قلت: فلعل الياء لغة في هذا الأصل كالواو بمنزلة ضاره يضيره ضيراً وضاره يضوره ضوراً.
قيل: يبعد ذلك هنا ألا ترى إلى اجتماع الكافة على قولهم: الدوام وليس أحد يقول: الديام فعلمت بذلك أن العارض في هذا الموضع إنما هو من جهة الصنعة لا من جهة اللغة.
ومثل ذلك ما حكاه أبو زيد من قولهم: " ما هت الركية تميه ميهاً " مع إجماعهم على أمواه وأنه لا أحد يقول: أمياه.
ونحو من ذلك ما يحكى عن عمارة بن عقيل من أنه قال في جمع ريح: أرياح حتى نبه عليه فعاد إلى أرواح.
وكأن أرياحاً أسهل قليلاً لأنه قد جاء عنهم قوله: وعلي من سدف العشي رياح فهو بالياء لهذا آنس.
وجماع هذا الباب غلبة الياء على الواو لخفتها فهم لا يزالون تسبباً إليها ونجشاً عنها واستثارة لها وتقرباً ما استطاعوا منها.
ونحو هذه الطريق في التدريج: حملهم علباوان على حمراوان ثم حملهم رداوان على علباوان ثم حملهم قراوان على رداوان وقد تقدم ذكره.
وفي هذا كاف مما يرد في معناه بإذن الله تعالى.
ومن ذلك أنه لما اطردت إضافة أسماء الزمان إلى الفعل نحو: قمت يوم قمت وأجلس حين تجلس شبهوا ظرف المكان في " حيث " فتدرجوا من " حين " إلى " حيث " فقالوا: قمت حيث قمت.
ونظائره كثيرة.
باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب
هذا موضع شريف. وأكثر الناس يضعف عن احتماله لغموضه ولطفه. والمنفعة به عامة والتساند إليه مقو مجد. وقد نص أبو عثمان عليه فقال: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول وإنما سمعت البعض فقست عليه غيره.
فإذا سمعت " قام زيد " أجزت ظرف بشر وكرم خالد. قال أبو علي: إذا قلت: " طاب الخشكنان " فهذا من كلام العرب لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب.
ويؤكد هذا عندك أن ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مجرى أصول كلامها ألا تراهم يصرفون في العلم نحو آجر وإبريسيم وفِرِند وفيروزج وجميع ما تدخله لام التعريف.
وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو الديباج والفرند والسهريز والآجر أشبه أصول كلام العرب أعني النكرات.
فجرى في الصرف ومنعه مجراها.
قال أبو علي: ويؤكد ذلك أن العرب اشتقت من الأعجمي النكرة كما تشتق من أصول كلامها هل ينجيني حلف سختيت أو فضة أو ذهب كبريت قال: ف " سختيت " من السخت ك " زحليل " من الزحل.
وحكى لنا أبو علي عن ابن الأعرابي أظنه قال: يقال درهمت الخبازى أي صارت كالدراهم فاشتق من الدرهم وهو اسم أعجمي.
وحكى أبو زيد: رجل مدرهم.
قال ولم يقولوا منه: دُرهِم إلا أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل في الكف.
ولهذا أشباه.
وقال أبو عثمان في الإلحاق المطرد: إن موضعه من جهة اللام نحو قُعدُد ورِمدِد وشَملَل وصَعرَر.
وجعل الإلحاق بغير اللام شاذاً لا يقاس عليه.
وذلك نحو جوهر وبيطر وجدول وحذيم ورهوك وأرطىً ومعزىً وسلقىً وجعبى.
قال أبو علي وقت القراءة عليه كتاب أبي عثمان: لو شاء شاعر أو ساجع أو متسع أن يبنى بإلحاق اللام اسماً وفعلاً وصفة لجاز له ولكان ذلك من كلام العرب.
وذلك نحو قولك: خرججٌ أكرم من دخللٍ وضربب زيد عمراً ومررت برجل ضرببٍ وكرممٍ ونحو ذلك.
قلت له: أفترتجل اللغة ارتجالاً قال: ليس بارتجال لكنه مقيس على كلامهم فهو إذاً من كلامهم.
قال: ألا ترى أنك تقول: طاب الخشكنان فتجعله من كلام العرب وإن لم تكن العرب تكلمت به.
هكذا قال فبرفعك إياه كرفعها ما صار لذلك محمولاً على كلامها ومنسوباً إلى لغتها.
هل تعرف الدار لأم الخزرج منها فظلت اليوم كالمزرج أي الذي شرب الزرجون وهي الخمر.
فاشتق المزرج من الزرجون وكان قياسه: كالمزرجن من حيث كانت النون في زرجون قياسها أن تكون أصلاً إذ كانت بمنزلة السين من قربوس.
قال أبو علي: ولكن العرب إذا اشتقت من الأعجمي خلطت فيه.
قال: والصحيح من نحو هذا الاشتقاق قول رؤبة: في خدر مياس الدمى معرجن وأنشدناه " المعرجن " باللام.
فقوله " المعرجن " يشهد بكون النون من عرجون أصلاً وإن كان من معنى الانعراج ألا تراهم فسروا قول الله تعالى " حتى عاد كالعرجون القديم " فقالوا: هي الكباسة إذا قدمت فانحنت فقد " كان على هذا القياس يجب " أن يكون نون " عرجون " زائدة كزيادتها في " زيتون " غير أن بيت رؤبة الذي يقول فيه " المعرجن " منع هذا وأعلمنا أنه أصل رباعي قريب من لفظ الثلاثي كسبطر من سبط ودمثر من دمث ألا ترى أنه ليس في الأفعال " فعلن " وإنما ذلك في الأسماء نحو علجن وخلبن.
ومما يدل على أن ما قيس على كلام العرب فإنه من كلامها أنك لو مررت على قوم " يتلاقون بينهم مسائل " أبنية التصريف نحو قولهم في مثال " صمحمح " من الضرب: " ضربرب " ومن القتل " قتلتل " ومن الأكل " أكلكل " ومن الشرب " شربرب " ومن الخروج " خرجرج " ومن الدخول " دخلخل ".
وفي مثل " سفرجل " من جعفر: " جعفرر " ومن صقعب " صقعبب " ومن زبرج " زبرجج " ومن ثرتم " ثرتمم " ونحو ذلك.
فقال لك قائل: بأي لغة كان هؤلاء يتكلمون لم تجد بداً من أن تقول: بالعربية وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه الحروف.
فإن قلت: فما تصنع بما حدثكم به أبو صالح السليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا الخليل بن أسد النوشجاني قال: قرأت على الأصمعي هذه الأرجوزة للعجاج: يا صاح هل تعرف رسماً مكرسا فلما بلغت: تقاعس العز بنا فاقعنسسا قال لي الأصمعي: قال لي الخليل: أنشدنا رجل: ترافع العز بنا فارفنععا فقلت: هذا لا يكون.
فقال: كيف جاز للعجاج أن يقول: فهذا يدل على امتناع القوم من أن يقيسوا على كلامهم ما كان من هذا النحو من الأبنية على أنه من كلامهم ألا ترى إلى قول الخليل وهو سيد قومه وكاشف قناع القياس في علمه كيف منع من هذا ولو كان ما قاله أبو عثمان صحيحاً ومذهباً مرضياً لما أباه الخليل ولا منع منه! فالجواب عن هذا من أوجه عدة: أحدها - أن الأصمعي لم يحك عن الخليل أنه انقطع هنا ولا أنه تكلم بشيء بعده فقد يجوز أن يكون الخليل لما احتج عليه منشده ذلك البيت ببيت العجاج عرف الخليل حجته فترك مراجعته وقطع الحكاية على هذا الموضع يكاد يقطع بانقطاع الخليل عنده ولا ينكر أن يسبق الخليل إلى القول بشيء فيكون فيه تعقب له فينبه عليه فينتبه.
وقد يجوز أيضاً أن يكون الأصمعي سمع من الخليل في هذا من قبوله أورده على المحتج به ما لم يحكه للخليل بن أسد لا سيما والأصمعي ليس ممن ينشط للمقاييس ولا لحكاية التعليل.
نعم وقد يجوز أن يكون الخليل أيضاً أمسك عن شرح الحال في ذلك وما قاله لمنشده البيت من تصحيح قوله أو إفساده للأصمعي لمعرفته بقلة انبعاثه في النظر وتوفره على ما يروى ويحفظ.
وتؤكد هذا عندك الحكاية عنه وعن الأصمعي وقد كان أراده الأصمعي على أن يعلمه العروض فتعذر ذلك على الأصمعي وبعد عنه فيئس الخليل منه فقال له يوماً: يا أبا سعيد كيف تقطع قول الشاعر: قال: فعلم الأصمعي أن الخليل قد تأذى ببعده عن علم العروض فلم يعاوده فيه.
ووجه غير هذا وهو ألطف من جميع ما جرى وأصنعه وأغمضه وذلك أن يكون الخليل إنما أنكر ذلك لأنه بناه " مما " لامه حرف حلقي والعرب لم تبن هذا المثال مما لامه أحد حروف الحلق إنما هو مما لامه حرف فموي وذلك نحو اقعنسس واسحنكك واكلندد واعفنجج.
فلما قال الرجل للخليل " فارفنععا " أنكر ذلك من حيث أرينا.
فإن قيل: وليس ترك العرب أن تبني هذا المثال مما لامه حرف حلقي بمانع أحداً من بنائه من ذلك ألا ترى أنه ليس كل ما يجوز في القياس يخرج به سماع فإذا حذا إنسان على مثلهم وأم مذهبهم لم يجب عليه أن يورد في ذلك سماعاً ولا أن يرويه رواية.
قيل: إذا تركت العرب أمراً من الأمور لعلة داعية إلى تركه وجب اتباعها عليه ولم يسع أحداً بعد ذلك العدول عنه.
وعلة امتناع ذلك عندي ما أذكره لتتأمله فتعجب منه وتأنق لحسن الصنعة فيه.
وذلك أن العرب زادت هذه النون الثالثة الساكنة في موضع حروف اللين أحق به وأكثر من النون فيه ألا ترى أنك إذا وجدت النون ثالثة ساكنة فيما عدته خمسة أحرف قطعت بزيادتها نحو نون جحنفل وعبنقس وجرنفس وفلنقس وعرندس عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه حتى قال أصحابنا: وإنما كان ذلك لأن هذا الموضع إنما هو للحروف الثلاثة الزوائد نحو واو فدوكس وسرومط وياء سميدع وعميثل وألف جرافس وعذافر.
والنون حرف من حروف الزيادة أغن ومضارع لحروف اللين وبينه وبينها من القرب والمشابهات ما قد شاع وذاع.
فألحقوا النون في ذلك بالحروف اللينة الزائدة.
وإذا كان كذلك فيجب أن تكون هذه النون - إذا وقعت ثالثة في هذه المواضع - قوية الشبه بحروف المد وإنما يقوى شبهها بها متى كانت ذات غنة لتضارع بها حروف المد للينها وإنما تكون فيها الغنة متى كانت من الأنف وإنما تكون من الأنف متى وقعت ساكنة وبعدها حرف فموي لا حلقي نحو جحنفل وبابه.
وكذلك أيضاً طريقها وحديثها في الفعل ألا ترى أن النون في باب احرنجم وادلنظى إنما هي محمولة من حيث كانت ثالثة ساكنة على الألف نحو اشهاببت وادهاممت وابياضضت واسواددت والواو في نحو اغدودن واعشوشب واخلولق واعروريت واذلوليت واقطوطيت واحلوليت.
وإذا كانت النون في باب احرنجم واقعنسس إنما هي أيضاً محمولة على الواو والألف في هذه الألفاظ التي ذكرناها وغيرها وجب أن تضارعها وهي أقوى شبهاً بها.
وإنما يقوى شبهها بها إذا كانت غناء وإنما تكون كذلك إذا وقعت قبل حروف الفم نحوها في اسحنكك واقعنسس واحرنجم واخرنطم.
وإذا كان كذلك لم يجز أن يقع بعدها حرف حلقي لأنها إذا كانت كذلك كانت من الفم وإذا كانت من الفم سقطت غنتها وإذا سقطت غنتها زال شبهها بحرفي المد: الواو والألف.
فلذلك أنكره الخليل وقال: هذا لا يكون.
وذلك أنه رأى نون " ارفنعع " في موضع لا تستعملها العرب فيه إلا غناء غير مبنية فأنكره وليست كذلك في اقعنسس لأنها قبل السين وهذا موضع تكون فيه مغنة مشابهة لحرفي اللين ولهذا ما كانت النون في " عجنس " و " هجنع " كباء " عدبس " ولامي " شلعلع " ولم يقطع على أن الأولى منهما الزائدة كما قطع على نون " جحنفل " بذلك من حيث كانت مدعمة وادغامها يخرجها من الألف لأنها تصير إلى لفظ المتحركة بعدها وهي من الفم.
وهذا أقوى ما يمكن أن يحتج به في هذا الموضع.
وعلى ما نحن عليه فلو قال لك قائل: كيف تبني من ضرب مثل " حبنطىً " لقلت فيه: " ضربنىً ".
ولو قال: كيف تبني مثله من قرأ لقلت: هذا لا يجوز لأنه يلزمني أن أقول: " قرنأى " فأبين النون لوقوعها قبل الهمزة وإذا بانت ذهبت عنها غنتها وإذا ذهبت غنتها زال شبهها بحروف اللين في نحو عثوثل وخفيدد وسرومط وفدوكس وزرارق وسلالم وعذافر وقراقر - على ما تقدم - ولا يجوز أن تذهب عنها الغنة في هذا الموضع الذي هي محمولة فيه على حروف اللين بما فيها من الغنة التي ضارعتها بها وكذلك جميع حروف الحلق.
فلا يجوز أيضاً أن تبنى من صرع ولا من جبه ولا من سنح ولا من سلخ ولا من فرغ لأنه كان يلزمك أن تقول: صرنعى وجبنهى وسننحى وسلنخى وفرنغى فتبين النون في هذا الموضع.
وهذا لا يجوز لما قدمنا ذكره.
ولكن من أخفى النون عند الخاء والغين في نحو منخل ومنغل يجوز على مذهبه أن يبني نحو حبنطى من سلخ وفرغ لأنه قد يكون هناك في لغته من الغنة ما يكون مع حروف الفم.
وقلت مرة لأبي على - رحمه الله - قد حضرني شيء في علة الإتباع في " نقيذ " وإن عري أن تكون عينه حلقية وهو قرب القاف من الخاء والغين فكما جاء عنهم النخير والرغيف كذلك جاء عنهم " النقيذ " فجاز أن تشبه القاف لقربها من حروف الحلق بها كما شبه من أخفى النون عند الخاء والغين إياهما بحروف الفم فالنقيذ في الإتباع كالمنخل والمنغل فيمن أخفى النون فرضيه وتقبله.
ثم رأيته وقد أثبته فيما بعد بخطه في تذكرته ولم أر أحداً من أصحابنا ذكر " امتناع فعنلى " وبابه فيما لامه حرف حلقي لما يعقب ذلك من ظهور النون وزوال شبهها بحروف اللين والقياس يوجبه فلنكن عليه.
ويؤكده عنك أنك لا تجد شيئاً من باب فعنلى ولا فعنلل ولا فعنعل بعد نونه حرف حلقي.
وقد يجوز أن يكون إنكار الخليل قوله " فارفنععا " إنما هو لتكرر الحرف الحلقي مع استنكارهم ذلك.
ألا ترى إلى قلة التضعيف في باب المهه والرخخ والبعاع والبحح والضغيغة والرغيغة هذا مع ما قدمناه من ظهور النون في هذا الموضع.
ومن ذلك قول أصحابنا: إن اسم المكان والمصدر على وزن المفعول في الرباعي قليل إلا أن تقيسه.
وذلك نحو المدحرج تقول: دحرجته مدحرجاً وهذا مدحرجنا وقلقلته مقلقلاً وهذا مقلقلنا وكذلك أكرمته مكرماً وهذا مكرمك أي موضع إكرامك وعليه قول الله تعالى: {مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} أي تمزيق وهذا ممزق الثياب أي الموضع الذي تمزق فيه.
قال أبو حاتم: قرأت على الأصمعي في جيمية العجاج: جأباً ترى بليته مسحجاً فقال: تليله فقلت: بليته فقال: هذا لا يكون فقلت: أخبرني به من سمعه من فِلق في رؤبة أعني أبا زيد الأنصاري فقال: هذا لا يكون فقلت: جعله مصدراً أي تسحيجاً فقال: هذا لا يكون فقلت: فقد قال جرير: ألم تعلم مسرحي القوافي فلا عياً بهن ولا اجتلابا أي تسريحي.
فكأنه أراد أن يدفعه فقلت له: فقد قال الله عز وجل: {وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} فأمسك.
وتقول على ما مضى: تألفته متألفاً وهذا متألفنا وتدهورت متدهوراً وهذا متدهورك وتقاضيتك متقاضىً وهذا متقاضانا.
وتقول: اخروَّط مخروَّطاً وهذا مخروَّطنا واغدودن مغدودنا وهذا مغدودننا وتقول: اذلوليت مذلولىً وهذا مذلولانا ومذلولاكن يا نسوة وتقول: اكوهدَّ مكوهداً وهذا مكوهدكما.
فهذا كله من كلام العرب ولم يسمع منهم ولكنك سمعت ما هو مثله وقياسه قياسه ألا ترى إلى قوله: أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلاً وأنجو إذا غم الجبان من الكرب وقوله: أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلاً وأنجو إذا لم ينج إلا المكيس وقوله: كأن صوت الصنج في مصلصله فقوله " مصلصله " يجوز أن يكون مصدراً أي في صلصلته ويجوز أن يكون موضعاً للصلصله.
وأما قوله: .
.
.
حتى لا أرى لي مقاتلا فمصدر ويبعد أن يكون موضعاً أي حتى لا أرى لي موضعاً للقتال: المصدر هنا أقوى تراد على دمن الحياض فإن تعف فإن المندَّى رحلة فركوب أي مكان تنديتنا إياها أن نرحلها فنركبها.
وهذا كقوله: تحية بينهم ضرب وجيع أي ليست هناك تحية بل مكان التحية ضرب.
فهذا كقول الله سبحانه {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.
وقال رؤبة: جدب المندى شئِز المُعَوَّهِ فهذا اسم لموضع التندية أي جدب هذا المكان.
وكذلك " المعوه " مكان أيضاً والقول فيهما واحد.
وهذا باب مطرد متقاود.
وقد كنت ذكرت طرفاً منه في كتابي " شرح تصريف أبي عثمان " غير أن الطريق ما ذكرت لك.
فكل ما قيس على كلامهم فهو من كلامهم.
ولهذا قال من قال في العجاج ورؤبة: إنهما قاسا اللغة وتصرفا فيها وأقدما على ما لم يأت به من قبلهما.
وقد كان الفرزدق يلغز بالأبيات ويأمر بإلقائها على ابن أبي إسحاق.
وحكى الكسائي أنه سأل بعض العرب عن أحد مطايب الجزور فقال: مطيب وضحك الأعرابي من نفسه كيف تكلف لهم ذلك من كلامه.
فهذا ضرب من القياس ركبه الأعرابي وذكر أبو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة فيشك فيها فإذا رأى الاشتقاق قابلاً لها أنس بها وزال استيحاشه منها.
فهل هذا إلا اعتماد في تثبيت اللغة على القياس.
ومع هذا أنك لو سمعت ظرف ولم تسمع يظرف هل كنت تتوقف عن أن تقول يظرف راكباً له غير مستحيٍ منه.
وكذلك لو سمعت سلم ولم تسمع مضارعه أكنت ترع أو ترتدع أن تقول يسلم قياساً أقوى من كثير من سماع غيره.
ونظائر ذلك فاشية كثيرة.
باب في الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا
من ذلك قول لبيد: سقى قومي بني مجد وأسقى نميراً والقبائل من هلال وقال: أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها وقال: فظلت لدى البيت العتيق أُخيلُهو ومطواي مشتاقان لهْ أرقان فهاتان لغتان: أعني إثبات الواو في " أخيلهو " وتسكين الهاء في قوله " له " لأن أبا الحسن زعم أنها لغة لأزد السراة وإذا كان كذلك فهما لغتان.
وليس إسكان الهاء في " له " عن حذف لحق بالصنعة الكلمة لكن ذاك لغة.
ومثله ما رويناه عن قطرب: وأشرب الماء ما بي نحوهو عطش إلا لأن عيونهْ سيل واديها وأما قول الشماخ: له زجل كأنه صوت حا إذا طلب الوسيقة أو زمير فليس هذا لغتين لأنا لا نعلم رواية حذف هذه الواو وإبقاء الضمة قبلها لغة فينبغي أن يكون ذلك ضرورة " وصنعة " لا مذهباً ولغة.
وكذلك يجب عندي وينبغي ألا يكون لغة لضعفه في القياس.
ووجه ضعفه أنه ليس على مذهب الوصل ولا مذهب الوقف.
أما الوصل فيوجب إثبات واوه كلقيتهو أمس.
وأما الوقف فيوجب الإسكان كلقيته وكلمته فيجب أن يكون ذلك ضرورة للوزن لا لغة.
وأنشدني الشجري لنفسه: وإنا ليرعى في المخوف سوامنا كأنه لم يشعر به من يحاربه فاختلس ما بعد هاء " كأنه " ومطل ما بعد هاء " بِهىِ " واختلاس ذلك ضرورة وصنعة على ما تقدم به القول.
ومن ذلك قولهم: بغداد وبغدان.
وقالوا أيضاً: مغدان وطبرزل وطبرزن.
وقالوا للحية: أيم وأين.
وأعصر ويعصر: أبو باهلة.
والطِنفِسة والطُنفُسة.
وما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أكثر من أن يحاط به.
فإذا ورد شيء من ذلك - كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان - فينبغي أن تتأمل حال كلامه فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في الاستعمال كثرتهما واحدة فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى على ذينك اللفظين لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها وسعة تصرف أقوالها.
وقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى وطال بها عهده وكثر استعماله لها فلحقت - لطول المدة واتصال استعمالها - بلغته الأولى.
وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من صاحبتها فأخلق الحالين به في ذلك أن تكون القليلة في الاستعمال هي المفادة والكثيرته هي الأولى الأصلية.
نعم وقد يمكن في هذا أيضاً أن تكون القلي منهما إنما قلت في استعماله لضعفها في نفسه وشذوذها عن قياسه وإن كانتا جميعاً لغتين له ولقبيلته.
وذلك أن من مذهبهم أن يستعملوا من اللغة ما غيره أقوى في القياس منه ألا ترى إلى حكاية أبي العباس عن عمارة قراءته {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} بنصب النهار وأن أبا العباس قال له: ما أردت فقال: أردت " سابقٌ النهار " قال أبو العباس فقلت له: فهلا قلته فقال: لو قلته لكان أوزن أي أقوى.
فهذا يدلك على أنهم قد يتكلمون بما غيره عندهم أقوى منه وذلك لاستخفافهم الأضعف إذ لولا ذلك لكان الأقوى أحق وأحرى كما أنهم لا يستعملون المجاز إلا لضرب من المبالغة إذ لولا ذلك لكانت الحقيقة أولى من المسامحة.
وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد فإن أخرى ذلك أن يكون قد أفاد أكثرها أو طرفاً منها من حيث كانت القبيلة الواحدة لا تتواطأ في المعنى الواحد على ذلك كله.
هذا غالب الأمر وإن كان الآخر في وجه من القياس جائزاً.
وذلك كما جاء عنهم في أسماء الأسد والسيف والخمر وغير ذلك وكما تنحرف الصيغة واللفظ واحد نحو قولهم: هي رَغوة اللبن ورُغوته ورِغوته ورُغاوته ورِغاوته ورُغايته.
وكقولهم: الذَرُوح والذُرُّوح والذِّرِّيح والذُرَّاح والذُرَّح والذُرنوح والذُرحرح والذُرَّحرح روينا ذلك كله.
وكقولهم: جئته من علُ ومن عِل ومن علا ومن عَلوُ ومن عَلوَ ومن عَلو ومن عُلُوّ ومن عال ومن معال.
فإذا أرادوا النكرة قالوا: من علٍ.
وههنا من هذا ونحوه أشباه له كثيرة.
وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت لإنسان واحد من هَنَّا ومن هَنَّا.
ورويت عن الأصمعي قال: اختلف رجلان في الصقر فقال أحدهما: الصقر " بالصاد " وقال الآخر: السقر " بالسين " فتراضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما هما فيه.
فقال: لا أقول كما قلتما إنما هو الزقر.
أفلا ترى إلى كل واحد من الثلاثة كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين أخريين معها.
وهكذا تتداخل اللغات.
وسنفرد لذلك باباً بإذن فقد وضح ما أوردنا بيانه من حال اجتماع الللغتين أو اللغات في كلام الواحد من العرب.
باب في تركب اللغات
اعلم أن هذا موضع قد دعا أقواماً ضعف نظرهم وخفت إلى تلقي ظاهر هذه اللغة أفهامهم أن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم وادعوا أنها موضوعة في أصل اللغة على ما سمعوه بأخرة من أصحابها وأنسوا ما كان ينبغي أن يذكروه وأضاعوا ما كان واجباً أن يحفظوه.
ألا تراهم كيف ذكروا في الشذوذ ما جاء على فعل يفعل نعم ينعم ودمت تدوم ومت تموت.
وقالوا أيضاً فيما جاء من فعل يفعل وليس عينه ولا لامه حرفاً حلقياً نحو قلى يقلى وسلا يسلى وجبى يجبى وركن يركن وقنط يقنط.
ومما عدوه شاذاً ما ذكروه من فعل فهو فاعل نحو طهر فهو طاهر وشعر فهو شاعر وحمض فهو حامض وعقرت المرأة فهي عاقر ولذلك نظائر كثيرة.
واعلم أن أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت فتركبت على ما قدمناه في الباب الذي هذا الباب يليه.
هكذا ينبغي أن يعتقد وهو أشبه بحكمة العرب.
وذلك أنه قد دلت الدلالة على وجوب مخالفة صيغة الماضي لصيغة المضارع إذ الغرض في صيغ هذه المثل إنما هو لإفادة الأزمنة فجعل لكل زمان مثال مخالف لصاحبه وكلما ازداد الخلاف كانت في ذلك قوة الدلالة على الزمان.
فمن ذلك أن جعلوا بإزاء حركة فاء الماضي سكون فاء المضارع وخالفوا بين عينيهما فقالوا: ضرب يضرب وقتل يقتل وعلم يعلم.
فإن قلت: فقد قالوا: دحرج يدحرج فحركوا فاء المضارع والماضي جميعاً وسكنوا عينيهما أيضاً قيل: لما فعلوا ذلك في الثلاثي الذي هو أكثر استعمالاً وأعم تصرفاً وهو كالأصل للرباعي لم يبالوا ما فوق ذلك مما جاوز الثلاثة.
وكذلك أيضاً قالوا: تقطع يتقطع وتقاعس يتقاعس وتدهور يتدهور ونحو ذلك لأنهم أحكموا الأصل الأول الذي هو الثلاثي.
فقل حفلهم بما وراءه كما أنهم لما أحكموا أمر المذكر في التثنية فصاغوها على ألفها لم يحفلوا بما عرض في المؤنث من اعتراض علم التأنيث بين الاسم وبين ما هو مصوغ عليه من علمها نحو قائمتان وقاعدتان.
فإن قلت: فقد نجد في الثلاثي ما تكون حركة عينيه في الماضي والمضارع سواء وهو باب فعل نحو كرم يكرم وظرف يظرف.
قيل: على كل حال فاؤه في المضارع ساكنة وأما موافقة حركة عينيه فلأنه ضرب قائم في الثلاثي برأسه ألا تراه غير متعد البتة وأكثر باب فعَل وفعِل متعد.
فلما جاء هذا مخالفاً لهما - وهما أقوى وأكثر منه - خولف بينهما وبينه فووفق بين حركتي عينيه وخولف بين حركتي عينيهما.
وإذا ثبت وجوب خلاف صيغة الماضي صيغة المضارع وجب أن يكون ما جاء من نحو سلا يسلى وقلى يقلى ونحو ذلك مما التقت فيه حركتا عينيه منظوراً في أمره ومحكوماً عليه بواجبه.
فنقول: إنهم قد قالوا: قليت الرجل وقليته.
فمن قال: قلَيته فإنه يقول أقليه ومن قال قلِيته قال: أقلاه.
وكذلك من قال: سلوته قال: أسلوه ومن قال سليته قال: أسلاه ثم تلاقى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا وهذا لغة هذا فأخذ كل واحد منهما من صاحبه ما ضمه إلى لغته فتركبت هناك لغة ثالثة كأن من يقول سلا أخذ مضارع من يقول سلى فصار في لغته سلا يسلى.
فإن قلت: فكان يجب على هذا أن يأخذ من يقول سلِى مضارع من يقول سلا فيجيء من هذا أن يقال: سلى يسلو.
قيل: منع من ذلك أن الفعل إذا أزيل ماضيه عن أصله سرى ذلك في مضارعه وإذا اعتل مضارعه سرى ذلك في ماضيه إذ كانت هذه المثل تجري عندهم مجرى المثال الواحد ألا تراهم لما أعلوا " شقي " أعلوا أيضاً مضارعه فقالوا يشقيان: ولما أعلوا " يغزي " أعلوا أيضاً أغزيت ولما أعلوا " قام " أعلوا أيضاً يقوم.
فلذلك لم يقولوا: سليت تسلو فيعلوا الماضي ويصححوا المضارع.
فإن قيل: فقد قالوا: محوت تمحى وبأوت تبأى وسعيت تسعى ونأيت تنأى فصححوا الماضي وأعلوا المستقبل.
قيل: إعلال الحرفين إلى الألف لا يخرجهما كل الإخراج عن أصلهما ألا ترى أن الألف حرف ينصرف إليه عن الياء والواو جميعاً فليس للألف خصوص بأحد حرفي العلة فإذا قلب واحد منهما إليه فكأنه مقر على بابه ألا ترى أن الألف لا تكون أصلاً في الأسماء ولا الأفعال وإنما هي مؤذنة بما هي بدل منه وكأنها هي هو وليست كذلك الواو والياء لأن كل واحدة منهما قد تكون أصلاً كما تكون بدلاً.
فإذا أخرجت الواو إلى الياء اعتد بذلك لأنك أخرجتها إلى صورة تكون الأصول عليها والألف لا تكون أصلاً أبداً فيهما فكأنها هي ما قلبت عنه البتة فاعرف ذلك فإن أحداً من أصحابنا لم يذكره.
ومما يدلك على صحة الحال في ذلك أنهم قالوا: غزا يغزو ورمى يرمي فأعلوا الماضي بالقلب ولم يقلبوا المضارع لما كان اعتلال لام الماضي إنما هو بقلبها ألفاً والألف لدلالتها على ما قلبت ويدلك على استنكارهم أن يقولوا: سليت تسلو لئلا يقلبوا في الماضي ولا يقلبوا في المضارع أنهم قد جاءوا في الصحيح بذلك لما لم يكن فيه من قلب الحرف في الماضي وترك قلبه في المضارع ما جفا عليهم وهو قولهم: نعِم ينعُم وفضِل يفضُل.
وقالوا في المعتل: مِت تموت ودِمت تدوم وحكي في الصحيح أيضاً حضِر القاضي يحضُره.
فنعِم في الأصل ينعَم وينعم في الأصل مضارع نعُم ثم تداخلت اللغتان فاستضاف من يقول نعِم لغة من يقول ينعُم فحدثت هناك لغة ثالثة.
فإن قلت: فكان يجب على هذا أن يستضيف من يقول: نعُم مضارع من يقول نعِم فتركب من هذا أيضاً لغة ثالثة وهي نعُم ينعَم.
قيل: منع من هذا أن فعُل لا يختلف مضارعه أبداً وليس كذلك نعِم لأن نعِم قد يأتي فيه ينعِم وينعَم جميعاً فاحتمل خلاف مضارعه وفعُل لا يحتمل مضارعه الخلاف ألا تراك كيف تحذف فاء وعد في يعد لوقوعها بين ياء وكسرة وأنت مع ذلك تصحح نحو وضؤ ووطؤ إذا قلت: يوضؤ ويوطؤ وإن وقعت الواو بين ياء وضمة ومعلوم أن الضمة أثقل من الكسرة لكنه لما كان مضارع فعُل لا يجيء مختلفاً لم يحذفوا فاء وضؤ ولا وطؤ ولا وضع لئلا يختلف باب ليس من عادته أن يجيء مختلفاً.
فإن قلت: فما بالهم كسروا عين ينعِم وليس في ماضيه إلا نعِم ونعُم وكل واحد من فعِل وفعُل ليس له حظ من باب يفعِل.
قيل: هذا طريقه غير طريق ما قبله.
فإما أن يكون ينعم - بكسر العين - جاء على ماض وزنه فعَل غير أنهم لم ينطقوا به استغناء عنه بنعِم ونعُم كما استغنوا بتَرك عن وَذر وودع وكما استغنوا بملامح عن تكسير لمحة وغير ذلك.
أو يكون فعِل في هذا داخلاً على فعُل فكما أن فعُل بابه يفعل كذلك شبهوا بعض فعِل به فكسروا عين مضارعه كما ضموا في ظرف عين ماضيه ومضارعه.
فنعِم ينعِم في هذا محمول على كرم يكرم كما دخل يفعل فيما ماضيه فعَل نحو قتل يقتل على باب يشرف ويظرف.
وكأن باب يفعل إنما هو لما ماضيه فعُل ثم دخلت يفعُل في فعَل على يفعِل لأن ضرب يضرب أقيس من قتل يقتل.
ألا ترى أن ما ماضيه فعِل إنما بابه فتح عين مضارعه نحو ركب يركب وشرب يشرب.
فكما فتح المضارع لكسر الماضي فكذلك أيضاً ينبغي أن يكسر المضارع لفتح الماضي.
وإنما دخلت يفعُل في باب فعَل على يفعِل من حيث كانت كل واحدة من الضمة والكسرة مخالفة للفتحة ولما آثروا خلاف حركة عين المضارع لحركة عين الماضي ووجدوا الضمة مخالفة للفتحة خلاف الكسرة لها عدلوا في بعض ذاك إليها فقالوا: قتل يقتل ودخل يدخل وخرج يخرج.
وأنا أرى أن يفعل فيما ماضيه فَعَل في غير المتعدي أقيس من يفعِل فضرب يضرب إذاً أقيس من قتل يقتل وقعد يقعد أقيس من جلس يجلس.
وذلك أن يفعل إنما هي في الأصل لما لا يتعدى نحو كرم يكرم على ما شرحنا من حالها.
فإذا كان كذلك كان أن يكون في غير المتعدي فيما ماضيه فعَل أولى وأقيس.
فإن قيل: فكيف ذلك ونحن نعلم أن يفعُل في المضاعف المتعدي أكثر من يفعِل نحو شده يُشدُّه ومده يمده وقده يقده وجزه يجزه وعزه يعزه وأزه يؤزه وعمه يعمه وأمه يؤمه وضمه يضمه وحله يحله وسله يسله وتله يتله.
ويفعِل في المضاعف قليل محفوظ هره يهِره وعله يعِله وأحرف قليلة.
وجميعها يجوز فيه " أفعُله " نحو عله يعله وهره يهره إلا حبه يحبه فإنه مكسور المضارع لا غير.
قيل: إنما جاز هذا في المضاعف لاعتلاله والمعتل كثيراً ما يأتي مخالفاً للصحيح نحو سيد وميت وقضاة وغزاة ودام ديمومة وسار سيرورة.
فهذا شيء عرض قلنا فيه ولنعد.
وكذلك حال قولهم قنط يقنط إنما هو لغتان تداخلتا.
وذلك أن قنَط يقنِط لغة وقنِط يقنَط أخرى ثم تداخلتا فتركبت لغة ثالثة.
فقال من قال قنَط: يقنَط ولم يقولوا: قنِط يقنِط لأن آخذاً إلى لغته لغة غيره قد يجوز أن يقتصر على بعض اللغة التي أضافها إلى لغته دون بعض.
وأما حسب يحسب ويئس ييئس ويبس ييبس فمشبه بباب كرم يكرم على ما قلنا في نعِم ينعِم.
وكذلك مِت تموت ودِمت تدوم وإنما تدوم وتموت على من قال مُت ودُمت وأما مِت ودِمت فمضارعهما تمات وتدام قال: يا ميّ لاغرو ولا ملاما في الحب إن الحب لن يداما وقال: بنيَّ يا سيدة البنات عيشي ولا يؤمن أن تماتي ثم تلاقى صاحبا اللغتين فاستضاف هذا بعض لغة هذا وهذا بعض لغة هذا فتركبت لغة ثالثة.
قال الكسائي: سمعت من أخوين من بني سليم: نما ينمو ثم سألت بني سليم عنه فلم يعرفوه.
وأنشد أبو زيد لرجل من بني عقيل: ألم تعلمي ما ظلت بالقوم واقفا على طلل أضحت معارفه قفرا فكسروا الظاء في إنشادهم وليس من لغتهم.
وكذلك القول فيمن قال: شعر فهو شاعر وحمض فهو حامض وخثر فهو خاثر: إنما هي على نحو من هذا.
وذلك أنه يقال: خَثُر وخَثَر وحمُض وحمَض وشعُر وشعَر وطهُر وطهَر فجاء شاعر وحامض وخاثر وطاهر على حمَض وشعَر وخثَر وطهَر ثم استغني بفاعل عن " فعيل " وهو في أنفسهم وعلى بال من تصورهم.
يدل على ذلك تكسيرهم لشاعر: شعراء لما كان فاعل هنا واقعاً موقع " فعيل " كسر تكسيره ليكون ذلك أمارة ودليلاً على إرادته وأنه مغن عنه وبدل منه كما صحح العواور ليكون دليلاً على إرادة الياء في العواوير ونحو ذلك.
وعلى ذلك قالوا: عالم وعلماء - قال سيبويه: يقولها من لا يقول عليم - لكنه لما كان العلم إنما يكون الوصف به بعد المزاولة له وطول الملابسة صار كأنه غريزة ولم يكن على أول دخوله فيه ولو كان كذلك لكان متعلماً لا عالماً فلما خرج بالغريزة إلى باب فعُل صار عالم في المعنى كعليم فكسر تكسيره ثم حملوا عليه ضده فقالوا: جهلاء كعلماء وصار علماء كحلماء لأنه العلم محلمة لصاحبه وعلى ذلك جاء عنهم فاحش وفحشاء لما كان الفحش ضرباً من ضروب الجهل ونقيضاً للحلم أنشد الأصمعي - فيما روينا عنه -: وهل علمت فحشاء جهله وأما غسا يغسى وجبى يجبى فإنه كأبى يأبى.
وذلك أنهم شبهوا الألف في آخره بالهمزة في قرأ يقرأ وهدأ يهدأ.
وقد قالوا غسى يغسى فقد يجوز أن يكون غسا يغسى من التركيب الذي تقدم ذكره.
وقالوا أيضاً جبى يجبى وقد أنشد أبو زيد: يا إبلي ماذا مه فتأبيَه فجاء به على وجه القياس كأتى يأتي.
كذا رويناه عنه وقد تقدم ذكره وأنني قد شرحت حال هذا الرجز في كتابي " في النوادر الممتعة ".
واعلم أن العرب تختلف أحوالها في تلقي الواحد منها لغة غيره فمنهم من يخف ويسرع قبول ما يسمعه ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته البتة ومنهم من إذا طال تكرر لغة غيره عليه لصقت به ووجدت في كلامه ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل: يا نبيء الله فقال: ( لست بنبيء الله ولكنني نبيّ الله ) وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنكر الهمز في اسمه فرده على قائله لأنه لم يدر بم سماه فأشفق أن يمسك على ذلك وفيه شيء يتعلق بالشرع فيكون بالإمساك عنه مبيح محظور أو حاظر مباح.
وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحي قال: اجتمع أبو عبد الله ابن الأعرابي وأبو زياد الكلابي على الجسر ببغداد فسأل أبو زياد أبا عبد الله عن قول النابغة الذبياني: على ظهر مبناةٍ.
.
.
فقال أبو عبد الله: النَّطع فقال أبو زياد: لا أعرفه فقال: النِطع فقال أبو زياد: نعم أفلا ترى كيف أنكر غير لغته على قرب بينهما.
وحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد عن أبي بكر محمد بن هرون الروياني عن أبي حاتم قال: قرأ علي أعرابي بالحرم: " طيبى لهم وحسن مآب " فقلت: طوبى فقال طيبى قلت طوبى قال طيبى.
فلما طال علي الوقت قلت: طوطو فقال طي طي.
أفلا ترى إلى استعصام هذا الأعرابي بلغته وتركه متابعة أبي حاتم.
والخبر المرفوع في ذلك وهو سؤال أبي عمرو أبا خيرة عن قولهم: استأصل الله عرقاتهم فنصب أبو خيرة التاء من " عِرقاتهم " فقال له أبو عمرو: هيهات أبا خيرة لان جلدك.
وذلك أن أبا عمرو استضعف النصب بعد ما كان سمعها منه بالجر قال: ثم رواها فيما بعد أبو عمرو بالنصب والجر فإما أن يكون سمع النصب من غير أبي خيرة ممن يرضى عربيته وإما أن يكون قوي في نفسه ما سمعه من أبي خيرة من نصبها.
ويجوز أيضاً أن يكون قد أقام الضعف في نفسه فحكى النصب على اعتقاده ضعفه وذلك أن الأعرابي قد ينطق بالكلمة يعتقد أن غيرها أقوى في نفسه منها ألا ترى أن أبا العباس حكى عن عمارة أنه كان يقرأ { وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ} بالنصب قال أبو العباس: فقلت له ما أردت فقال: سابقٌ النهارَ فقلت له فهلا قلته فقال: لو قلته لكان أوزن أي أقوى.
وقد ذكرنا هذه الحكاية للحاجة إليها في موضع آخر ولا تستنكر إعادة الحكاية فربما كان في الواحدة عدة أماكن مختلفة يحتاج فيها إليها.
فأما قولهم: عقرت فهي عاقر فليس " عاقر " عندنا بجار على الفعل جريان قائم وقاعد عليه وكذلك قولهم: طلقت فهي طالق فليس عاقر من عقرت بمنزلة حامض من حمض ولا خاثر من خثر ولا طاهر من طهر ولا شاعر من شعر لأن كل واحد من هذه هو اسم الفاعل وهو جار على فَعَل " فاستغني به عما يجري على فعُل وهو " فعيل على ما قدمناه.
وسألت أبا علي - رحمه الله - فقلت: قولهم حائض بالهمزة يحكم بأنه جار على حاضت لاعتلال عين فعلت.
فقال: هذا لا يدل.
وذلك أن صورة فاعل مما عينه معتلة لا يجيء إلا مهموزاً جرى على الفعل أو لم يجر لأن بابه أن يجري عليه فحملوا ما ليس جارياً عليه على حكم الجاري عليه لغلبته إياه فيه.
وقد ذكرت هذا فيما مضى.
فاعرف ما رسمت لك واحمل - ما يجيء منه عليه - فإنه كثير وهذا طريق قياسه.
باب فيما يرد عن العربي مخالفاً لما عليه الجمهور
إذا اتفق شيء من ذلك نظر في حال ذلك العربي وفيما جاء به.
فإن كان الإنسان فصيحاً في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به وكان ما أورده مما يقبله القياس إلا أنه لم يرد به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان فإن الأولى في ذلك أن يحسن الظن به ولا يحمل على فساده.
فإن قيل: فمن أين ذلك له وليس مسوغاً أن يرتجل لغة لنفسه قيل: قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها وتأبدت معالمها.
أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحجاج عن أبي خليفة الفضل بن الحباب قال: قال ابن عون عن ابن سيرين قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان الشعر علم القوم ولم يكن لهم علم أصح منه فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم ولهيت عن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر فلم يئولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد هلك من وحدثنا أبو بكر أيضاً عن أبي خليفة قال قال يونس بن حبيب: قال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير.
فهذا ما تراه وقد روي في معناه كثير.
وبعد فلسنا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابني نزار فقد يمكن أن يقع شيء من تلك اللغة في لغتهم فيساء الظن فيه بمن سمع منه وإنما هو منقول من تلك اللغة.
ودخلت يوماً على أبي علي - رحمه الله - خالياً في آخر النهار فحين رآني قال لي: أين أنت أنا أطلبك.
قلت: وما ذلك قال: ما تقول فيما جاء عنهم من حَوريت فخضنا معاً فيه فلم نحل بطائل منه فقال: هو من لغة اليمن ومخالف للغة ابني نزار فلا ينكر أن يجيء مخالفاً لأمثلتهم.
وأخبرنا أبو صالح السليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا الخليل بن أسد النوشجاني قال حدثني محمد بن يزيد بن ربان قال أخبرني رجل عن حماد الراوية قال: أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب في الطنوج - قال: وهي الكراريس - ثم دفنها في قصره الأبيض.
فلما كان المختار بن أبي عبيد قيل له: إن تحت القصر كنزاً فاحتفره فأخرج تلك الأشعار.
فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة.
وهذا ونحوه مما يدلك على تنقل الأحوال بهذه اللغة واعتراض الأحداث عليها وكثرة تغولها وتغيرها.
فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح يسمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ وما وجد طريق إلى تقبل ما يورده إذا كان القياس يعاضده فإن لم يكن القياس مسوغاً له كرفع المفعول وجر الفاعل ورفع المضاف إليه فينبغي أن يرد.
وذلك لأنه جاء مخالفاً للقياس والسماع جميعاً فلم يبق له عصمة تضيفه ولا مسكة تجمع شعاعه.
فأما قول الشاعر - فيما أنشده أبو الحسن -: يوم الصليفاء لم يوفون بالجار فإن شبه للضرورة لم ب " لا " فقد يشبه حروف النفي بعضها ببعض وذلك لاشتراك الجميع في دلالته عليه ألا ترى إلى قوله - أنشدناه -: أجِدَّك لم تغتمض ليلة فترقدها مع رقادها فاستعمل " لم " في موضع الحال وإنما ذلك من مواضع ما النافية للحال.
وأنشدنا أيضاً: أجِدّك لن ترى بثعيلباتٍ ولا بيدان ناحية ذَمولا استعمل أيضاً " لن " في موضع " ما ".
أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي فخضنا فيه واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من تبيتين كما حذف الحركة للضرورة في قوله: فاليوم أشرب غير مستحقب كذا وجهته معه فقال لي: فكيف تصنع بقوله " تدلكي " قلت: نجعله بدلاً من " تبيتي " أو حالاً فنحذف النون كما حذفها من الأول في الموضعين فاطمأن الأمر على هذا.
وقد يجوز أن يكون " تبيتي " في موضع النصب بإضمار " أن " في غير الجواب كما جاء بيت الأعشى: لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها ويأوي إليها المستجير فيعصما وأنشد أبو زيد - وقرأته عليه -: بياض بالأصل فجاء به على إضمار " أن " كبيت الأعشى.
فأما قول الآخر: إن تهبطين بلاد قو م يرتعون من الطلاح فيجوز أن تكون " أن " هي الناصبة للاسم مخففة غير أنه أولاها الفعل بلا فصل كما قال إن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبا نعمة عندي بها ويدا أن تقرآن على أسماء - ويحكما - مني السلام وألا تعلما أحدا سألت عنه أبا علي رحمه الله فقال: هي مخففة من الثقيلة كأنه قال: أنكما تقرآن إلا أنه خفف من غير تعويض.
وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال: شبه " أن " ب " ما " فلم يعملها كما لم يعمل ما.
فأما ما حكاه الكسائي عن قضاعة من قولها: مررت به والمال له فإن هذا فاش في لغتها كلها لا في واحد من القبيلة وهذا غير الأول.
فإذا كان الرجل الذي سمعت منه تلك اللغة المخالفة للغات الجماعة مضعوفاً في قوله مألوفاً منه لحنه وفساد كلامه حكم عليه ولم يسمع ذلك منه.
هذا هو الوجه وعليه ينبغي أن يكون العمل.
وإن كان قد يمكن أن يكون مصيباً في ذلك لغة قديمة مع ما في كلامه من الفساد في غيره إلا أن هذا أضعف القياسين.
والصواب أن يرد ذلك عليه ولا يتقبل منه.
فعلى هذا مقاد هذا الباب فاعمل عليه.
باب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في القياس
وإنما يقع ذلك في كلامهم إذا استغنت بلفظ عن لفظ كاستغنائهم بقولهم: ما أجود جوابه عن قولهم: ما أجوبه أو لأن قياساً آخر عارضه فعاق عن استعمالهم إياه وكاستغنائهم ب " كاد زيد يقوم " عن قولهم: كاد زيد قائماً أو قياماً.
وربما خرج ذلك في كلامهم قال تأبط شراً: فأبت إلى فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر هكذا صحة رواية هذا البيت وكذلك هو في شعره.
فأما رواية من لا يضبطه: وما كنت آئبا ولم أك آئبا فلبعده عن ضبطه.
ويؤكد ما رويناه نحن مع وجوده في الديوان أن المعنى عليه ألا ترى أن معناه: فأبت وما كدت أءوب فأما " كنت " فلا وجه لها في هذا الموضع.
ومثل ذلك استغناؤهم بالفعل عن اسم الفاعل في خبر " ما " في التعجب نحو قولهم: ما أحسن زيداً ولم يستعملوا هنا اسم الفاعل " وإن " كان الموضع في خبر المبتدأ إنما هو للمفرد دون الجملة.
ومما رفضوه استعمالاً وإن كان مسوغاً قياساً وذر وودع استغني عنهما بترك.
ومما يجوز في القياس - وإن لم يرد به استعمال - الأفعال التي وردت مصادرها ورفضت هي نحو قولهم: فاظ الميت يفيظ فيظاً وفوظاً.
ولم يستعملوا من فوظ فِعلاً.
وكذلك الأين للإعياء لم يستعملوا منه فِعلاً قال أبو زيد وقالوا: رجل مدرهم ولم يقولوا دُرهم.
وحدثنا أبو علي - أظنه عن ابن الأعرابي - أنهم يقولون: درهمت الخبازى فهذا غير الأول.
وقالوا: رجل مفئود ولم يصرفوا فِعله ومفعولٌ الصفة إنما يأتي على الفعل نحو مضروب من ضرب ومقتول من قتل.
فأما امتناعهم من استعمال أفعال الويح والويل والويس والويب فليس للاستغناء بل لأن القياس نفاه ومنع منه.
وذلك أنه لو صرف الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه كوعد وعينه كباع فتحاموا استعماله لما كان يعقب من اجتماع إعلالين.
فإن قيل: فهلا صرفت هذه الأفعال واقتصر في الإعلال لها على إعلال أحد حرفيها كراهية لتوالي الإعلالين كما أن شويت ورويت ونحو ذلك لما وقعت عينها ولامها حرفي علة صححوا العين لاعتلال اللام تحامياً لاجتماع الإعلالين فقالوا: شوى يشوي كقوله: رمى يرمي قيل: لو فعل ذلك في فعل ويح وويل لوجب أن تعل العين وتصحح الفاء كما أنه لما وجب إعلال أحد حرفي شويت وطويت وتصحيح صاحبه أعلوا اللام وصححوا العين ومحل الفاء من العين محل العين من اللام فالفاء أقوى من العين كما أن العين أقوى من اللام فلو أعلوا العين في الفعل من الويل ونحوه لقالوا وال يويل وواح يويح وواس يويس وواب يويب فكانت الواو تثبت هنا مكسورة وذلك أثقل منها في باب وعد ألا تراها هناك إنما كرهت مجاورة للكسرة فحذفت وأصلها يوعد والواو ساكنة والكسرة في العين بعدها.
ولو قالوا يويل لأثبتوها والكسرة فيها نفسها وذلك أثقل من يوعد لو أخرجوه على أصله وليس كذلك يشوي ويطوي لأن أكثر ما في ذلك أن أخرجوه والحركة فيه.
وهكذا كانت حاله أيضاً فيما صحت لامه ألا ترى أن يقوم أصله يقوُم فالعين في الصحيح اللام إنما غاية أصليتها أن تقع متحركة ثم سكنت فقيل يقوم فأما ما صحت عينه وفاؤه واو نحو وعد ووجد فإن أصل بنائه إنما هو سكون فائه وكسرة عينه نحو يوعد ويوزن ويوجد والواو كما ترى ساكنة فلو أنك تجشمت تصحيحها في يويل ويويح لتجاوزت بالفاء حدها المقدر لها فيما صحت عينه.
فإن أحللت الكسرة فيها نفسها فكان ذلك يكون - لو تكلف - أثقل من باب يوعد ويوجد لو خرج على الصحة.
فاعرف ذلك فرقاً لطيفاً بين الموضعين.
ومما يجيزه القياس - غير أن لم يرد به الاستعمال - خبر " العَمْر والايمُن " من قولهم: لعمرك لأقومن ولايمن الله لأنطلقن.
فهذان مبتدآن محذوفا الخبرين وأصلهما - لو خرج خبراهما - لعمرك ما أقسم به لأقومن ولايمن الله ما أحلف به لأنطلقن فحذف الخبران وصار طول الكلام بجواب القسم عوضاً من الخبر.
ومن ذلك قولهم: لا أدري أي الجراد عاره أي ذهب به ولا يكادون ينطقون بمضارعه والقياس مقتض له وبعضهم يقول: يعوره وكأنهم إنما لم يكادوا يستعملون مضارع هذا الفعل لما كان مثلاً جارياً في الأمر المتقضي الفائت وإذا كان كذلك فلا وجه لذكر المضارع هنا لأنه ليس بمتقضٍّ.
ومن ذلك امتناعهم من استعمال استحوذ معتلاً وإن كان القياس داعياً إلى ذلك ومؤذناً به لكن عارض فيه إجماعهم على إخراجه مصححاً ليكون دليلاً على أصول ما غير من نحوه كاستقام واستعان.
ومن ذلك امتناعهم من إظهار الحرف الذي تعرف به " أمسِ " حتى اضطروا - لذلك - إلى بنائه لتضمنه معناه فلو أظهروا ذلك الحرف فقالوا مضى الأمس بما فيه لما كان خلفاً ولا خطأ.
فأما قوله: وإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب فرواه ابن الأعرابي: والأمسِ والأمسَ جراً ونصباً.
فمن جره فعلى الباب فيه وجعل اللام مع الجر زائدة حتى كأنه قال: وإني وقفت اليوم وأمس كما أن اللام في قوله تعالى {قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ} زائدة واللام المعرفة له مرادة فيه وهو نائب عنها ومتضمن لها فلذلك كسر فقال: والأمسِ فهذه اللام فيه زائدة والمعرفة له مرادة فيه ومحذوفة منه.
يدل على ذلك بناؤه على الكسر وهو في موضع نصب كما يكون مبنياً إذا لم تظهر إلى لفظه.
وأما من قال: والأمسَ فنصب فإنه لم يضمنه معنى اللام فيبنيه ولكنه عرفه بها كما عرف اليوم بها فليست هذه اللام في قول من قال: والأمسَ فنصب هي تلك اللام التي " هي في قول من قال " والأمسِ فجر.
تلك لا تظهر أبداً لأنها في تلك اللغة لم تستعمل مظهرة ألا ترى أن من ينصب غير من يجر فلكل منهما لغته وقياسها على ما نطق به منها لا تداخل أختها ولا نسبة في ذلك بينها وبينها كما أن اللام في قولهم " الآن حد الزمانين " غير اللام في قوله سبحانه {قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ} لأن الآن من قولهم " الآن حد الزمانين " بمنزلة " الرجل أفضل من المرأة والملك أفضل من الإنسان " أي هذا الجنس أفضل من هذا الجنس فكذلك " الآن " إذا رفعه جعله جنس هذا المستعمل في قولك " كنت الآن عنده وسمعت الآن كلامه " فمعنى هذا: كنت في هذا الوقت الحاضر بعضه وقد تصرمت أجزاء منه.
فهذا معنى غير المعنى في قولهم الآنُ ونظير ذلك أن الرجل من نحو قولهم: نعم الرجل زيد غير الرجل المضمر في " نِعم " إذا قلت: نعم رجلاً زيد لأن المضمر على شريطة التفسير لا يظهر ولا يستعمل ملفوظاً به ولذلك قال سيبويه: هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمراً أي إذا فسر بالنكرة في نحو نعم رجلاً زيد فإنه لا يظهر أبداً.
وإذا كان كذلك علمت زيادة الزاد في قول جرير: تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا وذلك أن فاعل " نعم " مظهر فلا حاجة به إلى أن يفسر فهذا يسقط اعتراض محمد بن يزيد عن صاحب الكتاب في هذا الموضع.
واعلم أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس وإن لم يرد به سماع.
ألا ترى إلى قول أبي الأسود: ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى وَدَعه وعلى ذلك قراءة بعضهم {ما وَدَعك ربك وما قلى} بالتخفيف أي ما تركك.
دل عليه قوله " وما قلى " لأن الترك ضرب من القلي فهذا أحسن من أن يعل باب استحوذ واستنوق الجمل لأن استعمال " ودع " مراجعة أصل وإعلال استحوذ واستنوق ونحوهما من المصحح ترك واعلم أن استعمال ما رفضته العرب لاستغنائها بغيره جار في حكم العربية مجرى اجتماع الضدين على المحل الواحد في حكم النظر.
وذلك أنهما إذا كانا يعتقبان في اللغة على الاستعمال جريا مجرى الضدين اللذين يتناوبان المحل الواحد.
فكما لا يجوز اجتماعهما عليه فكذلك لا ينبغي أن يستعمل هذان وأن يكتفي بأحدهما عن صاحبه كما يحتمل المحل الواحد الضد الواحد دون مراسلة.
ونظير ذلك في إقامة غير المحل مقام المحل ما يعتقدونه في مضادة الفناء للأجسام.
فتضادهما إنما هو على الوجود لا على المحل ألا ترى أن الجوهر لا يحل الجوهر بل يتضمنه في حال التضاد الوجود لا المحل.
فاللغة في هذه القضية كالوجود واللفظان المقام أحدهما مقام صاحبه كالجوهر وفنائه فهما يتعاقبان على الوجود لا على المحل كذلك الكلمتان تتعاقبان على اللغة والاستعمال.
فاعرف هذا إلى ما قبله.
وأجاز أبو الحسن ضُرِب الضربُ الشديدُ زيداً ودُفع الدفع الذي تعرف إلى محمد ديناراً وقتل القتل يوم الجمعة أخاك ونحو هذه المسائل.
ثم قال: هو جائز في القياس وإن لم يرد به الاستعمال.
فإن قلت فقد قال: فأقام حرف الجر ومجروره مقام الفاعل وهناك مفعول به صحيح قيل هذا من أقبح الضرورة ومثله لا يعتد أصلاً بل لا يثبت إلا محتقراً شاذاً.
وأما قراءة من قرأ {وكذلك نُجِّي المؤمنين} فليس على إقامة المصدر مقام الفاعل ونصب المفعول الصريح لأنه عندنا على حذف إحدى نوني " ننجي " كما حذف ما بعد حرف المضارعة في قول الله سبحانه " تذكّرون " أي تتذكرون.
ويشهد أيضاً لذلك سكون لام " نجي " ولو كان ماضياً لانفتحت اللام إلا في الضرورة.
وعليه قول المثقب العبدي: لمن ظعن تطالع من ضبيب فما خرجت من الوادي لحين أي تتطالع فحذف الثانية على ما مضى.
وما يحتمله القياس ولم يرد به السماع كثير.
منه القراءات التي تؤثر رواية ولا تتجاوز لأنها لم يسمع فيها ذلك كقوله - عز اسمه - {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ} فالسنة المأخوذ بها في ذلك إتباع الصفتين إعراب اسم الله سبحانه والقياس يبيح أشياء فيها وإن لم يكن سبيل إلى استعمال شيء منها.
نعم وهناك من قوة غير هذا المقروء به ما لا يشك أحد من أهل هذه الصناعة في حسنه كأن يقرأ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ} برفع الصفتين جميعاً على المدح.
ويجوز {الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ} بنصبهما جميعاً عليه.
ويجوز { الرحمنُ الرحيمَ } برفع الأول ونصب الثاني.
ويجوز { الرحمنَ الرحيمُ } بنصب الأول ورفع الثاني.
كل ذلك على وجه المدح وما أحسنه ههنا! وذلك أن الله تعالى إذا وصف فليس الغرض في ذلك تعريفه بما يتبعه من صفته لأن هذا الاسم لا يعترض شك فيه فيحتاج إلى وصفه لتخليصه لأنه الاسم الذي لا يشارك فيه على وجه وبقية أسمائه - عز وعلا - كالأوصاف التابعة لهذا الاسم.
وإذا لم يعترض شك فيه لم تجيء صفته لتخليصه بل للثناء على الله تعالى.
وإذا كان ثناء فالعدول عن إعراب الأول أولى به.
وذلك أن إتباعه إعرابه جار في اللفظ مجرى ما يتبع للتخليص والتخصيص.
فإذا هو عدل به عن إعرابه علم أنه للمدح أو الذم في غير هذا عز الله تعالى فلم يبق فيه هنا إلا المدح.
فلذلك قوي عندنا اختلاف الإعراب في الرحمن الرحيم بتلك الأوجه التي ذكرناها.
ولهذا في القرآن والشعر نظائر كثيرة.
الجزء الثاني
باب في ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر
باب اختلاف اللغات وكلها حجة
باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه
باب في العربي يسمع لغة غيره أيراعيها ويعتمدها ام يلغيها ويطرح حكمها
باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع
باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح لا يسمع من غيره
باب في اللغة المأخوذة قياساً
باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية
باب في الأصلين يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير
باب في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه
باب في قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف
باب في اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين في الحروف والحركات والسكون
باب في اتفاق المصاير على اختلاف المصادر
باب في ترافع الأحكام
باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني
باب في الاشتقاق الأكبر
باب في الإدغام الأصغر
باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني
باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني
باب في مشابهة معاني الإعراب معاني الشعر
باب في خلع الأدلة
باب في تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان
باب في الشيء يرد مع نظيره مورده مع نقيضه
باب في ورود الوفاق مع وجود الخلاف
باب في نقض العادة المعتاد المألوف في اللغة
باب في تدافع الظاهر
باب في التطوع بما لا يلزم
باب في التام يزاد عليه فيعود ناقصا
باب في زيادة الحروف وحذفها
باب في زيادة الحرف عوضاً من آخر محذوف
باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض
باب في مضارعة الحروف للحركات والحركات للحروف
باب محل الحركات من الحروف أمعها أم قبلها أم بعدها
باب الساكن والمتحرك
باب في مراجعة أصل واستئناف فرع
باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع
باب في مراعاتهم الأصول للضرورة تارة وإهمالهم إياها أخرى
باب في حمل الأصول على الفروع
باب في الحكم يقف بين الحكمين
باب في شجاعة العربية
فصل في التقديم والتأخير.
فصل في التحريف
باب في فرق بين الحقيقة والمجاز
باب في أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة
باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها
باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد
باب في ملاطفة الصنعة
باب في التجريد
باب في غلبة الزائد للأصلي
باب في أن ما لا يكون للأمر وحده
باب في أضعف المعتلين وهو اللام لأنها أضعف من العين.
باب في الغرض في مسائل التصريف
باب في اللفظ يرد محتملاً
باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق
الجزء الثاني
باب في ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر
علّة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل.
ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر.
وكذلك أيضاً لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يرد عنها.
وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا لأنا لا نكاد نرى بدوياً فصيحا.
وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه وينال ويغض منه.
وقد كان طرأ علينا أحد من يدعي الفصاحة البدوية ويتباعد عن الضعفة الحضرية فتلقينا أكثر كلامه بالقبول له وميزناه تمييزاً حسن في النفوس موقعه إلى أن أنشدني يوماً شعرا لنفسه يقول في بعض قوافيه: أشئؤها وادأؤها بوزن أشععها وأدععها فجمع بين الهمزتين كما ترى واستأنف من ذلك ما لا أصل له ولا قياس يسوغه.
نعم وأبدل إلى الهمز حرفا لا حظ في الهمز له بضد ما يجب لأنه لو التقت همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما فكيف أن يقلب إلى الهمز قلباً ساذجاً عن غير صنعة ما لا حظ له في الهمز ثم يحقق الهمزتين جميعاً! هذا ما لا يتيحه قياس ولا ورد بمثله سماع.
فإن قلت: فقد جاء عنهم خطائئ ورزائئ ودريئة ودرائئ ولفيئة ولفائئ وأنشدوا قوله: فإنك لا تدري متى الموت جائئ إليك ولا ما يحدث الله في غد قيل: أجل قد جاء هذا لكن الهمز الذي فيه عرض عن صحة صنعة ألا ترى أن عين فاعل مما هي فيه حرف علة لا تأتي إلا مهموزة نحو قائم وبائع فاجتمعت همزة فاعل وهمزة لامه فصححها بعضهم في بعض الاستعمال.
وكذلك خطائئ وبابها: عرضت همزة فعائل عن وجوب كهمزة سفائن ورسائل واللام مهموزة فصحت في بعض الأحوال بعد وجوب اجتماع الهمزتين.
فأما أشئؤها وأدأؤها فليست الهمزتان فيهما بأصلين.
وكيف تكونان أصلين وليس لنا أصل عينه ولامه همزتان ولا كلاهما أيضاً عن وجوب.
فالناطق بذلك بصورة من جر الفاعل أو رفع المضاف إليه في أنه لا أصل يسوغه ولا قياس يحتمله ولا سماع ورد به.
وما كانت هذه سبيله وجب اطراحه والتوقف عن لغة من أورده.
وأنشدني أيضاً شعراً لنفسه يقول فيه: كأن فاي.
.
.
فقوى في نفسي بذلك بعده عن الفصاحة وضعفه عن القياس الذي ركبه.
وذلك أن ياء المتكلم تكسر أبداً ما قبلها.
ونظير كسرة الصحيح كون هذه الأسماء الستة بالياء نحو مررت بأخيك وفيك.
فكان قياسه أن يقول كأن في بالياء كما يقول كأن غلامي.
ومثله سواء ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: كسرت في ولم يقل فاي وقد قال الله سبحانه: {إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ} ولم يقل: إن أباي.
وكيف يجوز إن أباي بالألف وأنت لا تقول: إن غلامي قائم وإنما تقول: كأن غلامي بالكسر.
فكذلك تقول كأن في بالياء.
وهذا واضح.
ولكن هذا الإنسان حمل بضعف قياسه قوله كأن فاي على قوله: كأن فاه وكأن فاك وأنسى ما توجبه ياء المتكلم: من كسر ما قبلها وجعله ياء.
فإن قلت: فكان يجب على هذا أن تقول: هذان غلامى فتبدل ألف التثنية ياء لأنك تقول هذا غلامي فتكسر الميم قيل هذا قياس لعمري غير أنه عارضه قياس أقوى منه فترك إليه.
وذلك أن التثنية ضرب من الكلام قائم برأسه مخالف للواحد والجميع ألا تراك تقول: هذا وهؤلاء فتبني فيهما فإذا صرت إلى التثنية جاء مجيء المعرب فقلت: هذان وهذين.
وعلى أن هذا الرجل الذي أومأت إليه من أمثل من رأيناه ممن رأيناه ممن جاءنا مجئه وتحلى عندنا حليته.
فأما ما تحت ذلك من مرذول أقوال هذه الطوائف فأصغر حجماً وأنزل قدراً أن يحكى في جملة ما يثنى.
ومع هذا فإذا كانوا قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلحن في كلامه فقال: ( أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل ) ورووا أيضاً أن أحد ولاة عمر رضي الله تعالى عنه كتب إليه كتاباً لحن فيه فكتب إليه عمر: أن قنع كاتبك سوطاً وروى من حديث علي رضي الله عنه مع الأعرابي الذي أقرأه المقرئ: {أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} حتى قال الأعرابي: برئت من رسول الله فأنكر ذلك علي عليه السلام ورسم لأبي الأسود من عمل النحو ما رسمه: مالا يجهل موضعه فكان ما يروى من أغلاط الناس منذ ذاك إلى أن شاع واستمر فساد هذا الشأن مشهوراً ظاهراً فينبغي أن يستوحش من الأخذ عن كل أحد إلا أن تقوى لغته وتشيع فصاحته.
وقد قال الفراء في بعض كلامه: إلا أن تسمع شيئاً من بدوي فصيح فتقوله.
وسمعت الشجري أبا عبد الله غير دفعة يفتح الحرف الحقي في نحو يعدو وهو محموم ولم أسمعها من غيره من عقيل فقد كان يرد علينا منهم من يؤنس به ولا يبعد عن الأخذ بلغته.
وما أظن الشجري إلا استهواه كثرة ما جاء عنهم من تحريك الحرف الحلقي بالفتح إذا انفتح ما قبله في له نعل لا تطبي الكلب ريحها وإن جعلت وسط المجالس شمت وقول أبي النجم: وجبلا طال معدا فاشمخر أشم لا يسطيعه الناس الدهر وهذا قد قاسه الكوفيون وإن كنا نحن لا نراه قياساً لكن مثل يعدو وهو محموم لم يرو عنهم فيما علمت.
فإياك أن تخلد إلى كل ما تسمعه بل تأمل حال مورده وكيف موقعه من الفصاحة فاحكم عليه وله.
باب اختلاف اللغات وكلها حجة
اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم ألا ترى أن لغة التميميين في ترك إعمال ما يقبلها القياس ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك لأن لكل واحد من القومين ضرباً من القياس يؤخذ به ويخلد إلى مثله.
وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها.
لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أنسابها.
فأما رد إحداهما بالأخرى فلا.
أولا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف ).
هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتين.
فأما أن تقل إحداهما جدا وتكثر الأخرى جدا فإنك تأخذ بأوسعهما رواية وأقواهما قياسا ألا تراك لا تقول: مررت بك ولا المال لك قياساً على قول قضاعة: المال له ومررت به ولا تقول أكرمتكش ولا أكرمتكس قياساً على لغة من قال: مررت بكش وعجبت منكس.
حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب قال: ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن وتضجع قيس وعجرفية ضبة وتلتلة بهراء.
فأما عنعنة تميم فإن تميماً تقول في موضع أن: عن تقول: عن عبد الله قائم وأنشد ذو الرمة عبد الملك: أعن ترسمت من خرقاء منزلة قال الأصمعي: سمعت ابن هرمة ينشد هارون الرشيد: أعن تغنت على ساق مطوقة ورقاء تدعو هديلا فوق أعواد وأما تلتلة بهراء فإنهم يقولون: تِعلمون وتِفعلون وتِصنعون بكسر أوائل الحروف.
وأما كشكشة ربيعة فإنما يريد قولها مع كاف ضمير المؤنث: إنكش ورأيتكش وأعطيتكش تفعل هذا في الوقف فإذا وصلت أسقطت الشين.
وأما كسكسة هوازن فقولهم أيضاً: أعطيتكس ومنكس وعنكس.
وهذا في الوقف دون الوصل.
فإذا كان الأمر في اللغة المعول عليها هكذا وعلى هذا فيجب أن يقل استعمالها وأن يتخير ما هو أقوى وأشيع منها إلا أن إنسانا لو استعملها لم يكن مخطئا لكلام العرب لكنه كان يكون مخطئاً لأجود اللغتين.
فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منعي عليه.
وكذلك إن قال: يقول علي قياس من لغته كذا كذا ويقول على مذهب من قال كذا كذا.
وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خيراً منه.
باب في العربي الفصيح ينتقل لسانه
اعلم أن المعمول عليه في نحو هذا أن تنظر حال ما انتقل إليه لسانه.
فإن كان إنما انتقل من لغته إلى لغة أخرى مثلها فصيحة وجب أن يؤخذ بلغته التي انتقل إليها كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه إليها حتى كأنه إنما حضر غائب من أهل اللغة التي صار إليها أو نطق ساكت من أهلها.
فإن كانت اللغة التي انتقل لسانه إليها فاسدة لم يؤخذ بها ويؤخذ بالأولى حتى كأنه لم يزل من أهلها.
وهذا واضح.
فإن قلت: فما يؤمنك أن تكون كما وجدت في لغته فساداً بعد أن لم يكن فيها فيما علمت أن يكون فيها فساد آخر فيما لم تعلمه.
فإن أخذت به كنت آخذا بفاسد عروض ما حدث فيها من الفساد فيما علمت قيل هذا يوحشك من كل لغة صحيحة لأنه يتوجه منه أن تتوقف عن الأخذ بها مخافة أن يكون فيها زيغ حادث لا تعلمه الآن ويجوز أن تعلمه بعد زمان كما علمت من حال غيرها فساداً حادثاً لم يكن فيما قبل فيها.
وإن اتجه هذا انخرط عليك منه ألا تطيب نفساً بلغة وإن كانت فصيحة مستحكمة.
فإذا كان أخذك بهذا مؤدياً إلى هذا رفضته ولم تأخذ به وعملت على تلقي كل لغة قوية معربة بقبولها واعتقاد صحتها.
وألا توجه ظنة إليها ولا تسوء رأيا في المشهود تظاهره من اعتدال أمرها.
وذلك كما يحكى من أن أبا عمرو استضعف فصاحة أبي خيرة لما سأله فقال: كيف تقول استأصل الله عرقاتهم ففتح أبو خيرة التاء فقال له أبو عمرو: هيهات أبا خيرة لأن جلدك! فليس لأحد أن يقول: كما فسدت لغته في هذا ينبغي أن أتوقف عنها في غيره لما حذرناه قبل ووصفنا.
فهذا هو القياس وعليه يجب أن يكون العمل.
باب في العربي يسمع لغة غيره أيراعيها ويعتمدها ام يلغيها ويطرح حكمها
أخبرنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان عن أبي زيد قال: سألت خليلاً عن الذين قالوا: مررت بأخواك وضربت أخواك فقال: هؤلاء قولهم على قياس الذين قالوا في ييأس: ياءس أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها.
قال يعني الخليل: ومثله قول العرب من أهل الحجاز: يا تزن وهم ياتعدون فروا من يوتزن ويوتعدون.
فقوله: أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون يريد: أبدلوا الياء في ييأس والآخر: أبدلوا الياء في أخويك ألفاً.
وكلاهما يحتمله القياس ههنا ألا ترى أنه يجوز أن يريد أنهم أبدلوا ياء أخويك في لغة غيرهم ممن يقولها بالياء وهم أكثر العرب فجعلوا مكانها ألفا في لغتهم استخفافاً للألف فأما في لغتهم هم فلا.
وذلك أنهم هم لم ينطقوا قط بالياء في لغتهم فيبدلوها ألفاً ولا غيرها.
ويؤكد ذلك عندك أن أكثر العرب يجعلونها في النصب والجرياء.
فلما كان الأكثر هذا شاع على أسماع بلحرث فراعوه وصنعوا لغتهم فيه ولم تكن الياء في التثنية شاذة ولا دخيلة في كلام العرب فيقل الحفل بها ولا ينسب بلحرث إلى راعوها أو تخيروا للغتهم عليها.
فإن قلت: فلعل الخليل يريد أن من قال: مررت بأخواك قد كان مرة يقول: مررت بأخويك كالجماعة ثم رأى فيما بعد أن قلب هذه الياء ألفاً للخفة أسهل عليه وأخف كما قد تجد العربي ينتقل لسانه من لغته إلى لغة أخرى قيل: إن الخليل إنما أخرج كلامه على ذلك مخرج التعليل للغة من نطق بالألف في موضع جر التثنية ونصبها لا على الانتقال من لغة إلى أخرى.
وإذا كان قولهم: مررت بأخواك معللاً عندهم بالقياس فكان ينبغي أن يكونوا قد سبقوا إلى ذلك منذ أول أمرهم لأنهم لم يكونوا قبلها على ضعف قياس ثم تداركوا أمرهم فيما بعد فقوي قياسهم.
وكيف كانوا يكونون في ذلك على ضعف من القياس والجماعة عليه! أفتجمع كافة اللغات على ضعف ونقص حتى ينبغ نابغ منهم فيرد لسانه إلى قوة القياس دونهم! نعم ونحن أيضاً نعلم أن القياس مقتض لصحة لغة الكافة وهي الياء في موضع الجر والنصب ألا ترى أن في ذلك فرقاً بين المرفوع وبينهما وهذا هو القياس في التثنية كما كان موجوداً في الواحد.
ويؤكده لك أنا نعتذر لهم من مجيئهم بلفظ المنصوب في التثنية على لفظ المجرور.
وكيف يكون القياس أن تجتمع أوجه الإعراب الثلاثة على صورة واحدة! وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي في فقد علمت بهذا أن صاحب لغة قد راعى لغة غيره.
وذلك لأن العرب وإن كانوا كثيراً منتشرين وخلقاً عظيماً في أرض الله غير متحجرين ولا متضاغطين فإنهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة.
فبعضهم يلاحظ صاحبه ويراعي أمر لغته كما يراعي ذلك من مهم أمره.
فهذا هذا.
وإن كان الخليل أراد بقوله: تقلب الياء ألفاً: أي في ييأس فالأمر أيضاً عائد إلى ما قدمنا ألا ترى أنه إذا شبه مررت بأخواك بقولهم: ييأس وياءس فقد راعى أيضاً في مررت بأخواك لغة من قال: مررت بأخويك.
فالأمران إذاً صائران إلى موضع واحد.
ولهذا نظائر في كلامهم وإنما أضع منه رسماً ليرى به غيره بإذن الله.
وأجاز أبو الحسن أن يكون كانت العرب قدماً تقول: مررت بأخويك وأخواك جميعاً إلا أن الياء كانت أقيس للفرق فكثر استعمالها وأقام الآخرون على الألف أو أن يكون الأصل قبله الياء في الجر والنصب ثم قلبت للفتحة فيها ألفاً في لغة بلحرث بن كعب.
وهذا تصريح بظاهر قول الخليل الذي قدمناه.
ولغتهم عند أبي الحسن أضعف من هذا جحر ضب خرب قال: لأنه قد كثر عنهم الإتباع نحو شد وشروبابه فشبه هذا به.
ومن هذا حذف بني تميم ألف ها من قولهم هلم لسكون اللام في لغة أهل الحجاز إذا قالوا المم وإن لم يقل ذلك بنو تميم أو أن يكونوا حذفوا الألف لأن أهل الحجاز حذفوها.
وأيا ما كان فقد نظر فيه بنو تميم إلى أهل الحجاز.
ومن ذلك قول بعضهم في الوقف رأيت رجلاً بالهمزة.
فهذه الهمزة بدل من الألف في الوقف في لغة من وقف بالألف لا في لغته هو لأن من لغته هو أن يقف بالهمزة.
أفلا تراه كيف راعى لغة غيره فأبدل من الألف همزة.
باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع
سألت أبا علي رحمه الله فقلت: من أجرى المضمر مجرى المظهر في قوله أعطيتكمه فأسكن الميم مستخفاً كما أسكنها في قوله: أعطيتكم درهما كيف قياس قوله على قول الجماعة: أعطيته درهماً إذا اضمر الدرهم على قول الشاعر: له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير إذا وقع ذلك قافية فقال: لا يجوز ذلك في هذه المسألة وإن جاز في غيرها لا لشيء يرجع إلى نفس حذف الواو من قوله: كأنه صوت حاد لأن هذا أمر قد شاع عنهم وتعولمت فيه لغتهم بل لقرينة انضمت إليه ليست مع ذلك ألا ترى أنه كان يلزمك على ذلك أن تقول: أعطيتهه خلافاً على قول الجماعة: أعطيتهوه.
فإن جعل الهاء الأولى روياً والأخرى وصلا لم يجز ذلك لأن الأولى ضمير والتاء متحركة قبلها وهاء الضمير لا تكون روياً إذا تحرك ما قبلها.
فإن قلت: أجعل الثانية رويا فكذلك أيضاً لأن الأولى قبلها متحركة.
فإن قلت: أجعل التاء روياً والهاء الأولى وصلا قيل: فما تصنع بالهاء الثانية أتجعلها خروجاً هذا محال لأن الخروج لا يكون إلا أحد الأحرف الثلاثة: الألف والياء والواو.
فإذا أداك تركيب هذه المسئلة في القافية إلى هذا الفساد وجب ألا يجوز ذلك أصلاً.
فأما في غير القافية فتتابعة جائز.
هذا محصول معنى أبي علي فأما نفس لفظه فلا يحضرني الآن حقيقة صورته.
وإذا كان كذلك وجب إذا وقع نحو هذا قافية أن تراجع فيه اللغة الكبرى فيقال: أعطيتهوه البتة فتكون الواو ردفاً والهاء بعدها روياً وجاز أن يكون بعد الواو روياً لسكون ما قبلها.
ومثل ذلك في الامتناع أن تضمر زيداً من قولك: هذه عصا زيد على قول من قال: وأشرب الماء ما بي نحوه عطشٌ إلا لأن عيونه سيل واديها لأنه كان يلزمك على هذا أن تقول: هذه عصاه فتجمع بين ساكنين في الوصل فحينئذ ما تضطر إلى مراجعة لغة من حرك الهاء في نحو هذا بالضمة وحدها أو بالضمة والواو بعدها فتقول: هذه عصاه فاعلم أو عصا هو فاعلم على قراءة من قرأ خذوهو فغلوهو وفألقى عصاهو ونحوه.
ونحو من ذلك أن يقال لك: كيف تضمر زيداً من قولك: مررت بزيد وعمرو فلا يمكنك أن تضمره هنا والكلام على هذا النضد حتى تغيره فتقول: مررت به وبعمرو فتزيد حرف الجر لما أعقب الإضمار من العطف على المضمر المجرور بغير إعادة الجار.
وكذلك لو قيل لك: كيف تضمر اسم الله تعالى في قولك: والله لأقومن ونحوه لم يجز لك حتى تأتي بالباء التي هي الأصل فتقول: به لأقومن كما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: ألا نادت أمامة باحتمال لتحزنني فلا بك ما أبالي وكإنشاده أيضاً: رأى برقاً فأوضع فوق بكر فلا بك ما أسال ولا أغاما وكذلك لو قيل لك: أضمر ضارباً وحده من قولك: هذا ضارب زيداً لم يجز لأنه كان يلزمك عليه أن تقول: هذا هو زيداً فتعمل المضمر وهذا مستحيل.
فإن قلت فقد تقول: قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح فتعمل في اليوم هو قيل: في هذا أجوبة: أحدها أن الظرف يعمل فيه الوهم مثلا كذا عهد إلي أبو علي رحمه الله في هذا.
وهذا لفظه لي فيه البتة.
والآخر أنه يجوز في المعطوف مالا يجوز في المعطوف عليه.
ولا تقول على هذا: ضربك زيداً حسن وهو عمرا قبيح لأن الظرف يجوز فيه من الاتساع ما لا يجوز في غيره.
وثالث: وهو أنه قد يجوز أن يكون اليوم من قولك: قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح ظرفا لنفس قبيح يتناوله فيعمل فيه.
نعم وقد يجوز أن يكون أيضاً حالاً للضمير الذي في قبيح فيتعلق حينئذ بمحذوف.
نعم وقد يجوز أن يكون أيضاً حالاً للضمير الذي في قبيح فيتعلق حينئذ بمحذوف.
نعم وقد يجوز أن يكون أيضاً حالاً من هو وإن تعلق بما العامل فيه قبيح لأنه قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الحال.
نحو قول الله تعالى {وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً} فالحال ههنا من الحق والعامل فيه " هو " وحده أو " هو " والابتداء الرافع له.
وكلاذينك لا ينصب الحال.
وإنما جاز أن يعمل في الحال غير العامل في صاحبها من حيث كانت ضرباً من الخبر والخبر العامل فيه غير العامل في المخبر عنه.
فقد عرفت بذلك فرق ما بين المسئلتين.
وكذلك لو قيل لك: أضمر رجلاً من قولك: رب رجل مررت به لم يحز لأنك تصير إلى أن تقول: ربه مررت به فتعمل رب في المعرفة.
فأما قولهم: ربه رجلاً وربها امرأة فإنما جاز ذلك لمضارعة هذا المضمر للنكرة إذ كان إضماراً على غير تقدم ذكر ومحتاجاً إلى التفسير فجرى تفسيره مجرى الوصف له.
فلما كان المضمر لا يوصف ولحق هذا المضمر من التفسير ما يضارع الوصف خرج بذلك عن حكم الضمير.
وهذا واضح.
نعم ولو قلت: ربه مررت به لوصفت المضمر والمضمر لا يوصف.
وأيضاً فإنك كنت تصفه بالجملة وهي نكرة والمعرفة لا توصف بالنكرة.
أفلا ترى إلى ما كان يحدث هناك من خبال الكلام وانتقاض الأوضاع.
فالزم هذه المحجة.
فمتى كان التصرف في الموضع ينقض عليك أصلاً أو يخالف بك مسموعاً مقيساً فالغه ولا
يسمع من العربي الفصيح
باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح لا يسمع من غيره
وذلك ما جاء به ابن أحمر في تلك الأحرف المحفوظة عنه.
قال أحمد بن يحيى: حدثني بعض أصحابي عن الأصمعي أنه ذكر حروفاً من الغريب فقال: لا أعلم أحداً أتى بها إلا ابن أحمر الباهلي.
منها الجبر وهو الملك.
وإنما سمى بذلك أظن لأنه يجبر بجوده.
وهو قوله: اسلم براووق حبيت به وانعم صباحا أيها الجبر ومنها قوله: كأس رنوناة أي دائمة وذلك قوله: بنت عليه الملك أطنابها كأس رنوناةٌ وطرف طمر ومنها الديدبون وهو قوله: خلوا طريق الديدبون وقد فات الصبا وتنوزع الفخر ومنها مارية أي لؤلؤية لونها لون اللؤلؤ.
ومنها قوله البابوس وهو أعجمي يعني ولد ناقته.
وذلك قوله: حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا فما حنينك أم ما أنت والذكر وإنما العيش بربانه وأنت من أفنانه مقتفر ومنها المأنوسة وهي النار وذلك قوله: كما تطاير عن مأنوسة الشرر قال أبو العباس أحمد بن يحيى أيضاً: وأخبرنا أبو نصر عن الأصمعي قال: من قول ابن أحمر الحيرم وهو البقر ما جاء به غيره.
انتهت الحكاية.
وقد أنشد أبو زيد: كأنها بنقا العزاف طاوية لما انطوى بطنها واخروط السفر مارية لؤلؤان اللون أودها طل وبنس عنها فرقد خصر وقال: المارية: البقرة الوحشية.
وقوله.
بنس عنها هو من النوم غير أنه إنما يقال للبقر.
ولم سيند أبو زيد هذين البيتين إلى ابن أحمر ولا هما أيضاً في ديوانه ولا أنشدهما الأصمعي فيما أنشده من الأبيات التي أورد فيها كلماته.
وينبغي أن يكون ذلك شيئاً جاء به غير ابن أحمر تابعاً له فيه ومتقيلاً أثره.
هذا أوفق لقول الأصمعي: إنه لم يأت به غيره من أن يكون قد جاء به غير متبع أثره.
والظاهر أن يكون ما أنشده أبو زيد لم يصل إلى الأصمعي لا من متبع فيه ابن أحمر ولا غير متبع.
وجاء في شعر أمية الثغرور ولم يأت به غيره.
والقول في هذه الكلم المقدم ذكرها وجوب قبولها.
وذلك لما ثبتت به الشهادة من فصاحة ابن أحمر.
فإما أن يكون شيئاً أخذه عمن ينطق بلغة قديمة لم يشارك في سماع ذلك منه على حد ما قلناه فيمن خالف الجماعة وهو فصيح كقوله في الذرحرح: الذرحرح ونحو ذلك وإما أن يكون شيئاً ارتجله ابن أحمر فإن الأعرابي إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به فقد حكى عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسمعاها ولا سبقا إليها.
وعلى نحو من هذا قال أبو عثمان: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب.
وقد تقدم نحو ذلك.
وفي هذا الضرب غار أبو علي في إجازته أن تبنى اسماً وفعلاً وصفة ونحو ذلك من ضرب فتقول: ضربب زيد عمرا وهذا رجل ضربب وضرنبي ومررت برجل خرجج وهذا رجل خرجج ودخلخل وخرجج أفضل من ضربب ونحو ذلك.
وقد سبق القول على مراجعتي إياه في هذا المعنى وقولي له: أفترتجل اللغة ارتجالاً وما كان من جوابه في ذلك.
وكذلك إن جاء نحو هذا الذي رويناه عن ابن أحمر عن فصيح آخر غيره كانت حاله فيه حاله.
لكن لو جاء شيء من لك عن ظنين أو متهم أو من لم ترق به فصاحته ولا سبقت إلى الأنفس ثقته كان مردوداً غير متقبل.
فإن ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامها فإنه لا يقنع في قبوله أن تسمعه من الواحد ولا من العدة القليلة إلا أن يكثر من ينطق به منهم.
فإن كثر قائلوه إلا أنه مع هذا ضعيف الوجه في القياس فإن ذلك مجازه وجهان: أحدهما أن يكون من نطق به لم يحكم قياسه على لغة آبائهم وإما أن تكون أنت قصرت عن استدراك وجه صحته.
ولا أدفع أيضاً مع هذا أن يسمع الفصيح لغة غيره مما ليس فصيحاً وقد طالت عليه وكثر لها استماعه فسرت في كلامه ثم تسمعها أنت منه وقد قويت عندك في كل شيء من كلامه غيرها فصاحته فيستهويك ذلك إلى أن تقبلها منه على فساد أصلها الذي وصل إليه منه.
وهذا موضع متعب مؤذ يشوب النفس ويشرى اللبس إلا أن هذا كأنه متعدر ولا يكاد يقع مثله.
وذلك أن الأعرابي الفصيح إذا عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها ولم يبهأ بها.
سألت مرة الشجري أبا عبد الله ومعه ابن عم له دونه في فصاحته وكان اسمع غصنا فقلت لهما: كيف تحقران حمراء فقالا: حميراء.
قلت: فسوداء قالا: سويداء.
وواليت من ذلك أحرفا وهما يجيئان بالصواب.
ثم دسست في ذلك علباء فقال غصن: عليباء وتبعه الشجري.
فلما هم بفتح الباء تراجع كالمذعور ثم قال: آه! عليبي ورام الضمة في الياء.
فكانت تلك عادة له إلا أنهم أشد استنكاراً لزيغ الإعراب منهم لخلاف اللغة لأن بعضهم قد ينطق بحضرته بكثير من اللغات فلا ينكرها.
إلا أن أهل الجفاء وقوة الفصاحة يتناكرون خلاف اللغة تناكرهم زيع الإعراب ألا ترى أن أبا مهدية سمع رجلاً من العجم يقول لصاحبه زوذ فسأل أبو مهدية عنها فقيل له: يقول له: اعجل فقال أبو مهدية: فهلا قال له: حيهلك.
فقيل له: ما كان الله ليجمع لهم إلى العجمية العربية.
وحدثني المتنبي أنه حضرته جماعة من العرب منصرفه من مصر وأحدهم يصف بلدة واسعة فقال في كلامه: تحير فيها العيون قال: وآخر من الجماعة يحي إليه سراً ويقول له: تحار تحار.
والحكايات في هذا المعنى كثيرة منبسطة.
ومن بعد فأقوى القياسين أن يقبل ممن شهرت فصاحته ما يورده ويحمل أمره على ما عرف من حاله لا على ما عسى أن يكون من غيره.
وذلك كقبول القاضي شهادة من ظهرت عدالته وإن كان يجوز أن يكون الأمر عند الله بخلاف ما شهد به ألا تراه يمضي الشهادة ويقطع بها وإن لم يقع العلم بصحتها لأنه لم يؤخذ بالعمل بما عند الله إنما أمر بحمل الأمور على ما تبدو وإن كان في المغيب غيره.
فإن لم تأخذ بها دخل عليك الشك في لغة من تستفصحه ولا تنكر شيئاً من لغته مخافة أن يكون فيها بعض ما يخفى عليك فيعترض الشك على يقينك وتسقط بكل اللغات ثقتك.
ويكفي من هذا ما تعلمه من بعد لغة حمير من لغة ابني نزار.
روينا عن الأصمعي أن رجلاً من العرب دخل على ملك ظفار وهي مدينة لهم يجيء منها الجزع الظفاري فقال له الملك: ثب وثب بالحميرة: اجلس فوثب الرجل فانتدقت رجلاه فضحك الملك وقال لست عندنا عربيت من دخل ظفار حمر أي تكلم بكلام حمير.
فإذا كان كذلك جاز جوازاً قريباً كثيراً أن يدخل من هذه اللغة في لغتنا وإن لم يكن لها فصاحتنا غير أنها لغة عربية قديمة.
أوضعت هذه اللغة في وقت واحد باب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منها بفارط قد تقدم في أول الكتاب القول على اللغة: أتواضع هي أم إلهام.
وحكينا وجوزنا فيها الأمرين جميعاً.
وكيف تصرفت الحال وعلى أي الأمرين كان ابتداؤها فإنها لا بد أن يكون وقع في أول الأمر بعضها ثم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه لحضور الداعي إليه فزيد فيها شيئاً فشيئاً إلا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه وتأليفه وإعرابه المبين عن معانيه لا يخالف الثاني الأول ولا الثالث الثاني كذلك متصلاً متتابعاً.
وليس أحد من العرب الفصحاء إلا يقول: إنه يحكى كلام أبيه وسلفه ويتوارثونه آخر عن أول وتابع عن متبع.
وليس كذلك أهل الحضر لأنهم يتظاهرون بينهم بأنهم قد تركوا وخالفوا كلام من ينتسب إلى اللغة العربية الفصيحة.
غير أن كلام أهل الحضر مضاه لكلام فصحاء العرب في حروفهم وتأليفهم إلا أنهم أخلوا بأشياء من إعراب الكلام الفصيح.
وهذا رأي أبي الحسن وهو الصواب.
وذهب إلى أن اختلاف لغات العرب إنما أتاها من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف وإن كان كله مسوقاً على صحة وقياس ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفاً وإن كان كل واحد آخذا من صحة القياس حظاً.
ويجوز أيضاً أن يكون الموضوع الأول ضرباً واحداً ثم رأى من جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جار في الصحة مجرى الأول.
ولا يبعد عندي ما قال من موضعين: أحدهما سعة القياس وإذا كان كذلك جازت فيه أوجه لا وجهان اثنان.
والآخر أنه كان يجوز أن يبدأ الأول بالقياس الذي عدل إليه الثاني فلا عليك أيهما تقدم وأيهما تأخر.
فهذا طريق القول على ابتداء بعضها ولحاق بعضها به.
فأما أي الأجناس الثلاثة تقدم أعني الأسماء والأفعال والحروف فليس مما نحن عليه في شيء وإنما كلامنا هنا: هل وقع جميعها في وقت واحد أم تتالت وتلاحقت قطعة قطعة وشيئاً بعد شيء وصدراً بعد صدر.
وإذ قد وصلنا من القول في هذا إلى ها هنا فلنذكر ما عندنا في مراتب الأسماء والأفعال والحروف فإنه من أماكنه وأوقاته.
اعلم أن أبا علي رحمه الله كان يذهب إلى أن هذه اللغة أعني ما سبق منها ثم لحق به ما بعده إنما وقع كل صدر منها في زمان واحد وإن كان تقدم شيء منها على صاحبه فليس بواجب أن يكون المتقدم على الفعل الاسم ولا أن يكون المتقدم على الحرف الفعل وإن كانت رتبة الاسم في النفس من حصة القوة والضعف أن يكون قبل الفعل والفعل قبل الحرف.
وإنما يعني القوم بقولهم: إن الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى في النفس وأسبق في الاعتقاد من الفعل لا في الزمان.
فأما الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل.
ويجوز أن يكونوا قدموا الفعل في الوضع قبل الاسم وكذلك الحرف.
وذلك أنهم وزنوا حينئذ أحوالهم وعرفوا مصاير أمورهم فعلموا أنهم محتاجون إلى العبارات عن المعاني وأنها لا بد لها من الأسماء والأفعال والحروف فلا عليهم بأيها بدءوا أبالاسم أم بالفعل أم بالحرف لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بهن جمع إذا المعاني لا تستغني عن واحد منهن.
هذا مذهب أبي علي وبه كان يأخذ ويفتي.
وهذا يضيق الطريق على أبي إسحاق وأبي بكر في اختلافهما في رتبة الحاضر والمستقبل.
وكان أبو الحسن يذهب إلى أن ما غير لكثرة استعماله إنما تصورته العرب قبل وضعه وعلمت أنه لا بد من كثرة استعمالها إياه فابتدءوا بتغييره علماً بأن لا بد من كثرته الداعية إلى تغييره.
وهذا في المعنى كقوله: وقد كان أيضاً أجاز أن يكون قد كانت قديماً معربة فلما كثرت غيرت فيما بعد.
والقول عندي هو الأول لأنه أدل على حكمتها واشهد لها بعلمها بمصاير أمرها فتركوا بعض الكلام مبنياً غير معرب نحو أمس وهؤلاء وأين وكيف وكم وإذ واحتملوا ما لا يؤمن معه من اللبس لأنهم إذا خافوا ذلك زادوا كلمة أو كلمتين فكان ذلك أخف عليهم من تجشمهم اختلاف الإعراب واتقائهم الزيغ والزلل فيه ألا ترى أن من لا يعرب فيقول: ضرب أخوك لأبوك قد يصل باللام إلى معرفة الفاعل من المفعول ولا يتجشم خلاف الإعراب ليفاد منه المعنى فإن تخلل الإعراب من ضرب إلى ضرب يجري مجرى مناقلة الفرس ولا يقوى على ذلك من الخيل إلا الناهض الرجيل دون الكودن الثقيل قال جرير: من كل مشترف وإن بعد المدى ضرم الرفاق مناقل الأجرال ويشهد للمعنى الأول أنهم قالوا: اقتل فضموا الأول توقعاً للضمة تأتي من بعد.
وكذلك قالوا: عظاءة وصلاءة وعباءة فهمزوا مع الهاء توقعاً لما سيصيرون إليه من طرح الهاء ووجوب الهمز عند العظاء والصلاء والعباء.
وعلى ذلك قالوا: الشيء منتن فكسروا أوله لآخره وهو منحدر من الجبل فضموا الدال لضمة الراء.
وعليه قالوا: هو يجوءك وينبؤك فأثر المتوقع لأنه كأنه حاضر.
وعلى ذلك قالوا: امرأة شمباء وقالوا: العمبر ونساء شمب فأبدلوا النون ميماً مما يتوقع من مجيء الباء بعدها.
وعليه أيضاً أبدلوا الأول للآخر في الإدغام نحو مرأيت واذهفى ذلك واصحمطرا.
فهذا كله وما يجري مجراه مما يطول ذكره يشهد لأن كل ما يتوقع إذا ثبت في النفس كونه كان كأنه حاضر مشاهد.
فعلى ذلك يكونون قدموا بناء نحوكم وكيف وحيث وقبل وبعد علماً بأنهم سيستكثرون فيما بعد منها فيجب لذلك تغييرها.
فإن قلت: هلا ذهبت إلى أن الأسماء أسبق رتبة من الأفعال في الزمان كما أنها أسبق رتبة منها في الاعتقاد واستدللت على ذلك بأن الحكمة قادت إليه إذ كان الواجب أن يبدءوا بالأسماء لأنها عبارات عن الأشياء ثم يأتوا بعدها بالأفعال التي بها تدخل الأسماء في المعاني والأحوال ثم جاءوا فيما بعد بالحروف لأنك تراها لواحق بالجمل بعد تركبها واستقلالها بأنفسها نحو إن زيداً أخوك وليت عمرا عندك وبحسبك أن تكون كذا قيل يمنع من هذا أشياء: منها وجودك أسماء مشتقة من الأفعال نحو قائم من قام ومنطلق من انطلق ألا تراه يصح لصحته ويعتل لاعتلاله نحو ضرب فهو ضارب وقام فهو قائم وناوم فهو مناوم.
فإذا رأيت بعض الأسماء مشتقاً من الفعل فكيف يجوز أن يعتقد سبق الاسم للفعل في الزمان وقد رأيت الاسم مشتقاً منه ورتبة المشتق منه أن يكون أسبق من المشتق نفسه.
وأيضاً فإن المصدر مشتق من الجوهر كالنبات من النبت وكالاستحجار من الحجر وكلاهما اسم.
وأيضاً فإن المضارع يعتل لاعتلال الماضي وإن كان أكثر الناس على أن المضارع أسبق من الماضي.
وأيضاً فإن كثيراً من الأفعال مشتق من الحروف نحو قولهم: سألتك حاجة فلوليت لي أي قلت لي: لولا وسألتك حاجة فلاليت لي أي قلت لي: لا.
واشتقوا أيضاً المصدر وهو اسم من الحرف فقالوا: اللالاة واللولاة وإن كان الحرف متأخراً في الرتبة عن الأصلين قبله: الاسم والفعل.
وكذلك قالوا: سوفت الرجل أي قلت له: سوف وهذا فعل كما ترى مأخوذ من الحرفز ومن أبيات الكتاب: لو ساوفتنا بسوفٍ من تحيتها سوف العيوف لراح الركب قد قنع انتصب سوف العيوف على المصدر المحذوف الزيادة أي مساوفة العيوف.
وأنا أرى أن جميع تصرف " ن ع م " إنما هو من قولنا في الجواب: نعم.
من ذلك النعمة والنعمة والنعيم والتنعيم ونعمت به بالا وتنعم القوم والنعمى والنعماء وأنعمت به له وكذلك البقية.
وذلك أن نعم أشرف الجوابين وأسرهما للنفس وأجلبهما للحمد ولا بضدها ألا ترى إلى قوله: وإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح الوعد إن الخلف ذم وقال الآخر أنشدناه أبو علي: أبي جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجوع قاتله يروى بنصب البخل وجره.
فمن نصبه فعلى ضربين: أحدهما أن يكون بدلاً من لا لأن لا موضوعة للبخل فكأنه قال: أبي جوده البخل والآخر أن تكون لا زائدة حتى كأنه قال أبي جوده البخل لا على البدل لكن على زيادة لا.
والوجه هو الأول لأنه قد ذكر بعدها نعم ونعم لا تزاد فكذلك ينبغي أن تكون لا ههنا غير زائدة.
والوجه الآخر على الزيادة صحيح أيضاً لجرى ذكر لا في مقابلة نعم.
وإذا جازا للا أن تعمل وهي زائدة فيما أنشده أبو الحسن من قوله: لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إلي لامت ذوو أحسابها عمراً كان الاكتفاء بلغظها من غير عمل له أولى بالجواز.
ومن جره فقال لا البخل فبإضافة لا إليه لأن لا كما تكون للبخل قد تكون للجود أيضاً ألا ترى أنه لو قال لك إنسان: لا تطعم الناس ولا تقر الضيف ولا تتحمل المكارم فقلت أنت: لا لكانت هذه اللفظة هنا للجود لا للبخل فلما كانت لا قد تصلح للأمرين جميعاً أضيفت إلى البخل لما في ذلك من التخصيص الفاصل بين المعنيين الضدين.
فإن قلت: فكيف تضيفها وهي مبنية ألا تراها على حرفين الثاني حرف لين وهذا أدل شيء على البناء قيل: الإضافة لا تنافي البناء بل لو جعلها جاعل سبباً له لكان أعذر من أن يجعلها نافية له ألا ترى أن المضاف بعض الاسم وبعض الاسم صوت والصوت واجب بناؤه.
فهذا من طريق القياس وأما من طريق السماع فلأنهم قد قالوا: كم رجل قد رأيت فكم مبنية وهي مضافة.
وقالوا أيضاً: لأضربن أيهم أفضل وهي مبنية عند سيبويه.
فهذا شيء عرض قلنا فيه.
ثم لنعد إلى ما كنا عليه من أن جميع باب " ن ع م " إنما هو مأخوذ من نعم لما فيها من المحبة للشيء والسرور به.
فنعمت الرجل أي قلت له نعم فنعم بذلك بالا كما قالوا: بجلته أي قلت له بجل أي حسبك حيث انتهيت فلا غاية من بعدك ثم اشتقوا منه الشيخ البجال والرجل البجيل.
فنعم وبجل كما ترى حرفان وقد اشتق منهما أحرف كثيرة.
فإن قلت: فهلا كان نعم وبجل مشتقين من النعمة والنعيم والبجال والبجيل ونحو ذلك دون أن يكون كل ذلك مشتقاً منهما قيل: الحروف يشتق منها ولا تشتق هي أبداً.
وذلك أنها لما جمدت فلم تتصرف شابهت بذلك أصول الكلام الأول التي لا تكون مشتقة من شيء لأنه ليس قبلها ما تكون فرعاً له ومشتقة منه يؤكد ذلك عندك قولهم: سألتك حاجة فلوليت لي أي قلت لي لولا فاشتقوا الفعل من الحرف المركب من لو و لا فلا يخلو هذا أن يكون لو هو الأصل أو لولا لا يجوز أن يكون لولا لأنه لو كان لولا هو الأصل كان لو محذوفاً منه والأفعال لا تحذف إنما تحذف الأسماء نحو يدٍ ودمٍ وأخٍ وأب وما جرى مجراه وليس الفعل كذلك.
فأما خذ وكل ومر فلا يعتد إن شئت لقلته وإن شئت لأنه حذف تخفيفا في موضع وهو ثابت في تصريف الفعل نحو أخذ يأخذ وأخذ وآخذ.
فإن قلت: فكذلك أيضاً يدٌ ودمٌ وأخٌ وأبٌ وغدٌ وفمٌ ونحو ذلك ألا ترى أن الجميع تجده متصرفاً وفيه ما حذف منه وذلك نحو أيدٍ وأيادٍ ويدي ودماءٍ ودمي وأدماءٍ والدما في قوله فإذا هي بعظام ودما وإخوة وأخوة وآخاء وأخوان وآباء وأبوة وأبوان وغدواً بلاقع وأفواه وفويه وأفوه وفوهاء وفوه قيل: هذا كله إن كان قد عاد في كل تصرف منه ما حذف من الكلمة التي هي من أصله فدل ذلك على محذوفه فليست الحال فيه كحال خذ من أخذ ويأخذ.
وذلك أن أمثلة الفعل وإن اختلفت في أزمنتها وصيغها فإنها تجري مجرى المثال الواحد حتى إنه إذا حذف من بعضها شيء عوض منه في مثال آخر من أمثلته ألا ترى أنهم لما حذفوا همزة يكرم ونحوه عوضوه منها أن أوجدوها في مصدره فقالوا: إكراماً.
وكذلك بقية الباب.
وليس كذلك الجمع والواحد ولا التكبير والتصغير من الواحد لأنه ليس كل واحد من هذه المثل جارياً مجرى صاحبه فيكون إذا حذف من بعضها شيء ثم وجد ذلك المحذوف في صاحبه كان كأنه فيه وأمثلة الفعل إذا حذف من أحدها شيء ثم وجد ذلك المحذوف في صاحبه فإن قلت: فقد نجد بعض ما حذف في الأسماء موجوداً في الأفعال من معناها ولفظها.
وذلك نحو قولهم في الخبر: أخوت عشرة وأبوت عشرة وأنشدنا أبو علي عن الرياشي: وبشرة يأبونا كأن خباءنا جناح سماني في السماء تطير وقالوا أيضاً: يديت إليه يداً وأيديت ودميت تدمى دمى وغدوت عليه وفهت بالشيء وتفوهت به.
فقد استعملت الأفعال من هذه الكلم كما استملت فيما أوردته.
قيل: وهذا أيضاً ساقط عنا وذلك أنا إنما قلنا: إن هذه المثل من الأفعال تجري مجرى المثال الواحد لقيام بعضها قيام بعض واشتراكها في اللفظ.
وليس كذلك أب وأخ ونحوهما ألا ترى أن أب ليس بمثال من أمثلة الفعل ولا باسم فاعل ولا مصدر ولا مفعول فيكون رجوع المحذوف منه في أبوت كأنه موجود في أب وإنما أب من أبوت كمدق ومكحلة من دققت وكحلت.
وكذلك القول في أخٍ ويدٍ ودمٍ وبقية تلك الأسماء.
فهذا فرق.
فقد علمت بما قدمناه وهضبنا فيه قوة تداخل الأصول الثلاثة: الاسم والفعل والحرف وتمازجها وتقدم بعضها على بعض تارة وتأخرها عنه أخرى.
فلهذا ذهب أبو علي رحمه الله إلى أن هذه اللغة وقعت طبقة واحدة كالرقم تضعه على المرقوم والميسم يباشر به صفحة الموسوم لا يحكم لشيء منه بتقدم في الزمان وإن اختلفت بما فيه من الصنعة القوة والضعف في الأحوال.
وقد كثر اشتقاق الأفعال من الأصوات الجارية مجرى الحروف نحو هاهيت وحاحيت وعاعيت وجأجأت وحأحأت وسأسأت وشأشأت.
وهذا كثير في الزجر.
وقد كانت حضرتني وقتاً فيه نشطة فكتبت تفسير كثير من هذه الحروف في كتاب ثابت في الزجر فاطلبها في جملة ما أثبته عن نفسي في هذا وغيره.
باب في اللغة المأخوذة قياساً
هذا موضع كأن في ظاهره تعجرفاً وهو مع ذلك تحت أرجل الأحداث ممن تعلق بهذه الصناعة فضلاً عن صدور الأشياخ.
وهو أكثر من أن أحصيه في هذا الموضع لك لكني أنبهك على كثير من ذلك لتكثر التعجب ممن تعجب منه أو يستبعد الأخذ به.
وذلك أنك لا تجد مختصراً من العربية إلا وهذا المعنى منه في عدة مواضع ألا ترى أنهم يقولون في وصايا الجمع: إن ما كان من الكلام على فعل فتكسيره على أفعل ككلب وأكلب وكعب وأكعب وفرخ وأفرخ.
وما كان على غير ذلك من أبنية الثلاثي فتكسيره في القلة على أفعال نحو جبل وأجبال وعنق وأعناق وإبل وآبال وعجز وأعجاز وربع وأرباع وضلع وأضلاع وكبد وأكباد وقفل وأقفال وحمل وأحمال.
فليت شعري هل قالوا هذا ليعرف وحده أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره ألا تراك لو لم تسمع تكسير واحد من هذه الأمثلة بل سمعته منفرداً أكنت تحتشم من تكسيره على ما كسر عليه نظيره.
لا بل كنت تحمله عليه للوصية التي تقدمت لك في بابه.
وذلك كأن يحتاج إلى تكسير الرجز الذي هو العذاب فكنت قائلاً لا محالة: أرجاز قياساً على أحمال وإن لم تسمع أرجازا في هذا المعنى.
وكذلك لو احتجت إلى تكسير عجر من قولهم: وظيف عجر لقلت: أعجار قياساً على يقظ وأيقاظ وإن لم تسمع أعجارا.
وكذلك لو احتجت إلى تكسير شبع بأن توقعه على النوع لقلت: أشباع وإن لم تسمع ذلك لكنك سمعت نطع وأنطاع وضلع وأضلاع.
وكذلك لو احتجت إلى تكسير دمثر لقلت: دماثر قياساً على سبطر وسباطر.
وكذلك قولهم: إن كان الماضي على فعل فالمضارع منه على يفعل فلو أنك على هذا سمعت ماضياً على فعل لقلت في مضارعه: يفعل وإن لم تسمع ذلك كأن يسمع سامع ضؤل ولا يسمع مضارعه فإنه يقول فيه: يضؤل وإن لم يسمع ذلك ولا يحتاج أن يتوقف إلى أن يسمعه لأنه لو كان محتاجاً إلى ذلك لما كان لهذه الحدود والقوانين التي وضعها المتقدمون وتقبلوها وعمل بها المتأخرون معنى يفاد ولا عرض ينتحيه الاعتماد ولكان القوم قد جاءوا بجميع المواضي والمضارعات وأسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر وأسماء الأزمنة والأمكنة والآحاد والتثاني والجموع والتكابير والتصاغير ولما أقنعهم أن يقولوا: إذا كان الماضي كذا وجب أن يكون مضارعه كذا واسم فاعله كذا واسم مفعوله كذا واسم مكانه كذا واسم زمانه كذا ولا قالوا: إذا كان المكبر كذا فتصغيره كذا وإذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا دون أن يستوفوا كل شيء من ذلك فيوردوه لفظاً منصوصاً معيناً لا مقيساً ولا مستنبطاً كغيره من اللغة التي لا تؤخذ قياساً ولا تنبيهاً نحو دار وباب وبستان وحجر وضبع وثعلب وخزز لكن القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه على ضربين: أحدهما ما لا بد من تقبله كهيئته لا بوصية فيه ولا تنبيه عليه نحو حجر ودار وما تقدم ومنه ما وجدوه يتدارك بالقياس وتخف الكلفة في علمه على الناس فقننوه وفصلوه إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب المغنى عن المذهب الحزن البعيد.
وعلى ذلك قدم الناس في أول المقصور والممدود ما يتدارك بالقياس والأمارات ثم أتلوه ما لا بدله من السماع والروايات فقالوا: المقصور من حاله كذا ومن صفته كذا والممدود من أمره كذا ومن سببه كذا وقالوا في المذكر والمؤنث: علامات التأنيث كذا وأوصافها كذا ثم لما أنجزوا ذلك قالوا: ومن المؤنث الذي روى رواية كذا وكذا.
فهذا من الوضوح على ما لا خفاء به.
فلما رأى القوم كثيراً من اللغة مقيساً منقاداً وسموه بمواسمه وغنوا بذلك عن الإطالة والإسهاب فيما ينوب عنه الاختصار والإيجاز.
ثم لما تجاوزوا ذلك إلى ما لا بد من إيراده ونص ألفاظه التزموا وألزموا كلفته إذ لم يجدوا منها بداً ولا عنها منصرفاً.
ومعاذ الله أن ندعي أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة قياساً لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به ونبهنا عليه كما فعله من قبلنا ممن نحن له متبعون وعلى مثله وأوضاعه حاذون فأما هجنة الطبع وكدورة الفكر وخمود النفس وخيس الخاطر وضيق المضطرب فنحمد الله على أن حماناه ونسأله سبحانه أن يبارك لنا فيما آتاناه ويستعملنا به فيما يدني منه ويوجب الزلفة لديه بمنه.
فهذا مذهب العلماء بلغة العرب وما ينبغي أن يعمل عليه ويؤخذ به فأمضه على ما أريناه وحددناه غير هائب له ولا مرتاب به.
وهو كثير وفيما جئنا به منه كاف.
باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية
ولنبدأ من ذلك بذكر الثلاثي منفرداً بنفسه ثم مداخلاً لما فوقه.
اعلم أن الثلاثي على ضربين: أحدهما ما يصفو ذوقه ويسقط عنك التشكك في حروف أصله كضرب وقتل وما تصرف منهما.
فهذا ما لا يرتاب به في جميع تصرفه نحو ضارب ويضرب ومضروب وقاتل وقتال واقتتل القوم واقتل ونحو ذلك.
فما كان هكذا مجرداً واضح الحال من الأصول فإنه يحمي نفسه وينفي الظنة عنه.
والآخر أن تجد الثلاثي على أصلين متقاربين والمعنى واحد فههنا يتداخلان ويوهم كل واحد منهما كثيراً من الناس أنه من أصل صاحبه وهو في الحقيقة من أصل غيره وذلك كقولهم: شيء رخو ورخود.
فهما كما ترى شديدا التداخل لفظاً وكذلك هما معنى.
وإنما تركيب رخو من رخ و وتركيب رخود من رخ د وواو رخود زائدة وهو فعول كعلود وعسود والفاء والعين من رخو ورخود متفقتان لكن لاماهما مختلفتان.
فلو قال لك قائل: كيف تحقر رخوداً على حذف الزيادة لقلت: رخيد بحذف الواو وإحدى الدالين.
ولو قال لك: كيف تبني من رخو مثل جعفر لقلت رخوى ومن رخود: رخدد أفلا ترى إلى ازدحام اللفظين مع تماس المعنيين وذلك أن الرخو الضعيف والرخود المتثني والتثني عائد إلى معنى الضعف فلما كانا كذلك أوقعا الشك لمن ضعف نظره وقل من هذا الأمر ذات يده.
ومن ذلك قولهم: رجل ضياط وضيطار.
فقد ترى تشابه الحروف والمعنى مع ذلك واحد فهو أشد لإلباسه.
وإنما ضياط من تركيب " ض ي ط " وضيطار من تركيب " ض ط ر ".
ومنه قول جرير: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى! لو لا الكمى المقنعا فضياط يحتمل مثاله ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون فعالاً كخياط ورباط والآخر أن يكون فيعالاً كخيتام وغيداق والثالث أن يكون فوعالاً كتوراب.
فإن قلت: إن فوعالا لم يأت صفة قيل اللفظ يحتمله وإن كانت اللغة تمنعه.
ومن ذلك لوقة وألوقة وصوص وأصوص وينجوج وألنجوج ويلنجوج وضيف وضيفن في قول أبي زيد.
ومن ذلك حية وحواء فليس حواء من لفظ حية كعطار من العطر وقطان من القطن بل حية من لفظ " ح ي ي " من مضاعف الياء وحواء من تركيب " ح و ى " كشواء وطواء.
ويدل على أن الحية من مضاعف الياء ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم في الإضافة إلى حية بن بهدلة: حيوى.
فظهور الياء عيناً في حيوى قد علمنا منه كون العين ياء وإذا كانت العين ياء واللام معتلة فالكلمة من مضاعف الياء البتة ألا ترى أنه ليس في كلامهم نحو حيوت.
وهذا واضح.
ولولا هذه الحكاية لوجب أن تكون الحية والحواء من لفظ واحد لضربين من القياس: أما أحدهما فلأن فعالا في المعاناة إنما يأتي من لفظ المعاني نحو عطار من العطر وعصاب من العصب.
وأما الآخر فلأن ما عينه واو ولامه ياء أكثر مما عينه ولامه ياءان ألا ترى أن باب طويب وشويت أكثر من باب حييت وعييت.
وإذ كان الأمر كذلك علمت قوة السماع وغلبته للقياس ألا ترى أن سماعاً واحداً غلب قياسين اثنين.
نعم وقد يعرض هذا التداخل في صنعة الشاعر فيرى أو يرى أنه قد جنس وليس في الحقيقة تجنيساً وذلك كقول القطامي: مستحقبين فؤادا ما له فاد ففؤاد من لفظ " ف أ د " وفاد من تركيب " ف د ى " لكنهما لما تقاربا هذا التقارب دنوا من التجنيس.
وعليه قول الحمصي: وتسويف العدات من السوافي فظاهر هذا يكاد لا يشك أكثر الناس أنه مجنس وليس هو كذلك.
وذلك أن تركيب تسويف من " س و ف " وتركيب السوافي من " س ف ي " لكن لما وجد في كل واحد من الكلمتين سين وفاء وواو جرى في بادي السمع مجرى الجنس الواحد وعليه قال الطائي الكبير: ألحد حوى حية الملحدين! ولدن ثرى حال دون الثراء! فيمن رواه هكذا حوى حية الملحدين أي قاتل المشركين وكذلك قال في آخر البيت أيضاً: ولدن ثرى حال دون الثراء فجاء به مجيء التجنيس وليس على الحقيقة تجنيساً صحيحاً.
وذلك أن التجنيس عندهم أن يتفق اللفظان ويختلف أو يتقارب المعنيان كالعقل والمعقل والعقلة والعقيلة ومعقلة.
وعلى ذلك وضع أهل اللغة كتب الأجناس.
وليس الثرى من لفظ الثراء على الحقيقة وذلك أن الثرى وهو الندى من تركيب " ث ر و " لقولهم: التقى الثريان.
وأما الثراء لكثرة المال فمن تركيب " ث ر و " لأنه من الثروة ومنه الثريا لأنها من الثروة لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل.
ومنه قولهم: ثرونا بني فلان تثروهم ثروة إذا كنا أكثر منهم.
فاللفظان - كما ترى - مختلفان فلا تجنيس إذاً إلا للظاهر.
وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي في شرح المقصور والممدود عن ابن السكيت وأن الفراء تسمح في ذكر مثل هذا على اختلاف أصوله وأن عذره في ذلك تشابه اللفظين بعد القلب.
ومن ذلك قولهم: عدد طيس وطيسل.
فالياء في طيس أصل وتركيبه من " ط ي س " وهي في طيسل زائدة وهو من تركيب " ط س ل ".
ومثله الفيشة والفيشلة: حالهما في ذلك سواء.
وذهب سيبويه في عنسل إلى زيادة النون وأخذها من قوله: عسلان الذئب أمسى قارباً برد الليل عليه فنسل وذهب محمد بن حبيب في ذلك إلى أنه من لفظ العنس وأن اللام زائدة وذهب بها مذهب زيادتها في ذلك وأولالك وعبدل وبابه.
وقياس قول محمد ابن حبيب هذا أن تكون اللام في فيشلة وطيسل زائدة.
وما أراه إلا أضعف القولين لأن زيادة النون ثانية أكثر من زيادة اللام في كل موضع فكيف بزيادة النون غير ثانية.
وهو أكثر من أن أحصره لك.
فهذه طريق تداخل الثلاثي بعضه في بعض.
فأما تداخل الثلاثي والرباعي لتشابههما في أكثر الحروف فكثير منه قولهم: سبط وسبطر.
فهذان أصلان لا محالة ألا ترى أن أحداً لا يدعى زيادة الراء.
ومثله سواء دمث ودمثر وحبج وحبجر.
وذهب أحمد بن يحيى في قوله: يرد قلخاً وهديراً زغدبا إلى أن الباء زائدة وأخذه من زغد البعير يزغد زغداً في هديره.
وقوله: إن الباء زائدة كلام تمجه الآذان وتضيق عن احتماله المعاذير.
وأقوى ما يذهب إليه فيه أن يكون أراد أنهما أصلان مقتربان كسبط وسبطر.
وإن أراد ذلك أيضاً فإنه قد تعجرف.
ولكن قوله في أسكفة الباب: إنها من استكف الشيء أي انقبض أمر لا ينادي وليده روينا ذلك عنه.
وروينا عنه أيضاً أنه قال في تنور: إنه تفعول من النار.
وروينا عنه أيضاً أنه قال: الطيخ: الفساد قال: فهو من تواطخ القوم.
وسنذكر ذلك في باب سقطات العلماء بإذن الله.
ولكن من الأصلين المتداخلين: الثلاثي والرباعي قولهم: زرم وازرأم وخضل واخضأل وأزهر وازهأر وضفد واضفأد وزلم القوم وازلأموا وزغب الفرخ وازلغب.
ومنه قولهم: مبلع وبلعوم وحلق وحلقوم وشيء صلد وصلادم وسرطم وسرواط.
وقالوا للأسد: هرماس وحدثنا أبو علي عن الأصمعي أنه قال في هرماس: إنه من الهرس.
وحدثنا أيضاً أنهم يقولون: لبن ممارص.
وقالوا دلاص ودلامص ودمالص.
وأنشد ابن الأعرابي: فباتت تشتوي والليل داج ضماريط استها في غير نار ومن هذا أيضاً قولهم: بعير أشدق وشدقم.
وينبغي أن يكون جميع هذا من أصلين ثلاثي ورباعي.
وهو قياس قول أبي عثمان ألا تراه قال في دلامص: إنه رباعي وافق أكثره حروف الثلاثي كسبط وسبطر ولؤلؤ ولآل.
فلؤلؤ رباعي ولآل ثلاثي.
وقياس مذهب الخليل بزيادة الميم في دلامص أن تكون الميم في هذا كله زائدة وتكون على مذهب أبي عثمان أصلاً وتكون الكلم التي اعتقبت هذه الحروف عليها أصلين لا أصلاً واحداً.
نعم وإذا جاز للخليل أن يدعي زيادة الميم حشوا وهو موضع عزيز عليها فزيادتها آخرا أقرب مأخذاً لأنها لما تأخرت شابهت بتطرفها أول الكلمة الذي هو معان لها ومظنة منها.
فقياس قوله في دلامص: إنه فعامل أن يقول في دمالص: فماعل وكذلك في فمارص وأن يقول في بلعوم وحلقوم: إنه فعلوم لأن زيادة الميم آخراً أكثر منها أولاً ألا ترى إلى تلفيهم كل واحد من دلقم ودردم ودقعم وفسحم وزرقم وستهم ونحو ذلك بزيادة الميم في آخره.
ولم نر أبا عثمان خالف في هذا خلافه في دلامص.
وينبغي أن يكون ذلك لأن آخر الكلمة مشابه لأولها فكانت زيادة الميم فيه أمثل من زيادتها حشوا.
فأما ازرأم واضفاد ونحو ذلك فلا تكون همزته إلا أصلاً ولا تحملها على باب شأمل وشمأل لقلة ذلك.
وكذلك لام ازلغب هي أحرى أن تكون أصلاً.
ومن الأصلين الثلاثي والرباعي المتداخلين قولهم: قاع قرق وقرقر وقرقوس وقولهم: سلس وسلسل وقلق وقلقل.
وذهب أبو إسحاق في نحو قلقل وصلصل وجرجر وقرقر إلى أنه فعفل وأن الكلمة لذلك ثلاثية حتى كأن أبا إسحاق لم يسمع في هذه اللغة الفاشية المتشرة بزغد وزغدب وسبط وسبطر ودمث ودمثر وإلى قول العجاج: هذا مع قولهم وتر حبجر للقوى الممتلئ.
نعم وذهب إلى مذهب شاذ غريب في أصل منقاد عجيب ألا ترى إلى كثرته في نحو زلز وزلزل ومن أمثالهم توقرى يا زلزه فهذا قريب من قولهم: قد تزلزلت أقدامهم إذا قلقت فلم تثبت.
ومنه قلق وقلقل وهوة وهوهاءة وغوغاءٌ وغوغاءُ لأنه مصروفاً رباعي وغير مصروف ثلاثي.
ومنه رجل أدرد وقالوا: عض على دردره ودردوره.
ومنه صل وصلصل وعج وعجعج.
ومنه عين ثرة وثرثارة.
وقالوا: تكمكم من الكمة وحثحثت وحثثت ورقرقت ورققت قال الله تعالى: {فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ} وهذا باب واسع جداً ونظائره كثيرة: فارتكب أبو إسحاق مركباً وعزا وسحب فيه عدداً جماً وفي هذا إقدام وتعجرف.
ولو قال ذلك في حرف أو حرفين كما قال الخليل في دلامص بزيادة الميلم لكان أسهل لأن هذا شيء إنما احتمل القول به في كلمة عنده شاذة أو عزيزة النظير.
فأما الاقتحام بباب منقاد في مذهب متعاد ففيه ما قدمناه ألا ترى أن تكرير الفاء لم يأت به ثبت إلا في مرمريس وحكى غير صاحب الكتاب أيضاً مرمريت وليس بالبعيد أن تكون التاء بدلاً من السين كما أبدلت منها في ست وفيما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: يا قاتل الله بني السعلات عمرو بن يربوع شرار النات فأبدل السين تاء.
فإن قلت: فإنا نجد للمرمريت أصلاً يحتازه إليه وهو المرت قيل: هذا هو الذي دعانا إلى أن قلنا: إنه قد يجوز أن تكون التاء في مرمريت بدلاً من سين مرمريس.
ولولا أن معنا مرتا لقلنا فيه: إن التاء بدل من السين البتة كما قلنا ذلك في ست والنات وأكيات.
فإن قال قائل منتصراً لأبى إسحاق: لا ينكر أن يأتي في المعتل من الأمثلة ما لا يأتي في الصحيح نحو سيد وميت وقضاة ودعاة وقيدودة وصيرورة وكينونة وكذلك يجيء في المضاعف ما لا يأتي في غيره من تكرير الفاء.
بل إذا كانوا قد كرروها في مرمريت ومرمريس ولم نر في الصحيح فيعلا ولا فعلة في جمع فاعل ولا فيعلولا مصدراً كان ما ذهب إليه أبو إسحاق من تكرير الفاء في المضاعف أولى بالجواز وأجدر بالتقبل فهو قول غير أن الأول أقوى ألا ترى أن المضاعف لا ينتهي في الاعتلال إلى غاية الياء والواو وأن ما أعل منه في نحو ظلت ومست وظنت في ظننت وتقصيت تقضيت وتفضيت من الفضة وتسريت من السرية ليس شيء من إعلال ذلك ونحوه بواجب بل جميعه لو شئت لصححته وليس كذلك حديث الياء والواو والألف في الاعتلال بل ذلك فيها في عام أحوالها التي اعتلت فيها أمر واجب أو مستحسن في حكم الواجب أعني باب حاري وطائي وياجل وياءس وآية في قول سيبويه.
فإن قلت فقد قرأ الأعمش بعذاب بيئس فإنما ذاك لأن الهمزة وإن لم تكن حرف علة فإنها معرضة للعلة وكثيرة الانقلاب عن حروف العلة فأجريت بيئس عنده مجرى سيد وهين كما أجريت التجزئة مجرى التعزية في باب الحذف والتعويض وتابع أبو بكر البغداديين في أن الحاء الثانية في حثحثت بدل من ثاء وان أصل حثثت.
وكذلك قال في نحو ثرة وثرثارة: إن الأصل فيها ثرارة فأبدل من الراء الثانية ثاء فقالوا ثرثارة.
وكذلك طرد هذا الطرد.
وهذا وإن كان عندنا غلطا لإبدال الحرف مما ليس من مخرجه ولا مقارباً في المخرج له فإنه شق آخر من القول.
ولم يدع أبو بكر فيه تكرير الفاء وإنما هي عين أبدلت إلى لفظ الفاء فأما أن يدعى أنها فاء مكررة فلا.
فهذا طريق تزاحم الرباعي مع الثلاثي.
وهو كثير جداً فاعرفه وتوق حمله عليه أو خلطه به ومز كل واحد منهما عن صاحبه وواله دونه فإن فيه إشكالاً.
وأنشدني الشجري لنفسه: أناف على باقي الجمال ودففت بأنوار عشب مخضئل عوازبه وأما تزاحم الرباعي مع الخماسي فقليل.
وسبب ذلك قلة الأصلين جميعاً فلما قلاَّقلَّ ما يعرض من هذا الضرب فيهما إلا أن منه قولهم: ضبغطى وضبغطرى وقوله أيضاً: قد دردبت والشيخ دردبيس فدردبت رباعي ودردبيس خماسي.
ولا أدفع أن يكون استكره نفسه على أن بنى من كيف حال المثلين في الأصلية والزيادة باب في المثلين: كيف حالهما في الأصلية والزيادة وإذا كان أحدهما زائداً فأيهما هو اعلم أنه متى اجتمع معك في الأسماء والأفعال حرف أصل ومعه حرفان مثلان لا غير فهما أصلان متصلين كانا أو منفصلين.
فالمتصلان نحو الحفف والصدد والقصص وصببت وحللت وشددت وددن ويين.
وأما المنفصلان فنحو دعد وتوت وطوط وقلق وسلس.
وكذلك إن كان هناك زائد فالحال واحدة نحو حمام وسمام وثالث وسالس روينا عن الفراء قول الراجز: ممكورة غرثي الوشاح السالس تضحك عن ذي أشر غضارس وكذلك كوكب ودودح.
وليس من ذلك دؤادم لأنه مهموز.
وكذلك إن كان هناك حرفان تسقطهما الصنعة جريا في ذلك مجرى الحرف الواحد كألف حمام وسمام وواو كوكب ودودح وذلك ألندد ويلندد يوضح ذلك الاشتقاق في ألندد لأنه هو الألد.
وأما ألنجج فإن عدة حروفه خمسة وثالثه نون ساكنة فيجب أن يحكم بزيادتها فتبقى أربعة فلا يخلو حينئذ أن يكون مكرر اللام كباب قعدد وشربب وأو مزيدة في أوله الهمزة كأحمر وأصفر وإثمد.
وزيادة الهمزة أولاً أكثر من تكرير اللام آخراً.
فعلى ذلك ينبغي أن يكون العمل.
فتبقى الكلمة من تركيب " ل ج ج " فمثلاها إذن أصلان وكذلك يلنجج لأن الياء في ذلك كالهمزة كما قدمناه.
فمثلاً ألنجج ويلنجج أصلان كمثلي ألندد ويلندد.
فهذه أحكام المثلين إذا كان معهما أصل واحد في أنهما أصلان لا محالة.
فأما إذا كان معك أصلان ومعهما حرفان مثلان فعلى أضرب: منها أن يكون هناك تكرير على تساوي حال الحرفين.
فإذا كانا كذلك كانت الكلمة كلها أصولاً وذلك نحو قلقل وصعصع وقرقر.
فالكلمة إذاً لذلك رباعية.
وكذلك إن اتفق الأول والثالث واختلف الثاني والرابع فالمثلان أيضاً أصلان.
وذلك نحو فرفخ وقرقل وزهزق وجرجم.
وكذلك إن اتفق الثاني والرابع واختلف الأول والثالث نحو كربر وقسطاس وهزنبزان وشعلع فالمثلان أيضاً أصلان.
وكل ذلك أصل رباعي.
وكذلك إن اتفق الأول والرابع واختتلف الثاني والثالث فالمثلان أصلان والكلمة أيضاً من بنات الأربعة.
وذلك نحو قربق وصعفصة وسلعوس.
وكذلك إن اتفق الأول والثاني واختلف الثالث والرابع فالمثلان أصلان والكلمة أيضاً رباعية.
وذلك نحو ديدبون وزيزفون: هما رباعيان كباب ددن وكوكب في الثلاثة.
ومثالهما فيعلول كخيسفوج وعيضموز.
فهذه حال الرباعي.
وكذلك أيضاً إن حصل معك ثلاثة أحرف أصول ومعها مثلان غير ملتقيين فهما أيضاً أصلان وذلك كقولهم زبعبق وشمشليق وشفشليق.
فهذه هي الأصول التي يكون فيها المثلان أصلين.
وما علمنا أن وراء ما حضرنا وأحضرناه منها مطلوباً فيتعب بالتماسه وتطلبه.
فأما متى يكون أحد المثلين زائداً فهو أن يكون معك حرفان أصلان من بعدهما حرفان مثلان فأحدهما زائد.
وسنذكر أيهما هو الزائد عقيب الفراغ من تقسيم ذلك.
وذلك كمهدد وسردد وجلبب وشملل وصعرر واسحنكك واقعنسس.
وكذلك إن كان معك حرفان أصلان بينهما حرفان مثلان فأحد المثلين أيضاً زائد.
وذلك نحو سلمن وقلفٍ وكسرَّ وقطع.
وكذلك إن فصل بين المثلين المتأخرين عن الأصلين المتقدمين أو المتوسطين بينهما زائد فالحال واحدة.
وذلك نحو قردود وسحتيت وصهميم.
وقرطاط وصفنات وعثوثل واعشوشب واخلولق.
فهذا حكم المثلين بجيئان مع الأصلين.
وكذلك إن جاءا بعد الثلاثة الأصول وذلك نحو قفعدد وسهلل وسبحلل وهرشف وعربد وقسحب وقسقب وطرطب.
وكذلك إن التقى المثلان حشوا وذلك نحو علكد وهلقس ودبخس وشمخر وضمخر وهمقع وزملق وشعلع وهملع وعدبس وعجنس.
وكذلك إن حجز بين المثلين زائد.
وذلك نحو جلفزيز وهلبسيس وخربصيص وحندقوق.
فهذه الكلم كلها رباعية الأصل وأحد مثليها زائد.
فأما همرش فخماسي وميمه الأولى نون وأدغمت في الميم لما لم يخف هناك لبس ألا ترى أنه ليس في بنات الأربعة مثال جعفر فيلتبس به همرش.
ولو حقرت همرشاً لقلت هنيمر فأظهرت نونها لحركتها.
وكذلك لو استكرهت على تكسيرها لقلت هنامر.
ونظير إدغام هذه النون إذا لم يخافوا لبساً قولهم امحي واماز واماع.
ولما لم يكن في الكلام افعل علم أن هذا انفعل قال أبو الحسن: ولو أردت مثال انفعل من رأيت ولحزت لقلت: ارأى والحز.
فإن قلت: فما تقول في مثل عذور وسنور واعلوط واخروط وهبيخ وهبيغ وجبروة وسمعنة ونظرنة وزونك فيمن أخذه من زاك يزوك وعليه حمله أبو زيد لأنه صرف فعله عقيبه معه فإن هذا سؤال ساقط عنا وذلك أنا إنما كلامنا على ما أحد مثليه زائد ليذكر فإن قيل: فهذا ولكن ما تقول في صمحمح ودمكمك وبابهما قيل: هذا في جملة ما عقدناه ألا ترى أن معك في أول المثال الصاد والميم وهما لفظ أصلين ثم تكرر كل واجد من الثاني والثالث فصار عود الثالث فصار عود الثاني ملحقاً له بباب فعل وعود الثالث ملحقاً له بباب فعلل فقد ثبت أن كل واحد من الحرفين الثاني والثالث قد عاد عليه نفس لفظه كما عاد على طاء قطع لفظها وعلى دال قعدد أيضاً لفظها.
فباب فعلعل ونحوه أيضاً ثلاثي كما أن كل واحد من سلم وقطع وقعدد وشملل ثلاثي.
وهذا أيضاً جواب من سأل عن مرمريس ومرمريت سؤاله عن صمحمح ودمكمك لأن هذين أولا كذينك آخرا.
الآن قد أتينا على أحكام المثلين: متى يكونان أصلين ومتى يكون أحدهما زائداً بما لا تجده متقصي متحجراً في غير كلامنا هذا.
وهذا أوان القول على الزائد منهما إذا اتفق ذلك أيهما هو.
فمذهب الخليل في ذلك أن الأول منهما هو الزائد ومذهب يونس وإياه كان يعتمد أبو بكر أن الثاني منهما هو الزائد.
وقد وجدنا لكل من القولين مذهباً واستوسعنا له بحمد الله مضطرباً.
فجعل الخليل الطاء الأولى من قطع ونحوه كواو حوقل وياء بيطر وجعل يونس الثانية منه كواو جهور ودهور.
وجعل الخليل باء جلبب الأولى كواو جهور ودهور وجعل يونس الثانية كياء سلقيت وجعبيت.
وهذا قدر من الحجاج مختصر وليس بقاطع وإنما فيه الأنس بالنظير لا القطع باليقين.
ولكن من أحسن ما يقال في ذلك ما كان أبو علي رحمه الله يحتج به لكون الثاني هو الزائد قولهم: اقعنسس واسحنكك قال: ووجه الدلالة من ذلك أن نون افعنلل بابها إذا وقعت في ذوات الأربعة أن تكون بين أصلين نحو احرنجم واخرنطم.
واقعنسس ملحق بذلك فيجب أن يحتذي به طريق ما ألحق بمثاله.
فلتكن السين الأولى أصلاكما أن الطاء المقابلة لها من اخرنطم أصل.
وإذا كانت السين الأولى من اقعنسس أصلاً كانت الثانية الزائدة من غير ارتياب ولا شبهة.
وهذا في معناه سديد حسن جار على أحكام هذه الصناعة.
ووجدت أنا أشياء في هذا المعنى يشهد بعضها لهذا المذهب وبعضها لهذا المذهب.
فمما يشهد لقول يونس قول الراجز: بني عقيل ماذه الخنافق! المال هدى والنساء طالق فالخنافق جمع خنفقيق وهي الداهية.
ولن تخلو القاف المحذوفة أن تكون الأولى أو الثانية فيبعد أن تكون الأولى لأنه لو حذفها لصار التقدير به في الواحد إلى خنفيق ولو وصل إلى ذاك لوقعت الياء رابعة فيما عدته خمسة وهذا موضع يثبت فيه حرف اللين بل يجتلب إليه تعويضاً أو إشباعاً.
فكان يجب على هذا خنافيق.
فلما لم يكن كذلك علمت أنه إنما حذف القاف الثانية فبقى خنفقي فلما وقعت الياء خامسة حذفت فبقي خنفق فقيل في تكسيره خنافق.
فإن قلت: ما أنكرت أن يكون حذف القاف الأولى فبقي خنفيق وكان قياس تكسيره خنافيق غير أنه اضطر إلى حذف الياء كضرورته إلى حذفها في قوله: والبكرات الفسج العطامسا قيل: الظاهر غير هذا وإنما العمل على الظاهر لا على المحتمل.
فإذا صح أنه إنما حذف الثانية علمت أنها هي الزائدة دون الأولى.
ففي هذا بيان وتقوية لقول يونس.
ويقوى قوله أيضاً أنهم لما ألحقوا الثلاثة بالأربعة فقالوا مهدد وجلبب وبدأوا باستعمال الأصلين وهما الميم والهاء والجيم واللام فهذان أصلان لا محالة.
فكما تبعت الهاء الميم والهاء أصل كما أن الميم أصل فكذلك يجب أن تكون الدال الأولى أصلاً لتتبع الهاء التي هي أصل.
فكما لا يشك أن الهاء أصل تبع أصلاً فكذلك ينبغي أن تكون الدال الأولى أصلاً تبعت أصلاً من حيث تساوت أحوال الأصول الثلاثة وهي الفاء والعين واللام.
فلما استوفيت الأصول الثلاثة المقابل بها من جعفر الأصول الأول الثلاثة وبقيت هناك بقية من الأصل الممثل وهي اللام الثانية التي هي الراء استؤنفت لها لام ثانية مكررة وهي الدال الثانية.
نعم وإذا كانت اللام الثانية من الرباعي مشابهة بتجاوزها الثلاثة للزائد كان الحرف المكرر الذي هو أجد فهذا كله كما ترى شاهد بقوة قول يونس.
فأما ما يشهد للخليل فأشياء.
منها ما جاء من نحو فعوعل وفعيعل وفعنلل وفعاعل وفعاعيل نحو غدودن وخفيدد وعقنقل وزرارق وسخاخين.
وذلك أنك قد علمت أن هذه المثل التي تكررت فيها العينان إنما يتقدم على الثانية منهما الزائد لا محالة أعني واو فعوعل وياء فعيعل ونون فعنلل وألف فعاعل وفعاعيل.
فكما أنهما لما اجتمعا في هذه المثل ما قبل الثانية زائد لا محالة فكذلك ينبغي أن يكونا إذا التقيا غير مفصول بينهما في نحو فَعَّل وفُعّل وفَعَّال وفُعَّال وفٍعِّل وما كان نحو ذلك: الزائدة منهما أيضاً هي الأولى لوقوعها موقع الزوائد مع التكرير فيهما لا محالة.
فكما لا يشك في زيادة ما قبل العين الثانية في فعوعل وبابه فكذلك ينبغي ألا يشك في زيادة ما قبل العين الثانية مما التقت عيناه نحو فَعَّل وفُعّل وبقية الباب.
وهذا واضح.
فإن عكس عاكس هذا فقال: إن كان هذا شاهداً لقول الخليل عندك كان هو أيضاً نفسه شاهدا لقول يونس عند غيرك.
وذلك أن له أن يقول: قد رأينا العينين في بعض المثل إذا التقتا مفصولة إحداهما من الأخرى فإن ما بعد الأولى منهما زائد لا محالة ويورد هذه المثل عينها نحو عثوثل وخفيدد وعقنقل وبقية الباب فيقول لك: فكما أن ما بعد العين الأولى منها زائد فالجواب أن هذه الأحرف الزوائد في فعوعل وفعيعل وفعنلل وبقية الباب أشبه بالعين الأولى منها بالعين الآخرة وذلك لسكونها كما أن العينين إذا التقتا فالأولى منهما ساكنة لا غير نحو فَعّل وفُعّل وفِعِّيل وبقية الباب ولا نعرف في الكلام عينين التقتا والأولى منهما متحركة ألا ترى أنك لا تجد في الكلام نحو فِعِعْل ولا فُعُعْل ولا فُعُعْل ولا شيئاً من هذا الضرب لم نذكره.
فإذا كان كذلك علمت أن واو فعوعل لسكونها أشبه بعين فعل الأولى لسكونها أيضاً منها بعينها الثانية لحركتها فاعرف ذلك فرقاً ظاهراً.
ومنها أن أهل الحجاز يقولون للصواغ: الصياغ فيما رويناه عن الفراء وفي ذلك دلالة على ما نحن بسبيله.
ووجه الاستدلال منه أنهم كرهوا التقاء الواوين لا سيما فيما كثر استعماله فأبدلوا الأولى من العينين ياء كما قالوا في أما: أيما ونحو ذلك فصار تقديره: الصيواغ فلما التقت الواو والياء على هذا أبدلوا الواو للياء قبلها فقالوا الصياغ.
فإبدالهم العين الأولى من الصواغ دليل على أنها هي الزائدة لأن الإعلال بالزائد أولى منه بالأصل.
فإن قلت: فقد قلبت العين الثانية أيضاً فقلت صياغ فلسنا نراك إلا وقد أعللت العينين جميعاً فمن جعلك بأن تجعل الأولى هي الزائدة دون الآخرة وقد انقلبتا جميعاً قيل قلب الثانية لا يستنكر لأنه كان عن وجوب وذلك لوقوع الياء ساكنة قبلها فهذا غير بعيد ولا معتذر منه لكن قلب الأولى وليس هناك علة تضطر إلى إبدالها أكثر من الاستخفاف مجرداً هو المعتد المستنكر المعول عليه المحتج به فلذلك اعتمدناه وأنشأنا الاحتجاج للخليل عنه إذ كان تلعباً بالحرف من غير قوة سبب ولا وجوب علة.
فأما ما يقوي سببه ويتمكن حال الداعي إليه فلا عجب منه ولا عصمة للحرف وإن كان أصلياً دونه.
وإذا كان الحرف زائداً كان بالتلعب به قمنا.
واذكر قول الخليل وسيبويه في باب مقول ومبيع وأن الزائد عندهما هو المحذوف أعني واو مفعول من حيث كان الزائد أولى بالإعلال من الأصل.
فإن قلت: فما أنكرت أن يكونوا إنما أبدلوا العين الثانية في صواغ دون الأولى فصار التقدير به إلى صوياغ ثم وقع التغيير فيما بعد قيل: يمنع من ذلك أن العرب إذا غيرت كلمة عن صورة إلى أخرى اختارت أن تكون الثانية مشابهة لأصول كلامهم ومعتاد أمثلتهم.
وذلك أنك تحتاج إلى أن تنيب شيئاً عن شيء فأولى أحوال الثاني بالصواب أن يشابه الأول.
ومن مشابهته له أن يوافق أمثلة القوم كما كان المناب عنه مثالاً من مثلهم أيضاً ألا ترى أن الخليل لما رتب أمر أجزاء العروض المزاحفة فأوقع للزحاف مثالاً مكان مثال عدل عن الأول المألوف الوزن إلى آخر مثله في كونه مألوفاً وهجر ما وذلك أنه لما طوى " مُسْ تَفْ عِلُنْ " فصار إلى مُسْ تَعِلُن " ثناه إلى مثال معروف وهو مفتعلن لما كره مُسْتَعِلُنْ إذ كان غير مألوف ولا مستعمل.
وكذلك لما ثرم فَعُولُنْ فصار إلى عُولُ وهو مثال غير معروف عدله إلى فَعْلُ.
وكذلك لما خبل مُسْتَفْعِلُنْ فصار إلى مُتَعِلُنْ فاستنكر ما بقي منه جعل خالفة الجزء فَعَلَتُنْ ليكون ما صير إليه مثالاً مألوفاً كما كان ما انصرف عنه مثالاً مألوفاً.
ويؤكد ذلك عندك أن الزحاف إذا عرض في موضع فكان ما يبقى بعد إيقاعه مثالاً معروفاً لم يستبدل به غيره.
وذلك كقبضه مفاعلين إذا صار إلى مفاعلن وككفه أيضاً لما صار إلى مفاعيل فلما كان ما بقي عليه الجزء بعد زحافه مثالاً غير مستنكر أقره على صورته ولم يتجشم تصوير مثال آخر غيره عوضاً منه وإنما أخذ الخليل بهذا لأنه أحزم وبالصنعة أشبه.
فكذلك لما أريد التخفيف في صواغ أبدل الحرف الأول فصار من صيواغ إلى لفظ فيعال كفيداق وخيتام.
ولو أبدل الثاني لصار صوياغ إلى لفظ فيعال وفعْيال مثال مرفوض.
فإن قلت كان يصير من صوياغ إلى لفظ فوعال قيل قد ثبت أن عين هذه الكلمة واو فصوياغ إذاً لو صير إليه لكان فعيالا لا محالة فلذلك قلنا: إنهم أبدلوا العين الأولى ياء ثم إنهم أبدلوا لها العين الثانية وإذا كان المبدل هو الأول لزم أن يكون هو الزائد لأن حرمة الزائد أضعف من حرمة فهذا أيضاً أحد ما يشهد بصحة قول الخليل.
ومنها قولهم: صَمَحْمَح ودَمَكْمَك فالحاء الأولى هي الزائدة وكذلك الكاف الأولى وذلك أنها فاصلة بين العينين والعينان متى اجتمعتا في كلمة واحدة مفصولاً بينهما فلا يكون الحرف الفاصل بينهما إلا زائداً نحو عثوثل وعقنقل وسلالم وخفيفد.
وقد ثبت أيضاً بما قدمناه قبيل أن العين الأولى هي الزائدة.
فثبت إذاً أن الميم والحاء الأوليين في صمحمح هما الزائدتان وأن الميم والحاء الأخريين هما الأصلان.
فاعرف ذلك فإنه مما يحقق مذهب الخليل.
ومنها أن التاء في تفعيل عوض من عين فعال الأولى والتاء زائدة فينبغي أن تكون عوضاً من زائد أيضاً من حيث كان الزائد بالزائد أشبه منه بالأصلي.
فالعين الأولى إذاً من قطاع هي الزائدة لأن تاء تقطيع عوض منها كما أن هاء تفعلة في المصدر عوض من ياء تفعيل وكلتاهما زائدة.
فليس واحد من المذهبين إلا وله داع إليه وحامل عليه.
وهذا مما يستوقفك عن القطع على أحد المذهبين إلا بعد تأمله وإنعام الفحص عنه.
والتوفيق تبالله عز وجل.
باب في الأصلين يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير
اعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعاً أصلين ليس أحدهما مقلوباً عن صابحه فهو القياس الذي لا يجوز غيره.
وإن لم يمكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه ثم أريت أيهما الأصل وأيهما الفرع.
وسنذكر وجوه ذلك.
فمما تركيباه أصلان لا قلب فيهما قولهم: جذب وجبذ ليس أحدهما مقلوباً عن صاحبه.
وذلك أنهما جميعاً يتصرفان تصرفاً واحداً نحو جذب يجذب جذباَ فهو جاذب والمفعول مجذوب وجبذ يجبذ جبذاً فهو جابذ والمفعول مجبوذ.
فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلاً لصاحبه فسد ذلك لأنك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر.
فإذا وقفت الحال بينهما ولم يؤثر بالمزية أحدهما وجب أن يتوازيا وأن يمثلا بصفحتيهما معاً.
وكذلك ما هذه سبيله.
فإن قصر أجدهما عن تصرف صاحبه ولم يساوه فيه كان أوسعهما تصرفاً أصلاً لصاحبه.
وذلك كقولهم أنى الشيء يأني وآن يئين.
فآن مقلوب عن أنى.
والدليل على ذلك وجودك مصدر أنى يأنى وهو الإنَى ولا تجد لآن مصدراً كذا قال الأصمعي.
فأما الأين فليس من هذا في شيء إنما الأين: الإعياء والتعب.
فلما قال الأصمعي.
فأما الأين فليس من هذا في شيء إنما الأين: الإعياء والتعب.
فلما عدم من آن المصدر الذي هو أصل للفعل علم أنه مقلوب عن أنى يأنى إنىً قال الله تعالى {إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} أي بلوغه وإدراكه.
قال أبو علي: ومنه سموا الإناء لأنه لا يستعمل إلا بعد بلوغه حظه من خرزه أو صياغته أو نجارته أو نحو ذلك.
غير أن أبا زيد قد حكى لآن مصدراً وهو الأين.
فإن كان الأمر كذلك فهما إذاً أصلان متساويان وليس أحدهما أصلاً لصاحبه.
ومثل ذلك في القلب قولهم أيست من كذا فهو مقلوب من يئست لأمرين ذكر أبو علي أحدهما وهو ما ذهب إليه من أن أيست لا مصدر له وإنما المصدر ليئست وهو اليأس واليآسة.
قال: فأما قولهم في اسم الرجل إياس فليس مصدراً لأيست ولا هو أيضاً من لفظه وإنما هو مصدر أست الرجل أؤوسه إياساً سموه به كما سموه عطاء تفاؤلا بالعطية.
ومثل ذلك عندى تسميتهم إياه عياضاً وإنما هو مصدر عضته أي أعطيته قال: عاضها الله غلاماً بعد ما شابت الأصداغ والضرس نقد عطف جملة من مبتدأ وخبر على أخرى من فعل وفاعل أعني قوله: والضرس نقد أي ونقد الضرس.
وأما الآخر فعندي أنه لو لم يكن مقلوباً لوجب إعلاله وأن يقول: إست أآس كهبت أهاب.
فظهوره صحيحاً يدل على أنه إنما صح لأنه مقلوب عما تصح عينه وهو يئست لتكون الصحة دليلاً على ذلك المعنى كما كانت صحة عور دليلاً على أنه في معنى ما لا بد من صحته وهو أعور.
فأما تسميتهم الرجل أوسا فإنه يحتمل أمرين أحدهما أن يكون مصدر أسته أي أعطيته كما سموه عطاء وعطية.
والآخر أن يكون سموه به كما سموه ذئباً.
فأما ما أنشدناه من قول الآخر: لي كل يوم من ذواله ضغث يزيد على إباله فلا حشأنك مشقصاً أوسا أويس من الهباله فأوساً منه ينتصب على المصدر بفعل دل عليه قوله: لأحشأنك فكأنه قال لأؤوسنك أوساً كقول الله سبحان {وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ} لأن مرورها يدل على صنع الله فكأنه قال: صنع الله ذلك صنعاً وأضاف المصدر إلى فاعله كما لو ظهر الفعل الناصب لهذا المصدر لكان مسنداً إلى اسم الله تعالى.
وأما قوله أويس فنداء أراد: يا أويس يخاطب الذئب وهو اسم له مصغراً كما أنه اسم له مكبر قال: فأما ما يتعلق به " من " فإن شئت علقته بنفس أوسا ولم يعتدد بالنداء فاصلاً لكثرته في الكلام وكونه معترضاً به للتسديد كما ذكرنا من هذا الطرز في باب الاعتراض في قوله: يا عمر الخير جريت الجنه اكس بنياتي وأمهنه أو يا أبا حفص لأمضينه فاعترض بالنداء بين " أو " والفعل.
وإن شئت علقته بمحذوف يدل عليه أوسا فكأنه قال: أؤوسك من الهبالة أي أعطيك من الهبالة.
وإن شسئت جعلت حرف الجر هذا وصفاً لأوساً فعلقته بمحذوف وضمنته ضمير الموصوف.
ومن المقلوب قولهم امضحل وهو مقلوب عن اضمحل ألا ترى أن المصدر إنما هو على اضمحل وهو الاضمحلال ولا يقولون: امضحلا.
وكذلك قولهم: اكفهر واكرهف الثاني مقلوب عن الأول لأن التصرف على اكفهر وقع ومصدره الاكفهرار ولم يمرر بنا الأكرهفاف قال النابغة: أو فازجروا مكفهراً لا كفاء له كالليل يخلط أصراماً بأصرام وقد حكى بعضهم مكرهف.
فإن ساواه في الاستعمال فهما على ما ترى أصلان.
ومن ذلك: هذا لحم شخم وخشم وفيه تشخيم ولم أسمع تخشيم.
فهذا يدل على أن شخم أصل ومن ذلك قولهم: اطمأن.
ذهب سيبويه فيه إلى أنه مقلوب وأن أصله من طأمن وخالفه أبو عمر فرأى ضد ذلك.
وحجة سيبويه فيه أن طأمن غير ذي زيادة واطمأن ذو زيادة والزيادة إذا لحقت الكلمة لحقها ضرب من الوهن لذلك وذلك لأن مخالطتها شيء ليس من أصلها مزاحمة لها وتسوية في التزامه بينها وبينه وهو وإن لم تبلغ الزيادة على الأصول فحش الحذف منها فإنه على كل حال على صدد من التوهين لها إذ كان زيادة عليها تحتاج إلى تحملها كما يتحامل بحذف ما حذف منها.
وإذا كان في الزيادة طرف من الإعلال للأصل كان أن يكون القلب مع الزيادة أولى.
وذلك أن الكلمة إذا لحقها ضرب من الضعف أسرع إليها ضعف آخر وذلك كحذفهم ياء حنيفة في الإضافة إليها لحذف تائها في قولهم حنفي ولما لم يكن في حنيف تاء تحذف فيحذف ياؤها جاء في الإضافة إليه على أصله فقالوا: حنيفى.
فإن قال أبو عمر: جرى المصدر على اطمأن يدل على أنه هو الأصل وذلك قولهم: الاطمئنان قيل: قولهم الطأمنة بإزاء قولك: الاطمئنان فمصدر بمصدر وبقي على أبي عمر أن الزيادة جرت في المصدر جريها في الفعل.
والعلة في الموضعين واحدة.
وكذلك الطمأنينة ذات زيادة فهي إلى الاعتلال قرب.
ولم يقنع أبا عمر أن يقول: إنهما أصلان متقاودان كجبذ وجذب حتى مكن خلافه لصاحب الكتاب بأن عكس الأمر عليه البتة.
وذهب سيبويه في قولهم أينق مذهبين: أحدهما أن تكون عين أنوق قلبت إلى ما قبل الفاء فصارت في التقدير أونق ثم أبدلت الواو ياء لأنها كما أعلت بالقلب كذلك أعلت أيضاً بالإبدال على ما مضى والآخر أن تكون العين حذفت ثم عوضت الياء منها قبل الفاء.
فمثالها على هذا القول أيفل وعلى القول الأول أعفل.
وذهب الفراء في الجاه إلى أنه مقلوب من الوجه.
وروينا عن الفراء أنه قال: سمعت أعرابية من غطفان وزجرها ابنها فقلت لها: ردي عليه فقالت: أخاف أن يجوهني بأكثر من هذا.
قال: وهو من الوجه أرادت: يواجهني.
وكان أبو علي رحمه الله يرى أن الجاه مقلوب عن الوجه أيضاً.
قال: ولما أعلوه بالقلب أعلوه أيضاً بتحريك عينه ونقله من فَعْلٍ إلى فَعَل يريد أنه صار من وجه إلى جَوْهٍ ثم حركت عينه فصار إلى جَوَهٍ ثم أبدلت عينه لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار جاه كما ترى.
وحكى أبو زيد: قد وجه الرجل وجاهة عند السلطان وهو وجيه.
وهذا يقوي القلب لأنهم لم يقولوا جَوِيه ولا نحو ذلك.
ومن المقلوب قِسِيّ وأشياء في قول الخليل.
وقوله: مروان مروان أخو اليوم اليمي فيه قولان: أحدهما أنه أراد: أخو اليوم السهل اليوم الصعب يقال يوم أيوم ويوم كأشعث وشعث وأخشن وخشن وأوجل ووجل فقلب فصار يمو فانقلبت العين لانكسار ما قبلها طرفا.
والآخر أنه أراد: أخو اليوم اليوم كما يقال عند الشدة والأمر العظيم: اليوم اليوم فقلب فصار اليمو ثم نقله من فَعْل إلى فَعِل كما أنشده أوب زيد من قوله: علام قتل مسلم تعبدا مذ سنة وخَمِسون عددا يريد خَمْسونَ فلما انكسر ما قبل الواو قلبت ياء فصار اليَمِى.
هذان قولان فيه مقولان.
ويجوز عندي فيه وجه ثالث لم يقل به.
وهو أن يكون أصله على ما قيل في المذهب الثاني: أخو اليوم اليوم ثم قلب فصار اليَمْوُ ثم نقلت الضمة إلى الميم على حد قولك: هذا بَكُرْ فصارت اليَمُو فلما وقعت الواو طرفا بعد ضمة في الاسم أبدلوا من الضمة كسرة ثم من الواو ياء فصارت اليَمِى كأحقٍ وأدْلٍ.
فإن قيل: هلا لم تُستنكَر الواو هنا بعد الضمة لما لم تكن الضمة لازمة قيل: هذا وإن كان على ما ذكرته فإنهم قد أجروه في هذا النحو مجرى اللازم ألا تراهم يقولون على هذه اللغة: هذه هند ومررت بجمل فيتبعون الكسر الكسر والضم الضم كراهية للخروج من كسرة هاء هند إلى ضمة النون وإن كانت الضمة عارضة.
وكذلك كرهوا مررت بجمل لئلا يصيروا في الأسماء إلى لفظ فِعلُ.
فكما أجروا النقل في هذين الموضعين مجرى اللازم فكذلك يجوز أن يجرى اليمو مجرى أدلو وأحقو فيغيركما غيرا فقيل اليمى حملا على الأدلى والأحقي.
فإن قيل: نحو زيد وعون لا ينقل إلى عينه حركة لامه واليوم كعون قيل جاز ذلك ضرورة لما يعقب من صلاح القافية وأكثر ما فيه إجراء المعتل مجرى الصحيح لضرورة الشعر.
ومن المقلوب بيت القطامي: ما اعتاد حب سليمى حين معتاد ولا تقصى بواقي دينها الطادي هو مقلوب عن الواطد وهو الفاعل من وطد يطد أي ثبت.
فقلب عن فاعل إلى عالف.
ومثله عندنا الحادي لأنه فاعل من وحد وأصله الواحد فنقل عن فاعل إلى عالف سواء فإنقلبت الواو التي هي في الأصل فاء ياء لانكسار ما قبلها في الموضعين جميعاً.
وحكى الفراء: معي عشرة فأحدهن لي أي اجعلهن أحد عشر فظاهر هذا يؤنس بأن الحادي فاعل.
والوجه إن كان المروي صحيحاً أن يكون الفعل مقلوباً من وحدت إلى حدوت وذلك أنهم لما رأوا الحادي في ظاهر الأمر على صورة فاعل صار كأنه جارٍ على حدوت جريان غازٍ على غزوت كما أنهم لما استمر استعمالهم الملك بتخفيف الهمزة صار كأن مَلَكا على فَعَل فلما صار اللفظ بهم إلى هذا بنى الشاعر على ظاهر أمره فاعلاً منه فقال حين ماتت نساؤه بعضهن إثر بعض: غدا مالك يرمي نسائي كأنما نسائي لسهمي مالكٍ غرضان يعني ملك الموت ألا تراه يقول بعد هذا: فيا رب عمر لي جهيمة أعصرا فمالك الموت بالقضاء دهاني وهذا ضرب من تدريج اللغة.
وقد تقدم الباب الذي ذكرنا فيه طريقه في كلامهم فليضمم هذا إليه فإنه كثير جداً.
ومثل قوله فاحْدُهُنَّ في أنه مقلوب من وحد قول الأعرابية: أخاف أن يَجُوهَني وهو مقلوب من الوجه.
فأما وزن مالك على الحقيقة فليس فاعلاً لكنه ما فل ألا ترى أن أصل ملك ملأك: مفعل من تصريف ألكني إليها عمرك الله وأصله ألئكني فخففت همزته فصار ألكني كما صار ملأك بعد التخفيف إلى ملك ووزن مَلَك مَفَل.
ومن طريف المقلوب قولهم للقطعة الصعبة من الرمل تَيْهُورة وهي عندنا فَيْعُولة من تهور الجرف وانهار الرمل ونحوه.
وقياسها أن تكون قبل تغييرها هَيْوُورة فقدمت العين وياء فيعول إلى ما قبل الفاء فصارت وَيْهُورة ثم أبدلت الواو التي هي عين مقدمة قبل الياء تاء كتَيْقُور فصارت تيهورة كما ترى.
فوزنها على لفظها الآن عيفولة.
أنشدنا أبو علي: خليلي لا يبقى على الدهر فادر بتيهورة بين الطخا فالعصائب ويروى: الطخاف العصائب فهذا قول وهو لأبي علي رحمه الله.
ويجوز عندي أن تكون في الأصل أيضاً تفعولة كتعضوضة وتدنوبة فيكون أصلها على هذا تهوورة فقدمت العين على الفاء إلى أن صار وزنها تعفولة وآل اللفظ بها إلى توهورة فأبدلت الواو التي هي عين مقدمة ياء كما أبدلت عين أينق لما قدمت في مذهبي الكتاب ياء فنقلت من أنوق إلى أونق ومن أونق تقديراً إلى أينق لأنها كما أعلت بالقلب كذا أعلت بالإبدال فصارت أينقا.
وكذلك صارت توهورة إلى تيهورة.
وإن شئت جعلتها من الياء لا من الواو فقد حكى أبو الحسن عنهم: هار الجرف يهير.
ولا تحمله على طاح يطيح وتاه يتيه في قول الخليل لقلة ذلك ولأنهم قد قالوا أيضاً: تهير الجرف في معنى تهور وحمله على تفعل أولى من حمله على تفيعل كتحيز.
فإذا كانت تيهورة من الياء على هذا القول فأصلها تهيورة ثم قدمت العين التي هي الياء على الفاء فصار تيهورة.
وهذا القول إنما فيه التقديم من غير إبدال.
وإنما قدمنا القول الأول وإن كانت كلفة الصنعة فيه أكثر ويجوز فيه عندي وجه ثالث وهو أن يكون في الأصل يفعولة كيعسوبٍ ويربوعٍ فيكون أصلها يهوورة ثم قدمت العين إلى صدر الكلمة فصارت ويهورة: عيفولة ثم أبدلت الواو التي هي عين مقدمة تاء على ما مضى فصارت تيهورة.
ودعانا إلى اعتقاد القلب والتحريف في هذه الكلمة المعنى المتقاضيته هي.
وذلك أن الرمل مما ينهار ويتهور ويهور ويهير ويتهير.
فإن كسرت هذه الكلمة أقررت تغييرها عليها كما أن أينقا لما كسرتها العرب أقرتها على تغييرها فقالت: أيانق.
فقياس هذا أن تقول في تكسير تيهورة على كل قول وكل تقدير: تياهير.
وكذلك المسموع عن العرب أيضاً في تكسيرها.
والقلب في كلامهم كثير.
وقد قدمنا في أول هذا الباب أنه متى أمكن تناول الكلمة على ظاهرها لم يجز العدو عن ذلك بها وإن دعت ضرورة إلى القول بقلبها كان ذلك مضطراً إليه لا مختاراً.
باب في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه
اعلم أن هذا الباب لاحق بما قبله وتال له.
فمتى أمكن أن يكون الحرفان جميعاً أصلين كل واحد منهما قائم برأسه لم يسغ العدول عن الحكم بذلك. فإن دل دال أو دعت ضرورة إلى القول بإبدال أحدهما من صاحبه عمل بموجب الدلالة وصير إلى مقتضى الصنعة.
ومن ذلك سكر طبرزل وطبرزن: هما متساويان في الاستعمال فلست بأن تجعل أحدهما أصلاً لصاحبه أولى منك بحمله على ضده.
ومن ذلك قولهم: هتلت السماء وهتنت: هما أصلان ألا تراهما متساويين في التصرف يقولون: هتنت السماء تهتن تهتاناً وهتلت تهتل تهتالاً وهي سحائب هتن وهتل قال امرؤ القيس: فسحت دموعي في الرداء كأنها كلى من شعيب ذات سح وتهتان وقال العجاج: عزز منه وهو معطى الإسهال ضرب السواري متنه بالتهتال ومن ذلك ما حكاه الأصمعي من قولهم: دهمج البعير يدهمج دهمجة ودهنج يدهنج دهنجة إذا قارب الخطو وأسرع وبعير دهامج ودهانج وأنشد للعجاج: كأن رعن الآل ممنه في الآل بين الضحا وبين قيل القيال إذا بدا دهانج ذو أعدال وأنشد أيضاً: # وعير لها من بنات الكداد يدهنج بالوطب والمزود فأما قولهم: ما قام زيد بل عمرو وبن عمرو فالنون بدل من اللام ألا ترى إلى كثرة استعمال بل وقلة استعمال بن والحكم على الأكثر لا على الأقل.
هذا هو الظاهر من أمره.
ولست مع هذا أدفع أن يكون بن لغة قائمة برأسها.
وكذلك قولهم: رجل خامل وخامن النون فيه بدل من اللام ألا ترى أنه أكثر وأن الفعل عليه تصرف وذلك قولهم: خمل يخمل خمولاً.
وكذلك قولهم: قام زيد فم عمرو الفاء بدل من الثاء في ثم ألا ترى أنه أكثر استعمالاً.
فأما قولهم في الأثافي: الأثاثي فقد ذكرناه في كتابنا في سر الصناعة وقال الأصمعي: بنات مخر وبنات بخر: سحائب يأتين قبل الصيف بيض منتصبات في السماء قال طرفة: كبنات المخر يمأدن إذا أنبت الصيف عساليج الخضر قال أبو علي رحمه الله: كان أبو بكر يشتق هذه الأسماء من البخار فالميم على هذا في مخر بدل من الباء في بخر لما ذكر أبو بكر.
وليس ببعيد عندي أن تكون الميم أصلاً في هذا أيضاً وذلك لقول الله سبحانه: {وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ} أي ذاهبة وجائية وهذا أمر قد يشاركها فيه السحائب ألا ترى إلى قول الهذلي.
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج فهذا يدل على مخالطة السحائب عندهم البحر وتركضها فيه وتصرفها على صفحة مائه.
وعلى كل حال فقول أبي بكر أظهر.
ومن ذلك قولهم: بلهلة بن أعصر ويعصر فالياء في يعصر بدل من الهمزة في أعصر يشهد بذلك ما ورد به الخبر من أنه إنما سمي بذلك لقوله: أبني إن أباك غير لونه كر الليالي واختلاف الأعصر يريد جمع عصر.
وهذا واضح.
فأما قولهم: إناء قربان وكربان إذا دنا أن يمتلئ فينبغي أن يكونا أصلين لأنك تجد لكل واحدة مهما متصرفاً أي قارب أن يمتلئ وكرب أن يمتلئ إلا أنهم قد قالوا: جمجمة قربى ولم نسمعهم قالوا كربى.
فإن غلبت القاف على الكاف من هنا فقياس ما.
وقال الأصمعي: يقال: جعشوش وجعسوس وكل ذلك إلى قمأةٍ وقلةٍ وصغر ويقال: هم من جعاسيس الناس ولا يقال بالشين في هذا.
فضيق الشين مع سعة السين يؤذن بأن الشين بدل من السين.
نعم والاشتقاق يعضد كون السين غير معجمة هي الأصل وكأنه أشتق من الجعس صفة على فعلول وذلك أنه شبه الساقط المهين من الرجل بالخرء لذله ونتنه.
ونحو من ذلك في البدل قولهم: فسطاط وفستاط وفساط وبكسر الفاء أيضاً فذلك ست لغات.
فإذا صاروا إلى الجمع قالوا فساطيط وفساسيط ولا يقولون فساتيط بالتاء.
فهذا يدل أن التاء في فستاط إنما هي بدل من طاء فسطاط أو من سين فساط.
فإن قلت: هلا اعتزمت أن تكون التاء في فستاط بدلاً من طاء فسطاط لأن التاء أشبه بالطاء منها بالسين قيل بإزاء ذلك أيضاً: إنك إذا حكمت بأنها بدل من سين فساط ففيه شيئان جيدان: أحدهما تغيير للثاني من المثلين وهو أقيس من تغيير الأول من المثلين لأن الاستكراه في الثاني يكون لا في الأول والآخر أن السينين في فسّاط ملتقيتان والطاءين في فسطاط منفصلتان بالألف بينهما واستثقال المثلين ملتقيين أحرى من استثقالهما مفترقين وأيضاً فإن السين والتاء جميعاً مهموستان والطاء مجهورة.
فعلى هذا الاعتبار ينبغي أن يتلقى ما يرد من حديث الإبدال إن كان هناك إبدال أو اعتقاد أصلية الحرفين إن كانا أصلين.
وعلى ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا ينبغي أن تعتبر الكلمتان في التقديم والتأخير نحو اضمحل وامضحل وطأمن واطمأن.
والأمر واسع.
وفيما أوردناه من مقاييسه كاف بإذن الله.
ونحن نعتقد إن أصبنا فسحة أن نشرح كتاب يعقوب بن السكيت في القلب والإبدال فإن معرفة هذه الحال فيه أمثل من معرفة عشرة أمثال لغته وذلك أن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس.
قال لي أبو علي رحمه الله بحلب سنة ست وأربعين: أخطئ في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس.
ومن الله المعونة وعليه الاعتماد.
باب في قلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف
أما ما طريقه الإقدام من غير صنعة فنحو ما قدمناه آنفا من قولهم: ما أطيبه وأيطبه وأشياء في قول الخليل وقسيّ وقوله أخو اليوم اليمى.
فهذا ونحوه طريقه طريق الاتساع في اللغة من غير تأت ولا صنعة.
ومثله موقوف على السماع وليس لنا الإقدام عليه من طريق القياس.
فأما ما يتأتى له ويتطرق إليه بالملاينة والإكثاب من غير كد ولا اغتصاب فهو ما عليه عقد هذا الباب.
وذلك كأن يقول لك قائل: كيف تحيل لفظ وأيت إلى لفظ أويت فطريقه أن تبني من وأيت فَوْعلاً فيصير بك التقدير فيه إلى وَوْأَىٍ فتقلب اللام ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير وَوْأًى ثم تقلب الواو الأولى همزة لاجتماع الواوين في أول الكلمة فيصير أَوْأًى قم تخفف الهمزة فتحذفها وتلقي حركتها على الواو قبلها فيصير أَواً اسما كان أو فعلاً.
فقد رأيت كيف استحال لفظ وأى إلى لفظ أوا من غير تعجرف ولا تهكم على الحروف.
وكذلك لو بنيت مثل فَوْعال لصرت إلى وَوْآىٍ ثم إلى أَوْآىٍ ثم أوْآءٍ.
ثم تخفف فيصير إلى أواءٍ فيشبه حينئذ لفظ آءة أو أويت أو لفظ قوله: فأو لذكراها إذا ما ذكرتها وقد فعلت العرب ذلك منه قولهم: أوار النار وهو وهجها ولفحها ذهب فيه الكسائي مذهباً حسناً وكان هذا الرجل كثيراً في السداد والثقة عند أصحابنا قال: هو فُعَال من وَأَرْتُ الإرة أي احتفرتها لإضرام النار فيها.
وأصلها وُآر ثم خففت الهمزة فأبدلت في اللفظ واواً فصارت ووار فلما التقت في أول الكلمة الوالوان وأجرى غير اللازم مجرى اللازم أبدلت الأولى همزة فصارت أوَار أفلا ترى إلى استحالة لفظ وأر إلى لفظ أور بالصنعة.
وقال أبو زيد في تخفيف همزتي افعوعلت من وأيت جميعاً: أويت وقد أوضح هذا أبو زيد وكيف صنعته وتلاه بعده أبو عثمان في تصريفه.
وأجاز أبو عثمان أيضاً فيها وويت قال لأن نية الهمزة فاصلة بين الواوين.
فقياس هذا أن تصحح واوى ووار عند التخفيف لتقديرك فيه نية التحقيق وعليه قال الخليل في تخفيف فعل من وأيت أوى أفلا تراه كيف أحالته الصنعة من لفظ إلى لفظ.
وكذلك لو بنيت من أول مثال فَعْل لوجب أن تقول أَوْل: فتصيرك الصنعة من لفظ وول إلى لفظ أول.
ومن ذلك قول العرب: نسريت من لفظ " س ر ر " ومثله قصيت أظفاري هو من لفظ " ق ص ص " وقد آل بالصنعة إلى لفظ " ق ص ى ".
وكذلك قوله: تقضى البازي إذا البازي كسر هو في الأصل من تركيب " ق ض ض " ثم أحاله ما عرض من استثقال تكريره إلى لفظ " ق ض ى ".
وكذلك قولهم: تلعيت من اللعاعة أي خرجت أطلبها وهي نبت أصلها " ل ع ع " ثم صارت بالصنعة إلى لفظ " ل ع ى " قال: كاد اللعاع من الحوذان يسحطها ورجرج بين لحييها خناطيل وأشباه هذا كثير.
والقياس من بعد أنه متى ورد عليك لفظ أن تتناوله على ظاهره ولا تدعي فيه قلباً ولا تحريفاً إلا أن تضح سبيل أو يقتاد دليل.
ومن طريف هذا الباب قولك في النسب إلى محياً: محوى وذلك أنك حذفت الألف لأنها خامسة فبقي مُحَىّ كقُصَىّ فحذفت للإضافة ما حذفت من قُصَىّ وهي الياء الأولى التي هي عين محيا الأولى فبقي محى فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت مُحاً كهُدىً.
فلما أضفت إليها قلبت الألف واواً فقلت مُحَوِىّ كقولك في هُدىً: هُدَوِىّ.
فمثال محوى في اللفظ مُفَعِىّ واللام على ما تقدم محذوفة.
ثم إنك من بعد لو بنيت من ضرب على قول من أجاز الحذف في الصحيح لضربٍ من الصنعة مثل قولك محوى لقلت مضرى فحذفت الياء من ضرب كما حذفت لام محياً.
أفلا تراك كيف أحلت بالصنعة لفظ ضرب إلى لفظ مضر فصار مضرى كأنه منسوب إلى مضر.
وكذلك لو بنيت مثل قولهم في النسب إلى تحية: تحوى من نزف أو نشف أو نحو ذلك لقلت: تَنَفِىّ.
وذلك أن تحية تفعلة وأصلها تحيية كالتسوية والتجزئة فلما نسبت إليها حذفت أشبه حرفيها بالزائد وهو العين أعني الياء الأولى فكما تقول في عصية وقضية عصوى وقضوى قلت أيضاً في تحية تحوى فوزن لفظ تحوى الآن تفلى فإذا أردت مثل ذلك من نزف ونشف قلت تنفي ومثالها تفلي إلا أنه مع هذا خرج إلى لفظ الإضافة إلى تنوفة إذا قلت تنفى كقول العرب في الإضافة إلى شنوءة: شنئى.
أفلا ترى إلى الصنعة كيف تحيل لفظاً إلى لفظ وأصلاً إلى أصل.
وهذا ونحوه إنما الغرض فيه الرياضة به وتدرب الفكر بتجشمه وإصلاح الطبع لما يعرض في معناه وعلى سمته.
فأما لأن يستعمل في الكلام مضرى من ضرب وتنفى من نزف فلا.
ولو كان لا يخاض في علم من العلوم إلا بما لا بد له من وقوع مسائله معينة محصلة لم يتم علم على وجهٍ ولبقي مبهوتاً بلا لحظٍ ومخشوباً بلا صنعة ألا ترى إلى كثرة مسائل الفقه والفرائض والحساب والهندسة وغير ذلك من المركبات المستصعبات وذلك إنما يمر في الفرط منها الجزء النادر الفرد وإنما الانتفاع بها من قبل ما تقنيه النفس من الارتياض بمعاناتها.
باب في اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين في الحروف والحركات والسكون
غرضنا من هذا الباب ليس ما جاء به الناس في كتبهم نحو وجدت في الحزن ووجدت الضالة ووجدت في الغضب ووجدت أي علمت كقولك: وجدت الله غالباً ولا كما جاء عنهم من نحو الصدى: الطائر يخرج من رأس المقتول إذا لم يدرك بثأره والصدى: العطش والصدى: ما يعارض الصوت في الأوعية الخالية والصدى من قولهم: فلان صدى مال أي حسن الرعية له والقيام عليه.
ولا " هل " بمعنى الاستفهام وبمعنى قد و " أم " للاستفهام وبمعنى بل ونحو ذلك فإن هذا الضرب من الكلام وإن كان أحد الأقسام الثلاثة عندنا التي أولها اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ويليه اختلاف اللفظين واتفاق المعنيين كثير في كتب العلماء وقد تناهبته أقوالهم وأحاطت بحقيقته أغراضهم.
وإنما غرضنا هنا ما وراءه من القول على هذا النحو في الحروف والحركات والسكون المصوغة في أنفس الكلم.
قد يتفق لفظ الحروف ويختلف معناها وذلك نحو قولهم: درع دلاص وأدرع دلاص وناقة هجان ونوق هجان.
فالألف في دلاص في الواحد بمنزلة الألف في ناقة كناز وامرأة ضناك والألف في دلاص في الجمع بمنزلة ألف ظراف وشراف.
وذلك لأن العرب كسرت فعالا على فعال كما كسرت فعيلاً على فعال نحو كريم وكرام ولئيم ولئام.
وعذرها في ذلك أن فعيلاً أخت فعال ألا ترى أن كل واحد منهما ثلاثي الأصل وثالثه حرف لين وقد اعتقبا أيضاً على المعنى الواحد نحو كليب وكلاب وعبيدٍ وعباد وطسيس وطساس قال الشاعر: قرع يد اللعابة الطسيسا فملا كانا كذلك وإنما بينهما اختلاف حرف اللين لا غير ومعلوم مع ذلك قرب الياء من الألف وأنها أقرب إلى الياء منها إلى الواو كسر أحدهما على ما كسر عليه صاحبه فقيل: درع دلاص وأدرع دلاص كما قيل: ظريف وظراف وشريف وشراف.
ومثل ذلك قولهم في تكسير عُذَافِر وجُوَالِق: عَذافِر وجَوالِق وفي تكسير قُناقِنٍ: قَنَاقِن وهُداهِدٍ: هَداهِد قال الراعي: كهُداهِدٍ كسر الرماة جناحه يدعو بقارعة الطريق هَدِيلا فألف عذافِرٍ زيادة لحقت الواحد للبناء لا غير وألف عذافِر ألف التكسير كألف دَراهم ومنابر.
فألف عُذافِر تحذف كما تحذف نون جَحَنْفَلٍ في جحافِل وواو فَدَوْكسٍ في فداكِس وكذلك بقية الباب.
وأغمض من ذلك أن تسمى رجلاً بعبالٍّ وحمارٍّ جمع عبالة وحمارةٍ على حد قولك: شجرة وشجر ودجاجة ودجاج فتصرف فإن كسرت عبالاً وحمارا هاتين قلت حَمَارُّ وعَبَالٌّ فلم تصرف لأن هذه الألف الآن ألف التكسير بمنزلة ألف مخاد ومشاد جمع مخدة ومشد.
أفلا نرى إلى هاتين الألفين كيف اتفق لفظاهما واختلف معناهما ولذلك لم تصرف الثاني لما ذكرنا وصرفت الأول لأنه ليست ألفه للتكسير إنما هي كألف دجاجةٍ وسمامةٍ وحمامةٍ.
ومن ذلك أن توقع في قافية اسماً لا ينصرف منصوباً في لغة من نون القافية في الإنشاد نحو قوله: أقلى اللوم عاذل والعتابن فتقول في القافية: رأيت سعاداً فأنت في هذه النون مخير: إن شئت اعتقدت أنها نون الصرف وأنك صرفت الاسم ضرورة أو على لغة من صرف جميع ما لا ينصرف كقول الله تعالى {سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا} وإن شئت جعلت هذه النون في سعاداً نون الإنشاد كقوله: داينت أروى والديون تقضن فمطلت بعضاً وأدت بعضن يا أبتا علك أو عساكن ولكن إنما يفعل ذلك في لغة من وقف على المنصوب بلا ألف كقول الأعشى: وآخذ من كل حي عصم وكما رويناه عن قطرب من قول آخر: شئز جنبي كأني مهدأ جعل القين على الدف إبر وعليه قال أهل هذه اللغة في الوقف: رأيت فرح.
ولم يحك سيبويه هذه اللغة لكن حكاها الجماعة: أبو الحسن وأبو عبيدة وقطرب وأكثر اكوفيين.
فعلى هذه اللغة يكون قوله: فمطلت بعضاً وأدت بعضن إنما نونه نون الإنشاد لا نون الصرف ألا ترى أن صاحب هذه اللغة إنما يقف على حرف الإعراب ساكنا فيقول: رأيت زيد كالمرفوع والمجرور.
هذا هو الظاهر من الأمر.
فإن قلت: فهل تجيز أن يكون قوله: وأدت بعضاً تنوينه تنوين الصرف لا تنوين الإنشاد إلا أنه على إجراء الوقف مجرى الوصل كقوله: بل جوزتيهاء كظهر الحجفت فإن هذا وإن كان ضرباً من ضروب المطالبة فإنه يبعد وذلك أنه لم يمر بنا عن أحد من العرب أنه يقف في غير الإنشاد على تنوين الصرف فيقول في غير قافية الشعر: رأيت جعفرن ولا كلمت سعيدن فيقف بالنون.
فإذا لم يجئ مثله قبح حمله عليه.
فوجب حمل قوله: وأدت بعضن على أنه تنوين الإنشاد على ما تقدم من قوله: ولا تبقي خمر الأندرينن و # أقلى اللوم عاذل والعتابن و # ما هاج أحزانا وشجواً قد شجنْ ولم تحضرنا هذه المسألة في وقت علمنا الكتاب المعرب في تفسير قوافي أبي الحسن فنودعها إياه فلتلحق هذه المسألة به بإذن الله.
فإذا مر بك في الحروف ما هذه سبيله فأضفه إليه.
ومن ذلك الحركات.
هذه الحال موجودة في الحركات وجدانها في الحروف.
وذلك كامرأة سميتها بحيث وقبل وبعد فإنك قائل في رفعه: هذه حيث وجاءتني قبل وعندي بعد.
فالضمة الآن إعراب وقد كانت في هذه الأسماء قبل التسمية بها بناء.
وكذلك لو سميتها بأين وكيف وفقلت: رأيت أين وكلمت كيف لكانت هذه الفتحة إعراباً بعد ما كانت قبل التسمية في أين وكيف بناء.
وكذلك لو سميت رجلاً بأمسِ وجيرِ لقلت مررت بأمسٍ وجيرٍ فكانت هذه الكسرة إعراباً بعد ما كانت قبل التسمية بناء.
وهذا واضح.
فإن سميته بهؤلاء فقلت في الجر: مررت بهؤلاء كانت كسرة الهمزة بعد التسمية به هي الكسرة قبل التسمية به.
وخالف هؤلاء باب أمس وجير وذلك أن هؤلاء مما يجب بناؤه وحكايته بعد التسمية به على ما كان من قبل التسمية ألا ترى أنه اسم ضم إليه حرف فأشبه الجملة كرجل سميته بلعل فإنك تحكي الاسم لأنه حرف ضم إليه حرف وهو عَلَّ ضمت إليه اللام كما أنك لو سميته بأنت لحكيته أيضاً فقلت: رأيت أنت ولعل فكانت الفتحة في التاء بعد التسمية به هي التي كانت فيه قبلها لكنك إن سميته بأولاء أعربته فقلت: هذا أولاء ورأيت أولاءً ومررت بأولاٍ فكانت الكسرة لأن فيه إعراباً لا غير لأن أولاء اسم مفرد مثاله فعال كغراب وعقاب.
ومن الحركات في هذا الباب أن ترخم اسم رجل يسمى منصوراً فتقول على لغة من قال يا حارِ: يا منصُ ومن قال يا حارُ قال كذلك أيضاً بضم الصاد في الموضعين جميعاً.
أما على يا حار فلأنك حذفت الواو وأقررت الضمة بحالها كما أنك لما حذفت الثاء أقررت الكسرة بحالها.
وأما على يا حار فلأنك حذفت الواو والضمة قبلها كما في يا حارُ حذفت الثاء والكسرة قبلها ثم اجتلبت ضمة النداء فقلت: يا مَنْصُ.
فاللفظان كما ترى واحد والمعنيان مختلفان.
ومثل ذلك قول العرب في جمع الفُلكِ: الفُلْك كسروا فُعْلا على فُعْلٍ من حيث كانت فٌعْل تعاقب فَعَلاً على المعنى الواحد نحو الشُغْل والشَغَلِ والبُخْلِ والبَخَل و العُجْمِ والعَجَم والعُرْب والعَرَب.
وفَعَلٌ مما يكسر على فُعْل كأََسَدٍ وأسْد ووَثَنٍ ووُثْن.
حكى صاحب الكتاب إن تدعون من دونه إلا أُثْنا وذكر أنها قراءة.
وكما كسروا فعلا على فُعْل وكانت فُعْل وفَعَل أختين معتقبتين على المعنى الواحد كعجمٍ وعَجَم وبابه جاز أيضاً أن يكسر فُعْل على فُعْل كما ذهب إليه صاحب الكتاب في الفُلْكِ إذ كسر على الفُلْك ألا ترى أن قوله عز اسمه {فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} يدل على أنه واحد وقوله تعالى {حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم} فهذا يدل على الجمعية.
فالفُلْك إذاً في الواحد بمنزلة القُفْلِ والخُرْج والفُلْك في الجميع بمنزلة الحُمْرِ والصُفْر.
فقد ترى اتفاق الضمتين لفظاً واختلافهما تقديراً ومعنى.
وإذا كان كذلك فكسرة الفاء في هجان ودلاص في الواحد ككسرة الفاء في كنازٍ وضناكٍ وكسرة الفاء في هجانٍ ودلاصٍ في الجمع ككسرة الفاء في كرامٍ ولئام.
ومن ذلك قولهم قنو وقنوانٌ وصنو وصنوانٌ وخشف وخشفانٌ ورئد ورئدان ونحو ذلك مما كسر فيه فِعْل على فِعْلان كما كسروا فَعَلا على فِعْلان.
وذلك أن فِعْلا وفَعَلا قد اعتقبا على المعنى الواحد نحو بِدْلٍ وبَدَلٍ وشِبْهٍ وشَبَهٍ ومِثْلٍ ومَثَلٍ.
فكما كسروا فَعَلا على فِعلان كَشَبثٍ وشبْثان وخَرَبٍ وخِرْبانٍ ومن المعتل تاج وتيجان وقاع وقيعان كذلك كسروا أيضاً فِعْلاً على فِعْلان فقالوا: قِنْو وقِنْوانٌ وصِنْو وصِنْوانٌ.
ومن وجه آخر أنهم رأوا فِعْلا وفُعْلا قد اعتقبا على المعنى الواحد نحو العِلْو والعُلْو والسِفْل والسُفْل والرِجْز والرُجْز فكما كسروا فُعْلا على فِعلان ككُوزٍ وكِيزان وحوت وحيتان كذلك كسروا أيضاً فعلا على فعلان نحو صنو وصنوان وحسلٍ وحسلان وخشف وخشفان.
فكما أن كسرة فاء شِبثان وبِرقان غير فتحة فاء شَبثٍ وبَرق لفظاً فكذلك كسرة فاء صنو غير كسرة فاء صِنوان تقديراً.
وكما أن كسرة فاء حيتان وكيزان غير ضمة فاء كُوزٍ وحوت لفظاً فكذلك أيضاً كسرة فاء صِنوان غير كسرة فاء صِنْو تقديرا.
وسنذكر في كتابنا هذا باب حمل المختلف فيه على المتفق عليه بإذن الله.
وعلى هذا فكسرة فاء هجان ودلاص لفظاً غير كسرة فاء هجان ودلاص تقديراً كما أن كسرة فاء كرام ولئام غير فتحة فاء كريم ولئيم لفظا.
وعلى هذا استمرار ما هذه سبيله فاعرفه.
وأما السكون في هذه الطريقة فهو كسكون نون صِنْو وقِنْوٍ فينبغي أن يكون في الواحد غير سكون نون صِنوان وقِنْوان لأن هذا شيء أحدثته الجمعية وإن كان بلفظ ما كان في الواحد ألا ترى أن سكون عين شِبْثان وبِرْقان غير فتحة عين شَبَث وبَرَق فكما أن هذين مختلفان ونظير فِعْل وفِعْلان في هذا الموضع فُعْل وفُعْلان في قولهم قُوم وقُومَان وخُوط وخُوطان.
فواجب إذاً أن تكون الضمة والسكون في فُوم غير الضمة والسكون في فُومان وكذلك خُوط وخُوطان.
ومثله أن سكون عين بُطْنان وظُهْران غير سكون عين بَطْن وظَهْر الباب واحد غير مختلف.
وكذلك كسرة اللام من دِهْليِز ينبغي أن تكون غير كسرتها في دهالِيز لأن هذه كسرة ما يأتي بعد ألف التكسير وإن لم يكن في الواحد مكسورا نحو مفتاح ومفاتيح وجُرْموق وجرامِيق وعلى هذا أيضاً يجب أن تكون ضمة فاء رُبَابٍ غير ضمة فاء رُبى لأن ربابا كعُراق وظُؤارٍ ونُؤَام.
فكما أن أوائل كل منهن على غير أول واحده الذي هو عرق وظئر وتوأم لفظا فكذلك فليكن أول رُبَّى ورُبَابٍ تقديراً.
باب في اتفاق المصاير على اختلاف المصادر
من ذلك اسم الفاعل والمفعول في افتعل مما عينه معتلة أوة ما فيه تضعيف.
فالمعتل نحو قولك: اختار فهو مختار واختير فهو مختار: الفاعل والمفعول واحد لفظاً غير أنهما مختلفان تقديراً ألا ترى أن أصل الفاعل مختِير بكسر العين وأصل المفعول مختَير بفتحها.
وكذلك هذا رجل معتاد للخير وهذا أمر معتاد وهذا فرس مقتاد إذا قاده صاحبه الصاحب مقتاد له.
وأما المدغم فنحو قولك: أنا معتد لك بكذا وكذا وهذا أمر معتد به.
فأصل الفاعل معتدد كمقتطع وأصل المفعول معتدد كمقتطع.
ومثله هذا فرس مستن لنشاطه وهذا مكان مستن فيه إذا استنت فيه الخيل ومنه قولهم " استنت الفصال حتى القرعى ".
وكذلك افعَلَّ وافعالَّ من المضاعف أيضاً نحو هذا بسر محمر ومحمار وهذا وقت محمر فيه ومحمار فيه.
فأصل الفاعل محمِرر ومحمارِر مكسور العين وأصل المفعول محمَرر فيه مفتوحها.
وليس كذلك اسم الفاعل والمفعول في افعل وأفعال إذا ضعف فيه حرفا علة بل ينفصل فيه اسم الفاعل من اسم المفعول عندنا.
وذلك قولك: هذا رجل مُرْعَوٍ وأمر مُرْعَوى إليه وهذا رجل مًغَزاوٍ وهذا وقت مُغْزَاوًى فيه لكنه على مذهب الكوفيين لا فرق بينهما لأنهم يدغمون هذا النحو من مضاعف المعتل ويجرونه مجرى الصحيح فيقولون اغزوا يغزاو وآغزوَّ يغزو.
واستشهد أبو الحسن على فساد مذهبهم بقول العرب: أرعوى.
قال ولم يقولوا: أرعوَّ.
ومثله من كلامهم قول يزيد بن الحكم أنشدنيه أبو علي وقرأته في القصيدة عليه: تبدل خليلا بي كشكلك شكله فإني خليلاً صالحاً بك مقتوى فهذا عندنا مُفْعِّل من القنو وهو المراعاة والخدمة كقوله: إني امرؤ من بني خزيمة لا أحسن قتو الملوك والحفدا وفيها أيضاً: مُدْحَوِى وفيها أيضاً مُحْجَوِى: فهذا كله مُفْعَل كما تراه غير مدغم.
وانفعل في المضاعف كافتعل نحو قولك هذا أمر منحل ومكان منحل فيه ويوم منحل فيه أي تنحل فيهما الأمور.
فهذا طرف من هذا النحو.
ومن ذلك قولك في تخفيف فُعْل من جئت على قول الخليل وأبي الحسن تقول في القولين جميعاً: وذلك أن الخليل يقول في فُعْل من جئت: جيء كقوله فيه من بِعْت بِيعٌ.
وأصل الفاء عنده الضم لكنه كسرها لئلا تنقلب الياء واواً فيلزمه أن يقول: بُوع.
ويستدل على ذلك بقول العرب في جمع أبيض وبيضاء: بيض.
وكذلك عين تكسير أًعْيَن وعَيْناء وشِيم في أشيم وشيماء.
وأبو الحسن يخالفه فيقر الضمة في الفاء فيبدل لها العين واواً فيقول: برع وجوء.
فإذا خففا جميعاً صارا إلى جُيٍ لا غير.
فأما الخليل فيقول: إذا تحركت العين بحركة الهمزة الملقاة عليها فقويت رددت ضمة الفاء لأمنى على العين القلب فأقول: جيٌ وأما أبو الحسن فيقول: إنما كنت قلت: جُوء فقلبت العين واواً لمكان الضمة قبلها وسكونها فإذا قويت بالحركة الملقاة عليها تحصنت فحمت نفسها من القلب فأقول: جُي.
أفلا ترى إلى ما ارتمى إليه الفرعان من الوفاق بعد ما كان عليه الأصلان من الخلاف.
وهذا ظاهر.
ومن ذلك قولك في الإضافة إلى مائة في قول سيبويه ويونس جميعاً فيمن رد اللام: مئوى كمعوى فتوافى اللفظان على أصلين مختلفين.
ووجه ذلك أن مائة أصلها عند الجماعة مِئية ساكنة العين فلما حذفت اللام تخفيفاً جاورت العين تاء التأنيث فانفتحت على العادة والعرف في ذلك فقيل: مئة.
فإذا رددت اللام فمذهب سيبويه أن يقر العين بحالها متحركة وقد كانت قبل الرد مفتوحة فتقلب لها الام ألفاً فيصير تقديرها: مِئا كمعي فإذا أضفت إليها أبدلت الألف واوا فقلت: مئوى كثنوى.
وأما مذهب يونس فإنه كان إذا نسب إلى فَعْلة أو فعْلة مما لامه ياء أجراه مجرى ما أصله فَعِلة ألا تراه كيف كان يقول في الإضافة إلى ظَبْية: ظَبوَى ويحتج بقول العرب في النسب إلى بطية: بِطَوِيّ وإلى زنية: زِنَوِيّ فقياس هذا أن تجري مائة وإن كانت فِعْلة مجرى فِعِلة فتقول فيها: مِئَوىّ.
فيتفق اللفظان من أصلين مختلفين.
ومن ذلك أن تبنى من قلت ونحوه فُعُلا فتسكن عينه استثقالاً للضمة فيها فتقول: فُولٌ كما يقول أهل الحجاز في تكسير عَوَان ونَوَار: عُون ونُور فيسكنون وإن كانوا يقولون: رُسُل وكُتُب بالتحريك.
فهذا حديث فُعُل من باب قلت.
وكذلك فُعْل منه أيضاً قُول فيتفق فُعُل وفُعْل فيخرجان على لفظ متفق عن أول مختلف.
وكذلك فِعْل من باب بعت وفُعْل في قول الخليل وسيبويه: تقول فيهما جميعاً بيعٌ.
وسألت أبا علي رحمه الله فقلت: لو أردنا فُعْلات مما عينه ياء لا نريد بها أن تكون جارية على فِعْلة كتينة وتينات فقال أقول على هذا الشرط: تونات وأجراها لبعدها عن الطرف مُجرى واو عُوطَطٍ.
ومن ذلك أن تبنى من غَزَوت مثل إصبُع بضم الباء فتقول: إغزٍ.
وكذلك إن أردت مثل إصبع قلت أيضا: إغز.
فيستوي لفظ إفعُل ولفظ إفْعِل.
وذلك أنك تبدل من الضمة قبل الواو كسرة فتقلبها ياء فيستوي حينئذ لفظها ولفظ إفِعل.
وإِصْبُع وإن كانت مستكَرهة لخروجك من كسر وما يخرج إلى لفظ واحد عن أصلين مختلفين كثير لكن هذا مذهبه وطريقه فاعرفه وقسه.
ومن ذلك قولك في جمع تعزية وتعزوة جميعاً: تَعَازٍ وكذلك اللفظ بمصدر تعازَينا أي عَزَّى بعضًنا بعضاً: تعاز يا فتى.
فهذه تفاعُل كتضارُب وتحاسد وأصلها تعازو ثم تعازِى ثم تعازٍ.
فأما تعازٍ في الجمع فأصل عينها الكسر كنتافِل وتناضِب جمع تتفُل وتَنْضُبٍ.
ونظائره كثيرة.
باب في ترافع الأحكام
هذا موضع من العربية لطيف لم أر لأحد من أصحابنا فيه رسماً ولا نقلوا إلينا فيه ذكرا.
من ذلك مذهب العرب في تكسير ما كان من فعل على أفعال نحو عَلَم وأعلام وقدمٍ وأقدام ورَسنٍ وأرسان وفَدَنٍ وأفدانٍ.
قال سيبويه: فإن كان على فَعَلة كسروه على أَفْعُلٍ نحو أَكَمةٍ وآكُمٍ.
ولأجل ذلك ما حمل أمة على أنها فَعَلة لقولهم في تكسيرها: آمٍ إلى هنا انتهى كلامه إلا أنه أرسله ولم يعلله.
والقول فيه عندي أن حركة العين قد عاقبت في بعض المواضع تاء التأنيث وذلك في الأدواء نحو قولهم: رمث رمثا وحبط حبطا وحبج حبجاً.
فإذا ألحقوا التاء أسكنوا العين فقالوا: حَقِل حَقْلة ومغَل مَغْلة.
فقد ترى إلى معاقبة حركة العين تاء التأنيث.
ومن ذلك قولهم: جَفْنة وجَفَنات وقَصْعة وقَصَعات لما حذفوا التاء حركوا العين.
فلما تعاقبت التاء وحركة العين جريا لذلك مجرى الضدين المتعاقبين.
فلما اجتمعا في فَعَلة ترافعا أحكامهما فأسقطت التاءُ حكم الحركة وأسقطت الحركة حكم التاء.
فآل الأمر بالمثال وهذا حديث من هذه الصناعة غريب من هذه الصناعة غريب المأخذ لطيف المضطرب.
فتأمله فإنه مُجْدٍ عليك مُقَوِّ لنظرك.
ومن فَعَلة وأفعُل رَقَبة وأَرْقُب وناقة وأَيْنُق.
ومن ذلك أنا قد رأينا تاء التأنيث تعاقب ياء المد وذلك نحو فرازين وفرازنة وحجاجيح وجحاجحة وزناديق وزنادقة.
فلما نسبوا إلى نحو حنيفة وبجيلة تصوروا ذلك الحديث أيضاً فترافعت التاء والياء أحكامهما فصارت حنيفة وبجيلة إلى أنهما كأنهما حَنِف وبَجِل فجريا لذلك مجرى شَقِر ونَمِر فكما تقول فيهما: شَقَرِيّ ونَمَريّ كذلك قلت أيضاً في حنيفة: حنفي وفي بجيلة: بجلي.
يؤكد ذلك عندك أيضاً أنه إذا لم تكن هناك تاء كان القياس إقرار الياء كقولهم في حنيف: حنيفي وفي سعيد: سعيديّ.
فأما ثقفي فشاذ عنده ومشبه بحنفي.
فهذا طريق آخر من الحجاج في باب حنفيّ وبجليّ مضاف إلى ما يحتج به أصحابنا في حذف تلك الياء.
ومما يدلك على مشابهة حرف المد قبل الطرف لتاء التأنيث قولهم: رجل صَنَع اليد وامرأة صَنَاع اليد فأغنت الألف قبل الطرف مغنى التاء التي كانت تجب في صنعة لو جاءت على حكم نظيرها نحو حَسَن وحَسَنةٍ وبَطَلٍ وبَطَلة.
وهذا أيضاً حَسَن في بابه.
ويزيد عندك في وضوح ذلك أنهم قالوا في الإضافة إلى اليمن والشأم وتهامة: يمان وشآم وتهامٍ فجعلوا الألف قبل الطرف عوضاً من إحدى الياءين اللاحقتين بعدها.
وهذا يدلك أن الشيئين إذا اكتنفا الشيء من ناحيتيه تقاربت حالاهما وحالاه بهما.
ولأجله وبسببه ما ذهب قوم إلى أن حركة الحرف تحدث قبله وآخرون إلى أنها تحدث بعده وآخرون إلى أنها تحدث معه.
قال أبو علي: وذلك لغموض الأمر وشدة القرب.
نعم وربما احتج بهذا لحسن تقدم الدلالة وتأخرها هذا في موضع وهذا في موضع.
وذلك لإحاطتهما جميعاً بالمعنى المدلول عليه.
فمما تأخر دليله قولهم: ضربني وضربت زيداً ألا ترى أن المفسر للضمير المتقدم جاء من بعده.
وضده زيد ضربته لأن المفسر للضمير متقدم عليه.
وقريب من هذا أيضاً إتباع الثاني للأول نحو شُدٌّ وفِرٌّ وضّنَّ وعكسه قولك: اقتل اُستُضعِف ضممت الأول للآخر.
فإن قلت: فإن في تهامة ألفا فلم ذهبت إلى أن الألف في تهام عوض من إحدى الياءين للإضافة قيل: قال الخليل في هذا: إنهم كأنهم نسبوه إلى فَعْل أو فَعَل وكأنهم فكوا صيغة تهامة فأصاروها إلى تَهَمٍ أو تَهْم ثم أضافوا إليه فقالوا: تهامٍ.
وإنما ميل الخليل بين فَعْل وفَعَل ولم يقطع بأحدهما لأنه قد جاء هذا العمل في هذين المثالين جميعاً وهما الشأم واليمن.
وهذا الترجيم الذي أشرف عليه الخليل ظنَّا قد جاء به السماع أرَّقنى الليلةَ بَرْقٌ بالتَهم يا لكَ برقا من يَشُفْه لا ينمْ فانظر إلى قوة تصور الخليل إلى أن هجم به الظن على اليقين فهو المعنى بقوله: الألمعى الذيب يظنُّ بك الظ ن كأن قد رأى وقد سمعا وإذا كان ما قدمناه من أن العرب لا تكسر فعلة على أفعال مذهبا لها فواجب أن يكون أفلاء من قوله: مثلها يخرج النصيحة للقو م فلاة من دونها أفلاء تكسير فلا الذي هو جمع فلاة لا جمعا لفلاة إذ كانت فَعَلة.
و على هذا فينبغي أيضاً أن يكون قوله: كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصفي إنما هو تكسير صفاً الذي هو جمع صفاة إذ كانت فعلة لا تكسر على فعول إنما ذلك فعلة كبدرة وبدور ومأنة ومئون.
أو فعل كطلل وطلول وأسد وأسود.
وقد ترى بهذا أيضاً مشابهة فعلة لفعل في تكسيرهما جميعاً على فعول.
ومن ذلك قولهم في الزكام: آرضه الله وأملأه وأضأده.
وقالوا: هي الضؤدة والملأة والأرض.
و الصنعة في ذلك أن فُعْلا قد عاقبت فَعَلا على الموضع الواحد نحو المعُجْم والعَجَم والعُرْب والعَرَب والشُغْل والشَغَل والبُخْل والبَخَل.
و قد عاقبتها أيضاً في التكسير على أفعال نحو بُرْدٍ وأبراد وجُنْد وأجناد فهذا كقلم وأقلام وقدم وأقدام.
فلما كان فُعْل من حيث ذكرنا كفَعَل صارت الملأة والضؤدة كأنها فعلة وفعلة قد كسرت على أفْعُل على ما قدمنا في أكمة وآكُم وأمة وآمٍ.
فكما رفعت التاء في فَعَلة حكم الحركة في العين ورفعت حركة العين حكم التاء فصار الأمر لذلك إلى حكم فَعْلٍ حتى قالوا: أكمة وآكم ككلب وأكلب وكعب وأكعب فكذلك جرت فُعْلة مجرى فَعْل حتى عاقبته في الضؤدة والملأة والأرض فصارت الأرض كأنه أرضة أو صار الملأة والضؤدة كأنهما ملء وضأد.
أفلا ترى إلى الضمة كيف رفعت حكم التاء كما رفعت التاء حكم الضمة وصار الأمر إلى فَعْل.
باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني
هذا فصل من العربية حسن كثير المنفعة قوي الدلالة على شرف هذه اللغة.
وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة فتبحث عن أصل كل اسم منها فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه.
وذلك كقولهم خُلق الإنسان فهو فعل من خلقت الشيء أي ملسته ومنه صخرة خلقاء للملساء.
ومعناه أن خلق الإنسان هو ما قدر له ورتب عليه فكأنه أمر قد استقر وزال عنه الشك.
ومنه قولهم في الخبر: قد فرغ الله من الخَلْق والخُلقُ.
والخليقة فَعِيلة منه.
وقد كثرت فعيلة في هذا الموضع.
وهو قولهم: الطبيعة وهي من طبعت الشيء أي قررته على أمر ثبت عليه كما يطبع الشيء كالدرهم والدينار فتلزمه أشكاله فلا يمكنه انصرافه عنها ولا انتقاله.
ومنها النحية وهي فَعِيلة من نحت الشيء أي ملسته وقررته على ما أردته منه.
فالنحيتة كالخليقة: هذا من نحت وهذا من خلقت.
ومنها الغريزة وهي فعيلة من غرزت كما قيل لها طبيعة لأن طبع الدرهم ونحوه ضرب من وسمه وتغريزه بالآلة التي تثبت عليه الصورة.
وذلك استكراه له وغمز عليه كالطبع.
ومنها النقيبة وهي فَعِيلة من نقبت الشيء وهو نحو من الغريزة.
ومنها الضريبة وذلك أن الطبع لا بد معه من الضرب لتثبيت له الصورة المرادة.
ومنها النخيزة هي فَعِيلة من نَخَزْت الشيء أي دققته ومنه المنحاز: الهاوون لأنه موضوع للدفع به والاعتماد على المدقوق قال: ينحزن من جانبيها وهي تنسلب أي تضرب الإبل حول هذه الناقة للحاق بها وهي تسبقهن وتنسلب أمامهن.
ومنها السجية هي فعيلة من سجا يسجو إذا سكن ومنه طرف ساج وليل ساج قال: يا حبذا القمراء والليل الساج وطرق مثل ملاء النساج وقال الراعي: ألا أسلمي اليوم ذات الطوق والعاج والدل والنظر المستأنس الساجي وذلك أن خلق الإنسان أمر قد سكن إليه واستقر عليه ألا تراهم يقولون في مدح الرجل: فلان يرجع إلى مروءة ويخلد إلى كرم ويأوي إلى سداد وثقة.
فيأوي إليه هو هذا لان المأوى ومنها الطريقة من طرقت الشيء أي وطأتة وذللته وهذا هو معنى ضربته ونقبته وغرزته ونحته لأن هذه كلها رياضات وتدريب واعتمادات وتهذيب.
ومنها السجيحة وهي فَعِيلة من سجح خلقه.
وذلك أن الطبييعة قد قرت واطمأنت فسجحت وتذللت.
وليس على الإنسان من طبعه كُلْفَة وإنما الكلفة فيما يتعاطاه ويتجشمه قال حسان: ذروا التخاجؤ وامشوا مشية سجحاً إن الرجحال ذوو عصب وتذكير وقال الأصمعي: إذا استوت أخلاق القوم قيل: هم على سرجوجة واحدة ومرن واحد ومنهم من يقول: سرجيجة وهي فعليلة من هذا فسرجوجة: فعلولة من لفظ السرج ومعناه.
والتقاؤهما أن السرج إنما أريد للراكب ليعدله ويزل اعتلاله وميله.
فهو من تقويم الأمر.
وكذلك إذا استتبوا على وتيرة واحدة فقد تشابهت أحوالهم وزاح خلافهم وهذا أيضاً ضرب من التقرير والتقدير فهو بالمعنى عائد إلى النحيتة والسجية والخليقة لأن هذه كلها صفات تؤذن بالمشابهة والمقاربة.
والمرن ومصدر كالحلف والكذب.
والفعل منه مرن على الشيء إذا ألفه فلان له.
وهو عندي من مارن الأنف لما لان منه.
فهو أيضاً عائد إلى أصل الباب ألا ترى أن الخليقة والنحيتة والطبيعة والسجية وجميع هذه المعاني التي تقدمت تؤذن بالإلف والملاينة والإصحاب والمتابعة.
ومنها السليقة وهي من قولهم: فلان يقرأ بالسليقية أي بالطبيعة.
وتلخيص ذلك أنها كالنحيتة.
وذلك أن السليق ما تحات من صغار الشحر قال: تسمع منها في السليق الأشهب معمعة مثل الأباء الملهب وذلك أنه إذا تحات لان وزالت شدته.
والحت كالنحت وهما في غاية القرب.
ومنه قول الله سبحانه سلقوكم بألسنة حداد أي نالوا منكم.
وهذا هو نفس المعنى في الشيء المنحوت المحتوت ألا تراهم يقولون: فلان كريم النجار والنجر أي الأصل.
والنجر والنحت والحت والضرب والدق والنحز والطبع والخلق والغرز والسلق وكله التمرين على الشيء وتلييين القوى ليصحب وينجذب.
فأعجب للطف صنع الباري سبحانه في أن طبع الناس على هذا وأمكنهم من ترتيبه وتنزيله وهداهم للتواضع عليه وتقريره.
ومن ذلك قولهم للقطعة من المسك: الصوار قال الأعشى: إذا تقوم يضوع المسك أصورة والعنبر الورد من أردانها شمل فقيل له: صوار لأنه فعال من صاره يصوره إذا عطفه وثناه قال الله سبحانه {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ} وإنما قيل له ذلك لأنه يجذب حاسة من يشمه إليه وليس من خبائث ولو أن ركنا يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب وكذا تجد أيضاً معنى المسك.
وذلك أنه فعل من أمسكت الشيء كأنه لطيب رائحته يمسك الحاسة عليه ولا يعدل بها صاحبها عنه.
ومنه عندي قولهم للجلد: المسك هو فعل من هذا الموضع ألا ترى أنه يمسك ما تحته من جسم الإنسان وغيره من الحيوان.
ولولا الجلد لم يتماسك ما في الجسم: من اللحم والشحم والدم وبقية الأمشاج وغيرها.
فقولهم إذا: مسك يلاقي معناه معنى الصوار إن كانا من أصلين مختلفين وبناءين متباينين: أحدهما " م س ك " والآخر ص و ر " كما أن الخليقة من " خ ل ق " والسجية من " س ج و " والطبيعة من " ط ب ع " والنحيتة من " ن ح ت " والغريزة من " غ ر ز " والسليقة من " س ل ق " والضريبة من " ض ر ب " والسجيحة من " س ج ح " والسرجوجة والسرجيجة من " س ر ج " والنجار من " ن ج ر " والمرن من " م ر ن ".
فالأصول مختلفة والأمثلة متعادية والمعاني مع ذينك متلاقية.
ومن ذلك قولهم: صبي وصبية وطفل وطفلة وغلام وجارية وكله للين والانجذاب وترك الشدة والاعتياص.
وذلك أن صبياً من صبوت إلى الشيء إذا ملت إليه ولم تستعصم دونه.
وكذلك الطفل: هو من لفظ طفلت الشمس للغرب أي مالت إليه وانجذبت نحوه ألا ترى إلى والشمس قد كادت تكون دنفا يصف ضعفها وإكبابها.
وقد جاء به بعض المولدين فقال: وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرعا ومنه قيل: فلان طفيلي وذلك أنه يميل إلى الطعام.
وعلى هذا قالوا له: غلام لأنه من الغلمة وهي اللين وضعفة العصمة.
وكذلك قالوا: جارية.
فهي فاعلة من جرى الماء وغيره ألا ترى أنهم يقولون: إنها غضة بضة رطبة ولذلك قالوا: قد علاها ماء الشباب قال عمر: وهي مكنونة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب وذلك أن الطفل والصبي والغلام والجارية ليست لهم عصمة الشيوخ ولا جسأة الكهول.
وسألت بعض بني عقيل عن قول الحمصي: لم تبل جدة سمرهم سمر ولم تسم السموم لأدمهن أديما فقال: هن بمائهن كما خلقنه.
فإذا اشتد الغلام شيئاً قيل له حرور.
وهو فعول من اللبن الحازر إذا اشتد للحموضة قال العجلي: وكأنهم زادوا الواو وشددوها لتشديد معنى القوة كما قالوا للسيء الخلق: عذور فضاعفوا الواو الزائدة لذلك قال: إذا نزل الأضياف كان عذورا على الحي حتى تستقل مراجله ومنه رجل كروس للصلب الرأس وسفر عطود للشديد قال: إذا جشمن قذفا عطودا رمين بالطرف مداه الأبعدا ومثل الأول: قولهم: غلام رطل وجارية رطلة للينها.
وهو من قولهم: رطل شعره إذا أطاله فاسترخى.
ومنه عندي الرطل الذي يوزن به.
وذلك أن الغرض في الأوزان أن تميل أبداً إلى أن يعادلها الموزون بها.
ولهذا قيل لها: مثاقيل فهي مفاعيل من الثقل والشيء إذا ثقل استرسل وارجحن فكان ضد الطائش الخفيف.
فهذا ونحوه من خصائص هذه اللغة الشريفة اللطيفة.
وإنما يسمع الناس هذه الألفاظ فتكون الفائدة عندهم منها إنما هي علم معنياتها.
فأما كيف ومن أين فهو ما نحن عليه.
وأحج به أن يكون عند كثير منهم نيفاً لا يحتاج إليه وفضلا غيره أولى منه.
ومن ذلك أيضاً قالوا: ناقة كما قالوا: جمل.
وقالوا ما بها دبيج كما قالوا: تناسل عليه الوشاء.
والتقاء معانيهما أن الناقة كانت عندهم مما يتحسنون به ويتباهون بملكه فهي فعلة من .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تنوقت به حضرميات الأكف الحوائك وعلى هذا قالوا: جمل لأن هذا فَعَل من الجمال كما أن تلك فَعَلة من تنوقت وأجود اللغتين تأنقت قال الله سبحانه: {وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ}.
وقولهم: ما بها دبيج هو فِعْيل من لفظ الديباج ومعناه.
وذلك أن الناس بهم العمارة وحسن الآثار وعلى أيديهم يتم الأنس وطيب الديار.
ولذلك قيل لهم: ناس لأنه في الأصل أناس فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال.
فهو فعال من الأنس قال: أناس لا يملون المنايا إذا دارت رحى الحرب الزبون وقال: أناس عدا علقت فيهم وليتني طلبت الهوى في رأس ذي زلق أشم وكما اشتقوا ديبجا من الديباج كذلك اشتقوا الوشاء من الوشي فهو فعال منه.
وذلك أن المال يشي الأرض ويحسنها.
وعلى ذلك قالوا: الغنم لأنه من الغنيمة كما قالوا لها: الخيل لأنها فَعْل من الاختيال وكل ذلك مستحب.
أفلا ترى إلى تتالي هذه المعاني وتلاحظها وتقابلها وتناظرها وهي النتوق والجمال والأنس والديباج والوشي والغنيمة والاختيال.
ولذلك قالوا: البقر من بقرت بطنه أي شققته فهو إلى فإن قلت: فإن الشاة من قولهم: رجل أشوه وامرأة شوهاء للقبيحين.
وهذا ضد الأول ففيه جوابان: أحدهما أ تكون الشاة جرت مجرى القلب لدفع العين عنها لحسنها كما يقال في استحسان الشيء: قاتله الله كقوله: رمى الله في عيني بثينة بالقدى وفي الشنب من أنيابها بالقوادح وهو كثير.
والآخر أن يكون من باب السلب كأنه سلب القبح منها كما قيل للحرم: نالة.
ولخشسبة الصرار تودية ولجو السماء السكاك.
ومنه تحوب وتأثم أي ترك الحوب والإثم.
وهو باب واسع وقد كتبنا منه في هذا الكتاب ما ستراه بإذن الله تعالى.
وأهل اللغة يسمعون هذا فيرونه ساذجا غفلا ولا يحسنون لما نحن فليه من حديثه فرعا ولا أصلاً.
ومن ذلك قولهم: الفضة سميت بذلك لانفضاض أجزائها وتفرقها في تراب معدنها كذا أصلها وإن كانت فيما بعد قد تصفى وتهذب وتسبك.
وقيل لها فضة كما قيل لها لجين.
وذلك لأنها ما دامت في تراب معدنها فيه ملتزقة في التراب متلجنة به قال الشماخ: وماء قد وردت أميم طام عليه الطير كالورق اللجين أي المتلزق المتلجن وينبغي أن يكونوا إنما ألزموا هذا الاسم التحقير لاستصغار معناه ما دام في تراب معدنه.
ويشهد عندك بهذا المعنى قولهم في مراسله الذهب وذلك لأنه ما دام كذلك غير مصفى فهو كالذاهب لأن ما فيه من التراب كالمستهلك له أو لأنه لما قل في الدنيا فلم يوجد إلا عزيزاً صار كأنه مفقود ذاهب ألا ترى أن الشيء إذا قل قارب الانتفاء.
وعلى ذلك قالت العرب: قل رجل يقول ذلك إلا زيد بالرفع لأنهم أجروه مجرى ما يقول ذاك أحد إلا زيد.
وعلى نحو من هذا قالوا: قلما يقوم زيد فكفوا قل بما عن اقتضائها الفاعل وجاز عندهم إخلاء الفعل من الفاعل لما دخله من مشابهة حرف النفي كما بقوا المبتدأ بلا خبر في نحو هذا من قولهم: أقل امرأتين تقولان ذلك لما ضارع المبتدأ حرف النفي.
أفلا ترى إلى أنسهم باستعمال القلة مقارنة للانتفاء.
فكذلك لما قل هذا الجوهر في الدنيا أخذوا له اسماً من الذهاب الذي هو الهلاك.
ولأجل هذا أيضاً سموه تبراً لأنه فعل من التبار.
ولا يقال له تبر حتى يكون في تراب معدنه أو مكسور.
ولهذا قالوا للجام من الفضة الغرب وهو فعل من الشيء الغريب وذلك أنه ليس في العادة والعرف استعمال الأنية من الفضة فلما استعمل ذلك في بعض الأحوال كان عزيزاً غريباً.
هذا قول أبي إسحق.
وإن شئت جذبته إلى ما كنا عليه فقلت: إن هذا الجوهر غريب من بين الجواهر لنفاسته وشرفه ألا تراهم إذا أثنوا على إنسان قالوا: هو وحيد في وقته وغريب غربته العلا على كثرة النا س فأضحى في الأقربين جنيبا فليطل عمره فلو مات في مر و مقيما بها لمات غريبا وقول شاعرنا: أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني ولا أعاتبه صفحاً وإهوانا وهكذا كنت في أهلي وفي وطني إن النفيس عزيز حيثما كانا ويدلك على أنهم قد تصوروا هذا الموضع من امتزاجه بتراب معدنه أنهم إذا صفوه وهذبوه أخذوا له اسماً من ذلك المعنى فقالوا له: الخلاص والإبريز والعقيان.
فالخلاص فعال من تخلص والإبريز إفعيل من برز يبرز والعقيان فعلان من عقى الصبي يعقي وهو أول ما ينجيه عند سقوطه من بطن أمه قبل أن يأكل وهو العقي.
فقيل له ذلك لبروزه كما قيل له البراز.
فالتأتي والتلطف في جميع هذه الأشياء وضمها وملاءمة ذات بينها هو خاص اللغة وسرها وطلاوتها الرائقة وجوهرها.
فأما حفظها ساذجة وقمشها محطوبة هرجة فنعوذ بالله منه ونرغب بما أتاناه سبحانه عنه.
وقال أبو علي رحمه الله: قيل له حبي كما قيل له سحاب.
تفسيره أن حبيا فعيل من حبا يحبو.
وكأن السحاب لثقله يحبو حبواً كما قيل له سحاب وهو فعال من سحب لأنه يسحب وأقبل يزحف زحف الكسير سياق الرعاء البطاء العشارا وقال أوس: دان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراح وقالت صبية منهم لأبيها فتجاوزت ذلك: أناخ بذي نفر بركه كأن على عضديه كتافا وقال أبوهم: وألقى بصحراء الفبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المحمل قال: ومن ذلك قولهم في أسماء الحاجة: الحاجة والحوجاء واللوجاء والإرب والإربة والمأربة واللبانة والتلاوة بقية الحاجة والتلية أيضاً والأشكلة والشهلاء قال الشاعر: لم أقض حين ارتحلوا شهلائي من الكعاب الطفلة الغيداء وأنت تجد مع ذلك من اختلاف أصولها ومبانيها جميعها راجعاً إلى موضع واحد ومخطوما بمعنى لا يختلف وهو الإقامة على الشيء والتشبث به.
وذلك أن صاحب الحاجة كلف بها ملازم للفكر فيها ومقيم على تنجزها واستحثاثها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حبك الشيء يعمى ويصم ) وقال المولد: وتفسير ذلك أن الحاج شجر له شوك وما كانت هذه سبيله فهو متشبث بالأشياء فأي شيء مر عليه اعتاقه وتشبث به.
فسميت الحاجة تشبيهاً بالشجرة ذات الشوك.
أي أنا مقيم عليها متمسك بقضائها كهذه الشجرة في اجتذابها ما مر بها وقرب منها.
والحوجاء منها وعنها تصرف الفعل: احتاج يحتاج احتياجا وأحوج يحوج وحاج يحوج فهو حائج.
واللوجاء من قولهم: لجت الشيء ألوجه لوجا إذا أدرته في فيك.
والتقاؤهما أن الحاجة مترددة على الفكر ذاهبة جائية إلى أن تقضى كما أن الشيء إذا تردد في الفم فإنه لا يزال كذلك إلى أن يسيغه الإنسان أو يلفظه.
والإرب والإربة والمأربة كله من الأربة وهي العقدة وعقد مؤرب إذا شدد.
وأنشد أبو العباس لنكاز بن نفيع يقوله لجرير: غضبت علينا أن علاك ابن غالب فهلا على جديك إذ ذاك تغضب! هما حين يسعى المرء مسعاة جده أناخا فشداك العقال المؤرب! والحاجة معقودة بنفس الإنسان مترددة على فكره.
واللبانة من قولهم: تلبن بالمكان إذا أقام به ولزمه.
وهذا هو المعنى عينه.
والتلاوة والتلية من تلوت الشيء إذا قفوته واتبعته لتدركه.
ومنه قوله: والأشكلة كذلك كأنها من الشكال أي طالب الحاجة مقيم عليها كأنها شكال له ومانعة من تصرفه وانصرافه عنها.
ومنه الأشكل من الألوان: الذي خالطت حمرته بياضه فكأن كل واحد من اللونين أعتاق صاحبه أن يصح ويصفو لونه.
والشهلاء كذلك لأنها من المشاهلة وهي مراجعة القول قال: قد كان فيما بيننا مشاهلة ثم تولت وهي تمشي البأدله البأدلة: أن تحرك في مشيها بآدلها وهي لحم صدرها.
وهي مشية القصار من النساء.
فقد ترى إلى ترامي هذه الأصول والميل بمعانيها إلى موضع واحد.
ومن ذلك ما جاء عنهم في الرجل الحافظ للمال الحسن الرعية له والقيام عليه.
يقال: هو خال مال وخائل مال وصدى مال وسرسور مال وسؤبان مال ومحجن مال وإزاء مال وبلو مال وحبل مال وعسل مال وزر مال.
وجميع ذلك راجع إلى الحفظ لها والمعرفة بها.
فخال مال يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون صفة على فَعَل كبطل وحسن أو فَعِلٍ ككبش صاف ورجل مال.
ويجوز أن يكون محذوفاً من فاعل كقوله: لاثٌ به الأشاء والعبرى فأما خائل مال ففاعل لا محالة.
وكلاهما من قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أي يتعهدنا بها شيئاً فشيئاً ويراعينا.
قال أبو علي: هو من قولهم تساقطوا أخولَ أخولَ أي شيئاً بعد شيء.
وأنشدنا: يساقط عنه روقه ضارياتها سقاط حديد القين أخول أخولا فكأن هذا الرجل يرعى ماله ويتعهده حفظاً له وشحاً عليه.
وأما صدى مال فإنه يعارضها من ههنا وههنا ولا يهملها ولا يضيع أمرها ومنه الصدى لما يعارض الصوت.
ومنه قراءة الحسن رضي الله عنه صاد والقرآن وكان يفسره: عارض القرآن بعملك أي قابل كل واحد منهما بصاحبه قال العجلي: يأتي لها من أيمن وأشمل وكذلك سرسور مال أي عارف بأسرار المال فلا يخفى عنه شيء من أمره.
ولست أقول كما يقول الكوفيون وأبو بكر معهم: إن سرسورا من لفظ السر لكنه قريب من لفظه ومعناه بمنزلة عين ثرة وثرثارة.
وقد تقدم ذكر ذلك.
وكذلك سوبان مالٍ هو فُعْلان من السأب وهو الزق للشراب قال الشاعر: إذا ذقت فاها قلت علق مدمس أريد به قيل فغودر في ساب والتقاؤهما أن الزق إنما وضع لحفظ ما فيه فكذلك هذا الراعي يحفظ المال ويحتاط عليه وكذلك محجن مال هو مِفْعل من احتجنت الشيء إذا حفظته وادخرته.
وكذلك إزاء مال هو فِعَال من أزى الشيء يأزى إذا تقبض واجتمع قال: ظل لها يوم من الشعري أزى أي يغم الأنفاس ويضيقها لشدة الحر.
وكذلك هذا الراعي يشح عليها ويمنع من تسربها.
وأنشد أبو علي عن أبي بكر لعمارة: هذا الزمان مول خيره أزى صارت رءوس به أذناب أعجاز وكذلك بلو مال أي هو بمعرفته به قد بلاه واختبره قال الله سبحانه {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} قال عمر بن لجأ: فصادفت أعصل من أبلائها يعجبه النزع على ظمائها وكذلك حبل مال كأنه يضبطها كما يضبطها الحبل يشد به.
ومنه الحبل: الداهية من الرجال لأنه يضبط الأمور ويحيط بها.
وكذلك عسل مال لأنه يأتيها ويعسل إليها من كل مكان ومنه الذئب العسول ألا ترى أنه إنما سمي ذئباً لتذاؤ به وخبثه ومجيئه تارة من هنا ومرة من هنا.
وكذلك زر مال: أي يجمعه ويضبطه كما يضبط الزر الشيء المزرور.
ومن ذلك قولهم للدم: الجدية والبصيرة.
فالدم من الدمية لفظاً ومعنى.
وذلك أن الدمية إنما هي للعين والبصر وإذا شوهدت فكأن ما هي صورته مشاهد بها وغير غائب مع حضورها فهي تصف حال ما بعد عنك.
وهذا هو الغرض في هذه الصور المرسومة للمشاهدة.
وتلك عندهم حال الدم ألا ترى أن الرمية إذا غابت عن الرامي استدل عليها بدمها فاتبعه حتى يؤديه إليها.
ويؤكد ذلك لك قولهم فيه البصيرة وذلك أنها إذا أبصرت أدت إلى المرمى الجريح.
ولذلك أيضاً قالوا له الجدية لأنه يجدي على الطالب للرمية ما يبغيه منها.
ولو لم ير الدم لم يستدلل عليها ولا عرف موضعها قال صلى الله عليه وسلم ( كل ما أصميت ودع وهذا مذهب في هذه اللغة طريف غريب لطيف.
وهو فقهها وجامع معانيها وضام نشرها.
وقد هممث غير دفعة أن أنشء في ذلك كتاباً أتقصى فيه أكثرها والوقت يضيق دونه.
ولعله لو خرج لما أقنعه ألف ورقة إلا على اختصار وإيماء.
وكان أبو علي رحمه الله يستحسن هذا الموضع جداً وينبه عليه ويسر بما يحضره خاطره منه.
هذا باب إنما يجمع بين بعضه وبعض من طريق المعاني مجردة من الألفاظ وليس كالاشتقاق الذي هو من لفظ واحد فكأن بعضه منبهة على بعض.
وهذا إنما يعتنق فيه الفكر المعاني غير منبهته عليها الألفاظ.
فهو أشرف الصنعتين وأعلى المأخذين.
فتفطن له وتأن لجمعه فإنه يؤنقك ويفئ عليك ويبسط ما تجعد من خاطرك ويريك من حكم الباري عز اسمه ما تقف تحته وتسلم لعظم الصنعة فيه وما أودعته أحضانه ونواحيه.
باب في الاشتقاق الأكبر
هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أبا علي رحمه الله كان يستعين به ويخلد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر.
لكنه مع هذا لم يسمه وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويستروج إليه ويتعلل به.
وإنما هذا التلقيب لنا نحن.
وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن.
وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربين: كبير وصغير.
فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم كأن تأخذ أصلا من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه.
وذلك كتركيب " س ل م " فإنك تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه نحو سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى والسلامة والسليم: اللديغ أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة.
وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته وبقية الأصول غيره كتركيب " ض ر ب " و " ج ل س " و " ز ب ل " على ما في أيدي الناس من ذلك.
فهذا هو الاشبقاق الأصغر.
وقد قدم أبو بكر رحمه الله رسالته فيه بما أغنى عن إعادته لأن أبا بكر لم يأل فيه نصحا وإحكاما وصنعة وتأنيسا.
وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد.
وقد كنا قدمنا ذكر طرف من هذا الضرب من الاشتقاق في أول هذا الكتاب عند ذكرنا أصل الكلام والقول وما يجيء من تقليب تراكيبهما نحو " ك ل م " " ك م ل " " م ك ل " " م ل ك " " ل ك م " " ل م ك " وكذلك " ق و ل " " ق ل و " " و ق ل " " و ل ق " " ل ق و " " ل و ق " وهذا أعوص مذهباً وأحزن مضطربا.
وذلك أنا عقدنا تقاليب الكلام الستة على القوة والشدة وتقاليب القول الستة على الإسراع والخفة.
وقد مضى ذلك في صدر الكتاب.
لكن بقي علينا أن نحضر هنا مما يتصل به أحرفا تؤنس بالأول وتشجع منه المتأمل.
فمن ذلك تقليب " ج ب ر " فهي أين وقعت للقوة والشدة.
منها جبرت العظم والفقير إذا قويتهما وشددت منهما والجبر: الملك لقوته وتقويته لغيره.
ومنها رجل مجرب إذا جرسته الأمور ونجذته فقويت منته واشتدت شكيمته.
ومنه الجراب لأنه يحفظ ما فيه وإذا حفظ الشيء وروعى اشتد وقوى وإذا أغفل وأهمل تساقط ورذى.
ومنها الأبجر والبجرة وهو القوى السرة.
ومنه قول علي صلوات الله عليه: إلى الله أشكو عجري وبجري تأويله: همومي وأحزاني وطريقه أن العجرة كل عقدة في الجسد فإذا كانت في البطن والسرة فهي البجرة والبجرة تأويله أن السرة غلظت ونتأت فاشتد مسها وأمرها.
وفسر أيضاً قوله: عجرى وبجرى أي ما أبدى وأخفى من أحوالي.
ومنه البرج لقوته في نفسه وقوة ما يليه به وكذلك البرج لنقاء بياض العين وصفاء سوادها هو قوة أمرها وأنه ليس بلون مستضعف ومنها رجبت الرجل إذا عظمته وقويت أمره.
ومنه رجب لتعظيمهم إياه عن القتال فيه وإذا كرمت النخلة على أهلها فمالت دعموها بالرجبة وهو شيء تسند إليه لتقوى به.
والراجبة: أحد فصوص الأصابع وهي مقوية لها.
ومنها الرباجي وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله قال: وتلقاه رباجيا فخورا تأويله أنه يعظم نفسه ويقوي أمره.
ومن ذلك تراكيب " ق س و " " ق و س " " و ق س " " و س ق " " س و ق " وأهمل " س ق و " وجميع ذلك إلى القوة والاجتماع.
منها القسوة وهي شدة القلب واجتماعه ألا ترى إلى قوله: يا ليت شعري والمنى لا تنفع هل أغدون يوما وأمري مجمع أي قوى مجتمع ومنها القوس لشدتها واجتماع طرفيها.
ومنها الوقس لابتداء الجرب وذلك لأنه يجمع الجلد ويقحله ومنها الوسق للحمل وذلك لاجتماعه وشدته ومنه استوسق الأمر أي اجتمع " والليل وما وسق " أي جمع ومنها السوق وذلك لأنه استحثاث وجمع للمسوق بعضه مستوسقات لو يجدن سائقا فهذا كقولك: مجتمعات لو يجدن جامعا فإن شد شيء من شعب هذه الأصول عن عقده ظاهرا رد بالتأويل إليه وعطف بالملاطفة عليه.
بل إذا كان هذا قد يعرض في الأصل الواحد حتى يحتاج فيه إلى ما قلناه كان فيما انتشرت أصوله بالتقديم والتأخير أولى باحتمال وأجدر بالتأول له.
ومن ذلك تقليب " س م ل " " س ل م " " م س ل " " م ل س " " ل م س " " ل س م " والمعنى الجامع لها المشتمل عليها الإصحاب والملاينة.
ومنها الثوب السمل وهو الخلق.
وذلك لأنه ليس عليه من الوبر الزئبر ما على الجديد.
فاليد إذا مرت عليه للمس لم يستوقفها عنه جدة المنسج ولا خشنة الملمس.
والسمل: الماء القليل كأنه شيء قد أخلق وضعف عن قوة المضطرب وجمة المرتكض ولذلك قال: حوضا كأن ماءه إذا عسل من آخر الليل رو يزى سمل وقال آخر: وراد أسمال المياه السدم في أخريات الغبش المغم ومنها السلامة.
وذلك أن السليم ليس فيه عيب تقف النفس عليه ولا يعترض عليها به.
ومنها المسل والمسل والمسيل كله واحد وذلك أن الماء لا يجري إلا في مذهب له وإمام منقاد به ولو صادف حاجزا لاعتاقه فلم يجد متسرباً معه.
ومنها الأملس والملساء.
وذلك أنه لا اعتراض على الناظر فيه والمتصفح له.
ومنها اللمس.
وذلك أنه إن عارض اليد شيء حائل بينها وبين الملموس لم يصح هناك لمس فإنما هو إهواء باليد نحوه ووصول منها إليه لا حاجز ولا مانع ولا بد مع اللمس من إمرار اليد وتحريكها على الملموس ولو كان هناك حائل لاستوقفت به عنه.
ومنه الملامسة أو لامستم النساء أي جامعتم وذلك أنه لا بد هناك من حركات واعتمال وهذا واضح.
فأما " ل س م " فمهمل.
وعلى أنهم قد قالوا: نسمت الريح إذا مرت مراً سهلا ضعيفا والنون أخت اللام وسترى نحو ذلك.
ومر بنا أيضاً ألسمت الرجل حجته إذا لقنته وألزمته إياها.
قال: لا تلسمن أبا عمران حجته ولا تكونن له عونا على عمرا فهذا من ذلك أي سهلتها وأوضحتها.
واعلم أنا لا ندعى أن هذا مستمر في جميع اللغة كما لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة.
بل إذا كان ذلك الذي هو في القسمة سدس هذا أو خمسه متعذرا صعبا كان تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهبا وأعز ملتمسا.
بل لو صح من هذا النحو وهذه الصنعة المادة الواحدة تتقلب على ضروب التقلب كان غريباً معجباً.
فكيف به وهو يكاد يساوق الاشتقاق الأصغر ويجاريه إلى المدى الأبعد.
وقد رسمت لك منه رسماً فاحتذه وتقيله تحظ به وتكثر إعظام هذه اللغة الكريمة من أجله.
نعم وتسترفده في بعض الحاجة إليه فيعينك ويأخذ بيديك ألا ترى أن أبا علي رحمه الله كان يقوى كون لام أثفية فيمن جعلها أفعولة واواً بقولهم: جاء يثفه ويقول: هذا من الواو لا محالة كيعده.
فيرجح بذلك الواو على الياء التي ساوقتها في يثفوه ويثفيه.
أفلا تراه كيف استعان على لام ثفا بفاء وثف.
وإنما ذلك لأنها مادة واحدة شكلت على صور مختلفة فكأنها لفظة واحدة.
وقلت مرة للمتنبئ: أراك تستعمل في شعرك ذا وتا وذي كثيراً ففكر شيئاً ثم قال: إن هذا الشعر لم يعمل كله في وقت واحد.
فقلت له: أجل لكن المادة واحدة.
فأمسك البتة.
والشيء يذكر لنظيره فإن المعاني وإن اختلفت معنياتها آوية إلى مضجع غير مقض وآخذ بعضها برقاب بعض.
باب في الإدغام الأصغر
قد ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو تقريب صوت من صوت.
وهو في الكلام على ضربين: أحدهما أن يلتقى المثلان على الأحكام التي يكون عنها الإدغام فيدغم الأول في الآخر.
والأول من الحرفين في ذلك على ضربين: ساكن ومتحرك فالمدغم الساكن الأصل كطاء قطع وكاف سكر الأوليين والمتحرك نحو دال شد ولام معتل.
والآخر أن يلتقى المتقاربان على الأحكام التي يسوغ معها الإدغام فتقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدغمه فيه.
وذلك مثل ود في اللغة التميمية وأمحى وأماز واصبر واثاقل عنه.
والمعنى الجامع لهذا كله تقريب الصوت من الصوت ألا ترى أنك في قطع ونحوه قد أخفيت الساكن الأول في الثاني حتى نبا اللسان عنهما نبوة واحدة وزالت الوقفة التي كانت تكون في الأول لو لم تدغمه في الآخر ألا ترى أنك لو تكلفت ترك إدغام الطاء الأولى لتجشمت لها وقفة عليها تمتاز من شدة ممازجتها للثانية بها كقولك قططع وسككر وهذا إنما تحكمه المشافهة بله.
فإن أنت أزلت تلك الوقيفة والفترة على الأول خلطته بالثاني فكان قربه منه وإدغامه فيه أشد لجذبه إليه وإلحاقه بحكمه.
فإن كان الأول من المثلين متحركا ثم أشكنته وأدغمته في الثاني فهو أظهر أمراً وأوضح حكماً ألا ترى أنك إنما أسكنته لتخلطه بالثاني وتجذبه إلى مضامته ومماسة لفظه بلفظه بزوال الحركة التي كانت حاجزة بينه وبينه.
وأما إن كانا مختلفين ثم قلبت أدغمت فلا إشكال في إيثار تقريب أحدهما من صاحبه وأما إن كانا مختلفين ثم قلبت أدغمت فلا إشكال في إيثار تقريب أحدهما من صاحبه لأن قلب المتقارب أوكد من تسكين النظير.
فهذا حديث الإدغام الأكبر وأما الإدغام الأصغر فهو تقريب الحرف من الحرف وأدناؤه منه من غير إدغام يكون هناك.
وهو ضروب.
فمن ذلك الإمالة وإنما وقعت في الكلام لتقريب الصوت من الصوت.
وذلك نحو عالم وكتاب وسعَى وقَضى واسقضى ألا تراك قربت فتحة العين من عالِم إلى كسرة اللام منه بأن نحوت بالفتحة نحو الكسرة فأملت الألف نحو الياء.
وكذلك سعى وقضى: نحوت بالألف نحو الياء التي انقلبت عنها.
وعليه بقية الباب.
ومن ذلك أن تقع فاء افتعل صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء فتقلب لها تاؤه طاء.
وذلك نحو اصطبر واضطبر واضطرب واطرد واظطلم.
فهذا تقريب من غير إدغام فأما اطرد فمن ذا الباب أيضاً ولكن إدغامه وردههنا التقاطا لا قصداً.
وذلك أن فاءه طاء فلما أبدلت تاؤه طاء صادفت الفاء طاء فوجب الإدغام لما اتفق حينئذ ولو لم يكن هناك طاء لم يكن إدغام ألا ترى أن اصطبر واضطرب واظطلم لما كان الأول منه غير طاء لم يقع إدغام قال: ويظلم أحياناً فيظطلم وأما فيظلم وفيطلم بالظاء والطاء جميعاً فإدغام عن قصد لا عن توارد.
فقد عرفت بذلك فرق ما بين اطرد وبين اصبر واظلم واطلم.
ومن ذلك أن تقع فاء افتعل زايا أو دالاً أو ذالا فتقلب تاؤه لها دالاً كقولهم: ازدان وادعى وادكر واذدكر فيما حكاه أبو عمرو.
فأما ادعى فحديثه حديث اطرد لا غير في أنه لم تقلب قصداً للإدغام لكن قلبت تاء ادعى دالاً كقلبها في ازدان ثم وافقت فاؤه الدال المبدلة من التاء فلم يكن من الإدغام بد.
وأما اذدكر فمنزلة بين ازدان وادعى.
وذلك أنه لما قلب التاء دالاً لوقوع الذال قبلها صار إلى اذدكر فقد كان هذا وجهاً يقال مثله مع أن أبا عمرو قد أثبته وذكره غير أنه أجريت الذال لقربها من الدال بالجهر مجرى الدال فأوثر الإدغام لتضام الحرفين في الجهر فأدغم.
فهذه منزلة بين منزلتي ازدان وادعى.
وأما اذكر فاسمع واصبر.
ومن ذلك أن تقع السين قبل الحرف المستعلى فتقرب منه بقلبها صاداً على ما هو مبين في موضعه من باب الإدغام.
وذلك كقولهم في سُقْت: صُقْت وفي السوق: الصوق وفي سبقت: صبقت وفي سملق وسوق: صملق وصويق وفي سالغ وساخط: صالخ وصاخط وفي سقر: صقر وفي مساليخ: مصاليخ.
ومن ذلك قولهم ست أصلها سدس فقربوا السين من الدال بأن قلبوها تاء فصارت سدت فهذا تقريب لغير إدغام ثم إنهم فيما بعد أبدلوا الدال تقاء لقربها منها إرادة للإدغام الآن فقالوا ست.
فالتغيير الأول للتقريب من غير إدغام والتغيير الثاني مقصود به الإدغام.
ومن ذلك تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق نحو شعيرٍ وبعيرٍ ورغيفٍ.
وسمعت الشجري غير مرة يقول: زئير الأسد يريد الزئير.
وحكى أبو زيد عنهم: الجنة لمن خاف وعيد الله.
فأما مغيرة فليس إتباعه لأجل حرف الحلق إنما هو من باب منتن ومن قولهم أنا أجوءك وأنبوك.
والقرفصاء والسلطان وهو منحدر من الجبل وحكة سيبويه أيضاً منتن ففيه إذاً ثلاث لغات: مُنْتِن وهو الأصل ثم يليه مِنْتِن وأقلها مُنْتُن.
فأما قول من قال: إن مُنْتِن من قولهم أنتن ومِنْتِن من قولهم نَتُن الشيء فإن ذلك لكنة منه.
ومن ذلك أيضاً قولهم فَعَل يَفْعَل مما عينه أو لامه حرف حلقي نحو سَأَل يسأل وقَرَأ يَقَرَأ وسَعَر يَسعر وقرع يقرع وسَحَل يسحل وسَبَح يَسْبَح.
وذلك أنهم ضارعوا بفتحة العين في المضارع جنس حرف الحلق لما كان موضعاً منه مخرج الألف التي منها الفتحة.
ومن التقريب قولهم: الحمدُ لُلَّه والحمدِ لِله.
ومنه تقريب الحرف من الحرف نحو قولهم في نحو مَصْدر: مَزْدر وفي التصدير: التزدير.
وعليه قول العرب في المثل " لم يُحْرَمْ منْ فُزْد لَهُ " أصله فصد له ثم أسكنت العين على قولهم في ضُرِب: ضُرْبَ وقوله: ونفخوا في مدائنهم فطاروا فصار تقديره: فُصْدله فما سكنت الصاد فضعفت به وجاورت الصاد وهو مهموسة الدال وهي مجهورة قربت منها بأن أشمت شيئاً من لفظ الزاي المقاربة للدال بالجهر.
ونحو من ذلك قولهم: مررت بمذعور وابن بور: فهذا نحو من قيل وغيض لفاظاً وإن اختلفا طريقاً.
ومن ذلك إضعاف الحركة لتقرب بذلك من السكون نحو حيِى وأُحْيِى وأُعيىَ فهو وإن كان مخفى بوزنه محركا وشاهد ذاك قبول وزن الشعر له قبوله للمتحرك البتة.
وذلك قوله: أ أن زم أجمال وفارق جيرة فهذا بزنته محققاً في قولك: أأن زم أجمال.
فأما روم الحركة فهي وإن كانت من هذا فإنما هي كالإهابة بالساكن نحو الحركة وهو لذلك ضرب من المضارعة.
وأخفى منها الإشمام لأنه للعين لا للأذن.
وقد دعاهم إيثار قرب الصوت إلى أن أخلوا بالإعراب فقال بعضهم: وقال اضرب الساقين إمكَ هابِل وهذا نحو من الحمدُ لُلَّه والحمدِ لِله.
وجميع ما هذه حاله مما قرب فيه الصوت من الصوت جار مجرى الإدغام بما ذكرناه من التقريب.
وإنما احتطنا له بهذه السمة التي هي الإدغام الصغير لأن في هذا إيذانا بأن التقريب شامل للموضعين وأنه هو المراد المبغى في كلتا الجهتين فاعرف ذلك.
باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني
هذا غور من العربية لا ينتصف منه ولا يكاد يحاط به.
وأكثر كلام العرب عليه وإن كان غفلا مسهواً عنه.
وهو على أضرب: منها اقتراب الأصلين الثلاثيين كضياط وضَيْطار ولُوقةٍ وأَلوقةٍ ورخْو ورِخْوَدٍّ ويَنْجُوج وأَلَنْجُوج.
وقد مضى ذكر ذلك.
ومنها اقتراب الأصلين ثلاثياً أحدهما ورباعياً صاحبه أو رباعيا أحدهما وخماسياً صاحبه كدمث ودمثر و سبط وسبطر ولؤلؤ ولآل والضبغطى والضبغطرى.
ومنه قوله: قد دَرْدَبَتْ والشيخ دَرْدَبِيس وقد مضى هذا أيضاً.
ومنها التقديم والتأخير على ما قلنا في الباب الذي قبل هذا في تقليب الأصول نحو " ك ل م " و " ك م ل " و " م ك ل " ونحو ذلك.
وهذا كله والحروف واحدة غير متجاورة.
لكن من وراء هذا ضرب غيره وهو أن تتقارب الحروف لتقارب المعاني.
وهذا باب واسع.
من ذلك قول الله سبحانه: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} أي تزعجهم وتقلقهم.
فهذا في معنى تهزهم هزا والهمزة أخت الهاء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين.
وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاء وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز لأنك قد تهز ما لا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك.
ومنه العسف والأسف والعين أخت الهمزة كما أن الأسف يعسف النفس وينال منها والهمزة أقوى من العين كما أن أسف النفس أغلظ من التردد بالعسف.
فقد ترى تصاقب اللفظين لتصاقب المعنيين.
ومنه القرمة وهي الفقرة تحز على أنف البعير.
وقريب منه قلمت أظفاري لأن هذا انتقاص للظفر وذلك انتقاص للجلد.
فالراء أخت اللام والعملان متقاربان.
وعليه قالوا فيها: الجرفة وهي من " ج ر ف " وهي أخت جلفت لقلم إذا أخذت جُلْفته وهذا من " ج ل ف " وقريب منه الجنف وهو الميل وإذا جَلَفت الشيء أو جرفته فقد أملته عما كان عليه وهذا من " ج ن ف ".
ومثله تركيب " ع ل م " في العلامة والعلم.
وقالوا مع ذلك: بيضة عرماء وقطيع أعرم إذا كان فيهما سواد وبياض وإذا وقع ذلك بأن أحد اللونين من صاحبه فكان كل واحد منهما علما ما زلن ينسبن وهنا كل صادقةٍ باتت تباشر عراما غير أزواجِ حتى سَلَكن الشوى منهن في مسكٍ من نسل جوابة الآفاقِ مهداج ومن ذلك تركيب " ح م س " و " ح ب س " قالوا: حبست الشيء وحمس الشر إذا اشتد.
والتقاؤهما أن الشيئين إذا حبس أحدهما صاحبه تمانعا وتعازا فكان ذلك كالشر يقع بينهما.
ومنه العَلْب: الأثر والعَلْم: الشقّ في الشفة العليا.
فذاك من " ع ل ب " وهذا من " ع ل م " والباء أخت الميم قال طرفة: كأن عُلوب النسع في دأياتها موارد من خلقاء في ظهرٍ قردد ومنه تركيب " ق ر د " و " ق ر ت " قالوا للأرض: قَرْدَد وتلك نباك تكون في الأرض فهو من قرد الشيء وتقرد إذا تجمع أنشدنا أبو علي: أهوى لها مشقصٌ حشر فشبرقها وكنتُ أدعو قذاها الإثمد القردا أي أسمي الإثمد القرد أذى لها.
يعنى عينه وقالوا: قرت الدم عليه أي جمد والتاء أخت الدال كما ترى.
فأما لم خص هذا المعنى بذا الحرف فسنذكره في باب يلي هذا بعون الله تعالى.
ومن ذلك العلز: خفة وطيش وقلق يعرض للإنسان وقالوا العلوص لوجع في الجوف يلتوي له ومنه الغَرب: الدلو العظيمة وذلك لأنها يغرف من الماء بها فذاك من " غ ر ب " وهذا من " غ ر ف " أنشد أبو زيد: كأن عيني وقد بانوني غربان في جدول منجنون واستعملوا تركيب " ج ب ل " و " ج ب ن " و " ج ب ر " لتقاربها في موضع واحد وهو الالتئام والتماسك.
منه الجبل لشدته وقوته وجبن إذا استمسك وتقف وتجمع ومنه جبرت العظم ونحوه أي قويته.
وقد تقع المضارعة في الأصل الواحد بالحرفين نحو قولهم: السحيل والصهيل قال: كان سحيله في كل فجر على أحساء يمؤود دعاء وذاك من " س ح ل " وهذا من " ص ه ل " والصاد أخت السين كما أن الهاء أخت الحاء.
ونحو منه قولهم سحل في الصوت وزحر والسين أخت الزاي كما أن اللام أخت الراء.
وقالوا جلف وجرم فهذا للقشر وهذا للقطع وهما متقاربان معنى متقاربان لفظاً لأن ذاك من " ج ل ف " وهذا من " ج ر م ".
وقالوا: صال يصول كما قالوا: سار يسور.
نعم وتجاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة: الفاء والعين واللام.
فقالوا: عصر الشيء وقالوا: أزله إذا حبسه والعصر ضرب من الحبس.
وذاك من " ع ص ر " وهذا من أزل والعين أخت الهمزة والصاد أخت الزاي والراء أخت اللام.
وقالوا: الأزم: المنع والعصب: الشد فالمعنيان متقاربان والهمزة أخت العين والزاي أخت الصاد والميم أخت الباء.
وذاك من أزم وهذا من " ع ص ب ".
وقالوا: السلب والصرف وإذا سلب الشيء فقد صرف عن وجهه.
فذاك من " س ل ب " وهذا من " ص ر ف " والسين أخت الصاد واللام أخت الراء والباء أخت الفاء.
وقالوا: الغدر كما قالوا الختل والمعنيان متقاربان واللفظان متراسلان فذاك من " غ د ر " وهذا من " خ ت ل " فالغين أخت الخاء والدال أخت التاء والراء أخت اللام.
وقالوا: زأر كما قالوا: سعل لتقارب اللفظ والمعنى.
وقالوا: عدن بالمكان كما قالوا: تأطر أي أقام وتلبث.
وقالوا: شرب كما قالوا: جلف لأن شارب الماء مفن له كالجلف للشيء.
وقالوا: ألته حقه كما قالوا: عانده.
وقالوا: الأرفة للحد بين الشيئين كما قالوا: علامة.
وقالوا: قفز كما قالوا: كبس وذلك أن القافز إذا استقر على الأرض كبسها.
وقالوا: صهل كما قالوا: صهل كما قالوا: زأر.
وقالوا: الهتر كما قالوا: الإدل وكلاهما العجب.
وقالوا: كلف به كما قالوا: تقرب منه وقالوا: تجعد كما قالوا: شحط وذلك أن الشيء إذا تجعد وتقبض عن غيره شحط وبعد عنه ومنه قول الأعشى: إذا نزل الحي حل الجحيش شقيا غويا مبينا غيورا وذاك من تركيب " ج ع د " وهذا من تركيب " ش ح ط " فالجيم أخت الشين والعين أخت الحاء والدال أخت الطاء.
وقالوا: السيف والصوب وذلك أن السيف يوصف بأنه يرسب في الضريبة لحدته ومضائه ولذلك قالوا: سيف رسوب وهذا هو معنى صاب يصوب إذا انحدر.
فذاك من " س ي ف " وهذا من " ص و ب " فالسين أخت الصاد والياء أخت الواو والفاء أخت الباء.
وقالوا: جاع يجوع وشاء يشاء والجائع مريد للطعام لا محالة ولهذا يقول المدعو إلى الطعام إذا لم يجب: لا أريد ولست أشتهي ونحو ذلك والإرادة هي المشيئة.
فذاك من " ج و ع " وهذا من " ش ي أ " والجيم أخت الشين والواو أخت الياء والعين أخت الهمزة.
وقالوا: فلان حلس بيته إذا لازمه.
وقالوا: أرز إلى الشيء إذا اجتمع نحوه وتقبض إليه ومنه إن الإسلام ليأرز إلى المدينة وقال: بآرزة الفقارة لم يخنها قطاف في الركاب ولا خلاء فذاك من " ح ل س " وهذا من " أ ر ز " فالحاء أخت الهمزة واللام أخت الراء والسين أخت الزاي.
وقالوا: أفل كما قالوا: غبر لأن أفل: غاب والغابر غائب أيضاً.
فذاك من " أ ف ل " وهذا من " غ ب ر " فالهمزة أخت الغين والفاء أخت الباء واللام أخت الراء.
وهذا النحو من الصنعة موجود في أكثر الكلام وفرش اللغة و إنما بقي من يثيره ويبحث عن مكنونه بل من إذا أوضح له وكشفت عنده حقيقته طاع طبعه لها فوعاها وتقبلها.
وهيهات ذلك مطلبا وعز فيهم مذهبا! وقد قال أبو بكر: من عرف ألف ومن جهل استوحش.
ونحن نتبع هذا الباب باباً أغرب منه وأدل على حكمة القديم سبحانه وتقدست أسماؤه فتأمله تحظ به بعون الله تعالى.
باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني
اعلم أن هذا موضع شريف لطيف. وقد نبه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته.
قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومداً فقالوا: صر وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا: صرصر.
وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة نحو النقزان والغلبان والغثيان.
فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال.
ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه ومنهاج ما مثلاه.
وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعقعة والصعصعة والجرجرة والقرقرة.
ووجدت أيضاً الفَعَلى في المصادر والصفات إنما تأتى للسرعة نحو البشكي والجمزي والولقي قال رؤبة: أو بشكى وخد الظليم النز كأني ورحلي إذا هجرت على جمزي جازئ بالرمال أو اصحم حام جراميزه حزابية حيدى بالدحال فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر أعني باب القلقلة والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها.
ومن ذلك وهو أصنع منه أنهم جعلوا استفعل في أكثر الأمر للطلب نحو استسقى واستطعم واستوهب واستمنح واستقدم عمرا واستصرخ جعفرا.
فرتبت في هذا الباب الحروف على ترتيب الأفعال.
وتفسير ذلك أن الأفعال المحدث عنها أنها وقعت عن غير طلب إنما تفجأ حروفها الأصول أو ما ضارع بالصنعة الأصول.
فالأصول نحو قولهم طعم ووهب ودخل وخرج وصعد ونزل.
فهذا إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت ولم يكن معها دلالة تدل على طلب لها ولا إعمال فيها.
وكذلك ما تقدمت الزيادة فيه على سمت الأصل نحو أحسن وأكرم وأعطى وأولى.
فهذا من طريق الصنعة بوزن الأصل في نحو دحرج وسرهف وقوقى وزوزى.
وذلك أنهم جعلوا هذا الكلام عبارات عن هذه المعاني فكلما ازدادت العبارة شبها بالمعنى كانت أدل عليه وأشهد بالغرض فيه.
فلما كانت إذا فأجأت الأفعال فاجأت أصول المثل الدالة عليها أو ما جرى مجرى أصولها نحو وهب ومنح وأكرم و أحسن كذلك إذا أخبرت بأنك سعيت فيها وتسببت لها وجب أن تقدم أمام حروفها الأصول في مثلها الدالة عليها أحرفاً زائدة على تلك الأصول تكون كالمقدمة لها والمؤدية إليها.
وذلك نحو استفعل فجاءت الهمزة والسين والتاء زوائد ثم وردت بعدها الأصول: الفاء والعين واللام.
فهذا من اللفظ وفق المعنى الموجود هناك.
وذلك أن الطلب للفعل والتماسه والسعي فيه والتأتي لوقوعه تقدمه ثم وقعت الإجابة إليه فتبع الفعل السؤال فيه والتسبب لوقوعه.
فكما تبعت أفعال الإجابة أفعال الطلب كذلك تبعت حروف الأصل الحروف الزائدة التي وضعت للالتماس والمسئلة.
وذلك نحو استخرج واستقدم واستوهب واستمنح واستعطى واستدنى.
فهذا على سمت الصنعة التي تقدمت في رأي الخليل وسيبويه إلا أن هذه أغمض من تلك.
غير أنها وإن كانت كذلك فإنها منقولة عنها ومعقودة عليها.
ومن وجد مقالاً قال به وإن لم يسبق إليه غيره.
فكيف به إذا تبع العلماء فيه وتلاهم على تمثيل معانيه.
ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على تكرير الفعل فقالوا: كسر وقطع وفتح وغلق.
وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل والعين أقوى من الفاء واللام وذلك لأنها واسطة لهما ومنكوفة بهما فصارا كأنهما سياج لها ومبذولان للعوارض دونها.
ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها.
فأما حذف الفاء ففي المصادر من باب وعد نحو العدة والزنة والطدة والتدة والهبة والإبة.
وأما اللام فنحو اليد والدم والفم والأب والأخ والسنة والمائة والفئة.
وقلما تجد الحذف في العين.
فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواها وجعلوه دليلاً على قوة المعنى المحدث به وهو تكرير الفعل كما جعلوا تقطيعه في نحو صرصر وحقحق دليلاً على تقطيعه.
ولم يكونوا ليضعفوا الفاء ولا اللام لكراهية التضعيف في أول الكلمة والإشفاق على الحرف المضعف أن يجيء في آخرها وهو مكان الحذف وموضع الإعلال وهم قد أرادوا تحصين الحرف الدال على قوة الفعل.
فهذا أيضاً من مساوقة الصيغة للمعاني.
وقد أتبعوا اللام في باب المبالغة العين وذلك إذا كررت العين معها في نحو دمكمك وصمحمح وعركرك وعصبصب وغشمشم والموضع في ذلك للعين وإنما ضامتها اللام هنا تبعاً لها ولاحقة بها ألا ترى إلى ما جاء عنهم للمبالغة من نحو اخلولق واعشوشب واغدودن واحمومى واذلولى واقطوطى وكذلك في الاسم نحو عثوثل وغدودن وخفيدد وعقنقل وعبنبل وهجنجل قال: ظلت ظل يومها حوب حل وظل يوم لأبي الهجنجل فدخول لام التعريف فيه مع العلمية يدل على أنه في الأصل صفة كالحرث والعباس وكل واجد من هذه المثل قد فصل بين عينيه بالزائد لا باللام.
فعلمت أن تكرير المعنى في تباب صمحمح إنما هو للعين وإن كانت اللام فيه أقوى من الزائد في باب افعوعل وفعوعل وفعيعل وفعنعل لأن اللام بالعين أشبه من الزائد بها.
ولهذا أيضاً ضاعفوها كما ضاعفوا العين للمبالغة نحو عتل وصمل وقمد وحزق إلا أن العين أقعد في ذلك من اللام ألا ترى إن الفعل الذي هو موضع للمعاني لا يضعف ولا يؤكد تكريره إلا بالعين.
هذا هو الباب.
فأما اقعنسس واسحنكك فليس الغرض فيه التوكيد والتكرير لأن ذا إنما ضعف للإلحاق فهذه طريق صناعية وباب تكرير العين هو طريق معنوية ألا ترى أنهم لما اعتزموا إفادة المعنى توفروا عليه وتحاموا طريق الصنعة والإلحاق فيه فقالوا: قطع وكسر تقطيعاً وتكسيراً ولم يجيئوا بمصدره على مثال فعللة فيقولوا: قطعةً وكسرة كما قالوا في الملحق: بيطر بيطرة وحوقل حوقلة وجهور جهورة.
ويدلك على أن افعوعل لما ضعفت عينه للمعنى انصرف به عن طريق الإلحاق تغليباً للمعنى على اللفظ وإعلاماً أن قدر المعنى عندهم أعلى وأشرف من قدر اللفظ أنهم قالوا في افعوعل من رددت: اردود ولم يقولوا: اردودد فيظهروا التضعيف للإلحاق كما أظهروه في بياب اسحنكك واكلندد لما كان للإلحاق بالحرنجم واخرنطم ولا تجد في بنات الأربعة نحو احروجم فيظهروا افعوعل من رددت فيقال اردودد لأنه لا مثال له رباعياً فيلحق هذا به.
فهذا طريق المثل واحتياطاتهم فيها بالصنعة ودلالاتهم منها على الإرادة والبغية.
فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع ونهج متلئب عند عارفيه مأموم.
وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها فيعدلونها بها ويحتذونها عليها.
وذلك أكثر مما تقدره وأضعاف ما نستشعره.
من ذلك قولهم: خضم وقضم.
فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب.
والقضم للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك.
وفي الخبر قد يدرك الخضم بالقضم أي قد يدرك الرخاء بالشدة واللين بالشظف.
وعليه قول أبي الدرداء: يخضمون ونقضم والموعد الله فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس حذواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث.
ومن ذلك قولهم: التضح للماء نحوه والنضح أقوى من النضح قال الله سبحانه: {فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقوى منه.
ومن ذلك القد طولا والقط عرضاً.
وذلك أن الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعاً له من الدال.
فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض لقربه وسرعته والدال المماطلة لما طال من الأثر وهو قطعه طولا.
ومن ذلك قولهم: قرت الدم وقرد الشيء وتقرد وقرط يقرط.
فالتاء أخفت الثلاثة فاستعملوها في الدم إذا جف لأنه قصد ومستخف في الحس عن القردد الذي هو النباك في الأرض ونحوها.
وجعلوا الطاء وهي أعلى الثلاثة صوتاً للقرط الذي يسمع.
وقرد من القرد وذلك لأنه موصوف بالقلة والذلة قال الله تعالى: {فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ}.
ينبغي أن يكون خاسئين خبراً آخر لكونوا والأول قردة فهو كقولك: هذا حلو حامض وإن جعلته وصفا لقردة صغر معناه ألا ترى أن القرد لذله وصغاره خاسئ أبداً فيكون إذا ً صفة غير مفيدة.
وإذا جعلت خاسئين خبراً ثانياً حسن وأفاد حتى كأنه قال: كونوا قردة وكونوا خاسئين ألا ترى أن ليس لأحد الاسمين من الاختصاص بالخبرية إلا ما لصاحبه وليس كذلك الصفة بعد الموصوف إنما اختصاص العامل بالموصوف ثم الصفة من بعد تابعة له.
ولست أعني بقولي: إنه كأنه قال تعالى: كونوا قردة كونوا خاسئين أن العامل في خاسئين عامل ثان غير الأول معاذ الله أن أريد ذلك إنما هذا شيء يقدر مع البدل.
فأما في الخبرين فإن العامل فيهما جميعاً واحد ولو كان هناك عامل آخر لما كانا خبرين لمخبر عنه واحد وإنما مفاد الخبر من مجموعهما.
ولهذا كان عند أبي علي أن العائد على المبتدأ من مجموعهما لا من أحدهما لأنه ليس الخبر بأحدهما بل بمجموعهما.
وإنما أريد أنك متى شئت باشرت بكونوا أي الاسمين آثرت ولست كذلك الصفة.
ويؤنس بذلك أنه لو كانت خاسئين صفة لقردة لكان الأخلق أن يكون قردة خاسئة وفي أن لم يقرأ بذلك البتة دلالة على أنه ليس بوصف.
وإن كان قد يجوز أن يكون خاسئين صفة لقردة على المعنى إذ كان المعنى أنها هي هم في المعنى إلا أن هذا إنما هو جائز وليس بالوجه بل الوجه أن يكون وصفاً لو كان على اللفظ.
فكيف وقد سبق ضعف الصفة ههنا.
فهذا شيء عرض قلنا فيه ثم لنعد.
أفلا ترى إلى تشبيههم الحروف بالأفعال وتنزيلهم إياها على احتذائها.
ومن ذلك قولهم: الوسيلة والوصيلة والصاد كما ترى أقوى صوتاً من السين لما فيها من الاستعلاء والوصيلة أقوى معنى من الوسيلة.
وذلك أن التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة بل الصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء ومماسته له وكونه في أكثر الأحوال بعضا له كاتصال الأعضاء بالإنسان وهي أبعاضه ونحو ذلك والتوسل معنى يضعف ويصغر أن يكون المتوسل جزءا أو كالجزء من المتوسل إليه.
وهذا واضح.
فجعلوا الصاد لقوتها للمعنى ومن ذلك قولهم: الخذا في الأذن والخذأ: الاستخذاء فجعلوا الواو في خذواء لأنها دون الهمزة صوتاً للمعنى الأضعف.
وذلك لأن استرخاء الأذن ليس من العيوب التي يسب بها ولا يتناهى في استقباحها.
وأما الذل فهو من أقبح العيوب وأذهبها في المزراة والسب فعبروا عنه بالهمزة لقوتها وعن عيب الأذن المحتمل بالواو لضعفها.
فجعلوا أقوى الحرفين لأقوى العيبين وأضعفهما لأضعفهما.
ومن ذلك قولهم: قد جفا الشيء يجفو وقالوا: جفأ الوادي بغثائه ففيهما كليهما معنى الجفاء لارتفاعهما إلا أنهم استعملوا الهمزة في الوادي لما هناك من حفزه وقوة دفعه.
ومن ذلك قولهم: صعد وسعد.
فجعلوا الصاد لأنها أقوى لما فيه أثر مشاهد يرى وهو الصعود في الجبل والحائط ونحو ذلك.
وجعلوا السين لضعفها لما لا يظهر ولا يشاهد حساً إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجد لا صعود الجسم ألا تراهم يقولون: هو سعيد الجد وهو عالي الجد وقد ارتفع أمره وعلا قدره.
فجعلوا الصاد لقوتها مع ما يشاهد من الأفعال المعالجة المتجشمة وجعلوا السين لضعفها فيما تعرفه النفس وإن لم تره العين والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية.
فإن قلت: فكان يجب على هذا أن يكون الخذا في الأذن مهموزاً وفي الذل غير مهموز لأن عيب الأذن مشاهد وعيب النفس غير مشاهد قيل: عيب الأذن وإن كان مشاهدا فإنه لا علاج فيه على الأذن وإنما هو خمول وذبول ومشقة الصاعد ظاهرة مباشرة معتدة متجشمة فالأثر فيها أقوى فكانت بالحرف الأقوى وهو الصاد أحرى.
ومن ذلك أيضاً سد وصد.
فالسد دون الصد لأن السد للباب يسد والمنظرة ونحوها والصد جانب الجبل والوادي والشعب وهذا أقوى من السد الذي قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك فجعلوا الصاد لقوتها للأقوى والسين لضعفها للأضعف.
ومن ذلك القسم والقصم.
فالقصم أقوى فعلاً من القسم لأن القصم يكون معه الدق وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهما فلذلك خصت بالأقوى الصاد وبالأضعف السين.
ومن ذلك تركيب " ق ط ر " و " ق د ر " و " ق ت ر " فالتاء خافية متسفلة والطاء سامية متصعدة فاستعملنا لتعاديهما في الطرفين كقولهم: فتر الشيء وقطره.
والدال بينهما ليس لها صعود الطاء ولا نزول التاء فكانت لذلك واسطة بينهما فعبر بها عن معظم الأمر ومقابلته فقيل قدر الشيء لجماعة ومحرنجمه.
وينبغي أن يكون قولهم: قطر الإناء الماء ونحوه إنما هو فعل من لفظ القطر ومعناه.
وذلك أنه إنما ينقط الماء عن صفحته الخارجة وهي قطره.
فاعرف ذلك.
فهذا ونحوه أمر إذا أنت أتيته من بابه وأصلحت فكرك لتناوله وتأمله أعطاك مقادته وأركبك ذروته وجلا عليك بهجاته ومحاسنه.
وإن أنت تناكرته وقلت: هذا أمر منتشر ومذهب صعب موعر حرمت نفسك لذته وسددت عليها باب الحظوة به.
نعم ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر والحكمة أعلى وأصنع.
وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبها وتقديم ما يضاهي أول الحدث وتأخير ما يضاهي آخره وتوسيط ما يضاهي أوسطه سوقاً للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب.
وذلك قولهم: بحث.
فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض والحاء لصحلها تشبه مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرض والثاء للنفث والبث للتراب.
وهذا أمر تراه محسوساً محصلاً فأي شبهة تبقى بعده أم أي شك يعرض على مثله.
وقد ذكرت هذا في موضع آخر من كتبي لأمر دعا إليه هناك.
فأما هذا الموضع فإنه أهله وحقيق به لأنه موضوع له ولأمثاله.
ومن ذلك قولهم: شد الحبل ونحوه.
فالشين بما فيها من التفشي تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد ثم يليه إحكام الشد والجذب وتأريب العقد فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى من الشين ولاسيما وهي مدغمة فهو أقوى لصنعتها وأدل على المعنى الذي أريد بها.
ويقال شد وهو يشد.
فأما الشدة في الأمر فإنها مستعارة من شد الحبل ونحوه لضرب من الاتساع والمبالغة على حد ما نقول فيما يشبه بغيره لتقوية أمره المراد به.
ومن ذلك أيضاً جر الشيء يجره قدموا الجيم لأنها حرف شديد وأول الجر بمشقة على الجار والمجرور جميعاً ثم عقبوا ذلك بالراء وهو حرف مكرر وكررها مع ذلك في نفسها.
وذلك لأن الشيء إذا جر على الأرض في غالب الأمر اهتز عليها و اضطرب صاعداً عنها ونازلاً إليها وتكرر ذلك منه على ما فيه من العتعة والقلق.
فكانت الراء لما فيها من التكرير ولأنها أيضاً قد كررت في نفسها في جر وجررت أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها.
هذا هو محجة هذا ومذهبه.
فإن أنت رأيت شيئاً من هذا النحو لا ينقاد لك فيما رسمناه ولا يتابعك على ما أوردناه فأحد أمرين: إما أن تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك عنه أو لأن لهذه اللغة أصولاً وأوائل قد تخفى عنا وتقصر أسبابها دوننا كما قال سيبويه: أو لأن الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر.
فإن قلت: فهلا أجزت أيضاً أن يكون ما أوردته في هذا الموضع شيئاً اتفق وأمراً وقع في قيل: في هذا حكم بإبطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب التي تشهد بها العقول وتتناصر إليها أغراض ذوي التحصيل.
فما ورد على وجه يقبله القياس وتقتاد إليه دواعي النظر والإنصاف حمل عليها ونسبت الصنعة فيه إليها.
وما تجاوز ذلك فخفى لم توءس النفس منه ووكل إلى مصادقة النظر فيه وكان الأحرى به أن يتهم الإنسان نظره ولا يخف إلى ادعاء النقض فيما قد ثبت الله أطنابه وأحصف بالحكمة أسبابه.
ولو لم يتنبه على ذلك إلا بما جاء نهم من تسميتهم الأشياء بأصواتها كالخازباز لصوته والبط لصوته والخاقباق لصوت الفرج عند الجماع.
والواق للصرد لصوته وغاق للغراب لصوته وقوله تداعين باسم الشيب لصوت مشافرها وقوله: بينما نحن مرتعون بفلج قالت الدلح الرواء إنيه فهذا حكاية لرزمة السحاب وحنين الرعد وقوله: كالبحر يدعو هيقما وهيقما وذلك لصوته.
ونحو منه قولهم: حاحيت وعاعيت وهاهيت إذا قلت: حاء وعاء وهاء.
وقولهم: بسملت وهيللت وحولقت كل ذلك وأشباهه إنما يرجع في اشتقاقه إلى الأصوات.
والأمر أوسع.
ومن طريف ما مر بي في هذه اللغة التي لا يكاد يعلم بعدها ولا يحاط بقاصيها ازدحام الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون إذا مازجتهن الفاء على التقديم والتأخير فأكثر أحوالها ومجموع معانيها أنها للوهن والضعف ونحوهما.
من ذلك الدالف للشيخ الضعيف والشيء التالف والطليف والظليف المجان وليست له عصمة الثمين والطنف لما أشرف خارجا عن البناء وهو إلى الضعف لأنه ليست له قوة الراكب الأساس والأصل والنطف: العيب وهو إلى الضعف والدنف: المريض.
ومنه التنوفة وذلك لأن الفلاة إلى الهلاك ألا تراهم يقولون لها: مهلكة وكذلك قالوا لها: بيداء فهي فعلاء من باد يبيد.
ومنه الترفة لأنها إلى اللين والضعف وعليه قالوا: الطرف لأن طرف الشيء أضعف من قبله وأوسطه قال الله سبحانه {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا}.
وقال الطائي الكبير: كانت هي الوسط الممنوع فاستلبت ما حولها الخيل حتى أصبحت طرفا ومنه الفرد لأن المنفرد إلى الضعف والهلاك ما هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المرء كثير بأخيه ).
والفارط المتقدم وإذا تقدم انفرد وإذا انفرد أعرض للهلاك ولذلك ما يوصف بالتقدم ويمدح به لهول مقامه وتعرض راكبه.
وقال محمد بن حبيب في الفرتنى الفاجرة: إنها من السالك الثغرة اليقظان كالئها مشى الهلوك عليها الخيعل الفضل وقياس مذهب سيبويه أن تكون فرتنى فعللى رباعية كجحجبى.
ومنه الفرات لأنه الماء العذب وإذا عذب الشيء ميل عليه ونيل منه ألا ترى إلى قوله: ممقر مر على أعدائه وعلى الأدنين حلو كالعسل وقال الآخر: تراهم يغمزون من استركوا يوجتنبون من صدق المصاعا ومنه الفتور للضعف والرفت للكسر والرديف لأنه ليس له تمكن الأول.
ومنه الطفل للصبي لضعفه والطفل للرخص وهو ضد الشثن والتفل للريح المكوهة فهي منبوذة مطروحة.
وينبغي أن تكون الدفلى من ذلك لضعفه عن صلابة النبع والسراء والتنضب والشوحط.
وقالوا: الدفر للنتن وقالوا للدنيا أم دفر سب لها وتوضيع منها.
ومنه الفلتة لضعفة الرأي وفتل المغزل لإنه تثن واستدارة وذاك إلى وهي وضعفة والفطر: الشق وهو إلى الوهن.
الآن قد أنستك بمذهب القوم فقيما هذه حاله ووقفتك على طريقه وأبديت لك عن مكنونه وبقي عليك أنت التنبه لأمثاله وإنعام الفحص عما هذه حاله فإنني إن زدت على هذا مللت وأمللت.
ولو شئت لكتبت من مثله أوراقا مئين فأبه له ولاطفه ولا تجف عليه فيعرض عنك مشابهة
باب في مشابهة معاني الإعراب معاني الشعر
نبهنا أبو علي رحمه الله من هذا الموضع على أغراض حسنة.
من ذلك قولهم في لا النافية للنكرة: إنها تبنى معها فتصير كجزء من الاسم نحو لا رجل في الدار ولا بأس عليك وأنشدنا في هذا المعنى قوله: خيط على زفرة فتم ولم يرجع إلى دقة ولا هضم وتأويل ذلك أن هذا الفرس لسعة جوفه وإجفار محزمه كأنه زفر فلما اغترق نفسه بنى على ذلك فلزمته تلك الزفرة فصيغ عليها لا يفارقها كما أن الاسم بني مع لا حتى خلط بها لا تفارقه ولا يفارقها وهذا موضع متناه في حسنه آخذ بغاية الصنعة من مستخرجه.
ومثله أيضاً من وصف الفرس: بنيت معاقمها على مطوائها أي كأنها تمطت فلما تناءت أطرافها ورحبت شحوتها صيغت على ذلك.
ومن ذلك قولهم: ما أدري أأذن أو أقام إذا قالها بأو لا بأم.
فهو أنه لم يعتد أذانه أذانا ولا قال: فمثل ذلك قول عبيد: أعاقر كذات رحم أم غانم كمن يخيب فكان ينبغي أن يعادل بقوله: ذات رحم نقيضتها فيقول: أغير ذات رحم كذات رحم وهكذا أراد لا محالة ولكنه جاء بالبيت على المسئلة.
وذلك أنه لما لم تكن العاقر ولودا صارت وإن كانت ذات رحم كأنها لا رحم لها فكأنه قال: أغير ذات رحم كذات رحم كما أنه لما لم يوف أذانه ولا إقامته حقهما لمن يثبت له واحداً منهما لأنه قاله بأو ولو قال: ما أدري أأذن أم أقام بأم لأثبت له أحدهما لا محالة.
ومن ذلك قول النحويين: إنهم لا يبنون من ضرب وعلم وما كانت عينه لاما أو راء مثل عنسل.
قالوا: لأنا نصير به إلى ضنرب وعنلم فإن أدغمنا ألبس بفعل وإن أظهرنا النون قبل الراء واللام ثقلت فتركنا بناءه أصلاً.
وكان ينشد في هذا المعنى قوله: فقال: ثكل وغدر أنت بينهما فاختر وما فيهما حظ لمختار وقول الآخر: رأى الأمر يفضى إلى آخر فصير آخره أولا ووجدت أنا من هذا الضرب أشياء صالحة.
منها أن الشعر المجزوء إذا لحق ضربه قطع لم تتداركه العرب بالردف.
وذلك أنه لا يبلغ من قدره أن يفي بما حذفه الجزء فيكون هذا أيضاً كقولهم للمغني غير المحسن: تتعب ولا أطرب.
ومنهم من يلحق الردف على كل حال.
فنطير معنى هذا معنى قول الآخر: ومبلغ نفسٍ عذرها مثل منجح وقول الآخر: فإن لم تنل مطلباً رمته فليس عليك سوى الاجتهاد ومن ذلك قول من اختار إعمال الفعل الثاني لأنه العامل الأقرب نحو ضربت وضربني زيد وضربني وضربت زيداً.
فنظير معنى هذا معنى قول الهذلي: بلى إنها تعفو الكلوم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي وعليه قول أبي نواس: أمر غدٍ أنت منه في لبس وأمس قد فات فاله عن أمس فإنما العيش عيش يومك ذا فباكر الشمس بابنة الشمس ومنه قول تأبط شراً وما قدم نسي ومن كان ذا شر خشي في كلام له وقوله: وقول الآخر أنشدناه أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان عن الأصمعي عن أبي عمر و أن رجلاً من أهل نجد أنشده: حتى كأن لم يكن إلا تذكره والدهر أيتما حال دهارير ومن ذلك أيضاً قول شاعرنا: خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل ومما جاء في معنى إعمال الأول قول الطائي الكبير: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول وقول كثير: ولقد أردت الصبر عنك فعاقني علق بقلبي من هواك قديم وقول الآخر: تمر به الأيام تسحب ذيلها فتبلى به الأيام وهو جديد ومن ذلك ما جاء عنهم من الجوار في قولهم: هذا حجر ضب خرب وما يحكى أن أعرابياً أراد امرأة له فقالت له: إني حائض فقال: فأين الهنة الأخرى فقالت له: اتق الله فقال: كلا ورب البيت ذي الأستار لأهتكن حلق الحتار ومنه قول العرب: أعطيتك إذ سألتني وزدتك إذ شكرنني.
فإذ معمولة العطية والزيادة وإذا عمل الفعل في ظرف زمانياً كان أو مكانياً فإنه لا بد أن يكون واقعاً فيه وليست العطية واقعة فقي وقت المسئلة وإنما هي عقيبه لأن المسئلة سبب العطية والسبب جار مجرى العلة فيجب أن يتقدم المعلول والمسبب لكنه لما كانت العطية مسببة عن المسئلة وواقعة على أثرها وتقارب وقتاهما صار لذلك كأنهما في وقت واحد.
فهذا تجاور في الزمان كما أن ذاك تجاور في الإعراب.
ومنه قول الله تعالى: {وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ}.
طاولت أبا علي رحمه الله تعالى في هذا وراجعته فيه عودا على بدء فكان أكثر ما برد منه في اليد أنه لما كانت الدار الآخرة تلي الدار الدنيا لا فاصل بينهما إنما هي هذه فهذه صار ما يقع في الآخرة تلى الدار الدنيا لا فاصل بينهما إنما هي هذه فهذه صار ما يقع في الآخرة كأنه واقع في الدنيا فلذلك أجرى اليوم وهو الآخرة مجرى وقت الظلم وهو قوله: إذ طلمتم ووقت الظلم إنما كان في الدنيا.
فإن لم تفعل هذا وترتكبه بقي إذا ظلمتم ووقت الظلم إنما كان في الدنيا.
فإن لم تفعل هذا وتركبه بقي إذ ظلمتم غير متعلق بشيء فيصير ما قاله أبو علي إلى أنه كأنه أبدل إذ ظلمتم من اليوم أو كرره عليه وهو كأنه هو.
فإن قلت: لم لا تكون إذ محمولة على فعل آخر حتى كأنه قال: ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون اذكروا إذ ظلمتم أو نحو ذلك.
قيل: ذلك يفسد من موضعين: أحدهما اللفظ والآخر المعنى.
أما اللفظ فلأنك تفصل بالأجنبي وهو قوله إذ ظلمتم بين الفعل وهو ينفعكم وفاعله وهو أنكم في العذاب مشتركون وأنت عالم بما في الفصل بينهما بالأجنبي.
وإن كان الفصل بالظرف متجوزاً فيه.
وأما المعنى فلأنك لو فعلت ذلك لأخرجت من الجملة الظرف الذي هو إذ ظلمتم وهذا ينقض معناها.
وذلك لأنها معقودة على دخول الظرف الذي هو إذ فيها ووجوده في أثنائها ألا ترى أن عدم انتفاعهم بمشاركة أمثالهم لهم في العذاب إنما سببه وعلته ظلمهم فإذا كان كذلك كان احتياج الجملة إليه نحواً من احتياجها إلى المفعول له نحو قولك: قصدتك رغبة في برك وأتيتك طمعا في صلتك ألا ترى أن معناه: أنكم عدمتم سلوة التأسي بمن شارككم في العذاب لأجل ظلمكم فيما مضى كما قيل في نظيره: {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} أي ذق بما كنت تعد في أهل العز والكرم.
وكما قال الله تعالى في نقيضه: {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ}.
ومن الأول قوله: {ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} ومثله في الشعر كثير منه قول قول الأعشى: على أنها إذ رأتني أقاد تقول بما قد أراه بصيرا ومنه قولهم حكاية عن الشيخ: بما لا أخشى بالذئب أي هذا الضعف بتلك القوة.
ومنه أبيات العجاج أنشدناها سنة إحدى وأربعين: إما تربني أصل القعادا وأتقى أن أنهض الإرعادا من أن تبدلت بآدي آدا لم يك يناد فأمسى آنادا وقصبا حنى حتى كادا يعود بعد أعظمٍ أعوادا فقد أكون مرة رواداً أطلع النجاد فالنجادا وآخر من جاء به على كثرته شاعرنا فقال: وكم دون الثوية من حزين يقول له قدومي ذا بذاكا فكشفه وحرره.
ويدل على الانتفاع بالتأسي في المصيبة قولها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزى النفس عنه بالتأسي ومنه قول أبي داود: ويصيخ أحيانا كما اس تمع المضل لصوت ناشد وهو كثير جداً.
ولسنا نريد ههنا الجوار الصناعي نحو قولهم في الوقف: هذا بكُرْ ومررت ببِكرْ وقولهم: صُيمَّ وقُيمَّ وقول جرير: ومررت ببكر وقولهم: صيم وقيم وقول جرير: لحب المؤقدان إلى مؤسى وقولهم: هذا مصباح ومقلات ومطعان وقوله: إذا اجتمعوا علي وأشقذوني فصرت كأنني فرأ متار وما جرى مجرى ذلك.
وإنما اعتزامنا هنا الجوار المعنوي لا اللفظي الصناعي.
ومن ذلك قول سيبويه في نحو قولهم: هذا الحسن الوجه: إن الجر فيه من وجهين أحدهما طريق الإضافة والآخر تشبيه بالضارب الرجلِ هذا مع العلم بأن الجر في الضارب الرجل إنما جاءه وجاز فيه لتشبيههم إياه بالحسن الوجه فعاد الأصل فاستعاد من الفرع نفس الحكم الذي كان الأصل بدأ أعطاه إياه حتى دل ذلك على تمكن الفروع وعلوها في التقدير.
وقد ذكرنا ذلك.
ونظيره في المعنى قول ذي الرمة: ورملٍ كأوراك العذارى قطعته إذا ألبسته المظلمات الحنادس وإنما المعتاد في نحو هذا تشبيه أعجاز بكثبان الأنقاء.
وقد تقدم ذكر هذا المعنى في باب قبل وقربوا كل جمالي عضه قريبةٍ ندوته من محمضه وقد ذكرنا حاله وشرحنا الغرض فيه في باب متقدم فلا وجه لإعادته ههنا.
وسبب تمكن هذه الفروع عندي أنها في حال استعمالها على فرعيتها تأتي مأتى الأصل الحقيقي لا الفرع التشبيهي وذلك قولهم: أنت الأسد وكفك البحر فهذا لفظه لفظ الحقيقة ومعناه المجاز والاتساع ألا ترى أنه إنما يريد: أنت كالأسد وكفك مثل البحر.
وعليه جاء قوله: ليلى قضيب تحته كثيب وإنما يريد: نصف ليلى الأعلى كالقضيب وتحته ردف مثل الكثيب وقول طرفة: جازت القوم إلى أرحلنا آخر الليل بيعفور خدر أي بشخص أو بإنسان مثل اليعفور وهو واسع كثير.
فلما كثر استعمالهم إياه وهو مجاز استعمال الحقيقة واستمر واتلاب وتجاوزوا به ذاك إلى أن أصاروه كأنه هو الأصل والحقيقة فعادوا فاستعاروا معناه لأصله فقال: ورمل كأوراك العذارى وهذا من باب تدريج اللغة وقد ذكر فيما مضى.
وكان أبو علي رحمه الله إذا أوجبت القسمة عنده أمرين كل واحد منهما غير جائز يقول فيه: قسمة الأعشي يريد قوله: وسأله مرة بعض أصحابه فقال له: قال الخليل في ذراع: كذا وكذا فما عندك أنت في هذا فأنشده مجيباً له: إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام ويشبه هذا ما يحكى عن الشعبي أنه ارتفع إليه في رجل بخص عين رجل ما الواجب في ذلك فلم يزدهم على أن أنشدهم بيت الراعي: لها مالها حتى إذا ما تبوأت بأخفافها مرعى تبوأ مضجعا فانصرف القوم مجابين.
أي ينتظر بهذه العين المبخوصة فإن ترامى أمرها إلى الذهاب ففيها الدية كاملة وإن لم تبلغ ذاك ففيها حكومة.
باب في خلع الأدلة
من ذلك حكاية يونس قول العرب: ضرب من منا أي إنسان إنسانا أو رجل رجلا أفلا تراه كيف جرد مَنْ من الاستفهام ولذلك أعربها.
ونحوه قولهم في الخبر: مررت برجل أي رجل.
فجرد أيا من الاستفهام أيضاً.
وعليه بيت الكتاب: والدهر أينما حالٍ دهارير أي والدهر في كل وقت وعلى كل حال دهارير أي متلون ومتقلب بأهله.
وأنشدنا أبو علي: وأسماء ما أسماء ليلة أدلجت إلي وأصحابي بأي وأينما قال: فجرد أي من الاستفهام ومنعها الصرف لما فيها من التعريف والتأنيث.
وذلك أنه وضعها علما على الجهة التي حلتها.
فأما قوله: وأينما فكذلك أيضاً غير أن لك في أينما وجهين: أحدهما أن تكون الفتحة هي التي تكون في موضع جرما لا ينصرف لأنه جعله علماً للبقعة والآخر أن تكون فتحة النون من أينما فتحة التركيب ويضم أين إلى ما فيبنى الأول على الفتح كما يجب في نحو حضرموت وبيت بيت فإذا أنت فعلت ذلك قدرت في ألف ما فتحة ما لا ينصرف في موضع الجر كمررت بأحمد وعمر.
ويدل على أنه قد يضم ما هذه إلى ما قبلها ما أنشدناه أبو علي عن أبي عثمان: أثور ما أصيدكم أم ثورين أم تيكم الجماء ذات القرنين فقوله: أثور ما فتحة الراء منه فتحة تركيب ثور مع ما بعده كفتحة راء حضرموت ولو كانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة لأنه مصروف.
وبنيت ما مع الاسم وهي مبقاة على حرفيتها كما بنيت لا مع النكرة في نحو لا رجل.
ولو جعلت ما مع ثور اسما ضممت إليه ثورا لوجب مدها لأنها قد صارت اسما فقلت: أثور ماء أصيدكم.
وكما أنك لو جعلت حاميم من قوله: يذكرني حاميم والرمح شاجر اسمين مضموما أحدهما إلى صاحبه لمددت حا فقلت: حاء ميم ليصر كحضرموت.
ومثل قوله: أثور ما أصيدكم في أنه اسم ضم إلى حرف في قول أبي عثمان ما أنشدناه أبو على: وأسماء ليلة أدلجت إلي وأصحابي بأي وأينما فكلام في ويحما هو الكلام في أثور ما.
فأما قول الآخر: وهل لي أم غيرها إن هجوتها أبي الله إلا أن أكون لها لها أينما فليس من هذا الضرب في شيء وإنما هي ميم زيدت آخر ابن وجرت قبلها حركة الإتباع فصارت هذا ابنم ورأيت ابنما ومررت بابنم.
فجريان حركات الإعراب على الميم يدل على أنها ليست ما.
وإنما الميم في آخره كالميم في آخر ضرزم ودفعتم ودردم.
وأخبرنا أبو علي أن أبا عثمان ذهب في قول الله تعالى: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} إلى أنه جعل مثل وما اسما واحدا فبنى الأول على الفتح وهما جميعا عنده في موضع رفع لكونهما صفة لحق.
فإن قلت: فما موضع {أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} قيل: هو جر بإضافة مثل ما إليه.
فإن قلت: ألا تعلم أن ما على بنائها لأنها على حرفين الثاني منهما حرف لين فكيف تجوز إضافة المبنى قيل ليس المضاف ما وحدها إنما المضاف الاسم المضموم إليه ما فلم تعد ما هذه أن تكون كتاء التأنيث في نحو هذه جارية زيد أو كالألف والنون في سرحان عمرو أو في غائلات الحائر المتوه فهذا وجه.
وإن شئت قلت: وما في إضافة المبنى! ألا ترى إلى إضافة كم في الخبر نحوكم عبد ملكت وهي مبنية وإلى إضافة أي من قول الله سبحانه {ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا} وهي مبنية عند سيبويه.
وأيضاً فلو ذهب ذاهب واعتقد معتقد أن الإضافة كان يجب أن تكون داعية إلى البناء من حيث كان المضاف من المضاف إليه بمنزلة صدر الكلمة من عجزها وبعض الكلمة صوت والأصوات إلى الضعف والبناء لكان قولا!.
ومما خلعت عنه دلالة الاستفهام قول الشاعر أنشدناه سنة إحدى وأربعين: أني جزوا عامرا سيئاً بفعلهم أم كيف يجزونني السوأى من الحسن أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رثمان أنف إذ ما ضن باللبن فأم في أصل الوضع للاستفهام كما أن كيف كذلك.
ومحال اجتماع حرفين لمعنى واحد فلا بد أن يكون أحدهما قد خلعت عنه دلالة الاستفهام.
وينبغي أن يكون ذلك الحرف أم دون كيف حتى كأنه قال: بل كيف ينفع فجعلها بمنزلة بل في الترك والتحول.
ولا يجوز أن تكون كيف هي المخلوعة عنها دلالة الاستفهام لأنها لو خلعت عنها لوجب إعرابها لأنها إنما بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام فإذا زال ذلك عنها وجب إعرابها كما أنه لما خلعت دلالة الاستفهام عن مَنْ أعربت في قولهم: ضرب من مناً.
وكذلك قولك: مررت برجل أي رجل لما خلعت عنها دلالة الاستفهام جرت وصفا.
وهذا واضح جلى.
ومن ذلك كاف المخاطب للمذكر والمؤنث نحو رأيتك وكلمتك هي تفيد شيئين: الاسمية والخطاب ثم قد خلع عنها دلالة الاسم في قولهم: ذلك وأولئك وهاك وهاءك وأبصرك زيدا وأنت تريد: أبصر زيداً وليسك أخالك في معنى ليس أخاك.
وكذلك قولهم: أرأيتك زيدا ما صنع وحكى أبو زيد: بلاك والله وكلاك والله أي بلى وكلا.
فالكاف في جميع ذلك حرف خطاب مخلوعة عنه دلالة الاسمية وعليه قول سيبويه.
ومن زعم أن الكاف في ذلك اسم انبغى له أن يقول: ذلك نفسك.
وهذا كله مشروح في أماكنه.
فلا موضع إذاً لهذه الكاف من الإعراب.
وكذلك هي إذا وصلت بالميم والألف والواو نحو ذلكما وذلكمو.
فعلى هذا يكون قول الله سبحانه: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ}.
كما من أنهكما منصوبة الموضع وكما من تلكما لا موضع لها لأنها حرف خطاب.
فإن قيل: فإذا كان تحرفاً لا اسما فكيف جاز أن تكون الألف المنفصلة التي قبلها تأسيسا في .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
على صدفي كالحنية بارك ولا غرو إلا جارتي وسؤالها أليس لنا أهل سئلت كذلك وقول خفاف بن ندبة: وقفت له علوي وقدم خام صحبتي لأبني مجدا أو لأثار هالكا أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلكا ألا ترى أن الألف في هالكا وبارك تأسيس لا محالة وقد جمعهما مع الألف في ذلكا وذلك وهي منفصلة وليس الروي وهو الكاف اسما مضمرا كياء قوله بداليا ولا من جملة اسم مضمركميم كماهما.
وهذا يدل على أن الكاف في ذلك اسم مضمر لا حرف.
قيل: هذا كلام لا يدخل على المذهب في كونها حرفاً وقد قامت الدلالة على ذلك من عدة أوجه.
ولكن بقي علينا الآن أن نرى وجه علة جواز كون الألف في ذلك تأسيساً مع أن الكاف ليست باسم مضمر.
وعلة ذلك أنها وإن تجردت في هذا الموضع من معنى الاسمية فإنها في أكثر أحوالها اسم نحو رأيتك وكلمتك ونظرت إليك واشتريت لك ثوباً وعجبت منك ونحو ذلك.
فلما جاءت ههنا على لفظ تلك التي هي اسم وهو أقل الموضعين حملت على الحكم في أكثر الأحوال لا سيما وهي هنا وإن جردت من معنى الاسمية فإن ما كان فيها من معنى الخطاب باق عليها وغير مختزل عنها.
وإذا جاز حمل همزة علباء على همزة حمراء للزيادة وإن عريت من التأنيث الذي دعا إلى قلبها في صحراوات وصحراوي كان حمل كاف ذلك على كاف رأيتك جائزا أيضاً وإن لم يكن أقوى لم يكن أضعف.
وقد اتصل بما نحن عليه موضع طريف.
ونذكره لاستمرار مثله.
وذلك أن أصغر الناس قدراً قد يخاطب أكبر الملوك محلا بالكاف من غير احتشام منه ولا إنكار عليه.
وذلك نحو قول التابع الصغير للسيد الخطير: قد خاطبت ذلك الرجل واشتريت تينك الفرسين ونظرت إلى ذينك الغلامين فيخاطب الصاحب الأكبر بالكاف وليس الكلام شعرا فتحتمل له جرأة الخطاب فيه كقوله: لقينا بك الأسد وسألنا منك البحر وأنت السيد القادر ونحو ذلك.
وعلة جواز ذلك عندي أنه إنما لم تخاطب الملوك بأسمائها إعظاما لها إذ كان الاسم دليل المعنى وجارياً في أكثر الاستعمال مجراه حتى دعا ذاك قوما إلى أن زعموا أن الاسم هو المسمى.
فلما أرادوا إعظام الملوك وإكبارهم تجافوا وتجانفوا عن ابتذال أسمائهم التي هي شواهدهم وأدلة عليهم إلى الكناية بلفظ الغيبة فقالوا: إن رأى الملك أدام الله علوه ونسأله حرس الله ملكه ونحو ذلك وتحاموا إن رأيت ونحن نسألك لما ذكرنا.
فهذا هذا.
فلما خلعت عن هذه الكاف دلالة الاسمية وجردت للخطاب البتة جاز استعمالها لأنها ليست باسم فيكون في اللفظ به ابتذال له.
فلما خلصت هذه الكاف خطاباً البتة وعريت من معنى الاسمية استعملت في خطاب الملوك لذلك.
فإن قيل: فهلا جاز على هذا أن يقال للملك ومن يلحق به في غير الشعر أنت لأن التاء هنا أيضاً للخطاب مخلوعة عنها دلالة الاسمية قيل: التاء في أنت وإن كانت حرف خطاب لا اسما فإن معها نفسها الاسم وهو أن من أنت فالاسم على كل حال حاضر وإن لم تكن الكاف وليس كذا قولنا ذلك لأنه ليس للمخاطب بالكاف هنا اسم غير الكاف كما كان له مع التاء في أنت اسم للمخاطب نفسه وهو أن.
فاعرف ذلك فرقا بين الموضعين.
ونحو من ذلك ما رآه أبو الحسن في أن الهاء والياء في إياه وإياي حرفان أحدهما للغيبة وهو الهاء والآخر للحضور وهو الياء.
وذلك أنه كان يرى أن الكاف في إياك حرف للخطاب فإذا أدخلت عليه الهاء والياء في إياه وإياي قال: هما أيضاً حرفان للغيبة والحضور مخلوعة عنهما دلالة الاسمية في رأيته وغلامي وصاحبي.
وهذا مذهب هول.
وهو وإن كان كذلك جار واعلم أن نظير الكاف في رأيتك إذا خلعت عنها دلالة الاسمية واستقرت للخطاب على ما أرينا التاء في قمت وقعدت ونحو ذلك هي هنا تفيد الاسمية والخطاب ثم تخلع عنها دلالة الاسمية وتخلص للخطاب البتة في أنت وأنت.
فالاسم أن وحده والتاء من بعد للخطاب.
وللتاء موضع آخر تخلص فيه للاسمية البتة وليس ذلك للكاف.
وذلك الموضع قولهم: أرأيتك زيداً ما صنع.
فالتاء اسم مجرد من الخطاب والكاف حرف للخطاب مجرد من الاسمية.
هذا هو المذهب.
ولذلك لزمت التاء الإفراد والفتح في الأحوال كلها نحو قولك للمرأة: أرأيتك زيدا ما شأنه وللاثنين وللاثنتين أرأيتكما زيدا أين جلس ولجماعة المذكر والمؤنث: أرأيتكم زيدا ما خبره وأرأيتكن عمرا ما حديثه فالتغيير للخطاب لاحق للكاف والتاء لأنه لا خطاب فيها على صورة واحدة لأنها مخلصة اسما.
فإن قيل: هذا ينقض عليك أصلاً مقررا.
وذلك أنك إنما تعتل لبناء الأسماء المضمرة بأن تقول: إن شبه الحرف غلب عليها ومعنى الاسم بعد عنها وذلك نحو قولك: ذلك وأولئك فتجد الكاف مخلصة للخطاب عارية من معنى الاسم.
وكذلك التاء في أنت وأنت عارية من معنى الاسم مجردة لمعنى الحرف.
وأنت مع هذا تقول: إن التاء في أرأيتك زيداً أين هو ونحو ذلك قد أخلصتها اسما وخلعت عنها دلالة الخطاب.
فإذا كانت قد تخلص في موضع اسما كما قيل: إن الكاف في ذلك جردت من معنى الاسمية ولم تقرن باسم المخاطب بها.
والتاء في أرأيتك زيداً ما صنع لم تجرد من معنى الحرفية إلا مقترنة بما كان مرة اسما ثم جرد من معنى الاسمية وأخلص للخطاب والحرفية وهو الكاف في أرأيتك زيداً ما صنع ونحوه.
فأنت وإن خلعت عن تاء أرأيتك زيداً ما خبره معنى الحرفية فقد قرنت بها ما جردته من معنى الاسمية وهو الكاف بعدها فاعتدل الأمران باقتران الاسم البتة بالحرف البتة.
وليس كذلك ذلك لأنك إنما معك الكاف المجردة لمعنى الخطاب لا اسم معها للمخاطب بالكاف فاعرف ذلك.
وكذلك أيضاً في أنت قد جردت الاسم وهو أن من معنى الحرفية وأخلصت التاء البتة بعده للخطاب كما أخلصت الكاف بعد التاء في أرأيتك عمرا ما شأنه حرفا للخطاب.
فإن قلت: فأن من أنت لم تستعمل قط حرفا ولا خلعت دلالة الاسمية عنها فهذا يقوي حكم الأسماء المضمرة كما أضعفها ما قدمت أنت من حالها في تجردها من معنى الأسمية وما غلب عليها من حكم الحرفية.
قيل: لسنا ندعي أن كل اسم مضمر لا بد من أن يخلع عنه حكم الأسمية ويخلص للخطاب والحرفية فيلزمنا ما رمت إلزامنا إياه وإنما قلنا: إن معنى الحرفية قدج أخلص له بعضها فضعف لذلك حكم جميعها وذلك أن الخلع العارض فيها إنما لحق متصلها دون منفصلها وذلك لضعف المتصل فاجترئ عليه لضعفه فخلع معنى الاسمية منه.
وأما المنفصل فجار بانفصاله مجرى الأسماء الظاهرة القوية المعربة.
وهذا واضح.
فإن قلت: في الأسماء الظاهرة كثيرة من المبنية نحو هذا وهذى وتاك وذلك والذي والتي وما ومن وكم وإذ ونحو ذلك فهلا لما وجد البناء في كثير من المظهرة سرى في جميعها كما أنه لما غلب شبه الحرف في بعض المضمرة أجرى عليها جميعها على ما قدمته قيل: إن الأسماء المظهرة من حيث كانت هي الأول القدائم القوية احتمل ذلك فيها لسبقها وقوتها والأسماء المضمرة ثوان لها وأخلاف منها ومعوضة عنها فلم تقو قوة ما هي تابعة له ومعتاضة منه فأعلها ما لا يعله ووصل إليها ما يقصر دونه.
وأيضاً فإن المضمر المتصضل وإن كان أضعف من الضمير المنفصل فإنه أكثر وأسير في الاستعمال منه ألا تراك تقول: إذا قدرت على المتصل لم تأت بالمنفصل.
فهذا يدلك على أن المتصل أخف عليهم وآثر في أنفسهم.
فلما كان كذلك وهو مع ذلك أضعف من المنفصل وسرى فيه لضعفه حكم لزم المنفصل أعني البناء لأنه مضمر مثله ولا حق في سعة الاستعمال به.
فإن قيل: وما الذي رغبهم في المتصل حتى شاع استعماله وصار متى قدر عليه لم يؤت قيل: علة ذلك أن الأسماء المضمرة إنما رغب فيها وفزع إليها طلباً للخفة بها بعد زوال الشك بمكانها وذلك أنك لو قلت: زيد ضرب زيداً فجئت بعائده مظهراً مثله لكان في ذلك إلباس واستثقال.
أما الإلباس فلأنك إذا قلت: زيد ضربت زيدا لم تأمن أن يظن أن زيدا الثاني غير الأول وأن عائد الأول متوقع مترقب.
فإذا قلت: زيد ضربته علم بالمضمر أن الضرب إنما وقع بزيد بزيد المذكور لا محالة وزال تعلق القلب لأجله وسببه.
وإنما كان كذلك لأن المظهر يرتجل فلو قلت: زيد ضربت زيدا لجاز أن يتوقع تمام الكلام وأن يظن أن الثاني غير الأول كما تقول: زيد ضربت عمراً فيتوقع أن تقول: في داره أو معه أو لأجله.
فإذا قلت زيد ضربته قطعت بالضمير سبب الإشكال من حيث كان المظهر يرتجل والمضمر تابع غير مرتجل في أكثر اللغة.
فهذا وجه كراهية الإشكال.
وأما وجه الاستخفاف فلأنك إذا قلت: العبيثران شممته فجعلت موضع التسعة واحدا كان أمثل من أن تعيد التسعة كلها فتقول: العبيثران شممت العبيثران.
نعم وينضاف إلى الطول قبح التكرار المملول.
وكذلك ما تحته من العدد الثماني والسباعي فما تحتهما هو على كل حال أكثر من الواحد.
فلما كان الأمر الباعث عليه والسبب المقتاد إليه إنما هو طلب الخفة به كان المتصل منه آثر في نفوسهم وأقرب رحما عندهم حتى إنهم متى قدروا عليه لم يأتوا بالمنفصل مكانه.
فلذلك لما غلب شبه الحرفية على المتصل بما ذكرناه: من خلع دلالة الاسمية عنه في ذلك وأولئك وأنتَ وأنتِ وقاما أخواك وقاموا إخوتك: و.
.
.
يعصرن السليط أقاربه و قلن الجواري ما ذهبت مذهبا حملوا المنفصل عليه في البناء إذ كان ضميرا مثله وقد يستعمل في بعض الأماكن في موضعه نحو قوله: إليك حتى بلغت إياكا أي بلغتك وقول أبي بجيلة وهو بيت الكتاب: كأنا يوم قرى إن ما نقتل إيانا وبيت أمية: بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير كذلك قد يستعمل المتصل موضع المنفصل نحو قوله: فإن قلت: زعمت أن المتصل آثر في نفوسهم من المنفصل وقد ترى إلى أكثر استعمال المنفصل موضع المتصل وقلة استعمال المتصل موضع المنفصل فهلا دلك ذلك على خلاف مذهبك قيل: لما كانوا متى قدروا على المتصل لم يأتوا مكانه بالمنفصل غلب حكم المتصل فلما كان كذلك عوضوا منه أن جاءوا في بعض المواضع بالمنفصل في موضع المتصل كما قلبوا الياء إلى الواو في نحو الشروى والفتوى لكثرة دخول الياء على الواو في اللغة.
ومن ذلك قولنا: ألا قد كان كذا وقول الله سبحانه: {أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ} فألا هذه فيها هنا شيئان: التنبيه وافتتاح الكلام فإذا جاءت معها يا خلصت افتتاحا لا غير وصار التنبيه الذي كان فيها ليا دونها.
وذلك نحو قول الله عز اسمه: { ألا يا اسجدوا لله } وقول الشاعر: ألا يا سنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم ومن ذلك واو العطف فيها معنيان: العطف ومعنى الجمع.
فإذا وضعت موضع مع خلصت للاجتماع وخلعت عنها دلالة العطف نحو قولهم: استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة.
ومن ذلك فاء العطف فيها معنيان: العطف والإتباع.
فإذا استعملت في جواب الشرط خلعت عنها دلالة العطف وخلصت للإتباع.
وذلك قولك: إن تقم فأنا أقوم ونحو ذلك.
ومن ذلك همزة الخطاب في هاء يا رجل وهاء يا امرأة كقولك: هاكَ وهاكِ فإذا ألحقتها الكاف جردتها من الخطاب لأنه يصير بعدها في الكاف وتفتح هي أبداً.
وهو قولك: هاءكَ وهاءَكِ وهاء كما وهاء كم.
ومن ذلك يا في النداء تكون تنبيها ونداء في نحو يا زيد ويا عبد الله.
وقد تجردها من النداء للتنبيه البتة نحو قول الله تعالى: { ألا يا اسجدوا } كأنه قال: ألا ها اسجدوا.
وكذلك قول العجاج: يا دار سلمة يا أسلمي ثم أسلمي إنما هو كقولك: ها أسلمي.
وهو كقولهم: هَلُمَّ في التنبيه على الأمر.
وأما قول أبي العباس: إنه أراد: ألا يا هؤلاء اسجدوا فمردود عندنا.
وقد كرر ذلك أبو علي في غير موضع فغنينا عن إعادته.
باب في تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان
هذا باب من العربية غريب الحديث أراناه أبو علي رحمه الله تعالى.
وقد كنت شرحت حاله في صدر تفسيري أسماء شعراء الحماسة بما فيه مقنع إلا أنا أردنا ألا نخلي كتابنا هذا منه لإغرابه وحسن التنبيه عليه.
اعلم أن الأعلام أكثر وقوعها في كلامهم إنما هو على الأعيان دون المعاني.
الأعيان هي الأشخاص نحو: زيد وجعفر وأبي محمد وأبي القاسم وعبد الله وذي النون وذي يزن وأعوج وسبل والوجيه ولاحق وعلوي وعتوة والجديل وشدقم وعمان ونجران والحجاز والعراق والنجم والدبران الثريا وبرقع والجرباء.
ومنه محوة للشمال لأنها على كل حال جسم وإن لم تكن مرئية.
وكما جاءت الأعلام في الأعيان فكذلك أيضاً قد جاءت في المعاني نحو قوله: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر فسبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه بمنزلة عثمان وحمران.
وإن قال غاو من تنوخ قصيدة بها جرب عدت علي بزوبرا سألت أبا علي عن ترك صرف زوبر فقال: علقه علما على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث كما اجتمع في سبحان التعريف والألف والنون.
ومنه فيما ذكره أبو علي ما حكاه أبو زيد من قولهم: كان ذلك الفينة وفينة وندرى والندرى.
فهذا مما اعتقب عليه تعريفان: العلمية والألف واللام.
وهو كقولك: شعوب والشعوب للمنية.
وعروبة والعروبة.
كما أن الأول كقولك: في الفرط والحين.
ومثله غدوة جعلوها علما للوقت.
وكذلك أعلام الزمان نحو صفر ورجب وبقية الشهور وأول وأهون وجبار وبقية تلك الأسماء.
ومنه أسماء الأعداد كقولك: ثلاثة نصف ستة وثمانية ضعف أربعة إذا أردت قدر العدد لا نفس المعدود فصار هذا اللفظ علما لهذا المعنى.
ومنه ما أنشده صاحب الكتاب من قوله: أنا اقتسمنا خُطَّتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجار فبرة اسم علم لمعنى البر فلذلك لم يصرف للتعريف والتأنيث.
وعن مثله عدل فجار أي عن فجرة.
وهي علم غير مصروف كما أن برة كذلك.
وقول سيبويه: إنها معدولة عن الفجرة تفسير على طريق المعنى لا على طريق اللفظ.
وذلك أنه أراد أن يعرف أنه معدول عن فجرة علماً ولم تستعمل تلك علماً فيريك ذلك فعدل عن لفظ العلمية المراد إلى لفظ التعريف فيها المعتاد.
وكذلك لو عدلت عن برة هذه لقلت: برار كما قال: فجار.
وشاهد ذلك أنهم عدلوا حذام وقطام عن حاذمة وقاطمة وهما عَلَمان فكذلك يجب أن تكون فَجَارِ معدولة عن فَفْرَة علماً أيضاً.
ومن الأعلام المعلقة على المعاني ما استعمله النحويون في عباراتهم من المثل المقابل بها الممثلات نحو قولهم: أفعل إذا أرادت به الوصف وله فعلاء لم تصرف.
فلا تصرف أنت أفعل هذه من حيث صارت علماً لهذا المثال نحو أحمر وأصفر وأسود وأبيض.
فتجري أفعل هذا مجرى أحمد وأصرم علمين.
وتقول فاعلة لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة.
فلا تصرف فاعلة لأنها علم لهذا الوزن فجرت مجرى فاطمة وعاتكة.
وتقول: فعلان إذا كانت له فَعْلَى فإنه لا ينصرف معرفة ولا نكرة.
فلا تصرف فعلان هذا لأنه عَلَم لهذا الوزن بمنزلة حَمْدان وقحطان.
وتقول: وزن طلحة فَعْلة ومثال عَبَيْثُرَان فَعَيْلُلان ومثال إسحارّ إفعالّ ووزن إستبرق إستفعل ووزن طريفة فعيلة.
وكذلك جميع ما جاء من هذا الطرز.
وتقول: وزن إبراهيم فعلاليل فتصرف هذا المثال لأنه لا مانع له من الصرف ألا ترى أنه ليس فيه أكثر من التعريف والسبب الواحد لا يمنع الصرف.
ولا تصرف إبراهيم للتعريف والعجمة.
وكذلك وزن جبرئيل فعلئيل فلا تصرف جبرئيل وتصرف مثاله.
والهمزة فيه زائدة لقولهم: جبريل.
وتقول: مثال جعفر فعلل فتصرفهما جميعاً لأنه ليس في كل واحد منهما أكثر من التعريف.
وقد يجوز إذا قيل لك ما مثال أَفْكَلٍ أن تقول: مثاله أفعلٍ فتصرفه حكاية لصرف أفكلٍ كما جررته حكاية لجره ألا تراك إذا قيل لك: ما مثال ضرب قلت: فُعِل فتحكى في المثال بناء ضرب فتبنيه كما بنيت مثال المبنى كذلك حكيت إعراب أفكلٍ وتنوينه فقلت في جواب ما مثال أفكلٍ: مثاله أفعلٍ فجررت كما صرفت.
فاعرف ذلك.
ومن ذلك قولهم: قد صرجت بِجدّانَ وجلدانَ.
فهذا علم لمعنى الجِدّ.
ومنه قولهم: أتى على ذي بليان.
فهذا علم للبعد قال: تنام ويذهب الأقوامُ حتى يقالَ أتوا على ذي بِليَّان فإن قلت: ولم قلت الأعلام في المعاني وكثرت في الأعيان نحو زيد وجعفر وجميع ما علق عليه علم وهو شخص قيل: لأن الأعيان أظهر للحاسة وأبدى إلى المشاهدة فكانت أشبه بالعلمية مما لا يرى ولا يشاهد حساً وإنما يعلم تأملاً واستدلالاً وليست كمعلوم الضرورة للمشاهدة.
باب في الشيء يرد مع نظيره مورده مع نقيضه
وذلك أضرب منها اجتماع المذكر والمؤنث في الصفة المؤنثة نحو رجل علامة وامرأة علامة ورجل نسابة وامرأة نسابة ورجل همزة لمزة وامرأة همزة لُمَزة ورجل صرورة وفروقة وامرأة صرورة وفروقة ورجل هلباجة فقاقة وامرأة كذلك.
وهو كثير.
وذلك أن الهاء في نحو ذلك لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه وإنما لحقت لإعلام المسامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكراً أم مؤنثاً.
يدل على ذلك أن الهاء لو كانت في نحو امرأة فروقة إنما لحقت لأن المرأة مؤنثة لوجب أن تحذف في المذكر فيقال: رجل فروق كما أن التاء في نحو امرأة قائمة وظريفة لما لحقت لتأنيث الموصوف حذفت مع تذكيره في نحو رجل ظريف وقائم وكريم.
وهذا واضح.
ونحو من تأنيث هذه الصفة لا يعلم أنها بلغت المعنى الذي هو مؤنث أيضاً تصحيحهم العين في نحو حول وصيد واعتونوا واجتوروا إيذاناً بأن ذلك في معنى ما لا بد من تصحيحه.
وهو احول واصيد وتعاونوا وتجاوروا وكما كررت الألفاظ لتكرير المعاني نحو الزلزلة والصلصلة والصرصرة.
وهذا باب واسع.
ومنها اجتماع المذكر والمؤنث في الصفة المذكرة.
وذلك نحو رجل خصم وامرأة خصم ورجل عدل وامرأة عدل ورجل ضيف وامرأة ضيف ورجل رضا وامرأة رضاً.
وكذلك ما فوق الواحد نحو رجلين رضا وعدل وقوم رضا وعدل قال زهير: متى يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضاً وهم عدلُ وسبب اجتماعهما هنا في هذه الصفة أن التذكير إنما أتاها من قبل المصدرية فإذا قيل: رجل عدل فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة كما تقول: استولى على الفضل وحاز جميع الرياسة والنبل ولم يترك لأحد نصيباً في الكرم والجود ونحو ذلك.
فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيداً.
وقد ظهر منهم ما يؤيد هذا المعنى ويشهد به.
وذلك نحو قوله: أنشدناه أبو علي: ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخل فهذا كقولك: هو مجبول من الكرم ومطين من الخير وهي مخلوقة من البخل.
وهذا أوفق معنى من أن تحمله على القلب وأنه يريد به: والبخل من الضنين لأن فيه من الإعظام والمبالغة ما ليس في القلب.
ومنه ما أنشدناه أيضاً من قوله: وهن من الإخلاف قبلك والمطل وقوله: وهن من الإخلاف والولعان وأقوى التأويلين في قولها: فإنما هي إقبال وإدبار أن يكون من هذا أي كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار لا على أن يكون من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات إدبار.
ويكفيك من هذا كله قول الله عز وجل {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ} وذلك لكثرة فعله إياه واعتياده له.
وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد: خلق العجل من الإنسان لأنه أمر قد اطرد واتسع فحمله على القلب يبعد في الصنعة ويصغر المعنى.
وكأن هذا الموضع لما خفي على بعضهم قال في تأويله: إن العَجَل هنا الطين.
ولعمري إنه في اللغة كما ذكر غير أنه في هذا الموضع لا يراد به إلا نفس العجلة والسرعة ألا تراه عز اسمه كيف قال عقبه {سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ} فنظيره قوله تعالى {وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً} { وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} لأن العجلة ضرب من الضعف لما تؤذن به من الضرورة والحاجة.
فلما كان الغرض في قولهم: رجل عدل وامرأة عدل إنما هو إرادة المصدر والجنس جعل الإفراد والتذكير أمارة للمصدر المذكر.
فإن قلت: فإن نفس لفظ المصدر قد جاء مؤنثاً نحو الزيادة والعبادة والضئولة والجهومة والمحمية والموجدة والطلاقة والسباطة.
وهو كثير جداً.
فإذا كان نفس المصدر قد جاء مؤنثاً فما هو في معناه ومحمول بالتأويل عليه أحجى بتأنيثه.
قيل: الأصل لقوته أحمل لهذا المعنى من الفرع لضعفه.
وذلك أن الزيادة والعبادة والجهومة والطلاقة ونحو ذلك مصادر غير مشكوك فيها فلحاق التاء لها لا يخرجها عما ثبت في النفس من مصدريتها.
وليس كذلك الصفة لأنه اليست في الحقيقة مصدراً وإنما هي متأولة عليه ومردودة بالصنعة إليه.
فلو قيل: رجل عدل وامرأة عدلة وقد جرت صفة كما ترى لم يؤمن أن يظن بها أنها صفة حقيقية كصُعْبة من صعب وندبة من ندب وفخمة من فخم ورطبة من رطب.
فلم يكن فيها من قوة الدلالة على المصدرية ما في نفس المصدر نحو الجهومة والشهومة والطلاقة والخلاقة.
فالأصول لقوتها يتصرف فيها والفروع لضعفها يتوقف فإن قلت: فقد قالوا: رجل عدل وامرأة عدلة وفرس طوعة القياد وقال أمية أنشدناه: والحية الحتفة الرقشاء أخرجها من بيتها آمنات الله والكلم قيل: هذا مما خرج على صورة الصفة لأنهم لم يؤثروا أن يبعدوا كل البعد عن أصل الوصف الذي بابه أن يقع الفرق فيه بين مذكره ومؤنثه فجرى هذا في حفظ الأصول والتلفت إليها للمباقاة لها والتنبيه عليها مجرى إخراج بعض المعتل على أصله نحو استحوذ وضننوا وقد تقدم ذكره ومجرى إعمال صغته وعدته وإن كان قد نقل إلى فَعُلت لما كان أصله فَعَلت.
وعلى ذلك أنث بعضهم فقال: خصمة وضيفة وجمع فقال: يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد وعليه قول الآخر: إذا نزل الأضياف كان عذوراً على الحي حتى تستقل مراجله الأضياف هنا بلفظ القلة ومعناها أيضاً وليس كقوله: وأسيافنا يقطرن من نجدة دما في أن المراد به معنى الكثرة.
وذلك أمدح لأنه إذا قرى الأضياف وهم قليل بمراجل الحي أجمع فما ظنك به لو نزل به الضيفان الكثيرون! فإن قيل: فلم أنث المصدر أصلاً وما الذي سوغ التأنيث فيه مع معنى العموم والجنس وكلاهما إلى التذكير حتى احتجت إلى الاعتذار له بقولك: إنه أصل وإن الأصول تحمل ما لا تحمله الفروع.
قيل: علة جواز تأنيث المصدر مع ما ذكرته من وجوب تذكيره أن المصادر أجناس للمعاني كما غيرها أجناس للأعيان نحو رجل وفرس وغلام ودار وبستان.
فكما أن أسماء أجناس الأعيان قد تأتى مؤنثة الألفاظ ولا حقيقة تأنيث في معناها نحو غرفة ومشرقة وعلية ومروحة ومِقْرَمَة وكذلك جاءت أيضاً أجناس المعاني مؤنثاً بعضها لفظاً لا معنى.
وذلك نحو المحمدة والموجدة والرشاقة والجباسة والضئولة والجهومة.
نعم وإذا جاز تأنيث المصدر وهو على مصدريته غير موصوف به لم يكن تأنيثه وجمعه وقد ورج وصفاً على المحل الذي من عادته أن يفرق فيه بين مذكره ومؤنثه وواحده وجماعته قبيحاً ولا مستكرها أعني ضيفة وخصمة وأضيافاً وخصوماً وإن كان التذكير والإفراد أقوى في اللغة وأعلى في الصنعة قال الله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ}.
وإنما كان التذكير والإفراد أقوى من قبل أنك لما وصفت بالمصدر أردت المبالغة بذلك فكان من تمام المعنى وكماله أن تؤكد ذلك بترك التأنيث والجمع كما يجب للمصدر في أول أحواله ألا ترى أنك إذا أنثت وجمعت سلكت به مذهب الصفة الحقيقة التي لا معنى للمبالغة فيها نحو قائمة ومنطلقة وضاربات ومكرمات.
فكان ذلك يكون نقضا للغرض أو كالنقض له.
فلذلك قل حتى وقع الاعتذار لما جاء منه مؤنثاً أو مجموعاً.
ومما جاء من المصادر مجموعا ومعملا أيضاً قوله: مواعيد عرقوب أخاه بيثرب وبيترب ومنه عندي قولهم: تركته بملاحس البقر أولادها.
فالملاحس جمع ملحس ولا يخلو أن يكون مكاناً أو مصدرا فلا يجوز أن يكون هنا مكاناً لأنه قد عمل في الأولاد فنصبها والمكان لا يعمل في المفعول به كما أن الزمان لا يعمل فيه.
وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان المضاف هنا محذوفاً مقدراً وكأنه قال: تركته بمكان ملاحس البقر أولادها كما أن قوله: وما هي إلا في إزار وعلقة مغار ابن همام على حي خثعما محذوف المضاف أي وقت إغارة ابن همام على حي خثعم ألا تراه قد عداه إلى على في قوله على حي خثعما.
فملاحس البقر إذاً مصدر مجموع معمل في المفعول به كما أن مواعيد عرقوب أخاه بيثرب كذلك.
وهو غريب.
وكان أبو علي رحمه الله يورد مواعيد عرقوب مورد فأما قوله: قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنعا فقد يجوز أن يكون من هذا.
وقد يجوز أن يكون أبا قدامة منصوباً بزادت أي فما زادت أبا قدامة تجاربهم إياه إلا المجد.
والوجه أن ينصب بتجاربهم لأنه العامل الأقرب ولأنه لو أراد إعمال الأول لكان حرى أن يعمل الثاني أيضاً فيقول: فما زادت تجاربهم إياه أبا قدامة إلا كذا كما تقول: ضربت فأوجعته زيدا وتضعف ضربت فأوجعت زيدا على إعمال الأول.
وذلك أنك إذا كنت تعمل الأول على بعده وجب إعمال الثاني أيضاً لقربه لأنه لا يكون الأبعد أقوى حالاً من الأقرب.
فإن قلت: أكتفي بمفعول العامل الأول من مفعول العامل الثاني قيل لك: فإذا كنت مكتفياً مختصراً فاكتفاؤك بإعمال الثاني الأقرب أولى من اكتفائك بإعمال الأول الأبعد.
وليس لك في هذا مالك في الفاعل لأنك تقول: لا أضمر على غير تقدم ذكر إلا مستكرها فتعمل الأول فتقول قام وقعدا أخواك.
فأما المفعول فمنه بد فلا ينبغي أن تتباعد بالعمل إليه وتترك ما هو أقرب إلى المعمول فيه منه.
ومن ذلك فرس وساعٌ الذكر والأنثى فيه سواء وفرس جواد وناقة ضامر وجمل ضامر تدري فوق متنيها قرونا على بشر وآنسة لباب وقال ذو الرمة: سبحلا أبا شرخين أحيا بناته مقاليتها فهي اللباب الحبائس فأما ناقة هجان ونوق هجان ودرع دلاص وأدرع دلاص فليس من هذا الباب فإن فعالا منه في الجمع تكسير فعال في الواحد.
وقد تقدم ذكر ذلك في باب ما اتفق لفظه واختلف تقديره.
باب في ورود الوفاق مع وجود الخلاف
هذا الباب ينفصل من الذي قبله بأن ذلك تبع فيه اللفظ ما ليس وفقاً له نحو رجل نسابة وامرأة عدل وهذا الباب الذي نحن فيه ليس بلفظ تبع لفظاً بل هو قائم برأسه.
وذلك قولهم: غاض الماء وغضته سووا فيه بين المتعدى وغير المتعدى.
ومثله جبرت يده وجبرتها وعمر المنزل وغمرته وسار الدابة وسرته ودان الرجل ودنته من الدين في معنى أدنته وعليه جاء مديون في لغة التميميين وهلك الشيء وهلكته قال العجاج: ومهمه هالك من تعرجا فيه قولان: أحدهما أن هالكاً بمعنى مهلك أي مهلك من تعرج فيه.
والآخر: ومهمه هالك المتعرجين فيه كقولك: هذا رجل حسن الوجه فوضع من موضع الألف واللام.
ومثله هبط الشيء وهبطته قال: ما راعني إلا جناح هابطاً على البيوت قوطه العلابطا أي مهبطاً قوطه.
وقد يجوز أن يكون أراد: هابطاً بقوطه فلما حذف حرف الجر نصب فأما قول الله سبحانه {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ} فأجود القولين فيه أن يكون معناه: وإن منها لما يهبط من نظر إليه لخشية الله.
وذلك أن الإنسان إذا فكر في عظم هذه المخلوقات تضاءل وتخشع وهبطت نفسه لعظم ما شاهد.
فنسب الفعل إلى تلك الحجارة لما كان السقوط والخشوع مسبباً عنها وحادثاً لأجل النظر إليها كقول الله سبحانه {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى} وأنشدوا بيت الآخر: فاذكر موقفي إذا التقت الخي ل وسارت إلى الرجال الرجالا أي وسارت الخيل الرجال إلى الرجال.
وقد يجوز أن يكون أراد: وسارت إلى الرجال بالرجال فحذف حرف الجر فنصب.
والأول أقوى.
وقال خالد بن زهير: فلا تغضبن من سيرة أنت سرتها فأول راض سيرة من يسيرها ورجنت الدابة بالمكان إذا أقامت فيه ورجنتها وعاب الشيء وعبته وهجمت على القوم وهجمت غيري عليهم أيضاً وعفا الشيء: كثر وعفوته: كثرته وفغر فاه وفغر فوه وشحا فاه وشحا فوه وعثمت يده وعثمتها أي جبرتها على غير استواء ومد النهر ومددته قال الله عز وجل {وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} وقال الشاعر: وسرحت الماشية وسرحتها وزاد الشيء وزدته وذرا الشيء وذروته: طيرته وخسف المكان وخسفه الله ودلع اللسان ودلعته وهاج القوم وهجتهم وطاخ الرجل وطخته أي لطخته بالقبيح في معنى أطخته ووفر الشيء ووفرته.
وقال الأصمعي: رفع البعير ورفعته في السير المرفوع وقالوا: نفى الشيء ونفيته أي أبعدته قال القطامي: فأصبح جاراكم قتيلاً ونافيا ونحوه نكرت البئر ونكرتها أي أقللت ماءها ونزفت ونزفتها.
فهذا كله شاذ عن القياس وإن كان مطرداً في الاستعمال إلا أن له عندي وجهاً لأجله جاز.
وهو أن كل فاعل غير القديم سبحانه فإنما الفعل منه شيء أعيره وأعطيه وأقدر عليه فهو وإن كان فاعلاً فإنه لما كان معاناً مقدراً صار كأن فعله لغيره ألا ترى إلى قوله سبحانه {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى} نعم وقد قال بعض الناس: إن الفعل لله وإن العبد مكتسبه وإن كان هذا خطأ عندنا فإنه قول لقوم.
فلما كان قولهم: غاض الماء أن غيره أغاضه وإن جرى لفظ الفعل له تجاوزت العرب ذلك إلى أن أظهرت هناك فعلاً بلفظ الأول متعدياً لأنه قد كان فاعله في وقت فعله إياه إنما هو مشاء إليه أو معان عليه.
فخرج اللفظان لما ذكرنا خروجاً واحداً.
فاعرفه.
باب في نقض العادة المعتاد المألوف في اللغة
أنه إذا كان فعل غير متعد كان أفعل متعدياً لأن هذه الهمزة كثيراً ما تجيء للتعدية.
وذلك نحو قام زيد وأقمت زيداً وقعد بكر وأقعدت بكراً.
فإن كان فعل متعدياً إلى مفعول واحد فنقلته بالهمزة صار متعدياً إلى اثنين نحو طعم زيد خبزاً وأطعمته خبزاً وعطا بكر درهماً وأعطيته درهماً.
فأما كسى زيد ثوباً وكسوته ثوباً فإنه وإن لم ينقل بالهمزة فإنه نقل بالمثال ألا تراه نقل من فعل إلى فعل.
وإما جاز نقله بفعل لما كان فعل وأفعل كثيراً ما يعتقبان على المعنى الواحد نحو جد في الأمر وأجد وصددته عن كذا وأصددته وقصر عن الشيء وأقصر وسحته الله وأسحته ونحو ذلك.
فلما كان فعل وأفعل على ما ذكرنا: من الاعتقاب والتعاوض ونقل بأفعل نقل أيضاً فَعِل وأفعل على ما ذكرنا: من الاعتقاب والتعاوض ونقل بأفعل نقل أيضاً فَعِل بفَعَل نحو كسى وكسوته وشترِت عينه وشترها وعارت وعرتها ونحو ذلك.
هذا هو الحديث: أن تنقل بالهمز فيحدث النقل تعدياً لم يكن قبله.
غير أن ضرباً من اللغة وذلك قولهم: أجفل الظليم وجفلته الريح وأشنق البعير إذا رفع رأسه وشنقته وأنزف البئر إذا ذهب ماؤها ونزفتها وأقشع الغيم وقشعته الريح وأنس ريش الطائر ونسلته وأمرت الناقة إذا در لبنها ومَرَيتها.
ونحو من ذلك ألوت الناقة بذنبها ولوت ذنبها وصر الفرس أذنه وأصر بأذنه وكبه الله على وجهه وأكب هو وعلوت الوسادة وأعليت عنها.
فهذا نقض عادة الاستعمال لأن فعلت فيه متعد وأفعلت غير متعد.
وعلة ذلك عني أنه جعل تعدي فعلت وجمود أفعلت كالعوض لفعلت من غلبة أفعلت لها على التعدي نحو جلس وأجلسته ونهض وأنهضته كما جعل قلب الياء واواً في التقوى والرعوى والثنوى والفتوى عوضاً للواو من كثرة دخول الياء عليها وكما جعل لزوم الضرب الأول من المنسرح لمفتعلن وحظر مجيئه تماماً أو مخبوناً بل توبعت فيه الحركات الثلاث البتة تعويضاً للضرب من كثرة السواكن فيه نحو مفعولن ومفعولان ومستفعلان ونحو ذلك ما التقى في آخره من الضروب ساكنان.
ونحو من ذلك ما جاء عنهم من أفعلته فهو مفعول وذلك نحو أحببته فهو محبوب وأجنه الله فهو مجنون وأزكمه فهو مزكوم وأكزه فهو مكزوز وأقره فهو مقرور وآرضه الله فهو مأروض وأملأه الله فهو مملوء وأضأده الله فهو مضئود وأحمه الله من الحمى فهو محموم وأهمه من الهم فهو مهموم وأزعقته فهو مزعوق أي مذعور.
ومثله ما أنشدناه أبو علي من قوله: إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مودوع وواعد مصدق وهو من أودعته.
ويبغي أن يكون جاء على ودع.
وأما أحزنه الله فهو محزون فقد حمل على هذا غير أنه قد قال أبو زيد: يقولون: الأمر يحزنني ولا يقولون: حزنني إلا أن مجيء المضارع يشهد للماضي.
فهذا أمثل مما مضى.
وقد قالوا فيه أيضاً: مُحْزَنٌ على القياس.
ومثله قولهم: محب.
منه بيت عنترة: ولقد نزلت فلا تظنى غيره مني بمنزلة المحب المكرم ومثله قول الأخرى: لأنكحن بَبَّه جارية خدبه مكرمة محبه تجب أهل الكعبة وقال الآخر: ومن يناد آل يربوع يُجَبْ يأتيك منهم خير فتيان العرب قالوا: وعلة ما جاء من أفعلته فهو مفعول نحو أجنه الله فهو مجنون وأسله الله فهو مسلول وبابه أنهم إنما جاءوا به على فعل نحو جن فهو مجنون وزكم فهو مزكوم وسل فهو مسلول.
وكذلك بقيته.
فإن قيل لك من بعد: وما بال هذا خالف فيه الفعل مسنداً إلى الفاعل صورته مسنداً إلى المفعول وعادة الاستعمال غير هذا وهو أن يجيء الضربان معاً في عدة واحدة نحو ضربته وضرب وأكرمته وأكرم وكذلك مقاد هذا الباب قيل: إن العرب لما قوى في أنفسها أمر المفعول حتى كاد يلحق عندها برتبة الفاعل وحتى قال سيبويه فيهما: " وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم " خصوا المفعول إذا أسند الفعل إليه بضربين من الصنعة: أحدهما تغيير صورة المثال مسنداً إلى المفعول عن صورته مسنداً إلى الفاعل والعدة واحدة وذلك نحو ضرب زيد وضرب وقتل وقتل وأكرم وأكرم ودحرج ودحرج.
والآخر أنهم لم يرضوا ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيير حتى تجاوزوه إلى أن غيروا عدة الحروف مع ضم أوله كما غيروا في الأول الصورة والصيغة وحدها.
وذلك نحو قولهم: أحببته وحب وأزكمه الله وزكم وأضأده الله وضئد وأملاه الله وملئ.
قال أبو علي: فهذا يدلك على تمكن المفعول عندهم وتقدم حاله في أنفسهم إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة مخالفة لصيغته وهو وهذا ضرب من تدريج اللغة عندهم الذي قدمت بابه ألا ترى أنهم لما غيروا الصيغة والعدة واحدة في نحو ضَرَب وضُرب وشَتَم وشُتِم تدرجوا من ذلك إلى أن غيروا الصيغة مع نقصان العدة نحو أزكمه الله وزكم وآرضه الله وأرض.
فهذا كقولهم في حنيفة: حنفي لما حذفوا هاء حنيفة حذفوا أيضاً ياءها ولما لم يكن في حنيف تاء تحذف فتحذف لها الياء صحت الياء فقالوا فيه: حنيفيّ.
وقد تقدم القول على ذلك.
وهذا الموضع هو الذي دعا أبا العباس أحمد بن يحيى فقي كتاب فصيحه أن أفرد له باباًن فقال: هذا باب فُعِل بضم الفاء نحو قولك: عُنِيت بحاجتك وبقية الباب.
إنما غرضه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى المفعول ولا تسند إلى الفاعل في اللغة الفصيحة ألا تراهم يقولون: نخى زيد من النخوة ولا يقال: نخاه كذا ويقولون امتقع لونه ولا يقولون: امتقعه كذا ويقولون: انقطع بالرجل ولا يقولون انقطع به كذا.
فلهذا جاء بهذا الباب أي ليريك أفعالاً خصت بالإسناد إلى المفعول دون الفاعل كما خصت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون المفعول نحو قام زيد وقعد جعفر وذهب محمد وانطلق بشر.
ولو كان غرضه أن يرك صورة ما لم يسم فاعله مجملاً غير مفصل على ما ذكرنا لأورد فيه نحو ضرب وركب وطلب وقتل وأكل وسمل وأكرم فاعرف هذا الغرض فإنه أشرف من حفظ مائة ورقة لغة.
ونظير مجيء اسم المفعول ههنا على حذف الزيادة نحو أجببته فهو محبوب مجيء اسم الفاعل على حذفها أيضاً وذلك نحو قولهم: أورس الرمث فهو وارس وأيفع الغلام فهو يافع وأبقل المكان فهو باقل قال الله عز وجل: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} وقياسه ملاقح لأن الريح تلقح السحاب فتستدره.
وقد يجوز أن يكون على لقحت هي فإذا لقحت فزكت ألقحت السحاب فيكون هذا مما اكتفى فيه بالسبب من المسبب.
وضده قول الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ} أي فإذا أردت قراءة القرآن فاكتفي بالمسبب الذي هو القراءة من السبب الذي هو الإرادة.
وقد جاء عنهم مبقل حكاها أبو زيد.
وقال داود ابن أبي دواد لأبيه في خبر لهما وقد قال له أبوه ما أعاشك بعدي: أعاشني بعدك واد مبقل آكل من حوذانه وأنسل وقد جاء أيضاً حببته قال الشاعر: ووالله لو تمره ما حببته ولا كان أدنى من عبيد ومشرق ونظير مجيء اسم الفاعل والمفعول جميعاً على حذف الزيادة فيما مضى مجيء المصدر أيضاً على حذفها نحو قولهم جاء زيد وحده.
فأصل هذا أوحدته بمروري إيحاداً ثم حذفت بمنجرد قيد الأوابد هيكل أي تقييد الأوابد ثم حذف زائدتيه وإن شئت قلت: وصف بالجوهر لما فيه من معنى الفعل نحو قوله: فلولا الله والمهر المفدى لرحت وأنت غربال الإهاب فوضع الغربال موضع مخرق.
وعليه ما أنشدناه عن أبي عثمان: مئبرة العرقوب إشفى المرفق أي دقيقة المرفق وهو كثير.
فأما قوله: وبعد عطائك المائة الرتاعا فليس على حذف الزيادة ألا ترى أن في عطاء ألف إفعال الزائدة.
ولو كان على حذف الزيادة لقال: وبعد عطوك فيكون كوحده.
وقد ذكرنا هذا فيما مضى.
ولما كان الجمع مضارعاً للفعل بالفرعية فيهما جاءت فيه أيضاً ألفاظ على حذف الزيادة التي كانت في الواحد.
وذلك نحو قولهم: كَرَوان وكِرْوان ووَرَشان ووِرْشان.
فجاء هذا على حذف زائدتيه حتى كأنه صار إلى فَعَل فجرى مجرى خَرَبٍ وخِرْبان وبَرَقٍ وبِرْقان قال: وأنشدنا لذي الرمة: من آل أبي موسى ترى الناس حوله كأنهم الكِرْوان أبصرن بازيا ومنه تكسيرهم فَعَالا على أفعال حتى كأنه إنما كُسِّر فَعَل وذلك نحو جواد وأجواد وعياءٍ وأعياءٍ وحياء وأحياء وعراءٍ وأعراءٍ وأنشدنا: أو مُجْنَ عنه عَرِيت أعراؤه فيجوز أن يكون جمع عَراءٍ ويجوز أن يكون جمع عُرْى ويجوز أن يكون جمع عَراً من قولهم: نزل بِعَرَاه أي ناحيته.
ومن ذلك قولهم: نِعمة وأَنْعُم وشِدّة وأشُدّ في قول سيبويه: جاء ذلك على حذف التاء كقولهم: ذئب وأَذْؤب وقِطْع وأقُطع وضِرْس وأَضْرُس قال: وقرعن نابك قَرْعة بالأضرِس وذلك كثير جداً.
وما يجيء مخالفاً ومنتقضاً أوسع من ذلك إلا أن لكل شيء منه عذراً وطريقاً.
وفصل للعرب طريف وهو إجماعهم على مجيء عين مضارع فعلته إذا كانت من فاعلني مضمومة البتة.
وذلك نحو قولهم: ضاربني فضربته أضربه وعالمني فعلمته أعلمه وعاقلني من العقل فعقلته أعقله وكارمني فكرمته أكرمه وفاخرني ففخرته أفخره وشاعرني فشعرته أشعره.
وحكى الكسائي: فاخرني ففخرته أفخَره بفتح الخاء وحكاها أبو زيد أفخُره بالضم على الباب.
كل هذا إذا كنت أقوم بذلك الأمر منه.
ووجه استغرابنا له أن خص مضارعه بالضم.
وذلك أنا قد دللنا على أن قياس باب مضارع فَعَل أن يأتي بالكسر نحو ضرب يضرب وبابه وأرينا وجه دخول يفعُل على يفعِل فيه نحو قَتَل يقْتُل ونخل ينخُلُ فكان الأحجى به هنا إذ أريد الاقتصار به على أحد وجهيه أن يكون ذلك الوجه هو الذي كان القياس مقتضياً له في مضارع فَعَل وهو يفعل بكسر العين.
وذلك أن العُرْف والعادة إذا أريد الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك المقتصر عليه هو أقيسهما فيه ألا تراك تقول في تحقير أسود وجذول: أسيد وجديل بالقلب وتجيز من بعد الإظهار وأن تقول: أسيود وجديول فإذا صرت إلى باب مقام وعجوز اقتصرت على الإعلال البتة فقلت: مقيِّم وعجيِّز فأوجبت أقوى القياسين لا أضعفهما وكذل نظائره.
فإن قلت: فقد تقول: فيها رجل قائم وتجيز فيه النصب فتقول: فيها رجل قائماً فإذا قدمت أوجبت أضعف الجائزين.
فكذلك أيضاً تقتصر في هذه الأفعال نحو أكرمه وأشعُره على أضعف الجائزين وهو الضم.
قيل: هذا إبعاد في التشبيه.
وذلك أنك لم توجب النصب في قائماً من قولك: فيها رجل قائما و قائما هذا متأخر عن رجل في مكانه في حال الرفع وإما اقتصرت على النصب فيه لما لم يجز فيه الرفع أو لم يقو فجعلت أضعف الجائزين واجباً ضرورة لا اختياراً وليس كذلك كرمتته أكرمه لأنه لم ينقض شيء عن موضعه ولم يقدم ولم يؤخر.
ولو قيل: كرمته أكرمه لكان كشتمته أشتمه وهزمته أهزمه.
وكذلك القول في نحو قولنا: ما جاءني إلا زيداً أحد في إيجاب نصبه وقد كان النصب لو تأخر زيد أضعف الجائزين فيه إذا قلت: ما جاءني أحد إلا زيداً الحال فيهما واحدة و ذلك أنك لما لم تجد مع تقديم المستثنى ما تبدله منه عدلت به للضرورة إلى النصب الذي كان جائزاً فيه متأخراً.
هذا كنصب فيها قائماً رجل البتة والجواب عنهما واحد.
وإذا كان الأمر كذلك فقد وجب البحث عن علة مجيء هذا الباب في الصحيح كله بالضم نحو أكرمه وأضرُبه.
وعلته عندي أن هذا موضع معناه الاعتلاء والغلبة فدخله بذلك معنى الطبيعة والنحيزة التي تغِلب ولا تُغلب و تلازم ولا تفارق.
وتلك الأفعال بابها: فَعُل يفُعل نحو فقُه يفقُه إذا أجاد الفقه وعلُم يعلُم إذا أجاد العلم.
وروينا عن أحمد ابن يحيى عن الكوفيين: ضَرُبتِ اليدُ يدهُ وكذلك نعتقد نحن أيضاً في الفعل المبني منه فعل التعجب أنه قد نقل عن فَعَل وفَعِل إلى فَعُلَ حتى صارت له صفة التمكن والتقدم ثم بني منه الفعل فقيل: ما أفعله نحو ما أشعره إنما هو من شَعُر وقد حكاها أيضاً أبو زيد.
وكذلك ما أقتله وأكفره: هو عندنا من قَتُل وكَفُر تقديراً وإن لم يظهر في اللفظ استعمالاً.
فلما كان قولهم: كارمني فكرمته أكرمه وبابه صائراً إلى معنى فَعُلت أفُعل أتاه الضمّ من هناك.
فاعرفه.
فإن قلت: فهلا لما دخله هذا المعنى تمموا فيه الشبه فقالوا: ضربته أضرُبه وفَخُرْتُه أفْخُرهُ ونحو ذلك قيل: منع من ذلك أن فَعُلْت لا يتعدى إلى المفعول به أبداً ويفعُل قد يكون في المتعدي كما يكون في غيره ألا ترى إلى قولهم: سلبه يسلُبه وجلبه يجلبه ونخله ينخُله فلم يمنع من المضارع ما منع من الماضي فأخذوا منهما ما ساغ واجتنبوا ما لم يسغ.
فإن قلت: فقد قالوا: قاضاني فقضيته أقضيه وساعاني فسعيته أسعيه قيل: لم يكن من يفعله ههنا بد مخافة أن يأتي على يفُعل فينقلب الياء واواً وهذا مرفوض في هذا النحو من الكلام.
وكما لم يكن من هذا بد ههنا لم يجئ أيضاً مضارع فَعَل منه مما فاؤه واو بالضم بل جاء بالكسر على الرسم وعادة العرب.
فقالوا: واعدني فوعدته أعده وواجلني فوجلته أجِلُه وواضأني فوضأته أَضؤه.
فهذا كوضعته من هذا الباب أضعهُ.
ويدلك على أن لهذا الباب أثراً في تغييره باب فَعَل في مضارعه قولهم: ساعاني فسعيته أسعيه ولم يقولوا: أسعاه على قولهم: سعى يسعى لما كان مكاناً قد رتب وقرر وزوى عن نظيره في غير هذا الموضع.
فإن قلت: فهلا غيروا ما فاؤه واو كما غيروا ما لامه ياء فيما ذكرت فقالوا: واعدني فووعدته أَوعُدُه لما دخله من المعنى المتجدد.
قيل: فَعَل مما فاؤه واو لا يأتي مضارعه أبداً بالضمّ إنما هو بالكسر نحو وجد يجد ووزن يزن وبابه وما لامه ياء فقد يكون على يفعل كيرمى ويقضى وعلى يفعَل كيرعى ويسعى.
فأمر الفاء إذا كانت واواً في أغلظ حكماً من أمر اللام إذا كانت ياء.
فاعرف ذلك فرقاً.
باب في تدافع الظاهر
هذا نحو من اللغة له انقسام.
فمن ذلك استحسانهم لتركيب ما تباعدت مخارجه من الحروف نحو الهمزة مع النون والحاء مع الباء نحو آن ونأى وحب وبحّ واستقباحهم لتركيب ما تقارب من الحروف وذلك نحو صس وسص وطث وثط.
ثم إنا من بعد نراهم يؤثرون في الحرفين المتباعدين أن يقربوا أحدهما من صاحبه ويدنوه إليه وذلك نحو قولهم في سويق: صَوِيق وفي مساليخ: مصاليخ وفي السوق: الصوق وفي اصتبر: اصطبر وفي ازتان: ازدان ونحو ذلك ما أدنى فيه الصوتان أحدهما من الآخر مع ما قدمناه: من إيثارهم لتباعد الأصوات إذ كان الصوت مع نقيضه أظهر منه مع قرينه ولصيقه ولذلك كانت الكتابة بالسواد في السواد خفية وكذلك سائر الألوان.
والجواب عن ذلك أنهم قد علموا أن إدغام الحرف في الحرف أخف عليهم من إظهار الحرفين ألا ترى أن اللسان ينبو عنهما معاً نبوة واحدة نحو قولك: شد وقطع وسلم ولذلك ما حققت الهمزتان إذ كانتا عينين نحو سآل ورآس ولم تصحا في الكلمة الواحدة غير عينين ألا ترى إلى قولهم: آمن وآدم وجاء وشاء ونحو ذلك.
فلأجل هذا ما قال يونس في الإضافة إلى مُثَنَّى: مُثَنَّوِيّ فأجرى المدغم مجرى الحرف الواحد نحو نون مَثْنَّى إذا قلت: مَثْنِوَيّ قال الشاعر: حلفتُ يميناً غير ذي مَثْنَوِيَّةٍ ولأجل ذلك كان من قال: هم قالوا فاستخف بحذف الواو ولم يقل في هن قلن إلا بالإتمام.
ولذلك كان الحرف المشدد إذا وقع روياً في الشعر المقيد خفف كما يسكن المتحرك إذا وقع روياً فيه.
فالمشدد نحو قوله: أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستعر فقابل براء هر راء مستعر وهي خفيفة أصلاً.
وكذلك قوله: ففداء لبني قيس على ما أصاب الناس من سوء وضر ما أقلت قدمي إنهم نعم الساعون في الأمر المبر وأمثاله كثيرة.
والمتحرك نحو قول رؤبة: وقاتم الأعماق خاوي المخترق ونحو ذلك مما كان مفرداً محركاً فأسكنه تقييد الروى.
ومن ذلك أن تبنى مما عينه واو مثل فِعَّ فتصح العين للإدغام نحو قِوَّل وقِوَّم فتصح العين فلما كان في إدغامهم الحرف في الحرف ما أريناه من استخفافهم إياه صار تقريبهم الحرف من الحرف ضرباً من التطاول إلى الإدغام.
وإن لم يصلوا إلى ذلك فقد حاولوه واشرأبوا نحوه إلا أنهم مع هذا لا يبلغون بالحرف المقرب من الآخر أن يصيروه إلى أن يكون من مخرجه لئلا يحصلوا من ذلك بين أمرين كلاهما مكروه.
أما أحدهما فأن يدغموا مع بعد الأصلين وهذا بعيد.
وأما الآخر فأن يقربوه منه حتى يجعلوه من مخرجه ثم لا يدغموه وهذا كأنه انتكاث وتراجع لأنه إذا بلغ من قربه إلى أن يصير من مخرجه وجب إدغامه فإن لم يدغموه حرموه المطلب المروم فيه ألا ترى أنك إذ قربت السين في سويق من القاف بأن تقلبها صاداً فإنك لم تخرج السين من مخرجها ولا بلغت بها مخرج القاف فيلزم إدغامها فيها.
فأنت إذاً قد رمت تقريب الإدغام المستخف لكنك لم تبلغ الغاية التي توجبه عليك وتنوط أسبابه بك.
وكذلك إذا قلت في اضتبر: اصطبر فأنت قد قربت التاء من الصاد بأن قلبتها إلى أختها في الإطباق والاستعلاء والطاء مع ذلك من جملة مخرج التاء.
وكذلك إذا قلت في مصدر: مزدر فأخلصت الصاد زايا: قد قربتها من الدال بما في الزاي من الجهر ولم تختلجها عن مخرج الصاد.
وهذه أيضاً صورتك إذا أشممتها رائحة الزاي فقلت: فإن كان الحرفان جميعاً من مخرج واحد فسلكت هذه الطريق فليس إلا أن تقلب أحدهما إلى لفظ الآخر البتة ثم تدغم لا غير.
وذلك نحو اطعن القوم أبدلت تاء أطتعن طاء البتة ثم أدغمتها فيها لا غير.
وذلك أن الحروف إذا كانت من مخرج واجد ضاقت مساحتها أنت تدنى بالتقريب منها لأنها إذا كانت معها من مخرجها فهي الغاية في قربها فإن زدت على ذلك شيئاً فإنما هو أن تخلص الحرف إلى لفظ أخيه البتة فتدغمه فيه لا محالة.
فهذا وجه التقريب مع إيثارهم الإبعاد.
ومن تدافع الظاهر ما تعلمه من إيثارهم الياء على الواو.
وذلك لويت ليا وطويت طياً وسيد وهين وطي وأغريت ودانيت واستقصيت ثم إنهم مع ذلك قالوا: الفتوى والتقوى والثنوى فأبدلوا الياء واواً عن غير قوة علة أكثر من الاستحسان والملاينة.
والجواب عن هذا أيضاً أنهم مع ما أرادوه من الفرق بين الاسم والصفة على ما قدمناه أنهم أرادوا أن يعوضوا الواو من كثرة دخول الياء عليها.
ومثله في التعويض لا الفرق قولهم: تقي وتقواء ومضى على مضوائه وهذا أمر ممضو عليه.
ونحوه في الإغراب قولهم: عوى الكلب عوة وقياسه عيَّة.
وقالوا في العلم للفرق بينه وبين الجنس: حَيْوة وأصله حيَّة فأبدلوا الياء واواً.
وهذا مع إيثارهم خص العلمِ بما ليس للجنس فلا ترين من ذلك شيئاً ساذجاً عارياً من غرض وصنعة.
ومن ذلك استثقالهم المثلين حتى قلبوا أحدهما في نحو أمليت وأصلها أمللت وفيما حكاه أحمد بن يحيى أخبرنا به أبو علي عنه من قولهم: لا وربك لا أفعل يريدون: لا وربك لا أفعل.
نعم وقالوا في أشد من ذا: ينشب في المسعل واللهاء أنشب من مآشر حداء قالوا: يريد: حداد فأبدل الحرف الثاني وبينهما ألف حاجزة ثم قال مع هذا: لقد تعللت على أيانق صهب قليلات القراد اللازق فجمعوا بين ثلاثة أمثال مصححة وقالوا: تصببت عرقاً.
وقال العجاج: إذا حجاجا مقلتيها هججا وأجازوا في مثل فرزدق من رددت رَدَدّد فجمعوا بين أربع دالات وكرهوا أيضاً حنيفي ثم جمعوا بين أربع ياءات فقال بعضهم: أمَيِّيّ وعًدٍِتِّيّ وكرهوا أيضاً أربع ياءات بينهما حرف صحيح حتى حذفوا الثانية منها.
وذلك قولهم في الإضافة إلى أُسَيّدٍ: أُسَيْديّ.
ثم إنهم جمعوا بين خمس ياءات مفصولاً بينهما بالحرف الواحد.
وذلك قولهم في الإضافة إلى مُهيتم مُهَيّيمِىّ.
والجواب عن كل فصل من هذا حاضر.
أما أمليت فلا إنكار لتخفيفه بإبداله.
وأما تعللت وهججا ونحو ذلك مما اجتمعت فيه ثلاثة أمثال فخارج على أصله وليس من حروف العلة فيجب تغييره.
والذي فعلوه في أمليت ولاوربيك لا أفعل وأنشب من مآشر حداء لم يكن واجباً فيجب هذا أيضاً وإنما غير استحساناً فساغ ذلك فيه ولم يكن موجباً لتغيير كل ما اجتمعت فيه أمثال ألا ترى أنهم لما قلبوا ياء طيء ألفا في الإضافة فقالوا: طائي لم يكن ذلك واجباً في نظيره لما كان الأول مستحسناً.
وأما حنفي فإنهم لما حذفوا التاء شجعوا أيضاً على حذف الياء فقالوا: حنفي.
وليس كذلك عديي وأميي فيمن أجازهما ألا ترى عدياً لما جرى مجرى الصحيح في اعتقاب حركات الإعراب عليه نحو عديِّ وعديَّا وعديِّ جرى مجرى حنيف فقالوا: عديِّيِّ كما قالوا: حنيفيّ.
وكذلك أُمَيِّيّ أجروه مجرى نميريّ وعقيليّ.
ومع هذا فليس أميّيّ وعدييّ بأكثر في كلامهم.
وإنما يقولها بعضهم.
وأما جمعهم في مهييمي بين خمس ياءات وكراهيتهم في أسيدي أربعاً فلأن الثانية من أسيديّ لما كانت متحركة وبعدها حرف متحرك قلقت لذلك وجفت.
ولما تبعتها في مهييميّ ياء المد لانت ونعمت.
وذلك من شأن المدات.
ولذلك استعملن في الأرداف والوصول والتأسيس والخروج وفيهن يجري الصوت للغناء والحداء والترنم والتطويح.
وبعد فإنهم إذا خففوا في موضع وتركوا آخر في نحوه كان أمثل من ألا يخففوا في أحدهما.
وكذلك جميع ما يرد عليك مما ظاهره ظاهر التدافع يجب أن ترفق به ولا تعنف عليه ولا تسرع إلى إعطاء اليد بانتقاض بابه.
والقياس الفياس.
باب في التطوع بما لا يلزم
هذا أمر قد جاء في الشعر القديم والمولد جميعاً مجيئاً واسعاً.
وهو أن يلتزم الشاعر ما لا يجب عليه ليدل بذلك على غزره وسعة ما عنده.
فمن ذلك ما أنشده الأصمعي لبعض الرجاز: وحسدٍ أوشلت من حظاظها على أحاسي الغيظ واكتظاظها حتى ترى الجواظ من فظاظها مذلوليا بعد شدا أفظاظها وخطة لا روح كظاظها أنشطت عني عروتي شظاظها بعد احتكاء أربتي أشظاظها بعزمة جلت غشا إلظاظها بجك كرش الناب لافتظاظها فالتزم في جميعها ما تراه من الظاء الأولى مع كون الروي ظاء على عزة ذلك مفرداً من الظاء الأول فكيف به إذا انضم إليه ظاء قبله.
وقلما رأيت في قوة الشاعر مثل هذا.
وأنشد الأصمعي أيضاً من مشطور السريع رائية طويلة التزم قائلها تصغير قوافيها في أكثر الأمر عز على ليلى بذي سدير سوء مبيتي ليلة الغمير مقبضاً نفسي في طمير تجمع القنفذ في الحجير تنتهض الرعدة في ظهيري يهفو إلى الزور من صديري مثل هرير الهر للهرير ظمآن في ريح وفي مطير وأرز قر ليس بالقرير من لدما ظهر إلى سحير حتى بدت لي جبهة القمير لأربع غبرن من شهير ثم غدوت غرضاً من فوري وقطقط البلة في شعيري يقذفني مور إلى ذي مور حتى إذا وركت من أييرى سواد ضيفيه إلى القصير رأت شحوبي وبذاذ شوري وجردبت في سمل عفير راهبة تكنى بأم الخير جافية معوى ملاث الكور تتحزم فوق الثوب بالزنير تقسم أستياً لها بنير وتضرب الناقوس وسط الدير كلهم أمعط كالنغير وأرملات ينتظرن ميرى قالت ألا أبشر بكل خير ودهنت وسرحت ضفيري وأدمت خبزي من صيير من صير مصرين أو البحير وبزييت نمس مرير وعدس قشر من قشير وقبصات من فغى تمير وأتأرتني نظرة الشفير وجعلت تقذف بالحجير شطرى وما شطري وما شطيري حتى إذا ما استنتفدت خبيري قامت إلى جنبي تمس أيري فزف رألى واستطير طيري وقلت: حاجات عند غيري حقرت ألا يوم قد سيري إذ أنا مثل الفلتان العير حمساً ولا إضت كالنسير وحين أقعيت على قبيري أنتظر المحتوم من قديري كلا ومن منفعتي وخيري بكفه ومبدئي وحوري وكذلك ما أنشده الأصمعي من قول الآخر: قالوا ارتحل فاخطب فقلت هلاَّ إذ روقاي معاً ما انفلاَ وإذ أؤل المشي ألاَّ ألاَّ وإذ أنا أرى ثوب الصبا رفلاَ علي أحوى ندياً مخضلاَّ حتى إذا ثوب الشباب ولَّى وانضم بدن الشيخ واسمألاَّ وانشنج العلباء فاقفعلاّ مثل نضي السقم حين بلاّ وحر صدر الشيخ حتى صلاّ على حبيب بان إذ تولَّى غادر شغلاً شاغلاً وولَّى قلت تعلق فيلقاً هوجلاّ عجاجة هجاجة تألَّى لأصبحن الأحقر الأذلاَّ وأن أعل الرغم علاَّ علاَّ فإن أقل يا ظبي حلاً حلاَّ تقلق وتعقد حبلها المنحلاّ وحملقت حولي حتى احولاَّ مأقاأ كرهان لها واقبلاّ إذا أتت جارتها تفلَّى تريك أشغى قلحاً أفلاّ منتوفة الوجه كأن ملاّ يمل وجه العرس فيه ملاّ كأن صاباً آل حتى امطلاّ تسفه وشبرما وخلاّ إن حل يوماً رحله محلاّ حمو لها أزجت إليه صلاّ وعقرباً تمتل ملاً ملاَّ ذاك وإن ذو رحمها استقلاّ من عثرة ماتت جوى وسلاّ أو كثر الشيء له أو قلاّ قالت لقد أثرى فلا تملَّى وإن تقل يا ليته استبلاّ من مرض أحرضه وبلاّ تقل: لأنفيه ولا تعلَّى تسر إن يلق البلاد فلاّ مجروزة نفاسة وغلاّ وإن وصلت الأقرب الأخلاّ جنت جنوناً واستخفت قلاّ وأجللت من ناقع أفكلاّ إذا ظبي الكنسات انغلاّ تحت الإران سلبته الظلاَّ وإن رأت صوت السباب علَّى سحابة ترعد أو قسطلاّ أجت إليه عنقاً مئلاّ تقول لأبنيها إذا ما سلاّ سليلة من سرق أو غلاّ أو فجعا جيرتها فشلاّ وسيقة فكرشا وملاّ أحسنتما الصنع فلا تشلاّ لا تعدما أخرى ولا تكلاّ يا رب رب الحج إذ أهلاّ محرمه ملبياً وصلَّى وحل حَبْلَى رحله إذ حلاّ بالله قد أنضى وقد أكلاّ وأنقب الأشعر والأظلاّ من نافه قد انضوى واختلاّ يحمل بلو سفر قد بلَّى أجلاده صيامه وألاّ يزال نضو غزوة مملاّ وصال أرحام إذا ما ولَّى ذو رحم وصله وبلاّ سقاء رحم منه كان صلاّ وينفق الأكثر والأقلاّ من كسب ما طاب وما قد حلاّ إذا الشحيح غل كفاً غلاّ بسط كفيه معاً وبلاّ وحل زاد الرحل حلاً حلاَّ يرقب قرن الشمس إذ تدلَّى حتى إذا أوفى بلالاً بلاّ بدمعه لحيته وانغلاّ بها وفاض شرقاً فابتلاّ جيب الرداء منه فارمعلاّ وحفز الشأنين فاستهلاَّ كما رأيت الوشلين انهلاّ حتى إذا حبل الدعاء انحلاَّ وانقاض زبرا جاله فابتلاّ أثنى على الله علا وجلاّ ثم انثنى من بعد ذا فصلَّى على النبي نهلاً وعلاَّ وعم في دعائه وخلاّ ليس كمن فارق واستحلاّ دماء أهل دينه وولَّى وجهته سوى الهدى مولَّى مجتنباً كبرى الذنوب الجلّى مستغفراً إذا أصاب القلَّى لما أتى المزدلفات صلَّى سبعاً تباعاً حلهن حلاّ حتى إذا أنف الفجير جلَّى برقعه ولم يسر الجلاّ هب إلى نضيه فعلَّى رحيله عليه فاستقلاّ إني امرؤ أصفي الخلي الخله أمنحه ودي وأرعى إلَّه وأبغض الزيارة المملَّه وأقطع المهامه المضلَّه لست بها لركبها تعلَّه إلا نجاء الناجيات الجلّهْ على هبلِّ أو على هِبِلَّهْ ذات هباب جسرة شملّه ناجية في الخرق مشمعلّهْ تنسلُّ بعد العقب المكلّه مثل انسلال العضب من ذي الخلَّه وكاشح رقيت منه صلّه بالصفح عن هفوته والزلَّه حتى استللت ضغنه وغلّه وطامح ذي مخوة مدلّه حملته على شباة ألّه ولم أملَّ الشر حتى ملَّه وشنج الراحة مقفعلَّه ما إن تبض كفه ببلّه أفاد دثراً بعد طول خلّه وصار رب إبل وثلَّه لما ذممت دقه وجلّه ترى عليهم للندى أدلّه سماؤهم بالخير مستهلّه وغادروني بعدهم ذا غلَّه أبكيهم بعبرة منهلّه ثم صبرت واعتصمت بالله نفساً بحمل العبء مستقلَّه ودول الأيام مضمحله يشعبها ما يشعب الجبلّه تتابع الأيام والأهلًّه وأنشدنا أبو علي: شلَّت يدا قارية فرتها وفقئت عين التي أرتها مسك شبوب ثم وفرتها لو خافت النزع لأصغرتها فلزم التاء والراء وليست واحدة منهما بلازمة.
والقطعة هائية لسكون ما قبل الهاء والساكن لا وصل له.
ويجوز مع هذه القوافي ذرها ودعها.
وأنشد ابن الأعرابي ليزيد بن الأعور الشني وكان أكرى بعيراً له فحمل عليه محملان أول ما علمت المحامل.
وهو قوله: لما رأيت محمليه أنا مخدرين كدت أن أجنا قربت مثل العلم المبنى لا فاني السن وقد أسنا ضخم الملاط سبطاً عبنا يطرح بالطرف هُنَا وهَنّا وافتن من شأو النشاط فنا يدق حنو القتب المحنى إذا علا صوانة أرنا يرمعها والجندل الأغنا ضخم الجفور سهبلاً رفنا وفي الهباب سدماً معنى كأنما صريفه إذ طنا في الضالتين أخطبانٌ غنى مستحملاً أعرف قد تبنى كالصدع الأعصم لما اقتنا يقطع بعد الفيف مهوأنا وهو حديد القلب ما ارفأنا كأن شناً هزما وشنا قعقعه مهزج تعغنى تحت لبان لم يكن أدنا ألتزم النون المشددة في جميعها على ما تقدم ذكره وقال آخر: إليك أشكو مشيها تدافيا مشي العجوز تنقل الأثافيا فالتزم الفاء ولست واجبة.
وقال آخر: التزم الألف والحاء والياء وليست واحدة منهن لازمة لأنه قد يجوز مع هذه القوافي نحو يحدوه ويقفوه وما كان مثله.
وأنشد أبو الحسن: ارفعن أذيال الحقيّ وأربعن مشي حييات كأن لم يفزعن إن تمنع اليوم نساء تمنعن فالتزم العين وليست بواجبة.
وقال آخر: يا رب بكر بالردافي واسج اضطره الليل إلى عواسج عواسج كالعجز النواسج التزم الواو والسين وليست واحدة منهما بلازمة.
وقال آخر: أعيني ساء الله من كان سره بكاؤكما ومن يحب أذاكما ولو أن منظوراً وحبة أسلما لنزع القذى لم يبرئا لي قذاكما التزم الذال والكاف.
وقالوا: حبة امرأة هويها رجل من الجن يقال له منظور وكانت حبة لتطبب بما يعلمها منظور.
هل تعرف الدار بنعف الجرعاء بين رحا المثل وبين الميثاء كأنها باقي كتاب الإملاء غيرها بعدي مر الأنواء نوء الثريا أو ذراع الجوزاء قد أغتدى والطير فوق الأصواء مرتبئات فوق أعلى العلياء بمكرب الخلق سليم الأنقاء طرف تنقيناه خير الأفلاء لأمهاتٍ نسبت وآباء ثمت قاظ مرفها في إدناء مداخلاً في طولٍ وأغماء وفي الشعير والقضيم الأجباء وما أراد من ضروب الأشياء دون العيال وصغار الأبناء مقفى على الحي قصير الأظماء أمبسوا فقادوهن نحو الميطاء بمائتين بغلاء الغلاء أوفيته الزرع وفوق الإيفاء قد فزعوا غلمانها بالإيصاء مخافة السبق وجد الأنباء فلحقت أكبادهم بالأحشاء بالت وباتوا كبلايا الأبلاء مطلنفئين عندها كالأطلاء مستويات كنعال الحذاء فهن يعبطن جديد البيداء ما لا يسوى عبطه بالرفاء يتبعن وقعاً عند رجع الأهواء بسلبات كمساحي البناء يتركن في متن أديم الصحراء مساحبا مثل احتفار الكماء وأسهلوهن دقاق البطحاء يثرن من أكدارها بالدقعاء منتصباً مثل حريق القصباء كأنها لما رآها الرآء وأنشزتهن علاة البيداء ورفع اللامع ثوب الإلواء عقبان دجن في ندى وأسداء كل أغر محك وغراء شادخة غرتها أو قرحاء قد لحقت عصمتها بالأطباء من شدة الركض وخلج الأنساء كأنما صوت حفيف المعزاء معزول شذان حصاها الأقصاء صوت نشيش اللحم عند القلاء اطرد جميع قوافيها على جر واضعها إلا بيتاً واحداً وهو قوله: وذلك أن لمَّا مضافة إلى قوله: رآها الرآء والفعل لذلك مجرور الموضع بإضافة الظرف الذي هو لمّا إليه كما أن قول الله تعالى: {إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} الفعل الذي هو جاءَ في موضع جر بإضافة الظرف الذي هو إذا إليه.
وإذا كان كذلك وكان صاحب الجملة التي هي الفعل والفاعل إنما هو الفاعل وإنما جيء بالفعل له ومن أجله وكان أشرف جزءيها وأنبههما صارت الإضافة كأنها إليه فكأن الفاعل لذلك في موضع جر لا سيما وأنت لو لخصت الإضافة هنا وشرحتها لكان تقديرها: كأنها وقت رؤية الرآء لها.
فالرآء إذاً مع الشرح مجرور لا محالة.
نعم وقد ثبت أن الفعل مع الفاعل في كثير من الأحكام والأماكن كالشيء الواحد.
وإذا كان الفعل مجرور الموضع والفاعل معه كالجزء منه دخل الفاعل منه في اعتقاد تلخيصه مجروراً في اللفظ موضعه كما أن النون من إذن لما كانت بعض حرف جرى عليها ما يجري على الحرف المفرد من إبداله في الوقف ألفاً وذلك قولهم: لأقومن إذاً كما تقول: ضربت زيداً ومع النون الخفيفة للواحد: اضرباً.
فكما أجريت على بعض الحرف ما يجري على جميعه من القلب كذلك أجريت على بعض الفعل وهو الفاعل ما يجري على جميعه من الحكم.
ومما أجرى فيه بعض الحرف مجرى جميعه قوله: فبات متصباً وما تكردسا فأجرى منتصباً مجرى فخذ فأسكن ثانيه وعليه حكاية الكتاب: أراك منتفخاً.
ونحو من قوله: لما رآها الرآء في توهم جر الفاعل قول طرفة: وسديف حين هاج الصنبر كأنه أراد: الصنيبر ثم تصور معنى الإضافة فصار إلى أنه كأنه قال: حين هيج الصنبر ثم نقل الكسرة على حد مررت ببكر وأجرى صنَبِر من الصنّبر مجرى بكر على قوله: أراك منتفخاً.
وأعلى من هذا أن مجيء هذا البيت في هذه القصيدة مخالفاً لجميع أبياتها يدل على قوة شاعرها وشرف صناعته وأن ما وجد من تتالي قوافيها على جر مواضعها ليس شيئاً سعى فيه ولا أكره طبعه عليه وإنما هو مذهب قاده إليه علو طبقته وجوهر فصاحته.
وعلى ذلك ما أنشدناه أبو بكر محمد بن علي عن أبي إسحاق لعبيد من قوله: يا خليلي أربعاً واستخبرا ال منزل الدارس من أهل الحلال مثل سحق البرد عفى بعدك ال قطر مغناه وتأويب الشمال ولقد يغنى به جيرانك ال ممسكو منك بأسباب الوصال ثم أودى ودهم إذ أزمعوا ال بين والأيام حال بعد حال نحن قدنا من أهاضيب الملاال خيل في الأرسان أمثال السعالى شزبا يعسفن من مجهولة ال أرض وعثاً من سهول أو رمال فانتجعنا الحارث الأعرج في جحفل كالليل خطار العوالي يوم غادرنا عدياً بالقنا الن بل السمر صريعاً في المجال ثم عجناهن خوصاً كالقطا ال قاربات الماء من أين الكلال نحو قوص يوم جالت حوله ال خيل قباً عن يمين أو شمال كم رئيس يقدم الألف على السابح الأجرد ذي العقب الطوال قد أباحت جمعه أسيافنا ال بيض في البروعة من حي حلال ولنا دار ورثناها عن ال أقدم القدموس من ع وخال منزل دمنه آباؤنا ال مورثونا المجد في أولى الليالي ما لنا فيها حصون غير ما ال مقربات الخيل تعدو بالرجال في روابي عدملى شامخ ال أنف فيه إرث مجد وجمال فانتجعنا الحارث الأعرج في فصار هذا البيت الذي نقض القصيدة أن تمضى على ترتيب واحد هو أفخر ما فيها.
وذلك أنه دل على أن هذا الشاعر إنما تساند إلى ما في طبعه ولم يتجشم إلا ما في نهضته ووسعه من غير اغتصاب له ولا استكراه أجاءه إليه إذ لو كان ذلك على خلاف ما حددناه وأنه إنما صنع الشعر صنعاً وقابله بها ترتيباً ووضعاً لكان قمنا ألا ينقض ذلك كله بيت واحد يوهيه ويقدح فيه.
وهذا واضح.
وأما قول الآخر: قد جعل النعاس يغرنديني أدفعه عني ويسرنديني فلك فيه وجهان: إن شئت جعلت رويه النون وهو الوجه.
وإن شئت الياء وليس بالوجه.
وإن أنت جعلت النون هي الروى فقد التزم الشاعر فيها أربعة أحرف غير واجبة وهي الراء والنون والدال والياء.
ألا ترى أنه يجوز معها يعطيني ويرضيني ويدعوني ويغزوني ألا ترى أنك إذا جعلت الياء هي الروى فقد زالت الياء أن تكون ردفاً لبعدها عن الروى.
نعم وكذلك لما كانت النون روياً كانت الياء غير لازمة.
وإن أنت جعلت الياء الروى فقد التزم فيه خمسة أحرف غير لازمة وهي الراء والنون والدال والياء والنون لأن الواو يجوز معها ألا ترى أنه ومما يسأل عنه من هذا النحو قول الثقفي يزيد بن الحكم: وكم منزل لولاي طحت كما هوى بها بأجرامه من قلة النيق منهو التزم الواو والياء فيها كلها.
والجواب أنها واوية لأمرين: أحدهما أنك إذا جعلتها واوية كانت مطلقة ولو جعلتها يائية كانت مقيدة والشعر المطلق أضعاف المقيد والحمل إنما يجب أن يكون على الأكثر لا على الأقل.
والآخر أنه قد التزم الواو فإن جعلت القصيدة واوية فقد التزم واجباً وإن جعلتها يائية فقد التزم غير واجب واعتبرنا هذه اللغة وأحكامها ومقاييسها فإذا الملتزم أكثره واجب وأقله غير واجب والحمل على الأكثر دون الأقل.
فإن قلت: فإن هذه القلة أفخر من الكثرة ألا ترى أنها دالة على قوة الشاعر.
وإذا كانت أنبه وأشرف كان الآخذ يجب أن يكون بها ولم يحسن العدول عنها مع القدرة عليها.
وكما أن الحمل على الأكثر فكذلك يجب أن يكون الحمل على الأقوى أولى من الحمل على الأدنى.
قيل: كيف تضرفت الحال فينبغي أن يعمل على الأكثر لا على الأقل وإن كان الأقل أقوى قياساً ألا ترى إلى قوة قياس قول بني تميم في " ما " وأنها ينبغي أن تكون غير عاملة في أقوى القياسين عن سيبويه.
ومع ذا فأكثر المسموع عنهم إنما هو لغة أهل الحجاز وبها نزل القرآن.
وذلك أننا بكلامهم ننطق فينبغي أن يكون على ما استكثروا منه يحمل.
هذا هو قياس مذهبهم وطريق اقتفائهم.
ووجدت أكثر قافية رؤبة مجرورة الموضع.
وإذا تأملت ذلك وجدته.
أعني قوله: وقاتم الأعماق خاوي المخترق وقد التزم العجاج في رائيته: قد جبر الدين إلاله فجبر وذلك أنه التزم الفتح قبل رويها البتة.
ولعمري إن هذا مشروط في القوافي غير أنك قلما تجد قافية مقيدة إلا وأتت الحركات قبل رويها مختلفة وإنما المستحسن من هذه الرائية سلامتها مما لا يكاد يسلم منه غيرها.
فإن كانت المقيدة مؤسسة ازداد اختلاف الحركات قبل رويها قبحا.
وذلك أنه ينضاف إلى قبح اختلافه أن هناك تأسيساً ألا ترى أنه يقبح اختلاف الإشباع إذا كان الروى مطلقاً نحو قوله: فالفوارع مع قوله: فالتدافع.
فما ظنك إذا كان الروي مقيداً.
وقد أحكمنا هذا في كتابنا المعرب في شرح قوافي أبي الحسن.
وقد قال هميان بن قحافة: لما رأتني أم عمرو صدفت قد بلغت بي ذرأة فألحفت وهي تسعة وثلاثون بيتاً التزم في جميعها الفاء وليست واجبة وإن كانت قريبةً من صورة الوجوب.
وذلك أن هذه التاء في الفعل إذا صارت إلى الاسم صارت في الوقف هاء في قولك: صادفة وملحفة ومحلنقفة فإذا صارت هاء لم يكن الروي إلا ما قبلها فكأنها لما سقط حكمها مع الاسم من ذلك الفعل صارت في الفعل نفسه قريبة من ذلك الحكم.
وهذا الموضع لقطرب.
وهو جيد.
ومن ذلك تائية كثير: خليلي هذا ربع عزة فاعقلا لزم في جميعها اللام والتاء.
ومنه قول منظور: من لي من هجران ليلى من لي لزم اللام المشدد إلى آخرها.
وفي المحدثين من يسلك هذا الطريق وينبغي أن يكونوا إليه أقرب وبه أحجى إذ كانوا في صنعة الشعر أرحب ذراعاً وأوسع خناقاً لأنهم فيه متأنون وعليه متلومون و ليسوا بمرتجليه ولا مستكرهين فيه.
وقد كان ابن الرومي رام ذلك لسعة حفظه وشدة مأخذه.
فمن ذلك رائيته في وصف العنب وهي قوله: ورازقي مخطف الخصور كأنه مخازن البلور التزم فيها الواو البتة ولم يجاوزها غالباً.
وكذلك تائيته: أترفتها وخطرقتها وسفسفتها التزم فيها الفاء وليست بواجبة وكذلك ميميته التي يرثي بها أمه: أفيضا دَماً إن الرزايا لها قيَم أوجب على نفسه الفتحة قبل الميم على حد رائية العجاج: قد جبر الدين الإله فجبر غير أني أظن أن في هذه الميمية بيتاً ليس من قبل رويه مفتوحاً.
وأنشدني مرة بعض أحداثنا شيئاً سماه شعراً على رسم للمولدين في مثله غير أنه عندي أنا قوافٍ منسوقة غير محشوة في معنى قول سلم الخاسر: موسى القمر غيث بكر ثم انهمر وقول الآخر: قالت حيل شؤم الغزل هذا الرجل حين احتفل أهدى بصل والقوافي المنسوقة التي أنشدنيها صاحبنا هذا ميمية في وزن قوله: طيف ألم لا يحضرني الآن حفظها غير أنه التزم فيها الفتحة البتة إلا قافية واحدة وهو قوله: فاسلم ودم ورأيته قلقاً لاضطراره إلى مخالفة بقية القوافي بها فقلت له: لا عليك فلك أن تقول: فاسلم ودم أمرا من قولهم: دام يدام وهي لغة قال: يا مي لا غرو ولا ملاما في الحب إن الحب لن يداما فسر بذلك وقال: أسير بها إلى بلدي.
وأفضينا إلى هذا القدر لاتصاله با كنا عليه قال: وعند سعيد غير أن لم أبح به ذكرتك إن الأمر يذكر للأمر وأكثر هذه الالتزامات في الشعر لأنه يخطر على نفسه ما تبيحه الصنعة إياه إدلالاً وتغطرفاً واقتداراً وتعالياً.
وهو كثير.
وفيما أوردناه منه كاف.
فأما في غير الشعر فنحو قولك في جواب من سألك فقال لك: أي شيء عندك: زيد أو عمرو أو محمد الكريم أو علي العاقل.
فإنما جوابه الذي لا يقتضي السؤال غيره أن يجيبه بنكرة في غاية شياع مثلها فيقول: جسم.
ألا ترى أنه قد يجوز أن يكون في قوله: أي شيء عندك إنما أراد أن يستفصلك بين أن يكون عندك علم أو قراءة أو جود أو شجاعة وأن يكون عندك جسم ما.
فإذا قلت: جسم فقد فصلت بين أمرين قد كان يجوز أن يريد منك فصلك بينهما.
إلا أن جسماً وإن كان قد فصل بين المعنيين فإنه مبالغ في إبهامه.
فإن تطوعت زيادة على هذا قلت: حيوان.
وذلك أن حيواناً أخص من جسم كما أن جسماً أخض من شيء.
فإن تطوع شيئاً آخر قال في جواب أي شيء عندك: إنسان لأنه أخص من حيوان ألا تراك تقول: كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنساناً كما تقول: كل إنسان جسم وليس كل جسم إنساناً.
فإن تطوع بشيء آخر قال: رجل.
فإن زاد في التطوع شيئاً آخر قال: رجل عاقل أو نحو ذلك.
فإن تطوع شيئاً آخر قال: زيد أو عمرو أو نحو ذلك.
فهذا كله تطوع بما لا يوجبه سؤال هذا السائل.
ومنه قول أبي دواد: فقصرن الشتاء بعد عليه وهو للذود أن يقسمن جار فهذا جواب كم كأنه قال: كم قصرن عليه وكم ظرف ومنصوبة الموضع فكان قياسه أن يقول: ستة أشهر لأن كم سؤال عن قدر من العدد محصور فنكرة هذا كافية من معرفته ألا ترى أن قولك: عشرون والعشرون وعشروك ونحو ذلك فائدته في العدد واحدة لكن المعدود معرفة مرة ونكرة أخرى.
فاستعمل الشتاء وهو معرفة في جواب كم.
وهذا تطوع بما لا يلزم.
وليس عيباً بل هو زائد على المراد.
وإنما العيب أن يقصر في الجواب عن مقتضى السؤال فأما إذا زاد عليه فالفضل معه واليد له.
وجاز أن يكون الشتاء جواباً لكم من حيث كان عددا في المعنى ألا تراه ستة أشهر.
وافقنا أبو علي رحمه الله على هذا الموضع من الكتاب وفسره ونحن بحلب فقال: إلا في هذا البلد فإنه ثماية أشهر.
يريد طول الشتاء بها.
ومن ذلك قولك في جواب من قال لك: الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية: الحسن أو قولك: الحسين.
وهذا تطوع من المجيب بما لا يلزم.
وذلك أن جوابه على ظاهر سؤاله أن يقول له: أحدهما ألا ترى أنه لما قال له: الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية فكأنه قال: أ أحدهما أفضل أم ابن الحنفية فجوابه على ظاهر سؤاله أن يقول: أحدهما.
فقوله: الحسن أو قوله: الحسين فيه زيادة تطوع بها لم ينطو السؤال على استعلامها.
ونظير قوله في الجواب على اللفظ أن يقول: الحسن أو الحسين لأن قوله: أو الحسين بمنزلة أن يقول: أحدهما.
والجواب المتطوع فيه أن يقول: الحسن ويمسك أو أن يقول: الحسين ويمسك.
فأما إن كان كيسانياً فإنه يقول: ابن الحنفية هكذا كما ترى.
فإن قال: الحسن أفضل أم الحسين أو ابن الحنفية فقال: الحسن فهو جواب لا تطوع فيه.
فإن قال: أحدهما فهو جواب لا تطوع فيه أيضاً.
فإن قال: الحسين ففيه تطوع.
وكذلك إن قال: ابن الحنفية فقد تطوع أيضاً.
فإن قال: الحسن أو ابن الحنفية أفضل أم الحسين فقال له المجيب: الحسين فهو جواب لا تطوع فيه.
فإن قال: أحدهما فهو أيضاً جواب لا تطوع فيه.
فإن قال: الحسن أو قال: ابن الحنفية ناصاً على أحدهما معيناً فهو جواب متطوع فيه على ما بينا فيما قبل.
ومن التطوع المشام للتوكيد قول الله سبحانه: {إِلـهَيْنِ اثْنَيْنِ} {وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} وقوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} وقولهم: مضى أمس الدابر وأمس المدبر.
وهو كثير.
وأنشد الأصمعي: وأبي الذي ترك الملوك وجمعهم بصهاب هامدةً كأمس الدابر وقال: خبلت غزالة قلبه بفوارسٍ تركت منازله كأمس الدابر ومن ذلك أيضاً الحال المؤكدة كقوله: كفى بالنأى من أسماء كاف لأنه إذا كفى فهو كاف لا محالة.
ومنه قولهم: أخذته بدرهم فصاعداً هذه أيضاً حال مؤكدة ألا ترى أن تقديره: فزاد الثمن صاعداً ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعداً.
غير أن للحال هنا مزية عليها في قوله: كفى بالنأي من أسماء كاف لأن صاعدا ناب في اللفظ عن الفعل الذي هو زاد وكاف ليس بنائب في اللفظ عن شيء ألا ترى أن الفعل الناصب له ملفوظ به معه.
ومن الحال المؤكدة قول الله تعالى: {ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ} وقول ابن دارة: أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي وهو باب منقاد.
فأما قوله سبحانه: {وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} فيكون من هذا.
وقد يجوز أن يكون قوله سبحانه {بِجَنَاحَيْهِ} مفيداً.
وذلك أنه قد يقال في المثل: طاروا علاهن فشل علاها وقال آخر: وطرت بالرحل إلى شملة إلى أمون رحلةٍ فذلت ومن أبيات الكتاب: وقال القطامي: ونفخوا عن مدائنهم فطاروا وقال العجاج: طرنا إلى كل طوال أعوجا وقال العنبري: طاروا إليه زرافاتٍ وأحدانا وقال النابغة الذبياني: يطير فضاضاً بينها كل قونسٍ فيكون قوله تعالى: {يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} على هذا مفيداً أي ليس الغرض تشبيهه بالطائر ذي الجناحين بل هو الطائر بجناحيه البتة.
وكذلك قوله عز اسمه: {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ} قد يكون قوله من فوقعهم مفيداً.
وذلك أنه قد يستعمل في الأفعال الشاقة المستثقلة على قول من يقول: قد سرنا عشراً وبقيت علينا ليلتان وقد حفظت القرآن وبقيت علي منه سورتان وقد صمنا عشرين من الشهر وبقي علينا عشر.
وكذلك يقال في الاعتداد على الإنسان بذنوبه وقبيح أفعاله: قد أخرب علي ضيعتي وموت علي عواملي وأبطل علي انتفاعي.
فعلى هذا لو قيل: فخر عليهم السقف ولم يقل: من فوقهم لجاز أن يظن به أنه كقولك: قد خربت عليهم دارهم وقد أهلكت عليهم مواشيهم وغلاتهم وقد تلفت عليهم تجاراتهم.
فإذا قال: من فوقهم زال ذلك المعنى المحتمل وصار معناه أنه سقط وهم من تحته.
فهذا معنى غير الأول.
وإنما اطردت على في الأفعال التي قدمنا ذكرها مثل خربت عليه ضيعته وموتت عليه عوامله ونحو ذلك من حيث كانت على في الأصل للاستعلاء.
فلما كانت هذه الأحوال كلفاً ومشاق تخفض الإنسان وتضعه و تعلوه وتفرعه حتى يخضع لها ويخنع لما يتسداه منها كان ذلك من مواضع على ألا تراهم يقولون: هذا لك وهذا عليك فتستعمل اللام فيما تؤثره وعلى فيما تكرهه قالت: سأحمل نفسي على آلة فإما عليها وإما لها وقال ابن حلزة: فله هنا لك لا عليه إذا دنعت أنوف القوم للتعس فمن هنا دخلت على هذه في هذه الأفعال التي معناها إلى الإخضاع والإذلال.
وما يتطوع به من غير وجوب كثير.
وفيما مضى منه كاف ودال عليه بإذن الله.
باب في التام يزاد عليه فيعود ناقصا
هذا موضع ظاهره ظاهر التناقض ومحصوله صحيح واضح.
وذلك قولك: قام زيد فهذا كلام تام فإن زدت عليه فقلت: إن قام زيد صار شرطاً واحتاج إلى جواب.
وكذلك قولك: زيد منطلق فهذا كلام مستقل فإذا زاد عليه أن المفتوحة فقال أن زيداً منطلق احتاج إلى عامل يعمل في أن وصلتها فقال: بلغني أن زيداً منطلق ونحوه.
وكذلك قولك: زيد أخوك فإن زدت عليه أعلمت لم تكتف بالاسمين فقلت: أعلمت بكراً زيداً أخاك.
وجماع هذا أن كل كلام مستقل زدت عليه شيئاً غير معقود بغيره ولا مقتض أسواه فالكلام باق على تمامه قبل المزيد عليه.
فإن زدت عليه شيئاً مقتضياً لغيره معقوداً به عاد الكلام ناقصاً لا لحاله الأولى بل لما دخل عليه معقوداً بغيره.
فنظير الأول قولك: زيد قائم وما زيد قائم وقائماً على اللغتين وقولك: قام محمد وقد قام محمد وما قام محمد وهل قام محمد وزيد أخوك وإن زيداً أخوك وكان زيد أخاك ونظير الثاني ما تقدم من قولنا: قام زيد وإن قام زيد.
فإن جعلت إن هنا نفياً بقي على تمامه ألا تراه بمعنى ما قام زيد.
ومن الزائد العائد بالتمام إلى النقصان قولك: يقوم زيد فإن زدت اللام والنون فقلت: ليقومن زيد فهو محتاج إلى غيره وإن لم يظهر هنا في اللفظ ألا ترى أن تقديره عند الخليل أنه جواب قسم أي أقسم ليقومن أو نحو ذلك.
فاعرف ذلك إلى ما يليه.
باب في زيادة الحروف وحذفها
وكلا ذينك ليس بقياس لما سنذكره.
أخبرنا أبو علي رحمه الله قال قال أبو بكر: حذف الحروف ليس بالقياس.
قال: وذلك أن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصراً لها هي أيضاً واختصار المختصر إجحاف به.
تمت الحكاية.
تفسير قوله: إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار هو أنك إذا قلت: ما قام زيد فقد أغنت " ما " عن " أنفى " وهي جملة فعل وفاعل.
وإذا قلت: قام القوم إلا زيداً فقد نابت " إلا " عن " أستثنى " وهي فعل وفاعل.
وإذا قلت قام زيد وعمرو فقد نابت الواو عن أعطف.
وإذا قلت: ليت لي مالاً فقد نابت ليت عن أتمنى.
وإذا قلت: هل قام أخوك فقد نابت " هل " عن أستفهم.
وإذا قلت: ليس زيد بقائم فقد نابت الباء عن حقاً والبتة وغير ذي شك.
وإذا قلت فيما نقضهم ميثاقهم فكأنك قلت: فبنقضهم ميثاقهم فكأنك قلت: فبنقضهم ميثاقهم فعلنا كذا حقاً أو يقينا.
وإذا قلت: أمسكت بالحبل فقد نابت الباء عن قولك: أمسكته مباشرا له وملاصقة يدي له.
وإذا قلت: أكلت من الطعام فقد نابت " من " عن البعض أكلت بعض الطعام.
وكذلك بقية ما لم نسمه.
فإذا كانت هذه الحروف نوائب عما هو أكثر منها من الجمل وغيرها لم يجز من بعد ذا أن تتخرق عليها فتنتهكها وتجحف بها.
ولأجل ما ذكرنا: من إرادة الاختصار بها لم يجز أن تعمل في شيء من الفضلات: الظرف والحال والتمييز والاستثناء وغير ذلك.
وعلته أنهم قد أنابوها عن الكلام الطويل لضرب من الاختصار فلو ذهبوا يعملونها فيما بعد لنقضوا ما أجمعوه وتراجعوا عما اعتزموه.
فلهذا لا يجوز ما زيد أخوك قائماً حالاً منك أي أنفى هذا في حال قيامي ولا حالا من زيد أي أنفى هذا عن زيد في حال قيامه.
ولا هل زيد أخوك يوم الجمعة على أن تجعل يوم الجمعة ظرفاً لما دلت عليه هل من معنى الاستفهام.
فإن قلت: فقد أجازوا ليت زيداً أخوك قائماً ونحو ذلك فنصبوه بما في ليت من معنى التمني وقال النابغة: كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد فنصب خارجاً على الحال بما في كأن من معنى التشبيه وأنشد أبو زيد: فأعمل معنى التشبيه في كأن في الظرف الزماني الذي هو لما التقينا.
قيل: إنما جاز ذلك في " ليت " و " كأن " لما اجتمع فيهما: وهو أن كل واحدة منهما فيها معنى الفعل من التمني والتشبيه وأيضاً فكل واحدة منهما رافعة وناصبة كالفعل القوي المتعدي وكل واحدة منهما متجاوزة عدد الاثنين فأشبهت بزيادة عدتها الفعل وليس كذلك ما كان على حرف ولا ما كان على حرفين لأنه لم يجتمع فيه ما اجتمع في ليت ولعل.
ولهذا كان ما ذهب إليه أبو العباس: من أن إلا في الاستثناء هي الناصبة لأنها نابت عن أستثنى ولا أعني مردوداً عندنا لما في ذلك من تدافع الأمرين: الإعمال المبقى حكم الفعل والانصراف عنه إلى الحرف المختصر به القول.
نعم وإذا كانت هذه الحروف تضعف وتقل عن العمل في الظروف كانت من العمل في الأسماء الصريحة القوية التي ليست ظروفا ولا أحوالا ولا تمييزا لاحقاً بالحال اللاحقة بالظروف أبعد.
فإن قلت: فقد قالوا: يا عبد الله ويا خيرا من زيد فأعملوا يا في الاسم الصريح وهي حرف فكيف القول في ذلك قيل: ليا في هذه خاصة في قيامها مقام الفعل ليست لسائر الحروف.
وذلك أن هل تنوب عن أستفهم وما تنوب عن أنفى وإلا تنوب عن أستثنى وتلك الأفعال النائبة عنها هذه الحروف هي الناصبة في الأصل.
فلما انصرفت عنها إلى الحروف طلباً للإيجاز ورغبة عن الإكثار أسقطت عمل تلك الأفعال ليتم لك ما انتحيته من الاختصار.
وليس كذلك يا.
وذلك أن يا نفسها هي العامل الواقع على زيد وحالها في ذلك حال أدعو وأنادي في كون كل واحد منهما هو العامل في المفعول وليس كذلك ضربت وقتلت ونحوه.
وذلك أن قولك: ضربت زيداً وقلت عمرا الفعل الواصل إليهما المعبر بقولك: ضربت عنه ليس هو نفس " ض ر ب " إنما ثم أحدث هذه الحروف دلالة عليها وكذلك القتل والشتم والإكرام ونحو ذلك.
وقولك: أنادي عبد الله وأدعو عبد الله ليس هنا فعل واقع على عبد الله غير هذا اللفظ و " يا " نفسها في المعنى كأدعو ألا ترى أنك إنما تذكر بعد يا اسماً واحداً كما تذكره بعد الفعل المستقل بفاعله إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد كضربت زيداً ولقيت قاسماً وليس كذلك حرف الاستفهام وحرف النفي إنما تدخلهما على الجمل المستقلة فتقول: ما قام زيد وهل قام أخوك.
فلما قويت " يا " في نفسها وأوغلت في شبه الفعل تولت بنفسها العمل.
فإن قلت: فإنما تذكر بعد إلا اسماً واحداً أيضاً قيل: الجملة قبل إلا منعقدة بنفسها وإلا فضلة فيها.
وليس كذلك يا لأنك إذا قلت: يا عبد الله تم الكلام بها وبمنصوب بعدها فوجب أن تكون هي كأنها الفعل المستقل بفاعله والمنصوب هو المفعول بعدها فهي في هذا الوجه كرويد ومن وجه آخر أن قولك: يا زيد لما اطرد فيه الضم وتم به القول جرى مجرى ما ارتفع بفعله أو بالابتداء فهذا أدون حالي يا أعنى أن يكون كأحد جزأي الجملة.
وفي القول الأول هي جارية مجرى الفعل مع فاعله.
فلهذا قوى حكمها وتجاوزت رتبة الحروف التي إنما هي ألحاق وزوائد على الجمل.
فلذلك عملت يا ولم تعمل هل ولا ما ولا شيء من ذلك النصب بمعنى الفعل الذي دلت عليه ونابت عنه.
ولذلك ما وصلت تارة بنفسها في قولك: يا عبد الله وأخرى بحرف الجر نحو قوله: يا لبكر فجرت في ذلك مجرى ما يصل من الفعل تارة بنفسه وأخرى بحرف الجر نحو قوله: خشنت صدره وبصدره وجئت زيداً وجئت إليه واخترت الرجال ومن الرجال وسميته زيداً وبزيد وكنيته أبا علي وبأبي علي.
فإن قلت: فقد قال الله سبحانه { ألا يا اسجدوا } وقد قال غيلان: ألا يا أسلمي يا دارمي على البلى وقال: يا دار هند يا أسلمي ثم أسلمي فجاء بيا ولا منادى معها قيل: يا في هذه الأماكن قد جردت من معنى النداء وخلصت تنبيهاً.
ونظيرها في الخلع من أحد المعنيين وإفراد الآخر: ألا لها في الكلام معنيان: افتتاح الكلام والتنبيه نحو قول الله سبحانه: {أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ} وقوله تعالى: {أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} وقول كثير: ألا إنما ليلى عصا خيزرانة فإذا دخلت على " يا " خلصت " ألا " افتتاحاً وخص التنبيه بيا.
وذلك كقول نصيب: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد فقد زادني مسراك وجدا على وجد فقد صح بما ذكرناه إلى أن قادنا إلى هنا أن حذف الحروف لا يسوغه القياس لما فيه من الانتهاك والإجحاف.
وأما زيادتها فخارج عن القياس أيضاً.
وذلك أنه إذا كانت إنما جيء بها اختصاراً وإيجازاً كانت زيادتها نقضا لهذا الأمر وأخذا له بالعكس والقلب ألا ترى أن الإيجاز ضد الإسهاب ولذلك لم يجز أبو الحسن توكيد الهاء المحذوفة من صلة الذي في نحو الذي ضربت زيد فأفسد أن تقول: الذي ضربت نفسه زيد.
قال: لأن ذلك نقض من حيث كان التوكيد إسهاباً الحذف إيجازاً.
وذلك أمر ظاهر التدافع.
هذا هو القياس: ألا يجوز حذف الحروف ولا زيادتها.
ومع ذلك فقد حذفت تارة وزيدت أما حذفها فكنحو ما حكاه أبو عثمان عن أبي زيد من حذف حرف العطف في نحو قولهم: أكلت لحماً سمكاً تمراً.
وأنشدني أبو الحسن: كيف أصبحت كيف أمسيت مما يزرع الود في فؤاد الكريم يريد: كيف أصبحت وكيف أمسيت.
وأنشد ابن الأعرابي: وكيف لا أبكي على علاتي صبائحي غبائقي قيلاتي أي صبائحي وغبائقي وقيلاتي.
وقد يجوز أن يكون بدلاً أي كيف لا أبكي على علاتي التي هي صبائحي وهي غبائقي وهي قيلاتي فيكون هذا من بدل الكل.
والمعنى الأول أن منها صبائحي ومنها غبائقي ومنها قيلاتي.
ومن ذلك ما كان يعتاده رؤبة إذا قيل له: كيف أصبحت فيقول: خير عافاك أي بخير وحكى سيبويه: الله لا أفعل يريد والله.
ومن أبيات الكتاب: من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان أي فالله يشكرها.
وحذفت همزة الاستفهام نحو قوله: فأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر أتوني وقالوا: من ربيعة أو مضر طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب أراد: أو ذو الشيب يلعب.
ومنه قول ابن أبي ربيعة: ثم قالوا تحبها قلت بهراً عدد القطر والحصى والتراب أظهر الأمرين فيه أن يكون أراد: أتحبها لأن البيت الذي قبله يدل عليه وهو قوله: أبرزوها مثل المهاة تهادى بين خمس كواعب أتراب ولهذا ونحوه نظائر.
وقد كثرت.
فأما تكريرها وزيادتها فكقوله: لددتهم النصيحة كل لد فمجوا النصح ثم ثنوا فقاءوا فلا والله لا يلفي لما بي ولا للمابهم أبدا دواء وقد كثرت زيادة ما توكيدا كقول الله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ} وقوله سبحانه {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} وقوله عز قدره {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا}.
وقال جل وعز: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فالباء زائدة وأنشد أبو زيد: بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فقيهم غني مضر فزاد الباء في المبتدأ.
وأنشد لأمية: فإن لتوكيد النفي كقول زهير: ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم ولا من بعدها زائدة.
وزيدت اللام في قوله رويناه عن أحمد بن يحيى: مروا عجالاً وقالوا كيف صاحبكم قال الذي سألوا أمسى لمجهودا وفي قراءة سعيد بن جبير {وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ} وقد تقدم ذكر ذلك.
وزيدت لا قال أبو النجم: ولا ألوم البيض ألا تسخرا وقد رأين الشمط القفندرا وقال العجاج: بغير لا عصفٍ لا اصطراف وأنشدنا: أبي جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله فهذا على زيادة لا أي أبي جوده البخل.
وقد يجوز أن تكون لا منصوبة الموضع بأبي والبخل وزيادة الحروف كثير وإن كانت على غير قياس كما أن حذف المضاف أوسع وأفشى وأعم وأوفى وإن كان أبو الحسن قد نص على ترك القياس عليه.
فأما عذر حذف هذه الحروف فلقوة المعرفة بالموضع ألا ترى إلى قول امرئ القيس: فقلت: يمين الله أبرح قاعدا لأنه لو أراد الواجب لما جاز لأن أبرح هذه لا تستعمل في الواجب فلا بد من أن يكون أراد: لا أبرح.
ويكفي من هذا قولهم: رب إشارة أبلغ من عبارة.
وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها.
وذلك أنه قد سبق أن الغرض في استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصار والاكتفاء من الأفعال وفاعليها فإذا زيد ما هذه سبيله فهو تناه في التوكيد به.
وذلك كابتذالك في ضيافة ضيفك أعز ما تقدر عليه وتصونه من أسبابك فذاك غاية إكرامك له وتناهيك في الحفل به.
باب في زيادة الحرف عوضاً من آخر محذوف
اعلم أن الحرف الذي يحذف فيجاء بآخر عوضاً منه على ضربين: أحدهما أصلى والآخر زائد.
الأول من ذلك على ثلاثة أضرب: فاء عين لام.
أما ما حذفت فاؤه وجيء بزائد عوضا منه فباب فعله في المصادر نحو عدة وزنة وشية وجهة.
والأصل وعدة ووزنة ووشية ووجهة فحذفت الفاء لما ذكر في تصريف ذلك وجعلت التاء بدلاً من الفاء.
ويدل على أن أصله ذلك قول الله سبحانه: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} وأنشد أبو زيد: ألم تر أنني ولكل شيء إذا لم تؤت وجهته تعاد أطعت الآمري بصرم ليلى ولم أسمع بها قول الأعادي وقد حذفت الفاء في أناس وجعلت ألف فعال بدلاً منها فقيل ناس ومثالها عال كما أن مثال عدة وزنة علة.
وقد حذفت الفاء وجعلت تاء افتعل عوضاً منها وذلك قولهم: تقي يقتي والأصل اتقى يتقي فحذفت التاء فبقي تقي ومثاله تعل ويتقي: يتعل قال الشاعر: جلاها الصيقلون فأخلصوها خفافاً كلها يتقي بأثر وقال أوس: زيادتنا نعمان لا تنسينها تق الله فينا والكتاب الذي تتلو ومنه أيضاً قولهم تجه يتجه وأصله اتجه ومثال تجه على هذا تعل كتقى سواء.
وروى أبو زيد أيضاً فيما حدثنا به أبو علي عنه: تجه يتجه فهذا من لفظ آخر وفاؤه تاء.
وأنشدنا: قصرت له القبيلة اذتجهنا وما ضاقت بشدته ذراعي فهذا محذوف من اتجه كاتقى.
فأما قولهم: اتخذت فليست تاؤه بدلاً من شيء بل هي فاء أصلية بمنزلة اتبعت من تبع.
يدل على ذلك ما أنشده الأصمعي من قوله: وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيفاً كأفحوص القطاة المطرق وعليه قول الله سبحانه {قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} وذهب أبو إسحاق إلى أن اتخذت كاتقيت واتزنت وأن الهمزة أجريت في ذلك مجرى الواو.
وهذا ضعيف إنما جاء منه شيء في داره تقسم الأزواد بينهم كأنما أهله منها الذي اتهلا وروى لها أبو علي عن أبي الحسن علي بن سليمان متمن.
وأنشد: .
.
.
.
.
.
.
.
.
بيض اتمن والذي يقطع على أبي إسحاق قول الله عز وجل {قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}.
فكما أن تجه ليس من لفظ الوجه كذلك ليس تخذ من لفظ الأخذ.
وعذر من قال: اتمن واتهل من الأهل أن لفظ هذا إذا لم يدغم يصير إلى صورة ما أصله حرف لين.
وذلك قولهم في افتعل من الأكل: ايتكل ومن الإزرة: ايتزر.
فأشبه حينئذ ايتعد في لغة من لم يبدل الفاء تاء فقال: اتهل واتمن لقول غيره: ايتهل وايتمن.
وأجود اللغتين إقرار الهمز قال الأعشى: أبا ثبيتٍ أما تنفك تأتكل وكذلك ايتزر يأتزر.
فأما اتكلت عليه فمن الواو على الباب لقولهم الوكالة والوكيل.
وقد ذكرنا هذا الموضع في كتابنا في شرح تصريف أبي عثمان.
وقد حذفت الفاء همزة وجعلت ألف فعال بدلاً منها وذلك قوله.
وأما ما حذفت عينه وزيد هنا حرف عوضاً منها فأينق في أحد قولي سيبويه.
وذلك أن أصلها أنوق فأحد قوليه فيها أن الواو التي هي عين حذفت وعوضت منها ياء فصارت: أنيق.
ومثالها في هذا القول على اللفظ: أيفُل.
والآخر أن العين قدمت على الفاء فأبدلت ياء.
ومثالها على هذا أغفُل.
وقد حذفت العين حرف علة وجعلت ألف فاعل عوضاً منها.
وذلك رجل خاف ورجل مالٌ ورجل هاعٌ لاعٌ.
فجوز أن يكون هذا فعلاً كفرق فهو فرق وبطر فهو بطر.
ويجوز أن يكون فاعلاً حذفت عينه وصارت ألفه عوضاً منها كقوله: لاثٌ به الأشاء والعبرى ومما حذفت عينه وصار الزائد عوضاً منها قولهم: سيد وميت وهين ولين قال: هيْنون لينون أيسار دوو يسرٍ سواس مكرمةٍ أبناءُ أيسار وأصلها فيعِل: سيد وميت وهين ولين حذفت عينها وجعلت ياء فيعِل عوضاً منها.
وكذلك باب قيدودة وصيرورة وكينونة وأصلها فيعلولة حذفت عينها وصارت ياء فيعلولة الزائدة عوضاً منها.
فإن قلت: فهلا كانت لام فيعلولة الزائدة عوضاً منها قيل قد صح في فيعل من نحو سيد وبابه أن الياء الزائدة عوض من العين وكذلك الألف الزائدة في خاف وهاع لاع عوض من العين.
وجوز سيبويه أيضاً ذلك في أينق فكذلك أيضاً ينبغي أن تحمل فيعلولة على ذلك.
وأيضاً فإن الياء أشبه بالواو من الحرف الصحيح في باب قيدودة وكينونة.
وأيضاً فقد جعلت تاء التفعيل عوضاً من عين الفعال.
وذلك قولهم: قطعته تقطيعاً: وكسرته تكسيراً ألا ترى أن الأصل قطاع وكسار بدلالة قول الله سبحانه: {وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا} وحكى الفراء قال: سالين أعرابي فقال: أحلاق أحب إليك أم قصار فكما أن التاء الزائدة في التفعيل عوض من العين فكذلك ينبغي أن تكون الياء في قيدودة عوضاً من العين لا الدال.
فإن قلت: فإن اللام أشبه بالعين من الزائد فهلا كانت لام القيدودة عوضاً من عينها قيل: إن الحرف الأصلي القوي إذا حذف لحق بالمعتل الضعيف فساغ لذلك أن ينوب عنه الزائد الضعيف.
وأيضاً فقد رأيت كيف كانت تاء التفعيل الزائدة عوضاً من عينه وكذلك ألف فاعل كيف كانت عوضاً من عينه في خاف وهاع ولاع ونحوه.
وأيضاً فإن عين قيدودة وبابها وإن كانت أصلاً فإنها على الأحوال كلها حرف علة ما دامت موجودة ملفوظاً بها فكيف بها إذا حذفت فإنها حينئذ توغل في الاعتلال والضعف.
ولو لم يعلم تمكن هذه الحروف في الضعف إلا بتسميتهم إياها حروف العلة لكان كافياً.
وذلك أنها في أقوى أحوالها ضعيفة ألا ترى أن هذين الحرفين إذا قويا بالحركة فإنك حينئذ مع ذلك مؤنس فيهما ضعفاً.
وذلك أن تحملهما للحركة أشق منه في غيرهما.
ولم يكونا كذلك إلا لأن مبنى أمرهما على خلاف القوة.
يؤكد ذلك عندك أن أذهب الثلاث في الضعف والاعتلال الألف.
ولما كانت كذلك لم يمكن تحريكها البتة.
فهذا أقوى دليل على أن الحركة إنما يحملها ويسوغ فيها من الحروف الأقوى لا الأضعف.
ولذلك ما تجد أخف الحركات الثلاث وهي الفتحة مستثقلة فيهما حتى يجنح لذلك ويستروح إلى إسكانها نحو قوله: يا دار هند عفت إلا أثافيها وقوله: كأن أيديهن بالقاع القرق ونحو من ذلك قوله: وأن يعرين إن كسى الجواري فتنبو العين عن كرم عجاف نعم وإذا كان الحرف لا يتحامل بنفسه حتى يدعو إلى اخترامه وحذفه كان بأن يضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليه فيه أحرى وأحجى.
وذلك نحو قول الله تعالى {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} و {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ} و {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} وقوله: وقال الأسود بن يعفر: فألحقت أخراهم طريق ألاهم يريد أولاهم و {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} و {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} كتبت في المصحف بلا واو للوقف عليها كذلك.
وقد حذفت الألف في نحو ذلك قال رؤبة: وصاني العجاج فيما وصني يريد: فيما وصاني.
وذهب أبو عثمان في قول الله عز اسمه: يا أبت إلى أنه أراد يا أبتاه وحذف الألف.
ومن أبيات الكتاب قول لبيد: رهط مرجوم ورهط ابن المعل يريد المعلى.
وحكى أبو عبيدة وأبو الحسن وقطرب وغيرهم رأيت فرج ونحو ذلك.
فإذا كانت هذه الحروف تتساقط وتهي عن حفظ أنفسها وتحمل خواصها وعواني ذواتها فكيف بها إذا جشمت احتمال الحركات النيفات على مقصور صورها.
نعم وقد أعرب بهذه الصور أنفسها كما يعرب بالحركات التي هي أبعاضها.
وذلك في باب أخوك وأبوك وهناك وفاك وحميك وهنيك والزيدان والزيدون والزيدين.
وأجريت هذه الحروف مجرى الحركات في زيد وزيدا وزيدٍ ومعلوم أن الحركات لا تحمل لضعفها الحركات.
فأقرب ويؤكد عندك ضعف هذه الأحرف الثلاثة أنه إذا وجدت أقواهن وهما الواو والياء مفتوحاً ما قبلها فإنهما كأنهما تابعان لما هو منهما ألا ترى إلى ما جاء عنهم من نحو نوبة ونوب وجوبة وجوب ودولة ودول.
فمجيء فَعْلة على فُعَل يريك أنها كأنها إنما جاءت عندهم من فُعْلة فكأن دَولة دُولة وجَوْبة جُوبة ونَوبة نُوبة.
وإنما ذلك لأن الواو مما سبيله أن يأتي تابعاً للضمة.
وكذلك ما جاء من فَعلة مما عينه ياء على فِعَل نحو ضَيْعة وضِيع وخيمة وخيم وعَيبة وعِيب كأنه إنما جاء على أن واحدته فِعلة نحو ضِيعة وخِيمة وعِيبة.
أفلا تراهما مفتوحاً ما قبلهما مجراتين مجراهما مكسوراً ومضموماً ما قبلهما فهل هذا إلا لأن الصنعة مقتضية لشياع الاعتلال فيهما.
فإن قلت: ما أنكرت ألا يكون ما جاء من نحو فَعْلة على فُعَل نحو نُوب وجُوَب ودُول لما ذكرته من تصور الضمة في الفاء ولا يكون ما جاء من فَعلة على فِعَل نحو ضِيع وخِيم وعِيب لما ذكرته من تصور الكسرة في الفاء بل لأن ذلك ضرب من التكسير ركبوه فيما عينه معتلة كما ركبوه فيما عينه صحيحة نحو لأمةٍ ولُؤَم وعَرْصة وعُرَص وقَرْية وقُرَّى وبروة وبُرا فيما ذكره أبو علي ونَزْوة ونُزِّا فيما ذكره أبو العباس وحَلْفة وحِلَق وفَلْكة وفَلك قيل: كيف تصرفت الحال فلا اعتراض شك في أن الياء والواو أين وقعتا وكيف تصرفتا معتدتان حرفي علة ومن أحكام الاعتلال أن يتبعا ما هو منهما.
هذا ثم إنا رأيناهم قد كسروا فَعْلة مما هما عيناه على فُعَل وفِعَل نحو جُوَب ونُوَب وضِيَع وخِيَم فجاء تكسيرهما تكسير ما واحدة مضموم الفاء ومكسورها.
فنحن الآن بين أمرين: إما أن نرتاح لذلك ونعلله وإما أن نتهالك فيه ونتقبله غُفْل الحال ساذَجاً من الاعتلال.
فإن يقال: إن ذلك لما ذكرناه من اقتضاء الصورة فيهما أن يكونا في الحكم تابعين لما قبلهما أولى من أن ننقض الباب فيه ونعطي اليد عنوة به من غير نظر له ولا اشتمال من الصنعة عليه ألا ترى إلى قوله: وليس شيء مما يضطرون إليه إلا هم يحاولون له وجها.
فإذا لم يخل مع الضرورة من وجه من القياس محاول فهم لذلك مع الفسحة في حال السعة أولى بأن يحاولوه وأحجى بأن يناهدوه فيتعللوا به ولا يهملوه.
فإذا ثبت ذلك في باب ما عينه ياء أو واو جعلته الأصل في ذلك وجعلت ما عينه صحيحة فرعاً له ومحمولاً عليه نحو حِلَقٍ وفِلكٍ وعُرَص ولُؤَم وقرى وبرا كما أنهم لما أعربوا بالواو والياء والألف في الزيدون والزيدين والزيدان تجاوزوا ذلك إلى أن أعربوا بما ليس ذلك إلى أن أعربوا بما ليس من حروف اللين.
وهو النون في يقومان وتقعدين وتذهبون.
فهذا جنس من تدريج اللفة الذي تقدم بابه فيما مضى من كتابنا هذا.
وأما ما حذفت لامه وصار الزائد عوضاً منها فكثير.
منه باب سنة ومائة ورئة وفئة وعضة وضعة.
فهذا ونحوه مما حذفت لامه وعوض منها تاء التأنيث ألا تراها كيف تعاقب اللام في نحو برة وبرا وثبة وثبا.
وحكى أبو الحسن عنهم: رأيت مِئْيا بوزن مِعْياً.
فلما حذفوا قالوا: مائة.
فأما بنت وأخت فالتاء عندنا بدل من لام الفعل وليست عوضاً.
وأما ما حذف فالتاء عندنا بدل من لام الفعل وليست عوضاً.
وأما ما حذف لالتقاء الساكنين من هذا النحو فليس الساكن الثاني عندنا بدلا ولا عوضاً لأنه ليس لازماً.
وذلك نحو هذه عصاً ورحاً وكلمت معلى فليس التنوين في الوصل ولا الألف التي هي بدل منها في الوقف نحو رأيت عصاً عند الجماعة وهذه عصا ومررت بعصا عند أبي عثمان والفراء بدلاً من لام الفعل ولا عوضاً ألا تراه غير لازم إذ كان التنوين يزيله الوقف والألف التي هي بدل منه يزيلها الوصل.
وليست كذلك تاء مائة وعضة وسنة وفئة وشفة لأنها ثابتة في الوصل ومبدلة هاء في الوقف.
فأما الحذف فلا حذف.
وكذلك ما لحقه علم الجمع نحو القاضون والقاضين والأعلَون والأعلَين.
فعلم الجمع ليس عوضاً ولا بدلاً لأنه ليس لازماً.
فأما قولهم: هذان وهاتان واللذان واللتان والذين واللذون فلو قال قائل: إن علم التثنية والجمع فيها عوض من الألف والياء من حيث كانت هذه أسماء صيغت للتثنية والجمع لا على حد رجلان وفرسان وقائمون وقاعدون ولكن على حد قولك: هما وهم وهن لكان مذهباً ألا ترى أن " هذين " من " هذا " ليس على رجلين من رجل ولو كان كذلك لوجب أن تنكره البتة كما تنكر الأعلام نحو زيدان وزيدين وزيدون وزيدين والأمر في هذه الأسماء بخلاف ذلك ألا تراها تجري مثناة ومجموعة أوصافاً على المعارف كما تجري عليها مفردة.
وذلك قولك مررت بالزيدين هذين وجاءني أخواك اللذان في الدار.
وكذلك قد توصف هي أيضاً بالمعارف نحو قولك: جاءني ذانك الغلامان ورأيت اللذين في الدار الظريفين.
وكذلك أيضاً تجدها في التثنية والجمع تعمل من نصب الحال ما كانت تعمله مفردة.
وذلك نحو قولك: هذان قائمين الزيدان وهؤلاء منطلقين إخوتك.
وقد تقصينا القول في ذلك في كتابنا في سر الصناعة.
وقريب من هذان واللذان قولهم: هيهات مصروفة وغير مصروفة وذلك أنها جمع هيهاة وهيهاة عندنا رباعية مكررة فاؤها ولامها الأولى هاء وعينها ولامها الثانية ياء.
فهي لذلك من باب صِيِصية.
وعكسها باب يَلْيَل ويَهْيَاهٍ قال ذو الرمة: تلؤم يهياهٍ بياهٍ وقد مضى من الليل جَوْرٌ واسبطرتْ كواكبه وقال كثير: فهيهاةُ من مضعف الياء بمنزلة المرمرة والقرقرة.
فكان قياسها إذا جمعت أن تقلب اللام ياء فيقال هيهيات كشوشيات وضوضيات إلا أنهم حذفوا اللام لأنها في آخر اسم غير متمكن ليخالف آخرها آخر الأسماء المتمكنة نحو رَحَيَان ومَوْليَان.
فعلى هذا قد يمكن أن يقال: إن الألف التاء في هيهات عوض من لام الفعل في هيهاةٍ لأن هذا ينبغي أن يكون اسماً صيغ للجمع بمنزلة الذين وهؤلاء.
فإن قيل: وكيف ذاك وقد يجوز تنكيره في قولهم: هيهات هيهات وهؤلاء والذين لا يمكن تنكيرهما فقد صار إذاً هيهات بمنزلة قصاع وجفان وكرام وظراف.
قيل: ليس التنكير في هذا الاسم المبني على حده في غيره من المعرب ألا ترى أنه لو كانت هيهات من هيهاة بمنزلة أرطيات من أرطاة وسعليات من سعلاة لما كانت إلا نكرة كما أن سعليات وأرطيات لا تكونان إلا نكرتين.
فإن قيل: ولم لا تكون سعليات معرفة إذا جعلتها علماً كرجل أو امرأة سميتها بسعليات وأرطيات.
وكذلك أنت في هيهات إذا عرفتها فقد جعلتها علما على معنى البعد كما أن غاق فيمن لم ينون فقد جعل علماً لمعنى الفراق ومن نون فقال: غاقٍ غاقٍ وهيهاة هيهاة هيهاتٍ هيهاتٍ فكأنه قال: بعداً بعداً فجعل التنوين علماً لهذا المعنى كما جعل حذفه علماً لذلك قيل: أما على التحصيل فلا تصح هناك حقيقة معنى العلمية.
وكيف يصح ذاك وإنما هذه أسماء سمى بها الفعل في الخبر نحو شتان وسرعان وأف وأوتاه وسنذكر ذلك في بابه.
وإذا كانت أسماء للأفعال والأفعال أقعد شيء في التنكير وأبعده عن التعريف علمت أنه تعليق لفظ متأول فيه التعريف على معنى لا يضامه إلا التنكير.
فلهذا قلنا: إن تعريف باب هيهات لا يعتد تعريفاً.
وكذلك غاق وإن لم يكن اسم فعل فإنه على سمته ألا تراه صوتاً بمنزلة حاء وعاء وهاء وتعرف الأصوات من جنس تعرف الأسماء المسماة بها الأفعال.
فإن قيل: ألا تعلم أن معك من الأسماء ما تكون فائدة معرفته كفائدة نكرته البتة.
وذلك قولهم: غدوة هي في معنى غداة إلا أن غُدوة معرفة وغَداة نكرة.
وكذلك أسَد وأُسامة وثعلب وثُعالة وذئب وذُؤالة وأبو جَعْدة وأبو مُعْطة.
فقد تجد هذا التعريف المساوي لمعنى التنكير فاشياً في غير ما ذكرته ثم لم يمنع ذلك أسامة وثعالة وذؤالة وأبا جعدة وأبا معطة ونحو ذلك أن تُعدّ في الأعلام وإن لم يخص الواجد من جنسه فكذلك لم لا يكون هيهات كما ذكرنا.
قيل: هذه الأعلام وإن كانت معنياتها نكرات فقد يمكن في كل واحد منها أن يكون معرفة صحيحة كقولك: فرقت ذلك الأسد الذي فرقته وتبركت بالثعلب الذي تبركت به وخسأت الذئب الذي خسأته.
فأما الفعل فمما لا يمكن تعريفه على وجه فلذلك لم يعتد التعريف الوافع وأيضاً فإن هذه الأصوات عندنا في حكم الحروف فالفعل إذاً أقرب إليها ومعترض بين الأسماء وبينها أولا ترى أن البناء الذي سرى في باب صه ومه وحيهلا ورويدا وإيه وأيها وهلم ونحو ذلك من باب نزال ودراك ونظار ومناع إنما أتاها من قبل تضمن هذه الأسماء معنى لام الأمر لأن أصل ماصه أسم له وهو اسكت لتسكت كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم {فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ} وكذلك مَهْ هو اسم اكفُفْ والأصل لتكفف.
وكذلك نزال هو اسم انزل والأصل: لتنزل.
فلما كان معنى اللام عائراً في هذا الشق وسائراً في أنحائه ومتصوراً في جميع جهاته دخله البناء من حيث تضمن هذا المعنى كما دخل أين وكيف لتضمنهما معنى حرف الاستفهام وأمس لتضمنه معنى حرف التعريف ومن لتضمنه معنى حرف الشرط وسوى ذلك.
فأما أف وهيهات وبابهما مما هو اسم للفعل فمحمول في ذلك على أفعال الأمر.
وكأن الموضع في ذلك إنما هو لصهْ ومه ورويد ونحو ذلك ثم حمل عليه باب أفّ وشتان ووشكان من حيث كان اسما سمي به الفعل.
وإذا جاز لأحمد وهو اسم معرفة علم أن يشبه بأركب وهو فعل نكرة كان أن يشبه اسم سمي به الفعل في الخبر باسم سمي به الفعل في الأمر أولى ألا ترى أن كل واحد منهما اسم وأن المسمى به أيضاً فعل.
ومع ذا فقد تجد لفظ الأمر في معنى الخبر نحو قول الله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} وقوله عز اسمه {قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} أي فليمدنَّ.
ووقع أيضاً لفظ الخبر في معنى الأمر نحو قوله سبحانه {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} وقولهم: هذا الهلال.
معناه: انظر إليه.
ونظائره كثيرة.
فلما كان أف كصه في كونه اسما للفعل كما أن صه كذلك ولم يكن بينهما إلا أن هذا اسم لفعل مأمور به وهذا اسم لفعل مخبر به وكان كل واحد من لفظ الأمر والخبر قد يقع موقع صاحبه صار كأن كل واحد منها هو صاحبه فكأن لا خلاف هناك في لفظ ولا معنى.
وما كان على بعض هذه القربى والشبكة ألحق بحكم ما حمل عليه فكيف بما ثبتت فيه ووقت عليه واطمأنت به.
فاعرف ذلك.
ومما حذفت لامه وجعل الزائد عوضاً منها فرزدق وفريزيد وسفرجل وسفيريج.
وهذا باب واسع.
فهذا طرف من القول على ما زيد من الحروف عوضاً من حرف أصلي محذوف وأما الحرف الزائد عوضاً من حرف زائد فكثير.
منه التاء في فرازنة وزنادقة وجحاجحة.
لحقت عوضاً من ياء المد في زناديق وفرازين وجحاجيح.
ومن ذلك ما لحقته ياء المد عوضاً من حرف زائد حذف منه نحو قولهم في تكسير مدحرج وتحقيره: دحاريج ودحيريج.
فالياء عوض من ميمه.
وكذلك جحافيل وجحيفيل: الياء عوض من نونه.
وكذلك مغاسيل ومغيسيل: الياء عوض من تائه.
وكذلك زعافير الياء عوض من ألفه ونونه.
وكذلك الهاء في تَفْعِلة في المصادر عوض من ياء تفعيل أو ألف فعال.
وذلك نحو سليته تسلية وربيته تربية: الهاء بدل من ياء تفعيل في تسلى وتربى أو ألف سلاء ورباء.
أنشد أبو زيد: باتت تنزي دلوها تنزياً كما تنزى شهلة صبيا ومن ذلك تاء الفعللة في الرباعي نحو الهملجة السرهفة كأنها عوض من ألف فعلال نحو الهملاج والسرهاف قال العجاج: سرهفته ما شئت من سرهاف وكذلك ما لحق بالرباعي من نحو الحوقلة والبيطرة والجهورة والسلقاة.
كأنها عوض من ألف حيقال وبيطار وجهوار وسلقاء.
ومن ذلك قول التغلبي: متى كنا لأمك مقتوينا والواحد مقتوي.
وهو منسوب إلى مقتى وهو مفعل من القتو وهو الخدمة قال: فكان قياسه إذا جمع أن يقال: مقتويون ومقتويين كما أنه إذا جمع بصرى وكوفي قيل: كوفيون وبصريون ونحو ذلك إلا إنه جعل علم الجمع معاقباً لياءي الإضافة فصحت اللام لنية الإضافة كما تصح معها.
ولولا ذلك لوجب حذفها لالتقاء الساكنين وأن يقال: مقْتَوْن ومقْتَيْن كما يقال: هم الأعلَوْن وهم المصطَفَوْن قال الله سبحانه {وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ} وقال عز اسمه {وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ} فقد ترى إلى تعويض علم الجمع من ياءي الإضافة والجميع زائد.
وقال سيبويه في ميم فاعلته مفاعلة: إنها عوض من ألف فاعلته.
ولتبع ذلك محمد بن يزيد فقال: ألف فاعلت موجودة في المفاعلة فكيف يعوض من حرف هو موجود غير معدوم.
وقد ذكرنا ما في هذا ووجه سقوطه عن سيبويه في موضع غير هذا.
لكن الألف في المفاعل بلا هاء هي ألف فاعلته لا محالة وذلك نحو قاتلته مقاتلاً وضاربته مضارباً قال: أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلاً وأنجو إذا لم ينج إلا المكيس وقال: أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلاً وأنجو إذا غم الجبان من الكرب فأما أقمت إقامة وأردتن إرادة ونحو ذلك فإن الهاء فيه على مذهب الخليل وسيبويه عوض من ألف إفعال الزائدة.
وهي في قول أبي الحسن عوض من عين إفعال على مذهبهما في باب مفعول من نحو مبيع ومقول.
والخلاف في ذلك قد عرف وأحيط بحال المذهبين فيه فتركناه لذلك.
ومن ذلك الألف في يمانٍ وتهامٍ وشئامٍ: هي عوض من إتنحدجى ياءي الإضافة في يمنى وتهامى وشأمى.
وكذلك ألف ثمان.
قلت لأبي علي: لم زعمتها للنسب فقال: لأنها ليست بجمع مكسر فتكون كصحارٍ.
قلت له: نعم ولو لم تكن للنسب للزمتها الهاء البتة نحو عباقية وكراهية وسباهية.
فقال: نعم هو كذلك.
ومن ذلك أن ياء التفعيل بدل من ألف الفعال كما أن التاء في أوله عوض من إحدى عينيه.
ففي هذا كاف بإذن الله.
وقد أوقع هذا التعاوض في الحروف المنفصلة عن الكلم غير المصوغة فيها الممزوجة بأنفس صيغها.
وذلك قول الراجز على مذهب الخليل: إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوماً على من يتكل أي من يتكل عليه.
فحذف عليه هذه وزاد على متقدمة ألا ترى أنه: يعتمل إن لم يجد من يتكل عليه.
وندع ذكر قول غيره ههنا.
وكذلك قول الآخر: أولى فأولى يا امرأ القيس بعدما خصفن بآثار المطي الحوافرا أي خصفن بالحوافر آثار المطي يعني آثار أخفافها.
فحذف الباء من الحوافر وزاد أخرى عوضاً منها في آثار المطي.
هذا على قول من لم يعتقد القلب وهو أمثل فما وجدت مندوحة عن القلب لم ترتكبه.
وقياس هذا الحذف والتعويض قولهم: بأيهم تضرب أمرر أي أيهم تضرب أمرر به.
باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض
هذا باب يتلقاه الناس مغسولاً ساذجاً من الصنعة.
وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه.
وذلك أنهم يقولون: إن " إلى " تكون بمعنى مع.
ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه: {مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ} أي مع الله.
ويقولون: إن " في " تكون بمعنى على ويحتجون بقوله عز اسمه: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} أي عليها.
ويقولون: تكون الباء بمعنى عن وعلى ويحتجون بقولهم: رميت بالقوس أي عنها وعليها كقوله: أرمى عليها وهي فرع أجمع وقال طفيل: رمت عن قسي الماسخي رجالهم بأحسن ما يبتاع من نبل يثرب أرمى علي شريانة قذاف تلحق ريش النبل بالأجواف وغير ذلك مما يوردونه.
ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلاً هكذا لا مقيداً لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد وأنت تريد: معه وأن تقول: زيد في الفرس وأنت تريد: عليه وزيد في عمرو وأنت تريد: عليه في العداوة وأن تقول: رويت الحديث بزيد وأنت تريد: عنه ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش.
ولكن سنضع في ذلك رسماً يعمل عليه ويؤمن التزام الشناعة لمكانه.
اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه.
وذلك كقول الله عز اسمه: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة وإنما تقول: رفثت بها أو معها لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء وكنت تعدي أفضيت بإلى كقولك: أفضيت إلى المرأة جئت بإلى مع الرفث إيذاناً وإشعاراً أنه بمعناه كما صححوا عور وحول لما كانا في معنى اعور وإن شئتم تعاودونا عوادا لما كان التعاود أن يعاود بعضهم بعضاً.
وعليه جاء قوله: وليس بأن تتبعه اتباعاً ومنه قول الهل سبحانه: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا}.
وأصنع من هذا قول الهذلي: ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل فهذا على فعل ليس من لفظ هذا الفعل الظاهر ألا ترى أن معناه: طوى طي المحمل فحمل المصدر على فعل دل أول الكلام عليه.
وهذا ظاهر.
وكذلك قول الله تعالى: {مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ} أي مع الله وأنت لا تقول: سرت إلى زيد أي معه لكنه إنما جاء من أنصاري إلى الله لما كان معناه: من ينضاف في نصرتي إلى الله فجاز لذلك أن تأتي هنا إلى.
وكذلك قوله عز اسمه: {هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى} وأنت إنما تقول: هل لك في كذا لكنه لما كان على هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم صار تقديره أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى.
وعليه قول الفرزدق: كيف تراني قالياً مجنى أضرب أمري ظهره للبطن ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به ولعه لو جمع أكثره لا جميعه لجاء كتاباً ضخماً وقد عرفت طريقه.
فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس به فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها.
وفيه أيضاً موضع يشهد على من أنكر أن يكون في اللغة لفظان بمعنى واحد حتى تكلف لذلك أن يوجد فرقاً بين قعد وجلس وبين ذراع وساعد ألا ترى أنه لما كان رفث بالمرأة في معنى أفضى إليها جاز أن يتبع الرفث الحرف الذي بابه الإفضاء وهو " إلى ".
وكذلك لما كان هل لك في كذا بمعنى أدعوك إليه جاز أن يقال: هل لك إلى أن تزكى كما يقال أدعوك إلى أن تزكى وقد قال رؤبة ما قطع به العذر ههنا قال: بالٍ بأسماء البلى يسمى فجعل للبلى وهو معنى واحد أسماء.
وقد قدمنا هذا فيما مضى من صدر كتابنا.
ومما جاء من الحروف في موضع غيره على نحو مما ذكرنا قوله: إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها أراد: عنى.
ووجهه: أنها إذا رضيت عنه أحبته وأقبلت عليه.
فلذلك استعمل على بمعنى عن وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في هذا لأنه قال: لما كان رضيت ضد سخطت عدى رضيت بعلى حملاً للشيء على نقيضه كما يحمل على نظيره.
وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيراً فقال: قالوا كذا كما قالوا كذا وأحدهما ضد الآخر.
ونحو منه قول الآخر: إذا ما امرؤ ولى علي بوده وأدبر لم يصدر بإدباره ودي أي عني.
ووجهه أنه إذا ولي عنه يوده فقد استهلكه عليه كقولك.
أهلكت على مالي وأفسدت علي ضيعتي.
وجاز أن يستعمل على ههنا لأنه أمر عليه لا له.
وقد تقدم نحو هذا.
وأما قول الآخر: شدوا المطي على دليل دائب من أهل كاظمةٍ بسيف الأبحر فقالوا معناه: بدليل.
وهو عندي أنا على حذف المضاف أي شدوا المطي على دلالة دليل فحذف المضاف.
وقوي حذفه هنا شيئاً لأن لفظ الدليل يدل على الدلالة.
وهو كقولك: سر على اسم الله.
و " على " هذه عندي حال من الضمير في سر وشدوا وليست موصلة لهذين الفعلين لكنها متعلقة بمحذوف حتى كأنه قال: سر معتمداً على اسم الله ففي الظرف إذاً ضمير لتعلقه بالمحذوف.
وقال: أي على سرحة وجاز ذلك من حيث كان معلوماً أن ثيابه لا تكون في داخل سرحة لأن السرحة لا تنشق فتستودع الثياب ولا غيرها وهي بحالها سرحة.
فهذا من طريق المعنى بمنزلة كون الفعلين أحدهما في معنى صاحبه على ما مضى.
وليس كذلك قول الناس: فلان في الجبل لأنه قد يمكن أن يكون في غار من أغواره أو لصب من لصابه فلا يلزم أن يكون عليه أي عالياً فيه.
وقال: وخضخضن فينا البحر حتى قطعنه على كل حال من غمارٍ ومن وحل قالوا أراد: بنا.
وقد يكون عندي على حذف المضاف أي في سيرنا ومعناه: في سيرهن بنا.
ومثل قوله كأن ثيابه في سرحة: قول امرأة من العرب: هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا لأنه معلوم أنه لا يصلب في داخل جذع النخلة وقلبها.
وأما قوله: وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال فقالوا: أراد: مع ثلاثة أحوال.
وطريقه عندي أنه على حذف المضاف يريد: ثلاثين شهراً في عقب ثلاثة أحوال قبلها.
وتفسيره: بعد ثلاثة أحوال.
فالحرف إذاً على بابه وإنما هنا حذف المضاف الذي قد شاع عند الخاص والعام.
فأما قوله: يعثرن في حد الظبات كأنما كسيت برود بني تزيد الأذرع فإنه أراد: يعثر بالأرض في حد الظبات أي وهن في حد الظبات كقولك: خرج بثيابه أي وثيابه عليه وصلى في خفيه أي وخفاه عليه.
وقال تعالى: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} فالظرف إذاً متعلق بمحذوف لأنه حال من الضمير أي يعثرن كائنات في حد الظبات.
وأما قول بعض الأعراب: نلوذ في أم لنا ما تغتصب من الغمام ترتدي وتنتقب فإنه يريد بأم: سلمى أحد جبلى طيئ.
وسماها أما لاعتصامهم بها وأويهم إليها.
واستعمل في موضع الباء أي نلوذ بها لأنهم إذا لاذوا بها فهم فيها لا محالة إذ لا يلوذون ويعصمون بها إلا وهم فيها لأنهم إن كانوا بعداء عنها فليسوا لائذين بها فكأنه قال: نسمك فيها ونتوقل فيها.
فلأجل ذلك ما استعمل في مكان الباء.
فقس على هذا فإنك لن تعدم إصابة بإذن الله
باب في مضارعة الحروف للحركات والحركات للحروف
وسبب ذلك أن الحركة حرف صغير ألا ترى أن من متقدمي القوم من كان يسمى الضمة الواو الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والفتحة الألف الصغيرة.
ويؤكد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفاً من جنسها.
وذلك قولك في إشباع حركات ضرب ونحوه: ضوريبا.
ولهذا إذا احتاج الشاعر إلى إقامة الوزن مطل الحركة وأنشأ عنها حرفاً من جنسها.
وذلك قوله: نفي الدراهيم تنقاد الصياريف وقوله أنشدناه لابن هرمة: وأنت من الغوائل حين ترمي ومن الرجال بمنتزاح يريد: يمنتزح وهو مفتعل من النزح وقوله: وأنني حيث ما يسري الهوى بصري من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور فإذا ثبت أن هذه الحركات أبعاض للحروف ومن جنسها وكانت متى أشبعت ومطلت تمت ووفت جرت مجرى الحروف كما أن الحروف أنفسها قد تجد بعضها أتم صوتاً من بعض وإن ففما أجرى من الحروف مجرى الحركات الألف والياء والواو إذا أعرب بهن في تلك الأسماء الستة: أخوك وأبوك ونحوهما وفي التثنية والجمع على حد التثنية نحو الزيدان والزيدون والزيدين.
ومنها النون إذا كانت علماً للرفع في الأفعال الخمسة وهي تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين.
وقد حذفت أيضاً للجزم في لم يغزوا ولم يدع ولم يرم ولم يخش.
وحذفت أيضاً استخفافاً كما تحذف الحركة لذلك.
وذلك قوله: فألقحت أخراهم طريق ألاهم كما قيل نجم قد خوى متتابع يريد أولاهم ومضى ذكره.
وقال رؤبة: وصاني العجاج فيما وصني يريد: فيما وصاني وقال اله عز اسمه: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} وقد تقدم نحو هذا.
فنظير حذف هذه الحروف للتخفيف حذف الحركات أيضاً في نحو قوله: وقد بدا هنك من المئزر إذا اعوججن قلت صاحب قوم وقوله: ومن يتق فإن الله معه وقوله: أو يرتبط بعض النفوس حمامها وقوله: سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ونهر تيري ولا تعرفكم العرب أي ولا تعرفكم فأسكن مضطراً.
ومن مضارعة الحرف للحركة أن الأحرف الثلاثة: الألف والياء والواو إذا أشبعن ومطلن أدين إلى حرف آخر غيرهن إلا أنه شبيه بهن وهو الهمزة ألا تراك إذا مطلت الألف أدتك إلى الهمزة فقلت آء وكذلك الياء في قولك: إيء وكذلك الواو في قولك: أوء.
فهذا كالحركة إذا مطلتها أدتك إلى صورة أخرى غير صورتها.
وهي الألف والياء الواو في: منتزاح والصياريف أنظور.
وهذا غريب في موضعه.
ومن ذلك أن تاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً نحو حمزة وطلحة وقائمة ولا يكون ساكناً.
فإن كانت الألف وحدها من بين سائر الحروف جازت.
وذلك نحو قطاة وحصاة وأرطاة وحبنطاة.
أفلا ترى إلى مساواتهم بين الفتحة والألف حتى كأنها هي هي.
وهذ يدل على أن أضعف الأحرف الثلاثة الألف دون أختيها لأنها قد خصت هنا بمساواة الحركة دونها.
ومن ذلك قوله: ينشب في المسعل واللهاء أنشب من مآشر حداء قالوا: أراد: حدادا فلم يعدد الألف حاجزاً بين المثلين.
كما لم يعدد الحركة في ذلك في نحو أمليت الكتاب في أمللت.
ومن ذلك أنهم قد بينوا الحرف بالهاء كما بينوا الحركة بها وذلك نحو قولهم: وازيداه وواغلا مهماه وواغلامهوه وواغلامهموه وواغلامهيه ووانقطاع ظهرهيه.
فهذا نحو من قولهم: أعطيتكه ومررت بكَهْ واغزُهْ ولا تدعُهْ.
والهاء في كله لبيان الحركة لا ضمير.
ومن ذلك اقعد الثلاثة في المد لا يسوغ تحريكه وهو الألف فجرت لذلك مجرى الحركة ألا ترى أن الحركة لا يمكن تحريكها.
فهذا وجه أيضاً من المضارعة فيها.
وأما شبه الحركة بالحرف ففي نحو تسميتك امرأة بهند وجُمْل.
فلك فيهما مذهبان: الصرف وتركه.
فإن تحرك الأوسط ثقل الاسم فقلت في اسم امرأة سميتها بقدم بترك الصرف معرفة البتة أفلا ترى كيف جرت الحركة مجرى الحرف في منع الصرف.
وذلك كامرأة سميتها بسعاد وزينب.
فجرت الحركة في قدم وكبد ونحوه مجرى ألف سعاد وياء زينب.
ومن ذلك أنك إذا أضفت إلى الرباعي المقصور أجزت إقرار الألف وقلبها واوا نحو الإضافة إلى حُبْلَى: إن شئت قلت: حُبْلَى وهو الوجه.
و إن شئت: حبلوىّ.
فإذا صرت إلى الخمسة حذفت الألف البتة أصلاً كانت أو زائدة.
وذلك نحو قولك في حُبَارَى: حُبَارِيّ وفي مصطفى: مصطفي.
وكذلك إن تحرك الثاني من الرباعي حذفت ألفه البتة.
وذلك قولك في جمزى: حمزىّ وفي بشكى بشكيّ ألا ترى إلى الحركة كيف أوجبت الحذف كما أوجبه الحرف الزائد على الأربعة فصارت حركة عين جَمَزَى في إيجابها الحذف بمنزلة ألف حُبَارَى وياء خَيْزَلى.
ومن مشابهة الحركة للحرف أنك تفصل بها ولا تصل إلى الإدغام معها كما تفصل بالحرف ولا تصل إلى الإدغام معه.
وذلك قولك: وتد ويطد.
فحجزت الحركة بين المتقاربين كما يحجز الحرف بينهما نحو شميل وحبربر.
ومنها أنهم قد أجروا الحرف المتحرك مجرى الحرف المشدد.
وذلك أنه إذا وقع روياً في الشعر وقاتم الأعماق خاوي المخترق فأسكن القاف وهي مجرورة.
والمشدد نحو قوله: أصحوت اليوم أم شاقتك هر فحذف إحدى الراءين كما حذف الحركة من قاف المخترق.
وهذا إن شئت قلبته فقلت: إن الحرف أجري فيه مجرى الحركة وجعلت الموضع في الحذف للحركة ثم لحق بها فيه الحرف.
وهو عندي أقيس.
ومنها استكراههم اختلاف التوجيه: أن يجمع مع الفتحة غيرها من أختيها نحو جمعه بين المخترق وبين العقق والحمق.
فكراهيتهم هذا نحو من امتناعهم من الجمع بين الألف مع الياء والواو ردفين.
ومن ذلك عندي أن حرفي العلة: الياء والواو قد صحا في بعض المواضع للحركة بعدهما كما يصحان لوقوع حرف اللين ساكناً بعدهما.
وذلك نحو القود والحوكة والخونة والغيب والصيد وحول وروع وإن بيوتنا عورة فيمن قرأ كذلك.
فجرت الياء والواو هنا في الصحة لوقوع الحركة بعدهما مجراهما فيها لوقوع حرف الليلن ساكنا بعدهما نحو القواد والحواكة والخوانة والغياب والصياد وحويل ورويع وإن بيوتنا عويرة.
وكذلك ما صح من نحو قولهم: ثيؤ الرجل من الهيئة هو جار مجرى صحة هيوء لو قيل.
فاعرف ذلك مذهباً في صحة ما صح من هذا النحو لطيفاً غريباً.
باب محل الحركات من الحروف أمعها أم قبلها أم بعدها
أما مذهب سيبويه فإن الحركة تحدث بعد الحرف.
وقال غيره: معه.
وذهب غيرهما إلى أنها تحدث قبله.
قال أبو علي: وسبب هذا الخلاف لطف الأمر وغموض الحال.
فإذا كان هذا أمر يعرض للمحسوس الذي إليه تتحاكم النفوس فحسبك به لطفاً وبالتوقف فيه لبساً.
فمما يشهد لسيبويه بأن الحركة حادثة بعد الحرف وجودنا إياها فاصلة بين المثلين مانعة من إدغام الأول في الآخر نحو الملل والضعف والمشش كما تفصل الألف بعدها بينهما نحو الملال والضفاف والمشاش.
وهذا مفهوم.
وكذلك شددت ومددت فلن تخلو حركة الأول من أن تكنون قبله أو معه أو بعده.
قلو كانت في الرتبة قبله لما حجزت عن الإدغم ألا ترى أن الحرف المحرك بها كان يكون على ذلك بعدها حاجزاً بينها وبين ما بعده من الحرف الآخر.
ونحو من ذلك قولهم: ميزان وميعاد فقلب الواو ياء يدل على أن الكسرة لم تحدث قبل الميم لأنها لو كانت حادثة قبلها لم تل الواو فكان يحب أن يقال: موزان وموعاد.
وذلك أنك إنما تقلب الواو ياء للكسرة التي تجاورها من قبلها فإذا كان بينها وبينها حرف حاجز لم تلها وإذا لم تلها لم يجب أن نقلبها للحرف الحاجز بينهما.
وأيضاً فلو كانت قبل حرفها لبطل الإدغام في الكلام لأن حركة الثاني كانت تكون قبله حاجزة بين المثلين.
وهذا واضح.
فإذا بطل أن تكون الحركة حادثة قبل الحرف المتحرك بها من حيث أرينا وعلى ما أوضحنا وشرحنا بقي سوى مذهب سيبويه أن يظن بها أنها تحدث مع الحرف نفسه لا قبله ولا بعده.
وإذا فسد هذا لم يبق إلا ما ذهب إليه سيبويه.
والذي يفسد كونها حادثة مع الحرف البتة هو أنا لو أمرنا مذكرا من الطي ثم أتبعناه أمراً آخر له من الوجل من غير حرف عطف لا بل بمجيء الثاني تابعاً للأول البتة لقلنا: اطو أيجل.
والأصل فيه: اطو اوجل فقلبت الواو التي هي فاء الفعل من الوجل ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.
فلولا أن كسرة واو اطو في الرتبة بعدها لما قلبت ياء واو اوجل.
وذلك أن الكسرة إنما تقلب الواو لخالفتها إياها في جنس الصوت فتجتذبها إلى ما هي بعضه ومن جنسه وهو الياء وكما أن هناك كسرة في الواو فهناك أيضاً الواو وهي وفق الواو الثانية لفظاً وحساً وليست الكسرة على قول المخالف أدنى إلى الواو الثانية من الواو الأولى لأنه يروم أن يثبتهما جميعاً في زمان واحد ومعلوم أن الحرف أوفى صوتاً وأقوى جرساً من الحركة فإذا لم يقل لك: إنها أقوى من الكسرة التي فيها فلا أقل من أن تكون في القوة والصوت مثلها.
فإذا كان كذلك لزم ألا تنقلب الواو الثانية للكسرة قبلها لأن بإزاء الكسرة المخالفة للواو الثانية الواو الأولى الموافقة للفظ الثانية.
فإذا تأدى الأمر في المعادلة إلى هنا ترافعت الواو والكسرة أحكامهما فكأن لا كسرة قبلها ولا واو.
وإذا كان كذلك لم تجد أمراً تقلب له الواو الثانية ياء فكان يجب على هذا أن تخرج الواو الثانية من اطو أوجل ياء حتى صارت اطو أيجل على أن الكسرة أدنى إليها من الواو قبلها.
وإذا كانت أدنى إليها كانت بعد الواو المحركة بها لا محالة.
فهذا إسقاط قول من ذهب إلى أنها تحدث مع الحرف وقول من ذهب إلى أنها تحدث قبله ألا تراها لو كانت الكسرة في باب اطو قبل الواو لكانت الواو الأولى حاجزة بينها وبين الثانية كما كانت ميم ميزان تكون أيضاً حاجزة بينهما على ما قدمنا فإذا بطل هذان ثبت قول صاحب الكتاب وسقطت عنه فضول المقال.
قال أبو علي: يقوي قول من قال: إن الحركة تحدث مع الحرف أن النون الساكنة مخرجها مع حروف الفم من الأنف والمتحركة مخرجها من الفم فلو كانت حركة الحرف تحدث من بعده لوجب أن تكون النون المتحركة أيضاً من الأنف.
وذلك أن الحركة إنما تحدث بعدها فكان كذا قال رحمه الله ورأيته معيناً بهذا الدليل.
وهو عندي ساقط عن سيبويه وغير لازم له.
وذلك أنه لا ينكر أن يؤثر الشيء فيما قبله من قبل وجوده لأنه قد علم أن سيرد فيما بعد.
وذلك كثير.
فمنه أن النون الساكنة إذا وقعت بعدها الباء قلبت النون ميماً في اللفظ.
وذلك نحو عمبر وشمباء في غنبر وشنباء فكما لا يشك في أن الباء في ذلك بعد النون وقد قلبت النون قبلها فكذلك لا ينكر أن تكون حركة النون الحادثة بعدها تزيلها عن الأنف إلى الفم.
بل إذا كانت الباء أبعد من النون قبلها من حركة النون فيها وقد أثرت على بعدها ما أثرته كانت حركة النون التي هي أقرب إليها وأشد التباساً بها أولى بان تجذبها وتنقلها من الأنف إلى الفم.
وهذا كما تراه واضح.
ومما غير متقدماً لتوقع ما يرد من بعده متأخراً ضمهم همزة الوصل لتوقعهم الضمة بعدها نحو: اقُتل ادُخل اسُتضعف اخُرج اسُتخرج.
ومما يقوي عندي قول من قال: إن الحركة تحدث قبل الحرف إجماع النحويين على قولهم إن الواو في يعدو يزن ونحو ذلك إنما حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة.
يعنون: في يوعد ويوزن ونحوه لو خرج على أصله.
فقولهم: بين ياء وكسرة يدل على أن الحركة عندهم قبل حرفها المحرك بها ألا ترى أنه لو كانت الحركة بعد الحرف كانت الواو في يوعد بين فتحة وعين وفي يوزن بين فتحة وزاي.
فقولهم: بين ياء وكسرة يدل على أن الواو في نحو يوعد عندهم بين الياء التي هي أدنى إليها من فتحتها وكسرة العين التي هي أدنى إليها من العين بعدها.
فتأمل ذلك.
وهذا وإن كان من الوضوح على ما تراه فإنه لا يلزم من موضعين: أحدهما أنه لا يجب أن تكون فيه دلالة على اعتقاد القوم فيما نسبه هذا السائل إلى أنهم مريدوه ومعتقدوه ألا ترى أن من يقول: إن الحركة تحدث بعد الحرف ومن يقول: إنها تحدث مع الحرف قد أطلقوا جميعاً هذا القول الذي هو قولهم: إن الواو حذفت من يعد ونحوه لوقوعها بين ياء وكسرة فلو كانوا يريدون ما غزوته إليهم وحملته عليهم لكانوا مناقضين وموافقين لمخالفهم وهم لا يعلمون.
وهذا أمر مثله لا ينسب إليهم ولا يظن بهم.
فإذا كان كذلك علمت أن غرض القوم فيه ليس ما قدرته ولا ما تصورته وإنما هو أن قبلها ياء وبعدها كسرة وهما مستثقلتان.
فأما أن تماساً الواو وتباشراها على ما فرضته وادعيته فلا.
وهذا كثير في الكلام والاستعمال ألا ترى أنك تقول: خرجنا فسرنا فلما حصلنا بين بغداد والبصرة كان كذا.
فهذا كما تراه قول صحيح معتاد إلا أنه قد يقوله من حصل بدير العاقول فهو لعمري بين بغداد والبصرة وإن كان أيضاً بين جرجرايا والمدائن وهما أقرب إليه من بغداد والبصرة.
وكذلك الواو في يوعد هي لعمري بين ياء وكسرة وإن كان أقرب إليها منهما فتحة الياء والعين.
وكذلك يقال أيضاً: هو من عمره ما بين الخمسين إلى الستين فيقال ذلك فيمن له خمس وخمسون سنة فهي لعمري بين الخمسين والستين إلا أن الأدنى إليها الأربع والخمسون والست والخمسون.
وهذا جلى غير مشكل.
فهذا أحد الموضعين.
وأما الآخر فإن أكثر ما في هذا أن يكون حقيقة عند القوم وأن يكونوا مريديه ومعتقديه.
ولو أرادوه واعتقدوه وذهبوا إليه لما كان دليلاً على موضع الخلاف.
وذلك أن هذا موضع إنما يتحاكم فيه إلى النفس والحس ولا يرجع فيه إلى إجماع ولا إلى سابق سنة ولا قديم ملة ألا ترى أن إجماع النحويين في هذا ونحوه لا يكون حجة لأن كل واحد منهم إنما يردك ويرجع بك فيه إلى التأمل والطبع لا إلى التبعية والشرع.
هذا لو كان لا بد من أن يكونوا قد أرادوا ما عزاه السائل إليهم واعتقده لهم.
فهذا كله يشهد بصحة مذهب سيبويه في أن الحركة حادثة بعد حرفها المحرك بها.
وقد كنا قلنا فيه قديماً قولاً آخر مستقيماً.
وهو أن الحركة قد ثبت أنها بعض حرف.
فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو.
فكما أن الحرف لا يجامع حرفاً آخر فينشآن معاً في وقت واحد فكذلك بعض الحرف لا يجوز أن ينشأ مع حرف آخر في وقت واحد لأن حكم البعض في هذا جار مجرى حكم الكل.
ولا يجوز أن يتصور أن حرفاً من الحروف حدث بعضه مضاما لحرف وبقيته من بعده في غير ذلك الحرف لا في زمان واحد ولا في زمانين.
فهذا يفسد قول من قال: إن الحركة تحدث مع حرفها المتحرك بها أو قبله أيضاً ألا ترى أن الحرف الناشئ عن الحركة لو ظهر لم يظهر إلا بعد الحرف المحرك بتلك الحركة وإلا فلو كانت قبله لكانت الألف في نحو ضارب ليست تابعة للفتحة لاعتراض الضاد بينهما والحس يمنعك ويحظر عليك أن تنسب إليه قبوله اعتراض معترض بين الفتحة والألف التابعة لها في نحو ضارب وقائم ونحو ذلك.
وكذلك القول في الكسرة والياء والضمة والواو إذا تبعتاهما.
وهذا تناه في البيان.
والبروز إلى حكم العيان.
فاعرفه.
وفي بعض ما أوردناه من هذا كاف بمشيئة الله.
باب الساكن والمتحرك
أما إمام ذلك فإن أول الكلمة لا يكون إلا متحركاً وينبغي لآخرها أن يكون ساكناً.
فأما الإشمام فإنه للعين دون الأذن.
لكن روم الحركة يكاد الحرف يكون به متحركاً ألا تراك تفصل به بين المذكر والمؤنث في قولك في الوقف: أنتَ وأنتِ.
فلولا أن هناك صوتاً لما وجدت فصلاً.
فإن قلت: فقد نجد من الحروف ما يتبعه في الوقف صوت وهو مع ذلك ساكن.
وهو الفاء والثاء والسين والصاد ونحو ذلك تقول في الوقف: اِفْ: اِثْ اِسْ اِضْ.
قيل: هذا القدر من الصوت إنما هو متمم للحرف وموف له في الوقف.
فإذا وصلت ذهب أو كاد.
وإنما لحقه في الوقف لأن الوقف يضعف الحرف ألا تراك تحتاج إلى بيانه فيه بالهاء نحو واغلاماه ووازيداه وواغلامهوه وواغلامهيهْ.
وذلك أنك لما أردت تمكين الصوت وتوفيته ليمتد ويقوى في السمع وكان الوقف يضعف الحرف ألحقت الهاء ليقع الحرف قبلها حشوا فيبين ولا يخفى.
ومع ذلك فإن هذا الصوت اللاحق للفاء والسين ونحوهما إنما هو بمنزلة الإطباق في الطاء والتكرير في الراء والتفشي في الشين وقوة الاعتماد الذي في اللام.
فكما أن سواكن هذه الأحرف إنما تكال في ميزان العروض الذي هو عيار الحس وحاكم القسمة والوضع بما تكال به الحروف السواكن غيرها فكذلك هي أيضاً سواكن.
بل إذا كانت الراء لما فيها من التكرير تجري مجرى الحرفين في الإمالة ثم مع ذلك لا تعد في وزن الشعر إلا حرفاً واحداً كانت هذه الأحرف التي إنما فيها تمام وتوفية لهذا أحجى بأن تعد حرفاً لا غير.
ولأبي علي رحمه الله مسألتان: طويلة قديمة وقصيرة حديثة كلتاهما في الكلام على الحرف المبتدأ أيمكن أن يكون ساكناً أم لا.
فقد غنينا بهما أن نتكلف نحن شيئاً من هذا الشرح في معناهما.
ثم من بعد ذلك أن المتحرك على ضربين: حرف متحرك بحركة لازمة وحرف متحرك بحركة غير لازمة.
أما المتحرك بحركة لازمة فعلى ضربين أيضاً: مبتدأن وغير مبتدأ.
فالمبتدأ ما دام مبتدأ فهو متحرك لا محالة نحو ضاد ضرب وميم مهدد.
فإن اتصل أول الكلمة بشيء غيره فعلى قسمين: أحدهما أن يكون الأول معه كالجزء منه والآخر أن يكون على أحكام المنفصل عنه.
الأول من هذين القسمين أيضاً على ضربين: أحدهما أن يقر الأول على ما كان عليه من تحريكه.
والآخر أن يخلط في اللفظ به فيسكن على حد التخفيف في أمثاله من المتصل.
فالحرف الذي ينزل مع ما بعده كالجزء منه فاء العطف وواوه ولام الابتداء وهمزة الاستفهام.
الأول من هذين كقولك: وَهُو الله وقول: فهُوَ ما ترى ولَهُو أفضل من عمرو وأهِى عندك.
فهذا الباقي على تحريكه كأن لا شيء قبله.
والقسم الثاني منهما قولك: وهْو الله وقولك: فهْوَ يوم القيامة من المحضَرين ولهْو أفضل من وقمت للطيف مرتاعاً وأرقني فقلت أًهْي سَرَتْ أم عادني حُلُم ووجه هذا أن هذه الأحرف لما كن على حرف واحد وضعفن عن انفصالها وكان ما بعدها على حرفين الأول منهما مضموم أو مكسور أشبهت في اللفظ ما كان على فَعُل أو فَعِل فخفف أوائل هذه كما يخفف ثواني هذه فصارت وَهُو كعَضُد وصار وَهْو كعَضْد كما صارت أهِي كَعِلم وصار أَهْي بمنزلة عَلْم.
وأما قراءة أهل الكوفة ثم ليقطع فقبيح عندنا لأن ثُمَّ منفصلة يمكن الوقوف عليها فلا تخلط بما بعدها فتصير معه كالجزء الواحد.
لكن قوله: فلينظر حسن جميل لأن الفاء حرف واحد فيلطف عن انفصاله وقيامه برأسه.
وتقول على هذا: مررت برجل بطنه كَحْضَجْر تريد: كحِضَجْر ثم تسكن الحاء الأولى لأن كَحِضَ بوزن عَلِم فيجري هذا الصدر مجرى كلمة ثلاثية.
وأما أو الكلمة إذا لم يخلط بما قبله فمتحرك لا محالة على ما كان عليه قبل اتصاله به.
وذلك قولك: أحمد ضرب وأخوك دخل وغلامك خرج.
فهذا حكم الحرف المبتدأ.
وأما المتحرك غير المبتدأ فعلى ضربين: حشو وطرف.
فالحشو كراء ضرب وتاء قتل وجيم رجل وميم جمل ولام علم.
وأما الطرف فنحو ميم إبراهيم ودال أحمد وباء يضرب وقاف يغرق.
فإن قلت: قد قدمت أن هذا مما تلزم حركته وأنت تقول في الوقف: إبراهيم وأحمد ويضرب ويغرق فلا تلزم الحركة قيل: اعتراض الوقف لا يحفل به ولا يقع العمل عليه وإنما المعتبر بحال الوصل ألا تراك تقول في بعض الوقف: هذا بكر ومررت ببكر فتنقل حركة الإعراب إلى حشو الكلمة ولولا أن هذا عارض جاء به الوقف لكنت ممن يدعى أن حركة الإعراب تقع قبل الآخر وهذا خطأ بإجماع.
ولذلك أيضاً كانت الهاء في قائمه بدلاً عندنا من التاء في قائمة لما كانت إنما تكون هاء في الوفق دون الوصل.
فإن قلت: ولم جرت الأشياء في الوصل على حقائقها دون الوقف قيل: لأن حال الوصل أعلى رتبة من حال الوقف.
وذلك أن الكلام إنما وضع للفائدة والفائدة لا تجني من الكلمة الواحدة وإنما تجني من الجمل ومدارج القول فلذلك كان حال الوصل عندهم أشرف وأقوم وأعدل من حال الوقف.
ويدلك على أن حركة الآخر قد تعتد لازمة وإن كانت في الوقف مستهلكة أنك تقلب حرف اللين لها وللحركة قبله فتقول: عصا وقفا وفتى ودعا وغزا ورمى كما تقلبه وسطاً لحركته وحركة ما قبله نحو دار ونار وعاب وقال وقام وباع.
فإن قلت: فإن الجزم قد يدرك الفعل فيسكن في الوصل نحو لم يضرب أمس واضرب غدا وما كان كذلك.
قيل: إن الجزم لما كان ثانياً للرفع وإعراباً كالنصب في ذينك جرى الانتقال إليه عن الرفع مجرى الانتقال عن الرفع إلى النصب وحمل الجزم في ذلك على النصب كما حمل النصب على الجزم في الحرف نحو لن يقوما وأريد أن تذهبوا وتنطلقى.
قال أبو علي: وقد كان ينبغي أن تثبت النون مع النصب لثبات الحركة في الواحد.
فهذا فرق وعذر.
فهذه أحكام الحركة اللازمة.
وأما غير اللازمة فعلى أضرب.
منها حركة التقاء الساكنين نحو قم الليل واشدد الحبل.
ومنها حركة الإعراب المنقولة إلى الساكن قبلها نحو هذا بَكُرْ وهذا عَمُرْو ومررت ببِكَرْ ونظرت إلى عَمِرْو.
وذلك أن هذا أحد أحداث الوقف فلم يكن به حفل.
ومنها الحركة المنقولة لتخفيف الهمزة نحو قولك في مسئلة: مَسَلة وقولك في يلؤم: يَلُم وفي يزئر: يَزِر وقوله ولم يكن له كفاَ أحد فيمن سكن وخفف.
وعلى ذلك قول الله تعالى {لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي} أصله: لكن أنا ثم خفف فصار لكنَ نَا ثم أجرى غير اللازم مجرى اللازم فأسكن الأول وأدغم في الثاني فصار لكنا.
وذي ولد لم يلده أبوان لأنه أراد: لم يلده فأسكن اللام استثقالاً للكسرة وكانت الدال ساكنة فحركها لالتقاء الساكنين.
وعليه قولك الآخر: ولكنني لم أجْدَ من ذلك بدا أي لم أجِدْ فأسكن الجيم وحرك الدال على ما مضى.
ومن ذلك حركات الإتباع نحو قوله: ضرباً أليما بِسبْت يَلْعَجُ الجلدا وقوله: مشتبه الأعلام لمَّاع الخَفَقْ وقوله: .
.
.
.
.
.
.
.
.
لم يُنْظَرْ به الحشكُ وقوله: ماء بشرقي سلمى فَيْدُ أو رَكَكُ وقوله: وقوله: وحامل المينَ بعد المِينَ والألَفِ وأما قول الآخر: علمنا أخوالنا بنو عِجِلْ الشغزبي اعتقالا بالرجِلْ فيكون إتباعاً ويكون نقلاً.
وقول طرفة: .
.
.
.
.
.
.
.
.
ورادا وشقر ينبغي أن يكون إتباعاً يدلك على ذلك أنه تكسير أشقر وشقراء وهذا قد يجيء فيه المعتل اللام نحو قُنْو وعُشْو وظُمْى وعُمْى ولو كان أصله فُعُلا لما جاء في المعتل ألا ترى أن ما كان من تكسير فَعِيل وفَعُول وفَعالِ وفِعالٍ مما لامه معتلة لا يأتي على فُعُل.
فلذلك لم يقولوا في كِساءِ: كُسْوٌ ولا في رِداء: رُدْيٌ ولا في صبيّ: صُبْوٌ ولا نحو ذلك لأن أصله فُعُل.
وهي اللغة الحجازية القوية.
وقد جاء شيء من ذلك شاذاً.
وهو ما حكاه من قولهم: ثنى وثُنٍ.
وأنشد الفراء: فلو ترى فيهن سر العتق بين كماتي وحوبلق فهذا جمع فلو وكلا ذينك شاذ: أسلمتموها فباتت غير طاهرة مني الرجال على الفخذين كالموم فكسر منِيّا على مُنْى ولا يقاس عليه.
وإنما ذكرناه لئلا يجيء به جاءٍ فترى أنه كسر للباب.
ومن حركات الإتباع قولهم: أنا أجوءك وانبؤك وهو مُنْحُدُر من الجبل ومِنْتن ومِغِيرة ونحو من ذلك باب شِعير ورِغيف وبِعير والزِئير والجنة لمن خاف وعيد اللهز وشبهت القاف بالخاء لقربها منها فيما حكاه أبو الحسن من قولهم: النِقِيذ كا شبهت الخاء والغين بحروف الفم حتى أخفيت النون معهما في بعض اللغات كما تخفى مع حروف الفم.
وهذا في فَعيل مما عينه حلقية مطرد.
وكذلك فَعِل نحو نَغِر ومِحك جئز وضحك و {إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ}.
وقريب من ذلك الحمدِ للهِ والحمد للهِ وقِتِّلوا وفِتِّحوا وقوله: تدافُعَ الشِيبِ ولم تِقِتّل وقوله: لا حِطِّبَ القومَ ولا القوم سقى ومن غير اللازم ما أحدثته همزة التذكر نحو ألى وقدى.
فإذا صلت سقطت نحو الخليل وقد قام.
ومن قرأ اشتروا الضلالة قال في التذكير: اشترووا ومن قرأ: اشتروا الضلالة قال في التذكر: اشتروى ومن قال اشتروا الضلالة قال في التذكر: اشتروا.
وأما الساكن فعلى ضربين: ساكن يمكن تحريكه وساكن لا يمكن تحريكه.
الأول منهما جميع الحروف إلا الألف الساكنة المدة.
والثاني هو هذه الألف نحو ألف كتاب وحساب وباع وقام.
والحرف الساكن الممكن تحريكه على ضربين: أحدهما ما يبنى على السكون.
والآخر ما كان متحركاً ثم أسكن.
الأول منها يجيء أولاً وحشوا وطرفاً.
فالأول ما لحقته في الابتداء همزة الوصل.
وتكون في الفعل نحو انطلق واستخرج واغدودن وفي الأسماء العشرة: ابن وابنة وامرئ وامرأة واثنين واثنتين واسم واست وابنم وايمن.
وفي المصادر نحو انطلاق واستخراج واغديدان وما كان مثله.
وفي الحروف في لام التعريف نحو الغلام والخليل.
فهذا حال الحرف الساكن إذا كان أولا.
وأما كونه حشوا فككاف بكر وعين جعفر ودال يدلف.
وكونه أخرا في نحو دال قد ولام هل.
فهذه الحروف الممكن تحريكها إلا أنها مبنية على السكون.
وأما ما كان متحركاً ثم أسكن فعلى ضربين: متصل ومنفصل.
فالمتصل: ما كان ثلاثياً مضموم الثاني أو مكسوره فلك فيه الإسكان تخفيفاً.
وذلك كقولك في عَلم: قد عَلْمَ وفي ظُرف: قد ظَرْف وفي رَجُل رَجْل وفي كِبد: كبْد.
وسمعت الشجري وذكر طعنة في كتف فقال: رَجْلان من ضَبَّة أخبرانا إنا رأينا رجلا عُريانا وقد جاء هذا فيما كان على أكثر من ثلاثة أحرف قال العجاج: فبات منتصباً وما تكردسا وحكى صاحب الكتاب: أراك منتفخاً وقالوا في قول العجاج: بسَبْحل الدفين عيسجور أراد: سِبَحْل فأسكن الباء وحرك الحاء وغير حركة السين.
وقال أبو عثمان في قول الشاعر: هل عرفت الدار أم أنكرتها بين تبراك فشسى عَبَقُرْ أراد: عبْقَر فغير كما ترى إلا أنه حرك الساكن وقال غيره: أراد: عَبَيقُر فحذف الياء كما حذفت من عَرَنْقُضان حتى صارت عَرَقُصانا.
وكذلك قوله: لم يلده أبوان قد جاء فيه التحريك والتسكين جميعاً.
وكذلك قوله: ولكنني لم أجد من ذلكم بدا وقد مضيا آنفا.
وأما المنفصل فإنه شبه بالمتصل وذلك قراءة بعضهم {فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ} { فلا تناجوا } فهذا مشبه بدابة وخدل.
وعليه قراءة بعضهم {إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ} وذلك أن قوله " تَقِ وَ " ومن يَتَّقْ فإن الله معه ورزق الله مؤتاب وغاد لأن " يَتقِ ف " بوزن عَلِم.
وأنشد أبو زيد: قالت سليمى اشتر لنا سويقا لأن " تَراَ " كعلم.
ومنها: فاحذَرْ ولا تكتَرْ كرِيّا أعوجا وأما { إن الله يأمُرْكم } و { فتوبوا إلى بارئْكم } فرواها القراء عن أبي عمرو بالإسكان ورواها سيبويه بالاختلاس وإن لم يكن كان أزكى فقد كان أذكى ولا كان بحمد الله مُزَنّا برِيبة ولا مغموزاً في رواية.
لكن قوله: فاليوم أشربْ غير مستحْقِب وقوله: وقد بدا هَنْكِ من المئزر وقوله: سيروا بني العم فالأهوازُ منزلُكم ونهر تيرى ولا تعرفكم العربُ فمسكن كله.
والوزن شاهد ومصدقه.
وأما دفع أبي العباس ذلك فمدفوع وغير ذي مرجوع إليه.
وقد قال أبو علي في ذلك في عدة أماكن من كلامه وقلنا نحن معه ما أيده وشد منه.
وكذلك قراءة من قرأ { بلى ورُسْلنا لديهم يكتبون } وعلى ذلك قال الراعي: تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا وابنا نزار فأنتم بَيْضة البلد فإنه أسكن المفتوح وقد روى لا تعرف لكم فإذا كان كذلك فهو أسهل لاستثقال الضمة.
وأما قوله: تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها فقد قيل فيه: إنه يريد: أو يربط على معنى لألزمنه أو يعطيني حقي وقد يكمن عندي أن يكون يرتبط معطوفاً على أرضها أي ما دمت حياً فإني لا أقيم والأول أقوى معنى.
وأما قول أبي دواد: فأبلوني بليَّتَكم لعلي أُصالُحكم وأستدرِجْ نَوَيّا فقد يمكن أن يكون أسكن المضموم تخفيفاً واضطراراً.
ويمكن أيضاً أن يكون معطوفاً على موضع لعل لأنه مجزوم جواب الأمر كقولك: زرني فلن أضيعك حقك وأعطك ألفا أي زرني أعرف حقك وأعطِك ألفا.
وقد كثر إسكان الياء في موضع النصب كقوله: وهو كثير جداً وشبهتت الواو في ذلك بالياء كما شبهت الياء بالألف قال الأخطل: إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها نزلن وأنزلن القطين المولدا وقال الآخر: فمما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب وقول الآخر: وأن يعرين إن كسى الجواري فتنبو العين عن كرم عجاف باب في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد هذا موضع قلما وقع تفصيله.
وهو معنى يجب أن ينبه عليه ويحرر القول فيه.
ومن ذلك قولهم في ضمة الذال من قولك: ما رأيته مذ اليوم لأنهم يقولون في ذلك: إنهم لما حركوها لالتقاء الساكنين لم يكسروها لكنهم ضموها لأن أصلها الضم في منذ.
وهو هكذا لعمري لكنه الأصل الأقرب ألا ترى أن أول حال هذه الذال أن تكون ساكنة وأنها إنما ضمت لالتقاء الساكنين إتباعاً لضمه الميم.
فهذا على الحقيقة هو الأصل الأول.
فأما ضم ذال منذ فإنما هو في الرتبة بعد سكونها الأول المقدر.
ويدلك على أن حركتها إنما هي لالتقاء الساكنين أنه لما زال التقاؤهما سكنت الذال فلي مذ.
وهذا واضح.
فضمتك الذال إذاً من قولهم: مذُ اليوم ومذُ الليلة إنما هو رد إلى الأصل الأقرب الذي هو مُنْذُ دون الأبعد المقدر الذي هو سكون الذال في مُنْذُ قبل أن يحرك فيما بعده.
ولا يستنكر الاعتداد بما لم يخرج إلى اللفظ لأن الدليل إذا قام على شيء كان في حكم الملفوظ به وإن لم يجر على ألسنتهم استعماله ألا ترى إلى قول سيبويه في سودد: إنه إنما ظهر تضعيفه لأنه ملحق بما لم يجئ.
هذا وقد علمنا أن الإلحاق إنما هو صناعة لفظية ومع هذا فلم يظهر ذاك الذي قدره ملحقاً هذا به.
فلولا أن ما يقوم الدليل عليه مما لم يظهر إلى النطق به بمنزلة الملفوظ به لما ألحقوا سُرْدَدا وسُودَدا بما لم يفوهوا به ولا تجشموا استعماله.
ومن ذلك قولهم بعت وقلت فهذه معاملة على الأصل الأقرب دون الأبعد ألا ترى أن أصلهما فعل بفتح العين: بَيعَ وقَوَل ثم نقلا من فَعَل إلى فِعل وفَعُل ثم قلبت الواو والياء في فعلت ألفاً فالتقى ساكنان: العين المعتلة المقلوبة ألفاً ولام الفعل فحذفت العين لالتقائهما فصار التقدير: قَلْت وبَعْت ثم نقلت الضمة والكسرة إلى الفاء لأن أصلهما قبل القلب فَعُلت وفَعِلت فصار بِعت وقُلْت.
فهذا لعمري مراجعة أصل إلا أنه ذلك الأصل الأقرب لا الأبعد ألا ترى أن أول أحوال هذه العين في صيغة المثال إنما هو فتحة العين التي أبدلت منها الضمة والكسرة.
وهذا ومن ذلك قولهم في مطايا وعطايا: إنهما لما أصارتهما الصنعة إلى مطاءا وعطاءا أبدلوا الهمزة على أصل ما في الواحد من اللام وهو الياء في مِطيّة وعطيّة ولعمري إن لاميها ياءان إلا أنك تعلم أن أصل هاتين الياءين واوان كأنهما في الأصل مِطيَوة وعَطيَوة لأنهما من مطوت وعطوت أفلا تراك لم تراجع أصل الياء فيهما وإنما لاحظت ما معك في مطية وعطية من الياءت دون أصلهما الذي هو الواو.
أفلا ترى إلى هذه المعاملة كيف هي مع الظاهر الأقرب إليك دون الأول الأبعد عنك.
ففي هذا تقوية لإعمال الثاني من الفعلين لأنه هو الأقرب إليك دون الأبعد عنك.
فاعرف هذا.
وليس كذلك صرف ما لا ينصرف ولا إظهار التضعيف لأن هذا هو الأصل الأول على الحقيقة وليس وراءه أصل هذا أدنى إليك منه كما كان فيما أريته قبل.
فاعرف بهذا ونحوه حال ما يرد عليك مما هو مردود إلى أول وراءه ما هو أسبق رتبة منه وبين ما يرد إلى أول ليست وراءه رتبة متقدمة له.
باب في مراجعة أصل واستئناف فرع
اعلم أن كل حرف غير منقلب احتجت إلى قلبه فإنك حينئذ ترتجل له فرعً ولست تراجع به من ذلك الألفات غير المنقلبة الواقعة أطرافاً للإلحاق أو للتأنيث أو لغيرهما من الصيغة لا غير.
فالتي للإلحاق كألف أرطى فيمن قال: مأروط وحبنطي ودَلَنظى.
والتي للتأنيث كألف سكرى وغَضْبَى وجُمَادى.
والتي للصيغة لا غير كألف ضَبَغْطَرى وقَبَعْثَرى وزِبَعْرًى.
فمتى احتجت إلى تحريك واحدة من هذه الألفات للتثنية أو الجمع قلبتها ياء فقلت: أَرطَيانٍ وحَبَنْطَيانٍ وسكريان وجُمَادَيات وحُبَارَيات وضَبَغْطَرَيان وقبعثريان.
فهذه الياء فرع مرتجل وليست مراجعاً بها أصل ألا ترى أنه ليس واحدة منها منقلبة أصلاً لا عن ياء ولا غيرها.
وليست كذلك الألف المنقلبة كألف مغزى ومدعى لأن هذه منقلبة عن ياء منقلبة عن واو في غزوت ودعوت وأصلهما مَغْزَوٌ ومدْعَوٌ فلما وقعت الواو رابعة هكذا قلبت ياء فصارت مَغْزَيٌ ومَدْعَيٌ ثم قلبت الياء ألفاً فصارت مَدْعًى ومَغْزًى فلما احتجت إلى تحريك هذه الألف راجعت بها الأصل الأقرب وهو الياء فصارتا ياء في قولك: مغزيان ومدعيان.
وقد يكون الحرف منقلباً فيضطر إلى قلبه فلا ترده إلى أصله الذي كان منقلباً عنه.
وذلك قولك في حمراء: حمراوي وحمراوات.
وكذلك صفراوي وصفراوات.
فتقلب الهمزة واواً وإن كانت منقلبة عن ألف التأنيث كالتي في نحو بشرى وسكرى.
وكذلك أيضاً إذا نسبت إلى شقاوة فقلت: شقاوي.
فهذه الواو في شقاوي بدل من همزة مقدرة كأنك لما حذفت الهاء فصارت الواو طرفاً أبدلتها همزة فصارت في التقدير إلى شقاء فأبدلت الهمزة واواً فصار شقاوي قالوا إذاً في شقاوي غير الواو في شقاوة.
ولهذا نظائر في العربية كثيرة.
ومنها قولهم في الإضافة إلى عدوة: عدوي.
وذلك أنك لما حذفت الهاء حذفت له واو فَعُولة كما حذفت لحذف تاء حنيفة ياءها فصارت في التقدير إلى عَدُوٍ فأبدلت من الضمة كسرة ومن الواو ياء فصارت إلى عَدِيٍ فجرت في ذلك مجرى عَمٍ فأبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء ألفاً فصارت إلى عَداً كهُدًى فأبدلت من الألف واوا لوقوع ياءي الإضافة بعدها فصارت إلى عَدَوِيّ كهُدَويّ.
فالواو إذاً في عَدَوِيّ ليست بالواو في عدُوَّة وإنما هي بدل من ألف بدلٍ من ياء بدلٍ من الواو الثانية في عَدُوّة.فاعرفه.
باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع
اعلم أن الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين: أحدهما ما إذا احتيج إليه جاز أن يراجع.
والآخر ما لا تمكن مراجعته لأن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله.
الأول منهما: الصرف الذي يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين.
فمتى احتجت إلى صرفه فلتأتينكَ قصائدٌ وليدفعاً جيشاً إليك قوادم الأكوار وهو باب واسع.
ومنه إجراء المعتل مجرى الصحيح نحو قوله: لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب وبقية الباب.
ومنه إظهار التضعيف كلححت عينه وضبب البلد وألِلَ السقاء وقوله: الحمد لله العليّ الأجلل وبقية الباب.
ومنه قوله: سماء الإله فوق سبع سمائيا ومنه قوله: أهبني التراب فوقه إهبابا وهو كثير.
الثاني: منهما وهو ما لا يراجع من الأصول عند الضرورة.
وذلك كالثلاثي المعتل العين نحو قام وباع وخاف وهاب وطال.
فهذا مما لا يراجع أصله أبداً ألا ترى أنه لم يأت عنهم في نثر ولا نظم شيء منه مصححاً نحو قوم ولا بيع ولا خوف ولا هيب ولا طول.
وكذلك مضارعه نحو يقوم ويبيع ويخاف ويهاب ويطول.
فأما ما حكاه بعض الكوفيين من قولهم: هيؤ الرجل من الهيئة فوجهه أنه خرج مخرج المبالغة فلحق بباب قولهم: قضوا الرجل إذا جاد قضاؤه.
ورمو إذا جاد رميه.
فكما بني فَعُل مما لامه ياء كذلك خرج هذا على أصله في فَعُلَ مما عينه ياء.
وعلتهما جميعاً أن هذا بناء لا يتصرف لمضارعته بما فيه من المبالغة لباب التعجب ولنعم وبئس.
فلما لم يتصرف احتملوا فيه خروجه في هذا الموضع مخالفاً للباب ألا تراهم إنما تحاموا أن يبنوا فَعُل مما عينه ياء مخافة انتقالهم من الأثقل إلى ما هو أثقل منه لأنه كان يلزمهم أن يقولوا: بُعْتُ أبوع وهو يبوع ونحن نبوع وأنت أو هي تبوع وبوعا وبوعوا وبوعى وهما يبوعان وهم يبوعون ونحو ذلك.
وكذلك لو جاء فَعُل مما لامه ياء متصرفاً للزم أن يقولوا: رمُوتُ ورَمُوتَ وأنا أرمو ونحن نرمو وأنت ترمو وهو يرمو وهم يرمون وأنتما ترموان وهن يرمون ونحو ذلك فيكثر قلب الياء واواً وهو أثقل من الياء.
فأما قولهم: لرمُوَ الرجل فإنه لا يصرف ولا يفارق موضعه هذا كما لا يتصرف نعم وبئس فاحتمل ذلك فيه لجموده عليه وأمنهم تعديه إلى غيره.
وكذلك احتمل هيؤ الرجل ولم يعل لأنه لا يتصرف لمضارعته بالمبالغة فيه باب التعجب ونعم وبئس ولو صرف للزم إعلاله وأن يقال: هاء يهوء وأهوء وتهوء ونهوء وهما يهوءان وهم يهوءون ونحو ذلك فلما لم يتصرف لحق بصحة الأسماء فكما صح نحو القود والحوكة والصيد والغيب كذلك صح هيؤ الرجل فاعرفه كما صح ما أطوله وما أبيعه ونحو ذلك.
ومما لا يراجع من الأصول باب افتعل إذا كانت فاؤه صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء فإن تاءه تبدل طاء نحو اصطبر واضطرب واطرد واظطلم.
وكذلك إن كانت فاؤه دالاً أو ذالاً أو زاياً فإن تاءه تبدل دالاً.
وذلك نحو قولك أدلج وادكر وازدان.
فلا يجوز خروج هذه التاء على أصلها.
ولم يأت ذلك في نثر ولا نظم.
فأما ما حكاه خلف فيما أخبرنا به أبو علي من قول بعضهم: التقطت النوى واشتقطته واضتقطته فقد يجوز أن تكون الضاد بدلاً من الشين في اشتقطته.
نعم ويجوز أن تكون بدلاً من اللام في التقطته فيترك إبدال التاء طاء مع الضاد ليكون ذلك إيذاناً بأنها بدل من اللام أو الشين فتصح التاء مع الضاد كما صحت مع ما الضاد بدل منه.
ونظير ذلك قول بعضهم: يا رب أباز من العفر صدع تقبض الذئب إليه واجتمع لما رأى أن لادعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فالطجع فأبدل لام الطجع من الضاد وأقر الطاء بحالها مع اللام ليكون ذلك دليلاً على أنها بدل من الضاد.
وهذا كصحة عور لأنه بمعنى ما تجب صحته وهو اعور.
وقد مضى ذلك.
ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة ومن تصحيح الياء الساكنة بعد الضمة.
فأما قراءة أبي عمرو: { يا صالح آيتنا } بتصحيح الياء بعد ضمة الحاء فلا يلزمه عليها أن يقول: يا غلام اوجل.
والفرق بينهما أن صحة الياء في { يا صالح آيتنا } بعد الضمة له نظير وهو قولهم: قيل وبيع فحمل المنفصل: على المتصل وليس في كلامهم واو ساكنة صحت بعد كسرة فيجوز قياساً عليه يا غلام اوجل.
فإن قلت: فإن الضمة في نحو قيل وبيع لا تصح لأنها إشمام ضم للكسرة والكسرة في يا غلام اوجل كسرة صريحة.
فهذا فرق.
قيل: الضمة في حاء يا صالحُ ضمة بناء فأشبهت ضمة قيل من حيث كانت بناء وليس لقولك: يا غلام اوجل شبيه فيحمل هذا عليه لا كسرة صريحة ولا كسرة مشوبة.
فأما تفاوت ما بين الحركتين في كون إحداهما ضمة صريحة والأخرى ضمة غير صريحة فأمر تغتفر العرب ما هو أعلى وأظهر منه.
وذلك أنهم قد اغتفروا اختلاف الحرفين مع اختلاف الحركتين في نحو جمعهم في القافية بين سالم وعالم مع قادم وظالم فإذا تسمحوا بخلاف الحرفين مع الحركتين كان تسمحهم بخلاف الحركتين وحدهما في يا صالح آيتنا وقيل وبيع أجدر بالجواز.
فإن قلت: فقد صحت الواو الساكنة بعد الكسرة نحو اجلواذ واخرواط قيل: الساكنة هنا لما أدغمت في المتحركة فنبا اللسان عنهما جميعاً نبوة واحدة جرتا لذلك مجرى الواو المتحركة بعد الكسرة نحو طول وحول.
وعلى أن بعضهم قد قال: اجليواذا فأعل مراعاة لأصل ما كان عليه الحرف ولم يبدل الواو بعدها لمكان الياء إذ كانت هذه الياء غير لازمة فجرى ذلك في الصحة مجرى ديوان فيها.
ومن قال: ثيرة وطيال فقياس قولهم هنا أن يقول: اجلياذا فيقلبهما جميعاً إذ كانا قد جريا مجرى الواو الواحدة المتحركة.
فإن قيل: فالحركتان قبل الألفين في سالم وقادم كلتاهما فتحة وإنما شيبت إحداهما بشيء من الكسرة وليست كذلك الحركات في حاء يا صالح وقاف قيل من حيث كانت الحركة في حاء يا صالحُ ضمة البتة وحركة قاف قيل كسرة مشوبة بالضم فقد ترى الأصلين هنا مختلفين وهما هناك أعني في سالم وقادم متفقان.
قيل: كيف تصرفت الحال فالضمة في قيل مشوبة غير مخلصة كما أن الفتحة في سالم مشوبة مخلصة نعم ولو تطمعت الحركة في قاف قيل لوجدت حصة الضم فيها أكثر من حصة الكسر أو أدون حالها أن تكون في الذوق مثلها ثم من بعد ذلك ما قدمناه من اختلاف الألفين في سالم وقادم لاختلاف الحركتين قبلهما الناشئة هما عنهما وليست الياء في قيل كذلك بل هي ياء مخلصة وإن كانت الحركة قبلها مشوبة غير مخلصة.
وسبب ذلك أن الياء الساكنة سائع غير مستحيل فيها أن تصح بعد الضمة المخلصة فضلاً عن الكسرة المشوبة بالضم ألا تراك لا يتعذر عليك صحة الياء وإن خلصت قبلها الضمة في نحو ميسر في اسم الفاعل من أيسر لو تجشمت إخراجه على الصحة وكذلك لو تجشمت تصحيح واو موزان قبل القلب وإنما ذلك تجشم الكلفة لإخراج الحرفين مصححين غير معلين.
فأما الألف فحديث غير هذا ألا ترى أنه ليس في الطوق ولا من تحت القدرة صحة الألف بعد الضمة ولا الكسرة بل إنما هي تابعة للفتحة قبلها فإن صحت الفتحة قبلها صحت بعدها وإن شيبت الفتحة بالكسرة نحي بالألف نحو الياء نحو سالم وعالم وإن شيبت بالضمة نحى بالألف نحو الواو في الصلاة والزكاة وهي ألف التفخيم.
فقد بان لك بلك فرق ما بين الألف وبين الياء والواو.
فهذا طرف من القول على ما يراجع من الأصول للضرورة مما يرفض فلا يراجع.
فاعرفه وتنبه على أمثاله فإنه كثيرة.
باب في مراعاتهم الأصول للضرورة تارة وإهمالهم إياها أخرى
فمن الأول قولهم: صغت الخاتم وحكت الثوب ونحو ذلك.
وذلك أن فعلت هنا عديت فلولا أن أصل هذا فعلت بفتح العين لما جاز أن تعمل فعلت.
ومن ذلك بيت الكتاب: ألا ترى أن أول البيت مبني على اطراح ذكر الفاعل وأن آخره قد عوود فيه الحديث عن الفاعل لأن تقديره فيما بعد: ليبكه مختبط مما تطيح الطوائح.
فدل قوله: ليبك على ما أراده من قوله: ليبكه.
ونحوه قوله الله تعالى: {إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} {وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} هذا مع قوله سبحانه: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ} وقوله عز وجل: { خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} وأمثاله كثيرة.
ونحو من البيت قول الله تعالى: { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ} أي يسبح له فيها رجال.
ومن الأصول المراعاة قولهم: مررت برجل ضارب زيد وعمرا وليس زيد بقائم ولا قاعدا و {إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ} وإذا جاز أن تراعى الفروع نحو قوله: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا وقوله: مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةً ولا ناعبٍ إلا ببينٍ غرابها كانت مراجعة الأصول أولى وأجدر.
ومن ضد ذلك: هذان ضارباك ألا ترى أنك لو اعتددت بالنون المحذوفة لكنت كأنك قد جمعت بين الزيادتين المعتقبتين في آخر الاسم.
وعلى هذا القياس أكثر الكلام: أن يعامل الحاضر فيغلب حكمه لحضوره على الغائب لمغيبه.
وهو شاهد لقوة إعمال الثاني من الفعلين لقوته وغلبته على إعمال الأول لبعده.
ومن ذلك قوله: وما كل من وافى منى أنا عارف فيمن نون أو أطلق مع رفع كل.
ووجه ذلك أنه إذا رفع كلاّ فلا بد من تقديره الهاء ليعود على المبتدأ من خبره ضمير وكل واحد من التنوين في عارف ومدة الإطلاق في عارفو ينافي اجتماعه مع الهاء المرادة المقدرة ألا ترى أنك لو جمعت بينهما فقلت: عارفنه أو عارفوه لم يجز شيء من ذينك.
وإنما هذا لمعاملة الحاضر واطراح حكم الغائب.
فاعرفه وقسه فإنه باب واسع.
باب في حمل الأصول على الفروع
قال أبو عثمان: لا يضاف ضارب إلى فاعله لأنك لا تضيفه إليه مضمراً فكذلك لا تضيفه إليه مظهراً.
قال: وجازت إضافة المصدر إلى الفاعل لما جازت إضافته إليه مضمراً.
كأن أبا عثمان إنما اعتبر في هذا الباب المضمر فقدمه وحمل عليه المظهر من قبل أن المضمر أقوى حكماً في باب الإضافة من المظهر.
وذلك أن المضمر أشبه بما تحذفه الإضافة وهو التنوين من المظهر.
ولذلك لا يجتمعان في نحو ضاربانك وقاتلونه من حيث كان المضمر بلطفه وقوة اتصاله مشابهاً للتنوين بلطفه وقوة اتصاله وليس كذلك المظهر لقوته ووفور صورته ألا تراك تثبت معه التنوين فتنصبه نحو ضاربان زيداً وقاتلون عمراً.
فلما كان المضمر مما تقوى معه مراعاة الإضافة حمل المظهر وإن كان هو الأصل عليه وأصاره لما ذكرناه إليه.
ومن ذلك قولهم: إنما استوى النصب والجر في المظهر في نحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين لاستوائهما في المضمر نحو رأيتك ومررت بك.
وإنما كان هذا الموضع للمضمر حتى حمل عليه حكم المظهر من حيث كان المضمر عارياً من الإعراب فإذا عرى منه جاز أن يأتي منصوبه بلفظ مجروره وليس كذلك المظهر لأن باب الإظهار أن يكون موسوماً بالإعراب فلذلك حملوا الظاهر على المضمر في التثنية وإن كان المظهر هو الأصل إذ كان المراعى هنا أمراً غير الفرعية والأصلية وإنما هو أمر الإعراب والبناء.
وإذا تأملت ذلك علمت أنك في الحقيقة إنما حملت فرعاً على أصل لا أصلاً على فرع ألا ترى أن المضمر أصل في عدم الإعراب فحملت المظهر عليه لأنه فرع في البناء كما حملت المظهر على المضمر في باب الإضافة من حيث كان المضمر هو الأصل في مشابهته التنوين والمظهر فرع عليه في ذلك لأنه إنما يتأصل في الإعراب لا في البناء.
فإذا بدهتك هذه المواضع فتعاظمتك فلا تخنع لها ولا تعط باليد مع أول ورودها وتأت لها ولاطف بالصنعة ما يورده الخصم منها مناظراً كان أو خاطراً.
وبالله التوفيق.
باب في الحكم يقف بين الحكمين
هذا فصل موجود في العربية لفظاً وقد أعطته مقاداً عليه وقياساً. وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو غلامي وصاحبي. فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء.
أما كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعاً ومنصوباً وهي فيه نحو هذا غلامي ورأيت صاحبي وليس بين الكسر وبين الرفع والنصب في هذا ونحوه نسبة ولا مقاربة.
وأما كونها غير بناء فلأن الكلمة معربة متمكنة فليست الحركة إذن في آخرها ببناء ألا ترى أن غلامي في التمكن واستحقاق الإعراب كغلامك وغلامهم وغلامنا.
فإن قلت: فما الكسرة في نحو مررت بغلامي ونظرت إلى صاحبي أإعراب هي أم من جنس الكسرة في الرفع والنصب قيل: بل هي من جنس ما قبلها وليست إعراباً ألا تراها ثابتة في الرفع والنصب.
فعلمت بذلك أن هذه الكسرة يكره الحرف عليها فيكون في الحالات ملازماً لها.
وإنما يستدل بالمعلوم على المجهول.
فكما لا يشك أن هذه الكسرة في الرفع والنصب ليست بإعراب فكذلك يجب أن يحكم عليها في باب الجر إذ الاسم واحد فالحكم عليه إذاً في الحلات واحد.
إلا أن لفظ هذه الحركة في حال الجر وإن لم تكن إعراباً لفظها لو كانت إعراباً كما أن كسرة الصاد في صِنْو غير كسرة الصاد في صِنْوان حكماً وإن كانت إياها لفظاً.
وقد مضى ذلك وسنفرد لما يتصل به باباً.
ومن ذلك ما كانت فيه اللام أو الإضافة نحو الرجل وغلامك وصاحب الرجل.
فهذه الأسماء كلها وما كان نحوها لا منصرفة ولا غير منصرفة.
وذلك أنها ليست بمنونة فتكون منصرفة ولا مما يجوز للتنوين حلوله للصرف فإذا لم يوجد فيه كان عدمه منه أمارة لكونه غير منصرف كأحمد وعمر وإبراهيم ونحو ذلك.
وكذلك التثنية والجمع على حدها نحو الزيدان والعمرين والمحمدون وليس شيء من ذلك منصرفاً ولا غير منصرف معرفة كان أو نكرة من حيث كانت هذه الأسماء ليس مما ينون مثلها فإذا لم يوجد فيها التنوين كان ذهابه عنها أمارة لترك صرفها.
ومن ذلك بيت الكتاب: له زجل كأنه صوت حاد فحذف الواو من قوله كأنه لا على حد الوقف ولا على حد الوصل.
أما الوقف فيقضى بالسكون: كأنْه.
وأما الوصل فيقضى بالمَطْل وتمكين الواو: كأنهو فقوله إذاً كأنهُ منزلة بين الوصل والوقف.
وكذلك أيضاً سواءً قوله: يا مرحباه بحمار ناجيه إذا أتى قربته للسانيه فثبات الهاء في مرحباه ليس على حد الوقف ولا على حد الوصل: أما الوقف فيؤذن بأنها ساكنة: يا مرحباهْ.
وأما الوصل فيؤذن بحذفها أصلاً: يامرحبا بحماز ناجية.
فثباتها إذاً في الوصل متحركة منزلة بين المنزلتين.
وكذلك سواء قوله: ببازلٍ وجناءً أو عًيْهلِّ فإثبات الياء مع التضعيف طريف.
وذلك أن التثقيل من أمارة الوقف والياء من أمارة الإطلاق.
فظاهر هذا الجمع بين الضدين فهو إذاً منزلة بين المنزلتين.
وسبب جواز الجمع بينهما أن كل واحد منهما قد كان جائزاً على انفراده فإذا جمع بينهما فإنه على كل حال لم يكلف إلا بما من عادته أن يأتي به مفرداً وليس على النظر بحقيقة الضدين كالسواد والبياض والحركة والسكون فيستحيل اجتماعهما.
فتضادهما إذاً إنما هو في الصناعة لا في الطبيعة.
والطريق متلئبة منقادة والتأمل يوضحها ويمكنك منها.
باب في شجاعة العربية
اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف.
الحذف قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة.
وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه.
وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته.
فأما الجملة فنحو قولهم في القسم: والله لا فعلت وتالله لقد فعلت.
وأصله: أقسم بالله فحذف الفعل والفاعل وبقيت الحال من الجار والجواب دليلاً على الجملة المحذوفة.
وكذلك الأفعال في الأمر والنهي والتحضيض نحو قولك: زيداً إذا أردت: اضرب زيداً أو نحوه.
ومنه إياك إذا حذرته أي احفظ نفسك ولا تضعها والطريق الطريق وهلا خيرا من ذلك.
وقد حذفت الجملة من الخبر نحو قولك: القرطاس والله أي أصاب القرطاس.
وخير مقدم أي قدمت خير مقدم.
وكذلك الشرط في نحو قوله: الناس مجزيون بأفعالهم إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً أي إن فعل المرء خيراً جزى خيراً وإن فعل شراً جزي شراً.
ومنه قول التغلبي: إذا ما الماء خالطها سخينا أي فشربنا سخيناً وعليه قول الله سبحانه: {فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً} أي فضرب فانفجرت وقوله عز اسمه: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} أي فحلق فعليه فدية.
ومن ه قولهم: ألا تا بلى فا أي ألا تفعل بلى فافعل وقول الآخر: قلنا لها قفي لنا قالت قاف أي وقفت وقوله: .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وكأن قد أي كأنها قد زالت.
فأما قوله: إذا قيل مهلاً قال حاجزه قد فيكون على هذا أي قد قطع وأغنى.
ويجوز أن يكون معناه: قَدْك! أي حسبك كأنه قد فرغ ما قد أريد منه فلا معنى لردعك وزجرك.
وإنما تحذف الجملة من الفعل الفاعل لمشابهتها المفرد بكون الفاعل في كثير من الأمر بمنزلة الجزء من الفعل نحو ضربت ويضربان وقامت هند و {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ} وحبذا زيد وما أشبه ذلك مما يدل على شدة اتصال الفعل بالفاعل وكونه معه كالجزء الواحد.
وليس كذلك المبتدأ والخبر.
وأما حذف المفرد فعلى ثلاثة أضرب: اسم وفعل وحرف.
حذف الاسم على أضرب قد حذف المبتدأ تارة نحو هل لك في كذا وكذا أي هل لك فيه حاجة أو أرب.
وكذلك قوله عز وجل: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ} أي ذلك أو هذا بلاغ.
وهو كثير.
وقد حذف الخبر نحو قولهم في جواب من عندك: زيد أي زيد عندي.
وكذا قوله تعالى: {طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ} وإن شئت كان على: طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما وإن شئت كان على: أمرنا طاعة وقول معروف.
وعليه قوله: فقالت: على اسم الله أمرك طاعة وإن كنت قد كلفت ما لم أعود وقد حذف المضاف وذلك كثير واسع وإن كان أبو الحسن لا يرى القياس عليه نحو قول الله سبحانه: {وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} أي بر من اتقى.
وإن شئت كان تقديره: ولكن ذا البر من اتقى.
والأول أجود لأن حذف المضاف ضرب من الاتساع والخبر أولى بذلك من المبتدأ لأن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور.
ومنه قوله عز اسمه: { وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } أي أهلها.
وقد حذف المضاف مكرراً نحو قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} أي من تراب أثر حافر فرس الرسول.
ومثله مسئلة الكتاب: أنت منى فرسخان أي ذو مسافة فرسخين.
وكذلك قوله جل اسمه: {يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ} أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت.
وقد حذف المضاف إليه نحو قوله تعالى: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} أي من قبل ذلك ومن بعده.
وقولهم: ابدأ بهذا أول أي أول ما تفعل.
وإن شئت كان تقديره: أول من غيره ثم شبه الجار والمجرور هنا بالمضاف إليه لمعاقبة المضاف إليه إياهما.
وكذلك قولهم: جئت من عل أي من أعلى كذا وقوله: فملك بالليط الذي تحت قشرها كغرقئ بيضٍ كنه القيض من علُ فأما قوله: فلا حذف فيه لأنه نكرة ولذلك أعربه فكأنه قال: حطه السيل من مكان عالٍ لكن قول العجلي: أقب من تحت عريض من عل هو محذوف المضاف إليه لأنه معرفة وفي موضع المبني على الضم ألا تراه قابل به ما هذه حاله وهو قوله: من تحت.
وينبغي أن يكتب " علي " في هذا بالياء.
وهو فعل في معنى فاعل أي أقب من تحته عريض من عاليه بمعنى أعلاه.
والسافل والعالي بمنزلة الأسفل والأعلى.
قال: ما هو إلا الموت يغلي غاليه مختلطاً سافله بعاليه لا بد يوماً أنني ملاقيه ونظير عالٍ وعلٍ هنا قوله: وقد علتني ذرأة بادي بدي أي باديَ باديَ.
وإن شئت كان ظرفاً غير مركب أي في بادى بدي كقوله: عز اسمه: {بَادِيَ الرَّأْيِ} أي في بادي الرأي إلا أنه أسكن الياء في موضع النصب مضطراً كقوله: يا دار هند عفت إلا أثافيها وإن شئت كان مركباً على حد قوله: إلا أنه أسكن لطول الاسم بالتركيب كمعدي كرب.
ومثل فاعل وفعل في هذا المعنى قوله: أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يردا إلا عراداً عردا وصلياناً بردا وعنكثاً ملتبدا أراد: الإعراد عارداً وصليانا باردا.
وعليه قوله: كأن في الفرش القتاد العاردا فأما قولهم: عرد الشتاء فيجوز أن يكون مخففاً من عرد هذا.
ويجوز أن يكون مثالاً في الصفة على فعل كصعب وندب.
ومنه يومئذ وحينئذ ونحو ذلك أي إذ ذاك كذلك فحذفت الجملة المضاف إليها.
وعليه قول ذي الرمة: فلما لبسن الليل أو حين نصبت له من خذا آذانها وهو جانح أي: أو حين أقبل.
وحكى الكسائي: أفوق تنام أم أسفل حذف المضاف ولم يبن.
وسمع أيضاً: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} فحذف ولم يبن.
وقد حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأكثر ذلك في الشعر.
وإنما كانت كثرته فيه دون النثر من حيث كان القياس يكاد يحظره.
وذلك أن الصفة في الكلام على ضربين: إما للتخليص والتخصيص وإما للمدح الثناء.
وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب لا من مظان الإيجاز والاختصار.
وإذا كان كذلك لم يلق الحذف به ولا تخفيف اللفظ منه.
هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من الإلباس وضد البيان.
ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بطويل لم يستبن من ظاهر هذا اللفظ أن الممرور به إنسان دون رمح أو ثوب أو نحو ذلك.
وإذا كان كذلك كان حذف الموصوف إنما هو متى قام الدليل عليه أو شهدت الحال به.
وكلما استبهم الموصوف كان حذفه غير لائق بالحديث.
ومما يؤكد عندك ضعف حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أنك تجد من الصفات ما لا يمكن حذف موصوفه.
وذلك أن تكون الصفة جملة نحو مررت برجل قام أخوه ولقيت غلاماً وجهه حسن.
ألا تراك لو قلت: مررت بقام أخوه أو لقيت وجهه حسن لم يحسن.
فأما قوله: والله ما زيد بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه فقد قيل فيه: إن نام صاحبه علم اسم لرجل وإذا كان كذلك جرى مجرى قوله: بني شاب قرناها.
.
.
.
.
.
ولا مخالط الليان جانبه ليس علماً وإنما هو صفة وهو معطوف على نام صاحبه صفة أيضاً.
قيل: قد يكون في الجمل إذا سمى بها معاني الأفعال فيها.
ألا ترى أن شاب قرناها تصر وتحلب هو اسم علم وفيه مع ذلك معنى الذم.
وإذا كان كذلك جاز أن يكون قوله: ولا مخالط الليان جانبه معطوفاً على ما في قوله ما زيد بنام صاحبه من معنى الفعل.
فأما قوله: مالك عندي غير سهم وحجر وغير كبداء شديدة الوتر جادت بكفي كان من أرمى البشر أي بكفي رجل أو إنسان كان من أرمى البشر فقد روى غير هذه الرواية.
روى: بكفى كان من أرمى البشر بفتح ميم من أي بكفى من هو أرمى البشر وكان على هذا زائدة.
ولو لم تكن فيه إلا هذه الرواية لما جاز القياس عليه لفروده وشذوذه عما عليه عقد هذا الموضع.
ألا تراك لا تقول: مررت بوجهه حسن ولا نظرت إلى غلامه سعيد.
فأما قولهم بدأت بالحمد لله وانتهيت من القرآن إلى {أَتَى أَمْرُ اللّهِ} ونحو ذلك فلا يدخل على هذا القول من قبل أن هذه طريق الحكاية وما كان كذلك فالخطب فيه أيسر والشناعة فيه أوهى وأسقط.
وليس منا كنا عليه مذهباً له تعلق بحديث الحكاية.
وكذاك إن كانت الصفة جملة لم يجز أ تقع فاعلة ولا مقامة مقام الفاعل ألا تراك لا تجيز قام وجهه حسن ولا ضرب قام غلامه وأنت تريد: قام رجل وجهه حسن ولا ضرب إنسان قام غلامه.
وكذاك إن كانت الصفة حرف جر أو ظرفاً لا يستعمل استعمال الأسماء.
فلو قلت: جاءني من الكرام أي رجل من الكرام.
أو حضرني سواك أي إنسان سواك لم يجسن لأن الفاعل لا يحذف.
فأما قوله: أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل فليست الكاف هنا حرف جر بل هي اسم بمنزلة مثل كالتي في قوله: على كالقطا الجوني أفزعه الزجر وكالكاف الثانية من قوله: وصاليات ككما يؤثفين أي كمثل ما يؤثفين وعليه قول ذي الرمة: أبيت على مي كئيباً وبعلها على كالنقا من عالج يتبطح فأما قول الهذلي: فلم يبق منها سوى هامد وغير الثمام وغير النؤى ففيه قولان: أحدهما أن يكون في يبق ضمير فاعل من بعض ما تقدم كذا قال أبو علي رحمه الله.
والآخر أن يكون استعمل سوى للضرورة اسماً فرفعه.
وكأن هذا أقوى لأن بعده: وغير الثمام وغير النؤى فكأنه قال: لم يبق منها غير هامد.
ومثله ما أنشدناه للفرزدق من قوله: أئته بمجلوم كأن جبينه صلاءة ورس وسطها قد تفلقا وعليه قول الآخر: في وسط جمع بني قريط بعدما هتفت ربيعة يا بني جواب وقد أقيمت الصفة الجملة مقام الموصوف المبتدأ نحو قوله: لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم أي ما في قومها أجد يفضلها وقال الله سبحانه: {وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} أي قوم دون ذلك.
وأما قوله تعالى: {لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} فيمن قرأه بالنصب فيحتمل أمرين: أحدهما أن يكون الفاعل مضمراً أي لقد تقطع الأمر أو العقد أو الود ونحو ذلك بينكم.
والآخر أن يكون ما كان يراه أبو الحسن من أن يكون " بينكم " وإن كان منصوب اللفظ مرفوع الموضع بفعله غير أنه أقرت نصبة الظرف وإن كان مرفوع الموضع لاطراد استعمالهم إياه ظرفاً.
إلا أن استعمال الجملة التي هي صفة للمبتدأ مكانه أسهل من استعمالها فاعلة لأنه ليس يلزم أن يكون المبتدأ اسماً محضاً.
كلزوم ذلك في الفاعل ألا ترى إلى قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أي سماعك به خير من رؤيته.
وقد تقصينا ذلك في غير موضع.
وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها.
وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سير عليه ليل وهم يريدون: ليل طويل.
وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها.
وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك.
وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته.
وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلاً فتزيد في قوة اللفظ بالله هذه الكلمة وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها أي رجلاً فاضلاً أو شجاعاً أو كريماً أو نحو ذلك.
وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنساناً وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنساناً سمحاً أو جواداً أو نحو ذلك.
وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت: سألناه وكان إنساناً وتزوى وجهك وتقطبه فيغنى ذلك عن قولك: إنساناً لئيما أو لحزا أو مبخلا أو نحو ذلك.
فعلى هذا وما يجري مجراه تحذف الصفة.
فأما إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها لا يجوز ألا تراك لو قلت: وردنا البصرة فاجتزنا بالأبلة على رجل أو رأينا بستاناً وسكت لم تفد بذلك شيئاً لأن هذا ونحوه مما لا يعرى منه ذلك المكان وإنما المتوقع أن تصف من ذكرت أو ما ذكرت فإن لم تفعل كلفت علم ما لم تدلل عليه وهذا لغو من الحديث وجور في التكليف.
ومن ذلك ما يروى في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أي لا صلاة كاملة أو فاضلة ونحو ذلك.
وقد خالف في ذلك من لا يعد خلافه خلافاً.
وقد حذف المفعول به نحو قول الله تعالى: {وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ} أي أوتيت منه شيئاً.
وعليه قول الله سبحانه: {فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى} أي غشاها إياه.
فحذف المفعولين جميعاً.
وقال الحطيئة: منعمة تصون إليك منها كصونك من رداء شرعبي أي تصون الحديث منها.
وله نظائر.
وقد حذف الظرف نحو قوله: فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي على الجيب يا ابنة معبد أي إن مت قبلك هذا يريد لا محالة.
ألا ترى أنه لا يجوز أن يشرط الإنسان موته لأنه يعلم أهيم بدعدٍ ما حييت فإن أمت أوكل بدعدٍ من يهيم بها بعدي أي فإن أمت قبلها لا بد أن يريد هذا.
وعلى هذا قول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} أي من شهد الشهر منكم صحيحاً بالغاً في مصرٍ فليصمه.
وكان أبو علي رحمه الله يرى أن نصب الشهر هنا إنما هو على الظرف ويذهب إلى أن المفعول محذوف أي فمن شهد منكم المصر في هذا الشهر فليصمه.
وكيف تصرفت الحال فلا بد من حذف.
وقد حذف المعطوف تارة والمعطوف عليه أخرى.
روينا عن أحمد بن يحيى أنهم يقولون: راكب الناقة طليحان أي راكب الناقة والناقة طليحان.
وقد مضى ذكر هذا.
وتقول: الذي ضربت وزيداً جعفر تريد الذي ضربته وزيداً فتحذف المفعول من الصلة.
وقد حذف المستثنى نحو قولهم: جاءني زيد ليس إلا وليس غير أي ليس إلا إياه وليس غيره.
وقد حذف خبر إن مع النكرة خاصة نحو قول الأعشى: إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا أي إن لنا محلا وإن لنا مرتحلا.
وأصحا بنا يجيزون حذف خبر إن مع المعرفة ويحكون عنهم أنهم إذ قيل لهم إن الناس ألب عليكم فمن لكم قالوا: إن زيداً وإن عمرا أي إن لنا زيداً وإن لنا عمرا.
والكوفيون يأبون حذف خبرها إلا مع النكرة.
فأما احتجاج أبي العباس عليهم بقوله: خلا أن حيا من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم نهشلا أي أو أن الأكارم نهشلا تفضلوا.
قال أبو علي: وهذا لا يلزمهم لأن لهم أن يقولوا: إنما منعنا حذف خبر المعرفة مع إن المكسورة فأما مع أن المفتوحة فلن نمنعه.
قال: ووجه فصلهم فيه بين المكسورة والمفتوحة أن المكسورة حذف خبرها كما حذف خبر نقيضها.
وهو قولهم لا بأسَ ولا شكّ أي عليك وفيه.
فكما أن لا تختص هنا بالنكرات فكذلك إنما تشبهها نقيضتها في حذف الخبر مع النكرة أيضاً.
وقد حذف أحد مفعولي ظننت.
وذلك نحو قولهم: أزيدا ظننته منطلقاً ألا ترى أن تقديره: أظننت زيداً منطلقاً ظننته منطلقاً فلما أضمرت الفعل فسرته بقولك: ظننته وحذفت المفعول الثاني من الفعل الأول المقدر اكتفاء بالمفعول الثاني الظاهر في الفعل الآخر.
وكذلك بقية أخوات ظننت.
وقد حذف خبر كان أيضاً في نحو قوله: أسكرانُ كان ابنَ المراغة إذ هجا تميما ببطن الشأم أم متساكر ألا ترى أن تقديره: أكان سكرانُ ابن المراغة فلما حذف الفعل الرافع فسره بالثاني فقال: كان ابن المراغة.
وابن المراغة هذا الظاهر خبر " كان " الظاهرة وخبر " كان " المضمر محذوف معها لأن " كان " الثانية دلت على الأولى.
وكذلك الخبر الثاني الظاهر دل على الخبر الأول المحذوف.
وقد حذف المنادى فيما أنشده أبو زيد من قوله: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا أراد: يا لبني فلان ونحو ذلك.
فإن قلت: فكيف جاز تعليق حرف الحر قيل: لما خلط بيا صار كالجزء منها.
ولذلك شبه أبو علي ألفه التي قبل اللام بألف باب ودار فحكم عليها حينئذ بالانقلاب.
وقد ذكرنا ذلك.
وحسن الحال أيضاً شيء آخر وهو تشبث اللام الجارة بألف الإطلاق فصارت كأنها معاقبة للمجرور.
ألا ترى أنك لو أظهرت ذلك المضاف إليه فقلت: يا لبني فلان لم يجز إلحاق الألف هنا وجرت ألف الإطلاق في منابها هنا عما كان ينبغي أن يكون بمكانها مجرى ألف الإطلاق في منابها عن تاء التأنيث في نحو قوله: ولاعب بالعشيِّ بني بنيه كفعل الهِرِّ يحترش العَظَايا وكذلك نابت أيضاً واو الإطلاق في قوله: وما كل من وافى مني أنا عارف فيمن رفع كلا عن الضمير الذي يزاد في عارفه وكما ناب التنوين في نحو حينئذ ويومئذ عن المضاف إليه إذْ.
وعليه قوله: نهيتك عن طلابك أم عمرو بعاقبة وأنت إذٍ صحيح فأما قوله تعالى: { ألا يا اسجدوا } فقد تقدم القول عليه: أنه ليس المنادى هنا محذوفاً ولا مراداً كما ذهب إليه محمد بن يزيد وأن " يا " هنا أخلصت للتنبيه مجرداً من النداء كما أن " ها " من قول الله تعالى: {هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ} للتنبيه من غير أن تكون للنداء.
وتأول أبو العباس قول الشاعر: طلبوا صلحنا ولات أوانٍ فأجبنا أن ليس حين بقاء قول الجماعة في تنوين إذْ.
وهذا ليس بالسهل.
وذلك أن التنوين في نحو هذا إنما دخل فيما لا يضاف إلى الواحد وهو إذ.
فأما " أوان " فمعرب ويضاف إلى الواحد كقوله: فهذا أوان العرض حي ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس وقد كسروه على آونة وتكسيرهم إياه يبعده عن البناء لأنه أخذ به في شق التصريف قال: أبو حنشٍ يؤرقنا وطلقٌ وعبادٌ وآونةً أثالا وقد حذف المميز.
وذلك إذا علم من الحال حكم ما كان يعلم منها به.
وذلك قولك: عندي عشرون واشتريت ثلاثين وملكت خمسة وأربعين.
فإن لم يعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة.
فإن لم يرد ذلك وأراد الإلغاز وحذف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز.
وهذا إنما يصلحه ويفسده غرض المتكلم وعليه مدار الكلام.
فاعرفه.
وحذف الحال لا يحسن.
وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بها وما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف لأنه ضد الغرض ونقيضه ولأجل ذلك لم يجز أبو الحسن توكيد الهاء المحذوفة من الصلة نحو الذي ضربت نفسه زيد على أن يكون نفسه توكيداً للهاء المحذوفة من ضربت وهذا مما يترك مثله كما يترك إدغام الملحق إشفاقاً من انتقاض الغرض بإدغامه.
فأما ما أجزناه من حذف الحال في قول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} أي فمن شهده صحيحاً بالغاً فطريقه أنه لما دلت الدلالة عليه من الإجمع والسنة جاز حذفه تخفيفاً.
وأما لو عريت الحال من هذه القرينة وتجرد الأمر دونها لما جاز حذف الحال على وجه.
ولم أعلم المصدر حذف في موضع.
وذلك أن الغرض فيه إذا تجرد من الصفة أو التعريف أو عدد المرات فإنما هو لتوكيد الفعل وحذف المؤكد لا يجوز.
وإنما كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد.
فأما حذفه إذا لم يرد فسائغ لا سؤال فيه.
وذلك كقولنا: انطلق زيد ألا ترى هذا كلاماً تاماً وإن لم تذكر معه شيئاً من الفضلات مصدراً ولا ظرفاً ولا حالاً ولا مفعولاً له ولا مفعولاً معه ولا غيره.
وذلك أنك لم ترد الزيادة في الفائدة بأكثر من الإخبار عنه بانطلاقه دون غيره.
حذف الفعل حذف الفعل على ضربين: أحدهما أن تحذفه والفاعل فيه.
فإذا وقع ذلك فهو حذف جملة.
وذلك نحو زيداً ضربته لأنك أردت: ضربت زيداً فلما أضمرت ضربت فسرته بقولك: ضربته.
وكذلك قولك: أزيدا مررت به وقولهم: المرء مقتول بما قَتَل به إن سيفاً فسيف وإن خنجراً فخنجر أي إن كان الذي قَتَل به سيفاً فالذي يُقتل به سيف.
فكان واسمها وإن لم تكن مستقلة فإنها تعتد اعتداد الجملة.
وذلك أن يكون الفاعل مفصولا عنه مرفوعاً به.
وذلك نحو قولك: أزيد قام.
فزيد مرفوع بفعل مضمر محذوف خال من الفاعل لأنك تريد: أقام زيد فلما أضمرته فسرته بقولك: قام.
وكذلك {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} و {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} و {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} و {لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي} ونحوه الفعل فيه مضمر وحده أي إذا انشقت السماء وإذا كورت الشمس وإن هلك امرؤ ولو تملكون.
وعليه قوله: إذا ابنُ أبي موسى بلالٌ بلغته فقام بفأس بين وصليك جازر أي إذا بلغ ابن أبي موسى.
وعبرة هذا أن الفعل المضمر إذا كان بعده اسم منصوب به ففيه فاعله مضمراً.
وإن كان بعده المرفوع به فهو مضمر مجرداً من الفاعل ألا ترى أنه لا يرتفع فاعلان به.
وربما جاء بعده المرفوع والمنصوب جميعاً نحو قولهم: أما أنت منطلقاً انطلقتُ معك تقديره: لأن كنت منطلقاً انطلقتُ معك فحذف الفعل فصار تقديره: لأن أنت منطلقاً وكرهت مباشرة " أن " الاسم فزيدت " ما " فصارت عوضاً من الفعل ومصلحة للفظ لنزول مباشرة أن الاسم.
وعليه بيت الكتاب: أبا خراشسة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع أي لأن كنت ذا نفر قويت وشددت والضبع هنا السنة الشديدة.
قيل: بما لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب فعملت عمله من الرفع والنصب.
وهذه طريقة أبي علي وجلة أصحابنا من قبله في أن الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر ما كان المحذوف يليه.
من ذلك الظرف إذا تعلق بالمحذوف فإنه يتضمن الضمير الذي كان فيه ويعمل ما كان يعمله: من نصبه الحال والظرف.
وعلى ذلك صار قوله: فاه إلى في من قوله: كلمته فاه إلى في ضامناً للضمير الذي كان في جاعلا لما عاقبه.
والطريق واضحة فيه متلئبة.
حذف الحرف قد حذف الحرف في الكلام على ضربين: أحدهما حرف زائد على الكلمة مما يجيء لمعنى.
والآخر حرف من نفس الكلمة.
وقد تقدم فيما مضى ذكر حذف هذين الضربين بما أغنى عن إعادته.
ومضت الزيادة في الحروف وغيرها.
فصل في التقديم والتأخير.
وذلك على ضربين: أحدهما ما يقبله القياس.
والآخر ما يسهله الاضطرار.
الأول كتقديم المفعول على الفاعل تارة وعلى الفعل الناصبة أخرى كضرب زيداً عمرو وزيداً ضرب عمرو.
وكذلك الظرف نحو قام عندك زيد وعندك قام زيد وسار يوم الجمعة جعفر ويوم الجمعة سار جعفر.
وكذلك الحال نحو جا ضاحكاً زيد وضاحكاً جاء زيد.
وكذلك الاستثناء نحو ما قام إلا زيداً أحد.
ولا يجوز تقديم المستثنى على الفعل الناصب له.
لو قلت: إلا زيداً قام القوم لم يجز لمضارعة الاستثناء البدل ألا تراك تقول: ما قام أحد إلا زيداً وإلا زيد والمعنى واحد.
فما جارى الاستثناء البدل امتنع تقديمه.
فإن قلت: فكيف جاز تقديمه على المستثنى منه والبدل لا يصح تقديمه على المبدل منه.
قيل: لما تجاذب المستثنى شبهان: أحدهما كونه مفعولا والآخر كونه بدلاً خليت له منزلة وسيطة فقدم على المستثنى منه وأخر البتة عن الفعل الناصبة.
فأما قولهم: ما مررت إلا زيداً بأحد فإنما تقدم على الباء لأنها ليست هي الناصبة له إنما الناصب له على كل حال نفس مررت.
وما يصح ويجوز تقديمه خبر المبتدأ نحو قائم أخوك وفي الدار صاحبك.
وكذلك خبر كان وأخواتها على أسمائها وعليها أنفسها.
وكذلك خبر ليس نحو زيدا ليس أخوك ومنطلقين ليس أخواك.
وامتناع أبي العباس من ذلك خلاف للفرقين: البصريين والكوفيين وترك لموجب القياس عند النظار والمتكلمين وقد ذكرنا ذلك في غير مكان.
ويجوز تقديم المفعول له على الفعل الناصبة نحو قولك: طمعاً في برك زرتك ورغبة في ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل نحو قولك: والطيالسة جاء البرد من حيث كانت صورة هذه الواو صورة العاطفة ألا تراك لا تستعملها إلا في الموضع الذي لو شئت لا استعملت العاطفة فيه نحو جاء البرد والطيالسة.
ولو شئت لرفت الطيالسة عطفاً على البرد.
وكذلك لو تركت والأسد لأكلك يجوز أن ترفع الأسد عطفاً على التاء.
ولهذا لم يجز أبو الحسن جئتك وطلوع الشمس أي مع طلوع الشمس لأنك لو أردت أن تعطف بها هنا فتقول: أتيتك وطلوع الشمس لم يجز لأن طلوع الشمس لا يصح إتيانه لك.
فلما ساوقت حرف المعطف قبح والطيلالسة جاء البرد كما قبح وزيد قام عمرو لكنه يجوز جاء والطيالسة البردُ كما تقول: ضربت وزيداً عمرا قال: جمعتَ وفحشا غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعو ومما يقبح تقديمه الاسم المميز وإن كان الناصبة فعلاً متصرفاً.
فلا نجيز شحما تفقأت ولا عرقا تصببت.
فأما ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه أبو العباس من قول المخبل أتهجر ليلى للفراق حبيها وما كان نفساً بالفراق يطيب فتقابله برواية الزجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق أيضاً: وما كان نفسي بالفراق تطيب فرواية برواية والقياس من بعد حاكم.
وذلك أن هذا المميز هو الفاعل في المعنى ألا ترى أن أصل الكلام تصبب عرقي وتفقأ شحمي ثم نقل الفعل فصار في اللفظ لي فخرج الفاعل في الفاصل مميزاً فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فكذلك لا يجوز تقديم المميز إّ كان هو الفاعل في المعنى على الفعل.
فإن قلت: فقد تقدم الحال على العامل فيها وإن كانت الحال هي صاحبة الحال في المعنى نحو قولك: راكباً جئت و { خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ}.
قيل: الفرق أن الحال لم تكن في الأصل هي الفاعلة كما كان المميز كذلك ألا ترى أنه ليس التقدير والأصل: جاء راكبي كما أن أصل طبت به نفسا طابت به نفسي وإنما الحال مفعول فيها كالظرف ولم تكن قط فاعلة فنقل الفعل عنها.
فأما كونها هي الفاعل في المعنى فككون خبر كان هو اسمها الجاري مجرى الفاعل في المعنى وأنت تقدمه على كان فتقول: قائماً كان زيد ولا تجيز تقديم اسمها عليها.
فهذا فرق.
وكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل فكذلك لا يجوز تقديم ما أقيم مقام الفاعل كضرب زيد.
وبعد فليس في الدنيا مرفوع يجوز تقديمه على رافعه.
فأما خبر المبتدأ فلم يتقدم عند على رافعه لأن رافعه ليس المبتدأ وحده إنما الرافع له المبتدأ والابتداء جميعاً فلم يتقدم الخبر عليهما معاً وإنما تقدم على أحدهما وهو المبتدأ.
فهذا لا ينتقض.
لكنه على قول أبي الحسن مرفوع بالمبتدأ وحده ولو كان كذلك لم يجز تقديمه على المبتدأ.
ولا يجوز تقديم الصلة ولا شيء منها على الموصول ولا الصفة على الموصوف ولا المبدل على المبدل منه ولا عطف البيان على المعطوف عليه ولا العطف الذي هو نسق على المعطوف عليه إلا في الواو وحدها وعلى قلته أيضاً نحو قام وعمرو زيد.
وأسهل منه ضربت وعمرا زيدا لأن الفعل في هذا قد استقل بفاعله وفي قولك: قام وعمرو زيد اتسعت في الكلام قبل الاستقلال والتمام.
فأما قوله: ألا يا نخلةً من ذات عرق عليك ورحمةُ الله السلام فحملته الجماعة على هذا حتى كأنه عندها: عليك السلام ورحمة الله.
وهذا وجه إلا أن عندي فيه وجهاً لا تقديم فيه ولا تأخير من قبل العطف.
وهو أن يكون رحمة الله معطوفاً على الضمير في عليك.
وذلك أن السلام مرفوع بالابتداء وخبره مقدم عليه وهو عليك ففيه إذاً ضمير منه مرفوع بالظرف فإذا عطفت رحمة الله عليه ذهب عنك مكروه التقديم.
لكن فيه العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير توكيد له وهذا أسهل عندي من تقديم قلت إذ أقبلت وزهرٌ تهادى كنعاج الملا تعسفن رملا وذهب بعضهم في قول الله تعالى: {فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى} إلى أن هو معطوف على الضمير في استوى.
ومما يضعف تقديم المعطوف على المعطوف عليه من جهة القياس أنك إذا قلت: قام وزيد عمرو فقد جمعت أمام زيد بين عاملين: أحدهما قام والآخر الواو ألا تراها قائمة مقام العامل قبلها وإذا صرت إلى ذلك صرت كأنك قد أعملت فيه عاملين وليس هذا كإعمال الأول أو الثاني في نحو قام وقعد زيد لأنك في هذا مخير: إن شئت أعملت الأول وإن شئت أعملت الآخر.
وليس ذلك في نحو قام زيد وعمرو لأنك لا ترفع عمرا في هذا إلا بالأول.
فإن قلت: فقد تقول في الفعلين جميعاً بإعمال أحدهما البتة كقوله: كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال قيل: لم يجب هذا في هذا البيت لشيء يرجع إلى العمل اللفظي وإنما هو شيء راجع إلى المعنى وليس كذلك قام وزيد عمرو لأن هذا كذا حاله ومعناه واحد تقدم أو تأخر.
فقد عرفت ما في هذا الحديث.
ولا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف ولا شيء ما اتصل به.
ولا يجوز تقديم الجواب على المجاب شرطاً كان أو قسماً أو غيرهما ألا تراك لا تقول: أقُمْ إن تَقُمْ.
فأما قولك أقوم إن قمت فإن قولك: أقوم ليس جواباً للشرط ولكنه دال على الجواب أي إن قمت قمت ودلت أقوم على قمت.
ومثله أنت ظالم إن فعلت أي إن فعلت ظلمت فحذفت ظلمت ودل قولك: أنت ظالم عليه.
فأما قوله: فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت فطعنة لاغس ولا بمغمر فذهب أبو زيد إلى أنه أراد: إن ينج منها فلم أرقه وقدم الجواب.
وهذا عند كافة أصحابنا غير جائز.
والقياس له دافع وعنه حاجز.
وذلك أن جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط ومحال تقدم المجزوم على جازمه بل إذا كان الجار وهو أقوى من الجازم لأن عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال لا يجوز تقديم ما انجر به عليه كان ألا يجوز تقديم المجزوم على جازمه أحرى وأجدر.
وإذا كان كذلك فقد وجب النظر في البيت.
ووجه القول عليه أن الفاء في قوله: فلم أرقه لا يخلو أن تكون معلقة بما قبلها أو زائدة وأيهما كان فكأنه قال: لم أرقه إن ينج منها وقد علم أن لم أفعل نفي فعلت وقد أنابوا فعلت عن جواب الشرط وجعلوه دليلاً عليه في قوله: أي إن لم تحب أوديت.
فجعل أوديت دليلاً على أوديت هذه المؤخرة.
فكما جاز أن تجعل فعلت دليلاً على جواب الشرط المحذوف كذلك جعل نفيها الذي هو لم أفعل دليلاً على جوابه.
والعرب قد تجري الشيء مجرى نقيضه كما تجريه مجرى نظيره ألا تراهم قالوا: جوعان كما قالوا: شبعان وقالوا: علم كما قالوا: جهل وقالوا: كثر ما تقومن كما قالوا: قلما تقومن.
وذهب الكسائي في قوله: إذا رضيت على بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها إلى أنه عدى رضيت بعلى لما كان ضد سخطت وسخطت مما يعدي بعلى وهذا واضح.
وكان أبو علي يستحسنه من الكسائي.
فكأنه قال: إن ينج منها ينج غير مرقي منها وصار قوله: لم أرقه بدلاً من الجواب ودليلاً عليه.
فهذه وجوه التقديم والتأخير في كلام العرب.
وإن كنا تركنا منها شيئاً فإنه معلوم الحال ولاحق بما قدمناه.
وأما الفروق والفصول فمعلومة المواقع أيضاً.
فمن قبيح الفرق بين المضاف والمضاف إليه والفصل بين الفعل والفاعل بالأجنبي وهو دون الأول ألا ترى إلى جواز الفصل بينهما بالظرف نحو قولك: كان فيك زيد راغباً وقبح الفصل فلما للصلاة دعا المنادي نهضت وكنت منها في غرور وسترى ذلك.
ويلحق بالفعل والفاعل في ذل المبتدأ والخبر في قبح الفصل بينهما.
وعلى الجملة فكلما ازداد الجزءان اتصالاً قوي قبح الفصل بينهما.
فمن الفصول والتقديم والتأخير قوله: فقد والشك بين لي عناء بوشك فراقهم صرد يصيح أراد: فقد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم ولاشك عناء.
ففيه من الفصول ما أذكره.
وهو الفصل بين قد والفعل الذي هو بين.
وهذا قبيح لقوة اتصال قد بما تدخل عليه من الأفعال ألا تراها تعتد مع الفعل كالجزء منه.
ولذلك دخلت اللام المراد بها توكيد الفعل على قد في نحو قول الله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ} وقوله سبحانه: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ} وقوله: ولقد أجمع رجالي بها حذر الموت وإني لفرور فصل بين المبتدأ الذي هو الشك وبين الخبر الذي هو عناء بقوله: بين لي وفصل بين الفعل الذي هو بين وبين فاعله الذي هو صرد بخبر المبتدأ الذي هو عناء وقدم قوله: بوشك فراقهم وهو معمول يصيح ويصيح صفة لصرد على صرد وتقديم الصفة أو ما يتعلق بها على موصوفها قبيح ألا ترى أنك لا تجيز هذا اليوم رجل ورد من موضع كذا لأنك تريد: هذا رجل ورد اليوم من موضع كذا.
وإنما يجوز وقوع المعمول فيه بحيث يجوز وقوع العامل فكما لا يجوز تقديم الصفة على موصوفها كذلك لا يجوز تقديم ما اتصل بها على موصوفها كما لا يجوز تقديم معمول المضاف إليه على نفس المضاف لما لم يجز تقديم المضاف إليه عليه.
ولذلك لم يجز قولك: القتال زيدا حين تأتي وأنت تريد: القتال حين تأتي زيدا.
فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها وانخراق الأصول بها فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن دل من وجه على جوره وتعسفه فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه وليس بقاطع دليل على ضعف لغته ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته.
بل مثله في ذلك عندي مث لمجرى الجموح بلا لجام ووارد الحرب الضروس حاسراً من غير احتشام.
فهو وإن كان ملوماً في عنفه وتهالكه فإنه مشهود له بشجاعته وفيض منته ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر في سلاحه أو أعصم بلجام جواده لكان أقرب إلى النجاة وأبعد عن الملحاة لكنه جشم ما جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثله إدلالاً بقوة طبعه ودلالة على شهامة نفسه.
ومثله سواء ما يحكى عن بعض الأجواد أنه قال: أيرى البخلاء أننا لا نجد بأموالنا ما يجدون بأموالهم لكنا نرى أن في الثناء بإنفاقها عوضا من حفظها بإمساكها.
ونحو منه قولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثييها وقول الآخر: لا خير في طمع يدني إلى طبع وغفة من قوام العيش تكفيني فاعرف بما ذكرناه حال ما يرد في معناه وأن الشاعر إذا أورد منه شيئاً فكأنه لأنسه بعلم غرضه وسفور مراده لم يرتكب صعباً ولا جشم إلا أمما وافق بذلك قابلاً له أو صادف غير آنس به إلا أنه هو قد استرسل واثقاً وبنى الأمر على أن ليس ملتبساً.
ومن ذلك قوله: فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما أراد: فأصبحت بعد بهجتها قفراً كأن قلما خط رسومها.
ففصل بين المضاف الذي هو بعد والمضاف إليه الذي هو بهجتها بالفعل الذي هو خط وفصل أيضاً بخط بين أصبحت وخبرها الذي هو قفرا وفصل بين كأن واسمها الذي هو قلما بأجنبيين: أحدهما قفرا والآخر: رسومها ألا ترى أن رسومها مفعول خط الذي هو خبر كأن وأنت لا تجيز كأن خبزا زيداً آكل.
بل إذا لم تجز الفصل بين الفعل والفاعل على قوة الفعل في نحو كانت زيداً الحمى تأخذ كان ألا تجيز الفصل بين كأن واسمها بمفعول فاعلها أجدر.
نعم وأغلظ من ذا أنه قدم خبر كأن عليها وهو قوله: خط.
فهذا ونحوه مما لا يجوز لأحد قياس عليه.
غير أن فيه ما قدمناه ذكره من سمو الشاعر وتغطرفه وبأوه وتعجرفه.
فاعرفه واجتنبه.
ومن ذلك بيت الكتاب: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه وأما قول الفرزدق: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانتكليب تصاهره فإنه مستقيم ولا خبط فيه.
وذلك أنه أراد: إلى ملك أبوه ما أمه من محارب أي ما أم أبيه من محارب فقدم خبر الأب عليه وهو جملة كقولك: قام أخوها هند ومررت بغلامهما أخواك.
وتقول على هذا: فضته محرقة سرجها فرسك تريد: فرسك سرجها فضته محرقة ثم تقدم خبر السرج أيضاً عليه فتقول: فضته محرقة سرجها فرسك.
فإن زدت على هذا شيئاً قلت: أكثرها محرق فضته سرجها فرسك أردت: فرسك سرجها فضته أكثرها محرق فقدمت الجملة التي هي خبر عن الفضة عليها ونقلت الجمل عن مواضعها شيئاً فشيئاً.
وطريق تجاوز فأما قوله: معاوي لم ترع الأمانة فارعها وكن حافظاً لله والدين شاكر فإن شاكر هذه قبيلة.
أراد: لم ترع الأمانة شاكر فارعها وكن حافظاً لله والدين.
فهذا شيء من الاعتراض.
وقد قدمنا ذكره وعلة حسنه ووجه جوازه.
وأما قوله: يوماً تراها كمثل أردية العص ب ويوماً أديمها نغلا فإنه أراد: تراها يوماً كمثل أردية العصب وأديمها يوماً آخر نغلا.
ففصل بالظرف بين حرف العطف والمعطوف به على المنصوب من قبله وهو " ها " من تراها.
وهذا أسهل من قراءة من قرأ {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} إذا جعلت يعقوب في موضع جر وعليه تلقاه القوم من أنه مجرور الموضع.
وإنما كانت الآية أصعب مأخذاً من قبل أن حرف العطف منها الذي هو الواو ناب عن الجار الذي هو الباء في قوله بإسحاق وأقوى أحوال حرف العطف أن يكون في قوة العامل قبله وأن يلي من العمل ما كان الأول يليه والجار لا يجوز فصله من مجروره وهو في الآية قد فصل بين الواو ويعقوب بقوله {وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ}.
والفصل بين الجار ومجروره لا يجوز وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه.
وربما فرد الحرف منه فجاء منفوراً عنه قال: ففصل بين حرف الجر ومجروره بالظرف الذي هو منها وليس كذلك حرف العطف في قوله: .
.
.
ويوماً أديمها نغلا لأنه عطف على الناصب الذي هو ترى فكأن الواو أيضاً ناصبة والفصل بين الناصب ومنصوبه ليس كالفصل بين الجار ومجروره.
وليس كذلك قوله: فصلقنا في مراد صلقة وصداء ألحقتهم بالثلل فليس منه لأنه لم يفصل بين حرف العطف وما عطفه وإنما فيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمصدر الذي هو صلقة وفيه أيضاً الفصل بين الموصوف الذي هو صلقة وصفته التي هي قوله ألحقتهم بالثلل بالمعطوف والحرف العاطفة أعني قوله: وصداء وقد جاء مثله أنشدنا: أمرت من الكتان خيطاً وأرسلت رسولاً إلى أخرى جرياً يعينها أراد: وأرسلت إلى أخرى رسولاً جرياً.
والأحسن عندي في يعقوب من قوله عز اسمه: {وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} فيمن فتح أن يكون في موضع نصب بفعل مضمر دل عليه قوله {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ} أي وآتيناها يعقوب.
فإذا فعلت ذلك لم يكن فيه فصل بين الجار والمجرور.
فاعرفه.
فليست خراسان التي كان خالد بها أسد إذ كان سيفاً أميرها فحديثه طريف.
وذلك أنه فيما ذكر يمدح خالد بن الوليد ويهجو أسداً وكان أسد وليها بعد خالد قالوا فكأنه قال: وليست خراسان بالبلدة التي كان خالد بها سيفاً إذ كان أسد أميرها ففي كان على هذا ضمير الشأن والحديث والجملة بعدها التي هي أسد أميرها خبر عنها.
ففي هذا التنزيل أشياء: منها الفصل بين اسم كان الأولى وهو خالد وبين خبرها الذي هو سيفاً بقوله بها أسد إذ كان فهذا واحد.
وثان: أنه قدم بعضص ما إذ مضافة إليه وهو أسد عليها.
وفي تقديم المضاف إليه أو شيء منه على المضاف من القبح والفساد ما لا خفاء به ولا ارتياب.
وفيه أيضاً أن أسد أحد جزأي الجملة المفسرة للضمير على شريطة التفسير أعني ما في كان منه.
وهذا الضمير لا يكون تفسيره إلا من بعده.
ولو تقدم تفسيره قبله لما احتاج إلى تفسير ولما سماه الكوفيون الضمير المجهول.
فإن قلت: فقد قال الله تعالى: {فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقدم إذا وهي منصوبة بشاخصة وإنما يجوز وقعوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل فكأنه على هذا قال: فإذا هي شاخصة هي أبصار الذين كفروا وهي ضمير القصة وقد ترى كيف قدرت تقديم أحد الجزأين اللذين يفسرانها عليها فكما جاز هذا فكذلك يجوز أيضاً أن يقدم أسد على الضمير قيل: الفرق أن الآية إنما تقدم فيها الظرف المتعلق عندك بأحد جزأي تفسير الضمير وهو شاخصة والظرف مما يتسع الأمر فيه ولا تضيق مساحة التعذر له بأن تعلقه بمحذوف يدل عليه شاخصة أو شاخصة أبصار الذين كفروا كما تقول في أشياء كثيرة نحو قوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ} وقوله: {هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} وقول الشاعر: وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذا إنه عبد الفقا واللهازم فيمن كسر إن.
وأما البيت فإنه قدم فيه أحد الجزأين البتة وهو أسد.
وهذا ما لا يسمح به ولا يطوي كشح عليه.
وعلى أنه أيضاً قد يمكن أن تكون كان زائدة فيصير تقديره: إذ أسد أميرها.
فليس في هذا أكثر من شيء واحد وهو ما قدمنا ذكره من تقديم ما بعد إذ عليها وهي مضافة إليه.
وهذا أشبه من الأول ألا ترى أنه إنما نعى على خراسان إذ أسد أميرها لأنه إنما فضل أيام خالد المنقضية بها على أيام أسد المشاهدة فيها.
فلا حاجة به إذاً إلى كان لأنه أمر حاضر مشاهد.
فأما إذ هذه فمتعلقة بأحد شيئين: إما بليس وحدها وإما بما دلت عليه من غيرها حتى كأنه قال: خالفت خراسان إذ أسد أميرها حالتها التي كانت عليه لها أيام ولاية خالد لها على حد ما تقول فيما يضم للظروف لتتناولها وتصل إليها.
فإن قلت: فكيف يجوز لليس أن تعمل في الظرف وليس فيها تقدير حدث.
قيل: جاز ذلك فيها من حيث جاز أن ترفع وتنصب وكانت على مثال الفعل فكما عملت الرفع والنصب وإن عريت من معنى الحدث كذلك أيضاً تنصب الظرف لفظاً كما عملت الرفع والنصب لفظاً ولأنها على وزن الفعل.
وعلى ذلك وجه أبو علي قول الله سبحانه: {أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} لأنه أجاز في نصب يوم ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون متعلقاً بنفس ليس من حيث ذكرنا من الشبه اللفظي.
وقال لي أبو علي رحمه الله يوماً: الظرف يتعلق بالوهم مثلا.
فأما قول الآخر: نظرت وشخصي مطلع الشمس ظله إلى الغرب حتى ظله الشمس قد عقل فقيل فيه: أراد نظرت مطلع الشمس وشخصي ظله إلى الغرب حتى عقل الشمس ظله أي حاذاها فعلى هذا التفسير قد فصل بمطلع الشمس بين المبتدأ وخبره وقد يجوز ألا يكون فصل لكن على أن يتعلق مطلع الشمس بقوله: إلى الغرب حتى كأنه قال: شخصي ظله إلى الغرب وقت طلوع الشمس فيعلق الظرف بحرف الجر الجاري خبراً عن الظل كقولك: زيد من الكرام يوم الجمعة فيعلق الظرف بحرف الجر ثم قدم الظرف لجواز تقديم ما تعلق به إلى موضعه ألا تراك تجيز أن تقول: شخصي إلى الغرب ظله وأنت تريد: شخصي ظله إلى الغرب.
فعلى هذا تقول: زيد يوم الجمعة أخوه من الكرام ثم تقدم فتقول: زيد من الكرام يوم الجمعة أخوه.
فاعرفه.
وقال الآخر: أيا بن أناس هل يمينك مطلق نداها إذا عد الفعال شمالها أراد: هل يمينك شمالها مطلق نداها.
فها من نداها عائد إلى الشمال لا اليمين والجملة خبر عن يمينها.
وقال الفرزدق: ملوك يبتنون توارثوها سرادقها المقاول والقبابا أراد: ملوك يبتنون المقاول والقباب توارثوها سرادقها.
فقوله: " يبتنون المقاول والقباب " صفة لموك.
وقوله: توارثوها سرادقها صفة ثانية لملوك موضعها التأخير فقدمها وهو يريد بها موضعها كقولك: مررت برجل مكلمها مار بهند أي مار بهند مكلمها فقدم الصفة الثانية وهو معتقد تأخيرها.
ومعنى يبتنون المقاول أي أنهم يصطنعون المقاول ويبتنونهم كقول المولد: يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى وبين رجال وقوله: توارثوها أي توارثوا الرجال والقباب.
ويجوز أن تكون الهاء ضمير المصدر أي توارثوا فأما ما أنشده أبو الحسن من قوله: لسنا كمن حلت إياد دارها تكريت ترقب حبها أن تحصدا فمعناه: لسنا كمن حلت دارها ثم أبدل إياد من " من حلت دارها " فإن حملته على هذا كان لحناً لفصلك بالبدل بين بعض الصلة وبعض فجرى ذلك في فساده مجرى قولك: مررت بالضارب زيد جعفرا.
وذلك أن البدل إذا جرى على المبدل منه آذن بتمامه وانقضاء أجزائه فكيف يسوغ لك أن تبدل منه وقد بقيت منه بقية هذا خطأ في الصناعة.
وإذا كان كذلك والمعنى عليه أضمرت ما يدل عليه حلت فنصبت به الدار فصار تقديره: لسنا كمن حلت إياد أي كإياد التي حلت ثم قلت من بعده: حلت دارها.
فدل حلت في الصلة على حلت هذه التي نصبت دارها.
ومثله قول الله سبحانه: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} أي يرجعه يومن تبلى السرائر فدل رجعه على يرجعه.
ولا يجوز أن تعلق يوم بقوله لقادر لئلا يصغر المعنى لأن الله تعالى قادر يوم تبلى السرائر وغيره في كل وقت وعلى كل حال على رجع البشر وغيرهم.
وكذلك قول الآخر.ولا تحسبن القتل محضاً شربته نزارا ولا أن النفوس استقرت ومعناه: لا تحسبن قتلك نزاراً محضاً شربته إلا أنه وإن كان هذا معناه فإن إعرابه على غيره وسواه ألا ترى أنك إن حملته على هذا جعلت نزارا في صلة المصدر الذي هو القتل وقد فصلت بينهما بالمفعول الثاني الذي هو محضاً وأنت لا تقول: حسبت ضربك جميلاً زيداً وأنت تقدره على: حسبت ضربك زيداً جميلاً لما فيه من الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي.
فلا بد إذاً من أن تضمر لنزار ناصباً يتناوله يدل عليه قوله: القتل أي قتلت نزارا.
وإذا جاز أن يقوم الحال مقام اللفظ بالفعل كان اللفظ بأن يقوم مقام اللفظ أولى وأجدر.
وذاكرت المتنبيء شاعرنا نحوا من هذا وطالبته به في شيء من شعره فقال: لا أدري ما هو إلا أن الشاعر قد قال: لسنا كمن حلت إياد دارها البيت.
فعجبت من ذكائه وحضوره مع قوة المطالبة له حتى أورد ما هو في معنى البيت الذي تعقبته عليه من شعره.
واستكثرت ذلك منه.
والبيت قوله: وفاؤكما كالربع ِأشجاه طاسمه بإن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه وذكرنا ذلك لاتصاله بما نحن عليه فإن الأمر يذكر للأمر.
وأنشدنا أبو علي للكميت: أي وكالناظرات ما يرى المسحل صواحبها.
فإن حملته على هذا ركبت قبح الفصل.
فلا بد إذاً أن يكون ما يرى المسحل محمولاً على مضمر يدل عليه قوله الناظرات أي نظرن ما يرى المسحل.
وهذا الفصل الذي نحن عليه ضرب من الحمل على المعنى إلا أنا أوصلناه بما تقدمه لما فيه من التقديم والتأخير في ظاهره.
وسنفرد للحمل على المعنى فصلا بإذن الله.
وأنشدوا: كأن برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام أي كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار دق باللجام.
والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وحرف الجر قبيح كثير لكنه من ضرورة الشاعر.
فمن ذلك قول ذي الرمة: كأن أصوات من إبغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج أي كأن أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا أصوات الفراريج.
وقوله: ما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل أي بكف يهودي.
هما أخوا في الحرب من لا أخاله إذا خاف يوماً نبوة فدعاهما أي هما أخوا منلا أخا له في الحرب فعلق الظرف بما في أخوا من معنى الفعل لأن معناه: هما ينصرانه ويعاونانه.
وقوله: هما خطتا إما إسارٍ ومنةٍ وإما دمٍ والقتل بالحر أجدر ففصل بين خطتا وإسارٍ بقوله إما ونظيره هو غلام إما زيد وإما عمرو.
وقد ذكرت هذا البيت في جملة كتابي في تفسير أبيات الحماسة وشرحت حال الرفع في إسار ومنة.
ومن ذلك قوله: فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزاده أي زج أبي مزادة القلوص.
ففصل بينهما بالمفعول به.
هذا مع قدرته على أن يقول: زج القلوص أبو مزادة كقولك: سرني أكل الخبز زيد.
وفي هذا البيت عندي دليل على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول ألا تراه ارتكب ههنا الضرورة مع تمكنه من ترك ارتكابها لا لشيء غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول.
يطفن بحوزي المراتع لم يرع بواديه من قرع القسي الكنائن فلم نجد فيه بداً من الفصل لأن القوافي مجرورة.
ومن ذلك قراءة ابن عامر: { وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم } وهذا في النثر وحال السعة صعب جداً ولا سيما والمفصول به مفعول لا ظرف.
ومنه بيت الأعشى: إلا بداهة أو علا لة قارح نهد الجزاره ومذهب سيبويه فيه الفصل بين بداهة وقارح وهذا أمثل عندنا من مذهب غيره فيه لما قدمنا في غير هذا الموضع.
وحكى الفراء عنهم: برئت إليك من خمسة وعشري النخاسين وحكى أيضاً: قطع الله الغداة يد ورجل من قاله ومنه قولهم: هو خير وأفضل من ثم وقوله: يا من رأى عارضاً أرقت له بين ذراعي وجبهة الأسد فإن قيل: لو كان الآخر مجروراً بالأول لكنت بين أمرين.
أما أن تقول: إلا علالة أو بداهته قارحٍ وبرئت إليك من خمسة وعشريهم النخاسين وقطع الله يد ورجله من قاله ومررت بخير وأفضله مَنْ ثَمَّ وبين ذراعي وجبهته الأسدِ لأنك إنما تعمل الأول فجرى ذلك مجرى: ضربت فأوجعته زيداً إذا أعملت الأول.
وإما أن تقدر حذف المجرور من الثاني وهو مضمر ومجرور كما ترى والمضمر إذا كان مجروراً قبح حذفه لأنه يضعف أن ينفصل فيقوم برأسه.
فإذا لم تخل عند جرك الآخر بالأول من واحد من هذين وكل واحد منهما متروك وجب أن يكون المجرور إنما انجر بالمضاف الثاني الذي وليه لا بالأول الذي بَعُد عنه.
قيل: أما تركهم إظهار الضمير في الثاني وأن يقولوا: بين ذراعي وجبهته الأسد ونحو ذلك فإنهم لو فعلوه لبقي المجرور لفظاً لا جار له في اللفظ يجاوره لكنهم لما قالوا: بين ذراعي وجبهة الأسد صار كأن الأسد في اللفظ مجرور بنفس الجبهة وإن كان في الحقيقة مجروراً بنفس الذراعين.
وكأنهم في ذلك إنما أرادوا إصلاح اللفظ.
وأما قبح حذف الضمير مجروراً لضعفه ع الانفصال فساقط عنا أيضاً.
وذلك أنه إنما يقبح فصل الضمير المجرور متى خرج إلى اللفظ نحو مررت بزيدٍ وك ونزلت على زيد وه لضعفه أن يفارق ما جره.
فأما إذا لم يظهر إلى اللفظ وكان إنما هو مقدر في النفس غير مستكره عليه اللفظ فإنه لا يقبح ألا ترى أن هنا أشياء مقدرة لو ظهرت إلى اللفظ قبحت ولأنها غير خارجة إليه ما حسنت.
من ذلك قولهم: اختصم زيد وعمرو ألا ترى أن العامل في المعطوف غير العامل في المعطوف عليه فلا بد إذاً من تقديره على: اختصم زيد واختصم عمرو وأت لو قلت ذلك لم يجز لأن اختصم ونحوه من الأفعال مثل اقتتل واستب واصطرع لا يكون فاعله أفل من اثنين.
وكذلك قولهم: رب رجل وأخيه ولو قلت: ورب أخيه لم يجز وإن كانت رب مرادة هناك ومقدرة.
فقد علمت بهذا وغيره أن ما تقدره وهماً ليس كما تلفظ به لفظا.
فلهذا يسقط عندنا إلزام سيبويه هذه الزيادة.
والفصل بين المضاف والمضاف إليه كثير وفما أوردناه منه كاف بإذن الله.
وقد جاء الطائي الكبير بالتقديم والتأخير فقال: وإن الغنى لي لو لحظت مطالبي من الشعر إلا في مديحك أطوع وتقديره: وإن الغنى لي لو لحظت مطالبي أطوع من الشعر إلا في مديحك أي فإنه يطيعني في مدحك ويسارع إلي.
وهذا كقوله أيضاً معنى لا لفظاً: تغاير الشعر فيه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل وكقول الآخر: ولقد أردت نظامها فتواردت فيها القوافي جحفلا عن حجفل وذهب أبو الحسن في قول الله سبحانه: { مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ} إلى أنه أراد: من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس الذي يوسوس ومنه قول الله عز اسمه: {اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ} أي اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم.
وقيل في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} إن تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا.
ونحو من هذا ا قدمنا ذكره من الاعتراض في نحو قوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} تقديره والله أعلم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم وإنه لقسم عظيم لو تعلمون.
وقد شبه الجازم بالجار ففصل بينهما كما فصل بين الجار والمجرور وأنشدنا لذي الرمة: فأضحت مغانيها قفارا رسومها كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل وجاء هذا في ناصب الفعل.
أخبرنا محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى بقول الشاعر: لما رايت أبا يزيد مقاتلاً أدع القتال.
.
.
.
.
.
أي لن أدع القتال ما رأيت أبا يزيد مقاتلا كما أراد في الأول: كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش.
وكأنه شبه لن بان فكما جاز الفصل بين أن واسمها بالظرف في نحو قولك: بلغني أن في الدار زيداً كذلك شبه لن مع الضرورة بها ففصل بينها وبين منصوبها بالظرف الذي هو ما رأيت أبا يزيد أي مدة رؤيتي.
اعلم أن هذا الشَرْج غور من العربية بعيد ومذهب نازح فسيح.
قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً كتأنيث المذكر وتذكير المؤنيث وتصوير معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعاً وغير ذلك مما تراه بإذن الله.
فمن تذكير المؤنث قوله: فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان.
ومنه قول الله عز وجل: {فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي} أي هذا الشخص أو هذا المرئي ونحوه.
وكذلك قوله تعالى: {فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ} لأن الموعظة والوعظ واحد.
وقالوا في قوله سبحانه: {إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} إنه أراد بالرحمة هنا المطر.
ويجوز أن يكون التذكير هنا إنما هو لأجل فَعِيل على قوله: بأعينٍ أعداءٍ وهن صديق وقوله: #.
.
.
ولا عفراء منك قريب وعليه قول الحطيئة: ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي وأما بيت الحكمى: ككمون النار في حجره فيكون على هذا لأنه ذهب إلى النور والضياء ويجوز أن تكون الهاء عائدة على الكمون أي في حجر الكمون.
والأول أسبق في اصنعه إلى النفس وقال الهذلي: بعيد الغزاة فما إن يزا ل مضطمرا طرتاه طليحا ذهب بالطرتين إلى اشعر.
ويجوز أن يكون طرتاه بدلاً من الضمير إذا جعلته في مضطمر كقول الله سبحانه: {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ} إذا جعلت في مفتحة ضميراً وجعلت الأبواب بدلاً من ذلك الضمير ولم يكن تقديره: الأبواب منها على أن نخلى مفتحة من الضمير.
نعم وإذا كان في مفتحة ضمير والأبواب بدل منه فلا بد أيضاً من أن يكون تقديره مفتحة لهم الأبواب منها.
وليس منها وفي مفتحة ضمير مثلها إذا أخليتها من ضمير.
وذلك أنها إذا خلت مفتحة من ضمير فالضمير في منها عائد الحال إذا كانت مشتقة كقولك: مررت بزيد واقفاً الغلام معه وإذا كان في مفتحة ضمير فإن الضمير في منها هو الضمير الذي يرد به المبدل عائداً على المبدل منه كقولك: ضربت زيداً رأسه أو الرأس منه وكلمت قومك نصفهم أو النصف منهم وضرب زيد الظهر والبطن أي الظهر منه والبطن منه.
فاعرف ذلك فرقاً بين الموضعين.
إن امرأ غره منكن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور لما فصل بين الفعل وفاعله حذف علامة التأنيث وإن كان تأنيثه حقيقياً.
وعليه قولهم: حضر القاضي امرأة وقوله: لقد ولد الأخيطل أم سوء على باب استها صلب وشام وأما قول جران العود: ألا لا يغرن امرأ نوفلية على الرأس بعدي أو ترائب وضح فليست النوفلية هنا امرأة وإنما هي مشطة تعرف بالنوفلية فتذكير الفعل معها أحسن.
وتذكير المؤنث واسع جداً لأنه رد فرع إلى أصل.
لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإغراب.
وسنذكره.
وأما تأنيث المذكر فكقراءة من قرأ { تلتقطه بعض السيارة } وكقولهم: ما جاءت حاجتك وكقولهم: ذهبت بعض أصابعه.
أنث ذلك لما كان بعض السيارة سيارة في المعنى وبعض الأصابع إصبعاً ولما كانت " ما " هي الحاجة في المعنى.
وأنشدوا: أتهجر بيتاً بالحجاز تلفعت به الخوف والأعداء من كل جانب ذهب بالخوف إلى المخافة.
وقال لبيد: إن شئت قلت: أنث الإقدام لما كان في معنى التقدمة.
وإن شئت قلت: ذهب إلى تأنيث العادة كما ذهب إلى تأنيث الحاجة في قوله: ما جاءت حاجتك وقال: يأيها الراكب المزجى مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت ذهب إلى تأنيث الاستغاثة.
وحكى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سمع رجلاً من أهل اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها! فقلت له: أتقول: جاءته كتابي! فقال نعم أليس بصحيفة! قلت: فما اللغوب قال: الأحمق.
وهذا في النثر كما ترى وقد علله.
وهذا مما قد ذكرناه فيما مضى من كتابنا هذا غير أنا أعدناه لقوته في معناه.
وقال: لو كان في قلبي كقدر قلامةٍ حبا لغيرك قد أتاها أرسلي كسر رسولا وهو مذكر على أَرْسُل وهو من تكسير المؤنث كأتان وآتُن وعناق وأعنق وعُقاب وأعُقب لما كان الرسول هنا إنما يراد به المرأة لأنها في غالب الأمر مما يستخدم في هذا الباب.
وكذلك ما جاء عنهم من جناح واجنح.
قالوا: ذهب في التأنيث إلى الريشة.
وعليه قول عمر: فكان مجيء دون من كنت ألقى ثلاث شخوص: كأعيان ومعصر أنث الشخص لأنه أراد به المرأة.
وقال الآخر: فإن كلانا هذه شرُ ابطُن وأنت بريء من قبائلها العشر وأما قوله: كما شرقت صدر القناة من الدم فإن شئت قلت: أنث لأنه أراد القناة وإن شئت قلت: إن صدر القناة قناة.
وعليه قوله: مشين كما اهتزت رماحٌ تسفهت أعاليها مرُّ الرياح النواسم وقول الآخر: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع وقوله: طول الليالي أسرعت في نقضي وقوله: على قبضة موجوءة ظهر كفه وقول الآخر: قد صرح السير عن كتمان وابتذلت وقع المحاجن بالمهرية الذقن وأما قول بعضهم: صرعتني بعير لي فليس عن ضرورة لأن البعير يقع على الجمل والناقة وقال عز اسمه: {وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} لأنه أراد: امرأة.
ومن باب الواجد والجماعة قولهم: هو أحسن الفتيان وأجمله وأفرد الضمير لأن هذا موضع يكثر فيه الواحد كقولك: هو أحسن فتى في الناس قال ذو الرمة: ومية أحسن الثقلين وجها وسالفة وأحسنه قذالا فأفرد الضمير مع قدرته على جمعه.
وهذا يدلك على قوة اعتقادهم أحوال المواضع وكيف ما يقع فيها ألا ترى أن الموضع موضع جمع وقد تقدم في الأول لفظ الجمع فترك اللفظ وموجب الموضع إلى الإفراد لأنه يؤلف في هذا المكان.
وقال سبحانه: {وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ} فحمل على المعنى وقال: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} فأفرد على لفظ من ثم جمع من بعد وقال عبيد: فالقطبيات فالذنوب وإنما القُطيبية ماء واحد معروف.
وقال الفرزدق: فيا ليت داري بالمدينة أصبحت بأجفار فلج أو بسيف الكواظم يريد الجفر وكظمة.
وقال جرير: وإنما رامة أرض واحدة معروفة.
واعم أن العرب إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع اللفظ كقولك: شكرت من أحسنوا إلي على فعله ولو: قلت شكرت من أحسن إلي على فعلهم جاز.
فلهذا ضعف عندنا أن يكون هما من مصطلاهما في قوله: كميتاً الأسمالي جوبتا مصطلاهما عائدا على الأعالي في المعنى إذ كانا أعليين اثنين لأنه موضع قد ترك فيه لفظ التثنية حملا على المعنى لأنه جعل كل جهة منهما أعلى كقولهم: شابت مفارقه وهذا بعير ذو عثانين ونحو ذلك أو لأن الأعليين شيئان من شيئين.
فإذا كان قد انصرف عن اللفظ إلى غيره ضعفت معاوته إياه لأنه انتكاث وتراجع فجرى ذلك مجرى إدغام الملحق وتوكيد ما حذف.
على أنه قد جاء منه شيء قال: رءوس كبيريهن ينتطحان وأما قوله: كلاهما حين جد الحرب بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي فليس من هذا الباب وإن كان قد عاد من بعد التثنية إلى الإفراد.
وذلك أنه لم يقل: كلاهما قد أقلعا وأنفه راب فيكون ما أنكرناه لكنه قد أعاد كلا أخرى غير الأولى فعاملها على لفظها.
ولم يقبح ذلك لأنه قد فرغ من حديث الأولى ثم استأنف من بعدها أخرى ولم يجعل الضمير عائدين إلى كلا واحدة.
وهذا كقولك: من يقومون أكرمهم ومن يقعد أضربه.
فتأتي بمن الثانية فتعاملها على ما تختار مما يجوز مثله.
وهذا واضح فاعرفه.
ولا يحسن ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرج من عندك لما ذكرنا.
وأما قول الفرزدق: وإذا ذكرت أباك أو أيامه أخزاك حيث تقبل الأحجار يريد الحجر فإنه جعل كل ناحية حجراً ألا ترى أنك لو مسست كل ناحية منه لجاز أن تقول: مسست الحجر.
وعليه شابت مفارقه وهو كثير العثانين.
وهذا عندي هو سبب إيقع لفظ الجماعة على معنى الواحد.
وأما قوله: فقلنا أسلموا إنا أخوكم فقد برئت من الإحن الصدور فيجوز أن يكون جمع أخ قد حذفت نونه للإضافة ويجوز أن يكون واحداً وقع موقع الجماعة كقوله: وقد توضع من للتثنية وذلك قليل قال: نكن مثل مًنْ يا ذئبُ يصطحبان وأنشدوا: أخو الذئب يعوي والغراب ومن يكن شريكيه تطمع نفسه كل مطمع أودع ضمير من في يكن على لفظ الإفراد وهو اسمها وجاء بشريكيه خبراً ليكن على معنى التثنية فكأنه قال: وأي اثنين كانا شريكيه طمعت أنفسهما كل مطمع.
على هذا اللفظ أنشدناه أبو علي وحكى المذهب فيه عن الكسائي أعني عود التثنية على لفظ من إلا أنه عاود لفظ الواحد بعد أن حمل على معنى التثنية بقوله: تطمع نفسه ولم يقل: تطمع أنفسهما.
ولو ذهب فيه ذاهب إلى أنه من المقلوب لم أر به بأساً حتى كأنه قال: ومن يكن شريكهما تطمع نفسه كل مطمع.
وحسن ذلك شيئاً العلم بأنه إذا كان شريكهما كانا أيضاً شريكيه فشجع بهذا القدر على ما ركبه من القلب.
فاعرف ذلك.
والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة جداً.
ومنه قول الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ} ثم قال {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ} قيل فيه: إنه محمول على المعنى حتى كأنه قال: أرأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مَرَّ على قرية فجاء بالثاني على أن الأول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي بنصب يحسن والظاهر أن يرفع لأنه معطوف على أن الثقيلة إلا أنه نصب أن هذا موضع قد كان يجوز أن تكون فيه أن الخفيفة حتى كأنه قال: ألا زعمت بسباسة أن يكبر فلان كقوله تعالى: {وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ} بالنصب.
ومن ذلك قوله: بدا لي أني لستُ مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا لأن هذا موضع يحسن فيه لست بمدرك تما مضى.
ومنه قوله سبحانه: {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن} وقوله: فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم وأستدرج نويا حتى كأنه قال: أصالحكم وأستدرج نوايا.
ومن ذلك قول الآخر: ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح لأنه لما قال: ليبك يزيد فكأنه قال: ليبكه ضارع لخصومة.
وعلى هذا تقولك أكل الخبز زيد وركب الفرس محمد فترفع زيداً ومحمداً بفعل ثان يدل عليه الأول وقوله: لأنه لما قال: هيجني دل على ذَكَّرني فنصبها به.
فاكتفى بالمسبب الذي هو التهييج من السبب الذي هو التذكير ونحوه قول الآخر: أسقي الإله عدوات الوادي وجوزه كل ملثٍّ غاد كل أجشٍّ حالك السواد لأنه إذا أسقاها الله كل ملثٍّ فقد سقاها ذلك الأجشُّ.
وكذلك قول الآخر: تواهق رجلاها يداها ورأسه لها قتب خلف الحقيبة رادف أراد: تواهق رجلاها يديها فحذف المفعول وقد علم أن المواهقة لا تكون من الرجلين دون اليدين وأن اليدين مواهقتان كما أنهما مواهقتان.
فأضمر لليدين فعلا دل عليه الأول.
فكأنه قال: تواهق يداها رجليها ثم حذف المفعول في هذا كما حذفه في الأول فصار على ما ترى: تواهق رجلاها يداها.
فعلى هذه الصنعة التي وصفت لك تقول: ضارب زيد عمرو على أن ترفع عمرا بفعل غير هذا الظاهر ولا يجوز أن يرتفعا جميعاً بهذا الظاهر: فأما قولهم: اختصم زيد وعمرو ففيه نظر.
وهو أن عمرا مرفوع بفعل آخر غير هذا الظاهر على حد قولنا في المعطوف: إن العامل فيه غير العامل في المعطوف عليه فكأنه قال: اختصم زيد واختصم عمرو وأنت مع هذا لو نطقت بهذا الذي تقدره لم يصلح الكلام معه لأن الاختصام لا يكون من أقل من اثنين.
وعلة جوازه أنه لما لم يظهر الفعل الثاني المقدر إلى اللفظ لم يجب تقديره وإعماله كأشياء تكون في التقدير فتحسن فإذا أنت أبرزتها إلى اللفظ قبحت.
وقد ذكرنا ذلك فيما مضى.
ومن ذلك قول الآخر: فكرت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا وذلك أنه إذا وافقته والسباع معه فقد دخلت السباع في الموافقة فكأنه قال فيما بعد: وافقت السباع.
وهو عندنا على حذف المضاف أي وافقت آثار السباع.
قال أبو علي: لأنها لو وافقت السباع هناك لأكلتها معه.
فعلى الآن هذه الظرف منصوبة بالفعل المحذوف الذي نصب السباع في التقدير.
ولو رفعت السباع لكانت على هذه مرفوعة الموضع لكونها خبراً عن السباع مقدماً وكانت تكون متعلقة بالمحذوف كقولنا في قولهم: في الدار زيد.
وعلى هذا قال الآخر: تذكرت أرضاً بها أهلها أخوالها فيها وأعمامها لك فيها وجهان: إن شئت قلت: إنه أضمر فعلاً للأخوال والأعمام على ما تقدم فنصبهما به كأنه قال فيما بعد: تذكرت أخوالها فيها وأعمامها.
ودل على هذا الفعل المقدر قوله: تذكرت أرضاً بها أهلها لأنه إذا تذكر هذه الأرض فقد علم أن التذكر قد أحاط بالأخوال والأعمام لأنهم فيها على ما مضى من الأبيات.
وإن شئت جعلت أخوالها وأعمامها بدلاً من الأرض بدل الاشتمال على قول الله سبحانه: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ}.
فإن قلت: فإن البدل العامل عندك فيه هو غير العامل في المبدل منه وإذا كان الأمر كذلك فقد آل الحديث إلى موضع واحد وهو إضمار الفعل فلم قسمت الأمر فيهما إلى موضعين قيل: الفرق قائم.
ووجهه أن اتصال المبدل منه أشد من اتصال ما حمل على المعنى بما قبله وإنما يأتي بعد استقرار الكلام الأول ورسوخه وليس كذلك البدل لأنه وإن كان العامل فيه غير الأول عندنا فإنه مع ذلك مشابه للصفة وجار مجراها.
نعم وقد خالف فيه أقوام فذهبوا إلى أن العامل في الثاني هو العامل في الأول.
وحدثنا أبو علي أن الزيادي سأل أبا الحسن عن قولهم: مررت برجل قائمٌ زيدٌ أبوه أأبوه بدل أم صفة قال فقال أبو الحسن: لا أبالي بأيهما أجبتُ.
أفلا ترى إلى تداخل الوصف والبدل.
وهذا يدل على ضعف العامل المقدر مع البدل.
وسألت أبا علي رحمه الله عن مسئلة الكتاب: رأيتك إياك قائماً الحال لمن هي فقال: لإياك.
قلت: فالعامل فيها ما هو قال: رأيت هذه الظاهرة.
قلت: أفلا تعلم أن إياك معمول فعل آخر غير الأول وهذا يقود إلى أن الناصب للحال هو الناصب لصاحبها أعني الفعل المقدر فقال: لما لم يظهر ذلك العامل ضعف حكمه وصارت المعاملة مع هذا الظاهر.
فهذا يدلك على ضعف العامل في البدل واضطراب حاله وليس كذلك العامل إذا دل عليه غيره نحو قوله: تواهق رجلاها يداها.
.
.
وقوله: وول تعزيت عنها أم عمار ونحو ذلك لأن هذا فعل مثبت وليس محل ما يعمل فيه المعنى محل البدل.
فلما اختلف هذان الوجهان من هذين الموضعين اعتددناهما قسمين اثنين.
ومن ذلك قوله: لن تراها ولو تأملت إلا ولها في مفارق الرأس طيبا وهذا هو الغريب من هذه الأبيات.
ولعمي إن الرؤية إذا لحقتها فقد لحقت ما هو متصل بها.
ففي ذلك شيئان: أحدهما أن الرؤية وإن كانت مشتملة عليها فليس لها طريق إلى الطيب في مفارقها اللهم إلا أن تكون حاسرة غير مقنعة وهذه بذلة وتطرح لا توصف به الخفرات ولا المعشقات ألا ترى إلى قول كثير: ومن كانت من النساء هذه حالها فليست رذلة ولا مبتذلة.
وبه وردت الأشعار القديمة والمولدة قال الطائي: عالي الهوى مما يعذب مهجتي أروية الشعف التي لم تسهل وهي طريق مهيع.
وإذا كان كذلك وكانت الرؤية لها ليس مما يلزم معه رؤية طيب مفارقها وجب أن يكون الفعل المقدر لنصب الطيب مما يصحب الرؤية لا الرؤية نفسها فكأنه قال: لن تراها إلا وتعلم لها أو تتحقق لها في مفارق الرأس طيباً غير أن سيبويه حمله على الرؤية.
وينبغي أن يكون أراد: ما تدل عليه الرؤية من الفعل الذي قدرناه.
والآخر أن هذه الواو في قوله: ولها كذا هي واو الحال وصارفة للكلام إلى معنى الابتداء فقج وجب أن يكون تقديره: لن تراها إلا وأنت تعلم أو تتحقق أو تشم فتأتي بالمبتدأ وتجعل ذلك الفعل المقدر خبراً عنه.
فاعرف ذلك.
ومنه قوله: قد سلم الحيات منه القدما الأفعوان والشجاع الشجعما وذات قرنين ضموزا ضرزما هو من هذا لأنه قد علم أن الحيات مسالمة كما علم أنها مسالمة ورواها الكوفيون بنصب لنا أعنز لبنٌ ثلاث فبعضها لأولادها ثنتا وما بيننا عنز وينشدون قول الآخر: كأن أذنيه إذا تشوفا قادمتتا أو قلما محرفا على أنه أراد: قادمتان أو قلمان محرفان.
ورووه أيضاً: تخال أذنيه.
.
.
قادمة أو قلما للحرفا.
فهذا على أنه يريد: كل واحدة من أذنيه ومما ينسبونه إلى كلام الطير قول الحجلة للقطاة اقطي قطا فبيضك ثنتا وبيض مائتا أي ثنتان ومائتان.
ومن ذلك قوله: يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا أي وحاملا رمحا.
فهذا محمول على معنى الأول لا لفظه.
وعليه: علفتها تبنا وماء بارداً حتى شتت همالة عيناها أي وسقيتها ماء باردا وقوله: تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه ثاب له وفر أي ويفقأ عينيه وقوله: تسمع للأجواف منه صردا وفي اليدين جسأة وبددا أي وترى في اليدين جسأة وبددا وقوله: أي وأفرخت نعامها وقوله: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا أي وكحلن العيون.
ومن المحمول على المعنى قوله: طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنه من قوام ما وممتقباً لأن الأول في معنى: يا سحنه قواماً وقول الآخر: يذهبن في نجد وغورا غائرا أي ويأتين غورا.
وقول الآخر: فاذهب فأي فتى في الناس أحرزه من يومه ظلم دعج ولا جبل حتى كأنه قال: ما أحد أحرزه ظلم ولا جبل.
ومنه قوله: فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا حمله الفراء على المعنى قال: لأن معناه: لا يرضيك إلا أن تردني فجعل الفاعل متعلقاً على المعنى.
وكان أبو علي يغلظ في هذا ويكبره ويتناكره ويقول: الفاعل لا يحذف.
ثم إنه فيما بعد لان له وخفض من جناح تناكره.
وعلى كل حال فإذا كان الكلام إنما يصلحه أو يفسده معناه وكان هذا معنى صحيحاً مستقيما لم أر به بأساً.
وعلى أن المسامحة في الفاعل ليست بالمرضية لأنه أصعب حالاً من المبتدأ.
وهو في المفعول أحسن أنشد أبو زيد: وقالوا: ما تشاء فقلت: ألهو إلى الإصباح آثر ذي أثير أراد: اللهو فوضع ألهو موضعه لدلالة الفعل على مصدره.
ومثله قولك لمن قال لك: ما يصنع زيد: يصلي أو يقرأ أي الصلاة أو القراءة.
ومما جاء في المبتدأ من هذا قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أي سماعك به خير من رؤيتك له.
وقال عز وجل: {وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} أي منا قوم دون ذلك فحذف المبتدأ وأقام الصفة التي هي الظرف مقامه.
وقال جرير: نفاك الأغر ابن عبد العزيز وحقك تنفي عن المسجد فحذف أن من خبر المبتدأ وهي: حقك أن تنفي عن المسجد.
وقد جاء ذلك في الفاعل على عزته.
وأنشدنا: وما راعني إلا يسير بشرطة وعهدي به فينا يفش بكير كذا أنشدناه فينا وإنما هو قَيْنا أراد بقوله: وما راعني إلا يسير أي مسيره على هذا وجهه.
ومنه بيت جميل: جرعت حذار البين يوم تحملوا وحق لمثلي يا بثينة يجزع أي وحق لمثلي أن يجزع.
وأجاز هشام يسرني تقوم وينبغي أن يكون ذلك جائزاً عنده في الشعر لا في النثر.
هذا أولى عندي من أن يكون يرتكبه من غير ضرورة.
وباب الحمل على المعنى بحر لا يُنْكَش ن ولا يُفْثَج ولا يؤبى ولا يُغَرَّض ولا يُغضغض.
وقد رأينا وجهه ووكلنا الحال إلى قوة النظر وملاطفة التأول.
ومنه باب من هذه اللغة واسع لطيف طريف وهو اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به لأنه في معنى فعل يتعدى به.
من ذلك قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} لما كان في معنى الإفضاء عداة بإلى.
ومثله بيت الفرزدق: قد قتل الله زيادا عني لما كان ذلك في معنى: صرفه عني.
وقد ذكرناه فيما مضى.
وكان أبو علي يستحسنه وينبه عليه.
ومنه قول الأعشى: سبحان من علقمة الفاخر
فصل في التحريف
قد جاء هذا الموضع في ثلاثة أضرب: الاسم والفعل والحرف.
فالاسم يأتي تحريفه على ضربين: أحدهما مقيس والآخر مسموع غير مقيس.
الأول ما غيره النسب قياساً.
وذلك قولك في الإضافة إلى نَمِر: نَمَريّ وإلى شقِرة: شَقَرِيّ وإلى قاض: قاضَوِيّ وإلى حنيفة: حَنفيّ وإلى عدِيّ: عَدَويّ ونحو ذلك.
وكذلك التحقير وجمع التكسير نحو رجل ورُجَيل ورجال.
الثاني على أضرب: منه ما غيرته الإضافة على غير قياس كقولهم في بني الحُبْلَى حُبَلِيّ وفي بني عَبِيدة وجَذِيمة: عُبَدِيّ وجُذَمِيّ وفي زَبِينة: زَبانيّ وفي أَمس: إمسيّ وفي الأفُق: أَفَقيّ وفي جَلولاء: جَلوليّ وفي خرسان: خُرْسٍيّ وفي دَسْتواء: دستوانيّ.
ومنه ما جاء في غير الإضافة.
وهو نحو قوله: من نسج داود أبي سلام يريد: أبي سليمان وقول الآخر: وسائلة بثعلبة بن سير وقد علقت بثعلبة العلوق أبوك عطاء ألأم الناس كلهم يريد عطية بن الخطفي وقال العبد: وما دمية من دمى ميسنا ن معجبة نظراً واتصافاً أراد: ميسان فغير الكلمة بأن زاد فيها نوناً فقال: ميسنان وقال لبيد: درس المنا بمتالع فأبان أراد: المنازل وقال علقمة: كأن إبريقهم ظبي على شرف مفدم بسبا الكتان ملثوم وقال: واستحر القتل في عبد الأشل يريد الأشهل.
وقال: بسبحل الدفين عيسجور أي بسبحل.
وقال: يريد: في حجاج حاجب.
وقد مضى من التحريف في الاسم ما فيه كاف بإذن الله.
تحريف الفعل من ذلك ما جاء من المضاف مشبهاً بالمعتل.
وهو قولهم في ظللت: ظلت وفي مسست: مِسَتْ وفي أحسست: أحَسْت قال: خلا أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس وهذا مشبه بخفت وأردت.
وحكى ابن الأعرابي في ظننت ظنت.
وهذا كله لا يقاس عليه لا تقول في شمعت: شمت والشمت ولا في أقضضت: أقضت.
فأما قول أبي الحسن في مثال اطمأن من الضرب: اضربب وقول النحويين فيه: اضربب فليس تحريفاً وإنما هذا عند كل واحد من القبليلين هو الصواب.
ومن تحريف الفعل ما جاء منه مقلوباً كقولهم في اضمحل: امضحلن وفي أطيب: أيطب وفي اكفهر: اكرهف وما كان مثله.
فأما جذب وجبذ فأصلان لأن كل واحد منهما متصرف وذو مصدر كقولك: جذب يجذب جذباً وهو جاذب وجبذ يجبذ جبذا وهو جابذ وفلان مجبوذ ومجذوب فإذا تصرفا لم يكن أحدهما بأن يكون أصلاً لصاحبه أولى من أن يكون وأما قولهم: أيس فمقلوب من يئس.
ودليل ذلك من وجهين.
أحدهما أن لا مصدر لقولهم: أيس.
فأما الإياس فمصدر أست.
قال أبو علي: وسموا الرجل إياساً كما سموه عطاء لان أست: أعطيت.
ومثله عندي تسميتهم إياه عياضاً فلما لم يكن لأيس مصدر علمت انه لا أصل له وإنما المصدر اليأس.
فهذا من يئست.
والآخر صحة العين في أيس ولو لم يكن مقلوبا لوجب فيه إعلالها وأن يقال: آس وإست كهاب وهبت وكان يلزم في مضارع أواس كأهاب فتلقب الفاء لتحركها وانفتاحها واواً كقولك في هذا أفعل من هذا من أممت: هذا أوم من هذا هذا قول أبي الحسن وهو القياس.
وعلى قياس قول أبي عثمان أياس كقوله: هذا أيم من هذا.
فصارت صحة الياء في أيس دليلاً على أنها مقلوبة من يئس كما صارت صحة الواو في عور دليلاً على أنها في معنى ما لا بد من صحته وهو اعور.
وهو باب.
وكذلك قولهم: لم أبله.
وقد شرحناه في غير هذا.
تحريف الحرف قالوا: لا بَلْ ولابَنْ وقالوا: قام زيد فُمَّ عمرو كقولك: ثم عمرو.
وهذا وإن كان بدلا فإنه ضرب من التحريف.
وقالوا في سوف أفعل: سوأ فعل وسَفْ أفعل.
حذفوا تارة الواو رُبَ هَيْضَلٍ لجب لففتُ بهيضل وقال: أن هالكٌ كلُّ منْ يحفى ونتعل وقال الله سبحانه: {إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ}.
وقال: سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدما مذهب صاحب الكتاب أنه أراد: وإما من خريف.
وقد خولف فيه.
باب في فرق بين الحقيقة والمجاز
الحقيقة: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة.
والمجاز: ما كان بضد ذلك.
وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي: الاتساع والتوكيد والتشبيه.
فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة.
فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس: هو بحر.
فالمعاني الثلاثة موجودة فيه.
أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطرف وجواد ونحوها البحر حتى إنه إن احتيج إليه في شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك الأسماء لكن لا يفضى علوت مطا جوادك يوم يوم وقد ثمد الجياد فكان بحرا وكأن يقول الساجع: فرسك هذا إذا سما بغرته كان فجراً وإذا جرى إلى غايته كان بحراً ونحو ذلك.
ولو عَرِى الكلام من دليل يوضح الحال لم يقع عليه بحر لما فيه من التعجرف في المقال من غير إيضاح ولا بيان.
ألا ترى أن لو قال رأيت بحراً وهو يريد الفرس لم يعلم بذلك غرضه فلم يجز قوله لأنه إلباس وإلغاز على الناس.
وأما التشبيه فلأن جريه يجر ي في الكثرة مجرى مائه.
أما التوكيد فأنه شبه العرض بالجوهر وهو أثبت في النفوس منه والشبه في العرض منتفية عنه ألا ترى أن من الناس من دفع الأعراض وليس أحد دفع الجواهر.
وكذلك قول الله سبحانه: {وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا} هذا هو مجاز.
وفيه الأوصاف الثلاثة.
أما السعة فلأنه كأنه زاد في أسماء الجهات والمحال اسماً هو الرحمة.
وأما التشبيه فلأنه شبه الرحمة وإن لم يصح دخولها بما يجوز دخوله.
فلذلك وضعها موضعه.
وأما التوكيد فلأنه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر.
وهذا تعال بالغرض وتفخيم منه إذ صير إلى حيز ما يشاهد ويلمس ويعاين ألا ترى إلى قول بعضهم في الترغيب في الجميل: ولو رأيتم المعروف رجلاً لرأيتموه حسنا جميلاً وإنما يرغب فيه بأن ينبه عليه ويعظم من قدره بأن يصوره في النفوس على أشرف أحواله وأنوه صفاته.
وذلك بأن يتخيل شخصاً متجسماً لا عرضاً متوهماً.
وعليه قوله: تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير أي فباديه إلى الخافي يسير أي فباديه مضموماً إلى خافيه يسير.
وذلك أنه لما وصف الحب بالتغلغل فقد اتسع به ألا ترى أنه يجوز على هذا أن تقول: شكوت إليها حبها المتغلغلا فما زادها شكواي إلا تدللا فيصف بالمتغلغل ما ليس في أصل اللغة أن يوصف بالتغلغل إنما وصف يخص الجواهر لا الأحداث ألا ترى أن المتغلغل في الشيء لا بد أن يتجاوز مكاناً إلى آخر.
وذلك تغريغ مكان وشغل مكان.
وهذه أوصاف تخص في الحقيقة الأعيان لا الأحداث.
فهذا وج الاتساع.
وأما التشبيه فلأنه شبه ما لا ينتقل ولا يزول بما يزول وينتقل.
وأما المبالغة والتوكيد فلأنه أخرجه عن ضعف إلى قوة الجوهرية.
وعليه قول الآخر: قرعت ظنابيب الهوى يوم عالج ويوم النقا حتى قسرت الهوى قسرا ذهوب بأعناق المئين عطاؤه عزوم على الأمر الذي هو فاعله وقول الآخر: عمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال وقوله: ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد جعل للشمس رداء وهو جوهر لأنه أبلغ في النور الذي هو العرض.
وهذه الاستعارات كلها داخلة تحت المجاز.
فأما قولهم: ملكتُ عبداً ودخلت داراً وبنيت حماماً فحقيقي هو ونحوه لا استعارة فيه ولا مجاز في هذه المفعولات لكن في الأفعال الواصلة إليها مجاز.
وسنذكره.
ولكن لو قال: بنيت لك في قلبي بيتاً أو ملكت من الجود عبداً خالصاً أو أحللتك من رأيي وثقتي دار صدرق لكان ذلك مجازاً واستعارة لما فيه من الاتساع والتوكيد والتشبيه على ما مضى.
ومن المجاز كثير من باب الشجاعة في اللغة: من الحذوف والزيادات والتقديم والتأخير: والحمل على المعنى والتحريف.
ألا ترى أنك إذا قلت: بنو فلان يطؤهم الطريق ففيه من السعة إخبارك عما لا يصح وطؤه بما صح وطؤه.
فتقول على هذا: أخذنا على الطريق الواطئ لبني فلان ومررنا بقوم موطوئين بالطريق و يا طريق طأ بنا بني فلان أي أدنا إليهم.
وتقول: بني فلان بيته على سنن المارة رغبة في طئة الطريق بأضيافه له.
أفلا ترى إلى وجه الاتساع عن هذا المجاز.
ووجه التشبيه إخبارك عن الطريق بما تخبر به عن سالكيه.
فشبهته بهم إذ كان هو المؤدي لهم فكأنه هم.
وأما التوكيد فلأنك إذا أخبرت عنه بوطئه إياهم كان أبلغ من وطء سالكيه لهم.
وذلك أن الطريق مقيم ملازم فأفعاله مقيمة معه وثابتة بثباته.
وليس كذلك أهل الطريق لأنهم قد يحضرون فيه ويغيبون عنه فأفعالهم أيضاً كذلك حاضرة وقتاً وغائبة آخر.
فأين هذا مما أفعاله ثابتة مستمرة.
ولما كان هذا كلاماً الغرض فيه المدح والثناء اختاروا له أقوى اللفظين لأنه يفيد أقوى المعنيين.
وكذلك قوله سبحانه {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} فيه المعاني الثلاثة.
أما الاتساع فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله.
وهذا نحو ما مضى ألا تراك تقول: وكم من قرية مسؤولة.
وتقول: القرى وتسآلك كقولك: أنت وشأنك.
فهذا ونحوه اتساع.
وأما التشبيه فلأنها شبهت بما يصح سؤاله لما كان بها ومؤلفاً لها.
وأما التوكيد فلأنه في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته الإجابة.
فكأنهم تضمنوا لأبيهم عله السلام أنه إن سأل الجمادات والجبال أنبأته بصحة قولهم.
وهذا تناه في تاصحيح الخبر.
أي لو سألتها لأنطقها الله بصدقنا فكيف لو سألت مَن مِن عادته الجواب.
وكيف تصرفت الحال فالاتساع فاش في جميع أجناس شجاعة العربية.
باب في أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة
اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة.
وذلك عامة الأفعال نحو قام زيد وقعد عمرو وانطلق بشر وجاء الصيف وانهزم الشتاء.
ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية فقولك: قام زيد معناه: كان منه القيام أي هذا الجنس من الفعل ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام وكيف يكون ذلك وهو جنس والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي الكائنات من كل من وجد منه القيام.
ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم هذا محال عند كل ذي لب.
فإذا كان كذلك علمت أن قام زيد مجاز لا حقيقة وإنما هو على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير.
ويدل على انتظام ذلك لجميع جنسه أنك تعلمه في جميع أجزاء ذلك الفعل فتقول: ِ قمت قومة وقومتين ومائة قومة وقياماً حسناً وقياماً قبيحاً.
فأعمالك إياه في جميع أجزائه يدل على أنه موضوع عندهم على صلاحه لتناول جميعها.
وإنما يعمل الفعل من المصدر فيما فيه عليه دليل ألا تراك لا تقول: قمت جلوساً ولا ذهبت مجيئاً ولا نحو ذلك لما لم تكن فيه دلالة عليه ألا ترى إلى قوله: لعمري لقد أحببتك الحب كله وزدتك حباً لم يكن قبل يعرف فانتظامه لجميعه يدل على وضعه على اغتراقه واستيعابه وكذلك قول الآخر: فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا فقوله كل الظن يدل على صحة ما ذهبنا إليه.
قال لي أبو علي: قولنا: قام زيد بمنزلة قولنا خرجت فإذا الأسد ومعناه أن قولهم: خرجت فإذا الأسد تعريفه هنا تعريف الجنس كقولك: الأسد تعريفه هنا تعريف الجنس كقولك: الأسد أشد من الذئب وأنت لا تريد أنك خرجت وجميع الأسد التي يتناولها الوهم على الباب.
هذا محال واعتقاده اختلال.
وإنما أردت: خرجت فإذا واحد من هذا الجنس بالباب.
فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازاً لما فيه من الاتساع والتوكيد والتشبيه.
أما الاتساع فإنك وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد.
وأما التوكيد فلأنك عظمت قدر ذلك الواحد بأن جئت بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة.
وإذا كان كذلك فمثله قعد جعفر وانطلق محمد وجاء الليل وانصرم النهار.
وكذلك أفعال القديم سبحانه نحو خلق الله السماء والأرض وما كان مثله ألا ترى أنه عز اسمه لم يكن منه بذلك خلق أفعالنا ولو كان حقيقة لا مجازا لكان خالقاً للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا عز وعلا.
وكذلك علم الله قيام زيد مجاز أيضاً لأنه لست الحال التي علم عليها قيام زيد هي الحال التي علم عليها قعود عمرو.
ولسنا نثبت له سبحانه علما لأنه عالم بنفسه إلا أنا مع ذلك نعلم أنه ليست حال علمه بقيام زيد هي حال علمه بجلوس عمرو ونحو ذلك.
وكذلك قولك: ضربت عمرا مجاز أيضاً من غير جهة التجوز في الفعل وذلك أنك إنما فعلت بعض الضرب لا جميعه ولكن من جهة أخرى وهو أنك إنما ضربت بعضه لا جميعه ألا تراك تقول: ضربت زيداً ولعلك إنما ضربت يده أو إصبعه أو ناحية من نواحي جسده ولهذا إذا احتاط الإنسان واستظهر جاء ببدل البعض فقال: ضربت زيداً وجهه أو رأسه.
نعم ثم إنه مع ذلك متجوز ألا تراه قد يقول: ضربت زيداً رأسه فيبدل للاحتياط وهو إنما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كله.
ولهذا مات يحتاط بعضهم في نحو هذا فيقول: ضربت زيداً جانب وجهه الأيمن أو ضربته أعلى رأسه الأسمق لأن أعلى رأسه قد تختلف أحواله فيكون بعضه أرفع من بعض.
وبعد فإذا عرف التوكيد لم وقع في الكلام نحو نفسه وعينه وأجمع وكله وكلهم وكليهما وما أشبه ذلك عرفت منه حال سعة المجاز في هذا الكلام ألا تراك قد تقول: قطع الأمير اللص ويكون القطع له بأمره لا بيده فإذا قلت: قطع الأمير نفسه اللص رفعت المجاز من جهة الفعل وصرت إلى الحقيقة لكن يبقى عليك التجوز من مكان آخر وهو قولك: اللص وإنما لعله قطع يده أو رجله فإذا احتطت قلت: قطع الأمير نفسه يد اللص أو رجله.
وكذلك جاء الجيش أجمع ولولا أنه قد كان يمكن أن يكون إنما جاء بعضه وإن أطلقت المجيء على جميعه لما كان لقولك: أجمع معنى.
فوقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليل على شياع المجاز فيها واشتماله عليها حتى إن أهل العربية أفردوا له باباً لعنايتهم به وكونه مما لا يضاع ولا يهمل مثله كما أفردوا لكل معنى أهمهم باباً كالصفة والعطف والإضافة والنداء والندبة والقسم والجزاء ونحو ذلك.
وبينت منذ قريب لبعض منتحلي هذه الصناعة هذا الموضع أعني ما في ضربت زيداً وخلق الله ونحو ذلك فلم يفهمه إلا بعد أن بات عليه وراض نفسه فيه واطلع في الموضع الذي أومأت له إليه فحينئذ ما تصوره وجرى على مذهبه في أن لم يشكره.
واعلم أن جميع ما أوردناه في سعة المجاز عندهم واستمراره على ألسنتهم يدفع دفع أبي الحسن القياس على حذف المضاف وإن لم يكن حقيقة.
أولا يعلم أبو الحسن كثرة المجاز غيره وسعة استعماله وانتشار مواقعه كقام أخوك وجاء الجيش وضربت زيداً ونحو ذلك وكل ذلك مجاز لا حقيقة وهو على غاية الانقياد والاطراد.
وكذلك أيضاً حذف المضاف مجاز لا حقيقة وهو مع ذلك مستعمل.
فإن احتج أبو الحسن بكثرة هذه المواضع نحو قام زيد وانطلق محمد وجاء القوم ونحو ذلك قيل له: وكذلك حذف المضاف قد كثر حتى إن في القرآن وهو أفصح الكلام منه أكثر من مائة موضع بل ثلاثمائة موضع وفي الشعر منه ما لا أحصيه.
فإن قيل: يجيء من هذا أن تقول: ضربت زيداً وإنما ضربت غلامه وولده.
قيل: هذا الذي شنعت به بعينه جائز ألا تراك تقول: إنما ضربت زيداً بضربك غلامه وأهنته بإهانتك ولده.
وهذا باب إنما يصلحه ويفسده المعرفة به.
فإن فهم عنك في قولك: ضربت زيداً أنك إنما أردت بذلك: ضربت غلامه أو أخاه أو نحو ذلك جاز وإن لم يفهم عنك لم يجز كما أنك إن فهم عنك بقولك: أكلت الطعام أنك أكلت بعضه لم تحتج إلى البدل وإن لم يفهم عنك وأردت إفهام المخاطب إياه لم تجد بداً من البيان وأن تقول: بعضه أو نصفه أو نحو ذلك.
ألا ترى أن الشاعر لما فهم عنه ما أراد بقوله قال: وإنما أراد: عبد الله بن عباس ولو لم يكن على الثقة بفهم ذلك لم يجد بداً من البيان.
وعلى ذلك قول الآخر: عليم بما أعيا النطاسي حذيما أراد: ابن حذيم.
ويدلك على لحاق المجاز بالحقيقة عندهم وسلوكه طريقته في أنفسهم أن العرب قد وكدته كما وكحدت الحقيقة.
وذلك قول الفرزدق: عشية سال المربدان كلاهما سحابة موت بالسيوف الصوارم وإنما هو مربد واحد فثناه مجازاً لما يتصل به من مجاوره ثم إنه مع ذلك وكده وإن كان مجازاً.
وقد يجوز أن يكون سمى كل واحد من جانبيه مربداً.
وقال الآخر: إذا البيضة الصماء عضت صفيحة بحربائها صاحت صياحاً وصلت فأكد صاحت وهو مجاز بقوله: صياحا.
وأما قول الله عز وجل: {وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} فليس من باب المجاز في الكلام بل هو حقيقة قال أبو الحسن: خلق الله لموسى كلاماً في الشجرة فكلم به موسى وإذا أحثه كان متكلماً به.
فأما أن يحدثه في شجرة أو فم أو غيرهما فهو شيء آخر لكن الكلام واقع ألا ترى أن المتكلم منا إنما يستحق هذه الصفة بكونه متكلماً لا غير لا لأنه أحدثه في آلة نظقه وإن كان لا يكون متكلماً حتى يحرك به آلات نطقه.
فإن قلت: أرأيت لو أن أحدنا عمل آلة مصوتة وحركها واحتذى بأصواتها أصوات الحروف المقطعة المسموعة في كلامنا أكنت تسميه متكلماً وتسمي تلك الأصوات كلاماً.
فجوابه ألا تكون تلك الأصوات كلاماً ولا ذلك المصوت لها متكلماً.
وذلك أنه ليس في قوة البشر أن يوردوه بالآلات التي يصنعونها على سمت الحروف المنطوق بها وصورتها في النفس لعجزهم عن ذلك.
وإنما يأتون بأصوات فيها الشبه اليسير من حروفنا فلا يستحق لذلك أن تكون كلاماً ولا أن يكون الناطق بها متكلماً كما أن الذي يصور الحيوان تجسيماً أو ترقيماً لا يسمى خالقاً للحيوان وإنما يقال مصور وحاك ومشبه.
وأما القديم سبحانه فإنه قادر على أحداث الكلام على صورته الحقيقية وأصواته الحيوانية في الشجرة والهواء وما أحب سبحانه وشاء.
فهذا فرق.
فإن قلت: فقد أحال سيبويه قولنا: أشرب ماء البحر وهذا منه حظر للمجاز الذي أنت مدع شياعه وانتشاره.
قيل: إنما أحال ذلك على أن المتكلم يريد به الحقيقة وهذا مستقيم إذ الإنسان الواحد لا يشرب جميع ماء البحر.
فأما إن أراد به بضعه ثم أطلق هناك اللفظ يريد به جميعه فلا محالة من جوازه ألا ترى إلى قول الأسود بن يعفر نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطواد فلم يحصل هنا جميعه لأنه قد يمكن أن يكون بعض مائه مختلجاً قبل وصوله إلى أرضهم بشرب أو بسقي زرع ونحوه.
فسيبويه إذاً إنما وضع هذه اللفظة في هذا الموضع على أصل وضعها في اللغة من العموم واجتنب المستعمل فيه من الخصوص.
ومثل توكيد المجاز فيما مضى قولنا: قام زيد قياماً وجلس عمرو جلوساً وذهب سعيد ذهاباً وهو ذلك لأن قولنا: قام زيد ونحو ذلك قد قدمنا الدليل على أنه مجاز.
وهو مع ذلك مؤكد بالمصدر.
فهذا توكيد المجاز كما ترى.
وكذلك أيضاً يكون قوله سبحانه: {وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} ومن هذا الوجه مجازاً على ما مضى.
ومن التوكيد في المجاز قوله تعالى: {وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ} ولم تؤت لحية ولا ذكراً.
ووجه هذا عندي أن يكون مما حذفت صفته حتى كأنه قال: وأوتيت من كل شيء تؤتاه المرأة الملكة ألا ترى أنها لو أوتيت لحية وذكرا لم تكن امرأة أصلاً ولما قيل فيها: أوتيت ولقيل أوتى.
ومثله قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} وهو سبحانه شيء.
وهذا مما يستثنيه العقل ببديهته ولا يحوج إلى التشاغل باستثنائه ألا ترى أن الشيء كائناً ما كان لا يخلق نفسه كما أن المرأة لا تؤتي لحية ولا ذكرا.
فأما قوله سبحانه: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} فحقيقة لا مجاز.
وذلك أنه سبحانه ليس عالماً بعلم فهو إذاً العليم الذي فوق ذوي العلوم أجمعين.
ولذلك لم يقل: وفوق كل عالم عليم لأنه عز اسمه عالم ولا عالم فوقه.
فإن قلت: فليس في شيء مما أوردته من قولك: {وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ} و {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} اللفظ المعتاد للتوكيد.
قيل: هو وإن لم يأت تابعاً على سمت التوكيد فإنه بمعنى التوكيد البتة ألا ترى أنك إذا قلت: عممت بالضرب جميع القوم ففائدته فائدة قولك: ضربت القوم كلهم.
فإذا كان المعنيان واحداً كان ما وراء ذلك غير معتد به ولغواً.
باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها
الأول ما لم يدع داع إلى الترك والتحول من ذلك أو إنما أصل وضعها أن تكون لأحد الشيئين أين كانت وكيف تصرفت.
فهي عندنا على ذلك وإن كان بعضهم قد خفى عليه هذا من حالها في بعض الأحوال حتى دعاه إلى أن نقلها عن أصل بابها.
وذلك أن الفراء قال: إنها قد تأتي بعمنى بل وأنشد بيت ذي الرمة: بدت مثل قري الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح وقال: معناه: بل أنت في العين أملح.
وإذا أرينا أنها في موضعها وعلى بابها بل إذا كانت هنا على بابها كانت أحسن معنى وأعلى مذهباً فقد وفينا ما علينا.
وذلك أنها على بابها من الشك ألا ترى أنه لو أراد بها معنى بل فقال: بل أنت في العين أملح لم يف بمعنى أو في الشك لأنه إذا قطع بيقين أنها في العين أملح كان في ذلك سرف منه ودعاء إلى التهمة في الإفراط له وإذا أخرج الكلام مخرج الشك كان في صورة المقتصد غير المتحامل ولا المتعجرف.
فكان أعذب للفظة وأقرب إلى تقبل قوله ألا تراه نفسه أيضاً قال: أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت أَمْ أُمّ سالم فكما لا يشك في أن كلامه ههنا خرج مخرج الشك لما فيه من عذوبته وظرف مذهبه فكذلك ينبغي أن يكون قوله: أو أنت في العين أملح أو فيه باقية في موضعها وعلى شكلها.
وبعد فهذا مذهب الشعراء: أن يظهروا في هذا ونحوه شكاً وتخالجا ليروا قوة الشبه واستتكام الشبهة ولا يقطعوا قطع اليقين البتة فينسبوا بذلك إلى الإفراط وغلو الأشطاط وإن كانوا هم ومن بحضرتهم ومن يقرأ من بعد أشعارهم يعلمون أن لا حيرة هناك ولا شبهة ولكن كذا خرج الكلام على الإحاطة بمحصول الحال.
وقال أيضاً: ذكرتك أن مرت بنا أم شادن أمام المطايا تشرئب وتسنح وقال الآخر: أقول لظبي يرتعي وسط روضة أأنت أخو ليلى فقال: يقال وما أحسن ما جاء به الطائي الصغير في قوله: عارضننا أصلاً فقلنا الربرب حتى أضاء الأقحوان الأشنب وقال الآخر: فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق وذهب قطربي إلى أن أو قد تكون بمعنى الواو وأنشد بيت النابغة: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فقال: معناه: ونصفه.
ولعمري إن كذا معناه.
وكيف لا يكون كذلك ولا بد منه وقد كثرت فيه الرواية أيضاً بالواو: ونصفه.
لكن هناك مذهب يمكن معه أن يبقى الحرف على أصل وضعه: من كون لاشك فيه وهو أن يكون تقديره: ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو هو ونصفه.
فحذف المعطوف عليها وحرف العطف على ما قدمناه في قوله عز وجل {فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً} أي فضرب فانفجرت.
وعليه قول الآخر: ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث إلى ذا كما ما غيبتني غيابيا أي شهرين أو شهرين ونصف ثالث ألا تراك لا تقول مبتدئاً: لبثت نصف ثالث لأن ثالثاً من الأسماء المضمنة بما معها.
ودعانا إلى هذا التأول السعي في إقرار هذه اللفظة على أول أحوالها.
فأما قول الله سبحانه {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} فلا يكون فيه أو على مذهب الفراء بمعنى بل ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى الواو.
لكنها عندنا على بابها في كونها شكاً.
وذلك أن هذا كلام خرج حكاية من الله عز وجل لقول المخلوقين.
وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون.
ومثله مما مخرجه منه تعالى على الحكاية قوله {ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} وإنما هو في الحقيقة الذليل المهان لكن معناه: ذق إنك أنت الذي كان يقال له: العزيز الكريم.
ومثله قوله عز وجل {وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ} أي يا أيها الساحر عندهم لا عندنا وكيف يكون ساحراً عندهم وهم به مهتدون.
وكذلك قوله {أَيْنَ شُرَكَآئِيَ} أي شركائي عندكم.
وأنشدنا أبو علي لبعض اليمانية يهجو جريرا: أبلغ كليباً وأبلغ عنك شاعرها أني الأغر وأني زهرة اليمن قال: فأجابه جرير فقال: ألم تكن في وسوم قد وسمت بها من حان موعظة يا زهرة اليمن! فسماه زهرة اليمن متابعة له وحكاية للفظه.
وقد تقدم القول على هذا الموضع.
ومن ذلك ما يدعيه الكوفيون من زيادة واو العطف نحو قول الله عز وجل {حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} قالوا: هنا زائدة مخرجة عن العطف.
والتقدير عندهم فيها: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها.
وزيادة الواو أمر لا يثبته البصريون.
لكنه عندنا على حذف الجواب أي حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها كذا وكذا صدقوا وعدهم وطابت نفوسهم ونحو ذلك مما يقال في مثل هذا.
وأجاز أبو الحسن زيادة الواو في خبر كان نحو قولهم: كان ولا مال له أي كان لا مال له.
ووجه جوازه عندي شبه خبر كان بالحال فجرى مجرى قولهم: جاءني ولا ثوب عليه أي جاءني عارياً.
فأما " هل " فقد أخرجت عن بابها إلى معنى قد نحو قول الله سبحانه {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْر} قالوا: معناه: قد أتى عليه ذلك.
وقد يمكن عندي أن تكون مبقاة في هذا الموضع على بابها من الاستفهام فكأنه قال والله أعلم: هل أتى على الإنسان هذا فلا بد في جوابه من نعم ملفوظاً بها أو مقدرة أي فكما أن ذلك كذلك فينبغي للإنسان أن يحتقر نفسه ولا يبأى بما فتح له.
وهذا كقولك لمن تريد الاحتجاج عليه: بالله هل سألتني فأعطيتك! أم هل زرتني فأكرمتك!.
أي فكما أن ذلك كذلك فيجب أن تعرف حقي عليك وإحساني إليك.
ويؤكد هذا عندك قوله تعالى {إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ} أفلا تراه عز اسمه كيف عدد عليه أياديه وألطافه له.
فإن قلت: فما تصنع بقول الشاعر: سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القف ذي الأكم ألا ترى إلى دخول همزة الاستفهام على هل ولو كانت على ما فيها من الاستفهام لم تلاق همزته لاستحالة اجتماع حرفين لمعنى واحد.
وهذا يدل على خروجها عن الاستفهام إلى معنى الخبر.
قيل: هذا قول يمكن أن يقوله صاحب هذا المذهب.
ومثله خروج الهمزة عن الاستفهام إلى التقرير ألا ترى أن التقرير ضرب من الخبر وذلك ضد الاستفهام.
ويدل على أنه قد فارق الاستفهام امتناع النصب بالفاء في جوابه والجزم بغير الفاء في جوابه ألا تراك لا تقول: ألست صاحبنا فنكرمك كما تقول لست صاحبنا فنكرمك.
ولا تقول في التقرير: أأنت في الجيش أثبت اسمك كما تقول ما اسمك أذكرك أي إن أعرفه أذكرك.
ولأجل ما ذكرنا من حديث همزة التقرير ما صارت تنقل النفي إلى الإثبات والإثبات إلى النفي وذلك كقوله: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح أي أنتم كذاكم وكقول الله عز وجل {آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ} و {أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ} أي لم يأذن لكم ولم تقل للناس: اتخذوني وأمي إلهين ولو كانت استفهاماً محضاً لأقرت الإثبات على إثباته والنفي على نفيه.
فإذا دخلت على الموجب نفته وإذا دخلت على النفي نفته ونفي النفي عائد به إلى الإثبات.
ولذلك لم يجيزوا ما زال زيد إلا قائماً لما آل به المعنى من النفي إلى: ثبت زيد إلا قائماً.
فكما لا يقال هذا فكذلك لا يقال ذلك.
فاعرفه.
ويدل على صحة معنى التناكر في همزة التقرير أنها قد أخلصت للإنكار في نحو قولهم في جواب قوله ضربت عمر: أعمراه! ومررت بإبراهيم: أإبراهيماه.
ورأيت جعفرا: أجعفرنيه واعلم أنه ليس شيء يخرج عن بابه إلى غيره إلا لأمر قد كان وهو على بابه ملاحظاً له وعلى صدد من الهجوم عليه.
وذلك أن المستفهم عن الشي قد يكون عارفاً به مع استفهامه في الظاهر عنه لكن غرضه في الاستفهام عنه أشياء.
منها أن يرى المسئول أنه خفي عليه ليسمع جوابه عنه.
ومنها أن يتعرف حال المسئول هل هو عارف بما السائل عارف به.
ومنها أن يرى الحاضر غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد لما له في ذلك من الغرض.
ومنها أن يعد ذلك لما بعده مما يتوقعه حتى إن حلف بعد أنه قد سأله عنه حلف صادقاً فأوضح بذلك عذراً.
ولغير ذلك من المعاني التي يسأل السائل عما يعرفه لأجلها وبسببها.
فلما كان السائل في جميع هذه الأحوال قد يسأل عما هو عارفه أخذ بذلك طرفاً من الإيجاب لا السؤال عن مجهول الحال.
وإذا كان ذلك كذلك جاز لأجه أن يجرد في بعض الأحوال ذلك الحرف لصريح ذلك المعنى.
فمن هنا جاز أن تقع هل في بعض الأحوال موضع قد كما جاز لأو أن تقع في بعض الأحوال موقع الواو نحو قوله: وكان سيان ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت السوح جاز لك لما كنت تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين فيكون مع ذلك متى جالسهما جميعاً وكل حرف فيما بعد يأتيك قد أخرج عن بابه إلى باب آخر فلا بد أن يكون قبل إخراجه إليه قد كان يرائيه ويلتفت إلى الشق الذي هو فيه.
فاعرف ذلك وقسه فإنك إذا فعلته لم تجد الأمر إلا كما ذكرته وعلى ما شرحته.
باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد
اعلم أن هذا موضع قد استعملته العرب واتبعتها فيه العلماء.
والسبب في هذا الاتساع أن المعنى المراد مفاد من الموضعين جميعاً فلما آذنا به وأديا إليه سامحوا أنفسهم في العبارة عنه إذ المعاني عندهم أشرف من الألفاظ.
وسنفرد لذلك باباً.
فمن ذلك ما حكاه أبو الحسن: أنه سأل أعرابياً عن تحقير الحباري فقال: حبرور.
وهذا جواب من قصد الغرض ولم يحفل باللفظ إذ لم يفهم غرض أبي الحسن فجاء بالحبرور لأنه فرخ الحباري.
وذلك أن هذا الأعرابي تلقى سؤال أبي الحسن بما هو الغرض عند الكافة في مثله ولم يحفل بصناعة الإعراب التي إنما هي لفظية ولقوم مخصوصين من بين أهل الدنيا أجمعين.
ونحو من ذلك أني سألت الشجري فقلت: كيف تجمع المحر نجم فقال: وأيش فرقه حتى أجمعه! وسألته يوماً فقلت: كيف تحقر الدمكمك فقال: شخيت.
فجاء بالمعنى الذي يعرفه ونحو من هذا ما يحكى عن أبي السمال أنه كان يقرأ: فحاسوا خلال الديار فيقال له: إنما هو فجاسوا فيقول: جاسوا وحاسوا واحد.
وكان أبو مهدية إذا أراد الأذان قال: الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله ِإلا الله مرتين ثم كذلك إلى آخره.
فإذا قيل له: ليست السنة كذلك إنما هي: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فيقول: قد عرفتم أن المعنى واحد والتكرار عي.
وحكى عيسى بن عمر قال: سمعت ذا الرمة ينشد: وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سترا فقلت: أنشدتني: من بائس فقال يابس وبائس واحد.
وأخبرنا أبو بكر محمد ابن الحسن عن العباس أحمد بن يحيى قال أنشدني ابن الأعرابي: وموضع زَبْن لا أريد مبيته كأني به من شدة الروع آنس فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتنا إنما أنشدتنا: وموضع ضيق.
فقال: سبحان الله! تصحبنا منذ كذا وكذا ولا تعلم أن الزبن والضيق واحد وقد قال الله سبحانه وهو أكرم قيلا: {قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )نزل القرآن على سبع لغات كلها شاف كاف(.
وهذا ونحوه عندنا هو الذي أدى إلينا أشعارهم وحكاياتهم بألفاظ مختلفة على معان متفقة.
وكان أحدهم إذا أورد المعنى المقصود بغير لفظه المعهود كأنه لم يأت إلا به ولا عدل عنه إلى غيره إذ الغرض فيهما واحد وكل واحد منهما لصاحبه مرافد.
وكان أبو علي رحمه الله إذا عبر عن معنى بلفظ ما فلم يفهمه القارئ عليه وأعاد ذلك المعنى عينه بلفظ غيره ففهمه يقول: هذا إذا رأى ابنه في قميص أحمر عرفه فإن رآه في قميص كحلي لم يعرفه.
فأما الحكاية عن الحسن رضي الله عنه وقد سأله رجل عن مسئلة ثم أعاد السؤال فقال له الحسن: لبكت علي أي خلطت فتأويله عندنا أنه أفسد المعنى الأول بشيء جاء به في القول الثاني.
فأما أن يكون الحسن تناكر الأمر لاختلاف اللفظين مع اتفاق المعنيين فمعاذ الله وحاشى أبا سعيد.
ويشبه أن يكون الرجل لما أعاد سؤاله بلفظ ثان قدر أنه بمعنى اللفظ الأول ولم يحسن ما فهمه الحسن رضي الله عنه كالذي يعترف عند القاضي بما يدعي عليه وعنده أنه مقيم على إنكاره إياه.
ولهذا نظائر.
ويحكى أن قوماً ترافعوا إلى الشعبي في رجل بخص عين رجل فشرقت بالدم فأفتى في ذلك بأن أنشد بيت الراعي: لها أمرها حتى إذا ما تبوأت بأخفافها مأوى تبوأ مضجعا لم يزدهم على هذا.
وتفسيره أن هذه العين ينتظر بها أن يستقر أمرها على صورة معروفة محصلة ثم حينئذ يحكم في بابها بما توجبه الحال من أمرها.
فانصرف القوم بالفتوى وهم وأما اتباع العلماء العرب في هذا النحو فكقول سيبويه: ومن العرب من يقول: لب فيجره كجر أمس وغاق ألا ترى أنه ليس في واحد من الثلاثة جر إذ الجر إعراب لا بناء وهذا الكلم كلها مبنية لا معربة فاستعمل لفظ الجر على معنى الكسر كما يقولون في المنادى المفرد المضموم: إنه مرفوع وكما يعبرون بالفتح عن النصب وبالنصب عن الفتح وبالجزم عن الوقف وبالوقف عن الجزم كل ذلك لأنه أمر قد عرف غرضه والمعنى المعني به.
وإذا جاز أن يكون في أصول هذه اللغة المقررة اختلاف اللفظين والمعنى واحد كان جميع ما نحن فيه جائزاً سائغاً ومأنوساً به متقبلاً.
باب في ملاطفة الصنعة
وذلك أن ترى العرب قد غيرت شيئاً من كلامها من صورة إلى صورة فيجب حينئذ أن تتأتى لذلك وتلاطفه لا أن تخبطه وتتعسفه.
وذلك كقولنا في قولهم في تكسير جَرْ ودَلْوِ أَجرٍ وأَدلٍ: إن أصله أجرُوٌ وأدلُوٌ فقلبوا الواو ياء.
وهو لعمري كذلك إلا أنه يجب عليك أن تلاين الصنعة ولا تعازها فتقول: إنهم أبدلوا من ضمة العين كسرة فصار تقديره: أجرِوٌ وأدلِوٌ.
فلما انكسر ما قبل الواو وهي لام قلبت ياء فصارت أجرِيٌ وأدْلِيٌ وإنما وجب أن يرتب هذا العمل هذا الترتيب من قبل أنك لما كرهت الواو هنا لما تتعرض له من الكسرة والياء في أدْلُوَ وأدلُوِيّ لو سميت رجلاً بأدلُو ثم أضفت إليه فلما ثقل ذلك بدءوا بتغيير الحركة الضعيفة تغييراً عَبْطا وارتجالاً.
فلما صارت كسرة تطرقوا بذلك إلى قلب الواو ياء تطرقاً صناعياً.
ولو بدأت فقلبت الواو ياء بغير آلة القلب من الكسرة قبلها لكنت قد استكرهت الحرف على نفسه تهالكاً وتعجرفاً لا رفقاً وتلطفاً.
ولما فعلت ذلك في الضمة كان أسهل منه في الواو والحرف لأن ابتذالك الضعيف أقرب مأخذاً من إنحائك على القوى.
فاعرف ذلك أصلاً في هذا الباب.
وكذلك بقاب فُعُول مما لامه واو وكدَلْوٍ ودِلِيّ وحَقْوٍ وحِقِيّ أصله دُلُوّ وحُقُوّ.
فلك في إعلال هذا إلى حِقِيّ ودِلِيّ طريقان.
إن شئت شبهت واو فُعُول المدغمة بضمة عين أفعُل في أدلوٍ وأحقُوٍ فأبدلت منها ياء كما أبدلت من تلك الضمة كسرة فصارت: حُقِيُّو.
ثم أبدلت الواو التي هي لام ياء لوقوع الياء ساكنة قبلها فصارت حُقِيّ ثم أتبعت فقلت: حِقِيّ.
وهذا أيضاً مما أبدلت من ضمة عينه كسرة فتنقلب واو فعول بعدها ياء كالباب الأول.
فصارت أول: حُقُوّ ثم حقِيو قم حُقِيّ ثم حِقِيّ.
فهذا وجه.
وإن شئت قلت: بدأت بدُلُوٍّ فأبدلت لامها لضعفها بالتطرف وثقلها ياء فصارت دُلُويٌ.
ثم أبدلت الواو ياء لوقوع الياء بعدها فصارت حُثُيّ ثم أبدلت من الضمة في العين كسرة لتصح الياء بعدها فصارت: حُقِيّ ثم أتبعت فقلت: حِقِيّ ودِلِيّ.
ومن ذلك قولهم: إن أصل قام قَوَمَ فأبدلت الواو ألفاً.
وكذلك باع أصله بَيَعَ ثم أبدلت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.
وهو لعمري كذلك إلا أنك لم تقلب واحداً من الحرفين إلا بعد أن أسكنته استثقالاً لحركته فصار إلى قَوْمَ وبَيْعَ ثم انقلبا لتحركهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما الآن.
ففارقا بذلك باب ثوب وشيخ لأن هذين ساكنا العينين ولم يسكنا عن حركة.
ولو رمت قلب الواو والياء من نحو قوم وبيع وهما متحركتان لاحتمتا بحركتيهما فعزتا فلم تنقلب.
فهذا واضح.
ومن ذلك ست أصلها سدس فلما كثرت في الكلام أبدلوا السين تاء كقولهم.
النات في الناس ونحوه فصارت سِدْت.
فما تقارب الحرفان في مخرجيهما أبدلت الدال تاء وأدغمت في التاء فصارت ستّ.
ولو بدأت هذا الإبدال عارياً من تلك الصنعة لكان استطالة على الحرفين وهتكا للحرمتين.
فاعرف بهذا النحو هذه الطريق ولا تقدمن على أمر من التغيير إلا لعذر فيه وتأت له ما استطعت.
فإن لم تجن على الأقوى كانت جنايتك على الأضعف لتتطرق به إلى إعلال الأقوى فأما قوله: أو إلفاً مكة من ورق الحمى فلم تكن الكسرة لتقلب الميم ياء ألا تراك تقولك تظنيت وتقصيت والفتحة هناك لكنه كسر للقافية.
ومن ذلك مذهب أبي الحسن في قول الله تعالى: {وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً} لأنه ذهب إلى أنه حذف حرف الجر فصار تجزيه ثم حذف الضمير فصار تجزى.
فهذا ملاطفة من الصنعة.
ومذهب سيبويه أنه حذف فيه دفعة واحدة.
باب في التجريد
اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طريف حسن.
ورأيت أبا علي رحمه الله به غرياً معنياً ولم يفرد له باباً لكنه وسمه في بعض ألفاظه بهذه السمة فاستقر يتها منه وأنقت لها.
ومعناه أن العرب قد تعتقد أن في الشيء من نفسه معنى آخر كأنه حقيقته ومحصوله.
وقد يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت عليه معانيها.
وذلك نحو قولهم: لئن لقيت زيداً لتلقين منه الأسد ولئن سألته لتسئلن منه البحر.
فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً وبحراً وهو عينه هو الأسد وعلى هذا يخاطب الإنسان منهم نفسه حتى كأنها تقابله أو تخاطبه.
ومنه قول الأعشى: وهل تطيق وداعاً أيها الرجل وهو الرجل نفسه لا غيره.
وعليه قراءة من قرأ {قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أي اعلم أيها الإنسان وهو نفسه الإنسان وقال تعالى {لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ} وهي نفسها دار الخلد.
وقال الأعشى: لات هنا ذكرى جبيرة أم من جاء منها بطائف الأهوال وهي نفسها الجائية بطائف الأهوال.
وقد تستعمل الباء هنا فتقول: لقيت به الأسد وجاورت به البحر أي لقيت بلقائي إياه الأسد.
ومنه مسئلة الكتاب: أما أبوك فلك أب أي لك منه أو به بمكانه أب.
وأنشدنا: أفاءت بنو مروان ظلماً دماءنا وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل وهذا غاية البيان والكشف ألا ترى أنه لا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه ظرف لشيء ولا متضمن له فهو إذاً على حذف المضاف أي في عدل الله عدل حكم عدل.
وأنشدنا: ومصعب نفسه هو الأشعث.
وأنشدنا: جازت البيد إلى أرحلنا آخر الليل بيعفور خدر وهي نفسها اليعفور.
ولعيه جاء قوله: يا نفس صبراً كل حي لاق وكل اثنين إلى افتراق وقول الآخر: قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصد وقول الآخر: أقول للنفس تأساءً وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم ترد وأما قوله عز اسمه {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ} فليس من ذا بل النفس هنا جنس وهو كقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} ونحوه.
وقد دعا تردد هذا الموضع على الأسماع ومحادثته الأفهام أن ذهب قوم إلى أن الإنسان هو معنى ملتبس بهذا الهيكل الذي يراه ملاق له وهذا الظاهر مماس لذلك الباطن كل جزء منه منطو عليه ومحيط به.
باب في غلبة الزائد للأصلي
أما إذا كان الزائد ذا معنى فلا نظر في اسبقائه وحذف الأصلي لمكانه نحو قولهم هذا قاضٍ ومعطٍ ألا تراك حذفت الياء التي هي لام للتنوين إذ كان ذا معنى أعني الصرف.
ومثل ذلك قوله: لاث به الأشاء والعبريّ حذفت عين فاعل وأقررت ألفه إذ كانت دليلاً على اسم الفاعل.
ومثله قوله: شاك السلاح بطل مجرب وهذا أحد ما يقوى قول أبي الحسن في أن المحذوف من باب مقول ومبيع إنما هو العين من حيث كانت الواو دليلاً على اسم المفعول.
وقال ابن الأعرابي في قوله: في بئر لا حور سرى وما شعر أراد: حؤور أي في بئر لا حوور لا رجوع.
قال: فأسكنت الواو الأولى وحذفت لسكونها وسكون الثانية بعدها.
وكذلك حذفت لام الفعل لياءي الإضافة في نحو مصطفى وقاضي ومرامي في مرامى.
وكذلك باب يعد ويزن حذفت فاؤه لحرق المضارعة الزائدة كل ذلك لما كان الزائد ذا معنى.
وهذا أحد ما يدل على شرف المعاني عندهم ورسوخها في أنفسهم.
نعم وقد حذفوا الأصل عند الخليل للزائد وإن كانا متساويي المعنيين.
وإذا كان ذلك جائزاً بني عقيل ماذه الخنافق! المال هدى والنساء طالق فالخنافق جمع خنفقين والنون زائدة والقاف الأولى عند الخليل هي الزائدة والثانية هي الأصل وهي المحذوفة وقد قدمنا دليل ذلك والنون والقاف جميعاً لمعنى واحد وهو الإلحاق.
فإذا كانوا قد حذفوا الأصل للزائد وهما في طبقة واحدة أعني اجتماعهما على كونهما للإلحاق فكيف ليت شعري تكون الحال إذا كان الزائد لمعنى والأصل المحذوف لغير معنى! وهذا واضح.
وفي قولهم: خنافق تقوية لقول سيبويه في تحقير مقعنسس وتكسيره مقاعس ومقيعس فاعرفه فإنه قويّ في بابه.
بل إذا كانوا قد حذقوا الملحق للملحق فحذف الملحق لذي المعنى وهو الميم أقوى وأحجى.
وكأنهم إنما أسرعوا إلى حذف الأصل للزائد تنويهاً به وإعلاء له وتثبيتاً لقدمه في أنفسهم وليعلموا بذلك قدره عندهم وحرمته في تصورهم ولحاقه بأصول الكلم في معتقدهم ألا تراهم قد يقرونه في الاشتقاق مما هو فيه إقرارهم الأصول.
وذلك قولهم: قرنيت السقاء إذا دبغته بالقَرْنُوة فاشتق الفعل منها وأقرت الواو الزائدة فيها حتى أبدلت ياء في قرنيت.
ومثله قولهم: قَلْسيت الرجل فالياء هنا بدل من واو قلنسُوة الزائدة ومن قال قلنسته فقد أثبت أيضاً النون فنظير تقويتهم أمر الزائد وحذف الأصل له قول الشاعر: أميل مع الذمام على ابن عمي واحمل للصديق على الشقيق وجميع ما ذكرناه من قوة الزائد عندهم وتمكنه في أنفسهم يضعف قول من حقر تحقير الترخيم ومن كسر على حذف الزيادة.
وقد ذكرنا هذا.
إلا أن وجه جواز ذلك قول الآخر: كيما أعدهم لأبعد منهم ولقد يجاء إلى ذوي الأحقاد وقول المولد: وأنف الفتى من وجهه وهو أجدع وقول الآخر: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح وهو باب واسع.
باب في أن ما لا يكون للأمر وحده
قد يكون له إذا ضام غيره من ذلك الحرف الزائد لا يكون للإلحاق أولاً كهمزة أفعَل وأَفْعُل وإفعْلَ وأَفعِل وإفِعِلٍ ونحو ذلك وكذلك ميم مفعل ونحوه.
فإذا انضم إلى الزيادة أولا زيادة أخرى صارت للإلحاق.
وذلك نحو ألندد وألنجج الهمزة والنون للإلحاق.
وكذلك يلندد ويلنجح فإن زالت النون لم تكن الهمزة ولا الياء وحدهما للإلحاق.
وذلك نحو ألد ويلج.
وعلة ذلك أن الزيادة في أول الكلة إنما بيابها معنى المضارعة وحرف المضارعة إنما يكون مفرداً أبداً فإذا انضم إليه غيره خرج بمضامته إياه عن أن يكون للمضارعة فإذا خرج عنها وفارق الدلالة على المعنى جعل للإلحاق لأنه قد أمن بما انضم إليه أن يصلح للمعنى.
وكذلك ميم مفعول جعلت واو مفعول وإن كانت للمد دليلة على معنى اسم المفعول ولولا الميم لم تكن إلا للمد كفعول وفعيل وفعال ونحو ذلك إلا أنها وإن كانت قد أفادت هذا المعنى فإن ما فيها من المد والاستطالة معتد فيها مراعي من حكمها.
ويدلك على بقاء المد فيها واعتقادها مع ما أفادته من معنى اسم المفعول له أن العرب لا تلقى عليها حركة الهمزة بعدها إذا آثرت تخفيفها بل تجريها مجراها وهي للمد خالصة ألا تراهم يقولون في تخفيف مشنوءة بالإدغام البتة كما يقولون في تخفيف شنوءة.
وذلك قولهم: مَشْنُوَّة كشَنُوَّة فلا يحركون واو مفعول كما لا يحركون واو فعول وإن كانت واو مفعول تفيد مع مدها اسم المفعول وواو فعول خلصة للمد البتة.
فإن قلت: فما تقول في أفعول نحو أسكوب هل هو ملحق بجر موق قيل: لان ليس ملحقاً به بل الهمزة فيه للبناء والواو فيه للمد البتة لأن حرف المد إذا جاور الطرف لا يكون للإلحاق أبداً لأنه كأنه إشباع للحركة كالصيارف ونحوه ولا يكون أفعول إلا للمد ألا ترى أنك لا تستفيد بهمزة أفعول وواوه معنى مخصوصاً كما تستفيد بميم مفعول وواوه معنى مخصوصاً وهو إفادة اسم المفعول.
فهذا من طريق التأمل واضح.
وإذا كان كذلك إفعيل لا يكون ملحقاً.
وأبين منه باب إفعال لأنه موضع للمعنى وهو المصدر نحو الإسلام والإكرام.
والمعنى أغلب على المثال من الإلحاق.
وكذلك باب أفعال لأنه موضوع للتكسير كأقتاب وأرسان.
فإن قلت: فقد جاء عنهم نحو إمخاض وإسنام وإصحاب وإطنابة قيل: هذا في الأسماء قيل جداً وإنما بابه المصادر البتة.
وكذلك ما جاء عنهم من وصف الواحد بمثال أفعال نحو برمة أعشار وجفنة أكسار وثوب أكباش وتلك الأحرف المحفوظة في هذا.
إنما هي على أن جعل كل جزء منها عشراً وكسرا وكبشا.
وكذلك كبد أفلاذ وثوب أهباب وأخباب وحَبْل أرمام وأرماث وأقطاع وأحذاق وثوب أسماط كل هذا متأول فيه معنى الجمع.
وكذلك مفعيل ومفعول ومفعال ومَفْعَل: ليس شيء من ذلك ملحقاً لأن أصل زيادة الميم في الأول إنما هي لمعنى وهذه غير طريق الإلحاق.
ولهذا ادغموه فقالوا: مِصَكَ ومِتلّ ونحوهما.
وأما أُفاعِل كأُحامِر وأجارِد وأباتر فلا تكون الهمزة فيه والألف للإلحاق بباب قُذَعْمِل.
ومن أدل الدليل على ذلك أنك لا تصرف شيئاً من ذلك علماً.
وذلك لما فيه من التعريف ومثال الفعل لأن أجارد وأباترا جار مجرى أضارب وأفاتل.
وإذا جرى مجراه فقد لحق في المثال به والهمزة في ذلك إما هي في أصل هذا المثال للمضارعة والألف هي ألف فاعل في جارد وباتر لو نطقوا به وهي كما تعلم للمعنى كألف ضارب وقاتل.
فكل واحد من الحرفين إذاً إنما هو للمعنى وكونه للمعنى أشد شيء إبعادا لها عن الإلحاق لتضاد القضيتين عليه من حيث كان الإلحاق طريقاً صناعياً لفظياً والمعنى طريقاً مفيداً معنوياً.
وهاتان طريقتان متعاديتان.
وقد فرغنا منهما فيما قبل.
وأيضاً فإن الألف لا تكون للإلحاق حشو أبداً إنما تكون له إذا وقعت طرفاً لا غير كأرطًى ومعزي وحَبَنْطى.
وقد تقدم ذلك أيضاً.
ولا يكون أجارد أيضاً ملحقاً بعذافر لما قدمناه: من أن الزيادة في الأول لا تكون للإلحاق إلا أن يقترن بها حرف غير مدّ كنون ألندد وواو إزْمَول وإسْحَوفٍ وإدْرَون لكن دُوَاسر ملحق بعُذافر.
ومثله عُيَاهِم.
وكذلك كَوَأْلَل ملحق بسهبلل الملحق بهمرجل.
وأدل دليل على ألحاقه ظهور تضعيفه أعني كوأللاً.
ومثله سبهلل.
فاعرفه.
ومثل طومار عندنا ديماس فيمن قال: دياميس وديباج فيمن قال: ديابيج هو ملحق بقرطاس كما أن طومارا ملحق بفسطاط.
وساغ أن تكون الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها للإلحاق من حيث كانتا لا تجاوران الطرف بحيث يتمكن المد.
وذلك أنك لو بنيت مثل طومار أو ديماس من سألت لقلت: سوآل وسيئال فإن خففت حركت كل واحد من الحرفين بحركة الهمزة التي بعده فقلت: سوال وسيال ولم تقلب الهمزة وتدغم فيها الحرف كمقرو والنسي لأن الحرفين تقدما عن الموضع الذي يقوي فيه حكم المد وهو جواره الطرف.
وقد تقدم ذلك.
فتأمل هذه المواضع التي أريتكها فإن أحداً من أصحابنا لم يذكر شيئاً منها.
باب في أضعف المعتلين وهو اللام لأنها أضعف من العين.
يدل على ذلك قولهم في تكسير فاعل مما اعتلت لامه: إنه يأتي على فُعّلة نحو قاض وقضاة وغاز وغزاة وساع وسعاة.
فجاء ذلك مخالفاً للتصحيح الذي يأتي على فَعَلة نحو كافر وكفرة وبار وبررة.
هذا ما دام المعتل من فاعل لامه.
فإن كان معتله العين فإنه يأتي مأتى الصحيح على فَعَلة.
وذلك نحو حائك وحَوَكة وخائن وخوَنة وخانة وبائع وباعةٍ وسائِد وسادة أفلا ترى كيف اعتد اعتلال اللام فجاء مخالفاً للصحيح ولم يحفلوا باعتلال العين لأنها لقوتها بالتقدم لحقت وجاء عنهم سرى وسراة مخالفاً.
وحكى النضر سراة.
فسراة في تكسير سرى عليه بمنزلة شعراء من شاعر.
وذلك أنهم كما كسروا فعلاً على فُعلا وإنما فعلاء لباب فعِيل كظريف وظُرفاء وكريم وكرماء وكذلك كسروا أيضاً فعيلاً على فَعَلة وإنما هي لفاعل.
فإن قلت: فقد قالوا: فَيْعِل مما عينه معتلة نحو سيد وميت فبنوه على فيِعل فجاء مخالفاً للصحيح الذي إنما بابه فيعل نحو صيرف وخيفق وإنما اعتلاله من قبل عينه وجاءت أيضاً الفيعلولة في مصادر ما اعتلت عينه نحو الكينونة والقيدودة فقد أجروا العين في الاعتلال أيضاً مجرى اللام في أن خصوها بالبناء الذي لا يجود في الصحيح.
قيل: على كل حال اعتلال اللام أقعد في معناه من اعتلال العين ألا ترى أنه قد جاء فيما عينه معتلة فيعل مفتوحة العين في قوله: ما بال عيني كالشعيب العين وقالوا أيضاً: هَيَّبان وتيَّحان بفتح عينهما ولم يأت في باب ما اعتلت لامه فاعل مكسراً على فَعَلة.
فالاعتلال المعتد إذاً إنما هو للام ثم حملت العين عليها فيما ذكرت لك.
ويؤكد عندك قوة العين على اللام أنهما إذا كانتا حرفي علة صحت العين واعتلت اللام وذلك نحو نواة وحياة والجوى والطوى.
ومثله الضواة والحواة.
فأما آية وغاية وبابهما فشاذ.
وكأن فيه ويدلك على ضعف اللام عندهم أنهم إذا كسروا كلمة على فعائل وقد كانت الياء ظاهرة في واحدها لا ما فإنهم مما يظهرون في الجمع ياء.
وذلك نحو مطية ومطايا وسبية وسبايا وسوية وسوايا فهذه اللام.
وكذلك إن ظهرت الياء في الواحد زائدة فإنهم أيضاً مما يظهرونها في الجمع.
وذلك نحو خطيئة وخطايا ورزية ورزايا أفلا ترى إلى مشابهة اللام للزائد.
وكذلك أيضاً لو كسرت نحو عظاية وصلاية لقلت: عظايا وصلايا.
وأيضاً فإنك تحذفها كما تحذف الحركة.
وذلك في نحو لم يَدْعُ ولم يرم ولم يَخش.
فهذا كقولك: لم يضرب ولم يقعد وإن تقعد أقعد.
ومنها أيضاً حذفهم إياها وهي صحيحة للترخيم في نحو يا حار ويا مال.
فهذا نحو حذفهم الحركات الزوائد في كثير من المواضع.
ولو لم يكن من ضعف اللام إلا اختلاف أحوالها باختلاف الحركات عليها نعم وكنها في الوقف على حال يخالف حالها في الوصل نحو مررت بزيد يا فتى ومررت بزيدْ وهذه قائمة يا فتى وهذه قائمهْ لكان كافياً أو لا ترى إلى كثرة حذف اللام نحو يد ودم وغد وأب وأخ وذلك الباب وقلة حذف العين في سهٍ ومُذْ.
فبهذا ونحوه يعلم أن حرف العلة في نحو قام وباع أقوى منه في باب غزوت ورميت.
فاعرفه.
باب في الغرض في مسائل التصريف
وذلك عندنا على ضربين: أحدهما الإدخال لما تبنيه في كلام العرب والإلحاق له به.
والآخر التماسك الرياضة به والتدرب بالصنعة فيه.
الأول نحو قولك في مثل جعفر من ضرب: ضَرْبَب ومثل حُبْرُج: ضُرْبُب ومثل صِفْرٍد: ضِرْبِب ومثل سِبَطْر: ضِرَبّ ومثل فرزدق من جعفر: جَعَفْرَر.
فهذا عندنا كله إذا بنيت شيئاً منه فقد ألحقته بكلام العرب وأدعيت بذلك أنه منه.
وقد تقدم ذكر ما هذه سبيله فيما مضى.
الثاني: وهو نحو قولك في مثل فيعول من شويت: شَيْوِيّ وفي فعول منه: شُووٍيّ وفي مثل عَضْرفُوط من الآءة: أَوْ أَيُوء ومنها مثل صُفُرُّق: أُوُؤْيُؤ ومن يوم مثل مَرْمَريس: يَوْيَوِيم ومثل ألندد أيَنْوَم ومثل قولك في نحو افعوعلت من وأيت: ايأوْأيت.
فهذا ونحوه إنما الغرض فيه التأنس به وإعمال الفكرة فيه لاقتناء النفس القوة على ما يرد مما فيه نحو مما فيه.
ويدلك على ذلك أنهم قالوا في مثال إوزة من أويت: إياة والأصل فيه على الصنعة إيَويَة فأعلت فيه الفاء والعين واللام جميعاً.
وهذا مما لم يأت عن العرب مثلهُ.
نعم وهم لا يوالون بين إعلالين إلا لمحاً شاذاً ومحفوظاً نادراً فكيف بأن يجمعوا بني ثلاثة إعلالات! هذا مما لا ريب فيه ولا تخالج شك في شيء منه.
باب في اللفظ يرد محتملاً
لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه أيجازان جميعاً فيه أم يقتصر على الأقوى منهما دون صاحبه اعلم أن المذهب في هذا ونحوه أن يعتقد الأقوى منهما مذهباً.
ولا يمتنع مع ذلك أن يكون الآخر مراداً وقولاً.
من ذلك قوله: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا فالقول أن يكون ناهياً اسم الفاعل من نهيت كساع من سعيت وسار من سريت.
وقد يجوز مع هذا أن يكون ناهياً هنا مصدراً كالفالج والباطل والعائر والباغز ونحو ذلك مما جاء فيه المصدر على فاعل حتى كأنه قال: كفى الشيب والإسلام للمرء نهياً وردعاً أي ذا نهي فحذف المضاف وعلقت اللام بما يدل عليه الكلام.
ولا تكون على هذا معلقة بنفس الناهي لأن المصدر لا يتقدم شيء من صلته عليه.
فهذا وإن كان عسفاً فإنه جائز للعرب لأن العرب قد حملت عليه فيما لا يشك فيه فإذا أنت أجزته هنا فلم تجز إلا جائزاً مثله ولم تأت إلا ما أتوا بنحوه.
وكذلك قوله: فظاهر هذا أن يكون جوازيه جمع جاز أي لا يعدم شاكراً عليه ويجوز أن يكون جمع جزاء أي لا يعدم جزاء عليه.
وجاز أن يجمع جزاء على جواز لمشسابهة المصدر اسم الفاعل فكما جمع سيل على سوائل نحو قوله: وكنت لقًى تجري عليك السوائل أي السيول كذلك يجوز أن يكون جوازيه جمع جزاء.
ومثله قوله: وتترك أموال عليها الخواتم يجوز أن يكون جمع خاتم أي آثار الخواتم ويجوز أن يكون جمع ختم على ما مضى.
ومن ذلك قوله: ومن الرجال أسنة مذروبة ومزندون شهودهم كالغائب يجوز أن يكون شهودهم جمع شاهد وأراد: كالغياب فوضع الواحد موضع الجمع على قوله: على رءوس كرءوس الطائر يريد الطير ويجوز أن يكون شهودهم مصدراً فيكون الغائب هنا مصدراً أيضاً كأنه قال: شهودهم كالغيبة أو المغيب ويجوز أيضاً أن يكون على حذف المضاف أي شهودهم كغيبة ومن ذلك قوله: إلا يكن مال يثاب فإنه سيأتي ثنائي زيدا ابن مهلهل فالوجه أن يكون أني مهلهل بدلاً من زيد لا وصفاً له لأنه لو كان وصفاً لحذف تنوينه فقيل: زيد بن مهلهل.
ويجوز أيضاً أن يكون وصفاً أخرج على أصله ككثير من الأشياء تخرج على أصولها تنبيهاً على أوائل أحوالها كقول الله سبحانه: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ} ونحوه.
ومثله قول الآخر: جارية من قيس ابن ثعلبه القول في البيتين سواء.
والقول في هذا واضح ألا ترى أن العالم الواجد قد يجيب في الشيء الواحد أجوبة وإن كان بعضها أقوى من بعض ولاتمنعه قوة القوى من إجازة الوجه الآخر إذ كان من مذاهبهم وعلى سمت كلامهم كرجل له عدة أولاد فكلهم ولد له ولاحق به وإن تفاوتت أحوالهم في نفسه.
فإذا رأيت العالم قد أفتى في شيء من ذلك بأحد الأجوبة الجائزة فيه فلأنه وضع يده على أظهرها عنده فأفتى به وإن كان مجيزاً للآخر وقائلاً به ألا ترى إلى قول سيبويه في قولهم: لفه مائة بيضاً: إنه حال من النكرة وإن كان جائزاً أن يكون بيضا حالاً من الضمير المعرفة المرفوع في لعزة موحشا طلل فقال فيه: إنه حال من النكرة ولم يحمله على الضمير في الظرف.
أفيحسن بأحد أنيدعى على أحد متوسطينا أن يخفى هذا الموضع عليه فضلاً عن المشهود له بالفضل: سيبويه.
نعم وربما أفتى بالوجه الأضعف عنده لأنه على الحالات وجه صحيح.
وقد فعلت العرب ذلك عينه ألا ترى إلى قول عمارة لأبي العباس وقد سأله عما أراد بقراءته: {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} فقال له: ما أردت فقال أردت: سابق النهار فقال له أبو العباس: فهلا قلته فقال لو قلته لكان أوزن أي أقوى.
وهذا واضح.
فاعرف ذلك ونحوه مذهباً يقتاس به ويفزع إليه.
باب فيما يحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق
وجماع ذلك التقاء الساكنين المعتلين في الحشو.
وذلك كمفعول مما عينه حرف علة نحو مقول ومبيع ألا ترى أنك لما نقلت حركة العين من مقوول ومبيوع إلى الفاء فصارت في التقدير إلى مقُوْوْل ومَبُوْع تصورت حالاً لا يمكنك النطق بها فاضطررت حينئذ إلى حذف أحد الحرفين على اختلاف المذهبين.
وعلى ذلك قال أبو إسحاق لإنسان ادعى له أنه يجمع في كلامه بين ألفين وطول الرجل وكذلك فاعل مما اعتلت عينه نحو قائم وبائع ألا تراك لما جمعت بين العين وألف فاعل ولم تجد إلى النطق بهما على ذلك سبيلاً حركت العين فانقلبت همزة.
ومنهم من يحذف فيقول: شاك السلاح بطل مجرب ويقول أيضا: لاث به الأشاء والعبري وعلى ذلك أجازوا في يوم راح ورجل خاف أن يكون فعلاً وأن يكون فاعلاً محذوف العين لالتقاء الساكنين.
فإن اختلف الحرفان المعتلان جاز تكلف جمعهما حشوا نحو قاوْت وقايْت وقْيوت.
فإن تأخرت الألف في نحو هذا لم يمكن النطق بها كأن تتكلف النطق بقوات أو بقيات.
وسبب امتناع ذلك لفظاً أن الألف لا سبيل إلى أن تكون ما قبلها إلا مفتوحاً وليست كذلك الياء والواو.
فأنت إذا تكلفت نحو قاوْتٍ وقايْتٍ فكأنك إنما مطلت الفتحة فجاءت الواو والياء كأنهما بعد فتحتين وذلك جائز نحو ثوب وبيت ولو رمت مثل ذلك في نحو قيات أو قُوْات لم تخل من أحد أمرين كل واحد منهما غير جائز: أحدهما أن تثبت حكم الياء والواو حرفين ساكنين فتجيء الألف بعد الساكن و هذا ممتنع غير جائز.
والآخر أن تسقط حكمهما لسكونهما وضعفهما فتكون الألف كأنها تالية للكسرة والضمة و هذا خطأ بل فإن قلت: فهلا جاز على هذا أن تجمع بين الألفين وتكون الثانية كأنها إنما هي تابعة للفتحة قبل الأولى لأن الفتحة مما تأتي قبل الألف لا محالة وأنت الآن آنفاً تحكي عن أبي إسحاق أنه قال: لو مددتها إلى العصر لما كانت إلا ألفاً واحدة قيل: وجه امتناع ذلك أنك لو تكلفت ما هذه حاله للزمك للجمع بين الساكنين اللذين هما الألفان اللتان نحن في حديثهما أن تمطل الصوت بالأولى تطاولاً به إلى اللفظ بالثانية ولو تجشمت ذلك لتناهيت في مد الأولى فإذا صارت إلى ذلك تمت ووفت فوقفت بك بين أمرين كلاهما ناقض عليك ما أعلقت به يديك: أحدهما: أنها لما طالت وتمادت ذهب ضعفها وفقد خفاؤها فلحقت لذلك بالحروف الصحاح وبعدت عن شبه الفتاحة الصغيرة القصيرة الذي رمته.
والآخر: أنها تزيد صوتاً على ما كانت عليه وقد كانت قبل أن تشبع مطلها أكثر من الفتحة قبلها أفتشبهها بها من بعد أن صارت للمد أضعافها.
هذا جور في القسمة وإفحاش في الصنعة واعتداء على محتمل الطبيعة والمنة.
ولذلك لم يأت عنهم شيء من مقول ومبيع على الجمع بين ساكنيهما وهما مقوول ومبيوع لأنك إنما تعتقد أن الساكن الأول منهما كالحركة ما لم تتناه في مطله وإطالته وأما والجمع بينهما ساكنين حشو يقتادك إلى تمكين الحرف الأول وتوفيته حقه ليؤديك إلى الثاني والنطق به فلا يجوز حينئذ وقد أشبعت الحرف وتماديت فيه أن تشبهه بالحركة لأن في ذلك إضعافاً له بعد أن حكمت بطوله وقوته ألا ترى أنك إنما شبهت باب عصي بباب أدْلٍ وأحْقٍ لما خفيت واو فعول بإدغامها فحينئذ جاز أن تشبهها بضمة أفعل.
فأما وهي على غاية جملة البيان والتمام فلا.
وإذا لم يجز هذا التكلف في الواو والياء وهما أحمل له كان مثله في الألف للطفها وقلة احتمالها ما تحتمله الياء والواو أحرى وأحجى.
وكذلك الحرفان الصحيان يقعان حشوا وذلك غير جائز نحو فصْبْل ومرطل هذا خطأ بل ممتنع.
فإن كان الساكنان المحشو بهما الأول منهما حرف معتل والثاني حرف صحيح تحامل النطق بهما.
وذلك نحو قالب وقولب وقيلبٍ.
إلا أنه وإن كان سائغاً ممكناً فإن العرب قد عدته وتخطته عزوفاً عنه وتحاميا لتجشم الكلفة فيه ألا ترى أنهم لما سكنت عين فَعَلتْ ولامه حذفوا العين البتة فقالوا: قلت وبعت وخفت ولم يقولوا: قُولْت ولا بيعْت ولا خِيفْت ولا نحو ذلك مما يوجبه القياس.
وإذا كانوا قد يتنكبون ما دون هذا في الاستثقال نحو قول عمارة {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} مع أن إثبات التنوين هنا ليس بالمستثقلف استثقال قُولْت وبيعت وخِيفت كان ترك هذا البتة واجباً.
فإن كان الثاني الصحيح مدغماً كان النطق به جائزاً حسناً وذلك نحو شابة ودابة وتمود الثوب وقوصّ بما عليه.
وذلك أن الإدغام أنبى اللسان عن المثلين نبوة واحدة فصارا لذلك كالحرف الواحد.
فإن تقدم الصحيح على المعتل لم يلتقيا حشواً ساكنين نحو ضَرْوْب وضَرْيْب.
وأما الألف فقد كفينا التعب بها إذ كان لا يكون ما قبلها أبداً ساكناً.
وذلك أن الواو والياء إذا سكنتا قويتا شبها بالألف.
وإنما جاز أن يجيء ما قبلهما من الحركة ليس منهما نحو بيت وحوض لأنهما على كل حال محرك ما قبلهما وإنما النظر في تلك الحركة ما هي أمنهما أم من غير جنسهما.
فاما أن يسكن ما قبلهما وهما ساكنتان حشواً فلا كما أن سكون ما قبل الألف خطأ.
فإن سكن ما قبلهما وهما ساكنان طرفاً جاز نحو عَدْوْ وظَبْىْ.
وذلك أن آخر الكلمة أحمل لهذا النحو من حشوها ألا تراك تجمع فيه بين الساكنين وهما صحيحان نحو بَكْرْ وحَجْرْ وحِلْسْ.
وذلك أن الطرف ليس سكونه بالواجب ألا تراه في غالب الأمر محركاً في الوصل وكثيراً ما يعرض له روم الحركة في الوقف.
فلما كان الوفق مظنة من السكون وكان له من اعتقاب الحركات عليه في الوصل ورومها فيه عند الوقف ما قدمناه تحامل الطبع به وتساند إلى تلك التعلة فيه.
نعم وقد تجد في بعض الكلام التقاء الساكنين الصحيحين في الوقف وقيل الأول منهما حرف مد وذلك في لغة العجم نحو قولهم: آردْ وماسْت.
وذلك أنه في لغتهم مشبه بدابّة وشابة في لغتنا.
وعلى ما نحن عليه فلو أردت تمثيل أهرقت على لفظه لجاز فقلت: أهفلت.
فإن أردت تمثيله على أصله لم يجز من قبل أنك تحتاج إلى أن تسكن فاء أفعلت وتوقع قبلها هاء أهرقت وهي ساكنة فيلزمك على هذا إن تجمع حشوا بين ساكنين صحيحين.
وهذا على ما قدمناه وشرحناه فاسد غير مستقيم.
فاعرف مما ذكرناه حال الساكنين حشوا فإنه موضع مغفول عنه وإنما يسفر ويضح مع الاستقراء له والفحص عن حديثه.
ومن ذلك أنك لما حذفت حرف المضارعة من يضرب ونحوه وقعت الفاء ساكنة مبتدأة.
وهذا ما لا سبيل إلى النطق به فاحتجت إلى همزة الوصل تسبباً على النطق به.
الجزء الثالث
باب في حفظ المراتب
باب في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف
باب في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
باب في إضافة الاسم إلى المسمى والمسمى إلى الاسم
باب في اختصاص الأعلام بما لا يكون مثله في الأجناس
باب في تسمية الفعل
باب في اقتضاء الموضع لك لفظا هو معك
باب في احتمال القلب لظاهر الحكم
باب في أن الحكم للطارىء
باب في الشيء يرد فيوجب له القياس حكما
باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن لا على ما يبعد ويقبح
باب في خصوص ما يقنع فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب
باب في تركيب المذاهب
باب في السلب
باب في وجوب الجائز
باب في إجراء اللازم مجرى غير اللازم وإجراء غير اللازم مجرى اللازم
باب في إجراء المتصل مجرى المنفصل وإجراء المنفصل مجرى المتصل
باب في الاحتياط
باب في فك الصيغ
باب في كمية الحركات
باب في مطل الحركات
باب في مطل الحروف
باب في إنابة الحركة عن الحرف والحرف عن الحركة
باب في هجوم الحركات على الحركات
باب في شواذ الهمز
باب في حذف الهمز وإبداله
باب في حرف اللين المجهول
باب في بقاء الحكم مع زوال العلة
باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين
باب في الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من السبب
باب القول على فوائت الكتاب
باب في الجوار
باب في نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها
باب في الامتناع من نقض الغرض
باب في التراجع عند التناهي
باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية
باب في تجاذب المعاني والإعراب
باب في قوة اللفظ لقوة المعنى
باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف
باب في أغلاط العرب
باب في سقطات العلماء
باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد
باب في جمع الأشباه من حيث يغمض الاشتباه
باب في المستحيل وصحة قياس الفروع على فساد الأصول
الجزء الثالث
باب في حفظ المراتب
هذا موضع يتسمح الناس فيه فيخلون ببعض رتبه تجاوزاً لها وربما كان سهواً عنها.
وإذا تنبهت على ذلك من كلامنا هذا قويت به على ألا تضيع مرتبة يوجبها القياس بإذن الله.
فمن ذلك قولهم في خطايا: إن أصله كان خطائئ ثم التقت الهمزتان غير عينين فأبدلت الثانية على حركة الأولى فصارت ياء: خطائي ثم أبدلت الياء ألفا لأن الهمزة عرضت في الجمع واللام معتلة فصارت خطاءا فأبدلت الهمزة على ما كان في الواحد وهو الياء فصارت خطايا.
فتلك أربع مراتب: خطائئ ثم خطائي ثم خطاءا ثم خطايا.
وهو - لعمري - كما ذكروا إلا أنهم قد أخلوا من الرتب بثنتين: إما إحداهما فإن أصل هذه الكلمة قبل أن تبدل ياؤها همزة خطائئ بوزن خطايع ثم أبدلت الياء همزة فصارت: خطائئ بوزن خطاعع.
والثانية أنك لما صرت إلى خطائي فآثرت إبدال الياء ألفا لاعتراض الهمزة في الجمع مع اعتلال اللام لاطفت الصنعة فبدأت بإبدال الكسرة فتحة لتنقلب الياء ألفا فصرت من خطائي إلى خطاءي بوزن خطاعي ثم أبدلتها لتحركها وانفتاح ما قبلها على حد ما تقول في إبدال لام رحىً وعصا فصارت خطاءا بوزن خطاعي ثم أبدلت الهمزة ياء على مضى فصارت خطايا.
فالمراتب إذاً ست لا أربع.
وهي خطائىء ثم خطائي ثم خطائي ثم خطاءي ثم خطاءا ثم خطايا.
فإذا أنت حفظت هذه المراتب ولم تضع موضعاً منها قويت دربتك بأمثالها وتصرفت بك الصنعة فيما هو جارٍ مجراها.
ومن ذلك قولهم: إوزة.
أصل وضعها إوززة.
فهناك الآن عملان: أحدهما قلب الواو ياء لانكسار ما قبلها ساكنة والآخر وجوب الإدغام.
فإن قدرت أن الصنعة وقعت في الأول من العملين فلا محالة أنك أبدلت من الواو ياء فصارت إيززة ثم أخذت في حديث الادغام فأسكنت الزاي الأولى ونقلت فتحتها إلى الياء قبلها فلما تحركت قويت بالحركة فرجعت إلى أصلها - وهو الواو - ثم ادغمت الزاي الأولى في الثانية فصارت: اوزة كما ترى.
فقد عرفت الآن على هذا أن الواو في إوزة إنما هي بدل من الياء التي في إيززة وتلك الياء المقدرة بدل من واو " إوززة " التي هي واو وز.
وإن أنت قدرت أنك لما بدأتها فأصرتها إلى إوززة أخذت في التغيير من آخر الحرف فنقلت الحركة من العين إلى الفاء فصارت إوزة فإن الواو فيها على هذا التقدير هي الواو الأصلية لم تبدل ياء فيما قبل ثم أعيدت إلى الواو كما قدرت ذلك في الوجه الأول.
وكان أبو علي - رحمه الله - يذهب إلى أنها لم تصر إلى إيززة.
قال: لأنها لو كانت كذلك لكنت إذا ألقيت الحركة على الياء بقيت بحالها ياء فكنت تقول: إيزة.
فأدرته عن ذلك وراجعته فيه مرارا فأقام عليه.
واحتج بأن الحركة منقولة إليها فلم تقو بها.
وهذا ضعيف جداً ألا ترى أنك لما حركت عين طىّ فقويت رجعت واو في طووى وإن كانت الحركة أضعف من تلك لأنها مجتلبة زائدة وليست منقولة من موضع قد كانت فيه قوية معتدة.
ومن ذلك بناؤك مثل فعلول من طويت.
فهذا لا بد أن يكون أصله: طويويٌ.
فإن بدأت بالتغيير من الأول فإنك أبدلت الواو الأولى ياء لوقوع الياء بعدها فصار التقدير إلى طييوى ثم ادغمت الياء في الياء فصارت طيوىٌ " ثم أبدلت من الضمة كسرة فصارت طيوى ثم أبدلت من الواو ياء فصارت إلى طييىٌ ثم أبدلت من الضمة قبل واو فعلول كسرة فصارت طييى ثم أدغمت الياء المبدلة من واو فعلول في لامه فصارت طيى.
فلما اجتمعت أربع ياءات ثقلت فأردت التغيير لتختلف الحروف فحركت الياء الولى بالفتح لتنقلب الثانية ألفا فتنقلب الألف واوا فصار بك التقدير إلى طييى فلما تحركت الياء التي هي بدل من واو طو يوى الأولى قويت فرجعت بقوتها إلى الواو فصار التقدير: طويى فانقلبت الياء الأولى التي هي لام فعلول الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت طواى ثم قلبتها واوا لحاجتك إلى حركتها - كما أنك لما احتجت إلى حركة اللام في الإضافة إلى رحىً قلبتها واوا - فقلت: طووى كما تقول في الإضافة إلى هوى علما: هووى.
فلابد أن تستقرىء هذه المراتب شيئاً فشيئاً ولا تسامحك الصنعة بإضاعة شيء منها.
وإن قدرت أنك بدأت بالتغيير من آخر المثال فإنك لما بدأته على طويوى أبدلت واو فعلول ياء فصار إلى طوييىٍ ثم ادغمت فصار إلى طوييٍّ وأبدلت من ضمة العين كسرة فصار التقدير طويى " ثم أبدلت من الواو ياء فصار طييٌّ ثم ادغمت الياء الأولى في الثانية طييى ثم عملت فيما بعد من تحريك الأولى بالفتح وقلب الثانية ألفا ثم قلبها واوا ما كنت عملته في الوجه الأول.
ومن شبه ذلك يلي جمع قرن ألوى فإنه يقول: طيي وشيى.
ومن قال: لي فضم فإنه يقول: طييىٌّ وشييى فيهما من طويت وشويت.
فاعرف بهذا حفظ المراتب فيما يرد عليك من غيره ولا تضع رتبة البتة فإنه أحوط عليك وأبهر في الصناعة بك بحول الله.
بأي التغييرين في المثال الواحد يبدأ باب في التغييرين في المثال الواحد بأيهما يبدأ اعلم أن القياس يسوغك أن تبدأ بأي العملين شئت: إن شئت بالأول وإن شئت بالآخر.
أما وجه علة الأخذ في الابتداء بالأول فلأنك تغير لتنطق بما تصيرك الصنعة إليه وإنما تبتدىء في النطق بالحرف من أوله لا من آخره.
فعلى هذا ينبغي أن يكون التغيير من أوله لا من آخره لتجتاز بالحروف وقد رتبت على ما يوجبه العمل فيها وما تصير بك الصنعة عليه إليها إلى أن تنتهي كذلك إلى آخرها فتعمل ما تعمله ليرد اللفظ بك مفروغاً منه.
وأما وجه علة وجوب الابتداء بالتغيير من الآخر فمن قبل أنك إذا أردت التغيير فينبغي أن تبدأ به من أقبل المواضع له.
وذلك الموضع آخر الكلمة لا أولها لأنه أضعف الجهتين.
مثال ذلك قوله في مثال إوزة من أويت: إياة.
وأصلها إئوية.
فإبدال الهمزة التي هي فاء واجب وإبدال الياء التي هي اللام واجب أيضاً.
فإن بدأت بالعمل من الأول صرت إلى إيوية ثم إلى إييية ثم إلى إياة.
وإن بدأت بالعمل من آخر المثال صرت أول إلى إئواة ثم إلى إيواةٍ ثم إياةٍ.
ففرقت العمل في هذا الوجه ولم تواله كما واليته في الوجه الأول لأنك لم تجد طريقاً إلى قلب الواو ياء إلا بعد أن صارت الهمزة قبلها ياء.
فلما صارت إلى إيواة أبدلتها ياء فصارت إياة كما ترى.
ومن ذلك قوله في مثال جعفر من الواو: أوى.
وأصلها وووٌ.
وههنا عملان واجبان.
أحدهما إبدال الواو الأولى همزة لاجتماع الواوين في أول الكلمة.
والآخر إبدال الواو الآخرة ياء لوقوعها رابعة وطرفا ثم إبدال الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
فإن بدأت العمل من أول المثال صرت إلى أووٍ ثم إلى أوىٍ ثم إلى أوى.
وإن قدرت ابتداءك العمل من آخره فإنك تتصور أنه كان وَوّوٌ ثم صار إلى ووىٍ ثم إلى ووىًّ ثم إلى أوى.
هكذا موجب القياس على ما قدمناه.
وتقول على هذا إذا أردت مثال فعل من وأيت: وؤى.
" فإن خففت الهمزة فالقياس أن تقر المثال على صحة أوله وآخره فتقول: ووىٌ " فلا تبدل الواو الأولى همزة لأن الثانية ليست بلازمة فلا تعتد إنما هي همزة وؤى خففت فأبدلت في اللفظ واوا وجرت مجرى واو رويا تخفيف رؤيا.
ولو اعتددتها واو البتة لوجب أن تبدلها للياء التي بعدها.
فتقول: وى أو أى على ما نذكره بعد.
وقول الخليل في تخفيف هذا المثال: أوىٌ طريف وصعب ومتعب.
وذلك أنه قدر الكلمة تقديرين ضدين لأنه اعتقد صحة الواو المبدلة من الهمزة حتى قلب لها الفاء فقال: أوى.
فهذا وجه اعتداده إياها.
ثم إنه مع ذلك لم يعتددها ثابتة صحيحة ألا تراه لم يقلبها ياء للياء بعدها.
فلذلك قلنا: إن في مذهبه هذا ضربا من التنتاقض.
وأقرب ما يجب أن نصرفه إليه أن نقول: قد فعلت العرب مثله في قولهم: مررت بزيد ونحوه.
ألا تراها تقدر الباء تارة كالجزء من الفعل وأخرى كالجزء من الاسم.
وقد ذكرنا هذا فيما مضى.
يقول: فكذلك يجوز لي أنا أيضاً أن أعتقد في العين من ووى من وجه أنها في تقدير الهمزة وأصحها ولا أعلها للياء بعدها ومن وجه آخر أنها في حكم الواو لأنها بلفظها فأقلب لها الفاء همزة.
فلذلك قلت: أوىٌ.
وكأن " أبا عمر " أخذ هذا الموضع من الخليل فقال في همزة نحو رأس وبأس إذا خففت في موضع الردف جاز أن تكون ردفا.
فيجوز عنده اجتماع راس وباس مع ناس.
وأجاز أيضاً أن يراعى ما فيها من نية الهمزة فيجيز اجتماع راس مع فلس.
وكأن أبا عمر إن كان أخذ هذا الموضع أعذر فيه من الخليل في مسئلته تلك.
وذلك أن أبا عمر لم يقض بجواز كون ألف راس ردفا وغير ردف في قصيدة واحدة.
وإنما أجاز ذلك في قصديتين إحداهما قوافيها نحو حلس وضرس والآخرى قوافيها نحو ناس وقرطاس وقرناس.
والخليل جمع في لفظة واحدة أمرين متدافعين.
وذلك أن صحة الواو الثانية في ووى منافٍ لهمزة الأولى منهما.
وليس له عندي إلا احتجاجه بقولهم: مررت بزيد ونحوه وبقولهم: لا أبا لك.
وقد ذكر ذلك في باب التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين.
ولندع هذا إلى أن نقول: لو وجد في الكلام تركيب " ووى " فبنيت منه فعلاً لصرت إلى ووىٍ.
فإن بدأت بالتغيير من الأول وجب أن تبدل الواو التي هي فاء همزة فتصير حينئذ إلى أوىٍ ثم تبدل الواو العين ياء لوقوع اللام بعدها ياء فتقول: أي.
فإن قلت: أتعيد الفاء واوا لزوال الواو من بعدها " فتقول: وي أو تقرها على قلبها السابق إليها فتقول: أي " فالقول عندي إقرار الهمزة بحالها وأن تقول: أي.
وذلك أنا رأيناهم إذا قلبوا العين وهي حرف علة همزة أجروا تلك الهمزة مجرى الأصلية.
ولذلك قال في تحقير قائم: هو قوئيم فأقر الهمزة وإن زالت ألف فاعل عنها.
فإذا فعل هذا في العين كانت الفاء أجدر به لأنها أقوى من العين.
فإن قلت: فقد قدمت في إوزة أنها لما صارت في التقدير إلى إيززة ثم أدرت إليها الحركة الزاي بعدها فتحركت بها.
أعدتها إلى الواو فصارت إوزة فهلا أيضاً أعدت همزة أي إلى الواو لزوال العلة التي كانت قلبتها همزة أعني واو أوىٍ قيل: انقلاب حرف العلة همزة فاء أو عينا ليس كانقلاب الياء واوا ولا الواو ياء بل هو أقوى من انقلابهما إليهما ألا ترى إلى قولهم: ميزان ثم لما زالت الكسرة عادت الواو في موازين ومويزين.
وكذلك عين ريح قلبت للكسرة ياء " ثم لما " زالت الكسرة عادت واوا فقيل: أرواح ورويحة.
وكذلك قولهم: موسر وموقن لما زالت الضمة عادت الياء فقالوا: مياسر ومياقن.
فقد ترى إن انقلاب حرف اللين إلى مثله لا يستقر ولا يستعصم لأنه بعد القلب وقبله كأنه صاحبه والهمزة حرف صحيح وبعيد المخرج فإذا قلب حرف اللين إليه أبعده عن جنسه واجتذبه إلى حيزه فصار لذلك من وادٍ آخر وقبيل غير القبيل الأول.
فلذلك أقر على ما صار إليه وتمكنت قدمه فيما حمل عليه.
فلهذا وجب عندنا أن يقال فيه: أي.
" وأما إن " أخذت العمل من آخر المثال فإنك تقدره على ما مضى: ووى ثم تبدل العين للام فيصير: وي فتقيم حينئذ عليه ولا تبغي بدلا به لأنك لم تضطر إلى تركه لغيره.
وكذلك أيضاً يكون هذان الجوابان إن اعتقدت في عين وؤى أنك أبدلتها إبدالا ولم تخففها تخفيفاً: القول في الموضعين واحد.
ولكن لو ارتجلت هذا المثال من وأيت على ما تقدم فصرت منه إلى وؤى ثم همزت الواو التي هي الفاء همزا مختاراً لا مضطراً إليه لكن قولك في وجوه: أجوه وفي وقتت: أقتت لصرت إلى أؤىٍ فوجب إبدال الثانية واوا خالصة فإذا خلصت كما ترى لما تعلم وجب إبدالها للياء بعدها فقلت: أي لا غير.
فهذا وجه آخر من فإن قلت: فهلا استدللت بقولهم في مثال فعول من القوة: قيو على أن التغيير إذا وجب في الجهتين فينبغي أن يبدأ بالأول منهما ألا ترى أن أصل هذا قوو فبدأ بتغيير الأوليين فقال: قيو ولم يغير الأخريين فيقول: قوى قيل: هذا اعتبار فاسد.
وذلك أنه لو بدأ فغير من الآخر لما وجد بدا من أن يغير الأول أيضاً " لأنه لو أبدل الآخر فصار إلى قوى للزمه أن يبدل الأول أيضاً " فيقول: قيى: فتجتمع له أربع ياءات فيلزمه أن يحرك الأولى لتنقلب الثانية ألفا فتنقلب واوا فتختلف الحروف فتقول: قووى فتصير من عمل إلى عمل ومن صنعة إلة صنعة.
وهو مكفى ذلك وغير محوج إليه.
وإنما كان يجب عليه أيضاً تغيير الأولين لأنهما ليستا عينين فتصحا كبنائك فعلاً من قلت: قول وإنما هما عين وواو زائدة.
ولو قيل لك: ابن مثل خروع من قلت لما قلت إلا قيل لأن واو فعول لا يجب أن يكون أبدا من لفظ العين ألا ترى إلى خروع وبروع اسم ناقة فقد روى بكسر الفاء وإلى جدول فقد رويناه عن قطربٍ بكسر الجيم.
وكل ذلك لفظ عينه مخالف لواوه وليست كذلك العينان لأنهما لا يكونان أبدا إلا من لفظ واحد فإحداهما تقوى صاحبتها وتنهض منتها.
فإن قلت: فإذا كنت تفصل بين العينين وبين العين الزائد بعدها فكيف تبنى مثل عليب من البيع فجوابه على قول النحويين سوى الخليل بيع.
ادغمت عين فعيل فى يائه فجرى اللفظ مجرى فعل من الياء نحو قوله: وإذا هم نزلوا فمأوى العيل وقوله: كأن ريح المسك والقرنفل نباته بين التلاع السيل فإن قلت: فهلا فصلت فى فعيل بين العين والياء وبين العينين " كما فصلت فى فعول وفعل بين العين والواو وبين العينين " قيل: الفرق أنك لما أبدلت عين قول وأنت تريد به مثال فعول صرت إلى قيول فقلبت أيضا الواو ياء فصرت إلى قيل.
وأما فعيل من البيع فلو أبدت عينه واوا للضمة قبلها لصرت إلى بويع.
فإذا صرت إلى هنا لزمك أن تعيد الواو ياء لوقوع الياء بعدها فتقول بيع ولم تجد طريقاً إلى قلب الياء واواً لوقوع الواو قبلها كما وجدت السبيل إلى قلب الواو فى قيول ياء لوقوع الياء قبلها لأن الشرط فى اجتماع الياء والواو أن تقلب والواو للياء لا أن تقلب الياء للواو.
" وذلك " كسيد وميت وطويت طيا وشويت شيا.
فلهذا قلنا فى فعيل من البيع: بيع فجرى فى اللفظ مجرى فعل منه وقلنا فى فعول من القول: قيل فلم يجر مجرى فعل منه.
وأما قياس قول الخيل فى فعيل من البيع فأن تقول: بويع ألا تراه يجرى الأصل فى نحو هذا مجرىالزائد فيقول في فعل من أفعلت من اليوم على من قال: أطولت: أووم فتجرى ياء أيم الأولى وإن كانت فاء مجرى ياء فعيل من القول إذا قلت: قيل.
فكما تقول الجماعة في فعل من قيل هذا قوول وتجري ياء فيعل مجرى ألف فاعل كذلك قال الخليل في فعل مما ذكرنا: أووم.
فقياسه هنا أيضاً أن يقول في فيعل من البيع: بويع.
بل إذا لم يدغم الخليل الفاء في العين - وهي أختها " وتليتها " وهي مع ذلك من لفظها - في أووم حتى أجراها مجرى قوله: وفاحم دووي حتى اعلنكسا فألا يدغم عين بويع في يائه - ولم يجتمعا في كونهما أختين ولا هما أيضاً في اللفظ الواحد شريكتان - أجدر بالوجوب.
ولو بنيت مثل عوارة من القول لقلت على مذهب الجماعة: قوالة بالادغام وعلى قول الخليل أيضاً كذلك لأن العين لم تنقلب فتشبه عنده ألف فاعل.
لكن يجيىء على قياس قوله أن يقول في فعول من القول: قيول لأن العين لما انقلبت أشبهت الزائد.
يقول: فكما لا تدغم بويع فكذلك لا تدغم قيول.
اللهم إلا أن تفضل فتقول: راعيت في بويع ما لا يدغم وهو ألف فاعل فلم أدغم وقيول بضد ذلك لأن ياءه بدل من عين القول وادغامها في قول وقول والتقول ونحو ذلك جائز فهذا فصل اتصل بما كنا عليه.
فاعرفه متصلا به بإذن الله.
باب في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف
اعلم أن هذا موضع يدفع ظاهره إلى أن يعرف غوره وحقيقته.
وذلك أنه أمر يعرض للأمثال إذا ثقلت لتكريرها فيترك الحرف إلى ما هو أثقل منه ليختلف اللفظان فيخفا على اللسان.
وذلك نحو الحيوان ألا ترى أنه عند الجماعة - إلا أبا عثمان - من مضاعف الياء وأن أصله حييان فلما ثقل عدلوا عن الياء إلى الواو.
وهذا مع إحاطة العلم بأن الواو أثقل من الياء لكنه لما اختلف الحرفان ساغ ذلك.
وإذا كان اتفاق الحروف الصحاح القوية الناهضة يكره عندهم حتى يبدلوا أحدها ياء نحو دينار وقيراط وديماس وديباج " فيمن قال: دماميس ودبابيج " كان اجتماع حرفي العلة مثلين أثقل عليهم.
نعم وإذا كانوا قد أبدلوا الياء واوا كراهية لالتقاء المثلين في الحيوان فإبدالهم " الواو ياء " لذلك أولى بالجواز وأحرى.
وذلك قولهم: ديوان " واجليواذ ".
وليس لقائل أن يقول: فلما صار دوان إلى ديوان فاجتمعت الواو والياء وسكنت الأولى هلا أبدلت الواو ياء لذلك لأن هذا ينقض الغرض ألا تراهم إنما كرهوا التضعيف في دوان فأبدلوا ليختلف الحرفان فلو أبدلوا الواو فيما بعد للزم أن يقولوا: ديان فيعودوا إلى نحو مما هربوا منه من التضعيف وهم قد أبدلوا الحييان إلى الحيوان ليختلف الحرفان فإذا أصارتهم الصنعة إلى اختلافهما في ديوان لم يبق هناك مطلب.
وأما حيوة فاجتمع إلى استكراههم التضعيف فيه وأن يقولوا: حية أنه علم والأعلام يحتمل لها كثير من كلف الأحكام.
ومن ذلك قولهم في الإضافة إلى آية وراية: آئى ورائى.
وأصلهما: أيى ورايى إلا أن بعضهم كره ذلك فأبدل الياء همزة لتختلف الحروف ولا تجتمع ثلاث ياءات.
هذا مع إحاطتنا علما بأن الهمزة أثقل من الياء.
وعلى ذلك أيضاً قال بعضهم فيهما: راوى وآوى فأبدلها واوا ومعلوم أيضاً أن الواو أثقل من الياء.
وعلى نحو من هذا أجازوا في فعاليل من رميت: رماوى ورمائى فأبدلوا الياء من رمايى تارة واوا وأخرى همزة - وكلتاهما أثقل من الياء - لتختلف الحروف.
وإذا كانوا قد هربوا من التضعيف إلى الحذف نحو ظلت ومست وأحست وظنت ذاك أي ظننت كان الإبدال أحسن وأسوغ لأنه أقل فحشا من الحذف وأقرب.
ومن الحذف لاجتماع الأمثال قولهم في تحقير أحوى: أحى فحذفوا من الياءات الثلاث واحدة وقد حذفوا أيضاً من الثنتين في نحو هين ولين وسيد وميت وهذا واضح فاعرف وقس.
ومن ذلك قولهم عمبر أبدلوا النون ميما في اللفظ وإن كانت الميم أثقل من النون فخففت الكلمة ولو قيل عنبر بتصحيح النون لكان أثقل.
باب في إقلال الحفل بما يلطف من الحكم
وهذا أمر في باب ما لا ينصرف كثيرا ألا ترى أنه إذا كان في الاسم سبب واحد من المعاني الفرعية فإنه يقل عن الاعتداد به فلا يمنع الصرف له فإذا انضم إليه سبب آخر اعتونا فمنعا.
ونحو من ذلك جمعهم في الاستقباح بين العطف على الضمير المرفوع المتصل الذي لا لفظ له وبينه إذا كان له لفظ.
فقولك: قمت وزيد في الاستقباح كقولك: قام وزيد وإن لم يكن في قام لفظ بالضمير.
وكذلك أيضاً سووا في الاستقباح بين قمت وزيد وبين قولنا قمتما وزيد وقمتم ومحمد من حيث كانت تلك الزيادة التي لحقت التاء لا تخرج الضمير من أن يكون مرفوعاً متصلا يغير له الفعل.
ومع هذا فلست أدفع أن يكونوا قد أحسوا فرقا بين قمت وزيد وقام وزيد إلا أنه محسوس عندهم غير مؤثر في الحكم ولا محدث أثرا في اللفظ كما قد نجد أشياء كثيرة معلومة ومحسوسة إلا أنها غير معتدة كحنين الطس وطنين البعوض وعفطة العنز وبصبصة الكلب.
ومن ذلك قولهم: مررت بحمار قاسم ونزلت سفار قبل فكسرة الراء في الموضعين عندهم ومنن ذلك قولهم: الذي ضربت زيد واللذان ضربت الزيدان فحذف الضمير العائد عندهم على سمت واحد وإن كنت في الواحد إنما حذفت حرفا واحدا وهو الهاء في ضربته وأما الواو بعدها فغير لازمة في كل لغة والوقف أيضاً يحذفها وفي التثنية قد حذفت ثلاثة أحرف ثابتة في الوصل والوقف وعند كل قوم وعلى كل لغة.
ومن ذلك جمعهم في الردف بين عمود ويعود من غير تحاشٍ ولا استكراه وإن كانت واو عمود أقوى في المد من واو يعود من حيث كانت هذه متحركة في كثير من المواضع نحو هو أعود منك وعاودته وتعاودنا قال: وإن شئتم تعاودنا عوادا وأصلها أيضاً في يعود يعود.
فهو وإن كان كذلك فإن ذلك القدر بينهما مطرح وملغى غير محتسب.
نعم وقد سانوا وسامحوا فيما هو على من ذا وأنأى أمدا.
وذلك أنهم جمعوا بين الياء والواو ردفين نحو سعيد وعمود.
هذا مع أن الخلاف خارج إلى اللفظ فكيف بما تتصوره وهما ولا تمذل به لفظا.
ومن ذلك جمعهم بين باب وكتاب ردفين وإن كانت ألف كتاب مدا صريحا وهي في باب أصل غير زائدة ومنقلبة عن العين المتحركة في كثير من الأماكن نحو بويب وأبواب ومبوب ومن ذلك جمعهم بين الساكن والمسكن في الشعر المقيد على اعتدال عندهم وعلى غير حفل محسوس منهم نحو قوله: لئن قضيت الشأن من أمري ولم أقض لباناتي وحاجات النهم لأفرجن صدرك شقا بقدم فسوى في الروى بين سكون ميم لم وسكون الميمات فيما معها.
ومن ذلك وصلهم الروى بالياء الزائدة للمد والياء الأصلية نحو الرامي والسامي مع الأنعامي والسلامي.
ومن ذلك أيضاً قولهم: إني وزيدا قائمان وأني وزيدا قائمان لا يدعي أحد أن العرب تفصل بين العطف على الياء وهي ساكنة وبين العطف عليها وهي مفتوحة.
فاعرف هذا مذهبا لهم وسائغا في استعمالهم حتى إن رام رائم أو هجر حالم بأن القوم يفصلون في هذه الأماكن وما كان سبيله في الحكم سبيلها بين بعضها وبعضها فإنه مدع لما لا يعبئون به وعازٍ إليهم ما لا يلم بفكر أحد منهم بإذن الله.
فإن انضم شيء إلى ما هذه حاله كان مراعىً معتداً ألا تراهم يجيزون جمع دونه مع دينه ردفين.
فإن انضم إلى هذا الخلاف آخر لم يجز نحو امتناعهم إن يجمعوا بين دونه ودينه لأنه انضم إلى خلاف الحرفين تباعد الحركتين وجاز دونه مع دينه وإن كانت الحركتان مختلفتين لأنهما وإن اختلفا لفظا فإنهما قد اتفقتا حكما ألا ترى أن الضمة قبل الواو رسيلة الكسرة قبل الياء والفتحة ليست من هذا في شيء لأنها ليست قبل الياء ولا الواو وفقا لهما كما تكون وفقا للألف.
وكذلك أيضاً نحو عيده مع عوده وإن كانوا لا يجيزونه مع عوده.
فاعرف ذلك فرقا.
باب في إضافة الاسم إلى المسمى والمسمى إلى الاسم
هذا موضع كان يعتاده أبو على رحمة الله كثيراً ويألفه ويأنق له ويرتاح لاستعماله.
وفيه دليل نحوي غير مدفوع يدل على فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى.
ولو كان إياه لم تجز إضافة واحد منهما إلى صاحبه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه.
فإن قيل: ولم لم يضف الشيء إلى نفسه.
قيل: لأن الغرض في الإضافة إنما هو التعريف والتخصيص والشيء إنما يعرفه غيره لأنه لو كانت نفسه تعرفه لما احتاج أبدا أن يعرف بغيره لأنه نفسه في حالي تعريفه وتنكيره واحدة وموجودة غير مفتقدة.
ولو كانت نفسه هي المعرفة له أيضاً لما احتاج إلى إضافته إليها لأنه ليس فيها إلا ما فيه فكان يلزم الاكتفاء به عن إضافته إليها.
فلهذا لم يأت عنهم نحو هذا غلامه ومررت بصاحبه والمظهر هو المضمر المضاف إليه.
هذا مع فساده في المعنى لأن الإنسان لا يكون أخا نفسه ولا صاحبها.
فإن قلت: فقد تقول: مررت بزيد نفسه وهذا نفس الحق يعني أنه هو الحق لا غيره.
قيل: ليس الثاني هو ما أضيف إليه من المظهر وإنما النفس هنا بمعنى خالص الشيء وحقيقته.
والعرب تحل نفس الشيء من الشيء محل البعض من الكل وما الثاني منه ليس بالأول ولهذا حكوا عن أنفسهم مراجعتهم إياها وخطابها لهم وأكثروا من ذكر التردد بينها وبينهم ألا ترى إلى قوله: ولي نفس أقول لها إذا ما تنازعني لعلي أو عساني وقوله: أقول للنفس تأساء وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم ترد وقوله: قالت له النفس تقدم راشدا إنك لا ترجع إلا حامدا وقوله: قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصد وأمثال هذا كثيرة جدا وجميع هذا يدل على أن نفس الشيء عندهم غير الشيء.
فإن قلت: فقد تقول: هذا أخو غلامه وهذه جارية بنتها فتعرف الأول بما أضيف إلى ضميره والذي أضيف إلى ضمير فإنما يعرف بذلك الضمير ونفس المضاف الأول متعرف بالمضاف إلى ضميره فقد ترى على هذا أن التعريف الذي استقر في جارية من قولك هذه جارية بنتها إنما أتاها من قبل ضميرها وضميرها هو هي فقد آل الأمر إذاً إلى أن الشيء قد يعرف نفسه وهذا خلاف ما ركبته وأعطيت يدك به.
قيل: كيف تصرفت الحال فالجارية إنما تعرفت بالبنت التي هي غيرها وهذا شرط التعريف من جهة الإضافة.
فأما ذلك المضاف إليه أمضاف هو أم غير مضاف فغير قادح فيما مضى.
والتعريف الذي أفاده ضمير الأول لم يعرف الأول وإنما عرف ما عرف الأول.
والذي عرف الأول غير الأول فقد استمرت الصفة وسقطت المعارضة.
ويؤكد ذلك أيضاً أن الإضافة في الكلام على ضربين: أحدهما ضم الاسم إلى اسم هو غيره بمعنى اللام نحو غلام زيد وصاحب بكر.
والآخر ضم اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى من نحو هذا ثوب خز وهذه جبة صوف وكلاهما ليس الثاني فيه بالأول ألا ترى أن الغلام ليس بزيد وأن الثوب ليس بجميع الخز واستمرار هذا عندهم وفشوه في استعمالهم وعلى أيديهم يدل على أن المضاف ليس بالمضاف إليه البتة وفي هذا كافٍ.
فمما جاء عنهم من إضافة المسمى إلى الاسم قول الأعشى: فكذبوها بما قالت فصبحهم ذوآل حسان يزجي الموت والشرعا بثينة من آل النساء وإنما يكن للآدنى لاوصال لغائب أي بثينة من هذا القبيل المسمى بالنساء هذا الاسم.
وقال الكميت: إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألبب أي إليكم يا أصحاب هذا الاسم الذي هو قولنا: آل النبي.
وحدثنا أبو علي أن أحمد بن إبراهيم أستاذ ثعلب روى عنهم: هذا ذو زيد ومعناه: هذا زيد أي هذا صاحب هذا الاسم الذي هو زيد وأنشد: وحي بكر طعنا طعنة فجرى أي وبكرا طعنا وتلخيصه: والشخص الحي المسمى بكرا طعنا فحي ههنا مذكر حية أي وشخص بكر الحي طعنا وليس الحي هنا هو الذي يراد به القبيلة كقولك: حي تميم وقبيلة بكر إنما هو كقولك: هذا رجل حي وامرأة حية.
فهذا من باب إضافة المسمى إلى اسمه وهو ما نحن عليه.
ومثله قول الآخر: ياقر إن أباك حي خويلد قد كنت خائفه على الإحماق أي أن أبك خويلدا من أمره كذا فكأنه قال: إن أباك الشخص الحي خويلدا من حاله كذا.
ألا قبح الإله بني زيادٍ وحي أبيهم قبح الحمار أي: وأباهم الشخص الحي.
وقال عبد الله بن سبرة الحرشي: وإن يبغ ذا ودي أخي أسع مخلصا ويأبى فلا يعيا على حويلي أي إن يبغ ودي.
وتلخيصه: إن يبغ أخي المعنى المسمى بهذا الاسم الذي هو ودي.
وعليه قول الشماخ: وأدمج دمج ذي شطن بديع أي دمج شطن بديع أي أدمج دمج الشخص الذي يسمى شطنا صاحب هذا الاسم.
وقد دعا خفاء هذا الموضع أقواما إلى أن ذهبوا إلى زيارة ذي وذات في هذه المواضع أي وأدمج دمج شطن وإليكم آل النبي وصبحهم آل حسان.
وإنما ذلك بعد عن إدراك هذا الموضع.
وكذلك قال أبو عبيدة في قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر كأنه قال: ثم السلام عليكما.
وكذلك قال في قولنا بسم الله: إنما هو بالله واعتقد زيادة اسم.
وعلى هذا عندهم قول غيلان: لا ينعش الطرف إلا ما تخونه داعٍ يناديه باسم الماء مبغوم يدعونني بالماء ماء أسود والماء: صوت الشاء أي يدعونني - يعني الغنم - بالماء أي يقلن لي: أصبت ماء أسود.
فأبو عبيدة يدعى زيادة ذي واسم ونحن نحمل الكلام على أن هناك محذوفاً.
قال أبو علي: وإنما هو على حد حذف المضاف أي: ثم اسم معنى السلام عليكما واسم معنى السلام هو السلام فكأنه قال: ثم السلام عليكما.
فالمعنى - لعمري - ما قاله أبو عبيدة ولكنه من غير الطريق التي أتاه هو منها ألا تراه هو اعتقد زيادة شيء واعتقدنا نحن نقصان شيء.
ونحو من هذا اعتقادهم زيادة مثل في نحو قولنا: مثلي لا يأتي القبيح ومثلك لا يخفى عليه الجميل أي أنا كذا وأنت كذلك.
وعليه قوله: مثلي لا يحسن قولا فعفع أي أنا لا أحسن ذاك.
وكذلك هو لعمري إلا أنه على غير التأول الذي رأوه: من زيادة مثل وإنما تأويله: أي أنا من جماعة لا يرون القبيح وإنما جعله من جماعة هذه حالها ليكون أثبت للامر إذ كان له فيه أشباه وأضراب ولو انفرد هو به لكان غير مأمون انتقاله منه وتراجعه عنه.
فإذا كان له فيه نظراء كان حري أن يثبت عليه وترسو قدمه فيه.
وعليه قول الآخر: ومثلي لا تنبو عليك مضاربه فقوله إذاً: باسم الماء واسم السلام إنما هو من باب إضافة الاسم إلى المسمى بعكس الفصل الأول.
ونقول على هذا: ما هجاء سيف فيقول في الجواب: س ي ف.
فسيف هنا اسم لا مسمى أي ما هجاء هذه الأصوات المقطعة ونقول: ضربت بالسيف فألسيف هنا جوهر الحديد هذا الذي يضرب به فقد يكون الشيء الواحد على وجه اسما وعلى آخر مسمى.
وإنما يخلّص هذا من هذا موقعه والغرض المراد به.
ومن إضافة المسمى إلى اسمه قول الآخر: إذا ما كنت مثل ذوي عدي ودينار فقام علي ناع أي مثل كل واحد من الرجلين المسميين عدياً وديناراً.
وعليه قولنا: كان عندنا ذات مرة وذات صباح أي صباحاً أي الدفعة المسماة مرة والوقت المسمى صباحاً قال: عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود ما مجرورة الموضع لأنها وصف لأمر أي لأمر معتد أو مؤثر يسود من يسود.
واعلم أن هذا الفصل من العربية غريب وقل من يعتاده أو يتطرفه.
وقد ذكرته لتراه.
فتنبه على ما هو في معناه إن شاء الله.
باب في اختصاص الأعلام بما لا يكون مثله في الأجناس
وقد ذكرنا هذا الشرح من العربية في جملة كتابنا في تفسير أبيات الحماسة عند ذكرنا أسماء شعرائها.
وقسمنا هناك الموقع عليه الاسم العلم وأنه شيئان: عين ومعنى.
فالعين: الجوهر كزيد وعمرو.
والمعنى: هو العرض كقوله: سبحان من علقمة الفاخر وقوله: وإن قال غاوٍ من تنوخ قصيدة بها جرب عدت على بزو برا وكذلك الأمثلة الموزون بها نحو أفعل ومفعل وفعلة وفعلان وكذلك اسماء الأعداد نحو قولنا: أربعة نصف ثمانية وستة ضعف ثلاثة وخمسة نصف عشرة.
وغرضنا هنا أن نرى مجيء ما جاء منه شاذا عن القياس لمكان كونه علما معلقا على أحد الموضعين اللذين ذكرنا.
فمنه ما جاء مصححا مع وجود سبب العلة فيه وذلك نحو محببٍ وثهلل ومريم ومكوزة ومدين.
ومنه معدي كرب ألا تراه بني مفعلا مما لامه حرف علة وذلك غير معروف في هذا الموضع.
وإنما يأتي في ذلك مفعل بفتح العين نحو المدعي والمقضي والمشتي.
وعلى أنه قد شذ في الأجناس شيء من ذلك وهو قول بعضهم: مأوى الإبل بكسر العين.
فأما مأقٍ فليس من هذا.
ومن ذلك قولهم في العلم: موظب ومورق وموهب.
وذلك أنه بنى مما فاؤه واو مثال مفعل.
وهذا إنما يجيء أبدا على مفعل - بكسر العين - نحو الموضع والموقع والمورد والموعد والموجدة.
وأما سوءلة علما فإن كان من وأل أي نجا فهو من هذا وإن كان من قولهم: جاءني وما مألت مأله وما شأنت شأنه فإنه فوعل وهذا على هذا سرحٌ: سهل.
ومن ذلك قولهم في العلم: حيوة.
وهذه صورة لولا العلمية لم يجز مثلها لاجتماع الياء والواو وسبق الأولى منهما بالسكون.
وعلة مجيء هذه الأعلام مخالفة للأجناس هو ما هي عليه من كثرة استعمالها وهم لما كثر استعماله أشد تغييرا.
فكما جاءت هذه الأسماء في الحكاية مخالفة لغيرها نحو قولك في جواب مررت بزيد: من زيدٍ ولقيت عمرا: من عمرا كذلك تخطوا إلى تغييرها في ذواتها بما قدمناه ذكره.
وهذا من تدريج اللغة الذي قدمنا شرحه فيما مضى.
باب في تسمية الفعل
اعلم أن العرب قد سمت الفعل بأسماء لما سنذكره.
وذلك على ضربين: أحدهما في الأمر والنهي والآخر في الخبر.
الأول منهما نحو قولهم: صه فهذا اسم اسكت ومه فهذا: اكفف ودونك اسم خذ.
وكذلك عندك ووراءك اسم تنح ومكانك اسم اثبت.
قال: وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي فجوابه بالجزم دليل على أنه كأنه قال: اثبتي تحمدي أو تستريحي.
وكذلك قول الله جل اسمه {مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ} فأنتم توكيد للضمير في مكانكم كقولك: اثبتوا أنتم وشركاؤكم وعطف على ذلك الضمير بعد أن وكده الشركاء.
ويؤكد ذلك عندك قول بعضهم: مكانكني فإلحاقه النون كما تلحق النون نفس أنتني كقولك: انتظرني. ومنها هلم وهو آسم ائت. وتعال.
قال الخليل: هي مركبة وأصلها عنده ها للتنبيه ثم قال: لم أي لم بنا ثم كثر استعمالها فحذفت الألف تخفيفاً.
ولأن اللام بعدها وإن كانت متحركة فإنها في حكم السكون ألا ترى أن الأصل وأقوى اللغتين - وهي الحجازية - أن تقول فيها: المم بنا فلما كانت لام هلم في تقدير السكون حذف لها ألف ها كما تحذف لالتقاء الساكنين فصارت هلم.
وقال الفراء: أصلها هل زجر وحث دخلت على أم كأنها كانت هل أم أي اعجل واقصد وانكر أبو علي عليه ذلك وقال: لا مدخل هنا للاستفهام.
وهذا عندي لا يلزم الفراء لأنه لم يدع أن هل هنا حرف استفهام وإنما هي عنده زجر وحث وهي التي في قوله: ولقد يسمع قولي حيهل قال الفراء: فألزمت الهمزة في أم التخفيف فقيل: هلم.
وأهل الحجاز يدعونها في كل حال على لفظ واحد فيقولون للواحد والواحدة والأثنين والأثنتين والجماعتين: هلم يا رجل وهلم يا امرأة وهلم يا رجلان وهلم يا امرأتان وهلم يا رجال وهلم يا نساء.
وعليه قوله: يا أيها الناس ألا هلمه وأما التميميون فيجرونها مجرى لم فيغيرونها بقدر المخاطب.
فيقولون: هلم وهلما وهلمي وهلموا وهلممن يا نسوة.
وأعلى اللغتين الحجازية وبها نزل القرآن ألا ترى إلى قوله - عز اسمه - {وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا}.
وأما التميميون فإنها عندهم أيضاً اسم سمي به الفعل وليست مبقاة على ما كانت عليه قبل التركيب والضم.
يدل على ذلك أن بني تميم يختلفون في آخر الأمر من المضاعف فمنهم من يتبع فيقول: مدُّ وفرِّ وعضَّ ومنهم من يكسر فيقول: مدِّ وفرِّ وعضِّ ومنهم من يفتح لالتقاء الساكنين فيقول: مدَّ وفرَّ وعضَّ.
ثم رأيناهم كلهم مع هذا مجتمعين على فتح آخر هلم وليس أحد يكسر الميم ولا يضمها.
فدل ذلك على أنها قد خلجت عن طريق الفعلية وأخلصت اسماً للفعل بمنزلة دونك وعندك ورويدك وتيدك: اسم اثبت وعليك بكرا: اسم خذ وهو كثير.
ومنه قوله: أقول وقد تلاحقت المطايا كذاك القول إن عليك عينا فهذا اسم احفظ القول أو اتق القول.
وقد جاءت هذه التسمية للفعل في الخبر وإنما بابها الأمر والنهي من قبل أنهما لا يكونان إلا بالفعل فلما قويت الدلالة فيهما على الفعل حسنت إقامة غيره مقامه.
وليس كذلك الخبر لأنه لا يخص بالفعل ألا ترى إلى قولهم: زيد أخوك ومحمد صاحبك فالتسمية للفعل في باب الخبر ليست في قوة تسميته في باب الأمر والنهي.
وعلى ذلك فقد مرت بنا منه ألفاظ صالحة جمعها طول التقري لها.
وهي قولهم: أفَّ اسم الضجر وفيه ثماني لغات أفِّ وأفٍ وأفَّ وأفٌ وأفَّ وأفَّا وأفّي ممال وهو الذي تقول فيه العامة: أفي وأف خفيفة.
والحركة في جميعها لالتقاء الساكنين.
فمن كسر فعلى أصل الباب ومن ضم فللإتباع ومن فتح فللاستخفاف ومن لم ينون أراد التعريف ومن نون أراد التنكير.
فمعنى التعريف: التضجر ومعنى التنكير: تضجرا.
ومن أمال بناه على فعلى.
وجاءت ألف التأنيث مع البناء كما جاءت تاؤه معه في ذيَّة وكيَّة نعم وقد جاءت ألفه فيه أيضاً في قوله: هنّا وهنَّا ومن هنَّا لهن بها ومنها آوتاه وهي اسم أتألم.
وفيها لغات: آوَّتاه وآوَّه وأوَّه وأَوهُ وأَوهِ وأَوهَ وأَوِّ قال: فأَوهِِ من الذكرى إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بيننا وسماء ويروى: فأوِّ لذكراها.
والصنعة في تصريفها طويلة حسنة.
وقد كان أبو علي - رحمه الله - كتب إلي من حلب - وأنا بالموصل - مسئلة أطالها في هذه اللفظة جواباً على سؤالي إياه عنها وأنت تجدها في مسائله الحلبيات إلا أن جماع القول عليها أنها فاعلة فاؤها همزة وعينها ولامها واوان والتاء فيها للتأنيث.
وعلى ذلك قوله: فأوِّ لذكراها قال: فهذا كقولك في مثال الأمر من قويت: قوِّ زيدا ونحوه.
ومن قال: فأوهِ أو فأوِّه فاللام عنده هاء وهي من لفظ قول العبدي: ومثلها مما اعتقب عليه الواو والهاء لاما قولهم: سنة وعضة ألا تراهم قالوا: سنوات وعضوات وقالوا أيضاً: سانهت وبعير عاضه والعضاه.
وصحت الواو في آوة ولم تعتل إعلال قاوية وحاوية إذا أردت فاعلة من القوة والحوة من قبل أن هذا بني على التأنيث أعني آوة فجاء على الصحة كما صحت واو قرنوة وقلنسوة لما بنيت الكلمة على التأنيث البتة.
ومنها سرعان فهذا اسم سرع ووشكان: اسم وشك وبطئان: اسم بطؤ.
ومن كلامهم: سرعان ذي إهالةً أي سرعت هذه من إهالة.
فأما أوائل الخيل فسرعانها بفتح الراء قال: فيغيفون ونرجع السرعانا وقد قالوا: وشكان وأشكان.
فأما أشك ذا فماض وليس باسم وإنما أصله وشك فنقلت حركة عينه كما قالوا في حسن: حسن ذا قال: لا يمنع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا ومنها حس اسم أتوجع ودهدرين: اسم بطل.
ومن كلامهم: دهدرين سعد القين وساعد القين أي هلك سعد القين.
ومنها لب وهو اسم اسم لبيك وويك: اسم أتعجب.
وذهب الكسائي إلى أن ويك محذوفة من ويلك قال: والكاف عندنا للخطاب حرف عارٍ من الأسمية.
وأما قوله تعالى: {وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء} فذهب سيبويه والخليل إلى أنه وي ثم قال: كأن الله.
وذهب أبو الحسن إلى أنها ويك حتى كأنه قال عنده: أعجب أن الله يبسط الرزق.
ومن أبيات الكتاب: وي كأن من يكن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش ضر والرواية تحتمل التأويلين جميعاً.
ومنها هيهات من مضاعف الفاء في ذوات الأربعة.
ووزنها فعللة وأصلها هيهية كما أن أصل الزوزاة والقوقاة والدوداة والشوشاة: الزوزوة والقوقوة والدودوة والشوشوة فانقلبت اللام ألفا فصارت هيهاة.
والتاء فيها للتأنيث مثلها في القوقاة والشوشاة.
والوقوف عليها بالهاء.
وهي مفتوحة فتحة المبنيات.
ومن كسر التاء فقال: هيهات فإن التاء تاء جماعة التأنيث والكسرة فيها كالفتحة في الواحد.
واللام عندنا محذوفة لالتقاء الساكنين ولو جاءت غير محذوفة لكانت هيهيات لكنها حذفت لأنها في آخر اسم غير متمكن فجاء جمعه مخالفا لجمع المتمكن نحو الدوديات والشوشيات كما حذفت في قولك: ذان وتان واللذان واللتان.
وأما قول أبي الأسود: على ذات لوث أو بأهوج شوشوٍ صنيع نبيل يملا الرحل كاهله فسألت عنه أبا علي فأخذ ينظر فيه.
فقلت له: ينبغي أن يكون بني من لفظ الشوشاة مثال جحمرش فعاد إلى شوشووٍ فأبدل اللام الثالثة ياء لانكسار ما قبلها فعاد: شوشوٍ فتقول على هذا في نصبه: رأيت شوشوياً فقبل ذلك ورضيه.
ويجوز فيه عندي وجه آخر وهو أن يكون أراد: شوشوياً منسوباً إلى شوشاة ثم خفف إحدى ياءي الإضافة.
وفي هيهات لغات: هيهاة وهيهاةً وهيهات وهيهاتٍ وأيهات وأيهات وأيهاتٍ وأيهاتاً وأيهان بكسر النون حكاها لنا أبو علي عن أحمد بن يحيى وأيها والاسم بعدها مرفوع على حد ارتفاع الفاعل بفعله قال جرير: فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله وقال ايضاً: هيهات منزلنا بنعفٍ سويقة كانت مباركةً من الأيام وأما قوله: هيهات من منخرق هيهاؤه فهذا كقولك: بعد بعده وذلك أنه بني من هذا اللفظ فعلالا فجاء به مجيء القلقال والزلزال.
والألف في هيهات غير الألف في هيهاؤه هي في هيهات لام الفعل الثانية كقاف الحقحقة الثانية وهي في هيهاؤه ألف الفعلال الزائدة.
وهي في هيهات فيمن كسر غير تينك إنما هي التي تصحب تاء الهندات والزينبات.
وذكر سيبويه أن منهم من يقال له: إليك فيقول: إلي إلي فإلي هنا: اسم أتنحى.
وكذلك قول من قيل له: إياك فقال: إياي أي إياي لأتقين.
ومنها قولهم: همهام وهو اسم فني.
وفيها لغات: همهمامِ وحمحامِ ومحماحِ وبحباحِ.
أنشد أحمد بن يحيى: أولمت يا خنوت شر إيلام في يوم نحسٍ ذي عجاجٍ مظلام ما كان إلا كاصطفاق الأقدام حتى أتيناهم فقالوا: همهام فهذا اسم فني وقوله سبحانه: {أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} هو اسم دنوت من الهلكة.
قال الأصمعي في قولها: فأولى لنفسي أولى لها قد دنت من الهلاك.
وحكى أبو زيد: هاهِ الآن وأولاة الآن فأنث أولى وهذا يدل على أنه اسم لا فعل كما يظن وهاه اسم قاربت وهي نحو أولى لك.
فأما الدليل على أن هذه الألفاظ أسماء فأشياء وجدت فيها لا توجد إلا في الأسماء.
منها التنوين الذي هو علم التنكير.
وهذا لا يوجد إلا في الاسم نحو قولك: هذا سيبويه وسيبويهٍ آخر.
ومنها التثنية وهي من خواص الأسماء وذلك قولهم دهدرين.
وهذه التثنية لا يراد بها ما يشفع الواحد مما هو دون الثلاثة.
وإنما الغرض فيها التوكيد بها والتكرير لذلك المعنى كقولك: بطل بطل فأنت لا تريد أن تنفي كونه مرة واحدة بل غرضكم فيه متابعة نفيه وموالاة ذلك كما أن قولك: لا يدين بها لك لست تقصد بها نفي يدين ثنتين وإنما تريد نفي جميع قواه وكما قال الخليل في قولهم: لبيك وسعديك إن معناهما أن كلما كنت في أمر فدعوتني إليه أجبتك وساعدتك عليه.
وكذلك قوله: إذا شق بردٌ شق بالبرد مثله دواليك حتى ليس للبرد لابس أي مداولةً بعد مداولة.
فهذا على العموم لا على دولتين ثنتين.
وكذلك قولهم: دهدرين أي بطل بطلا بعد بطل.
ومنها وجود الجمع فيها في هيهات والجمع مما يختص بالاسم.
ومنها وجود التأنيث فيها في هيهاة وهيهات وأولاة الآن وأفي والتأنيث بالهاء والألف من خواص الأسماء.
ومنها الإضافة وهي قولهم: دونك وعندك ووراءك ومكانك وفرطك وحذرك.
ومنها وجود لام التعريف فيها نحو النجاءك.
فهذا اسم انج.
ومنها التحقير وهي من خواص الأسماء.
وذلك قولهم: رويدك.
وببعض هذا ما يثبت ما دعواه أضعاف هذا.
فإن قيل: فقد ثبت بما أوردته كون هذه الكلم أسماء ولكن ليت شعري ما كانت الفائدة في التسمية لهذه الأفعال بها.
فالجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها السعة في اللغة ألا تراك لو احتجت في قافية بوزن قوله: قدنا إلى الشأم جياد المصرين لأمكنك أن تجعل إحدى قوافيها دهدرين ولو جعلت هنا ما هذا اسمه - وهو بطل - لفسد وبطل.
وهذا واضح.
والآخر المبالغة.
وذلك أنك في المبالغة لا بد أن تترك موضعاً إلى موضع إما لفظاً إلى لفظ وإما جنساً إلى جنس فاللفظ كقولك: عراض فهذا قد تركت فيه لفظ عريض.
فعراض إذاً أبلغ من عريض.
وكذلك رجل حسان ووضاء فهو أبلغ من قولك: حسن ووضئ وكرام أبلغ من كريم لأن كريماً على كرم وهو الباب وكرام خارج عنه.
فهذا أشد مبالغة من كريم.
قال الأصمعي: الشيء إذا فاق في جنسه قيل له: خارجي.
وتفسير هذا ما نحن بسبيله وذلك أنه لما خرج عن معهود حاله أخرج أيضاً عن معهود لفظه.
ولذلك أيضاً إذا أريد بالفعل المبالغة في معناه أخرج عن معتاد حاله من التصرف فمنعه.
وذلك نعم وبئس وفعل التعجب.
ويشهد وعارضتها رهوا على متتابعٍ شديد القصيرى خارجي محنب والثالث ما في ذلك من الإيجاز والاختصار وذلك أنك تقول للواحد: صه وللاثنين: صه وللجماعة: صه وللمؤنث.
ولو أردت المثال نفسه لوجب فيه التثنية والجمع والتأنيث وأن تقول: اسكتا واسكتوا واسكتي واسكتن. وكذلك جميع الباب.
فلما اجتمع في تسمية هذه الأفعال ما ذكرناه من الاتساع ومن الإيجاز ومن المبالغة عدلوا إليها بما ذكرنا من حالها.
ومع ذلك فإنهم أبعدوا أحوالها من أحوال الفعل المسمى بها وتناسوا تصريفه لتناسيهم حروفه.
يدل على ذلك أنك لا تقول: صه فتسلم كما تقول: اسكت فتسلم ولامه فتستريح كما تقول: اكفف فتستريح.
وذلك أنك إذا أجبت بالفاء فإنك إنما تنصب لتصورك في الأول معنى المصدر وإنما يصح ذلك لاستدلالك عليه بلفظ فعله ألا تراك إذا قلت: زرني فأكرمك فإنك إنما نصبته لأنك تصورت فيه: لتكن زيارة منك فإكرام مني.
فزرني دل على الزيارة لأنه من لفظه فدل الفعل على مصدره كقولهم: من كذب كان شراً له أي كان الكذب فأضمر الكذب لدلالة فعله - وهو كذب - عليه وليس كذلك صه لأنه ليس من الفعل في قبيلٍ ولا دبيرٍ وإنما هو صوت أوقع موقع حروف الفعل فإذا لم يكن صه فعلاً ولا من لفظه قبح أن يستنبط منه معنى المصدر لبعده عنه.
فإن قلت: فقد تقول: أين بيتك فأزورك وكم مالك فأزيدك عليه فتعطف بالفعل المنصوب وليس قبله فعل ولا مصدر فما الفرق بين ذلك وبين صه.
قيل: هذا كلام محمول على معناه ألا ترى أن قولك: أين بيتك قد دخله معنى أخبرني فكأنه قال: ليكن منك تعريف لي ومني زيارة لك.
فإن قيل: وكيف ذلك أيضاً هلا جاز صه فتسلم لأنه محمول على معناه ألا ترى أن قولك: صه في معنى: ليكن منك سكوت فتسلم.
قيل: يفسد هذا من قبل أن صه قد انصرف إليه عن لفظ الفعل الذي هو اسكت وترك له ورفض من أجله.
فلو ذهبت تعاوده وتتصوره أو تتصور مصدره لكانت تلك معاودة له ورجوعاً إليه بعد الإبعاد عنه والتحامي للفظ به فكان ذلك يكون كإدغام الملحق لما فيه من نقض الغرض.
وليس كذلك أين بيتك لأن هذا ليس لفظاً عدل إليه عن: عرفني بيتك على وجه التسمية له به ولأن هذا قائم في ظله الأول من كونه مبتدأ وخبرا وصه ومه قد تنوهي في إبعاده عن الفعل البتة ألا تراه يكون مع الواحد والواحدة والاثنين والاثنتين وجماعة الرجال والنساء: صه على صورة واحدة ولا يظهر فيه ضمير على قيامه بنفسه وشبهه بذلك بالجملة المركبة.
فلما تناءى عن الفعل هذا التنائي وتنوسيت أغراضه فيه هذا التناسي لم يجز فيما فأما دراك ونزال ونظار فلا أنكر النصب على الجواب بعده فأقول: دراك زيداً فتظفر به ونزال إلى الموت فتكسب الذكر الشريف به لأنه وإن لم يتصرف فإنه من لفظ الفعل ألا تراك تقول: أأنت سائر فأتبعك فتقتضب من لفظ اسم الفاعل معنى المصدر وإن لم يكن فعلاً كما قال الآخر: إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف فاستنبط من السفيه معنى السفه فكذلك ينتزع من لفظ دراك معنى المصدر وإن لم يكن فعلا.
هذا حديث هذه الأسماء في باب النصب.
فأما الجزم في جواباتها فجائز حسن وذلك قولك: صه تسلم ومه تسترح ودونك زيدا تظفر بسلبه ألا تراك في الجزم لا تحتاج إلى تصور معنى المصدر لأنك لست تنصب الجواب فتضطر إلى تحصيل معنى المصدر الدال على أن والفعل.
وهذا واضح.
فإن قيل: فمن أين وجب بناء هذه الأسماء فصواب القول في ذلك أن علة بنائها إنما هي تضمنها معنى لام الأمر ألا ترى أن صه بمعنى اسكت وأن أصل اسكت لتسكت كما أن أصل قم لتقم واقعد لتقعد فلما ضمنت هذه الأسماء معنى لام الأمر شابهت الحرف فبنيت كما أن كيف ومن وكم لما تضمن كل واحد منها معنى حرف الاستفهام بني وكذلك بقية فأما قول من قال نحو هذا: إنه إنما بني لوقوعه موقع المبني يعني أدرك واسكت فلن يخلو من أحد أمرين: إما أن يريد أن علة بنائه إنما هي نفس وقوعه موقع المبني لا غير وإما أن يريد أن وقوعه موقع فعل الأمر ضمنه معنى حرف الأمر.
فإن أراد الأول فسد لأنه إنما علة بناء الاسم تضمنه معنى الحرف أو وقوعه موقعه.
هذا هو علة بنائه لا غير وعليه قول سيبويه والجماعة.
فقد ثبت بذلك أن هذه الأسماء نحو صه وإيه وويها وأشباه ذلك إنما بنيت لتضمنها معنى حرف الأمر لا غير.
فإن قيل: ما أنكرت من فساد هذا القول من قبل أن الأسماء التي سمي بها الفعل في الخبر مبنية أيضاً نحو أف وآوتاه وهيهات وليست بينها وبين لام الأمر نسبة قيل: القول هو الأول.
فأما هذه فإنها محمولة في ذلك على بناء الأسماء المسمى بها الفعل في الأمر والنهي ألا ترى أن سبب الحكم قد يكون سبباً لضده باب في أن سبب الحكم قد يكون سبباً لضده على وجه هذا سبب ظاهره التدافع وهو مع استغرابه صحيح واقع وذلك نحو قولهم: القود والحوكة والخونة وروع وحول وعور وعوز لوز وشول قال: شاوٍ مشل شلول شلشل شول وتلخيص هذه الجملة أن كل واحد من هذه الأمثلة قد جاء مجيئا مثله مقتضٍ للإعلال وهو مع ذلك مصحح وذلك أنه قد تحركت عينه وهي معتلة وقبلها فتحة وهذا يوجب قلبها ألفا كباب ودار وعابٍ ونابٍ ويومٍ راحٍ وكبشٍ صافٍ إلا أن سبب صحته طريف وذلك أنهم شبهوا حركة العين التابعة لها بحرف اللين التابع لها فكأن فعلاً فعال وكأن فعلا فعيل.
فكما يصح نحو جواب وهيام وطويل وحويل فعلى نحوٍ من ذلك صح باب القود والحوكة والغيب والروع والحول والشول من حيث شبهت فتحة العين بالألف من بعدها وكسرتها بالياء من بعدها.
ألا ترى إلى حركة العين التي هي سبب الإعلال كيف صارت على وجه آخر سببا للتصحيح وهذا وجه غريب المأخذ.
وينبغي أن يضاف هذا إلى احتجاجهم فيه بأنه خرج على أصله منبهة على ما غير من أصل بابه.
ويدلك على أن فتحة العين قد أجروها في بعض الأحوال مجرى حرف اللين قول مرة مبن محكان: في ليلةٍ من جمادى ذات أنديةٍ لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنبا فتكسيرهم ندىً على أندية يشهد بأنهم أجروا ندىً - وهو فعل - مجرى فعال فصار لذلك ندى وأندية كغداء وأغدية.
وعليه قالوا: باب وأبوبة وخال وأخولة.
وكما أجروا فتحة العين مجرى الألف الزائدة بعدها كذلك أجروا الألف الزائدة بعدها مجرى الفتحة.
وذلك قولهم: جواد وأجود وصواب وأصواب جاءت في شعر الطرماح.
وقالوا: عراء وأعراء حياء وأحياء وهباء وأهباء.
فتكسيرهم فعالا على أفعال كتكسيرهم فعلا على أفعلة هذا هنا كذلك ثمة.
وعلى ذلك - عندي - ما جاء عنهم من تكسير فعيل على أفعال نحو يتيم وأيتام وشريف وأشراف حتى كأنه إنما كسر فعل لا فعيل كنمر وأنمار وكبد وأكباد وفخذ وأفخاذ.
ومن ذلك قوله: إذا المرء لم يخش الكريهة أوشكت حبال الهوينى بالفتى أن تقطعا وهذا عندهم قبيح وهو إعادة الثاني مظهرا بغير لفظه الأول وإنما سبيله أن يأتي مضمراً نحو: زيد مررت به.
فإن لم يأت مضمراً وجاء مظهرا فأجود ذلك أن يعاد لفظ الأول البتة نحو: زيد مررت بزيد كقول الله سبحانه: { الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ} و {الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ} وقوله: لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ نغض الموت ذا الغنى والفقيرا ولو قال: زيد مررت بأبي محمد وكنيته أبو محمد لم يجز عند سيبويه وإن كان أبو الحسن قد أجازه.
وذلك أنه لم يعد على الأول ضميره كما يجب ولا عاد عليه لفظه.
فهذا وجه القبح.
ويمكن أن يجعله جاعل سبب الحسن وذلك أنه لما لم يعد لفظ الأول البتة وعاد مخالفا للأول شابه - بخلافه له - المضمر الذي هو أبدا مخالف للمظهر.
وعلى ذلك قال:
أوشكت حبال الهوينى بالفتى.
ولم يقل: به ولا بالمرء.
أفلا ترى أن القبح الذي كان في مخالفة الظاهر الثاني للأول قد عاد فصار بالتأويل من حيث أرينا حسنا.
وسببهما جميعا واحد.
وهو وجه المخالفة في الثاني للأول.
وأما قول ذي الرمة: ولا الخرق منه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هي ما هيا فيجوز أن تكون هي الثانية فيه اعادة للفظ الأول كقوله - عز وجل -: {الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ} وهوالوجه.
ويجوز أن تكون هي الثانية ضمير هي الأولى كقولك: هي مررت بها.
وإنما كان الوجه الأول لأنه إنما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم وهذا من مظانه لأنه في مدحه وتعظيم أمره.
ومن ذلك أنهم قالوا: أبيض لياح.
فقلبوا الواو التي في تصريف لاح يلوح للكسرة قبلها على ضعف ذلك لأنه ليس جمعا كثياب ولا مصدرا كقيام.
وإنما استروح إلى قلب الواو ياء لما يعقب من الخف كقولهم في صوار البقر: صيار وفي الصوان للتخت صيان.
وكان يجب على هذا أن متى زالت هذه الكسرة عن لام لياح أن تعود الواو.
وقد قالوا مع هذا: أبيض لياح فأقروا القلب بحاله مع زوال ما كانوا سامحوا أنفسهم في القلب به على ضعفه.
ووجه التأول منهم في هذا أن قالوا: لما لم يكن القلب مع الكسر عن وجوب واستحكام وإنما ظاهره وباطنه العدول عن الواو إلى الياء هربا منها إليها وطلبا لخفتها لم تراجع الواو لزوال الكسرة إذا مثلها في هذا الموضع في غالب الأمر ساقط غير مؤثر نحو خوان وزوان وقوام وعواد مصدري قاومت وعاودت فمضينا على السمت في الإقامة على الياء.
أفلا ترى إلى ضعف حكم الكسرة في لياح الذي كان مثله قمنا بسقوطه لأدنى عارض يعرض له فينقضه كيف صار سببا ومن ذلك أن الادغام يكون في المعتل سببا للصحة نحو قولك في فعل من القول: قول وعليه جاء اجلواذ.
والادغام نفسه يكون في الصحيح سببا للإعلال ألا تراهم كيف جمعوا حرة بالواو والنون فقالوا: إحرون لأن العين أعلت بالادغام فعوضوا من ذلك الجمع بالواو والنون. وله نظائر فاعرفه.
باب في اقتضاء الموضع لك لفظا هو معك
إلا أنه ليس بصاحبك من ذلك قولهم: لا رجل عندك ولا غلام لك فلا هذه ناصبة اسمها وهو مفتوح إلا أن الفتحة فيه ليست فتحة النصب التي تتقاضاها لا إنما هذه فتحة بناء وقعت موقع فتحة الإعراب الذي هو عمل لا في المضاف نحو لا غلام رجل عندك والممطول نحو لا خيرا من زيد فيها.
وأصنع من هذا قولك: لاخمس عشر لك فهذه الفتحة الآن فى راء " عشر فتحة بناء التركيب فى هذين الأسمين وهى واقعة موقع فتحة البناء فى قولك: لارجل عندك وفتحة لام رجل واقعة موقع فتحة الإعراب فى قولك: لاغلام رجل فيها ولا خيرا منك عنده.
ويدل على أن فتحة راء " عشر " من قولك لا خمسة عشر عندك هى فتحة تركيب الاسمين لا التى تحدثها " لا " فى نحو قولك: لا غلام لك أن " خمسة عشر " لا يغيرها العامل الأقوى أعنى الفعل فى قولك جاءني خمسة عشر والجار فى نحو قولك: مررت بخمسة عشر.
فإذا كان العامل الأقوى لا يؤثر فيها فالعامل الأضعف الذي هو " لا " أحجى بألا يغير.
فعلمت بذلك أن فتحة راء عشر من قولك: لا خمسة عشر لك إنما هي فتحة للتركيب لا فتحة للإعراب فصح بهذا أن فتحة راء عشر من قولك: لا خمسة عشر لك إنما هي فتحة بناء واقعة موقع حركة الإعراب والحركات كلها من جنس واحد وهو الفتح.
ومن ذلك قولك: مررت بغلامي.
فالميم موضع جرة الإعراب المستحقة بالباء والكسرة فيها ليست الموجبة بحرف الجر إنما هذه هي التي تصحب ياء المتكلم في الصحيح نحو هذا غلامي ورأيت غلامي فثباتها في الرفع والنصب يؤذنك أنها ليست كسرة الإعراب وإن كانت بلفظها.
ومن ذلك قولهم: يسعني حيث يسعك فالضمة في حيث ضمة بناء واقعة موقع رفع الفاعل. فاللفظ واحد التقدير مختلف. ومن ذلك قولك: جئتك الآن. فالفتحة فتحة بناء في الآن وهي واقعة موقع فتحة نصب الظرف.
ومن ذلك قولك: كنت عندك في أمس. فالكسرة الآن كسرة بناء. وهي واقعة موقع كسرة الإعراب المقتضيها الجر.
وأما قوله: وإني وقفت اليوم والأمس قبله ببابك حتى كادت الشمس تغرب فيروي: والأمس جرا ونصبا.
فمن نصبه فلانه لما عرفه باللام الظاهرة وأزال عنه تضمنه إياها أعربه والفتحة فيه نصبه الظرف كقولك أنا آتيك اليوم وغدا.
وأما من جره فالكسرة فيه كسرة البناء التي في قولك: كان هذا أمس واللام فيه زائدة كزيادتها في الذي والتي وفي قوله: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلاً ولقد نهيتك عن بنات الأوبر قال أبو عثمان: سألت الأصمعي عن هذا فقال: الألف واللام في الأوبر زائدة.
وإنما تعرف الأمس بلام أخرى مرادةٍ غير هذه مقدرة.
وهذه الظاهرة ملقاة زائدة للتوكيد.
ومثله مما تعرف بلام مرادة وظهرت فيه لام أخرى غيرها زائدة قولك: الآن.
فهو معرف بلام مقدرة وهذه الظاهرة فيه زائدة.
وقد ذكر أبو علي هذا قبلنا وأوضحه وذكرناه نحن أيضاً في غير هذا الموضع من كتبنا.
وقد ذكرت في كتاب التعاقب في العربية من هذا الضرب نحوا كثيرا.
فلندعه هنا.
باب في احتمال القلب لظاهر الحكم
هذا موضع يحتاج إليه مع السعة ليكون معدا عند الضرورة.فمن ذلك قولهم: أسطر.
فهذا وجهه أن يكون جمع سطر ككلب وأكلب وكعب وأكعب.
وقد يجوز أيضاً أن يكون جمع سطر فيكون حينئذ كزمن وأزمن وجبل وأجبل قال: إني لأكني بأجبالٍ عن اجلبها وباس أودية عن اسم واديها ومثله أسطار فهذا وجهه أن يكون جمع سطرٍ كجبل وأجبال وقد يجوز أيضاً أن يكون جمع سطر كثلج وأثلاج وفرخ وأفراخ قال الحطيئة: ماذا تقول لأفراخٍ بذي مرخٍ زغب الحواصل لا ماءٌ ولا شجر ومثله قولهم: الجباية في الخراج ونحوه: الوجه أن يكون مصدر جبيته ويجوز أن يكون من جبوته كقولهم: شكوته شكاية.
وأصحابنا يذهبون في قولهم: الجباوة إلى أنها مقلوبة عن الياء في جبيت ولا يثبتون جبوت.
ونحو من ذلك قولهم: القنية يجب على ظاهرها أن تكون من قنيت.
وأما أصحابنا فيحملونها على أنها من قنوت أبدلت لضعف الحاجز - لسكونه - عن الفصل به بين الكسرة وبينها.
على أن أعلى اللغتين قنوت.
ومن ذلك قولهم: الليل يغسى فهذا يجب أن يكون من غسى كشقى يشقى ويجوز أن يكون من غسا فقد قالوا: عسى يغسى وغسا يغسو ويغسى أيضاً وغسا يغسى نحو أبى يأبى وجبا الماء يجباه.
ومن ذلك زيد مررت به واقفا الوجه أن يكون واقفا حالا من الهاء في به وقد يجوز أن يكون حالا من نفس زيد المظهر ويكون مع هذا العامل فيه ما كان عاملا فيه وهو حال من الهاء ألا ترى أنه قد يجوز أن يكون العامل في الحال هو غير العامل في صاحب الحال ومن ذلك قول الله سبحانه وهو الحق مصدقاً فمصدقاً حال من الحق والناصب له غير الرافع للحق وعليه البيت: أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عار وكذلك عامة ما يجوز فيه وجهان أو أوجه ينبغي أن يكون جميع ذلك مجوزاً فيه.
ولا يمنعك قوة القوى من إجازة الضعيف أيضاً فإن العرب تفعل ذلك تأنيساً لك بإجازة الوجه الأضعف لتصح به طريقك ويرحب به خناقك إذا لم تجد وجها غيره فتقول: إذا أجازوا نحو هذا ومنه بد وعنه مندوحة فما ظنك بهم إذا لم يجدوا منه بدلا ولا عنه معدلا ألا تراهم كيف يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على تركها ليعدوها لوقت الحاجة إليها.
فمن ذلك قوله: قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنباً كله لم أصنع أفلا تراه كيف دخل تحت ضرورة الرفع ولو نصب لحفظ الوزن وحمى جانب الإعراب من الضعف.
وكذلك قوله: لم تتلفع بفضل مئزرها دعدٌ ولم تغذ دعد في العلب كذا الرواية بصرف دعد الأولى ولو لم يصرفها لما كسر وزنا وأمن الضرورة أو ضعف إحدى اللغتين.
وكذلك قوله: أبيت على معاري فاخرات بهن ملوب كدم العباط هكذا أنشده: على معاري بإجراء المعتل مجرى الصحيح ضرورة ولو أنشد: على معارٍ فاخرات لما كسر وزنا ولا احتمل ضرورة.
باب في أن الحكم للطارىء
اعلم أن التضاد في هذه اللغة جارٍ مجرى التضاد عند ذوي الكلام.
فإذا ترادف الضدان في شيء منها كان الحكم منهما للطارىء فأزال الأول.
وذلك كلام التعريف إذا دخلت على المنون حذف لها تنوينه كرجل والرجل وغلام والغلام.
وذلك أن اللام للتعريف والتنوين من دلائل التنكير.
فلما ترادفا على الكلمة تضادا فكان الحكم لطارئهما وهو اللام.
وهذا جارٍ مجرى الضدين المترادفين على المحل الواحد كالأسود يطرأ عليه البياض والساكن تطرأ عليه الحركة فالحكم للثاني منهما.
ولولا أن الحكم للطارىء لما تضاد في الدنيا عرضان.
أو إن تضادا أن يحفظ كل ضد محله فيحمي جانبه أن يلم به ضد له فكان الساكن أبدا ساكنا والمتحرك أبدا متحركا والأسود أبدا أسود والأبيض أبدا أبيض لأنه كان كلما هم الضد بوروده على المحل الذي فيه ضده نفى المقيم به الوارد عليه فلم يوجده إليه طريقاً ولا عليه سبيلا.
ومثل حذف التنوين للام حذف تاء التأنيث لياءى الإضافة كقولك في الإضافة إلى البصرة: بصرى وإلى الكوفة: كوفى.
وكذلك حذف تاء التأنيث لعلامته أيضاً نحو ثمرات وجمرات وقائمات وقاعدات.
وكذلك تغيير الأولى للثانية بالبدل نحو صحراوات وخنفساوات.
وكذلك حذف ياءي الإضافة لياءيه كقولك في الإضافة إلى البصرى: بصرى وإلى الكوفى: كوفى وكذلك إلى كرسي: كرسي وإلى بختي: بختي.
فتحذف الأوليين للأخريين.
وكذلك لو سميت رجلا أو امرأة بهندات لقلت في الجمع أيضاً: هندات فحذفت الألف والتاء الأوليين للأخريين الحادثتين.
فإن قلت: كيف جاز أن تحذف لفظا وإنما جئت بمثله ولم تزد على ذلك فهلا كان ذلك في الامتناع بمنزلة امتناعهم من تكسير مساجد ونحوه اسم رجل ألا تراهم قالوا: لو كسرته لما زدت على مراجعة اللفظ الأول وأن تقول فيه: مساجد.
فالجواب أن علم التأنيث يلحق الكلمة نيفا عليها وزيادة موصولة بها وصورة الاسم قبلها قائمة برأسها وذلك نحو قائمة وعاقلة وظريفة وكذلك حال ياءي الإضافة نحو زيدي وبكري ومحمدي وكذلك ما فيه الألف والتاء نحو هندات وزينبات إنما يلحقان ما يدخلان عليه من عجزه وبعد تمام صيغته فإذا أنت حذفت شيئاً من ذلك فإنك لم تعرض لنفس الصيغة بتحريف وإنما اخترمت زيادة عليها واردة بعد الفراغ من بنيتها فإذا أنت حذفتها وجئت بغيرها مما يقوم مقامها فكأن لم تحدث حدثاً ولم تستأنف في ذلك عملاً.
وأما باب مفاعل فإنك إن اعتزمت تكسيرها لزمك حذف ألف تكسيرها ونقص المشاهد من صورتها واستئناف صيغة مجددة وصنعة مستحدثة.
ثم مع هذا فإن اللفظ الأول والثاني واحد وأنت قد هدمت الصورة هدماً ولم تبق لها أمارة ولا رسماً وإنما اقترحت صورة آخرى مثل المستهلكة الأولى.
وكذلك ما جاء عنهم من تكسير فعل على فعل كالفلك في قول سيبويه.
لما كسرته على الفلك فأنت إنما غيرت اعتقادك في الصفة فزعمت أن ضمة فاء الفلك في الواحد كضمة دال درج وباء برج وضمتها في الجمع كضمة همزة أسد وأثن جمع أسد ووثن إلا أن صورة فلك في الواحد هي صورته في الجمع لم تنقص منها رسما وإنما استحدثت لها اعتقادا وتوهما.
وليست كذلك مساجد لأنك لو تجشمت تكسيرها على مساجد أيضاً حذفت الألف ونقصت الصيغة واستحدثت للتكسير المستأنف ألفا أخرى وصورة غير الأولى.
وإنما ألف مساجد لو اعتزمت تكسيرها كألف عذافر وخرافج وألف تكسيره كألف عذافر وخرافج. فهذا فرق.
ومن غلبة حكم الطارىء حذف التنوين للإضافة نحو غلام زيد وصاحب عمرو.
وذلك لأنهما ضدان ألا ترى أن التنوين مؤذن بتمام ما دخل عليه والإضافة حاكمة بنقص المضاف وقوة حاجته إلى ما بعده.
فلما كانت هاتان الصفتان على ما ذكرنا تعادتا وتنافتا فلم يمكن اجتماع علامتيهما.
وأيضاً فإن التنوين علم للتنكير والإضافة موضوعة للتعريف وهاتان أيضاً قضيتان متدافعتان إلا أن الحكم للطارىء من العلمين وهو الإضافة ألا ترى أن الإفراد أسبق رتبة من الإضافة كما أن التنكير أسبق رتبة من التعريف.
فاعرف الطريق فإنها مع أدنى تأمل واضحة.
واعلم أن جميع ما مضى من هذا يدفع قول الفراء في قوله سبحانه {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}: إنه أراد ياء النصب ثم حذفها لسكونها وسكون الألف قبلها.
وذلك أن ياء التثنية هي الطارئة على ألف ذا فكان يجب أن تحذف الألف لمكانها.
باب في الشيء يرد فيوجب له القياس حكما
ويجوز أن يأتي السماع بضده أيقطع بظاهره أم يتوقف إلى أن يرد السماع بجلية حاله وذلك نحو عنتر وعنبر وحنزقر وحنبتر وبلتع وقرناس.
فالمذهب أن يحكم في جميع هذه النونات والتاءات وما يجري مجراها - مما هو واقع موقع الأصول مثلها - بأصليته مع تجويزنا أن يرد دليل على زيادة شيء منه كما ورد في عنسل وعنبس ما قطعنا به على زيادة نونهما وهو الاشتقاق المأخوذ من عبس وعسل وكما قطعنا على زيادة نون قنفخر لقولهم: امرأة قفاخرية وكذلك تاء تألب لقولهم: ألب الحمار طريدته يألبها فكذلك يجوز أن يرد دليل يقطع به على نون عنبر في الزيادة وإن كان ذلك كالمتعذر الآن لعدم المسموع من الثقة المأنوس بلغته وقوة طبيعته ألا ترى أن هذا ونحوه مما لو كان له أصل لما تأخر أمره ولوجد في اللغة ما يقطع له به.
وكذلك ألف أءةٍ حملها الخليل - رحمه الله - على أنها منقلبة عن الواو حملا على الأكثر ولسنا ندفع مع ذلك أن يرد شيء من السماع يقطع معه بكونها منقلبة عن ياء على ما قدمناه من بعد نحو ذلك وتعذره.
ويجيء على قياس ما نحن عليه أن تسمع نحو بيت وشيخ فظاهره - لعمري - أن يكون فعلا مما عينه ياء ثم لا يمنعنا هذا أن نجيز كونها فيعلا مما عينه واو كميت وهين.
ولكن إن وجدت في تصريفه نحو شيوخ وأشياخ ومشيخة قطعت بكونه من باب: بيع وكيل.
غير أن القول وظاهر العمل أن يكون من باب بيع.
بل إذا كان سيبويه قد حمل سيدا على أنه من الياء تناولا لظاهره مع توجه كونه فعلا مما عينه واو كريح وعيد كان حمل نحو شيخ على أن يكون من الياء لمجيىء الفتحة قبله أولى وأحجي.
فعلى نحوٍ من هذا فليكن العمل فيما يرد من هذا.
باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن لا على ما يبعد ويقبح
وذلك كأن تقسم نحو مروان إلى ما يحتمل حاله من التمثيل له فنقول: لا يخلو من أن يكون فعلان أو مفعالا أو فعوالا. فهذا ما يبيحك التمثيل في بابه.
فيفسد كونه مفعالا أو فعوالا أنهما مثالان لم يجيئا وليس لك أن تقول في تمثيله: لا يخلو أن يكون مفلان أو مفوالا أو فعوان أو مفوان أو نحو ذلك لأن هذه ونحوها إنما هي أمثلة ليست موجودة أصلا ولا قريبة من الموجودة كقرب فعوال ومفعال من الأمثلة الموجودة الا ترى أن فعوالا أخت فعوال كقرواش وأخت فعوال كعصواد وأن مفعالا أخت مفعال كمحراب وأن كل واحد من مفلان ومفوان وفعوان لا يقرب منه شيء من أمثلة كلامهم.
وتقول على ذلك في تمثيل أيمن من قوله: يبري لها من أيمن وأشمل لا يخلو أن يكون أفعلا أو فعلنا أو أيفلا أو فيعلا.
فيجوز هذا كله لأن بعضه له نظير وبعضه قريب مما له نظير الا ترى أن أفعلا كثير النظير كأكلب وأفرخ ونحو ذلك وأن أيفلا له نظير وهو أنيق في أحد قولي سيبويه فيه وأن فعلنا يقارب أمثلتهم.
وذلك فعلن في نحو خلبن وعلجن قال ابن العجاج: وخلطت كل دلاثٍ علجن تخليط خرقاء اليدين خلبن وأن فعيلا أخت فيعل كصيرف وفيعل كسيد.
وأيضاً فقد قالوا: أيبلي وهو فيعلي وهيردان وهو فيعلان.
ولكن لا يجوز لك في قسمته أن تقول: لا يخلو أيمن أن يكون أيفعا ولا فعملا ولا أيفما ولا نحو ذلك لن هذه ونحوها أمثلة لا تقرب من أمثلتهم فيجتاز بها في جملة تقسيم المثل لها.
وكذلك لو مثلت نحو عصي لقلت في قسمته: لا يخلو أن يكون فعولا كدلى أو فعيلا كشعير وبعير أو فليعا كقسي وأصلها فعول: قووس فغيرت إلى قسو: فلوع ثم إلى قسي: فليع أو فعلا كطمر.
وليس لك أن تقول في عصي إذا قسمتها: أو فعلياً لأن هذا مثال لا موجود ولا قريب من الموجود إلا أن تقول: إنها مقاربة لطمر.
وتقول في تمثيل إوى من قوله: إذا قسمته: لا يخلو أن يكون فعولا كثدي أو فعيلا كشعير أو فعيا كمئي إذا نسبت إلى مائة ولم تردد لامها أو فعلا كطمر.
ولا تقول في قسمتها: أو فوعلاً أو إفعلا أو فوياً أو إفلعا أو نحو ذلك لبعد هذه الأمثلة مما جاء عنهم.
فإذا تناءت عن مثلهم إلى ههنا لم تمرر بها في التقسيم لأن مثلها ليس مما يعرض الشك فيه ولا يسلم الفكر به ولا توهم الصنعة كون مثله.
باب في خصوص ما يقنع فيه العموم من أحكام صناعة الإعراب
وذلك كأن تقول في تخفيف همزة نحو صلاءة وعباءة: لا تلقى حركتها على الألف لأن الألف لا تكون مفتوحة أبدا.
فقولك: مفتوحة تخصيص لست بمضطر إليه ألا ترى أن الألف لا تكون متحركة أبدا بالفتحة ولا غيرها.
وإنما صواب ذلك أن تقول: لأن الألف لا تكون متحركة أبدا.
وكذلك لو قلت: لأن الألف لا تلقى عليها حركة الهمزة لكان - لعمري - صحيحاً كالأول إلا أن فيه تخصيصاً يقنع منه عمومه.
فإن قلت: استظهرت بذلك للصنعة قيل: لا بل استظهرت به عليها ألا ترى أنك إذا قلت: إن الألف لا تكون مفتوحة أبدا جاز أن يسبق إلى نفس من يضعف نظره أنها وإن تكن مفتوحة فقد يجوز أن تكون مضمومة أو مكسورة.
نعم وكذلك إذا قلت: إنها لا تلقي عليها حركة الهمزة جاز أن يظن أنها تلقى عليها حركة غير الهمزة.
فإذا أنت قلت: لا يلقى عليها الحركة أو لا تكون متحركة أبدا احتطت للموضع واستظهرت للفظ والمعنى.
وكذلك لو قلت: إن ظننت وأخواتها تنصب مفعوليها المعرفتين - نحو طننت أخاك أباك - لكنت - لعمري - صادقا إلا انك مع ذلك كالموهم به أنه إذا كان مفعولاها نكرتين كان لها حكم غير حكمها إذا كانا معرفتين.
ولكن إذا قلت: ظننت وأخواتها تنصب مفعوليها عممت الفريقين بالحكم وأسقطت الظنة عن المستضعف الغمر وذكرت هذا النحو من هذا اللفظ حراسة له وتقريباً منه ونفياً لسوء المعتقد عنه.
باب في تركيب المذاهب
قد كنا أفرطنا في هذا الكتاب تركيب اللغات.
وهذا الباب نذكر فيه كيف تتركب المذاهب إذا ضممت بعضها إلى بعض وأنتجت بين ذلك مذهبا.
وذلك أن أبا عثمان كان يعتقد مذهب يونس في رد المحذوف في التحقير وإن غنى المثال عنه فيقول في تحقيرها هارٍ وهو يئر وفي يضع اسم رجل يويضع وفي بالة من قولك ما باليت به بالة: بويلية.
وسيبويه إذا استوفى التحقير مثاله لم يردد ما كان قبل ذلك محذوفاً.
فيقول هوير ويضيع وبويلة.
وكان أبو عثمان أيضاً يرى رأي سيبويه في صرف نحو جوارٍ علما وإجرائه بعد العلمية على ما كان عليه قبلها.
فيقول في رجل أو امرأة اسمها جوارٍ أو غواشٍ بالصرف في الرفع والجر على حاله قبل نقله ويونس لا يصرف ذلك ونحوه علما ويجريه مجرى الصحيح في ترك الصرف.
فقد تحصل إذا لأبي عثمان مذهب مركب من مذهبي الرجلين وهو الصرف على مذهب سيبويه والرد على مذهب يونس.
فتقول على قول أبي عثمان في تحقير اسم رجل سميته بيري: هذا يرىءٍ كيريع.
فترد الهمزة على قول يونس وتصرف على قول سيبويه.
ويونس يقول في هذا: يربئى بوزن يريعي فلا يصرف وقياس قول سيبويه يرى فلا يرد وإذا لم يرد لم يقع الطرف بعد كسرة فلا يصرف إذاً كما لا يصرف أحي تصغير أحوي.
وقياس قول أن يصرف فيقول: يريٌ كما يصرف تحقير أحوي: أحيٌ.
فقد عرفت إذاً تركب مذهب أبي عثمان من قولي الرجلين.
فإن خففت همزة يرىءٍ قلت يريى فجمعت في اللفظ بين ثلاث ياءات والوسطى مكسورة.
ولم يلزم حذف الطرف للاستثقال كما حذف في تحقير أحوي إذا قلت: أحي من قبل أن الياء الثانية ليست ياء مخلصة وإنما هي همزة مخففة فهي في تقدير الهمز.
فكما لا تحذف في قولك: يرىءٍ كذلك لا تحذف في قولك: يريى.
ولو رد عيسى كما رد يونس للزمه ألا يصرف في النصب لتمام مثال الفعل فيقول: رأيت يريئ ويريى وأن يصرف في الرفع والجر على مذهب سيبويه حملا لذلك على صرف جوارٍ.
ومن ذلك قول أبي عمر في حرف التثنية: إن الألف حرف الإعراب ولا إعراب فيها وهذا هو قول سيبويه.
وكان يقول: إن انقلاب الألف إلى الياء هو الإعراب.
وهذا هو قول الفراء أفلا تراه كيف تركب له في التثنية مذهب ليس بواحد من المذهبين الآخرين.
وقال أبو العباس في قولهم: أساء سمعا فأساء جابة: إن أصلها إجابة ثم كثر فجرى مجرى المثل فحذفت همزته تخفيفاً فصارت جابة.
فقد تركب الآن من قوله هذا وقولي أبي الحسن والخليل مذهب طريف.
وذلك أن أصلها اجوابة فنقلت الفتحة من العين إلى الفاء فسكنت العين وألف إفعالة بعدها ساكنة فحذفت الألف على قول الخليل والعين على قول أبي الحسن جريا على خلافهما المتعالم من مذهبيهما في مقول ومبيع.
فجابة على قول الخليل إذا ضامه قول أبي العباس فعلة ساكنة العين وعلى قول أبي الحسن إذا ضامه قول أبي العباس فالة.
أفلا ترى إلى هذه الذي أدى إليه مذهب أبي العباس في هذه اللفظة وأنه قول مركب ومذهب لولا ما أبدعه فيه أبو العباس لكان غير هذا.
وذلك أن الجابة - على الحقيقة - فعلة مفتوحة العين جاءت على أفعل بمنزلة أرزمت السماء رزمة وأجلب القوم جلبة.
ويشهد أن الأمر كذا ولا كما ذهب إليه أبو العباس قولهم: أطعت طاعة وأطقت طاقة.
وليس واحدة منهما بمثل ولا كثرت فتجري مجرى المثل فتحذف همزتها إلا أنه تركب من قول أبي العباس فيها إذا سبق على مذهبي الخليل وأبي الحسن ما قدمناه: من كونها فعلة ساكنة العين أو فالة كما ترى.
وكذا كثير من المذاهب التي هي مأخوذة من قولين ومسوقة على أصلين: هذه حالها.
باب في السلب
نبهنا أبو علي - رحمه الله - من هذا الموضع على ما أذكره وأبسطه لتتعجب من حسن الصنعة فيه.
اعلم أن كل فعل أو اسم مأخوذٍ من الفعل أو فيه معنى الفعل فإن وضع ذلك في كلامهم على إثبات معناه لا سلبهم إياه.
وذلك قولك: قام فهذا لإثبات القيام وجلس لإثبات الجلوس وينطلق لإثبات الانطلاق وكذلك الانطلاق ومنطلق: جميع ذلك وما كان مثله إنما هو لإثبات هذه المعاني لا لنفيها.
ألا ترى أنك إذا أردت نفي شيء منها ألحقته حرف النفي فقلت: ما فعل ولم يفعل ولن يفعل ولا تفعل ونحو ذلك.
ثم إنهم مع هذا قد استعملوا ألفاظا من كلامهم من الأفعال ومن الأسماء الضامنة لمعانيها في سلب تلك المعاني لا إثباتها.
ألا ترى أن تصريف ع ج م أين وقعت في كلامهم إنما هو للإبهام وضد البيان.
ومن ذلك العجم لأنهم لا يفصحون وعجم الزبيب ونحوه لاستتار في ذي العجم ومنه عجمة الرمل لما استبهم منه على سالكيه فلم يتوجه لهم.
ومنه عجمت العود ونحوه إذا عضضته: لك فيه وجهان: إن شئت قلت: إنما ذلك لإدخالك إياه في فيك وإخفائك له وإن شئت قلت: إن ذلك لأنك لما عضضته ضغطت بعض ظاهر أجزائه فغارت في المعجوم فخفيت.
ومن ذلك استعجمت الدار إذا لم تجب سائلها قال: صم صداها وعفا رسمها واستعجمت عن منطق السائل ومنه جرح العجماء جبار لأن البهيمة لا تفصح عما في نفسها.
ومنه قيل لصلاة الظهر والعصر: العجماوان لأنه لا يفصح فيهما بالقراءة.
وهذا كله على ما تراه من الاستبهام وضد البيان ثم إنهم قالوا: أعجمت الكتاب إذا بينته وأوضحته.
فهو إذاً لسلب معنى الاستبهام لا إثباته.
ومثله تصريف ش ك و فأين وقع ذلك فمعناه إثبات الشكو والشكوى والشكاة وشكوت واشتكيت.
فالباب فيه كما تراه لإثبات هذا المعنى ثم إنهم قالوا: أشكيت الرجل إذا زلت له عما يشكوه فهو إذاً لسلب معنى الشكوى لا لإثباته أنشد أبو زيد: تمد بالأعناق أو تلويها وتشتكي لو أننا نشكيها مس حوايا قلما نجفيها وفي الحديث: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا أي فلم يفسح لنا في إزالة ما شكوناه من ذلك إليه.
ومنه تصريف م ر ض إنها لإثبات معنى المرض نحو مرض يمرض وهو مريض ومارض ومرضى ومراضى.
ثم إنهم قالوا: مرضت الرجل أي داويته من مرضه حتى أزلته عنه أو لتزيله عنه.
وكذلك تصريف ق ذ ى إنها لإثبات معنى القذى منه قذت عينه وقذيت وأقذيتها ثم إنهم مع هذا يقولون: قذيت عينه إذا أزلت عنها القذى وهذا لسلب القذى لا لإثباته.
ومنه حكاية الفراء عن أبي الجراح: بي إجل فأجلوني أي داووني ليزول عني.
والإجل: وجع في العنق.
ومن ذلك تصريف أ ث م أين هي وقعت لإثبات معنى الإثم نحو أثم يأثم وآثم وأثيم وأثوم والمأثم وهذا كله لإثباته.
ثم إنهم قالوا: تأثم أي ترك الإثم.
ومثله تحوب أي ترك الحوب.
فهذا كله كما تراه في الفعل وفي ذي الزيادة لما سنذكره.
وقد وجدته أيضاً في الأسماء غير الجارية على الفعل إلا أن فيها معاني الأفعال كما أن مفتاحاً فيه معنى الفتح وخطافاً فيه معنى الاختطاف وسكيناً فيه معنى التسكين وإن لم يكن واحد من ذلك جارياً على الفعل.
فمن تلك الأسماء قولهم: التودية لعودٍ يصر على خلف الناقة ليمنع اللبن.
وهي تفعلة من ودى يدى إذا سال وجرى وإنما هي لإزالة الودى لا لإثباته.
فآعرف ذلك.
ومثله قولهم السكاك للجو هو لسلب معنى تصريف س ك ك ألا ترى أن ذلك للضيق أين وقع.
منه أذن سكاء أي لاصقة وظليم أسك: إذا ضاق ما بين منسميه وبئر سك أي ضيقة الجراب.
ومنه قوله: ومسك سابغةٍ هتكت فروجها يريد ضيق حلق الدرع.
وعليه بقية الباب.
ثم قالوا للجو - ولا أوسع منه -: السكاك فكأنه سلب ما في غيره من الضيق.
ومن ذلك قولهم: النالة لما حول الحرم.
والتقاؤهما أن من كان فيه لم تنله اليد قال الله - عز اسمه -: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.
فهذا لسلب هذا المعنى لا لإثباته.
ومنه: المئلاة للخرقة في يد النائحة تشير بها.
قال لي أبو علي: هي من ألوت فقلت له: فهذا إذاً من ما ألوت لأنها لا تألو أن تشير بها فتبسم رحمه الله إلي إيماء إلى ما نحن إليه وإثباتاً له واعترافاً به.
وقد مر بنا من ذلك ألفاظ غير هذه.
وكان أبو علي رحمه الله يذهب في الساهر إلى هذا ويقول: إن قولهم: سهر فلان أي نبا جنبه عن الساهرة وهي وجه الأرض قال الله عز وجل: {فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ} فكأن الإنسان إذا سهر قلق جنبه عن مضجعه ولم يكد يلاقي الأرض فكأنه سلب الساهرة.
ومنه تصريف ب ط ن إنما هو لإثبات معنى البطن نحو بطن وهو بطين ومبطان ثم قالوا: رجل مبطن للخميص البطن فكأنه لسلب هذا المعنى قال الهذلي:
مخطوف الحشا زرم وهذا مثله سواءً.
وأكثر ما وجدت هذا المعنى من الأفعال فيما كان ذا زيادة ألا ترى أن أعجم ومرض وتحوب وتأثم كل واحد منها ذو زيادة.
فكأنه إنما كثر فيما كان ذا زيادة من قبل أن السلب معنى حادث على إثبات الأصل الذي هو الإيجاب فلما كان السلب معنى زائداً حادثاً لاق به من الفعل ما كان ذا زيادة من حيث كانت الزيادة حادثة طارئة على الأصل الذي هو الفاء والعين واللام كما أن التأنيث لما كان معنى طارئاً على التذكير احتاج إلى زيادة في اللفظ علماً له كتاء طلحة وقائمة وألفى بشرى وحمراء وسكرى وكما أن التعريف لما كان طارئاً على التنكير احتاج إلى زيادة لفظ به كلام التعريف في الغلام والجارية ونحوه.
فأما سهر فإن في بابه وإنه خرج إلى سلب أصل الحرف بنفسه من غير زيادة فيه فلك فيه إن شئت قلت: إنه وإن عري من زيادة الحروف فإنه لم يعر من زيادة ما هو مجارٍ للحرف وهو ما فيه من الحركات.
وقد عرفت من غير وجهٍ مقاربة الحروف للحركات والحركات للحروف فكأن في سهر ألفاً وياء حتى كأنه ساهير فكأنه إذاً ليس بعار من الزيادة إذ كان فيه ما هو مضارع للحرف أعني الحركة.
فهذا وجه.
وإن شئت قلت: خرج سهر منتقلاً عن أصل بابه إلى سلب معناه منه كما خرجت الأعلام عن شياع الأجناس إلى خصوصها بأنفسها لا بحرف يفيد التعريف فيها ألا ترى أن بكراً وزيداً ونحوهما من الأعلام إنما تعرفه بوضعه لا بلام التعريف فيه كلام الرجل والمرأة وما أشبه ذلك.
وكما أن ما كان مؤنثاً بالوضع كذلك أيضاً نحو هند وجملٍ وزينب وسعاد فاعرفه.
ومثل سهر في تعريه من الزيادة قوله: يخفي النراب بأظلاف ثمانية ومن ذي الزيادة منه قولهم: أخفيت الشيء أي أظهرته.
وأنا أرى أن في هذا الموضع من العربية ما أذكره لك وهو أن هذا المعنى الذي وجد في الأفعال من الزيادة على معنى الإثبات بسلبه كأنه مسوق على ما جاء من الأسماء ضامناً لمعنى الحرف كالأسماء المستفهم بها نحوكم ومن وأي وكيف ومتى وأين وبقية الباب.
فإن الاستفهام معنى حادث فيها على ما وضعت له الأسماء من إفادة معانيها.
وكذلك الأسماء المشروط بها: من وما وأي وأخواتهن فإن الشرط معنى زائد على مقتضاهن: من معنى الأسمية.
فأرادوا ألا تخلو الأفعال من شيء أنيث لما كان معنى طارئاً على التذكير احتاج إلى زيادة في اللفظ علماً له كتاء طلحة وقائمة وألفى بشرى وحمراء أامن هذا الحكم - أعني تضمنها معنى حرف النفي - كما تضمن الأسماء معنى حرف الإستفهام ومعنى حرف الشرط ومعنى حرف التعريف في أمس والآن ومعنى حرف الأمر في تراك وحذار وصه ومه ونحو ذلك.
وكأن الحرف الزائد الذي لا يكاد ينفك منه أفعال السلب يصير كأنه عوض من حرف السلب.
وأيضاً فإن الماضي وإن عرى من حرف الزيادة فإن المضارع لا بد له من حرف المضارعة والأفعال كلها تجري مجرى المثال الواحد.
فإذا وجد في بعضها شيء فكأنه موجود في بقيتها.
وإنما جعلنا هذه الأفعال في كونها ضامنة لمعنى حرف النفي ملحقة بالأسماء في ذلك وجعلنا الأسماء أصلا فيه من حيث كانت الأسماء أشد تصرفاً في هذا ونحوه من الأفعال إذ كانت هي الأول والأفعال توابع وثوانٍ لها وللأصول من الاتساع والتصرف ما ليس للفروع.
فإن قيل: فكان يجب على هذا أن يبنى من الأسماء ما تضمن هذا المعنى وهو ما ذكرته: من التودية والسكاك والنالة والمئلاة وأنت ترى كلا من ذلك معربا.
قيل: الموضع في هذا المعنى من السلب إنما هو للفعل وفيه كثرته فلما لم يؤثر هذا المعنى في نفس الفعل كان ألا يؤثر فيما هو محمول عليه أولى و أحرى بذلك.
فإن قيل: وهلا أثر هذا المعنى في الفعل أصلا كما يؤثر تضمن معنى الحرف في الاسم.
قيل: البناء لتضمن معنى الحرف أمر يخص الاسم ككم وأين وكيف ومتى ونحو ذلك والأفعال لا تبنى لمشابهتها الحروف.
أما الماضي فلأن فيه من البناء ما يكفيه وكذلك فعل الأمر العارى من حروف المضارعة نحو افعل.
وأما المضارع فلأنه لما أهيب به ورفع عن ضعة البناء إلى شرف الإعراب لو يروا أن يتراجعوا به إليه وقد انصرفوا به عنه لئلا يكون ذلك نقصا.
فإن قلت: فقد بنوا من الفعل المعرب ما لحقته نون التوكيد نحو لتفعلن.
قيل: لما خصته النون بالاستقبال ومنعته الحال التي المضارع أولى بها جاز أن يعرض له البناء.
وليس كذلك السين وسوف لأنهما لم يبينا معه بناء نون التوكيد فيبنى هو وإنما هما فيه كلام التعريف الذي لا يوجب بناء الاسم فاعرفه.
باب في وجوب الجائز
وذلك في الكلام على ضربين: أحدهما أن توجبه الصنعة فلا بد إذاً منه.
والآخر أن تعتزمه العرب فتوجبه وإن كان القياس يبيح غيره.
الأول من ذلك كأن تقول في تحقير أسود: أسيد.
وإن شئت صححت فقلت: أسيود.
والإعلال فيه أقوى لا جتماع الياء والواو وسبق الأولى منهما بالسكون.
وكذلك جدول تقول فيه: جديل.
وإن شئت صححت فقلت: جديول.
فإذا صرت إلى تحقير نحو عجوز ويقوم اسم رجل قلت بالإعلال لا غير: عجيز ويقيم.
وفي مقام: مقيم البتة.
وذلك أنك إنما كنت تجيز أسيود وجديولا لصحة الواو في الواحد وظهورها في الجمع نحو أساود وجداول.
فأما مقام يقوم علماً فإن العين وإن ظهرت في تكسيرهما - وهو مقاوم ويقاوم - فإنها في الواحد معتلة ألا ترى أنها في مقام مبدلة وفي يقوم مضعفة بالإسكان لها ونقل الحركة إلى الفاء عنها.
فإذا كنت تختار فيما تحركت واو واحدة وظهرت في جمعه الإعلال صار القلب فيما ضعفت واوه بالقلب وبألا تصح في جمعه واجباً لا جائزاً وأما واو عجوز فأظهر أمراً في وجوب الإعلال من يقوم ومقام لأنها لاحظ لها في الحركة ولا تظهر أيضاً في التكسير إنما تقول: عجائز ولا يجوز عجاوز على كل حال.
وكذلك تقول: ما قام إلا زيداً أحدٌ فتوجب النصب إذا تقدم المستثنى إلا في لغة ضعيفة.
وذلك أنك قد كنت تجيز: ما قام أحد إلا زيداً فلما قدمت المستثنى لم تجد قبله ما تبدله منه فأوجبت من النصب له ما كان جائزاً فيه.
ومثله: فيما قائماً رجل.
وهذا معروف.
الثاني منهما وهو اعتزام أحد الجائزين.
وذلك قولهم: أجنة في الوجنة.
قال أبو حاتم: ولا يقولون: وجنة وإن كانت جائزة.
ومثله قراءة بعضهم: إن يدعون من دونه إلا أثناً وجمع وثن ولم يأت فيه التصحيح: وثن.
فأما أقتت ووقتت ووجوه وأجوه وأرقة وورقة ونحو ذلك فجميعه مسموع.
ومن ذلك قوله: وفوارسٍ كأوار ح ر النار أحلاس الذكور فذهب الكسائي فيه إلى أن أصله وآر وأنه فعال من وأرت النار إذا حفرت لها الإرة فخففت الهمزة فصارت لفظاً إلى ووار فهمزت الفاء البتة فصارت: أوار.
ولم يأت منهم على فأما قول الخليل في فعل من وأيت إذا خففته: أويٌ فقد رده أبو الحسن وأبو عثمان وما أبيا منه عندي إلا مأبياً.
وكذلك البرية فيمن أخذها من برأ الله الخلق - وعليه أكثر الناس - والنبي عند سيبويه ومن تبعه فيه والذرية فيمن أخذها من ذرأ الله الخلق.
وكذلك ترى وأرى ونرى ويرى في أكثر الأمر والخابية ونحو ذلك مما ألزم التخفيف.
ومنه ما ألزم البدل وهو النبي - عند سيبويه - وعيد لقولهم: أعياد وعييد.
ومن ذلك ما يبيحه القياس في نحو يضرب ويجلس ويدخل ويخرج: من اعتقاب الكسر والضم على كل واحدة من هذه العيون وأن يقال: يخرج ويخرج ويدخل ويدخل ويضرب ويضرب ويجلس ويجلس قياساً على ما اعتقبت على عينه الحركتان معاً نحو يعرش ويعرش ويشنق ويشنق ويخلق ويخلق وإن كان الكسر في عين مضارع فعل أولى به من يفعل لما قد ذكرناه في شرح تصريف أبي عثمان فإنهما على كل حال مسموعان أكثر السماع في عين مضارع فعل.
فاعرف ذلك ونحوه مذهباً للعرب فمهما ورد منه فتلقه عليه.
باب في إجراء اللازم مجرى غير اللازم وإجراء غير اللازم مجرى اللازم
الأول منهما كقوله: الحمد لله العلي الأجلل وقوله: تشكو الوجى من أظللٍ وأظلل وقوله: وإن رأيت الحجج الرواددا قواصرا بالعمر أو مواددا ونحو ذلك مما ظهر تضعيفه.
فهذا عندنا على إجراء اللازم مجرى غير اللازم من المنفصل نحو جعل لك وضرب بكر كما شبه غير اللازم من ذلك باللازم فادغم نحو ضر بكر وجعلك فهذا مشبه في اللفظ بشد ومد واستعد ونحوه مما لزم فلم يفارق.
ومن ذلك ما حكوه من قول بعضهم: عوى الكلب عوية.
وهذا عندي وإن كان لازماً فإنه أجرى مجرى بنائك من باب طويت فعلة وهو قولك: طوية كقولك: امرأة جوية ولوية من الجوى واللوى فإن خففت حركة العين فأسكنتها قلت: طوية وجوية ولوية فصححت العين ولم تعلها بالقلب والادغام لأن الحركة فيها منوية.
وعلى ذلك قالوا في فعلان من قويت: قويان فإن أسكنوا صححوا العين أيضاً فقالوا: قويان ولم يردوا اللام أيضاً وإن زالت الكسرة من قبلها لأنها مرادة في العين فكذلك قالوا: عوى الكلب عوية تشبيهًا بباب امرأة جوية ولوية وقويان هذا الذي نحن بصدده.
فإن قلت: فهلا قالوا أيضاً على قياس هذا: طويت الثوب طوية وشويت اللحم شوية رجع الجواب الذي تقدم في أول الكتاب: من أنه لو فعل ذلك لكان قياسه قياس ما ذكرنا وأنه ليست لعوى فيه مزية على طوى وشوى كما لم يكن لجاشم ولا قاثم مزية يجب لها العدل بهما إلى جشم وقثم على مالك وحاتم إذ لم يقولوا: ملك ولا حتم.
وعلى أن ترك الاستكثار مما فيه إعلال أو استثقال هو القياس.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود: فقلا له قولاً ليناً وذلك أنه أجرى حركة اللام ههنا - وإن كانت لازمة - مجراها إذا كانت غير لازمة في نحو قول الله تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ} و {قُمِ اللَّيْلَ} زيادتنا نعمان لا تنسينها خف الله فينا والكتاب الذي تتلو ويروى " تق الله فينا ".
ويروى:
تنسينها ا ت ق الله فينا ونحوه ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: وأطلس يهديه إلى الزاد أنفه أطاف بنا والليل داجي العساكر فقلت لعمروٍ صاحبي إذ رأيته ونحن على خوٍص دقاقٍ عواسر أي عوى الذئب فسر أنت.
فلم يحفل الراء فيرد العين التي كانت حذفت لالتقاء الساكنين فكذلك شبه ابن مسعود حركة اللام من قوله: فقلا له - وإن كانت لازمة - بالحركة لالتقاء الساكنين في " قل اللهم " و " قم الليل " وحركة الإطلاق الجارية مجرى حركة التقائهما في سر.
ومثله قول الضبي: في فتيةٍ كلما تجمعت ال بيداء لم يهلعوا ولم يخموا يريد: ولم يخيموا.
فلم يحفل بضمة الميم وأجراها مجرى غير اللازم فيما ذكرناه وغيره فلم يردد العين المحذوفة من لم يخم.
وإن شئت قلت في هذين: إنه اكتفى بالحركة من الحرف كما اكتفى الآخر بها منه في قوله: وقول الآخر:
بالذي تردان أي بالذي تريدان.
وسيأتي هذا في بابه.
الثاني منهما وهو إجراء غير اللازم مجرى اللازم وهو كثير.
من ذلك قول بعضهم في الأحمر إذا خففت همزته: لحمر حكاها أبو عثمان.
ومن قال: الحمر قال: حركة اللام غير لازمة إنما هي لتخفيف الهمزة والتحقيق لها جائز فيها.
ونحو ذلك قول الآخر: قد كنت تخفي حب سمراء حقبةً فبح لان منها بالذي أنت بائح فأسكن الحاء التي كانت متحركة لالتقاء الساكنين في بح الآن لما تحركت للتخفيف اللام.
وعليه قراءة من قرأ: {قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ} فأثبت واو قالوا لما تحركت لام لان.
والقراءة القوية قاللان بإقرار الواو على حذفها لأن الحركة عارضة للتخفيف.
وعلى القول الأول قول الآخر: حدبدبي بدبدبي منكم لان إن بني فزارة بن ذيبان قد طرقت ناقتهم بإنسان مشياً سبحان ربي الرحمن أسكن ميم منكم لما تحركت لام لان وقد كانت مضمومة عند التحقيق في قولك: منكم الآن فاعتد حركة التخفيف وإن لم تكن لازمة.
وينبغي أن تكون قراءة أبي عمرو:: { وأنه أهلك عادا لولى } على هذه اللغة وهي قولك مبتدئاً: لولى لأن الحركة على هذا في اللام أثبت منها على قول من قال: الحمر.
وإن كان حملها أيضاً على هذا جائزاً لأن الادغام وإن كان بابه أن يكون في المتحرك فقد أدغم أيضاً في الساكن فحرك في شد ومد وفرّ يا رجل وعض ونحو ذلك.
ومثله ما أنشده أبو زيد: ألا يا هند هند بني عميرٍ أرثٌ لان وصلك أم جديد ادغم تنوين رثّ في لام لان.
ومما نحن على سمته قول الله - عز وجل - {لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي} وأصله: لكن أنا فخففت الهمزة بحذفها وإلقاء حركتها على نون لكن فصارت لكننا فأجرى غير اللازم مجرى اللازم فاستثقل التقاء المثلين متحركين فأسكن الأول وادغم في الثاني فصار: لكنا كما ترى.
وقياس قراءة من قرأ: قاللان فحذف الواو ولم يحفل بحركة اللام أن يظهر النونين هنا لأن حركة الثانية غير لازمة فيقول: لكننا بالإظهار كما تقول في تخفيف حوأبة وجيئل: حوبة ومن ذلك قولهم في تخفيف رؤيا ونؤى: رويا ونوى فتصح الواو هنا وإن سكنت قبل الياء من قبل أن التقدير فيهما الهمز كما صحت في ضوٍ ونوٍ تخفيف ضوء ونوء لتقديرك الهمز وإرادتك إياه.
وكذلك أيضاً صح نحو شى وفىٍ في تخفيف شىء وفىء لذلك.
وسألت أبا علي - رحمه الله - فقلت: من أجرى غير اللازم مجرى اللازم فقال: لكنا كيف قياس قوله إذا خفف نحو حوءبة وجيئل أيقلب فيقول: حابة وجال أم يقيم على التصحيح فيقول حوبة وجيل فقال: القلب هنا لا سبيل إليه.
وأومأ إلى أنه أغلظ من الادغام فلا يقدم عليه.
فإن قيل فيما بعد: فقد قلبت العرب الحرف للتخفيف وذلك قول بعضهم ريا ورية في تخفيف رؤيا ورؤية وهذا واضح قيل: الفرق أنك لما صرت إلى لفظ رويا وروية ثم قلبت الواو إلى الياء فصار إلى ريا ورية إنما قلبت حرفا إلى آخر كأنه هو ألا ترى إلى قوة شبه الواو بالياء وبعدها عن الألف فكأنك لما قلبت مقيم على الحرف نفسه ولم تقلبه لأن الواو كأنها هي الياء نفسها وليست كذلك الألف لبعدها عنهما بالأحكام الكثيرة التي قد أحطنا بها علماً.
وهذا فرق.
وما يجري من كل واحد من الفريقين مجرى صاحبه كثير وفيما مضى من جملته كاف.
باب في إجراء المتصل مجرى المنفصل وإجراء المنفصل مجرى المتصل
فمن الأول قولهم: اقتتل القوم واشتتموا.
فهذا بيانه نحو من بيان شئت تلك وجعل لك إلا أنه أحسن من قوله: الحمد لله العلي الأجلل وهذا لأن إنما يظهر مثله ضرورة وإظهار نحو اقتتل واشتتم مستحسن وعن غير ضرورة.
وكذلك باب قولهم: هم يضربونني وهما يضربانني أجري - وإن كان متصلاً - مجرى يضربان نعم ويضربون نافعاً.
ووجه الشبه بينهما أن نون الإعراب هذه لا يلزم أن يكون بعدها نون ألا ترى أنك تقول: يضربان زيداً ويكرمونك ولا تلزم هي أيضاً نحو لم يضرباني.
ومن ادغم نحو هذا واحتج بأن المثلين في كلمة واحدة فقال: يضرباني وقال تحاجونا فإنه يدغم أيضاً نحو اقتتل فيقول: قتل.
ومنهم من يقول: قتل ومنهم من يقول: قتل.
ومنهم من يقول: اقتل فيثبت همزة الوصل مع حركة القاف لما كانت الحركة عارضة للنقل أو لالتقاء الساكنين وهذا مبين في فصل الادغام.
ومن ضد ذلك قولهم: ها الله ذا أجرى مجرى دابةٍ وشابةٍ.
وكذلك قراءة من قرأ { فلا تناجوا } و {حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا} ومنه - عندي - قول الراجز - فيما أنشده أبو زيد -: من أي يومي من الموت أفرّ أيوم لم يقدر أم يوم قدر كذا أنشده أبو زيد: لم يقدر بفتح الراء وقال: أراد النون الخفيفة فحذفها وحذف نون التوكيد وغيرها من علاماته جارٍ عندنا مجرى ادغام الملحق في أنه نقض الغرض إذ كان التوكيد من أماكن الإسهاب والإطناب والحذف من مظان الاختصار والإيجاز.
لكن القول فيه عندي أنه أراد: أيوم لم يقدر أم يوم قدر ثم خفف همزة أم فحذفها وألقى حركتها على راء يقدر فصار تقديره أيوم لم يقدرم ثم أشبع فتحة الراء فصار تقديره: أيوم لم يقدر ام فحرك الألف لالتقاء الساكنين فانقلبت همزة فصار تقديره أم واختار الفتحة إتباعاً لفتحة الراء.
ونحو من هذا التخفيف قولهم في المرأة والكمأة إذا خففت الهمزة: المراة والكماة.
وكنت ذاكرت الشيخ أبا علي - رحمه الله - بهذا منذ بضع عشرة سنة فقال: هذا إنما يجوز في المتصل.
قلت له: فأنت أبداً تكرر ذكر إجرائهم المنفصل مجرى المتصل فلم يرد شيئاً.
وقد ذكرت ومن أجراء المنفصل مجرى المتصل قوله: وقد بدا هنك من المئزر فشبه هنك بعضد فأسكنه كما يسكن نحو ذلك.
ومنه: فاليوم أشرب غير مستحقب كأنه شبه ر ب غ بعضد.
وكذلك ما أنشده أبو زيد: قالت سليمى اشتر لنا سويقاً وهو مشبه بقولهم في علم: علم لأن " ترل " بوزن علم.
وكذلك ما أنشده أيضاً من قول الراجز: فاحذر ولا تكتر كريا أعوجا لأن " ترك " بوزن علم.
وهذا الباب نحو من الذي قبله.
وفيه ما يحسن ويقاس وفيه مالا يحسن ولا يقاس.
ولكلٍّ وجه فاعرفه إلى ما يليه من نظيره.
في احتمال اللفظ الثقيل لضرورة التمثيل وذلك كقولهم في التمثيل من الفعل في حبنطى: فعنلى.
فيظهرون النون ساكنة قبل اللام.
وهذا شيء ليس موجوداً في شيء من كلامهم ألا ترى أن صاحب الكتاب قال: ليس في الكلام مثل قنرٍ وعنل.
وتقول في تمثيل عرند: فعنل وهو كالأول.
وكذلك مثال جحنفل: فعنلل ومثال عرنقصان: فعنللان.
وهذا لا بد أن يكون هو ونحوه مظهراً ولا يجوز ادغام النون في اللام في هذه الأماكن لأنه لو فعل ذلك لفسد الغرض.
وبطل المراد المعتمد ألا تراك لو ادغمت نحو هذا للزمك أن تقول في مثل عرندٍ: إنه فعل فكان إذاً لا فرق بينه وبين قمدًّ وعتلًّ وصمل.
وكذلك لو قلت في تمثيل جحنفل: إنه فعلل لالتبس ذلك بباب سفرجل وفرزدق وباب عدبس وهملع وعملس.
وكذلك لو ادغمت مثال حبنطى فقلت: فعلى لالتبس بباب صلخدى وجعلبى.
وذكرت ذرأ من هذا ليقوم وجه العذر فيه بإذن الله.
وبهذا تعلم أن التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد ألا تراك لو قيل لك: ابن من دخل مثل جحنفل لم يجز لأنك كنت تصير به إلى دخنلل فتظهر النون ساكنة قبل اللام وهذا غير موجود.
فدل أنك في التمثيل لست ببانٍ.
ولا جاعل ما تمثله من جملة كلام العرب كما تجعله منها إذا بنيته غير ممثل.
ولو كانت عادة هذه الصناعة أن يمثل فيها من الدخول كما مثل من الفعل لجاز أن تقول: وزن جحنفل من دخل الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية اعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معتد مراعىً مؤثر إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب: فأقواهن الدلالة اللفظية ثم تليها الصناعية ثم تليها المعنوية.
ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرض.
فمنه جميع الأفعال.
ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة.
ألا ترى إلى قام ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه ودلالة معناه على فاعله.
فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه.
وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنها وإن لم تكن لفظاً فإنها صورة يحملها اللفظ.
ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بها.
فلما كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة.
وأما المعنى فإنما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال وليست في حيز الضروريات ألا تراك حين تسمع ضرب قد عرفت حدثه وزمانه ثم تنظر فيما بعد فتقول: هذا فعل ولا بد له من فاعل فليت شعري من هو وما هو فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حاله من موضع آخر لا من مسموع ضرب ألا ترى أنه يصلح أن يكون فاعله كل مذكر يصح منه الفعل مجملاً غير مفصل.
فقولك: ضرب زيد وضرب عمرو وضرب جعفر ونحو ذلك شرع سواء وليس لضرب بأحد الفاعلين هؤلاء ولا غيرهم خصوص ليس له بصاحبه كما يخص بالضرب دون غيره من الأحداث وبالماضي دون غيره من الأبنية.
ولو كنت إنما تستفيد الفاعل من لفظ ضرب لا معناه للزمك إذا قلت: قام أن تختلف دلالتهما على الفاعل لاختلاف لفظيهما كما اختلفت دلالتهما على الحدث لاختلاف لفظيهما وليس الأمر في هذا كذلك بل دلالة ضرب على الفاعل كدلالة قام وقعد وأكل وشرب وانطلق واستخرج عليه لا فرق بين جميع ذلك.
فقد علمت أن دلالة المثال على الفاعل من جهة معناه لا من جهة لفظه ألا ترى أن كل واحد من هذه الأفعال وغيرها يحتاج إلى الفاعل حاجة واحدة وهو استقلاله له وانتسابه إليه وحدوثه عنه أو كونه بمنزلة الحادث عنه على ما هو مبينٌ في باب الفاعل.
وكان أبو علي يقوى قول أبي الحسن في نحو قولهم: إني لأمر بالرجل مثلك: إن اللام زائدة حتى كأنه قال: إني لأمر برجل مثلك لما لم يكن الرجل هنا مقصوداً معيناً على قول الخليل: إنه تراد اللام في المثل حتى كأنه قال: إني لأمر برجل المثل لك أو نحو ذلك قال: لأن الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة واعلم أن هذا القول من أبي علي غير مرضي عندي لما أذكره لك.
وذلك أنه جعل لفظ اللام دلالة على زيادتها وهذا محال وكيف يكون لفظ الشيء دلالة على زيادته وإنما جعلت الألفاظ أدلة على إثبات معانيها لا على سلبها وإنما الذي يدل على زيادة اللام هو كونه مبهماً لا مخصوصاً ألا ترى أنك لا تفصل بين معنيي قولك: إني لأمر بالرجل مثلك وإني لأمر برجل مثلم في كون كل واحد منهما منكوراً غير معروف ولا مومأ به إلى شيء بعينه فالدلالة أيضاً من هذا الوجه كما ترى معنوية كما أن إرادة الخليل اللام في مثلك إنما دعا إليها جريه صفة على شيء هو في اللفظ معرفة فالدلالتان إذاً كلتاهما معنويتان.
ومن ذلك قولهم للسلم: مرقاة وللدرجة مرقاة فنفس اللفظ يدل على الحدث الذي هو الرقىّ وكسر الميم يدل على أنها مما ينقل ويعتمل عليه وبه كالمطرقة والمئزر والمنجل وفتحة ميم مرقاة تدل على أنه مستقر في موضعه كالمنارة والمثابة ولو كانت المنارة مما يجوز كسر ميمها لوجب تصحيح عينها وأن تقول فيها: منورة لنه كانت تكون حينئذ منقوصة من مثال مفعال كمروحة ومسورة ومعول ومجول فنفس ر ق ى يفيد معنى الارتقاء وكسرة الميم وفتحتها تدلان على ما قدمناه: من معنى الثبات أو الانتقال.
وكذلك الضرب والقتل: نفس اللفظ يفيد الحدث فيهما ونفس الصيغة تفيد فيهما صلاحهما للأزمنة الثلاثة على ما نقوله في المصادر.
وكذلك اسم الفاعل - نحو قائم وقاعد - لفظه يفيد الحدث الذي هو القيام والقعود وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاحب الفعل.
وكذلك قطع وكسر فنفس اللفظ ها هنا يفيد معنى الحدث وصورته تفيد شيئين: أحدهما الماضي والآخر تكثير الفعل كما أن ضارب يفيد بلفظه الحدث وببنائه الماضي وكون الفعل من اثنين وبمعناه على أن له فاعلاً.
فتلك أربعة معانٍ.
فاعرف ذلك إلى ما يليه فإنه كثير لكن هذه طريقه.
باب في الاحتياط
اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مكنته واحتاطت له.
فمن ذلك التوكيد وهو على ضربين: أحدهما تكرير الأول بلفظه.
وهو نحو قولك: قام زيد قام زيد وضربت زيداً ضربت وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة والله أكبر الله أكبر وقال: إذا التياز ذو العضلات قلنا إليك إليك ضاق بها ذراعا وقال: وإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب وقال: إن قوماً منهم عمير وأشبا ه عميرٍ ومنهم السفاح لجديرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة: السلاح السلاح وقال: وقال: أبوك أبوك أربد غير شك أحلك في المخازى حيث حلا يجوز أن يكون من هذا تجعل أبوك الثاني منهما تكريراً للأول وأربد الخبر ويجوز أن يكون أبوك الثاني خبراً عن الأول أي أبوك الرجل المشهور بالدناءة والقلة: وقال: قم قائماً قم قائماً رأيت عبداً نائماً وأمة مراغماً وعشراء رائماً هذا رجل يدعو لابنه وهو صغير وقال: فأين إلى أين النجاء ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس وقالوا في قول امرىء القيس: نطعنهم سلكى ومخلوجةً كر كلامين على نابلٍ قولين: أحدهما ما نحن عليه أي تثنية كلامين على ذي النبل إذ قيل له: ارم ارم والآخر: كرك لامين وهما السهمان أي كما ترد السهمين على البراء للسهام إذا أخذتهما لتنظر إليهما ثم رميتهما إليه فوقعا مختلفين: هكذا أحدهما وهكذا الآخر.
وهذا الباب كثير جداً.
وهو في الجمل والآحاد جميعاً.
والثاني تكرير الأول بمعناه.
وهو على ضربين: أحدهما للإحاطة والعموم والآخر للتثبيت والتمكين.
الأول كقولنا: قام القوم كلهم ورأيتهم أجمعين - ويتبع ذلك من اكتع وأبضع وأبتع وأكتعين وأبضعين وأبتعين ما هو معروف - مررت بهما كليهما.
والثاني نحو قولك: قام زيد نفسه ورأيته نفسه.
ومن ذلك الاحتياط في التأنيث كقولهم: فرسة وعجوزة.
ومنه ناقة لأنهم لو اكتفوا بخلاف مذكرها لها - وهو جمل - لغنوا بذلك.
ومنه الاحتياط في إشباع معنى الصفة كقوله: والدهر بالإنسان دوارى أي دوار وقوله: غضف طواها الأمس كلابى أي كلاب وقوله: كان حداءً قراقرياً أي قراقراً.
حدثنا أبو علي قال: يقال خطيب مصقع وشاعر مرقع وحداء قراقر ثم أنشدنا وقد يؤكد بالصفة كما تؤكد هي نحو قولهم: أمس الدابر وأمس المدبر وقول الله - عز اسمه - {إِلـهَيْنِ اثْنَيْنِ} وقوله تعالى: {وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} وقوله سبحانه: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}.
ومنه قولهم: لم يقم زيد.
جاءوا فيه بلفظ المضارع وإن كان معناه المضى.
وذلك أن المضارع أسبق رتبة في النفس من الماضي ألا ترى أن أول أحوال الحوادث أن تكون معدومة ثم توجد فيما بعد.
فإذا نفى المضارع الذي هو الأصل فما ظنك بالماضي الذي هو الفرع.
وكذلك قولهم: إن قمت قمت فيجيء بلفظ الماضي والمعنى معنى المضارع.
وذلك أنه أراد الاحتياط للمعنى فجاء بمعنى المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه حتى كأن هذا قد وقع واستقر لا أنه متوقع مترقب.
وهذا تفسير أبي علي عن أبي بكر وما أحسنه !.
ومنه قوله: قالت بنو عامر خالوا بني أسدٍ يا بؤس للجهل ضراراً لأقوام أي يا بؤس الحرب فأقحم لام الإضافة تمكيناً واحتياطاً لمعنى الإضافة وكذلك قول الآخر: يا بؤس للحرب التي وضغت أراهط فاستراحوا أي يا بؤس الحرب إلا أن الجر في هذا ونحوه إنما هو اللام الداخلة عليه وإن كانت زائدة.
وذلك أن الحرف العامل وإن كان زائداً فإنه لا بد عامل الا ترى إلى قوله: بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فيهم غني مضر فالباء زائدة وهي مع ذا عاملة وكذلك قولهم: قد كان من مطر وقد كان من حديث فخل عنى فمن زائدة وهي جارّة ولا يجوز أن يكون الحرب من قوله: يا بؤس مجرورة بإضافة بؤس إليها واللام معلقة من قبل أن تعليق اسم المضاف والتأول له أسهل من تعليق حرف الجر والتأول له لقوة الاسم وضعف الحرف فأما قوله: لو كنت في خلقاء من رأس شاهقٍ وليس إلى منها النزول سبيل فإن هذا إنما هو فصل بحرف الجر لا تعليق.
فإن قلت: فما تقول في قوله: أني جزوا عامراً سوءاً بفعلهم أم كيف يجزونني السوءى من الحسن وجمعه بين أم وكيف فالقول أنهما ليسا لمعنى واحد.
وذلك أن أم هنا جردت لمعنى الترك والتحول وجردت من معنى الاستفهام وأفيد ذلك من كيف لا منها.
وقد دللنا على ذلك فيما مضى.
فإن قيل: فهلا وكدت إحداهما الأخرى كتوكيد اللام لمعنى الإضافة وياءي النسب لمعنى الصفة.
قيل: يمنع من ذلك أن كيف لما بنيت واقتصر بها على الاستفهام البتة جرت مجرى الحرف البتة وليس في الكلام اجتماع حرفين لمعنى واحد لأن في ذلك نقضاً لما اعتزم عليه من الاختصار في استعمال الحروف.
وليس كذلك يا بؤس للحرب وأحمرى وأشقرى.
وذلك أن هنا إنما انضم الحرف إلى الاسم فهما مختلفان فجاز أن يترادفا في موضعهما لاختلاف جنسيهما.
فإن قلت: فقد قال: وما إن طبنا جبنٌ ولكن وقال: ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم فجمع بين ما وإن وكلاهما لمعنى النفي وهما - كما ترى - حرفان.
قيل: ليست إن من قوله: ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم بحرف نفي فيلزم ما رمت إلزامه وإنما هي حرف يؤكد به بمنزلة ما ولا والباء ومن وغير ذلك ألا ترى إلى قولهم في الاستثبات عن زيد من نحو قولك جاءني زيد: أزيد إنيه وفي باب رأيت زيداً: أزيدا إنيه فكما زيدت إن هنا توكيداً مع غير ما فكذلك زيدت مع ما توكيداً.
وأما قوله: طعامهم لئن أكلوا معدٌ وما إن لا تحاك لهم ثياب فإن ما وحدها ايضاً للنفي وإن ولا جميعاً للتوكيد ولا ينكر اجتماع حرفين للتوكيد لجملة الكلام.
وذلك أنهم قد وكدوا بأكثر من الحرف الواحد في غير هذا.
وذلك قولهم: لتقومن ولتقعدن.
فاللام والنون جميعاً للتوكيد.
وكذلك قول الله - جل وعز - {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا} فما والنون جميعاً مؤكدتان.
فإما اجتماع الحرفين في قوله: وما إن لا تحاك لهم ثياب وافتراقهما في لتفعلن وإنا ترين فلأنهم أشعروا لجمعهم إياهما في موضع واحد بقوة عنايتهم بتوكيد ما هم عليه لأنهم كما جمعوا بين حرفين لمعنى واحد كذلك أيضاً جعلوا اجتماعهما وتجاورهما تنويهاً وعلماً على قوة العناية بالحال.
وكأنهم حذوا ذلك على الشائع الذائع عنهم من احتمال تكرير الأسماء المؤكد بها في نحو أجمع وأكتع وأبضع وأبتع وما يجري مجراه.
فلما شاع ذلك وتنوزع في غالب الأمر في الأسماء لم يخلو الحروف من نحوٍ منه إيذاناً بما هم عليه مما اعتزموه ووكدوه.
وعليه أيضاً ما جاء عنهم من تكرير الفعل فيه نحو قولهم: اضرب اضرب وقم قم وارم وارم وقوله: أتاك أتاك اللاحقوك احبس احبس فاعرف ذلك فرقاً بين توكيد المعنى الواحد - نحو الأمر والنهي والإضافة - وتوكيد معنى الجملة في امتناع اجتماع حرفين لمعنى واحد وجواز اجتماع حرفين لمعنى جملة الكلام في لتقربن وإما ترين ألا ترى أنك إذا قلت: هل تقومن فهل وحدها للاستفهام وأما النون فلتوكيد جملة الكلام.
يدل على أنها لذلك لا لتوكيد معنى الاستفهام وحده وجودك إياها في الأمر نحو اضربن زيداً وفي النهي في لا تضربن زيداً والخبر في لتضربن زيداً والنفي في نحو قلَّما تقومن.
فشياعها في جميع هذه المواضع أدل دليل على ما نعتقده: من كونها توكيداً لجملة القول لا لمعنى مفرد منه مخصوص لأنها لو كانت موضوعة له وحده لخصت به ولم تشع في غيره كغيرها من الحروف.
فإن قلت: يكون من الحروف ما يصلح من المعاني لأكثر من الواحد نحو: من فإنها تكون تبغيضاً وابتداء ولا تكون نفياً ونهياً وتوكيداً وإن فإنها تكون شرطاً ونفياً وتوكيداً.
قيل: هذا إلزام يسقطه تأمله.
وذلك أن من ولا وإن ونحو ذلك لم يقتصر بها على معنى واحد لأنها حروف وقعت مشتركة كما وقعت الأسماء مشتركة نحو الصدى فإنه ما يعارض الصوت وهو بدن الميت وهو طائر يخرج فيما يدعون من رأس القتيل إذا لم يؤخذ بثأره.
وهو أيضاً الرجل الجيد الرعية للمال في قولهم: هو صدى مالٍ وخائل مالٍ وخال مال وسر سور مال وإزاء مالٍ ونحو ذلك من الشوى ونحوه مما اتفق لفظه واختلف معناه.
وكما وقعت الأفعال مشتركة نحو وجدت في الحزن ووجدت في الغضب ووجدت في الغنى ووجدت في الضالة ووجدت بمعنى علمت ونحو ذلك فكذلك جاء نحو هذا في الحروف.
وليست كذلك النون لأنها وضعت لتوكيد ما قد أخذ مأخذه واستقر من الكلام بمعانيه المفادة من أسمائه وأفعاله وحروفه.
فليست لتوكيد شيء مخصوص من ذلك دون غيره ألا تراها للشيء وضده نحو اذهبن ولا تذهبن والإثبات في لتقومن والنفي في قلما تقومن.
فهي إذاً لمعنى واحد وهو التوكيد لا غير.
ومن الاحتياط إعادة العامل في العطف والبدل.
فالعطف نحو مررت بزيد وبعمرو فهذا أوكد معنى من مررت بزيد وعمرو.
والبدل كقولك: مررت بقومك بأكثرهم فهذا أوكد معنى من قولك: مررت بقومك أكثرهم.
باب في فك الصيغ
اعلم أن هذا موضع من العربية لطيف ومغفول عنه وغير مأبوه له.
وفيه من لطف االمأخذ وحسن الصنعة ما أذكره لتعجب منه وتأنق له.
وذلك أن العرب إذا حذفت من الكلمة حرفاً إما ضرورة أو إيثاراً فإنها تصور تلك الكلمة بعد الحذف منها تصويراً تقبله أمثله كلامها ولا تعافه وتمجه لخروجه عنها سواء كان ذلك الحرف المحذوف أصلاً أم زائداً.
فإن كان ما يبقى بعد ذلك الحرف مثالاً تقبله مثلهم أقروه عليه.
وإن نافرها وخالف ما عليها أوضاع كلمتها نقض عن تلك الصورة وأصير إلى احتذاء رسومها.
فمن ذلك أن تعتزم تحقير نحو منطلق أو تكسيره فلا بد من حذف نونه.
فإذا أنت حذفتها بقي لفظه بعد حذفها: مطلق ومثاله مفعل.
وهذا وزن ليس في كلامهم فلا بد إذاً من نقله إلى أمثلتهم.
ويجب حينئذ أن ينقل في التقدير إلى أقرب المثل منه ليقرب المأخذ ويقل التعسف.
فينبغي أن تقدره قد صار بعد حذفه إلى مطلق لأنه أقرب إلى مطلق من غيره ثم حينئذ من بعد تحقره فتقول: مطيلق وتكسره فتقول: مطالق كما تقول في تحقير مكرم وتكسيره: مكيرم ومكارم.
فهذا باب قد استقر ووضح فلتغن به عن إطالة القول بإعادة مثله.
وسنذكر العلة التي لها ومن أجلها وجب عندنا اعتقاد هذا فيه بإذن الله.
فإن كان حذف ما حذف من الكلمة يبقي منها بعده مثالاً مقبولاً لم يكن لك بد في الاعتزام عليه وإقراره على صورته تلك البتة.
وذلك كقولك في تحقير حارث على الترخيم: حريث.
فهذا لما حذفت ألفه بقي من بعد على حرث فلم يعرض له بتغيير لأنه كنمر وسبط وحذر.
فمن مسائل هذا الباب أن تحقر جحنفلاً أو تكسره فلا بد من حذف نونه فيبقى بعد: جحفلٌ فلا بد من إسكان عينه إلى أن يصير: جحفل.
ثم بعد ما تقول: جحيفل وجحافل.
وإن شئت لم تغير واحتججت بما جاء عنهم من قولهم في عرنتن: عرتن.
فهذا وجه.
ومنها تحقير سفرجل.
فلا بد من حذف لامه فيبقى: سفرج وليس من أمثلتهم فتنقله إلى أقرب ما يجاوره وهو سفرج كجعفر فتقول: سفيرج.
وكذلك إن استكرهته على التكسير فقلت: سفارج.
فإن كسرت حبنطىً أو حقرته بحذف نونه بقي معك: حبطىً.
وهذا مثال لا يكون في الكلام وألفه للإلحاق فلا بد أن تصيره إلى حبطى ليكون كأرطى.
ثم تقول: حبيطٍ وحباطٍ كأريطٍ وأراطٍ.
فإن حذفت ألفه بقي حبنط وهذا مثال غير معروف لأنه ليس في الكلام فعنل فتنقله أيضاً إلى حبنط ثم تقول: حبينط وحبانط.
فإن قلت: ولا في الكلام أيضاً فعنل قيل: هو وإن لم يأت اسماً فقد أتى فعلاً وهو قلنسته فهذا فعنلته.
وتقول في تحقير جردحلٍ: جريدح.
وكذلك إن استكرهته على التكسير فقلت: جرادح وذلك أنك لما حذفت لامه بقي: جردح وهذا مثال معروف كدرهم وهجرع فلم يعرض للبقية بعد حذف الآخر.
فإن حقرت أو كسرت مستخرج حذفت السين والتاء فبقي: مخرج فلم تغيره فتقول: مخيرج ومخارج.
فإن سميت رجلاً دراهم ثم حقرته حذفت الألف فبقي: درهم فأقررته على صورته ولم تغيره لأنه مثال قد جاء عنهم وذلك قولهم: جندل وذلذل وخنثر.
فتقول: دريهم.
ولا تكسره لأنك تعود إلى اللفظ الذي انصرفت عنه.
فإن حقرت نحو عذافر فحذفت ألفه لم تعرض لبقيته لأنه يبرد في يدك حينئذ عذفر وهذا قد جاء عنهم نحو علبط وخزخز وعجلط وعكلطٍ ثم تقول: عذيفر وفي تكسيره: عذافر.
فإن حقرت نحو قنفخرٍ حذفت نونه ولم تعرض لبقيته لأنه يبقى: قفخر.
وهذا نظير دمثرٍ وحبجرٍ فتقول: قفيخر وقفاخر.
فإن حقرت نحو عوارض ودواسرٍ حذفت الألف فبقي عورض ودوسر وهذا مثال ليس من كلامهم لأنه فوعل.
إلا أنك مع ذلك لا تغيره لأنه هو فواعل وإنما حذفت الألف وهي في تقدير الثبات.
ودليل ذلك توالي حركاته كتوالي حركات علبطٍ وبابه فتقول في تحقيره وتكسيره: عُويرض وعَوارض.
ومثله هُداهد وهَداهد وقُناقن وقَناقن وجُوالق وجَوالق.
فإن حقرت نحو عنتريسٍ أو كسرته حذفت نونه فبقي في التقدير عتريس.
وليس في الكلام شيء على فعليل فيجب أن تعدله إلى أقرب الأشياء منه فتصير إلى فعليل: عتريسٍ فتقول: عتيريس وعتاريس.
فإن حقرت خنفقيقاً حذفت القاف الأخيرة فيبقى: خنفقي وهذا فنعلي وهو مثال غير معهود فتحذف الياء فيبقى خنفق: فنعل كعنبس وعنسل فتقول فيه: خنيفق وخنافق.
وعليه قول الراجز: بني عقيل ماذه الخنافق وليس عنتريس كخنفقيق لأنه رباعي فلا بد من حذف نونه وخنفقيق ثلاثي فإحدى قافية زائدة فلذلك حذفت الثانية وفيه شاهد لقول يونس في أن الثاني من المكرر هو الزائد.
والذي يدل على أن العرب إذ حذفت من الكلمة حرفاً راعت حال ما بقي منه فإن كان مما تقبله أمثلتهم أقروه على صورته وإن خالف ذلك مالوا به إلى نحو صورهم قول الشماخ: حذاها من الصيداء نعلاً طراقها حوامي الكراع المؤيدات العشاوز ووجه الدلالة من ذلك أنه تكسير عَشَوزَن فحذف النون لشبهها بالزائد كما حذفت الهمزة في تحقير إسماعيل وإبراهيم لشبهها بالزائد في قولهم: بُريهيم وسُميعيل وإن كانت عندنا أصلاً.
فلما حذف النون بقي معه عَشَوز وهذا مثال فَعَول وليس من صور أبنيتهم فعدله إلى عَشوَز وهذا مثال فَعول ليلحق بجدول وقَسور ثم كسره فقال: عشاوِز.
والدليل على أنه قد نقله من عَشَوز إلى عَشوز أنه لو كان كسره وهو على ما كان عليه من سكون واوه دون أنت يكون قد حركها لوجب عليه همزها وأن يقال: عشائز لسكون الواو في الواحد كسكونها في عجوز ونحوها.
فأما انفتاح ما قبلها في عَشَوزٍ فلا يمنعها الإعلال.
وذلك أن سبب همزها في التكسير إنما هو سكونها في الواحد لا غير.
فأما اتباعها ما قبلها وغير اتباعها إياه فليس مما يتعلق عليه حال وجوب الهمز أو تركه.
فإذا ثبت بهذه المسئلة حال هذا الحرف قياساً وسماعاً جعلته أصلاً في جميع ما يعرض له شيء من هذا التحريف.
ويدل عليه أيضاً قولهم في تحقير ألنددٍ أليد ألا ترى أنه لما حذف النون بقي معه ألدد وهذا مثال منكور فلما نبا عنه أماله إلى أقرب الأمثلة منه وهو أفعَل فصار ألدد فلما أفضى إلى ذلك ادغمه فصار ألد لأنه جرى حينئذ مجرى ألد الذي هو مذكر لداء إذ كان صفة وعلى أَفعل فانجذب حينئذ إلى باب أصم من صماء وأيل من يلاء قال: وكوني على الواشين لداء شغبةً كما أنا للواشي ألد شغوب فلذلك قالوا في تحقيره: أليد فادغموه ومنعوه الصرف.
وفي هذا بيان ما نحن عليه.
فأما قول سيببويه في نحو سفيرج وسفارج: إنه إنما حذف آخره لأن مثال التحقير والتكسير انتهى دونه فوجه آخر من الحجاج.
والذي قلناه نحن شاهده العشاوز وأُليد.
ومن فك الصيغة أن تريد البناء من أصلٍ ذي زيادة فتلقيها عنه ثم ترتجل البناء منه مجرداً منها.
وذلك كأن تبني من ساعدٍ أو كاهل مثل جعفر أو غيره من الأمثلة فتفك عنه زائده وهو الألف فيبقى ك ه ل و س ع د لا عليك على أي صورة بقي بعد حذف زائده - لأنه إنما غرضك البناء من هذه المادة مرتبة من تقديم حروفها وتأخيرها على هذا الوضع - أفَعلا كانت أم فُعلا أم فِعلا أم غير ذلك لأنه على أيها بقي فالبناء منه سَعدَد وكَهلَل.
وكذلك إن أردت البناء من منصور مثل قَمَحدُوة قلت: نَصرُّوة.
وذلك أنك لما أردت ذلك حذفت ميمه وواوه فبقي معك ن ص ر ولا عليك على أي مثال بقي على ما مضى.
ومن ذلك جميع ما كسرته العرب على حذف زائده كقولهم في جمع كَروان: كِروان.
وذلك أنك لما حذفت ألفه ونونه بقي معك كَرَو فقلبت واوه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها طرفاً فصارت كرا ثم كسرت كرا هذا على كِروان كشبث وشِبثان وخرَب وخربان.
وعليه قولهم في المثل: أطرق كرا إنما هو عندنا ترخيم كَروان على قولهم: يا حار.
وأنشدنا لذي الرمة: من آل أبي موسى ترى الناس حوله كأنهم الكِروان أبصرن بازيا ومنه قول الله سبحانه: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ} وهو عند سيبويه تكسير شدة على حذف زائدته.
وذلك أنه لما حذف التاء بقي الاسم على شد ثم كسره على أشد فصار كذئب وأذؤب وقطع وأقطع.
ونظير شدة وأشد قولهم: نعمة وأنعم وقال أبو عبيدة: هو جمع أشد على حذف الزيادة.
قال: وربما استكرهوا على ذلك في الشعر وأنشد بيت عنترة: عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظلم ألا تراه لما حذف همزة أشد بقي معه شد كما ترى فكسره على أشد فصار كضَب وأضب وصَك وأصُك.
ومن فك الصيغة - إلا أن ذلك إلى الزيادة لا إلى النقص - ما حكاه الفراء من قولهم في جمع أتون: أتاتين.
فهذا كأنه زاد على عينه عيناً أخرى فصار من فَعُول مخفف العين إلى فعوُّل مشددها فتصوره حينئذ على أتون فقال فيه: أتاتين كسفّود وسفافيد وكلّوب وكلاليب.
وكذلك قولهم في تحقير رجل: رويجل فهذا ليس بتحقير رجل لكنه نقله من فَعُل إلى فاعل فصار إلى راجل ثم حينئذ قال في تحقيره: رويجل.
وعليه عندي قولهم في جمع دانق: دوانيق.
وذلك أنه زاد على فتحة عينه ألفاً فصار دأناق ثم كسره على دوانيق كساباط وسوابيط.
ولا يحسن أن يكون زاد حرف اللين على المكسور العين منهما لأنه كان يصير حينئذ إلى دانيق وهذا مثال معدوم عندهم ألا ترى أنه ليس في كلامهم فاعيل.
ولك في دانق لغتان: دانَق ودانِق كخاتَم وخاتِم وطابَق وطابِق.
وإن شئت قلت: لما كسره فصار إلى دوانق أشبع الكسرة فصار: دوانيق كالصياريف والمطافيل وهذا التغيير المتوهم كثير.
وعليه باب جميع ما غيرته الصنعة عن حاله ونقلته من صورة إلى صورة ألا تراك أنك لما أردت الإضافة إلى عدي حذفت ياءه الزائدة بقي معك عديٌ فأبدلت من الكسرة فتحة فصار إلى عدَيٍ ثم أبدلت من يائه ألفاً فصار إلى عَداً ثم وقعت ياء الإضافة من بعد فصار التقدير به إلى عداي ثم احتجت إلى حركة الألف التي هي لام لينكسر ما قبل ياء الإضافة فقلبتها واواً فقلت: عَدَوي.
فالواو الآن في عَدَوِي إنما هي بدل من ألف عداي وتلك الألف بدل من ياء عدي وتلك الياء بدل واو عدوت على ما قدمنا كمن حفظ المراتب فاعرف ذلك.
ومن فك الصيغة قوله: قد دنا الفصح فالولائد ينظم ن سراعاً أكلة المرجان فهذا جمع إكليل فلما حذفت الهمزة وبقيت الكاف ساكنة فتحت فصار إلى كليل ليكون كدليل ونحوه فعليه جاء أكلة كدليل وأدلة.
باب في كمية الحركات
أما ما في أيدي الناس في ظاهر الأمر فثلاث.
وهي الضمة والكسرة والفتحة.
ومحصولها على الحقيقة ست.
وذلك أن بين كل حركتين حركة.
فالتي بين الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل الألف الممالة نحو فتحة عين عالم وكاف كاتب.
فهذه حركة بين الفتحة والكسرة كما أن الألف التي بعدها بين الألف والياء والتي بين الفتحة والضمة هي التي قبل ألف التفخيم نحو فتحة لام الصلاة والزكاة والحياة.
وكذلك ألف قام وعاد.
والتي بين الكسرة والضمة ككسرة قاف قيل وسين سير فهذه الكسرة المشمة ضماً.
ومثلها الضمة المشمة كسراً كضمة قاف المنقر وضمة عين مذعور وباء ابن بور فهذه ضمة أشربت كسراً كما أنها في قيل وسير كسرة أشربت ضماً.
فهما لذلك كالصوت الواحد لكن ليس في كلامهم ضمة مشربة فتحة ولا كسرة مشربة فتحة.
فاعرف ذلك.
ويدل على أن هذه الحركات معتدات اعتداد سيبويه بألف الإمالة وألف التفخيم حرفين غير الألف المفتوح ما قبلها.
باب في مطل الحركات
وإذا فعلت العرب ذلك أنشأت عن الحركة الحرف من جنسها.
فتنشئ بعد الفتحة الألف وبعد الكسرة الياء وبعد الضمة الواو.
فالألف المنشأة عن إشباع الفتحة ما أنشدناه أبو علي لابن هرمة يرثي ابنه: من قوله: فأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال بمنتزاح أراد: بمنتزح: مفتعَل من النازح.
وأنشدنا أيضاً لعنترة: ينباع من ذفرى غضوبٍ جسرة وقال: أراد ينبع فأشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفاً.
وقال الأصمعي: يقال انباع الشجاع ينباع انبياعاً إذا انخرط بين الصفين ماضياً وأنشد فيه: يطرق حلماً وأناةً معاً ثمت ينباع انبياع الشجاع فهذا انفعل ينفعل انفعالاً والألف فيه عين.
وينبغي أن تكون عينه واواً لأنها أقرب معنى من الياء هنا.
نعم وقد يمكن عندي أن تكون هذه لغة تولدت.
وذلك أنه لما سمع ينباع أشبه في اللفظ ينفعل فجاءوا منه بماض ومصدر كما ذهب أبو بكر فيما حكاه أبو زيد من قولهم: ضفن الرجل يضفن إذا جاء ضيفاً مع الضيف.
وذلك أنه لما سمعهم يقولون: ضيفنٌ وكانت فيعل أكثر في الكلام من فعلن توهمه فيعلا فاشتق الفعل منه بعد أن سبق إلى وهمه هذا فيه فقال: ضفن يضفن.
فلو سئلت عن مثال ضفن يضفن على هذا القول لقلت إذا مثلته على لفظه: فلن يفلن لأن العين قد حذفت.
ولهذا موضع نذكره فيه مع بقية أغلاط العرب.
ومن مطل الفتحة عندنا قول الهذلي: بينا تعنقه الكماة وروغه يوما أتيح له جرىء سلفع أي بين أوقات تعنقه ثم أشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفا.
وحدثنا أبو على أن أحمد بن يحيى حكى: خذه من حيث وليسا قال: وهو إشباع ليس.
وذهب إلى مثل ذلك في قولهم آمين وقال: هو إشباع فتحة الهمزة من أمين.
فأما قول أبي العباس: إن آمين بمزلة عاصين فإنما يريد به أن الميم.
خفيفة كعين عاصين.
وكيف يجوز أن يريد به حقيقة الجمع وقد حكى عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: آمين: اسم من أسماء الله عز وجل.
فأين بك من أعتقاد معنى الجمع من هذا التفسير تعالى الله علوا كبيرا.
وحكى الفرّاء عنهم: أكلت لحما شاةٍ لحم شاة فمطل الفتحة فأنشأ عنها ألفا.
ومن إشباع الكسرة ومطلها ما جاء عنهم من الصياريف والمطافيل والجلاعيد.
فأما ياء مطاليق ومطيليق فعوض من النون المحذوفة وليست مطلا.
قال أبوالنجم: منها المطافيل وغير المطفل وأجود من ذلك قول الهذلي: جنى النحل في ألبان عوذٍ مطافل وكذلك قول الآخر: .
الخضر الجلاعيد وإنما هي الجلاعيد جمع جلعد وهو الشديد.
ومن مطل الضمة قوله - فيما أنشدناه وغيره -: وأنني حيث ما يشرى الهوى بصرى من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور يشرى: يحرك ويقلق.
ورواه لنا يسرى.
وقول الآخر: ممكورة جم العظام غطبول كأن في أنيابها القرنفول فهذه هي الطريق.
فما جاء منها قسه عليها.
باب في مطل الحروف
والحروف الممطولة هي الحروف الثلاثة اللينة المصوتة.
وهي الألف والياء والواو.
اعلم أن هذه الحروف أين وقعت وكيف وجدت بعد أن تكون سواكن يتبعن بعضهن غير مدغمات ففيها امتداد ولين نحو قام وسير به وحوتٍ وكوز وكتاب وسعيد وعجوز.
إلا أن الأماكن التي يطول فيها صوتها وتتمكن مدتها ثلاثة.
وهي أن تقع بعدها - وهي سواكن توابع لما هو منهن وهو الحركات من جنسهن - الهمزة أو الحرف المشدد أو أن يوقف عليها عند التذكر.
فالهمزة نحو كساء ورداء و خطيئة ورزيئة ومقروءة ومخبوءة.
وإنما تمكن المد فيهن مع الهمز أن الهمزة حرف نأى نشؤه وتراخى مخرجه فإذا أنت نطقت بهذه الأحرف المصوتة قبله ثم تماديت بهن نحوه طلن وشعن في الصوت فوفين له وزدن في بيانه و مكانه وليس كذلك إذا وقع بعدهن غيرها وغير المشدد ألا تراك إذا قلت: كتاب وحساب وسعيد وعمود وضروب وركوب لم تجدهن لدنات ولا ناعمات ولا وافيات مستطيلات كما تجدهن كذلك إذا تلاهن وأما سبب نعمتهن ووفائهن وتماديهن إذا وقع المشدد بعدهن فلأنهن - كما ترى - سواكن وأول المثلين مع التشديد ساكن فيجفو عليهم أن يتلقى الساكنان حشوا في كلامهم فحينئذ ما ينهضون بالألف بقوة الاعتماد عليها فيجعلون طولها ووفاء الصوت بها عوضاً مما كان يجب لالتقاء الساكنين: من تحريكها إذا لم يجدوا عليه تطرقاً ولا بالاستراحة إليه تعلقاً.
وذلك نحو شابة ودابة وهذا قضيب بكر في قضيب بكر وقد تمود الثوب وقد قوص بما عليه.
وإذا كان كذلك فكلما رسخ الحرف في المد كان حينئذ محفوظاً بتمامه وتمادى الصوت به وذلك الألف ثم الياء ثم الواو.
فشابة إذاً أوفى صوتاً وأنعم جرسا من أختيها وقضيب بكر أنعم وأتم من قوص به.
وتمود ثوبه لبعد الواو من أعرق الثلاث في المد - وهي الألف - وقرب الياء إليها.
نعم وربما لم يكتف من تقوى لغته ويتعالى تمكينه وجهارته بما تجشمه من مد الألف في هذا الموضع دون ان يطغى به طبعه ويتخطى به اعتماده ووطؤه إلى أن يبدل من هذه الألف همزة فيحملها الحركة التي كان كلفا بها ومصانعاً بطول المدة عنها فيقول: شأبة ودأبة.
وسنأتي بنحو هذا في بابه قال كثير.
إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت وقال: وهذا الهمز الذي تراه أمر يخص الألف دون أختيها.
وعلته في اختصاصه بها دونهما أن همزها في بعض الأحوال إنما هو لكثرة ورودها ساكنة بعدها الحرف المدغم فتحاملوا وحملوا أنفسهم على قلبها همزة تطرقاً إلى الحركة وتطاولا إليها إذ لم يجدوا إلى تحريكها هي سبيلاً لا في هذا الموضع ولا في غيره.
وليست كذلك أختاها لأنهما وإن سكنتا في نحو هذا قضيب بكر وتمود الثوب فإنهما قد تحركان كثيراً في غير هذا الموضع.
فصار تحركتهما في غير هذا الموضع عوضاً من سكونهما فيه.
فاعرف ذلك فرقاً.
وقد أجروا الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما مجرى التابعتين لما هو منهما.
وذلك نحو قولهم: هذا جيب بكر أي جيب بكر وثوب بكر أي ثوب بكر.
وذلك أن الفتحة وإن كانت مخالفة الجنس للياء والواو فإن فيها سرا له ومن أجله جاز أن تمتد الياء والواو بعدها في نحو ما رأينا.
وذلك أن أصل المد وأقواه وأعلاه وأنعمه وأنداه إنما هو للألف.
وإنما الياء والواو في ذلك محمولان عليها وملحقان في الحكم بها والفتحة بعض الألف فكأنها إذا قدمت قبلهما في نحو بيت وسوط إنما قدمت الألف إذ كانت الفتحة بعضها فإذا جاءتا بعد الفتحة جاءتا في موضع قد سبقتهما إليه الفتحة التي هي ألف صغيرة فكان ذلك سبباً للأنس بالمد لا سيما وهما بعد الفتحة - لسكونهما - أختا الألف وقويتا الشبه بها فصار ثوب وشيخ نحواً من وأما مدها عند التذكر فنحو قولك: أخواك ضربا إذا كنت متذكرا للمفعول أو الظرف أو نحو ذلك أي ضربا زيدا ونحوه.
وكذلك تمطل الواو إذا تذكرت في نحو ضربوا إذا كنت تتذكر المفعول أو الظرف أو نحو ذلك: أي ضربوا زيدا أو ضربوا يوم الجمعة أو ضربوا قياما فتتذكر الحال.
وكذلك الياء في نحو اضربي أي اضربي زيدا ونحوه.
وإنما مطلت ومدت هذه الأحرف في الوقف وعند التذكر من قبل أنك لو وقفت عليها غير ممطولة ولا ممكنة المدة.
فقلت: ضربا وضربوا واضربي وما كانت هذه حاله وانت مع ذلك متذكر لم توجد في لفظك دليلا على أنك متذكر شيئاً ولأوهمت كل الإيهام أنك قد أتممت كلامك ولم يبق من بعده مطلوب متوقع لك لكنك لما وقفت ومطلت الحرف علم بذلك أنك متطاول إلى كلام تالٍ للأول منوطٍ به معقود ما قبله على تضمنه وخلطه بجملته.
ووجه الدلالة من ذلك أن حروف اللين هذه الثلاثة إذا وقف عليهن ضعفن وتضاءلن ولم يف مدهن وإذا وقع بين الحرفين تمكن واعترض الصدى معهن.
ولذلك قال أبو الحسن: إن الألف إذا وقعت بين الحرفين كان لها صدى.
ويدل ذلك على أن العرب لما أرادت مطلهن للندبة وإطالة الصوت بهن في الوقف وعلمت أن السكوت عليهن ينتقصهن ولا يفي بهن أتبعتهن الهاء في الوقف توفية لهن وتطاولا إلى إطالتهن.
وذلك قولك: وازيداه واجعفراه.
ولابد من الهاء في الوقف فإن وصلت أسقطتها وقام التابع غيرها في إطالة الصوت مقامها.
وذلك قولك: وازيدا واعمراه.
وكذلك أختاها.
وذلك قولهم: وانقطاع ظهرهيه وواغلامكيه وواغلامهوه وواغلامهموه.
وتقول في الوصل: واغلامهمو لقد كان كريما! وانقطاع ظهرهى من هذا الأمر! والمعنى الجامع بين التذكر والندبة قوة الحاجة إلى إطالة الصوت في الموضعين.
فلما كانت هذه حال هذه الأحرف وكنت عند التذكر كالناطق بالحرف المستذكر صار كأنه هو ملفوظ به.
فتمت هذه الأحرف وإن وقعن أطرافا كما يتممن إذا وقعن حشوا لا أواخر.
فاعرف ذلك.
فهذه حال الأحرف الممطولة.
وكذلك الحركات عند التذكر يمطلن حتى يفين حروفا.
فإذا صرنها جرين مجرى الحروف المبتدأة توام فيمطلن أيضاً حينئذ كما تمطل الحروف.
وذلك قولهم عند التذكر مع الفتحة في قمت: قمتا أي قمت يوم الجمعة ونحو ذلك ومع الكسرة: أنتى أي أنت عاقلة ونحو ذلك ومع الضمة: قمتو في قمت إلى زيد ونحو ذلك.
فإن كان الحرف الموقوف عليه ساكنا فعل ضربين: صحيح ومعتل.
فالصحيح في نحو هذا يكسر لأنه لا يجرى الصوت في الساكن فإذا حرك انبعث الصوت في الحركة ثم انتهى إلى الحرف ثم أشبعت ذلك الحرف ومطلته.
وذلك قولك في نحو قد - وأنت تريد قد قام ونحوه إلا أنك تشك أو تتلوم لرأي تراه من ترك المبادرة بما بعد ذلك -: قدى وفي من: مني وفي هل: هلي وفي نعم: نعمي أي نعم قد كان أو نعم هو هو أو نحوه مما تستذكر أو تراخي بذكره.
وعليه تقول في التذكر إذا وقفت على لام التعريف: إلى وأنت تريد: الغلام أو الخليل أو نحو ذلك.
وإنما كانت حركة هذا ونحوه الكسرة دون أختيها من قبل أنه ساكن قد احتيج إلى حركته فجرت حركته إذاً مجرى حركة التقاء الساكنين في نحو " قل اللهم " و " قم الليل " وعليه أطلق المجزوم والموقوف في القوافي المطلقة إلى الكسر نحو قوله: وأنك مهما تأمرى القلب يفعل وقوله: لما تزل برحالنا وكأن قد ونحو مما نحن عليه حكاية الكتاب: هذا سيفنى وهو يريد: سيف من أمره كذا أو من حديثه كذا.
فلما أراد الوصل أثبت التنوين ولما كان ساكنا صحيحا لم يجر الصوت فيه فلما لم يجر فيه حرّكة بالكسر - كما يجب في مثله - ثم أشبع كسرته فأنشا عنها ياء فقال: سيفنى.
وأما الحرف المعتل فعلى ضربين: ساكن تابع لما قبله كقاما وقاموا وقومى وقد قدمنا ذكر هذا ومعتل غير تابع لما قبله وهو الياء والواو الساكنتان بعد الفتحة نحو أي وكي ولو وأو فإذا وقفت على شيء من ذلك مستذكرا كسرته فقلت: قمت كي أي كي تقوم ونحوه.
وتقول في العبارة: قد فعل كذا أبي معناه: أي أنه كذا ونحو ذلك.
ومن كان من لغته أن يفتح أو يضم لالتقاء الساكنين فقياس قوله أن يفتح أيضاً أو يضم عند التذكر.
روينا ذلك عن قطرب: قم الليل وبع الثوب فإذا تذكرت قلت: قما وبعا وفي سر: سرا.
وليس كذلك قراءة ابن مسعود فقلا له قولاً ليناً لأن الألف علم ضمير تثنية موسى وهرون عليهما السلام.
وأيضاً فإنه لم يقف عليه ألا ترى أن بعده له قولاً ليناً وإنما هذه لغة لبعضهم يجري حركة ألف التثنية وواو الجمع مجرى حركة التقاء الساكنين فيقول في التثنية: بعا يا رجلان ويا رجال بعوا ويا غلامان قما.
وعليه قراءة اين مسعود هذه وبيت الضبي:
لم يهلعوا ولم يخموا يريد: يخيموا فجاء به على ما ترى.
وروينا عن قطرب أن منهم من يقول: شم يا رجل.
فإن تذكرت على هذه اللغة مطلت الضمة فوفيتها واوا فقلت: شمو.
ومن العرب من يقرأ {اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ} ومنهم من يكسر فيقول: اشتروا الضلالة.
ومنهم من يفتح فيقول: اشتروا الضلالة.
فإن مطلت متذكرا قلت على من ضم: اشترووا وعلى من كسر: اشتروى وعلى من فتح: اشتروا.
.
وروينا عن محمد بن محمد عن أحمد بن موسى عن محمد بن الجهم عن يحيى بن زياد قول الشاعر: فهم بطانتهم وهم وزراؤهم وهم القضاة ومنهم الحكام فإن وقفت على هم من قوله: وهم القضاة قلت: همى.
وكذلك الوقوف على منهم الحكام: منهمى.
فإن وقفت على هم من قوله: وهم وزراؤهم قلت: همو لأنك كذا رأيته فعل الشاعر لما قال في أول البيت: فهمو ففصلت بين حركة التقاء الساكنين وغيرها كما فصل وإن شئت قلت: وهمى تريد: وهم وزراؤهم وقلت: وهمو تريد: وهم القضاة حملا على قوله: فهم بطانتهم لأنك إذا فعلت ذلك لم تعد أن حملت على نظير.
وكلما جاز شيء من ذلك عند وقفة التذكر جاز في القافية البتة على ما تقدم.
وعليه تقول: عجبت منا إذا أردت: من القوم على من فتح النون.
ومن كسرها فقال: من القوم قال: منى.
فاعرف ذلك إلى ما يليه إن شاء الله.
باب في إنابة الحركة عن الحرف والحرف عن الحركة
الأول منهما أن تحذف الحرف وتقر الحركة قبله نائبةً عنه.
ودليلةً عليه كقوله: كفاك كفٌ لا تليق درهما جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما يريد: تعطى.
وعليه بيت الكتاب: وأخو الغوان متى يشأ يصرمنه وبيته: دوامي الأيد يخبطن السريحا ومنه قول الله تعالى: {يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ} وهو كثير في الكسرة.
وقد جاء في الضمة منه قوله: إن الفقير بيننا قاضٍ حكم أن ترد الماء إذا غار النجم يزيد النجوم فحذف الواو وأناب عنها الضمة وقوله: حتى إذا بلت حلاقيم الحلق يريد الحلوق.
وقال الأخطل: ومنه قول الله عز اسمه {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} و {يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ} و {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} وكتب ذلك بغير واو دليلا في الخط على الوقوف عليه بغير واو في اللفظ.
وله نظائر وهذا في المفتوح قليل لخفة الألف قال: مثل النقا لبده ضرب الطلل ونحو منه قوله: ألا لا بارك الله في سهيلٍ إذا ما الله بارك في الرجال فحذف الألف من هذه اللفظة " الله ".
ومنه بيت الكتاب: أو الفاً مكة من ورق الحمى يريد الحمام فحذف الألف فالتقت الميمان فغير على ما ترى.
وقال أبو عثمان في قول الله سبحانه {يَا أَبتِ} أراد: يا أبتا فحذف الألف.
وأنشد أبو الحسن وابن الإعرابي: فلست بمدرك ما فات منى بلهف ولا بليت ولا لو أني يريد بلهفى وقد مضى نحو هذا.
الثاني منهما وهو إنابة الحرف عن الحركة.
وذلك في بعض الآحاد وجمع التثنية وكثير من الجمع.
فالآحاد نحو أبوك وأخوك وحماك وفاك وهنيك وذي مال.
فالألف والياء والواو في جميع هذه الأسماء الستة دواخل على الفتح والكسر والضم.
ألا تراها تفيد من الإعراب ما تفيده الحركات: الضمة والفتحة والكسرة.
والتثنية نحو الزيدان والرجلين.
والجمع نحو الزيدون والمسلمين.
وأعربوا بالنون أيضاً.
فرفعوا بها في الفعل: يقومان ويقومون وتقومين فالنون في هذا نائبة عن الضمة في يفعل.
وكما أن ألف التثنية وواو الجمع نائبتان عن الضمة والياء فهما نائبتان عن الكسرة والفتحة وإنما الموضع في الإعراب للحركات فأما الحروف فدواخل عليها.
وليس من هذا الباب إشباع الحركات في نحو منتزاح وأنظور والمطافيل لن الحركة في نحو هذا لم تحذف وأنيب الحرف عنها بل هي موجودة ومزيد فيها لا منتقص منها.
باب في هجوم الحركات على الحركات
وذلك على ضربين: أدهما كثير مقيس والآخر غير مقيس.
الأول منهما وهو قسمان: أحدهما أن تتفق فيه الحركتان والآخر أن تختلفا فيه فيكون الحكم للطارىء منهما على ما مضى.
فالمتفقان نحو قولك: هم يغزون ويدعون.
وأصله يغزوون فأسكنت الواو الأولى التي هي اللام وحذفت لسكونها وسكون واو الضمير والجمع بعدها ونقلت تلك الضمة المحذوفة على اللام إلى الزاي التي هي العين فحذفت لها الضمة الأصلية في الزاي لطروء الثانية المنقولة من اللام إليها عليها.
ولا بد من هذا التقدير في هجوم الثانية الحادثة على الأولى الراتبة اعتبارا في ذلك بحكم المختلفتين ألا تراك تقول في العين الكسورة بنقل الضمة إليها مكان كسرتها وذلك نحو يرمون ويقضون ألا تراك نقلت ضمة ياء يرميون إلى ميمها فابتزت الضمة الميم كسرتها وحلت محلها فصار: يرمون.
فكما لا يشك في أن ضمة ميم يرمون غير كسرتها في يرميون لفظا فكذلك فلنحكم على أن ضمة زاي يغزون غير ضمتها في يغزون تقديرا وحكما.
ونحو من ذلك قولهم في جمع مائة: مئون.
فكسرة ميم مئون غير كسرتها في مائة اعتبارا بحال المختلفين في سنة وسنين.
وبرة وبرين.
ومثله ترخيم برثن ومنصور فيمن قال: يا حار إذا قلت: يا برث ويا منص فهذه الضمة في ثاء برث وصاد منص غير الضمة فيمن قال: يا برث ويا منص علي يا حار على يا حار اعتبارا بالمختلفتين.
فكما لا شك في أن ضمة راء يا حار غير كسرة راء يا حار سماعا ولفظا فكذلك الضمة على يا حار في يا برث ويا منص غير الضمة فيهما على يا حار تقديرا وحكما.
وعلى ذلك كسرة صاد صنو وقاف قنو غير كسرتها في قنوانٍ وصنوانٍ.
وهذا باب وقد تقدم في فصله.
وكذلك كسرة ضاد تقضين غير كسرتها المقدرة فيها في أصل حالها وهو تقضيين.
والقول هنا هو ما تقدم في يدعون ويغزون.
فهذا حكم الحركتين المتفقتين.
وأما المختلفتان فأمرهما واضح.
وذلك نحو يرمون ويقضون.
والأصل: يرميون ويقضيون فأسكنت الياء استثقالا للضمة عليها ونقلت إلى ما قبلها فابتزته كسرته لطروئها عليها فصار: يرمون ويقضون.
وكذلك قولهم: أنت تغزين أصله تغزوين فنقلت الكسرة من الواو إلى الزاي فابتزتها ضمتها فصار: تغزين.
إلا أن منهم من يشم الضمة أرادة للضمة المقدرة ومنهم من يخلص الكسرة فلا يشم.
ويدلك على مراعاتهم لتلك الكسرة والضمة المبتزتين عن هذين الموضعين أنهم إذا أمروا ضموا همزة الوصل وكسروها إرادة لهما وذلك كقولهم: اقضوا ابنوا وقولهم: اغزى ادعى.
فكسرهم مع ضمة الثالث وضمهم مع كسرته يدل على قوة مراعاتهم للأصل المغير وأنه عندهم مراعىً معتد مقدر.
ومن المتفقة حركاته ما كانت في الفتحتان نحو اسم المفعول من نحو اشتد واحمر وذلك قولهم: مشتد ومحمر ومن قولك: هذا رجل مشتد عليه وهذا مكان محمر فيه وأصله مشتددٌ ومحمررٌ فأسكنت الدال والراء الأوليان وادغمتا في مثلهما من بعدهما ولم ننقل الحركة إلى ما قبلها فتغلبه على حركته التي فيه كما تغلب في يغزون ويرمين.
يدل على أنك لم تنقل الحركة هنا كما نقلتها هناك قولهم في اسم الفاعل أيضاً كذلك وهو مشتد ومحمر ألا ترى أن أصله مشتد ومحمرر.
فلو نقلت هذا لوجب أن تقول: مشتّد ومحمرّ.
فلما لم تقل ذلك وصح في المختلفين اللذين النقل فيهما موجود لفظا امتنعت من الحكم به فيما تحصل الصنعة فيه تقديرا ووهما.
وسبب ترك النقل في المفتوح انفراد الفتح عن الضم والكسر في هذا النحو لزوال الضرورة فيه ومعه ألا ترى إلى صحة الياء والواو جميعا بعد الفتحة وتعذر الياء الساكنة بعد الضمة والواو الساكنة بعد الكسرة.
وذلك أنك لو حذفت الضمة في يرميون ولم تنقلها إلى الميم لصار التقدير إلى يرمون ثم وجب قلب الواو ياء وأن تقول: هم يرمين فتصير إلى لفظ جماعة المؤنث.
وكذلك لو لم تنقل كسرة الواو في تغزوين إلى الزاى لصار التقدير إلى تغزين.
فوجب أن تقلب الياء لانضمام الزاى قبلها واوا فتقول للمرأة: أنت تغزون فيلتبس بجماعة المذكر.
فهذا حكم المضموم مع المكسور.
وليس كذلك المفتوح ألا ترى الواو والياء صحيحتين بعد الفتحة نحو هؤلاء يخشون ويسعون وأنت ترضين وتخشين.
فلما لم تغير الفتحة هنا في المختلفين اللذين تغييرهما واجب لم تغير الفتحتان اللتان إنما هما في التغيير محمولتان على الضم مع الكسر.
فإن قلت: فقد يقع اللبس أيضاً بحيث رُمت الفرق ألا تراك تقول للرجال: أنتم تغزون وللنساء: أنتنّ تغزون وتقول للمرأة: أنت ترمين ولجماعة النساء: أنتنّ ترمين.
قيل: إنما احتُمل هذا النحو في هذه الأماكن ضرورة ولولا ذلك لما احتمل.
ووجه الضرورة أن أصل أنتم تغزون: تغزوون فالحركتان - كما ترى - متفقتان لأنهما ضمتان.
وكذلك أنت ترمين الأصل فيه ترميين فالحركتان أيضاً متفقتان لأنهما كسرتان.
فإذا أنت أسكنت المضموم الأول ونقلت إليه ضمة الثاني وأسكنت المكسور الأول ونقلت إليه كسرة الثاني بقى اللفظ بحاله كأن لم تنقله ولم تغيّر شيئاً منه فوقع اللبس فاحتمل لما يصحب الكلام من أوله وآخره كأشياء كثيرة يقع اللبس في لفظها فيعتمد في بيانها على ما يقارنها كالتحقير والتكسير وغير ذلك فلما وجدت إلى رفع اللبس بحيث وجدته طريقا سلكتها ولما لم تجد إليه طريقا في موضع آخر احتملته ودللت بما يقارنه عليه.
فهذه أحوال الحركات المنقولة وغير المنقولة فيما كان فيه الحرفان جميعا متحركين.
فأما إن سكن الأول فإنك تنقل الحركات جُمع إليه.
وذلك نحو أقام ومُقيم ومُقام وأسار ومُسِير ومُسَار ألا ترى أن أصل ذلك أقوَم وأسيَر ومُقوِم ومُسيِر ومُقوَم ومُسيَر وكذلك يقوم ويسير: أصلهما يَقوُم ويَسيِر فنقل ذلك كله لسكون الأول.
والضرب الثاني مما هجمت فيه الحركة على الحركة من غير قياس.
وهو كبيت الكتاب: وقال اضرب الساقين إمك هابل وأصله: امك هابل إلا أن همزة أمك كسرت لانكسار ما قبلها على حد قراءة من قرأ: {فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} فصار: إمك هابل ثم أتبع الكسر الكسر فهجمت كسرة الإتباع على ضمة الإعراب فابتزتها موضعها فهذا شاذٌ لا يقاس عليه ألا تراك لا تقول: قدرك واسعة ولا عدلك ثقيل ولا بنتك عاقلة.
ونحو من ذلك في الشذوذ قراءة الكسائي { بما أنزليك }.
وقياسه في تخفيف الهمزة أن تجعل الهمزة بين بين فتقول: بما أنزل إليك لكنه حذف الهمزة حذفا وألقى حركتها على لام أنزل وقد كانت مفتوحة فغلبت الكسرة الفتحة على الموضع فصار تقديره: بما أنزلليك فالتقت اللامان متحركتين فأسكنت الأولى وادغمت في الثانية كقوله تعالى {لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي}.
ونحو منه ما حكاه لنا أبو علي عن أبي عبيدة أنه سمع: دعه في حر أمه.
وذلك أنه نقل ضمة الهمزة - بعد أن حذفها - على الراء وهي مكسورة فنفى الكسرة وأعقب منها ضمة.
ومنه ما حكاه أحمد بن يحيى في خبر له مع ابن الأعرابي بحضرة سعيد بن سلم عن امرأة قالت لبنات لها وقد خلون إلى أعرابي كان يألفهن: أفي السو تنتنه قال أحمد بن يحيى فقال لي ابن الأعرابي: تعالى إلى هنا اسمع ما تقول.
قلت: وما في هذا! أرادت: أفي السوأة أنتنه! فألقت فتحة أنتن على كسرة الهاء فصارت بعد تخفيف همزة السوأة: أفي السو تنتنه.
فهذا نحو مما نحن بسبيله.
وجميعه غير مقيس لأنه ليس على حد التخفيف القياسي ألا ترى أن طريق قياسه أن يقول: في حرأمه فيقر كسرة الراء عليها ويجعل همزة أمه بين بين أي بين الهمزة والواو لأنها مضمومة كقول الله سبحانه: {يَسْتَهْزِئُون} فيمن خفف أو في حريمه فيبدلها ياء البتة على يستهزيون وهو رأي أبي الحسن وكذلك قياس تخفيف قولها: أفي السوأة أنتنه: أفي السوءة ينتنه فيخلص همزة أنتنه ياء البتة لانتفاخها وانكسار ما قبلها كقولك في تخفيف مئر: مير.
وسنذكر شواذ الهمز في بابه بإذن الله.
باب في شواذ الهمز
وذلك في كلامهم على ضربين وكلاهما غير مقيس.
أحدهما أن تقر الهمزة الواجبة تغييرها فلا تغيرها.
والآخر أن ترتجل همزا لا أصل له ولا قياس يعضده.
الأول من هذين ما حكاه عنهم أبو زيد وأبو الحسن من قولهم: غفر الله له خطائئه.
وحكى أبو زيد وغيره: دريئة ودرائئ.
وروينا عن قطرب: لفيئة ولفائئ.
وأنشدوا: فإنك لا تدري متى الموت جائئٌ إليك ولا ما يحدث الله في غد وفيما جاء من هذه الأحرف دليل على صحة ما يقوله النحويون دون الخليل: من أن هذه الكلم غير مقلوبة وأنه قد كانت التقت فيها الهمزتان على ما ذهبوا إليه لا ما رآه هو.
ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائي أئمة بالتحقيق فيهما.
فالهمزتان لا تلتقيان في كلمة واحدة إلا أن تكونا عينين نحو سئال وسئار وجئار فأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين فضعيف عندنا وليس لحنا.
وذلك نحو قرأ أبوك و {السُّفَهَاء أَلا} و {وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ} و {أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ} فهذا كله جائز عندنا على ضعفه لكن التقاؤهما في كلمة واحدة غير عينيين لحن إلا ما شذ مما حكيناه من خطائئ وبابه.
وقد تقدم.
وأنشدني بعض من ينتمي إلى الفصاحة شعرا لنفسه مهموزا يقول فيه: أشاؤهما وأدأؤها فنبهته عليه فلم يكد يرجع عنه وهذا مما لو كان همزه أصلا لوجب تركه وإبداله فكيف أن يرتجل همزا لا أصل له ولا عذر في إبداله من حرف لين ولا غيره.
الثاني من الهمز.
وهو ما جاء من غير أصل له ولا إبدال دعا قياس إليه وهو كثير.
منه قولهم: مصائب.
وهذا مما لا ينبغي همزه في وجه من القياس.
وذلك أن مصيبة مفعلة.
وأصلها مصوبة فعينها كما ترى متحركة في الأصل فإذا احتيج إلى حركتها في الجمع حملت الحركة.
وقياسه مصاوب.
وقد جاء ذلك أيضا قال: يصاحب الشيطان من يصاحبه وهو أذيٌّ جمة مصاوبه ويقال فيها أيضاً: مصوبة ومصابة.
ومثله قراءة أهل المدينة: معائش بالهمز.
وجاء أيضا في شعر الطرماح مزائد جمع مزادة وصوابها مزايد.
قال: مزائد خرقاء اليدين مسيفةٍ وقالوا أيضا: منارة ومنائر وإنما صوابها: مناور لأن الألف عين وليست بزائدة.
ومن الجيد وإني لقوام مقاوم لم يكن جريرٌ ولا مولى جريرٍ يقومها ومن شاذ الهمز ما أنشده ابن الأعرابي لابن كثوة: ولى نعام بني صفوان زوزأةً لما رأى أسدا في الغاب قد وثبا وإنما هي زوزاة: فعللة من مضاعف الواو بمنزلة االقوقاة والضوضاة.
وأنشدوا بيت امرؤ القيس: كأني بفتخاء الجناحين لقوةٍ دفوفٍ من العقبان طاطات شئمالى يريد شماله أي خفضها بعنان فرسه.
وقالوا: تأبلت القدر بالهمز.
ومثله التأبل والخأتم والعألم.
ونحو منه ما حكوه من قول بعضهم: بأز بالهمز وهي البئزان بالهمز أيضاً.
وقرأ ابن كثير: {وكشفت عن سأقيها} وقيل في جمعه: سؤق مهموزا على فعل.
وحكى أبو زيد: شئمة للخليقة بالهمز وأنشد الفراء: يا دارمي بدكاديك البرق صبرا فقد هيجت شوق المشتئق يريد المشتاق.
وحكى أيضاً رجل مئل بوزن معل إذا كان كثير المال.
وحكوا أيضا: الرئبال بالهمز.
وأما شأمل وشمأل وجرائض وحطائط بطائط والضهيأ فمشهور بزيادة الهمز فيه.
وحكى لنا أبو علي في النيدلان: النئدلان بالكسر ومثاله فئعلان.
وأنشدوا لجرير: بالهمز في الموقدان وموسى.
وحكى أنه وجد بخط الأصمعي: قطا جؤنى.
وحكى عنه أيضاً فيه جوني.
ومن ذلك قولهم: لبأت بالحج ورثأت زوجي بأبيات وحلأت السويق واستلأمت الحجر وإنما هو استلمت: افتعلت قال: يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم فوزن استلأم على ما ترى: افتعأل وهو مثال مبدع غريب.
ونحو منه ما رويناه عن أحمد بن يحيى لبلال بن جرير جد عمارة: إذا ضفتهم أو سآيلتهم وجدت بهم علة حاضرة يريد: ساءلتهم.
فإما زاد الياء وغير الصورة فصار مثاله: فعايلتهم.
وإما أراد: ساءلتهم كالأول إلا أنه زاد الهمزة الأولى فصار تقديره: سئاءلتهم بوزن: فعاءلتهم فجفا عليه التقاء الهمزتين هكذا ليس بينهما إلا الألف فأبدل الثانية ياء كما أنه لما كره أصل تكسير ذؤابة - وهو ذآئب - أبدل الأولى واواً.
ويجوز أن يكون أراد: ساءلتهم ثم أبدل من الهمزة ياء فصار: سايلتهم ثم جمع بين المعوض والمعوض منه فقال: سآيلتهم فوزنه الآن على هذا: فعاعلتهم.
ومثله مما جمع فيه بين العوض والمعوض منه في العين ما ذهب إليه أبو إسحاق وأبو بكر في قول الفرزدق: هما نفثا في فيَّ من فمويهما فوزن " فمويهما " على قياس مذهبهما: فععيهما.
وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في بأز وسأق وتأبل ونحو ذلك إنما هو عن تطرق وصنعة وليس اعتباطاً هكذا من غير مسكة.
وذلك أنه قد ثبت عندنا من عدة أوجه أن الحركة إذا جاورت الحرف الساكن فكثيراً ما تجريها العرب مجراها فيه فيصير لجواره إياها كأنه محرك بها.
فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء باز إنما هي في نفس الألف.
فالألف لذلك وعلى هذا التنزيل كأنها محركة وإذا تحركت الألف انقلبت همزة.
من ذلك قراءة أيوب السختياني: {غير المغضوب عليهم ولا الضألين}.
وحكى أبو العباس عن أبي عثمان عن أبي زيد قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ: { فيومئذٍ لا يسئل عن ذنبه إنسٌ ولا جأنٌ } فظننت أنه قد لحن إلى أن سمعت العرب تقول: شأبة ودأبة.
وقال كثير: إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت يريد احمارت وقال أيضاً: وأنشد قوله: يا عجباً لقد رأيت عجبا حمار قبان يسوق أرنبا خاطمها زأمها أن تذهبا وقال دكين: وجله حتى ابيأض ملببه فإن قلت: فما أنكرت أن يكون ذلك فاسدا لقولهم في جمع بأز: بئزان بالهمز.
وهذا يدل على كون الهمزة فيه عيناً أصلاً كرأل ورئلانٍ.
قيل: هذا غير لازم.
وذلك أنه لما وجد الواحد - وهوبأز - مهموزاً - نعم وهمزته غير مستحكمة السبب - جرى عنده وفي نفسه مجرى ما همزته أصلية فصارت بئزان كرئلان.
وإذا كانوا ما قويت علة قلبه مجرى الأصلي في قولهم: ميثاق ومياثق كان إجراء بأز مجرى رأل أولى وأحرى.
وسيأتي نحو هذا في باب له.
وعليه أيضاً قوله: لحب المؤقدان إلي مؤسى ألا ترى أن ضمة الميم في الموقدان وموسى لما جاورت الواو الساكنة صارت كأنها فيها والواو .
فرأٌ متار يريد: متأرا فلما جاورت الفتحة في الهمزة التاء صارت كأنها فيها فجرى ذلك مجرى متأر فخفف على نحو من تخفيف رأس وبأس.
وسيأتي ذلك في بابه بإذن الله.
باب في حذف الهمز وإبداله
قد جاء هذا الموضع في النثر والنظم جميعاً.
وكلاهما غير مقيس عليه إلا عند الضرورة.
فإن قلت: فهلا قست على ما جاء منه في النثر لأنه ليس موضع اضطرار قيل: تلك مواضع كثر استعمالها فعرفت أحوالها فجاز الحذف فيها - وسنذكرها - كما حذفت لم يك ولم يبل ولا أدر في النثر لكثرة الاستعمال ولم يقس عليها غيرها.
فمما جاء من ذلك في النثر قولهم: ويلمه.
وإنما أصله ويل لأمه.
يدل على ذلك ما أنشده الأصمعي: لأم الأرض ويل! ما أجنت غداة أضر بالحسن السبيل فحذف لام ويل وتنوينه لما ذكرنا وحذفت همزة أم فبقي: ويلمه.
فاللام الآن لام الجر ألا تراها مكسورة.
وقد يجوز أن تكون اللام المحذوفة هي لام الجر كما حذف حرف الجر من قوله: الله أفعل وقول رؤبة: خيرٍ عافاك الله وقول الآخر: رسم دارٍ وقفت في طلله وهو من المقلوب أي طلل دار وقفت في رسمه وعليه قراءة الكسائي: بما أنزليك - وقد ذكرناه - وقراءة ابن كثير إنها لحدى الكبر وحكاية أحمد ابن يحيى قول المرأة لبناتها وقد خلا الأعرابي بهن: أفي السوتنتنه " تريد: أفي السوءة أنتنه " ومنه قولهم: الله في هذه الكلمة في أحد قولي سيبويه وهو أعلاهما.
وذلك أن يكون أصله إلاه فحذفت الهمزة التي هي فاء.
وكذلك الناس لأن أصله أناس قال: وإنا أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول ولا تكاد الهمزة تستعمل مع لام التعريف غير أن أبا عثمان أنشد: إن المنايا يطلع ن على الأناس الآمنينا ومنه قولهم: لن في قول الخليل.
وذلك أن أصلها عنده لا أن فحذفت الهمزة عنده تخفيفا لكثرته في الكلام ثم حذفت الألف لسكونها وسكون النون بعدها.
فما جاء من نحوه فهذه سبيله.
وقد اطرد الحذف في كل وخذ ومر.
وحكى أبو زيد: لاب لك " يريد: لا أب لك " وأنشد أبو الحسن: تضب لثات الخيل في حجراتها وتسمع من تحت العجاج لها ازملا وأنشدنا أبو علي: وحكي لنا عن أبي عبيدة: دعه في حرامه وروينا عن أحمد بن يحيى: هوي جند ابليسٍ المريد " وهو كثير " ومنه قوله: أرأيت إن جئت به أملودا وقوله: حتى يقول من رآه قد راه وهو كثير.
فأما الإبدال على غير قياس فقولهم: قريت وأخطيت وتوضيت.
وأنشدني بعض أصحابنا لابن هرمة: ليت السباع لنا كانت مجاورة وأننا لا نرى ممن نرى أحدا إن السباع لتهدا عن فرائسها والناس ليس بهادٍ شرهم أبدا ومن أبيات الكتاب لعبد الرحمن بن حسان: وكنت أذل من وتد بقاع يشجج رأسه بالفهرواجي يريد: واجئ كما أراد الأول: ليس بهادئ.
ومن أبياته أيضاً: ومن حكاياته بيس في بئس أبدل الهمزة ياء.
ونحوه قول ابن ميادة: فكان لها يومذٍ أمرها وقرأ عاصم في رواية حفص: أن تبويا في الوقف أي تبوءا.
وقال: تقاذفه الرواد حتى رموا به ورا طرق الشأم البلاد الأقاصيا أراد: وراء طرق الشام فقصر الكلمة.
فكان ينبغي إذ ذاك أن يقول: ورأ بوزن قرأ لأن الهمزة أصلية عندنا إلا أنه أبدلها ضرورة فقلبها ياء وكذلك ما كان من هذا النحو فإنه إذا أبدل " صار إلى أحكام ذوات الياء ألا ترى أن قريت مبدلة من قرأت بوزن قريت من قريت الضيف ونحو ذلك.
ومن البدل البتة النبي في مذهب سيبويه.
وقد ذكرناه.
وكذلك البرية عند غيره.
ومنه الخابية لم تسمع مهموزة.
فإما أن يكون تخفيفا اجتمع عليه كيرى وأخواته وإما أن يكون بدلاً قال: أري عيني ما لم ترأياه كلانا عالمٌ بالترهات والنبوة عندنا مخففة لا مبدلة.
وكذلك الحكم على ما جاء من هذا: أن يحكم عليه بالتخفيف إلى أن يقوم الدليل فيه على الإبدال.
فاعرف ذلك مذهبا للعرب نهجا بإذن الله.
وحدثنا أبو علي قال: لقي أبو زيد سيبويه فقال له: سمعت العرب تقول: قريت وتوضيت.
فقال له سيبويه: كيف تقول في أفعل منه قال: أقرأ.
وزاد أبو العباس هنا: فقال له سيبويه: فقد تركت مذهبك أي لو كان البدل قوياً للزم ووجب أن تقول: أقري كرميت أرمي.
وهذا بيان.
باب في حرف اللين المجهول
وذلك مدة الإنكار نحو قولك في جواب من قال: رأيت بكرا: أبكرنيه وفي جاءني محمد: أمحمدنيه وفي مررت على قاسم: أقاسمنيه! وذلك أنك ألحقت مدة الإنكار وهي لا محالة ساكنة فوافقت التنوين ساكناً فكسر " لالتقاء الساكنين " فوجب أن تكون المدة ياء لتتبع الكسرة.
وأي المدات الثلاث كانت فإنها لا بد أن توجد في اللفظ بعد كسرة التنوين ياء لأنها إن كانت في الأصل ياء فقد كفينا النظر في أمرها.
وإن كانت ألفاً أو واواً فالكسرة قبلها تقلبها إلى الياء البتة.
فإن قيل: أفتنص في هذه المدة على حرف معين: الألف أو الياء أو الواو.
قيل: لم تظهر في شيء من الإنكار على صورة مخصوصة فيقطع بها عليها دون أختيها وإنما تأتي تابعة لما قبلها ألا تراك تقول في قام عمر: أعمروه وفي رأيت أحمد: أأحمداه وفي مررت بالرجل آلرجليه وليست كذلك مدة الندبة لأن تلك ألف لا محالة وليست مدة مجهولة مدبرة بما قبلها ألا تراها تفتح ما قبلها أبداً ما لم تحدث هناك لبساً ونحو ذلك نحو وا زيداه ولم يقولوا: وا زيدوه وإن كانت الدال مضمومة في وا زيد.
وكذلك وا عبد الملكاه ووا غلام زيداه لما حذفت لها التنوين " من زيد " صادفت الدال مكسورة ففتحتها.
غير أننا نقول: إن أخلق الأحوال بها أن تكون ألفاً من موضعين.
أحدهما أن الإنكار مضاهٍ للندبة.
وذلك أنه موضع أريد فيه معنى الإنكار والتعجب فمطل الصوت به وجعل ذلك أمارة لتناكره كما جاءت مدة الندبة إظهاراً للتفجع وإيذاناً بتناكر الخطب الفاجع والحدث الواقع.
فكما أن مدة الندبة ألف فكذلك ينبغي أن تكون مدة الإنكار ألفا.
والآخر أن الغرض في الموضعين جميعاً إنما هو مطل الصوت ومده وتراخيه والإبعاد فيه لمعنى الحادث هناك.
وإن كان الأمر كذلك فالألف أحق به دون أختيها لأنها أمدهن صوتاً وأنداهن وأشدهن إبعادا " وأنآهن ".
فأما مجيئها تارة واوا وأخرى ياء فثانٍ لحالها وعن ضرورة دعت " إلى ذلك " لوقوع الضمة والكسرة قبلها.
ولولا ذلك لما كانت إلا ألفاً أبدا.
فإن قلت: فهلا تبعها ما قبلها في الإنكار كما تبعها في الندبة فقلت في جاءني عمر: أعمراه كما تقول الندبة: واعمراه.
قيل: فرق ما بينهما أن الإنكار جارٍ مجرى الحكاية ومعنى الجامع بينهما أنك مع إنكارك للأمر مستثبت ولذلك قدمت في أول كلامك همزة الاستفهام.
فكما تقول في جواب رأيت زيدا: من زيدا كذلك قلت أيضاً في جواب جاءني عمر: أعمروه.
وأيضاً فإن مدة الإنكار لا تتصل بما قبلها اتصال مدة الندبة بما قبلها ألا ترى التنوين فاصلا بينهما في نحو أزيدنيه ولا يفصل به بين المندوب ومدة الندبة في نحو وا غلام زيداه بل تحذفه لمكان مدة الندبة وتعاقب بينهما لقوة اتصالها به كقوة اتصال التنوين به فكرهوا أن يظاهروا بينهما في آخر الاسم لتثاقله عن احتمال زيادتين في آخره.
فلما حذف التنوين لمدة الندبة قوى اتصالها بالمندوب فخالطته فأثرت فيه الفتح.
ولما تأخرت عنه مدة الإنكار ولم تماسه مماسة مدة الندبة له لم تغيره تغييرها إياه.
ويزيدك في علمك ببعد مدة الإنكار عن الاسم الذي تبعته وقوع إن بعد التنوين فاصلة بينهما نحو أزيدا إنيه! وأزيدٌ إنيه! وهذا ظاهر للإبعاد لها عنه.
وأغرب من هذا أنك قد تباشر بعلامة الإنكار غير اللفظ الأول.
وذلك في قول بعضهم وقد قيل له: أتخرج إلى البادية إن أخصبت فقال: أنا إنيه! فهذا أمر آخر أطم من الأول ألا تراك إذا ندبت زيدا ونحوه فإنما تأتي بنفس اللفظ الذي هو عبارة عنه لا بلفظ آخر ليس بعبارة عنه.
وهذا تناهٍ في ترك مباشرة مدة الإنكار للفظ الاسم المتناكرة حاله وما أبعد هذا عن حديث الندبة! فإن قلت: فقد تقول في ندبة زيد " وا أبا محمداه " فتأتي بلفظ آخر وكذلك إذا ندبت جعفرا قلت: وا من كان كريماه! فتأتي بلفظ غير لفظ زيد وجعفر.
قيل: أجل إلا أن " أبا محمد " و " من كان كريما " كلاهما عبارة عينيهما وقوله: أنا إنيه ليس باللفظ الأول ولا بعبارة عن معناه.
وهذا كما تراه واضح جلي.
ومثل مدة الإنكار هذه البتة في جهلها مدة التذكر في قولك إذا تذكرت الخليل ونحوه: الي وعني ومنا ومنذو أي الخليل وعن الرجل ومن الغلام ومنذ الليلة.
باب في بقاء الحكم مع زوال العلة
هذا موضع ربما أوهم فساد العلة. وهو مع التأمل بضد ذلك نحو قولهم فيما أنشده أبو زيد: حمىً لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسأل الأقوام عقد المياثق ألا ترى أن فاء ميثاق - التي هي واو وثقت - انقلبت للكسرة قبلها ياء كما انقلبت في ميزان وميعاد فكان يجب على هذا لما زالت الكسرة في التكسير أن تعاود الواو فتقول على قول الجماعة: المواثيق كما تقول: الموازين والمواعيد.
فتركهم الياء بحالها ربما أوهم أن انقلاب هذه الواو ياء ليس للكسرة قبلها بل هو لأمر آخر غيرها إذ لو كان لها لوجب زواله مع زوالها.
ومثل ذلك ما أنشده خلف الأحمر من قول الشاعر: عداني أن أزورك أم عمرو دياوين تشقق بالمداد فللقائل أيضاً أن يقول: لو أن ياء ديوان إنما قلبت عن واو دوان للكسرة قبلها لعادت عند زوالها.
وكذلك للمعترض فيي هذا أن يقول: لو كانت ألف باز إنما قلبت همزة في لغة من قال: بأز لأنها جاورت الفتحة فصارت الحركة كأنها فيها فانقلبت همزة كما انقلبت لما حركت في نحو شأبة ودأبة لكان ينبغي أن تزول الهمزة عند زوال الألف في قولهم: بئزان فقد حكيت أيضاً بالهمز إذ كانت الياء إذا تحركت لم تقلب همزة في نحو قول جرير: فيوماً يجازين الهوى غير ماضيٍ ويوماً ترى منهن غولاً تغول وكذلك لو كانت الواو إنما انقلبت في صبية وقنية وصبيان ولياح للكسرة قبلها لوجب إذا زالت الكسرة أن تعود الواو فتقول: صبوة وصبوان وقنوة ولواح لزوال الكسرة.
والجواب عن هذا وغيره مما هذه حاله أن العلة في قلب هذه الأشياء هو ما ذكره القوم: من وقوع الكسرة قبلها لأشياء.
منها أن أكثر اللغة وشائع الاستعمال هو إعادة الواو عند زوال الكسرة.
وذلك قولهم: موازين ومواعيد وقولهم في ريح: أرواح وفي قيل: أقوال وفي ميثاق: مواثيق وفي ديوان: دواوين.
فأما مياثق ودياوين فإنه لما كثر عندهم واطرد في الواحد القلب وكانوا كثيراً ما يحملون الجمع على حكم الواحد وإن لم يستوف لجمع جميع أحكام الواحد نحو ديمة وديم وقيمة وقيم صار الأثر في الواحد كأنه ليس عندهم مسبباً عن أمر ومعرضاً لانتقاله بانتقاله بل تجاوزوا به ذلك وطغوا به إلى ما وراءه حتى صار الحرف المقلوب إليه لتمكنه في القلب كأنه أصل في موضعه وغير مسبب عندهم عن علة فمعرضٍ لانتقاله بانتقالها حتى أجروا ياء ميثاق مجرى الياء الأصلية وذلك كبنائك من اليسر مفعالا وتكسيرك إياه على مفاعيل كميسار ومياسير فمكنوا قدم الياء في ميثاق أنسابها واسترواحاً إليها ودلالة على تقبل الموضع لها.
وكذلك - عندي - قياس تحقيره على هذه اللغة أن تقول: مييثيق.
ومنها أن الغرض في هذا القلب إنما هو طلب للخفة فمتى وجدوا طريقاً أو شبهة في الإقامة عليها والتعلل بخفتها سلكوها واهتبلوها.
وليس غرضهم وإن كان قلبها مسبباً عن الكسرة أن يتناهوا في إعلامنا ذلك بأن يعيدوها واواً مع زوالها.
وإنما غالب الأمر ومجموع الغرض القلب لها لما يعقب من الاسترواح إلى انقلابها.
فكأنهم قنعوا أنفسهم بتصور القلب في الواحد لما انتقلوا عنه إلى الجمع ملاحظة لأحواله ومحافظة على أحكامه واسترواحاً إلى خفة المقلوب إليه ودلالة على تمكن القلب في الواحد حتى ألحقوه بما أصله الياء.
وعندي مثل يوضح الحال في إقرار الحكم مع زوال العلة على قلة ذلك في الكلام وكثرة ضده في الاستعمال.
وهو العود تقطعه من شجرته غضاً رطيباً فيقيم على ذلك زمانا ثم يعرض له فيما بعد من الجفوف واليبس ما يعرض لما هذه سبيله فإذا استقر على ذلك اليبس وتمكن فيه حتى ينخر لم يغن عنه فيما بعد أن تعيده إلى قعر البحر فيقيم فيه مائة عام لأنه قد كان بعد فهذه حال إقرار الحكم مع زوال العلة وهو الأقل في كلامهم.
وعلى طرف من الملامحة له قول الله عز وجل: {آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ}.
ومنها أنهم قد قلبوا الواو ياء قلباً صريحاً لا عن علة مؤثرة أكثر من الاستخفاف نحو قولهم: رجل غديان وعشيان والأريحية ورياح ولا كسرة هناك ولا اعتقاد كسرة فيه قد كانت في واحده لأنه ليس جمعاً فيحتذى به ويقتاس به على حكم واحده.
وكذلك قول الآخر: جول التراب فهو جيلاني فإذا جنحوا إلى الياء هذا الجنوح العاري من السبب المؤثر سوى ما فيه من الاسترواح إليه كان قلب الأثقل إلى الأخف وبقاؤه على ذلك لضرب من التأول أولى وأجدر.
نعم وإذا كانوا قد أقروا حكم الواحد على تكسيره مع ثقل ما صاروا إليه مراعاة لأحكامه نحو بأز وبئزان حتى شبهوه برأل ورئلان كان إقرار قلب الأثقل إلى الأخف عند التكسير أولى وأجدر ألا ترى أن الهمزة أثقل من الياء.
وكذلك قولهم لياح - وإنما هو فعال من لاح يلوح لبياضه - قد راعوا فيه انقلاب عينه مع الكسرة في لياح على ضعف هذا الأثر لأنه ليس بجمع كحياض ورياض ولا مصدر كقيام وصيام.
فإقرار الحكم القوي الوجوب في الواحد عند تكسيره أجدر بالجواز.
وكذلك حديث قنية وصبيان وصبية في إقرار الياء بحالها مع زوال الكسرة في صبيان وقنية.
وذلك أن القلب مع الكسرة لم يكن له قوة في القياس وإنما كان مجنوحاً به إلى الاستخفاف.
وذلك أن الكسرة لم تل الواو ألا ترى أن بينهما حاجزاً وإن كان ساكناً فإن مثله في أكثر اللغة يحجز.
وذلك نحو جرو وعلوٍ وصنو وقنو ومجولٍ ومقولٍ وقرواح وجلواخ وقرواش ودرواس وهذا كثير فاشٍ.
فلما أعلوا في صبية وبابه علم أن أقوى سببي القلب إنما هو طلب الاستخفاف لا متابعة الكسر مضطراً إلى الإعلال.
فلما كان الأمر كذلك أمضوا العزمة في ملازمة الياء لأنه لم يزل من الكسرة مؤثر يحكم القياس له بقوة فيدعو زواله إلى المصير إلى ضد الحكم الذي كان وجب به.
وليس هذا كمياثق من قبل أن القلب في ميثاق واجب والقلب في قنية وصبية ليس بواجب.
فكأن باب ميثاق أثرّ في النفس أثراً قوي الحكم فقرره هناك فلما زال بقي حكمه دالاً على قوة الحكم الذي كان به وباب صبية وعلية أقر حكمه مع زوال الكسرة عنه اعتذاراً في ذلك بأن الأول لم يكن عن وجوب فيزال عنه لزوال ما دعا إليه وإنما كان استحساناً فليكن مع زوال الكسر أيضاً استحساناً.
أفلا ترى إلى اختلاف حال الأصلين في الضعف والقوة كيف صرت له بهما إلى فرع واحد وهو القلب.
فإنه جيد في معناه ونافع في سواه مما شرواه.
ومن بعد فقد قالوا أيضاً: صبوان وصبوة وقنوة وعلى أن البغداديين قالوا: قنوت وقنيت وإنما كلامنا على ما أثبته اصحابنا وهو قنوت لا غير.
ومن بقاء الحكم مع زوال علته قول الراجز: لما رأى أن لادعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقفٍ فالطجع وهو افتعل من الضجعة.
وأصله: فاضتجع فأبدلت التاء طاء لوقوع الضاد قبلها فصارت: فاضطجع ثم أبدل الضاد لاماً.
وكان سبيله إذ أزال جرس الضاد أن تصح التاء فيقال: فالتجع كما يقال: التحم والتجأ لكنه أقرت الطاء بحالها إيذاناً بأن هذا القلب الذي دخل الضاد إلى اللام لم يكن عن استحكام ولا عن وجوب كما أن صحة الواو في قوله: وكحل العينين بالعواور إنما جاء لإرادة الياء في العواوير وليعلم أن هذا الحرف ليس بقياس ولا منقاد.
فهذه طريق بقاء الأحكام مع زوال العلل والأسباب.
فاعرف ذلك فإنه كثير جداً.
باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين
وذلك في الكلام على ضربين: أحدهما - وهو الأكثر - أن يتفق اللفظ البتة ويختلف في تأويله.
وعليه عامة الخلاف نحو قولهم: هذا أمر لا ينادى وليده فاللفظ غير مختلف فيه لكن يختلف في تفسيره.
فقال قوم: إن الإنسان يذهل عن ولده لشدته فيكون هذا كقول الله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} وقوله سبحانه: {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ} والآي في هذا المعنى كثيرة.
وقال قوم: أي هو أمر عظيم فإنما ينادى فيه الرجال والجلة لا الإماء والصبية.
وقال آخرون: الصبيان إذا ورد الحي كاهن أو حواء أو رقاء حشدوا عليه واجتمعوا له.
أي ليس هذا اليوم بيوم أنس ولهو إنما هو يوم تجرد وجد.
وقال آخرون - وهم أصحاب المعاني -: أي لا وليد فيه فينادي " وإنما فيه الكفاة والنهضة " ومثله قوله: أي لا منار فيه فيهتدى به وقوله أيضاً: لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الذئب بها ينجحر أي لا أرنب بها فتفزعها أهوالها.
ونحوه - عندي - بيت الكتاب: وقدرٍ ككف القرد لا مستعيرها يعار ولا من يأتها يتدسم أي لا مستعير يستعيرها فيعارها لأنها - لصغرها ولؤمها - مأبية معيفة.
وكذلك قوله: زعموا أن كل من ضرب العي ر مولٍ لنا وأنا الولاء على ما فيه من الخلاف.
وعلى ذلك عامة ما جاء في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده رضوان الله عليهم وما وردت به الأشعار وفصيح الكلام.
وهذا باب في نهاية الانتشار وليس عليه عقد هذا الباب.
وإنما الغرض الباب الآخر الأضيق الذي ترى لفظه على صورة ويحتمل أن يكون على غيرها كقوله: نطعنهم سلكى ومخلوجةً كرك لامين على نابل فهذا ينشد على أنه ما تراه: كرك لامين " أي ردك لامين " - وهما سهمان - على نابل.
ذلك أن تعترض من صاحب النبل شيئاً منها فتتأمله ترده إليه فيقع بعضه كذا وبعضه كذا.
فكذلك قوله: كرك لامين أي طعناً مختلفاً: بعضه كذا وبعضه كذا.
ويروى أيضاً على أنه: كر كلامين أي كرك كلامين على صاحب النبل كما تقول له: ارم ارم تريد السرعة والعجلة.
ونحو من ذلك - وإن كان فيه أيسر خلافٍ - بيت المثقب العبدي: أفاطم قبل بينك نوليني ومنعك ما سألت كأن تبيني فهذه رواية الأصمعي: أي منعك كبينك وإن كنت مقيمة.
ومثله: " قول الطائي " الكبير: لا أظلم النأي قد كانت خلائقها من قبل وشك النوى عند نوىً قدفا ورواه ابن الأعرابي: ومنعك ما سألتك أن تبيني أي منعك إياي ما سألتك هو بينك.
ورواية الأصمعي أعلى وأذهب في معاني الشعر.
ومن ذلك ما أنشده أبو زيد: وأطلس يهديه إلى الزاد أنفه أطاف بنا والليل داجي العساكر فقلت لعمرو صاحبي إذ رأيته ونحن على خوص دقاق عواسر أي عوى هذا الذئب فسر أنت.
خليلي لا يبقى على الدهر فادر بتيهورة بين الطخا فالعصائب أي بين هذين الموضعين وأنشدناه أيضاً: بين الطخاف العصائب.
وأنشد أيضاً: أقول للضحاك والمهاجر إنا ورب القلص الضوامر إنا أي تعبنا من الأين وهو التعب والإعياء.
وأنشد أبو زيد: هل تعرف الدار ببيدا إنه دار لخود قد تعفت إنه فانهلت العينان تسفحنه مثل الجمان جال في سلكنه لاتعجبي مني سليمى إنه إنا لحلالون بالثغرنه وهذه أبيات عملها أبو علي في المسائل البغدادية.
فأجاز في جميع قوافيها أن يكون أراد: إن وبين الحركة بالهاء وأطال فيها هناك.
وأجاز أيضاً أن يكون أراد: ببيداء ثم صرف وشدد التنوين للقافية وأراد: في سلك فبنى منه فعلناً كفرسن ثم شدده لنية الوقف فصار: سلكن.
وأراد: بالثغر فبنى منه للضرورة فعلنا وإن لم يكن هذا مثالاً معروفاً لأنه أمر ارتجله مع الضرورة إليه وألحق الهاء في سلكنه والثغرنه كحكاية الكتاب: أعطني أبيضه.
وأنشدوا وإنما هو: ها من لم تنله سيوفنا.
فها تنبيه ومن لم تنله سيوفنا نداء أي يا من لم ننله سيوفنا خفنا فإنا من عادتنا أن نفلق بسيوفنا هام الملوك فكيف من سواهم.
ومنه المثل السائر: زاحم بعود أو دع أي زاحم بقوة أو فاترك ذلك حتى توهمه بعضهم: بعود أو دع فذهب إلى أن أودع صفة لعود كقوله: بعود أو قص أو أوطف أو نحو ذلك مما جاء على أفعل وفاؤه واو.
ومن ذلك قول الله تعالى: {وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}.
فذهب الخليل وسيبويه فيه إلى أنه وي مفصول وهو اسم سمي به الفعل في الخبر وهو معنى أعجب ثم قال مبتدئاً: كأنه لا يفلح الكافرون وأنشد فيه: وي كأن من يكن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر وذهب أبو الحسن فيه إلى أنه: ويك أنه لا يفلح الكافرون أراد ويك أي أعجب أنه لا يفلح الكافرون أي أعجب لسوء اختيارهم ونحو ذلك فعلق أن بما في ويك من معنى الفعل وجعل الكاف حرف خطاب بمنزلة كاف ذلك وهنالك.
قال أبو علي ناصراً لقول سيبويه: قد جاءت كأن كالزائدة وأنشد بيت عمر: كأنني حين أمسي لا تكلمني ذو بغية يشتهى ما ليس موجودا أي أنا كذلك.
وكذلك قول الله سبحانه {وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} أي { هم لا يفلحون }.
وقال الكسائي: أراد: ويلك ثم حذف اللام.
ومن ذلك بيت الطرماح: وما جلس أبكار أطاع لسرحها جنى ثمر بالواديين وشوع قيل فيه قولان: وشوع أي كثير.
ومنه قوله: إني امرؤ لم أتوشع بالكذب أي لم أتحسن به ولم أتكثر به.
وقيل: إنها واو العطف والشوع: ضرب من النبت.
ونحو من ذلك ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: خالت خويلة أني هالك ودأ قيل: إنه واو عطف أي إني هالك وداء من قولهم: رجل داءٌ أي دوٍ ثم قلب.
وحدثنا عن ابن سلام أن أعرابياً قال للكحال: كحلني بالمكحال الذي تكحل به العيون الداءة.
وأجاز أيضاً في قوله: ودأ أن يكون فعلا من قوله: وللأرض كم من صالح قد تودأت عليه فوارته بلماعةٍ قفر أي غطته وثقلت عليه.
فكذلك يكون قوله: إني هالك كداً وثقلاً وكان يعتمد التفسير الأول ويقول: إذا كانت الواو للعطف كان المعنى أبلغ وأقوى وأعلى كأنه ذهب إلى ما يراه أصحابنا من قولهم في التشهد: التحيات لله والصلوات لله والطيبات.
قالوا: لأنه إذا عطف كان أقوى له وأكثر لمعناه من أن يجعل الثاني مكرراً على الأول بدلاً أو وصفاً.
وقال الأصمعي في قوله: وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا أراد جمع عدة.
وقال الفراء: أراد عدة الأمر فلما أضاف حذف الهاء كقول الله سبحانه { وإقام الصلاة } وهذا يجيء في قول الأصمعي على القلب فوزنه على قوله: علف الأمر.
وهذا باب واسع.
وأكثره في الشعر.
فإذا مر بك فتنبه عليه ومنه قوله: وغلت بهم سجحاء جارية تهوي بهم في لجة البحر يكون: فعلت من التوغل.
وتكون الواو أيضاً عاطفة فيكون من الغليان.
ومنه قوله: غدوت بها طياً يدي برشائها يكون فعلى من طويت.
ويجوز أن يكون تثنية طي أي طيا يدي وأراد: طياها بيدي فقلب.
ومنه بيت أوس: فملك بالليط الذي تحت قشرها كغرقئ كنه بيض القيض من عل " الأصمعي: هو من الملك وهو التشديد.
وقال ابن الأعرابي ": أراد: من لك بهذا الليط.
أبعد ابن عمرو من آل الشري د حلت به الأرض أثقالها هو من الحلية أي زينت به موتاها.
وقال ابن الأعرابي: هو من الحل كأنه لما مات انحل به عقد الأمور.
باب في الاكتفاء بالسبب من المسبب وبالمسبب من السبب
هذا موضع من العربية شريف لطيف وواسع لمتأمله كثير.
وكان أبو علي - رحمه الله - يستحسنه ويعنى به.
وذكر منه مواضع قليلة.
ومر بنا نحن منه مالا نكاد نحصيه.
فمن ذلك قول الله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ} وتأويله - والله أعلم -: فإذا أردت قراءة القرآن فاكتفى بالمسبب الذي هو القراءة من السبب الذي هو الإرادة.
وهذا أولى من تأول من ذهب إلى أنه أراد: فإذا استعذت فاقرأ لأن فيه قلباً لا ضرورة بك إليه.
وأيضاً فإنه ليس كل مستعيذ بالله واجبةً عليه القراءة ألا ترى إلى قوله: أعوذ بالله وبابن مصعب الفرع من قريشٍ المهذب وليس أحد أوجب عليه من طريق الشرع القراءة في هذا الموضع.
وقد يكون على ما قدمنا قوله عز اسمه: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} أي إذا أردتم القيام لها والانتصاب فيها.
ونحو منه ما أنشده أبو بكر: يعني امرأته.
يقول: إن لم أجد من يعينني على سقي الإبل قامت فاستقت معي فوقع الطين على خلوق يديها.
فاكتفى بالمسبب الذي هو اختلاط الطين بالخلوق من السبب الذي هو الاستقاء معه.
ومثله قول الآخر: يا عاذلاتي لا تردن ملامتي إن العواذل لسن لي بأمير أراد لا تلمنني فاكتفى بإرادة اللوم منه وهو تالٍ لها ومسبب عنها.
وعليه قول الله تعالى {فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً} أي فضرب فانفجرت فاكتفى بالمسبب الذي هو الانفجار من السبب الذي هو الضرب.
وإن شئت أن تعكس هذا فتقول: اكتفى بالسبب الذي هو القول من المسبب الذي هو الضرب.
ومثله قوله: إذا ما الماء خالطها سخينا إن شئت قلت: اكتفى بذكر مخالطة الماء لها - وهو السبب - من الشرب وهو المسبب.
وإن شئت قلت اكتفى بذكر السخاء - وهو المسبب - من ذكر الشرب وهو السبب.
ومثله قول الله عز اسمه {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} أي فحلق فعليه ومنه قول رؤبة: يا رب إن أخطأت أو نسيت فأنت لا تنسى ولا تموت وذلك أن حقيقة الشرط وجوابه أن يكون الثاني مسبباً عن الأول نحو قوله: إن زرتني أكرمتك فالكرامة مسببة عن الزيارة وليس كون الله سبحانه غير ناس ولا مخطئا أمرا مسببا عن خطأ رؤبة ولا عن إصابته إنما تلك صفة له - عز اسمه - من صفات نفسه.
لكنه كلام محمول على معناه أي إن أخطأت أو نسيت فاعف عنى لنقصي وفضلك.
فاكتفى بذكر الكمال والفضل - وهو السبب - من العفو وهو المسبب.
ومثله بيت الكتاب: إني إذا ما جئت نار لمرملة ألفى بأرفع تل رافعا نارى وذلك أنه إنما يفخر ببروز بيته لقرى الضيف وإجارة المستصرخ كما أنه إنما يذم من أخفى بيته وضاءل شخصه بامتناعه من ذلك.
فكأنه قال إذاً: إني إذا منع غيري وجبن أعطيت وشجعت.
فاكتفى بذكر السبب - وهو التضاؤل والشخوص - من المسبب وهو المنع والعطاء.
ومنه بيت الكتاب: أي إن بخلت تركناها وانصرفنا عنها.
فاكتفى بذكر طيب الريح المعين على الارتحال عنها.
ومنه قول الآخر: فإن تعافوا العدل والإيمانا فإن في أيماننا نيرانا يعنى سيوفا أي فإنا نضركم بسيوفنا.
فاكتفى بذكر السيوف من ذكر الضرب بها.
وقال: يا ناق ذات الوخد والعنيق أما ترين وضح الطريق أي فعليك بالسير.
وأنشد أبو العباس: ذر الآكلين الماء ظلما فما أرى ينالون خيرا بعد أكلهم الماء وقال: هؤلاء قوم كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلون فقال: الآكلين الماء لأن ثمنه سبب أكلهم ما يأكلونه.
ومر بهذا الموضع بعض مولدى البصرة فقال: جزت بالساباط يوما فإذا القينة تلجم وهذا إنسان كانت له جارية تغنى فباعها واشترى بثمنها برذونا فمر به هذا الشاعر وهو يلجم فسماه قينة إذ كان شراؤه مسبباً عن ثمن القينة.
وعليه قول الله سبحانه: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} وإنما يعصر عنبا يصير خمرا فاكتفى بالمسبب الذي هو الخمر من السبب الذي هو العنب.
وقال الفرزدق: وإنما قتل حيا يصير بعد قتله قتيلا فاكتفى بالمسبب من السبب.
وقال: قد سبق الأشقر وهو رابض فكيف لا يسبق إذا يراكض يعنى مهرا سبقت أمه وهو في جوفها فاكتفى بالمسبب الذي هو المهر من السبب الذي هو الأم.
وهو كثير جداً.
فإذا مر بك فاضممه إلى ما ذكرنا منه: كثرة الثقيل وقلة الخفيف باب في كثرة الثقيل وقلة الخفيف هذا موضوع من كلامهم طريف.
وذلك أنا قد أحطنا علما بأن الضمة أثقل من الكسرة وقد ترى مع ذلك إلى كثرة ما توالت فيه الضمتان نحو طُنُب وعُنُق وفُنُق وحُشُد وجُمُد وسُهُد وطُنُف وقلة نحو إبل.
وهذا موضع محتاج إلى نظر.
وعلة ذلك عندى أن بين المفرد والجملة أشباها.
منها وقوع الجملة موقع المفرد من الصفة والخبر والحال.
فالصفة نحو مررت برجل وجهُه حسن.
والخبر نحو زيد قام أخوه.
والحال كقولنا: مررت بزيد فرسه واقفة.
ومنها أن بعض الجمل قد تحتاج إلى جملة ثانية احتياج المفرد إلى المفرد.
وذلك في الشرط وجزائه والقسم وجوابه.
فالشرط نحو قولك: إن قام زيد قام عمرو.
والقسم نحو قولك: أقسم ليقومن زيد.
فحاجة الجملة الأولى إلى الجملة الثانية كحاجة الجزء الأول من الجملة إلى الجزء الثاني نحو زيد أخوك وقام أبوك.
ومنها أن المفرد قد أوقع موقع الجملة في مواضع كنعم ولا لأن كل واحد من هذين الحرفين نائب عن الجملة ألا ترى إلى قولك: نعم في موضع قد كان ذاك ولا في موضع لم يكن ذاك وكذلك صه ومه وإيه وأف وآوتاه وهيهات: كل واحد منها جزء مفرد وهو قائم برأسه وليس للضمير الذي فيه استحكام الضمير في الفعل.
يدل على ذلك أنه لما ظهر في بعض أحواله ظهر مخالفا للضمير في الفعل وذلك قول الله سبحانه: {هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ} وأنت لا تقول في الفعل: اضربُم ولا ادخلُم ولا اخرجُم ولا نحو ذلك.
فلما كانت بين المفرد وبين الجملة هذه الأشباه والمقاربات وغيرها شبهوا توالي الضمتين في نحو سُرُح وعُلُط بتواليهما في نحو زيد قائم ومحمد سائر.
وعلى ذلك قال بعضهم: الحمدُ لُله فضم لام الجر إتباعا لضمة الدال وليس كذلك الكسر في نحو إبل لأنه لا يتوالى في الجملة الجرّان كما يتوالى الرفعان.
فإن قلت: فقد قالوا: الحمدِ لِله فوالوا بين الكسرتين كما والوا بين الضمتين قيل: الحمدُ لُله هو الأصل ثم شبه به الحمد لله ألا ترى أن إتباع الثاني للأول - نحو مُد وفِر وضَن - أكثر من إتباع الأول للثاني نحو: اُقتُل.
وإنما كان كذلك لأن تقدم السبب أولى من تقدم المسبب لأنهما يجريان مجرى العلة والمعلول وعلى أن ضمة الهمزة في نحو: اقتل لا تعتد لأن الوصل يزيلها فإنما هي عارضة وحركة نحو مُد وفِر وعَض ثابتة مستمرة في الوصل الذي هو العيار وبه الاعتبار.
وأيضا فإنه إذا انضم الأول وأريد تحريك الثاني كانت الضمة أولى به من الكسرة والفتحة.
أما الكسرة فلأنك تصير إلى لفظ فُعِل وهذا مثال لا حظَّ فيه للاسم وإنما هو أمر يخصّ الفعل.
وأما دُئل فشاذّ.
وقد يجوز أن يكون منقولا أيضا كبَدَّر وعَثَّر.
فإن قيل: فإن دئلا نكرة غير علم وهذا النقل إنما هو أمر يخص العلم نحو يشكر ويزيد وتغلب.
قيل: قد يقع النقل في النكرة أيضاً.
وذلك الينجلب.
فهذا منقول من مضارع انجلب الذي هو مطاوع جلبته ألا ترى إلى قولهم في التأخيذ: أخذته بالينجلب فلم يحر ولم يغب.
ومثله رجل أباترٌ.
وهو منقول من مضارع باترت فنقل فوصف به.
وله نظائر.
فهذا حديث فعل.
وأما فعل فدون فعل أيضاً.
وذلك أنه كثيراً ما يعدل عن أصول كلامهم نحو عمر وزفر وجشم وقثم وثعل وزحل.
فلما كان كذلك لم يتمكن عندهم تمكن فعل الذي ليس معدولا.
ويدلك على انحراف فعل عن بقية الأمثلة الثلاثية غير ذوات الزيادة انحرافهم بتكسيره عن جمهور تكاسيرها.
وذلك نحو جعلٍ وجعلان وصرد وصردان ونغر ونغران وسلك وسلكان فاطراد هذا في فعل مع عزته في غيرها يدلك على أن له فيه خاصية انفرد بها وعدل عن نظائره إليها.
نعم وقد ذهب أبو العباس إلى أنه كأنه منقوص من فعالٍ.
واستدل على ذلك باستمراره علىفعلان قال: فجرذان وصردان في بابه كغراب وغربان وعقاب وعقبان.
وإذا كان كذلك ففيه تقوية لما نحن عليه ألا ترى أن فعُالأ أيضاً مثال قد يؤلف العدل نحو أحاد وثناء وثلاث ورباع.
وكذلك إلى عشار قال: ولم يستريثوك حتى علو ت فوق الرجال خصالا عشارا ومما يسال عنه من هذا الباب كثرة الواو فاءً وقلة الياء هناك.
وذلك نحو وعد ووزن وورد ووقع ووضع ووفد على قلة باب يمن ويسر.
وذلك أن سبب كثرة الواو هناك أنك قادر متى انضمت أو انكسرت أن تقلبها همزة.
وذلك نحو أعد وأجوهٍ وأرقة واصلة وإسادة وإفادة.
وإذا تغير الحرف الثقيل فكان تارة كذا وأخرى كذا كان أمثل من أن يلزم محجة واحدة.
والياء إذا وقعت أولا و انضمت أو انكسرت لم تقلب همزة ولا غيرها.
فإن قلت فقد قالوا: باهلة بن أعصر ويعصر وقالوا: طاف والركب بصحراء يسر قيل: أما أعصر فهمزته هي الأصل والياء في يعصر بدل منها.
يدل على هذا أنه إنما بذلك لبيت قاله وهو: أبني إن أباك شيب رأسه كر الليالي واختلاف الأعصر فالياء في يعصر إذاً بدل من همزة أعصر.
وهذا ضد ما أردته وبخلاف ما توهمته.
وأما أسر ويسر فأصلان كل واحد منهما قائم بنفسه كيتن وأتن وألملم ويلملم.
وأما أديه ويديه فلعمري إن الهمزة فيه بدل من الياء بدلالة يديت إليه وأيدٍ ويدي ونحو ذلك لكنه ليس البدل من ضرب إبدال الواو همزة.
وذلك أن الياء مفتوحة والواو إذا كانت مفتوحة شذ فيها البدل نحو أناة وأجم.
فإذا كان هذا حديث الواو التي يطرد إبدالها فالياء حرى ألا يكون البدل فيها إلا لضرب من الاتساع وليس طريقه الاستخفاف والاستثقال.
فإن قلت: فالهمزة على كل حال أثقل من الواو فكيف عدل عن الأثقل إلى ما هو أثقل منه.
قيل الهمزة وإن كانت أثقل من الواو على الإطلاق فإن إذا انضمت كانت أثقل من الهمزة لأنه ضمتها تزيدها ثقلا.
فأما إسادة فإن الكسرة فيهما محمولة على الضمة في أقنت فلذلك قل نحو إسادة وكثر نحو أجوه وأرقة حتى أنهم قالوا في الوجنة: الأجنة فأبدلوها مع الضمة البتة ولم يقولوا: وجنة.
وأيضاً فإن الواو إذا وقعت بين ياء وكسرة في نحو يعد ويرد ويرد حذفت والياء ليست كذلك ألا ترى إلى صحتها في نحو ييعر وييسر وكأنهم إنما استكثروا مما هو معرض تارة للقلب.
أخرى للحذف وهذا غير موجود في الياء.
فلذلك قلت بحيث كثرت الواو.
فإن قلت: فقد كثر عنهم توالي الكسرتين في نحو سدراتٍ وكسراتٍ وعجلاتٍ.
قيل: هذا إنما احتمل لمكان الألف والتاء كما احتمل لها صحة الواو في نحو خطوات وخطوات.
ولأجل ذلك ما أجاز في جمع ذيت إذا سميت بها ذياتٍ بتخفيف الياء وإن كان يبقى معك من الاسم حرفان والثاني منهما حرف لين.
ولأجل ذلك ما صح في لغة هذيل قولهم: جوزات وبيضات لما كان التحريك أمرا عرض مع تاء جماعة المؤنث قال: أبو بيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح فهذا طريق من الجواب عما تقدم من السؤال في هذا الباب.
وإن شئت سلكت فيه مذهب الكتاب فقلت: كثر فعل وقل فعل وكثرت الواو فاء وقلت الياء هنالك لئلا يكثر في كلامهم ما يستثقلون.
ولعمري إن هذه محافلة في الجواب وربما أتعبت وترامت ألا ترى أن لقائل أن يقول: فإذا كان الأمر كذلك فهلا كثر أخف الأثقلين لاأثقلهما فكان يكون أقيس المذهبين لا أضعفهما.
وكذلك قولهم: سرت سوورا وغارت عينه غوورا وحال عن العهد حوولا هذا مع عزة باب سوك الإسحل وفي غوور وسوور فضل واو وهي فعول.
وجواب هذا أن الواو وإن زادت في عدة المعتد فإن الصوت أيضاً بلينها يلذ وينعم ألا ترى أن غوورا وحوولا وإن كان أطول من سوك وسور فإنه ليس فيه قلق سوك وسور فتوالي الضمتين مع الواو غير موف لك بلين الواو المنعمة للصوت.
يدل على ذلك أنهم إذا أضافوا إلى نحو أسيد حذفوا الياء المحركة فقالوا: أسيدي كراهية لتقارب أربع ياءات فإذا أضافوا إلى نحو مهييم لم يحذفوا فقالوا مهييمي فقاربوا بين خمس ياءات لما مطل الصوت فلان بياء المد.
وهذا واضح.
فمذهب الكتاب - على شرفه وعلو طريقته - يدخل عليه هذا.
وما قدمناه نحن فيه لا يكاد يعرض شيء من هذا الدخل له.
فاعرفه وقسه وتأت له ولا تحرج صدرا به.
باب القول على فوائت الكتاب
اعلم أن الأمثلة المأخوذة على صاحبه سنذكرها ونقول فيها ما يدحض عنه ظاهر معرتها لو صحت عليه.
ولو لم تكن فيها حيلة تدرأ شناعة إخلاله بها عنه لكانت معلاة له لا مزراة عليه وشاهدة بفضله ونقص المتتبع له بها لا نقصه إن كان أوردها مريداً بها حط رتبته والغض من فضيلته.
وذلك لكلفة هذا الأمر وبعد أطرافه وإيعار أكنافه أن يحاط بها أو يشتمل تحجر عليها.
وإن إنساناً أحاط بقاصي هذه اللغات المنتشرة وتحجر أذراءها المترامية على سعة البلاد وتعادي ألسنتها اللداد وكثرة التواضع بين أهليها من حاضر وباد حتى اغترق جميع كلام الصرحاء والهجناء والعبيد والإماء في أطرار الأرض ذات الطول والعرض ما بين منثور إلى منظومٍ ومخطوب به إلى مسجوع حتى لغات الرعاة الأجلاف والواعي ذوات صرار الأخلاف وعقلائهم والمدخولين وهذاتهم الموسوسين في جدهم وهزلهم وحربهم وسلمهم وتغاير الأحوال عليهم فلم يخلل من جميع ذلك - على سعته وانبثاثه وتناشره واختلافه - إلآ بأحرف تافهة المقدار متهافتةٍ على البحث والاعتبار - ولعلها أو أكثرها مأخوذة عمن فسدت ولنذكر ما أورد عليه معقباً به ولنقل فيه ما يحضرنا من إماطة الفحش به عنه بإذن الله.
ذكر الأمثلة الفائتة للكتاب وهي: تلقامة وتلعابة فِرناس فُرانس تنوفى ترجمان شحم أمهج مهوأن عياهم ترامز وتماضر ينابعات دحندح عفرين ترعاية الصنبر زيتون ميسون كذبذب وكذبذب هزنبزان عفزران هديكر هندلع درداقس خزرانق شمنصير مؤقٍ مأقٍ جبروة مسكين منديل حوريت ترقؤة خلبوت حيوت سمرطول قرعبلانة عقربان مألك إصري إزلزل إصبع خرفع زئبر ضئبل خرنباش زرنوق صعفوق كنادر الماطرون خزعال قسطال ويلمة فرنوس سراوع ضهيد عتيد الحبليل الأربعاوى مقبئن يرنأ تعفرت.
أما تلقامة وتلعابة فإنه وإن لم يذكر ذلك في الصفات فقد ذكر في المصادر تفعّلت تِعِفّالاً نحو تحملت تِحمالاً ومثله تقربت تِقراباً.
ولو أردت الواحدة من هذا لوجب أن تكون تِحمالة.
فإذا ذكر تفعالاً فكأنه قد ذكره بالهاء.
وذلك لأن الهاء زائدة أبداً في تقدير الانفصال على غالب الأمر.
وعلى الجملة فإن هذه الفوائت عند أكثر الناس إذا فحص عن حالها وتؤملت حق تأملها فمنها ما ليس قائله فصيحاً عنده.
ومنها لم يسمع إلا في الشعر.
والشعر موضع إضطرار وموقف اعتذار.
وكثيراً ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله ألا ترى قوله: أبوك عطاء ألأم الناس كلهم يريد عطية.
وقالت امرأة ترثي ابناً لها يقال له حازوق: أقلب طرفي في الفوارس لا أرى حزاقاً وعيني كالحجاة من القطر وأمثاله كثيرة.
وقد ذكرناها في فصل التحريف.
ومنها ما هو لازم له.
وعلى أنا قد قلنا في ذلك ودللنا به على أنه من مناقب هذا الرجل ومحاسنه: أن يستدرك عليه من هذه اللغة الفائضة السائرة المنتشرة ما هذا قدره وهذه حال محصوله.
وليس لقائل أن يدعى أن تِلِقامة وتلعابة في الأصل المرة الواحدة ثم وصف بها على حد ما يقال في المصدر يوصف به نحو قول الله سبحانه: {إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا} أي غائراً ونحو قولها: فإنما هي إقبالٌ وإدبار وما كان مثله من قبل أن من وصف بالمصدر فقال: هذا رجل زور وصوم ونحو ذلك فإنما ساغ ذلك لأنه أراد المبالغة وأن يجعله هو نفسه الحدث لكثرة ذلك منه والمرة الواحدة هي أقل القليل من ذلك الفعل فلا يجوز أن يريد معنى غاية الكثرة فيأتي لذلك بلفظ غاية القلة.
ولذلك لم يجيزوا: زيد إقبالة وإدبارة قياساً على زيد إقبال وإدبار.
فعلى هذا لا يجوز أن يكون قولهم: تِلِقامة على حد قولك: هذا رجل صوم لكن الهاء فيه كالهاء في علامة ونسابة للمبالغة.
وإذا كان كذلك فإنه قد كاد يفارق مذهب الصفة ألا ترى أن من شرط الصفة أن تطابق موصوفها في تذكيره وتأنيثه فوصف المذكر بالمؤنث ووصف المؤنث بالمذكر ليس متمكناً في الوصف تمكن وصف المونث بالمؤنث والمذكر بالمذكر.
فقولك إذاً: هذا رجل عليم أمكن في الوصف من قولك: هذا رجل علامة كما أن قولك: مررت بامرأة كافرة أمكن في الوصف من قولك: مررت بامرأة كفور.
وإذا كان كذلك جرى تِلِقامة من قولك مررت برجل تلقامة نحواً من مجرى مررت بنسوة أربع في أن أربعاً ليس بوصف متمكن ولذلك صرفته وإن كان صفة وصف على أفعل.
فكأن تلقامة بعد ذلك كله اسم لا صفة وإذا كان اسما أو كالاسم سقط الاعتذار منه لأن سيبويه قد ذكر في المصادر تفعّلت تِفِعالاً فإذا ذكره أغنى عن ذكره في الأبنية ولم يجز لقائل أن يذكره مثالاً معتداً عليه.
كما أن ترعاية في الصفات تسقط عنه أيضاً من هذا الوجه ألا تراه صفة مؤنثة جرت على موصوف مذكر فأوحش ذلك منها في الوصف وجرى لذلك مجرى: مررت برجال أربعة في أن أربعة ليس وصفاً محضاً وإنما هو اسم عدد بمنزلة نسوة أربع كما أن أربعة لما لم يخص المؤنث دون المذكر جرى لذلك مجرى الاسم فلذلك قالوا في جمعه: ربعات فحركوا كما يحركون الاسم نحو قصعات.
وإذا كان كذلك سقط عنه أيضاً أن لم يذكر تِفِعالا في الصفة.
وكذلك ما حكاه الأصمعي من قولهم ناقة تضراب لأنها لما كانت صفة مذكرة جارية على مؤنث لم تستحكم في الصفة.
وأما فِرناس فقد ذكره في الأبنية في آخر ما لحقته الألف رابعة مع غيرها من الزوائد.
وأما فُرانس فلعمري إنه لم يذكره.
وظاهر أمره أنه فُعانل من لفظ الفرس قال: أأن رأيت أسداً فرانساً الوجه كرهاً والحبين عابسا وأما تنوفى فمختلف في أمرها.
وأكثر أحوالها ضعف روايتها والاختلاف الواقع في لفظها.
وإنما رواها السكري وحده.
وأسندها إلى امرىء القيس في قوله: كأن دثاراً حلقت بلبونه عقاب تنوفى لا عقاب الفواعل والذي رويته عن أحمد بن يحيى: وقال القواعل إكام حولها وقال أبو حاتم: هي ثنية طيىء وهي مرتفعة.
وكذا رواها ابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني.
ورواية أبي عبيدة: تنوفى.
وأنا أرى أن تنوف ليست فعولاً بل هي تفعل من النوف وهو الارتفاع.
سميت بذلك لعلوها.
ومنه أناف على الشيء إذا ارتفع عليه والنيف في العدد من هذا هو فَيعَل بمنزلة صيب وميت.
ولو كسرت النيف على مذهب أبي الحسن لقلت: نياوف فأظهرت عينه.
فتنوف - في أنه علم على تفعل - بمنزلة يشكر ويعصر.
وقلت مرة لأبي علي - وهذا الموضع يقرأ عليه من كتاب أصول أبي بكر رحمه الله -: يجوز أن يكون تنوفى مقصورة من تنوفاء بمنزلة بروكاء فسمع ذلك وعرف صحته.
وكذلك القول عندي في مسولي في بيت المرار: فأصبحت مهموماً كأن مطيتي بجنب مسولي أو بوجرة ظالع ينبغي أن تكون مقصورة من مسولاء بمنزلة جلولاء.
فإن قلت: فإنا لم نسمع بتنوفى ولا مسولى ممدودين ولو كانا أو أحدهما ممدوداً لخرج ذلك إلى الاستعمال.
قيل: ولم يكثر أيضاً استعمال هذين الاسمين وإنما جاءا في هذين الموضعين.
بل لو كثر استعمالها مقصورين لصح ما أردته ولزم ما أوردته فإنه يجوز أن يكون ألف تنوفى إشباعاً للفتحة لا سيما وقد رويناه تنوف مفتوحاً كما ترى وتكون هذه الألف ملحقة مع الإشباع لإقامة الوزن ألا تراها مقابلة لياء مفاعيلن كما أن الألف في قوله: ينباع من ذفرى غضوب جسرة إنما هي إشباع للفتحة طلباً لإقامة الوزن ألا ترى أنه لو قال: ينبع من ذفرى لصح الوزن إلا أن فيه زحافاً هو الخزل كما أنه لو قال: تنوف لكان الجزء مقبوضاً.
فالإشباع إذاً في الموضعين إنما هو مخافة الزحاف الذي مثله جائز.
وأما ترجمان فقد حكى فيه ترجمان بضم أوله.
ومثاله فُعلُلان كعُترُفان ودُحمُسان وكذلك التاء أيضاً فيمن فتحها أصليةٌ وإن لم يكن في الكلام مثال جعفر لأنه قد يجوز مع الألف والنون من الأمثلة ما لولاهما لم يجز.
ومن ذلك عُنفُوان ألا ترى أنه ليس في الكلام فُعلُوٌ.
وكذلك خِنظِيان لأنه ليس في الكلام فِعلِيٌ إلا بالهاء نحو حِدرِية وعِفرِية كما أنه ليس فيه فُعلُو إلا بالهاء نحو عُنصُوة.
وكذلك الريهقان لأنه ليس في الكلام فَيعُل.
ونظير ذلك كثير.
فكذلك يكون ترجمان فَعلُلاناً وإن لم يكن في الكلام فَعلُل ومثله قوله: وما أيبلىٌ على هيكلٍ هو فَيعُلي لأنه قد يجىء مع ياءي الإضافة ما لولاهما لم يجىء نحو قولهم: تحوى في الإضافة إلى تحية وهو تفلى.
وأما شحم أمهج فلعمري إن سيبويه قد حظر في الصفة أفعل.
وقد يمكن أن يكون محذوفاً من أمهوج كأسكوب.
وجدت بخط أبي علي عن الفراء: لبن أمهوج.
فيكون أمهج هذا مقصوراً منه لضرورة الشعر وأنشد أبو زيد: يطعمها اللحم وشحماً أمهجا ولم نسمعه في النثر أمهجا.
وقد يقال: لبن أمهجان وماهج قال هميان بن قحافة: وعرضوا المجلس محضا ماهجا ويروى: وأروت المجلس وكنت قلت لأبي علي - رحمه الله - وقت القراءة: يكون أمهج محذوفاً من أمهوج فقبل ذلك ولم يأبه.
وقد يجوز أن يكون أمهج في الأصل اسماً غير صفة إلا أنه وصف به لما فيه من معنى الصفاء والرقة كما يوصف بالأسماء الضامنة لمعاني الأوصاف كما أنشد أبو عثمان من قول الراجز: مئبرة العرقوب إشفى المرفق فلولا الله والمهر المفدى لرحت وأنت غربال الإهاب فهذا كقولك: وأنت مخرق الإهاب وله نظائر.
وأما مهوأن ففائت للكتاب.
وذهب بعضهم إلى أنه بمنزلة مطمأن.
وهذا سهو ظاهر.
وذلك لأن الواو لا تكون أصلاً في ذوات الأربعة إلا عن تضعيف.
فأما ورنتل فشاذ.
فمهوأن إذاً مفوعل.
كأنه جارٍ على اهوأن.
وقد قالوا: اكوهد واقوهد وهو افوعل ونحوه قول الهذلي: فشايع وسط ذودك مقبئناً لتحسب سيداً ضبعاً تبول مقبئناً: منصباً.
فهذا مفعلل كما ترى.
وشبه هذا المجوز لأن يكون مهوأن بمنزلة مطمأن الواو فيه بالواو في غوغاء وضوضاء وليس هذا من خطأ أهل الصناعة لأن غوغاء وضوضاء من ذوات تضعيف الواو بمنزلة ضوضيت وقوقيت.
وقد يجوز من وجه آخر أن يكون واو مهوأن أصلاً.
وذلك بأن يكون سيبويه قد سأل جماعة من الفصحاء عن تحقير مهوأن على الترخيم فحذفوا الميم وإحدى النونين ولم يحذفوا الواو البتة مع حذفهم واو كوثر على الترخيم في قولهم: كثير وحذفهم واو جدول وقولهم: جديل وامتنعوا من حذف واو مهوأن فقطع سيبويه بأنها أصل فلم يذكره.
وإذا كان هذا جائزاً وعلى مذهب إحسان الظن به سائغاً كان فيه نصرة له و تجميل لأثره فاعرفه فتكون الواو مثلها في ورنتلٍ.
وكذلك يمكن أن يحتج بنحو هذا في فرانسٍ وكنادر فتكون النون فيهما أصلاً.
وأما عياهم فحاكيه صاحب العين وهو مجهول.
وذاكرت أبا علي - رحمه الله - يوماً بهذا الكتاب فأساء نثاه.
فقلت له: إن تصنيفه أصح وأمثل من تصنيف الجمهرة فقال: الساعة لو صنف إنسان لغة بالتركية تصنيفاً جيداً أكانت تعتد عربية لجودة تصنيفها أو كلاهما هذا نحوه.
وعلى أن صاحب العين أيضاً إنما قال فيها: وقال بعضهم: عياهمة وعياهم كعذافرة وعذافر.
فإن صح فهو فُياعل ملحق بعذافر وقلت فيه لأبي علي: يجوز أن تكون العين فيه بدلاً من همزة كأنه أياهم كأباتر وأحامر فقبل ذلك.
وأما تماضر وترامز فذهب أبو بكر إلى أن التاء فيهما زائدة.
ولا وجه لذلك لأنها في موضع عين عذافر فهذا يقضى بكونها أصلاً وليس معنا اشتقاق فيقطع بزيادتها.
قال أبو زيد: وهو الجمل القوي الشديد وأنشد: إذا أردت طلب المفاوز فاعمد لكل بازلٍ ترامز وذهب بعضهم في تماضر إلى أنه تُفاعل وأنه فعل منقول: كيزيد وتغلب.
ولا حاجة به إلى ذلك بل تماضر رباعي وتاؤه فاء كترامز.
فإن توهم ذلك لامتناع صرفه في قوله: فليس شيئا لأن تماضر علم مؤنث وهو اسم الخنساء الشاعرة.
وإنما منع الصرف لاجتماع التأنيث والتعريف كامرأة سميتها بعذافر وعماهج.
وهذا واضح.
وأما ينابعات فما أظرف أبا بكر أن أورده على أنه أحد الفوائت! ألا يعلم أن سيبويه قد قال: ويكون على يفاعل نحو اليحامد واليرامع.
فأما لحاق علم التأنيث والجمع به فزائد على المثال وغير محتسب به فيه وإن رواه راوٍ ينابعات فينابع يفاعل كيضارب ويقاتل نقل وجمع.
وأما دحندح فإنه صوتان: الأول منهما منون: دحٍ والآخر منهما غير منون: دح وكأن الأول نون للوصل.
ويؤكد ذلك قولهم في معناه: دح دح فهذا كصهٍ صهٍ في النكرة وصه صه في المعرفة.
فظنته الرواة كلمة واحدة.
ومن هنا قلنا: إن صاحب اللغة إن لم يكن له نظر أحال كثيراً منها وهو يرى أنه على صواب.
ولم يؤت من أمانته وإنما أتي من معرفته.
ونحو هذا الشاهد إذا لم يكن فقيها: يشهد بما لا يعلم وهو يرى أنه يعلم.
ولذلك ما استد عندنا أبو عمرو الشيباني.
لملازمته ليونس وأخذه عنه.
ومعنى هذه الكلمة فيما ذكر محمد بن الحسن أبو بكر: قد أقررت فاسكت وذكر محمد بن حبيب أن دحندح دويبة صغيرة: يقال: هو أهون علي من دحندح ومثل هذين الصوتين عندي قول الآخر: إن الدقيق يلتوى بالجنبخ حتى يقول بطنه جخٍ جخ وأما عفرين فقد ذكر سيبويه فعلا كطمر وحبر.
فكأنه ألحق علم الجمع كالبرحين والفتكرين.
إلا أن بينهما فرقاً.
وذلك أن هذا يقال فيه: البرحون والفتكرون ولم يسمع في عفرين الواو.
وجواب هذا أنه لم يسمع عفرين في الرفع يالياء وإنما سمع في موضع الجر وهو قولهم: ليث عفرين.
فيجب أن يقال فيه في الرفع: هذا عفرون.
لكن لو سمع في موضع الرفع بالياء لكان أشبه بأن يكون فيه النظر.
فأما وهو في موضع الجر فلا يستنكر فيه الياء.
وأما ترعاية فقد قيل فيه أيضا: رجل ترعية وترعاية.
وكان أبو علي صنع ترعاية فقال: أصلها ترعية ثم أبدلت الياء الأولى للتخفيف ألفا كقولهم في الحيرة: حارى.
وإذا كان ذاك أمرا محتملا لم يقطع بيقين على أنه مثال فائت في الصفات.
ولكن قد حكى الأصمعي: ناقة تضراب إذا ضربها الفحل.
فظاهر هذا أنه تفعال في الصفة كما ترى.
وقد ذكرنا ما فيه في أول الباب.
وأما الصنبر فقد كنت قلت فيه في هذا الكتاب في قول طرفة: بجفان تعترى نادينا وسديف حين هاج الصنبر ما قد مضى وإنه يرجع بالصنعة إلى أنه من نحو مررت ببكر.
وذهب بعضهم إلى أنه كسر الباء لسكونها وسكون الراء.
وفيه ضعف.
وذلك أن الساكنين إذا التقيا من كلمة واحدة حرك الآخر منهما نحو أمس وجير وأين وسوف ورب.
وإنما يحرك الأول منهما إذا كانا من فإن قلت: فالوزن اقتضى تحريك الأول قيل: أجل إلا أنه لم يقتضك فساد الاعتلال.
فإذا قلت ما قلنا نحن في هذا فيما مضى من كتابنا سلم على يديك وثلج به صدرك إن شاء الله.
فإن قلت: فقد قالوا في الوقف: ضربته.
قيل: هذا أمر يخص تاء التأنيث رغبة في الكسرة الدالة على التأنيث.
وأيضاً فإن التاء آخر الكلمة والهاء زائدة من بعدها ليست منها.
وكذلك القول في ادعه واغزه ألا ترى أن الهاء زائدة من بعد الكلمة.
وعلى أنه قد يجوز أن تكون الكسرة فيهما إنما هي على حد قولك: ادع واغز ثم لحقت الهاء.
ونحوه ما أنشده أبو سهل أحمد بن زياد القطان: كأن ريح دبرات خمس وظربانا بينهن يفسى ريح ثناياها بعيد النعس أراد: يفسو ثم حذف الواو استخفافا وأسكن السين والفاء قبلها ساكنة فكسر السين لالتقائهما ثم أشبع للإطلاق فقال: يفسى.
فاعرف ذلك.
وأما هزنبزان وعفزران فقد ذكرا في بعض نسخ الكتاب.
والهزنبزان السيء الخلق قال: لقد منيت بهزنبران لقد نسيت غفل الزمان وعفزران: اسم رجل.
وقد يجوز أن يكون أصله: عفزر كشعلع وعديس ثم ثنى وسمى به وجعلت النون حرف إعراب كما حكى أبو الحسن عنهم في اسم رجل: خليلان.
وكذلك أيضاً ذهب في قوله: ألا يا ديار الحي بالسبعان إلى أنه تثنية سبع وجعل النون حرف إعراب.
وليس لك مثل هذا التأويل في هزنبزان لأنه نكرة وصفة للواحد.
وهذا يبعده عن العلمية والتثنية.
وأما هديكر فقال أبو علي: سألت محمد بن الحسن عن الهيدكر فقال: لا أعرفه وأعرف الهيدكور.
قال أبو بكر: وإن سمع فلا يمتنع.
هذا حديث الهيدكر وأما الهديكر فغير محفوظ عنهم وأظنه من تحريف النقلة ألا ترى إلى بيت طرفة: فهى بداء إذا ما أقبلت فخمة الجسم رداح هيدكر وكأن الواو حذفت من هيدكور ضرورة.
فإذا جاز أن تحذف الواو الأصلية لذلك في قول الأسود بن يعفر.
فألحقت أخراهم طريق ألاهم كان حذف الزيادة أولى.
ويقال: تهدكرت المرأة تهدكرا في مشيها.
وذلك إذا ترجرجت.
وأما زيتون فأمره واضح وأنه فعلون ومثال فائت.
والعجب أنه في القرآن وعلى أفواه الناس للاستعمال.
وقد كان بعضهم قد تجشم أن أخذه من الزتن وإن كان أصلا مماتا فجعله فيعولا.
وصاحب هذا القول ابن كيسان أو ابن دريد: أحد الرجلين.
ومثل زيتون - عندي - ميسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد بن معاوية.
وكان سمعها تهجوه فقال لها: الحقي بأهلك.
وأما قيطون فإنه فيعول من قطنت بالمكان لأنه بيت في جوف بيت.
وأما الهندلع فبقلة وقيل: إنها غريبة ولا تنبت في كل سنة.
وما كانت هذه سبيله كان الإخلال بذكره قدرا مسموحا به ومعفوا عنه.
وإذا صح أنه من كلامهم فيجب أن تكون نونه زائدة لأنه لا أصل بإزائها فتقابله.
فهى إذا كنون كنتأل.
ومثال الكلمة على هذا: فنعلل.
ومن ادعى أنها أصل وأن الكلمة بها خماسية فلا دلالة له ولا برهان معه.
ولا فرق بين أن يدعى أصلية هذه النون وبين ادعائه أصلية نون كنتأل وكنهبل.
وأما كذبذب خفيفا وكذبذب ثقيلا ففائتان.
ونحوهما ما رويته عن بعض أصحابنا من قول بعضهم: ذرحرح في هذا الذرحرح بفتح الرائين أنشد أبو زيد: وإذا أتاك بأنني قد بعتها بوصال غانية فقل كذبذب ولسنا نعرف كلمة فيها ثلاث عينات غير كذبذب وذرحرح.
وقد أنشد بعض البغدادين قول الشاعر: بات يقاسي ليلهن زمام والفقعسي حاتم بن همام مسترعفات ليصللخم سام اللام الأولى هي الزائدة هنا لأنه لا يلتقي عينان إلا والأولى ساكنة وهذا مصنوع للضرورة يريد: لصلخم فاحتاج لإقامة الوزن فزاد على العينين أخرى فصار من فعل إلى فععل.
وأما الدرداقس فقيل فيه: إنه أعجمي وقال الأصمعي: أحسبه روميا وهو طرف العظم الناتئ فوق القفا.
وأنشد أبو زيد: من زل عن قصد السبيل تزايلت بالسيف هامته عن الدرداقس وكذلك الخزرانق أعجمي أيضا.
وهو فارسي يعنى به ضرب من ثياب الديباج.
ويجب أن تكون نونه زائدة إن كان الدرداقس أعجميا.
فإن كان عربيا فيجب أن تكون نونه أصلا لمقابلتها قاف درداقس العربي.
وأما شمنصير ففائت أيضا إن كان عربيا.
قال الهذلي: لعلك هالك إما غلام تبوأ من شمنصير مقاما وأما مؤقٍ فظاهر أمره أنه فعلٍ وفائت.
وقد يجوز أن يكون مخففاً من فعلي كأنه في الأصل مؤقي بمعنى مؤقٍ وزيدت الياء لا للنسب بل كزيادتها في كرسي وإن كانت في كرسي لازمة وفي مؤقي غير لازمة لقولهم فيه: مؤقٍ.
لكنها في أحمري وأشقري غير لازمة.
وأنشدنا أبو علي: كان حداء قراقريا يريد قراقرا وأنشدنا أيضاً للعجاج: غضف طواها لأمس كلابي أي كلاب يعنى صاحب كلاب وأنشدنا أيضاً له: والدهر بالإنسان دواري أي دوار إلا أن زيادة هذه الياء فى الصفة أكثر منها في الاسم لأن الغرض فيها توكيد الوصف.
ومثل مؤقٍ في هذه القضية ما رواه الفراء من قول بعضهم فيه: ماقٍ.
فيجب أيضاً أن يكون مخففاً من ثقيله.
وأما ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: يا من العين لم تذق تغميضا وماقيين اكتحلا مضيضا فمقلوب.
وذلك أنه أراد من المأق مثال فاعل فكان قياسه ماق إلا أنه قد قلبه إلى فالع فصار: مأقٍ بمنزلة شاكٍ ولاثٍ في شائك ولائث.
ومثله قوله: وأمنع عرسي أن يزن بها الخالى أراد: الخائل: فاعلا من الخيلاء.
وجبروة من قبل الكوفيين.
وهو فائت.
ومثاله فعلوة.
وأما مسكين ومنديل فرواهما اللحياني.
وذاكرت يوماً أبا علي بنوادره فقال: كناش.
وكان أبو بكر - رحمه الله - يقول: إن كتابه لا تصله به رواية قدحاً فيه وغضاً منه.
وأما حوريت فدخلت يوماً على أبي علي - رحمه الله - فحين رأنى قال: أين أنت! أنا أطلبك.
قلت: وما هو قال: ما تقول في حوريت فخضنا فيه فرأيناه خارجاً عن الكتاب.
وصانع أبو علي عنه بأنه قال: إنه ليس من لغة ابني نزار فأقل الحفل به لذلك.
وأقرب ما ينسب إليه أن يكون فعليتا قريباً من عفريت.
ونحوه ما أخبرنا به أبو علي من قول بعضهم في الخلبوت: الخلبوت وأنشد: ويأكل الحية والحيوتا وهو ذكر الحيات فهذان فعلوت.
وأما ترقؤة فبادي أمرها أنها فائتة لكونها فعلؤة.
ورويناها عن قطرب وذكر أنها لغة لبعض عكل.
ووجه القول عليها - عندي - أن تكون مما همز من غير المهموز بمنزلة استلأمت الحجر واستنشأت الرائحة - وقد ذكرنا ذلك في بابه - وأصلها ترقوة ثم همزت على ما قلناه.
وأما سمرطول فأظنه تحريف سمرطول بمنزلة عضرفوط ولم نسمعه في نثر.
قال: على سمرطولٍ نيافٍ شعشع وإذا استكرهوا في الشعر لإقامة الوزن خلطوا فيه قال: بسحبل الدفين عيسجور أراد سبحلا فغير كما ترى.
وله نظائر قد ذكرت في باب التحريف.
وقرعبلانة كأنها قرعبل ولا اعتداد بالألف والنون وما بعدهما.
ويدلك على إقلالهم الحفل بهما ادغامهم الإمدان كما يدغم أفعل من المضاعف نحو أرد وأشد ولو كانت الألف والنون معتدة لخرج بهما المثال عن وزن الفعل فوجب إظهاره كما يظهر ما خرج عن مثاله نحو حضض وسُرر وسَرر.
وعلى أن هذه اللفظة لم تسمع إلا من كتاب العين.
وهي - فيما ذكر - دويبة.
وفيه وجه آخر.
وهو أن الألف والنون قد عاقبتا تاء التأنيث وجرتا مجراها.
وذلك في حذفهم لهما عند إرادة الجمع كما تحذف ألا تراهم قالوا في استخلاص الواحد من الجمع بالهاء وذلك شعير وشعيرة وتمر وتمرة وبط وبطة وسفرجل وسفرجلة.
فكذلك انتزعوا الواحد من الجمع بالألف والنون أيضاً.
وذلك قولهم: إنس فإذا أرادوا الواحد قالوا: إنسان وظرب فإذا أراد الواحد قالوا: ظربان قال: قبحتم يا ظربا مجحره وكذلك أيضاً حذفوا الألف والنون لياءي الإضافة كما حذف التاء لهما قالوا في خراسان: خراسي كما يقولون في خراشة: خراشي.
وكسروا أيضاً الكلمة على حذفهما كما يكسرونها على حذف التاء.
وذلك قولهم: كَروان وكِروان وشَقذان وشِقذان كما قالوا: بَرق وبِرقان وخرب خربان.
فنظير هذا قولهم: نعمة وأنعم.
وشدة وأشد عنده سيبويه.
فهذا نظير ذئب وأذؤب وقطع وأقطع وضرس وأضرس قال: وقرعن نابك قرعة بالأضرس وقالوا أيضاً: رجل كذبذب وكذبذبان حتى كأنهما مثال واحد كما أن دماً ودمة وكوكباً وكوكبة مثال واحد.
ومثله الشعشع والشعشان والهزنبر والهزنبران والفرعل والفرعلان.
فلما تراسلت الألف والنون والتاء في هذه المواضع وغيرها جرتا مجرى المتعاقبتين فإذا التقتا في مثال واحد ترافعتا أحكامهما على ما قدمناه في ترافع الأحكام.
فكذلك قرعبلانة لما اجتمعت عليه التاء مع الألف والنون ترافعتا أحكامهما فكأن لا تاء هناك ولا ألف ولا نوناً فبقى الاسم على هذا كأنه قرعبل.
وذلك ما أردنا بيانه.
فاعرفه.
وأما عقربان مشدد الباء فلك فيه أمران: إن شئت قلت: إنه لا اعتداد بالألف والنون فيه - على ما مضى - فيبقى حينئذ كأنه عقرب بمنزلة قسقب وقسحب وطرطب.
وإن شئت ذهبت مذهبا أصنع من هذا.
وذلك أنه قد جرت الألف والنون من حيث ذكرنا في كثير من كلامهم مجرى ما ليس موجوداً على بيننا.
وإذا كان كذلك كانت الباء لذلك كأنها حرف الإعراب وحرف الإعراب قد يلحقه التثقيل في الوقف نحو هذا خالد وهو يجعل.
ثم إنه قد يطلق ويقر تثقيله عليه نحو الأضخما وعيهل.
فكأن عقرباناً لذلك عقرب ثم لحقتها التثقيل لتصور معنى الوقف عليها عند اعتقاد حذف الألف و النون من بعدها فصارت كأنها عقرب ثم لحقها الألف والنون فبقي على تثقيله كما بقى الأضخما عند إطلاقه على تثقيله إذا أجرى الوصل مجرى الوقف فقيل: عقربان على ما شرحنا وأوضحنا.
فتأمله ولا يجف عليك ولا تنب عنه فإن له نظيراً بل نظراء ألا تراهم قالوا في الواحد: سيد فإذا أرادوا الواحدة قالوا سيدانة فألحقوا علم التأنيث بعد الألف والنون وإنما يجب أن يلحق بعد حرف إعراب المذكر كذئب وذئبة وثعلب وثعلبة وقد ترى إلى قلة اعتدادهم بالألف والنون في سيدانة حتى كأنهم قالوا: سيدة.
وهذا تناهٍ في إضعاف حكم الألف والنون.
وقد قالوا: الفرعل والفرعلان والشعشع والشعشعان والصحصح والصحصحان بمعنى واحد فكأن اللفظ لم يتغير.
ومثل التثقيل في الحشو لنية الوقف ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر: غضٌ نجارى طيب عنصري فثقل الراء من عنصري وإن كانت الكلمة مضافة إلى مضمر.
وهذا يحظر عليك الوقوف على الراء كما يثقلها في عنصر نفسه.
ومثله أيضاً قول الآخر: ياليتها قد خرجت من فمه فثقل آخر الكلمة وهي مضافة إلى مضمر فكذلك حديث عقربان.
فاعرفه فإنه غامض.
وأما مألك فإنه أراد: مألكة فحذف الهاء ضرورة كما حذفها الآخر من قوله: إنا بنو عمكم لا أن نباعلكم لا نصالحكم إلا على ناح أراد: ناحية.
وكذلك قوله الآخر: ليوم روع أو فعال مكرم أراد: مكرمة وقول الآخر: أراد: أي معونة فحذف التاء.
وقد كثر حذفها في غير هذا.
وأما أصرى فإن أبا العباس استدركها.
وقال: وقد جاءت أيضا إصبع.
وحدثنا أبو علي قال: قال إبراهيم الحربي: في إصبع وأنملة جميع ما يقول الناس.
ووجدت بخط أبي علي: قال الفراء: لا يلتفت إلى ما رواه البصريون من قولهم: إصبع فإنا بحثنا عنها فلم نجدها.
وقد حكيت أيضا: زئبر وضئبل وخرفع وجميع ذلك شاذ لا يلتفت إلى مثله لضعفه في القياس وقلته في الاستعمال.
ووجه ضعف قياسه خروجك من كسر إلى ضم بناء لازما وليس بينهما إلا الساكن.
ونحو منه ما رويناه عن قطرب من قول بعضهم في الأمر: اقتل اعبد.
ونحو منه في الشذوذ عن الاستعمال قول بعضهم: إزلزل وهي كلمة تقال عند الزلزلة.
وينبغي أن تكون من معناها وقريبة من لفظها ولا تكون من حروف الزلزلة.
وإنما حكمنا بذلك لأنها لو كانت منها لكانت إفعلل فهو مع أنه مثال فائت فيه بلية من جهة أخرى.
وذلك أن ذوات الأربعة لا تدركها الزيادة من أولها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو مدحرج وليس إزلزل من ذلك.
فيجب أن تكون من لفظ الأزل ومعناه.
ومثاله فعلعل نحو كذبذب فيما مضى.
وأما مد المقصور وقصر الممدود والإشباع والتحريف فلا تعتد أصولا ولا تثبت بها مثل وقال: الفعلال لا يأتي إلا مضاعفا نحو القلقال والزلزال.
وحكى الفراء: ناقة بها خزعال أي داء.
وقال أوس: ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا والخيل خارجة من القسطال وقد يمكن أن يكون أراد: القسطل فاحتاج فأشبع الفتحة على قوله: ينباع من ذفرى.
وقد جاء في شعر ابن ذريح سراوع اسم مكان قال: عفا سرفٌ من أهله فسراوع وقالوا: جلس الأربعاوي.
وجاء الفرنوس في أسماء الأسد.
والحبليل: دويبة يموت فإذا أصابه المطرعاش.
وقالوا: رجل ويلمة وويلم للداهية.
وهذا خارج على الحكاية أي يقال له من دهائه: ويلمه ثم ألحقت الهاء للمبالغة كداهية ومنكرة.
وقد رووا قوله: وجلنداء في عمان مقيما وإنما هو: جلندى مقصورا.
وكذلك ما أنشده من قول رؤبة: حملوه على فيعل مما اعتلت عينه.
وهو شاذ.
وأوفق من هذا - عندي - أن يكون: فوعلا أو فعولا حتى لا يرتكب شذوذه.
وكأن الذي سوغهم هذا ظاهر الأمر وأنه أيضا قد روى العين بكسر العين.
وكذلك طيلسان مع الألف والنون: فيعل في الصحيح على أن الأصمعي قد أنكر كسر اللام.
وذهب أحمد بن يحيى وابن دريد في يستعور إلى أنه يفتعول.
وليس هذا من غلط أهل الصناعة.
وكذلك ذهب ابن الأعرابي في يوم أرونانٍ إلى أنه أفوعال من الرنة وهذا كيستعورٍ في الفساد.
ونحوه في الفساد قول أحمد بن يحيى في أسكفة: إنها من استكف وقوله في تواطخ القوم: إنه من الطيخ وهو الفساد.
وقد قال أمية: إن الأنام رعايا الله كلهم هو السليطيط فوق الأرض مستطر ويروى السلطليط وكلاهما شاذ.
وأما صعفوق فقيل: إنه أعجمي.
وهم خول باليمامة قال العجاج: من آل صعفوقٍ وأتباعٍ أخر وقد جاء في شعر أمية بن أبي عائذ: مطاريح بالوعث مر الحشو ر هاجرن رماحه زيزفونا يعنى قوسا.
وهي في ظاهر الأمر: فيفعول من الزفن لأنه ضرب من الحركة مع صوت.
وقد يجوز أن يكون زيزفون رباعيا قريبا من لفظ الزفن.
ومثله من الرباعي ديدبون.
وأما الماطرون فذهب أبو الحسن إلى أنه رباعي.
واستدل على ذلك بكسر النون مع الواو ولو كانت زائدة لتعذر ذلك فيها.
ومثله الماجشون وهي ثياب مصبغة قال: طال ليلى وبت كالمحزون واعترتني الهموم بالماطرون وقال أمية الهذلي أيضا: ويخفى بفيحاء مغبرة تخال القتام به الماجشونا وينبغي أن يكون السقلاطون على هذا خماسيا لرفع النون وجرها مع الواو.
وكذلك أيضا نون أطرنون قال: وإن يكن أطربون قطعها فإن فيها بحمد الله منتفعا والكلمة بها خماسية كعضرفوط.
وضهيد: اسم موضع.
ومثله عتيد.
وكلاهما مصنوع.
وقيل: الخرنباش: نبت طيب الريح قال: وقد يمكن أن يكون في الأصل خرنبش ثم أشيعت فتحته فصار: خرنباش.
وحكى أبو عبيدة القهو باة.
وقد قال سيبويه: ليس في الكلام فعولى.
وقد يمكن أن يحتج له فيقال: قد يأتي مع الهاء ما لولا هي لما أتى نحو ترقوة وحذرية.
وأنشد ابن الأعرابي: إن تك ذا بز فإن بزى سابغةٌ فوق وأي إوز قال أبو علي: لا يكون إوز من لفظ الوز لأنه قد قال: ليس في الكلام إفعل صفة.
وقد يمكن - عندى - أن يكون وصف به لتضمنه معنى الشدة كقوله: لرحت وأنت غربال الإهاب وقد مضى ذكره.
ويجوز أيضا أن يكون كقولك: مررت بقائمٍ رجلٍ.
وقال أبو زيد: الزونك: اللحيم القصير الحياك في مشيه.
زاك يزوك زوكانا.
فهذا يدل على أنه فعنل.
وقيل: الضفنط من الضفاطة وهو الرجل الضخم الرخو البطن.
وأما زونزك فإنه فونعل فيجب أن يكونا من أصلين.
وأما زوزى فإنه من مضاعف الواو.
وهو فعلل كعدبس.
وحكى أبو زيد زرنوق بفتح الزاى فهذا فعنول.
وهو غريب.
وجميع هذا شاذ.
وقد تقدم في أول الباب وصف حاله ووضوح العذر في الإخلال به وقالوا: تعفرت الرجل.
فهذا تفعلت.
وقالوا: يرنأ لحيته إذا صبغها باليرنأ وهو الحناء وهذا يفعل في الماضي.
وما أغربه وأظرفه.
باب في الجوار
وذلك في كلامهم على ضربين: أحدهما تجاور الألفاظ والآخر تجاور الأحوال.
فاما تجاور الألفاظ فعلى ضربين: أحدهما في المتصل والآخر في المنفصل.
فأما المتصل فمنه مجاورة العين للام بحملها على حكمها.
وذلك قولهم في صوم: صيم ألا تراه قال: إنهم شبهوا باب صوم بباب عصى فقلبه بعضهم.
ومثله قولهم في جوع: جيع قال: بادرت طبختها لرهط جيع وأنشدوا: لولا الإله ما سكنا خضما ولا ظللنا بالمشاء قيما وعليه ما أنشده محمد بن حبيب من قوله: بريذينة بل البراذين ثفرها وقد شربت من آخر الصيف أيلا أجاوز فيه أن يكون أراد: جمع لبن آئل أي خاثر من قولهم: آل اللبن يئول إذا خثر فقلبت العين حملا على قلب اللام كما تقدم.
لحب لمؤقدان إلي مؤسى وقد ذكرنا أنه تصور الضمة - لمجاورتها الواو - أنها كأنها فيها فهمزها كما تهمز في أدؤرٍ والنؤور ونحو ذلك.
وعليه أيضا أجازوا النقل لحركة الإعراب إلى ما قبلها في الوقف نحو هذا بكر ومررت ببكر ألا تراها لما جاورت اللام بكونها في العين صارت لذلك كأنها في اللام لم تفارقها.
وكذلك أيضا قولهم: شابة ودابة صار فضل الاعتماد بالمد في الألف كأنه تحريك للحرف الأول المدغم حتى كأنه لذلك لم يجمع بين ساكنين.
فهذا نحو من الحكم على جوار الحركة للحرف.
ومن جوار المتصل استقباح الخليل نحو العقق مع الحمق مع المخترق.
وذلك لأن هذه الحركات قبل الروى المقيد لما جاورته وكان الروى في أكثر الأمر وغالب العرف مطلقا لا مقيدا صارت الحركة قبله كأنها فيه فكاد يلحق ذلك بقبح الإقواء.
وقد تقدم ذكر نحو هذا.
وله نظائر.
وأما الجوار في المنفصل فنحو ما ذهبت الكافة إليه في قولهم: هذا حجر ضب خرٍب وقول الحطيئة: فإياكم وحية بطن واد هموز الناب ليس لكم بسى كأن نسج العنكبوت المرمل وإنما صوابه المرملا وأما قوله: كبير أناس في بجاد مزمل فقد يكون أيضا على هذا النحو من الجوار.
فأما عندنا نحن فإنه أراد: مزمل فيه فحذف حرف الجر فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول.
وقد ذكرنا هذا أيضا.
وتجد في تجاور المنفصلين ما هو لاحق بقبيل المنفصل الذي أجرى مجرى المتصل في نحو قولهم: ها الله ذا أجروه في الادغام مجرى دابة وشابة ومنه قراءة بعضهم: { فلا تناجوا } و {حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا} بإثبات الألف في ذا ولا.
ومنه ما رأيته أنا في إنشاد أبي زيد: من أي يومى من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر أعنى فتح راء يقدر.
وقد ذكرته.
فهذا طريق تجاور الألفاظ وهو باب.
وأما تجاور الأحوال فهو غريب.
وذلك أنهم لتجاور الأزمنة ما يعمل في بعضها ظرفا ما لم يقع فيه من الفعل وإنما وقع فيما يليه نحو قولهم: أحسنت إليه إذا أطاعني وأنت لم تحسن إليه في أول وقت الطاعة وإنما أحسنت إليه في ثاني ذلك ألا ترى أن الإحسان مسبب عن الطاعة وهي كالعلة له ولا بد من تقدم وقت السبب على وقت المسبب كما لا بد من ذلك مع العلة.
لكنه لما تقارب الزمانان وتجاورت الحالان في الطاعة والإحسان أو الطاعة واستحقاق الإحسان صارا كأنهما إنما وقعا في زمان واحد.
ودليل ذلك أن لما من قولك: لما أطاعني أحسنت إليه إنما هي منصوبة بالإحسان وظرف له كقولك: أحسنت إليه وقت طاعته وأنت لم تحسن إليه لأول وقت الطاعة وإنما كان الإحسان في ثاني ذلك أو ما يليه ومن شرط الفعل إذا نصب ظرفا أن يكون واقعا فيه أو في بعضه كقولك: صمت يوما وسرت فرسخا وزرتك يوم الجمعة وجلست عندك.
فكل واحد من هذه الأفعال واقع في الظرف الذي نصبه لا محالة ونحن نعلم أنه لم يحسن إليه إلا بعد أن أطاعه لكن لما كان الثاني مسببا عن الأول وتاليا له فاقتربت الحالان وتجاور الزمانان صار الإحسان كأنه إنما هو والطاعة في زمان واحد فعمل الإحسان في الزمان الذي يجاور وقته كما يعمل في الزمان الواقع فيه هو نفسه.
فاعرفه.
ومثله: لما شكرني زرته ولما استكفاني كفيته وزرته إذ استزارني وأثنيت عليه حين أعطاني وإذا أتيته رحب بي وكلما استنصرته نصرني أي كل وقت أستنصره فيه ينصرني وإنما ينصرك فيما بعد زمان الاستنصار.
ويؤكد عندك حال إتباع الثاني للأول وأنه ليس معه في وقته دخول الفاء في هذا النحو من الكلام كقولك: إذا سألته فإنه يعطيني وإذا لقيته فإنه يبش بي.
فدخول الفاء هنا أول دليل على التعقيب وأن الفعلين لم يقعا معا في زمان واحد.
وقد ذكرنا هذا ليزداد القول به وضوحا وإن كان ما مضى كافيا.
ولما اطرد هذا في كلامهم وكثر على ألسنتهم وفي استعمالهم تجاوزوه واتسعوا فيه إلى ما تناءت حالاه وتفاوت زماناه.
وذلك كأن يقول رجل بمصر في رجل آخر بخراسان: لما ساءت حاله حسنتها ولما اختلت معيشته عمرتها.
ولعله أن يكون بين هاتين الحالين السنة والسنتان.
فإن قلت فلعل هذا مما اكتفى فيه بذكر السبب - وهو الاختلال - من ذكر المسبب عنه وهو المعرفة بذلك فيصير كأنه قال: لما عرفت اختلال حاله عمرتها.
قيل: لو كان الأمر على ذلك لما عدوت ما كنا عليه ألا ترى أنه قد يعرف ذلك من حال صاحبه وهو معه في بلد واحد بل منزل واحد فيكون بين المعرفة بذلك والتغيير له الشهر والشهران والأكثر.
فكيف بمن بينه وبينه الشقة الشاسعة المحتاجة إلى المدة المتراخية.
فإن قيل: فيكون الثاني من هذا كالأول أيضا في الاكتفاء فيه بالمسبب من السبب أي لما عرفت ذلك فكرت في إصلاحه فاكتفى بالمسبب الذي هو العمارة من السبب الذي هو الفكر فيه قيل: هذا وإن كان مثله مما يجوز فإنه ترك للظاهر وإبعاد في المتناول.
ومع هذا فإنك كيف تصرفت بك الحال إنما أوقعت الفكر في عمارة حاله بعد أن عرفت ذلك منها.
فوقعت العمارة إذاً بعد وقت المعرفة.
فإذا كان كذلك ركبت سمت الظاهر فغنيت به عن التطال والتطاول.
وعلى هذا يتوجه عندى قول الله - سبحانه -: {وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} وذلك أن تجعل إذ بدلا من قوله اليوم وإلا بقيت بلا ناصب.
وجاز إبدال إذ - وهو ماض في الدنيا - من قوله: اليوم وهو حينئذ حاضر في الآخرة لما كان عدم الانتفاع بالاشتراك في العذاب إنما هو مسبب عن الظلم وكانت أيضا الآخرة تلى الدنيا بلا وقفة ولا فصل صار الوقتان على تباينهما وتنائيهما كالوقتين المقترنين الدانيين المتلاصقين نحو أحسنت إليه إذ شكرني وأعطيته حين سألني.
وهذا أمر استقر بيني وبين أبي علي - رحمه الله - مع الباحثة.
وقد يجوز أيضا أن تنصب اليوم بما دل عليه قوله تعالى: {مُشْتَرِكُونَ} فيصير معناه لا إعرابه: ولن ينفعكم إذ ظلمتم اشتراككم اليوم في العذاب فينتزع من معنى {مُشْتَرِكُونَ} ما يعمل في اليوم على حد قولنا في قوله - سبحانه - {أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} في أحد الأقوال الثلاثة فيه وعلى قوله تعالى: {يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ} وإذ أنت فعلت هذا أيضا لم تخرج به من أن يكون إذ ظلمتم في اللفظ معمولا لقوله لن ينفعكم لما ذكرنا من الجوار وتلو الآخرة الأولى بلا فصل.
وكأنه إنما جاء هذا النحو في الأزمنة دون الأمكنة من حيث كان كل جزء من الزمان لا يجتمع مع جزء آخر منه إنما يلي الثاني الأول خالفا له وعوضا منه.
ولهذا قيل - عندى - للدهر عوض - وقد ذكرت هذا في كتابي في التعاقب - فصار الوقتان كأنهما واحد وليس كذلك المكان لأن المكانين يوجدان في الوقت الواحد بل في أوقات كثيرة غير منقضية.
فلما كان المكانان بل الأمكنة كلها تجتمع في الوقت الواحد والأوقات كلها لم يقم بعضها مقام بعض ولم يجر مجراه.
فلهذا لا نقول: جلست في البيت من خارج أسكفته وإن كان ذلك موضعا يجاور البيت ويماسه لأن البيت لا يعدم فيكون خارج بابه نائبا عنه وخالفا في الوجود له كما يعدم الوقت فيعوض منه ما بعده.
فإن قلت: فقد تقول: سرت من بغداد إلى البصرة نهر الدير قيل: ليس هذا من حديث الجوار في شيء وإنما هو من باب بدل البعض لأنه بعض طريق البصرة يدل على ذلك أنك لا تقول: سرت من بغداد إلى البصرة نهر الأمير لأنه أطول من طريق البصرة زائدة عليه والبدل لا يجوز إذا كان الثاني أكثر من الأول كما يجوز إذا كان الأول أكثر من الثاني ألا ترى أنهم لم يجيزوا أن يكون ربع من قوله: اعتاد قلبك من سلمى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطلل بدلا من الطلل من حيث كان الربع أكثر من الطلل.
ولهذا ما حمله سيبويه على القطع والابتداء دون البدل والإتباع هذا إن أردت بالبصرة حقيقة نفس البلد.
فإن أردت جهتها وصعقها جاز: انحدرت من بغداد إلى البصرة نهر الأمير.
وغرضنا فيما قدمناه أن تريد بالبصرة نفس البلد البتة.
وهذا التجاور الذي ذكرناه في الأحوال والأحيان لم يعرض له أحد من أصحابنا.
وإنما ذكروا تجاور الألفاظ فيما مضى.
وقد مر بنا شيء من هذا النحو في المكان قال: وهم إذا الخيل جالوا في كواثبها وإنما يجول الراكب في صهوة الفرس لا في كاثبته لكنهما لما تجاورا جريا مجرى الجزء الواحد.
باب في نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها
منها رأيت أبا علي - رحمه الله - معتمدا هذا الفصل من العربية ملما به دائم التطرق له والفزع فيما يحدث إليه.
وسنذكر من أين أنس به حتى عول في كثير من الأمر عليه.
وذلك كقولنا: بأبأت بالصبى بأبأة وبئباء إذا قلت له: بئبا.
وقد علمنا أن أصل هذا أن الباء حرف جر والهمزة فاء الفعل فوزن هذا على هذه المقدمة: بفبفت بفبفة وبفبافا إلا أنا لا نقول مع هذا: إن هذه المثل على ما ترى لكن نقول: إن بأبأت الآن بمنزلة رأرأت عيناه وطأطأت رأسي ونحو ذلك مما ليس متنزعا ولا مركبا.
فمثاله إذا: فعللت فعللة وفعلالا كدحرجت دحرجة ودحراجا.
ومن ذلك قولهم: الخاز باز.
فالألف عندنا فيهما أصل بمنزلة ألف كافٍ ودال.
وذلك لأنها أسماء مبينة وبعيدة عن التصرف والاشتقاق.
فألفاتها إذاً أصول فيها كألفات ما ولا وإذا وألا وإلا وكلا وحتى.
ثم إنه قال: ورمت لهازمها من الخزباز فالخزباز الآن بمنزلة السربال والغربال وألفه محكوم عليها بالزيادة كألفهما ألا ترى الأصل كيف استحال زائدا كما استحالت باء الجر الزائدة في بأبي أنت فاء في بأبأت بالصبى.
وكذلك أيضا استحالت ألف قافٍ ودالٍ ونحوهما وأنت تعتقد فيها كونها أصلا غير منقلبة إلى اعتقادك فيها القلب لما اعتزمت فيها الاشتقاق.
وذلك قولك: قوفت قافا ودولت دالا.
وسألني أبو علي - رحمه الله - يوما عن إنشاد أبي زيد: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا فقال: ما تقول في هذه الألف من قوله: بالا يعنى الأولى.
فقلت: أصل لأنها كألف ما ولا ونحوهما.
فقال: بل هي الآن محكوم عليها بالانقلاب كألف باب ودار.
فسألته عن علة ذلك فقال: لما خلصت بها لام الجر من بعدها وحسن قطعها والوقوف عليها والتعليق لها في قوله: يا لا أشبهت يال هذه الكلمة الثلاثية التي عينها ألف فأوجب القياس أن يحكم عليها بأنها كباب وساق ونحو ذلك.
فأنقت لذلك وذهب بي استحساني إياه كل مذهب.
وهذا الحديث الذي نحن الآن عليه هو الذي سوغ عندى أن يكتب نحو قوله: يال بكر أنشروا لي كليبا ونحو ذلك مفصولة اللام الجارة عما جرته.
وذلك أنها حيزت إلى يا من قبلها حتى صارت يال كباب ودار وحكم على ألفها من الانقلاب بما يحكم به على العينات إذا كن ألفات.
وبهذا أيضا نفسه يستدل على شدة اتصال حروف الجر بما تدخل عليه من الأفعال لتقويه فتعديه نحو مررت بزيد ونظرت إلى جعفر ألا ترى أن لام الجر في نحو يالزيد دخلت موصلة ليا إلى المنادى كما توصل الباء الفعل في نزلت بك وظفرت به.
وقد تراها محوزة إلى يا حتى قال يالا فعلق حرف الجر ولو لم يكن لاحقا بيا وكالمحتسب جزءا منها لما ساغ تعليقه دون مجروره نحو قوله: يال بكر ويال الرجال ويال الله و: يالك من قبرة بمعمر ونحو ذلك.
فاعرفه غرضا اعتن فيما كنا فيه فقلنا عليه.
وإن فسح في المدة أنشأنا كتابا في الهجاء وأودعناه ما هذه سبيله وهذا شرحه مما لم تجر عادة بإيداع مثله.
ومن الله المعونة.
ومما كنا عليه ما حكاه الأصمعي من أنهم إذا قيل لهم هلم إلى كذا فإذا أرادوا الامتناع منه قالوا: لا أهلم فجاءوا بوزن أهريق وإنما هاء هلم ها في التنبيه في نحو هذا وهذه ألا ترى إلى قول الخليل فيها: إن أصلها هالم بنا ثم حذفت الألف تخفيفا وهاء أهريق إنما هي بدل من همزة أرقت لما صارت إلى هرقت وليست من حديث التنبيه في قبيل ولا دبير.
ومن ذلك قولهم في التصويت: هاهيت وعاعيت وحاحيت فهذه الألف عندهم الآن في موضع العين ومحكوم عليها بالانقلاب وعن الياء أيضا وإن كان أصلها ألفا أصلا في قولهم: هاء وعاء وحاء.
فهي هنا كألف قاف وكاف ودال ولام أصل غير زائدة ولا منقلبة وهي في هاهيت وأختيها عين منقلبة عن ياء عندهم أفلا ترى إلى استحالة التقدير فيها وتلعب الصنعة بها.
ونحو من ذلك قولهم: دعدعت بالغنم إذا قلت لها: داع داع وجهجهت بالإبل إذا قلت لها: جاه جاه فجرى دعدعت وجهجهت عندهم الآن مجرى قلقلت وصلصلت ولو راعيت أصولها وعملت على ملاحظة أوائل أحوالها لكانت فلفلت لأن الألف التي هي عين عند تجشم التمثيل في داع وجاه قد حذفت ودعدعت وجهجهت.
وقد كنت عملت كتاب الزجر عن ثابت بن محمد وشرحت أحوال تصريف ألفاظه واشتقاقها فجاء منه شيء صالح وطريف.
وإذا ضممته إلى هذا الفصل كثر به وأنس بانضمامه إليه.
باب في الامتناع من نقض الغرض
اعلم أن هذا المعنى الذي تحامته العرب - اعنى امتناعها من نقض أغراضها - يشبه البداء الذي تروم اليهود إلزامنا إياه في نسخ الشرائع وامتناعهم منه إلا أن الذي رامته العرب من ذلك صحيح على السبر والذي ذهبوا هم إليه فاسد غير مستقيم.
وذلك أن نسخ الشرائع ليس ببداءٍ عندنا لأنه ليس نهيا عما أمر الله تعالى به وإنما هو نهى عن مثل ما أمر الله تعالى به في وقت آخر غير الوقت الذي كان - سبحانه - أمر بالأول فيه ألا ترى أنه - عز اسمه - لو قال لهم: صوموا يوم كذا ثم نهاهم عن الصوم فيه فيما بعد لكان إنما نهاهم عن مثل ذلك الصوم لا عنه نفسه.
فهذا ليس بداء.
لكنه لو قال: صوموا يوم الجمعة ثم قال لهم قبل مضيه: لا تصوموه لكان - لعمري - بداء وتنقلا والله - سبحانه - يجل عن هذا لأن فيه انتكاثا وتراجعا واستدراكا وتتبعا.
فكذلك امتناع العرب من نقض أغارضها هو في الفساد مثل ما نزهنا القديم - سبحانه - عنه من البداء.
فمن ذلك امتناعهم من ادغام الملحق نحو جلبب وشملل وشربب ورمدد ومهدد وذلك أنك إنما أردت بالزيادة والتكثير البلوغ إلى مثال معلوم فلوا ادغمت في نحو شربب فقلت: شرب لا تنقض غرضك الذي اعتزمته: من مقابلة الساكن بالساكن والمتحرك بالمتحرك فأدى ذلك إلى ضد ما اعتزمته ونقض ما رمته.
فاحتمل التقاء المثلين متحركين لما ذكرنا من حراسة هذا الموضع وحفظه.
ومن ذلك امتناعهم من تعريف الفعل.
وذلك أنه إنما الغرض فيه إفادته فلابد من أن يكون منكورا لا يسوغ تعريفه لأنه لو كان معرفة لما كان مستفادا لأن المعروف قد غنى بتعريفه عن اجتلابه ليفاد من جملة الكلام.
ولذلك قال أصحابنا: اعلم أن حكم الجزء المستفاد من الجملة أن يكون منكورا والمفاد هو الفعل لا الفاعل.
ولذلك لو أخبر بما لا شك فيه لعجب منه وهزئ من قوله.
فلما كان كذلك لم يجز تعريف ما وضعه على التنكير ألا تراه يجرى وصفا على النكرة وذلك نحو مررت برجل يقرأ فهذا كقولك: قارئٍ ولو كان معرفة لاستحال جريه وصفا على النكرة.
ومن ذلك امتناعهم من إلحاق من بأفعل إذا عرفته باللام نحو الأحسن منه والأطول منه.
وذلك أن من - لعمري - تكسب ما يتصل به: من أفعل هذا تخصيصا ما ألا تراك لو قلت: دخلت البصرة فرأيت أفضل من ابن سيرين لم يسبق الوهم إلا إلى الحسن رضي الله عنه فبمن ما صحت لك هذه الفائدة وإذا قلت: الأحسن أو الأفضل أو نحو ذلك فقد استوعبت اللام من التعريف أكثر مما تفيده من حصتها من التخصيص فكرهوا أن يتراجعوا بعد ما حكموا به من قوة التعريف إلى الاعتراف بضعفه إذا هم أتبعوه من الدالة على حاجته إليها وإلى قد ما تفيده: من التخصيص المفاد منه.
فأما ما ظن أبو عثمان الجاحظ من أنه يدخل على قول أصحابنا في هذا من قول الشاعر: فلست بالأكثر منهم حصىً وإنما العزة للكاثر فساقط عنهم.
وذلك أن من هذه ليست هي التي تصحب أفعل هذا لتخصيصه فيكون ما رامه أبو عثمان من جمعها مع لام التعريف.
وذلك لأنها إنما هي حال من تاء لست كقولك: لست فيهم بالكثير مالا ولا أنت منهم بالحسن وجها أي لست من بينهم وفي جملتهم بهذه الصفة كقولك: أنت والله من بين الناس حر وزيد من جملة رهطه كريم.
ومن ذلك امتناعهم من إلحاق علم التأنيث لما فيه علمه حتى دعاهم ذلك إلى أن قالوا: مسلمات ولم يقولوا مسلمتات لئلا يلحقوا علامة تأتيث مثلها.
وذلك أن إلحاق علامة التأنيث إنما هو ليخرج المذكر قبله إليه وينقله إلى حكمه فهذا أمر يجب عنه وله أن يكون ما نقل إلى التأنيث قبل نقله إليه مذكرا كقائم من قائمة وظريف من ظريفة.
فلو ذهبت تلحق العلامة العلامة لنقضت الغرض.
وذلك أن التاء في قائمة قد أفادت تأنيثه وحصلت له حكمه فلو ذهبت تلحقها علامة أخرى فتقول: قائمتات لنقضت ما أثبت من التأنيث الأول بما تجشمته من إلحاق علم التأنيث الثاني له لأن في ذلك إيذانا بأن الأول به لم يكن مؤنثا وكنت أعطيت اليد بصحة تأنيثه لحصول ما حصل فيه من علمه وهذا هو النقض والبداء البتة.
ولذلك أيضا لم يثن الاسم المثنى لأن ما حصل فيه من علم التثنية مؤذن بكونه إثنين وما يلحقه من علم التثنية ثانيا يؤذن بكونه في الحال الأولى مفردا وهذا هو الانتقاض والانتكاث لا غير.
فإن قلت: فقد يجمع الجمع نحو أكلب وأكالب وأسقية وأساقٍ فكيف القول في ذلك قيل له: فرق بينهما أن علمي التأنيث في مسلمات لو قيل مسلمتات لكانا لمعنى واحدٍ وهو التأنيث فيهما جميعاً وليس كذلك معنيا التكسير في أكلب وأكالب.
وذلك أن معنى أكلب أنها دون العشرة ومعنى أكالب أنها للكثرة التي أول رتبتها فوق العشرة.
فهذان معنيان - كما تراهما - اثنان فلم ينكر اجتماع لفظيهما لاختلاف معنييهما.
فإن قلت: فهلا أجازوا - على هذا - مسلمتات فكانت التاء الأولى لتأنيث الواحد والتاء الثانية لتأنيث الجماعة قيل: كيف تصرفت الحال فلم تفد واحدة من التاءين شيئاً غير التأنيث البتة.
فأما عدة المؤنث في إفراده وجمعه فلم يفده العلمان فيجوز اجتماعهما كما جاز تكسير التكسير في نحو أكلب وأكالب.
فإن قلت: فقد يجمع أيضاً الكثرة نحو بيوت وبيوتات وحُمُر وحُمُرات ونحو قولهم: صواحبات يوسف ومواليات العرب وقوله: قد جرت الطير أيامنينا فهذا جمع أيامن وأنشدوا: فهن يعلكن حدائداتها وكسروا أيضا مُثُل الكثرة قال: عقابين يوم الدجن تعلو وتسفل وقال آخر: ستشرب كأسا مرة تترك الفتى تليلا لفيه للغرابين والرخم وأجاز أبو الحسن في قوله: في ليلة من جمادى ذات أندية أن يكون كسر ندى على نداء كجبل وجبال ثمم كسر نداء على أندية كرداء وأردية.
قيل: جميع ذلك وما كان مثله - وما أكثره! - إنما جاز لأنه لا ينكر أن يكون جمعان أحدهما أكثر من صاحبه وكلاهما مثال الكثرة ألا ترى أن مائة للكثرة وألفا أيضا كذلك وعشرة آلاف أيضا كذلك ثم على هذا ونحوه.
فكأن بيوتا مائة وبيوتات مائة ألف وكأن عقبانا خمسون وعقابين أضعاف ذلك.
وإذا كان ذلك علمت اختلاف المعنيين لاختلاف اللفظين.
وإذا آل بك الأمر إلى هذا لم تبق وراءه مضطربا فهذا قول.
وجواب ثان: أنك إنما تكسر نحو أكلب وعقبان ونداء لمجئ كل واحد من ذلك على أمثلة الآحاد وفي طريقها فلما جاءت هذا المجئ جرت مجرى الآحاد فجاز تكسيرها كما يجوز تكسيرها ألا ترى أن لذلك ما جاز صرفها وترك الاعتداد بمعنى الجمعية فيها لما جاءت مجئ الآحاد فصرف كلاب لشبهه بكتاب وصرف بيوت لشبهه بأتى وسدوس ومرور وصرف عقبان لشبهه بعصيان وضبعان.
وصرف قضبان لأنه على مثال قرطان.
وصرف أكلب لأنه قد جاء عنهم أصبع وأرز وأسنمة ولأنه أيضا لما كان لجمع القلة أشبه في المعنى الواحد لأن محل مثال القلة من مثال الكثرة في المعنى محل الواحد من الجمع فكما كسروا الواحد كذلك كسروا ما قاربه من الجمع.
وفي هذا كاف.
فإن قلت: فهلا ثنيت التثية كما جمعت الجمع قيل: قد كفتنا العرب بقولهم: أربعة عن قولهم اثنانان.
وأيضا فكرهوا أن يجمعوا في اثنانان ونحوه بين إعرابين متفقين كانا أو مختلفين ومن ذلك ما قال أصحابنا: إن وصف العلم جارٍ مجرى نقض الغرض.
وذلك أن العلم إنما وضع ليغنى عن الأوصاف الكثيرة ألا ترى أنك إذا قلت: قال الحسن في هذه المسئلة كذا فقد استغنيت بقولك: الحسن عن قولك: الرجل الفقيه القاضي العالم الزاهد البصري الذي كان من حاله كذا ومن أمره كذا فلما قلت: الحسن أغناك عن جميع ذلك.
فإذا وصف العلم فلأنه كثر المسمون به فدخله اللبس فيما بعد فلذلك وصف ألا ترى أن ما كان من الأعلام لا شريك له في العلمية فإنه لا يوصف.
وذلك كقولنا: الفرزدق فإنه لا يوصف فيقال: التميمي ولا نحو ذلك لأنه لم يسم به أحد غيره.
وإذا ذكرته باسمه الذي هو همام جاز وصفه فقلت همام بن غالب لأن هماما شورك فيه فجاز لذلك لحاق الوصف له.
فإن قلت: فقد يكثر في الأنساب وصف كثيرٍ من الأعلام التي لا شركة فيها نحو قولهم: فلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان ونظائره كثيرة قيل: ليس الغرض إلا التنقل به والتصعد إلى فوق وإعلام السامع وجه النسب وأن فلانا اسم أبيه كذا واسم جده كذا واسم أبي جده كذا.
فإنما البغية بذلك استمرار النسب وذكر الآباء شيئا فشيئا على توالٍ.
وعلى هذا يجوز أيضا أن يقال: الفرزدق بن غالب فأما على التخليص والتخصيص فلا.
ومن ذلك امتناعهم من تنوين الفعل.
وذلك أنه قد استمر فيه الحذف والجزم بالسكون لثقله.
وإن شئت قلت: إن التنوين إنما لحق في الوقف مؤذنا بالتمام والفعل أحوج شيء إلى الفاعل فإذا كان من الحاجة إليه من بعده على هذه الحال لم يلق به التنوين اللاحق للإيذان بالتكامل والتمام فالحالان إذاً كما ترى ضدان.
ولأجل ذلك ما امتنعوا من لحاق التنوين للمضاف.
وذلك أن المضاف على غاية الحاجة إلى المضاف إليه من بعده.
فلو ألحقته التنوين المؤذن بالوقف وهو متناهٍ في قوة الحاجة إلى الوصل جمعت بين الضدين.
وهذا جلي غير خاف.
وأيضا فإن التنوين دليل التنكير والإضافة موضوعة للتخصيص فكيف لك باجتماعهما مع ما ذكرنا من حالهما.
فإن قلت: فإذا كان الأمر كذلك فما بالهم نونوا الأعلام كزيد وبكر.
قيل: جاز لك لأنها ضارعت بألفاظها النكرات إذ كان تعرفها معنويا لا لفظيا لأنه لا لام تعريف فيها ولا إضافة كما صرفوا من الجمع ما ضارع الواحد ببنائه نحو كلاب لأنه ككتاب وشيوخ لأنه كسدوس ودخول وخروج.
وهذا باب مطرد فاعرفه.
باب في التراجع عند التناهي
هذا معنى مطروق في غير صناعة الإعراب كما أنه مطروق فيها.
وإذا تشاهدت حالاهما كان أقوى لها وأذهب في الأنس بها.
فمن ذلك قولهم: إن الإنسان إذا تناهى في الضحك بكى وإذا تناهى في الغم ضحك وإذا تناهى في العظة أهمل وإذا تناهت العداوة استحالت مودة.
وقد قال: وكل شيء بلغ الحد انتهى وأبلغ من هذا قول شاعرنا: ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى ومن السرور بكاء والطريق في هذا ونحوه معروفة مسلوكة.
وأما طريق صناعة الإعراب في مثله فقول أبي إسحاق في ذكر العلة التي امتنع لها أن يقولوا: مازال زيد إلا قائماً: نفى و نفى النفي إيجاب.
وعلى نحو هذا ينبغي أن يكون قولهم: ظلمة وظلم وسدرة وسدر وقصعة وقصاع وشفرة وشفار.
وذلك أن الجمع يحدث للواحد تأنيثاً نحو قولهم: هذا جمل وهذه جمال وهذا رجل وهذه رجال قد أقبلت.
وكذلك بكر وبكارة وعير وعيورة وجريب وأجربة وصبى وصبية ونحو ذلك.
فلما كانت ظلمة وسدرة وقصعة مؤنثاتٍ - كما ترى - وأردت أن تكسرها صرت كأنك أردت تأنيث المؤنث: فاستحال بك الأمر إلى التذكير فقلت ظلم وسدر وقصاع وشفار.
فتراحعت الإيغال في التأنيث إلى لفظ التذكير.
فعلى هذا النحو لو دعا داع أو حمل حامل على تأنيث نحو قائمة ومسلمة لكان طريقه - على ما رأينا - أن نعيده إلى التذكير فنقول: قائم ومسلم.
هذا لو سوغ مسوغ تأنيث نحو قائمة وكريمة ونحو ذلك.
فإن قيل: فليزم على هذا أن لو أريد تذكير المذكر أن يؤنث قيل: هذا تقرير فاسد ووضع غير متقبل.
وذلك أن التذكير هو الأول والأصل.
فليس لك التراجع عن الأصول لأنها أوائل وليس تحت الأصل ما يرجع إليه.
وليس كذلك التأنيث لأنه فرع على التذكير.
وقد يكون الأصل واحداً وفروعه متضعفة ومتصعدة ألا ترى أن الاشتقاق تجد له أصولاً ثم تجد لها فروعاً ثم تجد لتلك الفروع فروعاً صاعدة عنها نحو قولك: نبت فهو الأصل لأنه جوهر ثم يشتق منه فرع هو النبات وهو حدث ثم يشتق من النبات الفعل فتقول: نبت.
فهذا أصل.
وفرع وفرع فرع.
فلذلك جار تصور تأنيث المؤنث ولم يجز تصور تذكير المذكر.
نعم ولو جاز تصور تذكير المذكر لأوجب فيه القياس أن يعاد به إلى التأنيث.
كذا وجه النظر.
وما في هذا من المنكر!.
فعلى هذا السمت لو ساغ تذكير قائم لوجب أن يقال فيه: قائمة.
فاعرف ذلك وأنس به.
ولا تنب عنه.
فإن قلت: فلسنا نجد كل المذكر إذا أريد تكسيره أنث ألا تراك تقول: رجل ورجال.
وغلام وغلمان وكلب وأكلب.
فهذا بخلاف ذكر وذكارة وذكورة وفحل وفحالة وفحولة.
قيل: لم ندع أن كل مذكر كسر فلا بد في مثال تكسيره من علم تأنيث وإنما أرينا أن هذا المعنى قد يوجد فيه فاستدللنا بذلك على صحة ما كنا عليه وبسبيله.
وكيف تصرفت الحال فأنت قد تلاحظ تأنيث الجماعة في نحو رجال فتقول: قامت الرجال وإذا عاديت الرجال فاصبر لها أي للرجال وإن شئت كانت الهاء للمعاداة.
وعلى نحو مما نحن بصدده ما قالوا: ثلاثة رجال وثلاث نسوة فعكسوا الأمر على ما تراه.
ولأجل ذلك ما قالوا: امرأة صابرة وغادرة فألحقوا علم التأنيث فإذا تناهوا في ذلك قالوا: صبور وغدور فذكروا.
وكذلك رجل ناكح فإذا بالغوا قالوا: رجل فكمة.
ونحو من ذلك سواءً اطراد التصرف في الأفعال نحو قام ويقوم وقم وما كان مثله.
فإذا بالغوا وتناهوا منعوه التصرف فقالوا: نعم الرجل وبئس الغلام فلم يصرفوهما وجعلوا ترك التصرف في الفعل الذي هو أصله وأخص الكلام به أمارة للأمر الحادث له وأن حكماً من أحكام المبالغة قد طرأ عليه كما تركوا لذلك أيضاً تأنيثه دليلاً عليه في نحو قولهم: نعم المرأة وبئس الجارية.
فإن قلت: فما بالهم منعوا هذين الفعلين التصرف البتة ولم يمنعوهما علم التأنيث البتة ألا تراك أيضاً قد تقول: نعمت المرأة وبئست الجارية وأنت لا تصرف واحداً منهما على وجه قيل: إنما حظروا عليهما ما هو أخص الأوصاف بهما - أعني التصرف - ليكون حظره عليهما أدل شيء على حدوث عائق لهما وليست كذلك علامة التأنيث لأن الفعل لم يكن في القياس تأنيثه ألا تراه مفيداً للمصدر الدال على الجنس والجنس أسبق شيء إلى التذكير وإنما دخل علم التأنيث في نحو قامت هند وانطلقت جمل لتأنيث فاعله ولو كان تأنيث الفعل لشيء يرجع إليه هو لا إلى فاعله لجاز قامت زيد وانطلقت جعفر فلأجل ذلك ما اعتزموا الدلالة على خروج هذين الفعلين إلى معنى المبالغة بترك تصرفهما الذي هو أقعد من غيره فيهما دون الاقتصار على ترك تأنيثهما إذ التأنيث فيهما ليس في الأصل مستحقاً لهما ولا راجعاً إليهما وإنما هو مراعىً به تأنيث فاعليهما.
ويؤكد ذلك عندك ما رواه الأصمعي عنهم من قوله: إذا فاق الشيء في بابه سموه خارجياً وأنشد بيت طفيل الغنوي: فقولهم في هذا المعنى: خارجي واستعمالهم فيه لفظ خرج من أوثق ما يستدل له على هذا المعنى وهو الغاية فيه.
فاعرفه واشدد يدك به.
باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية
اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب وأن الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية.
وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها وأصل اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه منها وجاز عليهم بها وعنها.
وذلك أنهم لما سمعوا قول الله - سبحانه وعلا عما يقول الجاهلون علوا كبيراً - {يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ} وقوله - " عز اسمه - {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ} وقوله: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وقوله تعالى: {مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا} وقوله: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} وقوله: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} وقوله: {وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} ونحو ذلك من الآيات الجارية هذا المجرى وقوله في الحديث: خلق الله آدم على صورته حتى ذهب بعض هؤلاء الجهال في قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ} أنها ساق ربهم - ونعوذ بالله من ضعفة النظر وفساد المعتبر - ولم يشكوا أن هذه أعضاء له وإذا كانت أعضاء كان هو لا محالة جسماً معضىً على ما يشاهدون من خلقه عز وجهه وعلا قدره وانحطت سوامى الأقدار والأفكار دونه.
ولو كان لهم أنس بهذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها أو مزاولة لها لحمتهم السعادة بها ما أصارتهم الشقوة إليه بالبعد عنها.
وسنقول في هذا ونحوه ما يجب مثله.
ولذلك ما قال رسول الله صلى اله عليه وسلم لرجل لحن: أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل فسمي اللحن ضلالاً وقال عليه السلام: رحم الله امرأ أصلح من لسانه وذلك لما علمه صلى الله عليه وسلم مما يعقب الجهل لذلك من ضد السداد.
وزيغ الاعتقاد.
وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جارٍ على المجاز وقلما يخرج الشيء منها على الحقيقة.
وقد قدمنا ذكر ذلك في كتابنا هذا وفي غيره.
فلما كانت كذلك وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها وانتشار أنحائها جرى خطابهم بها مجرى ما يألفونه ويعتادونه منها وفهموا أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم وعادتهم في استعمالها.
وذلك أهم يقولن: هذا الأمر يصغر في جنب هذا أي بالإضافة إليه وقرنه به.
فكذلك قوله تعالى: {يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ} أي فيما بيني وبين الله إذا أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه أياي.
وإذا كان أصله اتساعاً جرى بعضه مجرى بعض.
وكذلك قوله - صلى اله عليه وسلم -: كل الصيد في جنب الفرأ وجوف الفرأ أي كأنه يصغر بالإضافة إليه وإذا قيس به.
وكذلك قوله - سبحانه -: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ} إنما هو الاتجاه إلى الله ألا ترى إلى بيت الكتاب: أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل أي الاتجاه.
فإن شئت قلت: إن الوجه هنا مصدر محذوف الزيادة كأنه وضع الفعل موضع الافتعال كوحده وقيد الأوابد - في أحد القولين - ونحوهما.
وإن شئت قلت: خرج مخرج الاستعارة.
وذلك أن وجه الشيء أبدا هو أكرمه وأوضحه فهو المراد منه والمقصود إليه.
فجرى استعمال هذا في القديم - سبحانه - مجرى العرف فيه والعادة في أمثاله.
أي لو كان - تعالى - مما يكون له وجه لكان كل موضع توجه إليه فيه وجها له إلا أنك إذا جعلت الوجه في القول الأول مصدرا كان في المعنى مضافا إلى المفعول دون الفاعل لأن المتوجه إليه مفعول في المعنى فيكون إذاً من باب قوله - عز وجل - {لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ} و {لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ} ونحو ذلك مما أضيف فيه المصدر إلى المفعول به.
وقوله تعالى { مما عملته أيدينا } إن شئت قلت: لما كان العرف أن يكون أكثر الأعمال باليد جرى هذا مجراه.
وإن شئت قلت: الأيدي هنا جمع اليد التي هي القوة فكأنه قال: مما عملته قوانا أي القوى التي أعطيناها الأشياء لا أن له - سبحانه - جسما تحله القوة أو الضعف.
ونحوه قولهم في القسم: لعمر الله إنما هو: وحياة الله أي والحياة التي آتانيها الله لا أن القديم سبحانه محل للحياة كسائر الحيوانات.
ونسب العمل إلى القدرة وإن كان في الحقيقة للقادر لأن بالقدرة ما يتم له العمل كما يقال: قطعه السيف وخرقه الرمح.
فيضاف الفعل إليهما لأنه إنما كان بهما.
وقوله تعالى: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} أي تكون مكنوفا برأفتي بك وكلاءتي لك كما أن من يشاهده الناظر له والكافل به أدنى إلى صلاح أموره وانتظام أحواله ممن يبعد عمن يدبره ويلي أمره قال المولد: شهدوا وغبنا عنهم فتحكموا فينا وليس كغائب من يشهد وهو باب واسع.
وقوله: {وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} إن شئت جعلت اليمين هنا الجارحة فيكون على ما ذهبنا إليه من المجاز والتشبيه أي حصلت السموات تحت قدرته حصول ما تحيط اليد به في يمين القابض عليه وذكرت اليمين هنا دون الشمال لأنها أقوى اليدين وهو من مواضع ذكر الاشتمال والقوة.
وإن شئت جعلت اليمين هنا القوة كقوله: إذا ما رايةٌ رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين أي بقوته وقدرته.
ويجوز أن يكون أراد بيد عرابة: اليمنى على ما مضى.
وحدثنا أبو علي سنة إحدى وأربعين قال: في قول الله - جل اسمه - {فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ} ثلاثة أقوال: أحدها: باليمين التي هي خلاف الشمال.
والاخر باليمين التي هي القوة.
والثالث باليمين التي هي قوله: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم} فإن جعلت يمينه من قوله: {مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} هي الجارجة مجازا وتشبيها كانت الباء هنا ظرفا أي مطويات في يمينه وتحت يمينه.
وإن جعلتها القوة لم تكن الباء ظرفا لكنها تكون حرفا معناه الإلصاق والاستعانة به على التشبيه بما يستعان به كقولهم: ضرب بالسيف وقطع بالسكين وحفر بالفأس.
هذا هو المعنى الظاهر وإن كان غيره جائزا على التشبيه والسعة.
وقوله في الحديث: خلق الله آدم على صورته يحتمل الهاء فيه أن تكون راجعة على اسم الله تعالى وأن تكون راجعة على آدم.
فإذا كانت عائدة على اسم الله تعالى كان معناه: على الصورة التي أنشأها الله وقدرها.
فيكون المصور حينئذ مضافا إلى الفاعل لأنه - سبحانه - هو المصدر لها لا أن له - عز اسمه - صورة ومثالا كما أن قولهم: لعمر الله إنما معناه: والحياة التي كانت بالله والتي آتانيها الله لا أن له - تعالى - حياة تحله ولا أنه - عز وجهه - محل للآعراض.
وإن جعلتها عائدة على آدم كان معناه: على صورة آدم أي على صورة أمثاله ممن هو مخلوق ومدبر فيكون هذا حينئذ كقولك في السيد والرئيس: قد خدمته خدمته أي الخدمة التي تحق لأمثاله وفي العبد والمبتذل: قد استخدمته استخدامه أي استخدام أمثاله ممن هو مأمور بالخفوف والتصرف فيكون إذاً كقوله - عز وجل - {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ} وكذلك نظائر هذا: هذه سبيله.
فأما قول من طغى به جهله وغلبت عليه شقوته حتى قال في قول الله تعالى {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ}: إنه أراد به عضو القديم وإنها جوهر كهذه الجواهر الشاغلة للأماكن وإنها ذات شعر وكذا وكذا مما تتايعوا في شناعته وركسوا في غوايته فأمر نحمد الله على أن نزهنا عن الإلمام بحراه.
وإنما الساق هنا يراد بها شدة الأمر كقولهم: قد قامت الحرب على ساق.
ولسنا ندفع من ذلك أن الساق إذا أريدت بها الشدة فإنما هي مشبهة بالساق هذه التي تعلق القدم وأنه إنما قيل ذلك لأن الساق هي الحاملة للجملة المنهضة لها.
فذكرت هنا لذلك تشبيها وتشنيعا.
فأما أن تكون للقديم - تعالى - جارحة: ساق أو غيرها فنعوذ بالله من اعتقاده أو الاجتياز بطواره.
وعليه بيت الحماسة: كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح وأما قول ابن قيس في صفة الحرب والشدة فيها: فإنه وجه آخر وطريق من طرق الشدة غير ما تقدم.
وإنما الغرض فيه أن الروع قد بز العقيلة - وهي المرأة الكريمة - حياءها حتى ابدت عن ساقها للحيرة والهرب كقول الآخر: لما رايت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا وبدت محاسنها التي تخفى وكان الأمر جدا وقوله: إذا أبرز الروع الكعاب فإنهم مصادٌ لمن يأوى إليهم ومعقل وهو باب.
وضده ما أنشده أبو الحسن: أرفعن أذيال الحقي واربعن مشى حيياتٍ كأن لم يفزعن إن تمنع اليوم نساء تمنعن وأذكر يوما وقد خطر لي خاطر مما نحن بسبيله فقلت: لو أقام إنسان على خدمة هذا العلم ستين سنة حتى لايحظى منه إلا بهذا الموضع لما كان مغبونا فيه ولا منتقص الحظ منه ولا السعادة به.
وذلك قول الله - عز اسمه {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} ولن يخلو أغفلنا هنا من أن يكون من باب أفعلت الشيء أي صادفته ووافقته كذلك كقوله: أي صادفها هائجة النبات وقوله: فمضى وأخلف من قتيلة موعدا أي صادفه محلفا وقوله: أصم دعاء عاذلتي تحجى بأخرنا وتنسى أولينا أي صادف قوما صما وقول الآخر: فأصممت عمرا وأعميته عن الجواد والمجد يوم الفخار أي صادفته أعمى.
وحكى الكسائي: دخلت بلدة فأعمرتها أي وجدتها عامرة ودخلت بلدة فأخربتها أي وجدتها خرابا ونحو ذلك أو يكون ما قاله الخصم: أن معنى أغفلنا قلبه: منعنا وصددنا نعوذ بالله من ذلك.
فلو كان الأمر على ما ذهبوا إليه منه لوجب أن يكون العطف عليه بالفاء دون الواو وأن يقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه.
وذلك أنه كان يكون على هذا الأول علة للثاني والثاني مسببا عن الأول ومطاوعا له كقولك: أعطيته فأخذ وسألته فبذل لما كان الأخذ مسببا عن العطية والبذل مسببا عن السؤال.
وهذا من مواضع الفاء لا الواو ألا ترى أنك إنما تقول: جذبته فانجذب ولا تقول: وانجذب إذا جعلت الثاني مسبباً عن الأول.
وتقول: كسرته فانكسر واستخبرته فأخبر كله بالفاء.
فمجئ قوله تعالى واتبع هواه بالواو ودليل على أن الثاني ليس مسببا عن الأول على ما يعتقده المخالف.
وإذا لم يكن عليه كان معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي صادفناه غافلا على ما مضى وإذا صودف غافلا فقد غفل لا محالة.
فكأنه - والله أعلم -: ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي لا تطع من فعل كذا وفعل كذا.
وإذا صح هذا الموضع ثبت به لنا أصل شريف يعرفه من يعرفه.
ولولا ما تعطيه العربية صاحبها من قوة النفس ودربة الفكر لكان هذا الموضع ونحوه مجوزا عليه غير مأبوه له.
وأنا أعجب من الشيخين أبوى علي رحمهما الله وقد دوخا هذا الأمر وجولاه وامتخضاه وسقياه ولم يمرر واحد منهما ولا من غيرهما - فيما علمته به - على قربه وسهولة مأخذه.
ولله قطرب! فإنه قد أحرز عندي أجرا عظيما فيما صنفه من كتابه الصغير في الرد على الملحدين وعليه عقد أبو علي - رحمه الله - كتابة في تفسير القرآن.
وإذا قرأته سقطت عنك الشبهة في هذا الأمر بإذن الله وعونه.
باب في تجاذب المعاني والإعراب
هذا موضع كان أبو علي - رحمه الله - يعتاده ويلم كثيرا به ويبعث على المراجعة له وإلطاف النظر فيه.
وذلك أنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين: هذا يدعوك إلى أمر وهذا يمنعك منه.
فمتى اعتورا كلاما ما أمسكت بعروة المعنى وارتحت لتصحيح الإعراب.
فمن ذلك قول الله تعالى: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} فمعنى هذا: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر فإن حملته في الإعراب على هذا كان خطأ لفصلك بين الظرف الذي هو يوم تبلى وبين ما هو معلق به من المصدر الذي هو الرجع والظرف من صلته والفصل بين الصلة والموصول الأجنبي أمر لا يجوز.
فإذا كان المعنى مقتضيا له والإعراب مانعا منه احتلت له بأن تضمر ناصبا يتناول الظرف ويكون المصدر الملفوظ به دالاً على ذلك الفعل حتى كأنه قال فيما بعد: يرجعه يوم تبلى السرائر.
ودل رجعه على يرجعه دلالة المصدر على فعله.
ونحوه قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ} فإذا هذه في المعنى متعلقة بنفس قوله: لمقت الله أي يقال لهم: لمقت الله إياكم وقت دعائكم إلى الإيمان فكفركم أكبر من مقتكم أنفسكم الآن إلا أنك إن حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة التي هي إذ وبين الموصول الذي هو لمقت الله.
فإذا كان المعنى عليه ومنع جانب الإعراب منه أضمرت ناصبا يتناول الظرف ويدل المصدر عليه حتى كأنه قال بأخرة: مقتكنم إذ تدعون.
وإذا كان هذا ونحوه وقد جاء في القرآن فما أكثره وأوسعه في الشعر! فمن ذلك ما أنشده أبو الحسن من قوله: لسنا كمن حلت إيادٍ دارها تكريت ترقب حبها أن يحصدا فإيادٍ بدل مِن مَن وإذا كان كذلك لم يمكنك أن تنصب دارها بحلت هذه الظاهرة لما فيه من الفصل فحينئذ ما تضمر له فعلا يتناوله فكأنه قال فيما بعد: حلت دارها.
وإذا جازت دلالة المصدر على فعله والفعل على مصدره كانت دلالة الفعل على الفعل الذي هو مثله أدنى إلى الجواز وأقرب مأخذا في الاستعمال.
ومثله قول الكميت في ناقته: كذلك تيك وكالناظرات صواحبها ما يرى المسحل أي وكالناظرات ما يرى المسحل صواحبها.
فإن حملته على هذا كان فيه الفصل المكروه.
فإذا كان المعنى عليه ومنع طريق الإعراب منه أضمر له ما يتناوله ودل " الناظرات " على ذلك المضمر.
فكأنه قال فيما بعد: نظرن ما يرى المسحل ألا تراك لو قلت: كالضارب زيدٌ جعفرا وأنت تريد: كالضارب جعفرا زيد لم يجز كما أنك لو قلت: إنك على صومك لقادر شهر رمضان وأنت تريد: إنك على صومك شهر رمضان لقادر لم يجز شيء من ذلك للفصل.
وما أكثر استعمال الناس لهذا الموضع في محاوراتهم وتصرف الأنحاء " في كلامهم "! وأحد من اجتاز به البحتري في قوله: لا هناك الشغل الجديد بحزوى عن رسوم برامتين قفار فعن في المعنى متعلقة " بالشغل " أي لا هناك الشغل عن هذه الأماكن إلا أن الإعراب مانع منه وإن كان المعنى متقاضيا له.
وذلك أن قوله " الجديد " صفة للشغل والصفة إذا جرت على الموصوف آذنت بتمامه وانقضاء أجزائه.
فإن ذهبت تعلق " عن " بنفس الشغل على ظاهر المعنى كان فيه الفصل بين الموصول وصلته وهذا فاسد ألا تراك لو قلت: عجبت من ضربك الشديد عمرا لم يجز لأنك وصفت المصدر وقد بقيت منه بقية فكان ذلك فصلا بين الموصول وصلته بصفته.
وصحتها أن تقول: عجبت من ضربك الشديد عمرا لأنه مفعول الضرب وتنصب عمرا بدلا من الشديد كقولك: مررت بالظريف عمروٍ ونظرت إلى الكريم جعفر.
فإن أردت أن تصف المصدر بعد إعمالك إياه قلت: عجبت من ضربك الشديد عمرا الضعيف أي عجبت من أن ضربت هذا الشديد ضربا ضعيفا.
هذا تفسير المعنى.
وهذا الموضع من هذا العلم كثير في الشعر القديم والمولد.
فإذا اجتاز بك شيء منه فقد عرفت طريق القول فيه والرفق به إلى أن يأخذ مأخذه بإذن الله تعالى.
ومنه قول الحطيئة: أزمعت يأساً مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كالياس أي يأساً من نوالكم مبينا.
فلا يجوز أن يكون قوله " من نوالكم " متعلقا بيأس وقد وصفه بمبين وإن كان المعنى يقتضيه لأن الإعراب مانع منه.
لكن تضمر له حتى كأنك قلت: يئست من نوالكم.
ومن تجاذب الإعراب والمعنى ما جرى من المصادر وصفا نحو قولك: هذا رجل دنف وقوم رضا ورجل عدل.
فإن وصفته بالصفة الصريحة قلت: رجل دنف وقوم مرضيون ورجل عادل.
هذا هو الأصل.
وإنما انصرفت العرب عنه في بعض الأحوال إلى أن وصفت بالمصدر لأمرين: أحدهما صناعي والآخر معنوي.
أما الصناعي فليزيدك أنسا بشبه المصدر للصفة التي أوقعته موقعها كما أوقعت الصفة موقع المصدر في نحو قولك: أقائماً والناس قعود " أي وأما المعنوي فلأنه إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل.
وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه.
ويدل على أن هذا معنى لهم ومتصور في نفوسهم قوله - فيما أنشدناه -: ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخل أي كأنه مخلوق من البخل لكثرة ما يأتي به منه.
ومنه قول الآخر: وهن من الإخلاف والولعان وقوله: وهن من الإخلاف بعدك والمطل وأصل هذا الباب عندي قول الله - عز وجل - {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ}.
وقد ذكرنا هذا الفصل فيما مضى.
فقولك إذاً: هذا رجل دنف - بكسر النون - أقوى إعرابا لأنه هو الصفة المحضة غير المتجوزة.
وقولك: رجل دنف أقوى معنى لما ذكرناه: من كونه كأنه مخلوق من ذلك الفعل.
وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة.
فهذا وجه تجاذب الإعراب والمعنى فاعرفه وأمض الحكم فيه على أي الأمرين شئت.
التفسير على المعنى دون اللفظ باب في التفسير على المعنى دون اللفظ اعلم أن هذا موضع قد أتعب كثيراً من الناس واستهواهم ودعاهم من سوء الرأي وفساد الاعتقاد إلى ما مذلوا به وتتابعوا فيه حتى إن أكثر ما ترى من هذه الآراء المختلفة والأقوال المستشنعة إنما دعا إليها القائلين بها تعلقهم بظواهر هذه الأماكن دون أن يبحثوا عن سر معانيها ومعاقد أغراضها.
فمن ذلك قول سيبويه في بعض ألفاظه: حتى الناصبة للفعل يعني في نحو قولنا: اتق الله حتى يدخلك الجنة.
فإذا سمع هذا من يضعف نظره اعتدها في جملة الحروف الناصبة للفعل وإنما النصب بعدها بأن مضمرة.
وإنما جاز أن يتسمح بذلك من حيث كان الفعل بعدها منصوبا بحرف لا يذكر معها فصارت في اللفظ كالخلف له والعوض منه وإنما هي في الحقيقة جارة لا ناصبة.
ومنه قوله أيضاً في قول الشاعر: أنا اقتسمنا خطيتنا بيننا فحملت برة واحتملت فجار إن فجار معدولة عن الفجرة.
وإنما غرضه أنها معدولة عن فجرة " معرفة علما " على ذا يدل هذا الموضع من الكتاب.
ويقويه ورود برة معه في البيت وهي - كما ترى - علم.
لكنه فسره على المعنى دون اللفظ.
وسوغه ذلك أنه لما أراد تعريف الكلمة المعدول عنها مثل ذلك " بما تعرف " باللام لأنه لفظ معتاد وترك لفظ فجرة لأنه لا يعتاد ذلك علما وإنما يعتاد نكرة وجنسا نحو فجرت فجرة كقولك: تجرت تجرة ولو عدلت برة هذه على هذا الحد لوجب أن يقال فيها: برار كفجار.
ومنه قولهم: أهلك والليل فإذا فسروه قالوا: أراد: الحق أهلك قبل الليل.
وهذا - لعمري - تفسير المعنى لا تقدير الإعراب فإنه على: الحق أهلك وسابق الليل.
ومنه ما حكاه الفراء من قولهم: معي عشرة فاحدهن أي اجعلهن أحد عشر.
وهذا تفسير المعنى أي أتبعهن ما يليهن وهو من حدوث الشيء إذا جئت بعده.
وأما اللفظ فإنه من " و ح د " لأن أصل أحد وحد ألا ترى إلى قول النابغة: كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد أي منفرد وكذلك الواحد إنما هو منفرد.
وقلب هذه الواو المفتوحة المنفردة شاذ ومذكور في التصريف.
وقال لي أبو علي - رحمه الله - بحلب سنة ست وأربعين: إن الهمزة في قولهم: ما بها أحد ونحو ذلك مما أحد فيه للعموم ليست بدلا من واو بل هي أصل في موضعها.
قال: وذلك أنه ليس من معنى أحد في قولنا: أحد عشر وأحد وعشرون.
قال: لأن الغرض في هذه الانفراد والذي هو نصف الاثنين قال: وأما أحد في نحو قولنا: ما بها أحد وديار فإنما هي للإحاطة والعموم.
" والمعنيان " - كما ترى - مختلفان.
وهكذا قال وهو الظاهر.
ومنه قول المفسرين في قول الله تعالى: {مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ} أي مع الله ليس أن " إلى " في اللغة بمعنى مع ألا تراك لا تقول: سرت إلى زيد وأنت تريد: سرت مع زيد هذا لا يعرف في كلامهم.
وإنما جاز هذا التفسير في هذا الموضع لأن النبي إذا كان له أنصار فقد انضموا في نصرته إلى الله فكأنه قال: من أنصاري منضمين إلى الله كما تقول: زيد إلى خير وإلى دعة وستر أي آوٍ إلى هذه الأشياء ومنضم إليها.
فإذا انضم إلى الله فهو معه لا محالة.
فعلى هذا فسر المفسرون هذا الموضع.
ومن ذلك قول الله - عز وجل - {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ} قالوا معناه: قد امتلأت وهذا أيضاً تفسير على المعنى دون اللفظ و " هل " مبقاة على استفهامها.
وذلك كقولك للرجل لا تشك في ضعفه عن الأمر: هل ضعفت عنه وللإنسان " يحب الحياة " هل تحب الحياة أي فكما تحبها فليكن حفظك نفسك لها وكما ضعفت عن هذا الأمر فلا تتعرض لمثله مما تضعف عنه.
وكأن الاستفهام إنما دخل هذا الموضع ليتبع الجواب عنه بأن يقال: نعم فإن كان كذلك فيحتج عليه باعترافه به فيجعل ذلك طريقا إلى وعظه أو تبكيته.
ولو لم يعترف في ظاهر الأمر به لم يقو توقيفه عليه وتحذيرة من مثله قوته إذا اعترف به لأن الاحتجاج على المعترف أقوى منه على المنكر أو المتوقف فكذلك قوله سبحانه: هل امتلأت فكأنها قالت: لا فقيل لها: بالغي في إحراق المنكر " كان لك " فيكون هذا خطابا في اللفظ لجهنم وفي المعنى للكفار.
" وكذلك " جواب هذا من قولها: هل من مزيد أي أتعلم يا ربنا أن عندي مزيدا.
فجواب هذا منه - عز اسمه - لا أي فكما تعلم أن لامزيد فحسبي ما عندي.
فعليه قالوا في تفسيره: قد امتلأت فتقول: ما من مزيد.
فاعرف هذا ونحوه.
ويالله التوفيق.
باب في قوة اللفظ لقوة المعنى
هذا فصل من العربية حسن.
منه قولهم: خشن واخشوشن.
فمعنى خشن دون معنى اخشوشن لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو.
ومنه قول عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا وتمعددوا: أي اصلبوا وتناهوا في الخشنة.
وكذلك قولهم: أعشب المكان فإذا أرادوا كثرة العشب فيه قالوا: اعشوشب.
ومثله حلا واحلولي وخلق واخلولق وغدن واغدودن.
ومثله باب فعل وافتعل نحو قدر واقتدر.
فاقتدر أقوى معنى من قولهم: قدر.
كذلك قال أبو العباس وهو محض القياس قال الله سبحانه: {أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ} فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كان الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ.
وعليه - عندي - قول الله - عز وجل -: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} وتأويل ذلك أن كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة أمر يسير ومستصغر.
وذلك لقوله - عز اسمه -: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا} أفلا ترى أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى جزائها صغر الواحد إلى العشرة ولما كان جزاء السيئة إنما هو بمثلها لم تحتقر إلى الجزاء عنها فعلم بذلك قوة فعل السيئة على فعل الحسنة ولذلك قال - تبارك وتعالى -: {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا} فإذا كان فعل السيئة ذاهبا بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المترامية عظم قدرها وفخم لفظ العبارة عنها فقيل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
فزيد في لفظ فعل السيئة وانتقص من لفظ فعل الحسنة لما ذكرنا.
ومثله سواءً بيت الكتاب: أنا اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجار فعبر عن البر بالحمل وعن الفجرة بالاحتمال.
وهذا هو ما قلناه في قوله - عز اسمه -: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} لا فرق بينهما.
وذاكرت بهذا الموضع بعض أشياخنا من المتكلمين فسر به وحسن في نفسه.
ومن ذلك أيضاً قولهم: رجل جميل ووضئ فإذا أرادوا المبالغة في ذلك قالوا: وضاء وجمال فزادوا في اللفظ " هذه الزيادة " لزيادة معناه قال: والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء وقال: تمشى بجهم حسن ملاح أجم حتى هم بالصياح منه صفيحة وجه غير جمال وكذلك حسن وحسان قال: دار الفتاة التي كنا نقول لها يا ظبيةً عطلا حسانة الجيد وكأن أصل هذا إنما هو لتضعيف العين في نحو المثال نحو قطع وكسر وبابهما.
وإنما جعلنا هذا هو الأصل لأنه مطرد في بابه أشد من اطراد باب الصفة وذلك نحو قولك: قطع وقطّع وقام الفرس وقومت الخيل ومات البعير وموتت الإبل ولأن العين قد تضعف في الاسم الذي ليس بوصف نحو قبر وتمر وحمر.
فدل ذلك على سعة زيادة العين.
فأما قولهم: خطاف وإن كان اسماً فإنه لاحق بالصفة في إفادة معنى الكثرة ألا تراه موضوعا لكثرة الاختطاف به.
وكذلك سكين إنما هو موضوع لكثرة تسكين الذابح به.
وكذلك البزار والعطار والقصار ونحو ذلك إنما هي لكثرة تعاطي هذه الأشياء وإن لم تكن مأخوذة من الفعل.
وكذلك النساف لهذا الطائر كأنه قيل له ذلك لكثرة نسفه بجناحيه.
وكذلك الخضارى للطائر أيضاً كأنه قيل له ذلك لكثرة خضرته والحوارى لقوة حوره وهو بياضه.
وكذلك الزمل والزميل والزمال إنما كررت عينه لقوة حاجته إلى أن يكون تابعا وزميلا.
وهو باب منقاد.
ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن معتاد حاله.
وذلك فعال في معنى فعيل نحو طوال فهو أبلغ " معنى من " طويل وعراض فإنه أبلغ معنى من عريض.
وكذلك خفاف من خفيف وقلال من قليل وسراع من سريع.
ففعال - لعمري - وإن كانت أخت فعيل في باب الصفة فإن فعيلا أخص بالباب من فعال ألا تراه أشد انقياداً منه تقول: جميل ولا تقول: جمال وبطىء ولا تقول: بطاء وشديد ولا تقول: شداد ولحم غريض ولا يقال غراض.
فلما كانت فعيل هي الباب المطرد وأريدت المبالغة عدلت إلى فعال.
فضارعت فعال بذلك فعالا.
والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحد منهما عن أصله أما فعال فبالزيادة وأما فعال فبالانحراف به عن فعيل.
وبعد فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى به.
وكذلك إن انحرف به عن سمته وهديته كان ذلك دليلاً على حادث متجدد له.
وأكثر ذلك أن يكون ما حدث له زائداً فيه لا منتقصاً منه ألا ترى أن كل واحد من مثالي التحقير والتكسير عارضان للواحد إلا أن أقوى التغييرين هو ما عرض لمثال التكسير.
وذلك أنه أمر عرض للإخراج عن الواحد والزيادة في العدة فكان أقوى من التحقير لأنه مبقًّ للواحد على إفراده.
ولذلك لم يعتد التحقير سبباً مانعاً من الصرف كما اعتد التكسير مانعاً منه ألا تراك تصرف دريهما ودنينيرا ولا تصرف دراهم ولا دنانير لما ذكرنا من هنا حمل سيبويه مثال التحقير على مثال التكسير فقال تقول: سريحين لقولك: سراحين وضبيعين لقولك: ضباعين: وتقول سكيران: لأنك لا تقول سكارين.
هذا معنى قوله وإن لم يحضرنا الآن حقيقة لفظه.
وسألت أبا علي عن رد سيبويه مثال التحقير إلى مثال التكسير فأجاب بما أثبتنا آنفاً.
فاعرف ذلك إلى ما تقدمه.
نقض الأوضاع إذا ضامها طارىء
باب في نقض الأوضاع إذا ضامها طارىء عليها
من ذلك لفظ الاستفهام إذ ضامه معنى التعجب استحال خبراً. وذلك قولك: مررت برجل أي رجل. فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهماً. وكذلك مررت برجل إيما رجل لأن ما زائدة. وإنما كان كذلك لأن أصل الاستفهام الخبر والتعجب ضرب من الخبر.
فكأن التعجب لما طرأ على الاستفهام إنما أعاده إلى أصله: من الخبرية.
ومن ذلك لفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير عاد نفياً وإذا لحقت لفظ النفي عاد إيجاباً.
وذلك كقول الله سبحانه: {أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ} أي ما قلت لهم وقوله: {آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ} أي لم يأذن لكم.
وأما دخولها على النفي فكقوله - عز وجل -: {أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ} أي أنا كذلك وقول جرير: ألستم خير من ركب المطايا أي أنتم كذلك.
وإنما كان الإنكار كذلك لأن منكر الشيء إنما غرضه أن يحيله إلى عكسه وضده.
فلذلك استحال به الإيجاب نفياً والنفي إيجاباً.
ومن ذلك أن تصف العلم فإذا أنت فعلت ذلك فقد أخرجته به عن حقيقة ما وضع له فأدخلته معنى لولا الصفة لم تدخله إياه.
وذلك أن وضع العلم أن يكون مستغنياً بلفظه عن عدة من الصفات فإذا أنت وصفته فقد سلبته الصفة له ما كان في أصل وضعه مراداً فيه: من الاستغناء بلفظه عن كثير من صفاته.
وقد ذكرنا هذا الموضع فيما مضى.
فتأمل هذه الطريق حتى إذا ورد شيء منها عرفت مذهبه.
باب في الاستخلاص من الأعلام معاني الأوصاف
من ذلك ما أنشدناه أبو علي - رحمه الله - من قول الشاعر: أنا أبو المنهال بعض الأحيان ليس علي حسبي بضؤلان أنشدنيه - رحمه الله - ونحن في دار الملك.
وسألني عما يتعلق به الظرف الذي هو بعض الأحيان فخضنا فيه إلى أن برد في اليد من جهته أنه يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون أراد: أنا مثل أبي المنهال فيعمل في الظرف على هذا معنى التشبيه أي أشبه أبا المنهال في بعض الأحيان.
والآخر أن يكون قد عرف من أبي المنهال هذا الغناء والنجدة فإذا ذكر فكأنه قد ذكرا فيصير معناه إلى أنه كأنه قال: أنا المغنى في بعض الأحيان أو أنا النجد في بعض تلك الأوقات.
أفلا تراك كيف انتزعت من العلم الذي هو أبو المنهال معنى الصفة والفعلية.
ومنه قولهم في الخبر.
إنما سميت هانئاً لنهنأ.
وعليه جاء نابغة لأنه نبغ فسمي بذلك.
فهذا - لعمري - صفة غلبت فبقي عليها بعد التسمية بها بعض ما كانت تفيده من معنى الفعل من قبل.
وعليه مذهب الكتاب في ترك صرف أحمر إذا سمي به ثم نكر.
وقد ذكرنا ذلك في غير موضع إلا أنك على الأحوال قد انتزعت من العلم معنى الصفة.
وقد مر بهذا الموضع الطائي الكبير فأحسن فيه واستوفى معناه فقال: فلا تحسباً هنداً لها الغدر وحدها سجية نفسٍ كل غانية هند فقوله كل غانية هند مثناه في معناه وآخذ لأقصى مداه ألا ترى أنه كأنه قال: كل غانية غادرة أو قاطعة أو خائنة أو نحو ذلك.
ومنه قول الآخر: إن الذئاب قد اخضرت براثنها والناس كلهم بكر إذا شبعوا أى إذا شبعوا تعادوا وتغادروا لأن بكراً هكذا فعلها.
ونحو من هذا - وإن لم يكن الاسم المقول عليه علماً - قول الآخر: ما أمك اجتاحت المنايا كل فؤادٍ عليك أم كأنه قال: كل فؤاد عليك حزين أو كئيب إذ كانت الأم هكذا غالب أمرها لا سيما مع المصيبة وعند نزول الشدة.
ومثله في النكرة أيضاً قولهم: مررت برجل صوفٍ تكته أي خشنة ونظرت إلى رجل خز قميصه أي ناعم ومررت بقاع عرفجٍ كله أي جافٍ وخشن.
وإن جعلت كله توكيداً لما في ومن العلم أيضاً قوله: أنا أبو بردة إذ جد الوهل أي أنا المغني والمجدي عند اشتداد الأمر.
وقريب منه قوله: أنا أبوها حين تستبغي أبا أي أنا صاحبها وكافلها وقت حاجتها إلى ذلك.
ومثله وأحسن صنعة منه: لا ذعرت السوام في فلق الصب ح مغيراً ولا دعيت يزيدا أي لا دعيت الفاضل المغنى هذا يريد وليس يتمدح بأن اسمه يزيد لأن يزيد ليس موضوعاً بعد النقل عن الفعلية إلا للعلمية.
فإنما تمدح هنا بما عرف من فضله وغنائه.
وهو كثير.
فإذا مر بك شيء منه فقد عرفتك طريقه.
باب في أغلاط العرب
كان أبو علي - رحمه الله - يرى وجه ذلك ويقول: إنما دخل هذا النحو في كلامهم لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بها.
وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد.
هذا معنى قوله وإن لم يكن صريح لفظه.
فمن ذلك ما أنشده أحمد بن يحيى: غدا مالك يرمي نسائي كأنما نسائي لسهمي مالكٍ غرضان فيا رب فاترك لي جهينة أعصرا فمالك موتٍ بالقضاء دهاني هذا رجل مات نساؤه شيئاً فشيئاً فتظلم من ملك الموت عليه السلام.
وحقيقة لفظه غلط وفساد.
وذلك أن هذا الأعرابي لما سمعهم يقولون: ملك الموت وكثر ذلك في الكلام سبق إليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهر لفظها فصارت عنده كأنها فعل لأن ملكاً في اللفظ على صورة فلك فبني منها فاعلاً فقال: مالك موتٍ وغدا مالك.
فصار في ظاهر لفظه كأنه فاعل وإنما مالك هنا على الحقيقة والتحصيل مافل كما أن ملكاً على التحقيق مفل وأصله ملأك فألزمت همزته التخفيف فصار ملكاً.
واللام فيه فاء والهمزة عين والكاف لام هذا أصل تركيبه وهو " ل أ ك " وعليه تصرفه ومجيء الفعل منه في الأمر الأكثر قال: ألكني إليها وخير الرسو ل أعلمهم بنواحي الخبر وأصله: ألئكني فخففت همزته.
وقال: ألكني إليها عمرك الله يا فتى بآية ما جاءت إلينا تهاديا وقال: ألكني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافاً ولا عزلا " وقال يونس: ألك يألك ".
فإذا كان كذلك فقول لبيد: بألوكٍ فبذلنا ما سأل إنما هو عفول قدمت عينه على فائه.
وعلى أنه قد جاء عنهم ألك يألك من الرسالة إلا أنه قليل.
وعلى ما قلنا فقوله: أبلغ أبا دختنوس مألكةً غير الذي قد يقال ملكذب إنما هي معفلة.
وأصلها ملئكة فقلب على ما مضى.
وقد ذكرنا هذا الموضع في شرح تصريف أبي عثمان رحمه الله.
فإن قلت: فمن أين لهذا الأعرابي - مع جفائه وغلظ طبعه - معرفة التصريف حتى بنى من " ظاهر لفظ " ملكٍ فاعلا فقال: مالك.
قيل: هبه لا يعرف التصريف " أتراه لا " يحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا القدر! هذا ما لا يجب أن يعتقده عارف بهم أو آلف لمذاهبهم لأنه وإن لم يعلم حقيقة تصريفه بالصنعة فإنه يجده بالقوة ألا ترى أن أعرابياً بايع أن يشرب علبة لبن ولا يتنحنح فلما شرب بعضها كظه الأمر فقال: كبش أملح.
فقيل له: ما هذا! تنحنحت.
فقال: من تنحنح فلا أفلح.
أفلا تراه كيف استعان لنفسه ببحة الحاء واستروح إلى مسكة النفس بها وعللها بالصويت اللاحق " لها في الوقف " ونحن مع هذا نعلم أن هذا الأعرابي لا يعلم أن في الكلام شيئاً يقال له حاء فضلاً عن أن يعلم أنها من الحروف المهموسة وأن الصوت يلحقها في حال سكونها والوقف عليها ما لا يلحقها في حال حركتها أو إدراجها في حال سكونها في نحو بحر ودحر إلا أنه وإن لم يحسن شيئاً من هذه الأوصاف صنعة ولا علماً فإنه يجدها طبعا ووهماً.
فكذلك الآخر: لما سمع ملكاً وطال ذلك عليه أحس من ملك في اللفظ ما يحسه من حلك.
فكما أنه يقال: أسود حالك قال هنا من لفظة ملك: مالك وإن لم يدر أن مثال ملك فعل أو مفل ولا أن مالكاً هنا فاعل أو مافل.
ولو بني من ملك على حقيقة الصنعة فاعل لقيل: لائك كبائك وحائك.
وإنما مكنت القول في هذا الموضع ليقوى في نفسك قوة حس هؤلاء القوم وأنهم قد يلاحظون بالمنة والطباع ما لا نلاحظه نحن عن طول المباحثة والسماع.
فتأمله فإن الحاجة إلى مثله ظاهرة.
ومن ذلك همزهم مصائب.
وهو غلط منهم.
وذلك أنهم شبهوا مصيبة بصحيفة " فكما همزوا صحائف همزوا أيضاً مصائب وليست ياء مصيبة زائدة كياء صحيفة " لأنها عين ومنقلبة عن واو هي العين الأصلية.
وأصلها مصوبة لأنها اسم الفاعل من أصاب كما أن أصل مقيمة مقومة وأصل مريدة مرودة فنقلت الكسرة من العين إلى الفاء فانقلبت الواو ياء على ما ترى.
وجمعها القياسي مصاوب.
وقد جاء ذلك قال: يصاحب الشيطان من يصاحبه فهو أذي جمة مصاوبه وقالوا في واحدتها: مصيبة ومصوبة ومصابة.
وكأن الذي استهوى في تشبيه ياء مصيبة بياء صحيفة أنها وإن لم تكن زائدة فإنها ليست على التحصيل بأصل وإنما هي بدل من الأصل والبدل من الأصل ليس أصلاً وقد عومل لذلك معاملة الزائد حكى سيبويه عن أبي الخطاب أنهم يقولون في راية: راءة.
فهؤلاء همزوا بعد الألف وإن لم تكن زائدة وكانت بدلاً كما يهمزون بعد الألف الزائدة في فضاء وسقاء.
وعلة ذلك أن هذه الألف وإن لم تكن زائدة فإنها بدل والبدل مشبه للزائد.
والتقاؤهما أن كل واحد منهما ليس أصلاً.
ونحو منه ما حكوه في قولهم في زاي: زاء.
وهذا أشد " وأشد " من راءة لأن الألف في راءة على كل حال بدل وهي أشبه بالزائد وألف زاي ليست منقلبة بل هي أصل لأنها في حرف فكان ينبغي ألا تشبه بالزائد إلا أنها وإن لم تكن منقلبة فإنها وقعت موقع المنقلبة لأن الألف هنا في الأسماء لا تكون أصلاً.
فلما كان كذلك شبهت ألف زاي لفظاً بألف باب ودار كما أنهم لما احتاجوا إلى تصريف أخواتها قالوا: قوفت قافا ودولت دالا وكوفت كافا ونحو ذلك.
وعلى هذا " أيضاً قالوا " زويت زايا وحكى: إنها زاي فزوها.
فلما كان كذلك انجذب حكم زاي إلى حكم راءة.
وقد حكيت عنهم منارة ومنائر ومزادة ومزائد.
وكأن هذا أسهل من مصائب لأن الألف أشبه بالزائد من الياء.
ومن البدل الجاري مجرى الزائد - عندي لا عند أبي علي - همزة وراء.
ويجب أن تكون مبدلة من حرف علة لقولهم: تواريت عنك إلا أن اللام لما أبدلت همزة أشبهت الزائدة التي في ضهيأة فكما أنك لو حقرت ضهيأة لقلت: ضهيئة فأقررت الهمزة فكذلك قالوا في تحقير وراء: وريئة.
ويؤكد ذلك قول بعضهم فيها: ورية كما قالوا في صلاءة: صلية.
فهذا ما أراه أنا وأعتقده في " وراء " هذه.
وأما أبو علي - رحمه الله - فكان يذهب إلى أن لامها في الأصل همزة وأنها من تركيب " ورأ " وأنها ليست من تركيب " ورى ".
واستدل على ذلك بثبات الهمزة في التحقير على ما ذكرنا.
وهذا - لعمري - وجه من القول إلا أنك تدع معه الظاهر والقياس جميعاً.
أما الظاهر فلأنها في معنى تواريت وهذه اللام حرف علة لا همزة وأن تكون ياء واجب لكون الفاء واواً.
وأما القياس فما قدمناه: من تشبيه البدل بالزائد.
فاعرف ما رأيناه في هذا.
ومن أغلاطهم قولهم: حلأت السويق ورثأت زوجي بأبيات واستلأمت الحجر ولبأت بالحج وقوله: كمشترئٍ بالحمد أحمرة بترا وأما مسيل فذهب بعضهم في قولهم في جمعه: أمسلة إلى أنه من باب الغلط.
وذلك لأنه أخذه من سال يسيل " فهو عندهم على مفعل كالمسير والمحيض " وهو عندنا غير غلط لأنهم قد قالوا فيه: مسل وهذا يشهد بكون الميم فاء.
فأمسلة ومسلان: أفعلة وفعلان كأجربة وجربان.
ولو كانت أمسلة ومسلان من السيل لكان مثالهما: أمفلة ومفلان والعين منهما محذوفة وهي ياء السيل.
وكذلك قال بعضهم في معين لأنه أخذه من العين لأنه من ماء العيون فحمله على الغلط لأنهم قد قالوا: قد سالت معنانه وإنما هو عندنا من قولهم أمعن له بحقه إذا طاع له به.
وكذلك الماء إذا جرى من العين فقد أمعن بنفسه وطاع بها.
ومنه الماعون لأنه " ما من ": العادة المسامحة به والانقياد إلى فعله.
وأنشدني " أبو عبد الله الشجري " لنفسه من قصيدة: ترود ولا ترى فيها أريبا سوى ذي شجة فيها وحيد " كذا أنشدني هذه القصيدة مقيدة " فقلت له: ما معنى أريبا فقال: من الريبة.
وأخبرنا أبو علي " عن الأصمعي أنه " كان يقول في قولهم للبحر: المهرقان: إنه من قولهم: هرقت الماء.
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى بقول بلال بن جرير: إذا ضفتهم أو سآيلتهم وجدت بهم علة حاضره أراد: ساءلتهم " فاعلتهم " من السؤال ثم عن له أن يبدل الهمزة على قول من قال: سايلتهم فاضطرب عليه الموضع فجمع بين الهمزة والياء فقال: سآيلتهم.
فوزنه على هذا: فعاعلتهم.
ومن أغلاطهم ما يتعايبون به في الألفاظ والمعاني من نحو قول ذي الرمة: والجيد من أدمانةٍ عنود وقوله: حتى إذا دومت في الأرض راجعه كبر ولو شاء نجي نفسه الهرب وسنذكر هذا ونحوه في باب سقطات العلماء لما فيه من الصنعة.
وكذلك غمز بعضهم على بعض في معانيهم كقول بعضهم لكثير في قوله: فما روضة بالحزن طيبة الثرى يمج الندى جثجاثها وعرارها بأطيب من أردان عزة موهناً وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها والله لو فعل هذا بأمة زنجية لطاب ريحها ألا قلت كما قال سيدك: ألم ترأني كلما جئت طارقا وجدت بها طيباً وإن لم تطيب وكقول بشار في قول كثير: ألا إنما ليلى عصا خيزرانة إذا غمزوها بالأكف تلين لقد قبح بذكره العصا في لفظ الغزل هلا قال كما قلت: وحوراء المدامع من معد كأن حديثها " قطع الجمان " وكان الأصمعي يعيب الحطيئة ويتعقبه فقيل له في ذلك فقال: وجدت شعره كله جيداً فدلني على أنه كان يصنعه.
وليس هكذا الشاعر المطبوع: إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه: جيده على رديئه.
وهذا باب في غاية السعة.
وتقصيه يذهب بنا كل مذهب.
وإنما ذكرت طريقة " وسمته " لتأتم بذلك وتحقق سعة طرقات القوم في القول.
فاعرفه بإذن الله تعالى.
باب في سقطات العلماء
حكي عن الأصمعي أنه صحف قول الحطيئة: وغررتني وزعمت أن ك لابن في الصيف تامر فأنشده:
لاتني بالضيف تامر أي تأمر بإنزاله وإكرامه.
وتبعد هذه الحكاية " في نفسي " لفضل الأصمعي وعلوه وغير أني رأيت أصحابنا على القديم يسندونها إليه ويحملونها عليه.
وحكي أن الفراء " صحف فقال " الجر: أصل الجبل يريد الجراصل: الجبل.
وأخبرنا أبو صالح السليل بن أحمد عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن الخليل بن اسد النوشجاني عن التوزي قال قلت لأبي زيد الأنصاري: أنتم تنشدون قول الأعشى: بساباط حتى مات وهو محزرق وأبو عمرو الشيباني ينشدها: محرزق فقال: إنها نبطية وأم أبي عمرو نبطية فهو أعلم بها وذهب أبو عبيدة في قولهم: لي عن هذا الأمر مندوحة أي متسع إلى أنه من قولهم: انداح بطنه أي اتسع.
وليس هذا من غلط أهل الصناعة.
وذلك أن انداح: انفعل وتركيبه من دوح ومندوحة: مفعولة وهي من تركيب " ن د ح " والندح: جانب الجبل وطرفه وهو إلى السعة وجمعه أنداح.
أفلا ترى إلى هذين الأصلين: تبايناً وتباعداً فكيف يجوز أن يشتق أحدهما من صاحبه على بعد بينهما وتعادي وضعهما.
وذهب ابن الأعرابي في قولهم: يوم أرونان إلى أنه من الرنة.
وذلك أنها تكون مع البلاء والشدة.
وقال أبو علي - رحمه الله -: ليس هذا من غلط أهل الصناعة لأنه ليس في الكلام أفوعال وأصحابنا يذهبون إلى أنه أفعلان من الرونة وهي الشدة في الأمر.
وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى في قولهم: أسكفة الباب إلى أنها من قولهم: استكف أي اجتمع.
وهذا أمر ظاهر الشناعة.
وذلك أن أسكفة: أفعلة والسين فيها فاء وتركيبه من " س ك ف وأما استكف فسينه زائدة لأنه استفعل وتركيبه من " ك ف ف.
فأين هذان الأصلان حتى يجمعا ويدانى من شملهما.
ولو كانت أسكفة من استكف لكانت أسفعلة وهذا مثال لم يطرق فكرا ولا شاعر - فيما علمناه - قلبا.
وكذلك لو كانت مندوحة من انداح بطنه - كما ذهب إليه أبو عبيدة - لكانت منفعلة.
وهذا أيضاً في البعد والفحش كأسفعلة.
ومع هذا فقد وقع الإجماع على أن السين لا تزاد إلا في استفعل وما تصرف منه.
وأسكفة ليس من الفعل في قبيل ولا دبير.
وذهب أحمد أيضاً في تنور إلى أنه تفعول من النار - ونعوذ بالله من عدم التوفيق.
هذا على سداد هذا الرجل وتميزه من أكثر أصحابه - ولو كان تفعولاً من النار لوجب أن يقال فيه: تنوور كما أنك لو بنيته من القول لكان: تقوولا ومن العود: تعوودا.
وهذا في نهاية الوضوح.
وإنما تنور: فعول من لفظ " ت ن ر " وهو أصل لم يستعمل إلا في هذا الحرف وبالزيادة كما ترى.
ومثله مما يستعمل إلا بالزيادة كثير.
منه حوشب وكوكب " وشعلع " " وهزنبران " ودودري " ومنجنون " وهو واسع جداً.
ويجوز في التنور أن يكون فعنولاً من " ت ن ر " فقد حكى أبو زيد في زرنوق: زرنوقا.
ويقال: إن التنور لفظة اشترك فيها جميع اللغات من العرب وغيرهم.
فإن كان كذلك فهو طريف إلا أنه على كل حال فعول أو فعنول لأنه جنس ولو كان أعجمياً لا غير لجاز تمثيله " لكونه جنساً ولاحقاً " بالعربي فكيف وهو أيضاً عربي لكونه في لغة العرب غير منقول إليها وإنما هو وفاق وقع ولو كان منقولاً " إلى اللغة العربية من غيرها " لوجب أن يكون أيضاً وفاقاً بين جميع اللغات غيرها.
ومعلوم سعة اللغات " غير العربية " فإن جاز أن يكون مشتركاً في جميع ما عدا العربية جاز أيضاً أن يكون وفاقاً وقع فيها.
ويبعد في نفسي أن يكون في الأصل للغةٍ واحدة ثم نقل إلى جميع اللغات لأنا لا نعرف له في ذلك نظيرا.
وقد يجوز أيضاً أن يكون وفاقاً وقع بين لغتين أو ثلاث أو نحو ذلك ثم انتشر بالنقل في جميعها.
وما أقرب هذا في نفسي ! لأنا لا نعرف شيئاً من الكلام وقع الاتفاق عليه في كل لغة وعند كل أمة: هذا كله إن كان في جميع اللغات هكذا.
وإن لم يكن كذلك كان الخطب فيه أيسر.
وروينا هذه المواضع عن أحمد بن يحيى.
وروينا عنه أيضاً أنه قال: التواطخ من الطيخ وهو الفساد.
وهذا - على إفحاشه - مما يجمل الظن به لأنه من الوضوح بحيث لا يذهب على أصغر صغير من أهل هذا العلم.
وإذا كان كذلك وجب أن يحسن الظن به ويقال إنه " أراد به ": كأنه مقلوب منه.
هذا أوجه عندي من أن يحمل عليه هذا الفحش والتفاوت كله.
ومن هذا ما يحكى عن خلف أنه قال: أخذت على المفضل الضبي في مجلس واحد ثلاث سقطات: أنشد لامرئ القيس: تمس بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مضهب فقلت له: عافاك الله! إنما هو نمش: أي نمسح ومنه سمى منديل الغمر مشوشا وأنشد للمخبل السعدي: فقلت: عافاك الله! إنما هو طرفت وأنشد للأعشى: ساعةً أكبر النهار كما ش د محيل لبونه إعتاما فقلت: عافاك الله! إنما هو مخيل بالخاء المعجمة " وهو الذي " رأى خال السحابة فأشفق منها على بهمه فشدها.
وأما ما تعقب به أبو العباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه في المواضع التي سماها مسائل الغلط فقلما يلزم صاحب الكتاب منه إلا الشيء النزر.
وهو أيضاً - مع قلته - من كلام غير أبي العباس.
وحدثنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس أنه قال: إن هذا كتاب كنا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة واعتذر أبو العباس منه.
وأما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل فضلاً " عن نفسه " ولا محالة أن " هذا تخليط لحق " هذا الكتاب من قبل غيره رحمه الله.
وإن كان للخليل فيه عمل فإنما هو أنه أومأ إلى عمل هذا الكتاب إيماء ولم يله بنفسه ولا قرره ولا حرره.
ويدل على أنه قد كان نحا نحوه أني أجد فيه معاني غامضة ونزوات للفكر لطيفة وصنعة في بعض الأحوال مستحكمة.
وذاكرت به يوماً أبا علي - رحمه الله - فرأيته منكراً له.
فقلت له: إن تصنيفه منساق متوجه وليس فيه التعسف الذي في كتاب الجمهرة فقال: الآن إذا صنف إنسان لغة بالتركية تصنيفاً جيداً أيؤخذ به في العربية! أو كلاماً هذا نحوه.
وأما كتاب الجمهرة ففيه أيضاً من اضطراب التصنيف وفساد التصريف ما أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر.
ولما كتبته وقعت في متونه وحواشيه جميعا من التنبيه على هذه المواضع ما استحييت من كثرته.
ثم إنه لما طال علي أومأت إلى بعضه وأضربت البتة عن بعضه.
وكان أبو علي يقول: لما هممت بقراءة رسالة هذا الكتاب على محمد بن الحسن قال لي: يا أبا علي: لا تقرأ هذا الموضع علي فأنت أعلم به مني.
وكان قد ثبت في نفس أبي علي على أبي العباس في تعاطيه الرد على سيبويه ما كان لا يكاد يملك معه نفسه.
ومعذورا كان " عندي في ذلك " لأنه أمر وضع من أبي العباس وقدح فيه وغض كل الغض منه.
وذكر النضر عند الأصمعي فقال: قد كان يجيئني وكان إذا أراد أن يقول: ألف قال: إلف.
ومن ذلك اختلاف الكسائي وأبي محمد اليزيدي عند أبي عبيد الله في الشراء أممدود هو أم مقصور.
فمدة اليزيدي وقصره الكسائي فتراضيا ببعض " فصحاء العرب و " كانوا بالباب فمدوه على قول اليزيدي.
وعلى كل حال فهو يمد ويقصر.
وقولهم: أشرية دليل المد " كسقاء " وأسقية.
ومن ذلك ما رواه الأعمش في حديث عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة.
وكان أبو عمرو بن العلاء قاعداً عنده بالكوفة فقال " الأعمش: يتخولنا وقال أبو عمرو يتخوننا " فقال الأعمش: وما يدريك فقال أبو عمرو: إن شئت أن أعلمك أن الله - عز وجل - لم يعلمك " حرفاً من العربية " أعلمتك.
فسأل عنه الأعمش فأخبر بمكانه من العلم.
فكان بعد ذلك يدنيه ويسأله عن الشيء إذا أشكل عليه.
هذا ما في الحكاية.
وعلى ذلك فيتخولنا صحيحة.
وأصحابنا يثبتونها.
ومنها - عندي - قول البرجمي: يساقط عنه روقه ضارياتها سقاط حديد القين أخول أخولا أي شيئاً بعد شيء.
وهذا هو معنى قوله: يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة أي يفرقها ولا يتابعها.
ومن ذلك اجتماع الكميت مع نصيب وقد استنشده نصيب من شعره فأنشده الكميت: هل أنت عن طلب الأيفاع منقلب حتى إذا بلغ إلى قوله: أم هل ظعائن بالعلياء نافعة وإن تكامل فيها الدل والشنب عقد نصيب بيده واحداً فقال الكميت: ما هذا فقال أحصي خطأك.
تباعدت في قولك: الدل والشنب ألا قلت كما قال ذو الرمة: لمياء في شفتيها حوة لعس وفي اللثات وفي أنيابها شنب ثم أنشده: أبت هذه النفس إلا ادكارا حتى إذا بلغ إلى قوله: كأن الغطامط من غليه أراجيز أسلم تهجو غفارا قال نصيب: ما هجت أسلم غفاراً قط.
فوجم الكميت.
وسئل الكسائي في مجلس يونس عن أولقٍ: ما مثاله من الفعل فقال: أفعل.
فقال له يونس: استحييت لك يا شيخ! والظاهر عندنا من أمر أولق أنه فوعل من قولهم: ألق الرجل فهو مألوق أنشد أبو زيد: تراقب عيناها القطيع كأنما يخالطها من مسه مس أولق وقد يجوز أن يكون: أفعل من ولق يلق إذا خف وأسرع قال: يتبعن سامية العينين تحسبها مجنونة أو ترى ما لا ترى الإبل والأولق: الحنون.
ويجوز أيضاً أن يكون فوعلا من ولق هذه.
وأصلها - على هذا - وولق.
فلما التقت الواوان في أول الكلمة همزوا الأولى منهما على العبرة في ذلك.
وسئل الكسائي أيضاً في مجلس يونس عن قولهم: لأضربن أيهم يقوم لم لا يقال: لأضربن أيهم.
فقال: أي هكذا خلقت.
ومن ذلك إنشاد الأصمعي لشعبة بن الحجاج قول فروة بن مسيك المرادي: فما جبنوا أني أشد عليهم ولكن رأوا ناراً تحس وتسفع فقال شعبة: ما هكذا أنشدنا سماك بن حرب.
إنما أنشدنا: " تحش " بالشين معجمة.
قال الأصمعي: فقلت: تحس: تقتل من قول الله - تعالى - {إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ} أي تقتلونهم وتحش: توقد.
فقال لي شعبة: لو فرغت للزمتك.
وأنشد رجل من أهل المدينة أبا عمرو بن العلاء قول ابن قيس الرقيات: إن الحوادث بالمدينة قد أوجعنني وقرعن مروتيه فانتهره أبو عمرو فقال: ما لنا ولهذا الشعر الرخو! إن هذه الهاء لم توجد في شيء من الكلام إلا أرخته.
فقال له المديني: قاتلك الله! ما أجهلك بكلام العرب! قال الله - عز وجل - في كتابه: { مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ} وقال: {يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ} فانكسر أبو عمرو انكساراً شديداً.
قال أبو هفان: وأنشد هذا الشعر عبد الملك بن مروان فقال: أحسنت يا ابن قيس لولا أنك خنثت قافيته.
فقال يا أمير المؤمنين ما عدوت قول الله - عز وجل - في كتابه {مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ} فقال له عبد الملك: أنت في هذه أشعر منك في شعرك.
قال أبو حاتم: قلت للأصمعي: أتجيز: إنك لتبرق لي وترعد فقال: لا إنما هو تبرق وترعد.
فقلت له: فقد قال الكميت: أبرق وأرعد يا يزي د فما وعيدك لي بضائر فقال: هذا جرمقاني من أهل الموصل ولا آخذ بلغته.
فسألت عنها أبا زيد الأنصاري فأجازها.
فنحن كذلك إذ وقف علينا أعرابي محرم فأخذنا نسأله.
فقال " أبو زيد ": لستم تحسنون أن تسألوه.
ثم قال له: كيف تقول: إنك لتبرق لي وترعد.
فقال له الأعرابي: أفي الجخيف تعني أي التهدد.
فقال: نعم.
فقال الأعرابي: إنك لتبرق لي وترعد.
فعدت إلى الأصمعي فأخبرته فأنشدني: إذا جاوزت من ذات عرق ثنيةً فقل لأبي قابوس: ما شئت فارعد وقال أبوحاتم أيضاً: قرأت على الأصمعي رجز العجاج حتى وصلت إلى قوله: جأباً ترى بليته مسحجا فقال:.
.
.
تليله فقلت: بليته.
فقال: تليله مسحجا فقلت له: أخبرني به من سمعه من فلق في رؤبة أعني أبا زيد الأنصاري فقال: هذا لا يكون " فقلت: جعل " مسحجا " مصدراً أي تسحيجاً.
فقال: هذا لا يكون ".
فقلت: قال جرير: ألم تعلم مسرحي القوافي أي تسريحي.
فكأنه توقف.
فقلت: قد قال الله - تعالى - {وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} فأمسك.
ومن ذلك إنكار أبي حاتم على عمارة بن عقيل جمعه الريح على أرياح.
قال: فقلت له فيه: إنما هي أرواح.
فقال: قد قال - عز وجل - {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} وإنما الأرواح جمع روح.
فعلمت بذلك أنه ممن لا يجب أن يؤخذ عنه.
وقال أبو حاتم: كان الأصمعي ينكر زوجة ويقول: إنما هي زوج.
ويحتج بقول الله - تعالى - {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} قال: فأنشدته قول ذي الرمة: أذو زوجة في المصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاويا فقال: ذو الرمة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقالين.
قال: وقد قرأنا عليه " من قبل " لأفصح الناس فلم ينكره: فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والطامعون إلي ثم تصدعوا وقال آخر: من منزلي قد أخرجتني زوجتي تهر في وجهي هرير الكلبة وقد كان يعاب ذو الرمة بقوله: حتى إذا دومت في الأرض راجعه كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب فقيل: إنما يقال: دوى في الأرض ودوم في السماء.
وعيب أيضاً في قوله: والجيد من أدمانة عنود فقيل: إنما يقال: أدماء وآدم.
والأدمان جمع كأحمر وحمران وأنت لا تقول: حمرانة ولا صفرانة.
وكان أبو علي يقول: بني من هذا الأصل فعلانة كخمصانة.
وهذا ونحوه مما يعتد في أغلاط العرب إلا أنه لما كان من أغلاط هذه الطائفة القريبة العهد جاز أن نذكره في سقطات العلماء.
ويحكى أن أبا عمرو رأى ذا الرمة في دكان طحان بالبصرة كأنما عينها منها وقد ضمرت وضمها السير في بعض الأضى ميم فقيل له: من أين عرفت الميم فقال: والله ما أعرفها إلا أني رأيت معلماً خرج إلى البادية فكتب حرفاً فسألته عنه فقال: هذا الميم فشبهت به عين الناقة.
وقد أنشدوا: كما بينت كاف تلوح وميمها وقد قال أبو النجم: أقبلت من عند زياد كالخرف تخط رجلاي بخط مختلف تكتبان في الطريق لام ألف وحكى أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن أحمد بن يحيى عن سلمة قال: حضر الأصمعي وأبو عمرو الشيباني عند أبي السمراء فأنشده الأصمعي: بضرب كآذان الفراء فضوله وطعنٍ كتشهاق العفا هم بالنهق ثم ضرب بيده إلى فرو كان بقربه يوهم أن الشاعر أراد فرواً.
فقال أبو عمرو: أراد الفرو.
فقال الأصمعي: هكذا راويتكم!.
ويحكى عن رؤبة في توجهه إلى قتيبة بن مسلم أنه قال: جاءني رجلان فجلسا إلي وأنا أنشد شيئاً من شعري فهمسا بينهما فتفقت عليهما فهمدا.
ثم سألت عنهما فقيل لي: الطرماح والكميت.
فرأيتهما ظريفين فأنست بهما.
ثم كانا يأتياني فيأخذان الشيء بعد الشيء من شعري فيودعانه أشعارهما.
وقد كان قدماء أصحابنا يتعقبون رؤبة وأباه ويقولون: تهضما اللغة وولداها وتصرفا فيها غير تصرف الأقحاح فيها.
وذلك لإيغالهما في الرجز وهو مما يضطر إلى كثير من التفريع والتوليد لقصره ومسابقة قوافيه.
وأخبرنا أبو صالح السليل بن أحمد بإسناده عن الأصمعي قال: قال لي الخليل: جاءنا رجل فأنشدنا: ترافع العز بنا فارفنععا فقلنا: هذا لا يكون.
فقال: كيف جاز للعجاج أن يقول: تقاعس العز بنا فاقعنسسا فهذا ونحوه يدلك على منافرة القوم لهما وتعقبهم إياهما وقد ذكرنا هذه الحكاية فيما مضى من هذا الكتاب وقلنا في معناها: ما وجب هناك.
وحكى الأصمعي قال: دخلت على حماد بن سلمة وأنا حدث فقال لي: كيف تنشد قول الحطيئة: " أولئك قوم إن بنوا أحسنوا ماذا.
فقلت ": فقال: يا بنى أحسنوا البنا.
يقال: بنى يبنى بناء في العمران وبنا يبنوُ بناً في الشرف.
هكذا هذه الحكاية رويناها عن بعض أصحابنا.
وأما الجماعة فعندها أن الواحد من ذلك: بنية وبنية فالجمع على ذلك: البنى والبنى.
وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبى بإسناده عن أبي عثمان أنه كان عند أبي عبيدة فجاءه رجل فسأله فقال له: كيف تأمر من قولنا: عنيت بحاجتك فقال له أبو عبيدة: أعن بحاجتى.
فأومأت إلى الرجل: أى ليس كذلك.
فلما خلونا قلت له: إنما يقال: لتعن بحاجتى.
قال: فقال لى أبو عبيدة: لا تدخل إلي.
فقلت: لم.
فقال: لأنك كنت مع رجل خوزى سرق منى عاما أول قطيفة لى.
فقلت: لا والله ما الأمر كذلك: ولكنك سمعتنى أقول ما سمعت أو كلاما هذا معناه.
وحدثنا أبو بكر محمد بن علي المراغي قال: حضر الفراء أبا عمر الجرمي فأكثر سؤاله إياه.
قال: فقيل لأبي عمر: قد أطال سؤالك أفلا تسأله! فقال له أبو عمر: يا أبا زكرياء ما الأصل في قم فقال: اقوم.
قال: فصنعوا ماذا قال: استثقلوا الضمة على الواو فأسكنوها ونقلوها إلى القاف.
فقال له أبو عمر: هذا خطأ: الواو إذا اسكن ما قبلها جرت مجرى الصحيح ولم تستثقل الحركات فيها.
ويدل على صحة قول أبي عمر إسكانهم إياها وهى مفتوحة في نحو يخاف وينام ألا ترى أن أصلهما: يخوف وينوم.
وإنما إعلال المضارع هنا محمول على إعلال الماضى.
وهذا مشروح في موضعه.
ومن ذلك حكاية أبي عمر مع الأصمعى وقد سمعه يقول: أنا أعلم الناس بالنحو فقال له الأصمعى: يا أبا عمر كيف تنشد قول الشاعر: قد كن يخبأن الوجوه تسترا فالآن حين بدأن للنظار بدأن أو بدين فقال أبو عمر: بدأن.
فقال الأصمعى: يا أبا عمر أنت أعلم الناس بالنحو! - يمازحه - إنما هو بدون أى ظهرن.
فيقال: إن أبا عمر تغفل الأصمعى فجاءه يوما وهو في مجلسه فقال له أبو عمر: كيف تحقر مختارا.
فقال الأمصعى: مخيتير.
فقال له أبو عمر: أخطأت إنما هو مخير أو مخيير تحذف التاء لأنها زائدة.
حدثني أبو علي قال: اجتمعت مع أبي بكر بن الخياط عند أبي العباس المعمرى بنهر معقل في حديث حدثنيه طويل.
فسألته عن العامل في إذا من قوله - سبحانه -: {هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} قال: فسلك فيها مسلك الكوفيين.
فكلمته إلى أن أمسك.
وسألته عن غيرها وعن غيرها.
وافترقنا.
فلما كان الغد اجتمعت معه عند أبي العباس وقد أحضر جماعة من أصحابه فسألونى فلم أر فيهم طائلا.
فلما انقضى سؤالهم قلت لأكبرهم: كيف تبنى من سفرجل مثل عنكبوت فقال: سفرروت.
فلما سمعت ذلم قمت في المسجد قائما وصفقت بين الجماعة: سفرروت! سفرروت! فالتفت إليهم أبو بكر فقال: لا أحسن الله جزاءكم! ولا أكثر في الناس مثلكم! وافترقنا فكان آخر العهد به.
قال أبو حاتم: قرأ الأخفش: - يعنى أبا الحسن -: { وقولوا للناس حسنى } فقلت: هذا لا يجوز لأن حسنى مثل فعلى وهذا لا يجوز إلا بالألف واللام.
قال: فسكت.
قال أبو الفتح: هذا عندى غير لازم لأبي الحسن لأن حسنى هنا غير صفة وإنما هو مصدر بمنزلة الحسن كقراءة غيره: { قولوا للناس حسنا } ومثله في الفعل والفعلى: الذكر والذكرى وكلاهما مصدر.
ومن الأول البؤس والبؤسى.
والنعم والنعمى.
ولذلك نظائر.
وروينا - فيما أظن - عن محمد بن سلام الجمحى قال: قال لى يونس ابن حبيب: كان عيسى بن عمر يتحدث في مجلس فيه أبو عمر بن العلاء.
فقال عيسى في حديثه: ضربه فحشت يده.
فقال أبو عمرو: ما تقول يا أبا عمر! فقال عيسى: فحشت يده.
فقال أبو عمرو: فحشت يده.
قال يونس: التي رده عنها جيدة.
يقال حشت يده - بالضم - وحشت يده - بالفتح - وأحشت.
وقال يونس: وكانا إذا اجتمعا في مجلس لم يتكلم أبو عمرو مع عيسى الزيادى عن الأصمعى قال: حضر الفرزدق مجلس ابن أبي إسحق فقال له: كيف تنشد هذا البيت: وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر فقال الفرزدق: كذا أنشد.
فقال ابن أبي إسحق: ما كان عليك لو قلت: فعولين! فقال الفرزدق: لو شئت أن تسبح لسبحت.
ونهض فلم يعرف أحد في المجلس ما أراد بقوله: لو شئت أن تسبح لسبحت أى لو نصب لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما أن تفعلا ذلك وإنما أراد: أنهما تفعلان بالألباب ما تفعل الخمر قال أبو الفتح: كان هنا تامة غير محتاجة إلى الخبر فكأنه قال: وعينان قال الله: احدثا فحدثتا أو اخرجا إلى الوجود فخرجتا.
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال: سأل رجل سيبويه عن قول الشاعر: يا صاح ياذا الضامر العنس فرفع سيبويه الضامر فقال له الرجل: إن فيها والرحل ذى الاقتاد والحلس فقال سيبويه: من هذا هربت.
وصعد فى الدرجة.
فقال أبو الفتح: هذا عندنا محمول على معناه دون لفظه.
وإنما أراد: ياذا العنس الضامر والرحل ذى الاقتاد فحمله على معناه دون لفظه.
قال أبو العباس: حدثني أبو عثمان قال: جلست في حلقة الفراء فسمعته يقول لأصحابه: لا يجوز حذف لام الأمر إلا في شعر.
وأنشد: من كان لا يزعم أنى شاعر فيدن منى تنهه المزاجر قال: فقلت له: لم جاز في الشعر ولم يجز في الكلام.
فقال: لأن الشعر يضطر فيه الشاعر فيحذف.
قال: فقلت: وما الذى اضطره هنا وهو يمكنه أن يقول: فليدن منى قال: فسأل عنى فقيل له: المازنى فأوسع لى.
قال أبو الفتح: قد كان يمكن الفراء أن يقول له: إن العرب قد تلزم الضرورة في الشعر في حال السعة أنساً بها واعتياداً لها وإعداداً لها لذلك عند وقت الحاجة إليها ألا ترى إلى قوله: قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع فرفع للضرورة ولو نصب لما كسر الوزن.
وله نظائر.
فكذلك قال: " فيدن منى وهو قادر على أن يقول: فليدن منى لما ذكرت.
والمحفوظ في هذا قول أبي عمرو لأبي خيرة وقد قال: استأصل الله عرقاتهم - بنصب التاء -: هيهات أبا خيرة لان جلدك! ثم رواها أبو عمرو فيما بعد.
وأجاز أيضاً أبو خيرة: حفرت إراتك جمع إرة.
وعلى نحوه إنشاد الكوفيين: ألا يزجر الشيخ الغيور بناته وإنشادهم أيضاً: فلما جلاها بالإيام تحيزت ثباتاً عليها ذلها واكتئابها وأصحابنا لا يرون فتح هذه التاء في موضع النصب.
وأما عرقاتهم فواحدة كسعلاة.
وكذلك إراة: علفة وأصلها وئرة: فعلة فقلبت الفاء إلى موضع اللام فصار: إروة ثم قلبت الواو ألفا فصار إراة مثل الحادى وأصله: الواحد فقلبت الفاء إلى موضع اللام فصار وزنه على اللفظ: عالفا ومثله قول القطامى: ولا تقضى بواقى دينها الطادى أصله: الواطد ثم قلب إلى عالف.
وأنا ثباة ففعلة من الثبة وأما بناته ففعلة كقناة كما أن ثباة وسمعت لغاتهم إنما هي واحدة كرطبة.
هذا كله إن كان مارووه - من فتح هذه التاء - صحيحا ومسموعا من فصيح يؤخذ بلغته ولم يجز أصحابنا فتح هذه التاء في الجماعة إلا شيئا قاسه أبو عثمان فقال: أقول: لا مسلمات لك - بفتح التاء - قال: لأن الفتحة الآن ليست لمسلمات وحدها وإنما لها وللا قبلها.
وإنما يمتنع من فتح هذه التاء ما دامت الحركة في آخرها لها وحدها.
فإذا كانت لها ولغيرها فقد زال طريق ذلك الحظر الذي كان عليها.
وتقول على هذا: لا سمات بإبلك - بفتح التاء - على ما مضى.
وغيره يقول: لا سمات بها - بكسر التاء - على كل حال.
وفي هذا مسألة لأبي على - رحمه الله - طويلة حسنة.
وقال الرياشي: سمعت أبا زيد يقول: قال المنتجمع: أعمى على المريض وقال أبو خيرة: غمى عليه.
فأرسلوا إلى أم أبى خيرة فقالت: غمى على المريض.
فقال لها المنتجع: أفسدك ابنك.
وكان وراقا.
وقال أبو زيد: قال منتجع: كمء واحدة وكمأة للجميع.
وقال أبو خيرة: كمأة واحدة وكمء للجميع مثل تمرة وتمر قال: فمر بهما رؤبة فسألوه فقال كما قال منتجع.
وقال أبو زيد: قد يقال: كمأة وكمء كما قال أبو خيرة.
وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحجاج عن أبي علي بن بشر بن موسى الأسدى عن الأصمعى قال: اختلف رجلان فقال أحدهما: الصقر وقال الآخر: السقر.
فتراضيا بأول وارد يرد عليهما فإذا رجل قد أقبل فسألاه فقال: ليس كما قلت أنت ولا كما قلت أنت وقال الرياشي: حدثني الأصمعى قال: ناظرى المفضل عند عيسى بن جعفر فأنشد بيت أوس: وذات هدم عارٍ نواشرها تصمت بالماء تولبا جذعا فقلت: هذا تصحيف لا يوصف التولب بالإجذاع وإنما هو: جدعا وهو السىء الغذاء.
قال: فجعل المفضل يشغب فقلت له: تكلم كلام النمل وأصب.
لو نفخت في شبور يهودى ما نفعك شيئا.
ومن ذلك إنكار الأصمعى على ابن الأعرابى ما كان رواه ابن الأعرابى لبعض ولد سعيد بن سلم بحضرة سعيد بن سلم لبعض بنى كلاب: سمين الضواحى لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها فرفع ابن الأعرابي ليلة ونصبها الأصمعى وقال: إنما أراد: لم تؤرقه أبكار الهموم وعونها ليلةً وأنعم أى زاد على ذلك.
فأحضر ابن الأعرابي وسئل عن ذلك فرفع ليلة فقال الأصمعى لسعيد: من لم يحسن هذا القدر فليس بموضع لتأديب ولدك فنحاه سعيد فكان ذلك سبب طعن ابن الأعرابي على الأصمعى.
محمد بن يزيد قال: حدثني أبو محمد التوزى عن أبى عمرو الشيبانى قال: عنناً باطلا وظلما كما تع نز عن حجرة الربيض الظباء فقلت: يا سبحان الله! تعتر من العتيرة.
فقال الأصمعى: تعنز أى تطعن بعنزة.
فقلت: لو نفخت في شبور اليهودى وصحت إلى التنادى ما كان إلا تعتر ولا ترويه بعد اليوم إلا تعتر.
قال أبو العباس قال لى التوزى قال لى أبو عمرو: فقال: والله لا أعود بعده إلى تعنز.
وأنشد الأصمعى أبا توبة ميمون بن حفص مؤدب عمرو بن سعيد بن سلم بحضرة سعيد: واحدةٌ أعضلكم شأنها فكيف لو قمت على أربع! قال: ونهض الأصمعى فدار على أربع يلبس بذلك على أبي توبة.
فأجابه أبو توبة بما يشاكل فعل الأصمعى.
فضحك سعيد وقال لأبي توبة: ألم أنهك عن مجاراته في المعانى هذه صناعته.
وروى أبو زيد: ما يعوز له شيء إلا أخذه فأنكرها الأصمعى وقال: إنما هو يعور - بالراء -.
وهو كما قال الأصمعى.
وقال الأثرم على بن المغيرة: مثقل استعان بدفيه ويعقوب بن السكيت حاضر.
فقال يعقوب: هذا تصحيف إنما هو: مثقل استعان بذقنه.
فقال الأثرم: إنه يريد الرياسة بسرعة ودخل بيته هذا في حديث لهما.
وقال أبو الحسن لأبي حاتم: ما صنعت في كتاب المذكر والمؤنث قال: قلت: قد صنعت فيه شيئا.
قال: فما تقول في الفردوس قال: ذكر.
قال فإن الله - عز وجل - يقول: {الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} قال: قلت: ذهب إلى الجنة فأنث.
قال أبو حاتم: فقال لى التوزى: يا عاقل ! أما سمعت قول الناس: أسألك الفردوس الأعلى فقلت يا نا ئم: الأعلى هنا أفعل لا فعلى! قال أبو الفتح: لا وجه لذكره هنا لأن الأعلى لا يكون أبدا فعلى.
أبو عثمان قال: قال لى أبو عبيدة: ما أكذب النحويين! يقولون: إن هاء التأنيث لا تدخل على ألف التأنيث وسمعت رؤبة ينشد: فكر في علقى وفي مكور فقلت له: واحد العلقى فقال: علقاة.
قال أبو عثمان: فلم أفسر له لأنه كان أغلظ من أن يفهم مثل هذا.
وقد ذكرنا نحو هذا فيما قبل أو شرحناه.
قال أبو الفتح: قد أتينا في هذا الباب من هذا الشأن على أكثر مما يحتمله هذا الكتاب تأنيسا به وبسطا للنفس بقراءته.
وفيه أضعاف هذا إلا أن في هذا كافيا من غيره بعون الله.
باب في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة
هذا موضع من هذا الأمر لا يعرف صحته إلا من تصور أحوال السلف فيه تصورهم ورآهم من الوفور والجلالة بأعيانهم واعتقد في هذا العلم الكريم ما يجب اعتقاده له وعلم أنه لم يوفق لاختراعه وابتداء قوانينه وأوضاعه إلا البر عند الله سبحانه الحظيظ بما نوه به وأعلى شأنه.
أو لا يعلم أن أمير المؤمنين عليا - رضى الله عنه - هو البادئه والمنبه عليه والمنشئه والمرشد إليه.
ثم تحقق ابن عباس رضى الله عنه به واكتفال ابي الأسود - رحمه الله - إياه.
هذا بعد تنبيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه وحضه على الأخذ بالحظ منه ثم تتالى السلف - رحمهم الله - عليه واقتفائهم - آخرا على أول - طريقه.
ويكفى من بعد ما تعرف حاله ويتشاهد به من عفة أبي عمرو بن العلاء ومن كان معه ومجاورا زمانه.
حدثنا بعض أصحابنا - يرفعه - قال: قال أبو عمرو بن العلاء - رحمه الله -: مازدت في شعر العرب إلا بيتا واحدا.
يعنى مايرويه للأعشى من قوله: وأنكرتنى وما كان الذى نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا أفلا ترى إلى هذا البدر الطالع الباهر والبحر الزاخر الذي هو أبو العلماء وكهفهم وبدء الرواة وسيفهم كيف تخلصه من تبعات هذا العلم وتحرجه وتراجعه فيه إلى الله وتحوبه حتى أنه لما زاد فيه - على سعته وانبثاقه وتراميه وانتشاره - بيتا واحدا وفقه الله للاعتراف به وجعل ذلك عنوانا على توفيق ذويه وأهليه.
وهذا الأصمعى - وهو صناجة الرواة والنقلة وإليه محط الأعباء والثقلة ومنه تجنى الفقر والملح وهو ريحانة كل مغتبق ومصطبح - كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره - وهو حدث - لأخذ قراءة نافع عنه.
ومعلوم كم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته لأنه لم يقو عنده إذ لم يسمعه.
وقد ذكرنا في الباب الذي هذا يليه طرفا منه.
فأما إسفاف من لا علم له وقول من لا مسكة به: إن الأصمعى كان يزيد في كلام العرب ويفعل كذا ويقول كذا فكلام معفو عنه غير معبوء به ولا منقوم من مثله حتى كأنه لم يتأد إليه توقفه عن تفسير القرآن وحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحوبه من الكلام في الأنواء.
ويكفيك من ذا خشنة أبى زيد وأبى عبيدة.
وهذا أبو حاتم بالأمس وما كان عليه من الجد والانهماك والعصمة والاستمساك.
وقال لنا أبو علي - رحمه الله - يكاد يعرف صدق أبى الحسن ضرورة.
وذلك أنه كان مع هذا إلى ما يعرف عن عقل الكسائى وعفته وظلفه ونزاهته حتى إن الرشيد كان يجلسه ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته ويأمرهما ألا ينزعجا لنهضته.
وحكى أبو الفضل الرياشي قال: جئت أبا زيد لأقرأ عليه كتابه في النبات فقال: لا تقرأه علي فإني قد أنسيته.
وحسبنا من هذا حديث سيبويه وقد حطب بكتابه - وهو ألف ورقة - علما مبتكرا ووضعا متجاوزا لما يسمع ويرى قلما تسند إليه حكاية أو توصل به رواية إلا الشاذ الفذ الذي لا حفل به ولا قدر.
فلولا تحفظ من يليه ولزومه طريق ما يعنيه لكثرت الحكايات عنه ونيطت أسبابها به لكن أخلد كل إنسان منهم إلى عصمته وأدرع جلباب ثقته وحمى جانبه من صدقه وأمانته ما أريد من صون هذا العلم الشريف له به.
فإن قلت: فإنا نجد علماء هذا الشأن من البلدين والمتحلين به في المصرين كثيرا ما يهجن بعضهم بعضا ولا يترك له في ذلك سماء ولا أرضا.
قيل له: هذا أول دليل على كرم هذا الأمر ونزاهة هذا العلم ألا ترى أنه إذا سبقت إلى أحدهم ظنة أو توجهت نحوه شبهة سب بها وبرئ إلى الله منه لمكانها.
ولعل أكثر من يرمى بسقطة في رواية أو غمز في حكاية محمى جانب الصدق فيها برئ عند ذكره من تبعتها لكن أخذت عليه إما لاعتنان شبهة عرضت له أو لمن أخذ عنه وإما لأن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاه مغضوض الطرف دون مداه.
وقد تعرض الشبه للفريقين وتعترض على كلتا الطريقتين.
فلولا أن هذا العلم في نفوس أهله والمتفيئين بظله كريم الطرفين جدد السمتين لما تسابوا بالهجنة فيه ولا تنابزوا بالألقاب في تحصين فروجه ونواحيه ليطووا ثوبه على أعدل غروره ومطاويه.
نعم وإذا كانت هذه المناقضات والمثقافات موجودة بين السلف القديم ومن باء فيه بالمنصب والشرف العميم ممن هم سرج الأنام والمؤتم بهديهم في الحلال والحرام ثم لم يكن ذلك قادحا فيما تنازعوا فيه ولا غاضا منه ولا عائدا بطرف من أطراف التبعة عليه جاز مثل ذلك أيضا في علم العرب الذي لا يخلص جميعه للدين خلوص الكلام والفقه له ولا يكاد يعدم أهله الأنق به والارتياح لمحاسنه.
ولله أبو العباس أحمد بن يحيى وتقدمه في نفوس أصحاب الحديث ثقةً وأمانة وعصمة وحصانة.
وهم عيار هذا الشان وأساس هذا البنيان.
وهذا أبو علي رحمه الله كأنه بعد معنا ولم تبن به الحال عنا كان من تحو به وتأنيه وتحرجه كثير التوقف فيما يحكيه دائم الاستظهار لإيراد ما يرويه.
فكان تارة يقول: أنشدت لجرير فيما أحسب وأخرى: قال لي أبو بكر فيما أظن وأخرى: في غالب ظنى كذا وأرى أني قد هذا جزء من جملة وغصن من دوحة وقطرة من بحر مما يقال في هذا الأمر.
وإنما أنسنا بذكره ووكلنا الحال فيه إلى تحقيق ما يضاهيه.
باب في الجمع بين الأضعف والأقوى في عقد واحد
وذلك جائز عنهم وظاهر وجه الحكمة في لغتهم قال الفرزدق: كلاهما حين جد الجرى بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى فقوله: كلاهما قد أقلعا ضعيف لأنه حمل على المعنى وقوله: وكلا أنفيهما رابى قوى لأنه حمل على اللفظ.
وأنشد أبو عمرو الشيباني: كلا جانبيه يعسلان كلاهما كما اهتز خوط النبعة المتتابع فإخباره بيعسلان عن كلا جانبيه ضعيف على ما ذكرنا.
وأما كلاهما فإن جعلته توكيدا لكلا ففيه ضعيف لأنه حمل على المعنى دون اللفظ.
ولو كان على اللفظ لوجب أن يقول: كلا جانبيه يعسل كله أو قال: يعسلان كله فحمل يعسلان على المعنى وكله على اللفظ وإن كان في هذا ضعف لمراجعة اللفظ بعد الحمل على المعنى.
وإن جعلت كلاهما توكيدا للضمير في يعسلان فإنه قوى لأنهما في اللفظ اثنان كما أنهما في المعنى كذلك.
وقال الله - سبحانه -: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} فحمل أول الكلام على اللفظ وآخره على المعنى والحمل على اللفظ أقوى.
وتقول: أنتم كلكم بينكم درهم.
فظاهر هذا أن يكون كلكم توكيدا لأنتم والجملة بعده خبر عنه.
ويجوز أن يكون كلكم مبتدأ ثانيا والجملة بعده خبر عن كلكم.
وكان أجود من ذلك أن يقال: بينه درهم لأنه لفظ كل مفرد ليكون كقولك أنتم غلامكم له مال.
ويجوز أيضا: أنتم كلكم بينهم درهم فيكون عود الضمير بلفظ الغائب حملا على اللفظ وجمعه حملا على المعنى.
كل ذلك مساغ عندهم ومجاز بينهم.
وقال ابن قيس: لئن فتنتني لهى بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم وفتن أقوى من أفتن حتى إن الأصمعي لما أنشد هذا البيت شاهدا لأفتن قال: ذلك مخنث ولست آخذ بلغته.
وقد جاء به رؤبة إلا أنه لم يضممه إلى غيره قال: يعرضن إعراضا لدين المفتن ولسنا ندفع أن في الكلام كثيرا من الضعف فاشيا وسمتا منه مسلوكا متطرقا.
وإنما غرضنا هنا أن نرى إجازة العرب جمعها بين قوى الكلام وضعيفه في عقد واحد وأن وأما قوله: أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها فلغتان قويتان.
وقال: لم تتلفع بفضل مئزرها دعدٌ ولم تسق دعد في العلب فصرف ولم يصرف.
وأجود اللغتين ترك الصرف.
وقال: إني لأكنى بأجبال عن اجبلها وبآسم أودية عن اسم واديها وأجبال أقوى من أجبل وهما - كما ترى - في بيت واحد.
ومثله في المعنى لا في الصنعة قول الاخر: أبكي إلى الشرق ما كانت منازلها مما يلي الغرب خوف القيل والقال وأذكر الخال في الخد اليمين لها خوف الوشاة وما في الخد من خال قال صاحب الكتاب: أراد: يا معاوية فرخمه على يا حارُ فصار يا معاوى ثم رخّمه ثانيا على قولك: يا حارِ فصار: يامعاوِ كما ترى.
أفلا تراه كيف جمع بين الترخيمين: أحدهما على يا حارُ وهو الضعيف والآخر على يا حارِ وهو القوىّ ووجه الحكمة في الجمع بين اللغتين: القويّة والضعيفة في كلام واحد هو: أن يُروك أن جميع كلامهم - وإن تفاوت أحواله فيما ذكرنا وغيره - على ذكر منهم وثابت في نفوسهم.
نعم وليؤنِّسك بذاك حتى إنك إذا رأيتهم وقد جمعوا بين ما يقوى وما يضعف في عقد واحد ولم يتحاموه ولم يتجنبوه ولم يقدح أقواهما في أضعفهما كنت إذا أفردت الضعيف منهما بنفسه ولم تضممه إلى القوىّ فيتبين به ضعفه وتقصيره عنه آنس به وأقل احتشاما لاستعماله فقد عرفت ما جاء عنهم من نحو قولهم: كل مجرٍ بالخلاء يسر.
وأنشد الأصمعي: فلا تصلى بمطروق إذا ما سرى في القوم أصبح مستكينا إذا شرب المرضة قال: أوكى على ما في سقائك قد روينا وغرضه في هذين البيتين أن يريك خفضة في حال دعته.
وقريب منه قول لبيد: يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد أي: هناك يُعرف قد الإنسان لا في في حال الخلوة والخفيضة.
وعليه قولها: أي وقتى الإغارة والإضافة.
وقد كثر جدا.
وآخر ما جاء به شاعرنا قال: وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا ونظير هذا الإنسان يكون له ابنان أو أكثر من ذلك فلا يمنعه نجابة النجيب منهما الاعتراف بأدونهما وجمعه بينهما في المقام الواحد إذا احتاج إلى ذلك.
وقد كنا قدمنا في هذا الكتاب حكاية أبي العباس مع عمارة وقد قرأ: ولا الليل سابق النهار فقال له أبو العباس: ما أردت فقال: أردت: سابق النهار.
فقال: فهلا قلته! فقال عمارة: لو قلته لكان أوزن.
وهذا يدلك على أنهم قد يستعملون من الكلام ما غيره آثر في نفوسهم منه سعة في التفسح وإرخاء للتنفس وشحا على ما جشموه فتواضعوه أن يتكارهوه فيلغوه ويطرحوه.
فاعرف ذلك مذهبا لهم ولا تطعن عليهم متى ورد عنهم شيء منه.
باب في جمع الأشباه من حيث يغمض الاشتباه
هذا غور من اللغة بطين يحتاج مجتابه إلى فقاهة في النفس ونصاعة من الفكر ومساءلة خاصية ليست بمبتذلة ولا ذات هجنة.
ألقيت يوما على بعض من كان يعتادني فقلت: من أين تجمع بين قوله: لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب وبين قولنا: اختصم زيد وعمرو فأجبل ورجع مستفهما.
فقلت: اجتماعهما من حيث وضع كل واحد منهما في غير الموضع الذي بدئ له.
وذلك أن الطريق خاص وضع موضع العام.
وذلك أن وضع هذا أن يقال: كما عسل أمامه الثعلب وذلك الأمام قد كان يصلح لأشياء من الأماكن كثيرة: من طريق وعسف وغيرهما.
فوضع الطريق - وهو بعض ما كان يصلح للأمام أن يقع عليه - موضع الأمام.
فنظير هذا أن واو العطف وضعها لغير الترتيب وأن تصلح للأوقات الثلاثة نحو جاء زيد وبكر.
فيصلح أن يكونا جاءا معا وأن يكون زيد قبل بكر وأن يكون بكر قبل زيد.
ثم إنك قد تنقلها من هذا العموم إلى الخصوص.
وذلك قولهم: اختصم زيد وعمرو.
فهذا لا يجوز أن يكون الواو فيه إلا لوقوع الأمرين في وقت واحد.
ففى هذا أيضا إخراج الواو عن أول ما وضعت له في ألأصل: من صلاحها للأزمنة الثلاثة والاقتصار بها على بعضها كما اقتصر على الطريق من بعض ما كان يصلح له الأمام.
ومن ذلك أن يقال لك: من أين تجمع بين قول الله سبحانه: { يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ } من قول الشاعر: زمان عليّ غراب غداف فطيره الدهر عنى فطارا فالجواب: أن في كل واحد من الآية والبيت دليلا على قوة شبه الظرف بالفعل.
أما الآية فلأنه عطف الظرف في قوله: {فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ} على قوله: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} والعطف نظير التثنية وهو مؤذن بالتماثل والتشابه.
وأما البيت فلأنه عطف الفعل فيه على الظرف الذي هو قوله: علي غراب غداف.
وهذا واضح.
وبهذا يقوى عندي قول مبرمان: إن الفاء في نحو قولك: خرجت فإذا زيد عاطفة وليست زائدة كما قال أبو عثمان ولا للجزاء كما قال الزيادي.
ومن ذلك أن يقال: من أين تجمع قول الله سبحانه: { ولم يكن له ولى من الذل } مع قول امرىء القيس: والجواب أن معنى قوله: { ولم يكن له ولى من الذل }: لم يذل فيحتاج إلى ولى من الذل كما أن هذا معناه: لا منار به فيهتدى به.
ومثله قول الآخر: لا تفزع الأرنب أهوالها ولا يرى الضب بها ينجحر وعليه قول الله تعالى: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} أى لا يشفعون لهم فينتفعوا بذلك.
يدل عليه قوله عز اسمه: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} وإذا كان كذلك فلا شفاعة إلا للمرتضى.
فعلمت بذلك أن لو شفع لهم لا ينتفعون بذلك.
ومنه قولهم: هذا أمر لا ينادى وليده أى لا وليد فيه فينادى.
فإن قيل: فإذا كان لا منار به ولا وليد فيه ولا أرنب هناك فما وجه إضافة هذه الأشياء إلى ما لا ملابسة بينها وبينه قيل: لا بل هناك ملابسة لأجلها ما صحت الإضافة.
وذلك أن العرف أن يكون في الأرض الواسعة منا يهتدى به وأرنب تحلها.
فإذا شاهد الإنسان هذا البساط من الأرض خاليا من المنار والأرنب ضرب بفكره إلى ما فقده منهما فصار ذلك القدر من الفكر وصلة بين الشيئين وجامعا لمعتاد الأمرين.
وكذلك إذا عظم الأمر واشتد الخطب على أنه لا يقوم له ولا يحضر فيه إلا الأجلاد وذوو البسالة دون الولدان وذوى الضراعة.
فصار العلم بفقد هذا ومن ذلك أن يقال: من أين تجمع قول الأعشى: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا مع قول الآخر - فيما رويناه عن ابن الأعرابي -: وطعنة مستبسل ثائر ترد الكتيبة نصف النهار ومع قول العجاج: ولم يضع جاركم لحم الوضم ومع قوله أيضاً: حتى إذا اصطفوا له جدارا والجواب: أن التقاء هذه المواضع كلها هو في أن نصب في جميعها على المصدر ما ليس مصدرا.
وذلك أن قوله: ليلة أرمدا انتصب ليلة منه على المصدر وتقديره: ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمد فلما حذف المضاف الذي هو اغتماض أقام ليلة مقامه فنصبها على المصدر كما كان الاغتماض منصوبا عليه.
فالليلة إذاً ههنا منصوبة على المصدر لا على الظرف.
كذا قال أبو على لنا.
وهو كما ذكر لما ذكرنا.
فكذلك إذاً قوله: إنما نصف النهار منصوب على المصدر لا على الظرف ألا ترى أن ابن الأعرابي قال في تفسيره: إن معناه: ترد الكتيبة مقدار نصف اليوم أى مقدار مسيرة نصف يوم.
فليس إذاً معناه: تردها في وقت نصف النهار بل: الرد الذي لو بدىء أول النهار لبلغ نصف يوم.
وكذلك قول العجاج: ولم يضع جاركم لحم الوضم فلحم الوضم منصوب على المصدر أى ضياع لحم الوضم.
وكذلك قوله أيضاً: حتى إذا اصطفوا له جدارا فجدارا الوضم منصوب على المصدر.
هذا هو الظاهر ألا ترى أن معناه: حتى إذا اصطفوا له اصطفاف جدار ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه على ما مضى.
وقد يجوز أن يكون جدارا حالا أي مثل الجدار وأن يكون أيضاً منصوبا على فعل آخر أى صاروا جدارا أى مثل جدار فنصبه في هذا الموضع على أنه خبر صاروا.
والأول أظهر وأصنع.
ومن ذلك أن يقال: من أين يجمع قول الله سبحانه: {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ} مع قوله تعالى: {يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ}.
والتقاؤهما أن أبا علي - رحمه الله - كان يقول: إن عين استكانوا من الياء وكان يأخذه من لفظ الكين ومعناه وهو لحم باطن الفرج أى فما ذلوا وما خضعوا.
وذلك لذل هذا الموضع ومهانته.
وكذلك قوله: {وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ} إنما هو من لفظ الحياء ومعناه أى الفرج أى يطئوهن وهذا واضح.
ومن ذلك أن يقال: من أين يجمع بين قول الله تعالى: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ} و بين قوله: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}.
والتقاءهما من قبل أن الفاء في قوله سبحانه: {فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ} إنما دخلت لما في الصفة التي هي قوله: {الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ} من معنى الشرط أى إن فررتم منه لاقاكم - فجعل - عز اسمه - هربهم منه سببا للقيه إياهم على وجه المبالغة حتى كأن هذا مسبب عن هذا كما قال زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه فمعنى الشرط إذاً إنما هو مفاد من الصفة لا الموصوف.
وكذلك قوله عز وجل: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} إنما استحقوا الويل لسهوهم عن الصلاة لا للصلاة نفسها والسهو مفاد من الصفة لا من الموصوف.
فقد ترى إلى اجتماع الصفتين في أن المستحق من المعنى إنما هو لما فيهما من الفعل الذي هو الفرار والسهو وليس من نفس الموصوفين اللذين هما الموت والمصلون.
وليس كذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم} من قبل أن معنى الفعل المشروط به هنا إنما هو مفاد من نفس الاسم الذي وقال لى أبو علي - رحمه الله -: { إنى لم أودع كتابى } في الحجة شيئا من انتزاع أبي العباس غير هذا الموضع أعنى قوله: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ} مع قوله: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وكان - رحمه الله - يستحسن الجمع بينهما.
ومن ذلك أن يقال: من أين يجمع قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} مع قول الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر والتقاؤهما أن معناه: فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة وكذلك قوله: حتى يقول الناس أى حتى يقول كل واحد من الناس: يا عجبا! ألا ترى أنه لولا ذلك لقيل: يا عجبنا.
ومثل ذلك ما حكاه أبز ويد من قولهم: أتينا الأمير فكسانا كلنا حلة وأعطانا كلنا مائة أى كسا كل واحد منا حلة وأعطاه مائة.
ومثل قوله سبحانه: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ} أى: أو لم نعمر كل واحد منكم ما يتذكر فيه من تذكر.
ومن ذلك أن يقال: من أين يجمع قول العجاج: وكحل العينين بالعواور لما رأى أن لادعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فالطجع واجتماعهما أنه صحح الواو في العواور لإرادة الياء في العواوير كما أنه أراد: فاضطجع ثم أبدل من الضاد لا ما.
فكان قياسه إذ زالت الضاد وخلفتها اللام أن تظهر تاء افتعل فيقال: التجع كما يقال: التفت والتقم والتحف.
لكن أقرت الطاء بحالها ليكون اللفظ بها دليلا على إرادة الضاد التي هذه اللام بدل منها كما دلت صحة الواو في العواور على إرادة الياء في العواوير وكما دلت الهمزة في أوائيل - إذا مددت مضطرا - على زيادة الياء فيها وأن الغرض إنما هو أفاعل لا أفاعيل.
ونحو من الطجع في إقرار الطاء لإرادة الضاد ما حكى لنا أبو علي عن خلف من قولهم: التقطت النوى واستقطته واضتقطته.
فصحة التاء مع الضاد في اضتقطته دليل على إرادة اللام في التقطته وإن هذه الضاد بدل من تلك اللام كما أن لام الطجع بدل من ضاد اضطجع: هذا هنا كذلك ثمة.
ونحو من ذلك ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: لا أكلمك حيرى دهرٍ بإسكان الياء في الكلام وعن غير ضرورة من الشعر.
وذلك أنه أراد: حيرى دهر - أى امتداد الدهر وهو من الحيرة لأنها مؤذنة بالوقوف والمطاولة - فحذف الياء الأخيرة وبقيت الياء الأولى على سكونها وجعل بقاؤها ساكنة على الحال التي كانت عليها قبل حذف الأخرى من بعدها دليلا على إرادة هذا المعنى فيها وأنها ليست مبنية على التخفيف في أول أمرها إذ لو كانت كذلك لوجب تحريكها بالفتح فيقال: لا أكلمك حيرى دهر كقولك: مدة الدهر وأبد الأبد ويد المسند و: بقاء الوحى في الصم الصلاب ونحو ذلك.
وهذا يدل على أن المحذوف من الياءين في قوله: بكى بعينك واكف القطر ابن الحوارى العالى الذكر إنما هو الياء الثانية في الحوارى كما أن المحذوف من حيرى دهر إنما هو الثانية في حيرى.
فاعرفه.
ومثله إنشاد أبي الحسن: ارهن بنيك عنهم أرهن بنى يريد بنىّ فحذف الياء الثانية للقافية ولم يعد النون التي كان حذفها للإضافة فيقول: بنين لأنه نوى الياء الثانية فجعل ذلك دليلا على إرادتها ونيته إياها.
فهذا شرح من خاصى السؤال لم تكد تجرى به عادة في الاستعمال.
وقد كان أبو علي رحمه الله - وإن لم يكن تطرقه - يعتاد من الإلقاء نحوا منه فيتلو الآية وينشد البيت ثم يقول: ما في هذا مما يسأل عنه من غير أن يبرز نفس حال المسئول عنه ولا يسمح بذكره من جهته ويكله إلى استنباط المسئول عنه حتى إذا وقع له غرض أبي علي فيه أخذ في الجواب عليه.
باب في المستحيل وصحة قياس الفروع على فساد الأصول
اعلم أن هذا الباب وإن ألانه عندك ظاهر ترجمته وغض منه في نفسك بذاذة سمته فإن فيه ومن ورائه تحصينا للمعاني وتحريرا للألفاظ وتشجيعا على مزاولة الأغراض.
والكلام فيه من موضعين: أحدهما: ذكر استقامة المعنى من استحالته والآخر: الاستطالة على اللفظ بتحريفه والتعلب به ليكون ذلك مدرجة للفكر ومشجعة للنفس وارتياضا لما يرد من ذلك الطرز.
وليس لك أن تقول: فما في الاشتغال بإنشاء فروع كاذبة عن أصول فاسدة! وقد كان في التشاغل بالصحيح مغنٍ عن التكلف للسقيم.
هذا خطأ من القول من قبل أنه إذا أصلح الفكر وشحذ البصر وفتق النظر كان ذلك عونا لك وسيفا ماضيا في يدك ألا ترى إلى ما كان نحو هذا من الحساب وما فيه من التصرف والاعتمال.
وذلك قولك: إذا فرضت أن سبعة في خمسة أربعون فكم يجب أن يكون على هذا ثمانية في ثلاثة فجوابه أن تقول: سبعة وعشرون وثلاثة أسباع.
وبابه - على الاختصار - أن تزيد على الأربعة والعشرين سُبُعها وهو ثلاثة وثلاثة أسباع كما زدت على الخمسة والثلاثين سبعها - وهو خمسة - حتى صارت: أربعين.
وكذلك لو قال: لو كانت سبعة في خمسة ثلاثين كم كان يجب أن تكون ثمانية في ثلاثة لقلت: عشرين وأربعة أسباع نقصت من الأربعة والعشرين سبعها كما نقصت من الخمسة والثلاثين سبعها.
وكذلك لو كان نصف المائة أربعين لكان نصف الثلاثين اثنى عشر.
وكذلك لو كان نصف المائة ستين لكان نصف الثلاثين ثمانية عشر.
ومن المحال أن يقول لك: ما تقول في مال نصفه ثلثاه كم ينبغي أن يكون ثلثه فجوابه أن تقول: أربعة أتساعه.
وكذلك لو قال: ما تقول في مال ربعه وخمسه نصفه وعشره كم ينبغي أن يكون نصفه وثلثه فجوابه أن يكون: جميعه وتسعه.
وكذلك لو قال: ما تقول في مال نصفه ثلاثة أمثاله كم يجب أن تكون سبعة أمثاله فجوابه أن تقول: اثنين وأربعين مثلا له.
وكذلك لو قال: ما تقول في مال ضعفه ثلثه كم ينبغي أن يكون أربعة أخماسه وجوابه أن تقول: عشره وثلث عشره.
وكذلك لو قال لك: إذا كانت أربعة وخمسة ثلاثة عشر فكم يجب أن يكون تسعة وستة فجوابه أن تقول: أحدا وعشرين وثلثين.
وكذلك طريق الفرائض أيضا ألا تراه لو قال: مات رجل وخلف ابنا وثلاث عشرة بنتا فأصاب الواحدة ثلاثة أرباع ما خلفه المتوفى كم يجب أن يصيب الجماعة فالجواب أنه يصيب جميع الورثة مثل ما خلفه المتوفى إحدى عشرة مرة وربعا.
وكذلك لو قال: امرأة ماتت وخلفت زوجا وأختين لأب وأم فأصاب كل واحدة منهما أربعة أتساع ما خلفته المتوفاة كم ينبغي أن يصيب جميع الورثة والجواب أنه يصيبهم ما خلفته المرأة وخمسة أتساعه.
فهذه كلها ونحوه من غير ما ذكرنا أجوبة صحيحة على أصول فاسدة.
ولو شئت أن تزيد وتغمض في السؤال لكان ذلك لك.
وإنما الغرض في هذا ونحوه التدرب به والارتياض بالصنعة فيه.
وستراه بإذن الله.
فمن المحال أن تنقض أول كلامك بآخره.
وذلك كقولك: قمت غدا وسأقوم أمس ونحو هذا.
فإن قلت: فقد تقول إن قمت غدا قمت معك وتقول: لم أقم أمس وتقول: أعزك الله وأطال بقاءك فتأتى بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال وقال: ولقد أمر على اللئيم يسبنى فمضيت ثمت قلت لا يعنيني أي: ولقد مررت.
وقال: وإنى لآتيكم تشكر ما مضى من الأمر واستيجاب ما كان في غد أوديت إن لم تحب حبو المعتنك أي أودى - وأمثاله كثيرة -.
قيل: ما قدمناه على ما أردنا فيه.
فأما هذه المواضع المتجوزة وما كان نحوها فقد ذكرنا أكثرها فيما حكيناه عن أبي علي وقد سأل أبا بكر عنه في نحو هذا فقال أبو بكر كان حكم الأفعال أن تأتي كلها بلفظ واحد لأنها لمعنى واحد غير أنه لما كان الغرض في صناعتها أن تفيد أزمنتها خولف بين مُثُلها ليكون ذلك دليلا على المراد فيها.
قال: فإن أمن اللبس فيها جاز أن يقع بعضها موقع بعض.
وذلك مع حرف الشرط نحو إن قمت جلست لأن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال.
وكذلك لم يقم أمس وجب لدخول لم ما لولا هي لم يجز.
قال: ولأن المضارع أسبق في الرتبة من الماضي فإذا نفى الأصل كان الفرع أشد انتفاء.
وكذلك أيضا حديث الشرط في نحو إن قمت قمت جئت فيه بلفظ الماضي الواجب تحقيقا للأمر وتثبيتا له أي إن هذا وعد موفى به لا محالة كما أن الماضي واجب ثابت لا محالة.
ونحو من ذلك لفظ الدعاء ومجيئة على صورة الماضي الواقع نحو أيدك الله وحرسك الله إنما كان ذلك تحقيقا له وتفؤلا بوقوعه أن هذا ثابت بإذن الله وواقع غير ذي شك.
وعلى ذلك يقول السامع للدعاء إذا كان مريدا لمعناه: وقع إن شاء الله ووجب لا محالة أن يقع ويجب.
ولقد أمر على اللئيم يسبني فإنما حكى فيه الحال الماضية والحال لفظها أبدا في بالمضارع نحو قولك: زيد يتحدث ويقرأ أي هو في حال تحدث وقراءة.
وعلى نحو من حكاية الحال في نحو هذا قولك: كان زيد سيقوم أمس أي كان متوقعا منه القيام فيما مضى.
وكذلك قول الطرماح:
واستيجاب ما كان في غد يكون عذره فيه: أنه جاء بلفظ الواجب تحقيقا له وثقة بوقوعه أي إن الجميل منكم واقع متى أريد وواجب متى طلب.
وكذلك قوله: أوديت إن لم تحب حبو المعتنك جاء به بلفظ الواجب لمكان حرف الشرط الذي معه أي إن هذا كذا لا شك فيه فالله الله في أمرى يؤكد بذلك على حكم في قوله: يا حكم الوارث عن عبد الملك أي إن لم تتداركني هلكت الساعة غير شك هكذا يريد.
فلأجله ما جاء بلفظ الواجب الواقع غير المرتاب به ولا المشكوك في وقوعه.
وقد نظر إلى هذا الموضع أبو العتاهية فاتبعه عتب الساعة الساعه أموت الساعة الساعه وهذا - على نذالة لفظه - وفق ما نحن على سمته.
وهذا هذا.
وليس كذلك قولك: قمت غدا وسأقوم أمس لأنه عارٍ من جميع ما نحن فيه إلا أنه لو دل دليل من لفظ أو حال لجاز نحو هذا.
فأما على تعرية منه وخلوه مما شرطناه فيه فلا.
ومن المحال قولك: زيد أفضل إخوته ونحو ذلك.
وذلك أن أفضل: أفعل وأفعل هذه التي معناها المبالغة والمفاضلة متى أضيفت إلى شيء فهى بعضه كقولك: زيد أفضل الناس فهذا جائز لأنه منهم والياقوت أنفس الأحجار لأنه بعضها.
ولا تقول: زيد أفضل الحمير ولا الياقوت أنفس الطعام لأنهما ليسا منهما.
وهذا مفاد هذا.
فعلى ذلك لم يجيزوا: زيد أفضل إخوته لأنه ليس واحد من إخوته وإنما هو واحد من بنى أبيه ألا ترى أنه لو كان له إخوة بالبصرة وهو ببغداد وكان بعضهم وهم بالبصرة لوجب من هذا أن يكون من ببغداد البتة في حال كونه بها مقيما بالبصرة البتة في تلك الحال.
وأيضا فإن الإخوة مضافون إلى ضمير زيد وهي الهاء في إخوته فلو كان واحدا منهم وهم مضافون إلى ضميره كما ترى لوجب أيضا أن يكون داخلا معهم في إضافته إلى ضميره وضمير الشيء هو الشيء البتة والشيء لا يضاف إلى نفسه.
وأما قول الله تعالى {وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ} فإن الحق هنا غير اليقين وإنما هو خالصه وواضحه فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل نحو هذا ثوب خز.
ونحوه قولهم: الواحد بعض العشرة.
ولا يلزم من حيث كان الواحد بعض العشرة أن يكون بعض نفسه لأنه لم يضف إلى نفسه وإنما أضيف إلى جماعة نفسه بعضها وليس كذلك زيد أفضل إخوته لأن الإخوة مضافة إلى نفس زيد وهي الهاء التي هي ضميره.
ولو كان زيد بعضهم وهم مضافون إلى ضميره لكان هو أيضا مضافا إلى ضميره الذي هو نفسه وهذا محال.
فاعرف ذلك فرقا بين الموضعين فإنه واضح.
فأما قولنا: أخذت كل المال وضربت كل القوم فليس الكل هو ما أضيف إليه.
قال أبو بكر: إنما الكل عبارة عن أجزاء الشيء وكما جاز أن يضاف أجزاء الجزء الواحد إلى الجملة جاز أيضا أن تضاف الأجزاء كلها إليه.
فإن قيل: فالأجزاء كلها هي الجملة فقد عاد الأمر إلى إضافة الشيء إلى نفسه.
قيل: هذا فاسد وليس أجزاء الشيء هي الشيء وإن كان مركبا منها.
بل الكل في هذا جارٍ مجرى البعض في أنه ليس بالشيء نفسه كما أن البعض ليس به نفسه.
يدل على ذلك وأن حال البعض متصورة في الكل قولك: كل القوم عاقل أي كل واحد منهم على انفراده عاقل.
هذا هو الظاهر وهو طريق الحمل على اللفظ قال تعالى: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} وقال تعالى: كلا أبويكم كان فرع دعامة فلم يقل: كانا وهو الباب.
ومثله قول الأعشى أيضا: حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر أي حتى يقول كل واحد منهم: يا عجبا.
وعليه قول الآخر: تفوقت مال ابنى حجير وما هما بذى حطمة فانٍ ولا ضرع غمر أي: وما كل واحد منهما كذلك.
فأما قوله تعالى: {وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} و {كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} فمحمول على المعنى دون اللفظ.
وكأنه إنما حمل عليه هنا لأن كلا فيه غير مضافة فلما لم تضف إلى جماعة عوض من ذلك ذكر الجماعة في الخيبر.
ألا ترى أنه لو قال: وكل له فانت لم يكن فيه لفظ الجمع البتة ولما قال: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} فجاء بلفظ الجماعة مضافا إليها استغنى به عن ذكر الجماعة في الخبر.
وتقول - على اللفظ -: كل نسائك قائم ويجوز: قائمة إفرادا على اللفظ أيضا وقائمات على المعنى البتة قال الله - سبحانه -: {يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء} ولم يقل: كواحدة لأن الموضع موضع عموم فغلب فيه التذكير وإن كان معناه: ليست كل واحدة منكن وصواب المسألة أن تقول: زيد أفضل بني أبيه وأكرم نجل أبيه وعترة أبيه ونحو ذلك وأن تقول: زيد أفضل من إخوته لأن بدخول مِن ارتفعت الإضافة فجازت المسألة.
ومن المحال قولك: أحق الناس بمال أبيه ابنه.
وذلك أنك إذا ذكرت الأبوة فقد انطوت على البنوة فكأنك إذاً إنما قلت: أحق الناس بمال أبيه أحق الناس بمال أبيه.
فجرى ذلك مجرى قولك: زيد زيد والقائم القائم ونحو ذلك مما ليس في الجزء الثاني منه إلا ما في الجزء الأول البتة وليس على ذلك عقد الإخبار لأنه يجب أن يستفاد من الجزء الثاني ما ليس مستفادا من الجزء الأول.
ولذلك لم يجيزوا: ناكح الجارية واطئها ولا رب الجارية مالكها لأن الجزء الأول مستوف لما انطوى عليه الثاني.
فإن قلت: فقد قال أبو النجم: أنا أبو النجم وشعرى شعرى وقال الآخر: إذ الناس ناسٌ والبلاد بغرة وإذ أم عمار صديقٌ مساعف وقال آخر: بلاد بها كنا وكنا نحلها إذ الناس ناس والبلاد بلاد هذه رجائي وهذى مصر عامرةً وأنت أنت وقد ناديت من كثب وأنشد أبو زيد: رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجوه هُم هُم وأمثاله كثيرة.
قيل: هذا كله وغيره مما هو جار مجراه محمول عندنا على معناه دون لفظه ألا ترى أن المعنى: وشعرى متناهٍ في الجودة على ما تعرفه وكما بلغك وقوله: إذ الناس ناس أي: إذ الناس أحرار والبلاد أحرار وأنت أنت أي: وأنت المعروف بالكرم وهم هم أي: هم الذين أعرفهم بالشر والنكر لم يستحيلوا ولم يتغيروا.
فلولا هذه الأغراض وأنها مرادة معتزمة لم يجز شيء من ذلك لتعرى الجزء الآخر من زيادة الفائدة على الجزء الأول.
وكأنه إنما أعيد لفظ الأول لضرب من الإدلال والثقة بمحصول الحال.
أي أنا أبو النجم الذي يكتفى باسمه من صفته ونعته.
وكذلك بقية الباب كما قال: أنا الحباب الذي يكفى سمى نسبي ونظر إليه شاعرنا وقلبه فقال: ولكن صحة المسألة أن تقول: أحق الناس بماله أبيه أبرهم به وأقومهم بحقوقه.
فتزيد في الثاني ما ليس موجودا في الأول.
فهذه طريقة استحالة المعنى.
وهو باب.
وأما صحة قياس الفروع على فساد الأصول فكأن يقول لك قائل: لو كانت الناقة من لفظ القنو ما كان يكون مثالها من الفعل.
فجوابه أن تقول: علفة.
وذلك أن النون عين والألف منقلبة عن واو والواو لام القنو والقاف فاؤه.
ولو كان القنو مشتقا من لفظ الناقة لكان مثاله لفع.
فهذان أصلان فاسدان والقياس عليهما آوٍ بالفرعين إليهما.
وكذلك لو كانت الأسكفة مشتقة من استكف الشيء - على ما قال وذهب إليه أحمد بن يحيى لكانت أسفعلة - ولو كان استكف مشتقا من الأسكفة لكان على اللفظ: افتعل بتشديد اللام وعلى الأصل: افتعلل لأن أصله على الحقيقة: استكفف.
ومن ذلك أن لو كان ماهان عربيا فكان من لفظ هوم أو هيم لكان لعفان.
ولو كان من لفظ الوهم لكان لفعان.
ولو كان من لفظ همى لكان: علفان.
ولو وجد في الكلام تركيب و م ه فكان ماهان من لفظه لكان مثاله: عفلان.
ولو كان من لفظ النهم لكان: لاعافا.
ولو كان من لفظ المهيمن لكان: عافالا.
ولو كان في الكلام تركيب م ن ه فكان ماهان منه لكان: فالاعا.
ولو كان فيه تركيب ن م ه فكان منه لكان: عالافا.
وذهب أبو عبيدة في المندوحة إلى أنها من قولهم: انداح بطنه إذا اتسع.
وذلك خطأ فاحش.
ولو كانت منه لكانت: منفعلة.
وقد ذكرنا ذلك في باب سقطات العلماء.
نعم ولو كانت من لفظ الواحد لكانت: منلفعة.
ولو كانت من لفظ حدوت لكانت: منعلفة.
ولو كانت من دحوت لكانت: منفلعة.
ولو كان في الكلام تركيب و د ح فكانت مندوحة منه لكانت: منعفلة.
ولو كان قولهم: انداح بطنه من لفظ مندوحة لكانت: افعال بألف موصولة واللام مخففة.
وذهب بعض أشياخ اللغة في يستعور إلى أنه: يفتعول وأخذه من سعر.
وهذا غلط.
ولو كان من قولهم: عَّرس بالمكان لكان: يلتفوعا.
ولو كان من سَرُع لكان: يفتلوعا.
ولو كان من عسر لكان: يعتفولا.
ولو كان من لفظ رسع لكان: يعتلوفا.
ولو كان من لفظ رعس لكان: يلتعوفا.
وأما تيهورة فلو كانت من تركيب ه ر ت لكانت: ليفوعة.
ولو كانت من لفظ ت ر ه لكانت: فيلوعة.
ولو كانت من لفظ ه ت ر لكانت: عيفولة.
ولو كانت من لفظ ر ه ت لكانت: ليعوفة.
ولو كانت من لفظ ر ت ه لكانت: عيلوفة.
ومع هذا فليست من لفظ ت ه ر وإن كانت - في الظاهر وعلى البادى - منه بل هي عندنا من لفظ ه و ر.
وقد ذكر ذلك أبو على في تذكرته فغنينا عن إعادته.
وإنما غرضنا هنا مساق الفروع على فساد الأصول لما يعقب ذلك من قوة الصنعة وإرهاف الفكرة.
وأما مرمريس فلو كانت من لفظ س م ر لكانت: علعليف.
ولو كانت من لفظ ر س م: لكانت لفلفيع ولو كانت من لفظ ر م س لكانت: عفعفيل.
ولو كانت من لفظ س ر م لكانت: لعلعيف.
ولو كانت من لفظ م س ر لكانت: فلفليع.
لكنها عندنا من لفظ م ر س وهي على الحقيقة فعفعيل منه.
وأما قرقرير لقرقرة الحمام فإنها فعلليل وهو رباعي وليست من هذا الطرز الذي مضى.
وأما قندأو فإنها فنعلو من لفظ ق د أ ولو كانت من لفظ ق د و لكانت: فنعأل.
ولو كانت من لفظ د و ق لكانت: لنفأع.
ولو كانت من لفظ ن ق د لكانت: عفلأو.
ولو كانت من لفظ ن د ق لكانت: لفعأو.
ولو كانت من لفظ الندأة لكانت قفلعو فحكمت بزيادة القاف وهذا أغرب مما قبله.
ولو كانت من لفظ النآدى لكانت: قفلعو بزيادة القاف أيضا.
والمسائل من هذا النجر تمتد وتنقاد إلا أن هذا طريق صنعتها.
فاعرفه وقسه بإذن الله تعالى.
تم نسخ الكتاب من موقع المكتبة الإسلامية
من قبل : شبكة مشكاة الإسلامية / مكتبة مشكاة
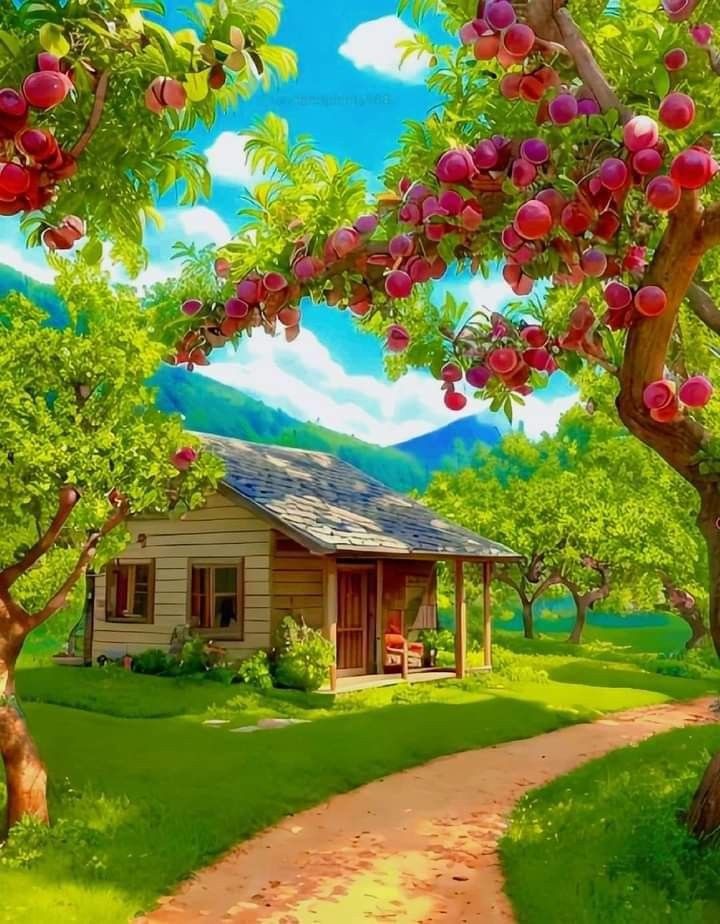
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق